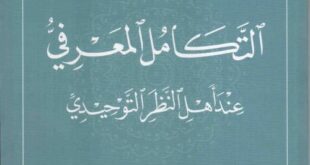المشروع الفكري لمالك بن نبي
أ. يارا عبد الجواد*
المقدمة
إننا إذ نلج إلى صفحات المشروع الفكري للمفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي نلج إلى حياة رجل مهمومًا بأمته الإسلامية وما آل إليه حالها من ضعف بعد قوة وذلة بعد عزة وتخلفًا بعدما كانت في مقدمة الأمم، ووصل بها الحال أن تقع تحت حكم المستعمر الأجنبي في بقاع كثيرة منها منذ أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين، في نفس الوقت الذي كان فيه العالم الغربي “المستعمِر” يسير بسرعة في مساره الحداثي التقدمي. لقد كان مالك بن نبي الذي عايش تجربة الاستعمار في بلده الجزائر وعانى ويلاته وآلامه يطرح التساؤلات حول هذا التغير الذي طرأ على عالمنا الإسلامي كما كان يضع الإجابات والحلول أيضًا مسترشدًا في ذلك بنور الوحي. فجاء مشروعه الفكري تشخيصًا لأزمة التخلف الحضاري في العالم الإسلامي ومقدمًا لمنظور حضاري لبعث الأمة من جديد.
لم يكن مالك بن نبي مجرد مفكرًا أيديولوجيًا، ولا كاتبًا مغرمًا بالتنظير، ولا مهتمًا بتجميع الناس حول فكره، ولا سياسيًا يطالب بالحقوق، ولكنه كان عالمًا ومفكرًا وصاحب دعوة وفيلسوف واسع النظر ومهندس أفكار نادر الوجود، انشغل نظريًا وعمليًا بتشخيص أمراض الأمة المتوارثة والمستوردة، واعتنى بصياغة منهجًا إصلاحيًا يعيد الأمة مرة أخرى إلى مسار التاريخ الحضاري.
مالك بن نبي: سيرته والسياق التاريخي لمشروعه الفكري
يقول مالك بن نبي: “وفي ظهيرة يوم الجمعة أخذت نصيبي من الرغيف وأخذت أقضمه بنهم ولذة، وفجأة سمعت بباب الدار سائلًا ينادي: “أعطوني من مال الله”، ولم أكن حينها أكلت من فطيرتي أكثر من النصف، ومع ذلك بادرت بإعطائها له عندما تذكرت واحدة من حكايات جدتي عن الإحسان وثوابه”.
إن هذه الجمل التي قالها مالك بن نبي تحكي لنا الكثير عن الطبيعة الأصيلة لشخصية هذا المفكر الكبير الذي نشأ منذ صغره وهو يحمل همًا أكبر من همّ نفسه وحدودها الضيقة، بل يعيش همّ أمة كاملة، حتى صبغ هذا الهمّ فكره وحدد معالم نبوغه العلمي الفريد وقد كان لنشأته وتكوينه الشخصي أثر كبير في مسيرته العلمية لذا نقف قليلًا معها.
ولد المفكر الإسلامي الجزائري (مالك بن عمر بن نبي) بمدينة قسنطينة عام 1905 م، في عائلة فقيرة، وقد تبناه عمه ليتربى عنده، وسرعان ما توفي عمه فأعادته زوجة عمه إلى أبويه، اللذين سافرا به إلى مدينة تبسة سنة 1912م عند أخوال أمه، الذين كانوا يعملون بالتجارة وببعض الحرف، وظل والده لفترة دون عمل، وفيها عرف مالك طعم الحرمان، وحكى عنه في مذكراته فقال: “ففي العائلة الفقيرة لابد أن يجوع الصغار متى فقد الأب عمله، غير أن أمي كانت تحول دون ذلك بممارستها للخياطة، وبالتالي فهي التي كانت تمسك بكيس النقود الذي كان دائمًا فارغًا”.
وقد كان لحكايات جدته وقع كبير على شخصيته، بسردها الدائم لأهوال فظائع سقوط مدينة قسنطينة بيد الفرنسيين سنة 1837م، وكيف هرّب أهل قسنطينة زوجاتهم وبناتهم بالحبال من أعالي مرتفع سيدي مسيد، كي لا يتعرضن لوحشية جنود الاحتلال.
تلقى مالك تعليمه الأولي في كُتّاب بلدة تبسة طيلة أربع سنوات، حفظ خلالها عدة أجزاء من القرآن الكريم، والتحق بالمدرسة الفرنسية أثناءها، لينقطع بعدها عن الكُتّاب، مع احتفاظه بالتردد على المسجد، وخاصة في أيام العطل والجمعة وأيام الصيف.
ولما أتم المرحلة الابتدائية ونجح في نيل شهادة التعليم الابتدائية، انتقل إلى قسنطينة ليواصل دراسته في المرحلة التكميلية للحصول على رتبة كاتب عدل، وكانت هذه المرحلة من أخصب مراحل حياته، حيث التقى فيها بالشيخ عبد الحميد بن باديس، وأعلام النهضة الجزائرية العربية الإسلامية الحديثة أمثال الشيخ المولود بن الموهوب، والشيخ محمد بن العابد، اللذين اكتسب منهما العلم الشرعي، ونمَّى ثقافته الإسلامية، كما اكتسب من الشيخ عبد الحميد بن باديس الحماسة والشجاعة والإقدام.
وفي هذه الفترة قرأ الكثير من الكتب، كما تعرّف على بعض تلامذة الشيخ عبد الحميد بن باديس، واطّلع على جريدة (الإقدام) التي أكسبته قوة عظيمة فقال عنها: “فالإقدام وضعت في فكري الحدود السياسية الدقيقة، فكانت تكشف عمليات استغلال الفلاح الجزائري، وقد بلغت درجة لا توصف في هذه الفترة”.
وقد كان طيلة تلك السنوات يتردد على مدينة تبسة التي أثرت فيه بيئتها تأثيرًا كبيرًا وجعلته مواكبًا لمعاناة الشعب الجزائري. وبعد نهاية السنة الرابعة من إتمام المرحلة الثانوية ما بين 1924- 1925م، سافر مع صديقه (قاواو) إلى فرنسا بحثًا عن العمل، فذهبا إلى مرسيليا وليون وباريس، ولكنهما أخفقا في إيجاد العمل المناسب فعاد مرة أخرى إلى تبسه.
وبعد العودة خاض تجارب عديدة في البحث عن عمل، فعمل في محكمة أفلو مارس 1927م، ثم أعاد الكرة سنة 1930م بالسفر لفرنسا، ولكن هذه المرة للدراسة، فحاول الالتحاق بمعهد الدراسات الشرقية، إلا أنه لم يكن يسمح للجزائريين بمزاولة مثل هذه الدراسات، فقد نصحه مدير المعهد بألا يحاول التقدم للامتحان مرة أخرى، وقد حيّره هذا الموقف وجعله يدرك بأن الالتحاق بالمعهد لا يخضع بالنسبة لجزائري مسلم لمقاييس فكرية، بل لمقاييس سياسية، ولذلك التحق بن نبي بمعهد الهندسة الكهربائية ليتخرج منه سنة 1935. وعند التحاقه بذلك المعهد وجد نفسه مفتونًا بالعلوم التجريبية التي تعد مفتاح الحضارة الغربية، فحرص على اقتناء الكتب العلمية، فأثرى مكتبته بالكتب الهندسية والتطبيقية، وفي ذلك يقول بن نبي: “كنتُ أريد أن أفهم كل شيء: الجبر، والهندسة، والكهرباء، والطبيعة، والميكانيكا”. وفي عام 1931م تزوج بن نبي من فتاة فرنسية، اعتنقت الإسلام وتسمت باسم خديجة، وكان لها أثر كبير في حياته، حيث كانت تعينه وتشجعه على الاجتهاد في دراسته العلمية ونشاطه الفكري، كما استطاعت أن تقرب له قيم الحضارة الغربية التي شكلت شخصيتها وأسلوبها في الحياة، الأمر الذي ساعد بن نبي على استيعاب الثقافة الغربية.
وقد كان بن نبي حريص على تحليل الأحداث التي كانت تحيط به، وقد أعطته ثقافته المنهجية قدرة على إبراز مشكلة العالم الإسلامي باعتبارها قضية حضارة أولًا وقبل كل شيء، فوضع كتبه جميعًا تحت عنوان مشكلات الحضارة، وانكب على الدراسة، وعلى الحياة الفكرية والنشاط النضالي والتقى بكثير من قادة الرأي والفكر والنضال السياسي من آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وأثناء دراسته في فرنسا وإقامته فيها إلى 1956 كان بن نبي منخرطًا في النضال الوطني، والاتصال بمعظم حركات الفكر والتحرر في العالم. كما كانت له جدالات كثيرة مع الشباب الجزائري والمغاربي والعربي من مختلف الاتجاهات الماركسية، والليبرالية، والعنصرية، والقومية.
وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، تم سجنه في فرنسا والتضييق عليه، ولكن تمت تبرئته من المحكمة. ومع قيام الثورة التحريرية الكبرى، اضطر للجوء إلى مصر، وبعد أن استقر في مصر حصل على وظيفة مستشار في مجمع البحوث الإسلامية، وكذلك في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهنا بدأت رحلة تواصله العميق مع المشرق ورجاله وحركاته.
وفي القاهرة تعرّف على المشرق العربي الذي طالما حلم بزيارته، وصارت القاهرة بالنسبة له ملتقى للقاء المثقفين والمفكرين والسياسيين. ومن القاهرة زار سوريا ولبنان وليبيا، والكويت، والسعودية، وغيرها من بلدان العالم العربي، حيث أتيحت له هناك فرص إلقاء المحاضرات في الجامعات والمنتديات الثقافية، فكانت هذه المرحلة بمثابة تعريف وتقديم مالك بن نبي وفكره إلى العالم العربي، الذي أخذ يشهد مشاركاته في العديد من المؤتمرات التي انعقدت في القاهرة، ومكة المكرمة، والكويت، وطرابلس.
في عام 1963 عاد بن نبي إلى الجزائر، وتم تعيينه في مناصب عديدة منها: مستشار التعليم العالي، ومدير جامعة الجزائر، ومدير عام التعليم العالي. وفي عام 1967م استقال من منصبه ليتفرغ للعمل الفكري[1] ولتنظيم الندوات حيث كانت له في العاصمة الجزائرية ندوة يقصدها الشباب من سائر أنحاء المغرب العربي وأوروبا، وهي ندوة أسبوعية تعقد في داره بالعاصمة، وتحولت فيما بعد إلى ملتقيات للتعرف على الفكر الإسلامي، واستمرت بعد وفاته، وتبنتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلى أن تم توقيفها بعد انقلاب 1992.
وفي عام 1972 قام بن نبي بتأدية فريضة الحج مارًا بدمشق حيث ألقى هناك محاضرة تحت عنوان “دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين” وقد كانت هذه المحاضرة بمثابة وصيته الأخيرة، إذ ما لبث بعد عودته إلى الجزائر أن توفي رحمه الله في 4 شوال 1393هـ / 31 أكتوبر 1973م، بعد حياة حافلة بالبذل والعمل لدينه وأمته.
أولًا- الحضارة ومشكلاتها: سؤال النهضة وإجابته
أ- الحضارة: منظور بن نبي الإصلاحي وإطاره العام
لقد بدأ مالك بن نبي بناء لبنات مشروعه الفكري بكتابين رئيسيين الأول هو “الظاهرة القرآنية”, وفي هذا دلالة على مركزية الوحي في ضبط بوصلته الفكرية. ثم جاء كتاب “شروط النهضة” الذي هو بمثابة خريطة تضم الخطوط العريضة والعناصر الأساسية الذي تألّف منها هذا المشروع. ثم كان تفصيل هذه العناصر في بقية مؤلفاته المندرجة تحت العنوان الكبير “مشكلات الحضارة”.
لقد حدد بن نبي داء العالم الإسلامي ودواؤه أيضًا في “الحضارة ومشكلاتها”. ولكن “مفهوم الحضارة” عند مالك بن نبي ليس مجرد مفهومًا جزئيًا وإنما هو منظورًا وإطارًا كليًا لتشخيص أمراض أمتنا الإسلامية ولوصف العلاج لها؛ فهو منظور يوفر فهمًا كليًا للحضارة دون اختزال لمشكلاتها الجزئية، بمعنى أنه ينظر إلى مشكلات الأمة على أنها كلها تنضوي تحت ما يسميه “مشكلة الحضارة”، باعتبار أن الحضارة هي الإطار الذي ينظم كل هذه الأجزاء؛ التي نسميها في مكان ما مشكلة سياسية، وفي مكان آخر مشكلة اقتصادية، وفي مكان ثالث مشكلة أخلاقية. هذا بالإضافة إلى أن معنى الحضارة بالنسبة له لم يكن مجرد مجموعة من المنجزات المادية فحسب، بل مفهوم شمولي يتجسد في كل جوانب الحياة، فهي تمثل المحيط الذي يعكس أساس ثقافي وفكري معين. ومن هنا اهتم مالك كثيرًا بالثقافة وعناصرها ومكوناتها ودورها في البناء الحضاري.
وبناءً على هذا يمكننا تلخيص المشروع الفكري لمالك بن نبي بأنه محاولة حثيثة للإجابة عن سؤالين: الأول لماذا تخلف المسلمون؟ “تشخيص الداء”. والثاني كيف ينهض المسلمون من جديد؟ “وصف الدواء”. وكلمة السر في كلا السؤالين هي “الحضارة”.
لقد كان يرى مالك بن نبي أن العالم الإسلامي أضاع وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا، بسبب عدم التحليل المنهجي للمرض الذي يتألم منه منذ قرون طويلة، فذهب يلتمس الحلول الجزئية، ونظر إلى القضية في صورها التجزيئية، فاختلفت الأطروحات؛ من الطرح السياسي إلى الطرح الاقتصادي إلى الطرح الأخلاقي وما إلى ذلك. ولأجل ذلك، فإن مالك يرفض النظرة السطحية للمشكلة أو تجزيئها، ويعتبر أن هذا يؤدي إلى تعميق التخلف، لأن الجهود تتجه في الحقيقة لمعالجة مظاهره وليس جوهره، ويكمن الجوهر في الإمساك بالمشكلة المركزية التي تنتظمه “مشكلة الحضارة”، ومن ثم الارتقاء إلى مستوى أرحب في التحليل، من خلال النظر إلى الأزمة بنظرة شمولية.
ومن هنا يقول بن نبي “إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها”.
ب- معادلة بناء الحضارة
يعرّف مالك بن نبي الحضارة – بصورة تحليلية – من خلال صياغة المعادلة الرياضية التالية: الحضارة = إنسان + تراب + وقت.
وانطلاقًا من هذه المعادلة فإن مشكلة الحضارة يمكن تفكيكها إلى ثلاث مشكلات أولية: مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت. وبالتالي لكي نتمكن من بناء حضارة فإننا نحتاج أن نقوم بحل المشكلات الثلاثة من أساسها.
1- مشكلة الإنسان: يقول مالك بن نبي “يجب أولًا أن نصنع رجالًا يمشون في التاريخ مستخدمين التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى”.
من هنا يعتبر بن نبي أن الإنسان هو نقطة البدء ومحور التغيير والفاعلية في حركة الحضارة، وبالتالي فإن التفكير في بناء الحضارة يتم عبر التفكير في بناء الإنسان، فهو يؤكد أن الإنسان هو الذي يحدد في النهاية القيمة الاجتماعية لمعادلة الحضارة، لأن التراب والوقت لا يقومان – إذا اقتُصر عليهما فحسب – بأي تحويل اجتماعي.
فالإنسان هو من يبني الحضارة حين يستخدم ما بين يديه من إمكانات بعد أن يتفاعل مع الفكرة الدينية ومقتضياتها، فيتحول خموده وسكونه إلى حركة بنائية فاعلة.
ويبين بن نبي أن الإنسان يؤثر في المجتمع بثلاثة مؤثرات: بفكره وعمله وماله، وهذا يستوجب توجيهه في هذه النواح الثلاثة:
1- توجيه الفكر(الثقافة): فالثقافة – كما يرى بن نبي – نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة، وقد عرّفها بأنها “مجموعة الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته”.
فالثقافة هي المحيط الذي يعكس حضارة معينة، والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر. وقد توسع بن نبي في تحليل ومناقشة مشكلة الثقافة في عالمنا الإسلامي في كتابه “مشكلة الثقافة”، الذي ركز فيه على أهمية الثقافة في جانبها النظري والعملي التربوي “كنظرية في السلوك” في نهضة المجتمعات أو تخلفها وأن قوة الأفكار هي التي تخلق الفعالية ابتداءً وليست القوة المادية.
ومن هنا ينطلق بن نبي من قاعدة مفادها أن “كل تفكير في مشكلة الإنسان هو تفكير في مشكلة الحضارة، وكل تفكير في مشكلة الحضارة هو في الأساس تفكير في مشكلة الثقافة باعتبار الحضارة في جوهرها مجموعة من القيم الثقافية المحققة، وأنه إذا ما أريد للنهضة أن تبرز إلى عالم الوجود فإن علينا أن نواجه مشكلة الثقافة في أصولها”.
وتوجيه الثقافة عند بن نبي يقوم على آليتين هما التصفية والبناء، فمن خلال التصفية يتم التخلص من رواسب الماضي، ومن خلال البناء نتصل بمقتضيات المستقبل.
وفي هذا السياق حاول بن نبي وضع برنامج عمل لحل هذه الأزمة وقد تجسد هذا الجهد في محاولة إجابته عن السؤال التالي: ما هي الثقافة التي تبني الفرد الفعال؟
ومن هنا تحدث عن دستور الثقافة أو عناصر الثقافة، وقد حدد عناصر الثقافة كالتالي:
– المبدأ الأخلاقي: حيث يرى بن نبي أن فاعلية المجتمعات متوقفة على القوة الدافعة التي يمنحها المبدأ الأخلاقي.
– الذوق الجمالي: يؤكد بن نبي على أن الإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق الجمال، “فالجمال هو الإطار الذي تتكون فيه أي حضارة”، لذلك ينبغي أن يتجه المشروع التربوي للثقافة إلى تنمية هذا الذوق في روح الفرد والمجتمع وتصفية الإطار الاجتماعي من كل ما يشيع فيه الفوضى أو يسيء للذوق الجمالي.
فعندما تكون البيئة نظيفة وجميلة فإنها تثّبت في الفرد الذي ينشأ ضمنها معاني الجمال والذوق الرفيع فينعكس هذا في سلوكياته وأفكاره.
– المنطق العملي: أحد أبعاد المنطق العملي تقوم على استخراج أقصى ما يمكن من الفائدة من الوسائل المتاحة مهما كانت بسيطة. وهنا يؤكد بن نبي أن هناك صور وأشكال من اللا فعالية تصبغ أعمالنا حيث يذهب جزء كبير منها في العبث والمحاولات الهازلة، لأننا نفقد الضابط الذي يربط بين العمل وهدفه، وبين السياسة ووسائلها، وبين الفكرة وتحقيقها.
وهكذا تُستهلك الإمكانات ويضيع الوقت، ويستنفد المجتمع طاقاته في مشاريع فاشلة فتتضاعف مديونيته الحضارية وتتفاقم أزمته.
– العلم أو الصناعة (بتعبير ابن خلدون):
إن أهم ما يميز مجتمعًا ما في مرحلة تخلفه الحضاري بالإضافة إلى تهدم شبكة علاقاته وفوضى عالمه الثقافي وخمود إنسانه هو تخلفه العلمي والتقني والصناعي.
1- التوجيه التربوي: هنا تبرز ضرورة التوجيه التربوي للقدرات والمهن والتكنولوجيا في المجتمع المسلم الذي يرغب في التقدم. من هذا المنطلق نجد بن نبي يلح على هذا العنصر المهم من عناصر التوجيه الثقافي، وهو عندما يتكلم عن الصناعة فلا يقصرها على مفهومها الضيق وإنما يوسعها لتشمل كل الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم، والتي بوجودها يتمكن المجتمع من المحافظة على كيانه ونموه.
2- توجيه العمل: هو الحلقة الثانية من مشكلة الإنسان. وتوجيه العمل هو تكتيل الجهود الجماعية لتصب في اتجاه واحد يحقق أهداف المجتمع.
وبن نبي عندما يتحدث عن العمل فإنه يبسط مفهومه ليشمل كل ما يمكن أن نعده في نظرنا تافهًا لا قيمة له من جهد بشري، ولكنه في حقيقة الأمر يكتسي أهمية بالغة لأن صناعة التاريخ تبدأ من هذه الأمور البسيطة.
3- توجيه رأس المال: يرى بن نبي أن المال لكي يكون عاملًا من عوامل النهضة يجب أن يكون على هيئة رأس مال لا على هيئة ثروة، لأن الثروة تزيد الطبقية في المجتمع، إذ أنها مال ثابت مكدّس ملك لإنسان، بينما تشغيل رأس المال يحرّك الدولة اقتصاديًا، ويتنقل بين الأفراد لا ينحصر في مِلك فرد بعينه. ومن هنا اعتنى بفكرة توجيه رأس المال باعتبارها الحلقة الثالثة من مشكلة الإنسان، أي تحريكه وتنشيطه نحو الصالح العام باعتباره آلة اجتماعية لا آلة سياسية في يد طبقة رأسمالية تضطهد من خلالها جموع الشعب.
2- مشكلة التراب
يعتبر التراب أحد العناصر الحضارية الهامة في معادلة مالك بن نبي، حيث يؤكد بن نبي عند التطرق له على أهمية استغلاله من قبل الإنسان وتحويله إلى ما فيه المنفعة العامة، لما لذلك من أثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ولذلك يقول بن نبي: “فالأرض هي مسرح التحضر وعليها يكون استقرار الإنسان، ومن مرافقها السطحية والباطنية يرتفق لاستيفاء حاجاته وتنمية أساليب حياته”.
3- مشكلة الوقت
يقول مالك بن نبي متحدثًا عن مشكلة الوقت: “الزمن نهر قديم يعبر العالم منذ الأزل فهو يمر خلال المدن، يغذي نشاطها بطاقته الأبدية، أو يذلل نومها بأنشودة الساعات التي تذهب هباء، وهو يتدفق على السواء في أرض كل شعب، ومجال كل فرد، بفيض من الساعات اليومية التي لا تفيض، ولكنه في مجال ما يصير ثروة، وفي مجال آخر يتحول عدمًا. فهو يمرق خلال الحياة، ويصب في التاريخ تلك القيم التي منحها له ما أنجز فيه من أعمال. ولكنه نهر صامت، حتى إننا ننساه أحيانًا، وتنسى الحضارات، في ساعات الغفلة أو نشوة الحظ قيمته التي لا تعوض”.
يشير بن نبي إلى أهمية الوقت كعنصر من عناصر بناء الحضارة وضرورة استثماره لتحصيل أفضل النتائج، ويرى أنه عندما يتحدد معنى الزمن في نفس الإنسان والمجتمع، يتحدد معنى التأثير والإنتاج وتصبح للوقت قيمته ودوره في تنمية حصاد المجتمع العقلي واليدوي والروحي.
لكنه أيضًا يشير إلى ملاحظة مهمة هي أنه إذا كان على البلاد الإسلامية أن تعرف كيف تقدر الآثار السلبية للإفراط في قيمة الوقت في نشاطها، فإن عليها بالمقابل ألا تغلو في الإفراط في تقديره، حيث يمكنها أن ترى بسهولة نتائجه السلبية في البلاد المتقدمة التي اتجهت نحو المادية الصرفة، وجعلت الإنسان يغترب عن ذاته وتهدر إنسانيته عندما أصبح ترسًا في عجلة آلة لا تتوقف أبدًا، هي عجلة الحضارة الغربية.
بناء على ما سبق وبعد أن فكك بن نبي مشكلات الحضارة وعناصرها الأولية معتبرًا أن أي جهد أو منتَج حضاري هو نتيجة للتفاعل بين هذه العناصر الثلاث، عنصر الإنسان صاحب الجهد المنجز، وعنصر التراب الذي هو مصدر الإنجاز المادي، وعنصر الزمن الذي هو شرط أساسي لأي عملية إنجازية يقوم بها الإنسان، يشير بن نبي أن التفاعل بين هذه العناصر الثلاث لا يتم تلقائيًا متى ما توفرت هذه العناصر وإنما يحتاج إلى مركب إضافي يجعل هذا التفاعل يتم وهذا المركب يتمثل في “الفكرة الدينية”، فالفكرة الدينية هي بمثابة الشرارة التي تشعل هذا التفاعل.
ج- الأثر الاجتماعي للفكرة الدينية
يرى بن نبي أننا حينما نتأمل القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية تحكم فكر الإنسان وحضارته، كما تحكم الجاذبية المادة، وتتحكم في تطورها. والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني، ابتداءً من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات البدائية، فهو قانون من قوانين الله عز وجل التي فطرت عليها النفس الإنسانية.
وبناء على ذلك قام بن نبي بتحليل دورتين من دورات الحضارة، هما الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية لاستخراج السر الذي دفع بكلتا الحضارتين إلى مسرح التاريخ، وتحديد الموقع الذي يمثله الدين في حركة الحضارة. وهو بتحليله لهذين الدورتين ينتهي إلى تأكيد أن السر الكوني الذي يركب العناصر الثلاثة الأساسية للحضارة: الإنسان والتراب والوقت، ويبعثها كقوة فاعلة في التاريخ هو الدين.
يبين بن نبي أن الفكرة الدينية كعامل اجتماعي تؤثر في توجيه التاريخ، وذلك من خلال تدخلها في صياغة إنسان الحضارة وتوجيه القيم النفسية والاجتماعية. فالعنصر الديني بصفة عامة – فضلًا عن أنه يغذي الجذور النفسية العامة – يتدخل مباشرة في العناصر الشخصية التي تكوِّن الأنا الواعية في الفرد وفي تنظيم الطاقة الحيوية التي تضعها الغرائز في خدمة هذه الأنا. كما أن الفكرة الدينية التي ترافق تركيب الحضارة خلال التاريخ – بمزج العناصر الثلاث: الإنسان، والتراب، والوقت – تعفي بعض المجتمعات من تكديس ما تنتجه الحضارات الأخرى وتدفع بها إلى محاولة البناء والتعويل على الذات.
غير أن الفكرة الدينية لا تقوم بدورها اعتباطًا، بل إن الفكرة الدينية لا تقوم بدورها الاجتماعي إلا بقدر ما تكون متمسكة بقيمتها الغيبية؛ أي بقدر ما تكون معبرة عن نظرتنا إلى ما بعد الأشياء الأرضية.
وعلاوة على ذلك فالفكرة الدينية بحكم بفكرة الغائية (مفهوم الآخرة) تمنح الحياة دلالة ومعنى، وبالتالي تبعث في المجتمع الوعي بهدف معين، وهذا الهدف ينتقل من جيل إلى جيل ومن طبقة إلى أخرى، وبذلك تكون قد مكنت لبقاء المجتمع ودوامه. كما أن الفكرة الدينية توفر الأرضية الأخلاقية أو القانون الأخلاقي الذي يسير عليه المجتمع، والذي به يمكن للمجتمع أن يؤسس لشبكة علاقاته الاجتماعية ويحفظها من التفكك، فكلّما حدث إخلال بالقانون الخلقي في مجتمع معين حدث تمزق في شبكة العلاقات التي تتيح له أن يصنع التاريخ.
د- دورة الحضارة ومراحلها
لم يقف مالك بن نبي عند مشكلات الحضارة وعناصر بناءها، بل توسع من خلال دراسته للتاريخ ليؤكد على الطابع الانتقالي للحضارة، حيث إنها تنتقل من طور إلى طور، ومن مجتمع إلى مجتمع، حسب شروط وسنن لا تتخلف، وأيضًا حسب التفاعل بين عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم الأشياء.
وعلى هذا الأساس قسم ابن نبي الأطوار التي تمر بها الحضارة إلى مراحل ثلاث هي:
– مرحلة الروح: تتسم هذه المرحلة بتحكيم فكرة دينية أو أخلاقية تنقل المجتمع من براثن الجهل، واتباع الغرائز إلى الإيمان بتلك الفكرة، يتبعه تنظيم للغرائز، فيصبح المجتمع أكثر فاعلية، وأتقن عملًا، ويعمل بما لا يحتمله عقل أو غريزة، ومن أمثلة تلك المرحلة:
* انتقال المجتمع الجاهلي من الجهل والتخلف إلى الرقي والحضارة بعد إيمانه بفكرة، وهي الرسالة السماوية، فأصبحت أهدافه أسمى، وأولوياته أرقى. ولقد رأينا صورًا من الإرادة يحملها من تشّرب تلك الروح، أمثال: عمار بن ياسر، وبلال بن رباح، وغيرهم.
* انتقال المجتمع الأوروبي من مرحلة الانحطاط والتخلف الحضاري إلى مرحلة النهضة بعد إيمانه بمبادئها.
* انتقال شعب اليابان من واقع اليأس أمام الدمار الذي أُلحق بهم إلى الفاعلية والمسؤولية بعد ما أشربوه من معانٍ لحب العمل، وإيجابية العمل الجماعي، والإرادة، والأخلاق.
– مرحلة العقل: وتعد هذه المرحلة أطول مرحلة من مراحل الدورة التاريخية، حيث تتميز بسيطرة العقل مقابل سيطرة الروح، وتبدأ الغريزة بالتحرر تدريجيًا. تتسم هذه المرحلة بالتوسع الفكري وغزارة الموروثات الحضارية، ويرافق ذلك توسع في البلاد.
وقد امتدت مرحلة العقل في عالمنا الإسلامي منذ بداية العصر الأموي وحتى سقوط الخلافة العثمانية والتي وصلت فيها الدولة الإسلامية إلى أوسع بقعة جغرافية، إضافة لريادة العلم وبروز مفكرين وعلماء أمثال ابن خلدون والفارابي وابن سينا وابن رشد.. إلخ.
– مرحلة الغريزة: تتسم هذه المرحلة بتراجع مرحلة العقل، وعجز الروح والفكرة، وسيطرة كاملة للغريزة من جاه وسلطة ومال وغيرها. وإذا ما قمنا بتطبيق هذه النظرية على واقع الأمم اليوم لوجدنا أن الحضارة الغربية في مرحلة العقل، وسيطرة جزئية للغريزة تزيد يومًا بعد يوم. أما الأمة الإسلامية فهي تعاني من عجز للفكرة وغياب تام للعقل وبالتالي فهي في المرحلة الثالثة من مراحل الدورة التاريخية أي في مرحلة الغريزة.
من هنا يؤكد بن نبي على أن الأمتين ليستا في نفس المرحلة. هذا فضلًا عن أن مشكلاتنا كأمة إسلامية تختلف تمامًا عن مشكلات العالم الغربي، فالتقليد الأعمى لهم، واستيراد حلولهم هو تضييع للوقت والجهد ومضاعفة للداء، بل هذا التقليد هو جهل وانتحار لأمتنا، حيث إن لكل مرحلة مشاكلها وخاصيّاتها.
ثم يتوسّع مالك بمرحلة الغريزة التي تعيش بها أمتنا، فيذكر أنّ هذه المرحلة – وما تتسم به من غياب عالم الأفكار – تعاني من طغيان عالم الأشخاص وعالم الأشياء وانتشار الوثنية، والتي تحمل صورًا عدة ليست مقتصرة على أحجار الجاهلية، بل تمتّد لتشمل الأشخاص والمؤسسات. ولقد مثّل القساوسة أوثان العصور الوسطى لدى الغربيين، كما مثّلت السياسة والسياسيّون أوثان أمتنا في العصر الحاضر، فصارت أمنياتنا معلقة بهم، وصار الاهتمام بنهضة الأمة مقتصر عليهم، وصار الحديث كله عن الحقوق دون أدنى التزام بالواجبات. وهنا يرى بن نبي أن الشعوب لا يمكن أن تُنشئ دستور حقوقها إلا إذا عدّلت أوضاعها الاجتماعية المرتبطة بسلوكها النفسي، “غيّر نفسك تغيّر التاريخ” تلك هي السنة الكونية والشرعية، يأمر بها القرآن ويلتزمها كل صاحب فكرة. قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ).
ولذلك يعتبر بن نبي أن الحكومة ما هي إلا آلة اجتماعية مسيّرة لوسط اجتماعي تتغير تبعًا للوسط الذي تعيش فيه، فإذا كان هذا الوسط نظيفًا حرًا فحكومته من جنسه، أما إذا كان الشعب يتصف بالقابلية للاستعمار فحكومته لا بد وأن تكون حكومة مستعمرة.
ومن هنا تناول مالك بن نبي عاملي الاستعمار والقابلية للاستعمار باعتبارهما عاملين أساسيين مؤثرَين في بناء الحضارة، لما لهما من أثر كبير على عناصر بناء الحضارة وخصوصًا “الإنسان”.
فأما العامل الاستعماري فيتمثل في الجهود التي يبذلها المستعمر لجعل المستعمَر قابلًا للاستعمار، من حملات تجهيل وتغريب وإفقار. وينطلق بن نبي في نظريته من التجربة الجزائرية الحاضرة في ذهنه، إذ أن المحتلّ الفرنسي كان أقل تحضّرًا وثقافة من البلد المحتَلّ: الجزائر، فكان على المحتل حتى يروّج ثقافته أن يحقق تفوقًا ثقافيًا، فعمد إلى إفقار الشعب الجزائري وتجهيله حتى تركه ونسبة الأمية فيه بلغت 93 %، ومن هنا خلص بن نبي إلى فكرة أن الغرب تحضّر بعدما استعمر، ولم يستعمر بعد تحضّره.
أما العامل الثاني وهو “القابلية للاستعمار” – وهو من أهم مفاهيمه وأكثرها تأثيرًا – فيرى بن نبي أن جهود المستعمِر تثمر في الشعوب المستعمَرة، فيستبطن الثاني ثقافة الأول، ويراعي في نفسه الحدود التي خطها المستعمر. وتتطور القضية من تبنيه لثقافته إلى مدافعته عنها، حتى تصل إلى رفضه للمصلحين ودعاة الفضيلة. إذًن فالعامل الثاني هو عامل داخلي يستجيبُ للعامل الأول وهو العامل الخارجي المتمثل في الاستعمار.
ثالثًا: “عالم الأفكار”: داء ودواء العالم الإسلامي
إن ما سبق ذكره هو بمثابة الإطار النظري لمشروع مالك بن نبي الفكري والإصلاحي. ولعلنا في هذا الجزء ننتقل بهذا الإطار إلى العالم الإسلامي لنرى من أين خط له بن نبي بداية الدواء والبناء الحضاري، وعمدتنا في هذا الجزء هو كتابه “مشكلة الأفكار في العالم الإٍسلامي” وهو من أهم ما ألف مالك بن نبي في سلسلة “مشكلات الحضارة”. فقد أصدر الكتاب قبل ثلاث سنوات من وفاته، وهذا ما يجعل منه خلاصة وثمرة مكتملة لأعماله، كما أنه أقرب كتبه إلى المنهج، فهو ليس جملة تأملات فردية أو ذاتية بقدر ما يعبر عن فقه صاحبه للسنن الاجتماعية.
لقد كان بن نبي ينظر للواقع من منظور كلي ووفق قواعد كلية شمولية ولا يغفل البعد السنني، ومن أهم أدواته في ذلك تحليل الواقع وفق ثلاث عوالم رئيسية: عالم الأفكار، عالم الأشخاص، عالم الأشياء.
فهو يري أن الإنسان يتعايش منذ طفولته مع ثلاثة عوالم: الأشياء، والأشخاص، والأفكار. والنمط الثقافي الاجتماعي هو الذي يحدد للشخص نوع عالمه حيث تتفوق إحداها على الأخرى وفق نمط الثقافة.
وفي هذا السياق يرى بن نبي أن المجتمعات تتخلف عندما تنحدر من عالم الأفكار إلى الأشخاص إلى الأشياء، ويرى أيضًا أن ما يميز المجتمعات عن بعضها هو ترجيحها لأحد العوالم الثلاثة (الأفكار – الأشخاص – الأشياء)، فرجحان أحد هذه العوالم هو الذي يميز كل مجتمع عن سواه.
وإذا كانت الحضارة في عناصرها الأساسية: الإنسان، التراب، الزمن – كما يشرح بن نبي في مؤلفاته – والثقافة إذا كانت في مهمتها أسلوب حضارة تحرك الإنسان ووسائله عبر القنوات الأربع: المبدأ الأخلاقي، الذوق الجمالي، المنطق العملي، التقنية، فإن مسيرة الحضارة هذه تسير بالمجتمع قوة وضعفًا، دفعًا وهونًا، صعودًا وهبوطًا، تبعًا لدرجة تمركزه حول الأفكار أو حول الأشياء المحيطة به. فلكل حضارة نمطها وأسلوبها وخيارها، فخيار العالم الغربي ذي الأصول الرومانية الوثنية قد جنح بصره نحو الأشياء، بينما الحضارة الإسلامية وعقيدة التوحيد، سبح خيارها نحو التطلع الغيبي وما وراء الطبيعة: أي نحو الأفكار. من هنا يؤكد بن نبي على أن مشكلة العالم الإسلامي هي مشكلة أفكار في المقام الأول.
يبين بن نبي أن تطور الأفكار في العالم الإسلامي قد حدث عبر الأجيال، حيث تراكمت الأفكار الموروثة مع الأفكار الجديدة المُضافة. ولكن مع مرور الوقت، بدأت هذه الأفكار في التلاشي تدريجيًا، خاصة مع ضعف الأفكار الجوهرية (الرئيسية). ففي البداية كانت الأفكار الجديدة الذي أتي بها الإسلام بمثابة عاصفة تلتها أمطار تروي النمو والازدهار، فلم تقم بتغيير الناس فقط من الخارج، بل غيرتهم في العمق داخل أنفسهم وضمائرهم، حيث تلاشت الموارد القبلية والفردية، وامتزجت مع أفكار الوحدة والأخوة والالتزام بسبيل الله الواحد، وأصبحت طاقة المجتمع الجديدة إبداعية. ولكن وفي المراحل اللاحقة وبعد أن تلاشى تأثير الأفكار الرئيسية في المجتمع المسلم، لم يبق شيء منه سوى الجذور المدفونة في الأرض والعمق، وأصبح جسد الأمة يشبه “الرجل المريض” المستسلم للعملية الجراحية الذي يقوم بها العدو الماكر(المستعمر)، الذي زرع فيه أعضاء غريبة (متنافرة مع ذاته) وبدأ بتسكيته بالوهم والمسكنات، وهو غير قادر على البقاء على قيد الحياة.
ويؤكد بن نبي على أن المجتمع الإسلامي اليوم يدفع ضريبة خيانته لنماذجه وأفكاره الأصيلة. وهذا نجده مجسدًا في تناقض المسلم مع ذاته، فهو يقوم بواجباته الدينية ويصلي في المسجد، ثم نجده بعد ذلك يخرج من المسجد ليغرق في عالم آخر ونموذج فكري آخر لا يشبهه.
وفي هذا السياق قدم بن نبي إطارًا معياريًا لتصنيف الأفكار من حيث أصالتها ومن حيث فعاليتها، فبيّن أن هناك أفكار أصيلة، وهي الأفكار التي تحتفظ بفاعليتها وقدسيتها على مدار الدهور، حيث تعبر عن حقائق مستقلة عن التاريخ وتتمتع بطبيعتها القدسية. ومع ذلك، فإن فاعلية تلك الأفكار ترتبط بالظروف والتاريخ. وهناك أفكار أخرى ذات فاعلية مؤقتة لكنها ليست أصيلة بالضرورة. فبعض الأفكار البادئة قد تنشأ وتكتسب فاعلية في ظروف معينة، وتعتبر تلك الفاعلية نتيجة للظروف، ولكنها ليست ثابتة ودائمة كالأفكار الأصيلة.
ويرى بن نبي أن أوروبا في القرن التاسع عشر قد أودعت قدرها في ثلاث كلمات: العلم، التقدم، الحضارة. فكانت هذه أفكارًا مقدسة سمحت لها أن ترسي قواعد حدود حضارة القرن العشرين، وأن تبسط خارج حدودها سلطتها على العالم. أما آفة النخبة الإسلامية فهو انغماسها في تقليد الحضارة الأوروبية دون العودة لأفكارها الأصيلة. ويشدد بن نبي على أنه يجب على العالم الإسلامي أن يحافظ على أصالة أفكاره ويبذل الجهد لاستعادة فاعليتها، ويعيد إلى الأذهان القيم والمبادئ التي تميزت بها الحضارة الإسلامية في الماضي، مع الاستفادة من التقدم والعلم الحديث. وهذا يتطلب تعزيز التفكير النقدي والتعليم المستمر وتطوير المفاهيم الإسلامية في ضوء التحديات الحديثة.
وفي هذا الإطار يشير بن نبي إلى أنه من الضروري أن يكون هناك توازن بين الأصالة والفاعلية، حيث يتم استمداد الأصالة من القواعد والقيم الثابتة، وفي الوقت نفسه يتم تطوير الفاعلية والتكيف مع التغيرات والتحديات المعاصرة. وأنه لا يكفي أن نعلن عن قدسية القيم الإسلامية، بل علينا أن نفعلها في الواقع بما يجعلها قادرة على مواجهة روح العصر. وليس المقصود أن نقدم تنازلات إلى الدنيوي على حساب المقدس، ولكن أن نحرر هذا الأخير من الأصالة المجردة إلى الأصالة ذات الفعالية والحركة.
وهنا يميز بن نبي أيضًا بين الفكرة الميتة والفكرة المميتة. فالفكرة الميتة هي الفكرة التي خذلت الأصول، وانحرفت عن مَثلها الأعلى؛ ولذا ليس لها جذور في الحضارة الثقافية الأصيلة. أما الفكرة المميتة: هي الفكرة التي فقدت هويتها وقيمتها الثقافيتين بعدما فقدت جذورها التي بقيت في مكانها في عالمها الثقافي الأصلي، أي الأفكار التي تم استعارتها من نموذج ثقافي آخر.
وبناءً على ذلك يرى بن نبي أن رسالة المسلم الأساسية في هذا العالم المتغير، رسالة واضحة المعالم والمبادئ، لا يجب أن يحيد عنها: منطلقها الكتاب والسنة، وبناؤها الإيمان والأخلاق، كما كانت أثناء بناء الدولة الأولى – دولة الرسول صلى الله عليه وسلم – فبهذا يستطيع المسلم منذ البداية أن يحتفظ باستقلاله الأخلاقي، حتى لو عاش في مجتمع لا يتفق مع مثله الأعلى، ويستطيع أن يواجه أيضًا مهما كانت الظروف الخارجية الأخلاقية والمادية المحيطة به، لأنه بتمسكه بأصوله ومبادئه العليا يستطيع أن ينشئ وسطه الخاص شيئًا فشيئًا، حين يؤثر على الظروف الخارجية بحياة نموذجية ينتقل أثرها إلى ما عداها، كما كانت حياة حفنة الرجال الذين عاشوا حول النبي – صلى الله عليه وسلم – بمكة أيام الإسلام الأولى.
خاتمة
إن مشروع مالك بن نبي الفكري هو مشروع نهضوي حضاري إصلاحي، يسعى الى تشخيص أسباب تأخر المسلمين، وقدم أدوات فكرية لإعادة بناء الذات والمجتمع والحضارة، مركزًا على الإنسان كفاعل أول في التاريخ، والثقافة كحاضنة للفكر، والفكرة الدينية كروح للنهضة.
فلم يكن بن نبي مفكرًا ومنظرًا يتحدث من برج عالي بعيد عن واقع الأمة ومشكلاتها، بل كان مهمومًا بها، معايشًا لمشكلاتها. وقد كان للتجربة الاستعمارية للجزائر التي عايش تفاصيلها وعانى هو شخصيًا من حيثياتها أثرًا كبيرًا في تشكيل هذا الهم. لكنه رحمه الله لم يقف عند الحدود الجغرافية للجزائر ولم ينحصر داخل مشكلته الشخصية أو مشكلة شعبه مع الاستعمار، وإنما انطلق منها لميدان الأمة الإسلامية الأرحب بنظرة شمولية تتناسب مع عمق المشكلات التي تعانيها الأمة. كما أنه لم يغرق في تفاصيل هذه المشكلات وجزئياتها، بل تجاوزها ليضع لها منظورًا وإطارًا كبيرًا تندرج تحته. ويلاحظ أن بن نبي لم يكن معاديًا للغرب بشكل أعمى، بل ميّز بين الحضارة الغربية كمنجز إنساني يمكن الاستفادة منه، وبين الاستعمار كأداة استغلال، فدعا الى الاستفادة من العلم والتقنية الغربية دون الوقوع في التبعية أو الذوبان.
فكانت “مشكلة الحضارة” هي هذا الإطار وهي تشخيص المرض العضال للأمة وهي علاجه، انطلاقًا من مفهوم رحب للحضارة غير منحصر في بعض المنجزات المادية، بل يمتد للجذور الثقافية والفكرية العاكسة لهذه الحضارة. فاعتنى كثيرًا بالثقافة والفكر وحاجة الأمة للعودة لأفكارها الأصيلة وتفعيلها في الواقع. وكذلك حذر من خطورة الأفكار الميتة والمميتة على مسار نهضتها متمسكًا بالسنة الإلهية “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” مسترشدًا في منهجه الإصلاحي بنور الوحي الرباني وطبيعته الرسالية العالمية.
وأختم هذه الدراسة بمقولة الأستاذ محمد المبارك في تقديمه لـ “وجهة العالم الإسلامي”: “إن مالكًا يبدو في كتابه هذا وفي مجموع آثاره لا مفكرًا كبيرًا وصاحب نظرية فلسفية في الحضارة فحسب، بل داعيًا مؤمنًا، يجمع بين نظرة الفيلسوف والمفكر ومنطقه، وحماسة الداعية المؤمن وقوة شعوره. وإن آثاره في الحقيقة تحوي تلك الدَفعة المحركة التي سيكون لها في بلاد العرب أولًا وفي بلاد الإسلام ثانيًا أثرها المنتج وقوتها الدافعة. وقلما استطاع كاتب مفكر أن يجمع كما جمع، بين سعة الإطار والرفعة التي هي موضوع البحث، وعمق النظر والبحث، وقوة الإحساس والشعور. أنا لا أقول إنه (مالك بن نبي)، ولكن أقول إنه ينهل من نفحات النبوة، وينابيع الحقيقة الخالدة”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحثة في العلوم السياسية.
[1] من أهم مؤلفاته: الظاهرة القرآنية – شروط النهضة – مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي – الصراع الفكري في البلاد المستعمرة – فكرة كومنولث إسلامي – ميلاد مجتمع –– وجهة العالم الإسلامي.
قائمة المصادر
- مالك بن نبي سيرة ذاتية غير موضوعية، الجزيرة، 25 أكتوبر 2018، متاح على الرابط التالي: – أسامة خضراوي،
- بدران بن لحسن، مالك بن نبي، أكاديمية رؤية للفكر، متاح على الرابط التالي:
– مالك بن نبي، شروط النهضة، (دار الفكر: دمشق)، 1989.
– مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، (دار الفكر: دمشق)، 2000.
– مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، (دار الفكر: دمشق)، 2002.
– مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، (دار الفكر: دمشق)، 2002.
– أحمد حسين، مراجعة كتاب “شروط النهضة” للمفكر مالك بن نبي، تبيان، 7 أكتوبر 2020، متاح على الرابط التالي:
– محمد عبد النور، مشكلة الأفكار ماذا تعرف عن أخر انتاجات مالك بن نبي، الجزيرة، 2 ديسمبر 2018، متاح على الرابط التالي:
– ملخص كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، غراس للإنتاج الفكري، 25 يناير 2024، متاح على الرابط التالي:
– رقية بوسنان، تكامل الرؤية المعرفية في تصور عناصر بناء الحضارة عند مالك بن نبي، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، مارس 2023.
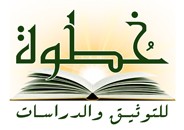 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies