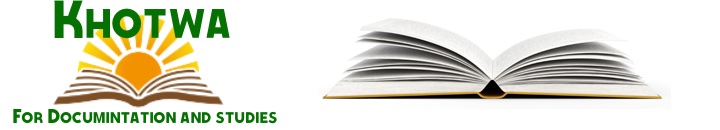منى أبو الفضل. 2
منى أبو الفضل والنموذج الإرشادي الإسلامي*
أ. د. يمنى طريف الخولي**
يأتي الإنجاز المنهجي الصافي، حيث الهمُّ المعرفي الخالص والإضافة النابضة للعلوم السياسية والاجتماعية عمومًا، مع د. منى أبو الفضل (1945 – 2008 م)، أم الفضل السابغ على العلم السياسي وعلى المنهجية الإسلامية. كانت عالمةً جليلة، وأيضًا فيلسوفة ميثودولوجية متمكنة. قدَّمَت رؤيةً منهجيةً متميزة بمنطلقاتها الإسلامية تمتد من النظرية السياسية إلى النظم السياسية والعلاقات الدولية وأنظمة الحكم، والتنشئة السياسية والتطور السياسي، ومناهج النقد والتحليل السياسي، والتاريخ السياسي والدبلوماسي …
ويطوِّق مداها المنهجي العلوم الاجتماعية إجمالًا. وبمنتهى الأناقة المعرفية والرشاقة المنطقية تنتقل معالجاتها من منهجية العلوم الاجتماعية عمومًا إلى منهجية العلوم السياسية خصوصًا.
وكانت منى أبو الفضل أستاذةً في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة تعلَّمَت من حامد ربيع واندرجَت في مدرسة المنظور الحضاري. وفي جامعة الدراسات الاجتماعية والإسلامية في الولايات المتحدة- التي أصبحَت فيما بعدُ جامعة قرطبة- عملَت مع إسماعيل راجي الفاروقي الرائد الذي أمعن في إيمانه بقضية المنهجية الإسلامية، وقبلًا أسلمة العلوم الاجتماعية. اقترنَت بالشيخ الأصولي المنهجي طه جابر العلواني الذي رأس جامعة قرطبة[1]. لقد قامت بالجهد الأكبر والأثمن في تنضيد المنهجية العلمية الإسلامية لمدرسة المنظور الحضاري «فانتقلت بفورة الجدل حول موضع التراث من خطابات الأصالة والمعاصرة إلى حالةٍ منهجية علمية منظَّمة ذات ارتباطاتٍ مباشرة بواقع الأمة ومستقبلها من ناحية، وبحالة مراجعة العلم من منظوراتٍ حضارية (أو نماذج إرشادية) من ناحيةٍ أخرى»[2] وكان مشروعها بحقٍّ مسيرةً رائدة، نطاق اجتهاد وميدان جهاد ومعالم تجديد[3].
فما هي معالم هذا المشروع اللافت؟
أعرضَت د. منى عن أسلمة العلم والتفتَت إلى ما هو عند الله وعند الناس خيرٌ وأبقى؛ أي أسلمة المنهجية. وانكبَّت على تطوير «المنظور الحضاري الإسلامي» تضع النقاط على الحروف باعتماد الرؤية التوحيدية إطارًا تنظيميٍّا يجعل التزكية والعمران مقصدًا مولدًا للمُثل العليا، والأخذ بالوحي كمصدرٍ معرفي يتفاعل ويتكامل مع الطبيعة ومع العالم الإنساني، بمعية تراث النبوة الذي كان تأويلًا وتطبيقًا للنص القرآني، والتراث الإسلامي الممتد على طول الحضارة الإسلامية كحصيلة تفاعُل العقل المسلم سلبًا أو إيجابًا مع هذَين المصدرَين. تؤكِّد أن النص القرآني لم يكن تجميعًا لنصوصٍ محفوظة؛ إنما هو جمع آياتٍ التحمَت عَبْر لحظاتٍ متدافعةٍ في مواقعَ متجدِّدة وبأغراضٍ توجيهيةٍ معلومة، سواء كان هذا التوجيه بالإعمال أو بالإبطال. ولا بد من مثول مسافةٍ فاصلة وحاسمة بين القرآن والسنة وسائر النصوص التراثية الأخرى، التي تخلَّقت عن تفاعُل العقل البشري والواقع الإنساني معهما، فضلًا عن الخبرة التاريخية المتراكمة ومعطيات الواقع الإسلامي الماثلة. وبهذه الخطوط تؤكِّد د. منى أن المنهجية العلمية الإسلامية المتوائمة مع مصادرنا التراثية خير ضمان لتأمين مسار الخطاب العربي العلمي المعاصر، وأن هذا يعني طرحًا لمنهاجية العلوم الاجتماعية يشمل أسسها وخصائصها ووظائفها الوصفية والتفسيرية، بل وحتى التطبيقية، من حيث يؤكِّد التكامل عبر التفاعل بين محاور ثلاثة:
- مصادر المعرفة وأنماطها.
- إطار النظام الاجتماعي.
- العلاقة بين الفكر والممارسة.
ويتمثل التفاعل والتكامل في تبادل التأثير والتساند بين ثلاثة خطوط هي: التصالح، وإعادة الاعتبار، وتحقيق التكامل فعليٍّا. فثمَّة التصالح بين العقل والوحي، حين يُعاد الاعتبار إليه كمصدرٍ أصيل لتوجيه المعرفة، في هذا يحلُّ التكامل بين الأطراف محل المواجهة بين الثنائيات الاستقطابية التي تُشرذِم البحث الاجتماعي.
وأخيرًا، على صعيد محور العلاقة بين الفِكر والممارسة يتم إلقاءُ الضوء على نتائج صياغة النظرية الاجتماعية، بحيث تتكامل الأبعاد المحسوسة وغير الملموسة، النفسية والعقلية، المادية والمعنوية، العاطفية والإدراكية في النظر الاجتماعي العمراني بهدف الوصول إلى نظرية لها صدًى في واقع الحال، وتأتي بمردودها في تقويم الممارسة[4].
وفقًا لهذه المنهجية ينطلق الباحث في العلوم الاجتماعية من مسلَّماتِ حقله التخصصي ومن مسلَّمات حضارته وتراثه معًا. توضِّح د. منى أن الباحث لن يرقى إلى مستوى التنظير الإسلامي إلا إذا توافَر له إلمامٌ بالثقافة الإسلامية ورؤيةٍ إسلاميةٍ سوية تمثِّل قاعدةً معرفية، بالإضافة إلى منطلقات حقله التخصُّصي. بتحقيق هذَين الجانبَين معًا تتكامل الرؤية العلمية وتمثِّل إضافةً حقيقية، فيكون الباحث «مجتهد التخصُّص» حيث البُعد التراثي تحرّر من سلطان التخصُّص الدقيق الأعمى والمقيد للحركة، ليتوافر قَدْر من المرونة الذهنية والحَراك العقلي، من أجل توسيع رقعة التعقُّل والتدبُّر، ولا يعود التقويم النهائي منوطًا أولًا وأخيرًا بمسلَّماتٍ جاهزةٍ صلبة.
وهذا يعني أن البحث العلمي في الظواهر الإنسانية، خصوصًا، ينبذ الحياد الأعمى والموضوعية الموهومة والتي أثبت تطوُّر الفكر العلمي أنها مستحيلة، ويصادر على قَدْر من «التحيز الحضاري» أسهب في معالجته عبد الوهاب المسيري وآخرون. وتؤكِّد منى أبو الفضل أن التحيز الحضاري مناط و«شرط للاستشراف العلمي، وهو الذي يمهِّد لدقة الرصد، ويشحَذ قريحة التفاعل والتتبع في وسط المجهول الذي هو ليس بالغريب، وهو الذي يحفزُ الخيال المبدع الذي يتجاوز التلقِّي إلى سَبر الغَور، والقراءة لما بين السطور ووضع النقاط على الحروف عند تحرير المعاني واستخلاص الدلالات»[5].
وعلى هذا النحو يتوفر للباحث المسلم النازع لتفهُّم ووصف وتفسير ظواهر الحضارة الإسلامية مداخلُ للفهم والتحليل والنقد، لا يلتفت إليها باحثٌ لم ينتمِ إلى الأمة ولم يلتزم بقضاياها؛ فلم يلتفِت بالتالي إلى آثار خصائصها الذاتية؛ وعلى رأسها صلةٌ لا تنفصم بالوحي الإلهي. وتؤكد د. منى تأكيدًا أن الباحث الذي يستحضر تلك الخصائص الذاتية للأمة هو الأقدَر على التفسير السليم والأقرب إلى الصواب لتاريخها ولواقعها.
وعلى هذه الأسس تقوم منهاجية البحث في العلوم السياسية ومنظورها الحضاري الإسلامي. تؤكِّد منى أبو الفضل من جانبها أن المقصد المنهجي هو علم السياسة فقط وليس العمل السياسي، وتراه في جوهره علم السلطة، السلطة هي القوة في المجتمع، والمرجع النهائي في أمور الجماعة، فتحتل السياسة موقعًا رئيسًا في العلوم الاجتماعية.
وفي تحليلاتٍ مقنعة، لا يشوبها إيجازٌ مُخِلٌّ ولا إسهابٌ مُمِلٌّ، أوضحَت د. منى أن نشأة علوم السياسة الحديثة مع المنعطف الذي شكَّله ميكيافيلِّي في القرنِ السابعَ عشرَ لم يكن محوره الفصل بين السياسة والأخلاق كما هو شائع، بل محوره التحام مع الواقع وغلبة المنهج التجريبي الذي أصبَح شعار العصر، هو اختلاف العلاقة بين دائرة الفكر والخطاب السياسي ودائرة الواقع والوقائع والأحداث السياسية. في العصور القديمة والوسيطة، حيث سيادة المقاربة الفلسفية التأملية، كانت الأولية والأسبقية للدائرة الأولى — دائرة الفكر أو الخطاب — التي تتعامل مع الثانية، وهي دائرة الواقع والوقائع كدائرةٍ كُلانيةٍ مُصمَتة، هي موضوع للمعياريات. مع نشأة الفكر السياسي الحديث في العصور الحديثة تشكَّلَت «معالم منهجية جديدة تتبنى استقراء الواقع، وبقَدْر تفاعُلها معه تأتي النصوص المعالجة بالتشخيص والمراجعة»[6]، وانفتح الباب لمعالجة الظاهرة السياسية من منطلقات المشاهدة والوصف القابل للتفسير والتعليل والتحليل والتفكيك، ثم التشخيص والتقرير. وعلى هذا النحو الذي يجعل التجريبية روح العصر وليس مجرد منهجٍ للعلم تشكَّلَت قيم الحداثة الأوروبية، فكانت التجريبية هي روح العصر ومناط أيديولوجيته. وتأتي محورية الثورة الفرنسية، كما تشير د. منى في قراءة قيم الحداثة من حيث إنها مثَّلَت الالتحام والمجابهة بين الأطراف الاجتماعية المعنية في لحظةِ تحوُّلٍ تاريخية اقترنَت بوعيٍ خطابيٍّ جديد في نسيج التراث الفكري الغربي، وهو الوعي الذي دُشِّن في سجلات أصحابه باسم «الخطاب الأيديولوجي» حيث تداخلَت فيه؛ العلاقة بين عالم الفكر وعالم الحركة، عالم القيَم والمُثل وعالم الواقع والحدث، متخذة شكلًا جديدًا تولَّدَت منه منظومةٌ معيارية للحكم على الأفكار كصناعة ومزاولة، قوامها الجدوى والمنفعة ومحكُّها موقع الفكرة من الحدث والواقع، ومدى ارتباط الفكرة بالموقف والمصلحة. وفي هذا السياق الصاخب – بتعبير د. منى- تولَّدَت علوم الإنسان والاجتماع الحديثة كمُحصِّلة، وكشاهد على المفارقة النوعية بين الخطاب التأملي والخطاب الحركي العلمي الحديث، وهي المفارقة التي تولَّدَت حولها روافدُ خطاب التنوير الأوروبي، حيث اقتصرَت عناصر التقويم على المقاييس الواقعية المادية البحتة، وصار هذا الخطاب يبدو وكأنه خيارٌ عالمي يفرض ذاته على كل راغب في التحديث والتقديم. ويعنينا من أمره الآن أنه هو ذاتُه خطابٌ يشهد على أن نقطة الافتراق الحداثية في الفكر السياسي لا تكمن في الانفصال عن الأخلاق بل في الارتباط بالواقع[7]، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يأتي الاستيعاب والتجاوز لتجربة الحداثة التي تخلَّقَت في أوروبا. التجاوز يرتكز أساسًا في متابعة المستجدات العالمية وثوابتنا الحضارية؛ حيث يعني هذا وذاك أن تناول الظواهر الاجتماعية تناولًا علميٍّا والنزول إلى واقعها تجريبيٍّا فيما يسمى بالواقعية العلمية لا يشترط قبلًا تحييد القيم، بل لا بد من تفعيلها وتوظيفها، كتفعيل وتوظيف مفهوم التحيُّز.
وعلى أساس هذه المقدمات قبل- المنهجية، تترسم معالم المنهجية العلمية الإسلامية متألقة في صياغة منى أبو الفضل لها، مرتكزة إلى أربع ركائز أو محددات، هي في جوهرها تنضيد وتوطيد لمعالم مدرسة المنظور الحضاري أو للنموذج الإرشادي في العلوم السياسية: ثمَّة، أولًا، المنظور الحضاري ذاته، وثانيًا، الإطار المرجعي، وثالثًا، النسق القياسي، ورابعًا، بناء المفاهيم. وفي تساندها وتكاملها ثمَّة عقدةٌ منهجيةٌ ماثلة لا بد من اقتحامها تحقيقًا للوثبة الحضارية. العقدة المنهجية هي القدرة على التمييز بين عمليتَين أو مستويَين في مصادر التنظير لبناء أدوات التخصص ومجاله، وهما بناء المفاهيم، ثم بناء الإطار المرجعي الذي تنتظم فيه هذه المفاهيم، «الاختلاف ليس اختلاف درجة، ولكنه اختلاف نوع»[8]
المنظور الحضاري يفرض إطارًا مرجعيٍّا، مستمَدًا من التصور الإسلامي كإطار للفعل المعرفي وللفعل الحضاري إجمالًا «فلكل فعلٍ حضاري منظومةٌ قيمية تشكِّل البواعث والمنطلقات والدوافع والأبعاد المعنوية لهذا الفعل وأهدافه، وهي عادةً ما يُطلَق عليها «الثقافة» كما أن لكل فعلٍ حضاري قاعدتَه البشرية التي تحمل هذه المنظومة القيمية وتتفاعل من خلالها البيئة عبر الزمان والمكان»[9]. يحمل الإطار المرجعي المنظومة القيمية وتفاعلاتها، ويمكن أن يُضاف ركن المقاصد والغايات كدعامةٍ مستقلة في المنظومة النسَقية، وتخصيص ركن الاستخلاف.
ومن الناحية المعرفية ومناهج البحث العلمي في مجال السياسة، فإن الإطار المرجعي يؤسس لإعادة بناء المدركات والمفاهيم والقيم بشكلٍ واعٍ منطقي وممنهج، يردمُ الفجوةَ بين العناصر الإسلامية الكامنة في الوعي وفي اللاوعي، وبين واقع البحث العلمي المعاصر.
إن الإطار المرجعي هو وسيطُ التعامل مع مصادر التنظير، وناظم لجملة المفاهيم والقيم الفعَّالة في المجال المنهجي، يعمل على وضع الجزئي في إطار الكلي، فيحفظ وحدة فروع البحث المتخصِّص ويربطها بالرؤية الكلية، إدراكًا لأهمية التجانس والتوافق الداخلي.
وينضبط الفعل البحثي الممنهج داخل الإطار المنهجي بفعل المرتكز الثالث وهو «النسق القياسي» الذي يبدو ضروريٍّا لإحكام منهاجية التحليل السياقي، خصوصًا إذا تذكَّرنا أن النموذج الإرشادي قياسي أيضًا، وربما قبلًا. «النسق القياسي» بدوره يعني عناصرَ جوهرية ومحورية وأساسية لا مندوحة عنها، حتى تمثِّل محكٍّا قياسيٍّا، يُمكِن عن طريقه أو من خلاله تحديد مدى الاقتراب أو الابتعاد عن المنظور الحضاري الإسلامي. هذا بدلًا من محكَّات من قبيل شرعي أو غير شرعي. منى أبو الفضل ترفض التوظيف الأيديولوجي للدين في مجال البحث العلمي، ولكنها من قبلُ ومن بعدُ ترفض طبعًا إقصاء الحضارة الغربية التام للوحي وللألوهية من المجال المعرفي؛ فهذا في المنظور الحضاري الإسلامي مناقضٌ للواقع وللمثال على السواء. وعلى أساس «النسَق القياسي» تنضم في المنظور الحضاري كل الدراسات المتعلقة بالعالم الإسلامي بما فيها النظم السياسية العربية، لتأتلف معًا. هكذا تُعدُّ الأنساق القياسية «بمثابة خرائطَ أساسيةٍ لا غنى عنها للإحاطة بالملامح العامة لفضاء التعامُل المعرفي السوي مع التراث الإنساني برافدَيه الإسلامي وغير الإسلامي، بالامتثال لثقافة القرآن»[10].
ويبقى بناء المفاهيم التي تنتظم في الإطار المرجعي، وفقًا للنسق القياسي، تحقيقًا للمنظور الحضاري. إن المفاهيم هي اللبنات التي تؤسس للمنهجية. العمل المنهاجي لابد أن يقوم على أساس من تأصيل المفاهيم، التي هي أكثر التحامًا بالجزئي والعيني والوقائع الإمبيريقية وواقع الحقل العلمي. ميَّزَت د. منى بين المفاهيم الكلية الإطارية التي تمثل دعائم منهجية، والمفاهيم المحورية التي تمثِّل مجال التخصُّص، والمفاهيم الفرعية التي تمثِّل حقل البحث المعيَّن. المفاهيم الإطارية «كلياتٌ جامعة متراتبة حاوية لجملة من المفاهيم الفرعية، المتولدة منها»[11]، وثمَّة مفاهيمُ كليةٌ معيارية، على رأسها العدالة والجهاد (وهو بذل أقصى الجهد في كل مجال وليس في الحرب فقط) اللذان يجسِّدان الوعي الإسلامي في الواقع، ثم الاستخلاف والأمانة والشرعة والتدافع والتعارف والنصيحة، ومفاهيم كلية مقيدة تمثِّل عموميات التخصُّص مثل الأمر والنهي، والطاعة، والولاية، والقضاء. ثم مفاهيم فرعية لحقلٍ بحثي معيَّن من قبيل الشورى والإصلاح.
وبخلاف الأهمية المنهجية للمفاهيم، تجدر الإشارة إلى بحث لمحمد صُفَّار، تناول المفاهيم في مشروع منى أبو الفضل من زاويةٍ أبعدَ من الطرح المنهاجي للعلوم السياسية، وأشمل من منظور العلوم الاجتماعية إجمالًا، ألا وهو النظر إلى مشروعها من حيث هو منبثقٌ عن رؤية لإشكالية العلاقة بين الشرق والغرب التي هي من أمهات إشكالياتنا الثقافية الحداثية. وردَت معالم هذه الرؤية في عملٍ لمنى أبو الفضل يبحث عن نقاط التقارب بين الشرق والغرب[12]. يجعل صُفَّار موقف منى بديلًا ثالثًا لموقفَين يمثِّلهما طه حسين الذي آمن بأن الشرق والغرب كليهما انبثاقان لعقليةٍ متوسطية واحدة تدين للأصول الإغريقية، وموقف محمد حسين هيكل الذي رأى أن احتكاك الشرق بالغرب سوف يولِّد شرارةً تجعل الشرق يبني حضارةً جديدة. أما موقف منى فهو حدْس اللحظة أو أنطولوجيا الحاضر حيث استلهام احتياجات الحاضر الملحَّة للأبعاد الروحانية. وتشير مقاربة صُفَّار إلى أن منى كتبَت أعمالًا هامة باللغة الإنكليزية، ودخل في تحليلٍ متعدد الطبقات لقدرتها على مواجهة تحدٍّ رئيس وهو استخدام اللغة السائدة من دون الوقوع بأشراك قواعدها التي ترسِّخ هيمنة الغرب. هنا تصبح اللغة أداةً لتحقيق غرضٍ استراتيجي للدعوة الجديدة أو البديل الثالث الذي يمثِّله موقف منى، ألا وهو إحداث تغييراتٍ مؤثِّرة في بنية العلاقة بين الشرق والغرب، بما يحطِّم هيمنة الغرب ويكسر احتكاره عملية التخصيص السلطوي للقيم[13] ويسهُل تبيان كيف أن نحت وبناء وصياغة المفاهيم الموائمة يسهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مثلما يسهم في تحقيق الأهداف المنهجية.
يصدِّق على هذا، ويؤكِّد قدرة المفاهيم على القيام بالوظيفتَين الثقافية والمنهجية، ذلك المفهوم الرئيس والمحوري الذي أسرفَت منى في خدمته وصياغاته، ألا وهو مفهوم«الأمة».
وإذا كانت المفاهيم هي لبنات المنهجية، فإن مفهوم «الأمة» بالذات أكثر من لبنة؛ فهو مدماك، ولعله في الأساس؛ لذا يحمل أكثر من سواه إيجابيات معالجة منى أبو الفضل من حيث النسَقية القياسية، مثلما يحمل سلبياتها التي تجعل من الضروري البحث عن موضع الدولة القومية، التي نراها نحن دائمًا في سويداء القلب من حيث إنها الوطن.
الأمة، كما تقول منى، هي أم الكيانات الجماعية التي عرفَتها هذه المنطقة الحضارية، والأمة قبل الإمام وقبل الإمامة؛ فلو لم تكن الأمة لما وجب مَنْ يؤمها، أو لما بحثوا عن إمام لها. وهي تقدِّم تعريفًا للأمة الإسلامية خصوصًا بأن الرابطة الدينية العقائدية هي الأصل في منشأ ومفهوم الأمة. ولعل مدرسة المنظور الحضاري قد لا ترحِّب بالدولة القومية كوحدةٍ أولية، كما هو شائع بين التوجُّه الإسلامي بشكلٍ عام، على الرغم من أن حامد ربيع كان قوميٍّا عروبيٍّا أصيلًا، والأهم، على الرغم مما يمثِّله مفهوم القومية «العربية» بالذات من قوةٍ ضامة ورابطةٍ لمجموعة الدول العربية التي هي أحوجُ ما تكون للترابط والتكامل فتغدو قلبًا وهَّاجًا للأمة الإسلامية التي هي بدورها أفقٌ حضاريٌّ ماثل للقومية العربية. منى أبو الفضل من جانبها تُهاجِم القومية بضراوةٍ متطرفةٍ في بعض الأحيان، وغير مقبولة أبدًا، حتى تزعُم أنها إبادة للتعددية! وأنها في تدريسها لمادة «النظم السياسية العربية» وجدت «القومية» محاطة بالتباسات واستحالات لا مخرج منها إلا بالتعويل على مفهوم «الأمة الإسلامية» بدلًا من القومية العربية. أليس في هذا إقصاء، بينما نبحث منذ البداية عن تكامل بدلًا من الإقصاء والاستبعاد؟!
على أية حال، فإنه جريًا على التمييز بين العام والخاص أو المشترك والمتفرد، توضِّح أبو الفضل كيف تجمع الأمة الإسلامية بين عناصر تشترك فيها مع غيرها من الأمم والجماعات السياسية، وبين عناصر تُميِّزها أو تنفرد بها «بحكم تمايز النشأة، أو قاعدة التأسيس والتكوين، أو بحكم ثوابتَ كامنةٍ أو وظيفةٍ حضاريةٍ مستبطنة»[14] لتكون دراستها في ضوء النسبي والمطلق، أو الثابت والمتحوِّل. الأمة الإسلامية لا تقوم على عرقية أو إثنية أو إقليميةٍ جغرافية، بل على دعوى ورسالةٍ توحيدية تجمع التعدُّدية وتنفتح على الاختلافات النوعية لتكون غير إقصائية (فلماذا إقصاء القومية العربية؟) وكحقيقةٍ تاريخية أو كواقعٍ تاريخي. وجدَت منى أن الأمة نظامٌ إسلامي اجتماعي وسياسي متكامل تمثَّل في شريعةٍ سماوية طُبقَت على حيز جغرافي ممتد شكَّل دار الإسلام وسكنَتْه شعوبٌ وقبائلُ متباينة الأصول يحوطها سياج العقيدة. تعترف بأن مفهوم الأمة الإسلامية قد تماهى في الواقع السياسي المعاصر وكاد يسقط في الوعي الباطن ويقتصر على وضع رباطٍ عاطفي لا يقدِّم ولا يؤخِّر، لكنها توضِّح أن طرحه وبعثه ليس حنينًا لماضٍ تاريخي، بل هو دعوة إلى الواقعية والالتزام في المنهاجية، من حيث إنه ينطلق من الكيفية التي ينبغي أن نُعالِج بها الموضوعات الإسلامية، وعلم السياسة لا يسعه أن ينعزل عن واقع مجتمعه أو يهرب من تحدياته. وفي المجتمع الإسلامي مفهوم الأمة له أبعادٌ وجودية كيانية تجعل من الضروري أن نُعيد النظر فيه تمحيصًا لحقيقة هويتنا كهويةٍ حضارية وثقافية متميِّزة بين الهويات أو الكيانات الأخرى، ذات أبعادٍ حضارية ممتدة تكفل لها المعاصرة الآنية مع الاستمرارية التاريخية[15].
هكذا يمكن القول إن المنظور الحضاري الإسلامي بات تمثيلًا للأمة الإسلامية على أن منى أبو الفضل تبحث أمرها أساسًا بوصفها «الأمة القطب» وهذا مصطلحٌ أثير لديها وضعَت له مقابلًا The Charismatic Community [16] ربما كان مصطلح «القطب» الذي تُصرُّ على إضافته مصطلحًا صوفيٍّا يعني مركزًا للاستقطاب والتأثير.
وهذا معنًى مُستحضَر وماثِل، ولكنه هنا علمي، أمكن تحويله من مفهومٍ عقائدي تراثي إلى مفهومٍ منهجي إجرائي في البحث السياسي، حيث بات يُعني أن الأمة الإسلامية ليست مجرد أمة بين الأمم، بل «أمة قطب» ذات قدرةٍ استقطابية، تؤدي إلى وحدةٍ جدلية من تماسكٍ داخلي ثم انفتاح للغير على المستوى الخارجي، تجمع بين الفاعلية والشرعية، فلا تفقد إحداهما أو كلتَيهما.
الأمة القطب، في رؤية منى أبو الفضل، هي الكيان الجماعي المميز الذي أحرزَته العقيدة التوحيدية، هي وعاء الاستخلاف وأداته. قلبُها عقيدة التوحيد وسياجُها شريعةٌ جامعة تقوم على الحق والعدل، وتلتقي عناصر المفهوم حول خصائصَ مشتركة الصفة أو الخاصة المركزية هي ما أقرَّه القرآن الكريم من أنها «أمة وسط». المجال الإسلامي الممتد من جمهوريات آسيا الوسطى إلى المغرب يمثل جغرافيٍّا المنطقة الوسطى في العالم، أو هو بتعبير د. منى القارة الوسيطة. على أن الوسطية ليست حيثيةً مكانية، أو وضعًا بين طرفَين كما هي منذ أرسطو، بل هي مشروعٌ حضاري لأمةٍ ذات رسالة، أمة تَعلم وتُعلِّم أن التعدُّد على أشكاله سنة وآية، وأن العبرةَ في أي نظام هي بانفتاحه على الاختلافات النوعية. فلا تحمل الأمة الإسلامية – الأمة القطب- أي طابعٍ إقصائي، لقد اتسعَت وتتسع للمِلل والأعراق والأجناس جميعًا، ثم هي مصدر للتوازن والاعتدال بين القيم الفردية والقيم الجماعية. وكانت الأمة القطب في عناصرها وخصائصها – بتعبير د. منى البليغ- ضاربة الجذور باسطة الفروع على مدى الأبعاد الذاتية والموضوعية، المعنوية والمادية، مرتكزة في تماسُكها على عقيدةٍ إيمانية شاملة، مصدرها رباني، ومجالها أوجه الحياة الدنيا كافة، فتصل بين الدنيا والآخرة، وتتمثَّل في وحدة القيم والمشاعر والمدارك والآمال التي تولَّدَت عن العقيدة، وفي خبرة تجد لها ضابطًا في تأطير السلوكيات الناجمة عنها حتى تنتظم العلاقة بين الماديات والمعنويات، والظاهر والباطن، والأفعال والاتجاهات. وتبرز العقائد والعبادات على المحور الرأسي لتصير ركائزَ لعملية الاستقطاب داخل الجماعة، وتُمارِس العقيدة وظيفتها في تنشيط خصائص «الأمة القطب» وكمصدرٍ لتماسُك الكيان الذاتي للفرد، وتحضُّ على التآلف والاعتصام بحبل الله، إنه التوحيد الخليق بأن ينتهي إلى الوحدة[17].
هكذا تتكامل المعالم المنهجية حتى تكاد تمثِّل خطةً استراتيجية تُرشِد العمل البحثي، فتنتهي أبو الفضل إلى خطواتٍ مقترحةٍ للبحث العلمي، تبدأ بتحديد جملة من مصطلحات التخصُّص، والكشف عن مواضعها في المصدر المنشئ؛ أي القرآن الكريم، ثم عملية فرز وتصنيف لهذه المفردات المفهومية وفقًا لمعايير يمكن استقراؤها من الموضوعي ومن واقع الممارسات ذاتها، وليس افتراضها مسبقًا. هدف هذه الخطوة الإقدام على تخريج الأنماط واستنباط النماذج والأنساق التي يمكن أن تتألف لتشكِّل قاعدة الانطلاق في مجال التنظير. وتأتي المرحلة التالية في التعامل مع الفروض المطروحة والمفاهيم والنماذج المقدَّمة، وهي مرحلة الاختبار أو التنزيل على الواقع التاريخي[18] للأمة القطب.
«الأمة القطب» مفهوم لا يُوجَد ما يعادله في الغرب، لا في الخبرة التاريخية ولا في العلم السياسي. أما في الحضارة الإسلامية فهو مفهومٌ يجمع بين التجربة والتصوُّر، بين المثالية والواقعية. فيجسِّد حِرص منى أبو الفضل على تفعيل فكرة الأنساق المتقابلة في علم السياسة، ليكون النسَق المعرفي الإسلامي نسقًا بديلًا، لا هو وضعي أو مادي أو ماركسي أو فينومينولوجي… بل إسلامي مقابلًا للنسَق المعرفي الغربي.
يرى البعض أن أبرز إسهامات منى أبو الفضل هي فكرة الأنساق المعرفية المتقابلة، المقترنة بالمنظورات والنماذج الإرشادية المتعدِّدة، والتي تنطلق من إمكانية ودواعي البديل للنموذج الغربي المهيمن. ولكن اتضح لنا أن الأنساق المتقابلة ترفَع لواءها الآن في الفكر الغربي ذاته تعدُّدية منهجيَّة وتعدُّدية ثقافية اقترنَت بنقض مركزية المركز الغربي. وكان هذا نتاجًا للفكر بعد الحداثي بعد الاستعماري، هو تيارٌ نقدي للإمبريالية والمركزية والوضعية.
ربما استبَقت د. منى هذه التيارات القوية الجزلة العطاء، وربما تفاعلَت مع إرهاصاتها وبوادرها، وربما استوعبَت معالمها. قضت منى في أوروبا وأمريكا أكثر مما قضته في مصر، ولم تكن أبدًا من دعاة الانغلاق، بل حملَت لواء المثاقفة، وبحثَت في سبل التداخل والتحاور بين الحضارات، بمنأى عن الاستعلاء وطمس الخصوصيات الحضارية والمركزية التي تسعى إلى إذابة الثقافة التابعة في إطار الثقافة المتبوعة. بدلًا من الإذابة والإلغاء والاحتواء، ثمَّة التثاقُف والتفاعُل والتداخُل، المعبِّر عن الحوار الخلَّاق بين الحضارات. وعُنيَت د. منى بالتمهيد للتثاقف من خلال تفعيل مداخل التقويم والترشيد. وقدَّمَت نموذجًا حيٍّا لهذا في تفاعلها مع النسوية والفكر النسوي.
النسوية من أبرز تيارات الفكر ما بعد الحداثي الناقد وأعلاها صوتًا. وقد طُرحَت فلسفةٌ نسوية ظهرَت منذ سبعينيات القرن العشرين، وأصبحَت من أبرز تيارات الفلسفة في القرن الحادي والعشرين، وكانت فلسفتُها للعلوم والميثودولوجيا العلمية إضافةً متميزةً حقا[19].
قامت الفلسفة النسوية من أجل رفض مطابقة الخبرة الإنسانية بالخبرة الذكورية، ورفض اعتبار الرجل الصانع الوحيد للعقل والعلم والفلسفة والتاريخ والحضارة جميعًا، وتجدُّ لإبراز الجانب الآخر للوجود البشري الذي طال قمعُه وكبتُه؛ فتعمل على خلخلة تصنيفات البشر إلى ذكورية وأنثوية بما تنطوي عليه من بنيةٍ تراتبية سادت لتعني الأعلى والأدنى، المركز والأطراف، السيد والخاضع، امتدَّت في الحضارة الغربية من الأسرة إلى الدولة إلى الإنسانية جمعاء، فكانت أعلى صورها في الاستعمارية والإمبريالية. وكما تقول لورين كود الظلم الذي نراه في معالجة أرسطو للنساء والعبيد هو عينُه الظلم في معالجة شعوب العالم النامي، إنه تصنيف البشر والكَيل بمكيالَين.
وكما أوضحتُ في أكثر من بحث وكتاب لي، تعمل الفلسفة النسوية على فضح ومقاومة كل هياكل الهيمنة وأشكال الظلم والقهر والقمع، وتفكيك النماذج والممارسات الاستبدادية، وإعادة الاعتبار للآخر المهمَّش والمقهور، والعمل على صياغة الهوية وجوهرية الاختلاف، والبحث عن عملية من التطور والارتقاء المتناغم الذي يقلب ما هو مألوفٌ ويؤدي إلى الأكثر توازنًا وعدلًا. إن الفلسفة النسوية أعمقُ من مجرد المطالبة بالمساواة مع الرجال. فلا بد من إعادة اكتشاف النساء لأنفسهن كنساء، لذاتهِن المقموعة، وإثبات جدوى إظهارها وإيجابياتها وفعالياتها، وصياغة نظرية عن الهوية النسوية.
وقدَّمَت الفلسفة النسوية في هذا ما تفاعلَت معه منى أبو الفضل، وما يتلاقى أصلًا مع المنظور الحضاري (البراديم الإسلامي) تلاقيًا لا يمكن إغفاله؛ ذلك أن فلسفة العلم النسوية كانت أكثر من سواها استجابةً للثورة التي أحدثَها توماس كُون، وعملَت على تفعيل وتشغيل مقولة البراديم من أجل إبراز الوجود النسَوي والقيم الأنثوية.
لقد انفردَت الذكورية بالميدان. وحمَل هذا الانفراد انحيازًا في الرؤية وسلبياتٍ أبرزها انطلاق العلم الحديث بروح الهيمنة الذكورية والسيطرة على الطبيعة وتسخيرها، مما تمخَّض عنه الكارثة البيئية، واستغلال قوى العلم المعرفية والتكنولوجية في قهر الثقافات والشعوب الأخرى. ترفُض فلسفة العلم النسوية التفسير الذكوري الوحيد المطروح للعلم، وهو أساسًا التفسير الوضعي المادي، وتحاول تقديم ميثودولوجيا نسوية تعمل على إبراز وتفعيل جوانب ومجالات وقيم مختلفة خاصة بالأنثى، كالعاطفة والخيال وعمق الارتباط بالآخر والرعاية الطويلة المدى، كلها جرى تهميشُها وإنكارها والحط من شأنها في عالم العلم، بحكم السيطرة الذكورية، ويجب أن يُفسح لها المجال لإحداث توازنٍ مأمول يجعل العلم أكثر إنسانيةً ومطابقةً للاحتياجات الحضارية الراهنة.
تنزع فلسفة العلم النسوية إلى أن تكون تحريرية، تمُد علاقة بين المعرفة والوجود والقيمة. وارتكزَت على ثلاثِ دعائم هي: المنظور (Perspective)، والموقف الاستشرافي النسوي (Feminist Standpoint)، والتجريبية النسوية (Feminist Empiricism) التي هي تجريبية بعد-كونية تؤكِّد دور الذات ودور المهمَّشين. وعن طريق هذه الأسس الثلاثة يعمل المنظور النسوي على استحضار القيم الأنثوية لإحداث تكاملٍ منشود بين الجانبَين الذكوري والأنثوي، مثلما يعمل «المنظور الحضاري» في مدرسة العلوم السياسية على التكامل بين الثوابت والمتغيِّرات، بين خصائصِ التجربة الحضارية الإسلامية ومنطلقات البحث المنهجي العلمي. وهذه أولًا وقبل كل شيء، قضية منهجٍ علمي وأسلوب للمقاربة، فلا يزعجنا أن النسوية في تمثيلها للفكر الغربي قد تجسِّد أحيانًا معالمَ غربيةً صارخة في مناقضتها للقيم الإسلامية؛ فالغرب على أية حال هو الآخر الثقافي. والأجدى أن نتوقف عند منزع النسوية النقدي بعد الحداثي وبعد الاستعماري، أو حتى منطلقها الأوَّلي وهو إثباتُ الذات، وتأكيدُ النسوية على مستوى الطرح المنهاجي، وما يمكن تقديمه من إضافة في هذا الصدد، الذي استوقف، بلا شك، منى أبو الفضل.
اهتمَّت د. منى كثيرًا بالنسوية، وتحديدًا بدراسات المرأة من المنظور الحضاري الإسلامي، خصوصًا في العقدَين الأخيرَين من حياتها، فكان من أهدافها تشييد نموذجٍ مقابل يمثِّل نسوية إسلامية وبحث الجنوسة الإسلامية (الجنوسة أو النوع أو الجندر (gender) هي المقولة الشاملة لمجمل اختلافات الرجل والمرأة وليس فقط الاختلافات البيولوجية أو العضوية). وبخلاف مقارباتٍ في جامعة قرطبة بالولايات المتحدة، أسَّسَت أبو الفضل في مارس ١٩٩٦ م جمعية «دراسات المرأة والحضارة» بالقاهرة التي تهدف إلى التوعية الفكرية من خلال البحوث والندوات والأنشطة التدريبية، في إطار فلسفةٍ عامة ترتكز على المنظور الحضاري الإسلامي. وقد أصدرَت مجلة المرأة والحضارة، تفتتحُها منى بعبارة تقول «الأم أمة، وما بينهما وثاقٌ يشد الأصل إلى الفرع، على منواله تنسج العِمارة التي هي أساس الحضارة»[20]. وفي محاولتها لتشييد نسويةٍ إسلامية وفحص الجنوسة من منظوراتها تدفَّقَت أفكارها ورؤاها كما هو معهود منها. وقدَّمَت فكرتَين ثاقبتَين حقٍّا، الأولى في توقفها عند تعدُّد مستويات الخطاب القرآني للمرأة: يخاطبها كأنثى… كفتاة… كزوجة… كأم …كعابدة … كقانتة… كمارقة… إلخ. أما الفكرة الثانية فتعطي مثالًا منهجيٍّا لدراسة أوضاع الجنوسة من منطلقات تحفَظ الخصوصية الإسلامية بقيمها وأبعادها وتشابكاتها في المنظومة الاجتماعية؛ فتقدِّم فهمًا أو تفسيرًا أشمل. إنه طرحها لمدخل دراسة أوقاف النساء. وفي هذا نذكُر الأصولي المجدد الطاهر بن عاشور الذي اهتم بدراسة «الوقف وآثاره في الإسلام» ككاشف عن المثال وعن الواقع الإسلاميَّين.
وعن طريق المنهجية المقارنة البينية المنفتحة التي تميَّزَت بها مداخلات منى أبو الفضل، عملت على تحديد الإيجابيات والسلبيات في تيار النسوية الغربية، وأبرزَت نقاط تلاقٍ معه. وبخلاف ما أشرنا إليه من منظورٍ نسوي وموقفٍ استشرافي نسوي نجد الدعامة الثالثة للفلسفة النسوية الغربية التي تقوم عليها إبستمولوجيتها وميثودولوجيتها هي: التجريبية النسوية (Feminist Empiricism) الرافضة للتجريبية الوضعية بنبذها للقيم والأبعاد السيوسيولوجية للأبنية المعرفية. بل تُصِر الفلسفة النسوية للعلم على أنها انطلقَت أصلًا من وصول التجريبية الوضعية والنزعة الأسسية إلى طريقٍ مسدود، أفصح عنه كتاب کواین عقيدتان جازمتان للتجريبية وجهود أخرين. تبيِّن تلك المرتكزات الثلاثة لفلسفة العلم النسوية — أي المنظور النسوي والموقف الاستشرافي النسوي والتجريبية النسوية — نقاط التقاءٍ حميم مع المشروع المنهجي لمنى أبو الفضل، ليس فقط في أن كلَيهما استبصاراتٌ ثاقبة متكاملة للمرأة المفكِّرة الفيلسوفة المُمنهِجة التي توارت طويلًا في الظلال، في الحضارتَين الغربية والشرقية على السواء، وإنما في أن كلَيهما نابع من نموذجٍ إرشادي أو براديم، ويصُب في رفض المركزية الغربية أو الذكورية، وقهرها للآخر أو تهميشه، دفاعًا عن الخصوصية الحضارية والتعدُّدية الثقافية والرؤى التكاملية الأكثر توازنًا وعدلًا، والأقدَر والأشمَل من الزاوية المنهجية، والتي تجعلنا نظفر بمقارباتٍ علميةٍ أفضل، إذا ما نظرنا إلى العلم وفلسفته ومنهجه من المنظور الحضاري، أو في الإطار الحضاري والثقافي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* منقول بتصرف من:
يمنى طريف الخولي (2024). منهجيتنا العلمية. وندسور: مؤسسة هنداوي سي آي سي. ص ص. 207- 222.
** الرئيس الأسبق لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.
[1] من الجدير بالذكر أيضًا أن منى أبو الفضل ابنة أستاذ للباثولوجيا الإكلينيكية بالقصر العيني. أما الوالدة فهي العالمة الجليلة الدكتورة زهيرة عابدين أستاذ طب الأطفال ومؤسسة طب المجتمع، والتي تُلقَّب بأم الأطباء، فهي أول مصرية وعربية تحصل على زمالة كلية الأطباء الملكية بلندن، وأول مصرية تعمل في هيئة التدريس بكلية الطب، كانت ابنة لواحد من كبار باشوات مصر، وأسبغَت تبرُّعاتها السخية على كلية الطب وسكن طلابها وعلى مشاريعَ طبية واجتماعية لرعاية الأطفال والفقراء ومرضى روماتيزم القلب واللقطاء والمسنين. وكانت منى كبرى أولادها الأربعة، شقيقة لأستاذتَين في كلية الطب وأستاذ في كلية الهندسة.
[2] نادية مصطفى «المنظور الحضاري والعلوم الاجتماعية والإنسانية» المصدر نفسه، ص. ٤٤.
[3] مدحت ماهر الليثي، الباحث السياسي في محراب القرآن الكريم شرعة ومنهاجًا، في: التحول المعرفي والتغيير الحضاري، المصدر نفسه، ص. ١٥٤ – ١٩٦، ص. ١٦٦. وليس من باب الإنشاء أن يقول هذا – الباحث الجاد عن منى أبو الفضل إنها: «باعثة المنظور الحضاري، وكاشفة الغطاء عن الأنساق المعرفية المتقابلة، وداعية المنظور المعرفي التوحيدي، وبانية مفهوم الأمة القطب، ومبتكرة المدخل التنموي التكاملي، ومنبِّهة الوعي المنهاجي، وراسمة معالم الإطار المرجعي للمنهج، ومشيدة المفاهيم لبنات المنهج، ورافعة راية الشهود الحضاري، ومنظرة علوم الأمة والعمران» (ص. ١٦٧).
[4] منى أبو الفضل، نحو طرح توحيدي في أصول التنظير ودواعي البديل، ترجمة عارف عطاري، في: مجلة إسلامية المعرفة، العدد ٦.
تنطلق هذه الدراسة من القضية المتفق عليها وهي رفض النموذج الغربي الوضعي الواحدي الذي يُلحِق العلوم الإنسانية والاجتماعية بمسيرة العلوم الطبيعية الإمبيريقية. ولكن أبو الفضل تطرح السؤال: لماذا سارت العلوم الاجتماعية في هذه المسيرة أصلًا؟ وتقدِّم إجابةً مفصلة، تبدو لنا غير مقبولة. إذ تذهب أبو الفضل إلى أن العلوم الاجتماعية كانت فروعًا من الفلسفة، ومع الحداثة والتنويراهترأَت الفلسفة وتداعت وتهاوت وانتهى عصرها، ففقدَت العلوم الإنسانية مأواها واضطُرَّت إلى اللجوء للعلم الطبيعي الإمبيريقي واتباع نموذجه. هكذا!! في اتباعٍ مباشرلتنميط أوغست كانط لمراحل الفكر البشري وانتقاله من المرحلة الدينية إلى المرحلة الفلسفية إلى المرحلة الوضعية! ولكي تثبت د. منى هذا، تتبعَت نقد الفلسفة التجريبية الإنكليزية الحديثة للميتافيزيقا لتخلُص إلى انتهاء عصرها وعصرالفلسفة جملة وتفصيلًا. وفي هذا نلاحظ أولًا أن العلوم جميعها حتى العلوم الرياضية والفيزيائية، وليس فقط العلوم الإنسانية والاجتماعية، كانت في الأزمنة القديمة فروعًا من الفلسفة، واستقلَّت جميعها واحدًا بعد الآخر، وما انهارت الفلسفة أو تهاوت أو انتهى عصرها كما زعم إمام الوضعية أوغست كانط، بل تطوَّرَت الفلسفة وتنامت. كانت الفيزياء كما هو معروف أسبقَ العلوم جميعًا في الاستقلال عن الفلسفة ومع هذا حمل كتاب نيوتن العمدة عنوان المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. وثانيًا، والأهم أن الميتافيزيقا ليست كل الفلسفة، بل فقط أحد فروعها الهامة، والتجريبية الإنكليزية ليست كل الفلسفة، بل فقط أحد تياراتها الهامة. إن رفضالميتافيزيقا عنصرٌموجود دائمًا في الفلسفة الغربية، منذ نقطة بدئها في القرن السادس قبل الميلاد مع طاليس في ملطية على سواحل اليونان. أجل اقترنَت نشأة العلم الحديث التي يمثِّلها فلسفيٍّا فرنسيس بيكون بإقصاء الميتافيزيقا من دائرة العلم أو حتى من دائرة الهمِّ المعرفي، ولكن لم يكن يعني هذا انهيار الفلسفة في العصر الحديث، بل كان يعني سطوع نجم الإبستمولوجيا، أو فلسفات المعرفة والعلم والمنهج العلمي الذي أثبت النجاحُ اللافت للعلوم الطبيعية أنه طريقُ الظفَر المبين، فعملَت العلوم الإنسانية بدورها على اتباعه، ولهذا تبنَّت النموذج الوضعي الإمبيريقي، وليس لأن حاضنتها الفلسفة تبخَّرت بقدرة قادر، أو نفقَت كما تنفقُ الدجاجة.
[5] منى أبو الفضل وطه علواني، إعادة بناء علوم الأمة، المصدر نفسه، ص. ٦٤.
[6] المصدر نفسه، ص. ٦٢.
[7] المصدر نفسه، ص. ٥٩، ٦٤.
[8] المصدر نفسه، ص. ٧٣.
[9] المصدر نفسه، ص. ١٠٨.
[10] السيد عمر، »بصائر منهجية في التعامل مع التراث: إطلالة على العطاء المنهجي للعلَّامة منى أبو الفضل»، في: التحول المعرفي والتغيير الحضاري، المصدر نفسه، ص. ٩٧.
[11] المصدر نفسه، ص. ٩٦ – ١٥٣.
[12] د. محمد صُفَّار، »الشرق في قلب الغرب: البديل الثالث» في: التحول المعرفي والتغيير الحضاري، المصدر نفسه، ص. ٣٦١ – ٣٩٥. والعمل الذي يقصده لمنى أبو الفضل هو:
Abul-Fadl Mona, Where East Meets West: An Agenda of the Islamic Revival (Virginia: IIIT, 1992).
[13] المصدر نفسه، ص. ٣٩٤.
[14] منى أبو الفضل، الأمة القطب، المصدر نفسه، ص. ٢٣.
[15] المصدر نفسه، ص. ٤٧.
[16] هذا الاستعمال لمصطلح Community ذي الأهمية الخاصة في العلوم الاجتماعية يدفع إلى إعادة النظر في الترجمة المعتمدة الشائعة له إلى «المجتمع المحلي»: ليبدو من الأفضل أن يقابله مثلًا، «المجتمع المتعين»: ومع هذا يبدو لي أن مفهوم «الأمة» غير قابل للترجمة أصلًا، هكذا تحكُم أصوله الاشتقاقية المرتبطة بكلمة «الأم» ومعانيه الإشارية والدلالية الخصيبة والمتميزة بكل ما يميز حضارة الإسلام واللغة العربية، كما هو من المذكور أعلاه حيث توظيفاته الترمينولوجية أو المصطلحية الهامة في مدرسة المنظور الحضاري لكل هذا، يبدو من الأفضل والأسلم أن ينتقل إلى اللغات الأخرى كما هو فنقول Ommah وإلى هذا يذهب، حسن حنفي وثقاتٌ آخرون.
[17] منى أبو الفضل، الأمة القطب، المصدر نفسه، ص. ٢٩، ٤٥، ٥٦، ٦٥، ٦٦.
[18] منى أبو الفضل وطه جابر العلواني، إعادة بناء علوم الأمة، المصدر نفسه، ص ١٢٢ – ١٢٣.
[19] يمنى طريف الخولي، النسوية وفلسفة العلم (القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١٤ م) وقارن:
ليندا جين شيفرد، أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة يمنى طريف الخولي، عالم المعرفة؛ ٣٠٦ (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠٠٤ م)، وثمة أيضًا مذكور سابقًا: ساندرا هاردنج وأوما ناريان (محررتان)، نقض مركزية المركز: الفلسفة من أجل عالم بعد استعماري متعدد الثقافات ونسوي، ترجمة يمنى طريف الخولي، ضمن سلسلة عالم المعرفة. ونخص بالذكر فصلَين في الجزء الثاني (عدد ٣٩٦ يناير ٢٠١٣ م) وهما الفصل الرابع عشر: ساندرا هاردنغ، الجنوسة والتنمية وفلسفات العلم بعد-التنويرية، ص. ١٥٠. والفصل السابعَ عشر: آن كَد، التعددية الثقافية كفضيلة معرفية للممارسة العلمية، ص ٢٩٧ – ٢٣٤.
[20] قامت منى أبو الفضل بتحرير كتاب بنت الشاطئ: خطاب المرأة أم خطاب العصر؟ مُدارسة في جينالوجيا النخب الثقافية (٢٠١٠ م) وهو أوراق ندوة عقدتها جمعية «دراسات المرأة والحضارة» وأيضا أشرفَت على إصدار أعداد المجلة غير الدورية المرأة والحضارة التي صدرَت عن هذه الجمعية. كما صدر لها المرأة العربية والمجتمع في قرن: بيبليوجرافيا المرأة العربية (دمشق، دار الفكر، ۲۰۰۲ م).
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies