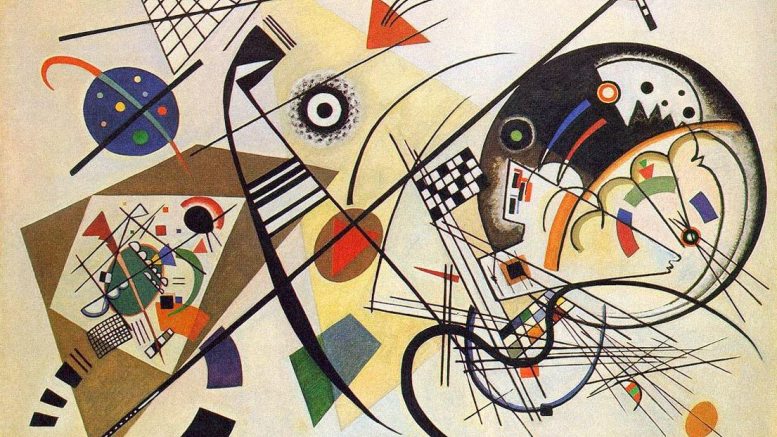من انتقاد الحداثة إلى نقدها
من هنا نبدأ*
محاضرة لـ أ. د. وائل حلاق**
إعداد وتحرير أ. وليد القاضي***
تنتشر اليوم موجات نقدية ترى أن الحداثة الغربية تواجه مأزقًا أساسيًا في قدرتها على الاستمرار والتجدُّد، حيث فشلت هذه الحداثة في حل المشاكل الاجتماعية والأخلاقية، بل وخلقت أزمة في الهوية والقِيَم، ليس فقط في الغرب، بل في العالم بأسره؛ نتيجة فرضها كنموذج عالمي. ولا ينبع هذا النقد من خارج العالم الغربي فقط، بل من داخله أيضًا، حيث بدأ مفكرون كبار ينتقدون “الحداثة المُفلِسة”، ويبحثون عن بدائل إيجابية لها.
ولا ريب أن إثارة موضوع “إفلاس الحداثة الغربية” يعكس حالة من النقد والتشكيك في قدرة الحضارة الغربية الحديثة على تحقيق ما نادت به من مبادئ العقلانية، والعدالة الاجتماعية، والتحرُّر الإنساني، حيث يرى كثيرٌ من المفكرين أنها على العكس من ذلك، فقد قامت بإضعاف الروح والأخلاق والقيم الإنسانية؛ بسبب اعتمادها شبه الكامل على المادية والدنيوية، وانتقادها الجدلي المُبالَغ فيه للتراث والدين.
ومن ثمَّ، يثير هذا الموضوع الشائك إشكالية الفشل النسبي أو الكامل للنموذج الحداثي الغربي في الاستجابة لتحديات الإنسان والمجتمع على المستويات الفكرية والاجتماعية والروحية، ويُبرز التساؤلات حول نموذج الحداثة الغربية كمرجع حضاري شامل. ويتصاعد هذا بالطبع، من جهة أخرى، مع تساؤلات جمَّة حول كيفية النهوض بالأوضاع العربية والإسلامية، وسط حالة التخبُّط التي تشهدها منذ عقود، والتي برزت الحداثة الغربية كأحد السبل المقترحة لمعالجتها، على يد بعض المفكرين الذين دافعوا عنها قدر طاقتهم.
وفي هذا السياق، تأتي هذه المحاضرة للأستاذ الدكتور وائل حلاق، أستاذ العلوم الإنسانية والإسلامية بجامعة كولومبيا الأمريكية، والتي يتناول فيها بالنقد أحد أسس الحداثة الغربية، ألا وهو الحرية الليبرالية، كملمح مهم لما نسميه “إفلاس الحداثة”، مُبيِّنًا السُبل المُمكِنة لتجاوز “المأزق الحداثي”، والآليات التي ينبغي الاستعانة بها من قِبَل العرب والمسلمين لتحقيق نهضتهم الخاصة والمستقلة.
وفيما يلي الأفكار الأساسية التي جاءت في المحاضرة، تليها إجابات لحلاق على عددٍ من أسئلة المشاركين.
هموم فكرية في ضوء العلاقة مع الغرب
جليٌ أن الحضارة العربية الإسلامية افتُتِنت بتلك الغربية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكأنه عالم ساحر نصبو أن ننتمي إليه بغير تساؤل أو مراجعة. ربما يكون هذا الافتتان راجع الى انفتاح فكري يتماشى مع التاريخ العربي والإسلامي منذ أكثر من ألف عام عندما تُرجِمَت العديد من مؤلفات الحضارات القديمة وعلومها ودُرِست واختُبرت في العالم الإسلامي. إلا أن مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأ يتشكَّل واقع جديد كاشفًا عن نتائج وعواقب سلبية للغاية للحداثة الغربية، حيث اختُزِلَت مفاهيم الحياة ومعناها الحقيقي في معانٍ ضيقة تحوم حول الجسد والمادة والمادية. فأصبح الإنسان المعاصر قشرة دون جوهر، وبغير روح وقلب.
والإشكال الآن هو أننا كعرب ومسلمين ما زلنا نُقدِّس الغربَ وقِيَمَه، والحداثة وحضارتها، ونعاني قصورًا في التفكير المستقل من ناحية، وافتتانًا كاملًا من ناحية أخرى بالمادة والمادية تجعلنا تابعين دون تفكير لهذه الحضارة التي أعلنت إفلاسها. ورغم ذلك، فأنا لا أدعو إلى الانغلاق الفكري، ولا أدعو – ولن أدعو – إلى القطع مع الآخر على مستوى القِيَم وتفاعلها، فإني من أوائل مَن يعتقد بحتمية التبادل الفكري والحضاري، بل إن كل الحضارات من بداية البشرية – بدون استثناء – تفاعلت مع الحضارات الأخرى واستفادت منها، فهذا قانون من قوانين الحياة البشرية والحضارية. ولكن الأخذ من الآخر له معايير وضوابط، فيمكن القول إن هناك نوعَيْن من التفاعل مع الآخر والتأثر به؛ الأول من منطق القوة والاستقلال، والآخر من منطق الضعف والذل. ويختلف كلاهما عن الآخر إبستمولوجيًا. ونحن الآن نعيش تجربة النوع الثاني، “الذي ينضح بالعبودية الفكرية والاتباع الأعمى”.
ومنذ نهاية القرن التاسع عشر، صرَّح كثيرٌ من مفكِّري العرب والإسلام بمواقف مدهشة تجاه موضوع العقل والعقلانية، وانخرط كثيرون منهم فيما أسمِّيه بـ “الازدواجية اللاواعية”؛ فهم ينكرون تبعيتهم “للعقل الغربي”، فيما يسعون في الوقت ذاته إلى إثبات وجود موضوعات للفكر الغربي في الفكر الإسلامي. ولعلَّ من أبرز الأمثلة على ذلك هو محمد عابد الجابري[1]، الذي شوَّه تاريخ التصوف في الإسلام، وجحد في حق الشريعة ما سمَّاه “البيان” ليؤكد في نهاية المطاف أن العقل العربي الإسلامي الخالص هو “العقل الرُّشْديّ” – نسبةً لابن رُشد[2] – الذي كان – وبالمصادفة غير البريئة – له تأثير كبير على حركات الإصلاح في أوروبا، وهي الحركات التي مهَّدت لنشوء عصر التنوير.
فحتى الآن لا أعرف أيَّ مفكر ذا سطوة في عالمنا العربي وقد تخلص من سطوة هذه الازدواجية، وبالتالي من العبودية الفكرية. فنحن جميعًا حداثيون، وإذا كنا نشتكي مما طغى علينا من مشاكل فذلك لأننا نعيش بكل كياننا في الحداثة، فصراعنا مع أنفسنا ومع العالم ليس هو إلا ظاهرة من ظواهر الحداثة.
فالسؤال إذن إلى أين نذهب من هنا؟ وكيف يحدث ذلك؟ خاصة وأننا كجميع شعوب العالم نواكب الأزمات العالمية من تدمير للطبيعة والإنسان والأسرة والمجتمعات والعلاقات الاجتماعية وتدمير النفس الإنسانية وزيادة أمراضها؟ مع تنامي العنف والحروب والقتل، وفقدان للعدالة الاجتماعية والغنى الفاحش وطمع الشركات متعددة الجنسيات، ودورها في تعزيز الاستغلال والفقر وغيرها من الأفعال غير المسؤولة.
والعجيب أن رغم كل هذه السلبيات فقد تكالبنا على تبنِّي هذه القيم بغير وَعْي. وفي حين يحاول الغرب جاهدًا الخروج من هذه المآزق، والخروج ممَّا أنتجته الحداثة وما صنعه هو لنفسه ولغيره من مآسٍ، لا نزال نحن نسأل السؤال الجاهل والعقيم: كيف ننضم إلى الحداثة؟
والسؤال الحق هو كيف يمكننا الخروج من هذا المأزق؟ كيف يمكن الخروج من الحداثة إلى عصر إنساني يتميز بقِيَم سامية، عصر نشقُّ طريقنا فيه بأيدينا نحن؟
من الانتقاد إلى النقد: من هنا نبدأ
نحن نقف الآن في مفترق طرقٍ صعب؛ فالتاريخ العريق وراءنا والمستقبل المفتوح بتحدياته أمامنا. ومن المقدمات المهمة لمشروع إحياء الأمة هو أننا أثرياء بتاريخنا، ومنفتحون على مستقبلنا، لكننا في لحظة عصيبة؛ ليس فقط نتيجة المشكلات والأزمات السياسية التي نعيشها، لكن لأن لحظتنا العصيبة هذه يتشاركها الجميع، بما فيه الغرب والشرق الأدنى، ما يؤشِّر على جسامة ما تنطوي عليه من تحديات وعقبات.
ومن ثمَّ، لا بد من أن نتبنَّى منهجًا فكريًا يعكس موقعنا من التاريخ، ويعكس طبيعتنا الحضارية التي لها خصوصيتها، إنْ كانت في الماضي أو الحاضر. ومن أهم العناصر التي تساعد على تكوين هذا المنهج هو عنصر “النقد”، والذي يختلف عن “الانتقاد” كيفًا وكمَّا من حيث الاستعمال. فالانتقاد تحتاج إليه أي منظومة كي تستمر في إنتاج ذاتها بعد كشف مواطن ضعفها؛ فهو بمثابة المُصلِح والمُرمِّم لوجه من وجوه المنظومة أو لجميعها، ومن الأمثلة البارزة على ذلك أن انتقاد إدوارد سعيد[3] للاستشراق أدى إلى تنبُّه الاستشراق إلى نِقاط ضعفه ووهانة مقارباته، فاشتغل سريعًا لإصلاح ذلك ليظهر في حُلَّةٍ جديدة تُخفِي نفس العورات. فانتقاد سعيد أكْسَبَ الاستشراقَ نوعًا من المناعة والحصانة ساعدت على استمراره بأفكاره إلى اليوم؛ لأن هذه الأفكار هي جزء أصيل من طبيعته، وإنْ اختلف شكلُه ومظهرُه. هذا كما أدت مقولات الاقتصادي جون كينز[4] من قبلُ إلى تقوية الرأسمالية في نهاية المطاف وتفادي عثراتها، إلى حدٍ ما. فأي منظومة تحتاج الى الانتقاد لكي تستمر في إنتاج ذاتها.
أمَّا النقد، فهو على العكس من الانتقاد، لا يتقبَّل كثيرًا من المسلمَّات التي يعتبرها الأخيرُ أمورًا طبيعية ومُسلَّمًا بها. فالنقد يدخل في صميم ما يتم نقده ويستجوبه إجابات وجودية وإبستمولوجية. فالنقد يريد زعزعة المنظومة والأسس التي تُبنى عليها، لأنه ينطلق من فكرة أن المنظومة يجب أن تتغير تغيرًا جذريًا. فالنقد في بدايته انتقادٌ، ووسطه هدمٌ، وآخره إعادة بناء؛ فالنقد لا يتقبل الشعارات والمسلمات الأيديولوجية فهو يبحث عن الجذور دائمًا لكي يتعدَّى المفاهيم التي تصبغ الأشياء بصبغة أيديولوجية مُقدَّسة، فالنقد فنُّه هو فن التفكيك الجينولوجي [الذي يبحث في نشأة الأشياء وأصلها]، وكَشْف العلاقات الخفية بين أركان المنظومة. فمفهوم الحرية، على سبيل المثال، وهو من أقدس مفاهيم الحداثة وأجلَّها، يستحضر نوعًا معينًا من الحرية يلغي بدوره ما عداه من مفاهيم أخرى للحرية، وكأنها لم تكن. وهذا قسم أساسي من العملية الأيديولوجية التي قَوْلَبَت مفهوم الحرية الحداثية، وهو مفهوم ليبرالي، بقالب القداسة، فأصبح كمفهوم “التقدم”، مفهومًا ثيولوجيًا لاهوتيًا. إلا أنه يجب التأكيد هنا على أننا علينا التحدث حول مفهوم آخر للحرية، لا يمُت إلى المفهوم المُهيمِن بصِلة.
وفي هذا السياق، يجدر الالتفات إلى أن للنقد التفكيكي التحليلي مهمة منهجية خاصة، وهي الكشف عن المسكوت عنه، إذ إن كل خطاب يعكس التراكيب المعقدة لأي منظومةٍ ما، يُلغِي بالضرورة إمكانيات خطابية أخرى، مُنافِسة ومُنازِعة لهذا الخطاب الرسمي.
الحرية الليبرالية نموذجًا لإفلاس الحداثة الغربية
إن أول ما يلفت النظر في مفهوم الحرية الغربية أن خطاب الحرية الحداثي المُهيمِن على حاضرنا الآن قد أعلن حربه على أي خطابات ومفاهيم أخرى للحرية؛ فالحرية “الليبرالية” لا تعطي أي “حرية” لأي مفهوم آخر، وهذا هو التناقض الأول.
أما التناقض الثاني، فهو أن المفهوم الليبرالي للحرية ينتحل لنفسه مصداقية عالمية شاملة وعامَّة، رأسيًا وأفقيًا، أي يشمل العالم جميعًا بحاضره وماضيه، بمعنى أن كل شئ في مختلف الحضارات الأخرى، الآسيوية والأفريقية، يُحكَم عليه بحكم هذا المفهوم الغربي.
والتناقض الثالث له علاقة بادّعاء شمولية هذا الخطاب؛ إذ إن هذا المفهوم لا يمكن أن يكون شموليًا وعالميًا؛ لأنه نِتاج التجربة الأوروبية على وجه الخصوص، وتحديدًا وسط وغرب أوروبا، فلم يُفرَز من قِبَل أي مجتمع آخر غير المجتمع الأوروبي. وهكذا، يصبح ادّعاء شمولية وعالمية هذا المفهوم أمرًا غير مُبرَّر.
ومن هنا يمكن القول بأن الحرية الحداثية هي أساسًا حرية ليبرالية محبوكة حَبْكًا تامًا بالتاريخ الرأسمالي الحديث؛ لأن جذور مبادئ الحرية الليبرالية هي جذور مادية تعتمد في الأساس على مفهوم الملكية الخاصة، ونشوء طبقة برجوازية منذ القرن السادس عشر تريد أن تحمي حقوقها المادية من طغيان الحاكم المُستبِد من جهة، ومن الحركات الشعبية الأناركية (الفوضوية) من جهة أخرى. ومن الواضح أن نجاح هذه الطبقة البرجوازية في إلجام طغيان الحُكَّام وغوغاء العوام، كان الحجر الأساسي الذي بُنِيَت عليه المنظومة السياسية الليبرالية. فأساس العالم الغربي الآن هو الركن الأول: المتمثل في المال والمادة والمادية والرأسمالية، والثاني: هو الحكومة وجهاز الأمن القمعي الضروري لإرساء قواعد منظومة الهيمنة الرأسمالية والمادية. وتمثل الولايات المتحدة حاليًا النموذج الأعلى لهذه الظاهرة التاريخية الفريدة من نوعها، بعد أن بدأت في غرب أوروبا، وفي إنجلترا وهولندا بالذات، منذ أواخر القرن السادس عشر.
وهذا يعني أن مفهوم الحرية الشائع في العالم اليوم هو مفهوم قد حُدِّدَت ملامحه من طريق تاريخ أوروبا السياسي والاقتصادي الشائك والمعقَّد. وهو تاريخ قد قام على تجربة خاصة وفريدة من نوعها. وبالتالي فإن مفهوم الحرية ليس له من الشمولية بشئ، ناهيك عمَّا يعتريه من نُقصان نَوعِي باختزاله واستبعاده أنواع أخرى من الحرية لم تكن أوروبا معنيَّة بها. وعلى هذا الأساس، لا أحد يستطيع أن يزعم بأن كل ديمقراطية هي حرية أو العكس؛ لأننا نشاهد بأعيننا الممارسات القمعية في فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل وغيرها من الدول التي تدَّعي الديمقراطية وتدعو إليها، في حين أنها تضطهد أقلياتها وتُخمِد الحركات الشعبية والديمقراطية في بلاد أخرى.
نوعان من الحرية!
في هذا السياق، يتبدَّى أن الحريات الديمقراطية الليبرالية ليست مُختزَلَة فقط، بل إنها استبعدت بالضرورة نوعًا مهمًا من الحريات وطمسته طمْسًا كليًا في صفحات القرون الخمسة السابقة. وفي هذا الصدد، يمكن التمييز بين نوعَيْن من الحرية؛ هما: الحرية الخارجية، والأخرى الداخلية أو الذاتية. فالأولى هي بالأساس حرية سياسية، تحاول أن توفر للفرد حرية التصرف في الحياة العملية والسياسية، لكنها لا تستطيع أن تزعم أن لها أيَّ شأنٍ في حرية الوجدان والنفس والروح؛ فهي تتخلَّى عن قَصْدٍ عن مسؤولية إنماء ورعاية الذات الداخلية، تارِكةً ذلك للمجال الخاص، وبالأحرى تتركه مهدورًا لصراع القوى الخارجية ضد بعضها البعض، وتكالبها على السيطرة على الفرد وعزله عن جماعته ليصبح مستهلِكًا رأسماليًا منخرطًا في المنظومة الاستهلاكية التي تزرع في الفرد اهتمامه الخالص بالجسد والمادة. وكلما نمت هذه النزعة واشتدت، نما معها حس الفردانية والنرجسية والأمراض الأخرى الاجتماعية كالاضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع، والاكتئاب، وأمراض النفس اللامتناهية، والتي تؤدي إلى مآسٍ مثل قتل النفس وغيرها من العواقب التراجيدية.
والحرية الليبرالية بوصفها السابق هي حرية خارجية لها تأثيرات سلبية هدَّامة على النفس؛ فهي تبدو برَّاقة ومغرية من الخارج، ولكن تعوث في النفس فسادًا يوازي ما تعوثه الرأسمالية الصناعية في البيئة والطبيعة. والاثنان لا ينفصمان، فدمار الرأسمالية الليبرالية هو دمار خارجي وداخلي، جسدي وروحاني، بيئي ونفساني.
أمَّا الحرية الذاتية، فهي حرية تبدأ من الداخل، من داخل العقل والروح والنفس، متدرِّجةً بعد ذلك إلى الخارج، فيكون لها وقعٌ في المجتمع ومجالات السياسة والاقتصاد، وغيرها من مجالات الحياة الناشطة. وهي حرية نفسية روحانية تبدأ من الوعي بالذات، والرغبة المُلِحَّة في تهذيب هذه الذات، وهذا ما يسميه البعض بـ “تقنيات الذات”. وجدير بالذكر أن هذه التقنيات، كان لها رواج واسع حتى القرن التاسع عشر في جميع أنحاء العالم تقريبًا، وحتى القرن السادس عشر في أوروبا، بالرغم من ضعفها النسبي في هذه القارة.
فتقنيات الذات عرفَتها مختلف الحضارات الفرعونية والهندية والصينية والإغريقية والرومانية والفينيقية وغيرها، وأتقنها العالم الإسلامي عن طريق الشريعة والتصوف إتقانًا شديدًا. ومن الخواص الأساسية للحرية الذاتية، هي الحرية (أي الزُّهْد) عن الحاجة والاحتياج، خصوصًا ما يجعل الفرد عبدًا لحاجاته الدنيوية. فالحرية الخارجية تجعل من الرغبة حاجة، ومن الشهوة حاجة، تؤدي جميعها إلى استرقاق النفس. وهذا هو السبب الرئيسي لنجاح عقلية ممارسة الاستهلاك في السوق الرأسمالية المعاصرة. ويزداد الأمر سوءًا بالنظر إلى مَن لم ينخرط في هذه الممارسات على أنه شاذ ينتمي إلى عصرٍ آخر متخلِّف.
فالحرية الذاتية هي التحرِّر من سيطرة الحاجات الاستهلاكية؛ لأنها صقلٌ للذات، تجعل القناعة فيها رصيد قوة تتجاوز الحاجات الاستعبادية، فهي القوة العظمى التي تبني نفسها على قهر الذات وتدريبها على ألا تحتاج، وتفضِّل ذلك عن السماح لقوة خارجية أن تقهرها؛ فهي حرية شريفة وكريمة ومستقلة. فقَهْر العبودية في الذات والنفس هو تحريرها من الضعف لتصبح مركز القوة الفردية.
فالإرادة الحرة الحقيقية هي ليست الإرادة الـ “ما بعد كانطية”[5]، التي تتكالب على الماديات والشهوانية، وترفعها إلى مراتب القِيَم الأولى، ولكنها هي التي تكبح هذه الشهوات السطحية، لكي تغذِّي “داخل” الإنسان، وهذا من أهم مزايا الحرية الذاتية، وما سمَّاه أحد الفلاسفة بـ “القلعة الداخلية”. فهذه القلعة أخلاقية، كونها تتعامل مع البيئة الخارجية على أساس القناعة، والتواضع، والكرامة، والاحترام. وإذا كانت هذه القلعة مبنية على “فرعية الإنسان”، بمعنى كونه مخلوقًا كسائر المخلوقات، فتصبح لدينا أسسٌ نبني عليها مفاهيم طبيعية وسياسية تؤهِّلنا للتعامل باحترام مع الطبيعة، وصياغة علاقات غير أدائية بين البشر، وذلك على غرار نهج الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس[6] وبعض خلفاء وسلاطين المسلمين.
الخلاصة أن الحرية الخارجية تبدأ بالحرية المادية ومظاهرها، وتنتهي بفراغ القلعة الداخلية وهدمها من الصميم، بل تزرع في النفس الضعف والوهن، وتترك الروح فريسة لسطحيات الحياة، والجشع، والطمع، والنهم. فالحرية الخارجية هي استعباد للنفس وقهر للروح.
نحو أُفق نهضوي أرحَب
في ضوء ما سبق، يجب على الأمتَيْن العربية والإسلامية ما يلي:
– التخلص من كل مفاهيم ومشاعر الانحطاط والدونية وقلة الثقة في النفس. إذ لدينا عقلٌ كالآخرين، وكل ما يستطيع الآخر فعله وتحقيقه، نحن نستطيعه كذلك. وفي ظل هذا المأزق الحداثي، ربما بإمكاننا الإتيان ببعض الأشياء على وجه أفضل من الآخرين، لاسيَّما العالم الغربي الذي يتخبَّط في غياهب الحداثة اليوم ونتائجها المريرة.
– ضرورة إتقان فن الدراسة والتمحيص والتمعُّن والتعمُّق فيما نقرأ، إذ يجب علينا فهم الحداثة والغرب، وما أنتجه من الداخل بعمق، وذلك من غير حُكم مُسبَق، ومن غير اغترار مسحور بقوته وهيمنته على العالم. فلو كانت هذه الهيمنة ناجحة وبنَّاءة وأخلاقية وسلمية، لما قامت أصواتٌ وحركات في الغرب نفسه تندِّد بالمنظومات التي هيمنت عليه وعلينا.
– ضرورة ممارسة ما يسمَّى بـ “النقد العميق”، والذي يرفض المُسلَّمات على واقعنا، إنْ كان ذلك في الشرق أو في الغرب. فيجب البحث عن المسلَّمات التي طمَسها التيار الحداثي الجارف، لأن فيها طاقة إنسانية تاريخية لا تموت مع الزمن. فكل شئ في عالمنا يموت باستثناء المقولات الأخلاقية، وهي العناصر التاريخية الوحيدة التي تعيش على مدى القرون، وإن خفتت أحيانًا بفعل صياح غيرها. والنقد الصحيح – كما سلفت الإشارة – هو النقد الهدَّام والبَنَّاء في آنٍ واحد، وعلينا أن نجعله قسمًا أساسيًا في بنيتنا العقلية والفكرية.
مناقشات وتعليقات:
س: هذا الانتقال من الانتقاد إلى النقد هو ما أقدم عليه الفيلسوف طه عبد الرحمن[7]، عندما أظهر محدودية المقولات الفلسفية الغربية، ورَفَعَ عنها طابع الكونية، مؤكدًا أن التفلسف وقضاياه يرتبط أساسًا بالسياق التداولي لكل أمة أو الشعب، بما في ذلك السياق الثقافي الذي نبعت منه.
د. حلاق: بالطبع هناك تشابه كبير بين تفكيري وتفكير د. طه عبد الرحمن، وليست صدفة أن أختاره من بين جميع مَن يظهر على الشاشة في العالمين العربي والإسلامي لكي أكتب عنه كتابًا كاملًا يتجاوز 350 صفحة، فهذا مشروع مشترك. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات غير الجذرية بيننا، وأقف فيها إلى درجة معينة على يسار د. طه. فهو يتشبَّث بالحداثة على حسب تعريفه الفلسفي، وأنا لا أريد أن أبقى في هذا العصر. فالعصر الحداثي هو تقريبًا نسخة كربونية من العصور الوسطى الأوروبية، أو هو نسخة مُعلمَنة من المسيحية الأوروبية، بشهادة عدد لا بأس به من المفكرين. وكما خرجت أوروبا من عصورها المُظلمة إلى العصر الحداثي، فأنا أدعو إلى الخروج من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، ولكن ليس بالتعريف السائد لما بعد الحداثة. فأنا لدي اقتناعٌ بأننا لم نخرج حتى الآن من الحداثة، وكما يقول الفيلسوف الألماني هابرماس[8] أن الحداثة لم تكتمل، وأن ما بعد الحداثة هي بمثابة خطوة إضافية لتحسين الحداثة، ولا تخرج محادثات الفلاسفة والأكاديميين حول هذا الموضوع عن هذا السياق. وهذا المنحى يمثل في نهاية المطاف خطوة يائسة ليست ذات جدوى أو فائدة. ونحن نعرف أن التركيب البنيوي للحداثة لا يزال مستمرًا حتى الآن؛ ما يعني بالتالي الاستمرار في تدمير الطبيعة والمجتمعات، وفي معادلاتنا غير العادلة في الاقتصاد والنهج الرأسمالي… إلخ. وبالتالي، فإن الحلول التي يجب تقديمها للتغلب على الحداثة لا يمكن أن ترتكز على المفاهيم الأساسية الحالية للحداثة، وحتى الآن لا توجد مفاهيم جذرية بعيدة عمَّا يقوله الغرب منذ ثلاثة قرون.
س: كيف يرى د. حلاق جوهر تقابل النماذج المعرفية بأسئلتها الكلية والنهائية، ومراكزها المعرفية وأدواتها التحليلية على ما تذهب إليه كتابات د. عبد الوهاب المسيري[9] في النقد، وليس الانتقاد فقط؟
د. حلاق: يُسأَل هذا التساؤل كثيرًا حول مدى التشابه بين مشروعي ومشروع الأستاذ الراحل المسيري. وأعتقد أنه يختلف في نقطة أساسية واحدة معي ومع د. طه عبد الرحمن، وهي أنه لم يهتم اهتمامًا مركزًا بمسألة الأخلاق كمنظومة لا يمكن أن تُجلَب إلى بؤرة البحث كاستبدالٍ لمراكز الحداثة. فهو ناقد لاذع وبارع في مجال الرأسمالية بالأساس، وانصبَّ اهتمامه أساسًا على ذلك. وانتقاد الرأسمالية من أقدم ما وُجِّه للحداثة، وهذا ليس شئ مدهش أو مفاجئ أو غير طبيعي.
س: هل نستطيع الإشارة إلى الحرية الذاتية على أنها امتلاك القدرة على إرادة التحرُّر؟
د. حلاق: بالطبع، هي كذلك بالفعل. والحرية الذاتية ليست مسألة بدأت اليوم، ففي منتصف خمسينيات وستينيات القرن الماضي تنبَّه لها كثيرٌ من المفكرين السياسيين مثل إسحق برلِن[10] في مقالته المشهورة “مفهومان للحرية – Two Concepts of Liberty” التي ألقاها أمام جامعة أكسفورد عام 1958، ولكنه ركز على ما أسماه “الحرية السلبية”، بجانب تلك “الإيجابية”، ولكن يبدو أن برلِن لم يفهم كل نواحي أو معظم الحرية الإيجابية، فلربما كان ممكنًا أن يُغنِي تفكيره لو أنه عرف النظام القانوني والصوفي في الإسلام، فهذه الظواهر التي بُنِي الإسلام على أساسها ظواهر مهمة جدًا لأنها حدَّدت ملامح التاريخ الإسلامي حتى منتصف القرن التاسع عشر، عندما دخل الاستعمار الغربي الأراضي الإسلامية فدمَّرها واستبدل مناهجها التعليمية بما يخدم مصالحه. فليس هناك الكثير من المفاهيم الجديدة التي قامت عليها كافة المجتمعات المعقدة منذ القِدَم، فكلها اعتمدت على “الحرية الذاتية”، وما سمَّاه برلِن – بشكل خاطئ – “الحرية الإيجابية”. وعلى كلٍ، فإن أطروحة برلِن، وكذا إسهامات ميشيل فوكو[11] – في أخريات حياته – عن الحرية، تمثلان أعمالًا جيدة نسبيًا لتفحُّصها والاستفادة منها في بحثنا هذا، لأنه ليس لدينا بصراحة الكثير من الفرص والمجالات لكي نجدِّد أنفسنا مرة أخرى، ونخرج من المأزق الذي نعيشه اليوم، لا سيَّما وأن ضرورة الوقت تستوجب عدم التراخي أو إعادة اختراع ما هو موجود بالأساس.
س: ما موقع مفهوم التسخير القرآني، سواء من الحرية في بُعدها الخارجي “الليبرالي”، أو في بُعدها الذاتي الروحي “التحريري”؟
د. حلاق: ليس للقرآن أي بُعْد ليبرالي، بمعنى أن الحرية الليبرالية هي اختراعٌ جديد تمامًا في تاريخ البشرية، ولا بد من أن نفهم ذلك ونستوعبه جيدًا؛ لأن هذا النوع من الحرية هي تجربة أوروبية خاصة، ذات امتدادت مادية خالصة. لكن الحرية الداخلية أو الذاتية أو الإيجابية هي في صميم القرآن. فمع بدء طلب القرآن الكريم بالصلاة والصيام، بدأت معها هذا النوع من الحرية، وكان لدى كل حضارة من الحضارات – لدى البابليين واليهود والفراعنة – تقنيات معيَّنة، تُعزِّز “الحرية الذاتية” لديها ولدى أفرادها، سواء من صيام أو غيره.
س: التناقض الأساسي في رؤية حلاق تقوم على اعترافه بطغيان الحداثة، وكوْن المسلمين جزءًا منها، ثم هو يريد من المسلمين الخروج من الحداثة المُتعيَّنَة وركوب مسار ما بعد حداثي مُتخيَّل ما دام لم يستدل على وجوده بعد. وهو في هذا يتبع منهج الجماعاتيين[12] مثل ماكنتاير[13] في نقده الجوهري للحداثة وأنساقها السياسية والاقتصادية، ثم مطالبته بحداثة الفضيلة وهي نوع من التركيب بين منظور هيجل[14] وتوما الأكويني[15] للأخلاق، ويضيف لذلك البُعد الروحاني الذي يطرحه طه عبد الرحمن التي تركز على الذات الأخلاقية، وترك كل نزوع مؤسساتي في الإصلاح الاجتماعي.
د. حلاق: أنا لا أرى أي تناقض في موقفي بالطبع، ويمكن لمَن يزعم ذلك أن يبحث في أذيال الأفكار في المنظومة الفكرية التي أقدِّمها. وأعتقد أنه ليس هناك أي تناقض في دعوتي للمسلمين أن يجدوا طريقهم في الحياة والعالم، وسبب المحاضرة هو رؤيتي الكثير من عدم الوعي بالذات وعدم الشجاعة الفكرية لكي نفكر لأنفسنا. وأعتقد أن الجميع يتفق معي في ذلك. ولكن السؤال هو: كيف نفعل ذلك؟ والإجابة تستوجب أولًا استمداد أفكارنا من جميع النواحي المفيدة. ولذلك ذكرت أنني لا أدعو إلى أي انغلاق فكري، ولكن فتح مجالات التفكير للخروج من هذا المأزق الحداثي.
س: مفهوم الحرية الشمولي من المنظور الأوروبي لا يمكن أن يُنازِعه أحد أو يُزعزِع رسوخه وتفوقه ما دام باقي المفاهيم المنافِسة ليست لها تجربة نهضوية تضاهي تلك الأوروبية، حتى تصل لمستواها للأبد أن تمر بدورها بمخاضات كتلك التي مرَّت بها الشعوب والمجتمعات الأوروبية، ومن ثمَّ يمكن أن تُضيف إليها مفاهيمها القِيَمِيَّة لتهذيبها، ولتحتوي في طيَّاتها سواءً التجربة الأوروبية دون أن تلغيها، وغيرها من المفاهيم الأخرى.
د. حلاق: أنا لا أتفق مع هذا المنطق الذي يدعو أنه يجب علينا أن نعيش التجربة الأوروبية لكي نصل إلى نصبو إليه من نهضة شاملة. وذلك لسبب بسيط جدًا، مفاده أنه كلما حاولنا أن نلحق بأوروبا وأمريكا، فإنهما سيبقيان في المقدمة على طريق الحداثة، لأنهم هم الذي اخترعوا وصاغوا الحداثة، وما تتضمَّنه من مفاهيم. ويمكن القول بأن هناك ميزة خاصة للغرب تؤهِّله لاختراع وتجديد الحداثة باستمرار، ومعنى ذلك أن التأثيرات السلبية للحداثة لن تقل، وإنما تتزايد بمرور الوقت.
وما ندعو إليه هو الوقوف وقفة استقلالية، نقلِّب فيها الأمور ونراجعها من وجهة نظرنا نحن وعلى شروطنا، وليس من منظور الغرب وشروطه، لأن التمثل بالغرب ومحاولة اللحاق به أمرٌ يبقي الأمة خلفه حتمًا. وكما نجحت أوروبا ذاتها، في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، بالانشقاق من صفوف العالم وفتح مجال جديد لنفسها، باختراع شئ اسمه عصر النهضة والتنوير، ثم الحداثة وغيرها، فيجب علينا نحن الآخرين استكشاف طريقنا بأنفسنا، من غير ما نمر بما مرَّت به أوروبا.
س: ما رأي حلاق في أنسنة التراث الفكري الإسلامي سعيًا لتعقيله، مثل اعتبار الإسلام “حنيفية محدثة”، وعليه اعتبار الإسلام في كل قِيَمه دينًا غير ناجز مسبقًا، إنما يعتمد الاجتهاد المستمر باعتماد العقل والإجماع؟
د. حلاق: أعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى الاجتهاد كثيرًا لكي “نُعقلِن” التراث الإسلامي؛ إذ إن هناك في التاريخ الإسلامي من المصادر والثروات الثقافية والعقلية والفكرية بما فيه الكفاية لأن نستمد منه مفهومًا عقليًا أفضل وأجود من المفهوم العقلي الغربي؛ لأن العقل الأوروبي – كما يعرف الكثيرون بما في أوروبا وأمريكا نفسها – هو العقل الحداثوي هو عقل أدائي مُتحرِّر من العناصر الأخلاقية، ولوجود هذه الصفة فإننا نجد أنفسنا دائمًا ندمِّر ما حولنا، عن قصد وبدون قصد. لذا يجب التخلص من هذا العقل الأدائي[16]، والبديل هو العقل الإسلامي الذي يمكن استخراجه من علوم الشريعة والكلام والتصوف وغيرها من علوم الإسلام وتراثه. وهناك الآن محاولات جادَّة شبيهة لفعل ذلك في الهند والصين؛ حيث يبرُز سعيٌ لاستعادة فلسفات ثرية جدًا من تاريخ البلدَيْن لصياغة هذا العقل غير الأدائي، والإكثار من عناصره الأخلاقية. ونرى حتى المدرسة الفرانكفورتية الأولى، بأقطابها أمثال ثيودور أدورنو[17]، قد أصبحت ذات أهمية كبيرة نتيجة تفكيرها حول الحداثة بكل جوانبها، ولكن حتى الآن هناك مشاكل عديدة، تعتري فلسفة هذه المدرسة.
س: ذكرتم في كتاب “إصلاح الحداثة” أن ما يميِّز نقد طه عبد الرحمن أنه يستثمر نقد نُقَّاد الحداثة الغربيين لها، لكنه عندما يقترح حلولًا يضع مسافة بينه وبين حلولهم، ويختار حلولًا منطلِقة من منطلقاته التراثية وفكره الإسلامي.
د. حلاق: أتفق مع هذا الموقف، وهذا ما فعله د. طه بالفعل. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه – وبصراحة – ليست هناك طرق عديدة لإصلاح ما نحن فيه. وبالتالي، أؤكد على أنه ليس هناك أي عيب أو نقص من الاستفادة من إسهامات الآخرين في بناء المنظومة الفكرية التي نسعى لتشييدها، فأنا بإمكاني فعل ما فعله الشيخ طه حينما أخذ حجرًا مثلًا من هابرماس ومن هيجل ومن كانط، ومن المواردي[18] والغزالي[19]، وحتى من مفكرين صينيين أو هنود. فالمهم هو شكل البيت أو المنظومة التي نبنيها.
س: ما هي المرجعية الفكرية والحضارية لممارسة النقد البنَّاء للغرب؟ وما هي البدائل الأخلاقية لنَسَق الحداثة الغربية دون السقوط في نفْس الفعل، ونفْس النمط الغربي؟
د. حلاق: المرجعية تكمن في البدائل الأخلاقية. فالمرجعية الفكرية التي مارسها الغرب بُنيَت من حوالي أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن التالي على أساس فصل الأخلاق عن كل شئ، ولذلك قد سُمِح بتطورات عديدة تتفاخر بها أوروبا، ولا تزال تدمر كل شئ حولنا. ولنأخذ مثال “الشركة” بمعناها الحالي؛ إذ ليس هناك ما يشبه هذا الكيان في التاريخ البشري، قبل عام 1600م. ويقوم هذا الكيان على مسألة “محدودية الضمان”، وهذه المسألة في حد ذاتها أخلاقية محضة، وليست مسألة قانونية. وهي تعني أنه يمكن أن ننخرط في المجازفة الاقتصادية وغيرها، بما في ذلك إمكانية ضياع أموال الآخرين، دون دفع العقوبة لذلك. فمثلًا، كما ذكرت في كتاب “قصور الاستشراق”، أن قيام الشركة بهذا المفهوم في الغرب، والتي أسهمت في العملية الاستعمارية في العالم، والتي تُحدِّد وتُعرِّف وتميِّز العصر الحديث بدماره واستغلاله، هي مبنية على أاس الفصل بين الاقتصاد والأخلاق. فالبديل حتمًا يكون بديلًا أخلاقيًا، وبرأيي لن نستطيع الخروج من الحداثة إلى شئ أفضل منها إلا باستعادة الأخلاق وقوتها في منظومتنا المعيشية، إنْ كانت على النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
س: هل يسير حلاق على خط مَن قرأ التراث الإسلامي بمنهج الأرخنة والعَقْلنة والأنسنة؟ وما رأيه في هذه القراءة؟
د. حلاق: هناك نواحي إيجابية عديدة من القراءات المعاصرة للتراث الإسلامي، بموضوعات الأرخنة والعقلنة والأنسنة، ويمكن استثمارها في تفكيرنا المستقبلي. ولكن بصراحة، فإن التراث الإسلامي برغم ما يدَّعيه الكثير من النُّقاد والقُرَّاء الحداثيين بأنه لم يكن تراثًا مثاليًا، من ناحية بعض الممارسات التطبيقات، حيث كان هناك السلطان الظالم والفاجر وغير ذلك، وهذا موجود في تاريخ جميع الشعوب دون استثناء، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك؛ فليس هناك تاريخ مثالي. وأنا لا أتحدَّث عن مثل هذا التاريخ، ولكن أتحدَّث عن المصادر التراثية التي تؤهِّلنا أن نستنتج منها دروسًا لكي نخرج من هذا المأزق. وبرأيي أن القرآن الكريم أولًا، إذا قُرِأ على الطرقة الصحيحة، وتاريخ الشريعة والتصوف ثانيًا، بجانب الحقول الأخرى الفرعية التي ساندت القرآن والشيرعة والتصوف، كلها مصادر لديها من التراث المعرفي ما يجعلنا أن نكوِّن فكرة وممارسة ما بعد حداثية حقيقية؛ لأن ما نحتاجه اليوم هو إدخال الأخلاق من جديد في حياتنا اليومية. والتراث الإسلامي من أغنى المصادر بذخيرته الأخلاقية ذات الصلة. لذا أقول إن دراسة التاريخ الإسلامي بوجه مستقل عن طريقة الاستشراق السامة هو ضروري جدًا، لكن لا يعني هذا أن ننظر لنموذج الحاكم الظالم، تاركين وراءنا الذخيرة الأخلاقية للإسلام.
س: يمكن توصيف مشروع حلاق بمشروع التحرير. فما هي العلاقة بين مشروعه وبين مشروع فلاسفة التحرير بأمريكا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء؟
د. حلاق: هذه المشروعات جميعًا جديرة بالاهتمام، وهناك تشابه كبيرة فيما بينها، وقد بيَّنت ذلك في كتاب “قصور الاستشراق”، حيث قدَّمت بعض الأفكار التي قامت في أمريكا الجنوبية على سبيل المثال مسانَدةً لمشروعي. ولكن لكل مشروع خصوصياته؛ فمشروع أمريكا الجنوبية، بكل نواحيه وتعدُّداته، ينبع من قاعدة فكرية وحضارية وثقافية تختلف عن القاعدة التي أنطلق منها. فقاعدتي الفكرية الأساسية التي أنطلق منها، أخلاقيًا وثقافيًا، هي قاعدة إسلامية. فتجربتي تنبع من صميم المجتمع العربي الإسلامي. وفي النهاية، نحن شركاء في مشروعات التحرر، لكن شركاء مختلفين.
س: هل الوضع اللغوي في العالم العربي يسمح ببزوغ فكر تجديدي يُسايِر تحديات عصر الصورة بتعبير د. طه عبد الرحمن؟
د. حلاق: بالطبع، تُعد مسألة التأهيل اللغوي جزءًا أصيلًا في المشروع النهضوي الذي يمكن القيام به، والتي تتطلَّب العمل على تأهيل أدوات اللغة العربية لتعزيز التعبير وتحسين الصياغة… إلخ، فاللغة هي الآلة التي تصنع الأفكار، فليس هناك فرق بين اللغة والفكر، فكلاهما ناحيتا النقد، ويجب علينا التفكير في هذا المجال، كل ذلك بالتفكير في مضمون المشروع، ألا وهو الأخلاق وسُبُل استعادتها. فيجب تحديد ما نحتاج في اللغة العربية لكي نصنع هذا الفكر النهضوي، كما فعلت أوروبا نفسها من قبلُ، حين صكَّت مصطلحاتها الخاصة بفكرها الحداثي. وتتبدِّى أهمية اللغة العربية وضرورة صكّ ما تحتاجه في مشروعها من أن هناك قصورًا أو نوع من عدم الاكتشاف للمصطلحات المقابلة لتلك الأجنبية حتى اليوم، على نحوٍ يُبرِز نوعًا من عدم قدرة اللغة على المجاراة، ناهيك عن صياغة مصطلحاتها الخاصة.
س: هل يمكن رسم طريق إبداع واستقلال فعل فلسفي في مجالنا التداولي الإسلامي بمعزل عن الاستعانة بترسانة النماذج والمقولات والمفاهيم المعرفية الغربية؟ هذا الذي تعتبرونه “عبودية معرفة”ّ لم يستطع طه عبد الرحمن نفسه الانفكاك من سلطة المقولات الكانطية!
د. حلاق: بالطبع نستطيع تحرير أنفسنا من ذلك. ولا أتقبل مقولة أنه ما دُمنا جميعًا نعيش في زمن الحداثة، فإنه لا يمكننا الانفكاك من أسْرها أو التفكير خارج أطرها. وكما قلتُ سابقًا، استطاعت أوروبا الخروج من العصور الوسطى والوصول لزمن الحداثة من خلال مكافحة الخطاب الكَنَسي السياسي المهيمِن حينذاك. وهذا بالطبع شيء لا يحدث بين عشيةٍ وضُحاها، وإنما يأخذ من الزمن بقدرٍ كبير حتى يظهر على الأرض.
هذا بجانب عدم التسليم أيضًا بأن الاستمداد من أفكار الآخرين يعني الوقوع في سجن ليس بالإمكان الخروج منه، فالأفكار مهمة ويؤدي بعضها دورًا إيجابيًا في تشييد منظومة فكرية بنَّاءة كتلك التي نسعى إليها، كما أشرنا سلفًا. ويشير البعض على سبيل المثال إلى طه عبد الرحمن حين يستعين ببعض مفاهيم كانط كنموذج، خصوصًا حال تعريفه “مبدأ الرُّشْد”[20]، ولكن إذا أخذنا فسلفة عبد الرحمن إجمالًا، فيمكن وصفها بأنها فلسفة أصيلة، يمكن الاستفادة منها، مع التجربة والتنقيح، في التوصل لبناءٍ معيَّن.
س: لقد ذهبنا مع حلاق في طرْحه لصورة التاريخ الإسلامي كمجتمع حي متوازن متكامل الجوانب، ولكن ما يُفهَم من خلاصة هذا الطرح أننا بحاجة إلى طرح متوازٍ مع الحداثة الغربية يعتمد التجربة الإسلامية كأساس، ويتجنَّب مساوئ الحداثة، فهل من توصيات في سبيل الوصول إلى هذا الطرح؟
د. حلاق: هناك أفكار وأشياء حداثية قيِّمة يمكن الاستفادة منها وتكييفها في بناء مشروعنا الخاص، ولكن أردتُ أن أوضح في هذه المحاضرة أن الكثير من المفاهيم التي تبدو مثيرة وبنَّاءة وإيجابية هي في الأساس أتت من مناطق ليست مُبهِرة، وكان لها – وهذا هو المهم – تأثيرات غير إيجابية على الحياة الإنسانية، وهو ما يتطلَّب الحذَر مما يمكن أن نأخذ منها وما نترك، فما نظن أنه جيد قد يعود علينا بعواقب وخيمة.
س: ما العمل؟ هل هي قطيعة حدِّيَّة كاملة، أم مُتدرِّجة؟ وبماذا نبدأ؟
د. حلاق: لا نستطيع الدعوة إلى أي قطيعة حادَّة أو آنية مع النهج الغربي؛ ويتطلَّب المشروع زمنًا بلا شك لإنجازه، وقد مضت أوروبا للوصول إلى فكرها الحداثي نحو أربعة قرون، بدأت منذ الحروب الصيلبية في القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس عشر أو السادس عشر، فأوروبا بدأت نشاطها الفكري والاقتصادي بعد الحروب الصليبية، وبسببِ هذه الحروب، وهو أمرٌ يجب التشديد عليه وإدراكه. وبالطبع لا نتحدث هنا عن عقد أو قرن واحد، فهذا مشروع طويل، ويتطلَّب بلا شك تكاملًا في الإسهامات والفكر لإنجازه، وهذا يبدأ بالمناقشة والجدل والبحث ثم التغيير التدريجي لمناهج التعليم للأطفال والشباب. فهذا شئ يجب أن نبدأ فيه حالًا، في مكانٍ أو آخر، مع محاولة تحقيق التغير التدريجي العضوي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هذه المحاضرة ألقاها حلاق تحت عنوان “من الانتقاد إلى النقد: من هنا نبدأ”، وذلك في لقاءٍ – افتراضي – استضافه وأداره د. مصطفى المرابط، مدير “مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني”، وهي منشورة على موقع “يوتيوب” بتاريخ 19 أكتوبر 2022.
يمكن الاطلاع على المحاضرة عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/yc48mtp4
** أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة مكجيل، مونتريال، كندا، كما دَرَّس في جامعات: واشنطن، تورنتو (كندا)، سنغافورة وإندونيسيا. وهو شخصية عربية معاصرة، عاشت هموم العالمَيْن العربي والإسلامي، وأصقلته في ذات الوقت خبرة حياتية وأكاديمية طويلة في العالم الغربي بماكينته الحداثية، وذلك منذ التحق بجامعة ماكجيل الكندية في عام 1985، ثم جامعة كولومبيا منذ عام 2009.
*** باحث دكتوراة في العلوم السياسية.
[1] محمد عابد الجابري (1935 – 2010): مفكِّر وفيلسوف مغربي، له أكثر من 30 مؤلفًا في قضايا الفكر المعاصر، أبرزها “نقد العقل العربي” الذي تُرجِم إلى عدة لغات أوروبية وشرقية. وكرّمته اليونسكو لكونه أحد أكبر المتخصصين في تراث ابن رشد.
[2] ابن رشد (520 – 595 هـ): هو أبو الوليد محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن أحمد بن رُشْد الأندلسي المعروف بابن رُشْد الحَفِيد، وُلِد بقرطبة الأندلسية، وأحد أهم فلاسفة الإسلام، وذاع صيته لدى الأوروبيين. من مؤلفاته “مناهج الأدلة”، و”بداية المجتهد ونهاية المقتصد”، و”تهافت التهافت”.
[3] إدوارد سعيد (1935 – 2003): أحد أهم المثقفين الفلسطينيين والعرب في القرن العشرين، كان أستاذًا جامعيًا للنقد الأدبي والأدب المقارن في جامعة كولومبيا الأمريكية، ومن الشخصيات المؤسِّسة لدراسات ما بعد الاستعمارية (ما بعد الكولونيالية)، ومن أهم مؤلفاته “الاستشراق”.
[4] جون مينارد كينز (1883 – 1946): اقتصادي إنجليزي ساهمت أفكاره في إحداثِ تغييرٍ جذري في نظرية وممارسة الاقتصاد الكلي. عُرف كينز بأنّه مُنقذ الفردية الرأسمالية من انتشار البطالة نتيجة إيمانه بأنّ عدم معالجة هذه المُشكلة سيؤدي لتحكم الأنظمة الاستبدادية في العالم الغربي.
[5] فلسفة ما بعد كانط تشير إلى الفترة الفلسفية التي تلت عمل الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط (1724 – 1804م)، وتحديدًا إلى الحركات الفكرية التي تأثرت به وطورت أفكاره أو عارضتها. وتتميز هذه الفترة بتنوع التيارات الفلسفية التي ظهرت، بما في ذلك المثالية الألمانية، والوجودية، والماركسية، والفلسفة القارية الحديثة، والتي شاعت إجمالًا في المناخ الحداثي الغربي.
[6] ماركوس أوريليوس أنطونيوس أوغسطس (121 – 180 م): الإمبراطور الوَرِع أو الإمبراطور الفيلسوف، حكم الإمبراطورية الرومانية منذ عام 161 حتى وفاته، محقِقًا فيها الأمن والأمان، ما جعله أحد أفضلِ خمسةِ أباطرةٍ رومانٍ على الإطلاق. وقد تشرَّب المذهب الرواقي الفلسفي، على يد فيلسوف الحرية “إبكتيتوس”، واستطاع أن يُحقِّقَ نظريةَ أفلاطون التي أكَّدَ فيها أنَّ أمورَ البشرية لن تَنصلِحَ ما لم يَتفلسَفِ الحاكمُ أو يَحكُمِ الفيلسوف. ولم يَتركْ أوريليوس سوى كتابِ “التأمُّلات” الذي عبَّر فيه عن أفكاره.
[7] طه عبد الرحمن (1944 – ): فيلسوف ومفكر مغربي يلقب بـ “فيلسوف الأخلاق” أو “فقيه الفلسفة”. ألف كتبًا عديدة تنوعت موضوعاتها بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، من بينها “روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية”، و”روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية”، و”سؤال الأخلاق”، وغيرها.
[8] يورغن هابرماس (1929 – ): فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر، يعتبر من أهم علماء الاجتماع والسياسة، ومن أهم منظِّري مدرسة فرانكفورت النقدية، وتزيد مؤلفاته عن خمسين مؤلفًا، يتحدَّث فيها عن مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم الاجتماع، وهو صاحب نظرية الفعل التواصلي.
[9] عبد الوهاب المسيري (1938 – 2008): مفكر وأستاذ جامعي وناقد أدبي مصري، عُيِّن مستشارًا ثقافيًا لوفد جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة عام 1975، من أبرز أعماله “الإنسان والحضارة والنماذج المركبة: دراسات نظرية وتطبيقية”، و”موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد”.
[10] إسحق – أو إشعيا – برلِن (1909 – 1997): مُنظِّر اجتماعي سياسي ليبرالي، وفيلسوف روسي – بريطاني، ترأَّس الأكاديمية البريطانية من عام 1974 إلى عام 1978، ونال جائزة القدس عام 1979 لكتاباته عن الحرية الفردية.
[11] بول ميشيل فوكو (1926 – 1984): أحد أبرز الفلاسفة الفرنسيين في النصف الثاني من القرن العشرين، وكان لكتاباته وتصوراته الفلسفية أثرٌ بالغ في المجال الثقافي والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ألَّف العديدَ من الكتب الفلسفية التي أثارت الكثير من النقاشات، من أبرزها: “تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي”، و”تاريخ الجنسانية”، و”أركيولوجيا المعرفة”. ويرى فوكو أن الحرية ليست مجرد غياب للقيود، بل هي ممارسة نشطة، نوع من المقاومة، وتشكيل للذات، فهو يركز فوكو على مفهوم الحرية كفعل وليس كحالة، حيث يرى أن الحرية تتشكل من خلال الممارسات اليومية والمواقف التي يتخذها الأفراد في مواجهة علاقات القوة.
[12] الجماعاتية (Communitarianism): فلسفة تؤكد على الصلة بين الفرد والمجتمع، وتستند فلسفتها الأساسية على الاعتقاد بأن الهوية الاجتماعية للشخص وشخصيته تتشكل إلى حد كبير من خلال العلاقات المجتمعية، مع وضع درجة أقل من التطور على الفردانية (Individualism). وتُفهَم الجماعة عادةً في هذا السياق، بالمعنى الفلسفي الأوسع، على أنها مجموعة من التفاعلات، بين مجتمع من الناس ذي بيئة جغرافية معينة أو مصلحة أو تاريخٍ ما. وغالبًا ما تُقارن الجماعة بالفردية، وتُعارِض عمومًا سياسات عدم التدخل التي تقلل من أولوية استقرار المجتمع ككل.
[13] ألاسدير تشالمرز ماكنتاير (1925 – 2025): أحد أقطاب الفكر الجماعاتي، وهو فيلسوف أسكتلندي أمريكي، ساهم في الفلسفة الأخلاقية والسياسية بالإضافة إلى تاريخ الفلسفة واللاهوت. من أبرز أعماله “بعد الفضيلة”، و”عدالة مَن؟ أيُّ عقلانية؟”.
[14] جورج فيلهلم فريدريش هيجل (1770 – 1831): أحد أهم الفلاسفة الألمان، حيث يعتبر أهم مؤسسي المثالية الألمانية في الفلسفة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. طوَّر المنهج الجدلي الذي قال من خلاله إن سير التاريخ والأفكار يتم بوجود الأطروحة، ثم نقيضها، ثم التوليف بينهما. كان هيجل آخر بناة “المشاريع الفلسفية الكبرى” في العصر الحديث، وكان لفلسفته أثر عميق على معظم الفلسفات المعاصرة.
[15] القديس توما الأكويني (1224 – 1274): أحد أكثر الفلاسفة واللاهوتيين تأثيرًا في التقاليد الغربية؛ وحاول دمج الفلسفة اليونانية، لاسيما أفكار أرسطو، مع مبادئ المسيحية. يرى أن الأخلاق تستند إلى العقل السليم والقانون الطبيعي، وأن الفضائل، سواء كانت أرسطية (مثل الحكمة والشجاعة والاعتدال) أو لاهوتية (مثل الإيمان والرجاء والمحبة)، تقود الإنسان نحو هذه الغاية. من أبرز أعماله “الخلاصة اللاهوتية”.
[16] يشير مصطلح “العقل الأدائي” إلى الجانب العملي والوظيفي للعقل، حيث يُستخدم للتخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام لتحقيق أهداف محددة، وهو مرتبط بـ “العقلانية الأداتية” التي تُعَد في حد ذاتها نهجًا يركز على اختيار الوسائل الأكثر فعالية لتحقيق أهداف معينة؛ فهي تبحث عن الطرق الأنسب للوصول إلى ما نريده، دون النظر بالضرورة إلى قِيَم أو أخلاقيات هذه الوسائل.
[17] ثيودور أدورنو (1903 – 1969): فيلسوف وعالم اجتماع وعالم نفس وموسِيقِي ألماني، كان أحد الأعضاء البارزين في مدرسة فرانكفورت النقدية، واشتُهِر بنظرياته النقدية الاجتماعية وكتبه التي انتقد فيها الفاشية وأثَّر من خلالها بشكلٍ كبير في اليسار الأوربي الجديد، ومن أبرزها “الجدل في عصر التنوير”، و”الجدل السلبي”.
[18] أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (974 – 1058 م): وُلِد في البصرة، كان من وجوه الفقهاء الشافعيين، وجُعِلَت إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة. له تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك، من أبرزها “الحاوي”، و”أدب الدنيا والدين”، و”الأحكام السلطانية”، و”سياسة الملك”.
[19] أبو حامد الغزالي (1058 – 1111 م): حجة الإسلام، كان فقيهًا وفيلسوفًا أصوليًا صوفيًا شافعيًا أشعريًا، عاش في زمن دولة السلاجقة وعاصر الحروب الصليبية، اتسم بالذكاء وسعة الأفق وقوة الحجة وإعمال العقل وشدة التبصر، من أبرز مؤلفاته “إحياء علوم الدين”، و”تهافت الفلاسفة”، و”منهاج العابدين”، و”التبر المسبوك في نصيحة الملوك”.
[20] مبدأ الرشد، في الحداثة الإسلامية البديلة للحداثة الغربية، لدى عبد الرحمن، يعني “أن الأصل في الحداثة هو الانتقال من حال القصور إلى الرشد”، فالقصور هو التبعية الفكرية والسلوكية للغير، أما الرشد فهو الاستقلال والإبداع؛ لتحقيق الحداثة الإسلامية الخاصة. ومبدأ الرشد هذا أحد ثلاثة مبادئ لهذه الحداثة البديلة، بجانب مبدأَي “النقد”، و”الشمول”. وربما يتشابه مبدأ الرشد لدى عبد الرحمن مع ذلك الخاص بكانط، كما يشير حلاق أعلاه، من زاوية أن المبدأ الكانطي يعني الاعتماد على العقل في تحديد الأفعال الأخلاقية، ما يجعل العقل دليلًا على الرشد الذي يمكن الاعتماد عليه كذلك لتحقيق حداثة إسلامية مستقلة وإبداعية.
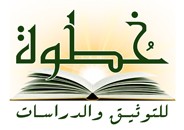 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies