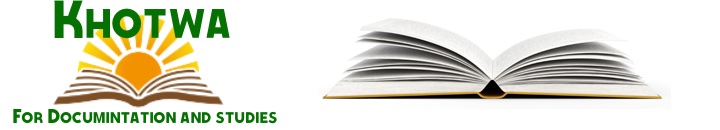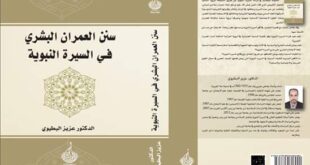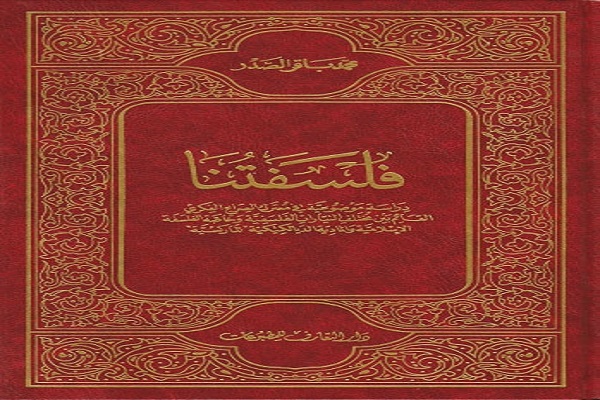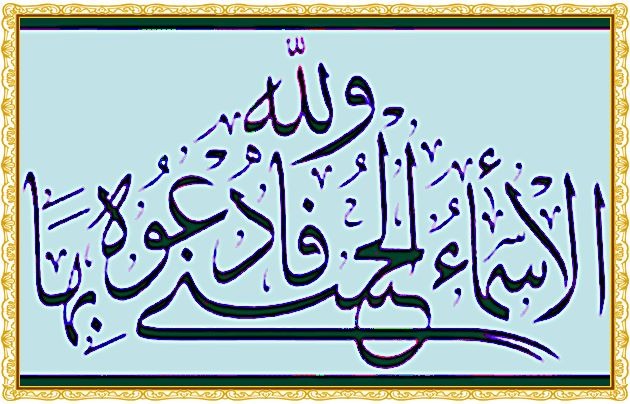إشكالية التراث بين طه عبد الرحمن والجابري*
أ. د. وائل حلاق**
منذ بداية ما يُطلق عليه النهضة في منتصف القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر، كان لابن رشد – الفيلسوف الأندلسي المبرّز- حضور من حين لآخر بوصفه نموذج العقلانية في الإسلام، وذلك مع كونه أحد الشخصيات المتميزة في تاريخ الإسلام، وربما زاد بعضهم عنه تميزًا. هيمن ابن رشد بتلك الصفة على كتابات فرح أنطون في القرن التاسع العشر، وحديثًا محمد أركون ومحمد عابد الجابري خاصةً. إن عودة ابن رشد بتلك القوة – مع تهميش كل منتجات النطاقات المركزية ومفكريها الأعلام بسبب ذلك (كما تثبت كتابات الجابري) – لهي خير دليل على قوة التراث بوصفه من بقايا تلك النطاقات، وإن كان من البقايا التي تجسدت في بعض عناصر التراث الحي[1]. إن القول بأن إحياء ابن رشد (وكذلك ابن خلدون)[2] كان بمثابة حيلة تهدف إلى تقويض التراث من داخله (أو بالأحرى، حيلة لتقويض التراث النموذجي من خلال التركيز على الشخصيات والأفكار التي كانت على هامشه) هو مجرد تأكيد على ما هو واضح. إن هذا النوع من الإحياء كان دائمًا أسلوبًا فكريًا بقدر ما كان فقهيًّا؛ فحتى في زمن رشيد رضا (ت. ١٩٣٥) – على سبيل المثال – استُخدمت الحيلة نفسها لإحداث الأثر ذاته في مجال «القانون». ففكرة الضرورة مثلًا – التي كانت ضئيلة القدر ومهمشة فقهيًا – وُظِفت لقلب المنظومة القانونية الإسلامية بالكامل رأسًا على عقب[3].
ليست المشكلة إذن ظاهرةً حديثةً بأي قدر؛ إذ إنها قد بدأت مع ما أطلق عليه ستيفان شيهي Stephan Sheehi الكتابات «التأسيسية»[4] لبطرس البستاني، مصلح القرن التاسع عشر المشهور الذي حاول تشخيص «عوامل الفشل العربي» من دون فهم حقيقي لها. فبالنسبة إلى البستاني، كما هو شأن أغلب المفكرين العرب المعاصرين له، «كانت الثقافة العربية المعاصرة في حالة انحطاط وجمود بحلول القرن التاسع عشر». وقد كان الحل الذي قدمه البستاني هو: «إذا أحيا الفرد رغبته في العلوم والمعرفة، فيصرف كل طاقته في السعي لكسب العلم الحديث»[5]. لم يتفرد البستاني بالفشل في فهم ما كان يدعو إليه فعليًا، أي فهم أن العلم الحديث ليس مشروعًا محايدًا، كما أنه ليس بديلًا سهلًا للمعرفة الإسلامية أو العربية. فكما هو حال أنطون وأركون والجابري، لم يقدّر البستاني – في ظني – عدم جدوى الرشدية في تناول ذلك التحدي، إلا إذا كان إحياء ابن رشد حيلة رخيصة مقصودة (وهو ما أشك في صحته)[6]. كما لم يفهم من ساروا على ضرب البستاني أو الجابري أو أركون نوعية المشكلة التي يتعاملون معها، مهما كانت ادعاءاتهم في نقد الاستشراق وبعض صور العلم الغربي الأخرى. وأحسب أن الاستثناءات لم تشمل إلا طه عبد الرحمن وعبد الوهاب المسيري وربما ناصيف نصار[7]. إن الدال في هذا النقص في الفهم والوعي لا يرتبط بالإمكانات الفكرية أو العبقرية والإبداع، بل يرتبط تمامًا بالقوة المنتجة للتشكلات الخطابية الأوروبية.
وفيما عدا تلك الاستثناءات (أي عبد الرحمن والمسيري)، لم يختلف كثيرًا مسار الفكر العربي فيما يخص إشكالية التراث من فرح أنطون إلى الجابري الذي يعتبره كثيرون أعظم مفكري ذلك المسار اليوم. إن الفرق بين هذين المفكرين لا يكمن في آرائهما بقدر ما يكمن في التعقيد الذي اتسم به الجابري وتمكنه المدهش من كامل نطاق التراث، كما تبرهن على ذلك أعماله. بيد أن التعقيد لا يكفي شرطًا أو مقياسًا للإبداع النوعي أو البصيرة الألمعية والاستقلال الفكري. يظل مشروع الجابري حبيس مغامرة تهدف إلى تمييز العقل – الذي هو تصور حديث وأداتي للعقلانية المتمركزة حول أوروبا – وتفضيله على كل العناصر والأبعاد المعرفية للتراث الفكري. يصبح استعراض مشروع الجابري أساسيًّا هنا إذن ليس فقط لفهم ردود فعل عبد الرحمن – الذي كانت أعمال الجابري هدفه الأساسي، على الأقل في بداية أمره – بل أيضًا لفهم الورطة التي أنتجها الفهم السائد للتراث.
*******
بينما كانت تلك الورطة هي نقطة انطلاق عبد الرحمن، يمكننا القول بأن الجابري قد أتم السردية التي لا تتجاوز مفهوم الأداتية والعقلانية السيادية الحديثة وصادَر على مستقبلها، وذلك على الرغم من الهجوم المتواصل على ذلك المفهوم في الدوائر الفكرية الغربية منذ نيتشه. ففي كتابه الأشهر “نقد العقل العربي” – لا سيما في جزئه الثاني المعنون بنية العقل العربي – يحدد الجابري ثلاثة من عناصر الفكر العربي التاريخي، وهي فكرة قومية وليست تاريخية تعرَّض الجابري بسببها لقدرٍ كبير من النقد[8].
يرى الجابري أن «الفكر العربي» يتكون من البيان[9]، والعرفان[10]، والبرهان[11]. وقد مرَّ هذا الفكر بأزمةٍ في القرن الحادي عشر بسبب اختلاط نظم المعرفة هذه وتفاعلها[12]. وقد أدى هذا التفاعل في النهاية إلى التضحية بالبرهان – وهو العنصر المعرفي الذي يفضّله الجابري ويتحيّز له – لصالح الأسطورة والسحر والغنوصية اللاعقلانية والبيان التأويلي الفاسد والمضطرب[13]. ولم يتمكن البيان – المرتبط بنيويًا باللغة – من تحرير نفسه من قيود النصوص المقدسة ما تسبب في فشله في تأسيس عقلانية مستقلة عن اللغة[14]. ومن خلال التأكيد على استقلالية العقل وانفصاله الموضوعي والشكلي عن البنى اللغوية، تجاهل الجابري المضامين الأخلاقية للسيادة المعرفية إذا ما قورنت بما أطلقت عليه «المعيار الأخلاقي الإسلامي»، الذي هو سمة مميزة للتراث الفكري والقانوني والثقافي[15].
وليس العرفان أفضل حالًا. ففيما يزيد على مئة وخمسين صفحة خصصها الجابري لكتابات شيوخ الصوفية، فإنه يطرح التراث الصوفي بكامله بوصفه دخيلًا على الإسلام، أي ظاهرة سابقة على الإسلام أعادت إنتاج نفسها فيه. «فالمصطلح العرفاني في الإسلام ليس إسلامي المضمون ولا عربي الأصل»[16]. ونظرًا لكون العرفان لاعقلانيًا ومعاديًا للتجريب، فإنه يقوم بالكامل – في رأي الجابري – على «تجنيد الإرادة وليس على شحذ الفكر، بل يمكن القول إنه يقوم على جعل الإرادة بديلًا عن العقل»[17]. إن العارف «ينطلق من القلق والشعور بالخيبة إزاء الواقع الذي يجد نفسه ملقى فيه… فلا يلقى إلا ما ينغص ويخدر [العيش]»[18]. إنه من المدهش حقًا أن يستطيع شخص في تمكن الجابري العلمي وصف العارف بأنه محاصر ومستعبد وغير قادر على رؤية العالم إلا على أنه «شر كله»، وتصبح مشكلته الأساسية، بل الوحيدة هي مشكلة الشر في العالم[19].
أحسب أن ما ذكرناه هنا يكفي للبرهنة على أسس مشروع الجابري الكانطية، بل والأسس التي جعلت من الإرادة العقلانية الحرة وتصور الحرية السلبية المشتق منها قدس أقداس الفرد الحديث. إننا نخطئ فهم هجوم الجابري على العرفان إذا قصرناه على مشروعه المعلن الهادف إلى الكشف عن «أشكال العقل الحقيقية» في باطن التراث. كما أن هجوم الجابري لا يقتصر على مشروع معرفي كما يصوّر هو برنامجه[20]. بل على خلاف هذا، فإن هجومه على العارف وعقليته «المستعبدة والمحاصرة» يُعد بمثابة هجوم على ما أسميه مفهوم الحرية الفردانية الإيجابية، التي هي إحدى السمات المميزة للثقافة الإسلامية[21]. فبينما كان كابوس إزايا برلين هو التصور السوفيتي (والدولاتي بهذا المعنى) الأيديولوجي للحرية الإيجابية[22]، فإن عدو الجابري اللدود كان الممارسة الصوفية لتلك الحرية، والتي كانت في يوم ما نمطًا متكاملًا للحياة[23]. يهدف هجوم الجابري على العرفان بكل تأكيد إلى نزع الشرعية عنه، غير أنه يبرهن أيضًا على قبول الجابري للأنماط الليبرالية من الحرية السلبية من دون تمحيص. وهنا تحديدًا – أي في نقطة المواجهة بين مفاهيم الحرية الإيجابية والسلبية – يظهر تميز فلسفة طه عبد الرحمن الجذري عن فلسفة مواطنه الجابري؛ فلو أننا قبلنا بأنه في تكوين الذاتية تقع التصورات الإيجابية والسلبية في مركز المنظومات الفلسفية وتحددها بذلك، نستطيع أن نقول إنه هنا – تحديدًا، يقع الفرق الجوهري والحاسم بين الجابري وعبد الرحمن.
وفضلًا عن كل ذلك، لا يتطرق الجابري مطلقًا لتداعيات النقد الذاتي الغربي بالنسبة إلى مشروعه. إن مستودع النقد الأوروبي (لا سيما الفرنسي) الذي يستدعيه عبد الرحمن ويوظفه، يُعَدُّ ثغرةً خطيرة في عمل الجابري يمكن لها أن تبطل مشروعه بالكامل، لا سيما وقد توفّر له ذلك المستودع. لا يشير الجابري – إلا قليلًا – إلى النقد القوي الذي قدمته المدارس الفرنسية الاجتماعية والأنثروبولوجية، فضلًا عن مساهمات مدرسة فرانكفورت في هذا النقد. يظل الجابري – الذي هو نسخة أكثر عمقًا من فرح أنطون وأحمد أمين معًا ـ- أسير الحداثة إلى حد بعيد. بيد أنه كان لفرح أنطون وأحمد أمين – اللذين كتبا قبل عقود سبقت الجابري – بعض العذر في الوقوع في فخ أسر الحداثة.
يمكننا نقد سرديات الجابري التاريخية وبنية حجاجه على أسس مختلفة. وفي الواقع، فإن أغلب تلك السرديات وكثيرًا من حججه العامة لا يمكنها أن تصمد أمام أي تمحيص. إن كتابات الجابري تعبر عن جوهر مشكلات التصورات العربية/ الإسلامية والغربية للحداثة التي يخضعها عبد الرحمن للتمحيص. ولكي نحسن فهم مشروع عبد الرحمن، يجب أن نبدأ أولًا بمعالجة تلك المشكلات كما يعرضها كتاب الجابري الموسوعي والمفتقد للانسجام في الوقت ذاته، أي كتاب “العقل الأخلاقي العربي”[24].
إن إحدى الأفكار المركزية في هذا الكتاب هي أن «تاريخ الفكر الأخلاقي في الثقافة العربية… لم يُكتب بعد»[25]. يُعَدُّ هذا التصريح مدهشًا، لا سيما إذا وضعنا في اعتبارنا أن الجابري كان قد نشر بالفعل عمله الموسوعي المزدوج “نقد العقل العربي”. وفي كتاب “العقل الأخلاقي العربي”، يكرر الجابري ما قاله في مؤلفات أخرى، أي «إن الثقافة العربية» عانت من «أزمة قيم» منذ «الفتنة الكبرى» بين عامي ٦٥٦ – ٦٦١ (٣٥- ٤٠ هـ)، وهي الأزمة التي فسحت المجال لتسرب قيم «خارجية»… للاستعانة بها في الصراع الذي أفرز أزمة القيم تلك»[26]. ويؤكد الجابري أنه على الرغم من أن هذه الأزمة وقعت في القرن السابع (الأول الهجري)، فإنها بقيت «حية عبر العصور»[27]. كما يفترض الجابري أنه بسبب تلك الأزمة، «أصبحت القيم الدينية نفسها، بل الدين نفسه موضوعًا للسياسة»[28]. هنا، لم تحدد تلك «الأزمة» وذلك «الصراع» أسس «الفكر العربي»[29] فحسب – ما حولهما إلى جواهر عابرة للمكان والزمان – بل تفسّر أيضًا حاجة ذلك الفكر إلى «الاستعانة» بالقيم الخارجية في المقام الأول.
يُعد التأثير الفارسي أحد تلك العناصر الأجنبية التي حددها الجابري. ففي عشرات الصفحات، يقدم الجابري نقدًا قاسيًا لذلك «التأثير» بصورة تعكس هاجسًا سياسيًا، وليس أخلاقيًا. في الواقع، قد ينسى المرء وهو يقرأ كتاب “العقل الأخلاقي العربي” أنه يقرأ ما يُفترض أنه كتاب عن الأخلاق. فإدانة الجابري لذلك التأثير – على سبيل المثال – لها صبغة تعصب قومي (chauvinism)؛ إذ يعرض الفكر الفارسي على أنه «سلبي»؛ لأنه يُعد مصدر السلطوية والاستبداد والطغيان في «الفكر العربي»[30]، ولأنه أوحى للمسلمين بفكرة «وحدة الدين والدولة وطاعة الله والخليفة»[31]. وقد أدى هذا بدوره إلى إنكار حرية الإرادة، ما مكَّن «القيم الكسروية» من «غزو المدينة الفاضلة»، وهي إشارة صريحة إلى نظرية الفارابي المعروفة[32].
لقد رأينا في “بنية العقل العربي” أن الجابري يدافع عن العقلانية اليونانية، وفي نسختها الأرسطية خاصة. وفي أغلب أجزاء “العقل الأخلاقي العربي”، يسعى الجابري إلى الهدف نفسه؛ إذ يدفع بأنه بينما أسس اليونانيون فلسفتهم الأخلاقية على العقل، فإن «العرب» في «الإسلام» لم يتمكنوا من حسم قضية الأسس التي ينبغي عليهم تأسيس فلسفتهم الأخلاقية عليها[33]. ويرجع سبب التذبذب هذا – في رأيه – إلى غياب ما يمكن أن يمثل «قوة متحركة دينامية» في الفكر العربي. ويرجع هذا الأمر – في جزء معتبر منه – إلى الموروث الصوفي[34]، وهي فكرة يناقشها الجابري بالتفصيل في “بنية العقل العربي”. ووفقًا للجابري، فإن الصوفية يؤسسون فلسفتهم الأخلاقية على العرفان، وليس على التحليل العقلاني والمنطقي. فتقنيات النفس الخاصة بهم وما يمكن أن نطلق عليه الأخلاق العملية (أو «آداب السلوك» في لغة المتصوفة، التي تتضمن تأسيس نمط حياة) لا تمثل في نظر الجابري نظرية أخلاقية أو تبريرًا عقلانيًا ذا قيمة خطابية. ما يهم الجابري هنا هو – بكل وضوح – نظرية أخلاق، أو خطاب نظري مفصل عنها، وليس الأخلاق من حيث هي ممارسة ثقافية أو تقنية اجتماعية وتطبيقية خاصة بالفرد والمجتمع. وفي نظر عبد الرحمن، لا يُعَدُّ تفضيل الجابري لشكل من أشكال اللوجوس على العرفان أو العمل الأخلاقي مجرد انزعاج فكري، بل يراه مؤشرًا وامتدادًا لهيمنة الغرب الخطابية التي تُعادي أشكال العقلانية القوية التي تؤسس نفسها في نظام قيم أخلاقي (أو ما يطلق عليه عبد الرحمن» العقلانية المؤيدة»). ويفسر لنا هذا إصرار عبد الرحمن في كل أعماله على التمييز بين ما يطلق عليه «ثقافة الكلام» و«ثقافة العمل»***.
وفي مرحلة متقدمة من الكتاب، يقدّم الجابري سببًا آخر لتأخر «الأخلاق العربية»، وهو مفهوم المروءة الذي يرجع إلى عصر ما قبل الإسلام والعصر الإسلامي الباكر. والمروءة مفهوم مركب يشمل الكرم والفطنة والنجدة والقدوة والفضيلة، وما إلى ذلك. ويرى الجابري هذا المفهوم غير أخلاقي فعليًا؛ إذ إنه مع مظهره الأخلاقي، كان وسيلة للترقي الاجتماعي[35].
إن تهميش كل الفلسفات الأخلاقية باستثناء فلسفة اليونان يمثل – إذن – جوهر مشروع الجابري ولُحمته. فوفقًا للجابري، يُعدُّ علم الأخلاق اليونانية «يونانيًا في صياغته، ولكنه إنساني في مضمونه». وهكذا، يتساءل الجابري: (كيف نجعل علم الأخلاق – المتداول والمنحدر من اليونان ـ علمًا إسلاميًا ؟)[36].
حين طرح الجابري هذا السؤال المحوري في كتابه “العقل الأخلاقي العربي”، كان قد كتب بالفعل ٥٧٠ صفحة (من ٦٣٠ صفحة يشملها الكتاب) لدحض كل الفلسفات الأخلاقية (باستثناء اليونانية) بوصفها غير جديرة بالاعتبار. شمل ذلك استبعاد فلسفة أبي حامد الغزالي والخطاب الفقهي، تمامًا كما فعل مع الموروث الفارسي والصوفي والعربي[37]. فقد عدَّ الجابري الخطاب الفقهي شكليًّا فقط [38]، كما اعتبر كتابات الغزالي مخدّرًا، بل «أشد العناصر تخديرًا في نظام القيم في الثقافة العربية»[39]. نتوقع – إذن – أن نجد سائر الكتاب مخصصًا لشرح الجابري سُبل أسلمة الفلسفة الأخلاقية اليونانية. بيد أنه على خلاف ذلك نرى الجابري غارقًا في مناقشة مطولة عن القرآن من حيث هو أصدق تجليات الأخلاق، ذلك أنه يهتم أساسًا بـ«العمل الصالح»[40] و«المصلحة». فالقرآن – مع الحديث النبوي – قرر «كثيرًا من القيم التي كانت على الدوام … دليل المسلم في الحياة»[41]، فـ «الأخلاق الإسلامية ليست شيئًا إذا لم تقم على «العمل الصالح»[42]. وهنا، نرى بوضوح قوة ما أطلقت عليه «الارتداد الأخلاقي»، وهو الأمر الذي أوقع الجابري في مجموعةٍ من المفارقات والتناقضات. ما أقصده هنا هو أن كتاب الجابري يُعَدُّ نموذجًا معبّرًا عن أكثر الفكر العربي/الإسلامي منذ نهايات القرن التاسع عشر تحديدًا بسبب عدم التمييز – المهيمن في عصر الحداثة – بين «ما هو كائن» و«ما ينبغي أن يكون»[43].
ثم يفاجئ الجابري القارئ مرةً أخرى حين يصرح بـ«اكتشافه» أخيرًا عالِمًا يمكن أن تُعَدَّ أفكاره معبرةً عن «الأخلاق الإسلامية» الحقيقية[44]. (ولا يقل عجبًا هنا – في صفحة ٥٩٣ وما بعدها من كتاب الجابري – استخدام الجابري فجأةً ودون تبرير لـ«الأخلاق الإسلامية» والفكر الإسلامي بدلًا من «الأخلاق العربية» والفكر العربي»). وليس ذلك العالِم المكتشَف إلا الفقيه المبرز العز بن عبد السلام (۱۱۸۱ – ١٢٦٢)، الذي يعده الجابري – كما يعد الشاطبي – «مغربي الأصل» مع مولده في دمشق[45]. ولا يدهشنا إعجاب الجابري بنموذج الـعـز بـن عبد السلام بمعارضته القوية للمماليك، أو حتى سيطرته عليهم. فمن خلال التصدي لسلاطين المماليك، أظهر ابن عبد السلام مقاومة مدهشة لـ«الاستبداد الشرقي»، وهو مفهوم نراه مضمرًا في كتاب الجابري بكامله. بيد أن السبب الحقيقي لاعتبار هذا الفقيه مثلًا أسمى للخطاب الأخلاقي، هو أن سيرته أعلت من قيمة العمل الصالح والصالح العام، وهي مبادئ قرآنية في المقام الأول. لا يتساءل الجابري هنا عن سبب عدم اعتداده بالقرآن نفسه – بكل ما أنتجه المسلمون عنه من تراث تأويلي – بوصفه نظرية أخلاقية في حد ذاته كما هو حال الفقه. بعبارة أخرى، لماذا نصل إلى القرآن من خلال العز بن عبد السلام؟ كما لا يسأل الجابري نفسه عما يميز ابن عبد السلام عن غيره من كثير من علماء المسلمين قبله وبعده، وقد كانت لهم إسهاماتهم في القانون والأخلاق وأمور أخرى كثيرة بصورة ضارعت إسهامات ابن عبد السلام أو تفوقت عليها. فبدلًا من هذه الأسئلة، نجد تناقضًا صارخًا في قول الجابري إن «فرادة سلطان العلماء العز بن عبد السلام وأصالته قائمة وبوضوح في أنه أحدث قطيعة نهائية وجذرية مع هذه البنية اليونانية، وأخذ كبديل لها بنية إسلامية»[46].
إن لُبَّ قضية الجابري فيما يخص التراث هي أنه في الإسلام أو الفكر العربي، لم تكن «الآداب الشرعية» «تعتبر علمًا قائمًا بذاته حتى وإن خُصَّت بتأليف مستقل. لقد كانت تابعة باستمرار للفقه»[47]. وإذا أخذنا هذا التأكيد على محمل الجد، فإن سيرة ابن عبد السلام – بما هي مشروع أخلاقي – لا تفي بشروط الجابري؛ فلقد كان ابن عبد السلام فقيهًا، وعاش فقيهًا، وألف في إطار تراث فقهي طويل وراسخ، بكل ما يعنيه ذلك من إنتاج تأويلي وارتباط بالتصوف وغيره من أمور أخرى كثيرة. نعود هنا – إذن – إلى المربع الأول لنتساءل: لو أن كل الخطابات الفقهية والصوفية – وقد تأثرت جميعها بمصادر يونانية وإيرانية وغيرها كثير – كانت محلًا لنظرية أخلاقية ولخطاب وممارسة أخلاقيين (أي نمط حياة فعلي)، فلماذا يؤشْكل الجابري القضية في المقام الأول؟
أحسب أنه لا مفر من افتراض تكوين الجابري تصورًا أوضح للقضايا التي يتضمنها كتابه فقط بعد إكماله معظم أجزاء ذلك الكتاب. من هنا نفهم استفاضة الجابري غير الضرورية في مناقشة الأخلاق اليونانية والتناقضات التي تضمنها الفكر العربي عنها. أظن أن الجابري أدرك متأخرًا أن «النظرية الأخلاقية في التراث الإسلامي متجذرة بالكامل في كامل نطاق الخطابات «المعرفية»، بما في ذلك الكلام والفلسفة والفقه وأصول الفقه والأدب وغيرها كثير. هذا هو ما خفي على الجابري في كتابه “نقد العقل العربي”، وهو الأمر الذي أدركه فقط في نهايات كتابه “العقل الأخلاقي العربي”. إن هذا الاكتشاف هو الذي دفع الجابري لتسمية مشروعه في هذا الكتاب الأخير «مغامرة»، وهو أمر يعترف به صوب نهاية الكتاب وفي المقدمة (التي كانت – على الأرجح – آخر ما ألف في الكتاب)[48].
إن خطأ نظرة الجابري – بكل ما له من وزن فكري – ليس أقل من مؤشر حاسم على التوتر الذي يشهده الفكر الإسلامي الحديث بين قوة التراث الأخلاقية (كما يمثلها القرآن والسنة وابن عبد السلام ومصادر أخرى لا تُحصى) وما يسميه عبد الرحمن العقلانية المجرَّدة لدى الغرب (الذي تمثله العقلانية اليونانية في أعمال الجابري كما يبدو).
لقد زعم أن الفكر العربي الحديث «يشكل فردًا يخضع دائمًا لمعلم ينفيه»، وأن ذلك يُعَدُّ بمثابة تشكيل الذات «بوصفها آخر، حيث تتوسط الذات الأوروبية في العلاقة بين العلم والذات العربية». إن هذا التوسط الزائد للذات الأوروبية هو فقط الذي يمنح المعرفة، ويمنح بالتالي للفرد العربي الحديث السيادة والحضور[49]. ومع صحة هذا الأمر، إلا أنه يمثل وجهًا واحدًا فقط من وجهي العملة. فوجه العملة الآخر يتناقض إلى حد بعيد مع هذه النظرة. فكما رأينا في كتاب “العقل الأخلاقي العربي”، فإنه توجد ذاتان هنا: ذات علمانية أوروبية، وأخرى أخلاقية إسلامية نشأت بنيتها الفكرية في ذات أخرى أعمق غير علمانية ولا متمركزة حول الإنسان. ترفض هذه الذات بوعي أشكال الحرية السلبية، وتعتنق أشكالها الإيجابية النشطة والقوية وغير المرتبطة بالدولة[50]. وبما أن أعمال الجابري تمثل ذروة تيار فكري بدأ ببطرس البستاني وجرجي زيدان واستمر مع أحمد أمين وحسن حنفي وغيرهم كثيرين، يتوجب علينا النظر لها ليس بوصفها من إنتاج مفكر فرد، وإنما من حيث كونها بصمةً فكريةً أو بنية فكر تُسفر عن شكل ناضح من تلك الثنائية. إن كتاب الجابري “العقل الأخلاقي العربي” لهو – ربما – أصدق وأقوى تعبير عن تلك المتقابلة الثنائية، وهي المتقابلة التي يرفضها عبد الرحمن مطلقًا لصالح تبني ذات أخلاقية إسلامية بشكل حصري. وحتى إذا لم يتفرد عبد الرحمن بهذه النظرة، فإن تعبيره عنها في شكل نظام فلسفي قوي هو – بالتأكيد – شيء فريد.
إن تلك المتقابلة الثنائية هي ما توفّر لمشروع عبد الرحمن شروط وجوده. يظهر عبد الرحمن في مرحلة من الحداثة المتأخرة شهد فيها المشروع الحداثي تشققات وتصدعات كثيرة، ما مكَّن الأخلاقي من العودة القوية مرةً أخرى غصبًا عن ذلك المشروع. ولو أن هيمنة الليبرالية والعلمانية الأوروبية قد طمست القيم الإسلامية ولطختها بين عامي ١٨٥٠ و ١٩٥٠، ولو كان الإسلام السياسي ردَّ فعل ضالًا لمشكلات الكولونيالية والهيمنة، فإن مشروع عبد الرحمن هو التوليفة التي جاءت لترفض القضية (أي الكولونيالية) ونقيضها (أي الإسلام السياسي). فمشروع عبد الرحمن – في نهاية المطاف – هو مشروع حديث زمنيًا يسعى لإنعاش زمان أخلاقي إسلامي وتعزيزه فيما يمكننا وصفه بنقد بعد- حداثي، أي فلسفة أخلاقية من الطراز الأول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* منقول بتصرف من:
وائل حلاق (2020). إصلاح الحداثة: الأخلاق والإنسان الجديد في فلسفة طه عبد الرحمن/ ترجمة عمرو عثمان. ط. 1. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر. ص ص. 35- 50.
** أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة مكجيل، مونتريال، كندا، كما دَرَّس في جامعات: واشنطن، تورنتو (كندا)، سنغافورة وإندونيسيا.
[1] إن إحدى الأطروحات الأساسية والمتكررة في كتابي الدولة المستحيلة، هي أنه بينما عانى عالم الإسلام من دمار مؤسسي ممنهج خلال القرن التاسع عشر وما بعده، فإن ذكرى وممارسة كثير من تقنيات النفس الشرعية – الصوفية ظلت مستمرة إلى الوقت الحاضر.
[2] انظر النقد الثاقب لعلي أومليل:
Ali Oumlil, L’histoire et son discours: Essai sur la méthodologie d’Ibn Khaldoun (Rabat: Éditions techniques nord-africaines, 1979).
إن قيمة هذا النقد تظل – مع ذلك – تحت وطأة الزعم بأنه مع ضرورة البحث في المعرفة الفهم بوصفه عملًا محايدًا! انظر أيضًا المقالة المفيدة لـ: التاريخية، إلا أنها يجب أن تظل محايدة أيديولوجيًا، ما يعني أن اكتساب المعرفة يجب أن يقتصر على الفهم بوصفه عملا محايدأ. انظر أيضا مقالة المفيدة لـ:
Abdelmajid Hannoum, “Translation and the Colonial Imaginary: Ibn Khaldun Orientalist,” His- tory and Theory, vol. 42 (February 2003), pp. 61-81.
[3] Wael Hallaq, A History of Islamic Legal Theories (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1997), pp. 214 – 220.
[4] Sheehi, Foundations of Modern Arab Identity, pp. 23 – 25.
[5] المصدر نفسه، ص ٢٥. ومن الجدير بالملاحظة هنا هو أنه بالنسبة إلى البستاني، بدأ العرب في التقهقر في القرن الرابع عشر، أي حين ظنوا أن تحصيل المعرفة والعلوم كان عملًا لا فائدة ترجى منه» (ص ۲۳). [الاقتباسات من ترجمة المترجم لعدم الوصول إلى الأصل العربي لها ] (المترجم).
[6] ويُعدُّ اهتمام الجابري العميق بالقرآن – لا سيما في مرحلة حياته المتأخرة ـ سببًا لدفع ذلك الشك. انظر: محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكريم: في التعريف بالقرآن (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (۲۰۱۰)، وفهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ٣ مجلدات (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية، (۲۰۱۰).
[7] انظر بصفة خاصة: عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان (دمشق: دار الفكر، (۲۰۰۲)؛ وعبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة (دمشق: دار الفكر، (۲۰۰۳)؛ وناصيف نصار، طريق الاستقلال الفلسفي: سبيل الفكر العربي إلى الحرية (بيروت: دار الطليعة، (۱۹۷۵)، وغيضان السيد علي الاستقلال الفلسفي ومقدمات التغريب عند ناصيف نصار»، مؤمنون بلا حدود ۱۸ آذار / مارس ٢٠١٦، ص ١ – ١٩، <https://bit.ly/2zksdtB>.
انظر أيضًا نقد نصار لكتاب: طه عبد الرحمن الحق العربي في الاختلاف الفلسفي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، (۲۰۰۶)؛ وناصيف نصار التواصل الفلسفي والمجال التداولي»، المستقبل العربي، السنة ،۳۰، العدد ٣٤٧ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٨)، ص ٨ – ٣٥.
[8] لا يُعد «العقل العربي» بالنسبة إلى الجابري «شعارًا أيديولوجيًا»، وإنما هو «جملة المفاهيم والفعاليات الذهنية التي تحكم – بهذه الدرجة أو تلك من القوة والصرامة – رؤية الإنسان العربي إلى الأشياء وطريقة تعامله معها في مجال اكتساب المعرفة، مجال إنتاجها وإعادة إنتاجها». كما أن هذا العقل» قد ترسخ في عصر التدوين» في القرن الثامن الميلادي وفقًا لما هو مفترض. انظر: محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي (بيروت: المركز الثقافي العربي، ۱۹۸۷)، ص ۷۰ – ۷۱. ثمة مشكلتان على الأقل في هذا التصور: المشكلة الأولى هي عدم وضوح سبب كون «العرب» تحديدًا (وليس «الفرس» أو «الترك») هم الذين عانوا من تلك الأزمة» كما يطلق عليها). فهل كان هناك مفهوم لـ «العربي» في القرن الثامن وحتى القرن الثامن عشر؟ أما المشكلة الثانية فهي الأهم؛ فلكي يدعم الجابري هذا التصور، وجب أن يفترض وجود تكوين وبنية ثابتين للعقل العربي» خلال ما يزيد على ألف عام، وهو مفهوم مضحك يزيد في عدم معقوليته عن فكرة نموذج الانهيار» الأيديولوجي.
[9] لا يوجد نظير مطابق للفظة «البيان» العربية في اللغات الأوروبية، وهي لفظة تمثل مستودعًا خطابيًا ثريًا تطور عبر قرون عديدة في محيط الإسلام الفكري. وتمثل فكرة أن «البيان» هو اللغة التي تصبح الأشياء من خلالها مفهومة وواضحة فتشمل بذلك ما يطلق عليه «علم الدلالة» (semiotics)) ركنًا أساسيًا من أركانها. فالقرآن هو كتاب بيان؛ لأنه يحوي العلم كله، أو تفصيل كل شيء»، وهو التفصيل الذي يُعَدُّ دائمًا فصيحًا ومنطقيًا في الوقت ذاته. فعندما يقول الله إنه علم الإنسان «البيان»، فهو يعني أنه خلق كائنًا انفصل عن مملكة الحيوان من خلال قدرته على التعبير عن العالم من خلال النطق، وهو ما يشير إلى كون العقلانية والمنطق جزءًا أساسيًا من اللغة ذلك أن «النطق» و«المنطق» مشتقان من الجذر اللغوي نفسه. فكون الإنسان حيوانًا ناطقًا لا يعني فقط أنه «حيوان متكلم»، بل يعنى أنه حيوان عاقل». وفي غياب بديل أفضل، أستخدم هنا لفظة الهرمنيوطيقا (hermeneutics)، أي ذلك العلم الذي يقوم على شرح الظواهر النصية والبنى اللغوية والدلائل اللفظية وتأويلها وجعلها مفهومة. ويستخدم الجابري «البيان» للإشارة إلى الاجتهادات الفقهية داخل التراث الإسلامي، وهي الاجتهادات التي هيمنت على الشريعة بوصفها نطاقًا مركزيًا. ولدلالات «البيان» اللغوية، انظر: جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر وعبد المنعم إبراهيم، ١٥ مجلدًا (بيروت: دار الكتب العلمية، (۲۰۰۹)، مج ۱۳، ص ۷۳ – ٨٤؛ ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط (بيروت: مؤسسة الرسالة، (۱۹۹۸)، ص۱۱۸۲ – ۱۱۸۳. وللاستخدامات الاصطلاحية للفظة، انظر: محمد بن علي بن محمد التهانوي، کشاف اصطلاحات الفنون، 5 مجلدات (بيروت: دار الكتب العلمية، (٢٠٠٦)، مج ١، ص ٢٠٦ – ٢٠٨.
[10] عن العرفان والتصوف بشكل عام – والذي هو هدف هجوم الجابري ـ انظر ترجمة جون رونارد للعديد من النصوص الصوفية في:
John Renard, Knowledge of God in Classical Sufism: Foundations of Islamic Mystical Theology (New York: Paulist Press, 2004).
انظر أيضًا:
William Chittick, Sufism: A Beginner’s Guide (Oxford: Oneworld, 2000), pp. 39-48; Ahmet T. Kar- amustafa, Sufism: The Formative Period (Berkeley, CA: University of California Press, 2007), and Carl W. Ernst, Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam (Boston, MA: Shambha- la, 2011).
[11] ولتعريف مصطلحي للفظة في العلوم الإسلامية، انظر التهانوي، کشاف اصطلاحات الفنون، مج ١، ص ٢٠٣ – ٢٠٥.
[12] محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، (۱۹۸۶)؛ والتراث والحداثة (بيروت: المركز الثقافي العربي، ۱۹۹۱)، ص ۲۷۲ – ۲۷۳.
[13] عن العرفان بوصفه سحرًا وأساطير، انظر: الجابري، بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، ص ۳۷۸ – ۳۷۹. وفي ص ٦٧، يقول الجابري عن البيان: وإذن، فتأويل البيان … كان تشريعًا للعقل العربي ولم يكن كما قد يُعتقد – مجالًا لممارسات الفعالية العقلية، فعالية العقل الكوني المستقل بنظامه عن نظام اللغة.
[14] انظر: الهامش السابق، والجابري، المصدر نفسه، ص ٣٨ و ١٠٣ – ١٠٤.
[15] انظر الهامش الرقم ٤١ في الفصل الرابع، و
Hallaq, Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge, pp. 73-84.
[16] الجابري، بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية ص ٣٧٤. ومن الجدير بالملاحظة عدم توجيه الجابرى الاتهام ذاته إلى الاستعارات الأرسطية فى الإسلام، والتي يعدها «أجنسة بوضوح. لا يشرح لنا الجابرى هنا سبب كون ذلك الأصل الأجنبى في صالح الأرسطية وضد الغنوصية في الوقت نفسه.
[17] المصدر نفسه، ص ٢٥٣.
[18] المصدر نفسه، ص ٢٥٥.
[19] المصدر نفسه، ص ٢٥٥. يصف الجابري العرفان بأنه محاصر ومستعبد فيبدو العالم له شرًا كله، بل تصبح مشكلته الأساسية، بل الوحيدة هي مشكلة الشر في الإسلام.
[20] وهو تأكيد يتكرر في كتابه بالكامل. انظر: المصدر نفسه، ص ٣٧١، ٤٢٥، ومواضع أخرى من الكتاب.
[21] وللمزيد عن هذا المفهوم، انظر القسم الأول من خاتمة هذا الكتاب.
[22]Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty,” in: I. Berlin, Liberty, edited by Henry Hardy (Oxford: Oxford University Press, 2008), pp. 166-217; John N. Gray, “On Negative and Positive Liberty,” Political Studies, vol. 28, no. 4 (1980), pp. 507-526, and Charles Taylor, “What’s Wrong with Negative Liberty,” in: Alan Ryan, ed., The Idea of Freedom: Essays in Honor of Isaiah Berlin (Oxford: Oxford University Press, 1979), pp. 175-193.
[23] عن أنواع الحرية – بما في ذلك الحرية الإيجابية ذات الأشكال الأيديولوجية والفردية – انظر القسم الأول من خاتمة هذا الكتاب.
[24] محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ۲۰۱۲)، وهو فعليًا الجزء الرابع من سلسلة «نقد العقل العربي».
[25] الجابري، العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، ص ١٧ و ٥٦، ومواضع أخرى من الكتاب.
[26] المصدر نفسه، ص ٦٠ و ٦٧. ولنقد صريح لتشخيص الأزمة، انظر: طه عبد الرحمن، الحوار أفقًا للفكر (بيروت الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ۲۰۱۳)، ص ۷ – ۸.
[27] الجابري، العقل الأخلاقي العربي: «فالأزمة هذه ولدتها الفتنة الكبرى … مما جعل أزمة القيم التي تعكسها تبقى حية عبر العصور». انظر أيضًا: نقد جورج طرابيشي لتوجه الجابري نحو «العربي» مقارنة بـ«اليوناني في كتابه نظرية العقل، نقد العقل العربي؛ ۱ (بيروت: دار الساقي، ۱٩٩٦)، ص ۱۱۷ – ۹۰.
[28] الجابري، العقل الأخلاقي العربي، ص ٦٨.
[29] المصدر نفسه، ص ۷۰، ٧٦، ٧٨ و ۱۲٤، ومواضع أخرى من الكتاب. انظر أيضًا: الجابري، التراث والحداثة، ص ۲۷۲ – ۲۷۳.
[30] الجابري، العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، ص ۷۸، ٤۲۸، و ۱۳۱ – ۷۰ بصفة عامة.
[31] المصدر نفسه، ص ۷۸
[32] المصدر نفسه، ص ٨٣ و ٣٤٥ – ٣٦٤.
[33] المصدر نفسه، ص ۱۰۳
[34] المصدر نفسه، ص ۱۰۹
*** يضيف حلاق هنا تجنبه لاستخدام مصطلح praxeology في ترجمة «عمل» (ويستخدم بدلًا منها praxis) لاهتمام المصطلح الأول – الوصفي والتحليلي – بدراسة الفعل والسلوك الإنسانيين، بينما يشير المصطلح الثاني – المعياري والتهذيبي – إلى تقنية منهجية وأدائية لغرس الأخلاق في الفرد والمجتمع (المترجم).
[35] المصدر نفسه، ص ٥٣١ – ٥٣٢ و ٠٥٣٦
[36] المصدر نفسه، ص ٥٧٢.
[37] المصدر نفسه، ص ٥٤٦ و ٥٩٢.
[38] المصدر نفسه، ص ٥٣٦.
[39] المصدر نفسه، ص ۵۹۲
[40] انظر:
Wael Hallaq: “Groundwork of the Moral Law: A New Look at the Qur’an and the Genesis of Shari’a,” Islamic law and Society, vol. 16, nos. 3-4 (2009), pp. 239-279, and “Qur’anic Constitution- alism and Moral Governmentality: Further Notes on the Founding Principles of Islamic Society and Polity”.
[41] الجابري، العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، ص ٥٣٥.
[42] المصدر نفسه ص. ٥٩٤.
[43] لمناقشة التمايز بين «ماهو كائن» و «ما ينبغي أن يكون»، أنظر القسم الثاني من الفصل الخامس.
[44] المصدر نفسه، ص ٥٩٥: المهم أنني اكتشفت أن عالمًا واحدًا على الأقل كان قد سد الفراغ الذي اشتكيت منه.
[45] المصدر نفسه، ص ٥٩٥
[46] المصدر نفسه، ص ٦٠٧.
[47] المصدر نفسه، ص ٥٣٦.
[48] المصدر نفسه، ص ١٩ و ٥٩٤.
[49] Sheehi, Foundations of Modern Arab Identity, p. 35.
يلجأ لهذا التحليل الهيجلي كل من عبد الله العروي وعبد الإله بلقزيز أيضًا. عن العروي، انظر:
Abdallah Laroui, L’Idéologie arabe contemporaine: Essai critique (Paris: François Maspero, 1967).
انظر أيضًا: عبد الله العروي العرب والفكر التاريخي (بيروت: دار الحقيقة، ۱۹۸۰)، ص ۱۸۳ – ۲۰۲؛ وبلقزيز، نقد التراث، ص ۲٦ – ۲۷. ومن الجدير بالملاحظة هنا أن تحليلات بلقزيز – على شموله وسعة علمه – في كتابه بالكامل تشوبها نفس آثار الحداثة المهيمنة أيديولوجيًا عند المفكرين الذين يخضعهم بلقزيز نفسه للنقد. ولمقارنة عامة لتصور كل من العروي وعبد الرحمن للوعي العربي بالحداثة، انظر: عبد الحليم مهورباشة، الحداثة الغربية وأنماط الوعي بها في الفكر العربي المعاصر: دراسة مقارنة بين عبد الله العروي وطه عبد الرحمن، تبين السنة ٦، العدد ۲۳ (شتاء ۲۰۱۸)، ص ١٠٣ – ١٢٥.
[50] يهدف التقييد بالوصف غير المرتبطة بالدولة هنا إلى التأكيد على الفرق النوعي بين الفهم الحداثي للمفهوم بوصفه منتجًا من منتجات أيديولوجية الدولة (مثل الشكل السوفياتي أو الكوبي، على سبيل المثال من جهة، والشكل الشخصي والفردي والمجتمعي للمفهوم نفسه من جهة أخرى. وفي الحالة الإسلامية على الأقل، لا يرتبط المفهوم بالدولة لأن الإسلام لم يطوّر قبل العصر الحديث أي شيء يشبه الدولة الحديثة، وهو ما يفسر الفرق والبعد النوعيين لأشكال الحرية الإيجابية. وكما أؤكد دائمًا، فإن ثمة أسبابًا حقيقية للاعتقاد بأن مسمى الحريات الإيجابية» و«السلبية» يشوبه القصور، إلا أن هذه تظل مشكلة يجب على التنظير الخاص بمجال الترجمة التعامل معها. وعن نظام الحكم» الإسلامي قبل القرن التاسع عشر بوصفه نظامًا مضادًا للدولة الحديثة، انظر: حلاق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies