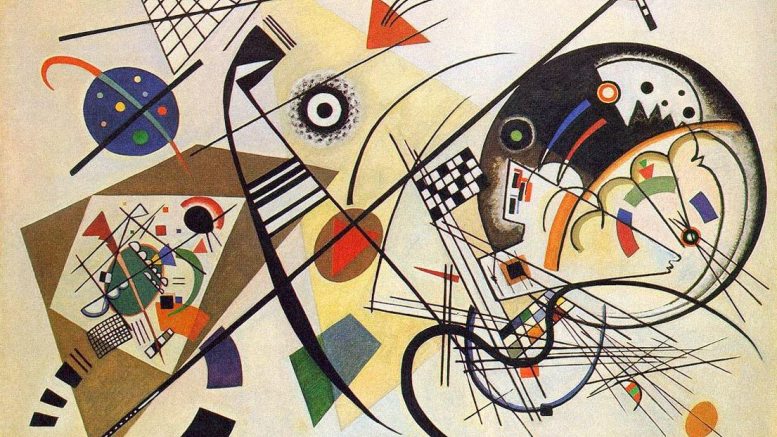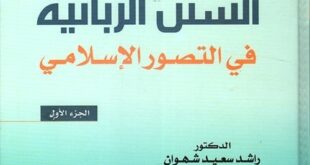الفردانية في مجتمعاتنا
مظاهرها وسبل تجاوزها
أ. تقى محمد يوسف*
مقدمة:
شهدت مجتمعاتنا العربية والإسلامية في العقود الأخيرة سلسلة من التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة التي أعادت تشكيل بنية العلاقات، وأنماط التفكير، وسبل التعبير عن الذات. وشملت هذه التحولات: التبدل في أشكال التدين، التحول في محددات الهوية والعلاقة مع التراث، التغير في أنماط الأسرة، وازدياد معدلات الطلاق، وظهور أشكال جديدة من العلاقات الاجتماعية—الزواج العرفي، المساكنة، الصداقة بين الجنسين إلخ، التغير في أنماط الاستهلاك، وفي الثقافة الشعبية، التحول في العلاقة مع التقانة، وفي أشكال التواصل الاجتماعي، وظهور ما يطلق عليه الذات الرقمية. إلخ
هذا وتُعدّ الفردانية قاسمًا مشتركًا بين معظم هذه التحولات الاجتماعية والثقافية. ونقصد بالفردانية: وضع الفرد في مركز المعنى والمرجعية والاهتمام، على نحو يُفضي إلى تراجع الانتماء الجمعي وتقلص الإحساس بالمسئولية تجاه الآخرين. الفردانية بهذا الوصف يمكن النظر إليها كأحد تجليات الحداثة، إذ تمثل مشروعًا منافسًا للدين في تعريف الإنسان وتحديد موقعه في الوجود. فهي تستبدل مركزية الأمة والمرجعية الإلهية بمركزية الفرد، فتجعل منه محورًا مطلقًا للمعنى والقيمة، بل قد ترفعه – ضمن عالمه الخاص – إلى مقام الإله المكتفي بنفسه!
وتأتي أهمية طرح هذا الموضوع في المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات ما بعد طوفان الأقصى، حيث عاد مفهوم “الأمة” إلى الواجهة بوصفه إطارًا جامعًا يتجاوز انكفاء الفرد على ذاته، ويستدعي وعيًا بانتماء أعمق إلى هوية جماعية. فقد أبرزت التطورات الأخيرة الحاجة الملحة إلى استنهاض روح التضامن، وإعادة الاعتبار للروابط الجماعية التي تشكّل حواضن ضرورية للقيم العليا، في مواجهة النزعات الفردانية والمادية التي يعززها النموذج الاستهلاكي السائد.
وإذا كانت الفردانية نتاجًا طبيعيًا لتطور التجربة التاريخية الغربية، فإن حضورها في المجتمعات العربية جاء عبر مسار أكثر تعقيدًا، تداخلت فيه عوامل ثقافية واقتصادية وسياسية، مما يفرض مقاربة متأنية تكشف عن جذورها وتشخيص مظاهرها بعيدًا عن التبسيط أو إطلاق الأحكام المسبقة.
وانطلاقًا من هذا الفهم، تتناول هذه الورقة جذور الفردانية في السياق العربي، وتتبع تجلياتها المعاصرة، لا سيما في ظل بروز أنماط من التدين الفردي التي باتت تزاحم التصورات التقليدية للتدين الجماعي. كما ترصد العوامل الراهنة التي تغذّي هذه النزعة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وتفكك البُنى الاجتماعية التقليدية، والعولمة الثقافية بما تحمله من خطابات متزايدة حول “الصحة النفسية” بوصفها مرجعية للذات. وفي الختام، تقترح جملة من المسارات الممكنة لتجاوز هذه الفردانية، من خلال إحياء القيم والسنن الاجتماعية التي شكّلت عبر التاريخ نسيج الحياة المشتركة، وإعادة بناء شبكة العلاقات، والانخراط الفاعل في قضايا الأمة الكبرى، بما يعيد للفرد موقعه الطبيعي ضمن الجماعة، لا في مواجهتها.
الفردانية في الغرب
تختلف مقدمات الفردانية في المجتمعات العربية والإسلامية عنها في الغرب؛ ففي السياق الغربي نشأت الفردانية نتيجة لتحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية وفكرية معقدة، شكلتها صراعات طويلة من أجل انتزاع الحقوق الفردية، في مواجهة سلطات دينية وسياسية شديدة المركزية، وعلى رأسها الكنيسة الكاثوليكية التي تحكمت في حياة الناس تحكمًا مطلقًا وسلبتهم إرادتهم الذاتية على نحو شبه كامل. وقد شكّل الإصلاح الديني البروتستانتي منعطفًا حاسمًا في هذا المسار، خاصة مع دعوة “مارتن لوثر” إلى أحقية كل إنسان في تفسير “كتابه المقدس” بنفسه، دون وساطة الكنيسة، مما رسّخ لمبدأ خصوصية العلاقة مع الإله، كما أسس لنوع من الاستقلال في مواجهة المؤسسات الدينية.
ترافقت هذه التحولات الدينية مع تطورات تاريخية كبرى في الفكر الأوروبي، لا سيما فلسفة الأنوار التي أعادت الاعتبار إلى العقل البشري، واعتبرت الذات الفردية المصدر الرئيسي للمعرفة والأخلاق. ويُعدّ ديكارت أحد أبرز ممثلي هذا التحوّل، حيث انطلق من مقولته الشهيرة “أنا أفكر إذن أنا موجود”، واضعًا الأنا المفكرة في مركز الوجود والحقيقة، من دون أي اعتبار للمرجعيات المتجاوزة. ثم جاء فلاسفة العقد الاجتماعي –هوبز ولوك وروسو– ليؤكدوا على الحقوق الطبيعية للفرد في مواجهة السلطة، وينظروا إلى المجتمع بوصفه ثمرة عقد اختياري بين أفراد أحرار، لا كيانًا متجاوزًا لهم.
وقد ساهمت الثورة الصناعية وما رافقها من تغيرات اقتصادية واجتماعية وفكرية، في تعميق الفجوة بين الفرد والجماعة، حيث أُعيد بناء المجتمع على أسس فردية بحتة، ومنح الفرد استقلالية تامة عن أي تنظيم تقليدي يملي عليه قيمه أو أفكاره أو نمط حياته. كما ازدهرت خلال قرن الثورة الصناعية (الثامن عشر) وما بعده التيارات الليبرالية والنفعية، التي اعتبرت أن تحقيق مصلحة الفرد وسعادته هو الغاية القصوى، وأن القوانين والمؤسسات يجب أن تُبنى لخدمة الفرد لا العكس. ومع تصاعد هذه التيارات، أصبح الفرد مرجعية نهائية، وفي المقابل تراجع دور الجماعة، التي نُظر إليها كقيد على حرية الفرد وسبب محتمل في فشله وإحباطه. وبذلك انتصرت الأيديولوجيا الليبرالية، وتحول المجتمع إلى ما سماه بعض المفكرين “مجتمع الأفراد” أو “مجتمع الذرات”.
الفردانية في الشرق
لم تعرف المجتمعات الشرقية عموما، والإسلامية على وجه الخصوص، هذا النوع من الصدام بين الفرد والجماعة، إذ ارتبط الفرد في السياق الإسلامي تقليديًا ببُنى جماعية قوية، مثل الأسرة الممتدة، والقبيلة، والمجتمع المحلي، وكانت هويته تُصاغ داخل هذه البُنى من خلال تفاعله الحي مع قيمها وأدوارها ومعاييرها الأخلاقية.
لكن هذه البنى الجماعية المتلاحمة بدأت في التعرض لتفكيك ممنهج منذ مجيء الاستعمار، الذي لم يقتصر أثره على تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية، بل طال أيضًا البنى الاجتماعية والأسس الثقافية العميقة. فقد سعت قوى الاستعمار إلى تفكيك “البنى الاجتماعية التقليدية” –كالقبائل والعشائر والتكوينات الدينية والتعليمية– التي كانت تقوم على أنساق جماعية وقيم تكافلية، واستبدلتها بمؤسسات مركزية حداثية تستمد مشروعيتها من منظومة قيم مغايرة.
ففي العديد من الدول تم تفكيك أنظمة الوقف الأهلي واستبدال المجالس العرفية، كما تم تفكيك الزوايا والمدارس القرآنية (الكتاتيب) التي كانت تمثل ركائز دينية هامة، لتحل محلها أنظمة تعليمية علمانية، كما تم تحديث الأنساق القبائلية بشكل قسري، من خلال أنظمة الإدارة الحديثة، ونظم الحكم المحلي، وتم دمج الجماعات التقليدية ضمن أنظمة ومؤسسات الدولة الحديثة، على نحو يضمن خضوعها للتحكم والمراقبة، وتم استبدال أشكال المجتمع التكافلي (الأحياء التقليدية القائمة على الجوار والتكافل والعلاقات المباشرة)، بمدن حديثة ذات طابع فردي منعزل.
كما امتد تأثير الاستعمار ليحدث تحولات جذرية في “البنية الثقافية” للمجتمعات التقليدية. فقد عملت القوى الاستعمارية على تفكيك وإقصاء المرجعيات الدينية والاجتماعية التقليدية مثل العلماء والقضاة الشرعيين، واستبدلتها بنخب جديدة، تتبنى النموذج الأوروبي في المعرفة واللغة والسلوك. كما فرضت أنظمة الاستعمار اللغة والثقافة الغربية باعتبارهما معيارًا للتقدم والتحضر، مما أسهم في نشوء شعور بالدونية تجاه الثقافة الأصلية. كما حدث نوع من الاستبدال لمنظومات القيم الجماعية التي تقوم على التكافل، لصالح قيم الفردانية والمنافسة، مما زعزع الأطر التقليدية للعلاقات الاجتماعية. وقد أعاد الاستعمار أيضًا تشكيل الهويات الجمعية من خلال إعادة إنتاج الزمان والمكان والمعرفة وفق تصورات علمانية، فتراجعت المركزية الرمزية للتقويم الهجري، والأماكن المقدسة، والمعرفة الشرعية. وكرّس المشروع الاستعماري، رؤية دونية للذات الثقافية الإسلامية، وأسهم في إعادة تعريف العلاقة بالتراث والهوية ضمن ثنائية صراعية بين الأصالة والحداثة، ما خلّف آثارًا لا تزال المجتمعات الإسلامية تواجه تداعياتها حتى اليوم.
وبعد الاستقلال، لم تشهد المجتمعات الإسلامية عودة فعلية إلى توازناتها الأصلية، بل استُكملت عملية إعادة التشكيل من الداخل (بما في ذلك تأكيد مظاهر الفردانية). فقد نشأت الدولة القُطرية بتصور مركزي للسلطة، وجرى تهميش الجماعات الوسيطة وتفكيك العلاقات الاجتماعية التقليدية، مقابل تعزيز حضور الفرد كمواطن في علاقة عمودية مع الدولة لا أفقية مع الجماعة[1].
وفي هذا المناخ، ظهرت تحولات فكرية عميقة، غذَّتها النخب الثقافية المتأثرة بالحداثة الغربية، والتي بدأت في إعادة صياغة مفاهيم الحرية والسلطة والمعرفة[2]. وقد كان لرواد التنوير العرب دور في الترويج لتصورات جديدة عن الفرد بوصفه كائنًا حرًا مستقلًا. ثم جاءت التحولات الاقتصادية النيوليبرالية لتعمّق هذا الاتجاه، من خلال تراجع دور الدولة الاجتماعي، حيث غذّت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية نزعة الاعتماد على الذات، وجعلت الكرامة الإنسانية مرتبطة بالقدرة على الاستهلاك والإنتاج، لا الانتماء لنسق من القيم المشتركة.
في هذا السياق، بدأ الدين، الذي كان يُشكّل إطارًا مرجعيًا جامعًا للقيم الجماعية والمنظومة السلوكية داخل المجتمع، يفقد تدريجيًا مكانته المركزية في توجيه السلوك العام. ويُعزى ذلك، جزئيًا، إلى تأميم المؤسسات الدينية، ومعاملتها كباقي المؤسسات الحكومية، مما أدى إلى إعادة تشكيل وظيفتها ضمن البنية البيروقراطية للدولة الحديثة. وفي نفس الإطار، أُعيد تعريف التدين بوصفه شأناً فرديًا يخص الضمير الشخصي، لا التزامًا جمعيًا مشتركًا. وأسهم هذا التحوّل في نقل التدين من كونه تجربة مجتمعية متجذّرة في الحياة اليومية، إلى ممارسة فردية، محكومة بالمعايير الرسمية.
وقد بلغت الفردانية ذروتها في أعقاب ثورات الربيع العربي. حيث شكّلت هذه الثورات لحظة انفجار للذات الفردية، التي لم تعد ترى نفسها ملزمة بصيغ الانتماء القديمة، سواء على مستوى العائلة، أو الطائفة، أو الحزب، أو المؤسسة الدينية. كما أدى انهيار الهياكل الأيديولوجية والتنظيمية –كالأحزاب السياسية والتنظيمات الدينية- وتراجع الخطابات الكبرى في أعقاب إخفاق معظم هذه الثورات، إلى شعور متنامٍ بالعجز الفردي وإحساس باللا جدوى الجماعية. وقد ترافق ذلك مع صعود نزعات شخصية تكرّس “تحقيق الذات” كغاية قصوى، مقابل فقدان الثقة في أي مشروع جماعي أو توجه أيديولوجي.
الفردانية والتدين
بشكل عام، تقوم العلاقة بين الدين والفردانية على توتر عميق، حيث يمثل كل منهما نظامًا مرجعيًا مختلفًا في تصور الإنسان، والمصدر الذي يحدد الصواب والخطأ، والمعنى والقيمة. فالدين، في جوهره، يقوم على الاعتراف بمرجعية متجاوزة للذات الفردية؛ مؤسسة على الوحي، وهو ما يفرض على الفرد نوعًا من الخضوع الطوعي لمصدر سلطة خارجة عنه. بينما الفردانية تنزع إلى جعل الفرد هو مركز المعنى ومرجعه، بحيث تُختبر الحقيقة والمعنى والقيمة في ضوء التجربة الذاتية للفرد، لا في ضوء مرجعية متعالية أو جماعية. فالفرد لا يعود مسؤولًا أمام نص أو مرجعية متجاوزة، بل أمام ذاته، بما يحمله من تجارب وقناعات وخيارات شخصية. ومن هنا تظهر المفارقة الأساسية: ففي حين يقوم الدين على وجود “حق” موضوعي ومتعالٍ يُلزم الجميع، ترى الفردانية أن “الحق” نسبي وشخصي، وأن ما يراه الفرد صوابًا فهو كذلك بالنسبة له، ولو خالف المرجعية أو النص.
والفردانية لا ترفض الدين ولا التدين بالضرورة، لكنها تُعيد تعريفه ليصبح تدينًا ذاتيًّا وانتقائيًّا، يخضع لذوق الفرد وقناعاته الخاصة، لا لسلطة شريعة أو إجماع أو نصوص. ولذلك ظهر ما يمكن أن نطلق عليه “التدين الفردي” والذي يتميز بانتقاء الأفراد لما يناسبهم من القيم الدينية دون اعتبار لشمول المنظومة أو ترابطها الداخلي. وهكذا فإن الدين الذي كان في السابق جماعيًا وعضوياً ومتشابكًا مع الحياة اليومية، ينتقل (في إطار الفردانية) من كونه ممارسة جمعية محكومة بمرجعية موحدة، إلى أشكال فردية وانتقائية، يُعيد فيها الفرد تأويل الدين بحسب تصوراته واحتياجاته الذاتية.
وقد ناقش باتريك هايني هذا النمط من التدين في كتابه إسلام السوق بالتركيز على العالم الإسلامي، حيث وصف كيف أصبح الدين أداة لتعزيز “المشروع الفردي” لا إطارًا ناظمًا له. فتحدث عن نمط التدين الذي يناسب “شبكة العلاقات الهشة” التي ظهرت في المجتمعات الإسلامية بعد أن غزتها قيم الرأسمالية التي تركِّز على التفوُّق الفردي على حساب الجماعة، و”عصرنة” المفاهيم الإسلامية بما يتناسب مع متطلبات السوق. هذا التدين أصبح ذا صبغة علمانية، وهو تدين فرداني يتخلى فيه الفرد عن أي مشاريع جماعية كبرى في سبيل مشاريع شخصية يهيمن عليها مبدأ تحقيق الذات والرفاهية[3].
هذا التدين “الجديد” الذي هو في جزء منه نتاج خطاب الدعاة الجدد الذين مزجوا بين الموروث الإسلامي والثقافة الغربية، والذين يطرحون قيم تحقيق الذات على النمط الليبرالي الرأسمالي؛ ممثلة في الطموح والثروة والنجاح والتحقق[4]، تفاقم وانتشر بشكل أوسع بعد الربيع العربي. فبعد تحلل التيارات والجماعات الكبرى الحاضنة للتدين الشعبي والجماعي من جهة، وضعف المؤسسات الدينية الرسمية من جهة أخرى، لم يعد هناك نموذج أو معيار أو مرجعية متفق عليها في التدين، بل بدأ الكل يسعى منفردًا لبناء نموذجه الخاص.
ومن سمات هذا التدين الفردي أنه يركز على التجربة الشخصية والطريق الروحي الخاص للفرد، وغايته الشعور بالذات وإيجاد المعنى، وبالتالي فإنه ينتقي الآراء الدينية الموافقة لهذه الأهداف دون تقيد بمذهب معين.[5] ويستبطن هذا التدين عدداً من المسلمات، منها: سيولة الأخلاق ونسبية الغاية، فليس لأحد حق تحديد الصواب والخطأ للآخرين. كما يستبطن تقديم الشأن الخاص على أي اعتبارات أخرى، فحماية الحرية الفردية وعدم التعدي عليها مقدّم على أي شيء آخر. وبهذا تلغي هذه الفكرة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ينطلق من وجود معيار واضح للصواب والخطأ يتم التوجيه وفقه[6]. أما تمثلات هذا التدين الفردي في الواقع فتظهر في:
- التدين الروحي (Spirituality)
هو نمط من البحث الديني أو الوجودي يركّز على المعنى الأعمق للحياة، والشعور بالصلة بما هو أسمى من الذات، سواء أكان ذلك إلهًا، أو حقيقة كونية، أو جوهرًا داخليًا. وتتنوع صوره وتفسيراته بحسب السياقات الثقافية والاجتماعية، ويمكن تمييز نمطين رئيسيين منه:
أولًا- في السياقات التقليدية والدينية، يُفهم التدين الروحي غالبًا على أنه تركيز على البُعد القلبي والباطني للعلاقة مع الله، ويُعبَّر عنه شعبياً بعبارات مثل: “ربك رب قلوب” أو “الجوهر أهم من المظهر”. ويرى بعض أتباع هذا الاتجاه أن صفاء القلب ونقاء السريرة هو المعيار الأهم في الدين، حتى وإن لم يواكبه التزام دقيق بالشعائر الظاهرة.
ثانيًا- في السياقات الحداثية والعلمانية، تنتشر نزعة “روحانية غير دينية ” (non-religious spirituality)، تُعبِّر عن رحلة داخلية للبحث عن الذات والمعنى، وتعتمد على مشاعر الارتباط بالطبيعة أو الكون، وتقدير القيم الإنسانية العليا مثل السلام، والمحبة، والتسامح، والرحمة. وغالبًا ما تكون هذه الروحانية فردية وانتقائية، حيث يميل أصحابها إلى اختيار عناصر من مختلف التقاليد الدينية والفلسفية بما يتوافق مع مشاعرهم وتجاربهم الذاتية، دون التزام بتعاليم محددة أو مرجعية دينية متجاوزة. وتشيع في هذا السياق مفاهيم مثل التأمل، والامتنان، والطاقة الإيجابية، بوصفها أدوات للوصول إلى الطمأنينة الداخلية أو “الانسجام مع الذات”، دون إحالة إلى الإيمان الغيبي أو الالتزام بالتكليف الشرعي. ويتفرع عن هذا التصنيف النموذجين التاليين؛ أي التدين الإنسانوي، والإيمان بالطاقة.
- التديّن الإنسانوي
هو نمط من أنماط التديّن يُمركز الإنسان ويمنحه موقع المرجعية العليا في تحديد المعنى والقيمة. وينطلق هذا التصور من تجاهل المرجعية الإلهية أو رفضها، ما يجعله يركّز على منظومة من القيم الأخلاقية “الإنسانية المشتركة” مثل العدالة والكرامة والتسامح، مع إقصاء أو تحجيم للمفاهيم الدينية المرتبطة بالإيمان بالعقائد والنصوص المقدسة.
ولا يرفض التديّن الإنسانوي الدين صراحة، بل يتعامل معه باعتباره مشروعًا أخلاقيًا لتحسين الوجود الإنساني والدعوة إلى السلام العالمي، لا منظومة تشريعية قائمة على التكليف والامتثال. ونتيجة لذلك، يعمد الخطاب الإنسانوي إلى إعادة تأويل النصوص الدينية بما يتوافق مع مفاهيم الحداثة وحقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تحوّل المرجعية من النص أو العقيدة إلى “الضمير الأخلاقي” الفردي بوصفه المعيار الأعلى للحكم على السلوك وتقرير المصير الأخروي.
- الإيمان بالطاقة
هذا النمط يُعد من أكثر أشكال التدين الفردي تداخلاً مع المفاهيم غير الدينية، إذ يقوم على دمج المفاهيم الدينية (كالدعاء، الذكر، النية) مع مفاهيم مستجلبة من مدارس الطاقة والتنمية البشرية مثل “قانون الجذب”، و”الطاقة الكامنة”، وتنظيف “الشكرات”، و”الوعي الكوني”. في هذا التدين، يُنظَر إلى الشعائر الدينية باعتبارها مجرد أدوات لتحسين الحالة النفسية أو تحقيق أهداف دنيوية، لا باعتبارها عبادات غائية قائمة على الخضوع لله تعالى والتعبد له، وبالتالي يمكن استبدال ممارسات اليوجا وغيرها من الطقوس بها، أو استخدام العبادات (كالدعاء) لخدمة هذه الطقوس. كما يتم توظيف النصوص الدينية لتدعيم أفكار مثل أن “الإنسان خالق لواقعه”، أو أن “الله يريد لنا أن نعيش برفاه”.
ويبرز في هذه الأنماط وغيرها “الانتقائية”؛ حيث يختار الفرد من المنظومة الدينية ما يتوافق مع قناعاته أو نمط حياته، فيمارس بعض الشعائر، أو يتبنى بعض القيم، ويهمل أخرى وفق هواه وتصوراته، لا وفق منهجية منضبطة. كما يبرز فيها معنى “الذرائعية”؛ حيث يصبح الدين وسيلة أو ذريعة لتحقيق غايات شخصية، مثل الشعور بالطمأنينة والراحة أو ملء فراغ روحي ما أو تحقيق طموحات دنيوية. وأخيراً يظهر فيها التقوقع حول الذات، مع انعزال شبه تام عن القضايا الاجتماعية والسياسية.
وإذا كان الدين هو مصدر القيم المجتمعية الرئيس، والتدين هو ما يرعى هذه القيم ويستبقيها في الممارسات والعلاقات الاجتماعية، فإن تأثير التحول نحو التدين الفردي ينعكس بشكل واضح على نمط العلاقات وأشكال التفاعل بين الأفراد، على النحو الذي نناقش بعض مظاهره فيما يلي:
بين المجتمعات التقليدية والمجتمعات الفردية:
شهدت المجتمعات الإسلامية والعربية في العقود الأخيرة تحولات بنيوية في بنيتها الاجتماعية، وقد رصد الدكتور عبد الوهاب المسيري هذه التحولات في مذكراته، مشيراً إلى أن الفرد في المجتمع التقليدي لم يكن منعزلاً، بل كان جزءاً من نسيج اجتماعي متكامل، على عكس المجتمع الحديث الذي ينغلق فيه الفرد على نفسه. ويمكن الحديث عن هذه التحولات بشيء من التفصيل من خلال محورين أساسيين: أولهما التحول من نموذج الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، وثانيهما الانتقال من نمط العلاقات التراحمية إلى نمط العلاقات التعاقدية القائمة على المصلحة الفردية كما أشار المسيري.
في الأسرة الممتدة، لم يكن الفرد ابن والديه فحسب، بل كان عضواً في مجتمع أوسع يشارك في تربيته وتوجيهه. فالتنشئة الاجتماعية كانت مسؤولية جماعية، يشترك فيها الأقارب والجيران في ظل قيم اجتماعية مشتركة، مما وفر للفرد شبكة دعم متكاملة وضوابط أخلاقية واضحة. وكان المجتمع القائم على هذا النوع من الأسر يتسم بدرجة من المرونة، حيث يسمح بحيز من الحرية الفردية، لكن ضمن إطار قيمي جماعي متفق عليه.
هذا النموذج الاجتماعي تلاشى لصالح نموذج الأسر النووية المكونة من الأب والأم والمسئولة بشكل فردي عن تنشئة الأبناء ورعايتهم وتربيتهم وفق منظومة قيم يحددها الوالدان وحدهم دون مشاركة أو مشاورة، وبالتالي أصبح العبء أكبر عليهم في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه هذه الأسرة.
واليوم يمكن أن نلحظ أنه حتى هذه الأسر النووية الصغيرة قد طالها التفكيك من داخلها، إذ زادت نسب الطلاق نتيجة عدم القدرة على التفاهم والوصول إلى رؤية مشتركة، واتسعت الفجوة بين الآباء والأبناء بشكل كبير نتيجة غياب منظومة القيم الاجتماعية المشتركة التي تجمع بينهم. وفي ظل تعدد وتنوع الخطابات التي يتعرض لها الأبناء، خاصة عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديثة، باتت سلطة الوالدين أضعف من أي وقت مضى، مما أدى إلى تراجع دورهم التربوي والتوجيهي داخل الأسرة. فقد أصبح الأبناء يكوّنون مرجعياتهم الخاصة بعيدًا عن تقاليد الأسرة ومعتقداتها، مستندين إلى مصادر خارجية متنوعة لا تخضع لأي رقابة أو توجيه، وغالبًا ما تحمل رؤى متضاربة أو سطحية. حتى إن الروابط بين الإخوة ضعفت نتيجة لانشغال كل فرد بحياته الخاصة واستقلاله الذاتي. هذا التفكك الداخلي للأسرة النووية يُعد أحد أبرز تجليات الفردانية الحديثة، والتي رغم ما توفره من حرية واستقلال، إلا أنها تفضي إلى ضعف الروابط الإنسانية وفقدان الإحساس الجماعي المشترك الضروري لتماسك المجتمع واستقراره.
ويرجع المسيري أسباب هذا التفكك المتتابع إلى تحول العلاقات الاجتماعية من نموذج العلاقات التراحمية التي تقوم على القيم الإسلامية، مثل التكافل والتطوع والتعاون والنجدة، إلى نموذج العلاقات التعاقدية التي تحكمها المصالح المباشرة والحسابات المادية[7]. فبعد أن كانت قيم هي الأساس الذي تنبني عليه شبكة العلاقات الاجتماعية القوية، والتي تمكن المجتمع من تجاوز المحن والأزمات بأقل ضرر ممكن، سادت العلاقات التعاقدية التي هي أشبه بعقود مؤقتة قابلة للإنهاء في أي لحظة.
صحيح أن نموذج البيوت التقليدية، التي كانت تُعرف بأبوابها المفتوحة وحسن استقبالها للجيران ومشاركتهم في الأفراح والأتراح، لا يزال حاضرًا في الذاكرة القريبة، بوصفه تجسيدًا لعلاقات قائمة على التكافل والتعاون المباشر، دون تكلّف أو انتظار لمقابل، إلا إنه في السياق المعاصر، ساد نموذج الأبواب المغلقة، التي يغلب عليها الطابع الفردي، والتي تنظر إلى علاقات الجوار من منظور الخصوصية والانفصال، لا من زاوية المسؤولية الاجتماعية أو الواجب الأخلاقي. ونتيجة لذلك، تراجعت مظاهر المساعدة المتبادلة، وحل محلها منطق المنفعة المادية والمصالح المحسوبة، ما ساهم في تفكك البنية الاجتماعية وتعطيل القيم الإسلامية التي حثّ عليها الشرع، كالإحسان إلى الجار، والتراحم، والتكافل.
إن الممارسات المجتمعية مثل موائد الإفطار الجماعية في شهر رمضان، ومبادرات كفالة الأيتام، وأعمال التطوع في توزيع الغذاء والدواء، والتكافل الأسري والمجتمعي في أوقات الأزمات، تقدم شواهد على استمرار حضور القيم الجماعية في الوعي الجمعي، ولكنه حضور (يُخشى من أنه) آخذ في الانزواء لصالح الممارسات الفردانية بسبب فقد هذا الغطاء من البنى الثقافية والاجتماعية والدينية التي كانت تحرس هذه الممارسات -والقيم التي تستبطنها وتغذيها. ولهذا فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في إرساء القيم المجتمعية من جديد، بل في استعادتها وإعادة تفعيلها بوصفها قاعدة مشتركة يمكن البناء عليها من أجل مجتمع متماسك وأمة قادرة على مواجهة التحديات المتراكبة، وهذا لا يكون إلا من خلال ثقافة وروابط اجتماعية تحمل هذه القيم وتبثها وتحرص على ديمومتها. ويزداد هذا التحدي إلحاحًا في ظل التحولات العالمية التي تدفع بالأفراد نحو الانعزال والانكفاء على الذات، ما يستدعي مجهودًا فكريًا ومجتمعيًا لإعادة الاعتبار للقيم الجماعية باعتبارها شرطًا أساسيًا للاستقرار والتماسك الاجتماعي.
الحداثة وأثرها في انتشار الفردانية:
أفرزت الحداثة -التي فشت في السياق العربي والإسلامي بفعل الاستعمار وتوابعه- قيماً وبنى اجتماعية وسياسية واقتصادية أعادت تشكيل موقع الفرد في المجتمع، وجعلته مركزًا للمعنى. فقد استُبدلت المرجعيات الدينية والجماعية بمنظومات جديدة تُمجّد الحرية الفردية والاستقلال الذاتي، ما أدى إلى تآكل البنى التقليدية التي كانت تضبط سلوك الأفراد ضمن نسيج اجتماعي مشترك.
فقد غدت مفاهيم مثل “تحقيق الذات” و”الاكتفاء بالنفس” و”النجاح الشخصي” هي الغايات العليا، بينما تراجعت مفاهيم الجماعة، والانتماء، والتكافل، بل باتت تُنظر أحيانًا كعوائق تحدّ من حرية الفرد ونموه. كما ساهمت المؤسسات الحداثية، من السوق الرأسمالية إلى أنظمة التعليم والإعلام، في تعزيز هذا التوجه، عبر تشجيع التنافسية والاستهلاك الفردي وتفكيك الروابط الاجتماعية لصالح روابط تعاقدية مؤقتة. وهكذا، لم تعد الفردانية مجرد خيار شخصي، بل أصبحت منطقًا مهيمنًا يعيد تشكيل العلاقات والهوية والانتماء في المجتمعات الحديثة.
فالنظام الرأسمالي يقوم على مبدأ المنافسة الفردية، حيث يُمجَّد النجاح المادي الفردي، ويُقاس بعدد الممتلكات وكم الإنجازات الشخصية. ويعزز هذا النظام ثقافة الاستهلاك الفردي، من خلال تخصيص المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات الأفراد على نحو شخصي مما يؤدي ذلك إلى تضخيم الرغبات الفردية. وفي أنظمة التعليم، تتجه المؤسسات التعليمية، ولا سيما المدارس والجامعات، إلى التركيز على تطوير المهارات الفردية التي يتطلبها سوق العمل، على حساب تنمية المهارات الاجتماعية والتشاركية التي تؤهل الفرد للانخراط في قضايا مجتمعه والتفاعل مع الشأن العام.
وبالتالي أصبحنا أمام مجتمعات منفصلة، يعيش أفرادها في فقاعات مغلقة، يخافون من التواصل مع الآخرين، ويؤمنون بأنه لا خيار سوى “الاعتماد على الذات”. لكن هذه الفردانية المفرطة تترك الناس وحيدين أمام أزمات الحياة، بدون شبكات أمان اجتماعي أو عاطفي حقيقية. وهكذا، ورغم كل ادعاءات التحرر، يصبح الفرد الحديث أكثر عُرضة للقلق والاكتئاب، لأنه ببساطةٍ خُلق ليعيش ضمن جماعة.
وإذا كانت هذه المقالة لا تملك استيعاب أو استقصاء جميع العوامل التي أسهمت —ولا تزال تسهم— في تصاعد النزعة الفردانية داخل المجتمعات العربية، فإنها تكتفي بالتركيز على عاملين محدّدين، ترى أنهما يشكّلان عناصر حاسمة في تعميق هذه الظاهرة، لاسيما في أوساط الأجيال الصاعدة، وهما وسائل التواصل الاجتماعي، وخطابات الصحة النفسية.
الأول: وسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها:
تتيح وسائل التواصل الاجتماعي لمستخدميها بناء شبكة علاقات افتراضية هشّة، تقوم على تشارك بعض الاهتمامات والأفكار العابرة مع آخرين لا يجمعهم بهم سياق حياتي مشترك. ورغم أن هذه العلاقات لا تحل محل العلاقات التقليدية بشكل مباشر، إلا أنه مع تراجع اللقاءات المباشرة، وتغيّر أنماط الترفيه والتواصل، وضيق الوقت الناتج عن الاستهلاك الرقمي المفرط -الذي نتج عن وسائل التواصل والانترنت عموما-، فقد أصبحت هذه العلاقات الهشة أكثر جاذبية للأفراد من العلاقات الواقعية التي أصبحت عبئا بسبب اختلاف القيم والتصورات بين الأجيال.
وعند التأمل في المحتوى الشائع على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضح أنه لا يكتفي بعكس ظاهرة الفردانية، بل يُسهم بفاعلية في تعميقها وتوسيع نطاقها. فمن خلال التركيز المكثف على قصص النجاح الفردي – سواء لشخصيات عامة، أو رواد أعمال، أو ما يُعرف بـ “المؤثرين” – تُقدَّم هذه النماذج بوصفها معايير مرجعية يُفترض الاقتداء بها. وغالبًا ما تُصاغ هذه القصص بإلحاح ضمن سردية تُرجع النجاح إلى الجهد الفردي المحض، وتعزّز فكرة تحقيق الذات بمعزل عن الجماعة، وكأن قيمة الإنسان لا تُقاس إلا بقدر استقلاله الذاتي عن الآخرين.
ومن جهة أخرى، تُغرق وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين بسيل من المحتوى التافه، في استجابة مباشرة لرغباتهم. وهكذا يُعاد تشكيل العلاقة بين المُنتِج والمتلقّي، ليغدو هدف صانعي المحتوى هو تلبية أهواء الأفراد على نحو مستمر، مما يُضخّم إحساس المستخدم بذاته ورغباته، وكأنها حقوق ينبغي إشباعها على الفور. وتتحول هذه المنصات تدريجيًا إلى ما يشبه “آلة لإرضاء الذات”، تُغذّي دوامة لا تنتهي من الرغبات الفورية والمتزايدة، وتُرسّخ بذلك ثقافة الاستهلاك والانغماس في المتع العارضة، على حساب المعنى والارتباط الجماعي.
يتحوّل الفرد من فاعلٍ موجِّه لرغباته إلى أسير لها، خاضع لإيقاعها المتسارع. وتغدو المنصات الرقمية، تحت شعار “إرضاء المستخدم”، أدوات لتكريس التعلق النفسي بها، تُقوّض الإرادة الذاتية وتُعمّق العزلة. والنتيجة: عالم مكتظ بأفراد منعزلين، منشغلين على نحو دائم بإشباع ذواتهم، دون أفق جمعي يحتضنهم أو مقصد أعلى يوجّههم.
ومن ناحية أخرى، تعمل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة انتقائية دقيقة، حيث تُحلل سلوك المستخدم وتفضيلاته لتُغرقه لاحقًا بما ينسجم مع ميوله الخاصة. وبهذا تُغذّي العزلة الفكرية وتُضيّق أفق الإنسان تدريجيًا، حتى يغدو سجينًا لرؤيته المحدودة وأفكاره الضيقة. إنها آلية تُكرّس ثقافة “الاستهلاك الفردي” حتى في ميدان المعرفة والقيم، إذ تُقدِّم لكل فرد ما يوافق رغباته وتُخفي عنه ما يُخالفها، مما يُضعف قدرته على النقد والتفكير المستقل، ويُرسّخ نمطًا معرفيًا منغلقًا ومنعزلاً[8].
الثاني: خطاب الصحة النفسية:
لطالما ارتبط العلاج النفسي في المجتمعات العربية، في العقود الماضية، بنظرة سلبية تُحمّله دلالات الخزي والازدراء، حيث كان يُنظر إليه باعتباره مؤشرًا على الضعف الشخصي أو نقص الإيمان، لا بوصفه مسارًا مشروعًا للتعافي. وقد عكست هذه النظرة تصورا غير منصفا تجاه المعاناة النفسية وأصحابها. أما اليوم، فقد أسهمت جهود متعددة في إعادة تأطير العلاج النفسي وجعله جزءًا مقبولًا من ثقافة الرعاية الذاتية.
غير أن هذا التحوّل لم يقتصر على التطبيع فحسب، بل وصل إلى حد الشغف بخطاب الصحة النفسية، إذ تسللت مفاهيم ومصطلحات علم النفس إلى الخطاب اليومي، وأصبحت تُستخدم على نطاق واسع في المحادثات العادية وعلى منصات التواصل الاجتماعي. بل أصبح من الشائع تداول شعارات مثل “كلنا مرضى نفسيون”، بما يعكس تعميمًا مفرطًا لحالة الاضطراب النفسي.
والأكثر لفتًا للنظر هو نزوع الكثيرين إلى تبني دور “الخبير النفسي” دون تأهيل، حيث بات كثيرون يطلقون أحكامًا تشخيصية على أنفسهم أو على غيرهم بعبارات مثل: “هذا شخص نرجسي”، أو “أنا مصاب بالاكتئاب”، أو “أعيش صدمة”، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود الخطاب النفسي حين ينفصم عن سياقه العلاجي ويُعاد توظيفه بصورة غير منضبطة[9].
وبعيدا عن زيادة إقبال النّاس على العلاج النفسي دون مساءلة للأطر القيمية والنظرية لهذه العلاجات، فإن تسرب هذه المفاهيم وسيولة تناولها جعل الكثيرين يتمركزون حول أنفسهم من جهتين: الأولى: أن التشخيص الذاتي يجعل الكثيرين يرون أنفسهم كمرضى أو كضحايا للمجتمع أو الأهل، وبالتالي ينغلقون على أنفسهم باعتبار الآخرين مؤذين لهم أو غير قادرين على فهمهم والتعامل مع جراحاتهم، وهكذا يتم تضخيم المعاناة الفردية وتوقع تعاطف الآخرين الدائم مع أصحابها. ومن جهة ثانية: يتم تشخيص الآخرين والتعامل معهم من منظور موقفهم النفسي، فهذا شخص “نرجسي” أو “مكتئب” أو “توكسيك” (toxic) ولذلك يحسن عدم مخالطته أو التعامل معه لكونه: متلاعب، أو ينشر السلبية، أو يلقي اللوم على الآخرين، أو يتصرف بأنانية، أو يظهر غيرة، أو يمتص الطاقة الإيجابية ممن حوله، أو يحاول التحكم في الآخرين، أو يقلل من شأنهم، إلخ. وهكذا تزداد العزلة والفجوة بين الفرد والآخرين من حوله.
ويلحق بهذا الخطاب، خطاب علم النفس الإيجابي وخطاب التنمية البشرية الغارقين في التمركز حول الذات و”تحقيق الذات” و”الثقة بالذات” و”تقدير الذات” والبحث عن المعنى بشكل فردي ذاتي بعيدا عن المعاني المتجاوزة التي تربط الإنسان بغيره لتحقيق غايات عظمى يصعب على الأفراد تحقيقها بأنفسهم. وهذه الخطابات تؤكد —بإفراط — على قيم الإنجاز، والإيجابية، والامتلاء، والتحقق، ورفاه الإنسان، وازدهاره، وسعادته إلخ، على نحو يصعب معه تخيل أن صاحبها سيقابل في حياته أي صعوبات لن يمكنه تجاوزها والتغلب عليها!
هذه الخطابات المتمركزة حول الفرد قد أدت إلى ارتفاع مؤشرات النرجسية لدى الأجيال المعاصرة، وزيادة هشاشتهم النفسية، وسرعة انهيارهم عند تعرّضهم لأي نقد أو محنة، مقارنة بالأجيال السابقة. ولذلك من الضروري مساءلة هذه الخطابات التي أصبحت تصدّر ذواتٍ نرجسية غارقة في الفردانية والأنانية وتقدس مصلحتها وسعادتها الشخصيّة.
نحو تجاوز للفردانية في المجتمعات العربية:
إذا كانت الفردانية تُعبّر عن هيمنة القيم الفردية وتفكك البنى الاجتماعية الحاملة لها، فإن تجاوزها يقتضي العمل على إعادة إحياء القيم الجماعية، بوصفها نقيضًا بنيويًا للفردانية. غير أن هذه القيم لا يمكن أن تزدهر في الفراغ، بل لا بد من أن تتجسد ضمن شبكة علاقات اجتماعية ممتدة تقوم بحملها، وبثها، وترسيخها في الممارسات اليومية. وانطلاقًا من ذلك، فإن تجاوز النزعة الفردانية يتطلب:
- إدراك القيم والسنن الاجتماعية:
بداية لا يمكن الزعم أن مظاهر الجماعية والتضامن قد اختفت بالكلية من مجتمعاتنا المسلمة، وإنما نقول إنها قد بدأت تتلاشى وتضعف شيئا فشيئا لأنها صارت تفتقر إلى الثقافة المعيارية والبنى الاجتماعية التي تعمل على ديمومتها. فمجتمعاتنا اليوم بحاجة ماسّة إلى استعادة ثقافة معيارية يُحتكم إليها وتُشكّل مرجعية مشتركة في التقييم والتوجيه، ثقافة تنبثق من منظومة الشريعة الإسلامية بما تحمله من معتقدات وأفكار وقيم وتوجّهات، تتجاوز الانغلاق الفردي، وتزود برؤية واضحة للعالم، وبأهداف عليا تتخطى حدود الأفراد نحو مقاصد جماعية.
إن الفردانية، في جوهرها، تُنتج مجتمعًا من الأفراد المنكفئين على ذواتهم، الشحيحين في عطائهم، والذين يُقدّمون مصلحتهم الخاصة على مصالح الأسرة أو الجماعة أو الأمة. وهي تُعلي من شأن قيم كالحرية الشخصية والأنانية وتحقيق الذات، على حساب قيم التكافل والتعاون والتضامن، مما يُفضي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية وإضعاف البنية الأخلاقية للمجتمع.
إن الشريعة الإسلامية لا تكتفي برفض النزعة الفردانية في مضامينها، بل تؤسس—بنصوصها القطعية—لرؤية جماعية متكاملة تُعلي من شأن التعاون والتضامن والتكافل. فقد قررت بوضوح مبدأ التناصر الاجتماعي، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وأكدت على وحدة الجماعة الإيمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]. كما جسّد النبي ﷺ هذه الرؤية في قوله: «مَثَلُ المؤمنينَ في توادِّهِم وتراحُمِهِم وتعاطُفِهِم كمَثَلِ الجسدِ الواحدِ، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمى» [رواه مسلم]. فالجماعة هنا ليست مجرد تجمع ميكانيكي من الأفراد، بل كيان عضوي حيّ تربط بين أفراده شبكة من المشاعر والمسؤوليات. ولم تُغفل الشريعة دور الفرد داخل الجماعة، بل أكّدت على مسؤوليته الفاعلة تجاهها، كما في الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم]. وكذلك في الحديث: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها…» [رواه البخاري ومسلم].
وتتجلى هذه القيم الجماعية أيضًا في تفاصيل الشريعة العملية، حيث تتجذر وتتغذّى قيم التعاون والوحدة باستمرار من خلال منظومة العبادات والمعاملات. فالعبادات الجماعية—كالصلاة، والصوم، والحج—تُرسّخ شعور الانتماء والمساواة والمسؤولية المشتركة. كما تُعبّر التشريعات المالية، كالزكاة والصدقة والوقف، عن التزام اجتماعي دائم يُذكّر الفرد بمسؤوليته تجاه الآخرين ويُعيد توزيع الموارد بما يحقق العدالة والتكافل. وتكتمل هذه المنظومة بالأخلاق الاجتماعية التي تحضّ عليها الشريعة، مثل صلة الرحم، والإحسان إلى الجيران، وإفشاء السلام، وزيارة المرضى، وكلها ممارسات تُعزّز الروابط الإنسانية وتُقاوم النزعة الفردانية والعزلة.
والفردانية تمثل انقلابًا على سنن الاجتماع البشري الثابتة، تلك السنن التي أودعها الله في نظام الخلق، والتي لا يستطيع الإنسان تجاوزها أو التفلّت منها. فقد جعل الله تعالى الاجتماع والتكافل والتعاون من سنن العمران التي لا تتبدل ولا تتغير، وهي شروط لازمة لنهوض المجتمعات واستقرارها. ومن ثم، فإن الإصرار على تبني الفردانية كبديل عن روح الجماعة والوحدة لا يؤدي إلا إلى تعطيل هذه السنن، وتأخير تحقق آثارها المباركة في حياة الناس. ومن أبرز هذه السنن، التي تعطلها الفردانية:
- سنة المسئولية الجماعية؛ وهي تعني أن انتشار المنكر في مجتمع ما دون أن يُواجَه بإنكار فعّال، يستتبع عقوبة عامة تطال الجميع، لا الظالمين فقط. وقد دلّ على ذلك قول الله تعالى ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: 25]. وكذلك ما جاء في الحديث النبوي الشريف:”إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب”[10]. وعلى مستوى أعمق، فإن شيوع الأنانية وغياب الروح الجماعية يعيق تحقق سنن النصر والتمكين، لأن هذه السنن مشروطة بشروط جماعية لا فردية. فـسنة التمكين لا تتحقق إلا بتحقيق سنة الإصلاح، التي تقوم على إقامة العدل، والاستقامة على أمر الله، وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك لا يتم إلا من خلال مجهود جماعي منظم. أما سنة النصر، فهي مرتبطة بوحدة الصف، ونبذ التفرق والتنازع، والتحلي بالصبر والثبات؛ كما قال تعالى ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: 46].
- سنة التغيير، كما في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]، فالتغيير الحقيقي في أحوال الأمم والمجتمعات لا يتم عبر نوايا فردية معزولة أو رغبات شخصية محدودة، بل يتحقق عندما يحدث تحول جماعي عميق يشمل اتجاهات الناس وقيمهم وسلوكهم. وهذا التحول يبدأ من الأفراد، لكنه لا يؤتي ثماره إلا حين يتحول إلى وعي جمعي وإرادة اجتماعية مشتركة، تتجاوز حدود الذات الفردية نحو مشروع إصلاحي عام. أما حين ينحصر التغيير في محاولات فردية منقطعة عن السياق الجماعي، فإنه يبقى عاجزًا عن إحداث الأثر المطلوب في الواقع[11].
- إعادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعية وإحياء الجماعات الوسيطة:
لإحياء القيم والسنن الاجتماعية وترسيخها كثقافة معيارية مشتركة في مواجهة النزعة الفردانية المتطرفة، تبرز الحاجة الملحة إلى استعادة شبكة العلاقات الاجتماعية التي تضطلع بمهمة حمل هذه الثقافة وبثّها. ويستدعي ذلك إحياء دور الجماعات والمؤسسات الوسيطة، بدءًا من الأسرة، ومرورًا بالمؤسسات التعليمية والدينية، والمساجد، والهيئات التطوعية. فهذه المؤسسات تضطلع بوظيفة مزدوجة: فهي من جهة تُعد حاضنة وناقلة للهوية والقيم المشتركة، ومن جهة أخرى تقوم بدور الوسيط بين الفرد والجماعات من ناحية، وبين الفرد والدولة من ناحية أخرى، مما يسهم في إعادة التوازن بين النزوع الفردي والانتماء الجماعي.
وتتطلب استعادة السنن الاجتماعية تصحيح التصور السائد حول دور العلاقات الاجتماعية في تشكيل الهوية وتنمية الشعور بالانتماء، إذ لا يمكن فهم الفرد خارج سياقه الاجتماعي، بل إن وجدانه وقيمه تنشأ من خلال تفاعله المستمر مع الآخرين ضمن شبكات من القيم، والمعنى، والدعم، والمساءلة. فحين تتآكل هذه الشبكات – بفعل التحولات الاقتصادية أو الثقافية أو الرقمية – تتفاقم عزلة الفرد ويخفت إحساسه بالارتباط والمسؤولية المتبادلة.
وقد غاب هذا التصور عن أذهان الكثيرين، غير أن إحياءه يظل ممكنًا عبر مبادرات فردية، يضطلع فيها الواعون بأهمية الروابط الاجتماعية بمسؤولية إعادة وصل ما انقطع من علاقاتهم الأسرية والمجتمعية، وإعادة النظر في أنماط التواصل والمشاركة ضمن محيطهم، والانخراط في دوائر جديدة وغير تقليدية تعزز فرص اللقاء والتعاون والسعي إلى غايات مشتركة.
وفي هذه المرحلة الانتقالية التي نشهد فيها تراجع المؤسسات التقليدية وتفكك الروابط الاجتماعية، تبرز الحاجة إلى دور فاعل للفرد، يكون فيه لبنة في إعادة الاعتبار للقيم الجماعية، من خلال تعزيز صلته بعائلته وجيرانه، والمشاركة في المبادرات المجتمعية، والعمل على نشر ثقافة التعاون في محيطه اليومي. فبهذا الجهد المتضافر يمكن حفظ حرية الفرد دون التفريط في واجباته، وصون حقوق الجماعة دون أن تطغى على استقلاله.
غير أن الجهد الفردي، مع أهميته، لا يُغني عن ضرورة إحياء الجماعات الوسيطة وتمكينها؛ فالمؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية، والمساجد، والمنظمات التطوعية، تمتلك قدرة محورية على إعادة بناء التصور المجتمعي للعلاقات الاجتماعية. فهي قادرة على خلق فضاءات للتلاقي، وإعادة بناء الثقة، وتعزيز خطاب يرفع من شأن الترابط الاجتماعي، ويُقاوم تمجيد الفرد المنعزل المكتفي بذاته.
على سبيل المثال، يمكن للمدارس والجامعات أن تتجاوز وظيفتها المعرفية لتصبح مصانع لتشكيل الوعي الجمعي، من خلال مناهج تُرسّخ قيم التعاون، وممارسات وأنشطة تُجسّد هذه القيم عمليًا. كما ينبغي على المؤسسات الدينية أن تضطلع بمسؤولية تجديد خطابها، بحيث تُبرز التلازم بين العبادات والمعاملات، وتُبيّن الصلة الوثيقة بين الصلاة وصلة الرحم، وبين الزكاة والتكافل الاجتماعي، وغير ذلك من المعاني التي تُعيد الربط بين الدين والمجتمع.
- الانخراط في أحداث الأمة الكبرى:
في السياق الإسلامي التقليدي، كان النموذج السائد هو نموذج “الجسد العضوي”[12]، حيث تُدرَك الأمة ككيان متكامل يتماسك أفراده على أساس قيم ومعايير ومرجعية موحّدة، ويتأثر بعضه ببعض على نحو مباشر. فلم يكن الفرد منفصلًا عن قضايا أمّته، بل كان يرى في انخراطه فيها امتدادًا طبيعيًا لانتمائه الديني والأخلاقي. وقد رسّخ هذا النموذج روح التكافل والتضامن، وجعل من الاهتمام بالشأن العام واجبًا مشتركًا لا مجرد خيار شخصي.
ومع أن هذا النموذج تراجع في العقود الأخيرة لصالح أنماط من الفردانية والانكفاء على الذات، إلا أن الأحداث الكبرى، خاصة تلك التي تمسّ الوجدان الجمعي بعمق، قادرة على بعث هذا الحس الجماعي من جديد، فتعود مشاعر الانتماء والمسؤولية، ويتقدّم فيه الوعي بهموم الأمة على هموم الذات. وفي ذلك دليل على أن الجماعية ليست حالة من الماضي، بل إمكانية حاضرة قابلة للاستدعاء حين تتوفر اللحظة الجامعة.
ومنذ بداية الطوفان، غدت القضية الفلسطينية نقطة التقاء يتجمّع حولها كثير ممن كانوا في السابق منغمسين في الفردانية، صاروا يتحدّثون عنها ويتساءلون عن الدور الذي يمكنهم أن يؤدّوه. وهكذا، بدأنا نشهد كيف أن المعاناة المشتركة تُذيبُ حواجزَ الأنانية، وتُعيدُ تشكيلَ الوعي الجمعي. بل إن كثيرا من المنهمكين في سباق تحقيق الذات وجدوا أنفسَهم يسألون: “ماذا يمكنني أن أقدّم؟” وذلك بعد أن كشفت هذه الأحداث زيف النموذج الغربي الذي يروج لإنسان منفصل عن محيطه. وحتى الخوارزميات التي كانت تقسمنا إلى “فقاعات” منعزلة، لم تستطع أن تمنع فيضان المشاعر الإنسانية التي اجتاحت العالم بأسره.
أعادتنا هذه الأحداث لمفهوم الأمة الذي كان يتآكل شيئاً فشيئاً، وأوقظت لدينا الإحساس بالمسؤولية الجماعية الذي غيّبته مظاهر الحياة الحديثة وآليات النظام الرأسمالي. فقد أذابت الخلافات المذهبية والفكرية والمناطقية، وأوقظت شعوراً موحّداً: بكوننا أمة واحدة.
ونموذج غزة في ذاته يُجسّد تجاوزا للفردانية ويؤسس لبناء روابط تراحمية صلبة أعانت الناس على الصمود في وجه حرب طويلة. فقد برزت منظومة من القيم المشتركة التي غدت جزءاً من الوعي الجمعي، وعلى رأسها الصبر والتحمل، حتى بات التواصي بالصبر سمة عامة، تمنح الأفراد القدرة على الاحتمال وتجاوز المحن. وكذلك التراحم؛ الذي يصل بالإنسان إلى تفضيل غيره على نفسه، وقد تجلّت صوره في تقاسم سبل العيش والطعام والمأوى، وفي رفض الطواقم الطبية مغادرة المستشفيات رغم الخطر. ثم تأتي المسؤولية؛ حيث لكل فرد دوره الذي يجب أن يؤديه مهما كانت التكاليف، والكل يسير نحو هدف مشترك واضح، فلا مجال لليأس أو التخلي عن الواجب[13].
إن ما حدث فيما بعد الطوفان يشكل فرصة لإعادة التفكير في قيم التضامن والمسؤولية المشتركة. فعندما نواجه أزمة جماعية بحجم ما يجري في غزة، فلا مناص من الانتماء إلى شيء يتجاوز الفرد. وهكذا تفعل القضايا الكبرى التي تُوقظ لدى الأفراد الشعور بالمصلحة العامة، وتدفعهم لإعادة تقييم دورهم في واقع أمتهم ومجتمعهم.
خاتمة:
ليست الفردانية مجرد نمط عيش حديث، بل هي تحوّل عميق طال جوهر التصوّرات عن الإنسان والمجتمع والعلاقات. فقد أدّت الفردانية، التي بالغت في تمجيد الذات وانكفاء الإنسان على رغباته الخاصة، إلى تفكيك كثير من الأواصر التي كانت تشكّل الحاضنة الاجتماعية في مجتمعاتنا، وأسهمت في إضعاف البنية الداخلية التي طالما ساعدت الأمة على تجاوز أزماتها.
وإن كان من الطبيعي أن تتبدّل البُنى الاجتماعية بتبدّل الأزمنة والسياقات، فإن تجاوز الفردانية السلبية لا يكون عبر الحنين إلى الماضي، بل من خلال إحياء القيم الجماعية الأصيلة. فبناء شبكات دعم اجتماعي فاعلة، وتعزيز التربية على التعاون، وتجديد الخطاب الديني والتربوي لمواجهة الانكفاء الفردي عبر ترسيخ قيم التكافل والتعاضد، وإعادة الاعتبار لقيمة العمل الجماعي في مؤسساتنا المجتمعية والتعليمية—كلها خطوات ضرورية لاستعادة قدرة الأمة على تجاوز هزائمها المتلاحقة.
يتطلب الأمر أيضا نقاشات موسعة وأبحاث معمقة حول كيفية إحياء ما اندثر من قيم جماعية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وكيفية إعادة غرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال الناشئة. كما نحتاج إلى تحديد ما هو مطلوب فعليًا من مؤسساتنا المختلفة، والبحث عن سُبل واقعية وفعّالة تعيد لمفهوم الأمة مكانتها الحقيقية في الوجدان والسلوك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحثة في العلوم السياسية.
[1] “وائل حلاق: الدولة والحرية وكيف تفكك المجتمع | بودكاست فنجان”، إذاعة ثمانية، يوتيوب،
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bwi8SZLFe2U
[2] إسماعيل عرفة، “عصر الأنا”، دار ديوان للنشر والتوزيع (الكويت، 2021):
[3] فاطمة علي عبود، “قراءة في كتاب “إسلام السوق” لـ “باتريك هايني”، رواء،
[4] أنور قاسم الخضري، “ظاهرة التدين الجديد وأثره في تمرير ثقافة التغريب”، مركز التأصيل للدراسات والبحوث (جدة، 2008): 34
[5] محمود أبو عادي، “عَلمَنة المُجتمع وعقلنة الدين: حَرَج المُتديّن والتديّن الفرديّ”، المنفى،
[6] المصدر السابق.
[7] عماد كوسا، “الأسرة الممتدة والأسرة النووية الحديثة”، غراس للإنتاج الفكري،
[8] إسماعيل عرفة، “عصر الأنا”:
[9] محمود أبو عادي، “هكذا تُبتذل الصحّة النفسيّة؛ المُشكلة ليست فيك، المُشكلة في الآخرين!” متراس، https://bit.ly/40Wm1oz
[10] محمد أمحزون، “السنن الاجتماعية في القرآن الكريم وعملها في الأمم والدول”، المجلد الأول، دار طيبة، (السعودية، 2011): 332-337
[11] المصدر السابق: 211-213
[12] نسبةً إلى الحديث النبوي ” مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى”
[13] رغداء زيدان، “نموذج غزة لتطبيق القيم وفهم ماهيتها!”، مدونات الجزيرة،
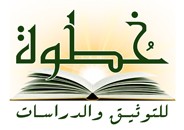 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies