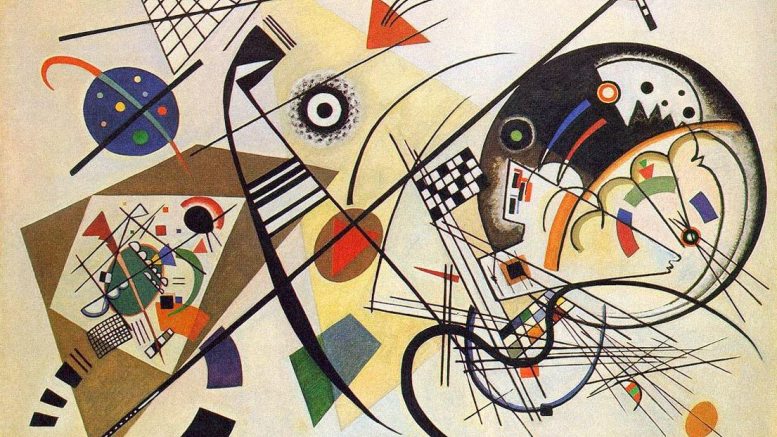الفطرة
الميثاق الأول والدلالة الصلبة في عالم سائل
أ. يارا عبد الجواد*
مقدمة
يتجلى في قوله تعالى “نسوا الله فأنساهم أنفسهم” توصيف شديد الدقة لحال الإنسان المعاصر في تخبطه واغترابه عن ذاته، ففي ظل الطابع الإلحادي الذي يصبغ مجمل الفكر الغربي المهيمن اليوم سادت حالة من السيولة والنسبية والعبثية والشك في الثوابت والبديهيات، كما تغلغل نوع من الشذوذ السلوكي والأخلاقي وفقدان المعنى والغاية، ففي باب الحقيقة أصبحت الحقيقة نسبية، وفي باب الأخلاق ًاصبحت الأخلاق شخصية، وفي باب المعنى أصبحت الدلالة حمالة أوجه. وبهذه النسبية المتفشية ضيع الإنسان الطرق الموصلة إلى الحق وبرد اليقين، وأول هذه الطرق وأجلاها طريق الفطرة الذي غاب تحت ركام هذا التشوه والانتكاس الإنساني والجنون الأخلاقي.
وفي هذا السياق المؤلم يجد الإنسان “الحديث” نفسه متعطشًا لليقين الذي يرفضه، وللإيمان الذي ينكره، وللعبادة التي يأباها، باحثًا عن معنى الوجود وغايته، متأرجحًا بين فطرته التي يحاول الانفكاك عنها وبين نزعاتها التي تغلبه في أحيان أخرى. من هذا المنطلق نسلط الضوء في هذا المقال على مفهوم الفطرة الإنسانية لبيان صلابته وبديهيته وقوته في الدلالة على الحق وتحصيل اليقين وعدم قدرة منكروه على الانفكاك من مقتضياته وهداياته.
أولًا: الفطرة من منظور الوحي
إنَّ توحيد الله – عز وجل – ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها، ميثاق مودع في كيانها، مودع في كل خلية حية منذ نشأتها، وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات، وفيه تشهد كل خلية بربوبية الله الواحد، ذي المشيئة الواحدة، المنشئة للناموس الواحد الذي يحكمها ويصرِّفها. قال تعالى: “أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” (الروم:30).
يقول الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية: (والفِطْرَةُ أصْلُهُ اسْمُ هَيْئَةٍ مِنَ الفَطْرِ وهو الخَلْقُ مِثْلَ الخِلْقَةِ كَما بَيَّنَهُ قَوْلُهُ “الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها” أيْ: جَبَلَ النّاسَ وخَلَقَهم عَلَيْها، أيْ: مُتَمَكِّنِينَ مِنها. ومَعْنى فَطَرَ النّاسَ عَلى الدِّينِ الحَنِيفِ أنَّ اللَّهَ خَلَقَ النّاسَ قابِلَيْنِ لِأحْكامِ هَذا الدِّينِ وجَعَلَ تَعالِيمَهُ مُناسِبَةً لِخِلْقَتِهِمْ غَيْرَ مُجافِيَةٍ لَها، غَيْرَ نائِينَ عَنْهُ ولا مُنْكِرِينَ لَهُ مِثْلَ إثْباتِ الوَحْدانِيَّةِ لِلَّهِ، لِأنَّ التَّوْحِيدَ هو الَّذِي يُساوِقُ العَقْلَ والنَّظَرَ الصَّحِيحَ، حَتّى لَوْ تُرِكَ الإنْسانُ وتَفْكِيرُهُ ولَمْ يُلَقَّنِ اعْتِقادًا ضالًّا لاهْتَدى إلى التَّوْحِيدِ بِفِطْرَتِهِ. الفِطْرَةَ هي النِّظامُ الَّذِي أوْجَدَهُ اللَّهُ في كُلِّ مَخْلُوقٍ، والفِطْرَةُ الَّتِي تَخُصُّ نَوْعَ الإنْسانِ هي ما خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ جَسَدًا وعَقْلًا، فَمَشْيُ الإنْسانِ بِرِجْلَيْهِ فِطْرَةٌ جَسَدِيَّةٌ، ومُحاوَلَتُهُ أنْ يَتَناوَلَ الأشْياءَ بِرِجْلَيْهِ خِلافَ الفِطْرَةِ الجَسَدِيَّةِ، واسْتِنْتاجُ المُسَبِّباتِ مِن أسْبابِها والنَّتائِجِ مِن مُقَدِّماتِها فِطْرَةٌ عَقْلِيَّةٌ، ومُحاوَلَةُ اسْتِنْتاجِ أمْرٍ مِن غَيْرِ سَبَبِهِ خِلافُ الفِطْرَةِ العَقْلِيَّةِ، وهو المُسَمّى في عِلْمِ الِاسْتِدْلالِ بِفَسادِ الوَضْعِ، وجَزْمُنا بِأنَّ ما نُبْصِرُهُ مِنَ الأشْياءِ هو حَقائِقُ ثابِتَةٌ في الوُجُودِ ونَفْسُ الأمْرِ فِطْرَةٌ عَقْلِيَّةٌ، وإنْكارُ السُّوفِسْطائِيَّةِ ثُبُوتَ المَحْسُوساتِ في نَفْسِ الأمْرِ خِلافَ الفِطْرَةِ العَقْلِيَّةِ. وكَوْنُ الإسْلامِ هو الفِطْرَةُ، ومُلازَمَةُ أحْكامِهِ لِمُقْتَضَياتِ الفِطْرَةِ صِفَةٌ اخْتَصَّ بِها الإسْلامُ. فالإسْلامُ عامٌّ خالِدٌ مُناسِبٌ لِجَمِيعِ العُصُورِ وصالِحٌ لِجَمِيعِ الأُمَمِ، ولا يَسْتَتِبُّ ذَلِكَ إلّا إذا بُنِيَتْ أحْكامُهُ عَلى أُصُولِ الفِطْرَةِ الإنْسانِيَّةِ لِيَكُونَ صالِحًا لِلنّاسِ كافَّةً ولِلْعُصُورِ عامَّةً وقَدِ اقْتَضى وصْفُ الفِطْرَةِ أنْ يَكُونَ الإسْلامُ سَمْحًا يُسْرًا لِأنَّ السَّماحَةَ واليُسْرَ مُبْتَغى الفِطْرَةِ. وفِي قَوْلِهِ “الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها” بَيانٌ لِمَعْنى الإضافَةِ في قَوْلِهِ “فِطْرَةَ اللَّهِ” وتَصْرِيحٌ بِأنَّ اللَّهَ خَلَقَ النّاسَ سالِمَةٌ عُقُولُهم مِمّا يُنافِي الفِطْرَةَ مِنَ الأدْيانِ الباطِلَةِ والعاداتِ الذَّمِيمَةِ وأنَّ ما يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الضَّلالاتِ ما هو إلّا مِن جَرّاءِ التَّلَقِّي والتَّعَوُّدِ، وقَدْ قالَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم “يُولَدُ الوَلَدُ عَلى الفِطْرَةِ ثُمَّ يَكُونُ أبَواهُ هُما اللَّذانِ يُهَوِّدانِهِ أوْ يُنَصِّرانِهِ أوْ يُمَجِّسانِهِ كَما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيها مِن جَدْعاءَ”.)[1]
وفي تفسير قوله تعالى “لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ” (التين-4)، يقول ابن عاشور أيضًا:
(وتُفِيدُ الآيَةُ أنَّ الإنْسانَ مَفْطُورٌ عَلى الخَيْرِ وأنَّ في جِبِلَّتِهِ جَلْبَ النَّفْعِ والصَّلاحِ لِنَفْسِهِ وكَراهَةَ ما يَظُنُّهُ باطِلًا أوْ هَلاكًا، ومَحَبَّةَ الخَيْرِ والحَسَنِ مِنَ الأفْعالِ، لِذَلِكَ تَراهُ يُسَرُّ بِالعَدْلِ والإنْصافِ، ويَنْصَحُ بِما يَراهُ مَجْلَبَةً لِخَيْرِ غَيْرِهِ، ويُغِيثُ المَلْهُوفَ ويُعامِلُ بِالحُسْنى، ويَغارُ عَلى المُسْتَضْعَفِينَ، ويَشْمَئِزُّ مِنَ الظُّلْمِ ما دامَ مُجَرَّدًا عَنْ رَوْمِ نَفْعٍ يَجْلِبُهُ لِنَفْسِهِ، أوْ إرْضاءِ شَهْوَةٍ يُرِيدُ قَضاءَها، أوْ إشْفاءِ غَضَبٍ يَجِيشُ بِصَدْرِهِ، تِلْكَ العَوارِضُ تَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ فِطْرَتِهِ زَمَنًا، ويَهَشُّ إلى كَلامِ الوُعّاظِ والحُكَماءِ والصّالِحِينَ ويُكْرِمُهم ويُعَظِّمُهم ويَوَدُّ طُولَ بَقائِهِمْ. فَإذا ساوَرَتْهُ الشَّهْوَةُ السَّيِّئَةُ فَزَيَّنَتْ لَهُ ارْتِكابَ المَفاسِدِ ولَمْ يَسْتَطِعْ رَدَّها عَنْ نَفْسِهِ انْصَرَفَ إلى سُوءِ الأعْمالِ، وثَقُلَ عَلَيْهِ نُصْحُ النّاصِحِينَ ووَعْظُ الواعِظِينَ عَلى مَراتِبَ في كَراهِيَةِ ذَلِكَ بِمِقْدارِ تَحَكُّمِ الهَوى في عَقْلِهِ. ولِهَذا كانَ الأصْلُ في النّاسِ الخَيْرَ والعَدالَةَ والرُّشْدَ وحُسْنَ النِّيَّةِ عِنْدَ جُمْهُورٍ مِنَ الفُقَهاءِ والمُحَدِّثِينَ.)[2]
إذن إذا أردنا أن نقدم تعريفا للفطرة يمكننا القول بأنها قُوًى واندفاعاتٌ مودَعَةٌ في نفسِ الإنسانِ، تظهرُ آثارُها أثناءَ نموِّهِ وتفاعلِهِ معَ بيئتِهِ، بدءًا مِن الْتِقامِهِ ثديَ أُمِّهِ ليرضعَ، ثمَّ انجذابِهِ للحقائقِ الكبرى والأخلاقِ السَّليمةِ.[3] وعلى الرغم من وضوح مفهوم الفطرة بالنسبة للنفس البشرية إلا أن الغوص في دلالاته بمستوياتها المختلفة يجلي الأمر أكثر ويمحوا عنه أي غموض.
ثانيًا: هدايات الفطرة ودلالاتها المختلفة
لقد خلق الله عزوجل الإنسان وهداه بالفطرة إلى مجموعة من الهدايات، كما في قوله تعالى: “قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ” (طه -50)، فإن مما هدى الله به الإنسان بفطرته:
أ- الإقرار بأن لهذا الكون خالقًا مدبرًا والشعور بالحاجة إليه، واللجوء إليه عند الشدائد.
ب- المبادئ العقلية الأولية: من القضايا التي يدركها الإنسان من نفسه ضرورة معقولات معينة ذات طبيعة خاصة اصطلح على تسميتها بالعلوم الضرورية، أو المبادئ الفطرية الأولية، أو البدهيات العقلية؛ وهي معقولات نظرية تهجم على النفس من غير توسط نظر واستدلال، بخلاف نمط آخر من المعقولات اصطلح على تسميتها بالعلوم النظرية؛ وهي ما يمكن تحصيله من خلال النظر والاستدلال.
والفرق بين هذه وتلك أن العلوم الضرورية يحسها الإنسان من نفسه ضرورة، ويجد لأجل ذلك من نفسه ممانعة شديدة لمحاولات التشكيك فيما تتضمنه من بدهيات، بخلاف العلوم النظرية، التي قد تعرض له فيها الشبهات والإشكالات فيدافعها بالنظر والاستدلال. بل إن من طبيعة هذه العلوم الضرورية استغناءها عن البرهنة والتدليل، بل إليها المرجع في العملية الاستدلالية؛ فالعلوم النظرية إنما تُردّ إلى العلوم الضرورية. وهذه الضرورات العقلية تفرض سؤالًا: ما الذي، أو مَن الذي أودع هذه المعاني الفطرية في النفس؟ ويبدو أن الإجابة المعقولة هي: أن الله تعالى هو الذي علّم الإنسان هذه المعاني، وأودعها في نفسه.
وحتى يتجاوز الخطاب الإلحادي مأزق هذا السؤال، سعى للتشكيك في أصل فطرية هذه المعرفة وموضوعيتها. وكانت النتيجة الحتمية لإهدار المبادئ العقلية الضرورية، وإلغاء الطبيعة الموضوعية لها هي إهدار كل العمليات العقلية، وإهدار إمكانية التواصل والإقناع بين الناس، وإهدار العلوم الطبيعية التجريبية، فهذه جميعًا لا يمكن أن تقوم إلا على قاعدة تعترف بوجود تلك المبادئ الضرورية، وتقول بقيمتها المتعالية والمتجاوزة للوجود الإنساني.[4]
ج- النزعة الأخلاقية: من المعاني الفطرية التي يجدها الإنسان في نفسه تلك النزعة الأخلاقية المتجذرة، التي يدرك من خلالها ليس فقط حسن الأخلاق من رديئها؛ وإنما يجد من نفسه إدراكًا ضروريًا بأن لهذه القيم الأخلاقية معانٍ موضوعية، تعطي لهذه الأخلاق قيمتها الحقيقية بعيدًا عن اعتبارات النسبية. فهي حقائق موضوعية متجاوزة للوجود الإنساني، بل للوجود المادي، فسواء وُجد الإنسان أو لم يوجد، وسواء وُجد الكون أو لم يوجد، فإن هذه القيم الأخلاقية محافظة على قيمتها الموضوعية.
وهنا يأتي السؤال البدهي: مَن الذي أودع هذه النزعة الأخلاقية في النفس؟ أي مَن الذي أودع في النفس الشعور الضروري بأن للعدل قيمة موضوعية تجعل منه قيمة أخلاقية إيجابية في مقابل الظلم والذي يستشعر الإنسان أنه قيمة سيئة؟ هل بالإمكان تقديم رؤية فلسفية أخلاقية متماسكة تجيب عن هذا السؤال في ضوء رؤية تستبعد وجود الله تعالى؟ بمعنى آخر: هل بالإمكان أن يكون ثمة خير موضوعي دون وجود الله تعالى؟
كثير من الملاحدة يردون بالإيجاب زاعمين أن الملحد يمكن أن يكون على قدر من المحافظة الأخلاقية، وأن يمارس في حياته أفعالا حسنة، من دون إيمان بالله. لكن السؤال لم يكن “هل بالإمكان أن يكون المرء خيرًا بدون الإيمان بالله؟ وإنما السؤال المطروح هو هل للقيم الأخلاقية الموضوعية وجود بدون وجود الله تعالى؟ فإن لم تكن موجودة فلا مجال لأن يكون الإنسان خيرًا أو شرًا، فوجود القيم ضروري لكي يمكن أن يتصف الإنسان بها ابتداء.
هذه المسألة تكشف لنا عن واحدة من أعمق المشكلات في بنية الفكرة الإلحادية، وهي مشكلة أعمق من مجرد الاختلاف في وسائل التعرف على حسن الأخلاق من قبيحها، بل في وجود القيم الأخلاقية ذاتها. تلك القيم المطلقة، المتعالية على وجود الإنسان أصلًا، والتي تجعل العدل أمرا مرغوبا، كما تجعل الظلم والعدوان أمورا مرفوضة، ليس بالنسبة إلى مجتمع إنساني معين، أو سياق زمان محدد، بل على نحو مطلق.
إن الأمر شبيه بطفل يجر قطة من ذيلها، فتنبهه أمه إلى عدم فعل ذلك، فيسألها: لماذا؟ فتجيب: لأن ذلك يؤذيها. فيسألها الطفل: وما المشكلة في إيذائها؟ فتجيب: لأنه من الخطأ إيذاء أي حيوان بلا مبرر ولا مصلحة؟ يستمر الطفل في السؤال: ولماذا من الخطأ إيذاء أي حيوان بلا مبرر ولا مصلحة؟ لتعبر الأم عن ضجرها وتعلن: هو خطأ وكفى!
نعم هو خطأ، ولكن يظل السؤال: ما المعيار الذي تحدد على وفقه خطأ ما هو خطأ، هذا هو السؤال، الذي تبدو التيارات الإلحادية عاجزة عن تقديم جواب له، ومن هنا يمكن صياغة هذا المعنى صياغة برهانية كدليل على وجود الله عز وجل؛ فإذا كان الله غير موجود؛ فإن القيم الأخلاقية لن تكون موجودة، ولكن هذا النمط من القيم الأخلاقية موجود على نحو ضروري، وبالتالي فإن الله – تبارك وتعالى – موجود.[5]
د- الجانب الغريزي: إن الظواهر المدهشة التي نراها والمتعلقة بالنزعات الغريزية العجيبة لدى الإنسان، بل والحيوان أيضًا، مثل غريزة الأمومة والتقام الطفل ثدي أمه فور ولادته تثير تساؤلات: من الذي هدى الطفل لالتقام ثدي الأم والارتضاع؟ ومن الذي زرع في قلب الأم غريزة الأمومة لرعاية أطفالها؟ ومن الذي علّم الطيور الهجرة في وقت معين ولمكان معين؟ ومن الذي وهب الأحياء جميعًا غريزة حب البقاء؟ ومن الذي زرع في النفوس نزعة حب الجمال؟
هذه الظواهر كسابقتها من المعاني الفطرية تستدعي سؤالًا: كيف وجدت هذه النزعات؟ ومن الذي أودعها في النفس؟ ومرة أخرى ليس لدى الملحد من إجابة سوى بالإحالة إلى الداروينية، التي تفترض أن هذه الغرائز هي مما أوجدته عملية التطور لمصلحة بقاء الكائن الحي. ولكن السؤال يظل قائمًا: لماذا وجدت هذه الغرائز أصلًا؟ إن هذه الغرائز تجد تفسيرها في وجود الله تعالى؛ فالله تعالى هو واهبها، وما رحمة الأم على سبيل المثال إلا جزء يسير جدًا من رحمته تعالى التي جعلها بين الخلائق، فبها يتراحم الخلق.
وقد نبه موسى – عليه السلام – في أثناء مجادلته لفرعون على أن الله هو الموجد للبعد الغريزي في الخلائق، كما جاء في سورة طه في قصة المناظرة “قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى (49)، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (50)“، أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، الدال على حسن صنعه؛ من كبر الجسم وصغره وتوسطه، وجميع صفاته، (ثُمَّ هَدَى) كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق يسعى لما خلق له من المنافع، وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به من ذلك.[6]
ه- الشعور بالغائية: من المعاني الفطرية الموجودة عند الإنسان: ذلك الشعور الوجداني العميق بوجود غاية، ومنه تنبثق تلك الأسئلة العميقة: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ ولماذا أنا هنا؟ وإلى أين المصير؟ هذه الأسئلة الفطرية العميقة تميز الإنسان عن الحيوانات، فإذا كانت الحيوانات تتحرك وفْقًا لغرائزها، فإن ما يحرك الإنسان شعور فطري بتلمس الغاية من وجوده ومن الحياة.
هذا الواقع البشري، وتلك الأسئلة الفطرية لا معنى لها مطلقًا في ظل التصور الإلحادي المنكر لوجود الله، فإذا كان الإنسان وليد صدفة عمياء، ونتاج للمادة والزمن والصدفة، فإن مثل هذه التساؤلات تكون بغير قيمة، بل تكون عديمة المعنى. وهو ما يصرّح به ريتشارد دوكنز وبقية الملاحدة، واصفين هذه التساؤلات بالسخيفة، وهي تساؤلات بلا معنى فعلًا في ظل ذلك التصور الإلحادي. فالبحث عن غرض مطلق للحياة هو أمر بلا معنى، في ظل إنكار وجود الله.
و- الشعور بالإرادة الحرة: من الجوانب الفطرية التي يجدها الإنسان من نفسه ذلك التفريق الضروري بين أفعاله الاختيارية وما يصدر عنه اضطرارًا؛ فحين يرفع الإنسان كأس ماء لفمه، أو يحمل حقيبته، أو يركب السيارة؛ فإنه يستطيع أن يميز بسهولة هائلة الفرق بين جنس هذه الأفعال، وبين نبضات قلبه، وجريان الدم في عروقه، أو ما يصيبه من رعشة برد شديد. هذا الشعور الفطري – بأن لدى الإنسان إرادة حرة يجدها من نفسه ضرورة – بحاجة إلى تفسير.
ويبدو الخطاب الإلحادي عاجزًا – في ظل نظرته المادية للوجود – عن تقديم تفسير لظاهرة الإرادة الحرة. فإذا كانت أفعالنا الاختيارية هي مجرد نتاج تفاعلات بيوكيميائية، وعبارة عن نبضات كهربائية لشبكة واسعة من الخلايا العصبية ليس إلا، وهذه بطبيعة الحال محكومة بقوانين صارمة؛ فكيف يمكن أن توجد إرادة حرة؟
إن النظرة المادية المحضة للوجود والحياة، من الطبيعي أن تتصور الإرادة الإنسانية تصورا جبريا؛ فالكون بكل ما فيه – بحسب تصور الإلحاد- محكوم بقوانين مادية صارمة، والإنسان بعواطفه ومشاعره وكيانه كله لا يستطيع الخروج عن قبضتها، بل إن اختياراته وإرادته ليست إلا تفاعلًا كيميائيًا محكومًا في الدماغ، حتى إن توهم المرء أنه صاحب الاختيار؛ فإن اختياره يكون محددا سلفًا في ضوء ذلك التفاعل.
وآثار وتداعيات مثل هذا التصور الجبري للإرادة الإنسانية كثيرة وخطيرة؛ بسبب ما تؤول إليه من إشكالات أخلاقية وأسئلة حول المسؤولية الفردية، فإذا كان المجرم مجبرًا على ما يفعل؛ فما المبرر الأخلاقي لمعاقبته؟ وإذا كان المحسن مجبرًا على إحسانه؛ فما المبرر لمكافأته وشكره والثناء عليه؟ وما المبرر للامتعاض من وجود الشرور البشرية، فالكل عبارة عن روبوتات، مبرمجة لتؤدي أعمالًا محددة، لا تستطيع الانفكاك عنها؟
الأغرب من ذلك هو سعي الملاحدة – بعد هذا كله – إلى تبني ألقاب من نوعية (المفكرون الأحرار) (Free Thinkers) للتعبير عن هويتهم الفكرية، في حين أن الرؤية الإلحادية عاجزة عن إقامة قاعدة علمية يمكن أن يتأسس عليها أي نشاط فكري حر، فضلًا عن هذا التنكر الصريح للإرادة الإنسانية الحرة والتي بدونها لا يكون للنشاط الفكري قيمة موضوعية، فالإنسان في ظل هذه الرؤية لا يمكن أن يكون مفكرًا ولا أن يكون حرًا.[7]
وبعد بيان هذه الهدايات الفطرية نضيف بعض النتائج الذي توصل لها العلم التجريبي والتي تثبت لمنكري وجود الأفكار الفطرية من أصحاب المذاهب المادية فساد معتقدهم بدليل تجريبي من النوع الذي يفضلونه. فقد أثبت البروفسور جستِن باريت Justin Barrett من خلال بحث أجراه في جامعة أوكسفورد وجود نزعة إيمانية فطرية داخل الإنسان، حيث طبق دراسته على أطفال في أعمار مبكرة على مدار سنوات ليخرج بنتيجة تؤكد أن الأطفال لديهم القابلية المُسبقة للإيمان بـ “كائن فائق”، وذلك لأنهم يعتبرون أن كل ما في هذا العالم مخلوق لسبب ما، وعبر باريت عن ذلك بقوله “إننا إذا وضعنا مجموعة من الأطفال على جزيرة لينشأوا بمفردهم، فأعتقد أنهم سيؤمنون بالله”. وقد وضع باريت نتائج أبحاثه في كتاب نشر عام 2012، كما نشرت عنه وسائل إعلام مختلفة، ففي حوار مع الـ بي. بي. سي قال “إن غالبية الأدلة العلمية في السنوات العشر الماضية تظهر أن الكثير من الأشياء تدخل في البنية الطبيعية لعقول الأطفال بشكل مختلف عما ظننا مسبقًا، من ضمنها القابلية لرؤية العالم الطبيعي على أنه ذو هدف، ومصمم بواسطة كائن ذكي مُسبب لذلك الهدف.” وقد انضم إلى البروفسور باريت باحث آخر، هو البروفسور جوناثان لانمان Jonathan A. Lanman من جامعة أكسفورد، الذي وضع بحثًا بعنوان “علم الإيمان الديني” The Science of Religious Beliefs، وتساءل فيه “إذن من أين جاءت هذه الاعتقادات الفطرية بوجود الخالق؟ نحن لا نستطيع القول بأنهم (الأطفال) تعلموها من المجتمع وذلك لأنها اعتقادات فطرية، وكذلك الدراسات أكدت أنها لا تعتمد على ضغوطات المجتمع، وأنها مشتركة بين مختلف الثقافات”.[8]
وبالطريقة نفسها، تقول الباحثة في علم نفس النمو والأديان بجامعة أكسفورد أوليفيرا بيتروفيتش Olivera Petrovich إن “الإيمان بالله ينمو طبيعيًا، أما الإلحاد فهو بالتأكيد موقف مكتسب”[9]. وهو ما يؤكد المقولة الشهيرة المنسوبة إلى المؤرخ الإغريقي بلوتارخ، عندما قال “لو سافرنا عبر العالم، فمن الممكن أن نجد مدنًا بلا أسوار، بلا حروف، بلا ملوك، بلا ثروات، بلا عملات، بلا مدارس ومسارح، ولكن أن نجد مدينة بلا معبد، وبلا ممارسات وعبادة وصلاة ونحوه، فلم ير أحد ذلك قط”[10]
ثالثًا: بين التنكر للفطرة ومقتضياتها والعجز عن الانفكاك عنها:
إن فطرة الإنسان السوية تقتضي لزومًا الإيمان بالله عزوجل خالقًا مدبرًا، وتوحيده وعبادته. أما تنكر الملحدون له فهو بمثابة خروج عن الفطرة السليمة. ولا عجب أن يكون أكثر مَن ينتحرون هم من الملحدين لأن الملحد الأمين في رؤيته التي لا يلابسها شيء من إيمان المؤمنين بالله، لا سبيل له غير سبيل العدمية، والقول بالعدمية الوجودية مآله نهاية كل معنى وقيمة، وخراب كل شيء في الذهن والواقع؛ فلا يبقى من الوجود غير صورة. وقد أدرك نيتشه مآل العالم بعد نهاية الإيمان بالله واختصار الوجود في المادة، وهو ما جعله يتنبأ أنه في القرنين التاليين (العشرين والواحد والعشرين)، ستسود العدمية في أوروبا، ويتمكن الخراب من ثقافتها. ولذلك يُعدّ نيتشه اليوم أبرز فلاسفة ما بعد الحداثة التي تنكر الحقيقة وتراها سرابًا لا يُنال، ولا ترى حياة الإنسان سوى شرارة توشك بعد وميضها أن تنطفئ؛ ليبقى الظلام هو الحاكم، وليسود الفراغ الشاحب.
ورغم وضوح كلام نيتشه عن موت الإله والمعنى، وكذلك كلام ريتشارد دوكينز عن انعدام القيمة، إلا أننا نجد مع ذلك في كتاباتهم حديثًا عن المعنى الحي، والقيم الإيجابية، وهم يناضلون تحت لافتات إنصاف الإنسان والشعوب والحقيقة؛ وذلك لعجز فلاسفة العدمية وأنصارها عن إقامة فلسفة متصلة بالواقع تستغني عن المعنى والقيم. وهنا يكون المرء في حيرة بين أن يصدّق أئمة الإلحاد في نصرتهم للعدمية؛ فينتهي كل إمكان للكلام والجدال، أو أن يصدّق إيمانهم بالمعنى والقيمة، وعندها ننكر عليهم إلحادهم؛ فهم لا يعرفون ما يلزم عن إلحادهم، أو لا يجرؤون على التزام لوازمه.
فنحن نرى في الغرب ملاحدة يجوبون البلاد لإنقاذ المنكوبين في أوقات الزلازل والفيضانات، وكذلك يحرص بعضهم على نفع البشرية بصور مختلفة، وهذا في حقيقته تناقض عجيب لأن الإلحاد لا يعترف بالخير والشر، فمثل هؤلاء يخونون إلحادهم لأنهم يسرقون من رصيد الفطرة الأولى الخيرة والثقافة الدينية السائدة في بيئتهم، ليكون ذلك حافزًا لفعلهم، وإن لم يعترفوا ظاهرًا بذلك، أو قد يكونون لم يكتشفوا تناقضهم في ذلك، فهم بلا وعي يدورون في فلك حقائق الأديان، ولا يغادرونها إلا قليلا.[11]
فالإنسان كائن ميتافيزيقي بطبيعته لا يمكنه أن ينفك عن حقيقة احتياجه وفقره لخالقه، وعطشه الروحي ونداء الفطرة الذي يلح عليه، وفي هذا السياق نجد أن هناك أطروحات “تلتزم بالإلحاد، وتجاهر بالعداء للأديان، وتنسب إليها معظم شرور العالم، وفي الوقت نفسه تحاول اقتباس مضمون “روحاني” نقي، فعلى سبيل المثال في عام 2006، نشر الفيلسوف الفرنسي الملحد أندريه كونت سبونفيل كتابًا بعنوان “روح الإلحاد -مقدمة لروحانية بلا إله”، وفي عام ٢٠١١م ألقى الكاتب البريطاني المعروف آلان دي بوتون كلمة شهيرة في منصة تيد (TED) كان هدفه منها الترويج لنسخة محدثة من الأيديولوجيا الإلحادية تحاول تفادي “الضياع الروحي” وفقدان المعنى بـ “سرقة” بعض المضامين الدينية، كالتوجيه والمواساة والأخلاقيات، وطريقة الوعي بالزمن، وكذلك الطقوس أو الشعائر التي تمزج الفكرة والمعتقد بسلوك محدد وحركات معينة تربط الروح بالجسد، وقد طور بوتون هذه الأفكار ونشرها في كتابه “الدين للملحدين: دليل غير المؤمنين لأغراض الدين” عام ٢٠١٢، وفي عام ٢٠١٤ نشر الملحد الأمريكي المعروف سام هاريس كتابًا بعنوان “الصحوة – دليل في الروحانية بلا أديان”، يقول في مقدمته إنه يحاول “استنباط حقائق نفسية هامة” من تحت ركام الأباطيل في الأديان لكن من غير تزييف، والفكرة الأساسية في الروحانية الملحدة التي يبشر بها هاريس تدور حول الوعي بالأنا والتأمل، وتقديم بعض التقنيات لطرائق لهذا الوعي تسمح له بـ”السمو فوق حدود الذات”، التي استفادها من تجاربه الطويلة مع الرهبان والمعلمين البوذيين، وتجارب اليوجا، وبرامج العزلة والصمت الطويل لأيام وأشهر. وفي هذا السياق أيضًا نجد الكثير من محاولات الملحدين صناعة مقدسات تسد فراغهم الروحي بالموسيقى أو بممارسة بعض الطقوس من ديانات مختلفة مثل اليوجا والريكي وغير ذلك.[12]
وهذا كله يشهد بسطوة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، تلك الفطرة التي تنزع لخالقها، وتنزع للخلود، وللحياة بعد الموت، وتنزع للأخلاق الحسنة، وهي الأرض الخصبة لتلقي الوحي وتحقيق العبودية لله عزوجل من خلاله.
وفي هذا السياق تقول الكاتبة إليزابيث كينج في مقال لها بعنوان “أنا ملحدة فلماذا لا أستطيع التخلص من الله”: وعلى الرغم من إلحادي لعقد من الزمان، دائما كان الإله بطريقة ما يجد طريقًا إلى عقلي، فكرة وجود الله تزعجني، وتجعلني أفكر أني لم أعط معتقداتي حقها كما يجب علي وكما أحب. ربما من دون وعي أخاف من النار، وأريد الذهاب إلى الجنة عند موتي، ولكن شعوري بشيء لا أؤمن به يجلب لي الحيرة والإحباط، والذي يزيد ذلك أن شخصية الله تكون حاضرة غالبًا عندما أكون محبطة مسبقًا. فدائما إذا كنت أسوّف لشيء، وجاهدت نفسي لأنهيهِ قبل موعده، وبدأت أشعر بالإحباط، أقول: “لماذا يا الله لماذا؟ وأيضًا عندما يأتي رجل ويظنني لا أفهم، أغضب، وأقول في نفسي: “أقسم بالله!” علما بأني لا أقولها كمزحة، أو لأني أتكلم بلهجة عامية، لكنها عادة لا أكثر، فبعد أن قضيت الكثير من حياتي وأنا أؤمن بالله فأنا أتوقع وجود إجابات لهذه الأسئلة، بالرغم من اعتقادي في عدم وجود إله في السماء ليجيبني، ولكن لا يسعني إلا السؤال”.[13]
وهنا نذكر ما قاله الدكتور سامي عامري في كتابه “الإلحاد في مواجهة نفسه”: لا يوجد ملاحدة – على الحقيقة الكاملة – أصلًا؛ فالإلحاد تصور لا يمكن أن يعيشه الإنسان؛ لأنه لا يمكن أن يصدقه، إن لحظة الوعي الصادقة بالإلحاد في صدر الملحد، والتي تقترن بالرغبة في أن يعيش الملحد طبق تصوره ويهتدي بمعالمه، لا بد أن تقترن بضغطة زر المسدس في اتجاه الرأس، أو أن يرمي الملحد نفسه من شاهق لا فرار”.[14]
فالملحد الذي يريد أن يتسق مع إلحاده ليس أمامه سوى العدمية في كل شيء، وهذه فكرة يستحيل أن يتعايش معها الإنسان، فيكون الانتحار هو الحل المنطقي الوحيد. أما النماذج التي نراها لأناس يقولون إنهم ملحدون ثم هم يتصرفون بقدر من الأخلاق أو يتبنون معاني وأهداف للحياة خاصة بهم فهؤلاء يعيشون تناقض مع إلحادهم لأن الإلحاد في حقيقته يلغي المعنى والأخلاق. وهذا التناقض الذي يعيشه الملحد المتنكر لفطرته يرينا آية من آيات الله تتحقق، وهي أنه مهما حاول الإنسان أن يبدل فطرته فلن يستطيع مهما بلغ بها الحال في الانتكاس فالله عزوجل يقول “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الروم-30)”.[15]
رابعا: الفطرة وتحصيل اليقين
إن الفطرة ليست مجرد ميل غامض، بل هي بنية معرفية وقيمية مركوزة في طبيعة الإنسان، تمكّنه من التعرف على الحقائق الكبرى — وأهمها الإيمان بالله ووحدانيته — من غير حاجة أولية إلى برهنة استدلالية معقدة، ومن هنا تكمن قوتها الدلالية وصلابتها، لأنها يستدل بها ولا يستدل عليها، فهي تمثل المستوى البدهي من المعرفة، حيث يُدرك الإنسان بعض الحقائق إدراكًا مباشرًا غير مكتسب، كإدراكه لوجود خالق، أو التمييز المبدئي بين الخير والشر. لتكون هذه المعارف الأولية بمثابة “المقدمات اليقينية” التي تبنى عليها بقية الاستدلالات العقلية. ومن هنا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم، أن الفطرة تمثل أصلًا معرفيًا لا يتطرق إليه الشك إلا بالفساد أو الانحراف. ولذلك فالفطرة تعمل كضمان لليقين فهي كالمصدق الداخلي للمعرفة حيث تمنح الإنسان الاطمئنان الداخلي لصحة ما يدركه من حقائق كلية، فإذا كانت الفطرة سليمة (لم تتلوث بالشبهات أو الأهواء أو العادات المحرّفة)، فإن إدراكها يكون ضروريًا يقينيًا.
ومما يؤكد هذا قضية “المعرفة النازلة” عند شيخ الإسلام ابن تيمية ويعني بها أن سير المعرفة البشرية نازل لا صاعد، بمعنى: أن التأسيس الأول للمعرفة لا بد أن يبدأ من “المعرفة العليا”، وهو: “العلم الإلهي” الذي يتعلق بضرورة وجود الله وربوبيته وألوهيته، فمنه تستمد المعرفة البشرية ضرورتها، وتتفتح على حقائق الوجود والمعرفة، وهذا بخلاف مَن يجعل النفس البشرية مستندًا أوليًا للمعرفة البشرية، عليها تتأسس، ومنها تصعد إلى معرفة حقائق الوجود والمعرفة، وأبرز مسوّغات نزول المعرفة في سيرها المنهجي، وأول شاهد على هذا المعنى الفطرة النفسية ذاتها، فإن الفطرة المعرفية المركوزة المخلوقة دالة على خالقها وفاطرها وصانعها دلالة ضرورية من خلال مبدأ فطري أولي هو مبدأ السببية.
وفي هذا السياق يقول ابن تيمية: “العلم به أصل للعلم بكل ما سواه، والعلم بما سواه فرع للعلم به، باعتبارات متعددة، فلا يكون الإنسان عالمًا بغيره على الوجه الذي ينبغي، حتى يعلم ما به وجد وتحقق، وذلك لا يكون إلا مع العلم بالله تعالى، ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود – الذي لم يوجد بنفسه – ما به وجد، سواء سمي ذلك مؤثرًا أو فاعلًا أو علة فاعلة أو صانعًا أو ربًا، حتى ينتهي النظر إلى الله ﷻ، فحينئذ يقف الطالب؛ فأصول المعرفة العلمية والعملية راجعة إلى الإله الخالق، فإن من العلم به تتشعب أنواع العلوم، ومن عبادته تتشعب وجوه المقاصد الصالحة”.
فإذا كان الله سبحانه – بوجوده وعلمه – أصلًا للمعارف البشرية، فإن العلم به، وتوجّه الإرادة إليه أشد رسوخًا، وأبلغ ضرورة في النفس البشرية، من ضرورة المعارف الأولية الضرورية، رياضية كانت أم طبيعية، هذا ما صرّح به ابن تيمية بناء على ذاك الأصل، إذ يقول: “أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وأنه أشدُّ رسوخًا في النفس من مبدأ العلم الرياضي؛ كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي؛ كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين،” ويُعلِّل شدة رسوخ أصل العلم الإلهي، المتعلق بمعرفة الله وإرادته في النفس، وكونه أمكَنَ في الضرورة من المبادئ الأولية، بأن ضرورة العلم الإلهي قد تغلغلت في النفس وتمكنت منها من جهتين: من جهة الضرورة العقلية العلمية، ومن جهة الضرورة الإرادية النفسية، فضرورة وجود الله وربوبيته ضرورة مزدوجة، لكن ضرورة المبادئ الأولية ضرورة عقلية وعلمية مجردة، ولذلك كان أصل العلم الإلهي أشد لزومًا للنفس دون باقي الضرورات، وفي هذا يقول: «هذا العلم يلزم نفوسهم لزومًا لا يمكنهم الانفكاك عنه، أعظم من لزوم العلم الضروري بالأمور الحسابية والطبيعية، مثل كون الواحد ثلث الثلاثة، وأن الجسم لا يجتمع في مكانين، وذلك أن ذلك علم مجرد ليسوا مضطرين إليه، بل قد لا يخطر ببال أحدهم، وأما هذا العلم، فهم مع كونهم مضطرين إليه، هم مضطرون إلى موجبه ومقتضاه، وهو الدعاء والسؤال والذل والخضوع للمدعو المعبود”.[16]
ومن هنا يكون الاعتراف بالخالق علم ضروري لازم للإنسان، لا يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه، بل لا بد أن يكون قد عرفه، وإن قُدِّر أن نسيه، فإنه يُذَكّر، ولهذا كانت وظيفة الأنبياء والرسل التذكير بهذه العلم الفطري وليس إنشائه ابتداء، فالوحي لا يأتي لينشئ الفطرة من الصفر، بل ليهديها ويزكّيها، ويعيدها إذا انحرفت.
خاتمة
إن الفطرة هي العهد الوثيق والميثاق الذي أخذه الله على بنو آدم، وهي نداء الإيمان الأول ذو السطوة الشديدة التي لا يستطيع الإنسان الانفكاك التام عنها، مهما تكلف ذلك كبرًا وعنادًا، نجد آثارها الدالة عليها في دعاء المضطر، وفي ثنائية الحق والباطل والخير والشر ووخز الضمير، وسؤال الغاية والمصير ونجدها في النظر إلى السماء والتوق إلى الخلود، فهي المعرفة الضرورية اليقينية، وهي سبيل ثبات الإيمان وتحصيل اليقين الذي لا ريبة فيه ولا شك، لأنه بني على معرفة ضرورية، إنكارها يقتضي هدم كل شيء، وهي مهد تلقي الوحي والعمل به الذي يأتي ببراهينه الدالة على أنه الحق وببيناته الساطعة ليتسق معها وينير لها ظلمات الطريق الذي عرفته ابتداء، وإن لم تهتدي لتفاصيل السير بمفردها فيكتمل النور ويصبح نورًا على نور، ومن هنا كانت وظيفة الرسل إيقاظ هذه الفطرة وتذكير الإنسان بمقتضياتها لا إنشائها ابتداء وختامًا يقول الشيخ السعدي في تفسير الآية (174) من سورة الأعراف “وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ” (174) أ] لعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحثة في العلوم السياسية.
[1] الطاهر بن عاشور، تفسير سورة الروم الآية الثلاثون، التحرير والتنوير، 1393ه، متاح على الرابط التالي:
[2] الطاهر بن عاشور، تفسير سورة التين الآية الرابعة، التحرير والتنوير، 1393، متاح على الرابط التالي:
[3] أياد قنيبي، الفطرة والكمبيوتر، يوتيوب، 3 أغسطس 2017، متاح على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=_g-t9rfiYdg
[4] عبد الله العجيري، شموع النهار إطلالة على الجدل الديني المعاصر في مسألة الوجود الإلهي، مركز تكوين للدراسات والأبحاث، 2016، ص39-53.
[5] المرجع السابق، ص57-72.
[6] المرجع السابق، ص 72-74
[7] عبد الله العجيري، شموع النهار إطلالة على الجدل الديني المعاصر في مسألة الوجود الإلهي، ص75-83
[8] Justin Barrett, God and the Brain: The Rationality of Belief, (Eerdmans Publishing Company, 2019), Lanman, Jonathan A. “The importance of religious displays for belief acquisition and secularization.” Journal of Contemporary Religion 27, no. 1 (2012): 49-65.
[9] Petrovich, Olivera. Natural-theological understanding from childhood to adulthood. Routledge, 2018.
[10] أحمد دعدوش، الإلحاد ووجود الله، السبيل، متاح على الرابط https://shorturl.at/aV9dK
[11] سامي عامري، الإلحاد في مواجهة نفسه، مركز رواسخ، سبتمبر 2021.
[12] عبد الله الوهيبي، معنى الحياة في العالم الحديث، مركز تكوين للدراسات والأبحاث، 2021.
[13] إليزابيث كينج، أنا ملحدة فلماذا لا أستطيع التخلص من الله، أثارة، 29 فبراير 2020، متاح على الرابط
[14] سامي العامري، الإلحاد في مواجهة نفسه، مرجع سابق.
[15] المرجع السابق.
[16] عبد الله بن نافع الدعجاني، منهج ابن تيمية المعرفي، مركز تكوين للدراسات والأبحاث، 2014.
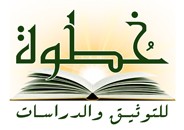 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies