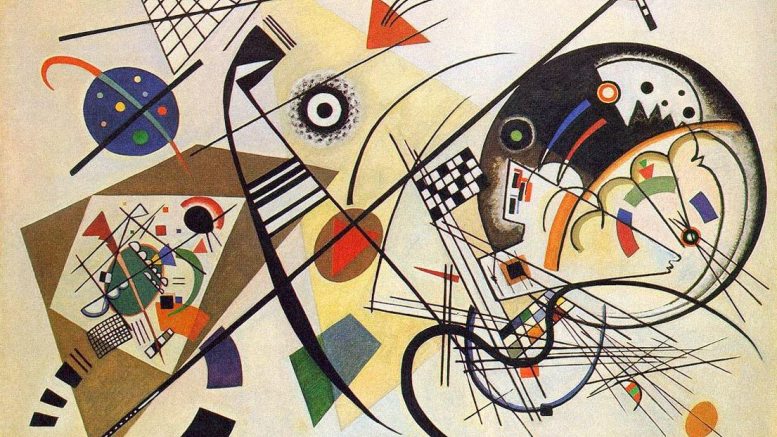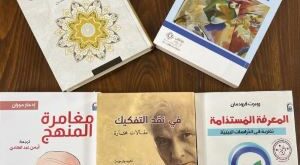القرآن الكريم ومنهج التاريخانية
أ. مهجة مشهور*
شاع في المجال المعرفي العربي ظاهرة التوسع في استخدام النظريات والمناهج الغربية واتخاذها أساسًا لدراسة الظواهر والبنى المعرفية.. وعلى الرغم مما يتضمنه ذلك من تنحية للمفاهيم الأصيلة وإحلال أخرى محلها نشأت في سياقات تاريخية ومعرفية مختلفة إلا أن الأمر لم يكن ينطوي على مشكلة عقدية طالما أن الأمر قاصرًا على دراسة الظواهر الفكرية والاجتماعية ولا يتعداها.
لكن منذ الربع الأخير من القرن الماضي أخذ بعض الدارسون العرب يتجهون نحو توظيف هذه المفاهيم والمناهج في قراءة وتحليل المصادر الأصلية الإسلامية (القرآن الكريم والسنة الشريفة)، مستخدمين مصطلحات الهرمنيوطيقا والأنسنة، والتفكيك، وهو ما أنتج ظاهرة القراءة المعاصرة للنص الديني.. ومن هذه المفاهيم مفهوم التاريخانية والذي نركز عليه في هذه الورقة.
ما هي التاريخانية؟
التاريخانية مفهوم قديم يعود لمنتصف القرن الثامن عشر، وهو يشير إلى مذهب فكري يستهدف إبراز أهمية البُعد التاريخي في دراسة الظواهر الإنسانية المختلفة، من خلال تفسير ما يحدث في التاريخ وفقًا للظروف التاريخية لا من خارجها.. فقد أراد التاريخانيون أن يحظى التاريخ بنفس المكانة المتميزة التي تحتلها العلوم الطبيعية، حيث تكون له أهدافه وطرقه البحثية ومعاييره المعرفية.
ويترتب على مفهوم “التاريخانية التقليدية” أن الأحداث لا تُفهم إلا ضمن سياقاتها التاريخية، وبالتالي ليس هناك قيم أبدية وثابتة، وإنما هناك أفكار نسبية ترتبط بالسياق الاجتماعي والتاريخي الذي وُجدت فيه، فالقيم والأخلاق والمبادئ كلها متغيرة ونسبية، وما يكون حقًا في عصر قد يصير باطلًا في عصر آخر، وهو ما يفضي الى السيولة المطلقة.
ثم ظهرت “التاريخانية الجديدة” كمدرسة من مدارس النقد الأدبي والنظرية الأدبية لأول مرة عام 1980 في الولايات المتحدة الأمريكية مع أعمال الناقد الأدبي ستيفن جرينبلات في كتاب “الصدى والأعجوبة”.. كما تستند التاريخانية الجديدة الى مجهودات ميشيل فوكو وجاك دريدا.
وتعتبر التاريخانية الجديدة new historicism من أهم نظريات الأدب التي ظهرت في فترة ما بعد الحداثة. وتربط التاريخانية الجديدة النص بسياقه الثقافي والسياسي والاجتماعي، وتهدف الى كشف بنى الهيمنة وعلاقات القوة التي تخفيها النصوص، فالنصوص الأدبية في رأي التاريخانيين الجدد ما هي الا خطابات تعبر عن بنى السلطة وما تتضمنه من الصراعات السياسية والاجتماعية والثقافية التي حدثت في عصر الكاتب، فتسعى الى فهم كيف يمكن قراءة النصوص على أنها انعكاسات للحظاتها التاريخية.
فالاقتراب التاريخاني في التعامل مع النص الأدبي إنما يشير إلى أن النص هو نتاج وتعبير عن المجتمع والثقافة التي نشأ في ظلها. ويترتب على هذا بالضرورة أن نطاق صلاحيته إنما يكون محدودًا بالإطار التاريخي والاجتماعي والثقافي لهذا المجتمع، بينما تكون للمجتمعات الأخرى تعبيراتها التاريخية المختلفة.
بهذا المعنى قامت التاريخانية بتوطيد العلاقة بين الأدب والتاريخ من جهة جعْل هذا الأخير معيار من المعايير النقدية التي يُلجأ اليها في فهم الظاهرة النصية. وقد سعت هذه المدرسة الحديثة في النقد الى تطبيق منهجها ليس فقط على النصوص الأدبية، ولكن أيضًا على النصوص المقدسة (إسلامية كانت أم مسيحية). فتفسير النص تبعًا للمنهج التاريخاني يجب أن يكون مرهونًا بتاريخه، فلا يمكن فصل النص عن تاريخ “صدوره”.
إذن فالتاريخانيون يرون أن المنهج التاريخاني ضرورة لفهم معاصر للقرآن الكريم. ومن خلال هذا المنهج التفسيري يتم وضع السياق التاريخي في قلب العملية التفسيرية، ويكون زمان الوحي ومكانه حاكمًا في فهم الآيات القرآنية. والمنهج التاريخاني بذلك هو وسيلة لإلصاق النص المقدس بالتاريخ لتسويغ التخلي عنه.
وهنا تُثار لدينا مشكلة منهجية ومعرفية أساسية، فالتاريخانية بهذا المعنى لا تصلح في التعامل مع النص المُنزّل الذي تؤمن الجماعة المسلمة بشكل مطلق بمصدره الإلهي وثباته وإطلاقه، وبصلاحيته لكل زمان ومكان. فالضمير الإسلامي ينبض بفكرة التعالي والمفارقة للنص الديني التأسيسي “قرآن وسنة” لكل الأغيار البشرية، ويرفض أي محاولة لجعله نصًا ظرفيًا خاضعًا لحدود المكان والزمان الذي ظهر فيه.
القرآن الكريم والتاريخانية:
كان الظهور الأول للمنهج التاريخاني في التعامل مع النص المقدس على يد المستشرق الألماني تيودور نولدكه في كتابه “تاريخ القرآن” عام 1860. وقد ناقش الكاتب العديد من الأحداث المرتبطة بالنص القرآني، وربطها بزمن محدد يتماشى فيه النص مع طبيعة الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية. ويمكن اعتبار هذه الدراسة أولى المحاولات الصريحة التي استعملت هذا المنهج في قراءة النص القرآني. تلت هذه المحاولة العديد من المحاولات الاستشراقية المتتابعة.
لم يتبن المفكرون الحداثيون “المسلمون” التاريخانية إلا في أواخر القرن العشرين مع ظهور بعض الكتاب الذين تبنوا الطرح التاريخاني في كتاباتهم حول النص الديني (القرآن الكريم والحديث الشريف)، ومن أبرزهم عبد الله العروي، محمد أركون، نصر حامد أبو زيد، هشام جعيط، فضل الرحمن وغيرهم.
وقد اتجه هؤلاء المفكرون الى التأكيد على مركزية التاريخ في مقاربة النص القرآني باعتباره (أي القرآن الكريم نفسه) ظاهرة تاريخية ومنتج ثقافي مرتبط بالزمان الذي حدث فيه (القرن السابع الميلادي)، والمكان الذي تجلى فيه (وهو مكة المكرمة). كما قاموا ببيان خصائص البيئة الجغرافية والثقافية التي ظهر فيها النص القرآني.
ويمكن تقسيم المقاربة التاريخانية للنص القرآني الى قسمين: التاريخانية الراديكالية والتاريخانية المقاصدية:
– التاريخانية الراديكالية: هي مقاربة تفكيكية للنصوص الشرعية تربطها بشكل كامل بزمانها ومكانها بحيث لا يمكن أن تُلزم الناس في عصر مختلف، وتُعلي هذه المقاربة سلطة الواقع والعقل المعاصر على حساب النصوص. فالوحي ما هو إلا تعبير عن التجربة التاريخية للنبي عليه السلام في سياق معين، وبالتالي فهي ليست مطلقة، بل هي مشروطة بالواقع التاريخي الذي نزلت فيه، وبالتالي فإن هذا التوجه التاريخاني الراديكالي يدعو الى قطيعة معرفية مع التراث الفقهي والنص المقدس. ومن أمثلة مفكري هذا التوجه محمد أركون، ونصر حامد أبو زيد.
– التاريخانية المقاصدية: هي مقاربة إصلاحية/تجديدية تؤمن بقدسية النصوص (وخاصة القرآن)، لكنها ترى أن فهم النص يجب أن يتم في ضوء السياق التاريخي، مع التركيز على المقاصد العليا للشريعة. فهذه المقاربة تحافظ على مرجعية النص، ولكنها لا تقف عند ظاهره، فتعتبر المقاصد هي جوهر الشريعة وليس التنزيل التاريخي للأحكام، بمعنى أن أحكام الجزية، أو الرق، أو الحجاب، أو الحدود يجب أن تُفهم في سياقها التاريخي، ومن ثم يجب إعادة النظر فيها الآن بما يحقق العدالة والمصلحة دون المساس بمرجعية الوحي. ومن أمثلة مفكري هذا التوجه فضل الرحمن وعبد المجيد الشرفي ورضوان السيد.
التاريخانية والمنهج التفكيكي:
المنهج التفكيكي – كما طرحه جاك دريدا – هو عملية هدم لبنية النص وإعادة النظر في ثوابته من خلال الكشف عن التناقضات الداخلية فيه. ويرفض المنهج التفكيكي وجود معنى نهائي للنص، ويرى أن كل قراءة هي إعادة كتابة (تأليف) للنص بحسب السياق والقارئ. ويمكن القول إن المنهج التاريخاني ليس تفكيكيًا بالمعنى الصريح، ولكنه يشترك معه في بعض ملامحه.
فالمنهج التاريخاني ينقل النص من كونه وحيًا إلهيّ الى مجرد منتج لغوي وثقافي، أي أنه يسحب النص من المركزية الإلهية الى المركزية البشرية النسبية. وهذا ما يفعله المنهج التفكيكي عندما يؤول النصوص الكلاسيكية، حيث يرفض التفكيك أن تكون القراءات التاريخية هي القراءات النهائية أو الصحيحة للنصوص.
كذلك فإن المنهج التاريخاني يرى أن معنى النص يتشكل تبعًا للظروف التاريخية والمكانية له، وفي هذا فإنه يشبه المنهج التفكيكي الذي يرى أن المعنى أو النص دائم الحركة والتغير ولا يخضع لمقصد كاتب النص فقط.
وفي هذا الإطار يذهب طه عبد الرحمن إلى أن التاريخانية تنطوي على تفكيك ضمني للنص المقدس، لأنها تجعل الوحي قابلًا للاختزال في ظرفيته البشرية، وهذا في رأيه مآله الى علمانية كامنة أو إلحاد معرفي.
كما يرى محمد عمارة أن التاريخانية هي خطوة نحو نزع القداسة عن النص القرآني أي تفكيكه من الداخل بدءًا من المرجعية، وانتهاءً بتعليق الأحكام.
يمكن فهم المنهج التاريخاني عند تطبيقه على النص المقدس بأنه “تفكيك تأويلي مُقنع” يشتغل من خلال التاريخ بدلًا من الفلسفة.
ونحاول الآن عرض أهم النقاط التي أثارها بعض أهم مفكري منهج التاريخانية من الحداثيين المسلمين، وهم د. نصر حامد أبو زيد، عبد الله العروي وفضل الرحمن. ويلاحظ أن لكل مفكر منهم مدخلًا مختلفًا يصوغ به رؤيته التاريخانية.
التاريخانية عند نصر حامد أبو زيد:
التاريخانية عند نصر حامد أبو زيد[1] هي الالتزام باستعادة السياق التاريخي لنزول القرآن من أجل تفهم مستويات المعنى وآفاق الدلالة. ولتحقيق هذا الأمر لا يبدأ أبو زيد من قائل النص (الله تعالى) كنقطة انطلاق في فهم النص، وإنما نقطة الانطلاق ومحور الاهتمام في فهم النص وتحليله هو المتلقي أو الإنسان بكل ما يحيط به من واقع اجتماعي وتاريخي. فالقرآن وفق أبو زيد نص ديني ثابت من حيث منطوقه، لكن حين يتعرض له العقل الإنساني يصبح “منتجًا ثقافيًا” يفقد صفة الثبات، فهو يتحرك وتتعدد دلالاته. إن الثبات من صفات المطلق والمقدس، أما الإنساني فهو نسبي متغير. والقرآن مقدس لكنه “من جهة الإنسان يتحول الى نص إنساني يتأنسن”.
وللتاريخانية في خطاب أبو زيد مدلولان:
1- الخاصية الواقعية التي تشير الى ارتباط النص بأحداث واقعية تخص فرد أو مجموعة من الأفراد، وهو مدلول يترادف مع مقولة “أسباب النزول” الذي يوظفه أبو زيد في التدليل على مشروعية هذا المدلول.
2- الخاصية الاجتماعية، وهي تشير إلى ارتباط النص القرآني بالمنظومة الثقافية للمجتمع الذي احتضن ظهوره، وهذا المستوى يتبدى في تشكيل المفهوم الحداثي للنص القرآني من خلال تعريفه بكونه منتجًا ثقافيًا، وهذا التعريف يتضمن تأكيدًا على انتماء النص الى الأصل الثقافي.
كذلك يرى أبو زيد أن البعد التاريخي للنصوص “لا ينصرف فحسب الى ما تشير اليه كتابات السلف من فعل للنص مع الواقع عبر نقاط تماس مثل أسباب النزول أو علم الناسخ والمنسوخ، وإنما عبر وعاء ضخم هو اللغة ومفاهيمها.”
إن النصوص الدينية – حسب أبو زيد – ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية، بمعنى أنها “تنتمي الى بنية ثقافية محددة تم إنتاجها طبقًا لقوانين تلك الثقافة التي تُعَد اللغة نظامها الدلالي المركزي”، فاللغة ليست وعاءً فارغًا، بل أداة للجماعة في إدراك العالم وتنظيمه. وهذا ما عبَّر عنه أبو زيد بعبارته المثيرة للجدل “إن القرآن منتج ثقافي”.
يقول أبو زيد في هذا الشأن: “من أهم الجوانب التي يتم تجاهلها في إشكالية النص الديني – ولعلها من أخطرها على الإطلاق – البُعد التاريخي لهذه النصوص. وليس المقصود بالبعد التاريخي هنا علم أسباب النزول – أي ارتباط النصوص بالواقع والحاجات المثارة في المجتمع –، أو علم الناسخ والمنسوخ – أي تغيير الأحكام لتغير الظروف والملابسات – أو غيرها من علوم القرآن التي لا يستطيع الخطاب الديني تجاهلها. فإن البُعد التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية المفاهيم التي تطرحها النصوص من خلال منطوقها وذلك نتيجة طبيعية لتاريخية اللغة التي صيغت بها النصوص” (النص والسلطة والحقيقة).
إن أبوزيد الذي يقترب من القرآن عبر المتلقي ومفاهيمه ينطلق من القول بتاريخية المفاهيم واجتماعيتها، وتاريخية اللغة التي صيغت بها النصوص لينتهي الى تاريخية النص القرآني. فالواقع التاريخي والاجتماعي واللغوي هو المتغير المستقل وليس النصوص التي يرى أنها لا تحمل عناصر جوهرية ثابتة. بل إن لكل قراءة – يعني القراءات في أزمنة مختلفة أو من شخوص مختلفين – جوهرها الذي تكتشفه في النص.
“الواقع إذن هو الأصل ولا سبيل لإهداره. ومن الواقع تكوّن النص ولغته وثقافته وصيغت مفاهيمه. ومن خلال حركته بفاعلية البشر تتجدد دلالته. فالواقع أولًا والواقع ثانيًا والواقع أخيرًا. وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحول كليهما الى أسطورة.” (نقد الخطاب الديني). فاستنطاق النصوص الدينية يتم بتصور إنساني تاريخي بطبعه، إنما “يحاول الفكر الديني دائمًا أن يُلبسه لباسًا ميتافيزيقيًا ليضفي عليه طابع الأبدية والسرمدية في آن واحد”.
ويرى أبو زيد في قراءته التاريخية للقرآن أن الشروط والقوانين التاريخية والدلالية المسبقة تجمد فهم النص الديني “لذا يلزم تغيير إطار فهمنا لهذه النصوص خارج السياق التقليدي الداعي الى مقولة “لا اجتهاد مع النص”. فسعي الخطاب الديني المعاصر إلى تثبيت دلالات النص على فهم واحد إنما هو دعوة صريحة لنفي التعدد والاختلاف ودعوة لتثبيت الواقع”.
لقد تأسست أطروحة أبو زيد على القول بتاريخية النص القرآني واعتباره نصًا ثقافيًا لغويًا كسائر النصوص، وبالتالي فهو لا يرى سببًا أن ينفرد هذا النص بمنهجيات خاصة، بل يدعو لأن تنطبق عليه منهجيات تحليل النصوص التي أنتجتها علوم اللغة واللسانيات المعاصرة كما قدمها الفكر الغربي. ومن ثم يوجه أبو زيد نقدًا للمنهجيات المتداولة في التراث خاصةً في التأويل والاستنباط، إذ يرى أن علوم القرآن واللغة وغيرها، المطروحة في إرث القدماء، أضحت غير كافية أو مُرضية، وأنه قد صار على المحدثين في ضوء التطور في علم الألسنيات والتحليل اللغوي وتحليل الخطاب أن يدلوا بدلوهم فيها من منظور آخر ووفق مفاهيم أخرى.
ورغم ذلك يستشهد أبو زيد بعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ لإثبات رؤيته التاريخانية، فيرى أن الآيات المرتبطة بأحداث تاريخية معينة (حرب، حادثة، سؤال..) دلالتها ليست مطلقة لكل زمان ومكان، بل هي مرتبطة بهذا الظرف التاريخي الخاص. إلا أن أسباب النزول لا تعني أن الآية محصورة في الحدث، بل أن الحدث مثال على عموم اللفظ. ففهم هذه السياقات التاريخية يسمح بتعميم أحكامها على مواقف تشترك معها في العلة والمعنى.
أما بالنسبة لعلم الناسخ والمنسوخ فأبو زيد يرى أن هذا اعتراف قرآني بالتغير التاريخي، فقام بنقل النسخ من كونه جزءًا من الوحي الإلهي لحكمة تشريعية الى آلية تاريخية بشرية لفهم تطور النص القرآني وتوظيفه لتجاوز الأحكام حسب الظروف التاريخية المتطورة.
التاريخانية عند عبد الله العروي:
طرح عبد الله العروي[2] مفهوم “المنهج التاريخاني” كأداة نقدية انطلق منها لقراءة الراهن العربي واستنتاج وسائل الخروج منه نحو المستقبل، فالمنهج التاريخاني عند العروي يهدف الى الكشف عن قوانين التطور والتغير الاجتماعي وفهم التبدلات الحضارية الكبرى في تاريخ الإنسانية.
إن اهتمام العروي بالإشكالات التي يواجهها العقل والمجتمع العربي أوصله الى أن مشكلة العقل العربي هي مشكلة “وعي”، بسبب نماذج حاولت الإصلاح بطرق ناقصة، فغابت عنها الشمولية وأحاطت العقل العربي بقيود واجهت كل ما هو جديد وعقلاني، حيث قادت الذهنية العربية الى متاهة اللاوعي التاريخي والفوات الحضاري.
ثم جاء كتابه المعنون (السنة والإصلاح) عام 2008 والذي قام فيه بطرح رؤيته عن القرآن الكريم، فيؤكد العروي أن “القرآن كمصحف يُتصفح، وكمجموع حروف وكلمات وعبارات، وثيقة مادية كباقي الوثائق، لا اعتراض على إخضاعها لجميع أنواع النقد المعاصر”. ويرى العروي أن القرآن الكريم هو ظاهرة تاريخية تتداخل فيه سياقات من مستويات مختلفة نفسية واجتماعية ولغوية.
ويتقصى العروي هوية القرآن من خلال تمحيص أهم تصور قُدم بهذا الشأن، أي تصور المذهب السُني، الذي يراه العروي تأويلًا مختزلًا. إلا أن أي فهم جديد للقرآن يمر حتمًا عبر مساءلة الفهم السني، لذلك انصب اهتمام العروي على النص السني باعتباره نصًا بلَّغنا التأويل الأساس للقرآن. فقد شكلت السنة نصًا على “هامش” النص المقدس، إلا أن هذا النص الموازي ليس نصًا ثانويًا، بل إنه النص الذي يقدم نفسه بوصفه نصًا قطعيًا لفهم القرآن.
يدعي العروي أن هذه المعالجة تجعل كما لو كان المفعول أقوى من فاعله، ففهم القرآن يتم من خلال السنة بوصفها سلطة التأويل، ومن هنا رأى العروي ضرورة مواجهة السنة وذلك عبر تجذير الوعي التاريخي بظاهرة القرآن. وعندما يحدد العروي الفهم السني للقرآن كظاهرة تاريخية، فإنه يدعي أنه لا يسعى بذلك الى التقليل من قيمة “الكتاب المقدس”، بل أن يستعيد الكتاب قيمته عبر وضع تأويل السُنة أمام تهافته.
فالعروي يرى ضرورة قراءة القرآن في أفق الزمن التاريخي، لكن هذه القراءة لا تتم إلا عبر تحرير الزمن من قبضة التثبيت، تثبيت الزمن الذي هو المقصد الأساس للتأويل السني وفقا له، وهو ما سماه العروي “مفارقة السنة”. فالسنة تقدم القرآن نصًا فوق التاريخ، والحقيقة أنها صاغت تأويله تحت ضرورات تاريخية، ولكنها تنفي ضرورات التأويل وتجعل من تأويلها قراءة خالصة مطابقة لروح النص. فهي ترفض أن تكون قراءتها مجرد تأويل يحتمل تأويلات أخرى بجانبها، وهي بذلك تنفي أن تكون طرفًا في حرب التأويلات المدفوعة بالحدث التاريخي. يقول العروي إن السنة إنما وجدت تحت نداء التاريخ، ولكنها تتصرف كما لو أنها سيدة التاريخ.
فالسنة – في رأي العروي – تريد الإصلاح لكن بمعاكسة الزمن، فهي إذا نادت في نهاية القرن الـ 19، إثر صدمة الحداثة، أن الإصلاح عودة الى الأصل، عودة تَسْخر من الزمن ولا تضعه في الحسبان، فهي تنسى أو تتناسى أن “الزمن مخلاف، يغير فينا كل شيء، يغير موقفنا من الكون والمجتمع والسياسة والأخلاق، يغير علاقتنا بالطبيعة، وبالجسد، وبالأسرة، وبالسلطة.”
يحدد العروي أنه من الواجب علينا إنقاذ العلم والسياسة، لا من الدين، بل من التأويل الذي فرضته السنة (!)، فإذا كانت السنة لا تنتعش إلا على أساس معاكسة الزمن، ولا ترى سبيلًا الى الإصلاح إلا في درء سننه، فإن “الزمن يواصل سيره ولا يتوقف عند رغبة هذا المتأخر. فيدور عليه كما دار على مَن سبقه، يرغمه على الانصياع لحكم الجميع”.
إذن فقد جاء كتاب “السنة والإصلاح” لوضع التأويل السني للقرآن تحت مجهر التاريخانية، لإبراز البُعد التاريخي لتأويل يضفي على نفسه طابع القداسة كما يدعي العروي. فالتأويل السني وفقا له هو معطى تاريخي، لذلك تتمثل مهمة التاريخانية في البحث عن شروط الإمكان التاريخي، أي في الكشف عن الشروط المتناهية لما يُقدم نفسه باعتباره لا متناهيًا مقدسًا (!).
التاريخانية عند فضل الرحمن:
تقوم نظرية فضل الرحمن[3] في التفسير على ما أسماه الحركتين أو الحركة المزدوجة: من الوضعية الراهنة الى زمان القرآن، ثم العودة الى الزمن الراهن، ويعني هذا أن على المفسر أن يسعى أولًا إلى فهم دلالة قول معين من خلال دراسة وضعيته التاريخية والسياق الخاص الذي جاء ردًا عليه، وهذا يقتضي عمل دراسة شاملة لوضع المجتمع والدين والأعراف التي كانت سائدة في جزيرة العرب عشية ظهور الإسلام. ثم عليه ثانيًا البحث عن الأهداف الأخلاقية والاجتماعية التي قصد إليها القرآن في ذلك الزمان. أما الحركة الثانية فإنها تنطلق من هذه الأهداف الأخلاقية والنظرة العامة وصولًا إلى النظرة الخاصة التي يتعين على المفسر صياغتها وإنجازها باعتبارها فهمه وتأويله الخاص بزمانه. وهذا يقتضي دراسة الوضعية الراهنة للمجتمع والفكر البشري. إن مبدأ استمرارية الهدي القرآني عبر الزمان، إضافة الى مبدأ تفاعل القرآن مع السياق التاريخي الذي نزل فيه، يقضي على المفسر أن يستخلص فحوى الرسالة القرآنية حتى يكون قادرًا على نقل حكمة القرآن عبر الزمان.
يلح فضل الرحمن على ضرورة استلهام البعد التاريخاني في أحكام القرآن الكريم والسنة الشريفة. فمثلًا إمعان النظر في حكم تحريم الخمر أو في حكم إباحة تعدد الزوجات يجعلنا نستخلص القيمة التي يوليها القرآن الكريم للظروف الاجتماعية والنفسية للمجتمع العربي في ذلك الوقت، وهو يعني بذلك أن بعض الأحكام القرآنية قد تكون أحكامًا مؤقتة.
ويرى فضل الرحمن أن الكثير مما علق بالسنة يحتاج الى مراجعة تعتمد المنهج التاريخاني تمكننا من التمييز بين “السنة المكتوبة” و”السنة المعيشة”، لأن العديد من الأحاديث المنسوبة الى الرسول إنما هي متأثرة بمراحل تدوينها والرؤى والمواقف السياسية التي قد تكون وجَّهتها. لهذا كان من أهداف أطروحة فضل الرحمن تأكيد الحاجة الى قراءة التراث قراءة تجديدية تستأنس بالنظرة التاريخانية، وتستهدي بمنجزات المناهج والمفاهيم الحديثة.
نقد منهج التاريخانية في فهم النص الديني:
جاءت الردود على منهج التاريخانية في تفسير القرآن الكريم من تيارات مختلفة: فلسفية وأصولية وفكرية معاصرة، وقد اشتركت جميعًا في رفض تحويل النص القرآني الى مجرد ظاهرة لغوية تاريخية، مع التأكيد على البُعد الغيبي والرباني للنص المقدس.
وجاءت أهم النقاط التي ركز عليها نقاد التاريخانية متمثلة في:
جاءت الردود على منهج التاريخانية في تفسير القرآن الكريم من تيارات فكرية متعددة: فلسفية، وأصولية، وفكرية معاصرة، وقد اشتركت جميعها في رفض اختزال النص القرآني إلى مجرد ظاهرة لغوية أو خطاب ثقافي تاريخي، مؤكدة على البعد الغيبي والرباني للنص، باعتباره وحيًا إلهيًا مُنزّلًا، لا يخضع للتفكيك أو إعادة التكوين تبعًا لمقتضيات السياق التاريخي أو التحولات الثقافية. وقد ركّز نقاد التاريخانية على عدد من الإشكالات المنهجية والمعرفية التي يرون أنها تضعف هذا الاتجاه وتجعله غير صالح لتفسير النص القرآني، ومن أبرز هذه النقاط:
أولًا- التأكيد على قداسة النص القرآني: فهو نص موحى به، وهو نص فوق التاريخ لا داخله. فنقطة البدء في التعامل مع القرآن الكريم هي الإيمان بأنه كتاب هداية موجه للبشرية كافة في كل عصر وكل مكان الى أن تقوم الساعة. “إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون“. فالكتاب المقدس اللإسلام لا يعرض لأيديولوجية تاريخية يمكن أن يلحقها التعديل، وإنما هو دينٌ يتجاوز إطار الزمان والمكان.
التأكيد على أن نقطة البدء في الاقتراب من التعامل مع القرآن الكريم تكمن في الإيمان بأنه كلام الله المنزل، وأنه كتاب هداية أُنزل لهداية البشر جميعًا، في كل زمان ومكان، إلى أن تقوم الساعة. فالقرآن ليس نتاجًا بشريًّا، ولا نصًّا خاضعًا لتحولات الوعي التاريخي أو السياق الثقافي، بل هو نصٌ موحى به، محفوظ بحفظ الله تعالى، كما قال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر: 9]. ولذلك، فإن التعاطي مع القرآن بوصفه مجرد خطاب تاريخي قابل للتجاوز أو التحوير الأيديولوجي، هو إخلال بحقيقته الجوهرية، وإنكار لقداسته المطلقة. فالقرآن ليس مجرد وثيقة دينية ترتبط بسياق بعينه، بل هو دين خالد، يتجاوز حدود الزمان والمكان، ويخاطب الإنسان في كينونته، في كل عصر، بما يحمله من حقٍّ مطلق وهداية ربانية خالدة.
ثانيًا- لا يمكن التسليم بأن العنصر الثابت في فهم القرآن الكريم هو الواقع التاريخي المتغير، وأن العنصر المتغير هو النص المقدس الذي جاء لتنظيم هذا الواقع. فالتاريخانية التي ترى أن القرآن الكريم يُفهم بناءً على ظروف العصر الذي نُزل فيه فقط، مما يؤثر بالضرورة على فهم آياته في العصور التالية، تنطلق من مصادرة مغلوطة تمامًا.
عدم إمكانية القبول بادعاء أن الثابت في فهم القرآن الكريم هو الواقع التاريخي المتغير، وأن النص المقدس هو العنصر القابل للتغيير والتأويل تبعًا لهذا الواقع. فهذه الرؤية تُقلب العلاقة رأسًا على عقب، وتجعل من القرآن تابعًا للتاريخ لا مُهيمِنًا عليه. إن التاريخانية التي تزعم أن فهم القرآن لا يكون إلا في ضوء ظروف العصر الذي نزل فيه فقط، وتربط دلالاته بسياق زمني منقطع، إنما تنطلق من مصادرة أولية خاطئة، تنفي عن الوحي صفته الكلية والربانية. فالقرآن الكريم ليس أسيرًا لزمن التنزيل، بل هو خطاب إلهي خالد، يتجاوز الأزمنة، ويُفهم في ضوء مقاصده الكلية، وثوابته التي لا تتبدل، دون أن يُلغى السياق، ولكن من غير أن يُختزل فيه.
ثالثًا- رغم تعددية الفهم، والتأويلات المختلفة والطبقات العديدة التي يقدمها النص القرآني، إلا أن هناك معنى ثابت قائم لا اختلاف عليه. والمسلمون جميعًا يقرون أن القرآن نص ثابت، أما الاجتهاد في فهمه فيمكن أن يُنتج تأويلًا متغيرًا، دون أن يتجاوز ذلك النص المقدس أو على نحو يضيع الثابت الشرعي فيه، ويؤدي الى تفكيكه بطريقة تؤدي الى النسبية المطلقة. وإذا كانت بعض الآيات قد نزلت في ظروف تاريخية معينة أو ردًا على أحداث بعينها، إلا أن التشريع القرآني له طابع تجاوزي يتضمن مبادئ عامة تصلح لكل زمان. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
رغم تعددية الفهم، وتنوع التأويلات، وتعدد الطبقات الدلالية التي يتيحها النص القرآني، فإن ذلك لا ينفي وجود معنى أصيل وثابت ينعقد عليه الإجماع، وتستقر به أصول الشريعة. فالمسلمون قاطبة يُقرّون بثبات القرآن من حيث كونه نصًا مقدسًا موحًى به، محفوظًا من التحريف والتبديل. أما الاجتهاد في تفسيره وفهمه، فهو مجال مفتوح للاجتهاد المشروع، شريطة أن يظل منضبطًا بأصول اللغة، ومقاصد الشريعة، والسياق الكلي للوحي، دون أن يُفضي إلى تذويب النص أو تجاوزه بذريعة التأويل، أو أن يؤدي إلى تفكيك بنية المعنى الثابت على نحو يُفضي إلى نسبية مطلقة تُبطل حجية النص نفسه. وإذا كانت بعض الآيات قد نزلت في سياقات تاريخية محددة أو استجابة لأحداث معينة، فإن الخطاب القرآني يتميز بطابع تجاوزي، يضمن له الاستمرارية والصلاحية لكل زمان ومكان. فـ”العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”؛ وهو أصل أصولي معتبر، يعكس قدرة النص على استيعاب المتغيرات دون التفريط في ثوابته.
رابعًا- خطأ إسقاط المناهج الغربية مثل التفكيكية والتأويلية على النص الديني، لخصوصية بنية هذا النص الموحى به. فاللغة في القرآن الكريم ليست مجرد وعاء بشري، بل أداة بلاغية للوحي. والقرآن الكريم هو بالفعل نص لغوي، ولكنه ذو مصدر إلهي، وهذا ما يميز النص القرآني عن أي خطاب بشري. فاستخدام أدوات التأويل الحديثة (اللسانيات والسيميائيات) لا ينبغي أن يتضمن على أي نحو نفي القداسة عن النص، ولا إعطاء سلطة مطلقة للعقل لتفكيك النص أو عزله من مرجعيته الإلهية.
يُعدّ إسقاط المناهج الغربية الحديثة، كالتفكيكية والتأويلية، على النص القرآني خطًا منهجيًّا جسيمًا، يتجاهل خصوصية النص المقدس من حيث مصدره وبنيته ووظيفته. فالقرآن الكريم، وإن كان نصًّا لغويًا من حيث الوسيط، إلا أن لغته ليست مجرد وعاء بشري، بل أداة بلاغية اختارها الله عز وجل لخطاب الإنسان، فهي جزء من إعجازه، وليست بنية قابلة للتفكيك بمعايير الخطاب الإنساني المحدود. والفرق الجوهري بين القرآن وأي خطاب بشري يكمن في أن القرآن كلام الله، المتعالي في مصدره، المحفوظ في مرجعيته، والمقصود به الهداية لا الإبهام أو التعمية كما تفترض بعض المناهج التفكيكية. ومن ثم، فإن الاستفادة من أدوات التحليل اللغوي أو اللسانيات أو السيميائيات في فهم دلالات النص، لا يصح أن تتحول إلى ذريعة لإلغاء قداسة النص أو تفكيك سلطته التشريعية، ولا إلى تمكين العقل من فصل النص عن مصدره الإلهي، أو تعزله عن مقصده الرباني، تحت دعوى تعددية القراءات أو نِسبية المعنى.
خامسًا- رفض فهم النصوص الدينية كمجرد تعبيرات بشرية ثقافية، كلٌ يأولها بطريقته على مستوى فهمه. إن تفسير القرآن الكريم قائم بالأساس على ضوابط اللغة وأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة. أما التاريخانية في اقترابها من النص المقدس فهي تستخدم الهرمنيوطيقا التي تعطي للقارئ سلطة فوق سلطة النص. وبالتالي فالقراءات المختلفة للنص القرآني كلها معتَبرة لدى هؤلاء الحداثيين نظرًا لخضوعها لتغيرات التاريخ وتطور اللغة واختلاف القراء. النتيجة الأساسية لما يدعو اليه دعاة التاريخانية هي استباحة النص القرآني، بحيث يتم تجاهل الثوابت التي جاء بها القرآن الكريم، فالتأويل لديهم يعني أن النص القرآني يخضع لحالة من السيولة الكاملة، وتُعتبر التاريخانية أداة من أدوات هذا الاقتراب غير المنضبط لتحقيق هذا الهدف.
لا يصح التعامل مع النصوص الدينية، وفي مقدمتها القرآن الكريم، بوصفها مجرد تعبيرات ثقافية بشرية مفتوحة على تأويلات لا حصر لها، يحددها القارئ حسب مستواه المعرفي أو ظرفه التاريخي. ففهم القرآن الكريم ليس عملية اعتباطية، بل يقوم على ضوابط محكمة: من أصول اللغة العربية، وأسس علم أصول الفقه، ومقاصد الشريعة، وما قرره العلماء من قواعد في التفسير والاستنباط. أما المنهج التاريخاني فيقارب النص القرآني من داخل الهرمنيوطيقا الحديثة، خصوصًا في صورتها التفكيكية كما صاغها جاك دريدا، حيث تُمنح السلطة النهائية للقارئ لا للنص، فيُصبح النص مجرد بنية مفتوحة، لا تحمل دلالة مستقرة، بل تخضع كل مرة لإعادة إنتاج جديدة وفق وعي القارئ وسياقه. بناء على ذلك، تُعدّ القراءات المختلفة والمتعارضة للنص القرآني عند دعاة الحداثة والتاريخانية كلها مقبولة ومعتَبرة، لأنها نتاج حتمي لتغيرات التاريخ وتطور اللغة وتعدد القراء. والنتيجة الخطيرة لهذه الرؤية أن النص القرآني يُستباح، وتُلغى ثوابته، ويُفرّغ من محتواه الملزِم، فيتحول إلى خطاب سائل خاضع للتأويل اللامحدود. فالتاريخانية، في جوهرها، ليست مجرد أداة تحليل، بل تُصبح وسيلة لهدم مرجعية النص، وتحقيق هدف غير معلن يتمثل في تفكيك سلطة الوحي ذاته، عبر تذويبه في السياقات التاريخية والثقافية المتغيرة.
سادسًا- لجوء المفكرين التاريخانيين الى علم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ لإثبات وجهة نظرهم يؤكد أن أي خطاب نقدي حول القرآن لا يمكن أن يتجاهل التراث وإلا سيفقد شرعيته في الوسط الإسلامي، وإلا فكيف نفهم تبرير هؤلاء المفكرين لمنهجهم الحداثي التاريخاني باستخدام هذه الأدوات التراثية التقليدية.
إن لجوء المفكرين التاريخانيين إلى أدوات من صميم التراث التفسيري الإسلامي، كعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، لتبرير مقارباتهم الحداثية للنص القرآني، يكشف عن مفارقة منهجية عميقة. فهؤلاء، رغم دعوتهم لتجاوز مناهج التفسير التقليدية، يعتمدون على هذه الأدوات التراثية لإكساب مشروعهم مسحة من القبول داخل السياق الإسلامي. وهذا التناقض يؤكد أن أي خطاب نقدي حول القرآن الكريم لا يمكن أن يكتسب شرعية أو تأثيرًا ما لم يتفاعل مع التراث التفسيري والأصولي، ولو على نحو انتقائي. إذ لو تجاهل هذا التراث تمامًا، لفقد صلته بالمرجعية الإسلامية وخرج من أفق التلقي الشرعي لدى جمهور المسلمين. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يستقيم أن تُستخدم أدوات من داخل منظومة معرفية أصيلة لتقويض أسس تلك المنظومة ذاتها؟ إن هذا النهج الانتقائي لا يعكس انسجامًا منهجيًا، بل يدل على توظيف استراتيجي للتراث، لا على إيمان علمي أو معرفي به.
إذن فهذه العلوم هي أدوات تُستخدم لفهم النص لا لإلغائه أو تقييده بزمن معين، فهي تسمح ببيان حكمة التشريع وتنزيله المرحلي المتدرج.
أخيرًا يمكننا القول إن القرآن الكريم، هذا الكتاب المقدس المعجز، ليس مجرد نتاج لبيئة تاريخية معينة، بل هو خطاب يعلو على الواقع ويتعالى عن التاريخ. فهذا النص المقدس لا يُفهم فقط من خلال سياقه التاريخي، بل في ضوء مقاصده وأبعاده الشمولية.
أخيرًا، يمكن القول إن القرآن الكريم، هذا الكتاب الإلهي المعجز، ليس نتاجًا لبيئة تاريخية محددة، ولا يُختزل في سياق نزوله، بل هو خطاب رباني متعالٍ على الواقع، ومجاوزٌ للزمان والمكان فالنص القرآني لا يُفهم حق الفهم بمجرد ربطه بسياقه التاريخي، بل يُقرأ في ضوء مقاصده الكلية، وأبعاده الشمولية التي تخاطب الإنسان في كل زمان، وتهديه إلى الحق بما يحمله من ثوابت تشريعية، وقيم أخلاقية، ومفاهيم كونية. إن التعالي الزمني والشمولي للقرآن هو ما يمنحه خلوده وفعاليته المستمرة، ويجعله مرجعًا أعلى لا يتغير بتغير السياقات، بل يُوجِّهها ويهديها، لأنه ليس من قول البشر، بل وحيٌ من رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مدير مركز خُطوة للتوثيق والدراسات، وسكرتير تحرير مجلة المسلم المعاصر.
[1] مفكر وأكاديمي مصري (1943-2010).
[2] مفكر ومؤرخ مغربي (1933)
[3] مفكر باكستاني (1919- 1988).
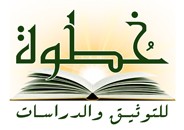 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies