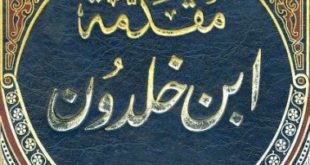علم العمران وعلوم الإنسان*
د. أحمد المطيعي
تعد مقدمة ابن خلدون في القرن الثامن الهجري أنضج محاولة في التفكير العلمي حول الإنسان والمجتمع والتاريخ مما لا مثيل له في الفكر العلمي السابق عليه. وإنا لنجد في موضوع المقدمة ومنهجها طفرة في العرض والمعالجة جعلت بعض الباحثين في حيرة من أمر هذا الكتاب وصاحبه بعد خمسة قرون من تأليفه. ماذا كان هدف عبد الرحمن بن خلدون من كتابة المقدمة؟ وفى أي صنف من المعارف يندرج علم العمران الذي تحدث عنه وهو علم جديد لم يُسبق إليه؟
إن هذه الأسئلة وغيرها كثير تتصل في جوهرها بحيوية علم العمران من حيث الموضوع والمنهج والرؤية، وتصل في النهاية إلى سؤال معرفي يهدف إلى مساءلة تاريخ العلم وأسسه الفكرية والعلمية والحضارية في سياقها التاريخي المخصوص.
لقد جذبت المقدمة اهتمام أعداد متزايدة من الباحثين داخل البلاد العربية الإسلامية وخارجها، وشكّلت موضوع دراسات جامعية وندوات ومؤتمرات دولية في الشرق والغرب، واتخذ البعض من ابن خلدون رهانًا حضاريًا لانتماءات شتى، ليبرالية وقومية وماركسية. بيد أن الاهتمام العلمي والمعرفي بالأساس تركز حول الدراسة العلمية والمنهجية للمقدمة سعيًا نحو تساؤل معرفي حول أصل هذا العلم وجذوره وامتداداته في التاريخ الفكري والعلمي لما يسمى اليوم بعلوم الإنسان؟ لكن ما علاقة علم العمران بعلوم الإنسان؟ هل هي علاقة تشابه وتقارب أم علاقة اختلاف وتباعد؟
تثير هذه الأسئلة إشكالات جمة تاريخية وفكرية وعلمية لا مناص من مجابهتها ومحاولة معالجتها بما يلزم من الدقة والموضوعية. وقد تطرق البعض إلى هذه الأسئلة وتحاشى البعض إثارتها عن غير وعي حينًا وتجاهلًا لها أحيانًا كثيرة. وفى كل الأحوال أسفرت دراساتهم عن إجابات عديدة بتعدد الدارسين واختلاف مشاربهم الفكرية واهتماماتهم العلمية والتخصصية.
فلنعد إذن إلى ابن خلدون ومقدمته الشهيرة.
تتصدر المقدمة كتابه المعنون (بكتاب العِبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، وهو أصلًا كتاب في التاريخ يستعرض فيه المؤلف أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى عهده (الكتاب الثاني) وأخبار البربر ومن إليهم (الكتاب الثالث).
أما الكتاب الأول الذي يفرده للحديث عن العمران فقد استهله بمقدمة في (فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلمام بمغالط المؤرخين). وفيها يبدو اهتمامه الأصيل بعلم التاريخ ونظره الثاقب ورغبته الأكيدة في الاجتهاد ونزع التقليد. فالتاريخ (في ظاهره لايزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأوَل تنمو فيه الأقوال وتضرب فيه الأمثال (…)، وفى باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق)؛ ولذلك فإن التاريخ (محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيا بصاحبهما إلى الحق ويُنكِّبان به عن المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكَّم أحوال العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق)… (ص 3-4)
وبهذا الاعتبار يحتاج علم التاريخ إلى معارف أخرى إضافية فضلًا عن ضرورة المنهج وما يقتضيه من (نظر) و(تحقيق) و(تعليل).
تكشف نظرة ابن خلدون هذه عن موقف معرفي مشهور في تعامله مع علم التاريخ! ذلك أن من سبقه من المؤرخين كانوا يكتفون في معظمهم بالرواية والنقل والإسناد دون تمحيص أو وعي بما تخضع له كتابة التاريخ من (تشيعات للآراء والمذاهب) أو (الذهول عن المقاصد)، و(توهم الصدق) و(الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع). هذا فضلًا عن (الجهل بطبائع الأحوال في العمران) (ص 35). وهذا ما سيضطلع ابن خلدون بالكشف عنه في نقده لعلم التاريخ وتثويره المنهجي لطريقة النظر في المادة التاريخية. وفى ذلك يقول ابن خلدون عن نفسه: (أنشأت في التاريخ كتابًا سلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكًا غريبًا واخترعته من بين المناحي مذهبًا عجيبًا وطريقة مبتدعة وأسلوبًا، وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية ما يُمتِّعك بعلل الكوائن وأسبابها ويعرِّفك كيف دخل أهل الدول من أبوابها حتى تنزع من التقليد يدك وتقف على أحوال من قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك).
وهذا النقد هو الذي سيقوده إلى اكتشاف العلم الجديد.
ففى الكتاب الأول الخاص بالعمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من المُلك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والأسباب، نتبين العلاقة التي يسعى ابن خلدون لإقامتها بين علم التاريخ وعلم العمران؛ فحقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال. والكشف عن طبائع الأحوال في العمران يهدف إلى أن يكون للمؤرخ قانونًا في تمييز الحق عن الباطل في الأخبار، والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه، ومعيارًا صحيحًا ليتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه. (ص 32).
أما عن علم العمران الذي تمخض عنه هذا الموقف النقدي، فيقول ابن خلدون عنه: (وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني، وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم وضْيعًا كان أوعقليًا. واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفائدة أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص… وكأنه علم مستنبط النشأة)، ثم يضيف ابن خلدون بسَمْت العالم المتواضع: (ولعمري لم أقف على الكلام مني منحاه لأحد من الخليقة ما أدري لغفلتهم عن ذلك وليس الظن بهم أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا. فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل) (ص 38).
فهو إذن علم مبتكر لم يسبقه إليه أحد من قبل، وابن خلدون – كما نرى – واعٍ بهذه الجدة كل الوعي. أما عن علاقة علم العمران بعلوم أخرى مجاورة كعلمي (الخطابة) و (السياسة المدنية) فهو يؤكد أن علم العمران خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربما يشبهانه من بعض الوجوه (نفس الصفحة).
لكن ما موضوع هذا العلم الجديد: علم العمران؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تختلف باختلاف الباحثين أنفسهم؟ فقد رأى بعض الباحثين أن ما يتحدث عنه ابن خلدون تحت هذه التسمية هو نفس ما تحدث عنه الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت (1798- 1857) في أواسط القرن التاسع عشر باسم علم الاجتماع (السوسيولوجى)؛ ومن ثم اعتبر هؤلاء ابن خلدون مؤسسًا لهذا العلم ورائدًا له قبل (كونت) بأكثر من أربعة قرون ونصف.
ويقوم هذا الحكم في إثبات الريادة والسبْق على أساس المطابقة بين علم وآخر دون احتراز للفروق النوعية والخصوصيات بين ثقافة وأخرى مما يطرح إشكالًا معرفيًا لا مناص منه. ومن نفس هذا المنطلق ذهب آخرون إلى أن ابن خلدون هو المبشر الأول بالماركسية، وذلك بالاستناد الى عناصر منتقاه من فكر ابن خلدون من قبيل (جدلية الصراع) والعامل الاقتصادي في العمران البشري وأثره في التحولات الاجتماعية.
وإذا كان البعض يحصر علم العمران في مجال بعينه كعلم الاجتماع أو التاريخ، فإن البقية الأخرى من الباحثين ترى أن ما يُطلِق عليه ابن خلدون اسم علم العمران ليس ميدانًا لعلم واحد أو لفرع علمي محدد، بل هو مجموعة علوم مختلفة كعلم الاجتماع والإناسة وعلم النفس والتربية.
ومثلما اختلف الباحثون في تحديد هوية هذا العلم فقد اختلفوا كذلك في تقييم فكر ابن خلدون حتى عدَّه بعض الباحثين حالة فريدة بل شاذة في التاريخ العربي والإسلامي يصح النظر إليه من خارج الإسلام لا من داخله. وهنا تظهر لنا نزعة التمركز الأوروبي التي تتخفى أحيانًا عن الأنظار في دراسة التراث الإسلامي. وبديهي بعد ذلك أن يبحث هؤلاء عن جذور الخلدونية في مصادر فلسفية يونانية أرسطية ومشائية وأفلاطونية جديدة، وأن يذهل البعض إزاء عقلانية ابن خلدون فيفتعل التناقض بين فكره العلمي وعقيدته الدينية. لكن نفس هؤلاء الباحثين نراهم لا يقفون طويلًا عند تكوينه الأصلي الذي يعتمد حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية كشأن المتعلمين في المدارس الإسلامية سابقًا، وابن خلدون يطالعنا بنفسه على ذلك فيقول:
(وبعد أن استظهرت القرآن عن حفظي قرأته بالسبع أفرادا وعرضت قصيدة الشاطبي اللامية في القراءات والرائية في الرسم وعرضت تفسير أحاديث الموطأ لابن عبد البر ودرست كتبًا جمة مثل التسهيل لابن مالك ومختصر ابن الحاجب في الفقه. وفى خلال ذلك تعلمت صناعة العربية على والدي وعلى أساتذة تونس فحفظت كتب الأشعار الستة والحاسة للأعلم وطائفة من شعر المتنبى وشعر الأغانى…)
ذاك كان المصدر الأساسى لتكوين ابن خلدون قبل أن يتعاطى دراسة المنطق، والفلسفة، والعلوم الطبيعية، والرياضية. وقد كان لهذا التكوين الأصلي أثرًا بارزًا في فكره العلمي تدل عليه شواهد كثيرة في المقدمة نكتفي منها بإيراد الآثار التالية:
1- إن كلمة العمران التي يطلقها على العلم الجديد ترجع في اشتقاقها اللغوي إلى الفعل (عَمَر)؛ وقد ورد في سورتين، (وعَمَّر) الذي يرد خمس مرات في أربع سور، (واستعمر) و (مُعمَّر) و(عِماَرة) مرة واحدة في ثلاث سور مختلفة.
وهذه الصيغ وما يجاورها تتكرر مرارًا في تاريخ ابن خلدون منذ السطر الثالث من التقديم حيث نقرأ: (الحمد لله الذي أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها أجيالًا وأممًا….). ويقول في موضع آخر: (هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعًا لهذا العلم.) (ص 36).
وفى الكتاب الثاني في أخبار العرب نجده يفتتح المقدمة الأولى في أمم العالم واختلاف أجيالهم فيقول: (اعلم أن الله سبحانه وتعالى اعتمر هذا العالم بخلقه وكرَّم بني آدم باستخلافهم في أرضه وبثهم في نواحيها لتمام حكمته…)، وهي كلها دلائل تؤكد الدلالة الإسلامية لكلمة العمران واستحيائه للوحي القرآني نصًا وروحًا.
2- إن الحاجة إلى الاجتماع البشري أمر ضروري لحفظ النوع الإنساني، وهو يقوم – حسب ابن خلدون – على (تبادل النفع) و(التعاون) من أجل التكامل بين حاجات الأفراد لأداء مهمة الخلافة على الأرض: {وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون} (البقرة 30). وهذه النظرة إلى الاجتماع البشري قوامها التعاون والتكامل وليس الصراع والتنافر. وما يقال هنا عن الحاجة إلى الاجتماع يمكن أن يُقال كذلك بصدد رؤى أخرى حول مفهوم (الترف) والبداوة والحضارة واختلال العمران والسببية، وهي كلها رؤى وتصورات مستوحاة من النصوص القرآنية والسنة النبوية.
3- على صعيد القوانين العمرانية: يظهر نفس التأثير كذلك في قوانين عمرانية كثيرة مثل تحديده لعمر الجيل بأربعين سنة استخلاصًا من قصة ضلال اليهود في سيناء وقانون السببية (أو سنة الله باللفظ القرآني) والمدافعة وما إلى ذلك.
4- على الصعيد المفاهيمى: استخدم ابن خلدون ألفاظًا قرآنية عامة مثل الحق والباطل والصدق والكذب والظاهر والباطن ومفاهيم فقهية (كالمقصد) أو (المقاصد) و(المصلحة) و(تطبيق الأحوال على الوقائع)، ونحو ذلك من المفاهيم التي تُثبت هوية ابن خلدون الفقهية وتجعله بشكل ما (امتدادًا لمدرسة الفقه الإسلامي في دراسة التاريخ والعمران البشري) بالأساس.
أما عن حياة ابن خلدون ذاتها فقد زخرت بتجارب عاصفة عُرِف عنه خلالها بتنقله الفاعل في مناطق مختلفة من العالم الإسلامى وتقلبه بين دواليب الحكم في مدينة فاس وغرناطة وتلمسان، فشكلت بذلك رافدًا حيًا في تجربته الإبداعية ومصدر إلهام في تعقبه للحوادث واستقصاء لمجرياتها وبحث عميق عن بواعثها الظاهرة والباطنة؛ حينما لم يكن صانعًا لها بالفعل على مسرح الحياة السياسية والفكرية والعلمية في عصره. فمما لا شك فيه أن نسب ابن خلدون المتنقل – فهو ينتسب إلى أسرة أندلسية حضرمية الأصل أقامت في إشبيلية واستقرت في تونس حيث ولد – وانتمائه إلى أسرة عالية المقام سهلت له التدريج في سلم الوظائف الإدارية، والوزارية، والتعليمية، والقضائية التي مارسها في أماكن متفرقة ما بين الأندلس والمغرب والجزائر وتونس ومصر. هذا فضلًا عن مؤهلاته النفسية والعقلية التي شحذتها ظروف عصره الحضارية.
لقد عاش ابن خلدون فترة بدأت فيها الحضارة الإسلامية تنحسر شيئًا فشيئًا وتفقد حركتيها وامتدادها الجغرافي والعلمي على السواء. ونحن حينما نتصفح المقدمة تطالعنا الإشارات المتنوعة لهذه الحالة من الانحدار الذي اعترى العالم الإسلامي وأدى به إلى (عصر ما بعد الحضارة) حسب تعبير مالك بن بنى. لذلك ما أشد حرص ابن خلدون على فك إسار التقليد وفتح باب الاجتهاد على النحو الذي سار فيه هو نفسه بعمله الفريد في المقدمة. ذلك أن ظهور ابن خلدون في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الحضارة الإسلامية أثار اهتمام أكثر من دارس، وقد قال عنه أرنولد توينبى أنه (تصور وصاغ فلسفة هي بلا شك أعظم نتاج أبدعه أي ذهن في أي عصر وفى أي بلد)، واعتبره فرانز روزنتال (أحد كبار الشخصيات في كل الأزمان).
إن الإعجاب بشخصية ابن خلدون وبآثاره العلمية إعجاب صارخ من قبل من طالعوه من المهتمين والباحثين، وقد يطول بنا المقام لو أننا سردنا أسماء من درسوه وشهدوا له بالعبقرية وشرف الريادة والمجد العلمي. وبغض النظر عن جانب الإطراء أو الانبهار المفرط أحيانًا تجاه هذه الشخصية الإسلامية، تستوقفنا بعض الشهادات التي تعبر عن المسار التاريخي للمقدمة وأثرها في الفكر العلمي اللاحق. فقد قال أحد الدارسين عن ابن خلدون (أنه جاء بدون سلف وبقي بدون خلف). هل هذه المقولة صحيحة؟
الحق أن فهم ابن خلدون يستلزم وضعه في السياق التاريخي الذي اختطته الحضارة الإسلامية طيلة فترة زمنية تقارب ثمانية قرون كاملة، وهي قرون خصبة من العطاء تستدعي عقليات علمية فذة في مجالات متنوعة فقهية ولغوية وفلسفية وطبيعية ورياضية وطبية، ونذكر من هؤلاء الشافعي (767-820 ) والبخاري (ت 870) والخليل بن أحمد (ت 786) وسيبويه (796) والجاحظ (ت 868) وإخوان الصفا (القرن 10) والغزالي (ت 1111) وابن رشد (ت 1198) وجابر بن حيان (ت 815) والخوارزمي (ت 849) وابن الهيثم (ت 1039) والرازي (ت 972) وابن سينا (980- 1037).
بل إن علم التاريخ ذاته الذي انطلق منه ابن خلدون قبل اكتشافه لعلم العمران كان قد راكم تراثًا علميًا ضخمًا لمؤرخين كبار أمثال الواقدي (747 – 822) والبلاذري (ت 892) والطبري (ت 923) والمسعودي (ت 958) وغيرهم. فقد أتيح لابن خلدون من قوة الفهم وطاقة الاستيعاب والتمثل وثاقب النظر ما جعله يستوعب هذا التراث في مراميه الشاسعة وأن يمارس بصدده موقفًا (أصوليًا) على عادة الفقهاء في نقدهم للأسس المنطقية والمنهجية للفقه. إن هذا الموقف الأصولي أو (المعرفى) بلغة الفلسفة المعاصرة مكّنه من التجديد المنهجي في علم التاريخ وفتح المجال لعلم جديد ارتاده بكل ثقة واطمئنان.
إن ابن خلدون عالم مجتهد كبقية العلماء الذين سبقوه، بيد أن اجتهاده لا ينحصر في نقده لعلم التاريخ وكشفه عن العوامل التي تتحكم في الكتابة التاريخية وممارستها؛ وإنما يتجاوزه لعلم آخر لم يسبق أن اطلع عليه في كتب من سبقوه من الأوائل، وهذا الاكتشاف الجديد هو ذاته كشف للعلاقة بين علم التاريخ والعلم الجديد، فعلمى التاريخ والعمران علمين متصلين يكشف أحدهما عن الآخر.
(إن التاريخ – كما يقول ابن خلدون – خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم). وهذا الخبر هو خبر عما جرى وانقضى. وبذلك فإن التاريخ علم بما مضى، أما علم العمران البشري فهو علم بما يجري من الأحداث والوقائع الحاضرة، ولكنها تدخل في حوزة الماضي ويلفها التاريخ بمجرد انقضائها. فعلميّ التاريخ والعمران ينصب كليهما على (الاجتماع البشري) في حيزين زمنيين مختلفين، ولكنهما متصلان اتصال الماضي بالحاضر، وكل منهما يستدعي الآخر في لحظة ما.
ربما لهذا يستدعى وجدنا ابن خلدون يمزج بين التاريخ وعلم العمران في تحليله للوقائع، فلا يكف عن استدعاء ماضي الأحداث والصنائع والعلوم أثناء الاستقصاء والدرس والتحليل، فيوازنه بين الماضي والحاضر مثلما يقارن الأحداث والوقائع العمرانية في نفس الفترة التاريخية وفى أماكن متفرقة ليتمكن من التعليل والتفسير؛ فاكتشاف علم العمران لم يمنعه من مزاولة مهمته الأصلية في التأريخ. لكن العلاقة بين العِلمين لا تقف عند هذا الحد أي علاقة الموضوع المشترك، كلا إن الرباط الآخر الذي يشد كلا العلمين إلى بعضهما البعض هو رباط منهجي كذلك، وذلك مثل (قياس الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب). وبالفعل إذا كانت (الوقائع العمرانية) تقف شاهدة أمام عين الباحث وحواسهوعقله؛ فإن التاريخ علم بالغائب الذي لا يملك حياله الباحث إلا سمعه، ومن هنا فإن قياس الغائب على الشاهد من أحوال العمران، والاجتماع البشري يجنب المؤرخ مغبة الكذب والزيف والتوهم، مثلما أن قياس الحاضر بالذاهب يدل العالم العمراني على تطور الأحوال وتقلبها من طور إلى طور، فلا يحسبها جامدة ساكنة فيفقد معرفته بطبيعة العمران.
هذا التداخل في الموضوع وهذا الترابط في المنهج يقتضي تواصلًا في الزمان بين الماضي والحاضر وتشابهًا في العلم بين التاريخ والعمران. وفى علم العمران بالذات لا تحول شهادة الوقائع الحاضرة دون استدعاء شهادة الوقائع الغائبة بالطبع. إن الحاضر إذ يستدعي الماضي لا يمنع تحققه في الحاضر داخل حركة من التفاعل الدائرى المستمر، إلا أن علم العمران الذي ينصب بالأساس على الوقائع الشاهدة يحاصره التحقق الفعلي للأحداث فلا يتفلت منها، فإن للتجربة دخلًا أكبر في معاينة طبيعة العمران وتقصي أسبابه وعلله…
فى المنظومة العلمية للإسلام نجد أن علم التاريخ يدخل دائمًا ضمن العلوم النقلية؛ شأنه في ذلك شأن علوم القرآن والحديث والفقه، وفضلًا عن ذلك فهو علم تابع لهذه العلوم الأصلية التي تعتمد النقل والسماع والرواية، بل إن ظهوره في العصر الإسلامي الأول ارتبط أصلًا بتناقل أخبار السيرة النبوية بالمشافهة والرواية. ومن ثم فقد اعتمد التاريخ مبدأ الإسناد أول ما اعتمد واستمر على هذا الحال قرونًا بعد ذلك، فهل يظل مع ذلك علمًا نقليًا رغم تغير المتن؟. إن ابن خلدون إذ ينتقد من سبقه من المؤرخين ويبين بعض سقطاتهم في نقل الأخبار وروايتها وتقييمها؛ فإنه إنما يستند إلى براهين عقلية ومنطقية للكشف عن صدق الأخبار أو كذبها، ولكنه لا يقول شيئًا عن مكانة علم التاريخ ضمن العلوم الأخرى. هل يكون علمًا نقليًا كما كان سابقًا؟ ولكن علم التاريخ لم يعد مرتبطًا فقط بعلوم القرآن والسنة والسيرة، ففى المرحلة اللاحقة ارتبط التاريخ بالفرق الإسلامية واهتم بأمور السلطان والملك وما شابه، ونجم عن ذلك ما نجم من تشيع للاعتقادات وتقرب لأهل السلطان وذوي التجلة والمراتب. وهذا كله مما يستدعي إعمالًا للعقل وتحكيمًا لموازينه ومعاييره. ومن هنا فقد اعتبر أحد الباحثين أن ابن خلدون إذ يثور منهج التاريخ ويتغاضى عن ذكر مكانه بين بقية العلوم الأخرى فلكي يخرجه من الحيز النقلي الذي نشأ فيه إلى حيز عقلي تكون فيه المادة التاريخية ذاتها مجالًا ينفسح فيه العقل ويمارس فعاليته، وهذا ما قد لا تتيحه المادة النقلية الأصلية ذاتها.
إن التصنيف العلمي القائم على التمييز بين العلوم النقلية أو العلوم الشرعية من جهة والعلوم العقلية من جهة أخرى يصل منتهاه مع ابن خلدون. وأظن أن التفرقة الحاسمة التي يضعها ابن خلدون بين ما هو نقلى وبين ما هو عقلي ترجع في الأصل إلى المصدر ذاته وهو الوحي أو العقل، الله أو الإنسان. ومن ثم تتضح شرعية هذا الفصل القاطع وتنكشف مبرراته.
فمن حيث إن القرآن الكريم كتاب الله المنزل وحيًا فإن ما تفرع عنه من سنة وشريعة لا يخرج عن هذه الدائرة. والتاريخ الذي كان تاريخ وحي وسنة وسيرة ظل محصورًا في نطاق النقل والسماع حتى بعد أن خرج موضوعه عن الوحي. أما بقية العلوم الأخرى فهي علوم عقلية من حيث صدورها عن الإنسان وليست مختصة بوحي سماوي مخصوص، ومن ثم فإن الأمر فيها موكول إلى مصدر العقل أكثر من أي مصدر آخر سواه.
لكن ابن خلدون إذ يتجه إلى نقد الممارسة التاريخية والكشف عن الأسباب الذاتية والموضوعية التي تتعلق بطبيعة العمران، فهو بذلك يهدف إلى جعل التاريخ عِلمًا عقليًا يخضع لأصول المنطق ومستلزمات الواقع الحي. فبعد أن اتسع نطاق التاريخ ولم يعد النقل مادته الأصلية أصبح لزامًا على المؤرخ أن يُعمل عقله لكشف مواطن الزيف أو الخداع والكذب في إيراد الأخبار وتسجيلها وروايتها، ومن ثم ينفتح التاريخ على باب العلوم العقلية ليتخذ وضعية جديدة في سلم التصنيفات العلمية في التراث العلمي للإسلام. وفى ذلك يقول محمد وقيدى: (إذا كان ابن خلدون في تصنيفه للعلوم لا يذكر التاريخ ضمن العلوم الشرعية فليس ذلك إغفالًا منه لمكانة ذلك العلم ضمن هذه المعارف، بل إرادة منه في توضيح المكانة الحقيقية لعلم التاريخ التي هي ضمن العلوم العقلية. وفى هذا تثوير للتصور الذي كان قائمًا عن علم التاريخ بقدر ما هو تثوير للتصور الذي كان قائمًا عن نسق المعارف الإنسانية).
لكن ما هو هذا النسق؟
إن تصنيفات العلوم التي أقامها علماء المسلمين وفلاسفتهم تُطْلعنا بشكل عام على طبيعة هذا النسق وأسسه الفكرية والمعرفية داخل النمط العلمي والحضاري لعصرهم. لنستعرض بعض هذه التصنيفات قبل أن نشرع في الكشف عن هذه الأسس وتبيان دلالتها فيما نحن بصدده الآن.
يقسم إخوان الصفا العلوم إلى أربعة أصناف:
1- الرياضيات، 2- العلوم الجسمانية الطبيعية؛ 3- العلوم النفسانية العقلية؛ 4- العلوم الناموسية الإلهية.
يقوم هذا التصنيف – كما يبدو – على تقسيم رباعي للمعارف في عصرهم بحسب المجال الخاص بكل منها. فهناك أولًا مجال الفكر المجرد الذي تتسع له الرياضيات، وتتبعه العلوم الجسمانية الطبيعية وهي محدودة بحدود هذا المجال الذي يصطدم به الحس ويحكمه الامتداد في العالم المرئي، وهذا عكس العلوم النفسانية العقلانية التي يحددون لها مجالًا خاصًا بها، أما الصنف الرابع فهو صنف العلوم الناموسية الإلهية.
ويذكرنا هذا الصنف الأخير بما يسميه الخوارزمي في كتابه (مفاتيح العلوم) بالعلوم الشرعية وما يتصل بها من علوم تابعة بما في ذلك علم الأخبار وهو ما يتصل بعلم التاريخ.
الحقيقة أن العلوم الشرعية كان لها مكانة خاصة في النسق المعرفي الإسلامي عند مفكري المسلمين. فقد أفردوا لها مكانة متميزة ضمن المعارف القائمة في عصورهم، ولم يدمجوها ضمن الأنماط السابقة المتوارثة عن الحضارات السابقة. لذلك وجدنا أن الوحي القرآني وما تفرع عنه من سنة وتشريع وعلوم تبوأ منزلة متفردة في تفكيرهم العلمي. إن هذه العلوم وضعية أي من وضع الشارع الحكيم والحكم فيها موكول للوحي قرآنًا أوسنة، فهل يمكن بعد ذلك أن نقول إنها علوم عقلية؟
يقول ابن خلدون: (العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا تطمع أن تزِنْ به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال) (المقدمة ص 460).
بيد أن العلوم الشرعية هي أشمل مما نتصوره الآن. فإخوان الصفا مثلًا يعددون ضمنها العلوم التالية: علم التنزيل وعلم التأويل وعلم الروايات والأخبار وعلم السند والفقه والأحكام وعلم التذكار والمواعظ والزهد والتصوف وعلم تأويل المنامات. ويؤكد أبو حامد الغزالى العلاقة القائمة بين العلوم الشرعية، فيميز بين ما هو أصول وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، وما هو فروع كالفقه، وإلى ما هو مقدمات كالعلوم التي تجري مجرى الآلة ومنها اللغة والنحو؛ وهي وإن لم تكن من علوم الشرع فهي ضرورية لها. ثم أخيرًا هناك المتممات كعلم التفسير فيما يتعلق بالقرآن وعلم الآثار وعلم الأخبار. وهذا العلم الأخير بحسب تعريف الغزالى هو (العلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم، والعلم بالعدالة في الرواة والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف من القوي، والعلم بأعمارهم ليميز المرسل من السند وكذلك ما يتعلق به).
وهذا هو العلم الذي سيطوره ابن خلدون ليصبح علمًا عقليًا قائمًا بذاته، فبعد العصر النبوي وفترة الخلفاء الراشدين – رضوان الله عليهم – حملت الأخبار أسماء رجال من غير الصحابة والخلفاء داخلتها اتجاهات ومذاهب سياسية تشيَّع لها بعض المؤرخين مثلما تقرب البعض الآخر منهم لأصحاب التجلة والمراتب طمعًا في الجاه أو المال، وذلك على نحو ما يطلعنا عليه ابن خلدون.
لكن من حقنا أن نثبت هنا الحقيقة التالية: إن كان علم التاريخ هو تطوير لعلم الأخبار فإن هذا الأخير، بما هو كذلك أي علم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم والعلم بالعدالة في الرواة والعلم بأحوالهم وأعمارهم، هو علم جديد ومستحدث غير متوارث أمْلته ضرورة الشرع واقتضته صيانة الذكر الحكيم من كل تزييف أو تحريف أو تبديل: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}. وما نقوله هنا عن علم الأخبار والرجال يمكن أن نردده كذلك بصدد علوم أخرى كعلم الكلام والفقه وأصوله… فهي علوم جديدة لا نجد لها أثرًا في الأمم السابقة قبل الإسلام، وهي كلها ملتفة حول الشريعة، وما عداها من العلوم كالتصوف وعلم تأويل المنامات مثلًا فإننا وإن وجدنا لها أصلًا في الحضارات السابقة إلا أنها تتخذ من الوحي موضوعًا لها. ومن ثم فإذا كانت الفلسفة هي المعجزة اليونانية بامتياز فإن معجزة الإسلام الخالدة هي القرآن الكريم الذي كان المنطلق لبناء حضارة إنسانية عرفت أكبر استقطاب حضاري لأمم وأجناس وثقافات مختلفة شديدة الاختلاف وعلى امتداد زمني وجغرافي لم يعرف له التاريخ مثيلًا. فإذا كانت الحضارة اليونانية حضارية العقل فإن حضارة الإسلام هي حضارة القرآن.
من أجل ذلك كان للوحي القرآني منزلة فوق العقل والحس؛ مع ما نعرفه من احتفاء بالعقل وتقدير له في الحضارة الإسلامية ذاتها. ومع ذلك فقد حرص المفكرون المسلمون على أن يُنْزلوا العقل منزلته الصحيحة بإزاء الوحي، وأن يحددوا مجاله فلا يتعداه. ومن هنا يؤكد ابن خلدون على أنه ليست (المشاهدة أقوى دليل) ولا (البرهان أصدق شاهد وأعدل حاكم)، إذ الحق طريقه وعر وسبله مختلفة متعددة ليس العقل إلا وسيلة ضمن وسائل أخرى ممكنة. وبهذا الصدد فقد خالف ابن خلدون من يزعم أن الوجود كله الحسي فيه وما وراء الحسي تدرك أدواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية. (فكأنهم – يقول ابن خلدون – في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء).
بجانب النقل والعقل ثمة مجال ثالث يتصل بالواقع الخارجى. وهنا نجد شخصية ابن خلدون الفقهية واضحة في أحكامه وتصريحاته. يقول في الفصل الخاص بأحكام الفقه (علم الفقه وما يتبعه من الفرائض) ما يلى : (الوقائع المتجددة لا توفى بها النصوص). ومعنى ذلك أن للواقع الخارجى سلطانًا على النص والفكر يستلزم اجتهادًا متجددًا لمراعاة ما يطرأ في الخارج من أحداث وأقضية ووقائع لم تكن في الحسبان. (ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهني الكلي للخارج الشخصي، اللهم إلا ما يشهد به الحس من ذلك، فدليله شهوده لا تلك البراهين). وبذلك يتخذ الواقع مكانته البارزة في استصدار الأحكام وقبولها بدل الاقتصار على الإمكان العقلي وحده. (وإنما الإمكان بحسب المادة التي للشيء). وهكذا فإذا كان العلماء أبعد البشر عن السياسة ومذاهبها بأنهم معتادون النظر الفكري والغوص على المعاني وانتزاعها من المحسوسات وتجريدها في الذهن أمورًا كلية عامة ليحكم عليها بأمر العموم لا بخصوص مادة، ولا شخص، ولا جيل، ولا أمة، ولا صنف من الناس ويطبقون من بعد ذلك الكلي على الخارجيات فإن (السياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج) (ص 479).
على هذا الأساس مارس ابن خلدون نقده لعلم الأخبار السابقة عليه، ومن خلال ذلك كشف عن طبائع الأحوال في العمران، فكان رائدًا لهذا العلم ومجددًا في منهج التاريخ. لقد تعددت المنابع الثقافية والعملية في فكره واختلطت شخصية السياسي بالمؤرخ والفقيه والمربي في مقدمته. إلا أن فكره في الأساس امتداد لمدرسة الفقه الإسلامي في دراسة التاريخ والعمران البشري فضلًا عن أنه امتداد في مجال دراسته هذه للمدرسة العلمية العربية الإسلامية عند ابن الهيثم وجابر بن حيان وغيرهما. كما أنه امتداد كذلك للمدرسة الاعتزالية رغم حملته عليها، إذ كان الفقه دومًا في ارتباط متجدد مع واقع الناس وشؤونهم وقضاياهم، ولم يكن الفقيه ليبتعد أبدًا عن الأقضية المتجددة أو يزور عنها في معاملاته الفقهية وأحكامه وتشريعاته القضائية. فمازال فقه النوازل تراثًا حيًا يشهد بماضي الفقه المجيد ووجهه المشرق في مواجهة الواقع وتحليله ومعالجته وبذل الاجتهاد في فهمه وممارسته.
إن هذا الانفتاح على الخارج هو ما يميز مقدمة ابن خلدون – مثلا – عن آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى (ت 950)؛ فإن هذا الأخير أقام مدينة على النمط المثالي الذي سار عليه أفلاطون في جمهوريته. فالمدينة هنا – كما يتصورها الفارابي – مدينة فاضلة لا علاقة لها بالواقع إلا من حيث اعتمادها على ما لا يجد له تحققًا عيانيًا في العالم الخارجي، فيأتي الفيلسوف ليَبني بألفاظه وأفكاره مدينته المجردة المتعالية عن دنيا الناس وبلاياهم. لم يكن ابن خلدون ليتجه هذه الوجهة، فقد كان شاهد حضارة بلغت أوج التقدم والرقى لتبدأ دورة الانحدار والاضمحلال شأن غيرها من الحضارات السالفة. ولعل هذا الظرف الحضاري ذاته هو الذي قاد ابن خلدون إلى أن يطرح السؤال الكبير حول نشوء الحضارات وزوالها والعوامل المتحكمة في ذلك كله على نحو ما اختطه في نظريته المعروفة عن الأدوار الحضارية الثلاثة.
مما سبق نتبين أن التمييز بين العلوم النقلية والعلوم العقلية راجع إلى المكانة الخاصة التي احتلها النقل داخل الحضارة الإسلامية وإلى ما اختص الله به أمة العرب من معجزة القرآن الخالدة. ومن ثم اقتضى الوحي منزلة خاصة في النسق المعرفي لمفكري الإسلام باعتباره المصدر الإلهي الأعلى. أما العلوم العقلية فهي تخص الإنسان (من حيث إنه ذو فكر)، وهي لذلك مِلك مشترك بين كل الأمم ولا تختص بها ملة أو نحلة دون غيرها، بل يستوي في مداركها ومباحثها كل الناس وهي موجودة في الجنس الإنساني منذ كان العمران البشري.
إن التمييز بين النقل والعقل – كما ذكرت سابقًا – يكاد يكون تمييزًا حاسمًا عند ابن خلدون؛ وإذا صح أنه قد صيَّر التاريخ علمًا عقليًا بعد أن لم يعد علمًا بالأخبار سنده الرواية والإسناد فحسب، فأين يجد علم العمران مكانته من هذا التصنيف؟
لن أسارع بالإجابة عن هذا السؤال، فابن خلدون نفسه لا يقول عنه شيئًا، ومن ثم هل يكون علم العمران علمًا عقليًا شأنه في ذلك شأن علم التاريخ؟ ولكن ابن خلدون كذلك لا يذكر التاريخ ضمن تصنيفه الثنائي للعلوم.
هذه إشكالية مفتوحة تقتضي البحث والمعالجة. وابن خلدون إذ يترك الجواب معلقًا يحفزنا للتفكير والاجتهاد وإعمال العقل. ولكنه يضعنا أمام تقسيم أولي يصنف بموجبه العلوم إلى صنفين: (صنف طبيعى للإنسان يهتدى إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه). فهل يكون علم العمران أحد هذين الصنفين أم أنه صنف ثالث؟
إن صمت ابن خلدون وتواضعه العلمي الذي عرف عنه يدفعنا إلى أن نذهب هذا المذهب الأخير. فعلم العمران بوصفه علمًا مختصًا بالعمران البشري والاجتماع الإنساني (يستند إلى توجيهات نقلية تخص الإنسان الذي هو مناط بمهمة التكليف بحمل الأمانة والاستحلاف في الأرض، ومن جهة أخرى فإن هذا العلم الجديد قد أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص)، مما يدل على دور العقل في استنباطه ونشأته على يديه.
وهكذا فإذا كان الوحي يفترض مكانة خاصة متميزة عما سواها؛ فإن العلوم النقلية التي مادتها القرآن والسنة لا تعني إبطالًا للعقل مادام أن العقل يجد فيها مجالًا معينًا على الأقل في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول. كما أن العلوم العقلية إن كان مصدرها هو العقل فإن للوحي وتوجيهاته مكانتها بلا شك. ونجد في نشأة العلوم الطبيعية والعقلية في الحضارة الإسلامية دليلًا على هذا القول. بل إن نزول الوحي ذاته جعل للقرآن وضعًا خاصًا في الممارسة العلمية للمسلمين كما لم توجد سابقًا في الحضارات السالفة. لذلك وجب تخصيص العلوم التي التفت حول القرآن الكريم والسنة النبوية بسِمة النقل والسماع تمييزًا لها عن العلوم السابقة التي لم يكن لها من مصدر آخر سوى العقل على نحو ما تطلعنا عليه المعجزة اليونانية بالتحديد. بل إن الفقه وأصوله الذي كان فيه للعقل مرتبة عُليا في الاستقراء والاستنباط من النص والواقع إنما يُقرن دائمًا بصنف العلوم النقلية لنفس هذا الاعتبار طالما أن سنده الأسمى هو الوحي.
أما علم العمران – فطبقًا للمقاييس الخلدونية ذاتها في التصنيف – يتاخم الحدود المجاورة للنقل والعقل معًا مما يخفف من حدة البت والحسم اللذين ميزا تصنيف العلوم لدى ابن خلدون وبعض من سبقه. من هنا يمكن أن نضع علم العمران في منزلة وسطى بين النقل والعقل.
لكن ماذا عن علوم الإنسان؟
تطلَق هذه التسمية على مجموعة من العلوم التي تختص بدراسة الإنسان والمجتمع ومظاهره التاريخية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية. وقد ظهرت هذه العلوم بأوربا بعد ما يقارب خمسة قرون على تأسيس علم العمران؛ ففى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بدأت ملامح علم الاجتماع تتحدد على يد أوجست كونت وتبعته الإناسة وعلم النفس. لقد كان للفلسفة الوضعية التي سادت أوربا في هذا القرن أثرًا حاسمًا في نقل المعرفة بالإنسان والمجتمع من طور التأمل الفلسفي التجريدي إلى طور آخر يكون عماده الوحيد الملاحظة الحسية والخبرة المباشرة لا غير. وقد قطع هذه الاتجاه الطريق على الفلسفة الأم لتبدأ رحلة الاستقلال التدريجي بالنسبة للعلوم التي كانت تحتضنها سابقًا حتى تشق طريقها بانفراد وثبات. ومن جانب آخر فإن الفلسفة الوضعية شكَّلت موقف حصار أشد بالنسبة للدين والتفكير اللاهواتي عامة. إذ إن الاعتماد على الملاحظة وحدها معناه إلغاء ما عداها من المفاهيم والأفكار التي كان يغص بها الفكر الديني وتسانده الكنيسة المسيحية ورجالاتها. والحق أن الصراع بين الدين والعلم في أوربا المسيحية شكَّل ظاهرة بارزة في الفكر الأوربي منذ أوائل عصر النهضة. ففى فترة السيطرة الكنسية واشتدادها قامت محاكم التفتيش التي اقتيد إليها علماء كبار شكَّلت اكتشافاتهم خطرًا مباشرًا على التعاليم الدينية المسيحية. وحينما خفت هذه السيطرة بعد قيام الثورة الفرنسية بدأ العلم يأخذ شيئًا فشيئًا مكانته لينافس الدين وينازعه الحق في تنظيم حياة الفرد والمجتمع. وقد انعكس هذا الصراع داخل هذه العلوم على نحو جلي.
والواقع أن تواطؤ الكنيسة والدولة كان قد بلغ حدًا لا يطاق من سيطرة رجال الدين وتحكمهم في رقاب الناس وأفكارهم وحرياتهم العامة. ومع ما داخل الدين المسيحي من عقائد لاهويتة مثل عقيدة التثليت والخطيئة الأصلية، أو تصورات أخلاقية حول الجنس والجسد أصبحت الحياة الفردية ذاتها موضع تأزم واضطراب بلغت أوجها في العصر الفيكتوري إبان القرن التاسع عشر بحيث لم يكن هناك مخرج آخر سوى الميدان العلمي الذي جسدت فيه علوم الاجتماع والنفس والتحليل النفسي فيما بعد خير مُعبِر عنه.
يقول ميشيل فوكو في هذا الصدد: (إذا كان القمع هو النمط الرئيسي للارتباط بين السلطة والمعرفة والجنس، فلا يمكن الانعتاق منه إلا بثمن باهظ، إذ لا تستلزم ما هو أدنى من انتهاك للقوانين ورفع للمحرمات وإبراز الكلام وإرجاع اللذة إلى الواقع، وفضلًا عن ذلك كله يتطلب اقتصادًا جديدًا في آليات السلطة؛ ذلك أن سني الحق مهما قل فإنه خاضع للظرف السياسي.)
لقد شمل هذا الانتهاك مبادئ الدين المسيحي نفسه، وتعمد العلماء إلغاء بعض هذه المبادئ ووضعها موضع التساؤل. فقد وضع (باراسيلز) منذ سنة 1520 نظرية (تعدد الأصول الإنسانية) التي تناقض فكرة التوراة حول منشأ الإنسان وأصله. وانتشعت هذه النظرية فيما بعد وسارت في إثرها محاولات جديدة لتحوير التوراة والخروج منها بنظريات مناقضة لما كان في السابق من أفكار حول النشأة والتكوين والخلق. وحينما نشر شارل داروين كتابه حول (أصل الأنواع) (عام 1858) أحدث وقعًا بارزًا في العالم الغربي وضربة عنيفة للتعاليم الدينية حول خلق الإنسان ونشأته. وقد كان لهذه النظرية امتداد في علوم الإنسان على نحو ما دُعي فيما بعد (بالداروينية الاجتماعية).
بعد ذلك دخل علماء الإنسان وفلاسفته في مرحلة مواجهة صريحة مع الدين؛ فقد كشف فيورباخ عن الخلفية الاستلابية للدين، وبيَّن ماركس وانجلز الأساس الاجتماعي للدين بوصفه نتاجًا من نتاجات المجتمع التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنشاط المادي للأفراد وعلاقات الإنتاج السائدة بينهم. ومقولة ماركس المعروفة (الدين أفيون الشعوب) تنطبق بالتأكيد على الحالة التي آل إليها الدين المسيحي في القرن الثامن عشر بأوروبا خاصة؛ فإن الكنيسة كيفت هياكلها بحسب بنية النظام الإقطاعي وانتهت إلى أن أصبحت هي نفسها (السيد الإقطاعي) الأكثر قوة، إذ كانت تملك ثلث الأراضي الزراعية في أوربا.. ولهذا كان لزامًا على البورجوازية الصاعدة أن تبادر بتحطيم التنظيم المركزي المقدس (الكنيسة) للإقطاع قبل مهاجمته في جزئياته في كل بلد.. (م. بارتران، مكانة الدين من ماركس وانجلس من كتاب مصطفى التواتي: التعبير الديني، الصراع الاجتماعي في الإسلام، دار الفارابي بيروت 1986.).
وقد سعى عالم الاجتماع الفرنسي اميل دوركايم إلى البحث عن الأصول الاجتماعية للدين من حيث هو مصدر جمعي للمعتقدات والشرائع داخل مجتمع ما، وسار على هذا النحو عدد من تلامذته وأتباعه داخل فرنسا وخارجها. أما فرويد فقد حاول الكشف عن الأساس اللاشعوري للاعتقاد الديني في حياه الإنسان، وأبرز فكرة الوهم التي يعبر عنها هذا الاعتقاد. وكتاباته تكتشف أحيانًا عن مواجهة صريحة بين رجال الدين والعلم، وفى ذلك نجده يقول: (إن الصراع مازال مستمرًا، فأنصار التصور الديني للكون يتصرفون وفقًا للمبدأ القديم: أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم).
وقد ولّد هذا الهجوم على العلم هجومًا مضادًا من طرف رجال العلم أدى شيئًا فشيئًا إلى ترجيح الكفة لصالح العلم، وأخذ الدين يتوارى بالتدريج ليترك مكانه للعلم ورجالاته. وإذ فقدت علوم الإنسان هذا السند الروحي بعد ماداخلت الدين المسيحي عدد من التصورات والعقائد الغريبة عنه، فإنها اتجهت إلى علوم الطبيعة بحثًا عن (مبررات) علمية لقيامها؛ وفى أجواء الفلسفة الوضعية التي كان يتنفس خلالها علماء القرن التاسع عشر بأوربا حدث تماه شبه كلي بعلوم الطبيعة وخاصة علم الحياة والفيزياء. ونحن نعلم أن أوجست كونت دعا علمه الجديد (بالفيزياء الاجتماعية) قبل أن يطلق عليه اسم علم الاجتماع. أما سيجموند فرويد فقد ضمَّن (مشروعه لعلم نفس علمي) وصفًا للحياة النفسية الداخلية على غرار الحديث عن الجهاز العصبي ووحدته العصبية. ونقل إميل دوركايم ما يشبه ذلك في تعريفه للوقائع الاجتماعية بوصفها أشياء منفصلة عن الذهن وقائمة في الخارج. وبذلك فُتح الباب لتشيئ الإنسان والانتقال من تماهي هذه العلوم الناشئة بالعلوم الطبيعية إلى تماثل الحياة الإنسانية بالعالم المادي للأشياء.
ومن ناحية أخرى فقد أدت نظرية (الداروينية الاجتماعية) إلى الانتقال بمفهوم التطور من المجال البيولوجي إلى الحياة الاجتماعية والثقافية والحضارية، فظهر مفهوم البدائية الذي ألحق بالمجتمعات التي لا تسير في تطورها بنفس السرعة التي تسير عليها المجتمعات الأوربية. وهكذا انقسم المجتمع الإنساني إلى مجتمعات بدائية ومجتمعات متحضرة تمثلها أوربا التي اعتبرت نفسها في أرقى درجات الحضارة، ووضعت تراتبية خاصة تتدرج من الحيوان إلى الإنسان (المتحضر). وقد أدى هذا الاستعلاء إلى اشتداد نزعة التمركز الأوربي نحو الذات بوصفها المركز الذي تقاس به الأطراف المحيطة به. وقد كان ذلك مبررًا للتوسع الاستعماري لأوروبا وتسلطها على غيرها من الشعوب. ولعل هذا الموقف هو ما جعل أنجلس مثلًا يقف موقفًا سلبيًا من ثورة عبد القادر في الجزائر وثورة عرابي في مصر. فرغم إدانته لطريقة بعض الجنود الفرنسيين في خوض الحرب، فقد رأى (أن احتلال الجزائر أمر هام ومفيد لتقدم الحضارة).
ومثلما تمت تصفية العلاقة بين الدين والعلم، فقد سعى علماء الإنسان الى تصفية ما تبقى من الجوانب الروحية للإنسان وتقريبه ماأمكن إلى المخلوقات الحيوانية تبعًا لنظرية داروين حول النشوء والارتقاء، وذلك بالتركيز المستمر على الجوانب الغرائزية التي تربطه بالحيوان. يقول سيجموند فرويد في ذلك: (عند الحيوان الإنساني تحدث الأمور بنفس الطريقة من غير شك، فإن وراثته الأثرية رغم اختلاف امتدادها وطبيعتها تشبه غرائز الحيوانات).
ومالبث بعد ذلك أن أعلن البعض عن احتضار الإنسان على المستوى المعرفي (ميشيل فوكو) أو موته روحيًا (إريك فروم). فماذا بقي بعد ذلك من موضوع لهذه العلوم؟
إن هذا الاستعراض السريع لنشأة علوم الإنسان في أوربا وما لابس ذلك من ظروف وملابسات يكشف لنا عن أن نشأة هذه العلوم كانت وليدة قطيعة مع الإرث الديني المسيحي الذي سعى العلم إلى التخلص منه والقضاء على التسلط الكنسي الذي كان يأخذ بخناق الفرد والمجتمع. وبصعود العلم وانتشار قيمه تم تعويض الدين تدريجيًا حتى اتخذت بعض علوم الإنسان مظهرًا شبه ديني في حياة الأفراد والمجتمعات.
وإن المقارنة بين علوم الإنسان وعلم العمران تطلعنا على وجه آخر مختلف عن الإنسان والمجتمع والقيم الدينية؛ فعلى حين اتخذت علوم الإنسان موقفًا صراعيًا من الدين المسيحي؛ فإن علم العمران – كما رأينا – يستوحي النص القرآني استيحاءً مباشرًا في تأكيده على عمارة الكون ومهمة الاستخلاف في الأرض. وإذ تجعل المسيحية نفسها طرفًا في مواجهة متبادلة مع العلم؛ يؤكد القرآن الكريم على قيمة العلم وعلو منزلته بإزاء الإيمان: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}، مثلما يؤكد كذلك على وحدة الخلق والنشأة: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء}، {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم}. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب).
هذه النصوص كلها تؤكد على فكرة الوحدة التي عدلت عنها الإناسة الأوربية في بدء نشأتها قبل أن تتراجع عنها لصالح فرضية جديدة تشدد على (وحدة الطبيعة الإنسانية). إن هذا التراجع في حد ذاته يشكل ظاهرة ملاحظة في تاريخ علوم الإنسان، فالفكر الأوربي يبدو كما لو كان يسير وفق آلية (النفى الذاتى) المستمر، ومن هذا المنظور يمكن أن نعتبر الأنظمة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كتعبير عن هذا النفي؛ فقد ظهرت الماركسية في مواجهة الليبرالية، والاشتراكية كرد على الرأسمالية، والديمقراطية في مواجهة الديكتاتورية، وهكذا دواليك. ومن جهة أخرى ظهر الصراع بين الدين والعلم والكنيسة والدولة والفرد والمجتمع، بل وفى داخل الإنسان ذاته ظهرت ثنائية الروح، والجسد، والعاطفة، والعقل.. حتى يصح أن يقال إن بنية الصراع هي إحدى البنيات المشَكّلة للفكر الأوربى خاصة، أما ما يستتبعه من توازن أو تركيب يأتي في مرحلة ثانية. في حين أن الفكر الإسلامي يقوم بالأساس على فكرة التوازن أولًا، فالإنسان روح وجسد وعقل ووجدان، والإسلام دين ودنيا وعقيدة وشريعة، والإيمان علم وعمل ظاهر وباطن وهكذا دواليك. أما الصراع فيأتي في مرحلة ثانية إما تعبيرًا عن الحركية العامة لهذه الأطراف وإما تعبيرًا عن الاختلال، ومن ثم فقد تميز الفكر الإسلامي بالوسطية في مقابل الجدلية التي طبعت الفكر الأوروبي خاصة.
هكذا يقودنا علم العمران إلى علوم الإنسان مثلما قاد التاريخ ابن خلدون إلى الكشف عن طبيعة الأحوال في العمران. ومن خلال ذلك تبينا كيف تحَكّم تكوين ابن خلدون العلمي وتجارب حياته الخصبة في نقده للتاريخ وارتياده آفاق علم جديد لم يرتده أحد ممن سبقه. لقد كان لظروف عصره تأثير على هذا التوجه في فكره على نحو ما نعرف له من تنظير حول أدوار الحضارة وتدرجها من النشأة والنمو إلى الانحدار والاضمحلال الذي شهد بعض آثاره في مناحي الفكر والواقع الاجتماعي والسياسي والحضاري بشكل عام. وقد تبينا كذلك أثناء الاستعراض السريع لنشأة علوم الإنسان في أوربا كيف تحَكّم الدين سلبًا وإيجابًا في بروز هذه العلوم واستجابتها لحاجات الإنسان والمجتمع على إثر القطيعة التي حدثت داخل أوربا بين الدين والواقع وما لحق ذلك من انعكاس على الاتجاهات السياسية والاجتماعية والعلمية.
وخلاصة القول إن علم العمران وعلوم الإنسان يخضعان معًا إلى نمطين حضاريين متمايزين، لكل منهما خلفيته العقدية والفكرية والعلمية وأسسه المعرفية التي تتحكم في كلتيهما داخل سياق زماني محدد، فأيهما نختار: علم العمران أم علوم الإنسان؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المقال منشور في:
أحمد المطيعي (1990). علم العمران وعلوم الإنسان. مجلة المسلم المعاصر. س. 14 (55- 56). ص ص. 31- 48.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies