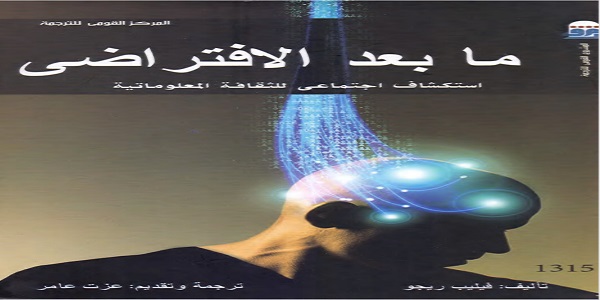العنوان: نقد القراءة العلمانية للسيرة النبوية: الدراسات العربية المعاصرة أنموذجًا.
المؤلف: منير بن حامد بن فراج البقمي.
الطبعة: ط. 2: طبعة مزيدة ومنقحة.
تاريخ النشر: 2024.
مكان النشر: جدَّة.
الناشر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث.
الوصف المادي: 459 ص.؛ 24 سم.
الترقيم الدولي الموحد: 978-603-91776-2-3.
إن دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القضايا المتجدِّدة بتجدُّد الأزمان. لذا، لم يَخلُ زمانٌ منذ وفاته عليه السلام من أن يتناول أهلُه سيرتَه بالدراسة والنظر. غير أن العصر الحديث بتبدُّل مفاهيمه وقِيَمه، وسيلان أحكامه، واندثار أثر الرسالات في معاييره الوازنة، ونزوعه ناحية المادية، قد جعل النظر إلى القضايا التاريخية الدينية، ومنها السيرة النبوية، موضعًا للمراجعة والنقد، لكن بمعايير هذا الزمان وإكراهاته، فتشعّبت الرؤى، وتعرضت حقائقها للهدم والتقويض.
وفي هذا السياق، يقدِّم د. منير البقمي أطروحته العلمية المحقَّقة التي قصدت إلى نقد القراءات العلمانية، العربية المعاصرة على نحوٍ خاص، للسيرة النبوية، بمقارنتها بقراءة علماء الإسلام السابقين في هذا الصدد؛ فبيَّنت الأطروحة مصادر ومناهج القراءة العلمانية للسيرة النبوية، وكشفت عن كيفية قراءتها لمصادر السيرة وتدوينها، والشبهات المتعلقة بذلك من تأخر التدوين والتدخل السياسي في تدوين السيرة. كما عرضت، بدراسة تفصيلية وتحليلية، للقراءة العلمانية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة قبل البعثة، وعلاقته بظاهرة الأديان قبل البعثة، ودعوته عليه السلام في مكة، والمعارضة المكية لدعوته، وكذا دعوته عليه السلام في المدينة، والمعارضة العلمانية لدعوته في هذه الفترة.
والحق أن أطروحة البقمي تتسم بمنهجية منضبطة، وتقديمها رؤية بانورامية سلِسة، تزيِّنها الحجج المنطقية والحاسمة، والاستعانة المستفيضة بالدلائل والاقتباسات من الكتابات والوثائق العلمانية والإسلامية على السواء، دون إفراطٍ أو تفريط. وقد آثرنا في أحيانٍ كثيرة الإشارة في هوامش هذا العرض إلى المراجع التي أوردها الكاتب في كتابه؛ تحقيقًا للإفادة، واستكمالًا للرؤية.
هذا، وقد قسَّم البقمي كتابه إلى مدخل وخمسة فصول، ناهيك عن مقدِّمة، وخاتمة تناول فيها أبرز استخلاصاته.
المدخل
مفهوم العَلْمانيَّة
استهلَّ البقمي أطروحته بمدخل حول مفهوم العلمانية (Secularism) الذي تقوم عليه الدراسة؛ حيث أصَّل له، ليخلُص إلى أنها تعني: “الدنيوية في الأحكام والتفسيرات والتصورات، مقابل النظرة الدينية في الأحكام والتفسيرات والتصورات، والتي تستند إلى الكتب المقدَّسة”.
واجتهد البقمي في تعيين الأسس الفلسفية التي تقوم عليها الرؤية العلمانية للعالم، وحَصَرها في أربعة؛ أولًا: إنسانية مصادر المعرفة (سواء بالعقل أو التجربة أو الحسّ)، وانزواء البعد الغيبي الميتافيزيقي، وتصاعد مفاهيم مثل “العِلمويَّة” أي الإيمان المطلق بقدرة العلوم التجريبية والطبيعية على حل كل القضايا ومعرفة الأشياء؛ ثانيًا: مادِّيَّة الوجود (باعتبار الرؤية العلمانية تضم الفلسفات المادية المعاصرة كالماركسية والداروينية والبراغماتية النسبية والوجودية والنفسية والإلحادية واللادينية)؛ ثالثًا: الصيرورة أو التغير الدائم (نتيجة للتفسير المادي وظهور مرحلة الحداثة وما بعدها، والتي تُوصَف بأنها مرحلة سائلة بلا مركز أو مرجعية والكل في تغير مستمر، مع طغيان اللايقين في كل شيء، لأنه لا يُستبعَد ما ينقضها في المستقبل، فلا حقائق مطلقة أو ثابتة ولا عِلَل أو غايات)؛ رابعًا: نسبية الحقيقة والأخلاق (حيث لا وجود للمُطلَقات ولا الكليَّات اليقينية الأنطولوجية الخارجة عن نطاق المادة، فيما تُحدِّد المنفعة المادية هذه النسبية).
وقد أكد البقمي على تناوله للعلمانيين العرب حصْرًا، في هذا الموضوع، دون غيرهم، إلا فيما تقتضيه الضرورة. وعرَّفهم بأنهم “كل مَن قرأ السيرة النبوية قراءة علمانية، كإطار عام يحكم تصوراته وقراءته للسيرة النبوية، لا يخرج عن حدوده”. وممَّن ذكرهم البقمي كلٌ من: محمد أركون (الجزائر)؛ ومحمد عابد الجابري وعبد الإله بلقزيز (المغرب)؛ وهشام جعيط وحسن بزاينية وعبد المجيد الشرفي والعفيف الأخضر وحياة عمامو (تونس)؛ وحسين أحمد أمين وخليل عبد الكريم وعبد الرحمن الشرقاوي ومحمد عبد الحي شعبان وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد (مصر)؛ وحسين مروَّه (لبنان)؛ وطيب تيزيني (سوريا)؛ ومعروف الرصافي (العراق)؛ وعلي دشتي (إيران).
ويشدِّد البقمي أن دراسته معنيَّة بالشق التاريخي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، من مولده إلى مماته، وليس إلى أصول الإسلام التي يتوقف التصديق بها على صدق النبي عليه السلام، وما جاء ارتباطًا بذلك في سيرته العطرة، موضحًا أن العلمانيين العرب قد يُدخِلون أو يخلطون في السيرة بين كلٍ من: الوحي، قرآنًا وسُنة؛ والنبوَّة؛ والسلوك الشخصي للنبي، سواء قبل البعثة أو بعدها.
الفصل الأول
مصادر ومناهج القراءة العلمانية للسيرة النبوية
- المصادر
على صعيد مصادر القراءة العلمانية العربية للسيرة النبوية، يشير المؤلف إلى أنها تنحصر في ثلاثة، هي: الاستشراق، وأقوال الفِرَق المخالفة لأهل السنة والجماعة، والأخبار الواهية.
فأمَّا الاستشراق، فذكر أن الغالب عليه في الموقف من الإسلام هو التشويه والافتراء، حيث يُنظر إلى الإسلام من خلال ما يجمعه من الشُّبه والمثالب. ومع ذلك، يُعظِّم العلمانيون العرب صراحةً الكتابات الاستشراقية حول السيرة النبوية، بكل ما فيها من عورات، ويرون أنه لولا المستشرقين الذين كتبوا في هذا الصدد[1]، لبَقيَ القرآنُ ونبيُّه لغزًا، بفضل ما تتمتع به كتابات هؤلاء من عمق وموضوعية وجدِّيَّة مستنيرة، على ضوء العلوم الحديثة. ويبيِّن البقمي أن الهالة الإعلامية التي واكبت الاستشراق مع ادّعاء المستشرقين المنهجية في البحث، وقيامهم بالتدريس في بعض الجامعات العربية، وتتلمُذ بعض العلمانيين العرب عليهم في جامعات أوروبا؛ كلها أمور كان لها دور كبير في تشكيل الإطار الفكري والصيغة المنهجية والمعطيات المعرفية لجيلٍ من الدارسين عُدَّ الجيل الأول من الباحثين العرب. لذا نجد أن هؤلاء المستشرقين قد علا صيتُهم في البلدان العربية، رغم أن معظمهم لا يحظى بذات الشهرة في بلده الأم.
ويعيب البقمي على العلمانيين العرب قبولهم المبالغة في إسقاط المستشرقين للواقع على السيرة النبوية؛ لأن المستشرقين غرباء لغةً ودينًا وبيئةً وزمنًا، ولهم تراثهم الخاص الذي يُحاكِمون الإسلام في ضوئه، ما يجعل إسقاطاتهم مليئة بالأخطاء. هذا فضلًا عن الغاية التنصيرية للاستشراق؛ بحكم أن الأخير وريث للتركة النصرانية في حربها مع الإسلام، منذ الحروب الصليبية في القرن السابع الهجري، مرورًا بالقرنَين التاسع عشر والعشرين، حين كان أحد أذرع المستعمر الغربي النصراني، لترسيخ ما ظفر به من البلدان العربية والإسلامية.
أما المصدر الثاني للعلمانيين العرب، وهو أقوال الفِرَق المخالفة لأهل السنة والجماعة، فيرى البقمي أنها ترجع إلى المدرسة العقلية، وفي مقدمتها المعتزلة، أو الإلحادية أو الشيعية أو الصوفية؛ مشيرًا إلى أن الغالب على استدلال العلمانيين واستعانتهم بمقولات هذه الفرق هو: إما استدلالٌ بالأقوال المغالية في نقد التراث الإسلامي؛ باعتبارها من أقوال إسلامية رافضة للدُّغمائية [الجمود] والأرثوذكسية المُسلِّمة للميتافيزيقا، أو استدلالٌ بأقوال الباطنية؛ باعتبارها تشكِّل وجهًا آخر لفهم النص، وارتباط ذلك الفهم بالقارئ، لا بمعنى ثابت، وهو ما يتوافق مع التأويلية الحديثة المرتبطة بالفكر المادي. ويُبرِّر العلمانيون استعانتهم بهذه الأقوال على اختلافها بالحاجة لاستكمال الصورة حول السيرة النبوية، وعدم الاقتصار فقط على إسلام الأغلبية [الإسلام السُّنِّي]، وربما ادَّعوا أن هذه الأقوال من “المسكوت عنه” و”المُهمَّش” الذي أعادت العلوم الإنسانية الحديثة الاهتمام به والتركيز عليه. كما أن ذلك يخدم مسعاهم – على نحو ما ذكر أركون – للتمييز بين مرحلة “النقل الشفهي” ومرحلة “الكتابة” التي تشكَّلت فيها مخطوطات كلٍ من التراث السُّنِّي والشِّيعي والخارجي [نسبةً إلى الخوارج]، بما يتجاوب مع التحليل الأنثروبولوجي الذي يُحلِّل التنافس التاريخي المزعوم بين “العقل الشفهي” و”العقل الكتابي”، والذي ينادي به أتباع المدارس الفرنسية الحديثة في دراستها للتاريخ.
ومن الأمثلة التي يُستَعان بها في هذا الصدد: قولُ الصوفية بأن النبي ليس له ظل، وأنه علَّة الخلق. ومن جهة الشيعة: أن النبيَّ مات مسمومًا على يد أبي بكرٍ وعمر لأجل وراثة المُلك من بعده. ويرد البقمي بأن هذه الأقوال بدعيَّة تخالف الثابت من جهة الشرع في سيرة النبي عليه السلام، ثم إنها أقوال ترى الحق مُنحصِرًا فيما تذهب إليه تبعًا لمصادر المعرفة الدينية لدى أصحابها، فهناك الأذواق والرؤى عند الصوفية، ونظرية الإمامة والأئمة عند الشيعة.
المصدر الثالث، وهو الأخبار الواهية، بما في ذلك تلك الموضوعة، التي تشكِّل مادةً للعجائبيات والخرافات. إذ يلجأ إليها العلمانيون خصوصًا في تصويرهم لسيرة النبي عليه السلام ومجتمعه قبل البعثة، وما جرى فيه من إرهاصات ومعجزات متعلقة بالنبوة، بغرض الكشف عن مدى تأثيرها فيما جاء به النبي، تحت عنوان “الإسلام المبكر” [أيْ الفترة التي كانت قبيل بدء الإسلام وبداية الإسلام في مكة]. ومن أمثلة هذه الأخبار انشقاق بصر النبي عليه السلام نحو السماء حين ولادته، وسيلان إبهامه لبنًا بعد الولادة ومصِّه إيَّاه، وتكلمه في المهد ومناجاته القمر. وقبل ذلك نبوءة سيف بن ذي يزن ملك اليمن لجدِّ النبي عبد المطلب بمجيء محمد بشيرًا ونذيرًا، وذلك على نحو ما جاء في كتاب “الأغاني” للأصفهاني، وفي “شرَف المصطفى” لأبي سعد عبد الملك الخركوشي. ويرى البقمي أن مجرد وجود مثل هذه الروايات “الموضوعة” في المصادر التاريخية العربية أو الإسلامية جعل منها حجة عند العلمانيين الذين يعظِّمون كثيرًا من النصوص؛ لقِدَمها، لا لصحَّتها، مما دفع بهم إلى المناداة بالتحلُّل من قيود الأحكام الحديثية القائمة على نقد المتن والسند واشتراط العدالة في الرواة[2]. إذ يلجأ هؤلاء إلى هذه النصوص للتدليل على أن النبي عليه السلام لم يعْدُ أن يكون أحد أفراد مرحلة تاريخية انقضت، وغير مخصوص بشي عن أهلها، ولذلك فالكتب الاجتماعية هي أكثر ما يلجأون إليه، ككتب الأدب والبلدان والشعر الجاهلي والأنساب والقبائل والحياة الاجتماعية بشكل عام.
- المناهج
يمكن حصر مناهج العلمانيين في قراءتهم للسيرة النبوية في: المنهج الماركسي والأنثروبولوجي والنفسي، مع استبعاد كلٍ من المنهج التأويلي والتاريخاني؛ لأنهما ينصرفان مباشرةً إلى النصوص وليس دراسة السيرة النبوية وصاحبها كتاريخ.
فالمنهج الماركسي، ذو الصوت العالي في القرن العشرين، ترك بصمته على بعض العرب والمسلمين الذين تبنَّوا أطروحاته الثورية والفكرية، ثم حاولوا تفسير الإسلام تفسيرًا ماديًا. ووفقًا لذلك، يُصرِّح العلمانيون العرب بأن النبي قام بدعوته فقط لأجل مناهضة عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق طموحات الجماهير المسحوقة الكادحة، ويمكن مقارنته بدور قائد الثورة البلشفية لينين، بحسب ما يقول (علي الدشتي) في كتابه “23 عامًا دراسة في السيرة النبوية المحمدية”. ويرى البقمي أن هذه الرؤية تتناقض أصلًا مع المذهب الماركسي الذي يرى أن التحول الذي يحدث في التاريخ ليس نتيجة للفكر، وإنما هو نتيجة تفاعل مادي في بنية الواقع الاقتصادي والاجتماعي. كما أن غرض النبوة هو تحقيق العبودية لله تعالى، لا التحرُّر المادي الذي ترنو إليه الماركسية.
بالنسبة للمنهج الأنثروبولوجي، فقد نشأ أساسًا إبَّان توسع الاستعمار الغربي لدراسة علم الإنسان غير الأوروبي، واستقصاء حياته بكل ما فيها بأدوات العلم الحديث، ومن منطلق مادي بحت. وينطوي هذا المنهج على الأنثروبولوجيا الاجتماعية، والأخرى الثقافية؛ وتركز الأولى على الوسط الاجتماعي الذي نشأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأسباب بعثه هو عليه السلام تحديدًا دون غيره، وتبحث عن الأدوات المادية الموهَمة؛ لترسِّخ صحة القول ببشرية النبوة والوحي والدعوة الإسلامية والسيرة النبوية تاليًا؛ لتُحلِّل في نهاية المطاف كيف أن محمدًا “أنتجَ” دينًا في القرن السابع الميلادي؟ وكيف استجابت الأطر الاجتماعية لذلك؟ قبولًا ورفضًا. وهذا أمرٌ يُصِر عليه جميع العلمانيين العرب دون استثناء. هذا بينما يرى المسلمون أن السيرة النبوية من تجلّيات الوحي المُجاوِز للمادة، وأخبارها من المقدَّس الثابت الذي لا دخل للمجتمع في إنتاجه.
أمَّا الأنثروبولوجيا الثقافية، فهي معنيَّة بدراسة الميثولوجيا والأساطير والفيلولوجيا. فالقراءة العلمانية للسيرة تستخدم كثيرًا من المصطلحات الدلالية التي هي جزء من بناء الأسطورة؛ كالمخيال والرمزية والخوارق وما شابهها، بقصد وصف السيرة بأنها غير واقعية، وكشف حقيقة الشخصية الأسطورية للنبي عليه الصلاة والسلام، بجانب القصص القرآني والحديث النبوي والوحي عمومًا، التي تُقدَّم على أنها تشكيلات استدلالية عقلانية، في حين أنها مَدِينَة لفعالية المخيال، كما يقول(أركون). والعلمانيون العرب يُحاكون الفلسفة الفرنسية النقدية التي ترفض تمامًا صحة كل ما هو ميتافيزيقي، والتي كرَّست جهودها لتزييف الكتاب المقدس باستخدام كل أنواع المناهج الحديثة من تأويلية، وبنيوية، وأنثروبولوجيا، وغيرها. وبحسب ذلك، تكون الجنة والنار والملائكة وشق صدر النبي وحادثة الإسراء والمعراج من جملة هذه الأساطير.
من جهة أخرى، تتناول الفيلولوجيا، التي تبحث في اللغة وفقهها ومقارناتها بين الثقافات الإنسانية، النصوصَ المكتوبة؛ لاستخراج وتحليل كل ما فيها من أبعاد لغوية. ويعمد إليها العلمانيون العرب لمحاولة إثبات أن النبي محمدًا نقل الإسلام عن الأديان التوحيدية، عبر بيان أصل الكلمات المشتركة بينها؛ وصولًا إلى بشرية القرآن وأنه تأليف محض من قِبَل النبي. ويُعد هذا المنهج أشهر مناهج المستشرقين في دراسة الوحي والسيرة. بل هناك مَن زعم أن تقريب النبي عليه السلام للصحابة كان بناءً على إلمامهم بلغات الكتب المقدسة، أو لأنهم كانوا من أهلها أساسًا؛ بما يسوِّغ الادّعاء بأنهم أدخلوا معارفهم الإسلامَ من هذه الجهة.
أخيرًا، فإن المنهج النفسي أو السيكولوجي، فيرمي إلى معرفة شخصية محمد النفسية على ضوء العلوم المعاصرة، والذي يشتمل على اتهامَين؛ هما: دعوى اتهام النبي عليه السلام بالمرض النفسي، ودعوى الرغبات النفسية المحمدية وتوليد الوحي. وفي هذا الأول يدَّعي التونسي (العفيف الأخضر) أن محمدًا أصبح ذي “شخصية اكتئابية وفصامية” نتيجة الحالة النفسية التي تسلَّلت إليه من أمه آمنة التي كابدت الصدمات والفواجع بعد وفاة والد النبي عليه الصلاة والسلام[3]. ويذهب (علي دشتي) إلى أن هذه الشخصية غدت “أشد انطوائية وانكفاءً كلما مرَّت سنة جديدة يقضيها وحيدًا في الصحراء، وعندها يمكن فجأة أن يظهر شبح أو يسمع اصطخاب الموج في بحر مجهول”[4]. فيما يدَّعي (طيب تيزيني) أن “محمد كان يُصاب بشيء من مظاهر الاضطراب النفسي التي تصل أحيانًا إلى درجة الفصام الشخصي”[5]. ويسَّر ذلك اتهام النبي بالصرع والهذيان، وجعل رؤيته لجبريل عليه السلام مجرد “هلوسة” بصرية[6]، ناهيك عن اتهامه كذلك بالعدوانية ضد الذات والآخر، و”الذهان الاهتياجي الاكتئابي المُسبِّب للفحولة المفرطة” كما يقول (العفيف الأخضر)[7].
أما الدعوى الأخرى، فيدَّعي العلمانيون أن النبي عليه السلام كان صاحب مشروع دنيوي، مسكونًا بهمومه ورغباته، التي خرجت في شكل نصوص استطاع أن يُلزِم بها المؤمنين به. فيذكر (معروف الرصافي)، على سبيل المثال، أن الجنة والنار نِتاج الخيال الواسع لدى محمد ولرغباته النفسية[8]. هذا فيما يرى (ساسي الضيفاوي) أن “الخلفية النفسية هي أبرز عامل اشتغل عليه محمد [لجذب أتباعه]… من خلال توظيف عقيدة ذات أشواق نفسية ودينية تُغرِي البسطاء والسُّذَّج بالفردوس المنشود والنعيم المفقود، حيث إنهم على استعداد لتقديم أرواحهم قربانًا لرب محمد”[9]. وهذا القول يمكن تعميمه في جميع العقائد الغيبية التي جاء بها النبي. ويتفق ذلك مع قول (علي دشتي) أن “جبريل الملاك هو تشخيص لذاك الطموح الذي ظل كامنًا لفترة طويلة في أغوار كينونته الباطنة”[10]. ومع ذلك، فإن العلمانيين لا يقدِّمون الدلائل على أن النبي “مريض نفسيًا”، وكيف لرجل “مريض” مثله أن يأتي بقرآن به 6236 آية، تحدَّى به نُظراءَه من فصحاء العرب ذوي البلاغة، بل وتحدَّى حتى الجنَّ عن الإتيان بمثله[11].
الفصل الثاني
القراءة العلمانية لمصادر السيرة النبوية وتدوينها
- القراءة العلمانية لمصادر السيرة النبوية:
وهذه القراءة للمصادر تتضمَّن دعاوى ثلاث، هي: السيرة النبوية المختلَقَة، والسيرة النبوية التبجيلية، والثالثة المحاكية.
ففي الأولى، السيرة النبوية المختلقة، يرى العلمانيون أن مصادر السيرة النبوية المكتوبة المتداوَلة بين المسلمين اليوم هي من اختلاق الرواة والمصنِّفين الذي كتبوا مبكرًا في السيرة، على غرار ما يقوله القصَّاصون والوُعَّاظ، بما يجعلها أساطير مُختلَقَة. وأكثر ما يطعن فيه العلمانيون هو شيخ المغازي والسِيَر محمد بن إسحق؛ لكوْن سيرته هي المرجع الرئيس لكثير من السِيَر النبوية اللاحقة له. هذا رغم أن شيوخه وأقرانه والأئمة عبر التاريخ الإسلامي مدحوه، كما أنه أخذ كثيرًا من الروايات عن أبيه المُحدِّث، فصار أميرًا للمحدِّثين بحفظه، كما ذكره البخاري في كتابه “التاريخ الكبير”.
ويشير البقمي إلى أن العلمانيين العرب يحاكون في ذلك مسلك المستشرقين الذين رفضوا أحاديث السيرة. فيرى (ماكسيم رودنسون)، على سبيل المثال، أنه لو جمعنا كل ما كُتِب عن تاريخ محمد لما تجاوز صفحة ونصفًا من كتاب، أما الباقي فأساطير. وهذا القول يوافقه فيه (العفيف الأخضر)، ويقترب منه (هشام جعيط) الذي رفض تمامًا الأحاديث النبوية واكتفى بالقرآن فقط كوثيقة صحيحة الثبوت تاريخيًا[12]. ومن جانبه، راح (طيب تيزيني) يذكر، للإجابة على تساؤل: ما المصدر الأدق للسيرة النبوية؟ – يذكر ترجيحات فلهاوزن، ثم يردف برأي جولدتسيهر وبروكلمان، تاركًا لهم المجال لتحديد مصادر السيرة النبوية[13]. والحقيقة أنه على افتراض ثبوت القدح العلماني، فإن السيرة النبوية ثابتةٌ بغيره؛ إذ إنها لدى علماء الإسلام ما هي إلا فرع من الرواية التي تمثلها السنة النبوية، وقد كان أوائل المشتغلين بها من طبقة التابعين كلهم محدِّثون.
أمَّا دعوى السيرة النبوية التبجيلية، فتعني أن السيرة ليست تاريخًا لحياة النبي عليه السلام، بقدر ما هي تبجيل وتقديس له، على غرار الشخصيات الخارقة والأسطورية. فيذكر (أركون) و(تيزيني) و(الضيفاوي) و(جعيط) و(بزاينية) و(عمامو) وغيرهم أن أدبيات السيرة شهدت كثيرًا من التضخيم والتهويل والمبالغات[14]. ولذلك، يُلاحَظ إهمال هؤلاء لصيغة الصلاة على النبي بعد ذكر اسمه، كما يصرِّح بذلك (محمد محمود) في كتابه “نبوة محمد التاريخ والصناعة”. ويخلص البقمي من ذلك إلى أن مراد هؤلاء هو طمس تميُّز النبي عن غيره، ويؤكد ذلك بما وقع فيه الضيفاوي من تناقض، حينما اعترض على فكرة تصديق ملك الروم هرقل لدعوة النبي عليه السلام، لكنه في المقابل مدح مسيلمة الكذاب باعتبار أنه “كانت له الجرأة الكافية للتعبير عن فكرته، وشرح أطروحته، وتأكيد نبوته، وأن هناك شريحة مصدِّقة بما جاء به ومؤمنة بنبوته، وهذا ما يقلق محمدًا ويُحدِث ضجَّةً كبرى بين اتباعه”[15]. ليتساءل البقمي: هل يُسلِّم الضيفاوي وغيره من العلمانيين بمبدأ النبوة أصلًا؟ والوحي المُجاوِز للمادة؟ وهل يؤمن بإله مفارِق للوجود يمكن أن يرسل مسيلمة إلى الضيفاوي؟
أخيرًا، تعني دعوى السيرة النبوية المحاكية تصوير العلمانيين للسيرة النبوية بأنها تُحاكِي سِيَر أنبياء بني إسرائيل، وأن كُتاب السيرة رغبوا بأن يكون لمحمد عليه السلام مثلها، وذلك على صعيد المعجزات، كالإسراء والمعراج، وسن البعث المُحدَّد بالأربعين عامًا، ورعْي الغنم كباقي الأنبياء. وقد نقَلَ (جعيط)، على سبيل المثال، أن ابن إسحق اعتمد في سيرته النبوية على مثال كُتُب سِيَر الآباء والقديسين المسيحيين البيزنطية، وأنه نَسَجَ على منوال الأناجيل[16].
ويذكر البقمي أن الإسرائيليات هي ممَّا انتقده علماء الإسلام على ابن إسحق، وعلى الروايات التاريخية وكتب التفسير عمومًا، ولكن شتَّان بين قصد ابن إسحق وقصد العلمانيين؛ فالأول أوردها من جهة جواز روايتها في تقديره، عملًا بحديث النبي عليه السلام: “حدِّثوا عن بني إسرائيلَ ولا حرجَ، ومن كذبَ عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعدَهُ من النَّارِ”[17]. أما الآخرون، فقصدوا أن الإسرائيليات هي قوام مادة السيرة، بحيث لو استُبعِدَت لسقطت السيرة. وتجدر الإشارة إلى أن ابن إسحق قد اعتمد في نقل أخبار الأمم السابقة على الإسلام على الروايات الإسرائيلية التي تُعد المصدر الأساسي لتاريخ تلك الحقبة الزمنية القديمة، ويُلاحَظ أنه لم يذكرها عنهم إلا للضرورة التاريخية، وقد ثبت اليوم أن ما نقله ابن إسحق كان مطابقًا لما في الأناجيل، ولم يزد فيها ما ليس منها.
هذا بالإضافة إلى أن النبي عليه السلام نهى المسلمين عن التفضيل بين الأنبياء، بما في ذلك موسى عليه السلام، صاحب المعجزات، الذي يَفترِض العلمانيون أن المسلمين قد حاكوها في كتاباتهم للسيرة النبوية. بل إن القرآن ذاته قد أفاض في ذكر معجزات موسى عليه السلام، حتى وإن لم يثبُت للنبي محمد عليه السلام مثلها، مثل الآيات التسع، وبياض اليد، وتحويل العصى إلى حية. كما لم يُخفِ القرآنُ بالمثل معجزات عيسى عليه السلام، من قبيل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله.
- القراءة العلمانية لتدوين السيرة النبوية:
وتشمل هذه القراءة كلًا من موضوعَي: تأخر تدوين السيرة النبوية؛ ودعوى التدخُّل السياسي في تدوينها.
فبالنسبة للأولى، تأخر تدوين السيرة النبوية يستنكر العلمانيون إمكانية الاعتماد على روايات كُتِبَت بعد الحدث بأكثر من مئة عام، على نحو ما يقوله (هشام جعيط)، الذي يُقرُّ بعدم الاعتقاد في الصحة التاريخية للأسانيد الحديثية، لأنها سلسلة أسماء وُضِعَت بعد الوقائع[18]. فيما تدعو (حياة عمامو) إلى ضرورة الحذر والتفريق بين “تاريخ الأحداث” و”تمثُّل التاريخ” الذي يقوم به الرواة لهذه الأحداث المنصرمة[19]. ونحا (عبد المجيد الشرفي) نفس المنحى، فرأى أن السيرة تعكس قراءة متأثرة بظروف واضعيها، خاصة في الفترة الفاصلة بين العهد النبوي وعهد التدوين[20]. ويزعم (الضيفاوي) أن هذه المرويات “لم تدوَّن من أجل التأريخ والتوثيق، وإنما كُتبت معظمها بغية تعظيم الإسلام وتبجيل محمد”[21].
ويرى البقمي أن هؤلاء يسايرون المستشرقين في هذا الصدد، أمثال جولدتسيهر وهملتون جيب وشاخت ومونتغمري وات وجاكلين شابي. ويدحض ادّعاءهم بتأخر التدوين، بأن روايات السيرة هي من المرويات المبكرة جدًا، وليست من ابتكارات مؤرِّخي الإسلام؛ فالسيرة فرعٌ عن السنة النبوية، وتقوم على الروايات التي حُفِظَت عن النبي عليه السلام ونُقِلَت أخبارها عنه. وقد اشتُهِر عن الصحابة تدوينهم لبعض مغازي النبي عليه السلام، وتحديثهم بسيرته. ومن دلائل ذلك ما رُوي عن رافع قال: “قُلنا: يا رسول الله إنَّا نسمع منك أشياء، أفنكتبها؟ قال: اكتبوا، ولا حَرَج”. وذكر الإمام الذهبي في “تذكرة الحفَّاظ”، أن عبد الله بن عمرو بن العاص “كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام علمًا كثيرًا، وكان يعترف له أبو هريرة بالإكثار من العلم، وقال: فإنه كان يكتب عن النبي، وكنتُ لا أكتب”. وبعد أن أوشك جيل الصحابة على الانقراض في نهاية القرن الهجري الأول، قيَّض الله من أبنائهم وأتباعهم جيلًا اعتنى بهذه الأخبار. وكان منهم أبان بن عثمان بن عفان، الذي دوَّن قسمًا من السيرة وصحَّحها، وكذا عروة بن الزبير وشرحبيل بن سعد ومحمد بن مسلم الزهري. هذا ولو لم يوجد إلا ما وَصَلَنا من مكاتبات الرسول إلى الزعماء لِدَعْوتِهم إلى الإسلام، لكانت كافية لنقْضِ دعوى العلمانيين بتأخُّر التدوين. ويتعجَّب البقمي: كيف لا يعتبِر العلمانيون بعلوم الجرح والتعديل والإسناد والعِلَل، التي هي بمثابة ميزان القسط الذي تُعرَض عليه الروايات، فيتفحَّصها سندًا ومتنًا، ليرى هل هي مما تثبت نسبته إلى النبي عليه السلام أم لا؟! لينتهي البقمي إلى أن هذا يثبت غاية القراءة العلمانية لهدم السيرة النبوية والحديث، ومن ثمَّ القرآن ذاته، وليس محاولة التوثُّق من صدق الأمور وكاذبها. إذ لو كان الأمر كذلك، لافتخر هؤلاء بعلم الإسناد الذي ينعدم نظيره في الحضارات الأخرى. هذا رغم أن العلمانيين يقبلون أشعار الجاهلية، وهي دون سند شفوي أو مكتوب، وكذا الأناجيل التي يزعمون أن ابن إسحق تأثر بها، وآراء فلاسفة اليونان التي ليس لها سند متصل يضمن عدم تعرَّضها للتبديل حين مرورها وانتقالها من الشفوي إلى المكتوب.
أمَّا دعوى التدخُّل السياسي في تدوين السيرة النبوية، فيزعم العلمانيون حدوث ذلك بغرض تكييفه للأغراض الأيديولوجية والسياسية، التي كانت في زمن بدايات التدوين، مع نهاية الدولة الأموية، وبدايات الدولة العباسية. فيذكر (حسن بزاينية)، على سبيل المثال، أن عروة بن الزبير اتصل بالخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وابنه الوليد من بعده، فيما أجْزلَ الأمويون العطاء للزهري، فخضعت روايته – بحسب زعمهم– لاختيارٍ أموي. وفي هذا المسلك، يوجد (منصف الجزار) و(هشام جعيط) و(حياة عمامو)، وكذا (ساسي الضيفاوي) الذي ادَّعى أن ابن إسحق مجَّدهم، باعتبارهم أقرب نَسَبًا للنبي عليه السلام[22]. ويصوِّب البقمي سهامه نحو هؤلاء بقوله إن هذه الدعوى هي مما عمَّمه العلمانيون على سائر تدوين العلوم الإسلامية، في نقدهم الموجَّه للعقل العربي الإسلامي ككل. وأن العلوم الإسلامية لديهم لا تعدو أن تكون نتاجًا لمحاولة تكوين دولة سياسية محضة، وليس سعيًا لحفظ وتحصيل المعارف الدينية. كما يقوم هؤلاء العلمانيون بإسقاط واقعهم الخاص على الماضي الإسلامي؛ باعتبار أن كثيرًا منهم منخرطون في النضال السياسي ضد الأنظمة السياسية القائمة، وذوو انتماء فكري يساري، مثل (محمد عابد الجابري) و(حسن حنفي) و(طيب تيزيني). لذا يكثر في إنتاجهم الفكري المصطلحات الدالَّة على ذلك، مثل: الإصلاح، معركة النهضة، مفهوم الدولة، الحرية، الاستبداد، وجدلية السلطة والمعارضة… إلخ. وهذا يعني أن همومهم السياسية حملتهم على سوء الظن بالخلفاء وعلماء الشريعة، بما فيهم كُتَّاب السيرة. علاوةً على ذلك، فإن نجْم ابن إسحق كان قد علا واشتهر حتى قبل قيام الدولة العباسية في عام 132 ه، وقد لجأ إليه الخليفة المنصور لشهرته وعلمه، بحسب ما يقول المستشرق بروكلمان ذاته[23]. كما أن ابن إسحق لم يُخفِ في سيرته دور جد المنصور، العباس بن عبد المطلب، في وقعة بدر، بجانب خصوم النبي المكِّيِّين، حيث أكد ابنُ إسحق ذلك الدور بوضوح، ويذكر العباس بين أسرى بدر. ولو كان الأمر مجاملة للمنصور، لتغاضى ابنُ إسحق عن ذلك خشية الإساءة لخليفة صارم مثله.
فضلًا عن ذلك، يتغافل العلمانيون تمامًا عن دور السلطة السياسية في إدخال الفلسفة وعلوم اليونان التي يتغنَّون بها، في البيئة الإسلامية، عبر تشجيع الترجمة والإبداع العلمي، وهو ما ولَّد التيار المعتزلي الذي قال بخلق القرآن، ويرى فيهم العلمانيون أنهم يمثلون المدرسة النقدية الإسلامية؛ لإعلائهم من شأن العقل في مواجهة النص. بل لم يعتبِر العلمانيون أن التقارب الذي حصل بين الخلفاء العباسيين والمعتزلة دليلًا على تدخُّل السلطة لتغيير الحقائق إلى ما يخدمها، وإنما عدُّوها قناعةً من الخلفاء بهذه المعارف، ووصفوا الخلفاء بأنهم من المثقفين وواسعي الأفق. وهذا أمرٌ يُبرِز انتقائية العلمانيين، علميًا ومنهجيًا، كما يبدو.
الفصل الثالث
القراءة العلمانية لسيرة النبي عليه السلام قبل البعثة
ويشتمل هذا الفصل على مسألتَين؛ الأولى هي الخاصة بالتناول العلماني لحياته عليه السلام قبل البعثة، والثانية لعلاقته عليه السلام بظاهرة الأديان قبل البعثة.
- القراءة العلمانية لحياة النبي عليه السلام قبل البعثة:
فبشأن حياته، طعن العلمانيون في مولده عليه السلام؛ فمِن قائل إنه لم يُولَد عام الفيل، (كهشام جعيط)، لِمُنكِرٍ للمعجزات التي رافقت ولادته عليه السلام (كعلي الدشتي)، لِمُدَّعٍ بأن أهل النبي وبني سعد كانوا يتقاذفونه فيما بينهم، كلٌ يريد الخلاص منه، على نحو ما ذكره (وحيد السعفي)[24]. كما يذهب (محمد محمود) إلى تأويل طير الأبابيل بأنها عدوى أصابت جيش أبرهة خاصة[25]. ويرى البقمي أن اهتمام العلمانيين بهذه المسائل تروم التشكيك في المعجزات التي رافقت النبي طيلة حياته، لعدم إيمانهم بما وراء المادة، كما يطعن ذلك في بعثته في تمام الأربعين كسائر الأنبياء.
كما يشكِّك هؤلاء في اسمه، ويزعم بعضهم أن مصادر السيرة تعمَّدت إخفاء ذلك، وأن اسمه هو “قثم” وليس محمدًا، بدعوى أن والد النبي (عبد الله بن عبد المطلب) كان يكنَّى أبا قُثم، وقد حمل ذلك (هشام جعيط) على الزعم بأن والد النبي لم يمت وأمه آمنة حاملًا به، وإنما جده عبد المطلب هو الذي مات أثناء حمله، ما ينفي بالتالي الزعم بأن مَن سمَّاه محمدًا هو جده![26]. ومن جانبه، يذهب (تيزيني) إلى أنه عليه السلام سُمِّي قُثمًا لفترة وجيزة، ثم بدَّله بمحمَّد، دون استبعاد أنه سُمِّي بـ “مذمَّم” كذلك، مستدلًا بحديث أبي هريرة لدى البخاري عن النبي عليه السلام، حينما قال: “ألَا تَعْجَبُونَ كيفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ ولَعْنَهُمْ؟! يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا ويَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وأنا مُحَمَّدٌ”. ويدفع البقمي ذلك بأن (جعيطًا) تحدث عن كنية عبد الله أبي النبي عليه السلام، والمعروف أن الكنية عادةً تقترن بالولد إنْ كان للشخص ولد، فإن لم يكنْ له ولدٌ، فقد يُكنَّى باسمٍ أحبَّه أو لحادثٍ وقع له. وقد تكون فعلًا كنيته أبا قثم؛ لأنه أراد أن يسميه كذلك، ثم لما وُلِد النبي وسُمِّي محمدًا، أصبح يُكنى بأبي محمد، ومن ثمَّ التصقت به الكُنيتان. أما تسميته بمُذمَّم، فتُظهِر سوء فهم من قِبَل (تيزيني) بأنه فهم أنَّ تسميته بمحمد إنما جاءت كرد فعل على اسم “مُذمَّم”، ومعلوم أن أعداء المرء هم مَن يَقلِبون اسمه إلى مذمَّة استهزاءً به. بجانب ذلك، فإن اسم “مُذمَّم” ذاته، وهو قبيح، لم يكن ليقبله أحد أكابر مكة وأشرافها، كعبد المطلب، لتسمية حفيده اليتيم به. وهكذا يكون الصحيح هو أن الكفار هم مَن رموه بهذه الاسم الخبيث، ودليل ذلك الحديث الصحيح أعلاه.
بجانب ما تقدَّم، يشير البقمي إلى مسعى (جعيط) للإيهام بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار محمدًا اسمًا له وهو في المدينة؛ كلقب تفخيمي له “بعد أن ارتفع مقامه”، ومحمد تعني – بحسب جعيط – ترجمة لِلَفظ “الباراكليتس [أو الباراقليط]” السرياني، الذي جاء في الإنجيل، ما يعني بالتالي أن النبي لجأ لذلك ليكتسب “مقامةً رفيعة في سيرورة الدين التوحيدي وشرعية التمادي”. وبذلك يرد (جعيطٌ) الفضل في ظهور محمد إلى المسيحية، زاعمًا تأثير المسيحية على القرآن، وقسط وافر من الأفكار والتعابير[27].
وعن أميَّته عليه السلام، يذكر (تيزيني) أنها جاءت في القرآن “من باب التسويغ الأيديولوجي الديني للاعتقاد بأن محمدًا مُعجِزٌ في نبوته لأنه لم يكن يقرأ ويكتب”[28]، ويوافقه (الجابري) في ذلك[29]، بل ويذهب كلاهما، مع جعيط، إلى أن لفظ “أميّ” يعني: من غير أهل الكتاب[30]. ويضيف (حسن حنفي) إلى ذلك قوله إنه “زُعِم” أن النبي لم يكن يقرأ ولا يكتب “حتى لا يُقال إنه تعلَّم الوحي وقراءة الكتب [السابقة] المُنزَّلة”[31]. ومن الجلي أن (تيزيني) و(الجابري) و(جعيط) قد تأثروا في ذلك بأقوال مونتغمري وات ولامنس وجولدتسيهر وبلاشير في هذا الصدد. وقد فاتهم أن القرآن الكريم ذكَر أن من بين بني إسرائيل “أميُّون”[32]، ما يعني أن لفظ “أميّ” هو مَن يجهل الكتابة، وليس بمعنى من غير أهل الكتاب. كما فاتهم قولُه عزَّ وجلَّ: “وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ” (العنكبوت: 48).
- القراءة العلمانية لعلاقة النبي عليه السلام بظاهرة الأديان قبل البعثة:
ركَّز العلمانيون في هذا الصدد على كلٍ من علاقته عليه السلام بظاهرة “الحنفاء” التي تزامنت مع ظهوره، وعلاقته بالمسيحية. فبالنسبة للأولى، رأى العلمانيون أن محمدًا هو أحد نواتج ظاهرة الحنفاء، التي تضمَّنت زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، والتي عُدَّت – بحسبهم- مشروعًا أيديولوجيًا ماديًا أفرزه الصراع بين الوثنيين والكتابيين من اليهود والنصارى، والتي اعتبرت إبراهيم عليه السلام مرجعيةً يمكن الاستناد إليها في مقابل الإرث الكتابي لليهود والنصارى، أو الإرث القَبَلي للوثنية العربية، ومحاولةً لجعل العرب يتجاوزون خلافاتهم ويوحِّدون صفوفهم وراء أيديولوجية تستعيد الهويَّة العربية ضد الإمبراطوريتَيْن الرومانية والفارسية. فالهدف عند العلمانيين سياسي، والدين عندهم مجرد وسيلة لتحقيقه. ومن هذا المنطلق، يُلاحَظ أن العلمانيين العرب رأوا في بيئة النبي عليه السلام المصدر الرئيس فيما ادَّعاه من النبوة؛ ذلك لأنهم لا يرون في النبوة أو الوحي أمرًا مُفارِقًا للمادة والأسباب الطبيعية. وبالنسبة لهؤلاء، كما يقول (أركون)، لا ينبغي التفريق بين الأديان الوثنية وأديان الوحي، فهذا التفريق هو عبارة عن مقولة “تيولوجية تعسُّفيَّة”[33].
أمَّا عن علاقته عليه الصلاة والسلام بالنصارى، فيلجأ إليها العلمانيون للإيهام بأنها من مصادر نبوته عليه السلام، وذلك من خلال أخبار وروايات السيرة التي تكلمت عن بعض الأفراد الذين عاصرهم النبي قبل البعثة، مثل ورقة بن نوفل والغلام عدَّاس الذي التقاه النبي في الطائف، أو أخبار رحلات النبي عليه السلام للشام، وافتراض أخذه عن المسيحية الشرقية السورية، أو مقارنة الوحي بما تضمَّنته عقائد أهل الكتاب وخصوصًا النصرانية. فيشير (جعيط)، على سبيل المثال، إلى أن القرآن لا يمكن إلا أن يكون مُستنسَخًا من المسيحية السورية، وإلا فيجب على المؤرخ الموضوعي الإذعانُ والإقرارُ بألوهية القرآن مبدئيًا ونهائيًا[34]. هذا بينما يذهب (العفيف الأخضر) إلى أن “محمد المكّي ظل مسيحيًا آريوسيًا، أي من التابعين للقس الإسكندراني آريوس الذي نفى أن يكون الأب أو الابن من طبيعة إلهية واحدة، [وأن] المسيح مخلوق الله الأول ونبيّه”[35]. بل ويرى كثيرٌ من هؤلاء أن خديجة عليها السلام هي “مؤسِّسة” نبوة محمد عليه السلام، ابتداءً ورعايةً له حتى اشتدَّ عوده، وأنها تأثَّرت بالنصرانية على نحو ما ادَّعى (خليل عبد الكريم) و(حسن بزاينية) من أن قومها يعتنقون التقاليد النصرانية في الزواج، حيث يحرِّمون الطلاق وكذا الجمع بين زوجتين في آنٍ واحد[36]، ومن ثمَّ كان لها تأثيرها المسيحي على النبي عليه السلام بحسب ما يزعمون.
ويفنِّد البقمي دعاوى العلمانيين في هذا الموضع، بتساؤله: هل يعني افتراض الاستنساخ عن النصارى القولَ بصحة نبوة عيسى عليه السلام عند العلمانيين؟ بمعنى أنهم يصحِّحون نسبتها إلى “المُفارِق” أو “الإله”؟ فإنْ صحَّ أنهم يؤمنون بنبوةٍ على هذه الكيفية، وأنها صحَّت في نظرهم لعيسى عليه السلام، فما الذي يمنع كونها صحَّت في حق محمد عليه السلام على سبيل الاستقلال؟ وإنْ كان مردُّ النبوة إلى القوى الخارقة والمُبدِعة للأنبياء في الإطار المادي، فما المانع أن يصحَّ في حق محمد عليه السلام ما صحَّ لغيره في الإطار المادي على سبيل الاستقلال أيضًا؟.
ويضيف البقمي أن (جعيطًا) نقل عن المستشرق السويدي تور أندريه في هذا الصدد، وبالمثل فعل (الأخضر) حين تحدَّث عن آريوسية النبي محمد، ناقلًا عن المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون، الذي وصف ورقة بن نوفل بأنه المعلم الأول لمحمد، وهو الوصف الذي استعان به وادّعاه (طيب تيزيني) كذلك. حتى في زعم تأثُّر النبي بعدَّاس، فات هؤلاء أن لقاءه بالنبي لم يكن إلا بعد العام العاشر من النبوة؛ أي بعد ما يقارب نصف عُمر النبوة، ومن غير المعقول احتياج النبي عليه السلام إليه، للنقل عنه، بعد ما لاقاه من تعنُّت قريش واضطهادها له.
الفصل الرابع
القراءة العلمانية للسيرة النبوية في الفترة المكيَّة
ويشتمل هذا الفصل على مبحثَيْن: الأول: هو القراءة العلمانية لدعوة النبي عليه السلام في مكَّة. والثاني: هو القراءة العلمانية للمعارضة المكِّيَّة لدعوة النبي عليه السلام.
- القراءة العلمانية لدعوة النبي عليه السلام في مكَّة:
يزعم العلمانيون أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حين ظهورها في مكَّة كانت ذات استراتيجية وغاية مادية دنيوية، تستهدف – بحسب معروف (الرصافي)– إحداث نهضة عربية، عبر توحيد العرب تحت شعار “لا إله إلا الله” الذي هو “من مبتكرات [محمد]”[37]. ويصف (تيزيني) مشروع النبي بأنه “بمثابة المشروع الاستراتيجي الكبير الذي لفَّ الجميع في ثناياه”، وأن “الحركة المحمدية حركة قرشية أولًا وقبل كل شيء”[38]. ولكن يتساءل البقمي: ما علاقة هذه الغاية المادية بإعلانه عليه السلام على الملأ: “إنْ أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون”؟ إذ من المعلوم أنه أنذرهم عذابَ الله تعالى، وبشَّرَ المؤمنين منهم بحياة طيبة ونعيم مقيم. ثم إذا كان الأمر على هذا النحو، فلِمَ اضطهدت قريشٌ النبي عليه السلام، الذي هو بحسب (تيزيني)، لفَّ الجميع – بما فيهم قريشًا– في ثناياه؟ هذا كما أن النبي عليه السلام دعا إلى قِيَمٍ أبَت قريشٌ إلا رفضها؛ مثل التوحيد وتحريم الطواف بالبيت عُراةً، والتأكيد على مكارم الأخلاق، والكفّ عن قتل البنات… إلخ؛ فكيف يكون النبي – في ضوء ذلك- امتدادًا لما كانت عليه قريش؟ وكيف تكون “حركته” قرشيَّة كذلك؟!
في سياقٍ متصل، فإن المزاعم العلمانية تدَّعي أن النبي عليه السلام قد استند إلى مفهوم مقدَّس خارق للطبيعة، وهو الإله، بصرف النظر عن صدقه في الحقيقة؛ بغرض إنجاح استراتيجيته المادية في مكَّة. فيذكر (جعيط)، على سبيل المثال، أن “نشأة الإسلام هي نتاج شخصَيْن: النبي والإله، إنسان زائل وقوة أبدية تتحكَّم في المصائر الإنسانية وتبقى زمنًا مديدًا، ما دامت الجماعة المؤمنة بها موجودة”[39]. ومن هذا المنطلق، يُفهَم أن العلمانية تُنكِر الوجود الإلهي، فالإله ليس حقيقة موضوعية خارج الذهن، وإنما هو مفهوم مقدَّس أمكن لمحمد عليه السلام الاستناد إليه كأيديولوجيا لدعوته في مكة، بما يسهل معه فرض التشريعات وإحداث التغييرات التي يطمح محمد في إقرارها كصياغة موحَّدة لمشروعه الجديد.
من المسائل التي أوْلاها العلمانيون اهتمامًا كذلك هو القول بأن محمدًا عليه السلام عمَد إلى ضمان احتكاره الاتصال بالسماء وخبرها، بعيدًا عن أفعال الكهانة والسحر، والشعر، والمتنبئ، والجن. وفي سبيل أن يحصر محمد عليه السلام الحق فيما جاء به من الوحي، وأن يُسقِطَ ما سواه ليحقق هدفه المادي، عمد إلى الجن فجعلهم ممَّن دخل في دعوته ومشروعه فصدَّقوا به، وإلى الكهانة أو السحر فأبطلها وغلَّظ في فعلها، كيلا تقبل العرب إلا منه ولا تسمع إلا له، على نحو ما يقول (الرصافي)[40]. ويشير البقمي إلى أن العلمانيين رأوا أن هناك قدرًا مشتركًا بين النبي والكاهن، هذا القدر المشترك هو البشرية والإحالة إلى “المُفارِق”، ولمَّا كان الاتفاق حاصلًا في الأولى، جعلوه حاصلًا في الثانية أيضًا. وقد فاتهم أن هناك فروقًا كبرى بين الوحي والكهانة؛ منها أن النبي عليه السلام تحدَّى قريشًا، بمَن فيهم الكُهَّان الذين يحاول العلمانيون أن ينسبوه إليهم، أنْ يأتوا بمثل هذا القرآن، ولم يستطيعوا. كما أن أخبار الوحي شاملةٌ لغيوب الماضي والحاضر والمستقبل، ووقعت بلُغات مختلفة، بخلاف الكُهَّان، وإنْ أخبروا ببعض الغيوب الجزئية في الحاضر أو المستقبل. ومن ذلك أيضًا أنه لو كان النبي عليه السلام كما يزعمون، لما توقف إخباره على الوحي الذي كان يتأخَّر أحيانًا؛ لئلا يقع في الإحراج، ومن ذلك سؤال قريش له عن الثلاث التي أرشدتهم اليهود إلى اختبار صدقه عليه السلام بها [أصحاب الكهف وذو القرنين والروح]، وكذا اتهام المنافقين له في عِرضه عليه السلام في المدينة [حادثة الإفك].
فضلًا عمَّا سبق، ادّعى العلمانيون بأن كلًا من أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما- لم يُؤمِنا رجاءَ مرضاة الله، وإنما ابتغاءً لمصالح خاصة، مع توسُّمهم في أن التحاقهم بالنبي سيمكِّنهم من تحقيق ذلك[41]. كما زعم بعضهم أن استجابة الأنصار للنبي ومبايعتهم له في العقبة كانت نابعة من حاجتهم للتغلب على الخلافات التي نشبت فيما بين قومهم، بل وأن الشباب قد سارعوا في الإيمان دون الشيوخ؛ لـ “حماسهم أمام مشروع جديد يمثل طموحاتهم ويتجاوز ضيق أفقهم”[42]. ويدحض البقمي هذه الادّعاءات عبر سرد ما لاقاه هؤلاء الشباب من اضطهادات ومآسٍ، كانوا في غنىً عنها، مضيفًا أن قلوبهم لم تستحكم فيها الدنيا، بعكس الشيوخ والكهول الذين لم يهُن عليهم خسارة ما يحظون به من الوجاهة والمكاسب الدنيوية. كما يذكر البقمي ما بايع الأنصار عليه الرسول [عدم الإشراك بالله، وعدم السرقة والزنا وقتل الأولاد… إلخ]، بما يوضح أن البيعة لم تتضمَّن حديثًا عن جاه أو دنيا أو دعوة للنبي للإصلاح بين فرقائهم المتخاصمين، على نحو ما زعم بعض العلمانيين. من جهة أخرى، فإن قصة إسلام عمر تدل بوضوح على أنه لم يُسارِع إلى الإيمان بالنبي، بل جاء إسلامه بعد ضربه أخته وزوجها، بعد علمه بإيمانهما به عليه السلام. بل وبعد وفاة النبي، لم يكتنز أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما مالًا أو ثروة، ولم يجعلا الأمر مُلكًا في أبنائهم أو مَن ينتسب إليهم، ما يؤكد بعدهما عن مطامح الدنيا الزائلة.
- القراءة العلمانية للمعارضة المكِّيَّة لدعوة النبي عليه السلام:
تتضمَّن هذه القراءة مسائل ثلاث، هي: التهوين من صلف المعارضة المكية للنبي عليه السلام؛ والتأكيد على إخفاق النبي بتلبية مطالبة المعارضين له بالمعجزات؛ بجانب الادّعاء بأن النبي سلك حلولًا “مادية” لكسب المعارضين وإنجاح دعوته. ومما ذُكر في هذه الجوانب، هو قول (جعيط) بأن “قريش كانت حريصة على الوحدة والجماعة”، وأخذوا على محمد “تفريق الشمل والجماعة”[43]، وقوله: “نحن نقبل بفكرة انعدام عنف حقيقي أو كبير على النبي وعلى أغلب أصحابه”[44]، وأن العنف إنما تجسَّد في العنف اللفظي الذي يمتلئ به القرآن، من تهديد إلهي وإجابة فظَّة على اعتراضات كفار قريش، الذي كانوا “متحضِّرين بصفة رائعة فيما بينهم”[45]. وفي هذا السياق، نجد (جعيطًا) رافضًا مسألة الحدوث الحقيقي لكلٍ من: الدعوة السِّرِّيَّة، والهجرة إلى الحبشة، والصَّدع بالدعوة، والعم الحنون أبوطالب، والرحلة إلى الطائف، والإسراء والمعراج، ودعوة القبائل في المواسم، والمفاوضات مع أهل يثرب، وقصة الغار أثناء الهجرة، فكلها –عنده- هباءً لا وجود لها[46]. ويستعجب البقمي: كيف نظر (جعيط) إلى حادثة سَلَا الجزور الذي وضعه المشركون باستهزاء وسخرية على ظهر النبي وهو يصلي عند المقام؟! وماذا يقول (جعيط) عن ترصُّد شباب القبائل أمام باب النبي ليقتلوه ليلة خروجه من مكة نحو المدينة؟! ثم إذا كانت قريش بهذا التحضُّر المزعوم، فسيكون منطقيًا عدم هجران النبي لمكة، أحب البلاد إليه، ما دام أهلها قادرون على احتوائه.
بالمثل، ادّعى العلمانيون أن النبي لم يأتِ بمعجزاتٍ تثبت نبوتَه، وزعَم كثيرٌ منهم بأنه عَجَز أمام الإلحاح القرشي في طلب المعجزات الحسية، فاخترع الطابع المُعجِز للقرآن، وأتى بمعجزات لم يقف عليها أحدٌ غيره كالإسراء والمعراج، أو ردّ الحجر السلام عليه، أو ما أضافه خيالُ المسلمين فيما بعد إليه من معجزات، كانشقاق القمر[47]. بل يسرف (العفيف الأخضر) في هذا الصدد، فيقول: “محمد نفى عن نفسه في القرآن أية معجزة باستثناء واحدة: القرآن [حيث تحدَّى قريشًا] بالإتيان بمثله، وهو طبعًا سؤال تعجيزي، لماذا؟ لأن لا أحد يستطيع أن يكتب ديوان المتنبي، أو المعري، أو أبو تمَّام، أو أبو نوَّاس، إلا هم أنفسهم، فالأسلوب يجعل الأشياء الأكثر تفاهة فريدة كما قال فولتير”[48].
الفصل الخامس
القراءة العلمانية لدعوة النبي عليه السلام في الفترة المدنية
ينبني قوام هذا الفصل كذلك على إيراد المزاعم العلمانية المادية للسيرة النبوية بعد هجرة النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة. ويتناول مبحثَين، هما: القراءة العلمانية للدعوة النبوية في المدينة، والقراءة العلمانية للمعارضة التي واجهت النبي عليه السلام فيها.
- القراءة العلمانية للدعوة النبوية في المدينة:
يدَّعي العلمانيون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يجني ثمار استراتيجيته المادية التي بدأها منذ إعلان نبوته في مكة، متخليًا عن المثالية التي كان عليها في البلد الذي هاجر منه. وفي هذا السياق، يشير بعضهم إلى أن النبي محمد عليه السلام سارع إلى “تشييد المُلك” و”تثبيت الزعامة” التي تبدَّت فكرتها منذ بيعة العقبة، وذلك تحت غطاء ديني أيديولوجي، على نحو ما يقول (ساسي الضيفاوي)[49]، وكذا (طيب تيزيني) الذي يزعم أن الدعوة النبوية امتداد للطموح في تحقيق المُلك القرشي[50]، وكذلك (حسين مروّة) الذي قال: “إن محمدًا كان حريصًا على إنجاز توسيع الخارطة العربية”[51]، و(الرصافي) الذي يزعم أن “الغاية التي يرمي إليها محمد هي إحداث نهضة عربية”[52].
ومن هذا المنطلق، ادّعى (جعيط) أن النبي حدَّد لنفسه مهمة إعادة تشكيل العرب على الساحة الإقليمية، بما تميَّز به من قدرات فائقة، فيما ذهب (العفيف الأخضر) إلى أن الغرض المادي للنبي أصبح حاضرًا في المدينة؛ سواء بحصته في الخمس تقليدًا لشيوخ القبائل في الجاهلية، أو اختصاص نفسه بإقطاعية فدك أو بسؤال مستفتيه أجرًا على فتاواه[53]. علاوةً على ذلك، يخلط كثيرٌ من هؤلاء ويقيسون نبوة محمد عليه السلام بنبوة أنبياء بني إسرائيل الذين آتاهم الله المُلك والنبوة، مثل داوود وسليمان عليهما السلام. ويرد البقمي بأن ذلك التصور يخالف الواقع والتاريخ والنصوص القطعية في الإسلام، فضلًا عن أن أولي العزم من الرسل، حتى من بني إسرائيل [موسى وعيسى عليهما السلام]، لم يجمعوا بين المُلك والنبوة، وقد كان محمد عليه السلام آخرهم، ولم يُجمَع له بين الأمرَيْن. ويضيف البقمي أن ذلك المنحى يساير خطى المستشرقين، مثل فلهاوزن ومنتجمري وات، الذين ذهبوا إلى أن النبي قد بلغ في المدينة ما كان يرمي إليه[54]. ويختم البقمي بأن الرسول مأمورٌ في تحركاته بالبلاغ عن الله تعالى للناس كافة، وليس للعرب وحدهم، وهذا ثابت بنص القرآن الصحيح تاريخيًا في رأي العلمانيين[55]. ولو كان محمدٌ صاحبَ غرض دنيوي، وباحِثًا عن المُلك، لقَبِل به حين عرض عليه المكيُّون ذلك في بدايات الدعوة، أو لثبَّته حينما أذعنت له مكة بعد الفتح.
الأمر الثاني الذي ادّعاه العلمانيون، لاسيَّما (العفيف الأخضر) و(معروف الرصافي)، أن النبي أطلق العنان لمكبوتاته النفسية و”ميوله الجنسية والعدوانية”[56]، ما نتج عنه كثرة زيجاته، والإمعان في قتل الأسرى، وذلك بعد ما استتبَّ له الأمر في المدينة، ونال المُلك والسؤدد فيها. فأما مسألة تعدُّد الزوجات، يُورِد البقمي التناقض الواضح الذي وقع فيه (العفيف الأخضر)، الذي أنكر على النبي تعدُّد زوجاته، لكنه دافع في كتابه “إصلاح الإسلام” عن الحرية الجنسية بلا قيود ولا حصر، مطالِبًا بضرورة التخلص من الشعور بالعار من ممارسة هذه الحرية، وهو العار الذي زرعته التربية الجنسية التقليدية القائمة على “سُنَّة الله ورسوله”[57]. ويوضح البقمي أن النبي عليه السلام تزوج بإحدى عشرة امرأة؛ لأسبابٍ اجتماعية وسياسية وتشريعية، بدليل تأخر زمن إكثاره من الزوجات من جهة عمره عليه السلام، ومن جهة زمن دعوته وحاجتها إلى التشريع، وحالة الزوجات اللائي تزوجهنّ، وانتماءاتهن القِبَلية أو الأسريَّة، بما ساعد على تأليف القلوب بين النبي وبيوت العرب، وأدى إلى انتشار دعوته عليه السلام. ولو كان عليه السلام يروم متعةً جنسية مجرَّدة، لتغاضى عن الأرامل وأطفالهن؛ إذ إنه لم يتزوج بِكْرًا – من جملة زوجاته الإحدى عشرة- إلا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ثم إن زواجه بأم المؤمنين زينب بنت جحش على وجه الخصوص كانت لإبطال التبنِّي، وذلك بنص القرآن ذاته: “لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًاۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا” (الأحزاب: 37). ثم إن الرسول عليه السلام كان يعرف زينب من صغرها، فلماذا تأخَّر عن الزواج منها ابتداءً وهي قريبته؟ هذا فضلًا عن أنه دعا زيدًا بأن يُمسِك عليه زوجَه زينب بنصِّ القرآن: “وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ” (الأحزاب: 37)، وهو ما يدل على أن زواجه عليه السلام بزينب ليس ناتجًا عن هواه، وإنما بأمر إلهي.
من جهة أخرى، فإن مسألة إمعانه عليه السلام في القتل والخروج عن شخصيته السمحة المسالمة التي كان عليها في مكة، فيتفق عليها (الأخضر) و(الرصافي) و(جعيط)، وهو ما جعل الفترة المدنية عندهم نقيض المكية. ويضيف (الجابري) و(القمني) إلى ذلك أن الرسول لم يهاجر إلى المدينة إلا بعد أن أبرم مع مُمثلِّيها معاهدة الدفاع المشترك المُعبَّر عنها ببيعة العقبة[58]. ويدحض البقمي ذلك بأن البيعة تمَّت بين المدنِيِّين الذين آمنوا بصدق النبي ودعوته، وكانت خُفية بعد مضي ثلث الليل في الشِّعب عند العقبة، خشية المُبايِعِين من بطش المشركين الذي قَدِموا معهم للحج[59]. وهذا يقوِّض بالمناسبة دعوى أن هؤلاء المُبايِعِين كانوا مُمثلِّي أهل المدينة. فضلًا عن ذلك، فإن آية “أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ” (الحج: 39) نزلت بعد إخراج الرسول عليه السلام من مكة، وهي أول آية نزلت في القتال.
وعلى كلٍ، يُلحِق العلمانيون بدعواهم هذه زعْمًا آخر مفاده أن الرسول سعى وناوَرَ وهو في المدينة إلى إشراك جماعته التي آمنت به في مشروعه المادي، عبر أدوات السلطة والمال والغنائم. ومرةً أخرى، يفنِّد البقمي ذلك بقوله إن هؤلاء المؤمنين آمنوا؛ لرغبتهم الصادقة في الإيمان، وليس لأجل مال أو جاه؛ ولأنهم احتكُّوا باليهود الذين كانوا ينبِّئونهم أن نبي آخر الزمان مُشارِفٌ على الظهور. هذا فضلًا عن حِسِّ الأنصار الإيماني؛ لأنهم لم يتركوا شعيرة الحج قبل إسلامهم، ولو على طريقة العرب؛ فكانت لهم صلة إيمانية، أعانتهم على التصديق بالنبي عليه السلام فيما بعد. ثم إنهم آمنوا ولم تكن الغنائم قد أُحِلَّت بعد. كما أنهم إنْ كانوا أصحاب غايات مادية، لم تكن لِتظهر منهم أسمى مظاهر المؤاخاة حين قدِم إليهم المهاجرون من مكة، بل المؤاخاة حتى في توارث المال، وذلك حتى وقعة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة.
- القراءة العلمانية للمعارضة المدنية لدعوة النبي عليه السلام:
يزعم العلمانيون أن معارضة الكفار في المدينة هي امتداد للمعارضة في مكة، مع تميزها عن مكة بوجود اليهود والمجتمع الوثني العربي الذي تمثله الأوس والخزرج، وما يشكِّله تحالف الجانبَين من قوة معارضة للنبي عليه السلام.
وبالنسبة لليهود، ادّعى (هشام جعيط) أن النبي قد خطط لتصفية اليهود وإخراجهم من المدينة وجوارها؛ بغية توسيع السلطة، خصوصًا بعد بدر، بما يعني أن السلسلة الزمنية للمواجهة مع اليهود مفتعَلة ومُرتَّب لها[60]. كما يرى أن طرد بني قنيقاع اليهود كان بسبب يهوديتهم، ولكونهم الحلقة الأضعف في قبائل اليهود والأقل عددًا، وليس لخيانتهم عهد الصلح مع النبي عليه السلام[61]. هذا فيما يرى (القمني) أن دعوى محاولة قتل بني النضير للنبي عليه السلام – بإلقاء الصخرة عليه- قد افتُعِلَت أسبابها من جانب المسلمين؛ لإجلاء بني النضير عن المدينة، وذلك بزعْم اعتقاد النبي أن اليهود سيظلوا مُنكِرين دائمين لنبوته في عقر دار دولته الصغيرة الناشئة[62]. وأما بنو قريظة، فيرى (الرصافي) أن النبي عليه السلام أراد تصفيتهم، فـ “ادَّعى” أن جبريل أمره بذلك[63]. فيما يزعم (العفيف الأخضر) أن النبي قتل رجالهم في مذبحة فظيعة على مدى يوم ونصف، ثم باع نساءَهم وأطفالَهم في الحبشة[64]. وعممَّ (جعيط) ذلك بقوله: “إن قمع اليهود، سواء بالإخراج من المدينة أم بالإعدام [بنو قريظة] قد حصل بانتظام بعد كل حدث حربي… بدت [هذه السياسة] مفيدة لمحمد ولمستقبل الإسلام، فقد تمكَّن بواسطتها من تأمين طاعة عرب المدينة كافة، ولاسيَّما الوثنيين منهم”[65].
ويأخذ البقمي على هؤلاء أنهم جاؤوا بأخبار وقائع النبي مع اليهود كما هي، دون ذِكر أسبابها أو نتائجها، كما وردت في ذات المصادر التي اقتبسوا منها، وهو ما جعل النبي عليه السلام متهمًا دائمًا، واليهود أبرياء دائمًا، لا ذنب لهم إلا أطماع محمد التوسُّعيَّة. فالصحيح الثابت تاريخيًا أن النبي عليه السلام عاهد اليهود أول ما قَدِم المدينة، وكان بنو قينقاع هم أول مَن نقضوا العهد، وكذا فعل بنو النضير حينما همُّوا باغتيال النبي الذي ذهب إليهم ليشاورهم في دية قتيلَين من بني عامر. وجاء دور بنو قريظة حينما أذعن كبيرُهم كعبٌ بن أسد لطلب حُيَيّ بن أخطب النضري بالانضمام إليه، مع قريش وغطفان، لاستئصال محمدًا ومَن معه، رغم اعتراف كعب ذاته بأنه لم يرَ من محمدٍ إلا وفاءً وصدقًا. بل إن النبي عليه السلام بعث إليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه في نفر للاستيثاق عن فعلهم ذلك، ولم يؤاخذهم بمطلق إشاعة الخبر. أضِف إلى ذلك أن كعبًا وأصحابه رفضوا الإيمان بالنبي عليه السلام رغم علمهم يقينًا أنه نبي مُرسَل، باعتراف كعب أيضًا. في ضوء ذلك، لماذا إذَن يُنصِّب العلماني نفسه محاميًا دون مَن اختار مصيره خيانةً وعنادًا؟ يوضح البقمي أن العلمانيين في هذه الجزئية موافقون تمامًا لموقف المستشرقين أمثال فلهاوزن، ومونتجمري وات، وميور، وفنسك، الذين غاروا على يهوديَّتهم أو نصرانيَّتهم من انتصارات النبي عليه السلام، وهي مواقف ذكرها البقمي تفصيلًا على نحوٍ يُدهِش القارئ من هول تشابه نُقول العلمانيين العرب عنهم[66].
هذا، وبالنسبة للوثنيين العرب، الذين تطلق عليهم الشريعة لفظ “المنافقين”، فيسمِّيهم العلمانيون العرب بـ “المعارضة”، وهذه المعارضة عندهم أقرب للمعارضة الفكرية من المعارضة الحربية. فيقول (ساسي الضيفاوي): “إن محمدًا ينتهج مع المعارضة ما أقرَّه القرآن من كل الأشكال العدائية والصور العدوانية، وحثَّ عليها وأمرَ بالتخلص من المُعارِض، بل نعَتَه بالمنافِق، إلى حد الدعوة إلى التمثيل به والتنكيل بحرمة جسده”[67]. ومن ثمَّ، لم يدخل الناس في الإسلام إلا خوفًا كما يقول (الرصافي)، وأن الذين اعتنقوه كمبدأ ذي غاية شريفة قليلون[68]. وبالنسبة لرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فحاول (جعيط) تبرئته؛ باعتباره الرجل الحكيم والسياسي الزعيم المحتمل، والذي سوَّدت كتب السيرة صفحته[69]. أمَّا (محمد محمود)، فيقلب تخذيلَ ابن سلول للجيش في غزوة أحد، ورجوعه إلى المدينة بثلث الجيش، إلى مدحٍ وإطراح؛ حيث عدَّ ذلك خطة استراتيجية من ابن سلول للدفاع عن المدينة أمام قريش، بل واعتبر صلاة النبي عليه السلام على ابن سلول فعلًا استثنائيًا بغرض احتواء الحدث وعدم السماح للمنافقين لتحويله لمظاهرة تتيح لهم كسب تعاطف أهل المدينة وتعزل المسلمين[70].
وقد أنكر البقمي هذه الادَعاءات؛ باعتبار أن العلمانيين قد تغافلوا حقيقة أن المنافقين كان لهم موقفهم الديني الهدَّام من الرسول عليه السلام؛ باختيارهم الإسلام ظاهرًا واستبطانهم الكفر، ما دفعهم بالضرورة إلى محاولة رفع سلطان النبي عنهم. ولذلك ابتُلوا بفضح بواطنهم من خلال تكاسلهم عن دعوة الجهاد، كما في سورة التوبة المُسمَّاة بـ “الفاضحة”. وقد عرَّفهم الوحيُ للنبي عليه السلام، ولكن كان أمرهم خافيًا على المسلمين، فكان أمرهم إلى الله في نهاية المطاف. وقد صلى النبي عليه السلام على موتاهم حتى أنزل الله تعالى قوله: “وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ” (التوبة: 84)، كما في قصة ابن سلول.
علاوةً على ذلك، لم يطلق النبي عليه السلام لفظ “المنافقين” على معارضيه كلهم، كما زعم (الضيفاوي) أعلاه، فلم يطلق ذلك لا على قريش ولا اليهود. بل إن الواقع يؤيد أن نفاق المنافقين كان عاصمًا لدمهم وأموالهم؛ لأنهم لم يُؤاخَذوا إلا بالظاهر، ومن ثمَّ امتنع النبي عن قتالهم حتى “لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه” كما ورد في الحديث الصحيح[71]، بل إن ابن سلول ذاته كان قد أوصى حين وفاته بأن يصلي عليه النبي ويُكفَّن في قميصه. ومن ثمَّ، يتبيَّن قفْز العلمانيين على الأخبار والروايات الصحيحة التي وصفت ابن سلول بالنفاق، فقط للتحكم في التاريخ وتطويعه لخدمة القراءة العلمانية وإبطال ما يخالفها.
****
ختامًا، فإن من أهم الملاحظات التي يمكن استخلاصها من العرض السابق هو تَسَاوي كافة المصادر بالنسبة للعلمانيين العرب، صحيحها وسقيمها، السماوي منها والوضعي. فالمهم هو اقتناص ما يدعم مبتغاهم منها، حتى ولو تم تفسيره أو تأويله على غير ما أجمع عليه علماء المسلمين بالصحة، في سياق المناهج العلمانية المادية المذكورة سَلَفًا. وبالتالي، هناك إشكالية حقيقية في منهجهم المزعوم بأنه “علمي”، وهي مسألة يجب تفنيدها وبيان عوارها باستفاضة؛ باعتبارها مبيِّنة للأسس الواهية لما يجئ بعدها. وقد أحسن البقمي حين استعرض بعض هذه المناهج، كما مضى.
من جهة أخرى، يلاحظ المرء تحاملًا جريئًا للعلمانيين العرب، وإنْ بدرجات متفاوتة، على شخص النبي عليه السلام وسيرته ودعوته، والتشكيك فيها، حتى أنهم لم يتركوا لمُعَادِيّ الإسلام ما يقومون به. وبينما قال تعالى: “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ” (الحجرات: 2)، فإن العلمانيين تجاوزوا مسألة رفع الصوت، ليطعنوا في نزاهته ومقاصده وشخصه، ولكن أين هم من مدح الله تعالى له عليه السلام: “وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ” (القلم: 4)؟ ثم إن أقوالهم تخرج من جُحرٍ واحد، فهي متشابهة المضمون والمرامي، وإن اختلفت الحروف. وكان من محاسن كتاب البقمي جمْعه ادّعاءاتهم وافتراءاتهم في مؤلَّف واحد لتنجلي الصورة كاملة.
عرض:
أ. وليد القاضي*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أمثال تيودور نولدكه وريجي بلاشير وتور أندريه وغودفروا ديمومبين ومنتغمري وات ومكسيم رودنسون وإجناتس جولدتسيهر ويوليوس فلهاوزن وهاملتون جيب ولين بول وفرانتس بول وصموئيل مرجوليوث وريتشارد بيل
[2] ينقل البقمي هنا قول أركون في كتابه “تاريخية الفكر العربي” (ص 17): “لقد آن الأوان لكي نفتح هذه الإضبارة الشائكة على مصراعَيها كليًا، إننا لا نستطيع أن نكتفي بمفهوم العدالة الذي بلوره المحدِّثون أصحاب الحديث”. انظر ص 89 من الكتاب محل العرض.
[3] انظر كتابه “من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ”، ص 39.
[4] انظر كتابه “23 عامًا دراسة في السيرة النبوية”، ص 31.
[5] كتابه “مقدمات في الإسلام المحمدي الباكر”، ص 446.
[6] انظر: العفيف الأخضر. من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ، ص 123. ومعروف الرصافي. الشخصية المحمدية، ص 115. وانظر ذلك المعنى بصورة غير مباشرة لدى كلٍ من: هشام جعيط. تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، ص 46. ومحمد عابد الجابري. مدخل إلى القرآن، ص ص 429، 433.
[7] انظر كتابه “من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ”، ص ص 41، 176. وانظر كذلك معنى ذلك لدى وحيد السعفي. العجيب والغريب في التفسير، ص 524.
[8] انظر كتابه “الشخصية المحمدية”، ص 95.
[9] انظر كتابه “التراسل بين النبي محمد ومعاصريه”، ص 294.
[10] راجع كتابه “23 عامًا دراسة في السيرة النبوية”، ص 47. وانظر كذلك كتاب “الشخصية المحمدية” للرصافي، ص 96.
[11] كما في قوله تعالى: ” قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا” (الإسراء: 88).
[12] انظر: العفيف الأخضر. من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ، ص 35. وهشام جعيط. مقدمة تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، ص 15.
[13] انظر كتابه “مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر، ص 161.
[14] انظر: محمد أركون. قراءات في القرآن، ص 316؛ وطيب تيزيني. مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر، ص 152؛ وساسي الضيفاوي. التراسل بين النبي محمد ومعاصريه، ص ص 128، 356؛ وهشام جعيط. مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام، ص 16؛ وحسن بزاينية. كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، ص 160؛ وحياة عمامو. السيرة النبوية: مناهج ونصوص وشروح، ص 16.
[15] انظر كتابه “التراسل بين النبي محمد ومعاصريه”، ص 352.
[16] انظر كتابه “تاريخية الدعوة المحمدية في مكة”، ص ص 28 – 30.
[17] صحيح البخاري، رقم 3461.
[18] انظر كتابه: الوحي والقرآن والنبوة، دار الطليعة، 2000، ص ص 94، 135.
[19] راجع كتابها: السيرة النبوية: مناهج ونصوص وشروح، ص 246.
[20] انظر كتاب “كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين”، ص 214.
[21] انظر كتابه “التراسل بين النبي محمد ومعاصريه”، ص 450.
[22] انظر في ذلك: حسن بزاينية. كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، ص 50؛ منصف الجزار. المخيال في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول، ص 62؛ حياة عمامو. السيرة النبوية: مناهج ونصوص وشروح، ص 16؛ هشام جعيط. تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، ص ص 89، 252؛ وساسي الضيفاوي. التراسل بين النبي محمد ومعاصريه، ص 23.
[23] انظر ص 265 من الكتاب محل العرض.
[24] انظر: هشام جعيط. تاريخية الدعوة المحمدية، ص 143؛ علي الدشتي. 23 عامًا دراسة في السيرة النبوية المحمدية، ص 26؛ وحيد السعفي. العجيب والغريب في كتب التفسير، ص ص 608 – 609.
[25] انظر كتابه “نبوة محمد التاريخ والصناعة”، ص 70.
[26] انظر كتابه “تاريخية الدعوة المحمدية في مكة”، ص ص 147، 149.
[27] المصدر السابق، ص ص 148، 176.
[28] كتابه “مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر”، ص 390.
[29] انظر كتابه “مدخل إلى القرآن الكريم، ص 93.
[30] انظر: طيب تيزيني. مقدمات في الإسلام المحمدي الباكر، ص 390؛ محمد عابد الجابري. مدخل إلى القرآن الكريم، ص 83؛ هشام جعيط. الوحي والقرآن والنبوة، ص 43؛
[31] انظر كتابه “علم السيرة”، ص 225.
[32] كما في قوله تعالى: “وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ” (البقرة: 78).
[33] انظر كتابه: العلمنة والدين، دار الساقي، 1996، ص 23.
[34] انظر: تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، ص ص 164، 166.
[35] انظر كتابه: من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ، ص 51.
[36] انظر: خليل عبد الكريم. فترة التكوين في حياة الصادق الأمين، ص ص 84، 238؛ حسن بزاينية. كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، ص 335. وانظر كذلك: طيب تيزيني. مقدمات في الإسلام المحمدي الباكر، ص 268.
[37] انظر كتابه: الشخصية المحمدية، ص 21.
[38] كتابه: مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر، ص ص 195، 253.
[39] انظر كتابه: تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، ص 46. وكتاب أركون: تاريخية الفكر العربي، ص 167.
[40] انظر كتابه: الشخصية المحمدية، ص ص 215 – 216.
[41] انظر: هشام جعيط. تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، ص 250.
[42] انظر: معروف الرضافي. الشخصية المحمدية، ص 223؛ وهشام جعيط. تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، ص 244.
[43] تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، ص 258.
[44] المرجع السابق، ص 256.
[45] المرجع السابق.
[46] المرجع السابق، ص ص 184، 312، 327.
[47] انظر: حسن حنفي. علم السيرة، ص ص 72، 123؛ محمد عابد الجابري. مدخل إلى القرآن، ص ص 187- 188؛ محمد محمود. نبوة محمد التاريخ والصناعة، ص ص 143، 223؛ علي الدشتي. 23 عامًا دراسة في السيرة النبوية المحمدية، ص 24؛
[48] انظر كتابه: من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ، ص 60.
[49] التراسل بين النبي محمد ومعاصريه، ص 326.
[50] مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر، ص 195.
[51] النزعات المادية، الجزء الأول، ص 386.
[52] الشخصية المحمدية، ص 21.
[53] هشام جعيط. مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام؛ والعفيف الأخضر. من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ، ص 233.
[54] يوليوس فلهاوزن. تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية. ترجمة: محمد أبو ريدة، القاهرة، ط. 1968، ص 5؛ ومنتجمري وات. محمد في المدينة، ص 3.
[55] وذلك مصداقًا لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68)” (المائدة). وسورة المائدة مدنية بالكامل، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم.
[56] العفيف الأخضر. من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ، ص ص 213 – 214؛ معروف الرصافي. الشخصية المحمدية، ص 350.
[57] إصلاح الإسلام: بدراسته وتدريسه بعلوم الأديان. منشورات الجمل، ط. 2014، ص 112.
[58] محمد عابد الجابري. التفسير الواضح حسب أسباب النزول. القسم الثالث. دار النشر المغربية، ط. 2009، ص 12؛ سيد القمني. حروب دولة الرسول، الجزء الأول، ص 35.
[59] سيرة ابن هشام، الجزء الأول، ص 441.
[60] مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام، ص ص 91، 93.
[61] المرجع السابق، ص 90.
[62] حروب دولة الرسول، الجزء الثاني، ص ص 211، 229، 231، 243.
[63] الشخصية المحمدية، ص 151.
[64] من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ، ص 240.
[65] مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام، ص 113.
[66] انظر الكتاب محل العرض، من ص 456، 460.
[67] التراسل بين النبي محمد ومعاصريه، ص 329.
[68] الشخصية المحمدية، ص 287.
[69] مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام، ص 110.
[70] نبوة محمد التاريخ والصناعة، ص ص 283، 287.
[71] صحيح البخاري، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، الجزء الرابع، ص 184.
* باحث دكتوراة في العلوم السياسية.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies