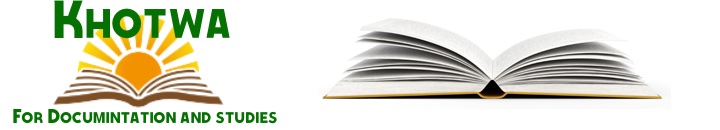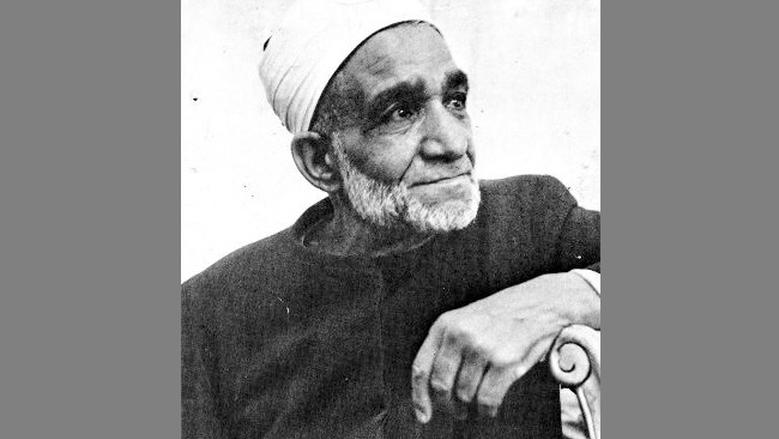محمد إقبال
مفكر النهضة وشاعر الشرق
أ. أحمد محمد علي*
لقد أسهمت مظاهر الانحطاط والضعف التي ألمّت بالعالمين العربي والإسلامي، إلى جانب موجات الاستعمار، في بروز العديد من المحاولات الإصلاحية والتجديدية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، بما في ذلك شبه القارة الهندية. وعند الحديث عن رموز الفكر والفلسفة في الهند، لا يمكن إغفال أحد أبرز أعلامها في العصر الحديث، وهو الشاعر والفيلسوف “محمد إقبال”، الذي يُعدّ من أهم مَن أنجبتهم الحضارة الهندية الإسلامية، فقد شكّلت أفكاره وفلسفته منبعًا ثريًّا للإلهام. وهو صاحب أكبر مدرسة شعرية في الهند. ولم يكن إقبال شاعرًا فيلسوفًا فحسب، بل كان رمزًا للأمل والتغيير في العالم الإسلامي.
وُلد إقبال في إقليم “البنجاب” بالهند عام 1877في أسرة هندوكية من البراهمة في كشمير[1]، وهي جماعة لها شأن كبير في الهند لكنها كانت تعبد الأصنام وتقدس التماثيل، لكن الجد الأكبر لمحمد إقبال تنازل عن هذه المكانة، ودخل في دين الإسلام. وهاجر إلى ولاية “بنجاب” طلبًا للرزق.
ونشأ إقبال في بيت صالح لأبوين تقيين، فكانت أمه نموذجًا رائعًا للتقوى والورع والالتزام بتعاليم الإسلام السمحة، أما والده “محمد نورد الدين إقبال” فكان له علم واسع في الدين، زاهدًا، تدمع عيناه خوفًا كلما ذُكرت الجنة والنار، وكلما سمع عن يوم الحساب.
النشأة العلمية لمحمد إقبال:
نشأ محمد إقبال في بيئة علمية ودينية متميزة. كان والده محبًّا للقرآن الكريم، يحرص على غرس تعاليمه في قلب ابنه منذ الصغر. وقد نشأ إقبال على تعظيم كتاب الله، والتأمل في آياته، مما كان له الأثر العميق في تشكيل فكره وشخصيته. وكان والده كثيرًا ما يحثه على قراءة القرآن لا لمجرد التلاوة، بل للتدبر والتفكر في معانيه، قائلًا له” اقرأ القرآن وكأنّه أُنزِل عليك.” وقد تركت هذه الكلمات أثرًا بالغًا في قلب إقبال، فظل يتدبر معانيه ويغوص في بحار علومه، حتى انطبع نور القراَن في قلبه، وفاض على لسانه، وأصبح دليله ومرشده في جميع خطوات حياته.
بدأ إقبال التعليم في طفولته على يد والده، ثم أُدخل كُتّابًا ليتعلم القرآن، ثم انتقل إلى المدرسة، ودرس اللغة الفارسية والعربية على يد الأستاذ مير حسن[2]، ولفت الأنظار إليه بذكائه الشديد، وأخلاقه الكريمة؛ فاحترمه الجميع؛ من زملائه وأساتذته، وحصل على الكثير من التقدير، ونال فرصة الدراسة مجانًا.
وفي هذه السن المبكرة برع إقبال في كتابة وتنظيم الشعر وشجعه على ذلك أستاذه “مير حسن”، فكان يُنْظم الشعر في بداية حياته بالبنجابية، ولكن أستاذه وجهه إلى النظم بلغة الأوردو. وقد سُمي إقبال بالشاعر الفيلسوف، فالشعر والفلسفة عنده مراَتان لنفْسٍ واحدة، لا نستطيع أن نفصل بينهما[3]. فلم يكن شعر إقبال ترفًا لغويًا، بل أداة لبث الروح في الأمة، وتعبير عن رؤية فلسفية عميقة بلغة عاطفية وشاعرية. وشعره باللغتين الأوردو والفارسية ما زال يُقرأ ويُحفظ ويُنشد، وفيه من القوة الخطابية والصدق ما يجعل القارئ يشعر أن الكلمات كُتبت له شخصيًا[4].
والتقى إقبال في الكلية الحكومية بــ(لاهور) بأستاذه المستشرق “توماس ووكر أرنولد”[5] الذي درس على يده الفلسفة، وأرنولد من كبار علماء الغرب الذين درسوا الإسلام عامة والتصوف خاصة، فكان يُرشده ويعينه في الدراسة، وكان توماس يفخر بذكاء تلميذه، ويعتز بصداقته.
وتميز إقبال في اللغتين العربية والإنجليزية، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الفلسفة. وبعد أن أنهى إقبال دراسته الجامعية بــ(لاهور) عُيّن أستاذًا للتاريخ والفلسفة والسياسة المدنية بالكلية الشرقية بـ(لاهور)، ثم أستاذًا للفلسفة واللغة الإنجليزية في الكلية الحكومية التي تخرج فيها. ثم سافر إقبال إلى أوروبا عام 1905، حيث نال درجة الفلسفة من جامعة “كمبردج” ودرجة القانون من “كلية لندن للعلوم السياسية”.
وقد أقام إقبال في أوروبا طيلة ثلاث سنوات لم تُغير أخلاقه الأصلية، بل أنه طالع عن قرب زيف ما يُسمونه بالحضارة الغربية، وانتقد الجوانب المادية في حضارتهم وفصلهم بين السياسة والدين. وهناك في بلاد الغرب كان إقبال يفخر بانتمائه الى الإسلام الذي حرر الإنسان وطهر النفوس.
وعقب عودته إلى وطنه سنة 1908 بعد ثلاث سنوات من الدراسة والتأمل في أوروبا، استُقبل محمد إقبال بحفاوة في دلهي ولاهور، وأول شيء فعله عقب عودته هو أنه زار مزار “نظام الدين أولياء” – وهو أحد كبار الأولياء الصوفيين في الهند ويُعد رمزًا للتصوف الإسلامي الروحي – وهو نفس الأمر الذي فعله عند مغادرته، وذلك في إشارة رمزية على تمسكه بثوابته الروحية رغم ما رآه من حضارة الغرب ومغرياته. وكان هذا دليل على أنه استفاد من التجربة الغربية عقليًّا دون أن يفقد توازنه الروحي أو ينخدع ببريقها الزائف.
وقد عمل إقبال في المحاماة بعد عودته، لكنه لم يجعلها غاية، بل وسيلة للعيش الكريم، حيث كان يختار القضايا بعناية ولا يعمل إلا ما يكفي حاجته المعيشية، متفرغًا لأداء رسالته الفكرية والفلسفية. وقد عُرف بدقته وانضباطه حتى في مواعيد المحكمة، مما يدل على قدرة نادرة على التوازن بين التزامات الحياة اليومية ومهمته الفكرية الكبرى، التي انطلقت من قناعات دينية وفلسفية عميقة.
وفي ميدان التعليم، عاد إلى كلية الحكومة في لاهور لتدريس الفلسفة والآداب، لكنه لم يلبث أن استقال اعتراضًا على القيود التي فرضتها الوظيفة تحت حكم الإنجليز، حيث أراد أن يكون حرًّا في التعبير عن أفكاره. ورغم استقالته، فإنه بقى على صلة وثيقة بالمؤسسات الأكاديمية، وعمل في لجان تعليمية داخل الهند وخارجها، وأسهم بفكره في تطوير مناهج التعليم، لا سيما عبر فلسفته في “الذاتية”. كما ألقى محاضرات مؤثرة في عدد من المدن والجامعات الهندية، مؤكدًا وحدة المسلمين، وناقدًا النزعات الوطنية الضيقة، ومشيدًا بإرث المسلمين الحضاري.
وفي ميدان السياسة، تجسّدت فلسفة إقبال في دعوة واعية إلى الحرية والكرامة والتعاون بين الشعوب، حيث رفض إقبال تقليد النموذج الأوروبي للوطنية، معتبرًا أن الأمة لا تقوم على وحدة العِرق أو الأرض فقط، بل أيضًا على وحدة الشعور والإيمان والمصير المشترك. وقد لعب دورًا سياسيًّا بارزًا في دعم حقوق مسلمي الهند، فكان من أوائل مَن نادوا بتقسيم البلاد على أسس دينية وثقافية تحفظ خصوصية المسلمين. وقد ترأس حزب الرابطة الإسلامية في لحظاته العصيبة، فكان صلبًا ثابتًا بشهادة “محمد علي جناح”[6]. ومثّلت خطبه في المؤتمرات السياسية الكبرى، ومشاركته في صياغة مستقبل الهند، مصدر إلهام للوعي القومي، ورسالة يقظة سياسية قائمة على العقل والعدل والمشاركة الواعية، لا على الذوبان القسري في هوية جامعة زائفة[7]. ورغم أن إقبال لم يعِش حتى يرى قيام الدولة الباكستانية إلا أن رؤيته كانت أحد العوامل المؤثرة في نشأة باكستان.
ظروف عصره:
يُعد فهم ظروف العصر الذي نشأ فيه الدكتور محمد إقبال، مفتاحًا جوهريًا لفهم مشروعه الإصلاحي والفكري، إذ لم تنشأ أفكار إقبال في الفراغ، بل تبلورت في سياق سياسي وثقافي مضطرب شهدته الهند. فقد مارست السلطات الاستعمارية سياسات ممنهجة لإقصاء المسلمين من مراكز النفوذ والسلطة، والقضاء على الحضارة الإسلامية القائمة في هذه المنطقة والعمل على اقتلاع الإسلام من جذوره، فعمدوا إلى القضاء على قادتها ورجالها وعلمائها[8]. تزامن ذلك مع صعود الحركات الوطنية ذات الأغلبية الهندوسية، والتي تجاهلت الخصوصية الثقافية والدينية للمسلمين. وهذا الأمر دفع إقبال لاتخاذ موقفًا نقديًا منها، داعيًا إلى ضرورة تمثيل سياسي مستقل للمسلمين يحمي هويتهم من التلاشي.
وفي ظل هذه التحديات، تشكّل وعي إقبال وبرزت دعوته إلى تجديد الفكر الإسلامي، باعتبارها استجابة تاريخية لواقعٍ مأزوم يتطلب يقظة روحية وعقلية، فدعا إلى إحياء الفكر الإسلامي بروح جديدة قائمة على الاجتهاد والتجديد والتوازن بين العقل والوحي، مُستلهمًا هذه الروح من تراث كبار المفكرين المسلمين[9].
وقد انعكست هذه الأوضاع مجتمعةً على بنية مشروع إقبال الفكري، الذي لم يكن مجرد استجابة ظرفية، بل رؤية إصلاحية متكاملة. فقد أدرك أن النهضة الحقيقية لا تبدأ من السياسة فقط، بل من الإنسان ذاته، فركّز على بناء “الخُودي” أو الذات الفاعلة – الذي سنتحدث عنه لاحقًا بالتفصيل-، التي تستمد كرامتها من علاقتها بالله واستقلالها عن التبعية الفكرية. وبهذا، مثّل إقبال صوتًا مميزًا في الفكر الإسلامي الحديث، يجمع بين الإيمان العميق بالعقيدة، والانفتاح العقلاني على أدوات العصر، دون تفريط في الخصوصية الحضارية.
وقد ألَّف إقبال باللغة الفارسية والأوردية مجموعة كبيرة من المؤلفات الهامة، تم ترجمة بعضها الى اللغة العربية، منها: أسرار الخودي. رسالة الشرق، ضربة موسى[10]، تجديد الفكر الديني في الإسلام[11].
دوافع التجديد الحضاري عند محمد إقبال:
استند التجديد في فكر الدكتور محمد إقبال إلى إعادة توجيه الفكر الإسلامي نحو مقاصده الكبرى، وعلى رأسها استعادة دوره الإنساني. فقد تمحور مشروعه الإصلاحي حول إعادة إبراز القيمة الجوهرية للإسلام كقوة موجهة لحركة الإنسان في العالم، ومن بين الدوافع التي حفزت إقبال إلى حركته التجديدية:
- الدافع الأول، أوضاع العالم الإسلامي: والذي يتمثل في الواقع الصعب الذي يعيشه المسلم المعاصر، والذي يتسم بالركود الفكري، والانحدار الاجتماعي، والضعف الحضاري في مختلف المجالات، على الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية لعقيدة التوحيد وشريعة سمحة تُعدُّ من أعظم ما أُوتي به الإنسان من مقومات النهوض. فقد كانت هذه المنظومة العقدية والتشريعية أساسًا لحضارة راقية أسسها المسلمون الأوائل. غير أن ما آلت إليه الأمة من تراجع يُعزى إلى جملة من العوامل، أبرزها: إغلاق باب الاجتهاد، وجمود الفكر الفقهي، وتدهور الأخلاق العامة، فضلًا عن تفشي الفساد في العقيدة وتحوّل التوحيد في الإسلام نحو تقديس الأولياء والأضرحة، وانتشار الشعوذة والسحر مما عطّل دور الدين في النهوض الحضاري.
إذن فما آل إليه حال المسلم المعاصر من ركود فكري وانحطاط اجتماعي ومن ضعف وتخلف هو ما دفع إقبال إلى التفكير في إصلاح بنية الفكر الإسلامي وبث في المسلمين الروح الدينية من جديد في وقت سيطرت عليه المادة من ناحية والأوهام والخرافات التي علقت بالدين جراء السكون وفقدان الثقة بالذات من ناحية أخرى. وهنا سعى إقبال الى إحياء الشريعة وإعادة الفاعلية إلى الدين وبعث الفكر الإسلامي من جديد.
- الدافع الثاني، التصوف السلبي: فالفهم الخاطئ للإسلام قد أدخل بعض المسلمين في الصوفية السلبية التي جعلتهم يعيشون في عزلة عن الواقع وفي حالة من الركود والجمود والابتعاد عن أي فاعلية حضارية. من أجل هذا سعى “إقبال” إلى دفع المسلم من جديد إلى العمل وعدم التواكل، بإيضاح أن الإسلام دين عمل، وأن العمل لا يبعد عن روح الله ووجود ذاته المقدسة، فسعى إقبال الى إنقاذ الفكر الإسلامي من الضياع والفناء والسلبية والزهد والاستسلام للأقدار[12]، ودفع المسلم الى التصوف الإيجابي الذي يُحرر الحياة الروحية للفرد، ويجعله أكثر تطلعًا وانفتاحًا على العصر، وهذا البُعد التصحيحي والتجديدي لمفهوم التصوف يراه إقبال ضروريًا ليقظة الوعي الإسلامي من حالة الخمول التي بثها التصوف السلبي.
- الدافع الثالث؛ الحضارة الغربية: أثرت الحضارة الغربية بمنتجاتها المادية الجديدة والبراقة تأثيرًا سلييًا على حياة الأمة الإسلامية. فالغالب هو أوروبا وما أنتجته من حضارة وفكر وعلم، والمغلوب هو المسلم المعاصر وما يحمله من فكر وضعف وانحطاط. فالفكر الديني الإسلامي ظل راكدًا خلال القرون الخمسة الأخيرة في وقت كانت تعيش الحضارة الأوروبية أوج إزدهارها. وسار المسلمون على درب الحضارة الغربية واقتدوا بها، فولدت في نفوسهم الضعف والتخلف والتقليد والاتباع، وبثت في روحهم الشعور بالنقص والوهن، فرضخوا للحضارة الغربية وخضعوا لها وأصبحوا مقدِسين لعظمتها، فتخلى المسلم عن قيمه ومبادئه وانسلخ من أصوله وأصبح مقلدًا لكل ما هو غربي. وحسب ابن خلدون: “المغلوب دومًا مولع بتقليد الغالب” حتى في نمط اللباس والجلوس وغيرها من المظاهر. هذه الوضعية هي التي ساهمت في بلورة فكرة الإصلاح عن “محمد إقبال”، فقد أعلن مواجهة فكرية شاملة ضد الحضارة الغربية وماديتها الجافة؛ وكان من القلائل – إن لم يكن الوحيد في عصره – الذين امتلكوا إلمامًا عميقًا بفلسفة الغرب ومعرفة دقيقة بمقومات حضارته ونمط حياته، ولذا حين شرع في تفنيد أسسها الفكرية ونقد نزعتها المادية، بدأ بريق تلك الحضارة يخفت تدريجيًا في أعين مَن انبهروا بها، وانكشف زيف سحرها الذي طالما استولى على القلوب والعقول[13].
وبالرغم من هذه النظرة السلبية التي حملتها الحضارة الغربية للأمة الإسلامية، إلا أننا نجد أن إقبال لا يقف منها موقف المعارض والرافض المُطلق، وإنما حث على نقدها دون تعصب، والتحاور معها من موقع الندّ وليس من موقع الضعف أو التقليد، وأخيرًا الاستفادة منها مع تفادي مخاطرها.
فهذه إذن كانت هي صورة المسلمين كما رآها إقبال، وجاهد طوال حياته لتحسين هذه الصورة وعلاج أمراض المسلمين، ورأى أن من أسس العلاج تجديد التفكير الديني على ضوء معطيات المعرفة الحديثة، وبمنهج يقوم على النقد وإعادة البناء.
وكانت رؤية إقبال واضحة المعالم في مشروعه الفكري؛ إذ آمن بقدرة العالم الإسلامي على الانخراط الفاعل في العصر الحديث، والمضي قدمًا في مسار التجديد الذي ينشده. وقد شدّد على أن المسلمين يمتلكون مؤهلات عقلية وتجريبية رصينة، تجعلهم قادرين على الإسهام في بناء الحداثة لا مجرد التكيف معها. فبحسب إقبال، فإن التجديد المنشود لا ينبغي أن يُختزل في مجرد التماهي مع مظاهر الحياة العصرية، بل يجب أن ينطلق من عمق فكري وتجربة حضارية واعية. كما حذّر من أن تسارع التقدّم في أوروبا لا ينبغي أن يُفضي بالمسلمين إلى الانكفاء أو الانعزال بدافع الخوف أو الشعور بالعجز، بل يجب أن يكون دافعًا لهم إلى الاندماج في العالم الحديث، بروح من الثقة والجرأة، ومن خلال تجديد الفكر على أسس أصيلة ومعاصرة في آن واحد[14].
الفكر الإصلاحي والتجديدي لمحمد إقبال:
في كتابه “تجديد الفكر الديني في الإسلام”؛ يُشيد محمد إقبال بفضل التجديد في حياة الأمم والشعوب. والتجديد عند إقبال لا يعني به تطوير الإسلام أو الدين في حد ذاته- كما فعل “مارتن لوثر كينج” في المسيحية- بل يكون التجديد تجديدًا في الفكر من خلال تحقيق التوافق بين التقدم الحضاري وبين المبادئ الإسلامية الثابتة[15].
استمد الفكر الإصلاحي والتجديدي لدى إقبال قوته ومكانته وعمقه من ارتباطه المباشر بالإسلام وواقع المسلمين وحياتهم في العالم الإسلامي المعاصر، وتعبيره عن مشاكلهم وهمومهم، وعن آلامهم وتطلعاتهم، فاستطاع أن يكفل التوازن بين كلٍ من الروح والمادة، وبين الدين والدولة، وبين الدنيا والآخرة. ويرى إقبال أن الدافع الأساسي للتجديد هو الحاجة إلى إعادة تموضع الأمة الإسلامية في خريطة الحضارة الإنسانية، والنهوض بمسؤوليتها التاريخية من جديد.
كما رأي إقبال أن خسارة الأمة الإسلامية موقع الريادة الحضارية وتقدم الأوروبيين صار يستدعي تجديدًا في الفكر الديني الإسلامي وغير الديني أيضًا. ورأى أن إعادة دراسة هذا الأمر يعني بشكل واضح نقدًا للفكر والواقع الذين قادا إلى تدهور حال المسلمين وخسارتهم التفوق الحضاري والعلمي. لذلك سعى إقبال إلى بلورة قراءة جديدة تسهم في تجديد الفكر الديني الإسلامي من خلال إعادة الاعتبار لمنهج الاستقراء العقلي في عملية التفكير الديني. وقد رأى أن إغفال هذا المنهج سيحُول دون قدرة الفكر الإسلامي على التفاعل مع الطفرات العلمية المتسارعة، ويعوق اندماجه في مقتضيات العصر الحديث[16].
ومن ثم فالتجديد الحضاري لدى إقبال يقوم على أساسين، الأساس الأول: نقد الفكر الغربي، والثاني: نقد الفكر الإسلامي. فقد تمثل نقده للحضارة الغربية نقدًا للأسس التي قامت عليها وهي الأسس المادية. أما نقده للفكر الإسلامي فهو نقد للتخلف الحضاري والفكري لدى المسلمين. وعليه فإن تجديد الفكر الإسلامي عند إقبال قام وفق خطة مُحكمة أو استراتيجية تجسدت في الهدم القائم على النقد ثم إعادة البناء[17].
الذات الإنسانية عند محمد إقبال:
في بناء مشروعه الفكري الإصلاحي جعل إقبال “الإنسان” هو جوهر المشروع، واعتبر أن النهضة الحضارية الحقيقية لا تتحقق إلا بالذات الإنسانية الحرة. فإقبال لا يرى الإنسان كائنًا سلبيًا مُنقادًا للقدَر، بل هو إنسان عاقل وفاعل ومسؤول، يمتلك روحًا تُمكنه من التطور وتجاوز العقبات. ومن هنا صاغ إقبال ما عُرف بــ”فلسفة الخودي”. وفلسفة “الخودي” أو فلسفة “الأنا” عند إقبال هي إحدى الركائز الأساسية لفكره الفلسفي والروحي، وقد طورها كأداة لتحفيز الإنسان المسلم على النهوض من حالة السكون والانحطاط واستعادة وعيه بذاته ودوره في العالم.
و”الخودي” كلمة فارسية تُعني الذات أو الأنا، لكنها ليست الأنا بمعناها النيتشوي المتعالي ولا بمعناها السلبي النرجسي، بل هي الوعي الحقيقي بالذات وإدراك القيمة الإلهية الكامنة في الإنسان، والسعي لتحقيق الذات عبر الاتصال بالله والعمل في العالم. وتقوم فلسفة الخودي على عدة أسس رئيسية:
- لا تتحقق الذات القوية إلا من خلال الاتصال بالله والتمسك بالقيم الروحية. والذات التي تنكر علاقتها بالله أو تغفل عن هذه العلاقة تذوب في القوى المادية أو في المجتمع وتفقد تميزها.
- الذات تنمو وتتطور من خلال الصراع والتجربة والعمل، فالذات القوية هي التي تنمو من خلال مواجهة التحديات لا الهروب منها.
- دور الذات في فلسفة إقبال – بجانب عبوديتها لله تعالى – المشاركة في إعمار الكون.
- ينتقد إقبال في فلسفته التصوف الذي يركز على “فناء الذات” وترك الدنيا. ويرى أن ذلك يؤدي الى ضعف الفرد وخمول الذات.
إذن يرى إقبال أن الإنسان الذي ينمي ذاته “خوديه” هو إنسان حر ومسؤول، لا يخضع للقهر أو التبعية. وقد طرح إقبال فلسفة الذات لأنه رأى أن المسلمين قد فقدوا شعورهم بذواتهم، وأصبحوا مقلدين أو خانعين، سواء تحت الاحتلال أو في ظل الجمود الفكري. فكان طرحه لهذه الفلسفة دعوة لبناء الذات المسلمة القوية المتصلة بالله من أجل تحقيق البعث والنهوض الحضاري وتأسيس لنهضة روحية وعقلية.
إذن وضع إقبال مشروعه على أساس من فلسفة تهدف إلى تربية الذات المسلمة لنقلها من حالة الضعف إلى القوة، ومن الذُل إلى العزة، ومن التخلف إلى التقدم، ليصبح تجديد الذات مرتبطًا بمبدأ التغيير في العالم، ذلك لأن مبدأ التغيير هو جوهر ولُب عملية التجديد الحضاري فهو شرط أساسي لبناء الحضارة ولكل عملية إصلاح أو تطور أو إحياء، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ” (الرعد-11)
وتُعد فلسفة الخودي، العنصر الأهم في أفكار إقبال، فهي تؤكد على أهمية الذات، والوعي الذاتي، والقوة الفردية للإنسان. وفي نظر إقبال “الخودي” تمثل القوة الداخلية للإنسان ومكانته وهويته الحقيقية. ووفقًا لهذه الفلسفة، يُعتبر استيقاظ الذات (أو الخودي) الهدف الأسمى في حياة الإنسان، حيث يُمكِّنه من التعرف على قوته وصنع مصيره بنفسه، كما يُعتبر العشق الإلهي جزءًا مُهمًا من هذه الفلسفة. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر إقبال أن الخودي الفردية تُشكل أساس الخودي الجماعية. وأكد أن إدراك الفرد لذاته يُمكِّنه من المساهمة في تشكيل الأمة، وهكذا تُعتبر فلسفة الخودي روح فكر إقبال، حيث توجه الإنسان نحو إدراك قواه الداخلية، وتحقيق البُعد الروحي، والسير نحو الحرية[18].
ولكي يبلغ الإنسان المقام الذي تصبو إليه فلسفة إقبال، لا بد أن يمر بمراحل متدرجة من التربية الروحية والانضباط النفسي، تبدأ بالطاعة، ثم بضبط الشهوات والنوازع الداخلية، وتنتهي بتحقيق أعلى درجات الفاعلية والوعي بالذات. وهذا التدرج مستمد من التصور الإسلامي للإنسان، حيث يتم الربط بين العقيدة والعمل، وبين تنمية الفرد وفاعليته في المجتمع.
من هذا المنظور، لا تندرج فلسفة إقبال ضمن نماذج التأمل المجرد أو التصوف المنعزل، بل تمثل مشروعًا حضاريًا لبناء الإنسان المسلم القادر على النهوض بأمته وقيادة عملية التجديد الشامل. فكل إصلاح – سواء كان دينيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا- لا يمكن أن يتحقق في رأي إقبال إلا إذا انطلق من إصلاح الإنسان ذاته، لأنه هو الفاعل في التاريخ، واللبنة الأولى في إعادة بناء الأمة الإسلامية.
وفي عام 1934 بدأت أعراض المرض تعتري الدكتور إقبال، وتوالت العلل، وأخذت صحته في التدهور شيئًا فشيئًا، وظل أيامًا طويلة طريح الفراش حتى فاضت روحه في فجر 21 أبريل 1938 في لاهور.
الخاتمة:
وفي الأخير، لقد شكّل الدكتور “محمد إقبال” شخصية استثنائية في الفكر الإسلامي الحديث، حيث جمع بين عمق الفلسفة وصدق الإيمان، وبين صلابة الموقف ونفاذ البصيرة. ولم يكن مجرد شاعر أو مفكر فحسب، بل كان صاحب مشروع إصلاحي متكامل، يسعى إلى إحياء الأمة الإسلامية من خلال تجديد الفكر الديني والارتقاء بالوعي الجمعي للمسلمين، مستندًا إلى القرآن الكريم ومستلهمًا روح الحضارة الإسلامية في أوجها. كما رأى أن طريق النهضة لا يمر عبر التقليد الأعمى للحضارات الأخرى، بل من خلال فهم الذات واستعادة الثقة بالإسلام كرسالة شاملة. ورغم ما واجهه من تحديات، ظل إقبال وفيًّا لقضيته، صامدًا في الدفاع عنها حتى آخر لحظة في حياته، فبقي أثره حيًّا في الوجدان الإسلامي.
يمكن القول إن مشروع محمد إقبال مشروع ملهم لكونه يخاطب كينونة الإنسان، في كل زمان ومكان وليس فقط في عصره. فهو مشروع إنساني النزعة، يجمع بين الإيمان والتجديد، بين العقل والروح، بين الحلم والعمل، بين الهوية القومية والرؤية الإنسانية وبين الفلسفة والعرفان. مشروع يهدف الى بناء عالمًَا جديدًا على أساس من الفكر والعمل والإيمان، ولذلك فهو مشروع ملهم لا يزال نابضًا بالحياة في زمن الاضطراب والبحث عن المعنى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ماجستير في العلوم السياسية. جامعة القاهرة.
[1] محمد بن المختار الشنقيطي، “خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين”، (الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 2016)، ص 9.
[2] من المنتسبين إلى آل البيت، وأستاذًا للغة العربية في كلية سيالكوت، وقد تميز بتبحّره في الأدب الفارسي. كان شخصية بارزة وعلَمًا من أعلام البلدة. كما يُشاد بأثر هذا الأستاذ الكبير في تأديب وتعليم تلميذه محمد إقبال.
[3] دينا عبد الحميد، “إقبال الشاعر والفيلسوف”، (مطابع دار القلم، القاهرة، 1959)، ص 7.
[4] غنت سيدة الغناء العربي أم كثوم قصيدة “حديث الروح” لمحمد إقبال والتي كان قد كتبها بالأوردو وترجمها الى اللغة العربية الشاعر الأزهري الصاوي شعلان.
[5] – سير توماس أرنولد: 1864 – 1930م، مُستشرق إنجليزي له العديد من المؤلفات، اهتم بتاريخ الهند وتراثها الإسلامي.
[6] محمد علي جناح هو مؤسس دولة باكستان وأول زعيم لها بعد الاستقلال، وُلد عام 1876 وقاد حركة المسلمين في الهند للحصول على وطن مستقل، واشتهر بلقب “قائد الأعظم”.
[7] عبد الوهاب عزام، “محمد إقبال: سيرته وفلسفته وشعره”، (مؤسسة هنداوي)، ص ص 46 – 50.
[8] أبو الحسن على الحسني الندوي، “الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراته”، (الهند، المجمع الإسلامي العلمي، ندوة العلماء، ط3، 1985)، ص30.
[9] سيد عبد الماجد الغوري، “ديوان محمد إقبال”، (بيروت، دار ابن كثير، ط3، 2007)، ص 370
[10] ترجم هذه المؤلفات الثلاث الى اللغة العربية د. عبد الوهاب عزام.
[11] تُرجم في خمسينيات القرن الماضي بواسطة د. عباس محمود بتكليف من وزارة التربية والتعليم المصرية.
[12] بن غزالة محمد الصديق، “فلسفة التجديد الحضاري في فكر محمد إقبال”، (رسالة ماجستير، جامعة باتنة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية، 2012-2013)، ص 37.
[13] حلمي السعيد، “تجديد الفكر الديني عند محمد إقبال وموقفه من الحركات الإصلاحية والتيارات الفكرية”، (مجلة كلية الآداب، جامعة الزقازيق، العدد 74)، ص 234.
[14] محمد إقبال، ترجمة: عباس محمود، ” تجديد الفكر الديني في الإسلام.”، (القاهرة: دار المعارف)، ص 212.
[15] محمد البهي، “الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي”، (مكتبة وهبة، الطبعة الرابعة، القاهرة، 1964)، ص 367.
[16] طه جابر العلواني، “إصلاح الفكر الإسلامي: مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر“. (الطبعة الأولى، لبنان: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2001)، ص 69
[17] بن أعمر مفتاح، “”التجديد الحضاري عند محمد إقبال”، (مذكرة مُكملة لنيل شهادة الماجيستير في الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 2017/2018)، ص ص 35-36.
[18] محمد بلال خان، “فلسفة الخودي عند العلامة محمد إقبال: قوة الإنسان الداخلية”، على الرابط التالي:
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies