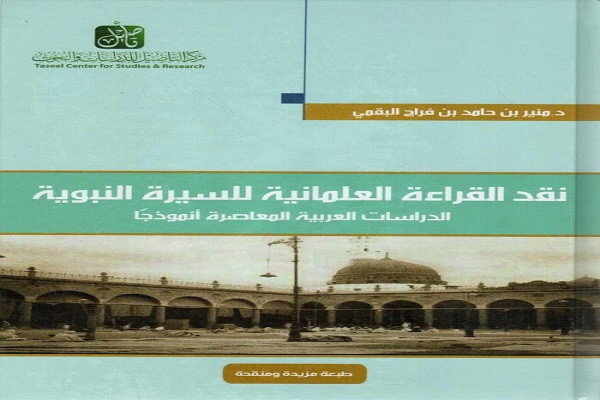العنوان: نظام التفاهة.
المؤلف: آلان دونو.
ترجمة: مشاعل عبد العزيز الهاجري.
مكان النشر: بيروت.
الناشر: دار السؤال للنشر.
تاريخ النشر: 2015.
عدد الصفحات: 368 ص.
الترقيم الدولي الموحد: 1-84-8020-614-978.
إن الإنسانية اليوم تعيش حالة من الاغتراب عن ذاتها بشكل مخيف، وسط ضوضاء ومعايير منحرفة تُعلي من قيمة كل ما هو مادي ولا تلتفت لقيم الحق والخير والعدل، من هنا يأخذنا آلان دونو الفيلسوف والمفكر الكندي في رحلة لدراسة واحدة من أبرز سمات العصر وهي سيطرة التفاهة، وهيمنة الرداءة والسطحية على جميع المجالات والحقول، حيث يشهد العالم صعوداً غريباً لقواعد تتسم بالرداءة ما أدى إلى تدهور متطلبات الجودة العالية، وتهميش منظومات القيم، وبروز الأذواق المنحطة، وتسيد شريحة كاملة من التافهين والجاهلين وذوي البساطة الفكرية، وذلك لخدمة أغراض السوق، وتحت شعارات الديمقراطية والحرية الفردية والخيار الشخصي. وفي هذا السياق يقدم لنا آلان دونو الجانب النظري لهذا النسق وكذلك انعكاساته وتجسداته الواقعية والنتائج التي تتسبب في حدوثها، فهو يشرح كيف مدت التفاهة أذرع سيطرتها في كل اتجاه وفي كل ميدان، من الميدان الأكاديمي، إلى السياسي، فالاقتصادي والتجاري، والمالي، والإعلامي، والفني.
وعلى الرغم من أن الكتاب ينطلق من السياق الثقافي الغربي بشكل عام، والكندي بشكل خاص، وينعكس ذلك فيما يطرحه من مشكلات وفيما يذكره من أمثلة، إلا أن المحور العام للكتاب يتقاطع بلا شك مع الكثير من المشكلات في مجتمعاتنا في العالم العربي والإٍسلامي، من حيث ارتباطها بهيمنة النموذج الغربي الرأسمالي عالمياً.
مقدمة الكتاب
يبين ألان دونو في مقدمة كتابه أن مصطلح “نظام التفاهة” يشير إلى النظام التافه، الذي يتم نَصْبُه كنّموذج، ويشرح كيف أصبح هذا النظام مسيطراً على مجالات الفكر والمعرفة، خصوصاً في الجامعات والمؤسسات الحديثة، بحيث يحوّل المثقفين والباحثين إلى أدوات ضمن منظومة مصالح اقتصادية وسياسية، لا إلى مفكرين أحرار يبحثون عن الحقيقة.
وفي هذا السياق يذكر دونو نموذج يعتبره مركزياً في تجسيد هذا النظام “نظام التفاهة” وهو نموذج “الخبير” الذي يتعرف غالبية أكاديميي الجامعات اليوم على أنفسهم فيه. فهو نموذج يعبر عن ظاهرة تحوّل المثقف أو الأكاديمي إلى موظف تقني داخل نظام المصالح، فهو نموذج لا ينتج معرفةً من موقع الرؤية النقدية أو الإبداعية، بل يعيد صياغة الاعتبارات الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية في هيئة معرفة تقنية محايدة ظاهرياً، مما يمنحها شرعية علمية زائفة، وهنا تكمن المفارقة:
فالخبير يبدو “موضوعياً”، لكنه في العمق يخدم منطق السلطة أو السوق، لأن ما يُحدّد عمله ليس السؤال الفلسفي أو الأخلاقي عن الحقيقة، بل ما تطلبه الجهة الممولة أو المؤسسة أو الدولة، وبالتالي فالخبير، في ظل هذه البنية، لا يُنتج أفكاراً جديدة، بل يُهذّب الموجود بما يتناسب مع “نظام التفاهة”، نظام يجعل من الكفاءة الإجرائية بديلاً عن العمق الفكري، ومن الامتثال بديلاً عن الجرأة النقدية.
من هنا يذكر آلان دونو أن وفقاً لإدوارد سعيد فإن الخطر الذي يتهدّد مثقف اليوم – في الغرب كما في بقية أنحاء العالم – يكمن في فكرة “المهنية “professionalism”، هذه المهنية التي صارت تقدم نفسها وكأنها اتفاق ضمني بين منتجي المعرفة والخطاب العام من جهة وبين مُلاك رأس المال من جهة أخرى. في ظلّ هذا العقد، فإن الفئة الأولى – من دون أي التزام قيمي – تقوم بالتنسيق لمصلحة الفئة الثانية وبتزويدها بالمعلومات العلمية والنظرية التي تتطلبها لإضفاء الشرعية عليها. بذلك فإن إدوارد سعيد يتعرف بداخل الخبير، على سمات التفاهة فيقول: إن الخبير يتصرف دائماً وفق ما يُعتبر سلوكاً مناسباً مهنياً، فلا يشرد بعيداً عن النماذج والحدود المقرّرة، مع جعل نفسه قابلاً للتسويق، وقبل كل شيء صالحاً للظهور، ومن ثم غير مثير للجدل، وغير سياسي، وموضوعياً.
وانطلاقاً من هذا المثال العاكس لطبيعة نظام التفاهة الذي يتناوله دونو يختم مقدمته بقوله: “فإن التفاهة تُشجّعنا، بكل طريقة ممكنة على الإغفاء بدلاً من التفكير، النظر إلى ما هو غير مقبول وكأنه حتمي، وإلى ما هو مَقيت وكأنه ضروري: إنها تُحيلنا إلى أغبياء. فحقيقة أننا نفكّر بهذا العالم باعتباره مجموعة من المتغيرات المتوسطة average variables هو أمر مفهوم، وأن بعض الناس يتشابهون بهذه المتوسطات إلى درجة كبيرة هو أمر طبيعي، ومع ذلك، فإن البعض منا لن يقبل أبداً بالأمر الصامت الذي يطلب من الجميع أن يصبحوا مماثلين لهذه الشخصية المتوسطة”.
الفصل الأول
الخبرة والمعرفة
في هذا الفصل يتناول آلان دونو سيطرة التفاهة على المجال الأكاديمي، فيبين كيف تحولت الجامعات ومراكز البحث العلمي إلى أدوات في خدمة السوق والشركات الكبرى.
ويوضح في هذا السياق كيف أن الأكاديميا كان لها دور كبير في الكثير من العلل الاجتماعية بسبب تحولها لأداة في خدمة الرأسمالية، ونظراً لكون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والعاملين في الأقسام العلمية هم “النخبة” فبالتالي هم يساهمون بشكل كبير في عملية صناعة القرار حتى لو بشكل غير مباشر. فهم يقومون بشكل أو بآخر بتشكيل العالم الذي نعيش فيه وتحديده من خلال المعارف المتحصلة أو المطوَّرة في الجامعات، والمدعَّمة بالشهادات.
ويستدعي آلان دونو هنا ما ذكره هيدجز في كتابه “إمبراطورية الوهم” أن المؤسسات الأكاديمية أصبحت مصدراً جدياً للقلق لأنها باتت مؤسسات تعتني كثيراً بالتكنولوجيا، التـرقـيـات الشخصية، تنظيم المعلومات، وأصبحت هذه هي الطريقة التي تستطيع من خلالها الجامعات أن تدعي لها مكاناً ضمن “اقتصاد المعرفة”، إذ ترى الشركات الكبرى الجامعة كجهة ذات تمويل حكومي مزودة بما تحتاج إليه تلك الشركات من عاملين ومعارف متقدمة. وفي هذا الإطار يذكر دونو عدد كبير من الأمثلة التي تعبر عن حالة خضوع الميدان الأكاديمي للرأسمالية وتقيده بها، فيذكر على سبيل المثال جيمس كريسويل الخبير في الزهور والنحل في جامعة إكستر البريطانية والذي كان يُدفَع له من قبل شركة سينجينتا Syngenta العملاقة في مجال المبيدات الحشرية للقيام بعمل يُظهر أن الموت الملحوظ لمستعمرات النحل حول العالم لا علاقة له بهذه المبيدات. وكذلك شركة كوكاكولا والتي كانت قد موّلت دراسات علمية تدّعي أن سبب السمنة لا يكمن في السُعرات الحرارية، بل يعود إلى نقص الرياضة. هذا، بالإضافة إلى ما عُرف عن أساتذة كليات الطب الممولين من قبل الشركات الدوائية من ميل إلى التهوين من آثار الأضرار الجانبية للأدوية عند مناقشتها في قاعات الدرس. وأخيراً، ففي عام 2010، أظهر البرنامج الوثائقي “مهمة داخلية” Inside Job أن كثيراً من الاقتصاديين – الذين يدرسون في الجامعات وينشرون أبحاثاً «علمية» ويبذلون النصيحة بصفتهم أعضاء في لجان مؤسسية – كانوا في الوقت ذاته أعضاءً في مجالس إدارة شركات مالية أو صناعية.
ينتقل دونو إلى صورة أخرى من صور سيطرة التفاهة على الميدان الأكاديمي، وهي انفصال الفكر الإنساني عن البعد الروحي والإنساني مستندًا إلى أطروحات الفيلسوف الألماني جورج سيميل في مقالته “مأساة الثقافة”. فالفكر الإنساني، كما يصوره، قد تحوّل إلى نشاط تافه خالٍ من المعنى حين انفصل عن بعده الروحي والإبداعي، وصار مجرد إنتاج آلي يخدم النظام الاقتصادي والمؤسسات العلمية بدل من أن يخدم الحقيقة والإنسان، فصار لدينا تراكم هائل للمعرفة يقابله عجز متزايد عن الفهم والمعنى.
يوضح دونو أن التفكير يغدو تافهًا عندما يتحول البحث إلى غاية في ذاته لا إلى وسيلة لاكتشاف الذات والعالم. فحين يصبح الفكر وظيفةً مهنية بدل من أن يكون رسالة إنسانية، يغدو مجرد تكرار ميكانيكي بلا روح. وهنا يذكر رؤية سيميل بأن الفكر، حين يُسخّر لخدمة الاقتصاد، يجسّد في واقعه عيوب المؤسسة التي تحتضنه، إذ يبدأ في تقليد منطق السوق في السرعة والكمّ والمنافسة والربح، فيُنتج المعرفة لا لأنها ضرورية، بل لأنها مطلوبة في دورة الإنتاج.
ومع هذا التسارع المفرط، تفقد المعرفة السيطرة على ذاتها، فيغدو الفكر الحديث أشبه بآلة ضخمة تواصل إنتاجها لمجرد أنها قادرة على الإنتاج. ومع تضخّم هذا الكمّ المعرفي، يفقد العقل قدرته على الفهم، ويغرق الباحث في فيض من المعلومات والمراجع حتى يشعر بالعجز. فبدل من أن يضيف فكرًا جديدًا، يصبح مجرد رقم آخر في سلسلة الإنتاج الأكاديمي، يعمل ليبقى داخل المنظومة لا ليغيّرها أو يحسنها.
ومن هنا تحولت المعرفة إلى منتج، والباحث إلى عامل إنتاج وأصبح العقل مثقلاً بكمٍّ هائل من المعلومات أغلق أمامه طريق التأمل.
وهنا يبين دونو أنه ضمن اقتصاد كهذا، فإن الجامعة ما عادت اليوم تبيع نتائج أبحاثها، وإنما تبيع علامتها التجارية، تلك العلامة brand التي تختم بها التقارير والتي تمتلك حقوقها التجارية.
يذهب آلان دونو لمظهر آخر من مظاهر سيطرة التفاهة على الميدان الأكاديمي فيتحدث عن أسلوب الكتابة الذي يهيمن اليوم على مجال البحث العلمي. هذا الأسلوب الذي يوصف بأنه “الأسلوب العلمي” ينبغي أن يكون محايداً وموضوعياً، ومملاً نوعاً ما – كما يصفه دونو- وأن يدور دائماً حول المنطقة الوسطى، هذا الأسلوب الذي يعتني باختيار ألفاظ توحي بأن أفكار الباحث ليس لها أية علاقة بالزمان والمكان، مع تجنب الكلمات المشحونة بالعاطفة، فعلى سبيل المثال يكون من الأفضل ألا نناقش “الطبقة” class، وإنما نحلّل “الفئات الاجتماعية” social categories. كما ينبغي أن يكون الأسلوب ذو نبرة معيارية بمعنى أن نفكر بمشكلات متعلقة بما ينبغي أن يكون العالم عليه، مركزين على أفكار مجرّدة حول المعايير، العدالة، أو الأخلاقيات الاتصالية، بدلاً من وضع أسس للتفكير المفاهيمي أو السياقي حول ما آل إليه العالم.
هذا بالإضافة إلى شيوع إضفاء طابع الغموض على الكتابة الأكاديمية مع كثرة استخدام ألفاظ من قبيل “إلى حد ما”، “إلى درجة ما”، “على ما يبدو”، “جزئياً”، وكأن على الأكاديمي دائماً أن يتخذ مسافة شخصية من عبارات هو ليس مستعداً لدعمها. وهنا يشير دونو إلى حقيقة أن الكتابة متصلة بالفكر لكن الأكاديميون أصبحوا يهملون هذه الحقيقة.
ثم يذهب دونو بنا إلى مساحة أخرى من مساحات إحكام أذرع التفاهة قبضتها على المجال الأكاديمي، وذلك برسم صورة قاتمة للحياة الجامعية المعاصرة، يكشف من خلالها عن طبيعتها التعسفية وانحرافها عن رسالتها الأصلية بوصفها فضاءً للمعرفة والبحث الحر. ويذكر في ذلك وصف الباحثة ريفير (Rivière) للمشهد الجامعي المعاصر من الداخل بوصفه ميدانًا تتصارع فيه الأنا المتضخمة والمصالح الشخصية، حيث تدور خصومات خفية بين الأساتذة تُدار بالوكالة عبر الطلبة، وتُبنى العلاقات الأكاديمية على المراوغة الخطابية والتظاهر بالعمق أكثر من السعي إلى الحقيقة. وفي هذا العالم الأكاديمي المغلق، تسود العزلة، والتكبّر، هذا فضلاً عن إثقال كاهل الأساتذة والباحثين بأعمال إدارية رتيبة لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية. غير أنّ الأزمة لا تقتصر على البنية النفسية للعلاقات الإنسانية داخل الجامعة، بل تمتد إلى الواقع المادي للعمل الأكاديمي، حيث يعاني حملة الدكتوراه من بطالةٍ مرتفعةٍ، فيتحول التعليم العالي إلى نظام إنتاج فائض من العقول لا يجد لها موضعًا في البنية الجامعية نفسها.
ويستدعي دونو هنا مقارنة أفونسو بين العالم الأكاديمي وعصابات تجارة المخدرات في مقاله المنشور عام 2013 تحت عنوان “كيف تشبه الأكاديميا عصابة المخدرات”. ففي نظره، تقوم الأكاديميا على تراتبية صارمة شبيهة بتلك التي تسود العصابات: فالقادة الكبار – من شاغلي الكراسي الجامعية ومديري المؤسسات – يجمعون الثروة والمكانة، بينما يتكدّس في أسفل الهرم جيشٌ من المحاضرين المؤقتين وطلبة الدراسات العليا الذين يتقاضون أجورًا متدنية ويعيشون في هشاشة مهنية دائمة. وكما في تجارة المخدرات، فإن الدافع الحقيقي للبقاء في اللعبة الأكاديمية ليس الدخل الحالي، بل أمل الثراء الرمزي والمستقبلي؛ أي حلم الحصول على منصب دائم أو اعتراف علمي. هذا الأمل – رغم ندرة تحققه – يكفي لضمان استمرار تدفّق المرشحين، إذ يتشبثون به كما يتشبث بائع المخدرات الصغير بحلم أن يصبح زعيمًا يومًا ما. ويشبه دونو هذه الحالة عموماً بلعبة يعرف الجميع قواعدها دون أن يصرح بذلك أحد.
ثم يختم آلان دونو الفصل بالحديث عن مهنة التدريس وأنها تنتمي إلى مجال التحرر والانعتاق مشيراً بذلك إلى خطورة حالة الخضوع التي تعيشها المؤسسات الأكاديمية والعاملين فيها لقواعد السوق العالمي واعتبارها ترساً في آلة الرأسمالية الضخمة.
الفصل الثاني
التجارة والتمويل
يسلط آلان دونو الضوء في هذا الفصل على كيفية هيمنة التفاهة على الميدان الاقتصادي.
وفي هذا الإطار يبدأ دونو بمناقشة فكرة الغموض التي باتت تحيط بعالم التجارة والاقتصاد وأثر ذلك على المجتمع. فيبدأ بالحديث عن عالم البورصات والمضاربات المالية الذي أصبح أسيراً لأنظمة حاسوبية تتحكم بها خوارزميات لا يعلم عنها الجمهور شيئاً. وفي هذا الإطار يقوم دونو بتصوير مشهد معقد من عالم الاقتصاد الحديث، حيث تتحول الأسواق المالية إلى ساحة حرب رقمية تتقاتل فيها الخوارزميات في صراع دائم على المكاسب اللحظية بحيث لا يتعامل المتداولون بوصفهم أفراداً يملكون رؤية اقتصادية، بل كمبرمجين.
يصف آلان دونو هذا المشهد بأنه تجلٍّ للداروينية الجديدة، حيث البقاء للأسرع والأمهر في المناورة، لا للأصلح في المعنى الاقتصادي الحقيقي. فالخوارزميات لا تنتج قيمة فعلية للمجتمع، وإنما تخدع بعضها البعض ضمن سباق إلكتروني لا هدف له سوى اقتناص أجزاء من الثانية، وهي الفترة التي تكفي لتحقيق مكاسب ضخمة أو خسائر فادحة. هذه الدينامية المحمومة تولّد بطبيعتها أزماتٍ مالية متكررة، تجعل الأسواق تنهار بشكل غير متوقع، وتترك الأفراد في حالة من الذهول والعجز أمام سرعة الأحداث التي تتجاوز قدرتهم العقلية على الفهم أو التحليل.
وبناءاً على ذلك ينتقل آلان دونو ليبين كيف أصبح الاقتصاد المعاصر آلية لإنتاج الغباء الجماعي، لا منظومةً لتنظيم الثروة أو تحقيق العدالة، موضحاً أننا فقدنا القدرة على التفكير في “الاقتصاد” بوصفه شأنًا جمعيًّا، لأنّه غدا بنية مغلقة على نفسها، تحجب الفهم بدل أن تيسّره. فحين نتعامل مع أرقام كبرى مثل الناتج المحلي الإجمالي أو مؤشرات خلق الوظائف، نصبح عاجزين عن التفكير النقدي. ومن هنا يعيد دونو قراءة الشعار السياسي الشهير في حملة بيل كلينتون “إنه الاقتصاد، أيها الغبي”، ليقلبه على وجهه الآخر قائلاً: “إنه الاقتصاد الغبي”، في إشارة إلى أن النظام الاقتصادي نفسه هو ما يُنتج الغباء ويشلّ عقولنا عن إدراك المسائل الحقيقية التي تمسّ حياتنا.
يذهب آلان دونو بعد ذلك إلى الاقتصاد الرأسمالي المهيمن حالياً وتجليات وحشيته على أًصعدة مختلفة، مبيناً أنه نظام اقتصادي يخدم مصالح الأقلية الغنية، ويفتح المجال أمام الفساد السياسي ونهب الثروات العامة، خصوصًا في الأسواق “الناشئة”.
يحلل دونو في هذا الصدد التحوّل الجذري الذي أحدثه المال في الثقافة الحديثة، فقد أصبح المال، في نظر دونو، أكثر من مجرد وسيلة لتبادل السلع أو تنظيم النشاط الاقتصادي، إذ فرض نفسه كمبدأ ثقافي شامل لقياس القيمة، حتى بات الناس ينظرون إلى الأشياء لا من حيث جوهرها أو معناها الإنساني، بل من خلال قيمتها النقدية. فالنقود صارت الأداة التي تُحدَّد بها “القيمة المتوسطة” لكل شيء، وأصبحت العلامة التي تتوسط كل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومع مرور الوقت، تُنسى القيم الحقيقية، ويغدو المال القيمة المطلقة الوحيدة، فتختلط الوسيلة بالغاية، ويُستبدل المضمون بالرمز، ويؤدي هذا الانقلاب في الوعي الى جعْل النقود النقطة المرجعية العامة التي تنحدر إليها جميع القيم والمعاني، حتى تفقد تميزها وتتحول إلى مجرد متوسطات اعتيادية ومحايدة. وهكذا يُختزل الوجود الإنساني في حسابات مالية خالية من الروح، وتُختزل الحياة في سلسلة من المقارنات الكمية التي تُخفي وراءها فراغاً أخلاقياً وثقافياً عميقاً. فالمال، الذي بدأ وسيلة عملية لتيسير التبادل، انتهى إلى أن يصبح إله العصر الحديث، ومصدر التفاهة الكبرى التي تُحوّل القيم إلى أرقام، والمعاني إلى أسعار، والإنسان إلى كائن يعبد الوسيلة وينسى الغاية. وهنا يظهر الجشع والطمع والتبذير والانحلال الأخلاقي.
ولعل أبرز تجليات الجشع قد تظهر في ممارسات الاستعمار الاقتصادي الذي تقوم به الدول الكبرى في دول الجنوب، فعلى سبيل المثال نجد أن الاقتصادات الأفريقية – رغم غناها بالموارد – تظل عاجزة عن بناء دورة إنتاجية داخلية بسبب تبعيتها للقوى الأجنبية. ونتيجة لذلك، لا ينتج عن دوران المال داخل القارة سوى حركة مالية شكلية لا تولّد قيمة حقيقية مرتبطة بالإنتاج المحلي، بل تظل موارد القارة المنهوبة رهينة النظام الرأسمالي الغربي الذي يستغلها. وبهذا الشكل، يؤدي هذا النمط من الاستعمار الاقتصادي المقنَّع إلى إضعاف روح المبادرة والإنتاج داخل المجتمعات الأفريقية، وهذه نتيجةً مرجوة تسعى إليها القوى المهيمنة للحفاظ على تبعية القارة واستمرار نفوذها فيها. ليس هذا فقط، بل يتصدى دونو لبيان وجه آخر من وجوه الهيمنة الغربية على دول الجنوب وهو ما يأتي في صورة التنمية والمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل على ذلك حيث يبين أنها مجرّد واجهة شكلية تُخفي وراءها فراغاً مؤسسياً عميقاً. فالمساعدات والمشروعات التي تنفذها المنظمات الدولية والشركات الخاصة لا تُحدث تنمية حقيقية، بل تحقّق تحسينات جزئية ومبعثرة لا ترتبط برؤية شاملة أو بنية تحتية مستدامة، ولا تستند إلى منظومة قيمية متماسكة، ومن ثم يصبح الخطاب التنموي مجرد أداة من أدوات إدامة التفاهة، فبدلاً من بناء مؤسسات حقيقية أو مجتمع فاعل، يتم تكريس حالة من التشتت والفوضى التي تُخفي عجز الدولة وتحوّل التنمية إلى استعراضٍ إداريٍّ بلا مضمون، حيث يغيب المعنى وتُستبدل القيم بالبروباغندا والتمويل المشروط.
وفي هذا السياق يفضح دونو أسطورة الخداع الجماعي القائمة على نظرية “التقاطر إلى الأسفل”، التي تزعم أن ازدياد ثراء الأغنياء سينعكس تلقائيًا على الفقراء، مبيناً أن الواقع يقول إن الأغنياء يزدادون غنى ويكدسون الثروات والفقراء في المقابل يزدادون فقراً.
يذهب بنا دونو إلى بُعد آخر من أبعاد تفشي التفاهة في مجال الاقتصاد، حيث يهاجم مفهوم “الحوكمة”، المفهوم الذي يفترض أن يربط بين مصلحة الشركات الخاصة والمصلحة العامة، لكنه في الواقع كثيرًا ما يُستخدَم لتجميل صورة المؤسسات المالية والتجارية، بينما تبقى ممارسات الفساد والاستغلال قائمة. وهنا يبين دونو أن من يسمون “الخبراء التكنوقراطيين” الذين يظهرون كمنقذين اقتصاديين لهم دور كبير في تبييض فساد أصحاب الشركات الكبرى وشرعنة ممارساتهم.
ومن خلال هذا النقد، يريد دونو أن يبيّن أن الاقتصاد تحوّل إلى نظام سيطرة وإيديولوجيا تفاهة، تُعيد صياغة القيم الاجتماعية وفق منطق الربح وحده. فصار المال معيار الذكاء، والطمع يُكافأ بوصفه نجاحًا، والمواطن يُختزل في كونه مستهلكًا لا يفكر. إن الاقتصاد الحديث، كما يصوره دونو، هو أخطر تجليات نظام التفاهة، لأنه يجعل الإنسان يعبد الأرقام، وينسى أن ما يُسمّى “النمو” قد يكون في جوهره نزعًا منظمًا لإنسانية البشر.
الفصل الثالث
الثقافة والحضارة
يستهل دونو هذا الفصل الذي يتصدى فيها لصور هيمنة التفاهة على المجال الثقافي، بتسليط الضوء على أزمة المتاجرة بالقيم والأخلاق من قبل طبقة الأثرياء، وذلك عندما يتدخل المال كوسيط في عملية الفعل الأخلاقي. ويذكر في هذا السياق أساليب مختلفة لاستخدام المال في هذا الصدد، فعلى صعيد نجد المال يقوم أحياناً بتحديد الفعل الأخلاقي من عدمه حتى يصبح نفس الفعل أخلاقياً في حق الأثرياء وغير أخلاقي في حق غيرهم. وعلى صعيد آخر يتم استخدام المال لشراء ضمائر الناس فيتم إسكات البعض بالمال وموافقة البعض على فسادهم بسبب المال، وهذا كله ضمن استعراض كبير للقوة المالية التي يملكها الرأسماليون المتحكمون في مفاصل الاقتصاد.
ينتقل دونو بعد ذلك للحديث عن المستوى الثقافي المتدني الذي آلت إليه هذه الطبقة من أصحاب السلطة وأصحاب الأموال الضخمة والتي تعرف بـ “النخب”، وتأثير ذلك على الجماهير، فيبين كيف أنّ حياة هؤلاء الأثرياء والمشاهير، رغم ما تبدو عليه من بريق ورفاه، ليست سوى انعكاس للثقافة التي أنتجها السوق ووسائل الإعلام، لا ثمرة إبداع أو ذوق خاص. فالنخبة المعاصرة، كما يشير هانس ماجنس إنتزنسبرجر، فقدت منذ زمن قدرتها على إنتاج ثقافة متميزة، بل لم تعد تشعر بحاجة إلى ذلك، إذ أصبحت تعيش داخل الصور والأوهام التي تصنعها بنفسها. لقد غدت هذه الفئة تمثّل أدوارها بجدّية ساذجة؛ تشاهد نفسها في الأفلام التي أنتجتها، وتصدق الأكاذيب التي روّجتها حين تراها منشورة في صحفها. إنها صورة ساخرة لطبقة أسيرة لعالم التسلية والتمثيل، انفصلت عن الواقع حتى أصبحت تعيش داخل فقاعة من الوهم والفراغ، في ظل مأساة ثقافية تنعكس في مشهد استعراضي فارغ من الجوهر.
ونتيجة لما سبق يغوص دونو قليلا في بيان ما آل إليه دور الفن والثقافة في عالمنا المعاصر، فيشير إلى التحوّل الخطير الذي طرأ على دور كلٍ من الفن والثقافة، حيث لم تعد الأعمال الفنية تُنتَج بروح إبداعية حرة، بل ضمن نظام إنتاج صناعي رأسمالي يخضع لمعايير السوق.
ففي “عصر إعادة الإنتاج التقني للأعمال الفنية” لم يعد الراعي أو الممول (sponsor) يدعم الفنان أو المدرسة الفنية بدافع تقدير الفن أو الجمال، بل صار يدعم منتجاً تجارياً تابعاً لصناعة ضخمة متشابكة مع قطاعات الاقتصاد الكبرى، مثل الإعلام، الإعلان، والموضة، أي أن الفن أصبح سلعة تُنتج وتُسوّق مثل أي منتج استهلاكي آخر.
وهكذا صارت القرارات الاقتصادية والاستهلاكية هي التي تحدد شكل الإبداع، فخطوط الإنتاج الفني تشبه خطوط التجميع الصناعي، وما يُنتَج هو ما يُتوقَّع أن يستهلكه الناس. هذه الفكرة سبق أن أكدها أدورنو وهوركهايمر في كتابهما “جدل التنوير”، حيث بيّنا أن ما يسمى بـ “صناعة الثقافة” يخلق تجانساً واسعاً في الأذواق والمعاني، فلا يكاد شيء ينجو من هذا القالب الموحد.
حتى الأعمال التي تبدو “مختلفة” أو “متمردة” على الذوق السائد، ليست في الحقيقة خروجاً حقيقياً عن النظام، بل اختلاف محسوب يهدف إلى إرضاء فئة صغيرة من المستهلكين “المميزين”، دون أن يهدد بنية النظام الثقافي والاقتصادي العام. فالمساحة الصغيرة من الحرية والاختلاف ما هي إلا وسيلة لإثبات أن النظام متنوع ومرن، بينما هو في جوهره موحّد ومتحكم فيه.
وهنا ينتقل دونو إلى تحليل رؤية هربرت ماركيوز، الذي يرى أن المشهد الثقافي في المجتمع الرأسمالي الحديث يعمل كجهاز رمزي رسمي، يوجه وعي الأفراد نحو قبول النظام القائم ودعمه. فالفن والإعلام والإعلانات كلها تُسخّر لتوجيه الطاقات الإنسانية والخيال والرغبة في اتجاه يخدم البنية الاجتماعية والسياسية السائدة، لا لتحدّيها أو تجاوزها.
حتى الدوافع العاطفية والرغبات العميقة لدى الناس، يجري تشفيرها وإعادة إنتاجها من خلال القوالب النمطية المتكررة في الأفلام والأغاني والإعلانات، بحيث يتمّ ضبط الوجدان الجمعي وتوجيهه.
وفي النهاية، يوضح دونو أن هذه النظرة – رغم كونها حادة ومتشائمة – تعبّر بدقة عن المنطق الذي يتعامل به المستثمرون مع الفن اليوم: فالفنان بالنسبة لهم ليس إلا “عاملًا مؤجرًا”، عليه أن يستسلم لقوانين السوق وأن ينتج ما يطلبه رأس المال، لا ما يفرضه ضميره الفني أو رؤيته الجمالية.
ينتقل دونو إلى مشهد نقدي حيث يبين كيف تم تفريغ الفن من مضمونه الأخلاقي والسياسي وتحويله إلى أداة لإدارة المشاعر وتلميع صورة السلطة. ففي هذا الإطار يرى دونو أن الفنان، أصبح مثل الخبير، يمكن تجنيده بسهولة في خدمة النظام خلال الأزمات. فالخبير يبرّر الكارثة ويجعلها تبدو أمراً طبيعياً ومنطقياً، بينما يُستدعى الفنان ليكون “بجوار سرير الضحية”؛ أي ليؤدي دور المسكّن الاجتماعي، فيحوِّل الحدث من واقعة سياسية مليئة بالمسؤوليات والمساءلات إلى مناسبة عاطفية تُدار بالموسيقى والحفلات والابتسامات. وهكذا، يُنزَع الطابع السياسي عن الكارثة، وتُدار مشاعر الناس بطريقة مضبوطة تمنع بروز الوعي النقدي أو الغضب الجماعي.
يضرب دونو مثالاً بكارثة لاك- ميغانتيك في كيبك سنة 2013، حين انفجر قطار محمّل بالنفط الخام فقتل سبعةً وأربعين شخصاً ودمّر وسط المدينة. ورغم وضوح مسؤولية الشركات الجشعة والسلطات المهملة، فإن المجتمع لم يواجه النظام بالاتهام أو المساءلة، بل تمّت إعادة توجيه الانتباه عبر الفنّانين الذين دُعوا لإقامة حفلات ومهرجانات “لدعم الضحايا”، وهي في حقيقتها كانت غطاءً لتبييض وجه الشركات والسلطات. لقد تم تحويل المأساة إلى حدث استهلاكي وإعلامي، حيث صارت منطقة الكارثة مادة لمجلات التسلية، واختُزل كل شئ في “المشاعر الطيبة” و”الإنسانية العامة”، بينما غابت الحقيقة والمسؤولية. وهكذا تحول الفن إلى أداة لضبط الانفعالات الجماعية، وإلى وسيلة لتزيين الكارثة لا لمواجهتها.
على صعيد آخر يذهب آلان دونو إلى مكون ثقافي آخر وهو “الإعلام” حيث يحاول معالجة علاقة الإنسان المعاصر بالإعلام، خصوصاً التلفاز، بوصفه أداة تفصل الإنسان عن الواقع بدل أن تقرّبه منه.
فالتلفاز، كما يبين دونو يقوم بتفكيك البنية الجمعية للمجتمع: فبدلاً من أن يجمع الأفراد في تجربة حقيقية مشتركة، يجعلهم يشاهدون الشيء نفسه في الوقت نفسه لكن دون أي تفاعل إنساني حقيقي. فالتلفاز يعيد تشكيل وعينا بما يخدم النظام التجاري والتافه، ويخلق مجتمعاً من المتفرجين المنعزلين ويُحوِّل الواقع إلى عرضٍ دائم، يُستهلك بسرعة ويُنسى بمجرد انتهاء البث.
الفصل الرابع
ثورة إنهاء ما يضر بالصالح العام
يتناول آلان دونو في هذا الفصل مناقشة مسألة العجز الفكري في مواجهة نظام عالمي متماسك، يهيمن على إنتاج المعرفة وتوجيهها بما يخدم مصالح السلطة والرأسمالية، بحيث لم تعد المعرفة وسيلة للتحرر أو الفهم، من هنا يرى دونو ضرورة العمل على التحرر من سطوة هذا النظام العالمي والتفكير في مواقف وأفكار تحررنا من التفاهة وتفتح طريقاً جديداً حتى وإن كان محاط بعلامات الاستفهام.
خاتمة
وفي خاتمة الكتاب قدّم ألان دونو تحليلاً عميقًا لما يسميه “سياسة الوسط المتطرّف”، وهو نموذج سياسي يبدو في ظاهره معتدلاً وعقلانياً، لكنه في جوهره يمثل أعلى درجات الهيمنة والتفاهة. فـ”الوسط” هنا ليس مساحة وسطية بين أطراف مختلفة، بل هو خطاب يفرض نفسه باعتباره الخيار الوحيد الممكن، ويُقصي كل بديل تحت ذريعة الواقعية والعلمية، ويلغي ضمنياً التباين التقليدي بين اليسار واليمين، وخلف هذا القناع تختبئ مصالح الشركات الكبرى والبنوك والبيروقراطيات، الذين يقدمون أنفسهم كحياديين بينما يرسّخون أيديولوجيا السوق والربحية.
ويُبرز دونو الدور الحاسم للخبراء والبيروقراطيات في ترسيخ هذا الوضع، إذ يتولون إعادة إنتاج النموذج السائد بوصفه النموذج العقلاني الوحيد. أما وسائل الإعلام فتلعب دورًا تكميليًا عبر هندسة رأي عام “معتدل” يتبنّى من دون وعي هذا الإجماع التقني، من خلال تجزئة الأخبار وصناعة الخوف وتقديم الوسط المتطرف كخيار طبيعي لا بديل له.
ونتيجة لهذا بدأ الخيال السياسي يختفي وبدأت الصراعات الاجتماعية تتحول إلى نزاعات تقنية خالية من المعنى. وفي هذا السياق تستغل الشركات الكبرى هذا الفراغ لتوسيع نفوذها عبر تمويل البحوث، والتحكم في الإعلام، وشراء النخب، وصياغة السياسات الاقتصادية. وبهذا تصبح “المصلحة العامة” مرادفة لمصالح السوق، ويتحوّل المواطنون إلى مستهلكين، والجامعة إلى مؤسسة لإنتاج الكفاءات التقنية، والثقافة إلى سلعة، والدولة إلى خادم مطيع لرأس المال.
وفي خضم هذا كله يظهر السياسي الحديث شخصيةً بلا شجاعة: يتجنب المبادرة، يخشى اتخاذ المواقف، يختبئ خلف اللجان والتقارير. هكذا تتحول السياسة إلى ما يشبه الجهاز الإداري الضخم الذي يعمل بكفاءة عالية، ولكن بلا روح وبلا رؤية وبلا مسؤولية.
يخلص دونو إلى أن الوسط المتطرف يمثل النسخة المكتملة من نظام التفاهة: نظام يقتل التنوع، ويحتكر العقلانية، ويفرض رؤية واحدة على المجتمع، ويمنع التفكير خارج الإطار.
ومع ذلك فإن آلان دونو يؤكد على أن الخروج من هذا النفق ممكن إذا استعاد الناس القيم الأخلاقية الحاكمة للاجتماع الإنساني، وأعادوا بناء الفضاء العام كمساحة حرة للمدافعة بين الأفكار، ودعموا المبادرات المجتمعية، وكسروا احتكار الخبراء للتفكير، وأعادوا للخيال السياسي مكانته الأساسية.
عرض:
أ. يارا عبد الجواد
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies