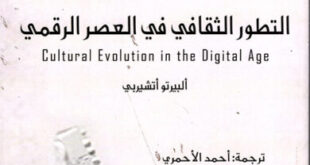العنوان: قصور الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي.
المؤلف: وائل حلاق.
ترجمة: عمرو عثمان.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: بيروت.
الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
تاريخ النشر: 2019.
الوصف المادي: 430 ص.، 24 سم.
الترقيم الدولي الموحد: 3-181-431-614-978.
إذا كان الفهم العام يتعامل مع الاستشراق باعتباره خطابا هداما صور العالم الإسلامي بصورة سلبية مهدت للسيطرة عليه وإخضاعه للكولونيالية. فإن هذا الكتاب يذهب إلى أن هذه القراءة للاستشراق بحاجة إلى مزيد من التعمق، وذلك بالغوص في الأبعاد البنيوية المتعلقة بأصول المعرفة الحداثية التي أنتجتها أوروبا في سياق ما يطلق عليه عصر التنوير وفرضتها على العالم كله، وذلك من أجل فهم الطريقة التي أصبحنا ننظر بها إلى العالم؛ ويحدد من خلالها كل فرد هويته، فالهدف الأساسي للكتاب هو أن نعرف ونفهم ما حدث لنا، وماهية التغيرات التي طرأت علينا، وكيف أصبحنا حداثيين رغم أنوفنا.
ففرضية حلاق الأساسية هى أن الحداثة كامنة خلف كل ما وصلنا إليه، لهذا يركز حلاق في كتابه هذا على الحداثة بنفس القدر الذي يتناول به الاستشراق، فهو يرى انه لا يوجد جانب واحد من القضايا التي يثيرها الاستشراق لا يتعلق بالحداثة، ففي كل أشكال الاستعمار والإبادة الجماعية يظهر الاستشراق كعرض، فيما ظل أصل الداء كامنا في الحداثة نفسها.
ونظرا لكون أشهر من كتب عن الاستشراق وأسس للوعي العام يشأنه، مع إهمال واضح للعلاقة بينه وبين الحداثة، هو إدوارد سعيد في كتابه الهام “الاستشراق،” يتناول حلاق هذا المؤلف بنقد مطول على صفحات كتابه. إذ يذهب حلاق إلى أن النقد الإجمالي للاستشراق أدى بسعيد إلى الفشل في الانتباه لبعض المستشرقين “البريئين من تهمة التحيز” وهو ما يعتبر ورطة نظرية من الدرجة الأولى. كما كان لعرض سعيد المتجذر في الليبرالية أثر قوي في تزويد حقل الاستشراق بلقاحات سمحت بإعادة تحصينه دون المساس بنزعاته التقليدية، فضلاً عن أن الصلات التي أوجدها سعيد بين الاستشراق والثقافة المحيطة به ظلت سياسية في طبيعتها بالمعنى البدائي والتقليدي، مع بعض الإشارات الشكلية للمصالح الاقتصادية والمادية، ولكن بدون رؤية شاملة وبنيويه لدور الأكاديميا الليبرالية والحداثية في المشروع الاستشراقي.
المقدمة
تتلخص أطروحة هذا الكتاب في أن مصطلح الاستشراق قد أسئ فهمه بشدة حتى أصبح وصف باحث ما بأنه مستشرق نوعا من الإدانة، حيث تم تسييس المصطلح وأفرغ من معناه الحقيقي، ومن ثم ظل محصورا في التحزب الثقافي والكولونيالية والسيطرة الإمبريالية، ومقيداً بإطار سياسي صارم لا يتجاوز نطاق توازنات القوى بين الدول، فيما تم عزله عن بنى الفكر التحتية التي أنتجته في المقام الأول.
يرى حلاق ان تناول الاستشراق بهذه الكيفية قد تجاهل بعداً بنيوياً أهم وأعمق، فالبدء بالسياسة والإنتهاء بها كما فعل إدوارد سعيد أدى إلى إغفال المقدمات التي يمكن من خلالها نقد مفهوم السياسي نفسه، فأي نقد سياسي صحيح للاستشراق لابد أن يبدأ بـ”الأسس” التي خلقت تصوراً معيناً للطبيعة والليبرالية والعلمانية والرأسمالية والدولة الحديثة، ولأمور كثيرة طورتها الحداثة كمفاهيم مركزية في مشروعها. من هنا يشير حلاق إلى أن (سعيد) قد قدم نقداً سياسياً بالمعنى التقليدي والسطحي، ولم يسائل أياً من أنماط الفكر والحركة التي خلقت مشكلة الاستشراق، لتظل إشكاليات الحداثة المركزية بمنأى عن التمحيص، وهو ما خلف لنا تفسيراً بسيطاً سطحياً لتلك الإشكاليات، فظلت أعمال سعيد تجابه العدو الآني وليس العدو الرئيسي. يحاول حلاق أن يقدم طرحاً بديلاً وذلك من أجل استكشاف الأفكار والأسس التي نظر إليها سعيد بالكاد من بعيد، أو لم يدركها أصلاً.
الفصل الأول: وضع الاستشراق في مكانه
تتمثل الفكرة الرئيسية التي يعرض لها حلاق في هذا الفصل في أن الاستشراق هو أكثر من مجرد بناء معزول، فهو نسق متصل بهيكل أكبر يحدد له طبيعته وهدفه، ويقصد بذلك المشروع الحداثي وفلسفته التنويرية. وبناء على ذلك يسعى حلاق إلى تسكين الاستشراق في إطار منظومة المشروع الحداثي، دون أن يركز اهتمامه فقط على كتابات آحاد المستشرقين كما فعل (سعيد) الذي ركز على أعمال آحاد المؤلفين التي اعتقد إنها يمكن أن تكشف عن فحوى هذا البناء المصمت. لخص حلاق ثغرات هذه الاقتراب من دراسة الاستشراق في النقاط التالية:
- ضبابية التسلسل التاريخي والإمتداد الجغرافي الذي وظفه سعيد في تناول النشاط الخطابي الاستشراقي، فهو لا يشرح الفارق بين الوجود الرسمي للاستشراق وبداية قصته، خاصة أن هاتين الظاهرتين يفصل بينهما أكثر من 1500 عام، كما انه لا يوضح الفروق الجوهرية بين مستشرق وآخر من حيث الزمان والمكان، فهو يعتبر أن كل من تناول الشرق مستشرق متورط في تزييف صورة الشرق، ولم يوضح الاختلافات النوعية بين المستشرقين في هذا الصدد.
- أغفل سعيد الفارق بين “نظرية المؤلف” و”نظرية النماذج،” ففيما تبنى وجهة النظر التي تذهب إلى أن لكل كاتب بصمة محددة في كتاباته (مخالفا بذلك نظرية المؤلف عند فوكو الذي اعتبر المؤلف بمعنى من المعاني جزءا من خطاب القوة السائد)، وأنه بدون هذه البصمة تصبح كل الكتابات مجرد نصوص مجهولة الهوية، إلا أنه لم يقدم مثالا ولو لكاتب واحد تركت أعماله بصمة محددة، ولم يسمح لهم أبداً بأي مساحة نصية تظهر فيها بصمتهم بصورة حقيقية.
- على الرغم من إيمانه بنظرية البصمة الخاصة، اعتقد سعيد أن كل المستشرقين يقعون داخل حدود التراث الاستشراقي الذي ينتمي في اعتقاده لفكرة محددة (نموذج) تتجاوز التاريخ. وبناء عليه اعتبر سعيد أن كل من كتب عن الشرق صار مستشرقاً. إن الاعتراف بالبصمة المحددة، وفقا لحلاق، كان يتطلب من سعيد نظرة قادرة على تفسير الاختلافات والاستثناءات، وقادرة على التمييز بين نظرية المؤلف (أو على الأقل استيعاب ما كتبه فوكو عنها)، ونظرية النماذج.
من جانبه يعتقد حلاق أن تقييم الاستشراق لا يتوقف على مظهره “الخطابي” باعتباره إيجابياً أو سلبياً في موقفه من الشرق، ولكنه يتوقف على مقدار تعلقه ببنية فكرية معينة، من هنا اقترح حلاق النظر للواقع الإنساني بوصفه مكوناً من بنى تحكمها “نماذج معرفية،” تتمايز بدورها بين نماذج/نطاقات مركزية وأخرى هامشية، تدلنا العلاقات بينهما على موقع المؤلف داخل أحد النطاقات، وتزودنا بأسلوب منطقي يمكن من خلاله المقارنة بين مستشرق وآخر. هذا ويمكن لنظرية النماذج أن تساعد التحليل في:
- تحديد موقع المؤلف في المنظومة الخطابية الأوسع وموقع هذه المنظومة في إطار أنظمة القوة الأشمل.
- توفير أسلوب يمكن من خلاله المقارنة بين ظاهرتين مختلفتين تاريخياً وثقافياً.
- يمنع هذا المنهج في تناول النطاقات النماذجية المختلفة زمانياً ومكانياً القياسات الفاسدة والمقارنات غير المتوازنة، كأن تتم مقارنة بين شئ ثانوي ينتمي لنطاق هامشي أو حتى استثناء في نطاق مركزي بسمة أساسية طاغية في هذا النطاق أو بأخرى منتمية إلى نموذج مركزي مغاير وليكن في ثقافة أخرى.
من ناحية أخرى يذهب حلاق إلى أن الفهم الصحيح للخطاب الاستشراقي يتطلب فهماً خاصاً للـنظرية “الأدائية” التي عرض لها “جون أستن،” والتي تشير إلى أن قيمة القضايا أو العبارات لا تتعلق فقط باجتيازها لاختبار الصدق/الكذب، وإنما تتعلق بالأفعال التي تؤديها والوقائع التي تخلقها والسياقات/الظروف التي تنطق في إطارها. ومن هنا يرى حلاق أن القوة الأدائية للخطاب الاستشراقي لا تتعلق بكونه صادقا أو كاذبا، منطبقا على الشرق أو مفتريا عليه، وإنما تتحقق بشروط الملاءمة، ويقصد بذلك الملاءمة اللغوية التي تعيد وصل الخطاب الاستشراقي ببنى الحداثة الأوسع التي تجاهلها سعيد. فما قام به سعيد من تركيز تام على النص باعتباره بناء منغلقاً على ذاته أدى إلى تزييف الصورة في الواقع وتزييف الظاهرة التي قام بدراستها، فلو كان سعيد استخدم مفهوم الأدائية لكان ربما تمكن من رد الاستشراق لحقيقة الحداثة والواقع الحداثي الذي أرسى بنى فكرية عميقة وأحدث حالة من السيادة المعرفية والكولونيالية وأشكالا مختلفة من الإبادة، فالخطاب الاستشراقي “أدى” أفعالا و”خلق” واقعا ماديا على الأرض، ولكنه لم يكن له أن “يؤدي” ذلك من دون وجود الظروف الملائمة، التي أكسبته القوة على خلق هذا الواقع. هذه الظروف الملائمة كانت ظروفا حداثية بامتياز.
الفصل الثاني: المعرفة والقوة والسيادة الكولونيالية
في هذا الفصل يشرح حلاق فكرته ان الاستشراق هو نموذج مصغر من “البنية الحداثية،” فوفقا له لا يوجد استشراق ما قبل حداثي، ولا يوجد مستشرقون قبل ميلاد الحداثة، وهي الفكرة التي لم يتناولها سعيد، لذا يسعى حلاق في هذا الفصل إلى التركيز على البنية الحداثية وشرح “أدائية” الخطاب الاستشراقي (وفق المعنى الذي تم تناوله في الفصل الأول) في المكان الذي أريد للاستشراق أن يؤثر فيه والوجهة التي انتشر فيها، وذلك من أجل تقييم وتحديد الاستشراق بصورة صحيحة، وفي سياق أكثر انضباطا من ذلك الذي طرح فيه سعيد فكرته حول الاستشراق حين تصوره ظاهرة ممتدة زمانا ومكانا.
في هذا السياق يؤكد حلاق على أن الأدوات التي ينتجها نطاق مركزي ما لا يمكنها المساهمة في إعادة تشكيل هذا النطاق. قد تقوم هذه الأدوات بأدوار إصلاحية أو تحسينية، ولكن لا يمكن أن تقوم بوظائف تتعارض مع النطاق نفسه، ومن هنا فإن أي نقد للحداثة (يخرج من رحم الحداثة نفسها كنطاق مركزي) قد يستطيع مراجعة أحد أبعادها، ولكنه يظل مع ذلك نقداً حداثياً، يحصن خطاب الحداثة الأيدلوجي، ويسبغ الشرعية على الوضع القائم.
يشير حلاق إلى أن نظرة سعيد للاستشراق كانت نظرة حداثية بالمعنى المعرفي، تصويرية وصفية بالمعنى الإجرائي. حيث ظل الاستشراق عنده مرهوناً برصد مواقف الكتاب وانتماءاتهم السياسية والأثنية والقومية والدينية، كما ظل استشراقا مسيساً؛ حيث افترض سعيد انه نتاج لقوى وأنشطة سياسية بالأساس، وتم فرضه على الشرق عندما كان في موقف أضعف من الغرب. ويجد حلاق أن هذا التفسير لا يتجاوز التمظهرات الخطابية وتوازن القوة في العلاقات الدولية، كما انه لا يظهر الكولونيالية كوحدة تحليل، ولا يبرز أفكارا أخرى على درجة كبيرة من الأهمية مثل الإبادة الجماعية، والهندسة الاجتماعية، واستباحة الثقافات المحلية. ولا يجيب على سؤال: إذا كان الاستشراق بالأساس علاقة قوة فلماذا لم يظهر في الشرق، عندما كانت أوروبا تحت تهديد الفتوحات الإسلامية، ولماذا لم يظهر فى أماكن أخرى (الصين مثلاً) عندما كانت في أوج قوتها وكانت تقيم ترادفا بين الاختلاف الثقافي وبين الهمجية وغياب الرقي من جهة أخرى.
من هنا يطرح حلاق تساؤلا مبدئيا حول لماذا الاستشراق أصلاً؟ وما السبب في وجود هذه الظاهرة، وما يرتبط بها من كوكبة ضخمة من باحثين وكتب ومؤسسات تعليمية ومنح دراسية، لقد تغافل سعيد — كما يرى حلاق — عن العديد من المفارقات التاريخية التي تحمل دلالات مهمة وتمايزات كيفية (معاكسة لأطروحته)، وهو ما انتهى به إلى تقديم فهما مشوشا لنطاق الاستشراق ومعناه النوعي وموقعه العضوي في الثقافة الغربية الحديثة وتفاعلاته الداخلية وارتباطاته الاكاديمية الخارجية، وقاده إلى طرح تشخيص جزئي وغير دقيق، فهو في تناوله لمفهوم الاستشراق يمكن وصفه بالليبرالي الذي لم يستطع أن ينظر للعالم بمعزل عن القيم الليبرالية، مهما بلغت درجة نقده لهذه القيم، فما أنتج الاستشراق هو بنية حداثية عميقة قابعة في الفكر الذي لم يستطع سعيد نفسه أن يتخلص منه، وهو بصدد نقد أحد مفرزاته.
وفي محاولته دحض أطروحة سعيد يقدم حلاق دراسة لحالة الحضارة الإسلامية، التي كان ينبغي وفقا لسعيد أن تفرز شيئا مشابها للاستشراق وهي في حال قوتها، ولكنها لم تفعل، ولم تفعل أي حضارة أخرى باستثناء أوروبا، وذلك للدفع بأطروحة أخرى إلى الصدارة مفادها أن فرادة أوروبا واستثنائيتها هي التي أنتجت الاستشراق.
وفي إطار دراسة الحالة التي يقترحها حلاق، يؤكد أن الثقافات الإسلامية حددتها أخلاقيات معينة (أي مجموعة معينة من الرؤي عن العالم سعت إلى تشكيل نمط معين من الذوات)، فعلى الرغم من التنوع الشديد في الثقافات الإسلامية الإثنية والسكانية والجغرافية والمادية والاقتصادية (وهو التنوع الذي يغري البعض بالقول بعدم وجود إسلام واحد يمكن أن يستهدفه الاستشراق بالتفكيك)، فإن ثمة نطاقات فرعية تعبر هذا التنوع، يترجمها الاشتراك في الأنشطة التعليمية، والمؤسسات الاجتماعية، وأشكال الحكم ذاتها. وكانت الشريعة هي النطاق المركزي الذي قومت على أساسه كافة هذه النطاقات الفرعية، وحددت إجاباتها حلول هذه النطاقات بدرجة كبيرة.
كان التعليم والمتعلمون في إطار النطاق المركزي الإسلامي، متنوعي التخصصات، على عكس العلم الحديث الذي يؤمن بالتخصصية وفصل حقول المعرفة عن بعضها (وهو ما أدى في عصر الحداثة إلى الدعوة للتخصصات البينية)، هذه العلاقة الوثيقة بين فروع العلوم الإسلامية الكلاسيكية لم تكن مجرد أمر شكلي بل استندت إلى قاعدة قوامها محورية المبادئ الأخلاقية، أي ربط التفكير المجرد (في العلوم) بأنماط السلوك الأخلاقي، كما سعى النطاق المركزي للشريعة إلى تفصيل الطرق التي تحض على السعي نحو الحياة الأخلاقية والروحية.
اعتمدت آلية التعليم بأكملها على التواصل الفكري والروحي بين الشيخ وتلاميذه، فلم يكن الشيخ مجرد عالم نظري بل نموذجاً أخلاقياً للعيش في هذا العالم، وكان النص المؤسس في كل المعارف الإسلامية هو القرآن، فبعد عملية جمع القرآن بدأ علماء الإسلام في التعمق في لغة القرآن لينتجوا في كل حقول العلم بما فيها العلوم الطبيعية.
وعلى الرغم من اختلاف فروع العلم في الإسلام إلا انها ارتبطت ببعضها بطريقة يمكن أن نصفها بالبنية المتماسكة التي قامت على التلاقح المستمر، وكانت الشريعة والتصوف أهم تلك العلوم التي تغلغلت في كل الأنشطة، فنظمت الشريعة المجتمع بطريقة تشبه القوانين، ونظّم التصوف الحياة الروحية للمجتمعات الإسلامية، وحددت بنية التعليم الإسلامي أولويات وضعتها الشريعة من علوم بلاغة ولغة ومنطق، أما الرياضيات والفلك — أسس العلم الأوروبي الحديث، فقد تطورا أيضاً بدافع من الشريعة، فمثلت الشريعة التعليم الأساسي لكل عالم أيا ما كان تخصصه، وكانت هي والتصوف نماذج مركزية وخطابات أدائية ومعايير أخلاقية تحكم على الواقع وتمارس ضغطاً عليه.
على جانب آخر، أظهرت دراسة الحالة الإسلامية — وفقا لحلاق — أنه لا يمكن لنظام تربوي فكري يتكون من جوهر أخلاقي ويتأسس على مبادئ أخلاقية أن يكون مفيداً للسياسة، خاصة وأن هذه المبادئ تعلو على إرادة القوى السياسية، وتوصل حلاق بعد دراسة النموذج الإسلامي إلى أن هناك أنواعاً من المعرفة تتناقض جوهرياً مع توظيف القوة، بينما ارتبطت المعرفة بالقوة في الدولة الغربية الحديثة، وذلك لسببين:
- نشأة الدولة الحديثة التي طورت أنماطاً من الحكم وجدت في أشكال بدائية تحت أنظمة سلطوية ملكية وتحت الكنيسة الكاثوليكية.
- مبدأ السيطرة على الطبيعة، والفصل بين الواقع والقيمة، وبين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.
لقد كان الباحثون والأكاديميون في الحضارة الأوروبية خاضعين لإرادة الدولة السيادية، حيث ظهرت الجامعة والأكاديميا باعتبارها مؤسسات تابعة للدولة، فلوائحها التنظيمية الداخلية تخضع لقانون الدولة، كما أنها تمول من جانب الدولة، وهو ما جعلها ترتبط بشروط سياسية تلتزم بوضعية الدولة، وتفكر في العالم من خلال الدولة، وتساهم في إدارة الدولة من خلال ما تنتجه من أبحاث. فما أنتجته الأكاديميا من مستشرقين هو نتيجة لكونها بنى تعليم مدجنة؛ تعمل من خلال شرطين: السيادة على الطبيعة والإنسان، ونشأة الدولة الحديثة وإدارتها، وهي البنية التي أخرجت لنا المستشرقين.
لم يعرف العالم الإسلامي مفهوم السيادة السياسية الحداثي قبل المواجهة مع الكولونيالية الأوروبية الحديثة، كانت شريعة الإسلام هي المحدد لمعنى السيادة، وكانت الشريعة عصية على المناورات السياسية، ولم تخضع للسلطة، وكان هذا نتاج جهد فقهاء خرجوا من المجتمع نفسه والتحقوا بدراسة الشريعة بناء على رغبتهم العلمية، فلم تكن هناك سلطة واحدة تحدد مضمون الشريعة، وإنما فُعّلت الشريعة على كل المؤسسات الإنسانية، إلى أن ظهر مفهوم “الدولة” في العالم الإسلامي من خلال مجموعة من الإصلاحات التي غيرت قوانين التعليم والإدارة، ووضعت فكرة نشأة الدولة موضع التطبيق كما حدث في الإمبراطورية العثمانية، فحلت المحاكم والمدارس والمؤسسات الأوروبية الحديثة محل كل الجوانب التي شغلتها الشريعة وما ارتبط بها من مؤسسات، ولم تكن مجرد عملية استبدال أو علمنة بل خلق “إنسان جديد” يرى العالم من منظور الدولة الحديثة، وأخذت ثقافة الشريعة في الذبول، وفي هذا دليل على اشتراك الباحثين والمستشرقين الممنهج والبنيوي في إعادة خلق العالم الاسلامي.
ثم طال الاستشراق الشريعة نفسها، فظهر النظام القانوني الحديث، وتم استبعاد الفقهاء ليحل محلهم رجال القانون الدارسين على الطريقة الفرنسية والبريطانية، وبذلك تحولت الشريعة الإسلامية لقانون دولة، وأعيد تشكيل الشريعة لتصبح نسخة من القانون الإنجليزي، فتفتت البنى الاجتماعية الأولى للأمة ليعاد تشكيلها على نظم حكم جديدة ومؤسسات دولة حديثة، لتقوم “القومية” التي هي أوروبية بالأساس بإعادة إنتاج سائر العالم من جديد وإلباسه ثوباً جديداً.
إن الصورة التي قدمها سعيد للاستشراق — وفقاً لحلاق — هي صورة مقلوبة، فلم تكن قوة الكولونيالية الدافعة هي البوارج الحربية أو الإدارة البيروقراطية، ولكن كانت “بنية الفكر” هي التي جعلت هذه الأمور ممكنة، فالتركيز على القوة العسكرية وقدرتها التدميرية يصرفنا عن الأصل، كما أن التركيز على فكرة أن النصوص الاستشراقية قد هدفت إلى تزييف صورة الشرق والإساءة له كما يعتقد سعيد هو بمثابة الزعم بأن الغرب اخترع القوة العسكرية المدمرة ثم تصادف استخدامه لها في غزو الشرق عسكرياً، ومثل هذا التحليل لا يقدم لنا شيئاً جديداً، فالمهم هو معرفة الغرض الذي اخترعت من أجله الأسلحة الحديثة والمنظومة الفكرية التي شكلت عقول المخترعين لها والعلاقة بين هذه المنظومة الفكرية واختراع الأسلحة والعلاقة بين المدفع والبوارج الحربية والنص الاستشراقي المزيف لصورة الشرق، فلو أن القوة السياسية والكولونيالية هي من دعمت النص الاستشراقي فكيف انقلب الوضع ليدعم النص نفسه تلك القوة القاتلة؟
الفصل الثالث: المؤلف الهدام
يتناول حلاق في هذا الفصل إشكالية “التعميم” عند إدوارد سعيد والتي هددت التماسك النظري والرؤية التحليلية لديه، وذلك من أجل الكشف عن تعقد ظاهرة الاستشراق فى علاقتها بفكرة النطاقات، فهناك مستشرقون ينتمون للنطاق المركزي للحداثة، وآخرون لا ينتمون له بنفس الدرجة، ومن هنا فإنه يمكن العثور فى داخل الاستشراق نفسه على خطابات ناقدة بنيوياً للكولونيالية، وهو نقد أكثر فائدة من نقد سعيد لأنه (نقد) يستمد قوته من اتصاله بقلب النطاق المركزي دون الوقوع في أسره، من هنا يرى حلاق أن “الإدانة المطلقة” لكل المستشرقين تؤدي إلى صعوبة نظرية كبرى، تقود لنتائج معاكسة لتصورنا للقوة ولفهمنا للحداثة ولاحتمالات الفكاك من قبضتها المهيمنة.
يؤكد حلاق على أنه كان لأوروبا مستشرقون مقيمون في البلاد التي خضعت للكولونيالية الأوروبية، وكان هناك فرقة كبيرة من المستشرقين المساندين لهم في أوروبا نفسها، اشتركوا جميعاً في إنتاج منظومة خطابية غذت ثقافة الغزو والسيطرة السيادية الأوروبية. وقد وفرت كل هذه الأمور ظروف الملاءمة المطلوبة ليصبح الاستشراق سلاحا إضافيا في عدوان أوروبا على كل بلد آخر. وحتى عندما لم يهدف هذا العدوان إلى القضاء على الضحية بشكل نهائي فإنه كان يهدف إلى إعادة ترتيب الوجود والواقع.
ويرى حلاق أن الطرح الذي قدمه سعيد لا يعبر عن الاستشراق بصورة متسقة، إذ انه يقع في إثم الاختزال، فوفقا لسعيد كان ثمة اتهام جاهز بالاستشراق لكل من يكتب أي شئ عن الشرق، حتى الكتابة عن مجد الشرق الحضاري تصبح — لدى سعيد — مجرد تعبير عن افتتان ناتج عن اختزال الشرق في صورة الشئ الغريب الخرافي، كان هذا بالنسبة لسعيد تزييفا للصورة بنفس قدر التصوير السلبي للشرق، وهو كما نرى تعميم جارف مازال رائجا بين الكثيرين، فسعيد وأتباعه لم يحددوا الشروط اللازمة للتمييز بين مستشرق ينتمي لنطاق نموذجي مركزي وآخر لا ينتمي إليه.
يرى سعيد أن أوروبا نظرت للشرق نظرة مبهمة حيث اعتبرته مختلفاً، فالشرق يقع في مرتبة أدنى من الغرب كما انه بدائي وخرافي، ويوسع سعيد تعريفه للاختلاف ليشمل سمات إيجابية مثل روحانية الشرق. يذهب حلاق إلى أن اعتراض سعيد على فكرة الاختلاف بين الشرق والغرب قد قام على اعتباره الغرب مقياساً، فالقيم العلمانية والديمقراطية والنموذج الثقافي العام للغرب حاضرة بشدة في تفكير سعيد لدرجة أن أي زعم بتميز الشرق لا يمكن بالنسبة إليه أن يتضمن عدم النظر للغرب بوصفه نموذجا، فسعيد يتخذ الحداثة الغربية معياراً ويعتبر إنجازاتها نموذجا حصريا، في الوقت الذي يدين فيه الاستشراق (على الرغم من أنه أحد المنتجات الحصرية للحداثة الغربية)، كما أن (سعيد) لم بحاول التعمق للوصول إلى مصادر الاختلاف وهو ما جعل تصوره عن الاختلاف أحادي البعد.
يسعى حلاق إلى تجاوز مشكلة التعميم الجارف التي وقع فيها سعيد من خلال تنقيح “نظرية المؤلف” عبر دراسة ما قدمه المستشرق الفرنسي رينيه جينون الذي انتقد الغرب الحديث في كثير من كتاباته التي تميزت بالعمق ودافع عنها مجموعة من الكتاب والمفكرين. كان لجينون قدرة على تأطير النقاشات الدائرة عن الاستشراق والحداثة وتجاوز خطاب سعيد الليبرالي العلماني. حيث استطاع أن يرصد النتائج السلبية للحداثة ووضع خطة إصلاح لها، فقدم تحليلا كليا للاستشراق في ضوء المجموعة الكبيرة من العلاقات التي أحاطت به وأنتجته وتأثرت هي نفسها بإنتاجه وأسلوب عمله. من هنا فإن تحليل جينون للاستشراق — وفقا لحلاق — لم يتجاوز نقد سعيد في قدرته التحليلية للمعرفة الاستشراقية والغربية وأصولهما فقط بل إنه يقدم عمقا في التشخيص ويفتح آفاقاً في المستقبل، بشكل يجعله قادراً على رصد وتفسير البنى العميقة للاستشراق وعلاقته الوثيقة بالحداثة، في الوقت الذي اقتصر فيه نقد سعيد على “المستوى السياسي التقليدي” ولم يكن قادراً على تقديم تحليل متعمق للاتجاهات التي أدت إلى نشأة الاستشراق في أوروبا.
لقد افترض جينون ان الاستشراق يزيف صورة الشرق ليس لارتباطه بمراكز القوى السياسية والكولونيالية فى الغرب كما يفترض سعيد، بل لأنه يتجذر في “نظام” يفهم العالم ويعيش فيه بشكل معين، هذا الشكل هو ببساطة مجرد تشويه للواقع وللوجود معاً. لأنه نظام يعتنق عقيدة التقدم المستمر، ويرفض الثبات بكافة أنواعه، حتى لو كان ثبات المباديء، ويرفض “المنظومات الأخلاقية” التي يمكن أن تستقى منها معايير الثبات ومبادئه. لقد رفض الاستشراق الشرق، لأنه تضمن “عنصر ثبات” تمثل فى مباديء وقيم معينة، تصورها الاستشراق على أنها عناصر جمود وتخلف ورجعية.
ومن خلال المقارنة التي عقدها حلاق بين سعيد وجينون انطلق إلى “نظرية المؤلف” عند فوكو والتي تصنف المؤلفين إلى نوعين هما المؤلف الطيع؛ وهو الذي يخضع لنظام القوة ولتشكلاتها الخطابية دون أن يعي ذلك، وهو الصنف الذي ينتمي إليه غالبية المؤلفين، والمؤلف الخطابي؛ وهو الذي يحدد الحدود العامة للتشكل الخطابي دون القدرة على التحكم في الطريقة التي تستخدم بها أعماله. ويوفر هذا المؤلف للنطاقات المركزية الأدوات الأيديولوجية التي تمكنها من تعريف نفسها وإضفاء شرعية عليها. ولم يكتف حلاق بعرض “نظرية المؤلف” عند فوكو وإنما قدم تصنفين آخرين —للتمييز بين المستشرقين بشكل أكثر وضوحاً — وهما المؤلف المعارض والمؤلف الناقض، بالنسبة للمؤلف المعارض فهو الذي يرفض الافتراضات والنتائج والآراء الموروثة التي تميز المؤلف الطيع، فهو ينتقد المؤلفين الآخرين حول تفاصيل معينة، ولكن دون أن يتجاوز نقده التشكل الخطابي الذي يعمل به المؤلف، فهو لا يسائل الأركان الأساسية للنظام أو البنى المعرفية التي تحدد النظرة الكونية، فهو يبقي على كل هذه الأصول والبنى المعرفية في مكانها ويقبل بها كما هى، أما ما يتم فحصه ونقده فهو النمط الذي يعمل في إطاره النظام ويقع فيه التحليل وتتحدد في إطاره القضايا المنهجية، وهو ما يعتبر تصحيحا للنظام من داخل النظام، فالمؤلف المعارض يبقي على حياة المنظومة الخطابية وفعاليتها ويقوم بتصحيح النظام ويمنحه مزيداً من الدعم، فتغيير النظام من الداخل يجعله أقوى وأكثر مرونة وحيوية، وهو الصنف الذي ينتمي إليه سعيد ففي تناوله للاستشراق كان قد كشف عن مشكلة الإنسانيات بصور قوية، وهو ما أدى إلى تخريج جيل جديد من الباحثين المدربين على تحسين مناهج دراسة الشرق ليصبح محتوى هذه الدراسات أكثر ضبطاً، ولكن لم يسائل سعيد أياً من دعائم ذلك النظام، حيث اعتقد في سلامة البنية الكلية للنظام.
أما النوع الآخر وهو المؤلف الناقض فهو الذي يسائل الافتراضات الأساسية والدعائم المعرفية للتشكل الخطابي، فضلاً عن نظام القوة الذي يدعمه، وذلك من أجل تغيير أسس النظام، وخلق نظام جديد مختلف بالكامل، وهو الصنف الذي ينتمي إليه جينون، حيث إنه كشف عن كون مشكلة الاستشراق جزءاً من مشكلة الحضارة الغربية، وعن ارتباطه بكل فروع الأكاديميا، ولكن افتقر طرحه لبيان آليات عمل الاستشراق الداخلية والترابطات العضوية والبنيوية بين الاستشراق وبيئته المعرفية والسياسية والثقافية الني نشأ فيها.
يزعم حلاق أن عرض سعيد للاستشراق بوصفه استثناء هو قضية إشكالية، يرجعها حلاق إلى قناعات سعيد الأيديولوجية؛ حيث ظل وفياً لنظام القوة الذي عمل في إطاره، بينما لم يصل تحليل جينون — من وجهة نظر حلاق — إلى الغاية القصوى لإمكاناته، ويرجع ذلك إلى أن جينون لم يشهد بنفسه القوى التدميرية للقرن العشرين، والتي دفعت مفكرين كباراً إلى إعادة تقييم أفكارهم المسبقة.
الفصل الرابع: السيادة المعرفية والإبادة البنيوية
في هذا الفصل يناقش حلاق الطرح القائل بأن كل الفروع الأكاديمية التي تنتمي للنطاق المركزي الحداثي — الفلسفة والاقتصاد وإدارة الأعمال … إلخ — أكثر تورطاً من الاستشراق في مشروع السيطرة والهيمنة نفسه، فهذه الفروع تضطلع بعملية تقسيم للنشاط المعرفي بهدف خلق معرفة وممارسة سياديتين. ويؤكد حلاق مدى ضآلة تأثير الاستشراق بالمقارنة مع الأثر العام لباقي التخصصات الأكاديمية، غير أن الطريق للشرق قد أوجد الاستشراق باعتباره أوضح الجسور وأكثرها استقامة لتحقيق الهدف، فالتخصصات الأكاديمية لا تساهم في تأسيس بنية فكرية استعمارية فقط، بل تتجذر في بيئة أوسع من العلل الاجتماعية العامة، فتخصصات النطاق المركزي الأكاديمية مرتبطة بنيويا بمشروع الحداثة الغربية الكولونيالي المنتشر في سائر العالم. وينهي حلاق طرحه بالربط بين الكولونيالية والإبادة الجماعية، وهي العلاقة نفسها التي تربط بين المعرفة/السلطة بتنوعها الأكاديمي والإبادة الجماعية.
في هذا السياق يوضح حلاق الفارق بين سعيد وجينون في كيفية عرض كل منهما للاستشراق داخل نطاق الإنسانيات بصورة عامة، فجينون يرى عالم الأكاديميا الحديثة بأكمله جزءاً من تشكلات أوروبا الخطابية التي تساهم في إنتاج نظرة معينة للعالم، كما اعتبر كل المعارف نتاج للتربة الحضارية الخصبة التي ظهرت فيها هذه المعارف، فالاستشراق هو أحد المجالات العلمية التي عكست مواقف الغرب ودراسته للشرق، من هنا تفرغ جينون لدراسته لأنه اعتبره حقلاً مهماً وبمثابة جسر يمكن للغرب من خلاله أن يتعلم شيئاً من الشرق ويستعيد المبادئ التي فقدتها أوروبا، أما سعيد فقد ركز على الاستشراق تحديداً لأنه افترض نقص كفاءته الفكرية وتخلفه بالمقارنة بالأكاديميا والعلوم الإنسانية، فلم يستخدم سعيد مهاراته النقدية في أي شئ يتجاوز الاستشراق ولم يلق الضوء على أزمات الحداثة، لاعتقاده بأن الشرق لا يمتلك أي شئ ذي قيمة، وعليه فقد تعامل سعيد مع الاستشراق كليبرالي علماني.
من جانبه، يؤكد حلاق أن الاستشراق لا يختلف عن أي حقل أكاديمي آخر، فقد أصبح خطاب عصر التنوير الفلسفي قوة فاعلة في تشكيل الأطروحات وطرق التحليل والنظرة الكلية للعالم، وقد استطاعت هذه المنظومة الخطابية إقصاء كل الرؤى المنافسة من النطاق المركزي، وارتبط العلم بالفلسفة بصورة جدلية، داعماً وضعيتها وماديتها، وفي الوقت ذاته استقى من خطابها المنمق شرعيته، فالعلم هو الذي أنتج الوسائل التي دمرت البيئة، كما أنه أنتج الكولونيالية وأسلحة الدمار الشامل، وقد اتُهم العلم بإحداث ذلك الدمار من دون أن يتساءل أحد عن أصوله وتاريخه، وفي إطار ذلك يسرد حلاق العديد من الأمثلة التي تؤكد على الروابط البنيوية المباشرة بين التخصصات الاكاديمية والاستشراق على كافة المستويات وخاصة على الصعيد الاقتصادي، وما قدمته هذه التخصصات للكولونيالية من تبريرات ربحية مادية على حساب التدمير البيئي واستغلال العمالة دون النظر للبعد الفلسفي الأخلاقي.
يحاول حلاق هنا أن يقدم تصنيفاً عاماً للأكاديميا يفرق فيه بين النطاقات المركزية والهامشية، فلا يمكن استعراض كافة أقسام الجامعة بوصفها جزءا من جدلية القوة، ولكن تسمح نظرية النطاقات المركزية والهامشية بتصنيف هذه الأقسام لتضم النطاقات المركزية (الأحياء والطب والفيزياء والكيمياء والفلسفة) وتضم النطاقات الهامشية (الأديان والآداب والفنون والموسيقى)، وكأن منطق هذا التصنيف هو أن النطاقات المركزية تتطلب دعم التشكلات الخطابية التي تشرعن وتحدد بنى قوة هذه النطاقات ومجالاتها، أما الفنون والموسيقى والأدب فليست مرتبطة بمجالات قوة النطاقات المركزية وبنيتها، كما أن طبيعتها الجمالية والفنية تجعلها تناقض أحادية فكر النطاقات المركزية، مما يجعل هذه المجالات حبيسة النطاقات الهامشية، فلا يمكن إخضاع بلد للكولونيالية من خلال الموسيقى والفنون المرئية والأدب، مهما كانت الفائدة التي تجنيها الكولونيالية من هذه المجالات، فالرأسمالية والعلم وفروعهما أثبتت كفايتها لفرض الكولونيالية على أغلب مناطق العالم بنهاية القرن التاسع عشر.
ترتبط الكولونيالية بنيوياً بالتشكلات الخطابية لثقافتها الأصلية وخاصة المؤسسات الأكاديمية وتخصصاتها الخاصة بالنطاق المركزي، واتساقاً مع سردية حلاق فإن الكولونيالية بطبيعتها إبادية، وهو ما جعل البني الأكاديمية والشركاتية مرتبطة بعدد كبير من الأمراض الاجتماعية، ومن ذلك أن الأكاديميا الخاصة بالنطاق المركزي، وليس الاستشراق فقط، تهدف إلى وضع أسس خطابية ومادية للإبادة الكولونيالية، ونستخلص من هذا أن هناك علاقة منطقية ووجودية بين الأكاديميا الخاصة بالنطاق المركزي والكولونيالية من جهة، وبين الكولونيالية والإبادة من جهة أخرى كما هو الحال مع الاستشراق.
هذا وتكشف لنا العلاقة بين الكولونيالية والإبادة عن أبعاد إيجابية وسلبية لظاهرة الإبادة، فسلبياً تسعى الإبادة لتصفية مجتمعات أصحاب الأرض، أما إيجابياً فهي تؤسس مجتمعاً كولونيالياً جديداً على الأرض المصادرة عبر إعادة التشكيل الاجتماعي وممارسة مجموعة من السياسات والممارسات التي تهدف إلى الدمج الثقافي، ولكل هذه السياسات سمات الكولونيالية الاستيطانية، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة كتابة تاريخ الكولونيالية والحداثة وذلك باعتبارهم مشروع حداثي يسعى إلى إعادة تشكيل الفرد، وهو الهدف النهائي للكولونيالية في شكلها الإستيطاني وفي استشراقها وعلمانيتها واقتصادها.
يخلص حلاق في النهاية إلى أن السمة الإبادية للكولونيالية ترتبط ببنية فكر شكلتها الأكاديميا الحديثة والتشكلات الخطابية المنبثقة عنها، ويلعب الاستشراق في هذه الصورة دوراً مهماً وإن لم يكن الدور الأهم، ودلل حلاق على ذلك بالحالة الإسرائيلية. ولو أن (سعيد) كان قد بدأ بهذه العلامة الدلالية المتجذرة في التشكلات الخطابية الراسخة، وفي نظم القوة التي تنبع من فهم للعالم بوصفه مادة يمكن الاستغناء عنها وتطويعها حسب الرغبة، لبدأ مشروعه في مكان آخر، ولأنهاه بتحليل للمشروع الحديث بوصفه سيادة إبادية/سيادة معرفية، ولأدرك أن سوء التمثيل وتزييف الصورة ليس إلا أداة ضمن مجموعة أدوات توظفها الحداثة.
الفصل الخامس: إعادة صوغ الاستشراق وإعادة صوغ الفرد
يؤكد حلاق في هذا الفصل أن تحويل الاستشراق بوصفه نموذجاً من المعرفة الأكاديمية المتخصصة إلى مجال للبحث المتسم بالإنسانية أمر ممكن الحدوث، ولكن بشرط أن ينفض الاستشراق عن نفسه نزعات العلمانية والتمركزية الإنسانوية والقدرة الكولونيالية والمعرفية السيادية، وذلك من خلال إعادة التكوين الأخلاقي، وفي هذا السياق يتناول حلاق المعضلة الفلسفية الليبرالية التي تشير إلى استحالة نجاح أي عمليات لتكوين “الذات الأخلاقية” من داخل إطار الليبرالية. ويستخدم سعيد الاستشراق كمثال يمكن أن يستخدم بفاعلية في وحدات أكاديمية أخرى يشتمل عليها النطاق المركزي، فالهدف هنا هو فتح مجال نقدي لدراسة المدى الكامل للأكاديميا الحديثة دون ترك منفذ لهروب التخصصات الصغيرة التي تقع في النطاق الهامشي لمشاريع الحداثة العنيفة والمدمرة.
إن دراسة أي ظاهرة تتأطر حتماً بنظام الباحث القيمي ومبادئه الثقافية مهما بلغت دعاوي الموضوعية من قوة، لذلك ترتبط المبادئ الأخلاقية التأسيسية — في إطار علاقة جدلية دقيقة — بالاهتمامات العلمية التي تطورت بوصفها منظومة فكرية، وهو ما حدث في مشروع المستشرقين حيث أُخضع الإنتاج الثقافي الإسلامي لمنظومة تأويلية غريبة عنه تتسم بنزعة تحويلية مهيمنة، ليس بدافع من الفضول العلمي، وإنما بهدف إعادة تعريف وتشكيل الطريقة التي يفكر بها المسلمون في أنفسهم وفي العالم، واستكملت كل أشكال الإمبريالية رسالتها الأساسية بنهاية القرن التاسع عشر، بمساعدة المؤسسات الكولونيالية الأداتية، ولم يكن هذا أقصى ما بلغه “الخطاب الاستشراقي” داخل “النص الاستشراقي” الموجه للقارئ العربي بل كانت هناك قوى أكبر من الاستشراق — بوصفه مجالا علميا وفيلولوجيا — تعمل على الأرض، ويعتبر هذا جزءا من الإبادة البنيوية.
لقد تجذرت منظومة التأويل الاستشراقية في تشكل فكرى ومادي أوروبي متفرد وغير مسبوق، وهيمنت علي هذا التشكل أفكار عصر التنوير، التي عكست قيمها تصورا معينا للعقل، وأفكارا محددة وفريدة عن العلمانية والدين والإنسانية والمادية والرأسمالية والأداتية والمشاعر والألم والعنف وغيرها كثير، ورغم أن أفكارا مثل هذه قد وجدت في إطار الشرق الاسلامي وغيره بكل تأكيد، إلا إنها ظهرت فى أوروبا ووظفت لغايات مختلفة، فالمشروع الاستشراقي يختلف جذرياً عن المشروع الإسلامي التاريخي في كثير من جوانبه، فالمشروع الإسلامي اتجه بصفة عامة نحو البناء الذاتي، إذ كان النفسي والأخلاقي والصوفي والشرعي هي أساس هذا المشروع، وفاقت هذه الأمور في أهميتها “المادي،” الذي لم يصبح نموذجيا إلا مع الحداثة.
أما المشروع الاستشراقي فقد كان لبنة أساسية من لبنات البناء الكولونيالي، وجزءاً أساسياً من بناء الحداثة التي أعادت تشكيل قيم الأوروبيين عن أنفسهم وعن العالم، لقد عاش الأوروبيون في تلك الحداثة — التي مثلت العالم الوحيد — باعتبارها نظاماً وجودياً ومعرفياً وثقافياً شاملاً ومستقلاً، فلم يتعلق الاختلاف الأساسي بين المشروعين إذاً بعمليات بناء الذات الثقافية والنفسية، بل بغاية الإنسانية والفرد وموقعهما في هذا العالم.
لقد ظل سعيد وفياً لأفكار عصر التنوير الإنسانوية العلمانية “المتمركزة حول الإنسان،” فيما غض الطرف عن الآثار الحتمية للمشروع الحداثي بصفة عامة والليبرالي بصفة خاصة، وهو ما جعل طرحه محلا للنقد، خاصة مع ظهور العديد من القضايا التي دفعت إلى إعادة تقويم القيم الحداثية والليبرالية، بجانب حالة الإدراك المتنامي بعدم استدامة المشروع الحداثي ونظامه المعرفي، فالوضع العالمي الحرج يستدعي نقداً أعمق للمشروع الاستشراقي، وهو ما لم يكن طرح سعيد كافياً لتوجيهه لهذا الحقل أو لأي حقل علمي آخر.
إن الاستشراق لم يكن مجرد مشروع أكاديمي بل مشروعا للقوة والثقافة مشدوداً بقوة إلى بنية الفكر السيادي، فكان من الطبيعي أن يعمل القائمون عليه داخل الحدود الثقافية التي تطلبتها الحداثة، ولقد ساهم الاستشراق في تشكل هذه الثقافة وتجذرها في المشروع الكولونيالي الذي شمل استغلالاً اقتصادياً وإبادة بنيوية وإخضاعاً للملايين من غير الأوروبيين، هذا العالم هو الذي جعل الاستشراق ممكناً، وهذا العالم هو الذي ازدهر فيه الاستشراق وخدمه. ومع حصول دول العالم الثالث على الاستقلال دخل الاستشراق في مرحلة جديدة “ما بعد الكولونيالية،” ليعيد تفصيل الطرق التي ينظر بها إلى الشرق، وليظهر لدينا مجموعة من الباحثين المنتمين للشرق ولكنهم يعززون الاستشراق بليبراليتهم.
وهنا يشير حلاق إلى إمكانية أن يقدم الاستشراق خطاباً مضاداً يمكنه تسهيل التغيير المطلوب للتعامل مع الأزمات التي يولدها المشروع الحديث، فالاستشراق يحتل موقعاً معرفياً يمكنه من تحقيق هذا الهدف تحديداً بسبب موقعه المهم في الأنظمة المعرفة الحالية وذلك من عدة أوجه:
فأولاً يعد الاستشراق هو المجال الأكثر وضوحاً الذي ينصب اهتمامه على الآخر (الذي يمكنه الآن المشاركة في صوغ الذات الجديدة لنفسه).
ثانياً يمتلك الاستشراق أدوات فيلولوجية متقنة وقدرة على الوصول إلى نصوص الآخر وأرشيفاته والتعامل معها.
ثالثاً يعتبر الاستشراق الحقل الأكاديمي الوحيد في الغرب القادر على التعامل مع تراث الشرق الفلسفي والأخلاقي والقانوني والصوفي والمركب.
فمن أجل أن يتمكن الاستشراق من البقاء كمنظومة بحث عقلاني يجب أن يأخذ في الاعتبار الحاجه الجديدة للنقد الداخلي الذي تتطلبه العقلانية نفسها، ففشل العقلانية الغربية وتمركزيتها الإنسانوية يستدعي مزيداً من التفكير في مصادر توجيه تكمل البحث الغربي — غير المجدي — للخروج من المأزق الحالي، ولا يمكن لهذا الحل أن يكون حلاً حداثياً لمشكلة حداثية، فحل أزمات الحداثة لا يمكن أن يكون حداثياً، كما أن الحل لا يمكن أن يقتصر على تشخيص جزئي محدود مكانياً، وهو تشخيص ناتج عن نظرة حداثية مفككة للواقع، بل يجب أن يغوص في أعماق بنى الحداثة، ويجب أن تخضع قيم النظام الأساسية للبحث بوصفها مجموعة واحدة من المشكلات أو مشكلة كلية، فبنية الفكر يجب أن يعاد التفكير في مجملها.
يمكن للمستشرقين أن يجبروا على تغيير الاتجاه، وتطوير نظرية لدراسة موضوع اهتمامهم، ستفترض هذه النظرية ذاتاً تختلف عن تلك الذات التي أنتجت الاستشراق والحقول الأكاديمية الأخرى على مدار القرنين المنصرمين وسيحول التوجه الجديد — من خلال توظيف التراث الإسلامي بهدف تطوير مشروعات وآليات بناءه — النوايا الفاشلة إلى خطاب فعال أو أدائي، وسيهدف هذا الاستشراق إلى إعادة تشكيل الذات أولاً، مغيراً علاقته بذاته ثم علاقته بالآخر، ويتضمن هذا التوجه فهم الطرق التي يمكن من خلالها للثقافات الشرقية قبل الحداثية أن تقدم مصادر إرشادية لصوغ طرق جديدة للتفكير في العالم وفي العيش فيه.
وهنا يؤكد حلاق على ضرورة دراسة الإسلام والتعامل معه بوصفه مشروعاً عقلانياً، مهما اختلف فهم الإسلام للعقلانية عن طريقة التفكير التي اعتاد عليها العقل الحداثي، ومحاولة الكشف عن المنطق الداخلي لذلك التراث، للتعرف على البعد الإرشادي للإسلام، والذي لا يقل عن أي تراث آخر. وذلك من أجل استدعاء رأس المال الأخلاقي الذي طورته الحضارة الإسلامية على مر القرون لمساءلة الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها حقل الاستشراق.
تفتقر الحداثة إلى هذا الأساس الأخلاقي، ولكنها لا تستشعر افتقادها لهذا المكون، ولا تبحث عنه وذلك وفقا لقاعدة “صعوبة ملاحظة ما لا يتم البحث عنه،” فإذا كان كنه الإنسان ودوره ورسالته أمورا لا يتم البحث عنها أو فيها، يصبح من العسير فى إطار النطاق المركزي الحداثي أن يتم الالتفات إلى من يقدم أجوبة بخصوصها. لقد فقد الإنسان الحديث البوصلة التي تحدد له كنهه ومبتغاه، والأسوأ انه فقد الإحساس بفقدانه لهذه البوصلة، لأنه تم تعليمه ألا يفكر فى هذه الأمور أصلاً، باعتبارها زائدة عن الحاجة، أو حتى بدون أي اعتبار، فهي غير موجودة في دائرة الوعي، وإذا ما طرحت على وجه التساؤل، فإنه يتم استبعادها فورا بوصفها هامشية، وغير ضرورية فى إطار مكونات النطاق المركزي.
المشكلة هنا أن هذه الأمور لا يمكن حتى تعريفها أو الإشارة إليها بأسماء واضحة، فهذه النوعية من المشكلات ليست مشكلات مادية أو بيئية، وإنما تصورية ومعرفية، وأولية إن جاز القول. لقد تم استبعاد هذه الأسئلة مع عملية إزاحة الميتافيزيقا وقتلها، وأصبحت النظرة الميكانيكية للعالم تستبعد هذه المشاكل، ولا تعترف لها أصلا بأنها مشاكل، كما لا تعترف بأي نقد غير حداثي يتم توجيهه لنطاق الحداثة المركزي. ولكن لا مفر — وفقا لحلاق — من الشروع في التناول الأخلاقي لإشكلات الحداثة، بوصف هذا التناول هو الذي يملك التساؤل حول مهمة إعادة تعريف موقع الإنسان، ويملك في الوقت ذاته الاشتباك مع البحث العلمي.
عرض وتقديم
أ. رضوى منتصر الفقي
ماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies