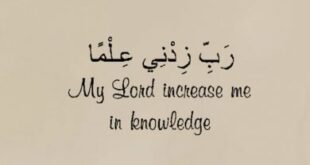إسلامية المعرفة مشروعًا للعلم والإنسان
أ. يارا عبد الجواد*
مقدمة
إن الرؤية الإسلامية المنطلقة من مبدأ توحيد الخالق ومن ثم وحدة الكون ووحدة الإنسانية، جعلت حضارة الإسلام في عصور ازدهارها تعكس سمة العالمية وترسي دعائمها بصورة غير مسبوقة، فالمنهج القرآني من خلال تعرضه لتاريخ الأمم علم البشرية الفصل بين المطلق والنسبي والمشترك والخاص والدائم والمؤقت وفق ميزان دقيق يقوم على استيعاب المطلق والمشترك ويتجاوز النسبي والخاص والمؤقت لتنفتح بذلك خزائن التراث الإنساني أمام بناة الحضارة الإسلامية[1]، وتنشط بذلك الحركة العلمية ويصبح النتاج العلمي لعلماء المسلمين مصدر أساسي تستقي منه الحضارات الأخرى، مرتبطة بجذورها الأصيلة وبمرجعية الوحي دون انغلاق أو تماهي، حتى قدمت العلم في صورته الإنسانية المركبة التي تجمع بين قراءة الوحى وقراءة الكون، وتنظر للإنسان على أنه مركب من جسد وروح، متجاوزة بذلك النظرة الأحادية المادية للكون والإنسان التي هي سمة النموذج المعرفي الغربي، الذي خلف حضارة الإسلام في حمل راية المعرفة بعد أن دخلت في مرحلة الضعف والركود.
من هنا كان تراجع حضارتنا ليس خسارة للمسلمين وحدهم بل خسارة للإنسانية كلها تعاني من ويلاتها حتى اليوم، لتظهر وللإنسان العالم الإسلامي تناشد بضرورة العمل على أسلمة المعرفة حتى نصل مرة أخرى قراءة الكون بقراءة الوحي ونعيد للعلم غائيته لمواجهة الاحتكار الغربي للمعيارية العلمية وادعائه أن نموذجه المعرفي الوضعي المادي هو النموذج العالمي مخلفًا بذلك آثارًا لم تمس المسلمين وحدهم بل البشرية أجمع كما ألقت بظلالها على العلم ذاته، انطلاقًا من هذه الخلفية نسلط الضوء في هذا المقال على خطورة النموذج المعرفي الغربي على العلم والإنسان في مقابل ما يقدمه التأصيل الإسلامي للعلوم (إسلامية المعرفة) للعلم و للإنسان المعاصر انطلاقًا من رؤية الإسلام العالمية.
أولًا: النموذج المعرفي الغربي: أسسه وطبيعته
منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم يعيش العالم تحت وطأة الاحتكار الغربي للعلم، فقد فرضت الحضارة الأوروبية نفسها على العلم منذ ذلك الحين، بحيث أصبح النموذج الغربي المعرفي هو نموذج شعوب الأرض كلها مختارة أو مكرهة، واعية بذلك أو غير واعية، ومن ثم سادت المفاهيم والنظريات الغربية وفي مقدمتها نظرياته في العلم والمعرفة والمناهج العلمية والتفسيرات العلمية، وبذلك هيمن النموذج المعرفي الغربي على كل الرؤى والنماذج المعرفية الأخرى، وقام بتهميشها أو إذابتها أو إخراجها من ميدان المنافسة، ليصبح العلم هو فقط ما يراه النموذج الغربي علمًا، حتى إن منظمة دولية كاليونسكو باتت تعرف العلم “بأنه كل معلوم خضع للحس والتجربة.” في المقابل، تم تنحية أي تعريف آخر للعلم وأي مصادر أخرى للمعرفة بخلاف الحس ليصبح هذا التعريف المادي هو التعريف السائد.
هذا ويصف العلم الغربي نفسه بصفتين أساسيتين هما “الموضوعية” و”العلمية”، ومن خلالهما يسوغ العلم الغربي المعاصر عالميته وينفى الخصوصية عن نموذجه المعرفي ومن ثم يفرض هيمنته على العالم[2]. وقد ولدت العولمة في هذا الإطار، والعولمة باعتبارها فكرة لصيقة بالتمركز الغربي حول الذات والسعي للهيمنة، هي محاولة لدمج العالم في نسق واحد يشمل كل المجالات، حيث لا اعتبار لمسألة الهوية والخصوصية[3].
والعولمة الغربية تعتبر طورا جديدا من اطوار النزعة المركزية الغربية تريد أن تصب العالم داخل القالب الغربي على مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الثقافية، القيمية[4]، ويدخل ضمن ذلك العولمة في مجال العلم والمعرفية التي نحن بصدد الحديث عنها، ونعني بها محاولة تعميم التعريف والمنهجية الغربية للعلم (باعتباره كل ما يمكن اختباره بالحس والتجربة) على سائر الثقافات لتحتكر بذلك معيار الحكم بعلمية أي طرح أو لا علميته في ظل رفض تام للآخر المختلف.
وكما هو معلوم فإن النموذج المعرفي الغربي الحديث يستند إلى مرجعية مادية تؤمن أن مركز الكون كامن فيه وليس متجاوزًا له، وفي إطار هذه المرجعية يتم القفز على ثنائية الخالق والمخلوق، لأن العالم يحوي بداخله ما يكفي لتفسيره ماديا. ومن خلال الدوران في فلك المادة يتم تأسيس المنظومات المعرفية والأخلاقية، وتمحي الفروق الجوهرية بين الإنسان والطبيعة، وبالتالي تدرس الظواهر الإنسانية من خلال القوانين المادية التي تتجاوز بطبيعتها كل الغائيات الإنسانية والدينية، فيعامل الإنسان ككائن طبيعي موجود بشكل كلي داخل النظام الطبيعي، يسري عليه ما يسري على الكائنات الأخرى، ليس له إرادة مستقلة عن القانون الطبيعي وتدريجيا يتم سحبه من عالم الإنسان إلى عالم الأشياء، وبذلك يفقد الإنسان أى صورة من صور القداسة أو التميز.
من ناحية أخرى يحصر النموذج الغربي مصادر المعرفة في الحس والعقل، والعقل يحصره في الإطار المادي أي أنه لا يستطيع تجاوز العالم المادي أو الإستقلال عنه.
وعلى صعيد المنظومات الأخلاقية فإن الرؤية المادية تختفي معها المقدسات والمطلقات والغائيات ليصبح هدف الإنسان من الكون منحصرًا في عملية التراكم المستمر والتحكم، ويصبح هدف العالم منصبًا على تحقيق هيمنة الإنسان الكاملة على الطبيعة، فالإنسان وفقًا لهذا ليس مخلوقًا مكرمًا له وظيفة استخلافية، بل مجرد كائن مادي وبذلك تكون المنظومة المعرفية الغربية التي بدأت بإعلان موت الإله انتهت بإعلان موت الإنسان باسم الطبيعة والحقيقة المادية[5].
ثانيًا: خطورة النموذج المعرفي الغربي على الإنسان والعلم
إن طبيعة النموذج المعرفي الغربي المادية التفكيكية تجعله معاديًا للإنسان، بل ويشكل خطورة على العلم ذاته، ويتجلى ذلك في صور عدة، تبدأ من تغييب الفكر الغربي للبعد الإنساني في العلم ومحاولة تشيئ الإنسان نفسه[6]. فالإنسان هو المخلوق الوحيد في الكون الذي يملك إرادة حرة، ويبحث عن غاية في الكون، ويتبع منظومة أخلاقية تنظم سلوكه، من ثم فإن إخضاع الجوهر الإنساني الذي يتكون من مكون مادي (الجسد) ومكون غير مادي (الروح) بشكل مطلق للقوانين المادية هو تحيز ضد الطبيعة البشرية لصالح طبيعة الأشياء، وينجم عن ذلك إسقاط للأبعاد الأخلاقية والنفسية الإرادية.
من ناحية أخرى يزعم النموذج الغربي كما ذكرنا أنه علمي وموضوعي ومن ثم فهو محايد، إلا أنه يحمل في طياته تحيزًا لكل ما هو مادي وغير إنساني، غير أن المعضلة لا تكمن في كونه متحيزًا وإنما في ادعائه الحياد على الرغم مما يكتنفه من تحيزات تضر بجوهر الإنسان ذاته[7].
وقد تطورت هذه الرؤية المادية الصلبة المعادية للإنسان على نحو متصاعد فظهرت اللاعقلانية المادية التي تنكر وجود مركز للوجود، سواء كان إنسانيًا أم طبيعيًا، ومن أبرز رموز اللاعقلانية المادية فردريك نيتشه الذي أسس فلسفته على أساس من مقولة “موت الإله”، وهذه المقولة تعني نهاية فكرة المركز الكائن خارج المادة، وبهذا تنهار فكرة الكلي المتجاوز، فيصبح العالم أجزاء متناثرة لا يجمعها مركز واحد، ما يتضمن نفي أي إمكانية لوجود رؤية ثابتة، وكذا نفي فكرة العام العالمي والإنساني، وبذلك تتآكل جميع القيم والمثل العليا وتتصدع جميع الضمانات لإمكانية تعقل العالم، وإمكان الوصول للحقيقة، وتضيع في خضم ذلك جميع الهويات، وعلى رأسها هوية الإنسان.
وقد تابع نيتشه في فلسفته “ميشيل فوكو” الذي تبنى مقولة أن التغيرات في أنظمة المعرفة تؤدي إلى “موت الإنسان” كمفهوم مركزي. وأنه بالاحتقار والازدراء يجب أن نواجه كل أولئك الذين مازالوا يتحدثون عن الإنسان وماهيته ويتخذون منه منطلقًا ومعبرًا للوصول إلى المعرفة.
وبعد إعلان فوكو “موت الإنسان” جاء رولان بارت ليعلن “موت المؤلف” حيث يرى أن الأدب النموذجي هو الذي يكون عبارة عن خلخلة دائمة، تهدف إلى زعزعة الذات الفاعلة وتقويضها. ثم جاء جاك دريد ليصل هذه السلسلة من الموت إلى أقصى حدودها فيعلن عن عدم إيمانه بأي شئ فيقول: “لا أؤمن ببساطة بأي شئ: الكتاب، الإنسان أو الله”[8].
من هنا يتبين كيف انتقلت المادية القديمة الصلبة إلى نوع من المادية السائلة، فبعد أن وضعت الأولى ثقتها بالطبيعة المادية كمركز ثابت ونادت بتنحية الدين وتفكيك الإنسان وتشييئه وجعل الطبيعة مركز كل شئ وسبب كل شيء، أصبحت هذه النسخة من المادية عاجزة عن استيعاب وقراءة كل صفحات الكون والإتساق مع طبيعة الجوهر الإنساني ما أدى بها إلى السقوط في وحل العدمية لتنذر بعالم لا هدف فيه ولا مركزولا مرجعية ولا حقيقة ولا معنى.
ولذلك فإن خطورة النموذج المعرفي الغربي تكمن في كونه معاد للإنسان بشكل عام، لما يضمره بداخله من نزعات عدمية تعمل على تصفية الإنسان كظاهرة لها تميزها وخصوصيتها ومركزيتها في الكون، بما يتناقض مع التجربة الإنسانية المتعينة التي لا يمكن انكارها والتي تقوم على استحالة التسوية بين الإنسان واليرقة كما يصور النموذج الغربي، فتسقط بذلك كل الحدود الإنسانية وبالتالي تسقط معها كل الهويات فيتحول العالم المركب الذي يضم الأنا والآخر ويتحرك فيه الإنسان ككائن أخلاقي متحمل لمسؤولية أفعاله بما يملكه من إرادة حرة وقدرة على الاختيار بين الخير والشر إلى عالم لا حدود له يدور في فلك المتع المادية[9].
من هذا المنطلق نفهم خطورة النموذج المعرفي الغربي على العلم بشكل عام والعلوم الإنسانية بشكل خاص، هذا النموذج المتحيز لكل ما هو محسوس ولكل ما يمكن قياسه على حساب غير المحسوس ومالا يمكن قياسه، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض الكثير من الأبعاد اللامحدودة والمركبة والكيفية إلى التجاهل فكل ما لا يمكن قياسه مثل العناصر الغائية والأخلاقية تعتبر أمورًا مهملة في الطرح العلمي الغربي[10].
هذا المبدأ الإختزالي جعل المساحة الإستدلالية الواسعة حبيسة سلطان البحث المادي التجريبي وحده، من هنا نجد مساحات كثيرة يحتاجها الإنسان يعجز العلم الغربي عن مجابهتها والخوض فيها وقد أدى ذلك إلى تضييق مجالات فهم الكون، بل ولي الحقائق أحيانًا وتشويهها، حتى لا تخرج عن نطاق القراءة المادية للكون، ونضرب هنا مثالا لعلماء الأحياء الداروينيين، حيث التزموا القول بأن ما لا نعرف وظيفته من الحمض النوى الصبغي نعتبره من رصيد الحمض “الخردة” الذي هو من مخلفات التطور الأعمى (أى لا وظيفة له). وقد أصروا على القول بذلك، لأن القول بخلافه يطعن في صدق رواية التطور، على الرغم من وصول البحث العلمي اليوم إلى أن قائمة الخردة في تقلص متواصل، وأن عامة الحمض النووي وظيفي وليس عاطلا. وهذه إحدى صور تشويه العلم ليتسق مع الرؤية المادية الضيقة، وهناك العديد من الصور المماثلة من تشويه الحقائق المتعلقة بتفسير أصل الكون، هروبًا من الإقرار بأن للوجود المادي بداية أولى[11].
أيضًا من مظاهر خطورة النموذج الغربي للعلم أنه يتحيز ضد التفسيرات المركبة، ويتبنى البسيطة المتجانسة، ولذلك نجده يرد الظواهر من الناحية التفسيرية إلى متغير واحد أو متغيرين على الأكثر، فيفسر السلوك الإنساني من خلال نماذج بسيطة تتجاوز عمقه وتعقيده، وهذا ما يسميه المسيري “الواحدية السببية”؛ البحث عن سبب واحد لتفسير الظواهر، وغالبا ما يكون هذا السبب هو السبب الاقتصادي، من مثل تحقيق الربح كما عند آدم سميث، أو تطور أدوات الإنتاج كما عند الماركسيين. وفي هذا السياق يقول المسيري: “هذه الواحدية السببية، النابعة من الواحدية المادية، تنطوي على رفض عميق للأخر المختلف، فوجود الأخر يعني وجود نماذج مختلفة وقوانين مختلفة للبشر”.
أيضًا من مواطن خطورة النموذج المعرفي الغربي على العلم تحيزه لكل ما هو موضوعي على حساب ما هو ذاتي، بمعنى إنه يفرض على الباحث أن يتجرد من خصوصيته والتزامه الخلقي، وأن يحول عقله إلى صفحة بيضاء ترصد وتسجل الحقائق بحيادية تامة، حتى يصبح الباحث مجرد متلق سلبي يقوم بوصف ورصد ظاهرة معينة دون أن يمنحها لونًا أو حكمًا بالخير أو الشر، لتبقى الظاهرة حبيسة الحياد البسيط الخالي من المطلقات والغائيات التي تمنحها معنى[12].
ومن مظاهر قصور النموذج الغربي أنه يحاول دائمًا الوصول لقانون عام يسد كل الثغرات انطلاقًا من افتراض يقضي بحتمية تناقص رقعة المجهول، وهذا مستحيلًا من الناحية العلمية لأنه بهذا التطلع يفترض بساطة العقل والواقع الإنساني (الطبيعي والاجتماعي)، وقد أثبت الواقع والتجربة مدى سطحية هذه الرؤية حتى جاءت مرحلة ما بعد الحداثة لتكفر بكل شكل من أشكال التعميم بل بإمكانية الوصول للحقائق ليتطرف النموذج الغربي مرة أخرى ولكن نحو العدمية واللامعنى[13].
واخيرًا لابد من الإشارة إلى كون المشروع المعرفي الغربي الحديث هو المشروع الوحيد في العالم الذي اكتملت معالمه وأطره ومنهجياته وآلياته، وهو مشروع يدعمه ويسانده عدد هائل من المؤسسات البحثية والثقافية والسياسية والعسكرية، بما يجعله مهيمنًا إلى الحد الذي يمكن تلك المؤسسات من توثيق أي شيء أو إشاعة أي مفاهيم، وفي المقابل تهميش أي معلومات أو حجبها دون مساءلة، بما يضر بموثوقية النتائج العلمية أحيانًا[14].
وفي هذا السياق يقول الفيلسوف ماسيمو بلوشي: “أعتقد أن العلموية تضر بالعلم بطريقتين على الأقل داخليًا بإفساد العلم نفسه، لأنها تمثل سوء فهم لماهية العلم وطريقة عمله، بما يبعد أن يفيد بشكل جيد العلماء الممارسين للعلم، وخارجيًا لأنه ينطوي على إمكانية تقويض فهم العامة للعلم والإضرار بسمعته”[15].
ثالثًا: إسلامية المعرفة: ضرورة إنسانية وعلمية
إن الإنسان يأبى ضرورة وقهرًا من داخله أن يرى نفسه مجموع ذرات ليس لها غاية، إنه مقهور أن يرى نفسه أكبر من مجموع أجزائه الصغرى وأعمق من أعراضه الفيزيائية[16]. بناءً على هذه الحاجة الفطرية الملحة يحتاج الإنسان المعاصر لمن يعيد له إنسانيته المفقودة بفعل هيمنة المادية على رؤيته لنفسه وللكون وللعلوم التي يتلقاها ولا تفي بكل حاجاته وتطلعاته كمخلوق مركب من روح وجسد مكرم له إرادة حرة.
من هنا كان مشروع إسلامية المعرفة أو التأصيل الإسلامي للعلوم ونعني به حسب تعريف إسماعيل راجي الفاروقي: “إعادة صياغة المعرفة على أساس علاقة الإسلام بها، أي إعادة تعريف المعلومات وتنسيقها وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة منها، وأن تقوم من جديد ما انتهى إليه من نتائج، وأن يعاد تحديد الأهداف، على أن يتم كل ذلك بحيث يجعل تلك العلوم تثري التصور الإسلامي وتخدم قضية الإسلام – وأعني وحدة الحقيقة ووحدة المعرفة ووحدة الحياة والطبيعة الغائية للخلق وتسخير الكون للإنسان وعبودية الإنسان منه – أن تحل هذه التصورات محل التصورات الغربية، وأن يتحدد على أساسها تحديد الحقيقة وإدراكها”
وفي هذا السياق تلتقي أسلمة العلوم مع أنسنتها أي مع البحث عن القيم الإنسانية ومحاولة إشاعتها في مضامين العلوم والمعارف، والبحث عن المناهج التي تخدم قضايا الإنسان في بعدها الأخلاقي، وتتجاوز النظرة التشيئية للإنسان وتجعل المعرفة في خدمته[17].
فالعلم في حقيقته إنساني، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، و بالتالي فإن التأصيل الإسلامي للعلوم يجعل العلم صالحًا للإنسان، ففي مقابل فلسفة الغرب العلمية اللاإنسانية فإن الفلسفة الإسلامية للعلم فلسفة إنسانية لا تعمل على تشيئ الإنسان وإنما تعمل على جعل العلم في خدمة ما هو إنساني، ولذلك فإن ما نود التأكيد عليه في كون إسلامية المعرفة مشروعًا للعلم وللإنسان هو أن إسلامية المعرفة تعمل على أنسنة فلسفة العلم بمعنى إعادة الإعتبار للمعرفة الإنسانية وخصوصية استحضار الإنسان باعتباره كائنًا متميزًا ومكرمًا وأن يكون العلم في خدمة قضاياه في أبعادها الأخلاقية والإنسانية وذلك في كل العلوم وفي العلوم الإنسانية على وجه الخصوص[18].
فالإسلام ينظر للعلم أنه منة من الرب سبحانه على الإنسان، بآلات الفهم والتلقي والتلقين، وأن العلم أوسع من المعرفة التجريبية، فهو يضم كل معرفة فطرية أو مكتسبة، كما أن هناك مصادر أخرى للمعرفة غير التجربة والحس وهي المعرفة التي ورد بها الوحي أو الخبر الصادق والعقل، كما أن الإسلام لا يرى المعرفة الحسية (التجريبية) وسيلة مستقلة للمعرفة وإنما هى تتعاضد مع بقية المصادر لإصابة الحق. والعلم وفقًا للرؤية الإسلامية غائي وليس عبثي، من غاياته صلاح حال الناس في الدنيا والغاية الأعلى معرفة الخالق سبحانه[19]، كما أنه يقف موقفا وسطا بين الموضوعية الجامدة والنسبية المطلقة التي تستحيل معها المعرفة العلمية، فهو يقوم على دمج قيم الذات الداخلية مع مدركات النظر الخارجي حتى ينتج عن ذلك معرفة تأسيسية موجهة ومقومة وليست مجردة[20].
وأخيرًا فالعلم في الإسلام خاضع للأخلاق التي مردها الوحي والحس الفطري السليم، ولها عليه سلطة توجيهية وليس العكس[21]. كما أن النموذج المعرفي الإسلامي من تصور مركب للإنسان بأنه روح ومادة ولا يفصل– كما هو حال النموذج المعرفي الغربي- بين الوجود الطبيعي المادي والروحي المعنوي، وبناءً على ذلك تتحرر فلسفة العلوم الإنسانية من أغلال المادية الوضعية التي جعلت من الظاهرة الإنسانية ظاهرة مادية فقط، ولذلك فإن من أهم ما تقدمه “إسلامية المعرفة” للإنسان المعاصر أن تعيد التصور الصحيح للإنسان، الذي هو موضوع العلوم الإنسانية بشكل أساسي، ولا ينفك بطبيعة الحال عن العلم الطبيعي من حيث التأثير والتأثر، مما يجعل هذه العلوم تعود بالنفع على حياة الإنسان.
من هنا نقول إن النموذج المعرفي الإسلامي الذي هو منطلق إسلامية المعرفة يرفض الرؤية الغربية المادية، ويستند إلى مرجعية توحيدية متجاوزة تؤسس لرؤيته للإنسان والكون، وبناءً على ذلك فإن التأصيل الإسلامي للعلوم يوسع أمام العقل مجال النظر المعرفي لينظر في عالمي الشهادة والغيب فيتجاوز ما هو محسوس إلى ما هو غير محسوس ليتخذ منه مجالًا للوصول إلى الحقيقة[22].
ولزيادة بيان حاجة العالم اليوم إلى إسلامية المعرفة نسلط الضوء على حاجة العلوم الإنسانية على وجه الخصوص، فإن الظاهرة الإنسانية التي هى محط نظر تلك العلوم تتجاوز المادة قطعًا لأنها تعبير عن أفراد طبيعتهم متميزة، ولكل منهم خصوصية تجعله مختلفًا عن غيره، فالأفراد ليسوا نسخًا متطابقة يمكن صبها في قوالب جاهزة وإخضاعها لنفس النموذج التفسيري، فمن طبيعة الظاهرة الإنسانية أنه يصعب تحديد كل أسبابها وحصرها في سبب أو سبيين كما هو حال الواحدية السببية، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكونات الشخصية والثقافية للأفراد والمجتمعات، هذا بالإضافة إلى تعدد هذه الثقافات ذاتها. ومما يزيد الأمر عمقًا وتعقيدًا حضور الوعي والإرادة الحرة والشعور والذاكرة…إلخ في بنية الظاهرة الإنسانية. كما أن وقائع العلوم الإنسانية لا يمكن إدراكها عن طريق الحواس لأنها ذاتية، فهي تتمثل في المشاعر والأفكار والنيات، ومن أهم ما يميزها أنها تدرس الإنسان الذي هو بطبيعته الفطرية كائن عاقل، أي أن سلوكياته ليست اعتباطية، بل تنطوي على معنى، وهذا يفرض علينا فهم الظاهرة الإنسانية، وتحليلها، وعدم الاقتصار على وصفها، وبناءً على ذلك فإن دراسة الظاهرة الإنسانية بمنهج مادي فقط هو من ضلال العقل الذي تأباه الفطرة والواقع والتجربة المتعينة لأنه يقوم على تهميش وتجاهل ما هو معلوم بالضرورة، كما أنه يعكس تشوهًا ومحدودية علمية، لأنه لا ينتج المعرفة التي تتسق مع واقع الإنسان، ومن ثم تقدم له ما ينتفع به في حياته فضلًا عن كونه خطر أخلاقي لأنه يشيئ الإنسان ويجعله مجرد مادة[23].
رابعًا: إسلامية المعرفة: رؤية عالمية
على صعيد آخر وبناءً على ما تقرر من حاجة الإنسان المعاصر إلى نموذج يحترم تميزه كإنسان ويعيد للعلم غائيته، فإن من أهم ما تقدمه إسلامية المعرفة للعالم اليوم هو زعزعة قيود العولمة الغربية الرافضة للآخر، تحت مزاعم العالمية والحيادية العلمية في ظل تحيز واضح لنموذجها المعرفي المادي، ومن ثم سوق العالم للسير في ركب اللحاق به، باعتبار أنه البديل الأوحد، ولذا نقول إن النسق المعرفي الإسلامي نسق عالمي ينطلق من عالمية الرسالة الإسلامية التي تخاطب مطلق الإنسان ومطلق الأنساق الفكرية والثقافية والحضارية، ولعلنا في هذا المقام نذكر مثالًا من منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته للآخر (أهل الكتاب) تعكس التطبيق العملي لهذه العالمية:
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لغير المسلمين يبعث إلى ملوك ورؤساء القبائل والبلاد المجاورة والبعيدة برسله ورسائله التي تحمل إليهم دعوته إلى دين الله بأسلوب غاية في السمو والحكمة والموعظة من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر — كتابه الكريم الذي بعث به “دحية الكلبي” إلى هرقل عظيم الروم، والذي جاء فيه “من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون”[24].
وهذا المثال يعكس عالمية دعوة الإسلام, ابتداءً بكون الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، ثانيًا تعظيمه لملك الروم وإعطاءه قدره، وبدؤه بالسلام، و بدأه بالدعوة وكما هو معلوم، فإنه لا إكراه في الدين، وإنما هي دعوة لمعرفة هذا الدين الاسلامي والدخول فيه، ثم ذكره بأنه في اعراضه سيتحمل إثمه وإثم من هم تحت إمرته (وهذا يعكس الموقف المتوازن بين حرية العقيدة وعدم المداهنة والذوبان والنسبية التي لا تحق الحق أو تبطل الباطل) ثم تلا عليه الآية العظيمة المؤسسة للحوار المشترك, وهو عبادة الله عز وجل، وبناء على ذلك شرعت القوة والحرب في الإسلام للذود عن هذا المبدأ الإنساني “مبدأ الحرية الإختيار” حيث إزالة كل العوائق التي تحول بين الناس وبين حرية الإختيار، وهذا ما عبر عنه ربعي بن عامر رضي الله عنه في حديثه لقائد الفرس الذين كانوا غارقون في أسر المادية معبرًا عن عالمية رسالة الإسلام وما تقدمه للإنسان من حرية من كل صور الاستعباد فيقول:
“إنّ الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتها، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام”[25] فبهذه الكلمات القليلة العميقة في معناها تتبدي عالمية رسالة الإسلام وأنه منذ البداية توجه نحو تعميم قيم العدل والحرية التي تنشدها الإنسانية جميعًا[26]، وأنه ما أتى إلا لتحرير الناس من كل قيد، فبه يملكون حرية الاختيار التي هى من صميم إنسانية الإنسان وجوهرها، وبه ينفكون عن كل أسر، ومن ذلك أسر الإمبريالية الغربية في عصرنا.
قارن هذا بما سبق ذكره من مخاطر النموذج المعرفي الغربي على النزعة الإنسانية وعالمية العلم وقدرته على نفع البشرية فضلًا عن ادعاء هذا النموذج العالمية واحتكار المعيارية العلمية ورفضه التام للآخر ولرؤيته حتى وصل الأمر بهذا التوجه المادي العنصري إلى رفض علمية ما ينبثق عن أصحاب الرؤية الإيمانية، فعلى سبيل المثال تمنع المجلات العلمية المحكمة في علم الأحياء “المؤمنين” من النشر فيها وتفتح بابها للملاحدة، لأن الإيمان في نظرهم يطعن في علمية الطرح المقدم[27].
من هنا تشتد حاجة العالم لمن يفتح للعلم آفاقًا جديدة، ويمنح للإنسان قيمته، ويفتح الميدان للنقد والتدافع، وهذا بالطبع يقف على النقيض من العولمة الغربية التي تسعى للقولبة والهيمنة كما بينا[28]، لذلك تلتقي عالمية الدعوة الإسلامية مع حنين الإنسان الغربي نفسه إلى القيم السامية وهو ما عبر عنه “رش” بقوله “من دون الدين لا يمكن أن تكون هناك فضيلة، ومن دون الفضيلة لا يمكن أن تكون هناك حرية، والحرية هي هدف كل الجمهوريات وحياتها”[29].
من هنا اقتضت عالمية الإسلام دفاعه المستمر عن كل ما هو إنساني، وعن القيم الإنسانية، ومن المعلوم أن القيم منها ما هو كوني وما هو نسبي ولذلك ترك الإسلام الناس على ثقافتهم وقيمهم وعاداتهم، وشجع منها ما هو إنساني، ثم زرع فيهم قيم الإسلام العليا، فلم يجدوا تناقضًا بين ما كانوا عليه من خير، وما جاء به الإسلام من قيم، أثرت ما هو حسن في ثقافتهم، فأشرقت بذلك حضارة تضم في كنفها أنماطًا متعددة، لكنها كلها تصب في بحر القيم الإنسانية، التي هي قيم مطلقة خالدة لا تطالها النسبية والتغير، ولذلك تلتقي في طبيعتها مع طبيعة الإسلام العالمية.
من هذا المنطلق الواسع الرحب الحر فإن فكل من يحمل القرآن الكريم والسنة والنبوية الشريفة عقيدة ومنهجًا وشريعة يتفاعل مع كل الأنساق الفكرية ليرتقي بها، ويتماس مع كل المناهج المعرفية ليستوعب منها ما يوافق منهجه ويتجاوز منها ما لا يوافقه، ولكنه يسمح للأخر بحق الوجود في ظل عالمية تنبذ منطق الثنائيات الحضارية المغلقة أو المتمركزة حول الذات، فإسلامية المعرفة ليست فقط مشروعًا تحتاجه الأمة الإسلامية في مسار نهضتها ولكنها منهجية تعلم العالم التثاقف الحضاري القائم على التفاعل والتدافع والاستيعاب والنقد والتجاوز. فهي وسط بين الانصهار الثقافي في الآخر وتنحيته تمامًا، وهي مشروع ينير من تاريخ الأمة ما أطفأته الأحداث، فهي ليست شيئًا مستحدثًا، فالعالم شهد من حضارة الإسلام ما أضاء عتمته، وهي في زمننا المعاصر بمثابة وصل للماضي بالحاضر، ومشروعًا إصلاحيًا لتحديات الواقع الجديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحثة في العلوم السياسية.
[1] عبد الوهاب المسيري (محرر)، إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، (فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996)، ص 1-3.
[2] المرجع السابق.
[3] الحسن حما، عمر مزاوضي، الإبستمولوجيا وإسلامية المعرفة، مركز نماء للبحوث والدراسات، فبراير 2015، 109.
[4] محمد عمارة، بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية، (القاهرة: الإمام البخاري للنشر، نوفمبر 2009) ص 26-28.
[5] عبد الوهاب المسيري (محرر)، إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للإجتهاد، مرجع سابق، ص48-52ا
[6] الحسن حما، عمر مزاوضي، الإبستمولوجيا وإسلامية المعرفة، مركز نماء للبحوث والدراسات، مرجع سابق، ص 146.
[7] المرجع السابق، ص53.
[8] على صديقي، الأزمة الفكرية العالمية: نحو نمذج قرآني بديل، إسلامية المعرفة، مجلد 15، عدد59، 2010، ص ص 37-40.
[9] المرجع السابق، ص74-75.
[10]عبد الوهاب المسيري (محرر)، إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للإجتهاد، مرجع سابق، ص 54.
[11] سامي عامري، العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان، (الكويت: مركز رواسخ، 2021) ص ص 156- 162.
[12] عبد الوهاب المسيري (محرر)، إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للإجتهاد، مرجع سابق، ص ص 54-56.
[13] المرجع السابق، ص 75.
[14] المرجع السابق، ص 57.
[15] سامي عامري، العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان، مرجع سابق، ص 163.
[16] سامي عامري، العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان، مرجع سابق.
[17] الحسن حما، عمر مزاوضي، الإبستمولوجيا وإسلامية المعرفة، مركز نماء للبحوث والدراسات، مرجع سابق، ص 158.
[18] المرجع السابق، ص ص 146-154
[19] سامي عامري، العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان، مرجع سابق، ص 47-48.
[20] على صديقي، الأزمة الفكرية العالمية: نحو نمذج قرآني بديل، مرجع سابق، ص ص 44- 48
[21] سامي عامري، العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان، مرجع سابق، ص 47-48.
[22] على صديقي، الأزمة الفكرية العالمية: نحو نمذج قرآني بديل، مرجع سابق، ص ص 44- 48.
[23] على صديقي، الأزمة الفكرية العالمية: نحو نمذج قرآني بديل، مرجع سابق، ص 50-52.
[24] رواه البخاري من حديث أبي سفيان بن حرب.
[25] الحافظ بن كثير، البداية والنهاية.
[26]، مرجع سابق، ص 111. الحسن حما، عمر مزاوضي، الإبستمولوجيا وإسلامية المعرفة، مركز نماء للبحوث والدراسات
[27] سامي عامري، العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان، مرجع سابق، ص 203.
[28] محمد جلاوي، عالمية الإسلام والعولمة، منار الإسلام للابحاث والدراسات، 23 سبتمبر 2019، متاح على الرابط التالي:
[29] الحسن حما، عمر مزاوضي، الإبستمولوجيا وإسلامية المعرفة، مركز نماء للبحوث والدراسات، مرجع سابق، ص 111.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies