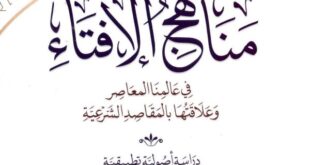الاجتهاد والتقليد لدى محمد عبده
قراءة في النص الكامل للفتاوى
د. فاطمة حافظ*
خضع الإنتاج الفكري والفقهي للشيخ محمد عبده لدراسات كثيرة يتعذر إحصاؤها، سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية، ورغم هذا لم يزل باب البحث حوله مشرعا؛ للأهمية التي يشكلها عبده ضمن مشروع الإصلاح الإسلامي، ولأن بعض الموضوعات المتعلقة بإنتاجه يعاد طرحه وفق اقترابات ومناهج جديدة أو انطلاقا من أسئلة جديدة.
وتأسيسا على هذا تحاول هذه الورقة بحث قضية الاجتهاد والتقليد الفقهي للشيخ محمد عبده، بالتطبيق على الفتاوى التي أصدرها خلال فترة توليه منصب إفتاء الديار المصرية (1899-1905) وذلك وفق المنهاجية التالية:
-أولا: الاستناد إلى النص الأصلي الكامل للفتاوى التي أفتى بها عبده، والمنشورة بحروفها للمرة الأولى عن دار الوثائق المصرية في مجلدين، (ما سبق نشره منها كان مجرد مقتطفات انتخبها الدكتور محمد عمارة من مجموع فتاويه، وقد تصرف فيها بالإضافة والتعديل، وأحيانا بالحذف، لتصبح أكثر ملائمة للصيغ اللغوية المستخدمة في عصرنا، أو تخفيفا من بعض البيانات التي اعتبارها غير دالة مثل: الديباجات البيروقراطية واسم السائل ووظيفته ومحل إقامته وما إلى ذلك).
–ثانيا: السعي إلى وضع هذه الفتاوى ضمن سياقها الفقهي الأشمل وهو فتاوى المعاصرين، وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى فتاوى الشيخ محمد العباسي المهدي (ت: 1897م) مفتي الديار المصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفتاوى الشيخ محمد عليش المالكي (ت: 1882م) مفتي المذهب المالكي بالديار المصرية، والذي يصنف عادة من الدارسين المعاصرين بأنه يقع على رأس معسكر التقليد الفقهي، والذي دخل في مواجهات عدة مع محمد عبده، وأخيرا فتاوى محمد رشيد رضا (ت: 1935م) وهو امتداد لمدرسة محمد عبده، وأحد فروعها. ومن خلال هذا نفحص ثنائية التقليد والاجتهاد ومدى نجاعتها في فهم التطور الفقهي المعاصر، ووفقا لها يعد عبده من المجتهدين، بل لعله أول المجتهدين المحدثين، على حين يصنف الشيخان عليش والعباسي بأنهما محافظين ومقلدين.
–ثالثا: تحاول الورقة كذلك البحث عن علاقة الفكر بالفقه لدى الشيخ محمد عبده، ذلك أن الفتاوى رغم استنادها إلى المدونة الفقهية، إلا أنها ليست نصا فقهيا خالصا فهي تستند إلى معتقدات وخبرات المفتي الذاتية التي تشكل تصوراته حول الواقع وما ينبغي أن يكون عليه، وهكذا يندمج العنصر الذاتي مع الموضوعي، ومنهما سويا تتألف الفتوى، وعليه تغدو علاقة الفقهي والفكري أحد التساؤلات التي ينبغي البحث فيها، لبيان مدى الاتساق أو الافتراق بينهما من خلال الفتاوى.
وتفترض الدراسة أن تبني ثنائية الاجتهاد والتقليد لوصف الإنتاج الفكري للشيخ محمد عبده تعترضه بضع إشكالات، منها أن النسبة الغالبة من الفتاوى لا يظهر فيها النزوع الاجتهادي، بل أفتى فيها الشيخ استنادا إلى النصوص الفقهية، وذلك في مسائل مثل الوقف والفرائض والأحوال الشخصية وغيرها، ونظن أن التعبير الأدق عن هذا النزعة هو “الالتزام” بما جاءت به المدونة الفقهية. غير أن هذه النزعة الملتزمة قد بلغت درجة التقليد الصريح وذلك في فتاوى مثل فتوى الجنسية، والوطنية، والامتيازات، وفتوى رفض اعتماد الحساب في تحديد الأهلة، وهو ما سنناقش بعضه لاحقا، وهي مسائل ذات صلة بالمتغيرات الحداثية، ويتجلى فيها غض النظر عن تغير السياق السياسي، وما صاحبه من بروز مفاهيم جديدة، وتطور وظائف الدولة وعلاقتها بالرعية. وذلك من دون أن ننكر ميله إلى الاجتهاد في مسائل أخرى، تردد إزاءها معاصروه ومن أتى بعده؛ مثل قبول الطب واعتباره قرينة يمكن للقاضي الحكم بمقتضاها في الدعاوى، جنبا إلى جنب مع وسائل الثبوت الشرعي.
ولأجل هذا نرجح أن كلا المبدأين —الاجتهاد والتقليد— اعتملا في نفس الشيخ، ولكنه يقدم أحدهما لأسباب يراها في فتوى، ثم يقدم الآخر في فتوى أخرى، وعندئذ لا يغدو السؤال المناسب هو: هل كان مقلدا أم مجتهدا؟ وإنما “متى كان يقلد ومتى كان يجتهد وفيم كان يجتهد، وما كانت دواعيه للاجتهاد، وكيف كان اجتهاده وهل يختلف اجتهاده عن اجتهادات الآخرين، وهل وجدت أفكاره الإصلاحية سبيلا للتطبيق من خلال اجتهاداته؟
محتوى الفتاوى وخصائصها:
شغل الشيخ محمد عبده منصب مفتي الديار المصرية في منتصف يوليو 1899، وخلال ست سنوات أمضاها في منصبه حتى وفاته في الحادي عشر من يوليو 1905 أصدر 944 فتوى، وهي تشغل سجلين من سجلات دار الإفتاء، المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة.
صدرت الفتاوى مؤخرا عن دار الوثائق القومية ضمن مجلدين؛ صدر أولهما عام 2017 والثاني عام 2022، وبلغ مجموع صفحاتهما 762 صفحة من القطع الكبير، وقد ضم كلا منهما سجلا من السجلين، إلا أن الدار لم تلتزم ترتيب الفتاوى الوارد في السجلات؛ وهو ترتيب حسب تاريخ وردوها، وإنما وزعت الفتاوى على أبواب الفقه المعتادة، وقدمت لها بدراسة قصيرة في عشر صفحات؛ تناولت التعريف بالمفتي والاجتهاد، وقدمت نبذة ترجمة مختصرة للشيخ ومنهجه في الإفتاء، والجهات الوارد منها الاستفتاءات؛ وهي جهات رسمية وجهات أهلية وبضع فتاوى وردت من الخارج، وانفرد المجلد الثاني بجدول يبين التوزيع الموضوعي للفتاوى، وهو ما افتقر إليه المجلد الأول. وفيما يلي بضع ملاحظات حول هذه الطبعة، ومنهج تعاملها مع الفتاوى:
الأولى: إغفالها تحليل البيانات الأساسية للاستفتاءات من مثل: إحصاء الاستفتاءات الحكومية والجهات الواردة منها ونسبتها الكلية إلى الفتاوى، وإحصاء الاستفتاءات الأهلية ونوعية السائلين ذكورا وإناثا ودياناتهم وطبقاتهم الاجتماعية، وخصوصا أن الشيخ لم يغفل ذكر هذه البيانات وضمنها سؤال الفتوى، وهي تفيد في فهم السياق الاجتماعي للفتوى، والتغيرات الحاصلة في المجتمع في ذلك الوقت.
والثانية: تتعلق بتصنيفها الموضوعي للفتاوى، فمن جهة لم تلتزم ترتيب الأبواب الفقهية التي تستهل بالعقائد، ثم العبادات، ثم المعاملات، إذ قدمت فتاوى المعاملات على العقائد والعبادات، ومن جهة أخرى تم عنونة الأبواب بعناوين تغاير عناوين الأبواب الفقهية، ففيها فصل عن “حقوق المرأة”، وآخر عن “الملكية”، وثالث للـ “أحوال الشخصية”، وهي تسميات غير معروفة في كتب الفقه.
والثالثة: غضها الطرف عن تعريف المصطلحات الفقهية من قبيل: العول، التعصيب، اختلاف الدارين، الارتفاق، المهايأة كما لم يتم تعريف معظم الكتب الفقهية.
ومع الإقرار بأن إخراج الفتاوى في صورتها الأصلية، والتنصيص على رقم الفتوى بالسجل وتاريخها، وتجنب إغراق النص بالهوامش والإحالات، هو مما يحمد لدار الوثائق وباحثيها، إلا أن هناك حاجة لذكر بعض التفاصيل الضرورية التي توضح طبيعة الفتاوى والسياق الاجتماعي الذي تنتمي إليه.
تقع الفتاوى في سجلين/مجلدين كما أسلفنا يضم أولهما 487 فتوى ويضم الثاني 457 فتوى، وقد افتتح السجل الأول بفتوى مؤرخة بتاريخ 2 صفر 1317ه/ 11 يونيو 1899م، وتقع ضمن باب الجنايات والديات وهي الفتوى الأولى للشيخ، ويختتم بالفتوى رقم 487 المؤرخة بتاريخ 23 صفر 1320ه/30 مايو 1902م، ويفتتح السجل الثاني بفتوى مؤرخة بتاريخ 27 صفر 1320ه/3 يونيو 1902م، وينتهي بالفتوى رقم 457، وهي آخر فتاويه وتقع ضمن باب الإجارة، وهي مؤرخة بتاريخ 4 ربيع الثاني 1323/ 7 يونيو 1905م.
وجميع الفتاوى وقع عليها الشيخ عبده منفردا، عدا فتوى مشروع قانون النفقة الزوجية، حيث شاركه في التوقيع عليها شيخ الأزهر ومفتي المذهب المالكي، وفتوى تكفير غير المسلم الواردة من الهند، وشاركه في التوقيع عليها علماء المذاهب الأربعة بمصر.
من الناحية الموضوعية، احتلت فتاوى الوقف المرتبة الأولى في تعداد الفتاوى؛ إذ بلغ عددها 379 فتوى بنسبة 42 بالمائة من مجموع الفتاوى، تليها فتاوى المواريث وعددها 263 فتوى بنسبة 25 بالمائة، ثم فتاوى الطلاق البالغة 45 فتوى بنسبة 4.5 بالمائة، وأما أصغر الأبواب فتضم باب الصيام وباب الحج، وكل منهما يضم فتوى واحدة، وأما باب الجنايات والقصاص فلا يزيد عن 33 فتوى في السجلين أي حوالي 3.5 بالمائة من مجموع الفتاوى، وهو رقم ضئيل للغاية إذا ما قورن بما أفتى به الشيخ العباسي المهدي، حيث بلغت نسبة الفتاوى القضائية 34 بالمائة من مجموع فتاويه البالغ عددها نحو 13500 فتوى[1]، وهو ما يوضح إلى أي مدى تقلص دور المفتي في الجهاز القضائي للدولة، إذ لم يعد “الرأي الشرعي” هو المعول عليه في فصل الدعاوى — اللهم إلا التصديق على أحكام الجنايات، وحل محله الطب والأدلة الجنائية الحديثة.
ومن حيث الجهات السائلة، تقدر نسبة الفتاوى الرسمية الواردة من جهات ومصالح حكومية بـ 122 فتوى أي ما نسبته 13 بالمائة من مجموع الفتاوى، وأكثر الجهات طلبا للفتوى على التوالي: الحقانية، الأوقاف، محكمة مصر الابتدائية، محكمة الاستئناف، المالية.[2] وهذه النسبة تقل كثيرا عن نسبة الفتاوى الرسمية لدى الشيخ المهدي البالغة نحو 77 بالمائة من مجموع الفتاوى، وتوحي أن النظارات والمصالح المصرية لم تعد مطالبة بالوقوف على الرأي الشرعي، كما كان الحال في منتصف القرن التاسع عشر حيث كانت الأجهزة الإدارية مطالبة باستطلاع رأي المفتي لضبط سير العمل بها وفقا للشرع، ولهذا الغرض عُين مفتي في معظم الهيئات الحكومية فكان هناك: مفتي الحقانية، ومفتي المالية، ومفتي الأوقاف، ومفتي الضبطية [شرطة مصر]، كما عين مفتي لكل من المجالس التشريعية، ولكل مديرية من مديريات القطر.
أما النسبة الغالبة من الفتاوى البالغة 822 فتوى، والتي تقدر بنحو 87 بالمائة، فوردت من الأفراد (مصريين وأجانب) وهي تمثل الشرائح الغالبة في المجتمع المصري آنذاك، فهناك فتاوى واردة من نساء الطبقة العليا،[3] ،[4] ونساء الطبقة الدنيا[5]،[6] وفتاوى تعبر عن الطوائف المسيحية الموجودة في مصر آنذاك مثل فتوى نائب بطركخانة الكلدان، وفتوى نائب بطركخانة الأروام الكاثوليك، وفتوى وكيل بطركخانة الموارنة[7]،[8]،[9]، والأقباط[10]وهناك فتوى واردة من أحد أعضاء الطائفة اليهودية المصرية[11]، وأخرى لحاخام يهودي من عكا[12]، وبضع فتاوى وردت من الخارج كالفتوى الترنسفالية حول ذبائح أهل الكتاب[13]، وفتوى أخرى واردة من الهند حول تكفير غير المسلم[14]، وكذلك وردت بعض الفتاوى من الشخصيات العامة التي لعبت دورا في تاريخ مصر الثقافي كفتوى قاسم أمين بصفته رئيس دائرة الجنايات الكبرى[15]، وفتوى الشيخ الأحمدي الظواهري شيخ المسجد الأحمدي بطنطا[16].
ومن الناحية المنهجية، تميز منهج الشيخ عبده في الإفتاء ببضع خصائص، يمكن أن نوجزها في الآتي:
- عدم التقيد بصيغة شكلية محددة للفتوى، يُفتتح السؤال عادة بلفظ (سأل) أو (سؤال مرسل من)، متبوعا باسم السائل إن كان فردا، أو (سئل بإفادة من) إن ورد من مؤسسة حكومية، ويختتم السؤال بصيغ مختلفة مثل: أفيدوا الجواب، نرجو الجواب، أفيدوا، أفيدونا مأجورين. والجواب يستهل بلفظ (أجاب) ويختم بعبارة (والله أعلم). وهو ما يعني أنه لم يقم بعملية تعديل للأسئلة الواردة إليه، ولم يقتف أثر المنهجية الفقهية الكلاسيكية التي تحذف اسم السائل وما يتعلق به من معلومات، لأجل جعله سؤالا معياريا صالح للتطبيق على الحالات المماثلة.
- تجنب الشواهد النصية، وهي الشواهد القرآنية والحديثية والشواهد الفقهية، وقد استعان في حالات قليلة بالنصوص الفقهية، إلا أنها كانت موجزة لا تسمح بالتعرف على الآراء المختلفة للمسألة الواحدة، كما هي عادة معاصريه، وفي حالات نادرة استعان بالنصوص القرآنية[17]، وأما الشواهد الحديثية فهي أكثر ندرة [18] إذ لم يزد عددها عن استشهادين، ورد الأول ضمن دعوى قتل عن طريق الخنق، ومذهب أبو حنيفة فيها عدم القصاص خلافا لصاحبيه، ورجح عبده رأي الصاحبين، وتوقف عبده أمام حديث الرسول (قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الأبل)، مرجحا أنه “لم يبلغ من الصحة ما يصح الرجوع إليه، على أنه محمول على الضرب للتأديب ونحوه بغير قصد القتل”[19]. وجاء الثاني في فتوى حول طوفان نوح وذهب إلى أن “ما ورد من الأحاديث على فرض صحة سنده فهو آحاد لا يوجب اليقين، والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظن إذ عد اعتقادها من حقائق الدين.. وما يذكره المؤرخون والمفسرون في هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية أو عدم الثقة بها ولا يتخذ دليلا قطعيا على معتقد ديني”[20]، وهذان المثالان يوحيان أنه لم يعتمد الحديث على إطلاقه في الاستدلال، وأن توظيف الحديث لديه ربما اعترضته بعض إشكالات، على صعيد آخر نلحظ أن الشيخ استعان بمصادر غير فقهية في الإجابة، ومن ذلك استشهاده بنصين مطولين من مقدمة ابن خلدون في فتواه حول تكفير المسلم وحكم الاستعانة بغير المسلمين[21]، وهو ما لا نجد له نظيرا لدى معاصريه من المفتين الذين لم يستعينوا سوى بالنصوص الفقهية.
- عدم التقيد بالإفتاء وفق المذهب الحنفي، وهو المذهب المعتمد للإفتاء في مصر منذ عهد محمد علي، ثم أصبح وفقا لأصح الآراء في المذهب في عهد خلفائه، وتمسك المفتون العاملون بالجهاز الحكومي بذلك، وبالغ بعضهم في ذلك حتى كان التقيد بالإفتاء وفقا لأصح الآراء في المذهب معلم من معالم منهج الإفتاء لدى المهدي، وخلافا لذلك كان محمد عبده ينتقل بيسر وسلاسة من الرأي الراجح إلى الرأي المرجوح، بل ربما خرج عنه إلى مذهب آخر، حيث تبنى رأي المذهب المالكي في عدة مسائل[22].
- الحضور الذاتي، لا يتردد الشيخ في الإعلان عن رأيه في مسألة ما بوضوح وعلانية، ومن أمثلته قوله “أما رأيي في هذه المسألة فهو يتفق مع رأي القائلين بأن الوقف تسمع الدعوى المتعلقة بعينه أبدا، لا يمنع من سماعها بمرور الزمن مهما طال، إلا أن المحاكم الآن ممنوعة من السماع بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة”[23]، وقوله ” الذي أراه أن كل ما يجيء في عبارات الواقفين من تعيين وظائف أو أماكن لم ترد في الكتاب والسنة يجب رده إلى أصول الدين، ولا يجوز اعتبار الواقف مشرعا محددا لشيء من القربات…”[24]، وإذا كان الإفصاح عن الرأي أمرا شائعا لدى الفقهاء، إلا أن الحضور الذاتي لدى عبده يختلف عن معاصريه من جهتين: الأولى أن الأشياخ محمد عليش المالكي، ومحمد البنا، والعباسي المهدي الحنفيين كانوا يعرضون للآراء المختلفة في المسألة محل السؤال، ثم يرجحون رأيا منها، أو يسوقون رأيا لهم لم يرد في الكتب الفقهية، أما عبده فلا يتطرق إلى الآراء في المسألة ولا يقوم بعملية ترجيح، ولا يبين لماذا يتبنى رأيا لا تنص عليه المدونة الفقهية وما أوجه منفعته، والثانية عدم تردده في افتتاح الجواب بمثل: “أما رأيي في هذه المسألة” أو “الذي أراه” وهي افتتاحيات لا نجد نظيرها لدى معاصريه الذين تورعوا عن تصدير آرائهم الذاتية في المسألة، وغض الطرف عن الآراء الأخرى المعتمدة في المسألة المطروحة[25].
- عدم الميل إلى التعليل؛ يميل الشيخ إلى إبداء الرأي الشرعي دون بسط الآراء المختلفة في المسألة أو الإحالة إلى المصادر، فإذا تبنى رأيا لا يعلله، حتى وإن كان اجتهادا، كما لا يسعى إلى تكييفه فقهيا، كما هو الحال مع رأيه في الطب والتشريح، ولعل هذا يطرح تساؤلا حول دواعي إحجام الشيخ عن التعليل، وهناك بضع افتراضات في ذلك أولها: أن المفتي ليس مطالبا بالتعليل أو الدليل، ويجوز له إبداء الرأي الشرعي دون التطرق إلى الآراء المختلفة للمسألة الواحدة، ولكن هذا يتعلق بكون الرأي مستقى من المدونة الفقهية، أما إن كان اجتهادا فيجب أن يعلل المفتي لم يتبن هذا الرأي، ويقوده هذا التعليل إلى القيام بعملية تكييف فقهي؛ أي بيان الآراء المختلفة، وأوجه الضعف بها، أو اختلاف السياق، ثم بيان أوجه المصلحة التي تستدعي الأخذ بالرأي الجديد، وثانيها: ضيق وقت الإمام للقيام بذلك، والمعلوم أن الإفتاء لم يكن إلا فرعا من مهام الشيخ المتشعبة، ومن الجائز أنها حرمته من التفرغ للقيام بالتعليل، وثالثها: أن عملية التعليل، وإعمال النظر في الآراء المختلفة، وترجيح بعضها على بعض، والخروج عنها، كل هذا يتطلب فقيها عالما بالأصول ودقائق الفروع والمسائل وإحاطة بالمدونة الفقهية والفروق الدقيقة بين المذاهب حتى يصير النظر ملكة لديه، وهي الملكة التي تتكون بالمران وطول النظر والممارسة، وقد حصلها الشيخ المهدي العباسي، الذي أمضى في الإفتاء زهاء نصف قرن، لم يُشغل فيها سوى بالفقه والإفتاء، وحصلها الشيخ عليش الذي أمضى في منصب مفتي السادة المالكية زهاء ثلاثة عقود، أفاد فيها وأفتى ونظَّر لكثير من المسائل، وحصلها الشيخ رشيد رضا الذي نهض بعبء الرد على استفتاءات القراء بمجلة المنار ما يربو عن ثلاثة عقود، والتي جمعها الأستاذ صلاح الدين المنجد وبلغت ست مجلدات.
أسس الاجتهاد وآلياته:
نوقشت قضية الاجتهاد في مصر خلال ثلاثينات القرن التاسع عشر مع وصول الشيخ محمد بن علي السنوسي (ت: 1859م) إلى مصر، وطرحه سؤالا عن مشروعية الاجتهاد، ولماذا يلتزم الفقهاء التقليد، واستفتى كبار المالكية في ذلك، وبعده تناول الطهطاوي المسألة في سلسلة مقالات نشرت بصحيفة روضة المعارف، وجمعت بعدها في رسالة (القول السديد في الاجتهاد والتقليد)، وعلى هذا كانت قضية الاجتهاد مطروحة قبيل وصول الأفغاني إلى مصر، وقبل تشكل تيار التجديد. وإذا كان عبده يعد من أنصار الاجتهاد فإن السؤال هو: ما الأسس التي يقيم عليها عملية الاجتهاد، وما آليات تطبيقه أو كيف يطبقه؟
ورد لفظ “الاجتهاد” مرة واحدة في الفتاوى، في معرض التمييز بينه وبين الضرورة، واستخدمه الشيخ دون تعريف أو تأصيل نظري، وبصورة محايدة دون نعته بنعوت سلبية أو إيجابية، وهذا الحياد اللفظي يعد في حد ذاته تأييدا للاجتهاد، لأن الشيخين عليش والمهدي ناصرا التقليد وأيدا وجوبه، يقول أولهما: “يجب علينا العمل براجح أو مشهور مذهبنا.. فإنه حجة ما دمنا في ربقة التقليد، ونظرنا في الأدلة والاتفاق والاختلاف فضول؛ إذ وظيفتنا محض التقليد واتباع المشهور من المذهب)[26]، ويذهب المهدي إلى ما هو أبعد من ذلك حين يقرر “أن الفقه نقلي لا عقلي” وهو ما يعني أننا ملتزمون بالتقليد أبدا،[27] وعلى الرغم من أن الشيخ محمد عبده قد استخدم المفهوم دون تأصيل نظري، إلا أننا نستطيع تبين بعض الأسس التي يؤسس عليها اجتهاده، وهي على الترتيب: الضرورة، والمصلحة، والحداثة.
أولا: الضرورة
وهي أولى الأسس التي توجب الاجتهاد لديه، فإذا وجدت الضرورة وجب اتباعها، وخير مثال لذلك فتواه بشأن تشكي زوجات المسجونين من عدم الإنفاق عليهن وعلى أولادهن أو التفريق بينهم، والتي طلبت نظارة الحقانية البحث عن مخرج شرعي لهن.
وقد رد الشيخ ردا فقهيا مسهبا، وقدم مشروع قانون للنفقة، صاغه في إحدى عشر بندا، لا يقتصر على زوجات المسجونين كما هو منطوق السؤال، وإنما تناول زوجات المفقودين، واللواتي امتنع أزواجهن من الإنفاق عليهن، أو أساءوا معاشرتهن، والحالات الأربع كما يقول الشيخ “في درجة واحدة من الحاجة إلى البحث”، ورغم أهمية القانون إلا أن الذي يعنينا هو الجواب الفقهي الذي ينقسم إلى:
“مقدمة”، تبحث في وجوه الضرورة الداعية للبحث عن مخرج شرعي للنسوة المتضررات من أزواجهن، ولأجل ذلك سرد بعضا من التساؤلات الواردة إليه والتي تظهر مأساة طائفة من النساء اللائي “يلجأن بحكم الضرورة إلى الفحش، وارتكاب ما يخالف أحكام كل دين وأدب، أو يهلكن، ولا سبيل لإنقاذهن في الحالتين إلا التطليق”، كما يقرر.
و”بنية الفتوى”، وتدور حول الحجج الفقهية التي سوغ بها التطليق رغم مخالفته رأي المذهب الحنفي، وركز نقاشه على مسألة الضرورة، وذكر أنه متى تحققت “وجب مراعاتها بنص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة، ولا حاجة لسرد النصوص على ذلك، لأنه معلوم من الدين بالضرورة”، ومراعاة حكم الضرورة لا يعد اجتهادا برأيه “لأن الاجتهاد إنما يكون له مجال في الأمر ذي الوجوه، أما ما قضت به الضرورة فهو من قبيل المحسوس، لا مجال للنظر فيه حتى يكون اجتهادا”، وعرج على العمل بالمرجوح واعتبره محظورا إن لم تقض به الضرورة، فإن قضت ساغ للقاضي الحكم به، حتى دون استئذان من ولاه، ويعني بذلك ولي الأمر الذي عينه وألزمه أن يفتي بأصح الآراء في المذهب الحنفي، ودلل على ذلك بما قاله الأحناف من جواز الخروج على رأي المذهب إلى المذهب المالكي في مسألة المفقود الذي لا يُعلم له محلا ولا حياته من موته، لأن المذهب الحنفي يقضي بعدم التطليق، حتى إن طالت غيبته عقودا، ولم يترك للزوجة نفقة، على حين يجيز المذهب المالكي التطليق في مدة أقصاها أربع سنوات.
و”خاتمة” تناقش الأمور الإجرائية المتعلقة بوضع القانون موضع التنفيذ، من مثل هل يجوز إصدار الخديوي للقانون أم أنه للخليفة العثماني، وهو يفتي بالجواز، لكنه يلجأ إلى الحيل الفقهية، فيقترح تطبيقه من خلال محاكم الأقاليم، أما محكمة مصر الشرعية العليا التي يترأسها القاضي العثماني المعين من استنبول فتقوم بتحويل دعاوى النفقة الواردة إليها إلى المحاكم الأدنى للفصل فيها.
ويستوقفنا في هذه الفتوى بضعة أمور أولها استخدام الشيخ لفظ الضرورة ثلاث عشر مرة في تراكيب وصيغ عدة من قبيل “ضرورة مُلجئة” و”مراعاة للضرورة” و”ما تمس إليه الضرورة” و”حكم الضرورة” الأمر الذي يوحي أنها الحجة الرئيسة التي اعتمدها، وما عداها من حجج مثل تفنيد آراء المتمسكين بالمذهب جاء في مرتبة تالية على سبيل دعم الحجة المركزية.
وثانيها توقيت الفتوى، فهي مؤرخة في السابع من أغسطس عام تسعمائة وألف، أي بعد أشهر قلائل من صدور كتاب (تحرير المرأة) لقاسم أمين، الذي لفت الأنظار إلى تدني أوضاع النساء وسوء معاملتهن، ولعل هذه الفتوى جاءت كأحد ردود الفعل التي أثارها الكتاب، ويدعم هذا أنه خلال القرن التاسع عشر غصت المحاكم الشرعية بدعاوى نفقة الزوجات وزوجات المفقودين، ولم تلق أي استجابة تذكر من الدولة أو رجال الشريعة والقضاء، من جانب آخر كان بالإمكان أن يكون التدخل من خلال منشور حكومي يقضي بالتفريق للضرر في الحالات الأربع المذكورة كما هو متبع في هذه المسائل، أما أن يأخذ الأمر شكل قانون متكامل يخص فئات مختلفة من النساء فهذه ممارسة قانونية غير مسبوقة.
وثالثها، أشار الشيخ في مقدمته للفتوى إلى بضع تساؤلات وردت إليه تبين معاناة النساء، منها واحدة تخص “امرأة ارتدّت لسوء معاشرة زوجها، ولا هو يطلقها، ولا هو يحسن عشرتها، ولا هو يتركها تعيش عند أهلها”، وبالرجوع إلى هذه الفتوى، وهي بتاريخ سابق، وجدنا الشيخ يتبنى رأي الفقهاء المتأخرين في عدم فسخ النكاح، وإجبار الزوجة على تجديد النكاح، ويعلل ذلك بالقول: “ولما كان كثير من الزوجات قد اتخذن دينهن لعبة يخلعنه كلما أردن التخلص من أزواجهن، وهي وسيلة من أقبح الوسائل، وجب لذلك إقفال هذا الباب في وجوههن، خصوصا مع تعذر إجراء أحكام الردة عليهن كما هو معلوم، فلهذا لا ينفسخ النكاح ولا تقع الفرقة بمجرد ردة الزوجة”[28]. وما ذهب إليه يطرح التساؤلات حول مدى تأثر الفتوى بالفكر، أو بعبارة أخرى هل وجدت قناعاته الفكرية —فيما يتعلق بضرورة إصلاح أوضاع النساء — سبيلها إلى التطبيق، من خلال الفتوى. في حالتنا تلك يبدو الجواب بالنفي.
وأخيرا: مسألة تسلل الحداثة ومفرداتها إلى بنية النص الفقهي، ويمكن الإشارة هنا إلى وعيه واستخدامه لمفهوم الطبقة الاجتماعية، وتوظيفه للتقسيم الطبقي (الحداثي) للإشارة إلى الفئات التي يسيء أفرادها (وفقا له) معاشرة النساء، والمكونة من “أغلب أفراد الطبقة السفلى من الأهالي، والكثير من أفراد الطبقة الوسطى والعليا”[29]، هذا التقسيم الطبقي يغاير التقسيم الإسلامي الكلاسيكي للمجتمع والذي يتألف من ولاة الأمر (الحكام والعلماء) والعامة، وأما الإشارة الثانية فنجدها في تمييزه بين (الأحكام الشرعية)، التي تتطلب موافقة ولي الأمر وعلماء الشريعة، و(الأحكام الوضعية) التي يجوز لنواب الأمة ممثلين في “مجلس شورى القوانين” النظر فيها[30].
ثانيا: المصلحة
وهي المبدأ الثاني الذي يؤسس عليه الشيخ اجتهاده، فإذا وجدت المصلحة وجب اتباعها، وهو ربما أشار إليها صراحة وربما استعاض عنها بـ “المنفعة” أو “موافقة العدل” وهما بذات المعنى، وقد يسكت عن اللفظ لكننا نجد مراعاة له، وهناك نماذج عدة على مراعاته المصلحة، منها ما ذهب إليه في مسألة حق الأب غير الأهل للتربية في ضم ابنته التي انتهت مدة حضانتها، حيث قرر أن القواعد الشرعية في كفالة الصغار تراعي القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم إذا عقلوا، ولذا اشترط الفقهاء تسليم البنت إلى أبيها إلا إذا كان مفسدا، مفسرا ذلك أن “الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح، فإن خُشي على بدن أو نفس، سقط حق من يُخشى منه ذلك في ضم الصبي”[31].
ومنها ما ذهب إليه في مسألة الصغير الذي لا يستطيع أبواه الإنفاق عليه؛ حيث أجاز الدفع به لمن يرغب في تربيته، وعلله “أن ذلك ليس مما يقع في باب الحضانة وحده، وإنما هي واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل”، لكنه اشترط أن يكون التسليم برضا الأبوين وموافقتهما، فلما سئل هل يجوز التسليم من غير هذا الشرط، لأن الأبوين عادة ما يسلمان الطفل إلى المشفى ولا يعودان، ويتعذر إحضارهما، أجاب “رأيت أن لا مانع في هذه الحالة من تسليمه لثقة قادر على حفظه… ويراعى في الثقة القادر أن يكون مسلما”، ويتبين من جوابه مراعاته لمصلحة الطفل، وإعماله لمقصد حفظ النفس من جهة، ومن جهة أخرى وضعه شروطا لمن يتكفل بالطفل ليقوم مقام الوالد، وهي: الثقة، القدرة، الإسلام، والأخير ليحفظ عقيدة الطفل، وليس بدنه وحده.
والظاهر أن الشيخ راعي المصلحة في جميع أحواله حتى وإن خالفت النص الفقهي، فجمهور الفقهاء على أن “شرط الواقف كنص الشارع” ولكنه يرى، ومن ورائه السيد رشيد رضا، ألا يُعمل بنص الواقف إن خالف المصلحة، ومن ذلك مخالفته شرط الواقف في ملو صهريج مدرسة وقفية مرة كل عامين، وتوزيع مياهه على مرشحات ليشرب منها التلاميذ والمدرسون، أما علة المخالفة فهي أن فيه زيادة مصاريف، فضلا عن أنه لا يلائم الصحة، ولذا وافق الشيخ على طلب إدارة الوقف إدخال مياه الشرب عبر مواسير “لأن الماء يكون به أنقى، والمنفعة للوقف أوفى”[32].
ثالثا: الحداثة
وهي الأساس الثالث الذي بنى عليه اجتهاداته، وموقفه منها أكثر تركيبا من الضرورة والمصلحة، لأنه لا يقبل بها مطلقا، وإنما يقبل بعضها ويعرض عن البعض الآخر، ولديه أسبابه في الحالتين. أما ما يقبله من الحداثة فهو ما لا يتعارض مع نصوص الشريعة أو روحها، كمسألة الزي الغربي الذي لم ير بأسا في التزي به[33]، لكنه لم يسوغ ذلك فقهيا، كما فعل سلفه المهدي العباسي حين ناقش هذه المسألة بتوسع، واستخرج من بطون الكتب الفقهية بعض ممارسات تؤيد ذلك، وفند آراء المخالفين[34]. وكذلك يقبل ما يمكن للمسلمين الإفادة منه من علوم حديثة مثل الطب الذي توقف معاصروه عن قبوله عموما وفي المجال القضائي خصوصا، حيث كانت الدعاوى والجنايات تفحص وفق أدوات الإثبات الشرعي المؤلفة من: البينة، الإقرار، النكول، ويُقضى بين الناس بها، فلما ظهر الطب الحديث صارت “التقارير الطبية” تزاحمها بعد أن تبنتها الحكومة.
ولما كان الطب في ذلك الحين علما جديدا لم تثبت نجاعته بصورة قاطعة، فقد تردد العلماء في الأخذ به باعتباره أداة غير يقينية، خلافا للأدوات الشرعية (البينة، الإقرار، النكول)، الموصوفة باليقين ولا يعتريها الشك، إلا أن الشيخ عبده لم يشاطرهم الرأي، ونظر بعين التقدير إلى الطب، وعول عليه، فكان يقبل التقارير الطبية، ويعدها قرينة تضاف إلى القرائن الشرعية ويقضي بمقتضاها، ومن أمثلته إفتاؤه بالقصاص من المدعو عايد سليمان لأن” الكشف الطبي يثبت أن المقتولَين الذين اتُهم بقتلهما عايد سليمان مصابان بجروح راضة قطعية، وأن الجروح ناشئة من آلة صلبة، ذات حافة كمقطع الحديد التي توضع في النبابيت القصيرة، وعلى ذلك يكون القتل مما يعاقب عليه بالإعدام متى ثبتت التهمة”[35]. ويُلاحظ من هذا النص أن الشيخ طلب القصاص من المتهم اعتمادا على التقرير الطبي وحده، دون نظر في الأدلة الشرعية أو حتى إشارة عابرة إليها، ويؤيد ذلك ما ذهب إليه في فتوى أخرى حيث يقول: “رأيت أن ما قاله المتهم.. في محضر الضبط وفي محضر التحقيق، وما قاله الشهود، وما جاء في التحليل الكيماوي، كل ذلك يدل على صحة التهمة بالنسبة إليه”[36]، لكننا نلحظ هنا دمجه بين الطب وبين الأدوات الشرعية.
يوضح النصان السالفان تعويل الشيخ على الطب، وإنزاله منزلة الأدوات الشرعية، لكن هذا التعويل لم يتم عبر الطريق الفقهي المعتاد الذي كان يقضي بالبحث عن النصوص التي يمكن تأويلها والاستناد إليها، مثل إجازة الفقهاء شق بطن النساء لاستخراج الأجنة، والقياس عليها، أو الترجيح بين المنافع المرجوة منه والمضار المترتبة على استبعاده، وهي عمليات ضرورية لتوطين الطب ضمن المنظومة الفقهية، وهو ما يجعلنا نعتقد أن ما مارسه الشيخ هو “اجتهاد ناقص” إذ لا يكفي أن يتبنى المفتي رأيا، ويعمل به في بضع فتاوى حتى يصبح ذلك اجتهادا منه، وإنما الاجتهاد أن يؤصل لهذه الممارسة الجديدة، ويجد لها موطئ قدم لها ضمن المنظومة الفقهية وبنفس أدواتها، وأن يفند آراء المخالفين حتى يمكن اتخاذها أساسا في فتاوى لاحقة وتصير عادة متبعة، ولذلك كان على “صفيه وخليله” الشيخ “رشيد رضا” النهوض بعبء هذه المهمة الشاقة في فتاوى المنار، حيث غدت فتاويه حول جواز التشريح والكشف على جثث المتوفين، أساسا لإجازة العمل بالطب الحديث لدى الفقهاء، حتى أن هيئة كبار العلماء بالسعودية —بعد عقود— لم تجد ما تستند إليه في إجازة التشريح إلا من خلال الحجج التي ساقها[37].
ولم يقتصر توظيف عبده للعلم الحديث على الدعاوى والجنايات، وإنما رأى إمكانية الإفادة منه في العقائد، وذلك حين سئل من مفتي نابلس أن الطلبة الذين درسوا العلوم الحديثة يشككون في حدوث طوفان نوح، ويؤولون الأحاديث الواردة فيه تأويلا يصرفها عن تأويل العلماء الثقات، فأجاب أن الأحاديث الواردة فيه هي آحاد لا توجب اليقين، وأن الطوفان محل اتفاق أهل الأديان الذين يعتقدون أنه عم الكرة الأرضية، وتؤيدهم الكشوف العلمية، الدالة على وجود بعض الأصداف والكائنات البحرية فوق أعالي الجبال، وهو ما يدل على صعود الماء إليها مرة من المرات وأنه كان عاما، ويخلص في النهاية إلى أن هذه المسألة “تحتاج إلى بحث طويل وعلم غزير في طبقات الأرض وما تحتوي عليه، وذلك يتوقف على علوم شتى عقلية ونقلية”[38]، ومما يسترعي النظر أن الشيخ لم يعتب على هؤلاء الطلبة إقحامهم للعلوم الحديثة في فهم العقيدة وتفسيرها، وإنما اقتفى أثرها ووظف نتائج العلم الحديث للتدليل على حدوث الطوفان، بل ذهب بعيدا حين افترض أن تقرير هذه المسائل العقدية يكون بالاتحاد بين العلوم العقلية الحديثة والعلوم النقلية.
وعلى الجهة المقابلة تردد الشيخ في قبول بعض منتجات الحداثة، ويبدو أن معياره الذي يحتكم إليه في ذلك هو رفض ما يتعارض مع الشريعة ونصوصها مثل الربا، لكن المسألة ليست يسيرة كما يبدو، ذلك أن بعض مؤسسات الحداثة لا تمس الشريعة في إطارها الخارجي، وإنما تكمن المشكلة في القوانين التي تطبقها، أو المبادئ التي تحتكم إليها عند التشغيل، ولنضرب مثالين على ذلك، أولهما الهياكل الاقتصادية الحديثة من بنوك وشركات مضاربة وغيرها فهذه ظاهريا فيها “الحظ والمنفعة”[39] لجميع الأطراف، كما أخبره أحدهم، فأجازها دون تبصر بما تنطوي عليه من ربا ومخالفات شرعية، وبعد إقرارها عُرضت عليه بضع فتاوى تكشف عن مخالفتها فرفضه، ومن أمثلته رفضه للفوائد الربوية التي يُحصلها البنك من القروض التي يمنحها للمقترضين، واعتقاده جواز رد القرض بدون الفائدة كما أفتى بذلك[40]، وما ذهب إليه في فتوى أخرى لامرأة اشترت أسهما من شركة قناة السويس العالمية، ولما أرادت سحبها نازعتها الشركة “أن الزوجة لا يجوز لها أن تتصرف في أملاكها بغير إذن زوجها بالنظر للقانون الفرنساوي”[41] الذي تطبقه الشركة، وهو ما رفضه الشيخ لأنه “يجوز للزوجة —حسب الشريعة— استلام الأسهم، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها”، وهو جواب لا يتطرق إلى كيفية إلزام الشركة بذلك، أو كيفية إبطال ما يتناقض مع الشريعة في القانون الفرنسي المعمول به.
وثمة مظهر آخر رفضه الشيخ من الحداثة، وهو الروابط التي أوجدتها، والتي أخذت تحل شيئا فشيئا محل روابط الشريعة، وأعني روابط القومية والجنسية بين أبناء الوطن الواحد، والتي حلت بدرجة أو بأخرى، محل الرابطة العقدية، وكان الشيخ قد سئل عن المسلم إذا دخل بلدا إسلاميا (1) هل يصير من أهله وتجري عليه أحكامه، (2) وما هي الجنسية في الإسلام، (3) وهل حقوق الامتيازات الأجنبية موجودة بين الممالك الإسلامية؟
وافتتح الشيخ جوابه بمقدمة قرر فيها أن ولاء المسلم هو للشريعة وليس لغيرها، ذلك أنها “قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد لها على كل مسلم في أي محل حل وفي أي بلد ارتحل”[42]، ومنها انتقل إلى مناقشة السؤال المركزي المتعلق بماهية الوطن والوطنية؛ ولم يعتمد على الأدبيات المعاصرة التي عرفت الوطن، حيث عرفه حسين المرصفي بأنه “القطعة من الأرض التي تسكنها الأمة”[43]، وإنما صاغ تعريفا له بأنه “المحل الذي ينوي الإقامة فيه، ويتخذ فيه طريق كسبه لعيشه، ويقر فيه مع أهله إن كان له أهل، ولا ينظر إلى مولده ولا إلى البلد الذي ولد فيه”[44]، وذهب إلى أن الوطن وما يتولد عنه من الرابطة الوطنية لا يترتب عليها أي حكم شرعي، “إذ لا أثر لاختلاف البلاد في اختلاف الأحكام، إلا فيما يتعلق بأحكام العبادات من قصر الصلاة للمسافر وجواز الفطر في رمضان”،[45] وهو ما يعني أنها في حكم العدم تقريبا، إذ لا ينبي عليها أي حقوق أو واجبات أو حتى أثار معنوية بين المنتسبين إليها.
ويلحق بها “الجنسية”؛ فهي ليست معروفة عند المسلمين، ولا لها أحكام تجري عليهم، لا في عامتهم، ولا خاصتهم، وإنما هي معروفة عند الأمم الأوروبية، “وتشبه ما كان يسمى عند العرب عصبية”، وقد جاء الإسلام، وأبطل هذه العصبية ومحى آثارها، وسوى بين الناس جميعا، ولذلك “فالجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة” حسب قوله.
وأما “الامتيازات” فلا شيء منها يوجد بين الممالك الإسلامية، حتى المستقلة عن الدولة العثمانية، وما ناله الإيرانيون والمغاربة من الامتياز بالتقاضي إلى المحاكم المختلطة “يناقض أصول الشريعة كافة فلا أهل السنة يجيزونه ولا مجتهدو الشيعة يسمحون به”[46].
وفي الأخير لخص الشيخ ما ذهب إليه بعبارات يقينية من أن “هذا ما تقضي به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها، لا جنسية في الإسلام، ولا امتياز في الحقوق بين مسلم ومسلم، والبلد الذي يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده، ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره”[47].
وتثير هذه الفتوى مشكلة مزدوجة، أولها مخالفتها مسلك الدولة الرسمي وتوجهها نحو تكريس أفكار الوطنية والانتماء الوطني، ودعمها منذ أوائل القرن التاسع عشر، من خلال المقالات والرسائل والإجراءات الحكومية، الأمر الذي توج بإصدار أول قانون للجنسية المصرية عام 1895، والذي عرّف من هو المصري، وصاغ للمرة الأولى حقوقا له، ورتب عليه واجبات بصرف النظر عن دينه، وثانيها أن ما ذهب إليه الشيخ يغاير ما كتبه في مقال له بعنوان (الحقوق السياسية) نشره في نوفمبر عام 1881، عندما كان يشغل منصب محرر (الوقائع المصرية)، يؤصل فيه لفكرة الوطنية، مقررا أن للوطن ثلاثة حدود: الأول أنه موطن الإنسان وفيه الأهل والولد، والثاني أنه محل الحقوق والواجبات التي هي مدار الحقوق السياسية، وأما الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها فهي: حرية الرأي، وحرية القول، وحرية الانتخاب، وأما الواجبات فهي الحرص على شأن الوطن، وألا تمس المصلحة الفردية “المصلحة المقدسة الوطنية”، والثالث أنه موضع النسبة التي يعلو بها الإنسان، أو يسفل ويذل، وخلص إلى أنه ينبغي لأبناء الوطن —على اختلاف مشاربهم وتصوراتهم— أن يأتلفوا تحت “الجامعة الوطنية” لامتناع الخلاف والنزاع فيها[48].
ويكمن الاختلاف في مسألتين، الأولى ذكره أن الوطن يرتب على مواطنيه حقوقا وواجبات، وهي الفكرة التي نفاها في فتواه، والثانية قوله إن في الانتساب إليه إما رفعة أو تسفل، وهذا عين الجاهلية كما يقرر لاحقا، وإزاء هذا نكون أمام احتمالين، إما أن الشيخ عدل أو راجع بعض أفكاره، سيما أن بينهما ما يقرب من ربع قرن، وهي فترة زمنية تسمح بحدوث مراجعات فكرية، أو أن اختلاف المواقع قد أثمر هذا الاختلاف في الرؤى، وهو ما أرجحه، فالمقال صادر عن صحفي يكتب في المجال السياسي، وينقل عن مصادر أجنبية-كما صرح، ويعبر عما فيها من أفكار، على حين أن الفتوى صادرة عن فقيه يستند إلى التراث الفقهي، ويقتفي منهجيته ويعبر بلغته ومصطلحاته التي لا يستطيع الخروج عنها —ولو أراد، وإن صح هذا فهو يعني أنه لم يستطع من خلال الفتوى تمرير معتقداته السياسية، بشأن قبول “الفكرة الوطنية”، وعدم اعتبارها نقيضا أو على الأقل مزاحما للفكرة الدينية، والتي أوجدت جسرا بينه وبين رجال السياسة مثل سعد زغلول وغيره، وأن ثمة فجوة ظلت قائمة حتى أواخر أيامه بين الفكر وبين الفقه.
كيفيات الاجتهاد:
شكلت الضرورة والمصلحة والحداثة المنطلقات التي أقام عليها عبده اجتهاده الذي مارسه بصيغ وطرائق مختلفة، ربما لا تشبه طرائق الفقهاء المعاصرين، فتوسع في استخدام العقل ومال إليه، حتى وإن أعوزه النص، ولذا نجده في عدد من فتاويه يلجأ إلى التعليل العقلي ليفسر لمَ يتبنى رأيا معينا، ويأخذ التعليل بضع صيغ فهو إما تعليل عقلي محض، أو تعليل مستند إلى المكتشفات العلمية -كما بينا، أو إلى الأعراف والعادات، وربما امتزج بالأدوات الفقهية، وهو ما تبينه النماذج التالية.
هذا ويعد التعليل المجرد، المستند إلى قواعد العقل والمنطق، أظهر طرق الاجتهاد لديه، ومن أمثلته ما ذهب إليه في مسألة نفقة علاج الابن، هل تعد من النفقة الواجبة على الأب أم لا، وهي مسألة مربكة لأن النصوص الواردة فيها محدودة، ولم تتطرق إلى علاج الابن، وإنما نصت على عدم الوجوب بالنسبة للزوجة، من جهة أخرى، لم تكن مسألة نفقات العلاج مطروحة في العصور السالفة، وإنما هي مسألة نتجت عن ظهور الطب الحديث، وارتفاع تكلفة العلاج والأدوية، ولذلك فالنصوص ربما لا تسعف الفقيه، ولذلك كان عليه العروج عليها سريعا، والاحتجاج بالعقل واستنباط ما يفيد الوجوب، ومما ذهب إليه أن النفقة تجب على الأب لابنه الصغير بأنواعها، ويندرج تحتها أجرة الطبيب وثمن الأدوية على ما يظهر “لأن وجوب النفقة.. إنما هو للصلة والتراحم، وقد صارت مداواة الأمراض بعد تحققها، وغلبة الظن بإفسادها لمزاج البدن، من أشد ما يقضي به التراحم، ومن أوجب ما تحمل عليه الصلات، وقلما يوجد الآن ممن لهم أقل فهم من ينكر دخول المعالجة فيما تفرضه صلة الولد بولده، حتى أصبح الكثير من ذوي المعرفة الصحيحة يعدها في منزلة أعلى من النفقة العادية من الأكل والشرب…فمتى تحقق المرض وسوء أثره في الجسم تعينت النفقة.. وقاية من غائلة المرض وحفظا للحياة أو للأعضاء من التلف”[49].
ويعلق الشيخ على حجج المخالفين بقوله إن النصوص التي تفيد عدم الوجوب تصح إذا لم يُظن هلاك البدن أو فساد أعضائه، أما إذا غلب الظن بذلك، لم يكن هناك فرق بين العلاج وبين الطعام والشراب، فكلاهما ضروري لحفظ البنية. ومن ذلك يفهم أنه أقام تعليله على وجهين: بيان ما في الوجوب من المنافع، وكونه من حسن الصلة والتراحم، ودحض الآراء المخالفة وبيان وجه بطلانها.
وثمة نموذج آخر استخدم فيه الشيخ التعليل العقلي، ويبدو من خلاله عمق ملاحظاته بشأن التغيير الحاصل في البنية الاجتماعية المصرية، التي شهدت تفككا في البنية الاجتماعية مع بداية ظهور العائلة النووية، الأمر الذي يستوجب تغيير مماثل البنية القانونية، وهو ما يستشف من سؤال الجهادية حول ما المقصود بالقرابة وما هي درجاتها، ذلك أن القانون العسكري الصادر عام 1887 أشار في مادته الثانية إلى أن من يفر من عساكر الجهادية يلتزم أهله بالبحث عنه، فإن لم يجدوه يُؤخذ فرد من عائلته بدلا عنه.
ولما كانت هذه العقوبة لا تلقى قبولا منه، لم يقف عند ظاهر السؤال ببيان ماهية القرابة ودرجاتها، وإنما جهر بمعارضته لها، واعتبرها ماسة بعدالة الحكومة التي “لا يليق بها أن تعاقب شخصا بذنب آخر”، ودعا إلى إلغائها، وبنى ذلك على اعتبارات: منها ما هو عقلي من أنه لا يمكن أخذ الأب أو الجد عوضا عن الهارب بحكم أنهم أقرب الأقارب، ومنها ما هو اجتماعي حيث وهنت علاقات القربى ولم تعد كالسابق، وإنما تقلصت وتبدلت، ذلك “أن شأن العلاقات قد تغير في هذه السنين الأخيرة، فأصبح القريب أشد مقاطعة لقريبه من البعيد، وأصبحت روابط الأخوة لا قيمة لها في الأغلب، بل الأبناء قد خرجوا على سلطة آبائهم”[50]. وقوله لا يجانب الحقيقة ذلك أن عددا متزايدا من الأبناء في ذلك الحين كان قد خرج من مسكن الأسرة، “وانعزل” حسب تعبير الفتاوى، ولم تعد الأسرة المكونة من الجد والأبناء والأحفاد تقطن منزلا واحدا، وكان لهذا تداعيات قانونية واجتماعية رصدتها سجلات المحاكم الشرعية.
وعلى صعيد آخر اعتمد الشيخ النقاش الفقهي في عدد لا بأس به من الفتاوى، واستند فيه إلى الوسائل المعتادة من قياس واستحسان وترجيح وخلافه، ومن ذلك أنه سئل في مطلقة تقررت لها نفقة وأجرة حضانة لأولادها من المحكمة الشرعية، ولم يدفع الزوج شيئا مدة أربع سنوات، ثم تزوجت بغيره وصارت الحضانة لأمها، ثم طلقت من الزوج الثاني، فهل لها مطالبة الزوج الأول بما مضى من النفقة وأجرة الحضانة.
وذكر الشيخ في إجابته أن هناك قولين في المسألة؛ أحدهما سقوط النفقة بمضي شهر، إن لم تؤمر المرأة بالاستدانة من القاضي، والثاني عدم سقوطها متى قدرت بالرضاء أو القضاء وإن طال الزمان، ورجح الثاني لأنه “الموافق للعدل خصوصا في هذه الأزمان التي عمت فيها مماطلة الرجال لنسائهم في الوفاء بالنفقات … فلو أُخذ بالقول الأول أصبحت أحكام القضاة وما يجري بين أيديهم مما لا أثر له، وعد ذلك كله لغوا، فالقول الثاني هو الذي يجب أن يكون عليه العمل”، ولا يقتصر الشيخ على النفقة وإنما يرى وجوب حصول المطلقة على أجرة الحضانة، في المدة التي كانت خالية عن الأزواج، ولها المطالبة بها[51].
ومن الحالات التي استخدم فيها القياس قياسه الدوطة على المهور، ذلك أنه سئل في رجل مسيحي تعهد لابنته بمبلغ من النقود بصفة دوطة، حسب العوائد المسيحية، يدفعها لها عند الزواج، وتوفي الأب ولم يدفعها فهل تؤخذ من التركة، فأجاب بالإيجاب “فكما يلزم مبلغ المهر في ذمة والد الزوج إذا ألزم به نفسه، فكذلك يلزم مبلغ الدوطة في ذمة والد الزوجة، ويعتبر دينا لازما من الديون التي تلزم الذمة يؤخذ من التركة، ولا يجوز للورثة الامتناع عن تأديته”[52].
التقليد ودواعيه: نماذج تحليلية
أوضحنا فيما سلف جانبا من جوانب اجتهاد الشيخ وذكرنا نماذج في ذلك، وبقيت الإشارة إلى جانب مسكوت عنه من جوانب عمله الفقهي وهو التقليد، فما هي المسائل التي التزم فيها التقليد، وما العلل أو الدوافع التي تقف وراء ذلك، وغرضنا إعطاء صورة متكاملة عن عمله الفقهي الذي يتداخل فيه الاجتهاد مع التقليد، وبيان مدى الترابط بينهما، وأنه ليس بمقدوره، أو بمقدور أي مفتي آخر، تنحية التقليد جانبا، بل ربما كان في اتباعه صونا للحق ومراعاة للمصلحة.
يمكن الادعاء أن التقليد كان غالبا في أبواب الأحوال الشخصية من قبيل: الزواج، الطلاق، المهر، الحضانة، النفقة، الفرائض، وفي المعاملات المالية كالبيوع والإجارة والهبة والرهن، والشفعة، باستثناء الشركات. وهي تشكل النسبة الغالبة من الفتاوى التي أفتى فيها، وهذا النزوع إلى التقليد يحتاج إلى تعليل بحيث نستبين العلة وراء ذلك، وهو ما يمكن استنباطه من الفتاوى التالية:
سئل في رجل أحيا أرضا مواتا وأنفق فيها أموالا كثيرة حتى أصلحها، ومكثت تحت يده بعد ذلك ست عشرة سنة، وأرادت الحكومة أن تفرض عليه خراجا (ضرائب)، فأصدرت له مبايعة صورية للأرض، ورأى أحدهم الاستيلاء عليها وأخذها بالشفعة، استنادا لعقد البيع الصوري، فما حكم ذلك.
وتطرقت الإجابة إلى المسألتين الواردتين بالسؤال، وهما ما أقدمت عليه الحكومة من بيع الأرض، وهو ما يعني ضمنا أنها مالكة لها، وهو ما رفضه عبده استنادا إلى أن الأرض بمجرد إصلاحها صارت ملكا لمن أصلحها (أحياها)، وعليه “لم يكن للحكومة حق البيع، فالبيع الصادر منها قد صدر على غير ملك”، كما يقول، ورتب على ذلك بطلان حق الشفعة وعدم جوازه.
ويندرج ضمن هذا إقراره أن المشافهة أو ما يسمى في عرف الفقهاء “السماع الفاشي” هو وسيلة قانونية مقبولة، مثله مثل الوثائق والحجج المدونة، ويقصد بالسماع إعلان أحدهم أمام جمع من الناس أنه أوقف مكانا، أو وهب شخصا مالا، أو ما شابه ذلك من التصرفات القانونية، وهؤلاء ينقلونه لآخرين، حتى يصبح من السماع المنتشر والمعلوم بين الناس، حتى وإن لم تدعمه الحجج والوثائق، وهذه المسألة طرحت مع إرساء الجهاز البيروقراطي للدولة المصرية في منتصف القرن التاسع عشر، حيث صار لزاما على المصريين توثيق عقودهم ومعاملاتهم القانونية وحفظها في السجلات الحكومية، وما لا يتم توثيقه لا يعتد به كما أفادت المنشورات الحكومية، وهي مسألة سببت مشقة لكثيرين، لأن أوقافا وبيوعا وهبات من عهود سابقة لم تُسجل، اعتمادا على السماع والإشهاد، وقد انحاز عبده للسماع، واعتبره وسيلة قانونية مقبولة إن وجد من يشهدون به، إذ هو بمثابة الوثيقة، فكلاهما من صيغ الخطاب، ولا فرق بينهما، كما أفاد في فتوى له.
وفي هذين المثالين نلحظ التزامه بما نصت عليه المدونة الفقهية، ومخالفته للتوجه الرسمي الذي يرى الأرض ملكا للدولة، وأن الوثائق القانونية الحكومية هي وحدها المثبتة للملكية، وهو في هذا يقتفي أثر الفقهاء الموصومين بالتقليد؛ عليش والمهدي، وهذا النزوع للتقليد ما هو إلا لحفظ حقوق العباد، وعدم إهدارها أمام سلطة الدولة الآخذة في التمدد.
ومن أمثلة التقليد لديه تمسكه بعدم نبش قبور الموتى ونقل رفاتهم بعد دفنهم بغير ضرورة، وهي المسألة التي روجع فيها من الصحة التي شيدت مقبرة جديدة بدسوق، وأرادت نقل رفات الموتى إليها، وهو ما اعتبره عملا “غير جائز بالمرة، وإذا أرادت الصحة أن تمنع دفن الموتى فيها فلتمنعه، وتعين محلا آخر بالدفن، وتبقى المقبرة إلى أن تندثر وتبلى عظام موتاها ثم تصنع بها بعد ذلك ما يجوز شرعا في هذه الحالة”[53]، وعلة التقليد في هذه الحالة كما أفاد هي عدم وجود ضرورة شرعية للنقل، ومن ورائها عدم انتهاك حرمة الموتى.
ومن أمثلة تقليده، تمسكه بإقامة الحدود الشرعية، رغم إلغائها مع تحديث النظام القانوني المصري الذي استبدل العقوبات الشرعية (التعازير والحدود)، بعقوبات أخرى كالحبس والغرامة المالية، وكان قد سئل في رجل اعترف ببنوة ابنته ثم نفاها بعد طلاقه لأمها، وأجريت بينهما الملاعنة الشرعية بالمحكمة الشرعية وثبت بهتانه؛ (1) فهل يعد بذلك قاذفا يُحد حد القذف؟ (2) وإذا كانت السياسة قد أبطلت الحد الشرعي هل يُعاقب قانونا؟ (3) وهل قبوله ترتيب النفقة عليه لزوجته يسقط القذف والحد معا أو يمنع توقيع الحد؟
وافتتح الشيخ إجابته بما ورد في “كنز الدقائق” وشرحه من أنه إن أقر بولد ثم نفاه لاعن، وإن نفى ثم أقر يقام عليه الحد وفي الحالتين ينسب الطفل له، وعضده بنقل آخر من “الفتاوى الهندية” نقلا عن “محيط السرخسي” يفيد لزوم الطفل له ووجوب الحد عليه، وضم إليهما قوله تعالى “ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا” مشيرا أن من تمام الحد عدم قبول شهادته. وهذه النصوص غايتها تعزيز حجية الفتوى، والتأكيد على أن هذا ما تقضي به الشريعة، وليس رأيا يتبناه ويحق له الرجوع عنه.
واستنادا إلى النصوص يناقش الشيخ مسألة جواز إسقاط الحد أو استبداله، مشددًا على أنه “لا يجوز لأحد أن يقول إن اللعان حق مدني، له أن يطلبه ثم يرجع عنه، فإن ذلك غير صحيح، لأن طلب اللعان ثم الإقرار بالبنوة يحقق معنى القذف المستتبع للعقوبة”[54].
وإذا كان الشيخ قد التزم التقليد في هذه المسألة، وذهب إلى عدم جواز استبدال العقوبة الشرعية بأخرى وضعية، فإنه لم يشأ مناقشة من سيطبق الحد، لأن هذا من صلاحيات ولي الأمر، فإذا أهدره فمن يضطلع بتطبيقه، وبغض النظر عن ذلك فإننا نرجح أن علة التقليد في هذه المسألة هو الرغبة في إقامة الأحكام الشرعية، وعدم إسقاطها، خصوصا أن فتواه ليست إلا بيانا للحكم الشرعي الذي وضعه الشارع وليست واجبة التنفيذ كالحكم القضائي، ومن هنا كانت الدولة تغض الطرف أحيانا عن فتاوى المفتين إذا ما خالفت سياستها وتوجهاتها العامة.
وثمة نموذج آخر التزم فيه (قلّد) مقولات علم السياسة الشرعية، وهو يدور حول شخص روسي توفي وترك زوجة وابنة، ثم توفيت الابنة، وكان لها ورثة مقيمون بدار الإسلام، فهل يرثون أم لا يرثون؟ ذهب الشيخ إلى أنهم لا يرثون شيئا عن مورثتهم للاختلاف بين دارهم ودار المتوفاة، والاختلاف مانع من الإرث”، وقد قالوا: إن اختلاف الدارين باختلاف المنعة أي المعسكر والملك، ولا شك في مخالفة منعة الروس وملكهم لمنعة العثمانيين ومُلكهم”[55]،[56].
وفي هذا المثال تحضر مفاهيم علم السياسة الشرعية مثل: اختلاف الدارين، دار الإسلام ودار الحرب، بمدلولاتها المعرفية، وما ينبني عليها من أحكام، وهو ما يبرهن على تمسكه بما نصت عليه المنظومة الفقهية، وأنه لم يقم بعملية تأويل لجعل هذه المفاهيم أكثر ملائمة للمتغيرات السياسية في عصره، وهذا التأويل كان ضروريا في حقبة “الاستعمار” التي نتج عنها سقوط دار الإسلام في يد دار الحرب، وهو ما دفع بعض معاصريه مثل الشيخ محمد بيرم الخامس في ذات العام الذي سقط فيه وطنه تونس في يد الاحتلال الفرنسي إلى وضع (رسالة في دار الحرب وسكناها)، أعاد فيها تأويل مفهومي دار الإسلام ودار الحرب، ليجنب بلاده مصير جارتها الجزائر، حين أفتى وجوه العلماء بوجوب هجرة أهلها لأنها لم تعد دار إسلام، وذهب بيرم إلى أنه ليست هناك دار إسلام بالمعنى الفقهي الكلاسيكي؛ فلا توجد دولة قائم فيها الإسلام من كافة الوجوه؛ فهناك بلاد يحتجب فيها ولاة الأمر، ويُقلَّد من يخون المسلمين ولا يعرف شعائر الدين، وبلاد تُعطل فيها أحكام الشريعة وتطبق أحكام الكفر، وأخرى تبطل شعائر الشريعة وتصدع بها النواقيس وتعطل الدواوين أيام الآحاد،[57] وهذا التأويل كان ضروريا في ذلك الحين، لكن الشيخ عبده لم يسهم فيه على مستوى التنظير، وإن كان —ربما— أسهم فيه واقعيا بنشاطاته وعلاقاته. وهكذا ظلت الفجوة قائمة بين أفكاره وقناعاته بشأن قبوله بالدولة القومية الحديثة، ومفاهيمها، بل وإمكانية الإفادة من الاستعمار، وبين فتاويه التي تمسكت بما عليه علم السياسة الشرعية، وهو ما يتعذر تسويغه وتبريره.
الخاتمة:
انشغلنا في هذه الورقة ببحث قضيتي الاجتهاد والتقليد لدى الشيخ محمد عبده تطبيقا على النص الكامل لفتاويه، وقد مهدنا لذلك ببيان معالم منهجه في الإفتاء، وأشرنا إلى الاختلافات التي تميزه عن غيره من المفتين المعاصرين له.
وبسطنا القول في قضية الاجتهاد، واستظهرنا الأسس التي يستند إليها، وهي: الضرورة، والمصلحة، والحداثة، وسقنا نماذج عدة في ذلك، وخلصنا من بحثنا إلى أن اجتهاد الشيخ هو اجتهاد غير معلل أو بعبارة أدق غير مؤصل فقهيا، حيث بُني في بعض الحالات على التعليل العقلي وافتقر إلى النظر الفقهي، ولهذا لم يجد أنصاره وأتباعه من الفقهاء في فتاويه ما يمكن البناء عليه في اجتهادات لاحقة، ويبدو هذا جليا في فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا على وجه الخصوص.
كما تناولنا قضية التقليد، وبينا من خلال النماذج الدواعي التي دفعته لذلك، وما هي المسائل التي التزم فيها التقليد، وخلصنا من ذلك إلى اتساع رقعة التقليد لديه، وهو ما يعكس إيمانه بالتراث الفقهي، وصلاحيته —في مجمله— للتطبيق في عصره من جانب، واستوقفنا من جانب آخر أن أوضح مظاهر التقليد لديه تمثلت في تمسكه بمقولات ومفاهيم السياسة الشرعية، إذ لم يقم الشيخ بأي محاولة لتأويل مفاهيمها تأويلا عصريا يلبي احتياجات العصر، وفيما نعتقد فإن هذا يعبر عن إشكالية مزدوجة لديه، أولهما تتعلق بالفجوة أو بالأحرى الفصام القائم بين الفكر والفقه، على صعيد السياسة الشرعية على الأقل، وثانيهما تتعلق بكيفيات التغيير في الواقع، إذ اتضح لنا من خلال البحث أن الإصلاح لديه إنما يتحقق من خلال التربية والتثقيف والإصلاح الاجتماعي في الواقع، ولا يتحقق من خلال التنظير الفكري عبر المقالات والكتب، أو التقعيد الفقهي عبر الفتاوى والبحوث الفقهية، وانعكس هذا على الإنتاج الفكري للشيخ الذي اتسم عموما بالندرة، وعلى فتاويه التي أعوزها التأصيل الفقهي وخصوصا في النوازل المستجدة.
وتأسيسا على هذا كله، رجح لدينا من خلال البحث أن نعت الشيخ محمد عبده بالاجتهاد ونعت معاصريه بالتقليد لا يساعد في فهم الإنتاج الفقهي للشيخ، وإن شئنا فهما أدق له علينا البحث عن العلاقة المركبة بين الاجتهاد والتقليد، متى يجتهد وكيف يجتهد، ولماذا يقلد، وأيهما يحقق المصلحة من وجهة نظره؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دكتوراة في التاريخ من كلية الآداب جامعة القاهرة.
[1] فاطمة حافظ، الفتوى والحداثة: تطور علاقة الدولة بالشريعة في مصر القرن التاسع عشر، بيروت: مركز نماء، ص76.
[2] انصاف عمر مصطفى، وثيقة الفتوى: سؤال المجتمع وفقه الإجابة، قراءة وثائقية في فتاوى الإمام محمد عبده، القاهرة: المجلة العلمية للمكتبات والوثائق، مج 20 ع 4، يوليو 2020، ص 223.
[3] محمد عبده، فتاوى الإمام محمد عبده، القاهرة: دار الوثائق القومية، 2017-2022، 1/161.
[4] المرجع السابق، 2/212.
[5] نفسه 2/213.
[6] نفسه، 2/154.
[7] نفسه،2/71.
[8] نفسه، 2/77.
[9] نفسه، 2/84.
[10] نفسه 53 /2.
[11] نفسه، 2/57
[12] نفسه، 397/2
[13] نفسه، 359/2
[14] فتاوى الإمام محمد عبده، 2/134
[15] نفسه، 125/1
[16] نفسه، 2/200
[17] نفسه، 1/133.
[18] نفسه، 1/133
[19] نفسه، 1/133
[20] نفسه 1/398.
[21] نفسه 2/146
[22] أنظر أمثلة لهذا الخروج في: فتاوى الإمام محمد عبده، 1/132، 1/127.
[23] نفسه 2/251
[24] نفسه 2/241
[25] يمكن أن نذكر مثالا لذلك بفتوى تمليك الأرض الزراعية للفلاحين التي خالف فيها الشيخ عليش رأي المذهب مفترضا أن المصلحة تقتضي التمليك، وقد افتتحها بنصوص المذهب ثم آراء المتأخرين ثم بسط رأيه في المسألة وبين دواعي مخالفته لرأي المذهب، أنظر: أبو عبد الله محمد أحمد عليش المالكي، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، القاهرة: دار الفكر، 19572، 2/244-246.
[26] فتح العلي المالك، 1/91.
[27] محمد العباسي المهدي، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية، القاهرة: المطبعة الأزهرية، 1301-1304ه، 3/369.
[28] فتاوى الإمام محمد عبده، 13/1
[29] المرجع السابق، 95 /1
[30] نفسه، 97/1.
[31] نفسه، 6/1
[32] نفسه، 242 /1.
[33] نفسه، 359/2
[34] الفتاوى المهدية، 5/ 305-309.
[35] فتاوى الإمام محمد عبده، 118 /2
[36] نفس المرجع السابق، 125 /1
[37] محمد رشيد رضا، فتاوى المنار، القاهرة: مجلة المنار، مج 9، 1906، ص 856-859. ومج 10 358-359.
[38] فتاوى الإمام محمد عبده، 398/1
[39] المرجع السابق، 157/1
[40] نفسه، 1/151
[42] فتاوى الإمام محمد عبده، 360/2
[43] حسين المرصفي، الكلم الثمان، القاهرة:1881، ص 16.
[44] فتاوى الإمام محمد عبده، 361/2
[45] المرجع السابق، 360/1.
[46] نفسه، 362/2
[47] نفسه، 362/2
[48] الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، تحقيق: محمد عمارة، ج 3، الكتابات السياسية 370، الشروق 2009.
[49]فتاوى الإمام محمد عبده، 1/102
[50] نفسه، 396/2.
[51] فتاوى الإمام محمد عبده، 100/1.
[52] المرجع السابق، 13-14/1
[53] فتاوى الإمام محمد عبده، 138 /1
[54] فتاوى الإمام محمد عبده، 98/2.
[55] اختلاف الدارين مصطلح فقهي، ويقصد به الفقهاء اختلاف المنعة، وفسروا المنعة بالعسكر واختلاف الملك والسلطان، كأن يكون أحدهما بالهند وله دار ومنعة والآخر في الترك وله دار ومنعة أخرى، وانقطعت بينهما العصمة حتى إن أحدهما يستحل قتل الآخر، أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: ذات السلاسل، 3/28.
[56] فتاوى الإمام محمد عبده، 2/85
[57] محمد بيرم بن مصطفى، الرياض، جامعة الملك سعود، رسالة في دار الحرب وسكناها، رقم 3456، ق10 (مخطوط).
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies