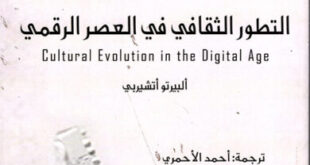الصفحات التالية من كتابه القيم رسالة في الطريق إلى ثقافتنا*
لمحمود محمد شاكر**
- ” الثقافة” فى جوهرها لفظ جامعٌ يُقصد بها الدلالة على شيئين أحدهما مبنى على الآخر، أي هما طوران متكاملان:
الطور الأول: أصول ثابتة مكتسبة تنغرس فى نفس “الإنسان” منذ مولده ونشأته الأولى حتى يشارف حد الإدراك البيِّن، جِماعُها كل ما يتلقاه عن أبويه وأهله وعشيرته ومعلميه ومؤدبيه حتى يصبح قادرًا على أن يستقل بنفسه وبعقله، وتفاصيل ما يتلقاه الوليد حتى يترعرع أو يراهق، تفوت كل حصر بل تعجزه. وهذه الأصول ضرورة لازمة لكل حي ناشيء في مجتمع ما، لكي تكون له “لغة” يبين بها عن نفسه، و “معرفة” تتيح له قسطًا من التفكير يعنيه على معاشرة من نشأ بينهم من أهله وعشيرته. وهذا على شدة وضوحه عند النظرة الأولى لأنك أَلِفتَهُ، لا لأنك فكرت فيه وعمقت التفكير، هو حقيقته سر ملثم يحير العقول إدراك دفينه، لأنه مرتبط أشد الارتباط، بل متغلغل في أعماق سِرَّين عظيمين غامضين هما: سر “النطق” وسر “العقل” اللذان تميز بهما “الإنسان” من سائر ما حوله من الخلق كله، وتحيرت عقول البشر في كيف جاءا ؟ وكيف يعملان؟ لأن “الإنسان” لم يشهد خلق نفسه حتى يستطيع أن يستدل بما شهد، لكى يصل إلى خبيء هذين السرَّين الملثمين المستغلقين البعدين، وإن توهم أحيانًا بالإلف أنهما قريبان واضحان.
ولأن “الإنسان” منذ مولده قد استودع فطرة باطنة بعيدة الغور فى أعماقه، توزعه، (أى تُلْهِمُه وتحركه)، أن يتوجه إلى عبادة رب يدرك إدراكًا مبهمًا أنه خالقه وحافظه ومعينه، فهو لذلك سريع الاستجابة لكل ما يلبي حاجة هذه الفطرة الخفية الكامنة في أغواره. وكُلُّ ما يلبي الحاجة، هو الذي هدَى الله عباده أن يسموه “الدين“، ولا سبيل البتة إلى أن يكون شيء من ذلك واضحًا في عقل الإنسان إلا عن طريق “اللغة” لا غير، لأن “العقل” لا يستطيع أن يعمل شيئا، فيما نعلم، إلا عن طريق “اللغة”. فالدين واللغة، منذ النشأة الأولى، متداخلان تداخلا غير قابل للفصل، ومن أغفل هذه الحقيقة ضل الطريق وأوغل في طريق الأوهام. هذا شأن كل البشر على اختلاف مللهم وألوانهم، لاتكاد تجد أمة من خلق الله ليس لها “دين” بمعناه العام، كتابيا كان، أو وثنيا، أو بدعا، (“البدع”، الدين ليس له كتاب أو وثن معبود).
ولذلك، فكل ما يتلقاه الوليد الناشئ في مجتمع ما، من طريق أبويه وأهله وعشيرته ومعلميه ومؤدبيه، من “لغة” و “معرفة” = يمتزج امتزاجا واحدا في إناء واحد، ركيزته أو نواته وخميرته دين أبويه ولغتهما، وأبلغهما أثرا هو “الدين”. فالوليد فى نشأته يكون كل ما هو “لغة” أو “معرفة” أو “دين” متقبلا فى نفسه تقبل “الدِّين”، أي يتلقاه بالطاعة والتسليم والاعتقاد الجازم بصحته وسلامته، وهذا بَيِّنٌ جدًّا إذا أنت دققت النظر فى الأسلوب الذى يتلقى به أطفالك عنك ما يسمعونه منك، أو من المعلم في المراحل الأولى من التعليم. ويظل حال الناشئ يتدرج على ذلك، لا يكاد يتفصَّى شيء من معارفه من شيء، ( “يتفصى” : أى يتخلص من هذا المضيق) حتى يقارب حد الإدراك والاستبانة، ولكنه لا يكاد يبلغ هذا الحد حتى تكون لغته ومعارفه جميعا قد غمست في”الدين” وصبغت به. وعلى قدر شمول “الدين” لشؤون حياة الإنسان، وعلى قدر ما يحصل منه الناشئ، يكون أثره بالغ العمق في لغته التى يفكر بها، وفي معارفه التى ينبني عليها كل ما يوجبه عمل العقل من التفكير والنظر والاستدلال. فهذه هى الأصول الثابتة المكتسبة فى زمن النشأة على وجه الاختصار.
الطور الثاني: فروع منبثقة عن هذه الأصول المكتسبة بالنشأة. وهي تنبثق حين يخرج الناشئ من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير. وإنما سميت “الطور الأول” : “إسار التسخير”، لأنه طور لا انفكاك لأحد من البشر منه منذ نشأته في مجتمعه. فإذا بلغ مبلغ الرجال استوت مداركه، وبدأت معارفه يتفصى بعضها من بعض، أو يتداخل بعضها في بعض، ويبدأ العقل عمله المستتب فى الاستقلال بنفسه، ويستند بتقليب النظر والمباحثة وممارسة التفكير والتنقيب والفحص، ومعالجة التعبير عن الرأى الذى هو نتاج مزاولة العقل لعمله، فعندئذ تتكون النواة الجديدة لما يمكن أن يسمى “ثقافة“.
وبيِّنٌ أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو “اللغة” و”المعارف” الأُوَل التى كانت فى طورها الأول مصبوغة بصبغة “الدين” لا محالة، حتى لو استعملها في الخروج على “الدين” الموروث ومناقشته رفضا له أو لبعض تفاصيله. هذه حال النَّشَأِ الصغار حتى يبلغوا منزلة الإدراك المستقل المفضى إلى حيز “الثقافة”.
- و”ثقافة” كل أمة وكل “لغة” هى حصيلة أبنائها المثقفين بقدر مشترك من أصول وفروع، كلها مغموس فى “الدين” المتلقى عند النشأة. فهو لذلك صاحب السلطان المطلق الخفي على اللغة وعلى النفس وعلى العقل جميعا، سلطان لاينكره إلا من لا يبالي بالتفكر فى المنابع الأُوَل التى تجعل الإنسان ناطقا وعاقلا ومبينا عن نفسه، ومستبينا عن غيره. فثقافة كل أمة مرآة جامعة فى حيزها المحدود كل ما تشعت وتشتت وتباعد من ثقافة كل فرد من أبنائها على اختلاف مقاديرهم ومشاربهم ومذاهبهم ومداخلهم ومخارجهم فى الحياة. وجوهر هذه المرآة هو “اللغة”، و”اللغة” و”الدين”، كما أسلفت، متداخلان تداخلا غير قابل للفصل البتة.
فباطل كل البطلان أن يكون فى هذه الدنيا على ما هى عليه، “ثقافة” يمكن أن تكون “ثقافة عالمية“، أى ثقافة واحدة يشترك فيها البشر جميعا ويمتزجون على اختلاف لغاتهم ومللهم ونحلهم وأجناسهم وأوطانهم. فهذا تدليس كبير، وإنما يراد بشيوع هذه المقولة بين الناس والأمم، هدف آخر يتعلق بفرض سيطرة أمة غالبة على أمم مغلوبة، لتبقى تبعا لها. فالثقافات متعددة بتعدد الملل، ومتميزة بتميز الملل، ولكل ثقافة أسلوب فى التفكير والنظر والاستدلال منتزع من “الدين” الذى تدين به لا محالة.
فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش، ولكن لا تتداخل تداخلا يفضي إلى الامتزاج البتة، ولا يأخذ بعضها عن بعض شيئا، إلا بعد عرضه على أسلوبها فى التفكير والنظر والاستدلال، فإن استجاب للأسلوب أخذته وعدلته وخلصته من الشوائب، وإن استعصى نبذته وأطرحته. وهذا باب واسع جدا ليس هذا مكان بيانه، ولكنى لا أفارقه حتى أنبهك لشئ مهم جدا، هو أن تفصل فصلا حاسما بين ما يسمى “ثقافة” وبين ما يسمى اليوم “علما”، (أعنى العلوم البحتة)، لأن لكل منهما طبيعة مباينة للآخر، فالثقافة مقصورة على أمة واحدة تدين بدين واحد، والعلم مشاع بين خلق الله جميعا، يشتركون فيه اشتراكا واحدا مهما اختلفت الملل والعقائد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* محمود محمد شاكر (1987). رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. القاهرة: مطبعة المدني.
** محمود محمد شاكر “أبو فهر” أديب مصري (1909- 1997م)، دافع عن العربية في مواجهة التغريب. اطلع على كتب التراث وحقق العديد منها. أقام منهجه الخاص في الشعر وسماه منهج التذوق. خاض الكثير من المعارك الأدبية حول أصالة الثقافة العربية، ومصادر الشعر الجاهلي.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies