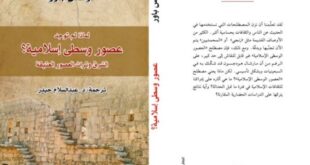هدف الكتاب، الماثل أمامنا، هو تقديم صورةٍ شاملةٍ متكاملةٍ عن أصل الوجود الكوني؛ وإيجاد رؤية ٍكونيةٍ خاصةٍ جداً Weltanschauung، مُفسرةٍ لكل شيء؛ من خلال مزيد من التنقيب والتدقيق في مجال العلوم الطبيعية، وفيما وراء هذا المجال أيضاً. إن تقديم تلك الرؤية الخاصة جداً – كما يؤكد “توماس ناجل Thomas Nagel” مؤلف الكتاب – ليس بمَهمةٍ سهلةٍ على الإطلاق. فبمقتضى تلك الرؤية، سيتم إسقاط فرضيات ونظريات علمية، تبوأت لعقودٍ طويلة الصدارة والأولوية في التفسير العلمي للكون؛ وأهمها النظرية التطورية الداروينية، وما يندرج تحتها من فرضياتٍ أساسية، أبرزها فرضية “المادية الاختزالية Material Reductionism”، وفرضية “الانتخاب الطبيعي Natural Selection”.
وقد تكمن صعوبة نشر تلك الرؤية الكونية الجديدة في تواجدها وسط “بيئةٍ علميةٍ فاسدةٍ”، كما يُسميها المؤلف. تلك البيئة التي تُجَرم كل من يشكك في تلك الفرضيات والنظريات العلمية السائدة المسيطرة. وعلى الرغم من عدم قناعة المؤلف بالتفسير الإيماني المقاصدي – الذي يمكن أن يكون ممثلاً لتلك الرؤية الكونية الجديدة، وبديلاً عن الرؤية “المادية الاختزالية” – إلا أنه لا يُخفي تأييده لأي تحدٍ مقاومٍ للتفسير “العلمي” المعهود، والقائم على فرضيتي “المادية الاختزالية” و”الانتخاب الطبيعي”.
قسَم “توماس ناجل”، أستاذ الفلسفة بكلية القانون بجامعة “نيويورك”، كتابه المؤلَف من 130 صفحة – الصادر عن دار نشر جامعة “أوكسفورد” في عام 2012 – إلى ستة أقسام: الافتتاحية، معارضة الاختزالية والقانون الطبيعي، الوعي، المعرفة، القيمة، الخلاصة.
يتطرق المؤلف بدايةً إلى تناول الصراع القائم بين مؤيدي “المادية الاختزالية” (أي اختزال كل شيء في الكون إلى المادة) وبين مُعارضيها. فبينما يعتقد “الماديون الاختزاليون” – عن قناعةٍ مطلقة – في مسألة الوضوح الكوني، لدرجةٍ تجعل المرء لا يُفسره فقط، بمنتهى الوضوح عبر القانون الطبيعي، بل تجعله أيضاً يفهمه ويستوعبه، يعتقد “التوحيديون” – على النقيض – في مسألة العقل الذي يُمثل الأصل في تفسير كل شيء، بما فيه تفسير القوانين الطبيعية. إلا أن هذين المعتقدين، كما يؤكد “ناجل”، لا يدحضان الشكوك والهواجس حول قضية وجود الكون؛ فكلاهما عاجزان عن الإجابة على تساؤلات أساسية؛ وهو الأمر الذي يدفع المؤلف، ويجعله طامحاً نحو فهمٍ متجاوز لذواتنا، لا مادي اختزالي ولا توحيدي.
اكتشف المؤلف وجود عقبات كبيرة أمام التصور المادي الاختزالي للكون؛ عقباتٍ تدحض النظرية المادية الاختزالية التطورية الداروينية. لخص تلك العقبات في الوعي، المعرفة، القيم. بمعنى آخر، لقد ارتأى “ناجل” فشل “المادية الاختزالية” – على مر العصور – في تفسير وجود الوعي والمعرفة والقيم تفسيراً علمياً منطقياً.
إن إشكالية العقل/ الجسد، كما يشير المؤلف، ليست وليدة اليوم، بل هي وليدة القرن السابع عشر الميلادي؛ وليدة الثورة العلمية حينذاك. قاد تلك الإشكالية كلٌ من “رينيه ديكارت Rene Decartes” و”جاليليو جاليلي Galilio Galilei”؛ كان همهما هو إدخال العقل ضمن الصورة الفيزيائية للكون. كان هدفهما هو الفصل بين الوصف الحيادي الكمي الدقيق للحقائق الخارجية وبين الوصف الشخصي – بناءً على عقل ووعي كل إنسان – للعالم الخارجي. كان طرحهما بمثابة التحدي للمنهج المادي التطوري المهيمن. كانا يحاولان تجاوز التفسير المادي، وطرح (بدلاً منه) تفسير موحد عن كيفية نشوء وتطور الصفات الفيزيائية الملموسة مع الصفات العقلية الذاتية في نفس الوقت. وإلى جانب “ديكارت” و”جاليليو” كان هناك أيضاً “توم سوريل Tom Sorell” الذي قرر بالمثل دخول هذا التحدي العلمي، مُعلناً عن نظريته حول الــNeutral Monism أو “الأحادية المحايدة”، والتي سنتحدث عنها لاحقاً.
يثني المؤلف على جميع تلك المحاولات، من قِبل العلماء، لإسقاط “المادية الاختزالية” والرواية الداروينية البيولوجية؛ إلا أنه لم يجد في جميع تلك المحاولات إجابةً شافيةً عن أسئلته المستمرة حول ماهية الحياة قبل ظهور الكائنات الحية العاقلة؛ كما لم يجد في تلك المحاولات التصور المناسب لحل المسائل التاريخية.
ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى العقبة أو الإشكالية الثانية، وهي إشكالية منطق المعرفة، طارحاً التساؤل الآتي: كيف نُمنطق المعرفة في ظل الرواية البيولوجية التطورية؟ فالمعرفة – مثلها مثل الوعي – ترى باطن الحقائق لا ظاهرها. وهو ما لا يتفق مع الرواية البيولوجية التطورية المادية التي لا تعترف إلا بظواهر الحقائق المرئية المحسوسة، ولا تعترف إلا بالمادة كأصل أو كمرجع وحيد للحقيقة؛ الأمر الذي يدفع المؤلف إلى الحديث عن التفسير الإيماني المقاصدي الذي يضع المسائل الباطنية، المتجاوزة لظواهر الأشياء، في الاعتبار…والذي لم يتم إجازته علمياً. وعلى الرغم من تقدير المؤلف لذلك التفسير الإيماني، كمحاولة لإجهاض الفكر المادي الاختزالي، إلا أنه يقر بعدم اعتقاده في ذلك التفسير، ولا حتى في تفسير “الصدفة” الذي تتبناه الرواية الداروينية. فهو الأكثر ميلاً إلى التفسير الغائي أو الـteleological الذي يفترض بأن لوجود الكون غاية، ولكنها منفصلة عن الدين.
وإذا كان الوعي والمعرفة يمثلان عقبتين في وجه النظرية التطورية، فإن القيم تشكل العقبة الكبرى. فالقيم تعتمد أكثر على الحس الأخلاقي والموقف الشخصي. كذلك، فإن القيم تشكل محوراً مركزياً في الحياة الآدمية. فالإنسان كائن ينقاد بالقيم، ولا ينقاد فقط برد فعله لخبرات الألم والمتعة، كما تفترض الرؤية التطورية الداروينية المادية. والعالم يعرف القيم منذ نشوء الحياة؛ بل إن للقيم علاقة وطيدة بقدرات التحكم النابعة من شخصية الإنسان. إلا أن التصور الدارويني لا يستوعب كل ذلك. بمعنى آخر، هناك “منطقة عتماء” في الرؤية الداروينية للإنسان صاحب القيمة والمقصد. وهو الأمر الذي يفرض السؤال التاريخي مرة أخرى من قبل المؤلف: كيف كان شكل الحياة في بدايتها؟
ومن الذين انتصروا لقضية القيم، وأخرجوها عن إطار النظرية التطورية، الباحثة “شارون ستريت Sharon Street” التي فصلت بين الحقائق القيمية الأخلاقية وبين الحقائق الطبيعية الواقعية، مؤكدةً أن الحقائق القيمية لا يمكن ردها إلى الوقائع. إن إشكالية القيم، كما تقول “ستريت”، تفرض الصراع بين الواقعية التي تعترف فقط بالحقائق الطبيعية الملموسة وبين الشخصانية التي تضع المواقف الشخصية القيمية في أعلى اعتبار.
وفي خلاصة كتابه، أشار المؤلف إلى الحُجج – التي قدمها بكل صبرٍ وتأنٍ – من أجل إسقاط النظرية التطورية الداروينية والفكر المادي الاختزالي، أو الشكل المعتاد للتفسير “العلمي”. إلا أنه أقر في الوقت ذاته بعدم وجود بديل؛ وهو ما يتطلب خروجاً أكبر على الأشكال المتعاهد عليها للتفسير الطبيعي المادي.
افتتاحية الكتاب
يناقش المؤلف، في افتتاحية كتابه، تحديه لفرضية “المادية الاختزالية”، ومقاومة المجتمع العلمي لذلك التحدي. فعلى الرغم من عدم منطقية تلك الفرضية، إلا أن المجتمع العلمي ما زال يعتبرها الرؤية العلمية الأصيلة؛ فأي مقاومة لها لا تعد فقط خطأً من الناحية العلمية، بل من الناحية الفلسفية أيضاً.
يصب المؤلف هجوماً لاذعاً على تلك الفرضية، مؤكداً أنه لمن الخبل والسذاجة الاعتقاد بأن الحياة التي نعيشها هي مجرد نتاج حوادث فيزيائية متعاقبة، أو نتيجة عملية “الانتخاب الطبيعي”. إن فرضية نشوء الحياة من العدم أو المادة الميتة، ثم تطورها (عبر آلية “الانتخاب الطبيعي” Natural Selection و”الطفرة العرضية” Accidental Mutation) إلى الأشكال الحية التي نراها اليوم، هي فرضية خاصة بمشروع علمي، وليست فرضيةً علميةً مُحكمةً مؤكدة.
يعرض المؤلف شكوكه ضد تلك الفرضية، ملخصاً تلك الشكوك في سؤالين: أولاً، على اعتبار وجود قاعدة كيميائية لعلم الأحياء والوراثة، كيف يمكن لظاهرة التكاثر التواجد بصورة تلقائية منذ الأزل، نتيجةً فقط لتفاعل قوانين الفيزياء والكيمياء؟ ثانياً، كيف يمكن للـ”طفرات الجينية” Genetic Mutations الحدوث بصورةٍ كافيةٍ لإحداث عملية “الانتخاب الطبيعي” الناتج عنها هذا الكم الهائل من الكائنات الحية التي نشهدها اليوم؟
إن مثل هذه الشكوك لا تثير المؤلف فقط، بل تثير أيضاً مجموعة من العلماء في وسط الجماعة العلمية؛ وهو الأمر الذي شجع المؤلف على حذو ذلك المنهج المعارض للفرضية الداروينية. ففي الآونة الأخيرة، ظهرت مجموعة من العلماء توجه سهام النقد تجاه الداروينية، سواءً من مدخل ديني، أو من مدخل الدفاع عن فرضية “التصميم الذكي” Intelligent Design (أن وراء إيجاد هذا الكون “مصمم ذكي”). كان أبرز هؤلاء العلماء القليلين، “ستيفين ماير Stephen Meyer”، و”مايكيل بيهي Michael Behe”، و”ديفيد برلينسكي David Berlinski”.
إلا أن الإجماع العلمي الأرثوذكسي السائد، كما يقول “ناجل” آسفاً، ضرب بكل تلك الشكوك عرض الحائط. فعلى الرغم من مواجهة ذلك الإجماع إشكاليات علمية جسيمة، فإن البيئة العلمية – التي نشأنا فيها – ما زالت مُصرةً على تبني ذلك الفكر التطوري الدارويني، معتبرةً إياه المقدس sacrosanct، وأن ما عداه ليس علماً. ومن ثم، تتجاهل تلك البيئة “العلمية” – بل تهاجم – كل باحث أو عالم معارض لها.
ويخرج “ناجل” من تلك الشكوك بفرضيتين؛ أولها: أن هناك أشياء معينة لا يمكن تفسيرها عبر الصدفة، إذا كنا نريد فعلاً فهم هذا الكون فهماً حقيقياً. ثانياً، أن هناك قانون طبيعي واحد، يوحد كل شيء على أساس مجموعة مباديء معروفة. وبالرغم من عدم قناعته الكاملة بالتفسير “التوحيدي” للحياة، وكذلك بفرضية “التصميم الذكي”، إلا أنه يحيي أصحاب تلك التفاسير المختلفة، لمجرد تحديهم للرؤية العلمية المهيمنة.
مناهضة المادية الاختزالية والقانون الطبيعي
في هذا الفصل، يتناول المؤلف الصراع القائم بين “الطبيعة العلمية” Scientific Naturalism وبين “المناهضة للاختزالية” Anti-Reductionism. فبينما تفترض “الطبيعة العلمية” ارتداد كل شكلٍ من أشكال الحياة إلى العلوم الطبيعية والفزيائية (ولاحقاً علوم الإحياء)، تفترض “المناهضة للاختزالية” عدم ارتداد جميع أشكال الحياة إلى العلوم الطبيعية والفيزيائية، وإنما ارتداد الكثير من تلك الأشكال – مثل العقل والوعي والمعرفة والمعنى والنية والفكر والغاية والقيمة – لما هو وراء الطبيعة والفيزياء والأحياء. فكيف يمكن مثلاً تفسير العقل تفسيراً فيزيائياً؟ وهو شيء متجاوز للمادة، بما يتضمنه من معانٍ وقيم؟
إن أصحاب مذهب “الطبيعة العلمية” أو “الطبيعة المادية” على قناعةٍ تامة بفرضية الوضوح الكامل للكون؛ فيؤمنون بوجود “قانون طبيعي واضح”، يفسر الكون بأسره؛ فلولاه لما استطعنا فهم واستيعاب الكون كما نفهمه الآن، ولولاه لما تم اكتشاف جميع تلك الإنجازات والتطورات العلمية. فالقانون الطبيعي، بالنسبة لمذهب “الطبيعة العلمية”، إنما هو قانون مُدشن في أبسط قوانين الفيزياء، حاكماً لأبسط العناصر؛ لذلك يوصف بأنه “نظرية كل شيء”. إن أصحاب هذا المذهب يرون في العلوم الطبيعية المفتاح الأساسي لفهم كل ظواهر الكون بمنتهى الوضوح؛ حتى العقل فسروه علمياً كنتيجةٍ بيولوجية متميزة للقانون الطبيعي. ومن ثم، فعلى حسب رؤيتهم، فإنه لا حاجة لمزيدٍ من الفهم، على اعتبار أن كل شيء قد أضحى بالعلم واضحاً. فهم يؤمنون بإمكانية تفسير كل شيء – مبدئياً – عبر القوانين التي تحكم الكون الفيزيائي.
كانت نظرية “التطور” خطوةً أساسيةً على طريق تشكل الرؤية “المادية الاختزالية” المتمحورة حول فكرة مثالية الكمال، حيث تقدم نظرية التطور تصوراً عاماً عن كيفية تطور الحياة بعد بدءها. فالحياة – من المنظور المادي الاختزالي – كانت نتاجاً لعمليات كيميائية محكومة بقوانين الطبيعة؛ ثم جاء “التطور” فيما بعد ليصير نتاجاً لعمليات كيميائية عرضية، ومنها عملية “الانتخاب الطبيعي”.
أما القطب المقابل لمذاهب “المادية الاختزالية” و”الطبيعة العلمية”، فهم يطلقون على أنفسهم إسم “التوحيديين” Theists الذين يرون أن العقل [الإلهي] – وليس القانون الطبيعي – هو الذي يقدم التفسير لكل شيء؛ بما فيه تفسير القوانين الطبيعية الأساسية. فالقانون الطبيعي هو نتيجة لذلك العقل، وليس العكس كما تفترض “المادية الاختزالية”، على حسب ما أورد “ناجل”.
تعتبر نظرية “التوحيد” Theismالعقل والمقصد مسئولين عن الصفة الفيزيائية والعقلية للكون. إن ميزة نظرية “التوحيد” – حتى بالنسبة للملحد – هي محاولتها تفسير الكون والحياة بصورةٍ لا تبدو ممكنة في مجال العلوم الطبيعية. فقد تتعامل نظرية “التوحيد” – بخلاف نظرية “التطور” – مع مصدر العقل المتجاوز الذي يمتلك الفهم والغاية من خلق الكون؛ وتجعل مسألة البحث عن الوضوح الكوني خارج العالم المرئي المحسوس؛ وتفترض بأن الإله حرٌ، لا تحكمه قوانين الطبيعة، ومن ثم ليس جزءاً من القانون الطبيعي.
وبالرغم من إشادة المؤلف بنظرية “التوحيد” إلا أنه يشوبها، من وجهة نظره، الكثير من النقص. فهي لا تفسر، مثلاً، كيف تتلاءم أو تتناسب الكائنات الإنسانية مع الكون؛ ولا تفسر كيف خُلق الكون من عدم؛ وكيف وُجد الضمير والعقل. هذا بالإضافة إلى أنها تتضمن تعاليم ومعتقدات لدينٍ معين، ومن ثم تقدم تفسيراً جزئياً للكون، كما يرى “ناجل”.
يحاول الاقترابان – “التوحيد” و”التطور” – تقديم تفسير لذواتنا من الخارج؛ يحاولان تقديم تفسير عن كيفية الاعتماد على ملكاتنا من أجل فهم الكون من حولنا. فمن ناحية، تقوم مدرسة “التوحيد” الإيمانية على فكرة الإله المسئول عن ملكاتنا، ومن ثم استحالة إيذائه لنا. ومن الناحية المناقضة، تفترض مدرسة “التطور” أن الملكات الحسية والإدراكية، التي وُجدت في ظل عملية “الانتخاب الطبيعي”، هي التي سترشدنا إلى المعتقدات الصحيحة. إلا أن هذين الاقترابين لا يدحضان الشكوك والهواجس لدى المؤلف. فالإثنان لا يقدمان الوسيلة والأداة لفهم أنفسنا وذواتنا، كما أنهما لا يقدمان “صورةً مناسبةً منطقيةً، تُرينا كيف نتلاءم مع الكون.
إن افتقاد كلٍ من نظريتي “التوحيد” و”التطور” للمفاهيم المتجاوزة – مع استحالة تجاهل البحث عن رؤية متجاوزة لذواتنا في الكون – يدفعنا إلى الأمل نحو فهمٍ موسع، يتجنب الاختزالية الفيزيائية. وتكون الصفة الأساسية في ذلك الفهم، كما يرى “ناجل”، هي تفسير مظاهر الحياة والعقل والضمير والمعرفة لا كنتائج عارضة لقوانين الطبيعة، ولا كنتائج لتدخلٍ مقصود في الطبيعة من الخارج، وإنما كنتيجة لازمة “للنظام” الذي يحكم العالم الطبيعي من “الداخل”. ذلك النظام قد يحتوي على القانون الفيزيائي، ولكنه يحتوي أيضاً على ما هو أكثر من ذلك؛ لأن الحياة ليست ظواهر فيزيائية فقط. ومن ثم لا يمكن تفسيرها فقط من قبل الفيزياء والكيمياء؛ مما يدفع المؤلف إلى الإقرار بأنه ما زال في حاجة إلى شكلٍ موسعٍ للتفسير؛ شكلٍ سيحتوي حتماً على عناصر غائية.
الوعي
يمثل الوعي العقبة الكبرى لمدرسة “الطبيعية الشاملة” Comprehensive Naturalism التي تعتمد فقط على مصادر العلوم الطبيعية. وجود الوعي يعني أن الوصف الفيزيائي للكون – بالرغم من ثرائه وقوة تفسيره – ليس إلا جزءاً من الحقيقة، وليس الحقيقة كلها. وإذا أخذنا هذه الإشكالية في الاعتبار، وتتبعنا معانيها ونتائجها، فإن ذلك سيهدد حتماً الصورة الكاملة لـ”طبيعية” الكون، التي ترد الوجود كله إلى المادة الطبيعية فقط. لكن بالرغم من ذلك، يؤكد المؤلف مراراً وتكراراً أنه لا وجود – حتى الآن – لأية بدائل منطقية أخرى.
كان ظهور إشكالية الوعي – وتحديها للفرضية المادية الطبيعية – نتيجةً مباشرةً للثورة العلمية في القرن السابع عشر الميلادي، حيث ظهر مفهوم “الحقيقة الفيزيائية الحيادية” Objective Physical Reality. كان “جاليليو” و”ديكارت” من أهم الرواد الذين أخرجوا تلك الإشكالية – إشكالية العقل/الجسد – إلى النور؛ حيث قاما بتدشين انقسام واضح بين الوصف الحيادي الكمي الدقيق للحقائق الخارجية الممتدة عبر الزمان والمكان (وصف الشكل والحجم والحركة والقوانين الحاكمة لها)، وبين الوصف الشخصي للعالم الخارجي، بناءً على نظرة كل شخصٍ للعالم؛ وهي وظيفة لا يقوم بها إلا العقل. باختصار، قام العالمان بالفصل بين المظاهر الشخصية الإنسانية وبين الكون الفيزيائي؛ قاما بفصل كل ما هو عقلي مقاصدي إنساني عن مجال العلوم الطبيعية الحديثة.
رأى “ديكارت” أن هناك فارقاً بين العقل والمادة رُغماً عن تفاعلهما مع بعضهما البعض، مفترضاً أن العقل هو الحقيقة الكبرى. رأي “ديكارت” أن هناك إزدواجية بين الوعي/العقل Mind وبين المخ Brain، وأن ذوي العقول والوعي هم مكونات حتمية من الحقيقة الكونية، دون أن تحكمهم العلوم الطبيعية. ولكن هذا المنهج الفكري – كما يُدلي المؤلف – تم تحديه من قبل الفكر المادي المهيمن تحت التبرير التالي: أن أجسادنا والأنظمة العصبية المركزية هي أجزاء من العالم الفيزيائي. صحيح أن العمليات العصبية هي الأكثر تعقيداً، إلا أنها ما زالت تُفسَر تفسيراً رياضياً، مليئاً بالأحداث الفيزيائية.
لقد رفضت المدرسة المادية الإزدواجية بين العقل والمخ، مفترضةً أن الكون الفيزيائي هو الحقيقية الوحيدة، وأن مكان العقل في هذا الكون هو أمرٌ مشكوكُ فيه، إن كان هناك أصلاً وجود للعقل، كما تقول المدرسة المادية. وقد ساعدت التطورات الحديثة في “الفسيولوجيا العصبية” Neurophysiology و”البيولوجيا الجزيئية” Molecular Biology على دعم قناعات المدرسة المادية، إذ شجعت تلك التطورات على فكرة إدماج العقل، وإلحاقه بتفسير فيزيائي وحيد للكون.
وكانت إحدى الإستيراتيجيات لإدراج العقل في داخل الصورة الفيزيائية للكون، دعم المدرسة “السلوكية” Behaviorist التي قامت بتعريف الظاهرة العقلية بالمواقف السلوكية، متجاهلةً العقلية الكامنة في داخل الإنسان، وكذلك الرؤية الداخلية للشخص الواعي. فعلى سبيل المثال، تصير الطريقة التي يستطعم بها شخصٌ ما السكر مجرد رد فعل سلوكي، على حسب منظور تلك المدرسة. إلا أن ذلك الفكر السلوكي المادي لاقى مقاومةً على أيدي بعض الفلاسفة الذين رأوا أن خبرة التذوق هي شيء يتم إنتاجه من قبل الوعي وليس من قبل الفيزياء أو الطبيعة. وقد طُرحت أدبيات كثيرة لتناول تلك الإشكاليات.
ملخص القول، يؤكد “ناجل” أن الإنسان كائن مُعقد جداً، لأنه مُكون من شكل فيزيائي خارجي Objective وشكل عقلي ذاتي Subjective من الداخل؛ وهو الأمر الذي يتطلب فهماً أكثر عمومية وشمولية للظاهرة الإنسانية، وليس مجرد حصرها في نطاق فيزيائية.
يؤكد “ناجل” على إخفاق وفشل نظرية التطور الطبيعي في تقديم تفسير لوجود الوعي الذاتي. فبما أن الشخصية الواعية تمثل أهم معالم الكائنات الحية، فإن تفسير وجود تلك الكائنات لابد وأن يتضمن تفسيراً لظاهرة الوعي؛ إذ لا يمكن فصل الإثنين عن بعضهما البعض. بمعنى آخر، إن نظرية التطور البيولوجي الدارويني لابد وأن تقدم تفسيراً لظاهرة الوعي الموجودة في تلك الكائنات الحية. فإن عجزت تلك النظرية عن فعل ذلك، فهذا يعني بطلان الرواية المادية للنظرية التطورية؛ على اعتبار أنها لا تقدم الحقيقة كلها؛ فالكائنات الحية مثلنا لا تتحول ببساطة إلى كائنات واعية؛ مما يدل على عوارٍ واضح في النظرية المادية.
إن نظرية التطور – كما يشير المؤلف – لا تستطيع الوصول إلى مقاصد وأهداف “المصمم” الذي صمم هذا الكون. وإذا كانت الفيزياء لا تستطيع تفسير ظاهرة الوعي، فإنه يجب مراجعة النظرة المعتادة لنظرية “التطور”. وإذا كان الأمر كذلك، فهناك الكثير من الإضافات التي ستحتاجها الرواية الفيزيائية من أجل إنتاج تفسير حقيقي للوعي. لابد من وجود مفهومٍ ما، يُضاف إلى المفهوم الفيزيائي للقانون الطبيعي؛ مفهوم يسمح لنا بتفسير كيفية نشوء كائنات حية تتجاوز المادة الفيزيائية. إن مصادر العلم الفيزيائي غير كافية لمثل هذا الهدف، لكونها مصادر صُممت من أجل تفسير معلوماتٍ ذات طبيعة مختلفةٍ تماماً.
من أجل تفسير ناجح للوعي، لابد من الإتيان بنظرية نفسية فيزيائية خاصة بالوعي، ونسجها في داخل “الرواية التطورية”. لابد من الإتيان بتفسير يجيب على سؤالين أساسيين: لماذا تمتلك بعض الكائنات الحية الوعي والعقل؟ ولماذا وُجدت الكائنات الحية الواعية في تاريخ الحياة على الأرض؟
ومن ضمن الأطروحات غير التقليدية، وغير المادية، التي فسرت وجود الوعي بطريقةٍ متجاوزةٍ للفيزياء والطبيعة المادية، أطروحة “توم سوريل Tom Sorell”، صاحب نظرية “الأحادية المحايدة” أو Neutral Monism. يقول “سوريل” إن بعض المواضع الفيزيائية في الجهاز العصبي هي أيضاً مواضع للوعي؛ وأن الوصف الفيزيائي لها ليس إلا وصفاً جزئياً من الخارج. ومن ثم، فالوعي ليس أثراً ناتجاً عن عمليات فيزيائية جارية في المخ فقط، وإنما هو ناتج عما هو أكثر من ذلك. وهذا يعني أن كل كائن حي يتكون من عناصر لديها طبيعة فيزيائية وغير فيزيائية في ذات الوقت؛ وأن كل العناصر في العالم الفيزيائي لديها وعي وعقل، كما يؤكد مؤلف الكتاب.
يؤمن “ناجل” بما هو وراء السببية، وبما هو متجاوز للتفسير. فليس كل شيء لديه تفسير، وليس كل شيء لديه سبب. فموت بعض الأشخاص، على سبيل المثال، ليس له تفسير فيزيائي. وإنما له تفسير آخر، يتخطى السببية، ويتخطى الحدث والوصف الظاهر، كما يؤكد “ناجل”. فهناك مثلاً تفسيرا فيزيائيا وراء ضرب 3+5 على الآلة الحاسبة؛ وهو تفسير فيزيائي يؤدي إلى ظهور “8” على الشاشة. إلا أن هذا التفسير السببي الفيزيائي، وراء الشكل الظاهر على الشاشة، ليس تفسيراً للسبب الذي جعل هذه الآلة تنتج الإجابة الصحيحة. بمعنى آخر، لابد من الرجوع إلى مقصد ونية الصانع الذي اخترع تلك الآلة، من أجل تفسير ما وراء ذلك الوصف الخارجي.
إن قناعة “ناجل” بما هو وراء السببية الفيزيائية جعلته يطالب بالبحث عن نظرية ما بعد المادية؛ نظرية تطرح تفسيراً موحداً عن كيفية نشوء وتطور الصفات الفيزيائية والعقلية الذاتية مع بعضها البعض. فالعقلي لا يمكن أن يتواجد دون الفيزيائي، والعكس صحيح.
وبالرغم من دعوة “ناجل” إلى البحث عن البدائل النظيرة غير المادية، وبالرغم من طرحه للـ”أحادية المحايدة”، إلا أنه ما زال متردداً حيال قبول تلك البدائل، معتبراً إياها غير كافيةٍ للإجابة على تساؤلاته المحيرة التي أهمها: لماذا وُجدت تلك الكائنات الحية العاقلة من الأساس؟ وكيف كان شكل الحياة قبل ظهور تلك الكائنات الحية؟ إن البدائل النظرية غير المادية أخفقت، من وجهة نظر المؤلف، في إجابة المسائل التاريخية، وفي تقديم تفسير تاريخي عن كيفية تطور الكائنات الحية العاقلة المالكة للوعي والتمييز.
يؤمن “ناجل” بضرورة وجود غاية ومقصد وراء إيجاد الكائنات الحية العاقلة؛ وأن التفسير التاريخي لذلك الإيجاد لابد وأن يكون غائياً أو مقصدياً. “أنا أؤمن بأن دور الوعي في بقاء الكائنات الحية غير مفصول عن المقاصد؛ غير مفصول عن الرؤية، والاعتقاد، والرغبة، والتصرف، وأخيراً عن العقل”. يرى المؤلف أن البشرية بحاجة إلى تطوير تفسير كوني موحد (يوحد بين الفيزيائي والعقلي)، لا مجرد نظرية عابرة. إن البشرية بحاجة إلى تفسير متداخل ما بين الفيزيائي وفوق الفيزيائي؛ تفسيرٍ من نوعٍ آخر، يحتاج إلى خطوات كثيرة حتى يكتمل. “لابد من مقاربة البحث اتطوري ونظيره العقلي النفسي بهدف (طوباوي utopian) بعيد المنال”. “فكلما قدمت النظرية تفسيرات متداخلة، كلما صارت أكثر قوة”. (The more the theory has to explain, the more powerful it has to be)
المعرفة
إن التفسير المادي الاختزالي للمعرفة والإدراك – وذلك برده إلى المكونات الأساسية العضوية – يصعب تخيله. فالمعرفة – أكثر من الوعي – هي انعكاس لتفاعل وعمل الوعي بأكمله، ومن ثم لا يمكن وصفها كشيء مكون من عدد غير متناهٍ من الذرات. إن محاولة فهم المعرفة والوعي والعقل والمنطق بطريقةٍ “طبيعيةٍ مادية” naturalistic محاولة في غاية الصعوبة؛ بل إنها تعد إشكالية من ضمن الإشكاليات التي طرحها “ناجل” في كتابه.
فنظرية التطور الدارويني لا تقدم لنا تفسيراً عن قدرة الإنسان على فهم ومعرفة قوانين الفيزياء والكيمياء والأحياء. كما أنها لا تقدم تفسيراً عن كيفية نشوء أو اكتساب اللغة التي تلعب دوراً رئيسياً ومهماً في إدراك الحقيقة. فاكتساب اللغة معناه اكتساب منظومة من المصطلحات والمفاهيم التي تعيننا على فهم الحقيقة. ومن ثم، فإن عملية البحث التي تصير دون لغةٍ تصير مستحيلةً، كما يؤكد “ناجل”.
إن إدراك ومعرفة الحقائق لا يتم عن طريق الحواس، كما تزعم نظرية التطور المادية الداروينية، إنما يتم عن طريق العقل. “الأمر المميز عن العقل أنه يربطنا مباشرةً بالحقيقة”؛ أما النظر بالعين فيربطنا بطريقةٍ غير مباشرة بالحقيقة. فهناك فارق كبير بين رؤية الحقيقة بعين العقل، ورؤية الحقيقة بعين النظر، اعتماداً على الانطباعات والغرائز والحواس. والمخلوقات العاقلة تحاول دائماً إبعاد نفسها عن تلك المؤثرات الحسية، من أجل إعمال عقلها. إن ذوي العقول يتحركون دائماً في نطاق العقل لا في نطاق الحواس لأن العقل يأخذنا إلى ما وراء الظواهر؛ فالعقل له استخدامات شاملة وعامة، وليس مجرد استخدام مكاني؛ والعقل هو المسئول عن التفكير المنطقي الأخلاقي لتصحيح مسار الغرائز؛ والعقل هو المسئول عن ردود أفعالنا العقلية المنظمة التي لا تأخذ أوامرها من أعضائها البيولوجية.
نحن بحاجةٍ إلى منظور غير مادي، غير واقعي؛ منظور تصير به “عوالم” العقل والمعرفة والإدراك والإبداع بناءً إنسانياً، لا بناءً فيزيائياً. نحن بحاجةٍ إلى نظرية تفسر كل شيء؛ لا تفسر فقط نشوء الكائنات الحية، وكيفية تطورها بتلك الصورة المعقدة، ولا تفسر فقط نشوء الوعي والمعرفة لدى بعض الكائنات الحية، وإنما تفسر أيضاً كيفية تطور الوعي إلى أداة للتجاوز، لرؤية الحقيقة والقيمة. فليست الحقائق فقط حقائق واقعية وعلمية، كما يشير المؤلف، وإنما هناك أيضاً حقائق أبدية عن المنطق والرياضيات؛ وكذلك حقائق معيارية وأخلاقية.
وكما أوردنا سالفاً، يقدم المؤلف تفسيراتٍ عدة مناهضة لنظرية التطور؛ منها التفسير الإيماني المقاصدي الذي يقول أن الحياة لا يمكن أن تكون وليدة صدفةٍ ، وإنما هي تبدو وكأنها نتاج تصميمٍ ذكيٍ ذي مقصد؛ وهو ما افترضه “روجير وايت Roger White”؛ ومنها التفسير الغائي الذي يقول أن للحياة غاية، ولكنه ينفي وجود الإله الخالق؛ وهو التفسير الذي يتطابق مع رؤية المؤلف الإلحادية. فقد يعلن المؤلف دوماً، في ثنايا كتابه، عن ترفعه الواضح عن التفسير الدارويني، وكذلك رفضه القاطع للتفسير الإيماني. ورغماً عن جميع تلك التفسيرات المطروحة من قبل المؤلف، إلا أنه ما زال باحثاً، في وسطها، عن حلٍ للمسألة التاريخية التي ظلت تؤرقه وتحيره طيلة فترة كتابته لهذا العمل.
القيم
منذ الوهلة الأولى، تبدو القيم – مثل الوعي والمعرفة – في تعارضٍ تام مع الطبيعة التطورية الداروينية في ثوبها المادي المعتاد. إلا أن إشكالية وضع القيم في العالم الطبيعي – حسب منظور المؤلف – تتجاوز إشكاليات الوعي والمعرفة؛ وذلك لأن القيم لها ارتباط خاص بالمجال العملي التطبيقي، ومجال ضبط السلوك وقياسه. صحيح أن القيم، وردود فعلنا تجاهها، تعتمد على الوعي والمعرفة، إلا أنها تتجاوز الإثنين؛ ومن ثم تطرح إشكاليةً أخرى بالنسبة للفرضية المادية العلمية.
اختلاف القيم عن الوعي والمعرفة إنما يتمثل في كونها أقل شفافية من حقيقة الوعي، وأقل وضوحاً من حقيقة المعرفة، على وجه العموم. الأمر الآخر أن القيم ترتبط أكثر بالموقف الشخصي Subjectivist Position لمن يطبق تلك القيم. فالحقيقة الأخلاقية القيمية تعتمد أكثر على مواقفنا المقاصدية، على عكس الموقف الواقعي الذي ينكر اعتماد الحقيقة على حِسنا الأخلاقي. فالشخصي يفسر حقيقة الحكم القيمي في إطار اتفاقه مع حِسنا الأخلاقي، بيما الواقعي يفسر حسنا الأخلاقي في إطار مَلكَات تقوم بتعريف وقائع، تجعلنا نختار فعل ممارسات معينة أو عدم فعلها؛ كما هو وارد في الكتاب.
لقد ناقش “ناجل” الصراع القائم بين الواقعية والشخصية. فقد يؤمن الواقعيون بإمكانية تفسير الحكم الأخلاقي عبر حقائق تقييمية عامة، إلى جانب بعض الوقائع المساندة، ولكنهم لا يؤمنون بإمكانية تفسير العنصر القيمي في ذلك الحكم. على سبيل المثال، يعتبر الواقعيون قيمة دفع الضرر قيمةً حقيقيةً في حد ذاتها؛ لكنها لا ترتبط – لديهم – بحقيقةٍ أخرى متجاوزة، أو ذي طبيعة مختلفة.
صحيح أن بعض الوقائع الفيزيائية تجعل بعض الأحكام القيمية حقيقية؛ بمعنى أنها تعطي أسباباً منطقيةً لفعل سلوك معين أو عدم فعله. فاصطدام سيارتك، مثلاً، بكلبٍ على الطريق قد يحدث حتماً إن لم تضع قدمك على فرامل السيارة؛ وهو ما يلزمك باستخدام فرامل القيادة. إلا أن الحقيقة الأخلاقية العامة، التي تمنع إلحاق الأذى بأي مخلوقٍ كان، لا تنشأ بسبب الوقائع، لكونها حقيقة قائمة بذاتها.
وقد استشهد “ناجل” بالباحثة “شارون ستريت Sharon Street” التي أكدت في بحثها (تحت عنوان “معضلة داروينية للنظريات الواقعية عن القيم A Darwanism Dilemma for Realist Theories of Value”) على أصالة الحقائق الأخلاقية، حيث لا يمكن ردها إلى أي نوعٍ من الوقائع الطبيعية. فالحقائق الأخلاقية، من وجهة نظرها، هي حقائق معيارية وعقلية مستقلة Mind-Independent Moral Truth. وبناءً عليه، فإذا كانت الحقائق الأخلاقية لديها وجود فعلي، فإن التفسير المادي الدارويني – للدوافع المؤدية إلى الحكم الأخلاقي – لابد وأن يكون خاطئاً.
يؤكد “ناجل” على وجود القيم التي تقود الإنسان. فالإنسان كائنٌ ينقاد بالقيم، وهو ليس فقط رد فعل لخبرات الألم والمتعة. وهو لديه من القدرات التي تجعله يتفاعل مع القيم، ويضبط سلوكه بطريقةٍ واعية؛ وهو ما لا نستطيع تحليله في إطار السببية الفيزيائية، ولا سيما حينما نتحدث عن عنصر “الإرادة الحرة” التي تتواجد حتماً ضمن المعادلة. جملة القول، إن تحديد مصادر دوافعنا الإنسانية لا يتفق أبداً مع الفرضية الداروينية، كما يؤكد “ناجل”.
ويُكمل المؤلف حُجته قائلاً، إن السلوك الإنساني لا يمكن تفسيره فقط عبر علم النفس، أو الغرائز والشهوات؛ ولكن أيضاً عبر حكم الإنسان على الأمور. وتلك الأحكام الإنسانية تندرج تحتها قضايا مهمة؛ أبرزها قضية القيم. فنحن كبشر نتواجد في عالمٍ من القيم، نتفاعل معه عبر أحكام معيارية، تقود تصرفاتنا في نهاية الأمر.
وتطرقاً إلى المسألة التاريخية، التي طالما أثارها المؤلف في نهاية كل فصلٍ من كتابه، يطرح المؤلف سؤالين مهمين: أولاً، أي كائنات حية نكون نحن، إذا كنا نتفاعل مع القيم وليس فقط مع عوامل طبيعية مادية؟ ثانياً، كيف كان شكل الكون والعملية التطورية التي أنتجت تلك الكائنات؟ إن إجابة هذين السؤالين تتطلب تقديم بديل عن الطبيعة المادية وتطبيقها الدارويني في عالم الأحياء؛ كما يؤكد “ناجل”.
ما هو التاريخ الحقيقي للقيم في هذا العالم؟ سؤال آخر يطرحه “ناجل” مجيباً عنه قائلاً: “لا يوجد شيء في هذا المجال يبدو واضحاً”. إلا إنه يعود مؤكداً بأن مسار التاريخ التطوري قد تضمن بعض الكائنات التي كانت لها قيمة حسنة وإيجابية، والتي امتلكت القدرة والوعي في التعرف على ما هو حسن وما هو سييء، وكذلك التعرف على الأسباب التي تقود إلى اكتساب الحسن وتجنب السييء.
يؤكد المؤلف على ثراء مجال القيم الذي دخل الكون مع نشوء الحياة؛ حيث ظهرت قدرات الاعتراف والتأثر بالقيم – في امتدادتها الكبرى – مع ظهور الكائنات العليا في الحياة. ومن ثم، فإن التفسير التاريخي للحياة لابد وأن يتضمن تفسيراً للقيم. إن مفهوم القيم – حسب منظور “ناجل” – لديه مساحة كبيرة للتطبيق، أكبر من مجرد اعتبارها أداة لتفسير الأسباب المادية. وإن القيم لم تأت كنتيجة عارضة للحياة، ولم تأت صدفةً؛ إذ أن الحياة هي شرط أساسي لوجود القيم.
الخلاصة
في الفصل الأخير – الخلاصة – تحدث المؤلف عن محاولاته المستميتة، عبر كتابه، في توضيح فرضيته الأساسية، وهي: أن النظرية المادية الداروينية غير قادرة على تقديم تفسير وافٍ لوجود الكون؛ سواءً تفسيراً تاريخياً أو تأسيسياً. ورُغماً عن ذلك، فإن محاولته للبحث عن بديل كانت خارج أطر التخيل؛ وهو الأمر الذي جعله يؤكد على ضرورة الخروج عن الأشكال المتعاهد عليها للتفسير الطبيعي المادي الدارويني؛ وتقديم أطروحات غير ماديةٍ، وأكثر تجاوزاً لجميع البدائل التي طُرحت في هذا الكتاب….وذلك عبر إيجاد تفسير وافٍ شاملٍ كامل، يجمع المادي مع غير المادي.
يُكمل المؤلف حديثه مؤكداً أن الحقيقة الكاملة – التي يبحث عنها وما زال – قد تكون متجاوزةً لبحثه وبحوث الآخرين بسبب محدودية إدراكهم. فعلى الرغم من التطور العقلي في المرحلة الإنسانية الراهنة، إلا أن “ناجل” على قناعةٍ بتجاوز الحقيقة الكاملة لمستوى قدراتهم ومعارفهم؛ وهو ما يستدعي مزيد من البحث بهدف الوصول إلى فهم منهجي لذاتنا، وكيفية تفاعلها مع الكون….بكفاءةً وجدارةٍ.
يقر المؤلف بصبره في عرض الحجج المناهضة والمقاومة للشكل المعتاد للمدرسة الطبيعية المادية أو المادية الاختزالية التي تنظر إلى الحياة عبر النظارة النيو-داروينية. وهي نظرية، كما يصفها “ناجل”، عصية على التصديق، ومخالفة للمنطق. بل إنه يراهن على سقوط الإجماع الحالي، حول صحة المادية الاختزالية، آجلاً أو عاجلاً؛ ذلك الإجماع الذي سيبدو مضحكاً بعد جيل أو جيلين، كما يؤكد المؤلف. إلا أن استبداله بإجماع جديد، يبدو (حتى هذه اللحظة) غير كافٍ وغير صائب؛ وهو الأمر الذي يتطلب إرادة وعزيمة وإيمان لإيجاد البديل الوافي، وهو ما اختتم به المؤلف كتابه، حيث تحدث عن قناعته الشخصية في الإرادة والإيمان، قائلاً:”إن الإرادة الإنسانية للإيمان لا تنضب”.
لا جدال في أهمية المضمون المعرفي لهذا الكتاب الذي أخذنا – عبر رحلة فلسفية معرفية علمية – إلى النظر في ماهية الرؤية التطورية الداروينية: في خطوطها العريضة ومبادئها؛ في عيوبها وأخطائها التي ظل المؤلف يسردها تدريجياً حتى أسقطها نهائياً عبر حجج معرفية وعلمية ومنطقية وفلسفية. وهو كتابٌ يعكس مدى التعنت “العلمي” في إخفاء وإنكار الحقيقة، من أجل الانتصار لمقولات وفرضيات “علمية” ثبت، تجريبياً ومنطقياً وعلمياً، عدم صحتها وعدم منطقيتها على أكثر من مستوى، كما أوضح المؤلف. وهو الأمر الذي يثير التساؤل الآتي: هل يعتبر التشبث بفرضياتٍ معينة، حتى ولو ثبت عدم مصداقيتها، هل يعتبر ذلك علماً؟ هل وظيفة العلم هي خدمة أهواء “العلماء” ومشاريعهم، أم خدمة الحقيقة والحق؟
لقد بذل المؤلف – الذي أعلن عن إلحاده بمنتهى الوضوح– جهداً واضحاً في دحض النظرية الداروينية؛ إلا أنه في ذات الوقت أعرض عن النظرية الإيمانية المقاصدية؛ محبذاً الوقوف في المنطقة الرمادية؛ حيث ظلت المسألة التاريخية تؤرقه طيلة الوقت: كيف كانت الحياة قبل نشوء المادة؟ وكيف بدأت علاقة الإنسان بالكون؟ وكيف يتلاءم الإنسان مع الكون؟
تساؤلات محورية وجودية كثيرة ظلت تراود فكر “ناجل”، لم يجد لها إجابة طوال بحثه. قد تجيب المدرسة المقاصدية الإيمانية عن جزء من تلك التساؤلات، ولكن يبقى جزء كبير مجهول بالنسبة إليه؛ وتظل لديه منطقة عتماء، تتقاذف منها أسئلة عديدة على ذهنه؛ أهمها: كيف تتلاءم الكائنات الإنسانية مع ذلك الكون الفسيح؟ ولماذا وُجدت تلك الكائنات بقدرات ٍخاصة في اكتساب المعرفة والوعي والإدراك والقيم؟
والحقيقة التي لا جدال فيها، أن إجابة تلك التساؤلات الوجودية ليس لها محل إلا في الرسالات السماوية التي بعثها الله لنا عبر رسله وأنبيائه، منذ خلقه للكون. تلك الرسالات السماوية التي حدثنا فيها الله سبحانه وتعالى عن قصة الخَلق، وعن مفهوم استخلاف الإنسان في الأرض، وتعليمهِ الأسماء وإسجاد الملائكةِ له، وعن حكمة خَلق الإنسان وتمييزه عن سائر المخلوقات؛ تمييزه بعقلٍ وضميرٍ ولغةٍ وإرادةٍ واختيارٍ وقدراتٍ خاصةٍ في اكتساب العلم والمعرفة. فالقصة التاريخية لإيجاد الكون ولإيجاد الإنسان – والتي ظل يبحث عنها المؤلف من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة من الكتاب – لن يتم معرفتها إلا من خلال كتب الله السماوية، ومن خلال الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله لإبراز وإيضاح تلك الحقائق الوجودية، فتكون هدىً واهتداءً للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
لقد تحدثت المدرسة المقاصدية الإيمانية عن ضرورة وجود مقصد وراء خلق الكون، وعن ضرورة وجود خالق وراء ذلك التصميم الذكي. إلا أن تلك المدرسة لم تتطرق إلى الرسالات السماوية التي أرست المنهج الرباني الذي يمثل الطريق المستقيم والهادي للإنسان في كل زمانٍ ومكان. وبرأيي، أن هذا هو بالضبط ما كان يبحث عنه المؤلف طيلة رحلته البحثية عن قصة الوجود والخلق والإنسان. لقد كان يبحث عن ذلك المنهج الرباني، صاحب الرؤية الحضارية الجامعة والموحدة للإنسان. رؤيةٌ لم تنظر إليه كمادةٍ فقط، أو كروحٍ فقط؛ إنما رؤيةُ جمعت بين العقلي والفيزيائي، بين الـsubjective والـobjective، بين الروحي والجسدي…بين المعنوي والمادي…بين الأخروي والدنيوي. إنها الرؤية التي توضح كيف يتلاءم الإنسان “الخليفة” مع الكون؛ وكيف يتفاعل معه من أجل إصلاح دنياه وآخرته.
عرض
د. شيرين حامد فهمي.
دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies