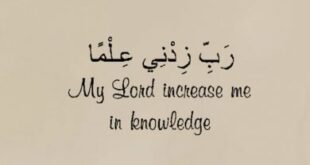حول منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية*
د. إبراهيم عبد الرحمن رجب*
تمهيد:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلقد خطت حركة أسلمة العلوم، أو التأصيل الإسلامي للعلوم، أو التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية خاصة – بفضل الله سبحانه وتعالي- خطوات واسعة خلال السنوات العشر الماضية، سواء فيما يتصل بعرض القضية علي نطاق واسع، أو ما يتصل بالبحث في أصوالها وأبعادها ونتائجها, أو فيما يتعلق بمناقشة آراء المعترضين عليها والمغالين فيها، حتي وصلنا اليوم إلي مرحلة يبدو ان الرؤية فيها اتضحت إلي حد كبير، وكان من ثمار ذلك ظهور العديد من الكتابات الجادة، التي لقيت اهتماماً كبيرا و كان لها اثر واضح لدي قطاعات عريضة من المشتغلين بمختلف فروع العلم- بحثا وتدريساً وطلباً- في كل أرجاء العالم الإسلامي.
واذا كان البعض قد يرون أن الكثير من الوقت والجهد قد أنفق ( أو أهدر )في غضون تلك الفترة في محاولات بذلت لتحديد المفاهيم أو انصرفت إلي الجدل حول المصطلحات فإنه لا ينبغي أن يفوتنا أن عمق وحجم التغيرات التي تتطلبها علمية إعادة صياغة العلوم؛ وخصوصاً الاجتماعية منها لصبغها بصبغة الإسلام صبغة الله- تستلزم بحكم طبيعتها إعادة نظر جذرية في مسلمات ومبادئ ومنهجيات أنفقنا العمر في تحصيلها، فإن ذلك يترتب علية بالضرورة أن نعطي مثل تلك المناقشات حقها دون استعجال شديد للنتائج، فالمناقشات إذا كانت أصيلة ومبنية علي علم، و كانت من النوع الذي يحرص المشاركون فيه علي بذل الجهود اللازم للاطلاع الجاد علي تفاصيل آراء من يخالفونهم، لا يمكن ان تأتي إلا بخير، ولكننا ينبغي أن نسلم في الوقت ذاته أنه لا يمكن لنا ان نبرر الوقت طويلًا عند ذلك النوع من المناقشات التي تدور حول خلافات لفظية (سيمانطيقية )، والتي يغلب أن تولد من الحرارة أكثر مما تولده من ضوء، كتلك التي تتوقف لإبداء اعتراضات لا نهاية لها علي ألفاظ “الأسلمة “أو “التأصيل” أو “التوجيه” لتقترح سلسلة جديدة من “الألفاظ” التي يصعب اجتماع الباحثين عليها (الذي هو شرط لاعتبار أي منهما “اصطلاحًا” مقبولًا)؛ لأن الأهم من هذا كله أن يكون هناك اتفاق علي المفهوم أو الصورة الذهنية التي تُستدعي في العقل غالباً عند ذكر أي من هذه الألفاظ والتي تتصل بالمهمة التي نحن متفقون جميعًا علي محوريتها وعلي ضرورتها لإصلاح مسار العلم ليس فقط في عالمنا الإسلامي, بل وفي العالم كله .
و الواقع ان الكثيرين خصوصًا بين علماء المسلمين من غير المتكلمين بالعربية – وهذا امر له دلالته – قد أصبحوا اليوم يستبطئون ظهور ثمار حركة أسلمة المعرفة ( أو التأصيل الإسلامي، أو التوجيه الإسلامي، والتي تستخدم في هذا البحث كمترادفات) وينظرون في أسباب ما يرون أنه صعوبات تواجه الحركة غير واعين بانشغال المتكلمين بالعربية بتلك القضايا اللفظية، وعلي كل حال فإنه رغم اختلاف هؤلاء في تحليل الأسباب فيما بينهم إلا انهم يجمعون علي أن الحاجة قد أصبحت ماسة للتعامل الجاد مع قضية “منهجية” الأسلمة أو التأصيل، خذ مثلًا ما ذكره سيد ولي نصر(Nasr, 1992:1 ) من أنه “برغم هذا الزخم من الأعمال التي وسعت نطاق مشروع إسلامية المعرفة ليصل إلي كل زاوية وركن من أركان الفكر الأكاديمي؛ فإن إسهام المسلمين (العلمي) في جملته وتفصيله لايزال أمراً غير واضح المعالم؛ يَعِدُ بالكثير ولم يقدم إلا القليل – أو هو عبارة عن وعد لم يتجسد بعد في نتائج ملموسة…. وبدلاً من أن (يُطور المشروع لنفسه) منهجية صارمة مستنيرة بنور العقيدة فإنه قد استبدل بالمنهجية العقيدة” أما لؤي صافي(23،1993:،Safi) فإنه يقرر ببساطة “إنني أزعم أن مشروع إسلامية (المعرفة) لازال في مرحلة ما قبل – المنهجية….. ثم يشير إلي أن الدكتور إسماعيل الفاروقي (يرحمه اللهً) قد كان همه الأول وضع الخطوط العريضة لمشروع إسلامية المعرفة، ولكنه لم يدخل إلي صلب مسألة المنهجية، إذا انحصر اهتمامه في التوصل إلي بعض المبادئ المتصلة بنظرية المعرفة (الإبستمولوجيا)” (25 (p.
ولقد وضع لؤي صافي يده علي أصل القضية عندما نقل رأي د. عبد الرحمن أبو سليمان المتضمن أنه “ينبغي إعادة تحديد العلاقة بين العقل والوحي …وأنه لم يعد من الممكن الاكتفاء بمجرد تقرير أن كلا من العقل والوحي يعتبر من مصادر المعرفة, فلابد من أن نتقدم خطوة أخري لنحدد- وبشكل ملموس- كيف يمكن الربط بين احدهما والأخر” (31.p)، كما زاد صافي الأمر وضوحًا عندما أشار إلي “المرء ينبغي ان يتساءل هنا عما إذا كانت هناك قواعد ينبغي علي عالم الاجتماعيات المسلم أن يتبعها عندما يحاول اشتقاق مبادئ اجتماعية من الوحي، أم أن عملية الاشتقاق هذه ببساطة مسألة ضمنية (لا يمكن تمييز مكونتها) أو مسألة حدسية؟ إن العلوم الاجتماعية الحديثة لا يمكن تركها للتخمينات الفضفاضة وغير المنضبطة لأفراد العلماء المسلمين, ولكنها ينبغي أن تقوم علي مجموعة من المبادئ والمعايير الواضحة الأبعاد والتي تقوم علي أصول صارمة؛ لأنه يمكن في غيبة تلك المبادئ استخدام التعبيرات القرآنية بشكل تعسفي لتبرير أي مواقف تخدم الالتزامات الأيدولوجية للجماعات الاجتماعية المختلفة “(p.p36-37) وهذه ولا شك قولة حق يتطلب الأمر الوقوف عندها طويلاً.
فالواقع أن المطلع علي كثير من الإسهامات التي تحسب ضمن جهود التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية يدرك علي الفور مدي الحاجة الماسة إلي الضبط المنهجي، وإلي وضوح الرؤية حول ماهية الإجراءات والخطوات العملية التي ينبغي أن يسير عليها الباحث، وحول ماهية الضوابط التي ينبغي عليه أن يلتزمها حال شروعه في العمل في بحوث التوجيه الإسلامي لهذه العلوم، ولقد كان هذا هو الدافع الأول وراء محاولتنا الحاضرة التي نأمل أن تلقي بعض الضوء علي أهم القضايا المتصلة بالمنهج، أو أن نفتح الباب أمام المناقشة الجادة لتلك القضايا – اتفاقاً أو اختلافاً – مما نرجو أن يكون من شأنه تعميق الرؤية لمختلف مسألة المنهجية أو ترشيد مسيرتها.
وأود أن يكون واضحًا منذ البداية أنه وإن كان مجال الاهتمام في هذا البحث ينحصر في التعامل مع منهجية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية من الزاوية التي تبدو بها للباحث الفرد (أو الفريق البحثي المحدود) الذي يريد الخوض في لجج تأصيل أحد موضوعات تخصصه –سواء كان الموضوع متسعًا أو مجردًا، أو كان جزئيا أو محددًا – ومعني ذلك أن غرضنا لا يتضمن التعرض لخطة العمل الشامل لمشروع إسلامية المعرفة برمته، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع بطبيعة الحال من تجاوز نظرتنا لزاوية رؤية الباحث المنفرد عندما نتطرق إلي الأمور المتصلة ببناء النظرية أو اختبارها، فتلك مسائل تتطلب بطبيعتها نظرة أوسع لا زال الباحث الفرد أن يضيعها في اعتباره حتي عندما يتعرض لدراسة قضية جزئية محدودة من منظور إسلامي ويرجع السبب في إبداء التحفظ إلي أن بعض الباحثين يلقبون علي “تأصيل” أحد موضوعات تخصصهم وكأنه أمريتم مرةone shot effort، أو كأنه عمل ذو صبغة ثباتيه (استاتيكي) إذا قام به اليوم أحد الباحثين بكفاءة فقد تم استيفاء الموضوع اللأبد، وينسي هؤلاء أن العلم والبحث عن الحقيقة نشاط تراكمي، قد نقوم اليوم ببذل جهد مبدئي لاستيضاح حقيقة الرؤية الإسلامية له كما نتصورها اليوم في ضوء فهمنا للنصوص وفي ضوء معرفتنا المستمدة من الجهود البحثية الواقعية الراهنة، ولكننا نكاد لا ننتهي من هذا العمل إلا لنقوم بربطه بغيرة من الأعمال الجزئية المتصلة به، ثم لنقوم في ضوء ذلك بإجراء بحوث جديدة يتمخض عنها لا محالة أطر تصويرة أكثر دقة واكثر اقتراباً من فهم الحقيقة وهكذا، فلزم ان نبدأ هنا بالتنويه إلي الطبيعة المتحركة (الدينامية) التراكمية لجهود التوجيه الإسلامي للعلوم، والمنبثقة – كما لا يخفي عن القارئ المتأمل – عن الطبيعة المتحركة (الدينامية) للبحث العلمي بصفة عامة.
وأخيرًا فإن هناك ملاحظة شكلية قد يكون من المناسب أن نسوقها هنا تتصل بالطريقة التي اخترناها عن قصد في عرض المفاهيم واستخدام المصطلحات في هذا البحث؛ فسيلاحظ القارئ أننا نورد أحيانا المصطلحات المألوفة للمنشغلين بالعلوم الاجتماعية الحديثة بلغتها الأصلية أو كما تنطق بالعربية (بين قوسين) وذلك بالإضافة إلي ذكر عبارات أو جمل تتضمن المعني الدقيق لتلك المصطلحات، ويرجع السبب في اختيار هذا الأسلوب إلي ان المصطلح الأجنبي الأصلي يترجم في معظم الأحيان “باصطلاحات” عربية مختلفة دون اتفاق واضح بين المتخصصين حول المقصود بالاصطلاح العربي البديل، مما يصعب معه متابعة للقارئ للفكرة المقصودة بالوضح المطلوب، ومن هنا كان الظن بأن أضافة المصطلح بلغته الأصلية (أو كما ينطق بالعربية) يصبح أقرب إلي ما هو مألوف لدي المشتغلين بالعلوم الحديثة، في نفس الوقت الذي يتيح فيه الشرح بعبارة أو جملة تعبر عن “المعني الكلي” للاصطلاح متابعة غيرهم لمضمون ذلك الاصطلاح وربطة بما لديهم من أطر مرجعية، وقد تستمر الحاجة إلي مثل هذه الطريقة في العرض علي جمهور مختلف في أطره المرجعية إلي حين تبلغ جهود التوجيه الإسلامي للعلوم بعون الله مداها، وحينئذ فإن الحاجة ستنتفي لاستخدام مثل هذا الأسلوب، بل ونأمل أنه عندما يتحول المسلمون ليصبحوا منتجين للعلم الأصيل أن تصبح المصطلحات العربية واللغة العربية بعامة هي لأصل الذي يتسابق إلي استخدامه أصحاب اللغات الأخري كما كان عليه الحال في “القرون الوسطي ” (راجع: توماس آرنولد،1896 ص ص 160 – 161).
والآن فإن من واجبنا قبل أن نشرع في الحديث عن مختلف جوانب أو مراحل منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية أن نقف وقفة قصيرة عند مفهوم “التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية” لتحديد أبعاده ومكوناته بأكبر قدر ممكن من الدقة باعتبار أنه هو المفهوم الأساسي الذي نريد البحث عن منهجيه، وأن الاتفاق علي المفهوم شرط لازم لأي اتفاق علي المنهج.
المبحث الأول: مفهوم التوجيه الإسلامي:
رغم الجهود المشكورة التي بذلها الباحثون إلي الآن لتعريف التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية وتحديد مضمونه بدقة فلا زال هناك قدر من التفاوت في الآراء يحسن معه أن نبدأ هذا البحث بتحديد المقصود “بالتوجيه الإسلامي” وما يتصل به من اصطلاحات، ولعل أنسب طريقة لمعالجة هذا الموضوع أن نعمد أولاً لتحديد الفكرة أو المهمة أو الرسالة التي يريد المشتغلون بالعلوم الاجتماعية في العالم الإسلامي اليوم تحقيقها لإقامة علوم علي أسس إسلامية أًيا كانت التسمية التي يطلقها كل منهم علي تلك المهمة، وذلك علي اعتبار أنه إذا ثبت وجود أتفاق كاف في الرأي حول طبيعة تلك المهمة وأبعادها، فإن مسألة التسمية أو الاصطلاح تصبح ثانوية إلي حد كبير، فما هي أبعاد مفهوم “التوجيه الإسلامي للعلوم” التي ينطلق هؤلاء الباحثون منها؟ لعلنا لا نبتعد عن الحقيقة كثيراً إذا قررنا أن هناك اتفاقاً واضحاً بين كل مَن كتبوا حول هذا الموضوع تقريباً (المبارك1977، الفاروقي، -1982|1980أبو سليمان 1938، المختاري 1985،عيسي 1986،المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1986، مركز البحوث بجامعة الأمام 1987،1993بدري 1987، نجاتي 1990، خليل 1990، رجب 1991،khalil)، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني علي أن التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية يتضمن المكونات أو الأركان الثلاثة الآتية علي الأقل:
(1)تحديد أبعاد التصور الإسلامي الشامل للإنسان والمجتمع والوجود، استخلاصاً من المنابع الرئيسة للمنهج الإسلامي التي تتمثل في الكتاب والسنة الصحيحة، مع الاستفادة من اجتهادات علماء المسلمين من السلف والمعاصرين، المستمدة من تلك المنابع الرئيسية والملتزمة بها؛ وتحديد متضمنات هذا التصور المتصلة بالمجال العام الذي تغطية اليوم العلوم الاجتماعية الحديثة.
(2) حصر نتائج “البحوث العلمية المحققة” في نطاق العلوم الحديثة، ومسح “نظريتها” وتحليلها وإخضاعها للتمحيص والنقد في ضوء مقتضيات ذلك التصور الإسلامي، سواء من حيث الموضوع أو المنهج.
(3) بناء نسق علمي متكامل يضم ما صح من نتائج العلوم الحديثة وما صمد للتحميص والنقد من نظريتها، ويربط بينها وبين ما توصل إليه علماء المسلمين من حقائق وتعميمات برباط تفسيري مستمد من التصور الإسلامي للإنسان والمجتمع والوجود.
ويمكن لنا أن نسارع فنضيف علي الفور ركناً رابعاً تكتمل به دائرة العلم الصحيح كما يلي:
(4) استنباط فروض مستمدة من ذلك النسق العلمي المتكامل الذي تم التوصل إليه فيما سبق، وإخضاع تلك الفروض للاختبار في أرض الواقع للتحقق من صدق الاجتهاد البشري المتضمن بالضرورة في عملية بناء أي نسق علمي نظري .
ولكن ما المبرر لإضافة هذا الركن الرابع؟ إن المصادر التي أشرنا إليها آنفا قد كفتنا- فيما نحسب – مؤنة البرهنة علي محورية المكونات أو الأركان الثلاثة الأولي ولوازمها لمفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، فالمطلًع علي تلك الكتابات لا يملك إلا أن يثبت عنده وجود هذه الأركان الثلاثة بوضوح مهما اختلف صورة التعبير عنها، ولكن الركن الرابع المتصل بضرورة اختبار الأطر التصورية المنطلقة من المنظور الإسلامي يستحق منا وقفة قصيرة في هذا الموضوع قبل العودة إليه في سياقة من العرض اللاحق لمختلف جوانب المنهج.
لقد أشفق الكثيرون ـ ولهم كل الحق في ذلك – من ان تتحول عملية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية إلي مسألة دعوية وعظيه، أو أن يُنظر إليها كمجرد إعلان ساذج بالالتزام الشخصي للباحث بالإسلام، حيث يندفع المتحمسون للقضية إلي استخلاص ما يظنون أنه يمثل وجهة الإسلام في موضوع الدراسة ليفرضوه علي الناس دون إخضاع تلك المرئيات للاختبار، وكأن الإخلاص يكفي “وحده” لبناء العلم، ويبدو لنا أن أمثال هؤلاء الباحثين يقومون بإحلال “الدوافع” للتأصيل محل التأصيل ذاته الذي هو نشاط علمي في جوهرة وأصلة، ويخضع أول ما يخضع لاعتبارات التحقق العلمي الصارم وإلا أصبح شيئًا آخر، قد لا يكون أقل أهمية من العلم، كالدعوة إلي الله مثلًا، ولكنه شيء أخر بالرغم من ذلك.
ولقد يرجع السبب في شيوع هذا التخوف لدي البعض إلي أن الكتابات الباكرة حول أسلمة المعرفة أو التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية (والتي أشرنا إلي بعض منها فيما سلف) كان من الطبيعي أن ينصب كل اهتماًمها علي الدعوة للفكرة، وبيان ضرورتها، وتوضيح أبعادها، أكثر من اهتمامها ببيان المنهجية العلمية الصارمة التي تلتزمها، تلك المنهجية التي لا تقل في الحقيقة – إن لم تتفوق –علي مناهج البحث العلمي المعاصرة في درجة التزامها بالضوابط المتفق عليها لأي نشاط علمي منظم، ومن هنا فقد كان من الضروري لنا -ونحن هنا بصدد البحث في موضوع المنهجية– إبراز هذا الركن الرابع ضمن أركان عملية التوجيه الإسلامي للعلوم استكمالاً للصورة وبياناً لوجه الحق في الأمر.
ويكفينا أن نشير في المقام إلي أن هذا الركن الرابع المتضمن لاشتقاق فروض مستمدة من النسق العلمي المتكامل(الذي يضم كلاً من إسهامات العلم الحديث التي تم تمحيصها وصمدت للنقد في ضوء معايير التصور الإسلامي كما يضم إسهامات علماء المسلمين في إطار تفسيري موحد مستمد من التصور الإسلامي) لاختبارها في ارض الواقع إنما هو جزء لا يتجزأ من منهجية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، والذي لا يمكن بدونه أن تعد تلك العلوم “علوماً” بالمعني المتعارف عليه للعلم؛ لأن في اختبار الفروض المستمدة من النظرية الضمان الرئيسي للتأكد مما إذا كان استنباطنا الذي نتج عنه ذلك النسق العلمي المتكامل صحيحاً ومطابقاً للواقع من عدمه، فعمليه الاختبار تتمشي مع فكرة التصحيح الذاتي التي تميز العلم الناضج، والتي تجعله مختلفاً عن الفلسفة التي تتركنا علي الدوام أمام أبواب مفتوحة بلا نهاية، كما أن عملية الاختبار تقضي علي الغارب لكل من يتوصل إلي استنباط مبينة علي فهمة للنصوص، أو علي ربط فهمه للنصوص بإسهامات العلوم الحديثة علي الوجه الذي يراه، دون وجود محك أو معيار للصدق يمكن الاعتماد عليه، فالمعيار المعتمد هنا هو مدي مطابقة تلك الاستنباط للواقع.
ولقد يتسأل البعض هنا مدفوعين بالغيرة علي دين الله: هل يتضمن هذا الركن الرابع لمفهوم التأصيل -عياذاً بالله- إخضاع آيات الله تعالي أو أحاديث المصطفي الصحيحة للاختبار في أرض الواقع؟ ولو عاد القارئ إلي الفقرة السابقة مباشرة ليتأمل ما أكدنا عليه فيها لوجود أن ما يخضع للاختبار في الحقيقة هو الأطر التصويرية التي يتوصل إليها الباحث باستنباطه هو للتأكد من مطابقتها للواقع، وليس اختبار للنصوص القرآنية أو الحديثية الصحيحة في ذاتها –نعوذ بالله العظيم أن نضل أو نضل- فتلك الأطر التصويرية المستنبطة ذات طبيعة كلية تفسيرية، وهي إن بنيت علي الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة إلا أن عملية الربط بين هذه النصوص المتعددة تتضمن جهداً بشرياً يحتمل الصواب أو الخطأ، كما سنبينه في موضوعه إن شاء الله تعالي.
والآن فإذا قد سلمنا بأن هذه الأركان تقترب في مجموعها من تصوير حقيقة المهمة التي نريد لها أن تتحقق في واقع علومنا الاجتماعية لتنطلق من هدي السماء توجيهاً لاجتهادنا البشري في البحث عن الحقائق بطريقة منظمة، فما الاصطلاح الذي يمكن ان يعبر عن هذه المهمة وفق هذا التصور المطروح بشكل مقبول؟ لقد تعددت الألفاظ التي استخدمت في هذا السياق تعدداً كبيراً حتي وصلت إلي ما يقرب العشرة (انظر: يالجن 1993 ب) وسنكتفي هنا باستخدام ثلاثة من هذه المصطلحات هي أكثر شيوعًا، وهي: التأصيل الإسلامي، الأسلمة، والتوجيه الإسلامي، ولكننا كما قدمنا سنستخدمها كبدائل تعبر عن نفس الشيء …. نفس المهمة، وسنخصص ما بقي من هذا البحث لبيان المنطق الذي استندنا إليه في ذلك عسي أن يكون في هذه المناقشة ما يساعد علي تخطي هذه القضية بدلا من تكريس الاختلاف بين الباحثين في غير طائل.
يعترض البعض علي استخدام اصطلاح أسلمة العلوم أو إسلامية العلوم علي أساس أن “الأسلمة” تقتضي إسلام العلوم وهي لا إرادة لها ولا عقل كالجمادات الأخري التي لا يمكن إطلاق الإسلام عليها، ويقال أيضا: متي كفرت العلوم حتي تسلم ….” (يالجن،1993 ب:3)، ولقد بالغ البعض متوسعاً في مد هذه الحجة إلي نهايتها المنطقية حين قال بأن: “كل علم فهو إسلامي، أليس الكون من خلق الله، والعقل هبة من الله، فكل ما يصدر عن الله في فهم كون الله فهو بالضرورة مسلم” أو ما هو قريب من هذه العبارات (ورد ما يشبه هذا القول ضمن مناقشات دارت في بعض المؤتمرات المتصلة بالتوجيه الإسلامي للعلوم ).
ورغم أنه قد يتبادر إلي الذهن لأول وهلة ما يوشك معه العقل أن يقبل متسرعاً بمثل تلك المقولات علي اعتبار انه بمنطق المخالفة، فإن الأسلمة تعني أن ما قبلها كفر، فإن هذا ليس بلازم أبداً، وإنما يمكن بطبيعة الحال أن يكون المقصود أن “المعرفة قبل أسلمتها كانت بعيدة في توجهها عن توجيه الإسلام” وأننا نريد لها ان تقترب من التوجه الإسلامي، وأننا مهتمون بإعادة صياغتها وفق منهج الإسلام وروحه بعد أن كانت مصاغة بشكل يهمل هذا المنهج أو لا يدرك وجه ارتباطه بها.
كما اعترض أخرون علي اصطلاح التأصيل الإسلامي للعلوم علي أساس أن التأصيل معناه عندهم رد الشيء لأصله، ومقتضي ذلك أن كل العلوم الاجتماعية الحديثة موجوده بحالتها الصحيحة أو مدفونة بشكل ما في تراثنا الإسلامي، وأن كل ما علينا هو التنقيب عنها، وإزالة الغبار العالق حولها لنصل مباشرة إلي ما نريد من عملية التأصيل، وليس لهذا الزعم ما يشهد له بالصحة، ونلاحظ هنا أنه حتي أولئك الذين يرون أن هذا “المصطلح سليم إلي حد كبير “فإنهم يضيفون أنه” لا يمكن إقامة كل العلوم علي الأصول الإسلامية مثل: الفيزياء، والكيمياء ….فإذا اقتصرنا التأصيل علي العلوم الاجتماعية يكون المصطلح سليمًا؛ لأننا نستطيع أن نجد لها أصولاً إسلامية، سواء في التراث الإسلامي أو في القرآن والسنة” (يالجن، 1993 ب:4). ولعله قد بات من الواضح في ضوء ما جاء في صدر هذا المبحث أن من يستخدمون اصطلاح التأصيل الإسلامي للعلوم لا يمكن في واقع الأمر أن يقصدوا أن الفيزياء النووية أو علوم الأعصاب الحديثة أو النظريات الحديثة في الإدراك الحسي كانت موجودة بتمامها عند الأقدمين من علماء المسلمين، أو أن المطلوب إعادتها إلي الوجود مرة أخري، وإنما يقصدون بالتأصيل تجعل الإسلام ومنهجه وتصوراته الكبري بمثابة “الأصل” الذي ترد إليه العلوم في مطلقاتها ومنهاجيتها ونظريتها، مع الإفادة من إسهامات السابقين من علماء المسلمين بالقدر الذي ثبتت به لبعض أعمالهم قيمة علمية مستمرة إلي اليوم دن صدود عن إسهام المعاصرين من غير المسلمين ما دام قابلاً للاندماج في منظومة التصور الإسلامي بشكل أصيل ودون تعسف.
ولم يسلم اصطلاح التوجيه الإسلامي للعلوم من النقد أيضاً، علي أساس أن التوجيه عند المعترضين علي أساس استعماله إنما يعني “استخدام العلوم في مجال خدمة الإسلام وخدمة الدعوة الإسلامية، وهذا المصطلح بهذا المعني قد لا يتضمن محاولة إيجاد الأصول والقواعد الإسلامية في التفكير الإسلامي أو في القرآن والسنة، ذلك…أنه يُوَجه ما هو موجود وكائن لا يُوَجه ما هو غير موجود ولا يقتضي إيجاد ما يجب إيجاده” (يالجن،1993 ب:3-4)، ومقتضي هذه الحجج أن لفظ التوجيه إنما ينصب علي تطبيق النتائج التي توصلت إليها العلوم بالفعل لتحقيق أهداف الإسلام، ولعل من الواضح أيضاً أن هذا المعني لا يلزم بالضرورة عن لفظ التوجيه، فالتوجيه الإسلامي للعلوم يقصد به كما رأينا استنارة الباحث في رؤيته العلمية العامة بنظرية المعرفة الإسلامية، كما يتضمن توجيه مناهج العلوم وطرق بحثها، وكذا توجيه بناءتها النظرية، ثم توجيه التطبيقات العلمية التي يتوصل إليها، وذلك دون أدني قدر من التعسف في استعمال اللفظ.
ولقد قام الدكتور مقدام يالجن أيضاً (1993ب) بالتعبير عن رفضه وانتقاده لعدد آخر من الألفاظ (المصطلحات) التي لم يكتب لها نفس الدرجة من الشيوع كبدائل للألفاظ الثلاثة السابقة، فأراح بذلك من قد يفكرون في اختراع ألفاظ بديلة جديدة، فانتقد مثلاً اصطلاح “تأسيس العلوم الاجتماعية علي الأصول الإسلامية” مبيناً أنه يؤخذ عليه أن التأصيل يتضمن أكثر من مجرد “إقامة العلوم الاجتماعية علي دعائم وأسس فقط، بل المراد إقامة بنيان العلوم بجميع جوانبها وهندستها علي الأصول الإسلامية “، كما اعترض علي لفظ “إبراز الأسس الإسلامية…” علي أساس أن الإبراز إظهار وبيان، والمطلوب بناء وتأسيس، وأعترض أيضاً علي “صياغة العلوم صياغة إسلامية” علي أساس أنه “يقيد وضعها في الثواب الإسلامي…. ولكن لا يفهم منها الدخول إلي محتواها والنزول إلي جوهر العلوم وإيجاد قواعد أو منهج أصيل وعريق… إلخ”، ثم إنه أضاف من عنده اصطلاحاً جديداً بلفظ آخر هو “بناء العلوم الاجتماعية علي منهج الإسلام”، وكل ما نخشاه أن يأتي معترض فيقتبس طريقة الدكتور يالجن نفسه؛ ليؤكد لنا أن هذا الاصطلاح أو التعريف مرفوض أيضاً؛ لأنه يركز علي المنهج، وأن التركيز علي “البناء” يعني أننا نقيم صرح العلوم علي أرض فضاء، ومعني ذلك أننا سنبدأ من فراغٍ، وأن عملية البناء لا تقول لنا شيئاً عن التطبيقات ….إلخ!!
لقد آن الأوان أن نتجاوز هذا الجانب الشكلي اللفظي من القضية؛ لكي نركز علي صورة أخيرة من الصور غير المنتجة للتعامل مع قضية المصطلح، فلقد دعا البعض في وقت من الأوقات إلي أنه ينبغي التمييز بين التأصيل والتوجيه علي أساس أن نستخدم التأصيل في الإشارة إلي المهمة التي نحن بصددها (والتي شرحنا أركانها فيما سبق) عندما يتعلق الأمر بالعلوم الاجتماعية، مع قصر اصطلاح التوجيه في الإشارة إلي نفس المهمة عند التعامل مع العلوم الكونية أو التطبيقية (الطبيعة في الاصطلاح التقليدي)، ورغم التسليم بأن هناك فرقاً واضحاً (سنعود لبيانه ) بين العلوم الاجتماعية والعلوم (الطبيعية ) فيما يتصل بحاجة الأولي الوحي كمصدر أساس للمعرفة، وحاجة الثانية إلي الحواس كمصدر أساس للمعرفة، إلا أن ما يحتاج إلي التنبيه إليه هو الطريقة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي علي ضرورة التفرقة بين الاصطلاحين؛ لأنها بيت القصيد هنا.
إن من المسلم به في علم المصطلح أن العلماء في سعيهم للبحث عن الحقيقة يقعون أولاً علي مفهوم أو فكرة أو تصور ذهني “يتفقون” علي إدراك كنهه بعقولهم، ثم إنهم يحتاجون إلي اختيار لفظ أو اصطلاح للدلالة علي ذلك المفهوم، وهم يختارون لفظاً مما يستخدم في لغة حية أو حتي لغة متروكة (لتجنب اختلاط المعني الإصلاحي بظلال غير مرغوبة في المعني اللغوي) أو قد يختارون رمزاً؛ لكي يربطوا هذا “المعني” أو “المفهوم” به ليتيسر التواصل والتفاهم بين الباحثين، وليس هناك من شك في أن كتابات أسلمة المعرفة أو التأصيل الإسلامي… إلخ لم تبدأ في الحقيقة إلا استجابة للشعور بوجود معني معين أو فكرة أو مهمة رُئِيَ فيها إصلاح العلوم، بل وصلاح الأمة، ولقد يكون مفهوماً أن يتناقش الباحثون أو يشتد جدالهم في محاولات لتحديد هذا “المعني” الإصلاحي أو المفهومConcept، ثم إن لهم بعد ذلك أن يطلقوا عليه ما شاءوا من اصطلاح فني Technical term إذا لقي قبولاً من جمهرتهم، ومن هنا فإن الأصل هو وضوح “المفهوم” الذي هو الحكم والفيصل في اختيار اللفظ أو “الاصطلاح” الذي يتفق علي أنه ينطبق عليه أفضل انطباق، ولكن الأمر المقلق حقاً هو أن المناقشات حول الاصطلاح قد ارتكست في الآونة الأخيرة لتجعل الاصطلاح أو “اللفظ” في معناه اللغوي حكماً وفيصلاً في تحديد المفاهيم! فرأينا بعض الباحثين يصدر حكمه بأنه “لما كانت لفظة التأصيل مختلفة في معناها عن لفظة التوجيه بحسب المعني الإصلاحي الذي يشير إليه كل منهما في معاجم اللغة العربية، فلابد أن يختلف المفهوم أو المعني الإصلاحي الذي يشير إليه كل منهما، ومن هنا فالتأصيل والتوجيه مختلفان، أو لابد أن يكونا مختلفين “الصياغة من عندي” وكأن من يدعو إلي هذا الرأي يريد لنا بعد أن قمنا – باختيارنا- فاستعملنا هذه الألفاظ للدلالة علي المعاني الفنية التي نقصدها أن نعود أدراجنا فننصب من هذه الألفاظ التي اخترناها بأنفسنا حكما علي مفاهيمنا الاصطلاحية، وهذه النزعة لتحكيم المعني اللغوي في المعني الإصلاحي لا يمكن أن تؤدي بنا إلا السير في دوائر دون طائل كالقطط التي تطاردها أذيالها كما يقولون.
ولكن تحذيرنا من هذه النزعة لا ينبغي من جانب آخر أن يصرفنا عن قضية هامة بالفعل، تتصل بالفرق بين العلوم الاجتماعية والعلوم المسماة بالطبيعية من حيث مدي ونطاق حاجتها لعملية أسلمة العلوم أو التأصيل الإسلامي للعلوم (أياً كانت التسمية التي تختارها)، ولكي نتعامل مع هذه القضية بطريقة منظمة فإنه يلزمنا أولاً أن نحدد الجوانب المختلفة “للمهمة” التي نحن بصددها أو الأنشطة العلمية المختلفة التي ينصب عليها التأصيل، ويمكننا بصفة عامة أن نقول: أن التأصيل الإسلامي للعلوم ينصب علي الجوانب الرئيسية التالية:
1- الغاية من العلم والنشاط العلمي بصفة عامة، وارتباطها بالغاية من وجود الإنسان ذاته.
2- التوجه العام للعاِلم في سلوكه البحثي أو في بحثه عن المعرفة وفي نظرته لنفسه وتكييفه لعلاقته بربه وخالقه .
3- نظرية المعرفة التي ينطلق منها العالم وافتراضاتها المعرفية (الإبستمولوجية) خصوصاً فيما يتصل بما يلي :
أ- مصادر المعرفة، وخصوصاً قضايا العلاقة بين الوحي والعقل والحواس.
ب- مجال المعرفة ونطاقها، وخصوصاً فيما يتصل بمدي شمولها لعالم الشهادة وعالم الغيب .
4- منهج البحث العلمي من الناحية (المثيولوجية).
5- التنظير وتفسير نتائج البحوث في صلتها بقضية درجة الاستفادة بكل من الوحي والعقل.
6- تطبيق نتائج العلم والاستفادة منها في حياة الناس (الجانب التقني أو التكنولوجيا).
ومن مجرد النظرة العابرة إلي هذه الجوانب نجد أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين العلوم الاجتماعية والعلوم المسماة بالطبيعة من حيث حاجتها لأن يشمل التأصيل فيها تلك الجوانب كلها بصفة عامة، وأن الاختلاف إنما يمكن فقط في “درجة” استخدام الوحي كمصدر للمعرفة (النقطة3 أ)، وفي “حدود” مجال المعرفة ونطاقها من جهة الاتصال بعالم الغيب أو الاقتصار علي عالم الشهادة (النقطة 3 ب)، وما ينبني علي ذلك فيما يتصل باختلاف “التركيز” في المنهج (النقطة 4) علي الملاحظة الخارجية والتجربة، وفي “درجة” الاستناد إلي الوحي في التنظير وتفسير النتائج (النقطة 5)، وبلغة أخري فإنه يبدو لنا أن الاختلاف بين كل من هذين القطاعين من قطاعات العلوم إنما هو في حقيقته اختلاف في الدرجة ينصب أساساً علي طبيعة موضوع الدراسة وعلي درجة إمكان الاعتماد علي الوحي كمصدر للمعرفة في نطاق اختصاصه، ورغم أن هناك العديد من الأمثلة والشواهد التي يمكن سوقها لتوضيح هذه العبارات إلا أن هذا يوشك أن يخرجنا عن قضيتنا الأصلية.
ونحن نزعم أن هذه الفروق لا تسوغ إطلاق تسميات مستقلة علي عملية أسلمة كل قطاع من هذين القطاعين من العلوم؛ لأن المهمة في جوهرها كما رأينا واحدة بالنسبة لكليهما، لا تستقل فيها العلوم الاجتماعية بجوانب تختص بها اختصاصاً كاملاَ، أو تستقل فيها العلوم المسماة بالطبيعة بجوانب أخري، وإذا كان البعض يظنون أن المهمة بالنسبة لتأصيل العلوم الطبيعية هي مهمة “توجيه” لتطبيقات تلك العلوم فقط فقد وهموا من جانبين:
1- أننا رأينا أن المطلوب في الحقيقة توجيه كل جانب من الجوانب الستة للأنشطة المطلوبة للسعي للحصول علي المعرفة العلمية في الاتجاهات التي تتمشي مع التصور الإسلامي.
2- كما أنه لا يمكن لأحد في نفس الوقت أن ينفي عن العلوم الاجتماعية أن “تطبيقاتها “في مختلف جوانب الحياة تحتاج أيضا إلي “توجيه” إسلامي مثلها في ذلك مثل تطبيقات العلوم (الطبيعية).
المبحث الثاني: تفاوت وجهات النظر حول مركز الثقل في المنهج:
أوضحنا فيما سبق ان هناك قدرًا كبيرًا من الاتفاق بين معظم الكتاب المهتمين بقضية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية (أو ما يكافئ ذلك الاصطلاح) حول مضمون المهمة التي يسعي الجميع إلي تحقيقها، وبينا أن جوهر هذا المفهوم إنما يكمن في إيجاد التكامل بين معطيات العلوم الاجتماعية الحديثة من جانب وبين ما يتضمنه الوحي (القرآن الكريم والسنة الصحيحة) وإسهامات علماء المسلمين حول الظواهر التي تتعرض لها العلوم الاجتماعية الحالية من جانب آخر، ولكن كيف هذا التكامل ومداه، والوزن النسبي لكل مصدر من مصادره (المصادر الشرعية، مصادر العلوم الاجتماعية الحديثة) أمر آخر اختلفت الأنظار فيه، وترتيب علي ذلك ظهور عدد من التوجهات التي تتصل بالمنهج، والتي يحسن الإحاطة بها ومناقشاتها قبل إلي تفاصيل الإجراءات النهجية وفق التوجه الذي اخترناه بينها.
فالمتابع للمناقشات والكتابات المتصلة بمنهجية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية سرعان ما يتبين له أن مواقف أصحاب الاجتهادات في الموضوع تتفاوت فيما بينها علي مقياس متدرج ذي طرفين متقابلين Continuum)) يبدأ من جهة بمن يرون التركيز علي مصادر الشرعية بشكل يكاد يكون كاملاً (في بعض الحالات)، إلي من يرون من الجهة الأخري التركيز علي مصادر العلوم الاجتماعية الحديثة بشكل يكاد يكون كاملاً (في بعض الحالات أيضًا) مع توزيع الآخرين فيما بين هذين القطبين، بحيث يحتل كل منهم نقطة علي هذا المقياس المتدرج فيكون أقرب إلي هذا القطب أو ذاك، مع التسليم بأن موقفه يتضمن قدراً مكاملاً من عناصر القطب المقابل، وبطبيعة الحال فإن من يريد استيعاب الصورة الكلية لوجه الاختلاف يكون في موضع أفضل للفهم إذا تفحص الحجج التي يقوم عليها موقف أولئك اللذين “يقتربون” من هذا القطب أو ذاك بدلاً من دراسة الحالات النقية الرافضة علي الجانبين أو دراسة الحالات الواقعة عند منتصف المقياس المتدرج.
فإذا تأملنا موقف أولئك الذين يقتربون من الطرف الأول للمتدرج فإننا نجدهم يرون أن التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية إنما هو في جوهره رجوع إلي المصادر الشرعية (ويلاحظ أن من يتخذون هذا الموقف في صورته النقية قد يصلون إلي رفض التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية أصلاً، ولا يرون لهذه العلوم أي مشروعية في الوجود)، بينما نجد من يقتربون الطرف المقابل يرون أن الأصل أننا نريد توجيها إسلامياً “لعلوم اجتماعية” قائمة بالفعل ولها مصداقيتها وتأثيرها، فهي من ثم محور الارتكاز الذي نعتمد عليه وننطلق منه، والذي يكفي في إصلاحه استبعاد ما خالف الشرعية من نتائج أو نظريات توصلت إليها هذه العلوم (وبطبيعة الحال فإن أصحاب الصورة النقية لهذا الاتجاه يرفضون كذلك التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية ويرون أن نتائج هذه العلوم بصورتها الراهنة نتاج لتطبيق منهج علمي رصين لا يمكن التشكيك في قيمته، ولا يحتاج تعديلاً أو إصلاحاً) فلننتقل الآن لتوضيح موقف الفريقين قبل أن نبين الموقف الذي نختاره ونلتزم به في الدراسة:
الاتجاه الأول: اتخاذ العلوم الشرعية نموذجا للتأصيل:
ويري أصحاب هذ ا الاتجاه أن عملية التوجيه الإسلامي إنما هي في جوهرها عملية “استخلاص واستنباط للآراء والنتائج التي يعتمد عليها في هذا المجال من المصدرين الأساسيين للشريعة (القرآن، والسنة) (جاء هذا التعريف ضمن وثيقة تحوي توجيهات للباحثين أعدتها إحدي الجهات المهتمة بقضية التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية)، ويتفق هذا بدرجة ما مع فحوي تعريف تبنته مؤخراً اللجنة الدائمة للـتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي عرفت التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية علي أنه “إبراز الأسس الإسلامية التي تقوم عليها هذه العلوم، من خلال جمعها أو استنباطها من مصادر الشريعة وقواعدها الكلية وضوابطها العامة، ودراسة موضوعات هذه العلوم علي ضوئها، مع الاستفادة مما توصل إليه العلماء المسلمون وغيرهم مما يتعرض مع تلك الأسس”.
ومن الواضح ان الأخذ بهذا التصور يترتب عليه بالضرورة آثار عميقة بالنسبة لمنهجية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، فالقضية لا تصبح فقط قضية اعتماد مكثف علي مصدر علوم الشرعية لاستخلاص الأحكام “الاجتماعية” منها إذا صح التعبير، ولكن الأهم من ذلك ان التركيز فيما يتصل بالمنهج سيكون علي طرق الاستنباط من النصوص، وأن صدق النتائج سيكون مبنًيا علي صحة استنباطها من مصادر الشريعة وقواعدها الكلية وضوابطها العامة كما أسلفنا، ولعل من العبارات المختصرة المفيدة في هذا السياق قول أحد كبار المتخصصين في العلوم الشرعية ذوي الاهتمام بمنهجية التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية تعبيراً عن هذا المعني “إن المطلوب هو وضع منهج للتأصيل علي غرار منهج الأصوليين والحديثيين”
ولقد قدم الدكتور مقداد يالجن (1993 أ)” تصوراً لأهم “القواعد والخطوات الإجرائية” للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، نورده هنا باعتبار أنه يمثل هذا الاتجاه بوضوح،
فيري الدكتور يالجن أن هذه القواعد والخطوات هي :
الخطوة الأولى: ضرورة وقوف الباحث علي الدراسات التخصصية والدراسات الإسلامية معًا.
الخطوة الثانية: البدء بالآيات القرآنية في التأصيل .
الخطوة الثالثة: الاستدلال بالأحاديث، وذلك بعد إثبات النص وبعد التأكد من درجته ومعرفة مواطن الاستشهاد به حسب درجته .
الخطوة الرابعة: ضرورة استخدام الآيات والأحاديث في كل موضوع إن أمكن، وذلك ليمكن إعطاء تصور كامل عن رأي الإسلام فيه؛ لأن القرآن والسنة يمثلان الإسلام في الدرجة الأولي.
الخطوة الخامسة: استخدام قواعد فهم النصوص من حيث العموم والخصوص والحصر والقصر وما إلي ذلك من وجوه الدلالات التي عالجها الأصوليون .
الخطوة السادسة : إن لم يوجد دليل من القرآن والسنة تستخدم مصادر المعرفة الإسلامية الأخري .
الخطوة السابعة : إن لم يجد الباحث دليلاً مما سبق، فعليه استخدام قواعد الاستنباط الأصولية.
الخطوة الثامنة : أن يكون استخلاص الأفكار والأحكام والقيم في ضوء أحد الأصول الإسلامية العامة أو كلها إن أمكن ذلك، وتلك الأصول هي الأصول الاعتقادية والتعبدية والتشريعية والأخلاقية والاقتصادية والفكرية.
الخطوة التاسعة : الرجوع إلي التراث الإسلامي وآراء العلماء المسلمين وإسهاماتهم في مجال البحث.
الخطوة العاشرة : الاسترشاد بالتوجيهات الإسلامية العامة في طرق دراسة الحقائق وتعليمها واستخدامها.
ويلاحظ علي هذا التصور أنه لم يشير إلي نصيب العلوم الاجتماعية الحديثة في عملية التوجيه الإسلامي لهذه العلوم لا من جهة النتائج، ولا من جهة المنهج، اللهم إلا في الخطوة الأولي التي أشار فيها إلي ضرورة “وقوف الباحث” علي الدراسات “التخصصية” والدراسات الإسلامية معاً، وهذا علي كل حال يتضمن اعترافاً ضمنياً بضرورة استخدام مناهج العلوم الاجتماعية في دراسات واقعية متخصصة، ولكن المنطق الذي يستند إليه أصحاب هذا الاتجاه في قلة اكتراثهم بالعلوم الاجتماعية الحديثة – مصادرها ومناهجها علي حد سواء – يقوم علي اعتبارين:
الاعتبار الأول: أن كل ما يتصل بالناس كأفراد أو جماعات أو مجتمعات في دنياهم وأخراهم إنما المختص بتوجيه الوحي، وأن ما تحاوله العلوم الاجتماعية من مزاحمتها للوحي كمصدر لتوجيه حياة الناس بناء علي ما تزعم أنها تتوصل إليه من “حقائق” إنما هو محط ادعاء، لا يقوم علي أساس، ذلك أن ما تصل إليه تلك العلوم من تصورات بناء علي دراسات تجري في مجتمعات مختلفة لا يعطيها صدقاً ذاتياً، لأنه إنما يعكس الانحرافات والاختلالات في تلك المجتمعات كما يعكس ما قد تكون عليه من هدي، يقول الدكتور عبد القادر هاشم رمزي (1984) في هذا السياق: إن هذه الدراسات “قفزت بدون مبرر إلي حيث يستحيل أن يوجد غير العلوم التجريبية …كما اختلطت فيها الحقائق بالأوهام اختلاطاً جعلها عاجزة عن سد الفجوة الثقافية ….{إن} أخذ المعلومات من المجتمعات المختلفة أو المجتمع الواحد في ظروف مختلفة لا يجعل هذه المعلومات حقائق، إن المجتمع الإنساني ليس مصدًرا للحقائق، وإن كان مصدراً للمعلومات، إنه {أي المجتمع الإنساني} عرضة لأن يلتوي أو ينحرف أو أن يتوقف أو أن يهبط، ولا بد من ضبط مسارة بالحقائق التي ليس لها مصدر سوي المصدر الأهلي المتمثل في النصوص الإسلامية وفي دلالات هذه النصوص (ص ص62، 68)، ويري نفس المؤلف أن نظريات المبنية علي التصورات الوضعية لم تستطيع أن تتوصل إلي “مرجع أو مقياس تقاس به أحكامها وتعميمها” ( ص 76 ) وبلغة أخري؛ فإنه إذا كان الفرد قادراً علي الخير والشر، غير مجبر بحكم تكوينه علي منهما، أو علي نمط ثابت بينهما، فكيف يمكن اتخاذ سلوك الأفراد الواقعي كمعيار، وإذا كانت المجتمعات البشرية تختلف قيمتها ومعاييرها فكيف يمكن أن يكون “واقع” تلك المجتمعات معياراً، فلابدّ من بوصلة تشير إلي نقطة معيارية ثابتة يقاس إليها الواقع، وهذا المعيار لا يمكن إلا أن يكون ذا مصدر متعال علي الناس وعلي المجتمعات .
الاعتبار الثاني: أن العلوم الاجتماعية بسبب تأثرها في نشأتها بالظروف التاريخية للحضارة الغريبة، وبسبب ما شاب هذه التجربة من صراع بين الكنيسة والعلم، مما انتهي إلي نزعة مادية (إلحادية في كثير من الأحوال)، قد عانت خلال تطورها من التواءات وندوب وكسور يصعب جبرها، ففشلت من جهة فشلاً ذريعاً في تحقيق ما زعمت أنها تحققه من أهداف، وجاء ما توصلت إليه من مجدب النتائج مهلهلاً ومشوباً بالعيوب من كل جانب، بحيث لا يمكن استنفاذ شيء منه للانتفاع به، وبذلك فإنه يكون من العبث أو من الغلفة الرجوع إلي نتائج تلك العلوم؛ لأنه حتي لو وجدنا فيها ما يشبه الخير، فإننا لن نعدم أن نجده “ملوثاً” أو مدموغًا بشكل لا يمكن إزالته بطابع أصله الذي نشأ فيه، والذي لا يمكن أن يؤدي في المجتمعات الموحَدِة إلا إلي تشتت الرأي والخيال واختلال المعايير، ولقد قام الدكتور أحمد خضر ( 1991أ، 1992 ب )- وهو من أساتذة علم الاجتماع – ليبرهن علي صحة هذا الرأي، وانتهي في كتابه المتعددة الموثقة من الناحية العلمية (التي رجع فيها إلي المصادر الأصلية لأساطين علم الاجتماع الغربيين)، وإلي أنه بالمسلمين أصلاً إلي علم الاجتماع، ليس هناك مبرر موضوعي لبذل أي جهد لاستنفاذ أي علم نافع منه؛ لأنه ببساطة لا يحوي علًما نافعًا.
ولكن هناك من يرون أن البديل الذي يطرحه أصحاب هذا الاتجاه من اكتفاء بالمناهج الأصولية يثير أيضاً إشكاليتين خطيرتين، لا يجوز التغافل عنهما مهما كان تقديرنا لهذه المناهج:
الإشكالية الأولي : وتتصل هذه الإشكالية بماهية معيار الصدق في كل ما يتوصل إليه المشتغلون بالتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية بالاعتماد علي المناهج الأصولية من اجتهادات، فلا يخفي أن هناك اختلافاً واضحاً بين المادة الخام التي هي موضوع عمل الفقهاء؛ والتي تتصل بالأحكام الجزئية التي يمكن أن تنضبط بالالتزام “بقواعد الاستنباط الأصولية”، وبين المادة الخام؛ التي هي الموضوع اهتمام العلوم الاجتماعية، والتي تتصل بكليات الدين في توجيهها لكليات الحياة الاجتماعية، ومن هنا يري هؤلاء المعترضون أن اتخاذ منهجية أصول الفقه نموذجاً ودليلاً يحتذيه التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية سيكون مشوباً بأخطاء ناتجة عن بعد الشقة بين النصوص من جانب وبين الاجتهادات التي يتوصل إليها الباحثون في العلوم الاجتماعية من جانب آخر، ويصبح من الخطورة بمكان أن نساوي بين اجتهادات الفقهاء في المسائل الجزئية في ضوء المنهج الأصولي، وبين “اجتهادات” المتخصصين في العلوم الاجتماعية (ومن يتعاونون معهم من المتخصصين في العلوم الشرعية) في المسائل المتصلة بكليات الحياة الاجتماعية باستخدام نفس المنهج الواحد، وذلك لما يمكن أن ينتج في الحالة الثانية من تجاوزات باسم استخدام المناهج الأصولية وإلصاق أي قدر مضاف من الصحة للنتائج ستارها، ومن هنا فإن من المحتم استخدام طرق” إضافية” للضبط واختبار النتائج التي يتوصل إليها المشتغلون بالتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية؛ للتأكد من صدقها الواقعي، وهو أمر ميسور باعتبار أن تلك العلوم تتصدي لواقع الناس والمجتمعات، بما يُمكن من اختبار تلك النتائج فيها .
الإشكالية الثانية: وتتصل هذه الإشكالية بأن المنهجية الأصولية رغم نجاحها الكبير في صدر الإسلام في توجيه حياة المجتمع في كل جوانبها إلا أنها في العصور المتأخرة قد أصيبت بعدد من الشوائب التي قللت فاعليتها، وعلي سبيل المثال فقد انتقد الدكتور عبد الحميد أبو سليمان بمرارة ( 1992) ما أسماه “بقصور المنهجية الإسلامية بمفهومها التقليدي” نتيجة الانفصام بين علماء الإسلام من جانب وبين القيادة السياسية للمجتمع المسلم من جانب آخر، والتي أدت انصراف العلماء “إلي العمل في التأليف والبحث والدرس والتأصيل للجوانب الخاصة بدراسات نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما يتعلق بشيءون الأفراد من عبارات ومعاملات، دون كبير التفات إلي شيءون السياسة والحكم ومؤسسات المجتمع وذاتيته الجماعية والعامة .. وضاعت حكمة السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة وحركية الفقه والفكر الإسلامي، وانعدام في كثير من هذا الفكر بعدا الزمان والمكان وموضع للنص الجزئي من أصل مجمل الوحي والفطرة الإنسانية والكونية ….(ص ص 74، 77)، وقد أدي هذا كله إلي تقسيم العلوم إلي “علوم شرعية وغير شرعية”، وارتبط ذلك “بوأد العلوم الاجتماعية”، ثم يشير إلي أنه وإن كان الفقه الإسلامي خاصة “تتخلله تأملات اجتماعية إسلامية، ولكنه لا يقدم ما يمكن اعتباره علوماً اجتماعية إسلامية …. بسبب الفصام والعزلة عن أن يوالي التقدم، وأن يأخذ بزمام المبادرة الفكرية والتنظيرية لتوجيه مسيرة حياة الأمة ومؤسستها الاجتماعية، وإمدادها بالحلول والبدائل الحضارية اللازمة لمواكبة إمكانيتها وحاجاتها والتحديات التي تواجهها” (ص 82).
وفي ضوء ما تقدم يتبين أن الاتجاه إلي اعتماد العلوم ” الشرعية” بمحتواها التقليدي وبمناهجها الأصولية الحالية – نموذجاً تحتذيه العلوم الاجتماعية الموجهة إسلامياً لن يحقق الهدف المنشود من العلوم اجتماعية إسلامية قادرة علي قيادة الحياة في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة بشكل فعال، اللهم إلا بعد عملية تقويم شاملة تعود بهذه المناهج إلي أصل نصوعها وحيويتها، مع الاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة بعد تطويرها، علي الوجه الذي يحقق التكامل المنشود دون تجوٌزٍ أو صدود .
الاتجاه الثاني :الانطلاق من نموذج العلوم الاجتماعية الحديثة:
إن نقطة البدء عند أصحاب هذا الاتجاه هي الواقع الراهن الذي يقوم علي وجود متمايز، وهوية مستقلة لمجموعة من “العلوم الاجتماعية “، التي اختطت لنفسها حدوداً للظواهر التي تتعامل معها، والتي بلورت لنفسها مجموعة من المناهج والأدوات البحثية، والتي تختلف في ذلك كلة عن مجموعة “العلوم الشرعية” بمجالاتها ومنهاجها الخاصة بها، ومن هنا فإن أصحاب هذا الاتجاه ينظرون بشيء من الدهشة أو الانزعاج لما يقترحه أصحاب الاتجاه الأول الذي ينظر للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية علي أنه يتضمن استبدال مصادر ومناهج العلوم الشرعية بمصادرهم ومناهجهم “العلمية”، ويرون أن هذا يعني “إخضاع العلوم الاجتماعية للعلوم الشرعية” علي حد تعبير أحد المشاركين في ندوة حول مفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، وهو أمر غير وارد وغير مرغوب فيه من الناحية العلمية؛ لأن معناه عندهم أن نترك “العلوم” الاجتماعية ودراساتها المدققة، ونتائجها المحققة؛ لنستبدل بها “تأكيدات” يزعم أصحابها أنها تمثل وجهة نظر الإسلام، دون التحقق منها واقعياً، ويطلب من الباحثين أن يسلموا بها علي أنها دين، بكل ما يترتب علي ذلك خصوصاً في حالة وجود اختلاف في الرأي قد ينظر إليه علي أنه دلالة علي عدم الالتزام الديني، كما أن بعض أصحاب هذا الاتجاه يتصورون أن تبني نموذج العلوم الشرعية في التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية يعني تحويل تلك العلوم إلي مواعظ وخطب تدور حول الدعوة إلي فعل أشياء والنهي عن فعل أشياء أخري علي أساس معياري ودون دراسة “علمية “.
وفي مقابل ذلك يري أصحاب هذا الاتجاه أن “الأصل” أن لدينا تراثناً متراكماً من نتائج العلوم الاجتماعية، والتي أثمرتها جهود أجيال من الباحثين اللذين كرسوا حياتهم لها، وأن لدينا ثروة وافرة من مناهج البحث وأدوات القياس التي تمت تجربتها علي مدي السنين، حتي اشتد عودها، وثبتت قيمة الكثير منها، وبان إمكان الاعتماد عليها، وأن الباحث المسلم لا يمكن له أن يتجاهل وجود هذه النتائج والمناهج جملة واحدة، وأنه لا يليق به أن يتخذ منها موقفاً رافضا من البداية، فهذا كله يتمخض عنه ضياع وإهدار لجهود وتراث شارك المسلمون أصلاً في نشأته الأولي، كما أن معناه أن نبدأ من فراغ، أو أن نبدأ من جديد عند النقطة التي توقف فيها إبداع العقل المسلم عن العطاء منذ بضعة قرون.
ومع ذلك فإن أصحاب هذا الاتجاه مقتنعون بأهمية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ولكنهم قانعون بمنهجيه يرونها واقعية (تجنبنا المثالية علي حد تعبير أحدهم) يكتفي فيها بالانطلاق من النتائج المحققة والمناهج الشائعة الاستخدام في العلوم الاجتماعية في أرقي صورها، علي أن نأخذ في الاعتبار أوجه النقد التي تثار حولها من داخل النموذج العلمي التقليدي ذاته، مع إضفاء الصبغة الإسلامية عليها علي الصورة الآتية:
- اعتماد نتائج ونظريات العلوم الاجتماعية الحالية كما هي، (مع إثبات أوجه النقد –من الداخل – المثارة حولها)، وإثبات التحفظات عليها في ضوء التصور الإسلامي.
- استبدال المصطلحات الحديثة ببدائلها الإسلامية خصوصاً ما اتصل منها بالأنساق التصنيفية التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة.
- الاهتمام بالدراسات التراثية التي تمثل إسهام علماء المسلمين تاريخياً في نطاق كل تخصص من تخصصات العلوم الاجتماعية.
- إيضاح الرؤية الإسلامية لمشكلات العالم الإسلامي، واستخدام المعارف المتخصصة في إيجاد الحلول لها.
- تحديد النماذج النمطية المعيارية للسلوك الفردي وللتنظيمات المجتمعية كما تشير إليها المصادر الإسلامية؛ لتتخذ كمعيار تقاس عليه ألوان السلوك الفردي والاجتماعي وأشكال التنظيمات الاجتماعية الواقعية.
وأما من الناحية المنهجية؛ فإنه ليس مطروحا عند أصحاب هذا الاتجاه الاعتماد علي المناهج الأصولية التي تقوم علي استنباط من النصوص، بل إن الأصل في العلوم الاجتماعية قيامها علي الدراسات الواقعية التي تستهدف “الوصف” تعرفاً علي آيات الله في خلقه، كما تستهدف “التفسير” كشفنا عن سنن الله في مخلوقاته. ولقد أوضح الدكتور فؤاد أبو حطب (1989) المقصود بذلك، إذا قال :
“والتعرف علي آيات الله في خلقه علي مستوي العلم المتخصص لا يتحقق إلا بالوصف الجيد الدقيق لها، ومن هنا يحتل الوصف مكانة أولي بين أهداف العلم في الإسلام …والوصف العلمي يعتمد في جوهره علي الملاحظة…. وقد تكون الملاحظات مباشرة…. وفي الحالتين تكون المؤشرات القابلة للملاحظة المباشرة التي تستخدم في التسجيل والوصف من نوع معطيات الحس …” (ص 92) ثم يشير إلي أنه إذا كان ” الوصف “الدقيق المحكم هو وسيلة العلم إلي “التعرف علي آيات الله”, فإن “الكشف عن سنن الله في مخلوقاته” يتم من خلال “التفسير”، ولكن التفسير يقود بدوره إلي هدفين آخرين هما “التحكم” و”التنبؤ”، وبين أن الإنسان يستخدم …. “في التعرف علي آيات الله (أي الوصف) وفي الكشف عن سننه (أي التفسير) ما زوده سبحانه وتعالي به من معم، وخاصة الحواس والعقل” [ص ص 93، 96 ، 98 ]. وإذا يدرك المؤلف أن ما جاء تحت أهداف العلم “يبدو تقليدياً” فإنه يذكر أنه في إطار المنظور الإسلامي “تصبح له صبغة إسلامية “، فالقانون العلمي الذي يتوصل إليه علماء النفس هو بمثابة “محاولة بشرية قد تصيب وقد تخطي في اكتشاف السنة الإلهية “(ص 98).
كما أن العلم في الإسلامي شامل لأمر الدنيا والآخرة – كما يبين المؤلف – وهو يتطلب التَعلم والتعليم، والاستعداد للتعلم والقدرة علي التعليم من نعم الله علي الإنسان، كما أن العلم عبادة، ودراسة النفس وتأملها مطلب قرآني بأمر مباشر من الله تعالي كجزء من الدعوة الصريحة إلي تأمل الكون. “والوجهة الإسلامية” لعلم النفس تطالبنا بأن “نتأمل القوائم التصنيفية والجداول الحالية لهذه الظواهر النفسية في إطار إسلامي ناقد لنتوصل إلي تصنيف يتفق مع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه الكريم ” (ص 92 ).
أما عن مناهج البحث؛ فإنه يوضح أنه “بمنطق الإسلام تصبح طرق البحث في علم النفس- إذا توافرت فيها [بعض] الضوابط – مقبولة، ابتداء من منهج الرواية أو المنهج القصصي…. حتي الاستنباط والتجريب الموضوعي والقياس، كما تستخدم جميعاً في وقتنا الحاضر” (ص 94). ولكن العلم من الوجهة الإسلامية ينبغي أن يتم “استخدامه” وتطبيقه لتحقيق المقاصد الشرعية؛ ليكون العلم عبادة، فالتعرف علي الآيات والكشف عن السنن سبل “لمعرفة الله والوصول إلي عظمته”، ثم إن العلم في الإسلام هو العلم النافع من جهة “فائدته المباشرة للناس”، كما أن العلم الإسلامي يتضمن استخلاص مواصفات نموذج السواء، أو “النموذج القدوة” للسلوك الإنساني، كما يجب أن يكون من القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة النبوية ” (ص 103).
ولا نظن أنه يخفي علي صاحب ذلك البحث المنهجي الرصين أن عملية استخلاص مواصفات هذا “النموذج السلوكي الإسلامي” من القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة النبوية، تتطلب ولا شك استخدام المناهج الأصولية التي توجه عملية الاستنباط من النصوص، وفي هذا دلالة ضمنية علي اقترب من يتبعون هذا الاتجاه بدرجة ما من أصحاب الاتجاه الأول، مما يفتح الباب أمام من ينادون باتجاه تتكامل فيه وجهتا النظر بشكل صحي.
وهناك حجة “عملية ” منطقية يشير إليها أصحاب الاتجاه الثاني الذين يرون اتخاذ العلوم الاجتماعية الحديثة كأساس لانطلاقة التوجيه الإسلامي لتلك العلوم، فهم يشيرون إلي ان تلك العلوم بنتائجها ومناهجها تملأ الساحة اليوم، وجيوش الخرجين اللذين يشغلون معظم مواقع العمل في مختلف جوانب الحياة قد تم تعلميهم وفق النموذج التقليدي لهذه العلوم، وهم يمارسون أعمالهم وفق هذا النموذج ذاته، ولا يعقل أن نبدأ في محاولة التعامل مع هؤلاء الذين يتخذون القرار اليوم في كل جوانب الحياة عن طريق لفتهم بشدة إلي منطلقات جديدة تماماً عليهم، وليس من العدل أن نطالبهم بالسير في طريق التأصيل (وفق الاتجاه الأول) في اتجاهات لم يألفوها، ويصعب عليهم الارتباط بها معتمدين في ذلك علي استثارة مشاعرهم ونخوتهم الدينية، وإنما مقتضي الإنصاف أن نبدأ تدريجياً من حيث يقفون اليوم، ومن المصطلحات التي ألفوها؛ لكي ننتقل معهم في الاتجاه الصحيح بما يتمشي مع اتضاح منهج التوجيه الإسلامي وبما يتمشي مع ظهور ثماره.
ثم إن أصحاب هذا الاتجاه الثاني يشيرون أيضاً إلي أننا علي كل حال لا نبدأ نقد نتائج هذه العلوم الاجتماعية الحديثة ومناهجها من فراغ، ولكن هذه العلوم قد وصلت تلقائياً – ومن خلال التصحيح الذاتي للعلم – إلي شيء من النقد من الداخل لهذه النتائج والمناهج كما تقدم، والكثيرون ممن أفنوا أعمارهم في تعلم تلك العلوم وتعليمها لديهم الكثير مما يندرج في إطار هذا النقد من الداخل، وأن من الخير أن ننطلق من مثل تلك البصائر التي تشير – ومن عجب – في كثير من الأحيان إلي ما يقترب من الاتجاهات التي ينادي بها التوجه الإسلامي (ولا نتوقف عندها بالطبع )، وصولاً إلي ترشيد تلك العلوم بطريقتها، وبما ييسر قبول التغيير، ويتلافي أسباب المقاومة، فالواقع أن التهجم علي العلوم الاجتماعية دون تدقيق أو تمييز يؤدي إلي تردد الباحثين من أهل الجد والرصانة العلمية وتوفقهم عن قبول الكثير مما يمكن أن يُقبل لولا ذلك التهجم، ولقد ظهرت آثار ذلك في البحث المشار إليه آنفاً لشيخ علماء النفس في مصر الدكتور فؤاد أبو حطب الذي بدأه بالفقرة التالية: ” لعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن علماً من العلوم الإنسانية أو السلوكية أو الاجتماعية لم يلق في تاريخه ما لقيه علم النفس من غارات الهجوم الضاربة، وكانت أشد هذه الحملات قسوة وعنفاً في السنوات الأخيرة، تلك التي صدرت عن فريق من الكتاب الإسلاميين…. لم يجد هذا العلم إلا قلة من رجاله هم اللذين تصدوا لأعباء الدفاع، وأقل القليل…. توجهوا لمهام أكثر إيجابية في مجال الإبداع” (ص 1).
تعقيب:
لا يعدم من يتابع المناقشة السابقة أن يستشعر أن كل اتجاه من هذين الاتجاهين المتمايزين قد أصاب جانباً من الحق، وإن جانبه الحق في بعض ما ذهب إليه المدافعون عنه، وإذا كنا قد ذكرنا منذ البداية أن هذين الموقفين إنما هما بمثابة القطبين المتباعدين، فإن علينا أن نتذكر احتمالات مبالغة أنصار كل اتجاه في إبراز الحجج المؤيدة لموقفه ضماناً لإبراز وجهة نظره وبيانها بقدر كافٍ من الوضوح، فإذا أضفنا إلي ذلك أن هذين الموقفين إنما يقعان بالقرب من طرفي مقياس متدرج مزدوج النهايات Continuum، فإن معني ذلك أنه يندر أن نجد بين الباحثين اليوم من يلتزم بما يمكن ان نسميه بالصورة “النقية” المطرفة لأي اتجاه من الاتجاهين، والصورة الأكثر احتمالاً أن نجد أن موافق الباحثين تقع في مكان ما بينهما، بحيث تمتزج في تلك المواقف دائماً عناصر تنتمي إلي كل من الاتجاهين، ولكن بدرجات متفاوتة.
ولعل أحد العوامل الفارقة بين نظر الفريقين كما رأينا يتمثل في النتيجة التي توصل إليها كل منهما في تقويمه لنتائج ومناهج العلوم الاجتماعية الحديثة، فأصحاب الاتجاه الأول يبدون وكأنهم يرون كل عيوب تلك العلوم وسوءاتها، ولا يكادون يرون فيها خيراً أبداً، كما يرون أن ما هو معيب في تلك العلوم متداخل ومختلط بما قد يكون فيها من صواب اختلاطاً شديداً لا يمكن معه عزل الغث من السمين، ويرون أن السبب في ذلك يرجع إلي الافتراضات الوجودية (الأنطولوجية) والافتراضات المعرفية (الأبستمولوجية) التي بني عليها المنهج والتي تشربت بها النظريات معيبة، وبالتالي أن كل ما بني عليها معيب، وأن أي محاولة لاستنقاذ أي خير منها محكوم عليها مسبقاً بالفشل. بينما يري أصحاب الاتجاه الثاني أن في هذه العلوم نضجاً وخيراً كثيراً، وأن الغرب قد استخدم نتائجها بنجاح لتحقيق أهدافه وفق تصوراته، وأنه يمكن بسهولة عزل العناصر المخالفة للتصور الإسلامي واستبعادها, ثم استبدالها بما يناسب ذلك التصور، ويرون في الضبط والاتساق المنهجي الذي تلتزم به الكثير من الدراسات الواقعية نماذج تحتذي لا يمكن أن يفرط فيها إلا غافل.
وفي كل من المقالين حق لا مراء فيه كما ذكرنا، وإن كان في كل شيء كثير من المبالغة، ويبدوا لنا أن الحق يمكن بين هاتين النظرتين إذا أعرضنا عما فيهما من مبالغة, وبلغة أخري فإن الصواب يبدوا لنا في التوازن بين الاتجاهين بشكل إيجابي، يري ما في العلوم الاجتماعية الحديثة من خير علي حقيقته دون زيادة أو نقصان، ويرفض رفضاً قاطعاً ما يشوبها من أخطاء، وإن كان في الوقت ذاته لا يتحرج عن قبول ما قد يكون فيها من خير دون تردد، ولعل العبارة البليغة التي جاءت علي لسان الدكتور سيد أحمد عثمان ضمن فعاليات إحدي الندوات التي عقدت مؤخراً حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية أن تكون قريبة من تصوير هذا الموقف، حيث تساءل ” ما الموقف من العلوم الاجتماعية المعاصرة ؟ ألا يحتاج أي تأصيل إسلامي للعلوم الاجتماعية لتحديد الموقف وتوضيحه وتفصيله من هذه العلوم المعاصرة ؟ [إن في تلك العلوم] من القوة والنضج بقدر ما فيها من الوهن والغرارة، فما الموقف منها؟ هل نقيم بيننا وبينها – ابتداء- حجابا من العداء أو جداراً من الازدراء أو بيداء من الجفاء، أم نقبل عليها لنتعرف علي ما فيها من نضج، فنفيد منها في إثراء نظرتنا العلمية الإسلامية، وفي تقويم منهجنا البحثي الإسلامي في العلوم الاجتماعية، وثم لنكون علي بينة مما فيها وهن، وعلي دراية بما فيها من غرارة، فنحرص علي تعويض ما يمكن تعويضه من وهنها من جانبنا إن كنا نستطيع، ونعمل علي إنضاج ما يمكن إنضاجه منها من جانبنا إن كنا علي هذا قادرين ….؟”.
ولعل هذه الدعوة إلي الوسطية والاعتدال والنصفة في النظر إلي الأمور أن تكون أولي بنا، وأن نكون أولي بها في مواجهة مثل هذه القضية البالغة التعقيد والبالغة الأهمية في آن معاً. إن ما نحن بصدده اليوم لا يقل عن أن يكون محاولة لاستعادة مسار أمتنا علي طريق الحق، وأن يكون دعوة إلي دعوة معارفنا إلي منهج العلم بمعناه الإسلامي الصحيح… منهج وحدة المعرفة، المبنية علي وحدة الخلق، المستمدة جميعاً من عقيدة وحدانية الخالق.. منهج البحث عن الحقيقة بحثاً خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالي، فلا يصدنا شنآن قوم علي عدم العدل، ولا يصرفنا صارف علي أن نقول الحق ولو علي أنفسنا أو الوالدين والأقربين؛ لأننا إن فعلنا نكون الخاسرين في كل من الحالتين، وسنن الله لا تحابي أحداً، {ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يحجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً} [النساء :123 -124]. هذا هو “الموقف المتوازن “الذي سنحاول الالتزام به، ونحاول تجلية أبعاده في تحديد خطوط منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية فيما تبقي من هذا البحث.
المبحث الثالث: نحو منهج متوازن للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية:
إن ما نقصده بالمنهج المتوازن الذي نحاول التزامه في هذا البحث هو ذلك المنهج الذي يأخذ من المناهج الأصولية بقدر الحاجة إليها؛ وصولاً للفهم المنضبط لنصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فيما يتصل بشؤون الإنسان والمجتمع، كما يأخذ من مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة بقدر الحاجة إليها فيما يتصل بفقه الواقع الاجتماعي والإنساني دون تجاوز أو صدود، وبهذا يوضع كل من النوعين من المناهج في أفضل موضع يمكننا من إنتاج علم إجماعي إسلامي بالمعني الصحيح، أي علم إجماعي واقعي مهتد بنور الوحي وموجه بتوجيهاتها. ولكن هناك عددًا من الأسئلة التي ينبغي طرحها هنا، وهي: هل سيتم استخدام المناهج الأصولية بنفس أسسها ومنطلقاتها الحالية؟ وهل سيحقق استخدام تلك المناهج الآمال المرجوة منها في إنشاء هذا العلم الاجتماعي الإسلامي؟ وإذا كان ذلك كذلك، فلماذا لم تنتج تلك المناهج علماً اجتماعياً إسلامياً حقيقياً من قبل هذا كجزء لا يتجزأ من “الفقه”، أو أي من علوم الشرعية الأخري؟ ومن جهة أخري هل سيتم استخدام منهج البحث العلمي المستخدم حاليا في العلوم الاجتماعية بنفس أسسه ومنطلقاته الحالية؟ وهل سيحقق ذلك الآمال المرجوة في إصلاح هذه العلوم في ضوء التوجه الإسلامي الصحيح؟
إن من الواضح ان استخدامنا لكل من النوعين من المناهج لإنتاج العلم الاجتماعي الإسلامي سيتطلب تعديلات تجري في منظور كل منهما إذا اردنا أن نواجه أنفسنا مواجهة صريحة في هذه القضية، فإذا كنا كما يقول الدكتور طه العلواني (1988): لا نرضي بأن يكون مصدر معارفنا كلها هو “الوجود” وحده، كما يفعل علماء الغرب، وإذا كنا قد انتهينا إلي ضرورة ضم ” الوحي” ليكون مصدراً الآخر للمعرفة، فلا بد من منهج يتعامل بكفاءة مع هذين المصدرين من مصادر المعرفة (الوحي والوجود)، وإذا كانت لنا ملاحظات علي المنهج الغربي المعاصر للتعامل مع الوجود، وإذا كانت لنا أيضاً ملاحظات علي منهج الأصوليين، فإن علينا أن ننظر في هذه المناهج جميعاً لنري ما هو صالح وما يمكن توظيفه منها، ” وما تحتاجه المساحات الخالية ” لنضيفه إلي تلك المناهج “…. لكي يتكامل عندك المنهج العلمي مع المنهج الأصولي فتسد الفراغ الذي لم يسد في الظاهرة الاجتماعية والإنسانية ” (ص 49)، وسنحاول فيما يلي أن نستجلي أبعاد هذه القضية تمهيداً لعرض منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية المنطلق من هذا المنظور في البحث التالي، بادئين أولاً بالنظر في مناهج علم أصول الفقه ثم ثانياً بالنظر في مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة.
(1) الموقف من المناهج الأصولية:
يحذرنا الدكتور العلواني – وهو من المتخصصين البارزين في العلوم الشرعية – من الظن بأن إجراء بعض تعديلات طفيفة علي منهج الأصوليين يمكن ان يجعله منهجًا صالحاً لكل القضايا، فالظاهرة “الاجتماعية والإنسانية يستحيل أن نتعامل معها كما نتعامل مع القضية الفقهية.. فلا يمكن أن ندعو إلي إهمال سائر المناهج والاقتصار علي المنهج الأصولي كما هو وبوضعه الحالي؛ لأنه منهج لن يلبي الحاجة المطلوبة، وإنما نقول: ما دام لنا مصدران للمعرفة (الوحي والوجود) فلابد لنا من منهج يجمع بين الاثنين، بين المنهج العلمي وبين منهج نريده للوحي، فالأصوليون قرروا هذا المنهج وفيه ما فيه… وكثير من قضاياه قابلة للنقض والأخذ والرد…. ” ولكن من الممكن تطويره ليكون منهجاً للوحي الذي سيتناول ظواهر اجتماعية وظواهر إنسانية (ص 50).
وقد أوضح الدكتور العلواني ضمن ما عرضه في سلسلة من المحاضرات الهامة التي ألقيت في ستراسبورج (1988) أنه من الصعب مد منهج أسس في الأصل لمعالجة الظاهرة الفقهية، وهي ذات صفة خاصة تتسم بالجزئية في الغالب؛ لكي يكون صالحاً لمعالجة الظاهرة الاجتماعية أو الإنسانية التي يراد أن تكون معالجتها متصفة بالتعميم، كما أن الظاهرة الفقهية المطلوب منها أن نتبين الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي {معناه في علم الأصول ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء}، أما الظاهرة الاجتماعية والإنسانية فنريد منها أن نتبين القوانين والسنن وشبكة العلاقات التي يمكن علي ضوئها أن نقيم نظاماً صالحاً… لا أتوقع أن أصول الفقه في وضعه الذي أعرفه قادر علي أن يستجيب لهذه الحاجة ” (ص 39).
أما عن الملاحظات التي يشير إليها الدكتور العلواني (بطريق النقد – من الداخل – باعتباره متخصصاً في العلوم الشرعية ) حول منهج أصول الفقه والتي يري أنها تحد من فاعليته في تحقيق المأمول من وراء بناء مناهج العلوم الاجتماعية علي غراره، فيمكن إجمالها في ثلاثة:
- أن تعريف الأصوليين للأجماع وبيانهم لحقيقه “أفقد هذا الدليل معناه”، إذ قالوا: إنه “اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد في عصر من العصور علي أمر من الأمور، وهذا أمر يستحيل تحقيقه”، رغم أن الإجماع دليل من أفضل الأدلة، وقد “كنا نريد أن نستخدمه دليلاً يمكن أن يغطي مساحة من المساحات الخالية ….”(ص 41 ).
- تجميد العقل وإفقاده أهميته كدليل؛ نتيجة لكثرة القيود والضوابط التي وضعت عليه بسبب ظروف استثنائية نتجت عن انفصال علماء الأمة عن قيادتها السياسة وعدم ممارستهم للحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولما حاولت القيادة السياسية الاستعانة بعناصر فقهية لا تثق فيها الأمة فقد حاولت الأمة الدفاع عن “فقهها وعن تشريعها وعن دينها بأن تقول :إما أن تأتوني بنص من الكتاب والسنة، وإما أن تأتوني بأقوال إمام من الأئمة السابقين…(ص 42)، مما أدي إلي إفقاد العقل المسلم لفاعليته .
- كما أن الاجتهاد أيضاً قد تمت معاملته معاملة الإجماع، فشروط الاجتهاد “بالطريقة التي وضعها الأصوليين يستحيل [معها] أن تجد مجتهداً” (ص 44) .
ويقرر الدكتور العلواني أنه لا بد من إعادة النظر في الاجتهاد؛ ليكون مفهومه ” هو المفهوم الذي ينسجم مع مقاصد الإسلام، والذي يمكن أن نتعامل به مع الظواهر المختلفة، آنذاك ربما يكون لدينا فقه من نوع آخر، ليس الفقه في الأحكام الجزئية الشرعية المعروفة، وإنما فقه نستطيع أن نسميه فقه الواقع، فالدراسات الاجتماعية المختلفة تعد نوعاً من الواقع..”، وينعي الفقيه الناقد في محاضراته القيمة علي الفقهاء إهمالهم فقه الواقع واقتصارهم علي الفهم اللغوي، فالحكم الشرعي “خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين [إما بالطلب] أو التخيير، وأن أركان الحكم :حاكم وهو الله سبحانه وتعالي …ومحكوم عليه، وهو المكلف الإنسان، ومحكوم به، وهو الحكم، …في فقهنا درسنا الحكم وعرفنا الحاكم …ولكن المحكوم عليه الذي هو الإنسان :طبيعته، قوته، ضعفه [عندما] نتحدث عن رفع الحرج، وعن التكاليف، وعن سد الذرائع، وعن المصلحة، وعن الاستحسان، هذه كلها لا نستطيع أن نعرفها دون أن نتعرف علي هذا المحكوم عليه الذي هو الإنسان فرداً أو أسرة أو دولة أو قيادة ” (ص44) .
ويضيف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان (1990) في نفس الاتجاه أن “العقل المسلم والمنهج الأصولي قد قدما للإنسانية تراثاً وفكراً حضارياً غير مسبوق أضاء حلكة الأفق الإنساني كله، [ولكن] مع تعاظم الهوة بين الغاية الإسلامية والالتزام الإسلامي، ضعف الأثر الإسلامي …[واليوم] فإن جوهر أزمة هذه الأمة إنما ينبع من الجمود والقصور والتدهور الذي ألم بمنهجية فكرها الإسلامي، مما أدي إلي تدهور قدراتها …”(ص ص 108، 113 )، ولعل هذا كله يشير من جهة إلي أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي بمنهج أصولي مستجيب بجرأة وفاعلية لحاجات الواقع المتغير، سائر في حدود التوجيه الإلهي ومنضبط به، بما لا يترك مجالاً لمساحات خالية من حياة المجتمعات المسلمة تغيب عنها شمس المنهجية الإسلامية الحية، تملأ بغثاء من إفراز العقول البشرية غير المهتدي بنور الوحي وغير المنضبط بضوابطه. كما أن هذا كله يشير من جهة أخري إلي حاجتنا الماسة إلي جهود جهابذة المتخصصين في المناهج الأصولية ممن لديهم القدرة والكفاءة، وممن يدركون هذه الأبعاد الكبرى للقضية، وممن يستطيعون النظر في الكيفية التي يمكن بها أن تستجيب تلك المناهج للقضايا الكلية الأوسع التي تهتم بها العلوم الاجتماعية، حتي تتكامل بهذا علوم الإسلام، بما يخدم الأمة وحاجتها وبما يعينها علي النهوض من كبوتها .
(2) الموقف من مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة:
لقد لخص الدكتور عبد القادر هاشم رمزي ( 1984 ب) موقف المنهج “العلمي” للبحث في الدراسات الإنسانية وآثار اتباع هذا المنهج (المستمد من مناهج البحث في العلوم الطبيعية) علي المجتمعات الإنسانية تلخيصاً جيداً حين أشار إلي عدم ملاءمة تلك المناهج للدراسات الإنسانية، وإلي أن هذه الدراسات المنصبة علي الإنسان والمجتمع نتيجة لذلك قد “غيرت اتجاهها وطريقتها، وتشعبت موضوعاتها وفروعها بشكل لم تعد معه إيجابية أو علمية …كما اختلطت فيها الحقائق بالأوهام اختلاطاً جعلها عاجزة عن سد الفجوة الثقافية، بل جعلها أضعف وسيلة في مجال الحفاظ علي توازن المجتمع الإنساني وإيقاف التراجع الثقافي أمام التفجر المعرفي والتطور التكنولوجي….” (ص 62)، وتلك أحكام لا يمارى في صدقها ومطابقتها لمقتضي أحوال الأمم اليوم إلا مكابرٌ فالمجتمعات المعاصرة التي قعدت زمناً تنتظر الهداية في فهم النفس الإنسانية علي أيدي أمثال سمجنود فرويد، وفي تربية أبنائها في ضوء حكمة أمثال دكتور سبوك، وفي بناء حياتها الاقتصادية والاجتماعية علي أيدي أمثال آدم سميث وكارل ماركس لم تؤب علي أيدي هؤلاء وقرنائهم إلا بالخسران المبين، الذي تصرخ به أحوال المجتمعات المعاصرة وما تفيض به حياة الناس فيها من اختلالات ومظالم، تبدو مظاهرها علي مستوي الأفراد، كما تبدو علي مستوي المجتمعات وعلي المستوي الدولي.
وإذا كان هذا النوع الهداية التي تقدمها العلوم الاجتماعية للمجتمعات، فلا غرور أن يتخذ الكثيرون منها موقفاً رافضاً، وأن يعيدوا النظر والبحث عن مصادر أصدق للتوجيه الفردي والمجتمعي، ولكن لما كانت هذه العلوم قد حققت أيضاً بعض النجاحات في العديد من الأمور الجزئية كما قدمنا، فإنه قد يكون من المفيد لتحديد موقفنا من هذه العلوم ومن مدي إمكان الاعتماد علي مناهجها ضمن إطار منهجية التوجيه الإسلامي للعلوم أن ننظر أيضاً في جوانب الضعف أو القصور في تلك العلوم ومناهجها؛ لتلافي هذه الجوانب من الضعف، واستكمال جوانب القصور، ضمن منهجية أشمل.
إن باستطاعتنا أن نميز بوضوح عاملين جوهرين يمكن النظر إليها علي أنهما من أهم أسباب الضعف والقصور في العلوم الاجتماعية المعاصرة، يتصل أولهما بالمنهج، ويتصل الآخر بطبيعة الظواهر الاجتماعية والإنسانية (كما ألمحنا من قبل ). فأما من جهة المنهج؛ فإنه من العلوم أن الفلسفة الوضعية التي دعا إليها أوجيست كونت وأشاعها، قد قامت على نظرة مادية بحتة للوجود وللإنسان، تعكس التصورات التقليدية لعلم الطبيعة ولفلسفة العلم المرتبطة بها في القرن التاسع عشر، كما استهدفت في الوقت ذاته قطع كل صلة للعلوم الاجتماعية بالدين ممثلاً في الكنيسة؛ لإبعاد تأثير المعتقدات الخرافية عن مجال العلم، فل تعترف الوضعية بغير معطيات الحس سبيلاً للمعرفة، مما أثر في النهاية علوماً اجتماعية تقف علي ساق واحدة، أجهدت نفسها إجهاداً شديداً في دراسة ما هو مادي بدني في الإنسان، وأغفلت أو تجاهلت الجانب الروحي غير المادي الذي يتمني إلي عالم الغيب، فلما أهملت مصدر المعرفة بالغيب ألا وهو الوحي، فإنها قد ضلت فأضلت أجيالاً متعاقبة من البشر ممن أحسنوا الظن بتلك “العلوم “، التي حسبوا أنها علي شيء نتيجة لادعاءاتها المتواصلة، ولقد أشرنا تفصيلاً في مواضع آخر (رجب، 1991) إلي أن الاكتشاف العلمية الحديثة في علم الطبيعة علي أيدي آينشتاين وهايزبرج قد أطاحت بتلك النظرة المادية التقليدية للعلم، وإلي أن هذه الاكتشاف قد ترتبت عليها مراجعة جذرية في اتجاهات فلسفة العلوم خلال العقود الأربعة الأخيرة، مما أسفر عن الوجهة الجديدة في العلم The New Paradigm كثورة علي الوضعية الإمبيريقية التي لاتزال هي الأساس الفلسفي الذي يقوم عليه؛ بناء العلم التقليدي إلي يومنا هذا. وقد أوضحنا في العمل المشار إليه آنفا بأن هذه التطورات الرائعة في مجال علم الطبيعة وعلوم الأعصاب قد أدت إلي فتح المجال من جديد نحو أخذ العوامل العقلية والمعرفية، بل والروحية في الاعتبار في ضوء هذا “المنظور الجديد للعلم ” (أو جروس وستانسيو، 1984)، وهذا التحول في نظرية المعرفة الحديثة وفي المنهج العلمي الجديد في دراسة الظواهر الإنسانية يفتح الباب علي مصراعيه أمام مشروعية الإفادة من مصادر للعلم متجاوزة لمعطيات الحس، وهي عندنا ليست شيئاً آخر إلا وحي السماء وهدي الله علي الوجه الذي قامت عليه حضارة الإسلام في عصرها الزاهر الأول، حيث يمد الوحي الإنسان بالأطر التصورية العامة، ولكنه يطالب الإنسان في الوقت ذاته باستخدام الحواس والعقل في استكشاف سنن الله في الآفاق في تناغم تام ووحدة كاملة .
وأما من جهة النظر إلي طبيعة الظواهر الاجتماعية الإنسانية، فإن أخطر الأخطاء التي وقعت فيها العلوم الاجتماعية الحديثة هي الظن بأن دراسة الواقع الفردي أو الاجتماعي أو دراسة الظواهر النفسية والاجتماعية علي الأشكال والصور التي تتبدي بها في المجتمعات موضوع الدراسة يمكن أن يكون منطلقاً للفهم الموضوعي للإنسان والحياة الاجتماعية، ويمكن الخلل الخطير في هذا المنطق في التغافل عن قضية المعيارية التي هي جزء لا يتجزأ أبداً من الوجود البشري في كل صوره (وإن لم تكن لازمة لدراسة الوجود المادي, الذي تتعرض له العلوم الطبيعية بالدراسة).
إننا إذا تأملنا طبيعة الإنسان الفرد من جهة، وطبيعة المجتمع الإنساني من جهة أخري؛ فإننا ندرك علي الفور أن من المستحيل بناء علوم اجتماعية علي أساس الملاحظة الخارجية والتجربة التي تنصب علي ما هو واقع وكائن وحده؛ لأن ما هو واقعٍ وكائن لا يمثل في ذاته ناموساً أو قانوناً اجتماعياً، وإنما هو يعتبر مجرد وصف لمحصلة الاختيارات المحددة التي اختارها البشر تحت ظروف معينة، ولو أن نفس أولئك البشر قد اتخذوا لهم أطراً مرجعية مختلفة، فاعتقدوا مثلاً بديانة، أو التزموا أيديولوجية أخري لا تخذ واقعهم وما هو كائن فيهم صورة واقعية مختلفة، وهنا يدخل في الصورة ما ينبغي أن يكون – أي العنصر المعياري يكون كل شيء مساوياً لكل شيء دون وجود نقطة بدء يقاس إليها كل شيء ..وليس هذا إلا العقيدة الصحيحة (وليس أي عقيدة، فالقضية ليست نسبية موحدة ترد كل شيء إلي مصدر كل الخير في هذا الوجود وترتبط به سبحانه جل شأنه) التي يكون بمثابه القطب الشمالي للبوصلة الذي تنسب إليه كل الاتجاهات فيصبح لكل شيء معني بعد أن كان لا معني له في ذاته.
فإذا كان المولي سبحانه وتعالي قد عرفنا أنه قد خلق الإنسان قادراً علي السير في أي من الاتجاهين {ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها }[الشمس: 8] فكيف يمكن لنا أن نتخذ من ذي الاتجاهين (أو بالأحرى ذي الاتجاهات) أساساً يقاس به نفسه إلي نفسه ؟ إن هذه النسبية المطلقة التي تترتب لا محالة علي الأخذ بالتوجهات الحالية للعلوم الاجتماعية لهي ولا شك أساس للضياع الذي تعاني منه البشرية اليوم في حضارة تعتبر نفسها “حضارة العلم”… ولا يقصد أصحاب التسمية بذلك فقط العلم الطبيعي، بل أيضاً العلم الاجتماعي، ولكن المولى جل شأنه أبت حكمته أن يتركنا هملاً دون هدى أو رشد، فالآيات الكريمة لتلك التي حددت تلك الطبيعة الأصلية المتكافئة للإنسان، تأتي لتبين لنا مباشرة ماهية القطب الشمالي، أي المعيار الذي يمكن بالقياس إليه تحديد الاتجاهات {قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها} [الشمس :9، 10] وطريق التزكية بعد ذلك موضح تفصيلاً في آيات الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، وعليها يقاس السلوك الفردي معيارياً، وبها يتحدد الاتجاه.
ونفس النتيجة نصل إليها بمراجعة الموقف علي المستوي المجتمعي، فالعلوم الاجتماعية أيضاً تزعم أنها تقوم بدراسة ما هو كائن وواقع في المجتمعات البشرية، ولكنها أيضاً لا تملك نقطة بداية – لا تملك قطباً شمالياً تقاس إليه بقية الاتجاهات – فهل يمكن والحال كذلك أن تصل تلك العلوم إلي نتيجة ذات بال؟ يقول الدكتور عبد القادر رمزي (1984 ب) في تقويمه للنظريات التفاعلية في علم الاجتماع (وهي لا تختلف في هذا عن غيرها من نظريات علوم المجتمع ) “إنها لا تطرح أية وجهة نظر من خارج المجتمع، بل هي تتلمس الأحوال والأوضاع الاجتماعية، وتستنتج بعض الاستنتاجات المشروطة بهذه الأوضاع والأحوال وتسميها قوانين التفاعل الاجتماعي، وتواصل الدراسة والاستنتاج والتعميم علي مختلف المجتمعات. ولكن الرؤية الإسلامية – نظر وعملا – تقوم علي ما ترسمه الرسالة الإسلامية التي تضع دعائم المجتمع، وتصبغ مكوناته الأفكار والمشاعر والأنظمة والناس والقيادة “الدولة” بالصبغة المهتدية، وترسى قواعد الأفكار والعلاقات والمعاملات… في حركة متسامية متجهة نحو تحقيق استخلاف الإنسان في الأرض …”(ص 222).
ويضيف الدكتور رمزي أن المنظور أن المنظور الإسلامي في إطار هذا الفهم إنما يتمثل في بلورة مكونات المجتمع في ضوء النصوص، واستخلاص المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعملية الاجتماعية التربوية التي يفترض أن تجسد منهاج الرسالة الإسلامية، أي أن تكون العملية هداية للمجتمع وللفرد،….. وعليه فإن الرؤية الإسلامية لا تنشغل أو لا تهتم بتشريح عمليات التفاعل في المجتمعات غير المهتدية، بل ينصب اهتمامها علي رعاية الإيمان وعلي عملية الهداية وما يتعلق بهما، كما أنها لا تأخذ من المجتمع ما ترفعه به إلي مستوي الاهتداء دون أن يكون ما يريده هذا المجتمع أو ما يرتضيه أو ما يعيشه مقياساً أو مصدراً للأخذ ” (ص 222).
وفي ضوء التحليل السابق يتبين لنا أن منهجية العلوم الاجتماعية الحديثة وإن كانت لازمة بالضرورة كأحد المكونين الرئيسيين لمنهجية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، إلا أن هناك تعديلات جوهرية لابد من إحداثها في تلك المنهجية وفي النظرية المعرفية التي تستند إليها إذا أرادنا لها أن تحقق ما هو متوقع منها من فائدة في بناء علم إجماعي إسلامي صحيح، وأول تلك التعديلات يتمثل في إفساح المجال لدراسة عالم الغيب المتضمن في الجانب الروحي للإنسان بالرجوع إلي المصدر الأساسي للمعرفة فيه ألا وهو الوحي دون الاقتصار التقليدي علي عالم الشهادة وعلي شهادة الحواس، وأما ثانيها: فيتصل بالنظرة إلي طبيعة الإنسان والمجتمع الإنساني من حيث إنهما – بطبيعتها – لا تجدي فيهما دراسة ما هو كائن وحده، وإنما لابد لفهم سلوكهما من تعدي ذلك إلي الانطلاق من بعد معياري، بشرط أن يكون لهذا البعد المعياري صدق تجاوزي Transcendent ، أي أن يكون مصدره مصدراً متعالياً عن البشر، وأن يكون سند وصوله إلينا سنداً صحيحاً موثوقاً بعيداً عن التزييف والتحريف.
وتتبقي قضية أخيرة: هل يعني تأكيدنا علي الجانب المعياري باعتباره جوهر معني الحياة النفسية للأفراد والحياة الاجتماعية للمجتمعات أن نبالغ في الأمر، حتي ينكر البعض أنه توجد في الوقت ذاته أوجه للانتظام Regularities في حياة الأفراد والمجتمعات يمكن دراستها دراسة وصفية وصولاً إلي تعميمات تنطبق علي واقع الناس بصرف النظر عن الإطار المعياري الذي تمارس الحياة الفردية أو الاجتماعية في ضوئه؟ الحق أنه لا يمكن إلا لمكابر أن ينكر وجود تلك الانتظامات في السلوك الفردي والتنظيمات المجتمعية (التي لا يمكن بدونها أن توجد حياة إنسانية منظمة، ولا يمكن بدونها أن أيضاً فهم تلك الحياة) فالتعميمات التي توصلت إليها العلوم السلوكية حول الوظائف العقلية كالإدراك والتذكر والتعلم، وكذلك التعميمات التي توصلت إليها العلوم الاجتماعية مثلاً حول عمليات الاتصال والتأثير الجماعي، تعبر عن مثل هذه الانتظامات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو عن مدي الأهمية النسبية والقيمة الحقيقة لدراسة مثل هذه الانتظامات التي تظهر كثيراً ولا شك في ألوان مختلفة من السلوك الفردي والمجتمعي، والتي يمكن بالفعل دراستها دراسة وصفية تقريرية واقعية؟
إننا إذا أمعنا النظر في هذه الانتظامات التي تمتلئ كتابات العلوم الاجتماعية بالإشارة إليها علي أنها هي بؤرة اهتمام الدراسة فيها، لوجدناها لا تخرج في حقيقة الأمر عن مجموعة من الآليات أو المكانزمات ذات الطبيعة المحايدة التي يمكن استخدامها وتوجيهها؛ لتحقيق ما يختاره الناس من خير أو شر، ولكن مشكلة العلوم الاجتماعية المعاصرة أنها تشير إلي تلك الآليات علي أنها تمثل الصورة الكلية للحياة البشرية؛ بسبب ما هو ملاحظ من تداخلها المطرد في كل جوانب السلوك الفردي أو المجتمعي، ولكن هل يمكن لمن يفهم هذه الآليات أو الميكانزمات وحدها دون أي صلة بالأنساق المعيارية المحملة فوقها أن يفهم كلية الحياة البشرية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن إلا أن تكون بالنفي القاطع.
إن المجتمعات البشرية لا يمكن أن تنحصر توقعاتها من العلوم الاجتماعية في الوقوف عند تلك الآليات أو الميكانزمات المحايدة وحدها مهما بدا لذلك من وجاهة علمية شكلية، ولكنها تنتظر أن تساعدها تلك العلوم علي فهم السلوك الفردي والتنظيمات المجتمعية وإضفاء المعني عليها بما يعين علي تحقيق أهداف الإنسان، ولقد كان مقتضي الأمانة العلمية أن تضع العلوم الاجتماعية الصورة كاملة أمام تلك المجتمعات، وأن تبين الحجم الحقيقي والقيمة الحقيقية للجوانب الوضعية من تلك العلوم، فتضعها موضعها الصحيح، وتضع المجتمعات أمام مسؤوليتها فيها يتصل بخطورة اختياراتها، فيما يتعلق بالجوانب المعيارية، ولكن الأمر قد جاء العكس من ذلك، حيث أسهمت “نظريات “العلوم الاجتماعية بشكل نشط في تسريب الأطر المعيارية التي اختارتها وفق الظروف التاريخية والجغرافية التي أثرت علي تكوينها – وهي اطر إلحادية مادية عند معظم مؤسسي تلك العلوم كأوجيست كونت وإميل دور كايم – إلي حياة الناس تحت ستار العلم الوصفي التقريري الذي يصف ويحلل ما هو كائن بشكل موضوعي محايد …!!
التكامل بين المنهج الأصولي والمنهج العلمي الاجتماعي:
لقد انتهينا فيما سبق إلي أن منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية يقوم علي جناحين، هما: استخدام المنهجية الأصولية (في صورة أكثر سعة)، ومنهجية العلوم الاجتماعية الحديثة (في صورتها المعدلة)؛ وصولاً إلي علم إجماعي إسلامي ناضج، بحيث تنصب الدراسة في تلك العلوم علي الوجود الإنساني الكلي الذي يضم عناصر تنتمي إلي عالم الغيب، كما يضم عناصر تنتمي إلي عالم الشهادة، وتتكامل فيه مصادر المعرفة لتشمل الوحي، كما تشمل معطيات المشاهدة الحسية، وكذا عمل العقل (المنضبط بضوابط الوحي)، ولكن السؤال المهم الآن هو كيف يمكن أن يتحقق هذا التكامل، وما هي الصورة الواقعية التي يمكن أن يتخذها والتي يمكن أن ينطلق منها المشتغلون بالتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية فيما يبذلونه من جهود لتطوير وبلورة أبعاد هذا العلم الاجتماعي الناضج الذي نصبو إليه؟
لقد قدمنا في غير هذا الموضوع (رجب، 1991) (1993، Ragab) محاولة لوضع استراتيجية لإيجاد التكامل المنهجي بين حصيلة ما نستنبطه من المصادر الشرعية باستخدام المناهج الأصولية، وبين ما نتوصل إليه من الدراسة الواقعية للظواهر الإنسانية باستخدام مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة، ويمكن لمن شاء الرجوع إلي تلك المصادر تفصيلاً، ولما كنا أيضاً قد تعرضنا في ثنايا المباحث السابقة لبعض جوانب متفرقة تتصل بالموضوع، فإننا سنكتفي في هذا المقام بتلخيص الأسس العامة التي نظن أنها تحقق هذا التكامل كأساس لمنهجية موحدة للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية.
إن الصعوبة الرئيسية التي تقابل الباحث في أسس التكامل بين مناهج ونتائج تنتمي – لظروف تاريخية – إلي ما يشبه عالمين مختلفين (عالم العلوم الشرعية، وعالم العلوم الاجتماعية ) إنما تكمن في معيار الصدق المطبق في كل منهما، فمعيار الصدق في العلوم الشرعية يتمثل في صحة إسناد النصوص باستخدام منهج التحقيق التاريخ، ثم في صحة الاستنباط من النصوص باستخدام منهج أصول الفقه، أما معيار الصدق وفقاً للمنهجية العلمية الاجتماعية فهو مطابقة النتائج لما يشاهد في الواقع المحسوس باستخدام الملاحظات والتجارب.
ولعل أول خطوة لتقريب هذه الفجوة بين المنظورين تتمثل فيما سبق أن أشرنا إليه من ضرورة توسيع نظرة كل من المنهجين لحدود ولجوهر رسالته، بحيث يتجه علم أصول الفقه لإعطاء مزيد من الاهتمام لما كان في الماضي يعتبر من الأصول الفرعية الأقل أهمية؛ كالاستحسان والمصلحة المرسلة بما يمكن من تخطي “النظر الجزئي إلي النظر الكلي …[في ضوء] ما تمليه روح الشريعة” (أبو سليمان، 1990:ص 109) وذلك يساعد علي تغطية المساحات الخالية التي تتصل بالأمور الاجتماعية والسياسية التي تهم الناس؛ في الوقت الذي يتجه فيه المنهج العلمي للبحث في العلوم الاجتماعية إلي إعطاء مساحة أوسع لدراسة النواحي الروحية والاعتقادية في تأثيرها علي سلوك الأفراد وتنظيم المجتمعات، مع تحظي النزعة الإمبيرقية الحسية وتجاوزها إلي الآفاق الأرحب للنظر للإنسان في كليته، والنظر للواقع الفردي والاجتماعي في إطار النظرة المعيارية المنطلقة من التصور الموحد.
أما بوتقة التكامل بين النوعين من المناهج فإنها تتمثل في أنشطة “بناء النظرية” في العلوم الاجتماعية التي ينبغي أن تتم علي أسس جديدة قديمة في آن معاً! فالخط الذي التزمنا – والذي نعترف هنا بالانحياز إليه عن قصد – هو أن التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية لا يتطلب في حقيقة الأمر هدم كل ما سبقه والبدء من جديد، بقدر ما يتطلب النظر الناقد في ما هو متاح ومقبول ومتعارف عليه في المناهج والإجراءات والضوابط القائمة أولاً، فإن وجد فيها ما يغني فبها ونعمت، وإن وجدت بحاجة إلي إصلاح جزئي فلا بأس بذلك أيضاً، أما إن لم يوجد فيها ما يصلح علي الإطلاق فهنا وهنا فقط يكون المسوغ الحقيقي للبدء من نقطة الصفر دون تردد أو التفات إلي الوراء.
فإذا نظرنا في بناء النظرية من المنظور التقليدي بعين الإنصاف، فإننا سنجد أن الأسس التي يقوم عليها تنتمي إلي الفئة الثانية المذكورة أعلاه، بمعني أن في تلك الأسس خيراً كثيراً، ولكنها مع ذلك بحاجة إلي عدد من الإصلاحات الجوهرية؛ لكي تصبح قادرة علي استيعاب المنظور الإسلامي القائم علي التكامل بين الوحي والعقل والحواس، فمن المعلوم للكافة أن بناء النظرية العملية في العلوم الاجتماعية يقوم علي المكونات الآتية:
1- عدد من المشاهدات المحققة أو الحقائق العلمية Facts, Observationsالجزئية التي تم التوصل إليها من خلال إجراء البحوث الواقعية (الإمبيريقية)من خلال إجراء البحوث كوسيلة وحيدة للوصول إلي المعرفة العلمية.
2- عدد من التعميمات الواقعية (الإمبيرقية ) Empirical Generalizations التي هي عبارة عن “علاقات ذات طبيعة عامة بين حقائق تم التحقق من صدقها بالمشاهدات الواقعية ..؟” ( p130 : 1969 Theodorson & Theodorson)
3- تفسيرات تربط بين تلك الحقائق والتعميمات الواقعية (الإمبيريقية ) برباط منطقي، برباط منطقي، وينبغي أن يلاحظ أن “تفسير المشاهدات يستهدف ربط المشاهدات الحالية بالسابقة أو حتي بوقائع أو علاقات افتراضية ..”(Ibid p213).
ويتفق من كتبوا في مجال “بناء النظريات” العلمية علي الدور الهام الذي يلعبه خيال الباحث في التوصل إلي هذه التفسيرات بما يؤدي إلي إضفاء المعني علي الحقائق الجزئية والتعميمات المتفرقة؛ لكي نصل إلي فهم الظواهر، فروبرت دوبن مثلاً يقرر أن “كل النماذج النظرية إنما هي محاولة تخيلية من جانب المنظر؛ لإعادة بناء شريحة من العالم المشاهد، بهدف فهم ذلك القطاع المختار من العالم المحيط به.. فالخيال البناء يزيد من قدرة الإنسان علي فهم العالم المشاهد” (Dubin 1978 :p 216 221).
ولكن هل معني ذلك أن النظريات “العلمية” تستمر طويلاً في الاعتماد علي التخمين وعلي خيال الباحث إلي ما نهاية؟ إن الخط الرسمي الذي تلتزمه العلوم الاجتماعية الحديثة في الرد علي هذا السؤال هو بالنفي بطبيعة الحال، ولكنك إذا سألتهم كيف إذن يبني علم علي ظن وتخيل؟ فإن الرد الحاضر دائماً هو أن الباحثين يقومون – بعد إدخال هذه التفسيرات المبنية علي خيال الباحث – بطريقة منظمة باستنباط فروض تستمد من تلك الأطر التفسيرية التي تضمنها النظرية لكي يتم اختبارها في أرض الواقع المحسوس (الإمبيريقي)، فإذا ثبت صدق هذا الفروض – أي مطابقة مضمونها للواقع – فإنها تتحول إلي مشاهدات محققة أو حقائق علمية، وبهذا تزداد الثقة في النظرية وفي الأطر التفسيرية التي تضمنها إلي أن تتحول إلى قانون علمي (وإن كان استخدام اصطلاح القانون لا زال إشكالياً إلي اليوم في العلوم الاجتماعية)، وأما إذا لم تثبت صحة الفروض فإن الثقة في النظرية وفي أطرها التفسيرية تتناقص، ويجري تعديلها بحيث تستوعب النتائج المحققة (الحقائق /المشاهدات )ولا تناقضها.
ومنهجية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية لا تحتاج إلي هدم هذا الفهم العام لبناء النظرية العلمية الاجتماعية، ولكنها تقدم تحسينات جوهرية عليه في مواضع ثلاثة أساسية:
1- بدلاً من الاعتماد علي خيال الباحث أو علي مجرد التخمين وحدهما في الوصول إلي أطر تفسيرية تضم الحقائق (أو المشاهدات المحققة) إلي بعضها لتعطيها معني، فإن التصور الإسلامي يقدم أطراً تفسيرية مستنبطة وفق ضوابط المنهجية الأصولية من الكتاب والسنة، ولأن هذه الأطر مستنبطة من مصدر يقيني هو الوحي، فإنها تكون ولا شك أرقي من مجرد الاعتماد علي خيال الباحثين، ثم لأنها تتضمن استنباطاً واجتهادًا بشرياً ستظل خاضعة للاختيار لضمان الصدق الواقعي للاستنباط.
2- بدلاً من الاعتماد في اختبار الفروض علي ما يسمي بالواقع المحسوس (الإمبيريقي) وحده، فإن اختبار الفروض في التصور الإسلامي سيكون في الواقع الشامل Total Reality الذي يضم ما هو محسوس وما ليس محسوساً في ذاته بسبب انتمائه إلي عالم الغيب، (وهذا بطبيعة الحال يتطلب استخدام طرق غير مباشرة في مشاهدة نتائجه وآثاره).
3- يتم استنباط الجوانب المعيارية الموجهة للسلوك الفردي وللتنظيمات المجتمعية بالاعتماد علي المصادر الشرعية باستخدام المناهج والقواعد الأصولية العامة، بما يضمن أفضل اقتراب ممكن من تحقيق مقاصد الشريعة، وتعتبر هذه الجوانب المعيارية مكملة ومتممة وموجهة للأطر النظرية التي تنطلق منها العلوم الاجتماعية المؤصلة إسلامياً، سواء تم اختبارها بطريقة غير مباشرة، أو قبل أن يتم اختبارها، أو حتي دون أن يتم اختبارها إذا كانت قد روعيت في استنباطها الضوابط الصحيحة في الاستنباط، وينبغي أن نراعي هنا ما هو متعارف عليه من أن ما هو معياري بطبيعته لا يمكن اختباره في ذاته بالرجوع إلي الواقع؛ لأنه مبني علي التفضيل والاختبار.
المبحث الرابع: الإجراءات المنهجية للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية:
في ضوء ما تقدم فإننا سنقوم في هذا المبحث بمحاولة لترجمة منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية إلي مجموعة من الإجراءات أو الخطوات أو العمليات المحددة التي يمكن للباحث أن يسير في ضوئها حال سعيه لتأصيل أحد موضوعات العلوم الاجتماعية أو حتي أحد فروعها، ويلاحظ أن تناولنا للموضوع سيكون منطلقاً مما أسميناه “بالمدخل المتوازن” في النظر إلي منهج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية، كما يلاحظ أننا نقصد – كلما كان ذلك ضروريا – إلي صياغة بعض ” القواعد” التي نعتبرها من مسلمات المنهج، وأننا نبرزها في العرض لإعطاء الفرصة للقارئ لمعرفة الأرضية التي ننطلق منها، ثم لنقدها أو الإضافة إليها بما يعين علي وضوح الرؤية أمام الجميع، وسيتم تناول الموضوع من خلال العناصر التالية:
(1) اختيار الإطار المرجعي الذي ينطلق البحث في البداية من مفاهيمه.
(2) الاستنباط من المصادر الإسلامية.
(3) الاستفادة من نتائج العلوم الحديثة.
(4 ) إيجاد التكامل المنشود بين الأطر التصويرية الإسلامية وبين النتائج الممحصة المستمدة من العلوم الحديثة.
(5 ) اختبار وتطوير النظريات الموجهة إسلامياً.
وفيما يلي نتعرض لكل من هذه العناصر بشيء من التفصيل في حدود ما يسمح به المقام.
أولا: اختبار الإطار المرجعي الذي ينطلق البحث في البداية من مفاهيمه:
يواجه الباحث في المراحل الأولي للتفكير في بحثه قضية مبدئية هامة ينبغي عليه اتخاذ قرار بشأنها عندما يبدأ العمل، ألا وهي :هل يبدأ بحثه منطلقاً من مفاهيم العلوم الاجتماعية الحديثة؟ أو يبدأ منطلقاً من مفاهيم العلوم الشرعية ومصطلحاتها؟ وذلك بصرف النظرعما يكون في المراحل التالية بالضرورة من التكامل بينهما.
فعلي سبيل المثال هب أن متخصصاً في الخدمة الاجتماعية انتوي القيام بدراسة يحاول فيها استجلاء أبعاد موضوع كالرعاية الاجتماعية Social Welfare في ضوء المنهج المتوازن للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية علي الوجه الذي بيناه فيما سبق، فإنه سيسأل نفسه هل يبدأ بحثه من المفاهيم الحديثة المألوفة في محيط المتخصصين في مهنة الخدمة الاجتماعية، فيستخدم في البداية مثلاً اصطلاحات كالرعاية الاجتماعية، وظائف الرعاية الاجتماعية، برامج الرعاية الاجتماعية، تمويل الرعاية الاجتماعية ..، ثم يمضي قُدُماً في تقسيم كل موضوع من تلك الموضوعات إلي عناصره بنفس الطريقة، بحيث يستخدم كل اصطلاح بنفس المفهوم المشتق من الإطار المرجعي الغربي، اعتماداً علي أن المهم هو المحتوي الذي يوضع في كل فئة من تلك الفئات، وهو محتوي سيتضمن في نهاية المطاف المضمون الإسلامي إلي جانب ما صح من التصورات الحديثة لمهنة الخدمة الاجتماعية.. وهكذا؟
أو إنه سيري أنه إن فعل فسيكون بذلك قد وقع – دون أن يقصد – أسيراً لفئات الفكر الغربي ذاته، المنطلقة من افتراضاته الوجودية والمعرفية (الأنطولوجية والإبستمولوجية)، ويكون قد كبل نفسه بقيودها دون وعي منه ؟ وهل كان الأفضل أن يبدأ مباشرة بمفاهيم ومصطلحات إسلامية ضاربة بجذورها في التصور الإسلامي بدلاً من ذلك؟ فيستخدم مثلاً مفاهيم كالتكافل الاجتماعي أو البر بدلاً من الرعاية الاجتماعية، ومفاهيم موارد الزكاة ومصارفها والصدقات والهبات بدلاً من مفهوم التمويل، ومفاهيم حقوق الوالدين الطاعنين في السن وحق الضعيف مثلاً بدلاً من خدمات رعاية المسنين؟
وفي كل الحالات ستثور لدي الباحث تساؤلات مكملة عن مدي صحة نقطة البدء التي اختارها من الناحية المنهجية، فإذا اختار مثلاً اصطلاح “الرعاية الاجتماعية” فمن يدريه أن الإسلام يتوقف عند حد مفهوم “الرعاية”، إن نظرة الإسلام للعلاقات بين المسلمين… أفرادهم وجماعاتهم، قويهم وضعيفهم …هي نظرته إلي الأجزاء في “جسد واحد”، وقد يكون مفهوم “الرعاية الاجتماعية” الذي نبت عند غيرنا يعتبر قمة الرحمة في المجتمعات المادية، ولكنه لا يكون كافياً في مجتمع مسلم يعيش التصور الإسلامي الصحيح… وهكذا، ومن جهة أخري فإن الباحث إذا اختار مفهوم “التكافل الاجتماعي” أو “البر” مثلاً فإنه لا بد أن يسأل نفسه عن علاقة هذا المفهوم بالمفاهيم المقابلة (أو التي تبدو له كذلك) في التصور الغربي مثل مفهوم الاعتماد الوظيفي المتبادل هي Functional Interdependenceأو مفهوم التكامل الاجتماعي Social Integration أو غيرها..، وتلك كلها أسئلة لها وجاهتها، وقد يعني التعامل الواعي معها الفرق بين الانعتاق من القيود الفكرية المستقرة في العقول وبين العبودية الفكرية التي لا ينتج منهما شيء أصيل، ولكنه قد يعني أيضاً الفرق بين فكر إسلامي ناضج صحيح وبين التجني ومراهقة الفكر وعدم التروي.
وعموماً، فإننا سنقوم فيما يلي بتلخيص الجوانب المختلفة للموضوع في ضوء المثال السابق، حيث نبين باختصار المبررات التي يستند إليها كل من الخيارين المطروحين، ونوضح التحفظات علي كل منهما، ثم نوضح الطريق العلمي الواجب اتباعه في المراحل التالية – أيا كان الخيار الذي يفضله الباحث في البداية:
الخيار الأول: اتخاذ الفئات والتصنيفات المستمدة من العلوم الاجتماعية الحديثة كنقطة بداية للبحث :
- المبررات: البدء من نسق من المفاهيم والمصطلحات المألوفة والمتفق علي تعريفاتها بين الباحثين المتخصصين .
- التحفظات: الانزلاق إلي تبني الأطر المرجعية للعلوم الحديثة دون وعي بمخاطر ذلك علي عملية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية.
الخيار الثاني: اتخاذ الفئات والتصنيفات المشتقة من الألفاظ القرآنية، أو من منطوق الأحاديث النبوية، أو من تصنيفات العلماء المسلمين المتقدمين كنقطة بداية للبحث :
- المبررات:
أ- المصطلحات هنا تكون أقرب للإطار التصوري الإسلامي.
ب – المفاهيم مصدرها الأصلي يقيني (خصوصاً تلك المستمدة من النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت) بعكس المصطلحات ذات المصدر البشري البحث .
- التحفظات:
أ- التعسف في تحميل الألفاظ القرآنية أو النبوية من المعاني ما لا تحتمل أو ما لا يقصد منها.
ب- صعوبة الربط في المراحل الأولي من العمل بين المفاهيم والمصطلحات الشرعية والمصطلحات المستمدة من الإطار المرجعي الغربي المألوف لدي الباحثين.
ج- الكتابة الموسوعية ذات الطابع الدعوي عند كثير من علماء المسلمين، وصعوبة ترجمتها إلي أنساق تصنيفه محددة قابلة للاختيار الواقعي.
وعلي أي حال، فأيٌا كان الإطار المرجعي المتخذ كنقطة للبدء، فإن الباحث ينبغي عليه أن يقوم في المراحل التالية لذلك الاختيار الأولي بالمراوحة الدائمة والترداد المستمر بين كل من الإطارين المرجعيين (تصنيفات العلوم الحديثة – التصنيفات المستمدة من المصادر الشرعية) علي أن يتم ذلك بوعي شديد، وبإدراك كاف للتحفظات السابقة، ودون تعسف، مع ترك الباب مفتوحاً دائماً لمراجعة الأنساق التصنيفية والمفاهيم في ضوء كل تقدم يحرزه الباحث في الفهم والربط، وفي ضوء كل استبصار جديد يسفر البحث عنه، ويتطلب ذلك:
(1) الانتباه إلي أي شعور بعدم التساوق بين مجموعة المفاهيم المستقاة من العلوم الغربية أو العلوم الشرعية، فتلك علامة علي الحاجة إلي إعادة فحص الأطر المرجعية الأصلية التي بدأ الباحث منها وإعادة الاختبار بين المفاهيم .
(2) الانتباه إلي وجود فجوات بين المفاهيم بمعني وجود مساحات من الظواهر التي لم يفلح نسق المفاهيم المستخدم في تغطيتها، وعجز الإطار المرجعي عن تغطية كافة فئات الظاهرة بشكل مقبول.
(3) التحلي بالجرأة العلمية علي تجاوز الأنساق التصنيفية التقليدية في العلوم الاجتماعية كلما ظهر سبب جوهري وأصيل يدعو لذلك، بشرط إمكان تبرير ذلك منطقياً دون تعسف أو تجن (اعدلوا هو أقرب للتقوي) {المائدة:8}.
(4) التخلي عن إغراء “الاقتصار” علي الأطر المرجعية المستمدة من كتابات الإسلاميين لما توحي به من اتصال مباشر بعملية التوجيه “الإسلامي” للعلوم دون رجوع لما قد يكون مفيداَ من إسهامات العلوم الحديثة .
(5) التخلي عن التوجس أو النفور من استخدام المصطلح الحديث كراهية لأصله، ويمكن في المراحل الأولي وضع المقابل الإسلامي بين قوسين – والعكس بالعكس – إلي حين التوصل إلي لغة مشتركة متفق عليها بين معظم الباحثين .
ثانياً: الاستنباط من المصادر الإسلامية:
(قاعدة رقم 1): يتطلب التوجيه الإسلامي لأي موضوع جزئي من موضوعات العلوم الاجتماعية وضوحاً أولياً لدى الباحث فيما يتصل بالأطر العامة والمسلمات الأساسية التي يقوم عليها التصور الإسلامي للإنسان والمجتمع والكون والحياة بصفة عامة، باعتبار أن هذه المسلمات الوجودية (الأنطولوجية) والمعرفية (الإبستمولوجية) تحدد إلي حد كبير، بل وتكاد تحسم الاعتبارات المنهجية (الميثودولوجية) التي ينبغي أن يلتزم بها الباحث في بحثه لأي موضوع جزئي.
إن الدراسة المنظمة التي تستهدف بلورة الرؤية الإسلامية لأي موضوع متخصص من موضوعات العلوم الاجتماعية لتتطلب القيام بالإجراءات الآتية (حسب الاستطاعة) في ضوء نوع ومدي المعرفة السابقة للباحث بمصادر العلوم الشرعية ومناهجها:
(1) البحث المنظم والواعي عن الألفاظ والتعبيرات المتضمنة في الآيات القرآنية، أو في الأحاديث النبوية الصحيحة، والتي يبدو للباحث أنها ترتبط بالظاهرة موضوع البحث، أو إلي بعض جوانبها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمكن التقاط الإشارات إلي تلك الألفاظ القرآنية والحديثية الملائمة من خلال:
- مراجعة المكانز الإسلامية المتخصصة التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة، والتي تحوي حصراً لمصطلحات التخصص مع ما يمكن أن يقابلها في الاصطلاح الإسلامي.
- الرجوع إلي الجهود التأصيلية السابقة التي قام بها المشتغلون بالتخصص.
- الرجوع إلي الكتابات الإسلامية العامة، خصوصاً ما اتصل منها بما أصبح يعرف بالثقافة الإسلامية، والتي تنظر في كليات الإسلام، ومن هنا تكون أقرب لتقديم الأطر التصورية التي يستفيد منها المشتغلون بالتخصص.
- الإفادة من كتابات علماء الإسلام المتقدمين ممن اشتهروا بنظراتهم النفسية والاجتماعية، ويمكن الاستعانة في هذا الصدد بالأدلة المتخصصة التي تمد الباحثين بإشارات مختصرة إلي مثل تلك الكتابات، مع جهود لتحليلها وربطها بما يمكن أن يقابلها في المصطلح الحديث.
- القراءة المنظمة للقرآن الكريم، والنظر في الأبواب والفصول الملائمة من صحاح السنة , للبحث المستقل من جانب الباحث نفسه عن الألفاظ القرآنية والحديثية المتصلة بالموضوع , أو اكتشاف الآيات والأحاديث المتضمنة للمعني باستخدام ألفاظ أخري مع رصد تلك الألفاظ.
(2) حصر جميع المواضع التي استخدمت فيها تلك الألفاظ والتعبيرات القرآنية والنبوية التي تم التقاطها، وذلك باستخدام معجم ألفاظ القرآن الكريم ومعجم ألفاظ الحديث؛ لكي نضمن ألا تفوتنا أي إشارات لتلك الألفاظ دون قصد.
(3) الكشف عن معاني الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي وردت تلك الألفاظ في سياقها رجوعاً إلي كتب التفسير والشروح المعتمدة، ويمكن الاستعانة في هذا الصدد بالكشافات المتخصصة لآيات القرآن الكريم وللأحاديث النبوية الشريفة ’والتي تضم مختلف التفاسير والشروح للنصوص المتصلة بكل موضوع من موضوعات التخصص , والتي بدأت في الظهور في السنوات الأخيرة.
(4) الاستناد إلي مجموعة الأفكار الواردة في تلك التفاسير والشروح لاستنباط المفاهيم والقضايا التي تصف أو تفسير موضوع الدراسة أو تضع الضوابط المعيارية عليه, وذلك عن طريق الربط المنطقي والمنظم بين المعاني المستمدة من تلك التفاسير والشروح، ومن الواضح أن هذا الربط المنظم سيقوم علي أساس استخدام القواعد المنطقية للانتقال من المقدمات إلي النتائج , وهو بطبيعة الحال يتضمن اجتهاداً بشرياً من جانب الباحث , ولكن من الضروري أن نشير هنا إلي ضرورة إلمام الباحث بالقواعد الأصولية والقواعد اللغوية المتعارف عليها في فهم النصوص؛ ضماناً لعدم التجاوز عند محاولات الربط والاستنباط.
(5) في حالة شعور الباحث بإمكان استيعاب نصوص الآيات أو الأحاديث لمعان ومضامين أخري غير تلك التي وردت في شرح وكتابات المقدمين، فقد يمكن للباحث المتمكن في فنه والمتمكن في الوقت نفسه من منهجية العلوم الشرعية استنباط معان وأفكار جديدة للنصوص، ولكن هذا الأمر لا يجوز إلا بمبررات، كما أن عليه ضوابط ومحاذير:
1– المبررات:
- حدوت معارف محققة جديدة لم تكن معرفة في زمن المفسرين والشراح المقدمين حول ظواهر ووقائع تتسم بالثبات النسبي .
- ظهور حوادث وظواهر جديدة تتطلب تجلية “التصور الإسلامي” الذي يحكمها.
2– الضوابط:
- العلم بمناهج البحث المعتمدة في العلوم الشرعية – ولو في حدها الأدنى المقبول.
- التطبيق الدقيق لمناهج البحث المعتمدة في العلوم الشرعية للاستنباط من النصوص أو الجمع بينها ,وخصوصا ما اتصل منها بالقواعد الأصولية الواجب مراعاتها في الاستنباط من النصوص وفهمها {أمثلة: العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب – العمل بالمطلق علي إطلاقه إلا بدليل علي تقييده – العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره – صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب والمبادرة بالفعل إلا لدليل يخرجه عن ذلك فيصير إلي الندب أو الإباحة – لا يجوز حمل اللفظ علي مجازه إلا بدليل صحيح أي قرينة (العثيمين، 1986)} وكذا القواعد الفقهية الكلية {من أمثلتها :الأمور بمقاصدها – اليقين لا يزول بالشك – المشقة تجلب تيسير – الضرورات تبيح المحظورات – الضرورة تقدر بقدرها – الحاجة تنزل منزلة الضرورة– لا ضرر ولا ضرار – درء المفسدة أول من جلب المنافع – يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام – يختار أهون الشرين – الضرر لا يزال بمثله – التصرف علي الرعية منوط بالمصلحة – لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه –الأصل في الأشياء الإباحة (جمال الدين عطية، 1988).
- عرض النظر الجديد في النصوص، علي المتخصصين في العلوم الشرعية للتأكد من درجة دقة متابعته للأصول المرعية في تلك العلوم في الفهم الذي توصل إليه لتلك النصوص.
3– المحاذير:
- الحذر من الاستناد إلي الخواطر أو “النظرات الشخصية” البحتة في كتاب الله أو أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم؛ لأن النظرات الشخصية لا يمكن أن تلزم إلا صاحبها.
- تجاوز النزعات “الرمزية” والصوفية التي تستهوي البعض؛ لأن العبرة في العلم هي بالمعارف القابلة للتعميم، ولأن كل خروج عن هدي المصطفي صلي الله عليه وسلم في فهم كتاب الله إلي تهويمات الصوفية وأشباههم لا يمكن أن يؤدي إلي خير.
- تجاوز النزعات اللفظية والتحليلات اللغوية تتبع “الغريب” من الاستخدامات القاموسية وتتشبث بها (دون منطق راشد) في تفسير الآيات والأحاديث.
- ومن جهة أخري فإن من الضروري الابتعاد عن المسارعة في تفسير الألفاظ بتفسيرات مجازية ما دام منطوقها يوحي بمعني مباشر مقبول – وعند التحير أو التردد فإن النزاهة العلمية تتقضي التوقف إلي أن يفتح المولي بما يجلو الموقف أمام الباحثين.
- الحذر من الوقوف في العلوم الاجتماعية عند إسهامات الفقهاء ذات الطبيعة الحكمية (إصدار الأحكام علي الوقائع) أو الاكتفاء بذلك والاستعاضة به عن النظر الإيجابي التفصيلي في شؤون الحياة الاجتماعية الذي يكون موجهاً ودافعاً للفعل وللوقائع لتحقيق مقاصد الشرعية؛ لأن هذا النظر فيما يدفع واقع الحياة إيجابياً – في إطار الشرعية – يقع علي عاتق العلوم الاجتماعية بمفهومها الصحيح, وكما يقول الدكتور طه العلواني (1988) فإن “الفقه من شأنه أن ينظم حضارة قامت, لكن أن ينشئ أو يوجد حضارة فليس الأمر كذلك؛ لأن الفقه عبارة عن ضبط لوقائع ونوازل تكون قد حدثت، وبيان وجه الحق أو الصواب فيها من عدمه” (ص37).
(6)- تحديد معالم التصور الإسلامي المبدئي لموضوع الدراسة في ضوء ما سبق , وفي ضوء المسلمات الوجودية (الأنطولوجية)، والمعرفية (الأبستمولوجية)، والمنهجية (الميثودوجية) الإسلامية.
(7)- عرض التصور المبدئي الذي تمت بلورته في جمله علي المتخصصين في العلوم الشرعية من ذوي التفهم لقضايا العلوم الاجتماعية وذوي التعاطف مع قضايا التوجيه الإسلامي لتلك العلوم, وذلك “لاختبار” درجة مطابقته للفهم الشرعي الصحيح بوجه عام.
(8)- إجراء التعديلات المناسبة علي ذلك التصور في ضوء أوجه النقد التي يبديها المتخصصون في العلوم الشرعية, خصوصاً تلك التي يتفق عليها أكثر من واحد من أولئك المتخصصين, تحسباً للاحتمالات القائمة دائماً لوجود اختلافات في الرأي بين ذوي الاجتهاد.
(9)- صياغة إطار تصوري متماسك – بقدر الإمكان – يمكن استخدامه في تحقيق الأغراض الآتية:
1- ليكون معياراً يتم نقد إسهامات العلم الحديث في ضوئه.
2- ليكون إطاراً نظرياً يمكن أن يتخذ أساساً الحقائق الجزئية (كما سنري فيما بعد ).
ثالثاً: الاستفادة من نتائج العلوم الحديثة:
قاعدة رقم 2: إن أي جهود تبذل لاستنباط الرؤية الإسلامية لموضوع ما اقتصاراً علي المصادر الشرعية وحدها لا تعد بذاتها “توجيهاً إسلامياً للعلوم الاجتماعية “بالمعني الإصلاحي، وإنما تعتبر بحثاً في العلوم الشرعية أو في الدراسات الإسلامية (في المرحلة الحالية التي لا زال الانفصال فيها قائماً بين المجالين) أما التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية فإنه يتطلب إلي جانب ذلك:
أ- استثمار ما صلح من معطيات العلوم الاجتماعية التفصيلية في الموضوع وإدماجه في نسق معرفي متكامل تحت مظلة التصور الإسلامي.
ب – تعريض حصيلة هذا التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية للاختبار الميداني في أرض الواقع، والتصحيح المستمر لتلك الحصيلة في ضوء نتائج الاختبار الواقعي.
قاعدة رقم 3: يتطلب حسن الاستفادة من نتائج العلوم الاجتماعية الحديثة في إطار التوجيه الإسلامي لأي قضية جزئية من جزئيات التخصص وعياً واضحاً بالمسلمات المعرفية والمنهجية الموجهة “لذلك التخصص” بأسره، مع المراجعة المنظمة والمتأنية للمصادر الأساسية لذلك التخصص، سواء من حيث النتائج أو المناهج أو الظروف التاريخية التي أثرت في تطورها جميعاً حتي وصلت إلينا علي الوجه الذي نعرفه اليوم، وذلك قبل الانتقال إلي التناول النقدي لإسهامات العلم في الموضوع المحدد المراد توجيهه إسلامياً .
- حصر النظريات والتعميمات والقضايا والمفاهيم والمصطلحات المتصلة بالموضوع في الكتابات العلمية المتخصصة التي تمثل الوجهة السائدة في فهم الموضوع The Paradigm بكافة اتجاهاتها، مع الوعي بالمنطلقات التي تنطلق وبأصولها الفكرية قدر الاستطاعة.
- بذل الجهد خاص لاستقصاء وجهات النظر النقدية والآراء “المنشقة” والمخالفة لتلك الوجهة السائدة والثائرة عليها، حتي وإن كانت لا تزال دائرة في فلك الحضارة الغربية المعاصرة؛ لأن الوجهات النقدية والآراء المنشقة عادة ما تكشف عن المسلمات الضمنية التي تكمن وراء الوجهة السائدة بما يعنينا علي تجنب مواطن الزلل إن سلمنا بما يبدو بريئاً وغير محمل قيمياً وليس كذلك علي الحقيقة .
- إلقاء نظرة نقدية فاحصة علي كل من الوجهة السائدة والتوجهات المنشقة، وذلك في ضوء السابق التوصل إليه.
- استثمار الآراء النظرية المنشقة (التي أظهرت الخبرة أنها في حالات كثيرة تمثل رد فعل للاتجاهات المادية والاختزالية التي اصطبغ بها العلم الحديث في توجهه السائد) إلي المدي الذي تصل إليه – ودون التوقف عنده بطبيعة الحال – طالما أنها تخدم التصور الإسلامي وتسير في اتجاهه (ذلك أنها في أغلب الأحوال تتوقف عند نقطة معينة لا تقوي علي تجاوزها بسبب ارتباط تلك الآراء بالثقافة التي نبتت فيها).
- فرز المفاهيم والتعميمات والأطر النظرية وغربلتها في ضوء ما سبق، واستبقاء ما يتمشى منها مع التصور الإسلامي، واستبعاد ما بني منها علي مسلمات خاطئة.
- يراعي الحذر من التسرع باختيار إحدى النظريات التي يري الباحث أنها “الأكثر اقتراباً” من التصور الإسلامي تبينها باعتبارها نمثل نهاية المطاف للتوجيه الإسلامي؛ لأن مثل هذا الاختيار يتجاهل عادة المسلمات التي بنيت عليها مثل تلك النظرية، والتي قد تختلف بشكل جوهري عن المسلمات التي يقوم عليها التصور الإسلامي.
قاعدة رقم 4: بعض مكونات العلوم الحديثة أقرب بطبيعتها للاستفادة منها في إطار النظرة الإسلامية من بعضها الآخر، ومثال ذلك آليات العمليات النفسية والاجتماعية، وطرق التحليل المنهجي المنظم للقضايا والمشكلات، وأدوات جمع البيانات، وأدوات التدخل المهني، ولكن مما ينبغي ملاحظته أن الخطأ الذي يشوب الاستفادة من تلك الآليات أو الأدوات في المنظور الغربي التقليدي إنما يمكن عادة في الإطار العام الذي يحكم استخدامها، والذي يكون عادةً ناقصاً ومختزلاً وبحاجة إلي إعادة النظر.
رابعاً : إيجاد التكامل المنشود بين الأطر التصورية الإسلامية وبين النتائج الممحصة المستمد من العلوم الحديثة:
(1) إعادة ترتيب وإعادة تفسير المشاهدات المحققة (الحقائق والتعميمات الإمبريقية) المستمدة من الكتابات العلمية الحديثة في ضوء:
1- الأطر التصورية الإسلامية التي تم التوصل إليها.
2- الأطر النظرية المستبقاة من تراث العلم الحديث بعد ثبوت اتساقها مع التصور الإسلامي.
(2) صياغة النظرية العلمية الموجه إسلاميا في شكل أنساق استنباطية تسمح باستخلاص فروض علمية تقبل الاختبار الواقعي، وهذا جهد إنشائي أو بنائي يقوم علي الانتقال المنطقي من المقدمات إلي النتائج بطريق صحيح، ويسمح في الوقت ذاته باستنباط نتائج أخري مشتقة منها، وهكذا (انظر الأمثلة في مقال المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية : “إبراهيم رجب، 1991”).
(3) إن كون هذه النظرية العلمية الموجهة إسلامياً “علمية ” يعني:
1- أن صدق هذه النظريات ليس أمراً مسلماً به أساس قبلي Prior، وأن درجة صدقها تتوقف دائماً علي ما يسفر عنه “اختبارها” في الواقع.
2- أنه لا يتصور التوصل إلي تلك النظريات مع جهل بإسهامات العلوم الاجتماعية أو تجاهل لها.
(4) إن كون هذه النظريات “موجهة إسلامياً” يعني:
أ- هيمنة التصور الإسلامي وإعطائه “أولوية مطلقة” في تفسير المشاهدات الجزئية المحققة، وفي توجيه الفروض العلمية، وذلك في حالة عدم وجود أطر تصورية تفسيرية منافسة ذات بال.
ب- في حالة وجود أطر تفسيرية منافسة: فإن التصور الإسلامي يعطي “أولوية نسبية” علي الأطر المستمدة من الاجتهاد البشري المحض، لزيادة احتمال الصدق في التصور الإسلامي المشتمل علي ما يزيد عن الاجتهاد البشري الذي هو قدر مشترك بين النوعين من الأطر.
خامساً: اختبار وتطوير النظريات الموجهة إسلامياً:
قاعدة رقم 5: النظريات “العلمية” المتخصصة الموجهة إسلاميا وإن استمدت مسلماتها وأطرها العامة من التصور الإسلامي إلا أنها ليست في نفسها وحياً منزلاً، وإنما هي مشتملة بالضرورة علي اجتهادات وأنظار بشرية ضمن مكونتها الرئيسية، وذلك من جهتين :
- أن التصور الإسلامي الموجه لتلك النظريات وإن بني علي آيات الكتاب الكريم وعلي الأحاديث الصحيحة، فإن الاجتهاد البشري للباحثين يدخل في عملية البناء هذه من عدة طرق:
- الاختيار من بين الآيات أو الأحاديث (عن وعي، أو بدون قصد ) لما يظنه الباحث متصلاً بموضوع بحثة، واستبعاد ما لا يظنه متصلاً بموضوعه.
- الاختيار من بين التفسيرات المختلفة الواردة في كتب التفسير المعتمدة للنص الواحد.
- الجهد الذي يبذله الباحث في “الربط “بين الآيات والأحاديث التي يراها متصلة بموضوع بحثه.
وهذه الاجتهادات لا تعدو من وجهة النظر العلمية أن تكون “فروضاً” تستحق الاختبار في أرض الواقع .
- أن المشاهدات الواقعية المحققة (الحقائق العلمية في الاصطلاح التقليدي) التي تحويلها نظريات العلوم الاجتماعية إنما تم التوصل إليها من خلال دراسات وبحوث هي محاولات بشرية للاقتراب من الحقيقة إلي أقصي قدر مستطاع، ولكنها معرضة في الوقت ذاته للتأثر بقصورنا البشري الذي يتبدى أساسا في ضعف الإجراءات المنهجية وفي قصور عمليات القياس).
يترتب علي تلك القاعدة أن اعتبارات العلمية الحقة تتطلب إخضاع نتائج التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية للاختبار الميداني الواقعي؛ حتي نتمكن من التحقق من صحة استنباطاتنا البشرية التفصيلية, وحتي يمكن الاحتفاظ للعلم البشري بخاصية التصحيح – الذاتي المسلم بأنها وراء كل علم صحيح فيما يخرج عن نطاق الوحي المنزل اليقيني, وتتضمن عملية الاختبار ما يلي:
- استنباط فروض مستمدة من النظريات “العلمية” الموجهة إسلامياً، والتي تم التوصل إليها من خلال الخطوات السابقة (يلاحظ أن اختبار كل فرض جزئي إنما هو الوقت ذاته اختبار للنظرية كلها بدرجة ما).
- اختبار تلك الفروض في الواقع بمعناه الشاملTotal Reality الذي يضم ما هو محسوس قابل مباشرة للمشاهدة الحسية, كما يضم ما ليس محسوساً, وإن كان يمكن مشاهدة آثاره بطريقة غير مباشرة، ويتطلب ذلك بالطبع بذل جهود كبيرة لابتكار أدوات للبحث ذات حساسية كافية لاختبار هذا النوع الأخير من الظواهر, (ويلاحظ وجود بدايات جيدة في هذا الطريق عند أصحاب التوجه الجديد The New Paradigmمن رجال مناهج البحث من الغربيين أنفسهم)، وعلي سبيل المثال فقد قام ريزون وروان Reason & Rowan ,1981 بجمع عدد من الإسهامات الحديثة في مجال طرق وأدوات البحث المنطلقة من هذا التوجه, والتي تبدو ذات فائدة كبيرة للمشتغلين بالتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية, خصوصاً ما يطلق عليه منهجية البحث بالمشاركةParticipative Research , المنهجية الباطنةEndogenous Research، المنهجية الخبراتية Experimental Methodogies, المنهجية الحوارية Research Dialogical وغيرها من المنهجيات والأدوات التي تنظر في الجوانب الداخلية للخبرة الإنسانية الذاتية؛ توصلاً إلي تعميمات موضوعية, وذلك كبديل لمنهجيات الملاحظة من الخارج بزعم الموضوعية دون إمكان الوصول إلي الحقيقة الداخلية أبداً .
- إذا ثبتت صحة الفروض (أو إذا فشلنا في رفضها.. بلغة الاختبارات الإحصائية) فإن ثقتنا في النظرية الموجهة إسلامياً تزداد.
- إذا لم تثبت صحة الفروض فإنه يكون من الضروري القيام بالخطوات الآتية علي الترتيب:
1- مراجعة الإجراءات المنهجية المستخدمة في البحث , وخصوصاً ما اتصل منها بإجراءات القياس؛ للتأكد من عدم الوقوع في أخطاء جوهرية , وللتأكد أيضاً من عدم استخدام تقريبات غير كافية من النموذج المثالي لتصميم البحث أو اختبار العينة ….. إلخ.
2 – إذا ثبت أن الإجراءات المنهجية صحيحة تماماً (وهو أمر شديد الندرة , بل قد يراه البعض مستحيلاً في العلوم الاجتماعية) فإن علي الباحث مراجعة “استنباطاته” من المصادر الشرعية, وخصوصاً ما اتصل منها باختبار النصوص واختيار الشروح، وما اتصل بضم تلك النصوص والشروح إلي بعضها, للتعرف علي مصدر الخطأ أو التجاوز, ثم تعديل الإطار التصوري في ضوء ذلك.
- في كل الأحوال فإنه يتم إعادة إجراء البحوث Replica للتأكد من ثبات النتائج، وذلك في حالة ثبوت صحة الفروض، والاستمرار في إجراءات بحوث جديدة بهدف إعادة تقدير الموقف بعد تعديل الإجراءات المنهجية أو تعديل الأطر التصورية (وذلك في حالة رفضها).
قاعدة رقم 6: لما كان الكون من خلق إله واحد , وهو سبحانه وتعالي، أيضا منزل الوحي, فإنه لا يمكن تحت أي ظرف أن يوجد تناقض بين مشاهدات محققة واقعياً وصادقة وبين أي نص شرعي يقيني الثبوت.
خاتمة:
(1) بالرغم من أن العرض السابق لمكونات أو إجراءات عملية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية قد يوحي بوجود نوع من التسلسل الزمني أو الترتيب المنطقي لتلك الخطوات, إلا أن هذا ليس أمراً لازماً، فواقع الأمر أن تفكير الباحث في كل خطوة أو جانب من الجوانب السابقة يندر أن يتم في معزل عن التفكير في الجوانب والخطوات الأخرى، ويلزم التنبيه هنا إلي أن ثراء عملية التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية وتشابك جوانبها يتنافى بطبيعته مع مثل ذلك التفكير الخطي الذي قد يتصور معه إمكان السير في خطوات متتابعة إلية.
(2) ينبغي النظر إلي النموذج المعروض في المبحث الأخير علي أنه إنما يقدم مؤشرات إلي الطريق الذي تسير فيه عمليه التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية “بصفة عامة”، ولم يقصد منه قيام أي باحث منفرد باستيفاء جميع العناصر والمكونات والإجراءات المشار إليها في كل عملي يقوم بإنتاجه، ومن المتصور أن يقوم أي باحث بخدمة جانب أو عنصر، أو مرحلة أو اكثر – كلياً أو جزئياً – في أحد بحوثه؛ ليخدم غيره في بحث آخر، وهكذا، ولكن بالشروط الآتية:
- أن يكون الباحث واعياً بموقع العلم الذي يقوم به وبموضوعه من هذه العلمية التأصيلية المترابطة الحلقات.
- أن يكون ذلك العمل قابلاً للاندماج مع غيره في المنظومة الكلية للجهود التأصيلية، وعلي الباحث أن يشير بنفسه إلي نقاط انطلاقه وصلتها بما قبلها (عند مراجعة أدبيات الموضوع)، وإلي نقاط انتهائه وصلتها المتوقعة بما بعدها (عندما يشير إلي البحوث المستقبلية).
- أن يلتزم الباحث في عمله بالشروط والضوابط العامة لعملية التوجيه الإسلامي علي الوجه الذي فصلناه في المباحث السابقة.
(3) إن النموذج المطروح في المبحث الأخير لا زال يشير إلي الاتجاهات العامة ويتحمل الكثير من التفصيل والتحديد، والهدف من عرضه علي هذا المستوي من التجريد أمران:
- فتح الطريق أمام حوار علمي يرشد هذا التوجه العام ويصحح مساره.
- تطبيق ما يصح من هذا النموذج – بعد تمحيصه وترشيده – من خلال جهود تأصيله واقعية تملأ فراغاته، وتثري بالتفصيلات عموميات.
(4) من الواضح أن علي الباحثين المتخصصين في العلوم الاجتماعية ممن يريدون أن يسهموا بشكل فعال في جهود التوجيه الإسلامي لتلك العلوم عليهم أن يعيدوا تعليم أنفسهم؛ لاكتساب أكبر قدر مستطاع من العلوم الشرعية، خصوصاً ما كان منها منطلقاً للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية؛ حتي تكون إسهاماتهم جادة وصحيحة من جهة, وحتي يكتسبوا ثقة وتعاون المتخصصين في العلوم الشرعية من جهة أخري بما يؤدي بإذن الله إلي تضافر الجهود نحو توحيد العلم الإسلامي في ضوء التصور الإسلامي الواحد.
(5) وإذا كان البعض قد يتوهم أن الإلمام بالحد الأدنى المطلوب من تلك العلوم أمر مستحيل علي المتخصص في العلوم الاجتماعية, فلعل مما يدعوه للاطمئنان أن يرجع إلي ما ذكره الإمام الرازي في مصنفه (المحصول في علم أصول الفقه) ليري أنه يهون الأمر على من كانت له همة في الأمر, إذ إنه علي سبيل المثال يقدر الحد الأدنى المطلوب من تلك العلوم بوجود تصنيف معتمد في كل فن يمكن الرجوع إليه عند الحاجة, مع القدرة علي الاطلاع عليه عند الاحتياج إليه وليس حفظه (راجع : الإسنوي، 1981: ص ص 44-45).
(6) وفي الخاتمة فلعله من المفيد أن نُذَكٌر هنا بأن ثمرة التوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية لا يمكن تحصيلها إلا بإخلاص النية لله عز وجل في طلب هذا العلم العظيم, وبالثقة في معونته جل وعلا لمن وجه وجهه إلي الله وهو محسن, فهذا العمل ليس حرفة تحترف أو مهنة تمتهن علي الوجه الذي أعتدناه في إطار التصور الغربي للوظائف والمهن, وإنما هو أولاً وقبل كل شيء طاعة وقربة إلي الله عز وجل, وهو واجب نحو الأمة التي بدأت تتداعي الأكلة عليها تداعي الأكلة إلي قصعتها، عسي أن يكون إصلاح فكر الأمة ومنهاجيتها أساساً في إصلاح أحوالها وإقالتها من عثرتها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو نعم النصير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع العربية
* أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.
(1) آرنولد، السير توماس (1896) الدعوة إلي الإسلام، ترجمة د . حسن إبراهيم حسن وزملائه ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، 1970)
(2) أبو حطب، فؤاد (1989) نحو وجهة إسلامية لعلم النفس بحث قدم في “ندوة علم النفس ” التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة .
(3) أبو سليمان، عبد الحميد (1990) قضية المنهجية في الفكر الإسلامي، بحوث ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي، الخرطوم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي .
(4) أبو سليمان، عبد الحميد (1992) أزمة العقل المسلم (الرياض : الدار العالمية للكتاب الإسلامي ) .
(5) الإسنوي، جمال الدين، المتوفي 772هجري ( 1981) التمهيد في تخريج الفروع علي الأصول، تحقيق د . محمد حسن هيتو، ط 2 . بيروت : مؤسسة الرسالة ) .
(6) بدري، مالك ( 1987) علم النفس الحديث من منظور أسلامي، بحث قدم لمؤتمر قضايا المنهجية في العلوم السلوكية، المعهد العالم للفكر الإسلامي، الخرطوم .
(7) خضر، أحمد إبراهيم ( 1991أ) ” هل تحتاج بلادنا إلي علماء اجتماع ؟”، البيان، العدد 45، ص ص 19-27
(8) خضر، أحمد إبراهيم (1991ب) “هل تحتاج بلادنا إلي علماء اجتماع ؟، البيان، العدد 46، ص ص 37 -43 .
(9) خليل، عماد الدين (1990) مدخل إلي إسلامية المعرفة (المعهد العالمي للفكر الإسلامي ) .
(10) رجب، إبراهيم عبد الرحمن (1991) المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي للخدمة الاجتماعية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة .
(11) رجب إبراهيم عبد الرحمن (1992) “مداخل التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، المسلم المعاصر، العدد 63، ص ص 43- 79
(12) رمزي، عبد القادر هاشم ( 1984 أ) النظرية الإسلامية في فلسفة الدراسات الاجتماعية التربوية (الدوحة : دار الثقافة )
(13) رمزي، عبد القادر هاشم ( 1984 ب) الدراسات الإنسانية في ميزان الرؤية الأسلامية (الدوحة : دار الثقافة )
(14) العثيمين، محمد صالح ( 1986) الأصول من علم الأصول (بيروت :مؤسسة الرسالة )
(15) عطية، جمال الدين (1987) التنظير الفقهي (القاهرة .مطبعة المدينة )
(16) عطية جمال الدين (1988) النظرية العامة للشريعة الإسلامية (القاهرة مطبعة المدينة )
(17) العلواني، طه جابر (1988) :إسلامية المعرفة، محاضرات دورة استراسبورج (المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة ) .
(18) عيسي، محمد رفقي ( 1986) ” نحو أسلمة علم النفس “، المسلم المعاصر، العدد 46، ص ص 31- 56 .
(19) الفاروقي، إسماعيل راجي ( 1980) ” صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية، المسلم المعاصر، العدد 20، ص ص 35- 41 .
(20) الفاروقي، إسماعيل راجي ( 1982) ” أسلمة المعرفة “، المسلم المعاصر، العدد 12، ص ص 15 – 44 .
(21) المبارك، محمد (1977) ” نحو صياغة إسلامية لعلم الاجتماع “، المسلم المعاصر، العدد 12، ص ص 15- 44 .
(22) المختاري، أحمد (1985) ” نحو علم اجتماع إسلامي “، المسلم المعاصر، العدد 43، ص ص 39- 54 .
(23) مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية (1407) ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية : أوراق العمل، الرياض
(24) مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية (1993) مفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، تعريف معروض علي الندوة التي عقدت حول مفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية الرياض .
(26) نجاتي، محمد عثمان (1990) ” منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس “، المسلم المعاصر، العدد 57، ص ص 21- 45 .
(27) يالجن، مقداد ( 1993 أ) أهم معام منهج التوجيه الإسلامي للعلوم، ورقة غير منشورة .
(28) يالجن، مقداد (1993 ب) مفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ورقة مقدمة إلي ندوة مفهوم التأصيل الإسلامي، ذي الحجة 1413، عماد البحث العلمي – جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية – بالرياض .
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies