الإنسان الحداثي
بين وهم الحرية وحنين الثبات
أ. مهجة مشهور*
في أعقاب العصور الوسطى دخل العالم الغربي حقبة زمنية جديدة اشتملت على مجموعة من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية عُرفت بالحداثة. وقد قامت الحداثة على رؤية تجعل من الإنسان مركز للكون مع استبعاد المرجعية الإلهية من هذه الرؤية. وقد اعتمدت الحداثة على فلسفة عقلانية مادية نجحت في تأسيس نظمًا معرفية وأخلاقية تستند إلى نقاط ثبات مثل العقل والقوانين العلمية والنظريات الفلسفية الكبرى.
ثم ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين حركة فكرية عُرفت بما بعد الحداثة كرد فعل على المشاكل الناتجة من الحداثة، كالحروب الطاحنة والتلوث البيئي وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء وغيرها… وقد تبنت هذه الحركة المتمردة على الواقع المتأزم موقف الهروب من الحقائق الكبرى ونقاط الثبات التي ارتكزت عليها الحداثة، فأنكرت وجود أية نقطة صلبة أو أية مرجعية متجاوزة. فنشأ في الغرب عالم لا مركز له، عالم يتسم بالسيولة الكاملة ويسعى الإنسان فيه إلى معنى لحياته من خلال الاستهلاك والتوجه نحو اللذة.
وفي ظل هذه المرحلة الما بعد الحداثية سعى الإنسان إلى الحرية، الحرية من الثوابت التي تحدد الثواب والخطأ، أو الخير والشر، أو الأهداف المشتركة للإنسانية. فظهرت حرية ذات طبيعة خاصة أفرزت ظاهرتين مرهقتين أصبح يتسم بهما نمط الحياة المعاصرة، وهي ظاهرة السيولة وظاهرة النسبية.
يشير مفهوم السيولة إلى حالة من عدم الثبات، والتحول المستمر، وانعدام الاستقرار التي تطبع حياة الإنسان في المجتمعات الحديثة. فسيولة الحياة تعني أن الأفراد يعيشون في عالم سريع التغير، حيث لا شيء يبقى ثابتًا لفترة طويلة: لا العلاقات، ولا الوظائف، ولا القيم، ولا الهويات. هذه النوعية من الحياة تفرض على الإنسان أن يكون مرنًا سريع الاستجابة للتغيرات الحياتية، ولكنه يدفع في المقابل ثمنًا من القلق والوحدة وفقدان الجذور.
أما النسبية فهي البُعد الفلسفي لظاهرة السيولة، فهي تُعني أن الحقائق والقيم ليست مطلقة، فليست هناك حقيقة واحدة ولا صواب مطلق ولا قيم ثابتة يمكن تعميمهم على الجميع. فالأشياء يعتمد تقييمها على الظروف المحيطة أو وجهة النظر أو الإطار المرجعي.
وقبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انتشار هاتين الظاهرتين في الغرب بصورة كاسحة الا أنهما في البلدان الإسلامية ما زالتا تمثلان تهديدًا بدرجات متفاوتة على الحياة في هذه البلدان. فيمكن ملاحظة تسللهما إلى العديد من السلوكيات والممارسات الفردية، إلا أن الإطار العقدي والقيمي في هذه المجتمعات ما زال هو المرجع الذي يتم بواسطته التصدي إلى الممارسات الناتجة عن هاتين الظاهرتين. فلم تنجح هذه الموجة الحداثية من اقتلاع المكونات الأساسية والطابع الأصيل للمجتمعات الإسلامية كما حدث في الغرب.
ولكن من الضروري الالتفات إلى أن هناك ممارسات وسلوكيات ناتجة عن هذه الظواهر في مجتمعاتنا – وأحيانًا دون إدراك أو وعي حقيقي لنتائجها – بدأت في التزايد بصورة لافتة مما يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى تبني خطاب يحول دون التطبيع مع هذه الظواهر وما يتبعها من سلوكيات مرفوضة.
وسنحاول في هذه الدراسة الاقتراب من هاتين الظاهرتين وتأثيرهما على الفرد والمجتمع.
النسبية:
ظاهرة النسبية ظاهرة مدمرة للوجود الإنساني. وإذا كانت السيولة هي أسلوب الحياة الذي يصف سلوكيات البشر في فترة ما بعد الحداثة فإن النسبية هي الُبُعد الفلسفي لهذه الظاهرة. فالنسبية تعبر عن كيفية فهم الحقائق الكبرى في الحياة، فهي تفسر الحقائق والقيم في ضوء السياق الثقافي أو التاريخي أو الفردي، فما يُعد خطًا في مجتمع قد يكون صوابًا في مجتمع آخر، وما يُعد حقا في مرحلة زمنية معينة يمكن أن يصير باطلًا في زمن آخر، وما يبدو صحيحًا أو طبيعيًا في موقف ما قد لا يكون كذلك في موقف آخر.
لقد جاءت الديانات السماوية لتضع للإنسان ثوابت عقدية وقيمية يقيم عليها حياته، وتمثل له مرجعية مركزية يلجأ اليها. إلا أن الحداثة جاءت لتحييد المركز (الخالق سبحانه وتعالى) ووضع الإنسان في مركز الوجود وتفصل بين العقل والإيمان وبين العالم والإله. وقد قام هذا الإنسان بإحلال مجموعة من السرديات الكبرى محل الديانات السماوية، تلك السرديات التي ظهرت في صورة نظريات ومقولات فلسفية قادت البشرية في مرحلة الحداثة. ثم جاءت مرحلة مابعد الحداثة لتلغي كل من سلطة الديانات السماوية والسرديات الكبرى فأصبح الإنسان معلقًا في فراغ.
لقد أدت النسبية إلى تحطيم المرجعيات الكبرى والمؤسسات الصلبة (الدين، الأسرة، الوطن..)، ولم يعد الإيمان إطارًا بديهيًا، بل خيارًا حرًا، وهذا ما فتح الباب للقلق والتساؤل والتناقض. كما أدت النسبية إلى ضياع المعايير الأخلاقية، فالنسبية تسمح بتبرير الخطأ أو الظلم نظرًا لأنها ترفض أن تكون القيم مطلقة.
فيما قبل الحداثة، كان الإيمان بالله والانتماء إلى جماعة والالتزام بقيم كبرى يشكلون “مركزًا” معنويًا لحياة الإنسان. ذلك المركز لم يكن فقط مرجعًا أخلاقيًا، بل كان معنى للوجود ومصدرًا للطمأنينة في مواجهة المستقبل والغموض والموت. في هذه المجتمعات ما قبل الحداثية لم يكن الإيمان بالله موضوعًا للتشكيك، فالدين كان نسيجًا بنيويًا في الوجود الفردي والجماعي، ولم يكن التدين مجرد خيار فردي، بل الأساس الذي تُبنى عليه تصورات العالم (الكون، الأخلاق، السلطة). كانت الهوية والمعنى والمعرفة دينية بالضرورة. فالإيمان لا يواجه “أزمة المعنى” ولا يعاني قلقا وجوديا كما في الحداثة، بل إن البنية الاجتماعية والثقافية لم تكن تتيح طرح هذه التساؤلات أصلًا، ليس لأن الشك الديني والإلحاد لم يكونا موجودين فيما قبل الحداثة، ولكن لأنه كان يُنظر إليهما على أنهما ابتلاء روحي لا مشكلة فلسفية جذرية.
ثم جاءت النسبية والسيولة الحداثيتان فجعلتا من الإيمان خيارًا فرديًا، بينما كان قبل ذلك أساسًا وجوديًا جماعيًا بديهيًا. قام الإنسان الحداثي بإعادة تعريف ذاته بوصفه مصدرًا للمعنى بدلًا من كونه باحثًا عنه، لقد بات “يعيش كما يشاء” لا “كما ينبغي”. فالمعنى في الحداثة لم يعُد يُستمد من المطلق، بل من النجاح والإنجاز والحرية.. فلم يعُد الإنسان يرى في الإيمان أو في الثبات الديني حاجة، لأنه أقنع نفسه أن بإمكانه اختراع المعنى لا اكتشافه.
غير أن هذه الحرية الظاهرة جاءت على حساب الإحساس بالاستقرار. فمَن يؤمن بالله يؤمن بأن هناك حقائق ثابتة، مثل وجود الغيب والملائكة والرسل والأديان السماوية والشريعة الحاكمة والثواب، والعقاب الإلهي، والخير، والشر. كذلك يؤمن بوجود قيم أخلاقية مطلقة كالعدل، والصدق، والأمانة، والرحمة، والتكافل..، ويؤمن بأن للحياة غاية ومعنى، كل هذا يعطي للإنسان استقرارًا داخليًا ومرجعية واضحة.
إلا أن الالتزام بمركز (إله، عقيدة) يُعني أنك لم تعُد حرًا تمامًا، في حين أن الإنسان الما بعد الحداثي يريد أن يترك كل الأبواب مفتوحة، لا عقيدة ثابتة، لا زواج دائم، لا انتماء ملزم. فالمطلق يفرض حدودًا، والنسبية تهرب منها. إذن فالإنسان الحداثي يهرب من الثبات لأنه يراه عدوًا لحريته.
ورغم ادعاء الاستغناء عن الثبات، تشير ظواهر اجتماعية عديدة إلى حاجة دفينة إلى مرجعية ما، فهذه الظواهر تعكس عطشًا داخليًا لمركز روحي أو معنوي. لكن الإنسان المعاصر لا يريد أن يلتزم، فيختار روحانية “مرنة” لا تلزمه بشيء وكأنها محاولة للحصول على الطمأنينة دون ثمن الثبات.
إلا أن الثبات لا يعني الجمود، بل يعني امتلاك محور داخلي يدور حوله كل شيء. فالثابت الحقيقي ليس الذي لا يتغير، بل الذي يعطيك القدرة على التوازن وسط التغيير، وهو الذي يحول دون السقوط وسط تيار الحياة الهادر. فالمطلقات الإيمانية لا تمنع المرونة في التطبيق والتفكير. فالدين – في كثير من تعاليمه – يراعي السياق والاختلاف، فالإيمان بالله تعالى والأخلاق هي مطلقات، أما أساليب التفكير والعادات والعديد من المسائل الفقهية هي متغيرة لتتلائم مع الاختلاف الزماني والمكاني.
فإذا كان كل شيء يتغير تحت ضغوط الحياة، فإن الإيمان بالله هو الثابت وسط كل هذه المتغيرات، مثل جبل داخلي لا تقتلعك منه العواصف مهما كانت، فالصلاة والتفكر والذكر كلها أدوات تمنح منظورًا أوسع للزمن ومعنى متجاوز للمعاناة والغرض من الوجود.
إن الإنسان الحداثي يبحث عن المركز في المكان الخطأ، فهو يستبدل القضايا الكبرى (الدين، القيم..) بقضايا لحظية وسطحية (ترند، مشاهير، محتوى لحظي)، في الإعجابات، الظهور، المقارنة بالآخرين، فيتنقل بين موجات الترند والموضوعات اليومية بسرعة هائلة… هذا يعكس احتياجًا داخليًا للثبات والاعتراف والمعنى لكن يُلبَى عبر أدوات مؤقتة وسطحية.
في هذا العالم المتغير النسبي يبقى الوعي بالذات والسكينة الداخلية هما المكان الأكثر ثباتًا والذي يمكّن الإنسان من التحرك بثقة بدون معاناة.
السيولة[1]:
ظاهرة السيولة أضحت ظاهرة منتشرة في كافة أوجه حياة الإنسان المعاصر. وهذه الظاهرة تتجسد في الواقع المعاش في صور عديدة، فنجد السيولة الروحية، والنفسية، والاقتصادية، وسيولة العلاقات الاجتماعية، وسيولة الهوية، وفوق ذلك كله وقبله سيولة السرديات الكبرى. وسنقوم بعرض موجز لهذه الأوجه المختلفة من السيولة، وسنجد بالضرورة أن هناك العديد من ظواهرها قد بدأنا نتلمسها في حياتنا المعاصرة بدرجات متفاوتة.
السيولة الروحية Spiritual Fluidity:
تُشير السيولة الروحية إلى الانتقال من الإيمان الديني التقليدي إلى ما يعرف بالروحانية الفردانية، Individual Spirituality، حيث يقوم الفرد بتشكيل إيمان بطريقة شخصية بالكامل، دون الرجوع إلى جماعة أو تقليد أو مصادر موثوقة، فيصبح الإيمان تجربة شخصية بحتة، بلا جذور. فتختزل الروحانية في أدوات “استرخاء” و”شفاء” فقط مثل التأمل والطاقة، دون ربطها بمسئولية أخلاقية أو معنى أعمق للوجود. فتظهر أشكال روحانية فردية ومفصلة حسب الطلب، حيث يبحث الأفراد عن تجارب شخصية مع الروحانيات، ويصممون معتقداتهم بأنفسهم من مصادر متعددة، بما يُعرف بالانتقائية الروحية Spiritual Shopping[2] فنرى انفجارًا في الاهتمام باليوجا والتأمل وعلم الطاقات والروحانيات الهجينة، التي لا تُلزم بشيء، وكأن الإنسان لا يريد العودة إلى الله، ولكنه يريد إشباع الجانب الروحاني لديه دون أن يفقد استقلاله. وأصبحت الروحانية عند البعض أشبه بمنتج استهلاكي، فيحضر الشخص جلسة يوجا، أو يقرأ كتابًا عن الطاقة، أو يستمع لتأملات معينة، ثم ينتقل لشيء آخر. فلا التزام طويل المدى، ولا شعائر دينية محددة، بل تجارب قصيرة بحثًا عن “السلام الداخلي” وليس عن عقيدة راسخة والتزام أخلاقي.
وإذا كان هذا النوع من السيولة منتشر بوضوح في المجتمعات الغربية، إلا أننا نرى أن مجتمعاتنا الإسلامية ما زالت محصنة ضده حتى الآن لرسوخ العقيدة الإسلامية في وجدان الأغلبية. ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الحديث عن ممارسة اليوجا وقوة الطاقة وغيرها من المفردات قد بدأت تدخل في الخطاب الموجه لشريحة معينة في المجتمع، بل بدأ الكلام حولها يعلو نبرته، وتتزايد المجالس التي تناقش هذه الأمور وتمارسها. وبدأ جمهور هذا الخطاب يتزايد تدريجيًا، خصوصًا أن طرح هذه الممارسات لا يتم بالتصادم مع العقيدة الإيمانية، ولذا فهو يتسلل بهدوء إلى وجدان الأفراد، ولا يجد أي ممانعة.
السيولة النفسية Psychological Fluidity:
السيولة النفسية هي الوجه “الذاتي” لظاهرة السيولة، وهي تبرز في صورة حالة من عدم الاستقرار الداخلي، والتقلب السريع في المشاعر والرغبات والانفعالات، ناتجة عن حياة متغيرة باستمرار بدون جذور ثابتة أو مرجعية واضحة.
يعيش الفرد في ظل السيولة النفسية في حالة “تيه مستمر” فيعيش تحت وطأة مشاعر سريعة التقلب من الحماس المفرط إلى الإحباط العميق دون سبب واضح، وتحت وطأة مزاج متغير بصورة مفرطة. وفي ظل السيولة النفسية يتبنى الفرد آراء الآخرين بسهولة أو يرفضها بسهولة لعدم تمكن أي وجهة نظر حقيقية من نفسه، كما أنه يسعى جاهدًا لنيل القبول الاجتماعي حتى على حساب ذاته.
ويُعاد تعريف الراحة النفسية على أنها لحظات من المتعة، وليست استقرار وجداني طويل المدى. فيصبح هدف الإنسان دائمًا هو الهروب من القلق لا مواجهته. ويخشى المرء من الجلوس مع نفسه، فيلجأ إلى وسائل تشتيت، مثل المحادثات السطحية على وسائل التواصل الاجتماعي أو التنقل بين الصفحات المختلفة دون هدف، أو اللجوء إلى التسوق وشراء ما لا يحتاج اليه.
ومن مستتبعات السيولة، أن يُصاب الإنسان بقلق دائم من الفقد، فيخشى أن يفقد وظيفته، أو أن يفقد مظهره أو شبابه، أو أن يفقد اهتمام الآخرين، فيعيش نتيجة لذلك في توتر نفسي مستمر. وتؤدي هذه الحالة من التوتر النفسي والقلق المتواصل إلى ارتفاع معدل الاكتئاب والانتحار والفراغ الوجودي وانعدام المعنى، خاصةً في المجتمعات الغنية، وحتى بين مَن يحرزون نجاحًا ماديًا، كما يعاني الإنسان الحداثي من فقدان الحافز أو الدافع، لأن كل شيء يبدو مؤقتًا فيفقد الإنسان حماسه لأي شيء.
سيولة العلاقات الاجتماعية Social Fluidity:
سيولة العلاقات الاجتماعية تعني التغير والتحول المستمر في البنى والعلاقات الاجتماعية، بحيث تفقد هذه البنى ثباتها أو شكلها التقليدي، وتصبح أكثر عرضة للتفكك والتغير السريع وإعادة التشكل في صور جديدة غير تقليدية. يؤدي هذا بالعلاقات الاجتماعية في ظل السيولة أن تتسم بعدم الاستقرار والهشاشة وقصر المدى، بحيث تصبح الروابط الإنسانية أقل التزامًا، وأكثر عُرضة للتبدل والانفصام السريع.
ونتيجة لذلك يلاحظ الانتشار الواسع لنماذج الحب المؤقت، وتأخر سن الزواج، وتصاعد نسب الطلاق، وكأن الإنسان في إطار نمط العلاقات الاجتماعية السائلة يهرب من الالتزام لأنه يراه قيدًا. كذلك يلاحظ انتشار العلاقات المؤقتة أو المفتوحة أو النفعية، أو حتى الامتناع عن الزواج كخيار دائم. وأصبح الطلاق هو الحل الشائع عند ظهور أية مشكلة أو حتى مَلل في إطار العلاقة الزوجية، بحيث يتم إنهاء العلاقة بدلًا من العمل على حل الخلاف. فالالتزام بعلاقة واحدة مدى الحياة يُنظر اليه في ظل السيولة على أنه عبء. والعلاقة العاطفية التي كانت سابقًا مركزًا وجدانيًا للإنسان أصبحت بدورها خاضعة للسيولة. وظهرت مفاهيم جديدة مثل “الحب الافتراضي” و”العلاقات عن بُعد” و”الأصدقاء الرقميين”، وبذلك أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التعارف في تعزيز نمط “العلاقات السائلة” حيث يتم التعارف والانفصال بضغطة زر. وإذا كان الإنسان بطبيعته يزدهر نفسيًا داخل علاقات مستقرة، فالسيولة الاجتماعية تؤدي بالضرورة إلى هشاشة نفسية.
وقد أدت ظاهرة السيولة بما تتضمنه من بُعد عن أي التزام حقيقي – سواء أخلاقي أو اجتماعي – ومن حرية اختيار لما يراه الفرد سببًا لمتعة لحظية؛ إلى ظهور صور جديدة من الأسر مثل الأسرة المثلية، والأسرة الفردية، والأسرة التكنولوجية (التي تنجب من خلال التلقيح الصناعي أو عبر تأجير الأرحام أو التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية).
وإذا كانت الأسرة التقليدية (الأسرة الممتدة، والأسرة النووية) ما تزال هي الركيزة الأساسية للمجتمعات الإسلامية، وما تزال هي الخلية الأولى التي لم يصلها التأثير المباشر لظاهرة السيولة على كيانها الأصيل، إلا أن هناك من الظواهر ما يثير لدى الكثيرين شكوك في بدء التأثير السلبي عليها، وذلك من خلال تأثيرها على أدوار كل من الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء داخل الأسرة.
فلم يعُد يُنظر إلى السلطة الأبوية كشيء مسلم به، وأصبحت المنصات الاجتماعية تشكل وعي الأبناء أحيانًا أكثر من الأبوين، وتغذي فيهم شعور التمرد على كل ما هو موروث أو أخلاقي بما يهيئ الجو لتبني ممارسات تتعارض مع الدين أو الأخلاق. وأصبح أفراد الأسرة الواحدة يعيش كلٌ منهم في عالمه الرقمي الخاص به مما أثر بالسلب على العلاقات الأسرية، فأدى ذلك إلى تعميق العزلة داخل الأسرة وإضعاف الحوار والتماسك داخلها، كما أدى إلى تفكك أو تراجع مفهوم “القوامة” داخل الأسرة. فالقوامة معنى مقاوم لظاهرة السيولة في الأسرة، فهو كعمود الخيمة الذي يحول دون تفككها أو انهيارها.
السيولة الاقتصادية Economic Liquidity:
تعني السيولة الاقتصادية أن العلاقات الاقتصادية والعمل والدخل والوظائف باتت غير مستقرة، سريعة التغير ومؤقتة. فالاستغناء عن الموظفين صار ملمح شائع في ظل ظاهرة السيولة، وأصبح نموذج “الفريلانسر” Freelancer الذي يتنقل بين المشروعات دون ضمانات نموذجًا منتشرًا. كما أصبح انتقال الصناعات إلى البلدان ذات الأيدي العاملة الرخيصة أمر واقع بما يؤثر بالسلب على الدول الأغلى من حيث القوة العاملة. وهذا يؤدي إلى فقدان الأمن الوظيفي في العديد من الدول. ومما عمق من ظاهرة فقدان الأمن الوظيفي إحلال الآلات والذكاء الاصطناعي محل الأيدي العاملة مما أدى إلى فقدان عديد من الناس وظائفهم.
من ناحية أخرى أصبحت عملية البيع والشراء تخضع لنمط من الدعاية يسوّق لكافة الأنواع من السلع بصورة جاذبة تنهار أمامها أي قدرات مادية لدى الأفراد، ما أدى لتفشي ظاهرة الاستهلاك السريع والاستبدال المستمر، فلم يعُد الشراء من أجل الاستخدام طويل المدى هو الشائع، فالمستهلك يسعى إلى التغيير المستمر، وكثير من المنتِجين صاروا يقدمون سلعًا ذات كفاءة متدنية، لكونهم يخططون لأن يتم التخلص منها سريعًا واستبدالها بسلع أحدث.
من ناحية أخرى أصبح الاعتماد على بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية والدفع بالتقسيط جزءًا من النمط الاقتصادي السائل حيث يستهلك الإنسان أموالا لم يتحصل عليها بعد. ولهذا يعيش الإنسان في ظل السيولة الاقتصادية في حالة من القلق المالي المستمر، نتيجة تراجع القدرة على التخطيط طويل المدى بسبب عدم وضوح المستقبل المالي للفرد.
إذن فالسيولة الاقتصادية هي تعبير عن عصر تتغير فيه كثير من الثوابت؛ العمل، الاستهلاك، البيع، الشراء، الوظائف، الدخل. حيث يعيش الإنسان في حالة من اللايقين والسرعة، وحين يصبح الاقتصاد هشًا تصبح حياة الإنسان أكثر قلقًا واضطرابًا.
سيولة الهوية Identity Fluidity:
السيولة في الهوية من أكثر ما يؤثر على الإنسان المعاصر، لأنها تمس جوهر من نكون؟ وكيف نرى أنفسنا؟ والى مَن ننتمي؟ فالهوية هي مجموعة السمات والخصائص التي تميز الفرد. فهناك هوية شخصية تتعلق بالصفات الفردية كالاسم والديانة والجنس واللغة والعِرق والطبقة والخبرات والطموحات، وهناك هوية اجتماعية تتعلق بالانتماء لوطن وأمة ذات تاريخ وعادات وتقاليد مشتركة.
والهوية كانت دائمًا محل ثبات نسبي، حيث كانت تُبنى على أساس من الدين والعائلة والوطن واللغة والتاريخ، فهي تُكتسب بأكثر مما تُختار. والسيولة في الهوية تُعني أن الهوية لم تعُد ثابتة، بل هي تتشكل وتتغير بناءً على السياقات الاجتماعية والثقافية وحتى النفسية. فكثير من الأفراد أصبحوا يبحثون عن بناء “هوية ذاتية” رافضين ما يُفرض عليهم من دين أو أسرة أو وطن. فقد أدى التنقل والهجرة والتكنولوجيا والعولمة إلى جعل الناس أكثر تعرضًا لثقافات متعددة مما جعلهم يتمردون على هويتهم الموروثة، ويرون أن الثبات على هوية واحدة نوع من الجمود. فقد أصبحت الهويات مرنة متحركة وأحيانًا تجريبية يمكن التبديل بينها. فتعديل الهوية الجنسية على سبيل المثال أصبح أمرًا متاحًا ومعترفًا به في كثير من دول العالم.
ومن مظاهر سيولة الهوية ظهور ما يُعرف بالهوية الرقمية، حيث يمكن للإنسان أن يخلق لنفسه هويات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتطابق مع هويته الحقيقية، فيمكن للشخص الواحد أن يمتلك أكثر من هوية رقمية بأسماء مختلفة وصور شخصية متباينة وسلوك يتشكل تبعًا للسياق والجمهور. كذلك يمكن للشخص إسقاط هويته الرقمية بسهولة والخروج من المجتمع الرقمي، بل وابتكار هوية جديدة على نفس المنصة في نفس الوقت.
إن سيولة الهوية تُعني فقدان الإحساس بالانتماء الثابت لجماعة أو ثقافة أو حضارة واحدة، وهذا الأمر له كثير من التداعيات الخطيرة التي تجعل الفرد فريسة سهلة لكل غزو ثقافي يحمل أفكارا هدامة ومناقضة لهوية الإنسان الأصلية. ولهذا فإن سيولة الهوية تحمل معها تحديات كبيرة، وتحتاج إلى تأكيد للذات والوعي حتى لا تنتهي بالفرد إلى حالة من التشتت والضياع.
السيولة القيمية Value Liquidity:
تشير السيولة القيمية إلى حالة من عدم الثبات أو الغموض أو التغير المستمر في المنظومة القيمية التي يعتنقها الأفراد أو المجتمعات. فقيم كالصدق والأمانة والاحترام وغيرها من القيم أصبحت قابلة لإعادة التفسير حسب الظروف، ويمكن أن يتم التخلي عنها بسرعة عند تغير المصالح.
ويمثل غياب الدين كمرجع ثابت سببًا أساسيًا لسيولة القيم، وشيوع التناقضات الأخلاقية، كالقبول الاجتماعي للشخص الناجح اقتصاديًا بصرف النظر عن الطريقة التي حقق بها هذا النجاح. كذلك تظهر الفردانية التي تختزل القيم الجمعية إلى القيم المصلحة الفردية ولو على حساب الجماعة.
وإذا كان النجاح في مرحلة ما قبل الحداثة يعتمد على قيم المثابرة والعمل الجاد والشرف، فإن النجاح في مرحلة الحداثة يرفع لواء الثراء بأي وسيلة، والشهرة السريعة، أو القدرة على التأثير في إطار وسائل التواصل الاجتماعي. وأصبح التبرير الأخلاقي الشائع لمثل هذه الأفعال هو القول: إن الكل يتبع هذه الوسائل، لا مكان للضعيف في المجتمع، لن أصلح الكون بمفردي…إلخ.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجتمعات الما بعد حداثية ما زالت ترفع لواء القيم، ولكن بعد إعادة تشكيلها ضمن صور جديدة كحقوق الإنسان والرفاه وحماية البيئة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والحرية. هذه القيم تتميز بقدر عالٍ من السيولة وتستخدم ضمن سياسات الكيل بمكيالين، للتدخل في شئون الآخرين.
السيولة وسقوط السرديات الكبرى[3]:
السرديات الكبرى هي الأطر العقائدية والفكرية والفلسفية الشاملة التي تقدم تفسيرات كلية للعالم والتاريخ والإنسان، وتمنح حياة الأفراد والمجتمعات معنى ومغزى. فهناك السردية الدينية، التي قدمتها الأديان السماوية الثلاث. وهناك السردية الماركسية، وهي تصور التاريخ كصراع طبقي. وهناك السردية التنويرية، التي تتلخص في الإيمان بأن العقل والعلم سيقودان البشرية نحو التقدم والتحرر. وهناك السردية القومية، التي تدور حول فكرة الأمة الواحدة التي تتشارك التاريخ، والهوية، واللغة، والمصير.
هذه السرديات تقدم رؤى ثابتة يعتنقها الأفراد لتفسير الحقائق الكبرى في الحياة. فهي تمثل المرجع الذي يحدد ما هو الصواب، من نحن؟ وإلى أين نسير؟ وسقوط هذه السرديات – في رأي كثير من المفكرين – يعني أنه لن تعود هناك قصة شاملة واحدة يمكن الالتفاف حولها. فيصبح هناك تعدد في الرؤى والحقائق بدلًا من وجود حقيقة واحدة مطلقة. فيحتل الشك والتفكيك والنسبية محل الإيمان باليقينيات.
أزمة المعنى: Crisis of Meaning
أزمة المعنى هي النتيجة الطبيعية لظاهرتي النسبية والسيولة. وأزمة المعنى تعني أن الإنسان لم يعد يعي لماذا يعيش ولماذا يعمل، فالمعاني الثابتة فقدت قدرتها التفسيرية للحياة وللقيمة الحقيقية لكل ما يحيط بالإنسان بسبب تمرد الإنسان على هذه الثوابت.
الاستهلاك، الشاشات، العمل، البحث عن اللذة اللحظية، اللهث وراء الشهرة والنجاح، وسائل الترفيه.. كلها تُبقي الإنسان منشغلًا دائمًا، وفي هذه الدوامة لا يجد لحظة لطرح أسئلة: مَن أنا؟ لماذا؟ ما الهدف؟ وإن طرحها سرعان ما يصرفها بمزيد من الانشغال.
فالإفراط في العمل والترفيه السطحي والاستهلاك العشوائي تُلهي الإنسان عن معنى وجوده في هذه الحياة، بل إنها تخلق شعورًا بالفراغ والحاجة دائمًا إلى المزيد منه، فيعيش الإنسان تحت وطأة حاجات زائفة أو سطحية تسحب منه كل طاقة إيجابية وتجعله يعيش حياة موازية لا هدف فيها ولا وعي حقيقي.
البحث عن معنى الحياة:
نحن في زمن مفرط في كل شيء، معلومات بلا حدود، تواصل بلا دفء، حرية بلا بوصلة، رفاهية مادية تقابلها فقر روحي. في وسط هذا الواقع يأتي الإيمان بالله ليعيد ترتيب الفوضى. فالعالم الحديث يعاني من “أزمة معنى”، والإيمان بالله هو ضرورة إنسانية، فهو كبوصلة وجودية، يشير للإنسان إلى مكانته في الكون ومعنى حياته ومسؤولياته في هذه الحياة ويمنحه القدرة على الصمود أمام الابتلاءات.
في زمن يشعر فيه الإنسان بالوحدة رغم الزحام، يعطي الإيمان بالله شعورًا بالارتباط العميق بمصدر الوجود، بخالق يسمع الدعاء ويستجيب.
في زمن العلاقات الإنسانية السطحية القائمة على المصلحة تعتبر الأسرة المتماسكة والصداقة الحقيقية والأخوة في الله جزر من الطمأنينة.
وفي زمن النسبية المطلقة يصبح التمسك بقيم مثل الصدق والعدل والرحمة قيم إنسانية خالدة تتجاوز النسبية. فحين تتآكل القيم ويقدَم النجاح المادي على حساب الأخلاق، يصبح الإيمان بالله رادعًا داخليًا، وضوءًا يرشد الإنسان ليبقى نقيًا في وسط العاصفة. فنسبية القيم والمعايير تُشعر الإنسان بالضياع. هنا يمنح الإيمان بالله الإنسان مرجعية ثابتة وأرضًا صلبة يقف عليها. فحين لا يعود أحد متأكدًا من أي شيء يصبح التعلق بالخالق مصدر يقين عميق. “ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين” (الذاريات- 50).
وفي زمن الأزمات الاقتصادية والحروب والتكنولوجيا الكاسحة لكل ما هو إنساني يشعر كثير من الناس بالقلق، بل بالرعب الداخلي، هنا يصبح الإيمان بالله هو منبع الطمأنينة والسكون في القلب، لأن الإنسان يعلم أن هناك من يدبر الأمر وأننا لسنا متروكين للصدفة. “الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب”. (الرعد-28).
في زمن الكآبة وفقدان الأمل لا شيء أكثر ثورية من أن نؤمن أن لألمنا معنى، وأنه نداء للعودة، وأن وراء العتمة نور مهما تأخر.
ما بعد الحداثة وعدت الإنسان بالتحرر من القيود لكنها لم تنجح في تحريره من حاجته العميقة إلى المعنى، إلى الانتماء، إلى الله. وربما كانت السيولة التي نحياها اليوم ليست إنكارًا للمطلق، بل علامة على شوق مضمر اليه. فالإنسان الحداثي يدّعي الاستغناء عن المركز والثبات لكنه في الواقع يبحث عنه بأشكال جديدة وغير واعية، في العلاقات، في التكنولوجيا، في الذات، في الروحانية المفصلة حسب الهوى. الظواهر الاجتماعية المعاصرة تثبت أن الحاجة إلى المعنى والثبات ما زالت حية، لكنها تُعبر عنها في أنماط مؤقتة سائلة وأحيانًا هشة، مما يبرز التوتر بين الحرية والطمأنينة.
في عالم يتسم بالنسبية والسيولة يبدو الإيمان بالله كمطلق ثابت وكأنه في موقع التناقض مع روح العصر. فالنسبية تفكك اليقين، والسيولة تزعزع الثبات، بينما الإيمان يشيَّد على مطلق لا يتغير، فالإيمان بالله استجابة لقلق الإنسان السائل، ومرجعية تمنح المعنى في عالم فقد بوصلته. إن التوتر بين النسبية والإيمان ليس نهاية الإيمان. بل قد يكون بدايته الحقيقية.
إن الإنسان المسلم المعاصر ليجد نفسه في مواجهة أسلوبين للحياة في علاقته بالمطلق والنسبي:
الأسلوب الأول:
الإيمان بالله تعالى كمركز ثابت يعني وجود مرجعية ثابتة، فالله هو الحقيقة المطلقة، والإيمان به تعالى يحدد معنى الحياة، الخير والشر، والغاية من الوجود. ويقدم للإنسان بوصلة أخلاقية وروحية وسط هذا التغير المستمر. إن ثبات الإيمان والمرجعية الروحية لا يعني ثبات أساليب العيش وأشكال العمل ونوع العلاقات الاجتماعية.
فالإيمان لا يُعني الجمود أو الانغلاق، بل هو مصدر للتقييم النقدي للعالم من حولنا من خلال المساءلة الأخلاقية والروحية. على سبيل المثال يتساءل المؤمن: هل هذا النمط من الاستهلاك يعبِر عن قِيَمي؟ .. فالمؤمن يستطيع التفاعل مع الواقع السائل دون أن يذوب فيه. فيقوم بإظهار من خلال سلوكه أن هناك معنى، أن هناك مرجعية، أن الإيمان ممكن وسط التحولات.
لا يحتاج الإنسان المعاصر أن يختار إما الثابت المطلق أو الذوبان الكامل، بل يمكنه أن يتخذ من الإيمان بالله مركزًا ثابتًا ومعنى عميقًا. وبالتالي يعيش في عالم متغير بوعي، ومرونة، وشهادة أخلاقية، وروحية. هذه هي المرونة الإيجابية التي تمنح الإنسان القدرة على التكيف دون فقدان الجذور أو تقديم تنازلات في المعتقدات الأساسية. فالإيمان لا يُلغي السيولة لكن يمنحها اتجاهًا. فالثابت يعطي المعنى والحركة تمنح الحياة.
الأسلوب الثاني:
في غياب الوعي بالعلاقة بين الثابت والنسبي، يعيش الكثيرون حالة مختلطة بين أنماط الحياة الحديثة وقيم الإيمان، دون رؤية واضحة، مما يؤدي إلى التناقض الداخلي أو حتى الانفصام الوجودي.
فلا يكفي أن يؤمن الإنسان بالله ليكون محصنًا من السيولة الفكرية. فالوعي الروحي والفلسفي يعيد ترتيب العلاقة بين الثوابت والمتغيرات. وعندما يغيب هذا الوعي يصبح الشخص متدينًا شكليًا لكن قيمه الفعلية نفعية أو فردانية. أو بالمقابل يعيش معاصرًا متحررًا في أسلوب حياته لكن ممزقًا في داخله ويعيش إيمانًا مغتربًا عن الواقع.
ونرى في حياتنا اليومية مثل هذه النماذج المتكررة: شخص يصلي ويصوم لكنه في عمله يتبنى ثقافة “النجاح بأي ثمن”، ولو بالكذب والمنافسة غير الأخلاقية. أو شخص يؤمن أن الحياة اختبار من الله، ولكنه بعيش بانشغال كامل بالمظاهر والاستهلاك بلا أي عمق تأملي أو تواصل داخلي.
هذا هو الهجين الذي نتحدث عنه: تدين سطحي + حداثة مبتورة = تناقض خانق.
الخاتمة:
إن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى جذور والى علاقة مستقرة مع ما يؤمن به ليشعر بالطمأنينة. وهذا يتطلب بناء علاقة أصيلة مع الله، والعودة للمصادر الدينية والنصوص المنشئة للعقيدة. ولكن في ظل الحداثة السائلة أصبحت الحياة الروحية عند كثيرين انتقائية ومؤقتة. فالنسبية تُستخدم لتبرير التفلت ورفض كل قيد، لكن الإيمان يحقق توازنًا، فهو يعطي حرية، لكنه يحمل الإنسان مسؤولية أخلاقية وروحية أمام خالقه.
فالسيولة والنسبية يولدان عند الإنسان القلق وفقدان المعنى، وفي المقابل يمنح الإيمان طمأنينة بوجود غاية للحياة ويجعل الوجود غير عبثي. كما أنه يحرر الإنسان من اختزاله في الماديات (من استهلاك ومزيد من الاستهلاك)، فيذكر الإنسان بكرامته وقيمه الجوهرية التي لا ترتبط بماله أو مظهره.
في عصر السيولة والنسبية يصبح الإيمان بالله أكثر من مجرد عقيدة شخصية، بل هو بوصلة وجودية، ومرساة روحية، ودرع أخلاقي يحفظ الإنسان من الغرق في بحر اللامعنى والضياع، وينقذه من العيش بين وهم الحرية وحنين الثبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مدير مركز خُطوة للتوثيق والدراسات، وسكرتير تحرير مجلة المسلم المعاصر.
[1] زيجمونت باومان، الحداثة السائلة. ترجمة حجاج أبو جبر. الشبكة العربية للأبحاث والنشر. بيروت 2016.
[2] Alan Aldrige, Religion in the Contemporary World. A Sociological Introduction. Cambridge, UK, 2000
[3] هذا المفهوم جاء في كتاب “وضع ما بعد الحداثة” للمفكر الفرنسي جان فرانسوا ليوتار.
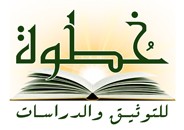 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies





