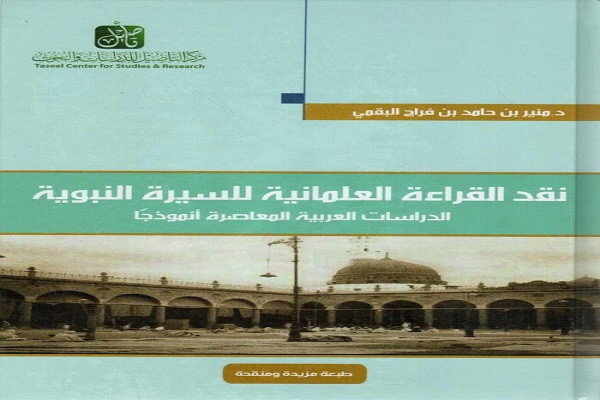العنوان: المعنى القرآني: معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة. رؤية منهجية ومقاربة تأويلية.
المؤلف: محمود توفيق محمد سعد.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: القاهرة.
دار النشر: مكتبة وهبة.
تاريخ النشر: 2021.
عدد الصفحات: 536 ص.؛ 24 سم.
الترقيم الدولي الموحد: 0-532-225-977-978.
مقدمة
خلق الله عز وجل الإنسان ولم يتركه هملا، بل سخَّر له الكون وأمده بمقومات الحياة وأنزل له منهاجًا يدله عليه ويعرفه به سبحانه ويهديه في رحلته إلى ما فيه صلاحه في الدنيا ونجاته في الآخرة. وقد امتنّ الله عز وجل على هذه الأمة بكتابه الخاتم “القرآن العظيم” الذي به خُتمت الرسالات وخُتمت الشرائع وخُتمت المناهج، فهو حبل الله المتين، وهو الحق والنور والهدى والفرقان، وفيه تبيان كل شيء، فهو سبيل النجاة الأوحد للإنسان، أنزله الله عز وجل ليهدينا به ويخرجنا به من ظلمات الضلال والتيه إلى نور الهدى والرشد، وجعل وسيلة ذلك تدبر هذا الكتاب والعمل بما فيه.
وفي هذا السياق نقف مع درة من درر مكتبتنا الإسلامية وهو كتاب “المعنى القرآني” للدكتور محمود توفيق، الذي هو بمثابة منهج لمدارسة المعاني القرآنية، حيث يقدم فيه الدكتور – رحمه الله- رؤيةً منهجيةً لتدبر القرآن بما يعين على اجتناء المعاني القرآنية في سياق السورة تأسيسًا على أنها وحدة التحدي الصغرى، لتكون زادًا إلى حسن الفهم عن الله عز وجل. وقد قسمه – رحمه الله- إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بالجانب النظري والمفاهيمي ، والقسم الثاني في التطبيق والمدارسة العملية في سياق السورة.
القسم الأول
في المصطلح وما إليه
المقصد الرباني من إعجاز القرآن البياني
يبيّن المؤلف أن جوهر إعجاز القرآن البياني لا يكمن في المفردات وحدها، ولا في التراكيب المنفصلة، بل في منهج الإبانة نفسه؛ أي الطريقة التي تُنظَّم بها الألفاظ وتتدرّج، وتُنسج بينها علاقات دقيقة بما يحقّق الإفهام الكامل للمعاني. كما يقوم هذا المنهج على إحداث الإقناع العقلي والنفسي بالحقائق المشهودة والغيبيّة وآياتها، فضلًا عمّا يتضمّنه من معاني الهداية التي يعجز البشر عن الإحاطة بها أو الإخبار بمثلها؛ لقصور علمهم، مهما بلغ تعاونهم أو تظاهرهم. إذ إن البيان، في حقيقته، تابع لمقدار العلم؛ فكلّ متكلّم لا يبيّن إلا بقدر ما أحاط به علمه، ولما كان الإنسان غير محيط بحقائق الأشياء، استحال أن يبلغ بيانه الغاية القصوى من البلاغة. وغاية هذا البيان القرآني المعجز كما يبين المؤلف – رحمه الله- ليست منحصرة في إثبات حقيقة أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل وإثبات صدق النبوة المحمدية، فهذا هو المقصد الأول بالطبع، لكنه ينطوي بداخله على مقاصد أخرى تشمل الهدى والتزكية والدعوة إلى الخير والحق. فهذا الكتاب الذي ثبت أنه كلام الله عز وجل بإعجازه يجب أن يؤخذ بقوة لأن فيه الهدى للناس كافة، العربي منهم والأعجمي، فهو كتاب الله الخاتم الذي يصلح لكل زمان ومكان وهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ما بقيت الحياة على اتساعها وتجددها.
وهنا يبين المؤلف أنه لما كان القرآنُ قد نزل للنَّاس كافَّةً، وتحدَّي الله – تعالى- به النَّاس أجمعين في كل عصرٍ ومصرٍ وجنسٍ، ولسانٍ، جعل لكل تحديًا في ما هو متميزٌ فيه، ومن ثَمَّ لم يكن إعجازُ بلاغة القرآن منحصرًا في بلاغة التَّصوير المتوقفة على عربية البيان، بل فيه ضربان من الإعجاز البيانيّ، الضربُ الأوّلُ: إعجاز بلاغة الإقناع العقلي والمحاجّة، والضرب الآخر: إعجاز بلاغة تناسب المعاني وتآخيها وتناديها وتناغيها، وهما إعجازان حاضران حضورًا قويًا لو تُرجمت معاني القرآن، فترجمة معاني القرآن لا تفقده كل إعجازه.
وبناءً على ذلك يرشد المؤلف إلى ضرورة التعامل مع البيان القرآني المعجز بخصوصية منهجية وبأدوات استبصار واستنباط تؤول إلى حسن تلقي معانيه، فأصول علم البلاغة وضوابطه ليست كافية في التعامل مع البلاغة القرآنية التي تختلف عن بلاغة الإنسان، ولذلك يقول المؤلف: “ومِنَ البيّنِ أنَّ بعضَ الأدواتِ الفعيلةِ في تلقِّي القرآن ما هو عِلميٌّ معرفيُّ، يتوصَّلُ إليه بطريقِ التَّعليم والتَّعلم والممارسة، وإنَّ بعضها ما هو إيمانيٌّ سلوكيٌّ مرتبطٌ بعلاقةِ الدَّارس والباحثِ في هذا البيان الوحيِ بصاحبِ هذا البيان جلَّ جلاله، فإنَّ من خَواصِّ هذا البيان القرآنيِّ الَّتِي لن تجدَها في أيِّ بيان آخَر، أنَّ من عواملِ إحسانِ تلقّيه إحسانَ علاقةِ المتلقِّي بصاحبِ هذا البيان سبحانه وتعالى قنوتًا وتزلفًا”.
أولًا- التدبر مفهومًا ومغزى:
يؤكد المؤلف مرة أخرى على أن القرآن ليس مجرد آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال آيات من سبقوه من الأنبياء، وإنما جعله الله عز وجل كتاب هداية لكل ما يحتاج له الثقلين، وفيه تبيان كل شيء، ولذلك يقول الله عز وجل في شأنه “كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ” (ص29)، وهنا يبين المؤلف على أن اللام في (ليدبروا)، وفي (ليتذكر) هي لام الغاية والحكمة، فيكون التدبر المفضي للتذكر هو غاية إنزال هذا الكتاب العظيم.
وفي هذا الإطار يُبيّن المؤلف معنى التدبر، فهو في لسان العرب النظر الثاقب في أدبار الأمور للوقوف على ما تنتهي إليه، كما أنه عند أهل العلم يشير إلى ديمومية أي فعل من أفعال مراتب التلقي عن الله سبحانه وتعالى، وهي سِتَّةُ أفعالٍ كليّة تبدأ بـ “التعقُّل”، و “التعقُّل” درجات، وأول درجاته: (استيعاب البيان وأصول معانيه في الفؤاد)، ثم “التفكُّر”: (تفكيك البيان وتحليله) وهذا التفكر يصحبُه تعقل ما أنتجه التفكر، ثم التبصُّر” وهو: (التغلغل في البيان ومعانيه لإدراك دقائقه ورقائقه)، وهذا التبصّر يصحبه أيضًا تعقل ما أثَمره التبصر، ثم يأتي “الاستنباط” وهو: (استخراج الدقائق واللطائف من مَعْدِنِهَا ومَكْنِزِهَا)، ثم “الاستنتاج” وهو: (استخراج ما ليس بموجودٍ ممّا هو موجود)، فالاستنتاج يكون بتلقيح المعاني ببعضها، وهذا أيضًا يصحبه عقل ثماره ثم تأتي المرتبة الأخيرة: وهي “الاستطعام”: (استطعام المنتج المستحصد من كل تلك الأفعال؛ ليسري أثره في سلوك العبد).
ويوضح المؤلف أن ثمرة التدبر في كل فعل تتمثل في تحقيق درجة من درجاتِ “التذكر” كما في قوله تعالى “وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ” أي تذكرُ جلالِ الألوهيّة، وجمال الربوبيّة متجليًّا في آياتِ الله عز وجل في العالمين. والتذكر هو حضور المتذكر في الفؤاد وسلطانه عليه سلطانًا يضبطُ به الفؤاد حركةَ المرءِ حسيها ومعنويها، فلا يكونُ من المرءِ إلا ما هو منضبطٌ بمقتضيات هذا التذكر فيكون جَميع أمره قولًا، وفعلًا، وحالا، بالله ولله.
وبناءً على ذلك فإن التدبر – كما يبين المؤلف – ليس فعلًا من أفعال التلقي وإنما هو بمثابة المنهج والكيفية لكل فعل من أفعال التلقي، وبه يترقى المتدبر في مقامات الإيمان.
ثانيًا- مصطلح “المعنى القرآني”؛ مفهومه وأنواعه وخصائصه ومستوياته:
يؤكد المؤلف أنه لا يهدف في هذا المقام النظر في معنى “المعنى اللغوي” على إطلاقه بل إلى (المعنى القرآنيِّ) والذي يعرِّفه بأنه: “هو كلُّ ما أبان الله – تعالى – في كتابه العليِّ الحكيم المنزّل على رسوله – صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه وسَلَّمَ – بلسانٍ عربيٍّ مبين، ويدركه ويستنبطه الأعيان مِنْ أهل العلم مِنَ النَّصِّ القرآني في سياقه القريبِ والمديد، وفقًا لأصول الفهم والاستنباط وضوابطهما، متجليًا فيه جلال الألوهية وجمال الربوبية، هاديًا مَن آمن به إلى الارتقاء إلى مقام العبودية الصَّفاء لله ربِّ العالمين”.
وبناءً على هذا التعريف للمعنى القرآني يبين المؤلف أنه يتضمن شروطًا وأركانًا، أما الأركان فهي أنَّ ما يستنبطه ويستخرجَه أهلُ العلم من البيان القرآني وفق منهاج الاستنباط الصحيح والتزامًا بضوابطه هو ما أودعه الله تعالى في بيانه. وكلمة “استنباط” هادية إلى أنَّ ذلك المعنى مستخرَجٌ من داخل هذا البيان، فما هو بمستسقط عليه من نفسِ الناظر، وما هو مِمّا يَرِدُ على الخاطر عند سماع البيان لعارض بحيث يزول ذلك عند زوال العارض. وأمّا شرط الصحة فيمثله قوله: “متجليًا فيه جلال الألوهية وجمال الربوبية، هاديًا من آمن به إلى الارتقاء إلى مقام العبودية الصَّفاء لله ربِّ العالمين”، حيث يتضمن هذا الشرط أمرًا يرجع إلى ذات المعنى، وأمرًا يرجع إلى وظيفته. أَمّا الَّذي يرجع إلى ذاته، فقوله: “متجليًا فيه جلال الألوهية وجمال الربوبية”، وأمَّا الذي يرجع إلى وظيفته، فقوله: “هاديًا مَن آمن به إلى الارتقاء إلى شرفِ مقام العبودية الصَّفاء لله ربِّ العالمين”. وبالتالي فكلُّ معنى لا يتسم بهذا يرى المؤلف أنه مباعد عن أن يتسم بصفة “القرآني” وإن كان لغويًا ونحويًا صحيح. فالمعنى القرآني – كما يبينه المؤلف- هدىً وذكرى ورحمة وشفاء وبشرى للمؤمنين وللمحسنين، فإذا لم يكن للناظر من هذه الأوصاف نصيب فقد رأى المعنى البياني لكنه لم يستطعم المعنى القرآني.
أنماط المعنى:
يشير المؤلف إلى أن أيَّ معنىً ينقسمُ إلى ثلاثة أنماط: مقصودٌ، ومدلول، ومفهوم. النَّمط الأوَّل: “المعنى المقصودُ” هو ذلك المعنى الَّذي يريد المتكلم أن يوصله للسَّامع، وهذا لا يحيط به إلا صاحبه، فهو يرجع إلى المتكلم. وفي حالة الوحي، لا يمكن لأحد القطع بأن فهمه هو “عين مراد الله” إلا بنص توقيفي صحيح. ومع ذلك، فإن ما يصل إليه أهل العلم من المعاني وفق المنهج القويم للفهم ووفق أدواته ومهاراته والتزامًا بضوابطه وعواصمه سيكون من مراد الله تعالى؛ لأنَّه لو لم يكن مِنْ مراده لأقام تعالى في بيانه وسياقه من القرائن ما يحاجز عن فهم ما لا يريد، فإنَّ حكمته وعدله ورحمته من عطاءاتها أن يحمي المتدبرين كتابه أن يفهموا غير مراده ما داموا أهلًا للفهم عنه. أما النمط الثاني فهو “المعنى المدلول” وهو ما تدل عليه صورة التركيب اللغوي وسياقها. وفي القرآن، يتطابق “المدلول” مع “المقصود” تمامًا لأن الله مقتدر على جعل بيانه حاملًا لمراده، بخلاف بيان البشر الذي يعتريه النقص أو الزيادة. أما النمط الثالث فهو “المعنى الإدراكي” أو “المعنى المفهوم” وهو المعنى الذي يقع في قلب المتلقي نتيجة تبصره، وهو نمط متغير يتفاوت بتفاوت العلماء وأحوال قلوبهم مع الله، وهذا النمط هو مناط اعتناء المؤلف في هذا الكتاب.
خصائص المعنى القرآني
الخصيصة الأولى: أن المعنى القرآني إلهي المصدر آدمي الغاية: إلهية المعنى تعني أنَّ هذا المعنى متضمنٌ كل معالم الصفات الحسنى لله تعالى، وأنَّ هذا المعنى لا يتناهى عطاؤه لمن هو أهلٌ لأن يتلقاه، وأن هذا المعنى صالحٌ في كل زمان ومكان، ومصلحٌ كلَّ زمان ومكان وإنسان. وآدمية الغاية يراد بها أنَّ مقاصد هذه المعاني الإلهية إنما جاءت لصالح بني آدم، ففيها ما يُبيّن لهم عن مراد ربهم جلَّ جلاله منهم فعلًا وتركًا، وفيها البيان عن أصول علاقة بني آدم بالحياة وما خلقوا لأجله، ويخلص المؤلف أن استحضار هذه الخصيصة تنقل المتدبر من طور الأنس بالنعمة “الاستمتاع بالنص” إلى طور الأنس بالمنعم سبحانه.
الخصيصة الثانية: اجتماع جلال الألوهية وجمال الربوبية في كل معنى قرآني.
الخصيصة الثالثة: التكاثر في الأفئدة: تتلخص هذه الخصيصة في أن للمعنى القرآني وجودًا مطلقًا داخل النص يتسم بكونه فضاءً رحبًا لا يمكن للبشر الإحاطة به مهما اجتمعوا، ووجودًا آخر متجددًا في قلب المتلقي يتشكل حسب مهاراته وقوة صلته بالله.
الخصيصةُ الرابعة: مواءمته لأحوال المؤمنين به على تنوُّع مقاماتهم الإيمانية: فما يكون للذين آمنوا من المعنى القرآني ليس على مرتبة واحدة وإنما لا يُطيقُ الأدنى مستطعَمَ الأعلى إلا إذا تهيأ بصنوف الطَّاعات لذلك.
الخصيصة الخامسة: امتزاج معاني التثقيف بمعاني التكليف: من خصائص المعنى القرآني أنَّك لا تجد فيه معنى يكلف الله تعالى فيه العباد بأمرٍ عقديٍّ أو شرعيٍّ إلا وقد مُزج هذا المعنى بما يحفز النفس المأمورة بذلك، أي بما يخاطب العاطفة فيها، بحيثُ إذا ما أحسنت فقه ما تخاطب به كان لها من ذلك الفقه ما يحفزها إلى أن تقوم إلى ما أُمرت به. ولذا تجد البيان القرآني من سنته البيانية أنّه غالبًا ما يُصدر معاني التكليف بقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا”، وهو نداءٌ يحفز على حسن الامتثال وحسن استطعام الطَّاعة في ما تؤمر به وما تنهى عنه لما فيه من جميل التودد، والتذكر بالعهد. فما من معنىً من معاني التكليف إلا وفيه وفي سياقه من التثقيف القلبيّ ما فيه.
الخصيصةُ السادسة: أنّه معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يتفاوت في درجة بلاغته.
الخصيصة السابعة: حسن تلقيه من حسن العلاقة بمنزلته سبحانه وتعالى: ففي القرآن مواضع عدة تهدي إلى أن التقرب إلى الله تعالى سبيلٌ إلى فهم كتابه سبحانه، وأنَّ هنالك عوائق تحاجز المرء عن أن يكون له من الفهم نصيبٌ، على نحو ما تراه في قول الله تعالى: “سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأيَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ” (الأعراف- ١٤٦)، ومن الصَّرف عن آياته الصَّرف عن حسن التلقي والفهم عنه تعالى.
مستويات المعنى القرآني:
يذكر المؤلف أن هناك مستويين للمعنى القرآني:
المستوى الأول: المعنى الجمهوري: وهو المعنى الذي يتلقاه كلُّ مَنْ ينطِقُ العربيةَ ويعقلُ عنها، ولا يحتاجُ المرءُ معه إلى مهارة الاستنباط ، وهو غير قليلٍ في القرآن الكريم، ويغلبُ أن يكونَ في المعاني الرئيسية المتعلّقة بالعقيدة، ولاسيما وحدانية الله تعالى، والبعث، وإثبات النُّبوة والرِّسالة، وكثير من أحكام الشريعة أمرًا ونهيًا لها.
المستوى الثاني: المعنى الإحساني: ويدخل فيه ما يسمى باطن البيان إذا ما كان هذا جاريًا على مقتضى الظاهر المقرَّر في لسان العرب، وله شاهد نصًا أو ظاهرًا في محلٍّ آخر يشهد لصحته من غير معارض، فهو معنىً مكنونٌ في باطن العبارة، وليس في باطن المتَقَوِّل، لا يتوصل إليه إلا بطول تدبّر وقلب زكيّ مطهّر من الشبهات والشهوات والغفلة والعصبية لغير الحق، ولابد لبلوغه أن يُحسن المتدبر الاستعداد للتلقي فقهًا وفهمًا، وذلك بالسعي الحثيث إلى امتلاك مهارات التلقي وأدواته الحسية والمعنوية. والمعاني الإحسانية هي ولائد المعاني الجمهورية، فليس ثمَّ معنىً إحسانيّ غير خارج من رحم المعنى الجمهوري. وهنا يشير المؤلف إشارة هامة وهي أن ما يسميه المعاني الإحسانية ليست من قبيل ما يسمى بـالمعنى الباطني، أو المعنى الإشاري فتلك نسبة إلى باطن البيان، أما غيره فهو باطني لأنه خرج من بطن قائله لا من بطن البيان نفسه، فهو من سبيل التقويل لا من سبيل التأويل. فالمعاني الإحسانية هي من قبيل الترقي في مستويات التدبر في المعنى القرآني الذي لا يخرج عن ضوابط فهم النص ولا يخرج عن نطاق المعنى الجمهوري الظاهر.
ثم يتكلم المؤلف أخيرًا عن حديث القرآن، فذكر أنه كان من فضل الله تعالى أن أبان لنا عن شأن القرآن وفاعليته في القلب السليم المعافى من داء الشبهات والعصبية الحمقاء والتقليد الأعمى، ومن ذلك قوله تعالى: “اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ” (الزمر- ٢٣). وقد تناول المؤلِّف هذه الآية مقسِمًا لها إلى خمسة أجزاء، حيث تناول كل جزء منها بالتفصيل تدبرًا وغوصًا في معانيها، وذلك قبل أن ينتقل الى الأمور التي قد تعيق السعي نحو التدبر.
ثالثًا- العواصم من القواصم (المنقذ من الضلال):
في هذا الجزء يتناول المؤلف العواصم التي يجب الاعتناء بها في رحلة التدبر حتى يسير فيها المتدبر على هدى، ويقسمها المؤلف إلى مجموعات أو كما يسميها “كليات”:
الكلية الأولى: عواصم تتعلق بالقول في شأن مُنزل هذا القرآن: يؤكد المؤلف هنا على ضرورة العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، وأن التدبر الحقيقي للقرآن الكريم يبدأ من معرفة المتكلم عز وجل واستحضار صفاته؛ فالعلم بالله عز وجل يعصم المتلقي من فهم الآيات بما لا يليق بجلال الله، كما أن أسماء الله الحسنى الواردة في سياقات التنزيل وخاصة في فواتح السور ليست مجرد كلمات، بل هي مفاتيح معرفية ومعايير دقيقة تفتح للمتلقي أبواب الفهم وتُعين فؤاده على استبصار المعاني الدقيقة والجليلة. وبناءً على ذلك، يصبح فقه أسماء الله وصفاته وأفعاله وفق منهج أهل السنة والجماعة، أصلًا من أصول التكوين العلمي لكل باحث في بلاغة القرآن؛ وعاصم له من الوقوع في التأويلات المنحرفة.
الكلية الثانية: عواصم تتعلق بالقول في شأن الكتاب نفسه: يؤكد المؤلف على ضرورة أن يضبط المتدبر تلقيه وفق ما وصف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم القرآن من أنه هدى ورحمة وموعظة وذكرى إلى غير ذلك من الصفات، وأن استحضار هذه الصفات في سياق الفعل التدبري هو معيار ضبط هام لمخرجات هذا التدبر. فإذا لم يستبصر المتدبر هذه المعالم في ما قام في قلبه من فهم، فقد ضلّ عن المعنى القرآني الصحيح. فليس هناك مبيّن عن القرآن أعظم من بيان الله عز وجل عنه، ثم بيان رسوله صلى الله عليه وسلم، والوعي بهذين “البيانين” فيه عونٌ بالغٌ على حسن التَّهيُّئ لتلقّي المعنى القرآني.
الكلية الثالثة: عواصم تتعلق بمقاصد هذا الكتاب: ويوضح المؤلف هنا، أن للبيان القرآني مناهجُ متعدّدة في الإبانة عن المعاني، يُراعى فيها شأنُ المعنى ذاته ومقصودُ الإفصاح عنه، وهو ما ينبغي أن يكون منطلق استقصاء طرائق البيان القرآني. ومن هنا تبرز الحاجة إلى رصد منهج الإبانة عن كلِّ معنى كليّ، وبيان مقتضياته في الإفهام بحسب طبيعة ذلك المعنى ومقامه. ومن العواصم المنهجية في هذا الباب العلمُ بكمال بيان الوحي وتكامله قرآنًا وسنةً، واتساق منهج الإفهام بينهما. ومن خصائص البيان القرآني أنه يُصرِّف المعنى الواحد في صور متعددة، لا على جهة التكرار، بل بإضافة دلالات جديدة تناسب السياق والمقام والمقصد الكلي للسورة، ولا سيما في المعاني المركزية كالتوحيد والبعث. ويستلزم ذلك من المتدبِّر وعيًا بمواضع التصريف البياني للمعنى، وجمع صوره المختلفة، والنظر إليها بحسب ترتيب النزول – متى أمكن – وبحسب ترتيب التلاوة. كما يقتضي تتبع موارد المعنى في سباقه ولحاقه، إذ يفسر القرآن بعضه بعضًا؛ فما أُجمل في موضع بُيِّن في آخر، وما اختُصر بُسط في غيره، وكذلك العناية بعلم القراءات وبتفسير السنة للقرآن.
الكلية الرابعة: عواصم تتعلق باللسان الذي أبان به هذا الكتاب عن معانيه: تقرر هذه الكلية أن من عواصم فهم البيان القرآني العلمَ بخصائص اللسان العربي الذي نزل به القرآن. إذ يؤكد القرآن في مواضع متعددة أنه بلسانٍ عربيٍ مبين. ويظهر من ذلك عظيم عناية القرآن بتصريف البيان في إطار العربية، تنويعًا في الأساليب والسياقات، بقصد إفهام معانيه وهداياته. ولا يُتاح تلقي ما في القرآن من معاني الهدى، ولا سيما معاني الإحسان، إلا لمن ملك فقه منهاج العربية في الإفهام والفهم، إذ أن إدراك هذه المعاني متوقف على الإحاطة بلسان الوحي وطرائق بيانه.
وأخيرًا يشير المؤلف إلى ضرورة استحضار ما يسميه بالسياق المقامي الذي نزل فيه الوحي، وذلك إلى جانب الوعي بسياق تنزيل المعنى على واقع الحياة المتجددة، لأن المقام ليس عنصرًا لغويًا داخليًا فحسب، بل أفق حضاري واجتماعي تشكّلت البنية البيانية في ضوئه، وبدونه يختل إدراك الدلالة.
فقاعدة “لكل مقام مقال” تمثل أصلًا حاكمًا في فهم الخطاب القرآني. ويتفرع عن ذلك نوعان من السياق: سياق النزول المتصل بالزمان والمكان والحال عند تلقي الوحي، والذي اعتنى به العلماء من خلال علم أسباب النزول، وسياق تنزيل المعنى على الواقع. ومن هنا يُبرز المؤلف أهمية الإحاطة بواقع الحياة زمن التنزيل، ومعرفة سيرة النبي عليه السلام ومنهجه في الدعوة والتقويم، وخصائص الصحابة في تلقي الوحي والامتثال له، إضافة إلى معرفة طبيعة المناوئين للدعوة وخطابهم؛ لأن ذلك كله يسهم في تعميق الفهم واستجلاء دقائق المعاني ورقائقها، إذ كلما اتسع وعي القارئ بالمقام وسياقاته، ازداد نفاذه إلى أسرار البيان القرآني ومقاصده.
رابعًا- مستويات بناء صورة المعنى في الذكر الحكيم:
وهي أربعة مستويات مترابطة:
المستوى الأول هو النظم، ويعني مراعاة معاني النحو في العلاقة بين الكلمات عند بناء الجملة، بحيث تُرتَّب الكلمات وفق المعاني والأغراض التي يُقصد التعبير عنها في الكلام.
والمستوى الثاني هو الترتيب، ويقصد به مراعاة العلاقات بين معاني الجمل نفسها، لا من جهة الإعراب، بل من جهة ترابط المعاني وتتابعها.
أما المستوى الثالث فهو التأليف، وهو النظر في العلاقات التي تقوم بين معاني المقاطع أو الوحدات الكبرى في النص (التي يسميها عبد القاهر الجرجاني بالنجوم أو العُشر، وتُسمى أيضًا الصور الكلية أو الفِقَر)، وذلك عند بناء الفصل أو المقطع وفق غرض مرحلي جزئي يخدم الكلام.
ويأتي المستوى الرابع وهو التركيب، ويعني مراعاة العلاقات بين معاني الفصول أو المقاطع كلها عند بناء النص الكامل، كالسورة أو القصيدة أو الخطبة، بحيث تخدم هذه العلاقات غرضًا محوريًا رئيسًيا ومقصدًا كليًا واحدًا، تتحقق به وحدة المعنى، وتنتظم في ضوئه الموضوعات المتعددة والمتنوعة.
خامسًا- النص والخطاب وما إليهما:
يرى المؤلف أنه قد كثر في كتابات المحدثين – سواء في باب البيان المعجز أو غيره- استعمال مصطلحات يرى جمعٌ أنّ بينها فروقًا دلالية وأنها ليست سواءً، فأراد رحمه الله أن يُبين عن حال هذه المصطلحات التي يستخدمها في كتابه، فميّز بين مصطلحي النص والخطاب كما يُستعملان في الدراسات اللغوية والبلاغية؛ مبينًا أن النصّ قولٌ مستقلّ مكتمل الدلالة في ذاته، لا يُشترط فيه اعتبار حال المخاطَب أو سياق الاستعمال، أمّا الخطاب فهو نصٌّ يُراعى فيه حال المتلقي بقصد تحقيق التواصل والتأثير. وبناءً على ذلك قد يكون القول المبين نصًا لا خطابًا، بينما لا يكون الكلام إلا خطابًا، وكلّ ما جاء من بيان الوحي قرآنًا وسنّة هو كلامٌ وخطابٌ مؤثّر، لا نصًّا مجرّدًا، ومن ثمّ كان محلّ عناية العقل البلاغي، بخلاف البيان البشري الذي تتفاوت مراتبه. وقد أشار المؤلف أيضًا إلى الفروق بين مصطلحات القول، البيان، والكلام عند البلاغيين، فبيّن أن القول لا يُشترط فيه البيان، والبيان هو قول أبان به المتكلم عمّا في نفسه دون لزوم تحقق الأثر في السامع، أمّا الكلام فهو قولٌ مبين مكتمل في ذاته من شأنه إحداث تأثير بالغ في المتلقي. ومع ذلك فإنه يؤكد على أن هذه الفروق تتلاشى في سياق الحديث عن البيان القرآني؛ إذ يُكثر الكاتب من استعمال هذا المصطلح “البيان القرآني” لوروده نصًا في القرآن، كما أنه يستعمل لفظ “النص” تنبيهًا إلى الوجود الكلي للبيان محلّ النظر، وكذلك يستعمل مصطلح الخطاب استحضارًا للقيمة التأثيرية الفعلية للبيان القرآني، وهي وجه من وجوه إعجازه البلاغي وركنٌ أساس في القيمة البلاغية لكل بيان.
القسم الثاني
معالم على الطريق- توطئة تأصيلية
افتتح المؤلِّف هذا القسم بتوطئةٍ تأصيليّة، بيّن فيها أنّ العقل الفِطريّ يحكم بأنّ اجتماع الأجزاء أو تتابعها وحده لا يكفي لإنتاج معنى أو فائدة، ما لم تحكمه علاقة منظِّمة، فلا بدّ – في كل كلامٍ ذي معنى – من أمرين أساسين:
الأول، وجود علاقات بين المكوِّنات تجعلها قادرة على إنتاج المعنى، وهو ما سمّاه المؤلِّف “النِّسَب المديد”. والثاني، وجود نظام يحكم ترتيب هذه المكوِّنات وتواليها، بحيث لا يمكن لجزءٍ أن يُوضَع في غير موضعه من غير أن يختلّ المعنى أو يخرج الكلام عن مقصوده.
ثم أشار المؤلِّف إلى أنّ هذا الأصل قد قرّره علماؤنا الأوائل ابتداءً في شأن الكلمة داخل الجملة، ليكون أساسًا يُبنى عليه النظر في البُنى الأكبر والأعقد.
أولًا- موقع السورة من نسق التلاوة المديد والحزب الذي تكون فيه:
استهل المؤلف هذا الجزء بالحديث عن منة الله عز وجل بإنزال القرآن والتكفل بحفظه، ثم فصَّل في شكل تنزل القرآن، وقسم ذلك إلى ثلاث تنزلات:
التنزيل الأول: من الله إلى اللوح المحفوظ.
التنزيل الثاني: من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر.
التنزيل الثالث: من بيت العزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وعشرين عامًا، وقد بدأ التنزيل ليلة القدر.
وهنا يشير المؤلف إلى أهمية الالتفات إلى مسألة تنزل القرآن منجمًا على حسب الأحداث والوقائع، ففي هذا ضرب من ضروب التربية للأمة ومعالجة لأحوالها، ومن هنا كان على المتلقي أن يتبصر منهج القرآن في معالجة الأحداث بالآيات، ليتخذ من هذا خبرةً في معالجة الأحداث بتنزيل الآيات عليها لتُصلح شأن العباد وأحوالهم فيها.
وفي هذا الإطار يؤكد المؤلف على أهمية الاعتناء بوحدة البناء القرآني وإعجاز ترتيبه وأثر ذلك في حسن فهمه وتلقيه، فيبين رحمه الله أن القرآن الكريم نزل في أصله نزولًا جمعيًّا، ثم نزل بعد ذلك مفرّقًا، فكانت تنزل آيات من سور مختلفة في أزمنة متتابعة، مع تعيين موضع كل آية في سورتها بوحيٍ من الله تعالى، حتى استقرّ القرآن في بنائه النهائي؛ آياتٍ في مواضعها، وسورًا في ترتيبها المحكم، على النحو الثابت في اللوح المحفوظ. فلكل سورة وحدة معنوية متكاملة، ولها موقعها في التدرّج العام لمعاني القرآن؛ حيث ينمو المعنى القرآني نموًّا متكاملًا، فتأتي كل سورة مؤكِدة لما سبقها، ومؤسِسة لما بعدها، حتى يبلغ المعنى ذروته في سور الإخلاص والمعوّذتين.
ومن ثمّ فإن دراسة مواقع الآيات وبنية السور، وترتيب السور في نسق القرآن العام، تُعدّ من فروض الكفاية على أهل العلم؛ إذ بها يتجلّى إعجاز القرآن البلاغي، من بناء الجملة في سياقها إلى انتظام السور في السياق الترتيلي الكلي.
أثر تحزيب القرآن في الوعي بموقع السورة من حركة المعنى القرآني المديد
ينتقل المؤلف إلى بيان أن البناء القرآني يقوم على نظام تسلسل توقيفي محكم له فاتحة هي “أمّ القرآن” وخاتمة هي سورة الإخلاص والمعوذتان، وبينهما سور مفصّلة تمثل تفصيل ما أُجمل في الفاتحة، وقد جعلها الله أحزابًا أربعة رحمةً بعباده، كما دلّ عليه الحديث النبوي الشريف “أعطيت مكان التوراة السبع، وأُعطيت مكان الزبور المئين، وأُعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفُضّلت بالمفصّل”، مما يهدي إلى أن لكل حزب من الأحزاب الأربعة المذكورة في الحديث خصوصية في الرسالة والمعنى ومنهج الإبانة. وهنا يشير المؤلف إلى أن تحزيب القرآن بهذا الاعتبار يعين على إدراك موقع السورة في سياقها الترتيلي، إذ إن لكل سورة موقعين متلازمين: موقعها من “أمّ الكتاب” أي موقعها من الفاتحة من حيث اتصال معانيها بأصول الهداية المجملة فيها، وموقعها من سور حزبها من حيث دورها في التهيئة أو التأسيس أو التقرير داخل الرسالة العامة للحزب. وبحسب هذا الموقع تتحدد خصائص السورة الموضوعية والبيانية. وكل سورة تؤدي وظيفة في حركة المعنى القرآني، فيَرِد المعنى على القلوب في صور متعددة تُمكّنه وتقرّره، على تفاوت في إدراك المتلقين. ومن ثمّ فإن لكل سورة خصوصية بنائية وبيانية لا تتكرر، ويجب أن يُستولد منهج مدارستها من ذاتها لا أن يُفرض عليها من غيرها، لأن الوعي بموقع السورة في حزبها وفي القرآن كله من أعظم ما يعين على حسن تلقي معاني الهدى وفهم الخطاب القرآني فهمًا فقهيًا واعيًا.
ثانيًا- الطريق إلى استنباط المقصود الأعظم للسورة وفقه أثره في البناء النصي للسورة:
يؤكد المؤلف أن تقسيم القرآن الكريم إلى مائةٍ وأربع عشرة سورة تقسيمٌ توقيفيّ، وأن السورة الواحدة – كما أشار إلى ذلك الزمخشري- بينها من تلاحق المعاني وتجاوب النظم ما يجعل آيات السورة ليست مبعثرة، بل بينها تآخٍ وتناغم يربطها في بناء واحد معجز.
وتسمية هذه الأقسام بـ “السور” – وهي تسمية توقيفية – تدل دلالةً بيانية على أن كل سورة كيانٌ مستقلٌّ جامع، تحيط آياته روابط داخلية محكمة، كما يحيط سور المدينة بما فيها إحاطةً جامعة، فالسورة تملك سلطانًا معنويًا واحدًا يهيمن على عناصرها ويوجّهها.
وتُبنى السورة على مفتتح ومختتم، يكون ما بينهما تفصيلًا لما أُجمل في المفتتح، وتخليصًا له في المختتم، مما يدل على أن آياتها منسوجة على وشيجة واحدة، تحقق بينها مؤانسةً وتآزرًا في أداء الغرض.
ويرتكز هذا البناء على ما يسميه المؤلف “المقصود الأعظم للسورة” أو “المعنى الأم”، وهو المعنى المحوري الذي تقوم عليه جميع موضوعات السورة، حضورًا لا غيابًا، وإن تفاوت ظهوره وبيانه، وهو بمنزلة الروح في الجسد، يسري في جميع أجزاء السورة، وتندرج تحته أغراضها المرحلية كلها.
واستبصار هذا المعنى الأمّ من أدقّ مسالك الفهم البياني، إذ يحتاج إلى طول مراجعة وتدقيق واعتبار معيار الحضور الشامل للمعنى لا مجرد بروزه الظاهر. فلا يكون المعنى الأم صحيحًا ما دام في السورة ما لا ينتسب إليه ولو خفيًا. ولأهمية هذا المقصد، وصعوبته وكثرة الاختلاف فيه، يسعى المؤلف إلى جمع روافد تساعد على استبصاره.
الرافد الأول: اسم السورة
يقرر المؤلف أن اسم السورة مدخل مهم لاستبصار مقصودها الأعظم، إذ هو كاشف عن روحها المهيمنة ومعناها المركزي. وقد ثبت أن بعض السور سُمّيت بأكثر من اسم، منها ما هو توقيفي ورد عن النبي عليه السلام، وهو المقدَّم في الدلالة والاعتبار، ومنها ما جاء عن الصحابة والتابعين وأهل العلم، ويُنظر فيه بحسب منزلة القائل في العلم بالقرآن، إذ أن التسمية ثمرة استبصار بالمقصد الكلي للسورة.
ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد المقاصد؛ فالأصل أن لكل سورة مقصودًا أعظم واحدًا، وتعدد الأسماء يدل على شرف السورة وسعة معانيها الكلية، وقد تكون الأسماء متكافئة أو متقاربة الدلالة، كما في أسماء سورة الفاتحة، إذ تتضافر كلها في الإشارة إلى موقعها الوظيفي ومعناها المركزي.
والتسمية الصحيحة لا تقوم على كثرة الذكر أو خصوصية الموضوع، بل على ما يوسم السورة بمقصدها العام، وتتجلى هذه القاعدة في أمثلة عديدة؛ فسورة “البقرة” سُمّيت بما يرمز إلى مقصدها المحوري في الإيمان بالغيب، وسورة “محمد” عُقدت للمواجهة بين الحق والباطل، وسورة “النمل” اختير اسمها لكونه أبلغ في الدلالة على الحكمة والعلم، وهو مقصدها الأعظم، كما أن سورة “يونس” سُمّيت بما يجسد معنى التدارك بالإيمان قبل نزول العذاب، لا بمجرد كثرة ذكر القصة، أما سورة “فصلت” فجاء اسمها هاديًا إلى وظيفتها الأسلوبية في تفصيل ما أُجمل في سورة “غافر”.
وخلاصة الأمر أن اسم السورة إنما يُعتدّ به من حيث دلالته على وسم السورة ومقصدها الأعظم، لا من حيث قلة الذكر أو كثرته.
الرافد الثاني: مطلع السورة ومقطعها تلاوة
يقرر المؤلف أن فاتحة السورة وخاتمتها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمقصود الأعظم للسورة. ومن هنا فإنَّ بناء السورة يقوم على أمرين كليين: علاقة فاتحتها وخاتمتها بالمعنى المركزي الذي تدور عليه السورة كلها، ثم علاقة الخاتمة بالفاتحة موضوعًا ووظيفةً.
ويؤكد العلماء، ومنهم البقاعي، أن لكل سورة مقصدًا واحدًا تُدار عليه آياتها من أولها إلى آخرها، وأن هذا المقصد يسري في السورة جميعًا، ولا يُدرَك إلا بالاجتهاد والتدبر. ويبيّن المؤلف أن من سنن البيان العربي التي جرى عليها القرآن، أن ينعطف آخر الكلام على أوله، فتكون الخاتمة متآخية مع الفاتحة، مطابقة لمقصود السورة، ومتمّمة لمعناها.
ويذكر المؤلف ما بينه البقاعي من تشبيه بناء القرآن ببناء الدوائر المتداخلة: فالقرآن كله دائرة كبرى لها مقصود أعظم، وكل سورة دائرة كبرى داخلها لها مقصود أعظم خاص بها، وتندرج تحتها موضوعات جزئية، ثم نجوم ومعاقد، يخضع بعضها لبعض في نظام محكم، ينتهي كله إلى المقصود الأعظم للقرآن.
ويخلص المؤلف إلى أن مطلع السورة وخاتمتها يمثلان مفتاحين أساسيين لفهم مقصودها، وأن لكل سورة خصوصيتها، فلا توجد طريقة واحدة صالحة لجميع السور، ثم يطبق ذلك على سورة البقرة، فيبيّن أن الغرض المركزي الذي تقوم عليه السورة هو الإيمان بالغيب، كما دلّ عليه مطلعها في وصف المتقين، وأن جميع آياتها وتشريعاتها وقصصها مبنية على هذا الأساس، إما تقريرًا له أو بيانًا لآثار غيابه، فالتشريعات لا تُؤدَّى حق الأداء إلا إذا استقر الإيمان بالغيب في القلب، وكذلك القصص القرآني في السورة يُظهر آثار حضوره أو فقدانه.
وتقوم مقدمة السورة على ثلاثة مرتكزات: الكتاب، والمتقين، والإيمان بالغيب، وهي مترابطة ترابط الأصل بالفرع، وقد جاء التعبير عنها في قوله تعالى: “ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ” تعبيرًا موجزًا عن معنى عميق مديد، حيث يبرز في السورة تكرار لافت لمادتي الإيمان بالغيب والتقوى، بما يدل على مركزيتهما في مقصودها الأعظم، إذ أن التقوى قائمة في أصلها على يقين بالغيب.
وتتآخى خاتمة السورة مع مطلعها، فتعود لتؤكد الإيمان بالغيب، والبعث، والمحاسبة، وتظهر صفات المؤمنين الذين عملوا عن علم ويقين، فيتحقق بذلك التناسق البياني بين الفاتحة والخاتمة، ويكتمل بناء السورة على مقصدها الأعظم، الذي هو مفتاح فهمها وسر انتظام آياتها.
الرافد الثالث: تدبر الفروق البيانية بين المعاني الكلية المصرفة في السور
يبين المؤلف في سياق هذا الرافد أن كثيرًا من السور القرآنية الكبرى تقوم على معانٍ كلية تتفرع عنها معانٍ جزئية، وأن منهج الجمع بين الإجمال ثم التفصيل هو الطريق الأمثل لإحكام الفهم وتيسير المعرفة. وينشأ عن هذا المنهج نوعان من المهارة:
إحداهما إدراك الجامع الكلي الذي تنتظم حوله المعاني المتفرقة، وهو ما تشتد حاجة الأمة إليه، والأخرى القدرة على تحليل هذه المعاني وتثوير ما فيها من دلالات كامنة.
كما يوضح أن تشابه المعاني الكلية بين السور لا يعني تماثلها في التفصيل، بل يظل بينها تنوع بياني ناتج عن تصريف المعاني، وهو وجه من وجوه الإعجاز القرآني، ويتجلى بوضوح في القصص القرآني، كما في اختلاف عرض قصة موسى عليه السلام بين السور. وبناء على ذلك يخلص المؤلف إلى أن تدبر تصريف المعاني الكلية سبيل كشف المقصد الأعظم لكل سورة، وذلك عبر التحليل البياني، وملاحظة أوجه الاتفاق والاختلاف، والتمييز بين الأصول والفروع في بناء المعنى.
الرافد الرابع: تدبر المعاني الكلية الخاصة
يذكر المؤلف أن المعاني الكليّة التي يقوم عليها بناء السور القرآنية ليست على مرتبة واحدة؛ فبعضها يُصرَّف في أكثر من سورة، بينما تختصّ بعض المعاني الكليّة بسورة بعينها. وتأمُّل هذا الاختصاص يعين على فهم الغرض المرحلي لتلك المعاني، ومن ثمّ استكشاف المعنى المحوري المهيمن على السورة، إذ تتجلى روح السورة وملامح مقصدها في هذه المعاني الكليّة الخاصة بها.
ثم يطبق هذا المعنى على عدد من السور ومنها سورة البقرة، حيث يبين أنها انفردت بوفرة من المعاني الكليّة التي لم ترِد في غيرها، مثل تمثيل المنافقين في مطلع السورة، وجملة من القصص القرآنيّة كقصة البقرة، وهاروت وماروت، وتحويل القبلة، وطالوت وجالوت، وغيرها، إضافة إلى تشريع الصيام وأحكام المعاملات كالدَّين، حيث يخلص من ذلك إلى أن اختصاص سورة البقرة بهذه المعاني يدل على شدة اتصالها بمقصدها الأعظم، إذ تقوم هذه الكليّات فيها على معنى الإيمان بالغيب قيامًا راسخًا، وهو ما يميّز السورة ويحدّد وجهتها المعنوية.
الرافد الخامس: تدبر الفروق البيانية بين المعاني الجزئية المصرفة في السور
يبين المؤلف من خلال هذا الرافد أهمية تدبّر الفروق البيانية بين المعاني الجزئية المتشابهة في السور القرآنية، وذلك بهدف اتخاذ هذا التشابه وسيلةً لكشف المقصود الأعظم لكل سورة، حيث يوضِح أن التشابه في النظم والمعنى ليس تطابقًا، وإنما هو تشابه تقتضيه وحدة المقصود مع بقاء التمايز، إذ إن أدنى اختلاف في صورة المعنى يدل بالضرورة على اختلاف في المعنى الذي اقتضاه السياق الكلي للسورة.
ويضرب المؤلف مثالًا بآيتي آل عمران والحديد، في الأمر بالسعي إلى المغفرة والجنة، حيث يظهر التشابه في أصل المعنى، ويبرز الاختلاف في الألفاظ والنظم:
ففي آل عمران يقول الله عز وجل “وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ” (آل عمران: 133). فقد جاء الأمر بـ “المسارعة”، ووُصفت الجنة بأن عرضها “السماوات والأرض” دون تشبيه، وأُعدّت “للمتقين”. أما في سورة الحديد يقول الله عز وجل “سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ” (الحديد: 21).فجاء الأمر بـ “المسابقة”، ووُصفت الجنة بأن عرضها “كعرض السماء والأرض” بأداة تشبيه، وأُعدّت “للذين آمنوا”.
هذه الفروق – يبين المؤلف- لم تأت اعتباطًا، بل اقتضاها السياق الكلي لكل سورة؛ فسورة آل عمران تقوم على تعظيم التوحيد واصطفاء المتقين، والحضّ على الجهاد والزهد في الدنيا، فجاء التعبير أبلغ وأعلى، مناسبًا لمقام التقوى. أما سورة الحديد فخطابها موجّه إلى قوم دون مرتبة المتقين، تُذكّرهم بالإيمان والإنفاق، وتحثهم على التقدّم التدريجي، فجاء التعبير أخفّ وأقرب إلى حالهم، وكان الأمر بالمسابقة لا المسارعة.
وبذلك يتبيّن أن الفروق البيانية في هذه الآيات إنما هي انعكاس مباشر لهيمنة المقصود الأعظم على نظم المعاني الجزئية، وأن تدبّر هذه الفروق سبيلٌ مهم إلى فهم روح السورة ومقاصدها الكبرى.
الرافد السادس: تكرار نمط تركيبي في سياق السورة
يشير المؤلف أن تكرار بعض الأنماط التركيبية داخل السورة الواحدة يكشف عن عناية السورة بمعنى محوري يرتبط بسياقها العام ومقصدها الأعظم، ويأتي هذا التكرار على نوعين:
التكرار النظمي: وهو إعادة التركيب نفسه لفظًا ومعنى داخل السورة لتأكيد المعنى المركزي، مثل تكرار قوله تعالى “فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ” في سورة الرحمن، وقوله تعالى “وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ” في سورة المرسلات.
والتصريف النظمي: وهو إعادة النمط التركيبي مع تغير بعض الألفاظ أو مواقعها داخل السورة الواحدة مع بقاء المعنى العام متحدًا، مثل قوله تعالى في سورة الأنفال الآية (52) “كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ” وقوله تعالى في نفس السورة الآية (54) “كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ”. وعلى هذا الأساس يخلص المؤلف إلى أن وجود التكرار أو التصريف النظمي في السورة دليل على شدة ارتباط هذه التراكيب بالسياق الكلي للسورة ومقصدها الأعظم.
الرافد السابع: المعجم الكلمي
يوضح المؤلف من خلال هذا الرافد أن كل سورة قرآنية تقوم على صنفين من الكلمات بحسب العلاقة بينها: الصنف الأول هو الكلمات التي تنتظم في أسر لغوية أو دلالية، فالأسر اللغوية تجمعها وحدة الجذر الاشتقاقي أو تقاربه، أما الأسر الدلالية فتقوم على التقارب أو التقابل في المعنى دون اشتراك اشتقاقي، مثل ألفاظ الإيمان والتقوى والطاعة، ويُعدّ تتبع علاقاتها داخل السورة وسياقاتها الجزئية طريقًا مهمًا لفهم موضوع السورة ومقاصدها المرحلية.
ويذكر المؤلف مثالًا على ذلك من سورة البقرة، حيث تتكرر فيها مفردات بعينها، مثل الإيمان، والتقوى، والهدى، والخير، والإحسان، والصلاة، والزكاة، والإنفاق، والصيام، والحج، والجهاد، تكرارًا يكشف عن انسجام معجم السورة مع مقصدها الأعظم ومطلعها، وأن هذه المفردات منبثقة من سياقها الكلي ودالة عليه.
أما الصنف الثاني فهو الفرائد، وهي الكلمات أو الصيغ التي تختص بها سورة بعينها دون غيرها، كاختصاص بعض السور بألفاظ لا ترِد في القرآن إلا فيها، أو اختصاصها بوجه من وجوه الاشتقاق أو الصيغة. ويدل هذا الاختصاص على شدة اتصال معنى تلك الكلمة بمقصد السورة التي وردت فيها. ومن الأمثلة على ذلك، اختصاص سورة النساء باسم الله “المقيت”، وسورة الطور باسم الله “البر”، بما يخدم المقصود الأعظم للسورة.
القسم الثالث
تقسيم السورة إلى معاقد كلية
تناول المؤلف في هذا القسم مسألة تقسيم السورة إلى معاقد كلية، فبيّن أن قارئ القرآن، ولا سيما عند تأمله سور السبع الطوال والمئين والمثاني، يلحظ أن غالب السور تشتمل على أكثر من موضوع، باستثناء عدد قليل من السور التي تدور حول موضوع واحد، كسورة يوسف وسورة القصص وسورة نوح. لكن تعدد موضوعات السورة الواحدة لا يلغي أنها تفضي إلى مقصد واحد مركزي كما قرر سابقًا. من هنا تناول المؤلف الحديث عن معاقد السورة وذلك من حيث ترتيبها وعمودها، فذكر أن سور القرآن الكريم، ولا سيما السور الطوال والمئين والمثاني، تقوم على معانٍ كلية تمثل الأساس الذي يُبنى عليه كيان السورة العام. وأن الوقوف على معالم هذه المعاقد من حيث بداياتها ونهاياتها وترتيبها، ومعرفة ما يقوم عليه هذا الترتيب من عمود جامع، لا يتأتى إلا بطول الملازمة للسورة، وكثرة القراءة، ودقة النظر، وحسن التدبر. ثم بيّن أن أساس تقسيم السورة إلى معاقد هو تآلف المعاني الجزئية وتناسقها في تكوين وحدة كلية واضحة المعالم، تتميز بها عن غيرها من المعاقد السابقة واللاحقة من جهة، وترتبط بها في الوقت نفسه على خط السياق الكلي للسورة من جهة أخرى.
وقد قام المؤلف بتطبيق هذه المقاربة على عدد من السور، فبدأ بسورة البقرة حيث بيّن المعاقد الكلية للسورة، ثم انتقل لسورة يوسف، وسورة النحل حيث جمع فيها بين العرض الإجمالي للسورة والتفصيل في بنائها التركيبي، مبيناُ أنها قائمة على مقصود أعظم واحد، وهو بيان منهاج الدعوة إلى وحدانية الله عز وجل وكمال قدرته استدلالًا وامتنانًا بنعمائه وآلائه، وهذا المقصود الأعظم تندرج تحته ثلاثة معاقد رئيسة، تسبقها مقدمة استهلالية، وتُختتم بخاتمة جامعة تكرّس ذلك المقصود. فبعد المقدمة جاء المعقد الأول مبتدئًا بقوله تعالى: “خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ” ليعرض دلائل التوحيد من خلال الامتنان بنعم الله وآلائه في الخلق والتدبير، تدليلًا على وحدانيته، وإحاطة علمه، وكمال قدرته، وأُتبع ذلك بـ المعقد الثاني، مستفتحًا بقوله عز وجل: “فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ” وهو معقود لعرض اعتراضات المعاندين وشبهاتهم في أمر العقيدة والرسالة، مع الرد عليها وتقويضها، وبيان وظيفة الكتاب في الهداية ورفع الاختلاف. ثم جاء المعقد الثالث مفتتحًا بقوله تعالى:“وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا” ليعود إلى تقرير التوحيد مرة أخرى، ولكن بأسلوب مغاير، من خلال تصريف الامتنان وتكثيف آيات القدرة في الكون، وربطها بالحساب والشهادة يوم القيامة. وتُختَم السورة بخاتمة واسعة تبدأ بقوله تعالى:”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ”، وقد خُصِّصت لبيان مكارم الأخلاق، وتكريس منهاج الدعوة إلى الله، والوعد بالمعية والنصر لأهل التقوى والإحسان. وتنقسم هذه الخاتمة إلى قسمين: أحدهما للتعقيب على المعاقد السابقة ببيان أخلاق الداعية، والآخر لتكثيف أصول الدعوة وبيان جزاء من أحسن سلوكها.
ويخلص المؤلف إلى أن هذه المعاقد، على تنوّع أغراضها المرحلية، قد انتظمت في نسق متآخٍ متكامل، يخدم المقصود الأعظم لسورة النحل، ويكشف عن وحدة بنائها وتماسك خطابها.
وفي هذا السياق يؤكد المؤلف على أن استبصار السُّورة آية آية دون تقسيمها إلى فصول ومعاقد كليَّة يضعف قدرة المستبصر على إدراك معالم المقصود والغرض الأعظم العمدة المهيمن على السُّورة. فإن اشتغاله بتلاحم الآية بالآية التي بعدها لا يعنيه على مد بصره إلى أفق أبعد، لكن استبصار التلاحم بين آيات المعقد الواحد أقرب وأمكن، ثم من بعده استبصار علاقات المعاقد بعضها ببعض وخضوعها لسلطان غرض رئيس ومقصود أعظم.
القسم الرابع
في شأن تقسيم المعقد إلى نجوم وعلاقتها بالغرض المرحلي للمعقد
يقرر المؤلف أن السور الطوال والمئين وعِظم المثاني تقوم على معاقد كلية، يندرج تحت كل معقد عدد من الآيات تمثل ما يسميه “نجومًا”، لكل نجم معنى تام في ذاته، لكنه متصل بسائر النجوم داخل دائرة المعقد، والمعقد بدوره خاضع للغرض المحوري للسورة، وهو المقصود الأعظم.
ويُجسّد المؤلف ذلك تطبيقيًا على سورة الفاتحة، إذ يبين أنها تتألف من ثلاثة معاقد:
الأول يقرر حقيقة الألوهية وكمال صفات الله ووحدانيته، وهو الإطار التعريفي بمنزلة الكتاب ورب العالمين.
والثاني يتمثل في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، وهو مركز المعنى القرآني كله، والمعنى الأم الذي تولدت عنه سائر المعاني القرآنية، ولا تكاد جملة في القرآن تنفك عن نسبتها إليه.
أما الثالث فيتمثل في دعاء الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو امتداد طبيعي للمعنى الأم، إذ يجمع بين العبادة والاستعانة، ويُعد الدعاء الجامع الذي تندرج تحته جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة.
ويخلص المؤلف إلى أن هذا البناء الثلاثي لسورة الفاتحة يمثل النموذج الأمثل لبناء سائر سور القرآن، مشيرًا إلى تميّز بيان العلامة محمد عبد الله دراز في كشف هذا المنهج البنائي.
وعلى نفس النحو قام المؤلف بالتطبيق على سورة الضحى وسورة البقرة.
القسم الخامس
التحليل البياني في ضوء السياق والمغزى
يوضح المؤلف أن “البيان” هو كل ما يهدي المتلقي إلى إدراك المعنى المكنون في نفس المُبيِّن، وأن “التحليل” هو سعيٌ إلى تفكيك الكل إلى مكوّناته، والنظر في علاقاتها المتبادلة وهيئات انتظامها، على نحو تتحكم فيه عوامل داخلية وخارجية. ومن ثم فإن “التحليل البياني” هو نظرٌ في مكوّنات البيان في وجوده التركيبي الكلي، بقصد الكشف عن العلاقات الخاصة التي تنتظم بين هذه المكوّنات المتنوعة في ذواتها ووظائفها، وبيان أثر السياق والمغزى في الاختيار والاتساق والانسجام بينها. وعلى هذا الأساس، يذهب المؤلف إلى أن تحليل البناء التركيبي للسورة هو الأداة القادرة على إضاءتها من داخلها، بحيث تتجلى مضامين الهدى في نفس المتلقي باستصحاب المغزى الرئيس الحاكم لحركة المعنى القرآني فيها، الأمر الذي يثمر ضبط النفس في التلقي، ويحقق للعبد اكتساب مضمونين كليين: عقديٍّ وسلوكيٍّ، مع ما يتولد عنهما من قناعةٍ ورضًا قلبيٍّ مثمرٍ زهدًا في كل ما يشغل عن التلذذ بالعبودية لله رب العالمين.
ويؤكد المؤلف أن التحليل البياني، سواء تعلق بالنص القرآني المعجز أو بالبيان الأدبي الرفيع شعرًا أو نثرًا، لا يصح إلا بعد إدراك البيان في كليته التركيبية وأثره الفاعل في نفس المتلقي، إذ على هذا الإدراك تُبنى الموازنة بين حال المكوّنات في نسقها الكلي، وحالها عند النظر إليها مفردة، تبصّرًا لخصائصها الذاتية الثابتة، وخصائصها الوظيفية المتغيرة بتغيّر السياق وأنماط التركيب. ومن ثم يقرر أن التحليل عمل فطري من أعمال التلقي، وأن قيمته وضرورته ليست في ذاته، بل فيما يفضي إليه من عطاءات معرفية وتربوية لا تتحقق إلا بتحققه.
التحليل البياني بين الذاتية والموضوعية:
ذكر المؤلف أنَّ البيان القرآني وحيٌ من الله تعالى لم يجعله خاضعًا لسلطان ما يُعْرَف من قواعد بيان الإنسان ومعاييره، وبيَّن المؤلِّف أنه لا يَصْلُح كلُّ ما استنبطه العلماء من قواعد من بيانِ الإنسان أن يُتَّخَذ وحده معيارًا أو نموذجًا يُلتزَم به في التحليل البياني للسورة، وأن قواعد العربية لا تعدو الاسترشاد بها والاهتداء بضوئها. ثم ذكر أنَّ من المهم أن يقوم منهاج التحليل البياني على ثلاثة مرتكزات؛ التحليل والتأويل والتعليل، وذلك ليقف المرء على ما هو مكنون في البيان من خصال البلاغة والبراعة والبيان ولا يكتفي بالعلم المجمل.
وهنا يقرر المؤلف أمر في غاية الأهمية حتى يتزن المتدبر بين الذاتية والموضوعية، حيث يبين رحمه الله أن كل كلام يُستحسن لا بد أن يكون لاستحسانه جهةٌ معروفة، وعلةٌ معقولة يمكن التعبير عنها، ويقوم عليها دليل يثبت صحتها. فالمطلوب ليس مجرد الإحساس بجمال العبارة أو جودة اللفظ، بل العلم بأسباب هذا الحسن وعلله، ثم القدرة على الإبانة عمّا أدركته الفراسة البيانية إبانةً واضحة. وبهذا يتحول التذوق والتدبر من إحساس ذاتي مجرد — لا يُغني في باب العلم والتعلّم — إلى تذوق موضوعي علمي، يمكن نقله إلى الغير، ومن هنا تتحدد رسالة البلاغي والناقد في فتح السبل للولوج إلى النص، وإزالة ما يعترض الطريق إليه، واستدعاء القارئ إلى مصاحبة النص، بالتنبيه إلى شيء من نفائس مكنونه وجليل معانيه.
تكلَّم المؤلِّف بعد ذلك عن مجالات التحليل البياني، فذكر أن التحليل البياني للمعنى القرآني ولصورته يمكن أن يُجعل في ثلاثة مجالات كلية؛ الأول: علاقات المعاني ومواقعها، والثاني: بناء صورة المعنى، والثالث: دلالة صورة المعنى ومستويات دلالتها عليه، وأثر ذلك في المعنى ومتلقيه، مؤكدً على أن هذا لا يتحقق إلا إذا كان المقصود الأعظم للسورة حاضرًا في الوعي. ثم تناول المؤلِّف هذه المجالات بالتفصيل:
المجال الأول- تحليل علاقات المعاني ومواقعها على مستوى بنية المعقد والنجم والآية: يبين المؤلِّف أنَّ العلاقات هي العنصر الجوهري في تشكُّل المعنى، سواء في الوجود الإنساني أو في الوجود البياني؛ فكما تصنع العلاقات بين الناس وجودهم الحضاري، تصنع العلاقات بين الكلمات والجمل الوجودَ الدلالي للبيان، ومن ثمّ فإن العناية الأَولى في الفهم والإفهام ينبغي أن تتجه إلى هذه الروابط وكيفياتها واختياراتها.
المجال الثاني- تحليل بناء صورة المعنى: يبين المؤلف أن استبصار بناء صورة المعنى ذاتها ليس متوقفًا على علاقات المعاني وحدها، بل تشارك فيه عناصر أخرى مكوِّنة للصورة، من مادة الكلمة وصيغتها وجرسها الصوتي. وتتنوع صورة المعنى تبعًا لتنوع المعنى المصوَّر؛ فقد تأتي في جملة قصيرة أو طويلة، وقد تمتد لتكون قصة كاملة، بسيطة البناء أو مديدة السياق، وكل ما يتوقف عليه اكتمال المعنى والمغزى المرحلي يدخل في تكوين صورة المعنى. وعلى هذا الأساس، تُعدّ بعض السور القصيرة – كسورتي العصر والنصر- جملةً قرآنيةً واحدة من حيث الصورة، إذ يكتمل بها المعنى المقصود.
وكذلك تمتد صورة الجملة القرآنية الواحدة عبر آيات متعددة، كما في تصوير حال المنافقين في مطلع سورة البقرة من الآية الثامنة إلى الآية العشرين، حيث لا يتحقق تمام المعنى إلا بمجموعها. وينطبق الأمر نفسه على قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح في سورة الكهف، إذ تشكِّل القصة بأكملها صورةً واحدة لا يكتمل مغزاها إلا بتتابعها جميعًا.
وفي هذا السياق يذكر المؤلف أن التحليل البياني لصورة المعنى يقوم على وجوه متعددة، من أبرزها:
1- التحليل البياني للكلم: يقرر المؤلف – كما بيّن سابقًا- أن المعجم اللغوي للسورة من أهم الوسائل لفهم مقصدها، ولهذا ينبغي للمتدبّر أن يُحصي كلمات السورة كلها: من أسماء وأفعال وحروف، قبل تقسيمها على معاقد السورة، حتى يتبيّن له ما يكثر منها وما يقلّ، وما اختص به كل معقد.
فإذا طُبّق ذلك مثلًا على سورة الفاتحة، وصُنّفت كلماتها بحسب نوعها وصيغها، وقورنت بشقائقها في المعنى، ظهر سبب اختيار ألفاظ معينة دون غيرها، وانكشفت حكمة هذا الاختيار. ثم يُنظر في تكرار هذه الكلمات في باقي سور القرآن، ومواضع كثرتها وقلتها، وما لذلك من صلة بمقاصد السور، وأثره في المعنى وفي نفس القارئ.
وفي هذا السياق يقرر المؤلف أن كثرة ورود كلمةٍ ما في السورة دليلٌ على أهميتها في بنائها ومعناها؛ فكلما تكررت، أعانت القارئ على جمع المعنى ورؤيته رؤيةً شاملة متماسكة.
2- التحليل البياني للتراكيب: يبين المؤلف أن بنية الآية القرآنية لا تخضع في تحديد بدايتها ونهايتها لمعيار ظاهر من تمام المعنى، أو اتساق التركيب، أو النسق الصوتي، بل وراء ذلك حكمة إلهية قد تعجز العقول عن الإحاطة بها، ولذلك لا يصلح اتخاذ الآية دائمًا إطارًا لتحليل التراكيب البيانية، بل الأَوْلى أن يكون التحليل منصبًّا على الجملة، ثم على العبارة المؤلفة من جمل تحقق تمام المعنى.
ثم يوضح أن التحليل البياني للتركيب يبدأ بتحقيق عمود البلاغة، وهو نَظم الكلمات وفق قواعد العربية. وبما أن أساليب التركيب ووجوهه في العربية كثيرة لا تنحصر، فإن العبرة ليست باستيعاب الأنماط، بل بفهم منهج التركيب، وأصول العلاقات بين الكلمات في الجملة، وبين الجمل في العبارة.
ويؤكد المؤلف في هذا الصدد أن فقه الاقتضاء والمغزى أنفع من حفظ أنماط التراكيب؛ لأن المزية البيانية تنشأ تبعًا لثلاثة أمور :المعنى والغرض الذي سيق له الكلام، وموقع الأساليب بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع بعض.
وهذه الأمور متغيرة بتغير السياق، ولذلك لا توجد قواعد ثابتة تُطبَّق في كل موضع. ومن ثمّ، يتعيّن على المحلل البياني أن يراعي أمرين رئيسين: تحقيق التناسب بين الوجه التركيبي المختار والمعنى المقصود، والعناية بعلاقات الأساليب بعضها ببعض في الاستعمال.
ويختم المؤلف بالتنبيه إلى ضرورة استبصار النمط التركيبي المهيمن في كل صورة من صور المعاني، إذ قد يَرِد هذا الأسلوب المهيمن في صدر الصورة أو وسطها أو خاتمتها، ولا يلتزم موضعًا واحدًا.
3- التحليل البياني للنغم: يبين المؤلف هنا أن العربية تقوم في بنيتها الصوتية والتركيبية على نظام دقيق من الوزن والإيقاع، يجعل التوازن بين أصوات الجملة عنصرًا أصيلًا في بيانها. وانطلاقًا من ذلك، فعلى قارئ القرآن أن يجتهد في تحسين صوته والتغني به دون إخلال بالألفاظ أو المعاني، لما في هذا التحبير من تزيين للمعنى القرآني، وشدٍّ لانتباه السامع، وإبقائه حاضر القلب مع القرآن.
غير أن للتغني غاية محددة، هي تزيين القرآن في الصدور ليُقبِل عليه السامعون إصغاءً وعبادة. فإذا تجاوز التغني هذه الغاية فصرف الانتباه عن جلال المعنى ومقصوده انقلب إلى أمرٍ مذموم. ثم يقرر أن التغني الحق هو ما كان مستقيمًا مع فهم المغزى، وذلك لأن النغم قائم على انسجام الجرس والإيقاع المرتبطين بسياق الكلام ومعناه، وبالتالي فالتغني الخالي من الفقه بالمعنى فعديم الأثر، ولا يحقق تزيين القرآن في قلوب المتلقين.
وفي هذا الإطار يذكر المؤلف أن الجرس والإيقاع من روافد الدلالة على المعنى، كما يشير أيضًا إلى حال المتغني بالقرآن وأثر حاله في عملية التلقي، فيقول رحمه الله: “ومنهاج التغني متأثر بشأن المتغني الإيماني والفهمي لما يتغنى به، فليس تغني من لا يؤمن بما يتغنى كمثل تغني من يؤمن به، وكذلك تغني من لم يفقه ما يتغنى كمثله من لا يفقه ما يتغنى به “.
المجال الثالث- التحليل البياني لدلالة الصورة على المعنى: ذكر المؤلف في سياق حديثه عن مفهوم دلالة الصورة على المعنى، أن أهل العلم ينظرون إلى الدلالة من جهاتٍ عدّة: من جهة نوع الدال، ومن جهة مستوى الظهور، ومن جهة الوضع الشخصي للألفاظ والنوعي للتراكيب، ومن جهة العموم والخصوص، ومن جهة الإطلاق والتقييد، مبينًا أن الأحرى في تحليل دلالة الصورة على المعنى ألا نقصر الأمر على ما قصره البلاغيون في علم البيان، بل نبسط القول في كل مستويات الدلالة سواء من حيث نوع الدال، أو مستوى الدلالة في الجلاء والخفاء، ومستوى الدلالة في الإحكام والاحتمال، القرب والبعد، والقصد الرئيس والقصد الثانوي.
وفي هذا الإطار أورد المؤلف خصائص دلالة الصورة على المعنى عند عالم اللغة الكبير عبد القاهر الجرجاني في كتابه “دلائل الإعجاز” وقد صاغها في ثلاث خصائص:
1- حسن الدلالة، وهو لا يعني الوضوح السطحي أو انكشاف المعنى بلا جهد، بل يعني تيسير الطريق إلى المعنى وإزالة التعقيد عنه. فالغموض المقبول لا يقدح في حسن الدلالة ما دام له سبيل يُهتدى به، أما التعقيد فهو المذموم لأنه يقطع الطريق إلى الفهم.
2- تمام الدلالة، ويتمثل في الصدق والأمانة في الإبانة، بحيث تدل الصورة البيانية على كامل المراد دون زيادة أو نقص. وهذا المقام لا يتحقق على وجه الكمال إلا في بيان الوحي قرآنًا وسنة، لأن غير الوحي يعجز غالبًا عن الوفاء التام بما يختلج في صدر المتكلم، ولا سيما إذا كانت معانيه دقيقة ولطيفة. إذ كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة عنها.
3- إحكام الدلالة، وهو تنقيتها من الاحتمالات الضعيفة أو الفاسدة التي تفسد الفهم، وهو ما سماه عبد القاهر الجرجاني “التبرج”. وإحكام الدلالة حق للسامع على المتكلم، إذ بدونه لا يؤدي البيان رسالته، وقد يفضي إلى سوء الفهم وضياع المعنى المقصود.
ثم يرشد إلى أنَّ علينا في تحليل دلالة الصورة على المعنى أن نجتهد في العلم بوجه الدلالة على المعنى، ومستواها، ومَنزلها حين تتعارض دلالات الصور، وكيف يُجمع بينها إن أمكن الجمع، وكيف يُرجَّح وجهٌ على وجه. وأن نجتهد في العلم بدلالة الصورة على ما لطف من المعاني ودقَّ، فإن معاني بيان الوحي لا تتناهى، فهي تتسع حركة الحياة على تنوّعها وتجددها لتصلح منها ما اعوجّ، وتؤكِّد ما استقام وتزكِّيه.
وفي الختام يقول الدكتور محمود توفيق رحمه الله: “أنه ليس من أحدٍ مؤمنٍ بالقرآن إلا وله من المعنى القرآني ما يقوم عوجه أو يسدّ خلله أو يُكمل نقصه أو يقوّي صوابه أو يزكّيه أو ينمّيه، فتستقيم له الحياة على وفق ما يريد الله قبلًا منه وله في مسيره، وليكون له من الله كفيلٌ في مصيره ما يرضيه ويسعده”.
عرض:
أ. يارا عبد الجواد*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحثة في العلوم السياسية
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies