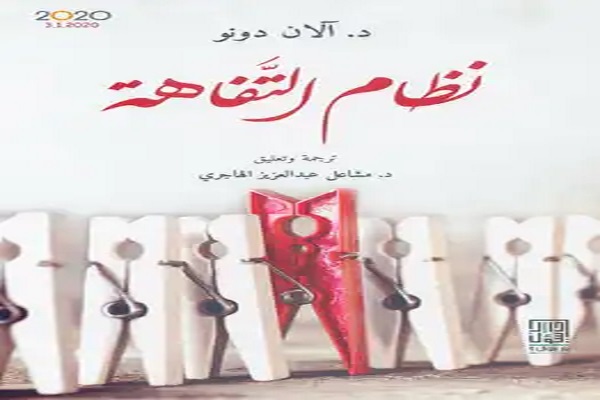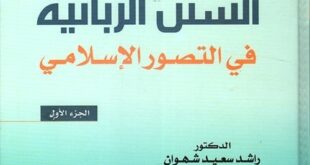العنوان: ما بعد الافتراضي: استكشاف اجتماعي للثقافة المعلوماتية.
المؤلف: فيليب ريجو.
المترجم: عزت عامر.
الطبعة: ط. 1.
الناشر: المركز القومي للترجمة.
مكان النشر: القاهرة.
تاريخ النشر: 2009.
الوصف المادي: 223 صفحة، 24 سم.
الترقيم الدولي: 978-977-479-160-8.
أولًا: التعريف بالكاتب:
فيليب ريجو: باحث في كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بيكاردي جول فيرن، مهتم بعلم اجتماع الاتصالات، وله العديد من المقالات المكرسة للممارسات المستحدثة على الجسم الإنساني، والعودة إلى “اللاعقلانية” و”العقيدة الذاتية”، وله عدة مؤلفات في مجال دراسة الحداثة من الناحية الاجتماعية والأنثروبولوجية من بينها: “الرومانسية وما بعد الحداثة” و”مقاربة اجتماعية تاريخية اجتماعية لحداثتنا”، إلى جانب كتاب “ما بعد الافتراضي: استكشاف اجتماعي للثقافة المعلوماتية”.
مقدمة:
في هذا الكتاب، يقدم “ريجو” رؤية تحليلية لتأثير التقنيات الرقمية على مختلف جوانب حياتنا اليومية، من أدب، وسينما، وترفيه، واقتصاد، ليبرهن على أن تلك التقنيات قد أبرزت نوعًا من الثقافات، اتسمت في جوهرها بالتناقض – والتطرف أحيانًا – لتغير من نظرتنا للوجود الإنساني بأكمله.
من بدايات دخول الآلات في المصانع إبان الثورة الصناعية، يتتبع “ريجو” مسار اندماج التقنيات الرقمية بحياة الإنسان، وكيف وظف الأدباء والفنانون رؤيتهم لمستقبل العلاقات بين الإنسان وتلك التقنيات، حتى استطاعت التقنيات الرقمية التأثير على الواقع المعاش في عالم اليوم، بل وحتى على رؤية الإنسان لذاته، وهويته، ودوره، وأهدافه.
هذا ويمكن القول إن الكتاب يدور حول أفكار خمسة رئيسة، هي: كيف اندمجت التقنيات الحديثة في مظاهر الحياة الإنسانية، ومظاهر ذلك التأثير على الجوانب المختلفة من الاجتماع البشري، وتحول الممارسات الإنسانية بفعل دخول التقنيات الرقمية لحياة الإنسان، وكيف ساهمت التقنيات الرقمية في خلق الواقع، وكيف برزت الثقافة الرقمية في عالمنا المعاصر. وجرى تناول هذه الأفكار في ثنايا خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: الآلات واليوتوبيا: أشكال كلاسيكية للحداثة:
يناقش “ريجو” في هذا الفصل كيف تغلغلت الآلة والتقنية في الحياة البشرية، لتصل إلى مرحلة اندماج “شبه كامل” بين الإنسان والآلة. في البداية، أشار “ريجو” إلى أعمال مفكرين مثل “جيريمي بنتام” و”كلود نيكولاس ليدو”، و”توماس مور”، وغيرهم، والتي تمحورت حول بناء مجتمع عالمي متكامل في القرن الثامن عشر، وإلى انتشار الأفكار الرأسمالية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، والتي قامت على إدخال الآلات إلى المصانع، لتحسين الإنتاجية، وربط بينها وبين ظهور أفكار تهدف إلى تكوين “المجتمع المثالي” و”الفرد المثالي” المكون لذلك المجتمع، سواءً من جانب القيم الأخلاقية التي يتبناها أولئك الأفراد أو من جانب “الكمال التشريحي” لهم، فبرزت أفكار جديدة مثل “علم تحسين النسل” (اليوجينيا)، الذي يهدف لاستئصال العناصر والسمات غير المرغوب فيها في ذلك الفرد، وبدأ يُنظر إلى الإنسان على أنه “كائن قابل للتعديل”.
يرى “ريجو” أن التمثُّل الأبرز لتلك الأفكار كان في أدبيات الخيال العلمي التي راجت في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين، إذ سادت أفكار تخليق الكائن البشري المعدل عن طريق الآلات، كقصة “فرانكشتاين”، وهو الكائن نصف البشري، الذي تم تخليقه من خلال تجميع أجزاء بشرية مع معدات آلية وبثِّ الحياة فيها من خلال التيار الكهربائي. كما برزت أعمال أدبية تناولت مفهوم استبدال الروبوت بالإنسان في مجالات الحياة المختلفة، حتى تمكُّنها من الانقلاب على البشر واستعباد الإنسان في النهاية، إلى جانب مفهوم “الإنسان نصف الآلي” (Cyborg)، والذي تم استبدال أجزاء الكترونية بأعضاء حيوية بجسده، ليحوز قدرات فوق الطبيعة البشرية.
تزامنت أفكار الخيال الأدبي تلك مع جهود علماء في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الآلة مثل “آلان تورينج”، و”ل. ج. بيجلوف”، و”أ. روزنبلوت”، وغيرهم، والتي مهدت لخلق منظومات رقمية فيما بعد، يتشابه نمط التفكير الاصطناعي بها مع نمط التفكير البشري، فظهرت الآلات القادرة على اتخاذ القرارات واستشراف المستقبل عبر قياس الاحتمالات المتعددة. وظهرت -عبر تلك الجهود – تقنيات دخلت مختلف أركان الحياة البشرية، من المنازل الذكية المزودة بأجهزة تلبي مطالب ساكنيها بمجرد أوامر صوتية، إلى التقنيات الرقمية القادرة على تعزيز قدرات الإنسان ذاته، كزرع رقاقات متناهية الصغر في جسم الإنسان لالتقاط معلومات الحواس كحاسة الشم على سبيل المثال.
يُمهد ذلك، من وجهة نظر “ريجو” لظهور عصر “ما بعد البشرية”، حيث تبرز التقنية كسمة من سماته، وتمثل المرحلة التالية من مراحل التطور الإنساني، مع ما يستتبعه ذلك من مزايا وتساؤلات أخلاقية في آن واحد، كتلك المتعلقة بتقنيات الاستنساخ، وقضية تسليع الكائن الحي، وإمكانية توظيف التقنيات الحيوية لأهداف مهددة للبشرية كالحرب البيولوجية.
الفصل الثاني: وعود الفجر الإلكتروني:
مع بداية فترة التسعينيات، برز مفهوم “الوسائط المتعددة” (Multimedia)، والقائم بشكل أساسي على عملية تحويل المعلومات التناظرية إلى صيغ رقمية، تعتمد على لغة الآلة، والتي أتاحت تحويل أشكال متعددة من المعلومات من صور، ومرئيات، وأصوات إلى رموز رقمية، يمكن نقلها، وتبادلها، وضغطها في أحجام أصغر بكثير. ظهرت بفعل ذلك سمات ميزت الوسائط الرقمية عن غيرها من الوسائط التقليدية، فاتسمت تلك الوسائط بدرجة عالية من التفاعلية، سواءً بين الأجهزة الرقمية وبعضها البعض، أو بين المستخدم البشري وتلك الأجهزة، فعلى سبيل المثال، بات من الممكن نقل محتوى رقمي، كمقطع مرئي، من جهاز إلى آخر بشكل أسهل، وبات بمقدور الفرد أن يمارس عدداً أكبر من المهام باستخدام تلك الأجهزة الرقمية.
أتاح ذلك بدوره درجة أكبر من التشعبية في تداول المحتوى الرقمي، وهو ما مهد لظهور شبكة الإنترنت والوِب، والتي سمحت بالوصول إلى المعلومات بشكل محدث، وآني، ومستدام. كما أتاحت إمكانية ضغط المحتوى الرقمي حفظ كميات هائلة من المعلومات في أجهزة صغيرة كالمساعدات الرقمية وأجهزة القارئ الرقمي، فأصبح بمقدور الشخص أن يحمل معه آلاف الكتب في جهاز رقمي واحد وفي أي مكان، على سبيل المثال.
انعكس ذلك – من وجهة نظر “ريجو” – على أبعاد عدة للحياة البشرية، فمن الناحية السياسية نُظر إلى شبكة الإنترنت على أنها مجال عام مفتوح وعالمي، يعزز من قيم المشاركة المتساوية بين المستخدمين، ويتجاوز العلاقات التراتبية بينهم، لتصبح العلاقات المتبادلة في شكل أفقي. ومن الناحية المعرفية، شجعت شبكة الإنترنت على التبادل الحر للمعلومات، وسهلت من الوصول لها، بعيداً عن القيود والقواعد التقليدية، وبات بمقدور الدارسين والباحثين التعاون فيما بينهم متجاوزين الحدود الزمنية والمكانية. وأتاحت شبكة الإنترنت فرصاً أوسع للترفيه والتعارف، فبات بمقدور المستخدمين التواصل بشكل أيسر عبر غرف الدردشة على الإنترنت على سبيل المثال.
وفي الجانب الاقتصادي، منحت التقنيات الحديثة الشركات الناشئة فرصاً وأدوات مكنتها من الوصول إلى فرص اقتصادية أوسع، ومنافسة الشركات الكبرى، وذلك من خلال بناء مواقع على شبكة الإنترنت، بتكلفة قليلة، تتيح اتصالاً أيسر بين الشركة والمستهلكين المحتملين، وتبرز ما عُرف بـ “اقتصاد الإنترنت” و”التجارة الرقمية”. يتسم ذلك الشكل من أشكال التجارة بإمكانية استهداف الزبون المحتمل بمنتجات ومحتوى مخصص له، بناءً على الميول الشخصية لذلك الزبون، والتي تم التعرف عليها من خلال جمع وتحليل كميات هائلة من المعلومات وبناء ملف شخصي له يحوي تفضيلاته الشخصية، وفي الجانب المعاكس، تمكن المواقع التفاعلية على الإنترنت المستخدمين من معاينة المنتج قبل شرائه.
انتقلت فكرة التخصيص تلك إلى المواقع غير التجارية على الإنترنت، فظهرت مواقع تتمحور حول تفضيلات معينة لمستخدميها، مثل مواقع التعارف، ومواقع الدردشة، أو المواقع المتمحورة حول مجال معين كتشارك المعرفة. كما أدى انخفاض تكلفة إنشاء المواقع الرقمية إلى تفجر أعداد المواقع التي تركز على قضايا بعينها، كالقضايا السياسية أو الاجتماعية، أو المرتبطة لتجمعات وتنظيمات بعينها.
الفصل الثالث: الضيافة المعلوماتية:
يتتبع “ريجو” في هذا الفصل انتقال تأثير ما عُرف باسم “تلفزيون الواقع” إلى الفضاء الرقمي، إذ عاد الكاتب هنا إلى فترة ذيوع البرامج التلفزيونية والمجلات التي ركزت نشاطها على نقل الحياة الشخصية للمشاهير في شتَّى المجالات، من أجل الحصول على مزيد من الشهرة، حتى ظهور المواقع والصفحات الشخصية على شبكة الإنترنت، والتي من خلالها استطاع الأفراد نشر مستجدات حياتهم الشخصية مباشرةً، للوصول إلى نطاق أوسع من المتابعين. ويرى “ريجو” في مثل ذلك النوع من الظهور الرقمي وسيلة لتوسيع حدود ما هو مسموح لعرضه أمام العامة، وخلق نظام جديد للوصول إلى الشهرة، كامتداد لبرامج “تلفزيون الواقع” التي سبقتها.
يستطيع الأفراد تكريس تلك المواقع لعرض أدق تفاصيلهم الحياتية لجمهورهم، بدءًا من التفضيلات الشخصية للموسيقى، أو الكتب، أو الأغذية، وحتى العلاقات الشخصية والأسرية، فيما أسماه الكاتب “التعري الرقمي”، أي الكشف عن حياة الفرد الشخصية أمام الجمهور. وقد عزز هذا التوجه – من وجهة نظر “ريجو” – انتشار تقنيات ككاميرات الوِب، التي أتاحت إمكانية الاتصال والعرض، دون التعرض للضغوط الاجتماعية التي كان من الممكن أن يلاقيها الفرد إذا ما حاول أن يمارس تلك الرغبة في الانكشاف في الحياة الواقعية.
وقد أرجع “ريجو” الرغبة في استعراض الحياة الشخصية أمام الجمهور الافتراضي على شبكة الإنترنت إلى سببين رئيسين، أولهما، أن التقنيات الرقمية الحديثة، مثلها مثل “تلفزيون الواقع”، تعمل على تضخيم قيمة الأشياء، إذ تعمل على جعل مجموعة الصور أو المقاطع المرئية التي ينشرها الشخص على موقعه الشخصي تمثيلاً لحياته الاجتماعية، وثانيهما، أن رغبة الشخص ذاته في استرعاء انتباه العامة، ولو بشكل منافٍ للقيم، قد يمثل حافزاً لتلك الممارسات على شبكة الإنترنت.
وعلى النقيض من ذلك، تمتلك تقنيات الإنترنت – من وجهة نظر “ريجو” – إمكانية إخفاء الهوية الحقيقية لمستخدميها، حمايةً لخصوصيته، كمثل ما يحدث عند تبادل المحادثات الافتراضية على غرف الدردشة حول مختلف الموضوعات، فالمستخدم الرقمي هنا يستطيع أن يبتكر له اسمًا مستعارًا يخفي وراءه هويته الحقيقية، سواءً من خلال استعارة أسماء شخصيات مشهورة، أو أحداث عالمية مهمة، أو حتى ابتكار اسم لا يرتبط بالواقع بأي صلة، كالتسمي باسم شخصية خيالية مثلًا. بذلك خلق الإنترنت هويةً ذاتية قائمة على الاختيار، فبإمكان المستخدم أن يحدد بنفسه كُنه ومضمون شخصيته الرقمية التي سيظهر بها أمام باقي المستخدمين الرقميين، سواءً بشكل مباشر وسري، أو عن طريق نشر المحتوى للعامة بشكل علني.
ربط “ريجو” بين تلك الهوية الاختيارية عبر الإنترنت وبين ظهور ما أسماه “عشائر الإنترنت”، وهي المجتمعات الافتراضية المتمحورة حول موضوع بعينه، فيما يشبه العشيرة أو القبيلة المشتركة في سمات تميزها عن غيرها، لتظهر هنا كذلك ما يشبه الهوية الجمعية لمرتادي تلك المجتمعات الافتراضية، يشترك أفرادها في ذات مدارات الاهتمام، ولعلك تربط بين ذلك ومجموعات “فيسبوك” على سبيل المثال. وينظر “ريجو” إلى مثل تلك المجتمعات الافتراضية على أنها ساحة افتراضية “أجورا”، تسمح بالنقاش الحر حول موضوعات بعينها، يشترك أفراد تلك المساحة في حبها ويجتمعون عليها، وهو ما يمتد إلى الحياة الواقعية عبر خلق “ازدواجية هوياتية” لذات الفرد.
الفصل الرابع: الافتراضي في كل حالاته:
في هذا الفصل، يتناول الكاتب المقصود بمفهوم الافتراضي، وكيف انتقل ذلك المفهوم من معناه الاحتمالي، إلى معنى أكثر شموليةً ينعكس على خلق واقع جديد موازٍ لواقعنا الفعلي من خلال التقنيات الرقمية، فبحسب تعبير “ريجو”، أتاحت تلك التقنيات “قدرات الاستكشاف الخلَّاقة”، والتي ساعدت على دمج الخيال بالواقع، لينتج لنا ذلك البُعد الجديد، الذي نتحكم – نحن – بقوانينه كيفما شئنا.
من العروض التلفزيونية والسينمائية التي تستخدم حيل تزييف الواقع لأغراض الترفيه، إلى تعديل الصور الفوتوغرافية لإزالة العيوب، وإنتاج “كمال متخيل”، إلى مجال التقارير الإخبارية (المضللة)، التي قد تستخدم خدع تزييف الواقع من أجل بث معلوماتها للجمهور، إلى إمكانية ابتكار شخصيات افتراضية، يرتبط بها الناس، كشخصيات الألعاب الرقمية، وعوالم وهمية تنقل الأفراد إلى بُعد جديد يستطيعون التفاعل فيه سواءً في أفلام السينما أو الألعاب الرقمية التفاعلية، كل ذلك هو نتائج تلك القدرة الاستكشافية الخلاقة، التي سمحت لنا بتعديل الواقع، وخلق عوالم جديدة، تزيل الحدود بين الحقيقة والخيال، بل ساهمت التقنيات الرقمية في نشر تلك القدرات الاستكشافية لدى فئات أوسع من غير المحترفين، فمع برنامج لتعديل الصور أو المرئيات إلى جانب كاميرا بسيطة، يستطيع أي فرد أن يخلق عالمه الخاص.
وفق “ريجو”، غزا الخيال الافتراضي مجالات العمل والترفيه على حد سواء، إذ نجد أن الألعاب الرقمية الحديثة، والقائمة على خلق تلك العوالم المفترضة، تتطلب مزيداً من التفاعلية من قبل المستخدمين، فترى اللاعب يندمج بشكل فعلي في عالم اللعبة، ويتفاعل معها بجسمه، ويتقمص أدواراً في اللعبة بحسب متطلباتها.
كما أن العديد من الجوانب المهنية باتت ضمن المجال الرقمي، فصار اعتماد العديد من المهندسين المعماريين على البرمجيات الرقمية لتصميم نماذج أعمالهم، بدلًا من الاعتماد على الورقة والقلم أو الكرتون المقوى، وبات العديد من الطيارين يتدربون على عملهم عبر برامج المحاكات المختلفة، على سبيل المثال.
الفصل الخامس: الثقافة المعلوماتية الأخرى:
يسوق “ريجو” في هذا الفصل ما يدلل به على بروز نوع جديد من الثقافة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والحداثة، بدأت مع أدب الخيال العلمي، وانتقلت إلى عوالم الموسيقى، والسينما، والألعاب الرقمية، ومن ثم إلى الممارسات الفعلية للأفراد في الحياة الواقعية. يرى “ريجو” أنه مع انفتاح المجال بشكل أوسع أمام التكنولوجيا في الحياة اليومية، بدأت السرديات الأدبية تتناول موضوع من قبيل الانتقال عبر الزمن وتمرد التقنيات الحديثة على الإنسان، فيما أسماه الكاتب “أدب التمرد المعلوماتي”.
يتسم ذلك “التمرد المعلوماتي” بسمات عدة، أبرزها: التناقض، فبينما تكون ركيزة ذلك الأدب هو التقنيات الرقمية، فإنه يمزج ذلك بعناصر قد تكون تاريخية أو من عصور أخرى، كأن يتناول قصص حضارات قديمة لديها أسلحة حديثة متطورة أو قصص اتصال تلك الحضارات بالكائنات الفضائية، والعشائرية، والتي تقوم على إعادة تشكيل ممارسات من ثقافات بدائية، ودمجها مع التقنيات الحديثة، فيما يشبه الحركات الهيبية التي انتشرت في فترة الستينيات والسبعينيات. ووفق ذلك، بات لكل جماعة مهتمة بموضوع معين وسائل للإعلان عن ذاتها عبر تلك التقنيات الحديثة.
تتمثل السمة الثالثة في التطرف الشديد، الذي يظهر في بروز ممارسات مرتبطة بالتعديل على الجسد – على سبيل المثال – ارتباطاً بفكرة إبدال الأعضاء الحيوية للجسم البشري بأدوات وآلات رقمية، أو سعي بعض الباحثين إلى إعادة إحياء الموتى عبر حفظ أجسادهم باستخدام التقنيات الحديثة، على أمل ظهور تقنيات مستقبلية تمكنهم من تلك العملية، فتسعى الثقافة الرقمية الجديدة – إذن – إلى تجاوز القيود البيولوجية للجسد البشر.
في النهاية، يخلص “ريجو” إلى أن التقنيات الرقمية والإنترنت قد أثرا في الوجود البشري بشكل كبير، مع اختفاء القيود الزمنية، والمكانية، والجسدية التي تعوق الإنسان إلى حد بعيد، بل لم يعد الفرد مضطراً إلى اتخاذ قراراته بنفسه، من خلال الاستعاضة عن ذلك بما توفره تلك التقنيات من أدوات لاتخاذ القرارات وقياس الاحتمالات، والحصول على المعلومات، حتى إن الكاتب وصف الإنترنت بأنه أشبه بـ “عقل عالمي”.
كما غذت الثقافة الرقمية المتولدة من تفشي التقنيات الحديثة في حياتنا أفكارا مرتبطة بتجاوز حدودنا البشرية، وبات الإنسان كائنا قابلا للتعديل والدمج مع الآلة، وهو ما ظهر في أدبيات الخيال العلمي على مر السنين. بالإضافة إلى أن الاقتصاد قد تأثر بعمق بالعولمة الرقمية، والتي وفرت للشركات الناشئة فرصًا لتقديم خدماتها وسلعها بشكل حر، وتنمية تأثيرها على الأفراد وحتى الدول، كما غير الإنترنت العلاقة بين المستهلك والمنتج، فبات بمقدور أي فرد أن يكون منتجاً، ما دام لديه المعرفة اللازمة للابتكار والابداع.
ألغى الإنترنت القيود المفروضة على الدخول إلى عالم الشهرة، كتلك القيود المرتبطة بثقافة دولة معينة أو القيم المجتمعية، وبرزت هوية جديدة معقدة، تجمع بين عناصر متضادة تعبر عن واقع المجتمعات الحديثة.
وختامًا، وضع “ريجو” في هذا الكتاب أسس تحليل أنثروبولوجي للتأثيرات الحضارية للرقمنة والتقانة الحديثة، والتي من غير المستعبد أن تتفاقم مظاهرها مع تقدم تلك التقنيات، ويتعمق تأثيرها على الإنسان وحياته واجتماعه البشري، فاليوم بات دمج الإنسان في واقع افتراضي من صنعه أمراً في غاية السهولة، وباتت إرهاصات ظهور علم اجتماع رقمي جديد شاخصة للعيان، فلم تعد التقانة فقط شاشة أو جهازًا محمولًا، بل مهدت لظهور أبعاد جديدة بقوانين حاكمة يضعها الإنسان، أو الشركات المبتكرة لتلك الأبعاد والعوالم.
يرتبط ما سبق بأفكار العديد من المبشرين حول قيام حضارة رقمية جديدة، تختلف عن سابقاتها، لا تزال معالمها في طور التكوين، ولم يُعرف بعد دور الإنسان فيها ولا مكانته. ومن هنا، كان لزامًا على باحثي العلوم الاجتماعية والتقانة العمل على سبر محددات وأبعاد تلك الحضارة المنتظرة، وتوقع كيف ستكون تفاصيل وتحديات الواقع المعاش في ظلها.
عرض:
أ. أحمد خميس*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الإسكندرية.
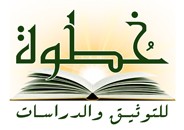 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies