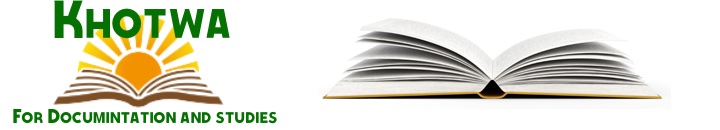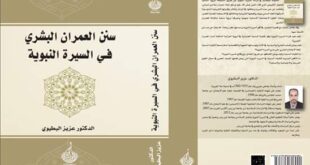الفلسفة الاجتماعية
بين الرأسمالية والاشتراكية والإسلام*
محمد باقر الصدر**
مشكلة العالم التي تملأ فكر الإنسانية اليوم وتمس واقعها بالصميم هي مشكلة النظام الاجتماعي التي تتلخص في محاولة إعطاء أصدق إجابة عن السؤال الآتي: ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية؟
ومن الطبيعي أن تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير، وأن تكون في تعقيدها وتنوع ألوان الاجتهاد في حلها مصدرًا للخطر على الإنسانية ذاتها، لأن النظام داخل في حساب الحياة الإنسانية ومؤثر في كيانها الاجتماعي في الصميم.
وهذه المشكلة عميقة الجذور في الأغوار البعيدة من تاريخ البشرية، وقد واجهها الإنسان منذ نشأت الحياة الاجتماعية. وتتمثل الإنسانية الجماعية في عدة أفراد تجمعهم علاقات وروابط مشتركة، وهذه العلاقات التي تكونت تحقيقًا لمتطلبات الفطرة والطبيعة في حاجة بطبيعة الحال إلى توجيه وتنظيم. وعلى مدى انسجام هذا التنظيم مع الواقع الإنساني ومصالحه يتوقف استقرار المجتمع وسعادته.
وقد دفعت هذه المشكلة بالإنسانية في ميادينها الفكرية والسياسية إلى خوض جهاد طويل، وكفاح حافل بمختلف ألوان الصراع، وبشتى مذاهب العقل البشري التي ترمي إلى إقامة البناء الاجتماعي وهندسته، ورسم خططه ووضع ركائزه. وكان جهادًا مرهقًا يضج بالمآسي والمظالم، ويزخر بالضحكات والدموع، وتقترن فيه السعادة مع الشقاء، كل ذلك لما كان يتمثل في تلك الألوان الاجتماعية من مظاهر الشذوذ والانحراف عن الوضع الاجتماعي الصحيح. ولولا ومضات شعت في لحظات من تاريخ هذا الكوكب، لكان المجتمع الإنساني يعيش في مأساة مستمرة.
ولا نريد أن نستعرض الآن أشواط الجهاد الإنساني في الميدان الاجتماعي، لأننا لا نقصد بهذه الدراسة أن نؤرخ للإنسانية المعذبة، وأجوائها التي تقلبت فيها منذ الآماد البعيدة. وإنما نريد أن نواكب الإنسانية في واقعها الحاضر، وفي أشواطها التي انتهت اليها، لنعرف الغاية التي يجب أن ينتهي اليها الشوط، والساحل الطبيعي الذي لا بد للسفينة أن تشق طريقها إليه، وترسو عنده لتصل إلى السلام والخير، وتؤوب إلى الحياة مستقرة، يعمرها العدل والسعادة، بعد جهد وعناء طويلين وبعد تطواف عريض في شتى النواحي ومختلف الاتجاهات.
المذاهب الاجتماعية
إن أهم المذاهب الاجتماعية التي تسود الذهنية الإنسانية العامة اليوم، ويقوم بينها الصراع الفكري أو السياسي على اختلاف مدى وجودها الاجتماعي في حياة الإنسان هي مذاهب ثلاثة:
- النظام الديمقراطي الرأسمالي.
- النظام الاشتراكي.
- النظام الإسلامي.
ويتقاسم العالم اليوم اثنان من هذه الأنظمة الثلاثة. فالنظام الديمقراطي الرأسمالي هو أساس الحكم في بقعة كبيرة من الأرض، والنظام الاشتراكي هو السائد في بقعة كبيرة أخرى. وكل من النظامين يملك كيانًا سياسيًا عظيمًا، يحميه في صراعه مع الآخر، ويسلحه في معركته الجبارة التي يخوضها أبطاله في سبيل الحصول على قيادة العالم، وتوحيد النظام الاجتماعي فيه.
وأما النظام الإسلامي فوجوده بالفعل فكري خالص، غير أن هذا النظام مر بتجربة من أروع النظم الاجتماعية وأنجحها، ثم عصفت به العواصف بعد أن خلا الميدان من القادة المبدئيين أو كاد، وبقيت التجربة عند أناس لم ينضج الإسلام في نفوسهم، ولم يملأ أرواحهم بروحه وجوهره فعجزت عن الصمود والبقاء، فتقوض الكيان الإسلامي، وبقي نظام الإسلام فكرة في ذهن الأمة الإسلامية، وعقيدة في قلوب المسلمين، وأملا يسعى إلى تحقيقه أبناؤه المجاهدون.
فما هو موضعنا من هذه الأنظمة؟
أولًا – الديمقراطية الرأسمالية
ولنبدأ بالنظام الديمقراطي الرأسمالي. هذا النظام الذي أطاح بلون من الظلم في الحياة الاقتصادية، وبالحكم الدكتاتوري في الحياة السياسية، وبجمود الكنيسة وما اليها في الحياة الفكرية، وهيأ مقاليد الحكم والنفوذ لفئة حاكمة جديدة حلت محل السابقين، وقامت بنفس دورهم الاجتماعي في أسلوب جديد.
وقد قامت الديمقراطية الرأسمالية على الإيمان بالفرد إيمانًا لا حد له، وبأن مصالحه الخاصة بنفسها تكفل – بصورة طبيعية – مصلحة المجتمع في مختلف الميادين… وأن فكرة الدولة إنما تستهدف حماية الأفراد ومصالحهم الخاصة، فلا يجوز أن تتعدى حدود هذا الهدف في نشاطها ومجالات عملها.
ويتلخص النظام الديمقراطي الرأسمالي في إعلان الحريات الأربع:
السياسية، والاقتصادية، والفكرية، والشخصية.
فالحرية السياسية تجعل لكل فرد كلامًا مسموعًا ورأيًا محترمًا في تقرير الحياة العامة للأمة: من حيث وضع خططها، ورسم قوانينها، وتعيين السلطات القائمة لحمايتها. وذلك لأن النظام الاجتماعي للأمة، والجهاز الحاكم فيها، مسألة تتصل اتصالًا مباشرًا بحياة كل فرد من أفرادها، وتؤثر تأثيرًا حاسمًا في سعادته أو شقائه، فمن الطبيعي حينئذ أن يكون لكل فرد حق المشاركة في بناء النظام والحكم.
وإذا كانت المسألة الاجتماعية – كما – قلنا مسألة حياة أو موت، ومسألة سعادة أو شقاء للمواطنين الذين تسري عليهم القوانين والأنظمة العامة.. فمن الطبيعي أيضًا ألا يباح الاضطلاع بمسؤوليتها لفرد، أو لمجموعة خاصة من الأفراد – مهما كانت الظروف – ما دام لم يوجد الفرد الذي يرتفع في نزاهة قصده ورجاحة عقله، على الأهواء والأخطاء.
فلا بد إذن من إعلان المساواة التامة في الحقوق السياسية بين المواطنين كافة، لأنهم يتساوون في تحمل نتائج المسألة الاجتماعية، والخضوع لمقتضيات السلطات التشريعية والتنفيذية. وعلى هذا الأساس قام حق التصويت ومبدأ الانتخاب العام، الذي يضمن انبثاق الجهاز الحاكم – بكل سلطاته وشُعبه – عن أكثرية المواطنين.
والحرية الاقتصادية ترتكز على الإيمان بالاقتصاد الحر، وتقرر فتح جميع الأبواب، وتهيئة كل الميادين أمام المواطن في المجال الاقتصادي. فيباح التملك للاستهلاك وللإنتاج معًا، وتباح هذه الملكية الإنتاجية التي يتكون منها رأس المال من غير حد وتقييد، وللجميع على حد سواء. فلكل فرد مطلق الحرية في الإنتاج بأي أسلوب وسلوك أي طريق لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفتها، على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية.
وفي زعم بعض المدافعين عن هذه الحرية الاقتصادية أن قوانين الاقتصاد السياسي التي تجري على أصول عامة بصورة طبيعية، كفيلة بسعادة المجتمع وحفظ التوازن الاقتصادي فيه.. وأن المصلحة الشخصية، التي هي الحافز القوي والهدف الحقيقي للفرد في عمله ونشاطه، هي خير ضمان للمصلحة الاجتماعية العامة، وأن التنافس الذي يقوم في السوق الحرة، نتيجة لتساوي المنتجين في حقهم من الحرية الاقتصادية، يكفي وحده لتحقيق روح العدل والإنصاف في شتى الاتفاقات والمعاملات. فالقوانين الطبيعية للاقتصاد تتدخل – مثلًا – في حفظ المستوى الطبيعي للثمن، بصورة تكاد أن تكون آلية، وذلك أن الثمن إذا ارتفع عن حدوده الطبيعية العادلة، انخفض الطلب بحكم القانون الطبيعي الذي يحكم بأن ارتفاع الثمن يؤثر في انخفاض الطلب، وانخفاض الطلب بدوره يقوم بتخفيض الثمن، تحقيقًا لقانون طبيعي آخر، ولا يتركه حتى ينخفض به إلى مستواه السابق ويزول الشذوذ بذلك.
والمصلحة الشخصية تفرض على الفرد دائمًا التفكير في كيفية زيادة الإنتاج وتحسينه، مع تقليل نفقاته. وذلك يحقق مصلحة المجتمع، في نفس الوقت الذي يعتبر مسألة خاصة بالفرد.
والتنافس يقتضي – بصورة طبيعية – تحديد أثمان البضائع وأجور العمال والمستخدمين بشكل عادل، لا ظلم فيه ولا إجحاف. لأن كل بائع أو منتج يخشى من رفع أثمان بضائعه، أو تخفيض أجور عماله، بسبب منافسة الآخرين له من البائعين والمنتجين.
والحرية الفكرية تعني أن يعيش الناس احرارًا في عقائدهم وأفكارهم، يفكرون حسب ما يتراءى لهم ويحلو لعقولهم، ويعتقدون ما يصل اليه اجتهادهم أو ما توحيه إليهم مشتهياتهم وأهواؤهم بدون عائق من السلطة. وكذلك حرية الإعلان عن الأفكار والمعتقدات، والدفاع عن وجهات النظر والاجتهاد.
والحرية الشخصية تعبر عن تحرر الإنسان في سلوكه الخاص من مختلف ألوان الضغط والتحديد. فهو يملك إرادته ويطورها وفقًا لرغباته الخاصة، مهما نجم عن استعماله لسيطرته هذه على سلوكه الخاص من مضاعفات ونتائج، مالم تصطدم بسيطرة الآخرين على سلوكهم. فالحد النهائي الذي تقف عنده الحرية الشخصية لكل فرد هو حرية الآخرين، فما لم يمسها الفرد بسوء فلا جناح عليه أن يكيف حياته باللون الذي يحلو له ويتبع مختلف العادات والتقاليد والشعائر والطقوس التي يتذوقها، لأن ذلك مسألة خاصة تتصل بكيانه وحاضره ومستقبله. وما دام يملك هذا الكيان فهو قادر على التصرف فيه كما يشاء.
وليست الحرية الدينية – في رأي الرأسمالية التي تنادي بها– إلا تعبيرًا عن الحرية الفكرية في جانبها العقائدي، وعن الحرية الشخصية في الجانب العملي، الذي يتصل بالشعائر والسلوك.
ونخلص من هذا العرض أن الخط الفكري العريض لهذا النظام – كما ألمحنا اليه – هو أن مصالح المجتمع بمصالح الأفراد. فالفرد هو القاعدة التي يجب أن يرتكز عليها النظام الاجتماعي، والدولة الصالحة هي الجهاز الذي يسَّخر لخدمة الفرد، والإدارة القوية لحفظ مصالحه وحمايتها.
هذه هي الديمقراطية الرأسمالية في ركائزها الأساسية، التي قامت من أجلها جملة من الثورات، وجاهد في سبيلها كثير من الشعوب والأمم في ظل قادة كانوا حين يعبرون عن هذا النظام الجديد ويعِدون بمحاسنه، يصفون الجنة في نعيمها وسعادتها، وما تحفل به من انطلاق، وهناء، وكرامة، وثراء. وقد أجريت عليها بعد ذلك عدد من التعديلات، غير أنها لم تمس جوهرها، بل بقيت محتفظة بأهم ركائزها وأسسها.
الاتجاه المادي في الرأسمالية
ومن الواضح أن هذا النظام الاجتماعي نظام مادي خالص، أخذ الإنسان منفصلًا عن مبدئه وآخرته، محدودًا بالجانب النفعي من حياته المادية. ولكن هذا النظام في نفس الوقت الذي كان مشبعًا بالروح المادية الطاغية لم يُبنَ على فلسفة مادية للحياة وعلى دراسة مفصلة لها. فالحياة في الجو الاجتماعي لهذا النظام، فُصِلت عن كل علاقة خارجة عن حدود المادة والمنفعة. ولكن لم يهيأ لإقامة هذا النظام فهم فلسفي كامل لعملية الفصل هذه. ولا أعني بذلك أن العالم لم يكن فيه مدارس للفلسفة المادية وأنصار لها، بل كان فيه إقبال على النزعة المادية تأثرًا بالعقلية التجريبية التي شاعت منذ بداية الانقلاب الصناعي[1]، واعتمادًا على روح الشك والتبلبل الفكري الذي أحدثه انقلاب الرأي على طائفة من الأفكار كانت تُعد من أوضح الحقائق وأكثرها صحة[2]، وبروح التمرد والسخط على الدين المزعوم الذي كان يجمد الأفكار والعقول، ويتملق للظلم والجبروت وينتصر للفساد الاجتماعي في كل معركة يخوضها مع الضعفاء والمضطهدين[3].
فهذه العوامل الثلاثة ساعدت على بعث المادية، في كثير من العقليات الغربية..
كل هذا صحيح، ولكن النظام الرأسمالي لم يركز على فهم فلسفي مادي للحياة، وهذا هو التناقض والعجز، فإن المسألة الاجتماعية للحياة تتصل بواقع الحياة، ولا تتبلور في شكل صحيح إلا إذا أقيمت على قاعدة مركزية، تشرح الحياة وواقعها وحدودها. والنظام الرأسمالي يفتقد هذه القاعدة، فهو ينطوي على خداع وتضليل أو على عجلة وقلة أناة حين جمد المسألة الواقعية للحياة ودرس المسألة الاجتماعية منفصلة عنها، مع أن قوام الميزان الفكري للنظام يقوم على تحديد نظرته منذ البداية إلى واقع الحياة، التي تموّن المجتمع بالمادة الاجتماعية – وهي العلاقات المتبادلة بين الناس – وطريقة فهمه لها، واكتشاف أسرارها وقيمها. فالإنسان في هذا الكوكب إن كان من صنع قوة مدبرة مهيمنة، عالمة بأسراره وخفاياه، بظواهره ودقائقه، قائمة على تنظيمه وتوجيهه.. فمن الطبيعي أن يخضع في توجيهه وتكييف حياته لتلك القوة الخالقة، لأنها أبصر بأمره وأعلم بواقعه، وأنزه قصدًا وأشد اعتدالًا منه.
وأيضًا، فإن هذه الحياة المحدودة إن كانت بداية الشوط لحياة خالدة تنبثق عنها، وتتلون بطابعها، وتتوقف موازينها على مدى اعتدال الحياة الأولى ونزاهتها؛ فمن الطبيعي أن تنظم الحياة الحاضرة بما هي بداية الشوط لحياة لا فناء فيها، وتقام على أسس القيم المعنوية والمادية معًا.
وإذن فمسألة الإيمان بالله وانبثاق الحياة عنه، ليست مسألة فكرية خالصة لا علاقة لها بالحياة، لتُفصل عن مجالات الحياة، ويُشرع لها طرائقها ودساتيرها مع إغفال تلك المسألة وفصلها، بل هي مسألة تتصل بالعقل والقلب والحياة جميعًا.
والدليل على مدى اتصالها بالحياة من منظور الديمقراطية الرأسمالية نفسها أن الفكرة فيها تقدم على أساس عدم وجود شخصية أو مجموعة من الأفراد بلغت من العصمة في قصدها وميلها وفي رأيها واجتهادها، إلى الدرجة التي تبيح إيكال المسألة الاجتماعية اليها، والتعويل في إقامة حياة صالحة للأمة عليها. وهذا الأساس بنفسه لا موضع ولا معنى له، إلا إذا أقيم على فلسفة مادية خالصة، لا تعترف بإمكان انبثاق النظام الا عن عقل بشري محدود.
فالنظام الرأسمالي مادي بكل ما للفظ من معنى، فهو إما أن يكون قد استبطن المادية، ولم يجرؤ على الإعلان عن ربطه بها وارتكازه عليه. وإما أن يكون جاهلًا بمدى الربط الطبيعي بين المسألة الواقعية للحياة ومسألتها الاجتماعية. وعلى هذا فهو يفقد الفلسفة التي لابد لكل نظام اجتماعي أن يرتكز عليها. وهو – بكلمة – نظام مادي، وإن لم يكن مقامًا على فلسفة مادية واضحة الخطوط.
موضع الأخلاق من الرأسمالية
وكان من جراء هذه المادية التي زخر النظام بروحها أن أقصيت الأخلاق من الحساب، ولم يلحظ لها وجود في ذلك النظام، أو بالأحرى تبدلت مفاهيمها ومقاييسها، وأعلنت المصلحة الشخصية كهدف أعلى، والحريات جميعًا كوسيلة لتحقيق تلك المصلحة. فنشأ عن ذلك أكثر ما ضج به العالم الحديث من محن، وكوارث، ومآسي، ومصائب.
وقد يدافع أنصار الديمقراطية الرأسمالية عن وجهة نظرها في الفرد ومصالحه الشخصية قائلين إن الهدف الشخصي بنفسه يحقق المصلحة الاجتماعية، وأن النتائج التي تحققها الأخلاق بقيمها الروحية تحقق في المجتمع الديمقراطي الرأسمالي، لكن لا عن طريق الأخلاق، بل عن طريق الدوافع الخاصة وخدمتها. فإن الإنسان حين يقوم بخدمة اجتماعية يحقق بذلك مصلحة شخصية أيضًا، باعتباره جزءًا من المجتمع الذي سعى في سبيله، وحين ينقذ حياة شخص تعرضت للخطر فقد أفاد نفسه أيضًا، لأن حياة الشخص سوف تقوم بخدمة للهيئة الاجتماعية فيعود عليه نصيب منها. وإذن فالدافع الشخصي والحس النفعي يكفيان لتأمين المصالح الاجتماعية وضمانها، ما دامت ترجع بالتحليل إلى مصالح خاصة ومنافع فردية.
وهذا الدفاع أقرب إلى الخيال الواسع منه إلى الاستدلال. فتصور بنفسك أن المقياس العملي في الحياة لكل فرد في الأمة، إذا كان هو تحقيق منافعه ومصالحه الخاصة على أوسع نطاق وأبعد مدى، وكانت الدولة توفر للفرد حرياته وتقدسه بغير تحفظ ولا تحديد، فما هو وضع العمل الاجتماعي من قاموس هؤلاء الأفراد؟! وكيف يمكن أن يكون اتصال المصلحة الاجتماعية بالفرد كافيًا لتوجيه الأفراد نحو الأعمال التي تدعو اليها القيم الخلقية؟!، مع أن كثيرًا من تلك الأعمال لا تعود على الفرد بشيء من النفع، وإذا اتُفق أن كان فيها شيء من النفع باعتباره فردًا من المجتمع فكثيرًا ما يزاحم هذا النفع الضئيل، الذي لا يدركه الإنسان الا في نظرة تحليلية، بفوات منافع عاجلة أو مصالح فردية، تجد في الحريات ضمانًا لتحقيقها، فيطيح الفرد في سبيلها بكل برنامج الخلق والضمير الروحي.
مآسي النظام الرأسمالي
وإذا أردنا أن نستعرض الحلقات المتسلسلة من المآسي الاجتماعية التي انبثقت عن هذا النظام المرتجل لا على أساس فلسفي مدروس؛ فسوف يضيق المجال المحدود لهذا البحث، ولذا نلمح اليها: فأول تلك الحلقات: تحّكم الأكثرية في الأقلية ومصالحها ومسائلها الحيوية. فإن الحرية السياسية كانت تعني أن وضع النظام والقوانين وتمشيتها من حق الأكثرية، ولنتصور أن الفئة التي تمثل الأكثرية في الأمة ملكت زمام الحكم والتشريع، وهي تحمل العقلية الديمقراطية الرأسمالية، وهي عقلية مادية خالصة في اتجاهها ونزعاتها وأهدافها وأهوائها فماذا يكون مصير الفئة الأخرى؟ أو ماذا ترتقب للأقلية من حياة في ظل قوانين تُشرَع لحساب الأكثرية ولحفظ مصالحها؟!، وهل يكون من الغريب حينئذ إذا شرّعت الأكثرية القوانين على ضوء مصالحها خاصة وأهملت مصالح الأقلية واتجهت إلى تحقيق رغباتها اتجاهـــــــًا مجحفًا بحقوق الآخرين؟! فمَن الذي يحفظ لهذه الأقلية كيانها الحيوي ويذب عن وجهها الظلم، ما دامت المصلحة الشخصية هي مسألة كل فرد وما دامت الأكثرية لا تعرف للقيم الروحية والمعنوية مفهومًا في عقليتها الاجتماعية؟ وبطبيعة الحال، أن التحكم سوف يبقى في ظل النظام كما كان في السابق وأن مظاهر الاستغلال والاستهتار بحقوق الآخرين ومصالحهم ستحفظ في الجو الاجتماعي لهذا النظام كحالها في الأجواء الاجتماعية القديمة. وغاية ما في الموضوع من فرق أن الاستهتار بالكرامة الإنسانية كان من قِبل أفراد، وأصبح في هذا النظام من الفئات التي تمثل الأكثريات بالنسبة إلى الأقليات، التي تشكل بمجموعها عددًا هائلًا من البشر.
وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل إن الأمـــــــر تفاقم واشتد حين أجازت الحرية الاقتصادية مختلف أساليب الثراء وألوانه مهما كان فاحشًا، ومهما كان شاذًا في طريقته وأسبابه. ففي الوقت الذي كان العالم يحتفل فيه بانقلاب صناعي كبير، والعلم يتمخض عن ولادة الآلة التي قلبت وجه الصناعة وكسحت الصناعات اليدوية ونحوها، فانكشف الميدان عن ثراء فاحش من جانب الأقلية من أفراد الأمة، ممن أتاحت لهم فرص وسائل الإنتاج الحديث وزودتهم الحريات الرأسمالية غير المحدودة بضمانات كافية لاستثمارها واستغلالها إلى أبعد حد، والقضاء بها على كثير من فئات الأمة التي اكتسحت الآلة البخارية صناعتها، وزعزعت حياتها، ولم تجد سبيلًا للصمود في وجه التيار، ما دام أرباب الصناعات الحديثة مسلحين بالحرية الاقتصادية وبحقوق الحريات المقدسة كلها، وهكذا خلا الميدان إلا من تلك الصفوة من أرباب الصناعة والإنتاج، وتضاءلت الفئة الوسطى واقتربت إلى المستوى العام المنخفض، وصارت هذه الأكثرية المحطمة تحت رحمة تلك الصفوة، التي لا تفكر ولا تحسب إلا على الطريقة الديمقراطية الرأسمالية. ومن الطبيعي حينئذ ألا تمد يد العطف والمعونة إلى هؤلاء لتنتشلهم من الهوة وتشركهم في مغانمها الضخمة. ولماذا تفعل ذلك مـــــــــا دام المقياس الخلقي هو المنفعة واللذة، وما دامت الدولة تضمن لها مطلق الحرية فيما تعمل، وما دام النظام الديمقراطي الرأسمالي يضيق بالفلسفة المعنوية للحياة ومفاهيمها الخاصة؟.
فالمسألة إذًا يجب أن تدرس بالطريقة التي يوحي بها هذا النظام، وهي أن يستغل هؤلاء الكبراء حاجة الأكثرية إليهم ومقوماتهم المعيشية، فيفرض على القادرين العمل في ميادينهم ومصانعهم، بأثمان لا تفي الا بالحياة الضرورية لهم. هذا هو منطق المنفعة الخالص الذي كان من الطبيعي أن يسلكوه. وتنقسم الأمة في ذلك إلى فئة في قمة الثراء، وأكثرية في المهوى السحيق. وهنا يتبلور الحق السياسي للأمة من جديد بشكل آخر. فالمساواة في الحقوق السياسية بين أفراد المواطنين، وإن لم تُمحَ من سجل النظام، غير أنها لم تعد الا خيالًا وتفكيرًا خالصًا. فان الحرية الاقتصادية حين تسجل ما عرضناه من نتائج تنتهي إلى هذا الانقسام الفظيع، وتكون هي المسيطرة على الموقف والماسكة بالزمام، وتقهر الحرية السياسية أمامها. فإن الفئة الرأسمالية بحكم مركزها الاقتصادي من المجتمع، وقدرتها على استعمال جميع وسائل الدعاية، وتمكُنها من شراء الأنصار والأعوان؛ تهيمن على تقاليد الحكم في الأمة، وتتسلم السلطة لتسخيرها في مصالحها والسهر على مآربها، ويصبح التشريع والنظام الاجتماعي خاضعًا لسيطرة رأس المال، بعد أن كــــــان المفروض في المفاهيم الديمقراطية أنه من حق الأمة جمعاء. وهكذا تعود الديمقراطية الرأسمالية في نهاية المطاف حكمًا تستأثر به الأقلية، وسلطانًا يحمي به عدة من الأفراد كيانهم على حساب الآخرين بالعقلية النفعية التي يستوحونها من الثقافة الديمقراطية الرأسمالية.
ونصل هنا إلى أفظع حلقات المأساة التي يمثلها هذا النظام، فــــإن هؤلاء السادة الذين وضع النظام الديمقراطي الرأسمالي في أيديهم كل نفوذ، وزودهم بكل قوة وطاقة؛ سوف يمدون أنظارهم – بوحـــي من عقلية هذا النظام – إلى الآفاق ويشعرون بوحي من مصالحهم وأغراضهم أنهم في حاجة إلى مناطق نفوذ جديدة وذلك لسببين:
الأول: أن وفرة الإنتاج تتوقف على مدى توفر المواد الأولية وكثرتها، فكل من يكون حظه من تلك المواد أعظم تكون طاقاتـــــــــه الإنتاجية أقوى وأكثر. وهذه المواد منتشرة في بلاد الله العريضة. وإذا كان من الواجب الحصول عليها، فاللازم السيطرة على البلاد التي تملك المواد لامتصاصها واستغلالها.
الثاني: أن شدة حركة الإنتاج وقوتها، بدافع من الحرص على كثرة الربح من ناحية، ومن ناحية أخرى انخفاض المستوى المعيشي لكثير من المواطنين بدافع من الشره المادي للفئة الرأسمالية، ومغالبتها للعامة على حقوقها بأساليبها النفعية التي تجعل المواطنين عاجزين عن شراء المنتجات واستهلاكها – كل ذلك يجعل كبار المنتجين في حاجة ماسة إلى أسواق جديدة لبيع المنتجات الفائضة فيها، وإيجاد تلك الأسواق يعني التفكير في بلاد جديدة.
وهكذا تدرس المسألة بذهنية مادية خالصة. ومن الطبيعي لمثل هذه الذهنية التي لم يرتكز نظامها على القيم الروحية والخلقية، ولم يعترف مذهبها الاجتماعي بغاية الا إسعاد هذه الحياة المحدودة بمختلف المتع والشهوات؛ أن ترى في هذين السببين مبررًا ومسوغًا منطقيًا للاعتداء على البلاد الآمنة، وانتهاك كرامتها والسيطرة على مقدراتها ومواردها الطبيعية الكبرى واستغلال ثرواتها لترويج البضائع الفائضة. فكل ذلك أمر معقول وجائز في عُرف المصالح الفردية التي يقوم على أساسها النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر. وينطلق من هنا عملاق المادة يغزو ويحارب، ويقيد ويكبل، ويستعمر ويستثمر، إرضاءً للشهوات وإشباعًا للرغبات.
فانظر ماذا قاست الإنسانية من ويلات هذا النظام، باعتباره ماديًا في روحه، وصياغته، وأساليبه، وأهدافه! وقدِر بنفسك نصيب المجتمع الذي يقوم على ركائز هذا النظام ومفاهيمه من السعادة والاستقرار، هذا المجتمع الذي ينعدم فيه الإيثار والثقة المتبادلة والتراحم والتعاطف الحقيقي، وجميع الاتجاهات الروحية الخيّرة، فيعيش الفرد فيه وهو يشعر بأنه المسؤول عن نفسه وحده، وأنه في خطر من قِبل كل مصلحة من مصالح الآخرين التي قد تصطدم به. فكأنه يحيا في صراع دائم ومغالبة مستمرة، لا سلاح له فيها الا قواه الخاصة، ولا هدف له منها الا مصالحه الخاصة.
ثانيًا – الاشتراكية والشيوعية
في الاشتراكية مذاهب متعددة، وأشهرها المذهب الاشتراكي القائم على النظرية الماركسية والمادية الجدلية، التي هي عبارة عن فلسفة خاصة للحياة وفهم مادي لها على طريقة ديالكتيكية. وقد طبق الماديون الديالكتيكيون هذه المادية الديالكتيكية على التاريخ والاجتماع والاقتصاد، فصارت عقيدة فلسفية في شأن العالم، وطريقة لدرس التاريخ والاجتماع، ومذهبًا في الاقتصاد وخطة في السياسة. وبعبارة أخرى: أنها تصوّغ الإنسان كله في قالب خاص، من حيث لون تفكيره ووجهة نظره إلى الحياة وطريقته العملية فيها. ولا ريب في أن الفلسفة المادية، وكذلك الطريقة الديالكتيكية، ليستا من بدع المذهب الماركسي وابتكاراته فقد كانت النزعة المادية تعيش منذ آلاف السنين في الميدان الفلسفي، سافرة تارة ومتوارية أخرى وراء السفسطة والإنكار المطلق، كما أن الطريقة الديالكتيكية في التفكير عميقة الجذور ببعض خطوطها فـــي التفكير الإنساني، وقد استكملت كل خطواتها على يــــــد (هيجل) الفيلسوف المثالي المعروف. وإنما جاء (كارل ماركس) إلى هذا المنطق وتلك الفلسفة فتبناهما، وحاول تطبيقهما على جميع ميادين الحياة، فقام بتحقيقين:
أحدهما: أن فسر التاريخ تفسيرًا ماديًا خالصًا بطريقة ديالكتيكية. والآخر: زعم فيه أنه اكتشف تناقضات رأس المال والقيمة الفائضة، التي يسرقها صاحب المال -في عقيدته- من العامل[4]. وأشاد على أساس هذين التحقيقين إيمانه بضرورة فناء المجتمع الرأسمالي، وإقامة المجتمع الشيوعي والمجتمع الاشتراكي، وقد اعتبر هذا الأخير خطوة الإنسانية إلى تطبيق الشيوعية تطبيقًا كاملًا.
فالميدان الاجتماعي في هذه الفلسفة ميدان صراع بين المتناقضات، وكل وضع اجتماعي يسود ذلك الميدان فهو ظاهرة مادية خالصة، منسجمة مع سائر الظواهر والأحوال المادية ومتأثرة بها، غير أنه في نفس الوقت يحمل نقيضه في صميمه، وينشب حينئذ الصراع بين النقائض، حتى تتجمع المتناقضات وتحدث تبدلًا في ذلك الوضع وانشاءً لوضع جديد، وهكذا يبقى العراك قائمًا حتى تكون الإنسانية كلها طبقة واحدة، وتتمثل مصالح كل فرد في مصالح تلك الطبقة الموحدة، فــــي تلك اللحظة يسود الوئام، ويتحقق السلام، وتزول نهائيًا جميع الآثار السيئة للنظام الديمقراطي الرأسمالي، لأنها إنما كانت تتولد من تعـــــــدد الطبقة في المجتمع، وهذا التعدد إنما نشأ من انقسام المجتمع إلى منتج وأجير. وإذًا فلا بد من وضع حد فاصل لهذا الانقسام، وذلك بإلغـــاء الملكية. وتختلف هنا الشيوعية عن الاشتراكية في بعض الخطوط الاقتصادية الرئيسية، وذلك لأن الاقتصاد الشيوعي يرتكز:
أولًا: على إلغاء الملكية الخاصة ومحوها محوًا تامًا من المجتمع، وتمليك الثروة كلها للمجموع وتسليمها إلى الدولة باعتبارها الوكيل الشرعي عن المجتمع في إدارتها واستثمارها لخير المجموع. واعتقــــــاد المذهب الشيوعي بضرورة هذا التأميم المطلق كان رد الفعـــــــل الطبيعي لمضاعفات الملكية الخاصة في النظام الديمقراطي الرأسمالي. وقد برر هذا التأميم بأن المقصود منه إلغاء الطبقة الرأسمالية وتوحيد الشعب في طبقة واحدة ليختم بذلك الصراع، ويسد على الفرد الطريق إلى استغلال شتى الوسائل والاساليب لتضخيم ثروته، إشباعًا لجشعه واندفاعًا بدافع الأثرة وراء المصلحة الشخصية.
ثانيًا: على توزيع السلع المنتَجة على حسب الحاجات الاستهلاكية للأفراد، ويتلخص في النص الآتي: “من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته”. وذلك أن كل فرد له حاجات طبيعية لا يمكنه الحياة بدون توفيرها، فهو يدفع للمجتمع كل جهده فيدفع له المجتمع متطلبات حياته ويقوم بمعيشته.
ثالثًا: على منهاج اقتصادي ترسمه الدولة، وتوفق فيه بين حاجة المجموع والإنتاج في كميته وتنويعه وتحديده، لئلا يعاني المجتمع بنفس الأدواء والازمات التي حصلت في المجتمع الرأسمالي حينما أطلق الحريات بغير تحديد.
الانحراف عن العملية الشيوعية:
ولكن أقطاب الشيوعية، الذين نادوا بهذا النظام، لم يستطيعوا أن يطبقوه بخطوطه كلها حين قبضوا على مقاليد الحكم، واعتقدوا أنه لا بد لتطبيقه من تطوير الإنسانية في أفكارها ودوافعها ونزعاتها، زاعمين أن الإنسان سوف يجيء عليه اليوم الذي تموت في نفسه الدوافع الشخصية والعقلية الفردية، وتحيا فيه العقلية والنوازع الجماعية، فلا يفكر إلا في المصلحة الاجتماعية ولا يندفع إلا في سبيلها.
ولأجل ذلك كان من الضروري – في عرف هذا المذهب الاجتماعي – إقامة نظام اشتراكي قبل ذلك، ليتخلص فيه الإنسان من طبيعته الحاضرة، ويكتسب الطبيعة المستعدة للنظام الشيوعي. وهذا النظام الاشتراكي أجريت فيه تعديلات مهمة على الجانب الاقتصادي من الشيوعية. فالخط الأول من خطوط الاقتصاد الشيوعي، وهو إلغاء الملكية الفردية، قد بُدل إلى حل وسط وهو تأميم الصناعات الثقيلة والتجارة الخارجية والتجارات الداخلية الكبيرة، ووضعها جميعًا تحت السيطرة الحكومية. وبكلمة أخرى، إلغاء رأس المال الكبير مع إطلاق الصناعات والتجارات البسيطة وتركها للأفراد، وذلك لأن الخط العريض في الاقتصاد الشيوعي اصطدم بواقع الطبيعة الإنسانية، حيث أخذ الأفراد يتقاعسون عن القيام بوظائفهم والنشاط في عملهم، ويتهربون من واجباتهم الاجتماعية، لأن المفروض تأمين النظام لمعيشتهم وسد حاجاتهم. فعلام إذن يجهد الفرد ويكدح ويجد، ما دامت النتيجة هي نفسها في حالي الخمول والنشاط؟، ولماذا يندفع إلى توفير السعادة لغيره وشراء راحة الآخرين بعرقه ودموعه وعصارة حياته وطاقاته، ما دام لا يؤمن بقيمة من قيم الحياة إلا القيمة المادية الخالصة؟ فاضطر زعماء هذا المذهب إلى تجميد التأميم المطلق.
كما اضطروا ايضًا إلى تعديل الخط الثاني من خطوط الاقتصاد الشيوعي، وذلك بجعل هناك فوارق بين الأجور لدفع العمال إلى النشاط والتكامل في العمل، معتذرين بأنها فوارق مؤقتة سوف تزول حينما يُقضى على العقلية الرأسمالية، وينشأ الإنسان انشاءً جديدًا. وهم لأجل ذلك يجرون التغييرات المستمرة على طرائقهم الاقتصادية وأساليبهم الاشتراكية لتدارك فشل كل طريقة بطريقة جديدة. ولم يوفقوا حتى الآن للتخلص من جميع الركائز الأساسية في الاقتصاد الرأسمالي. فلم تُلغَ مثلًا القروض الربوية نهائيًا، مع أنها في الواقع أساس الفساد الاجتماعي في الاقتصاد الرأسمالي.
ولا يعني هذا كله أن أولئك الزعماء مقصرون، أو أنهم غير جادين في مذهبهم وغير مخلصين لعقيدتهم؛ وإنما يعني أنهم اصطدموا بالواقع حين أرادوا التطبيق، فوجدوا الطريق مليئًا بالمتناقضات، التي تضعها الطبيعة الإنسانية أمام الطريقة الانقلابية للإصلاح الاجتماعي الذي كانوا يبشرون به، ففرض عليهم الواقع التراجع آملين أن تتحقق المعجزة في وقت قريب أو بعيد.
وأما من الناحية السياسية، فالشيوعية تستهدف في نهاية شوطها الطويل إلى محو الدولة من المجتمع، حين تتحقق المعجزة وتعم العقلية الجماعية كل البشر، فلا يفكر الجميع إلا في المصلحة المادية للمجموع، وأما قبل ذلك، ما دامت المعجزة غير محققة، وما دام البشر غير موحدين في طبقة، والمجتمع ينقسم إلى قوى رأسمالية وعمالية؛ فاللازم أن يكون الحكم عماليًا خالصًا، فهو حكم ديمقراطي في حدود دائرة العمال، ودكتاتوري بالنسبة إلى العموم. وقد عللوا ذلك بأن الدكتاتورية العمالية في الحكم ضرورية في كل المراحل التي تطويها الإنسانية بالعقلية الفردية، وذلك حماية لمصالح الطبقة العاملة، وخنقًا لأنفاس الرأسمالية، ومنعًا لها عن البروز إلى الميدان من جديد.
والواقع أن هذا المذهب، الذي يتمثل في الاشتراكية الماركسية، ثم في الشيوعية الماركسية يمتاز على النظام الديمقراطي الرأسمالي بأنه يرتكز على فلسفة مادية معينة، تتبنى فهمًا خاصًا للحياة، لا يعترف لها بجميع المثل والقيم المعنوية، ويعللها تعليلًا لا موضع فيه لخالق فــــــوق حدود الطبيعة، ولا لجزاء مرتقب وراء حدود الحياة المادية المحدودة.
وهذا على عكس الديمقراطية الرأسمالية، فإنها وإن كانت نظامًا ماديًا، ولكنها لم تبن على أساس فلسفي محدد، فالربط الصحيح بين المسألـــــة الواقعية للحياة والمسألة الاجتماعية، آمنت به الشيوعية المادية، ولم تؤمن به الديمقراطية الرأسمالية، أو لم تحاول ايضاحه.
وبهذا كان المذهب الشيوعي حقيقًا بالدرس الفلسفي، وامتحانه عن طریق اختبار الفلسفة التي ركز عليها وانبثق عنها، فان الحكم على كل نظام يتوقف على مدى نجاح مفاهيمه الفلسفية في تصوير الحياة وإدراكها.
ومن السهل أن ندرك في أول نظرة تلقيها على النظام الشيوعي المخفف أو الكامل، أن طابعه العام هو إفناء الفرد في المجتمع، وجعله آلة مسخرة لتحقيق الموازين العامة التي يفترضها. فهو على النقيض تمامًا من النظام الرأسمالي الحر الذي يجعل المجتمع للفرد ويسخره لمصالحه، فكأنه قد قُدر للشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية – في عرف هذين النظامين- أن تتصادما وتتصارعا. فكانت الشخصية الفردية هي الفائزة في أحد النظامين الذي أقام تشريعه على أساس الفرد ومنافعه الذاتية، فمُنِي المجتمع بالمآسي الاقتصادية التي تزعزع كيانه وتشوه الحياة. وكانت الشخصية الاجتماعية هي الفائزة في النظام الآخر الذي جاء يتدارك أخطاء النظام السابق، فساند المجتمع وحكم على الشخصية الفردية بالاضمحلال والفناء فأصيب الأفراد بمِحن قاسية قضت على حريتهم ووجودهم الخاص، وحقوقهم الطبيعية في الاختيار والتفكير.
المؤاخذات على الشيوعية
والواقع أن النظام الشيوعي وإن عالج جملة من أدواء الرأسمالية الحرة بمحوه للملكية الفردية، غير أن هذا العلاج له مضاعفات طبيعية تجعل ثمن العلاج باهظًا وطريقة تنفيذه شاقة على النفس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هو علاج ناقص لا يضمن القضاء على الفساد الاجتماعي كله، لأنه لم يحالفه الصواب في تشخيص الداء وتعيين النقطة التي انطلق منها الشر حتى اكتسح العالم في ظل الأنظمة الرأسمالية، فبقيت تلك النقطة محافظة على موضعها من الحياة الاجتماعية في المذهب الشيوعي. وبهذا لم تظفر الإنسانية بالحل الحاسم لمشكلتها الكبرى، ولم تحصل على الدواء الذي يطيب أدواءها ويستأصل أعراضها الخبيثة.
أما مضاعفات هذا العلاج فهي جسيمة جدًا: فإن من شأنه القضاء على حريات الأفراد لإقامة الملكية الشيوعية مقام الملكيات الخاصة، وذلك لأن هذا التحويل الاجتماعي الهائل على خلاف الطبيعة الإنسانية العامة، باعتبار أن الإنسان لا يزال يفكر تفكيرًا ذاتيًا، ويحسب مصالحه من منظاره الفردي المحدود. ووضْع تصميم جديد للمجتمع يذوب فيه الأفراد نهائيًا، ويقضي على الدوافع الذاتية قضاءً تامًا، يتطلب قوة حازمة تمسك زمام المجتمع بيد حديدية، وتحبس كل صوت يعلو فيه، وتحتكر جميع وسائل الدعاية والنشر، وتضرب على الأمة نطاقًا لا يجوز أن تتعداه بحال، لئلا يفلت الزمام من يدها فجأة. وهذا أمر طبيعي في كل نظام يُراد فرضه على الأمة قبل أن تنضج فيها عقلية ذلك النظام وتعم روحيته.
نعم لو أخذ الإنسان المادي يفكر تفكيرًا اجتماعيًا، ويعقل مصالحه بعقلية جماعية، وذابت من نفسه جميع العواطف الخاصة والأهواء الذاتية والانبعاثات النفسية، لأمكن أن يقوم نظام يذوب فيه الأفراد، ولا يبقى في الميدان إلا العملاق الاجتماعي الكبير. ولكن تحقيق ذلك في الإنسان المادي، الذي لا يؤمن الا بحياة محدودة ولا يعرف معنى لها إلا اللذة المادية يحتاج إلى معجزة تخلق الجنة في الدنيا، وتنزل بها من السماء إلى الأرض. والشيوعيون يعِدوننا بهذه الجنة، وينتظرون ذلك اليوم الذي يقضي فيه المعمل على طبيعة الإنسان ويخلقه من جديد، انسانًا مثاليًا في أفكاره وأعماله، وإن لم يكن يؤمن بالقيم المثالية والأخلاقية. فوضع التصميم الاجتماعي الذي يرومونه يستدعي حبس الأفراد في حدود فكرة هذا التصميم، وتأمين تنفيذه بقيام الفئة المؤمنة به على حمايته، والاحتياط له بكبت الطبيعة الإنسانية والعواطف النفسية، ومنعها من الانطلاق بكل أسلوب من الأساليب. والفرد في ظل هذا النظام، وإن كسب تأمينًا كاملًا وضمانًا اجتماعيًا لحياته وحاجاته، لأن الثروة الجماعية تمده بكل ذلك في وقت الحاجة، ولكن أليس من الأفضل أن يظفر الفرد بهذا التأمين دون أن يخسر حريته؟ وكيف يمكن أن يعيش إنسان حُرم من الحرية في معيشته وربطت حياته الغذائية ربطًا كاملًا بهيئة معينة.
ويعتذر عن ذلك المعتذرون فيتساءلون: ماذا يصنع الإنسان بالحرية والاستمتاع بحق النقد والإعلان عن آرائه، وهو يرزح تحت عبء اجتماعي فظيع؟ وماذا يجديه أن يناقش ويعترض وهو أحوج إلى التغذية الصحيحة؟
وهؤلاء المتسائلون لم يكونوا ينظرون إلا إلى الديمقراطية الرأسمالية، كأنها القضية الاجتماعية الوحيدة التي تنافس قضيتهم في الميدان، فانتقصوا من قيمة الكرامة الفردية وحقوقها، لأنهم رأوا فيها خطرًا على التيار الاجتماعي العام. ولكن من حق الإنسانية ألا تضحي بشيء من مقوماتها وحقوقها ما دامت غير مضطرة إلى ذلك، وأنها إنما وقفت موقف التخيير بين كرامة هي من الحق المعنوي للإنسانية، وبين حاجة هي من الحق المادي لها إذا أعوزها النظام الذي يجمع بين الناحيتين ويوفق إلى حل المشكلتين.
إن انسانًا يعتصر الآخرون طاقاته، ولا يطمئن إلى حياة طيبة وأجر عادل وتأمين في أوقات الحاجة، لهو إنسان قد حرم من التمتع بالحياة، وحيل بينه وبين الحياة الهادئة المستقرة. كما أن انسانًا يعيش مهددًا في كل لحظة، محاسَبًا على كل حركة، لهو إنسان مرعوب، يسلبه الخوف حلاوة العيش وينغص الرعب ملاذ الحياة
والانسان الثالث المطمئن إلى معيشته، الواثق بكرامته وسلامته، هو حلم الإنسانية العذب. فكيف يتحقق هذا الحلم؟ ومتى يصبح حقيقة واقعة؟
وقد قلنا إن العلاج الشيوعي للمشكلة الاجتماعية ناقص. فهو وإن كان تتمثل فيه عواطف ومشاعر انسانية أثارها الطغيان الاجتماعي العام، فأهاب بجملة من المفكرين إلى الحل الجديد، غير أنهم لم يضعوا أيديهم على سبب الفساد ليقضوا عليه، فلم يوفقوا في العلاج ولم ينجحوا في التطبيب.
ان مبدأ الملكية الخاصة ليس هو الذي نشأت عنه آثام الرأسمالية المطلقة، التي زعزعت سعادة العالم وهناءه، فلا هو الذي يفرض تعطيل الملايين من العمال في سبيل استثمار آلة جديدة تقضي على صناعاتهم، كما حدث في فجر الانقلاب الصناعي، ولا هو الذي يفرض التحكم في أجر الأجير وجهوده بلا حساب، ولا هو الذي يفرض على الرأسمالي أن يتلـف كميات كبيرة من منتجاته حفظًا على ثمن السلعة وتفضيلا للتبذير عـلى توفير حاجات الفقراء بها، ولا هو الذي يدعوه إلى جعل ثروته رأس مال يضاعفه بالربا، وامتصاص جهود المدينين بلا إنتاج ولا عمل، ولا هو الذي يدفعه إلى شراء جميع البضائع الاستهلاكية من الأسواق ليحتكرها ويرفع بذلك من أثمانها، ولا هو الذي يفرض عليه فتح أسواق جديدة وإن انتُهكت بذلك حريات الأمم وحقوقها وضاعت كرامتها وحريتها.
كل هذه المآسي المروعة لم تنشأ من الملكية الخاصة، وإنما هي وليدة المصلحة المادية الشخصية التي جُعلت مقياسًا للحياة في النظام الرأسمالي، والمبرر المطلق لجميع التصرفات والمعاملات. فالمجتمع حين تُقام أسسه على هذا المقياس الفردي والمبرر الذاتي لا يمكن أن يُنتظر منه غير ما وقع، فإن من طبيعة هذا المقياس تنبثق تلك اللعنات والويلات على الإنسانية كلها، لا من مبدأ الملكية الخاصة. فلو أُبدل المقياس ووُضعت للحياة غاية جديدة تنسجم مع طبيعة الإنسان لتَحقق بذلك العلاج الحقيقي للمشكلة الإنسانية الكبر.
التعليل الصحيح للمشكلة
ولأجل أن نصل إلى تعليل المشكلة الاجتماعية علينا أن نتساءل عن تلك المصلحة المادية الخاصة التي أقامها النظام الرأسمالي مقياسًا ومبررًا وهدفًا وغاية، فإن تلك الفكرة هي الأساس الحقيقي للبلاء الاجتماعي، وهي تتلخص في التفسير المادي المحدود للحياة، الذي أشاد عليه الغرب صرح الرأسمالية الجبار. فإن كل فرد في المجتمع إذا آمن بأن ميدانه الوحيد في هذا الوجود العظيم هو حياته المادية الخاصة، وآمن أيضًا بحريته في التصرف بهذه الحياة واستثمارها، وأنه لا يمكن أن يكسب من هذه الحياة غاية الا اللذة التي توفرها له المادة، وأضاف هذه العقائد المادية إلى حب الذات، الذي هو من صميم طبيعته، فسوف يسلك السبيل الذي سلكه الرأسماليون وينفذ أساليبهم كاملة، ما لم تحرمه قوة قاهرة من حريته وتسد عليه السبيل.
وحب الذات هو الغريزة التي لا نعرف غريزة أهم منها وأقدم، فكل الغرائز فروع عن هذه الغريزة. فإن حب الإنسان ذاته الذي يعني حبه للذة والسعادة لنفسه، وبغضه للألم والشقاء لذاته، هو الذي يدفع الإنسان إلى كسب معيشته، وتوفير حاجياته الغذائية والمادية. فالواقع الطبيعي الحقيقي إذن الذي يكمن وراء الحياة الإنسانية كلها ويوجهها بأصابعه هو حب الذات الذي نعبر عنه بحب اللذة وبغض الألم. ولا يمكن تكليف الإنسان أن يتحمل مختارًا مرارة الألم دون شيء من اللذة في سبيل أن يلتذ الآخرون ويتنعموا، إلا إذا سُلبت منه إنسانيته وأُعطي طبيعة جديدة لا تعشق اللذة ولا تكره الألم.
وحتى الألوان الرائعة من الإيثار التي نشاهدها في الإنسان ونسمع بها عن تاريخه تخضع في الحقيقة أيضًا لتلك القوة المحركة الرئيسية: غريزة حب الذات. فالإنسان قد يؤثر ولده أو صديقه على نفسه، وقد يضحي في سبيل بعض المثل والقيم، ولكنه لن يقدم على شيء من هذه البطولات ما لم يحس فيها بلذة خاصة، ومنفعة تفوق الخسارة التي تنجم عن إيثاره لولده وصديقه، أو تضحيته في سبيل مثل من المثل التي يؤمن بها.
وهكذا ففي الإنسان استعدادات كثيرة للالتذاذ بأشياء متنوعة: مادية، كالالتذاذ بالطعام والشراب وألوان المتعة الجنسية وما إليها من اللذائذ المادية. أو معنوية، كالالتذاذ الخلقي والعاطفي بقيم خلقية او أليف روحي أو عقيدة معينة، حين يجد الإنسان أن تلك القيم أو ذلك الأليف أو هذه العقيدة جزء من كيانه الخاص. وهـــــــذه الاستعدادات التي تهيئ الإنسان للالتذاذ بتلك المتع المتنوعة تختلف في درجاتها عند الأشخاص، وتتفاوت في مدى فعاليتها باختلاف ظروف الإنسان وعوامل الطبيعة والتربية التي تؤثر فيه. فمتى أردنا أن نغير من سلوك الإنسان شيئًا، يجب أن نغير من مفهوم اللذة والمنفعة عنده، ونُدخل السلوك المقترح ضمن الإطار العام لغريزة حب الذات.
فاذا كانت غريزة حب الذات بهذه المكانة من دنيا الإنسان، وكانت الذات في نظر الإنسان عبارة عن طاقة مادية محدودة، وكانت اللذة عبارة عما تهيئه المادة من مُتَع، فمن الطبيعي أن يشعر الإنسان بأن مجال كسبه محدود، وأن شوطه قصير وأن غايته في هذا الشوط أن يحصل على مقدار من اللذة المادية. وطريق ذلك ينحصر بطبيعة الحال في عصب الحياة المادية وهو المال، الذي يفتح أمام الإنسان السبيل إلى تحقيق كل أغراضه وشهواته.
هذا هو التسلسل الطبيعي في المفاهيم المادية، الذي يؤدي إلى عقلية رأسمالية كاملة.
إذًا هل ترى أن المشكلة تحل حلًا حاسمًا إذا رفضنا مبدأ الملكية الخاصة، وأبقينا تلك المفاهيم المادية عن الحياة كما حاول اولئك المفكرون؟ وهل يمكن أن ينجو المجتمع من مأساة تلك المفاهيم بالقضاء على الملكية الخاصة فقط ويحصل على ضمان لسعادته واستقراره؟، مع أن ضمان سعادته واستقراره يتوقف إلى حد بعيد على ضمان عدم انحراف المسؤولين عن مناهجهم وأهدافهم الإصلاحية في ميدان العمل والتنفيذ. والمفروض في هؤلاء المسؤولين أنهم يعتنقون نفس المفاهيم المادية الخالصة عن الحياة التي قامت عليها الرأسمالية، وإنما الفرق أن هذه المفاهيم أفرغوها في قوالب فلسفية جديدة.
إن الثروة تسيطر عليها الفئة الرأسمالية في ظل الاقتصاد المطلق والحريات الفردية، وتتصرف فيها بعقليتها المادية، تُسلّم عند تأميم الدولة لجميع الثروات والغاء الملكية الخاصة إلى نفس جهاز الدولة المكوّن من جماعة تسيطر عليهم نفس المفاهيم المادية عن الحياة، والتي تفرض عليهم تقديم المصالح الشخصية بحكم غريزة حب الذات، وهي تأبى أن يتنازل الإنسان عن لذة ومصلحة بلا عوض. وما دامت المصلحة المادية هي القوة المسيطرة، بحكم مفاهيم الحياة المادية، فسوف تُستأنف من جديد ميادين للصراع والتنافس، وسوف يتعرض المجتمع لأشكال من الخطر والاستغلال.
فالخطر على الإنسانية يكمن كله في تلك المفاهيم المادية، وما ينبثق عنها من مقاييس للأهداف والأعمال. وتوحيد الثروات الرأسمالية الصغيرة او الكبيرة في ثروة كبرى يسلم أمرها للدولة من دون تطوير جديد للذهنية الإنسانية لا يدفع ذلك الخطر، بل يجعل من الأمــــــة جميعًا عمال شركة واحدة، ويربط حياتهم وكرامتهم بأقطاب تلك الشركة وأصحابها.
نعم إن هذه الشركة تختلف عن الشركة الرأسمالية في أن اصحاب تلك الشركة الرأسمالية هم الذين يملكون أرباحها، ويصرفونهــــــا في أهوائهم الخاصة، وأما اصحاب هذه الشركة فهم لا يملكون شيئًا من ذلك، من حيث المبدأ، غير أن ميادين المصلحة الشخصية لا تزال مفتوحة، والفهم المادي للحياة – الذي يجعل من تلك المصلحة هدفًا ومبررًا- لا يزال قائمًا.
كيف تعالج المشكلة
العالم أمامه سبيلان إلى دفع الخطر وإقامة دعائم المجتمع المستقر:
أحدهما: أن يُبدَل الإنسان غير الإنسان، أو تُخلق فيه طبيعة جديدة تجعله يضحي بمصالحه الخاصة ومكاسب حياته المادية المحدودة في سبيل المجتمع ومصالحه، مع إيمانه بأنه لا قِيَم إلا قِيم تلك المصالح المادية ولا مكاسب إلا مكاسب هذه الحياة المحدودة. وهذا إنما يتم إذا انتزع من صميم طبيعته حب الذات، وأبدله بحب الجماعة، فيولد الإنسان وهو لا يحب ذاته، إلا باعتبار كونه جزءًا من المجتمع، ولا يلتذ لسعادتــــــه ومصالحه إلا بما أنها تمثل جانبًا من السعادة العامة ومصلحة المجموع. فإن غريزة حب الجماعة تكون ضامنة حينئذ للسعي وراء مصالحها وتحقيق متطلباتها بطريقة ميكانيكية وأسلوب آلي.
والسبيل الآخر، الذي يمكن للعالم سلوكه لدرء الخطر عن حاضر الإنسانية ومستقبلها هو أن يطور المفهوم المادي للإنسان عن الحياة، وبتطويره تتطور طبيعيًا أهدافها ومقاييسها، وتتحقق المعجزة حينئذ من أيسر طريق.
والسبيل الأول هو الذي يحلم أقطاب الشيوعيين بتحقيقه للإنسانية في مستقبلها، ويعِدون العالم بأنهم سوف ينشئونها إنشاءً جديــــــدًا يجعلها تتحرك ميكانيكيًا إلى خدمة الجماعة ومصالحها. ولأجل أن يتم هذا العمل الجبار، يجب أن نوكل قيادة العالم إليهم، كما يوكل أمـــــــر المريض إلى الجراح، ويفوض اليه تطبيبه وقطع الأجزاء الفاسدة منه وتعديل المعوج منها. ولا يعلم أحد كم تطول هذه العملية الجراحية التي تجعل الإنسانية تحت مبضع جراح. وإن استسلام الإنسانية لذلك لهو أكبر دليل على مدى الظلم الذي قاسته في النظام الديمقراطي الرأسمالي، الذي خدعها بالحريات المزعومة، وسلب منها اخيرًا كرامتها، وامتص دماءها، ليقدمها شرابًا سائغًا للفئة التي يمثلها الحاكمون.
والفكرة في هذا الرأي القائل بمعالجة المشكلة عن طريق تطوير الإنسانية وإنشائها من جديد ترتكز على مفهوم الماركسية عن حب الذات. فإن الماركسية تعتقد أن حب الذات ليس ميلًا طبيعيًا وظاهرة غريزية في كيان الإنسان، وإنما هو نتيجة للوضع الاجتماعي القائم على أساس الملكية الفردية، فالحالة الاجتماعية للملكية الخاصة هي التي تكوّن المحتوى الروحي والداخلي للإنسان، وتخلق في الفرد حبه لمصالحه الخاصة ومنافعه الفردية. فاذا حدثت ثورة في الأسس التي يقوم عليها الكيان الاجتماعي، وحلت الملكية الجماعية والاشتراكية محل الملكية الخاصة، فسوف تنعكس الثورة في كل أرجاء المجتمع وفي المحتوى الداخلي للإنسان، فتنقلب مشاعره الفردية إلى مشاعر جماعية، ويتحول حبه لمصالحه ومنافعه الخاصة إلى حب لمنافع الجماعة ومصالحها وفقًا لقانون التوافق بين حالة الملكية الأساسية ومجموع الظواهر الفوقية التي تتكيف بموجبها.
والواقع أن هذا المفهوم الماركسي لحب الذات يقدِّر العلاقة بين الواقع الذاتي (غريزة حب الذات)، وبين الأوضاع الاجتماعية بشكل مقلوب، وإلا فكيف نستطيع أن نؤمن بأن الدافع الذاتي وليد الملكية الخاصة والتناقضات الطبقية التي تنجم عنها؟ فإن الإنسان لو لم يكن يملك سلفًا الدافع الذاتي لما أوجد هذه التناقضات، ولا فكر في الملكية الخاصة والاستئثار الفردي. ولماذا يستأثر الإنسان بمكاسب النظام ويضعه بالشكل الذي يحفظ مصالحه على حساب الآخرين، ما دام لا يحس بالدافع الذاتي في أعماق نفسه؟ فالحقيقة أن المظاهر الاجتماعية للأنانية في الحقل الاقتصادي والسياسي لم تكن إلا نتيجة للدافع الذاتي لغريزة حب الذات. فهذا الدافع أعمق منها في كيان الإنسان، فلا يمكن أن يزول وتُقتلع جذوره بإزالة تلك الآثار، فإن عملية كهذه لا تعدو أن تكون استبدالًا لآثار بأخرى قد تختلف في الشكل والصورة، لكنها تتفق معها في الجوهر والحقيقة.
أضف إلى ذلك أننا لو فسرنا الدافع الذاتي (غريزة حــــــب الذات) تفسيرًا موضوعيًا، – بوصفه انعكاسًا لظواهر الفردية في النظام الاجتماعي، كظاهرة الملكية الخاصة- كما صنعت الماركسية، فلا يعني هذا أن الدافع الذاتي سوف يفقد رصيده الموضوعي وسببه من النظام الاجتماعي بإزالة الملكية الخاصة، لأنها وإن كانت ظاهرة ذات طابع فردي، ولكنها ليست هي الوحيدة من نوعها، فهناك -مثلًا- ظاهرة الإدارة الخاصة التي يحتفظ بها حتى النظام الاشتراكي. فإن النظام الاشتراكي وإن كان يلغي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، غير أنه لا يلغي إدارتها الخاصة من قِبل هيئات الجهاز الحاكم، الذي يمارس دكتاتورية البروليتاريا ويحتكر الإشراف على جميع وسائل الإنتاج وإدارتها. إذ ليس من المعقول أن تدار وسائل الإنتاج في لحظة تأميمها إدارة جماعية اشتراكية من قبل أفراد المجتمع كافة. فالنظام الاشتراكي يحتفظ إذن بظواهر فردية بارزة، ومن الطبيعي لهذه الظواهر الفردية أن تحافظ على الدافع الذاتي وتعكسه في المحتوى الداخلي للإنسان باستمرار، كما كانت تصنع ظاهرة الملكية الخاصة.
وهكذا نعرف قيمة السبيل الأول لحل المشكلة: السبيل الشيوعي الذي يعتبر إلغاء تشريع الملكية الخاصة ومحوها من سجل القانون كفيلًا وحده بحل المشكلة وتطوير الإنسان.
وأما السبيل الثاني فهو الذي سلكه الإسلام، إيمانًا منه بأن الحل الوحيد للمشكلة هو تطوير المفهوم المادي للإنسان عن الحياة. فلم يتوجه إلى مبدأ الملكية الخاصة ليبطله، وإنما غزا المفهوم المادي عن الحياة ووضع للحياة مفهومًا جديدًا، وأقام على أساس ذلك المفهوم نظامًا لم يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكية في الجهاز الاجتماعي، ولا المجتمع هيئة قائمة لحساب الفرد، بل وضع لكل منهما حقوقه، وكفل للفرد كرامته المعنوية والمادية معًا. فالإسلام وضع يده على نقطة الداء الحقيقية في النظام الاجتماعي للديمقراطية، وما اليه من أنظمة، فمحاها محوًا ينسجم مع الطبيعة الإنسانية. فغن نقطة الارتكاز الأساسية لما ضجت به الحياة البشرية من أنواع الشقاء وألوان المآسي هي النظرة المادية إلى الحياة التي نختصرها بعبارة مقتضبة في افتراض حياة الإنسان في الدنيا هي كل ما في الحساب من شيء، وإقامة المصلحة الشخصية مقياسًا لكل فعالية ونشاط.
إن الديمقراطية الرأسمالية نظام محكوم عليه بالانهيار والفشل المحقق في نظر الإسلام، ولكن لا باعتبار ما يزعمه الاقتصاد الشيوعي من تناقضات رأس المال بطبيعته، وعوامل الفناء التي تحملها الملكية الخاصة في ذاتها، لأن الإسلام يختلف في طريقته المنطقية، واقتصاده السياسي، وفلسفته الاجتماعية عن مفاهيم هذا الزعم وطريقته الجدلية، ويضمن وضع الملكية الفردية في تصميم اجتماعي خالٍ من تلك التناقضات المزعومة.
بل إن مرد الفشل الذي مُنيت به الديمقراطية الرأسمالية في عقيدة الإسلام يعود إلى مفاهيمها المادية الخالصة، التي لا يمكن أن يسعد البشر بنظام يستوحي جوهره منها، ويستمد خطوطه العامة من روحها.
فلا بد اذن من معين آخر -غير المفاهيم المادية عن الكون- ليُستقي منه النظام الاجتماعي، ولا بد من وعي سياسي صحيح ينبثق عن مفاهيم حقيقية للحياة، ويتبنى القضية الإنسانية الكبرى، ويسعى إلى تحقيقها على قاعدة تلك المفاهيم، ويدرس مسائل العالم من هذه الزاوية. وعند اكتمال هذا الوعي السياسي في العالم واكتساحه لكل وعي سياسي آخر، وغزوه لكل مفهوم للحياة لا يندمج بقاعدته الرئيسية، يمكن أن يدخل العالم في حياة جديدة، مشرقة بالنور عامرة بالسعادة.
ان هذا الوعي السياسي العميق هو رسالة السلام الحقيقي في العالم، وإن هذه الرسالة المنقذة لهي رسالة الإسلام الخالدة التي استمدت نظامها الاجتماعي، المختلف عن كل ما عرضناه من أنظمة، من قاعدة فكرية جديدة للحياة والكون.
وقد أوجد الإسلام بتلك القاعدة الفكرية النظرة الصحيحة للإنسان إلى حياته، فجعله يؤمن بأن حياته منبثقة عن مبدأ مطلق الكمال، وأنها إعداد للإنسان إلى عالم لا عناء فيه ولا شقاء، ونصب له مقياسًا خلقيًا جديدًا في كل خطواته وأدواره، وهو رضا الله تعالى. فليس كل ما تفرضه المصلحة الشخصية فهو جائز، وكل ما يؤدي إلى خسارة شخصية فهو محرم وغير مستساغ، بل الهدف الذي رسمه الإسلام للإنسان في حياته هو الرضا الالهي، والمقياس الخلقي الذي توزن به جميع الأعمال إنما هو مقدار ما يُحصّل بها من هذا الهدف المقدس، والإنسان المستقيم هو الإنسان الذي يحقق هذا الهدف، والشخصية الإسلامية الكاملة هي الشخصية التي سارت في شتى أشواطها على هدي هذا الهدف، وضوء هذا المقياس، وضمن إطاره العام.
وليس هذا التحويل في مفاهيم الإنسان الخلقية وموازينه وأغراضه يعني تغيير الطبيعة الانسانية وإنشائها إنشاءً جديدًا، كما كانت تعني الفكرة الشيوعية. فحب الذات -أي حب الإنسان لذاته وتحقيـــــق مشتهياتها الخاصة- طبيعي في الإنسان، ولا نعرف استقراءً في ميدان تجريبي أوضح من استقراء الإنسانية في تاريخها الطويل، الذي يبرهن على ذاتية حب الذات. بل لو لم يكن حب الذات طبيعيًا وذاتيًا للإنسان لما اندفع الإنسان الأول – قبل كل تكوينة اجتماعية- إلى تحقيق حاجاته ودفع الأخطار عن ذاته، والسعي وراء مشتهياته بالأساليب البدائية التي حفظ بها حياته وأبقى وجوده؛ وبالتالي خوض الحيـــــــــاة الاجتماعية والاندماج في علاقات مع الآخرين تحقيقًا لتلك الحاجات ودفعًا لتلك الأخطار. ولمّا كان حب الذات يحتل هذا الموضع من طبيعة الإنسان فأي علاج حاسم للمشكلة الإنسانية الكبرى يجب أن يقوم على أساس الإيمان بهذه الحقيقة. وإذا قام على فكرة تطويرها أو التغلب عليها فهو علاج مثالي لا مكان له في واقع الحياة العملية التي يعيشها الإنسان.
رسالة الدين
ويقوم الدين هنا برسالته الكبرى التي لا يمكن أن يضطلع بأعبائها غيره، ولا أن تُحقق أهدافها البناءة وأغراضها الرشيدة إلا على أسسه وقواعده، فيربط بين المقياس الخلقي الذي يضعه للإنسان وحب الذات المتمركز في فطرته.
وفي تعبير آخر، إن الدين يوحد بين المقياس الفطري للعمل والحياة، وهو حب الذات، والمقياس الذي ينبغي أن يُقام للعمل والحياة، ليضمن السعادة والرفاه والعدالة.
فكيف يتم التوفيق بين المقياسين وتوحيد الميزانين؟ إن التوفيق والتوحيد يحصل بعملية يضمنها الدين للبشرية التائهة، وتتخذ العملية أسلوبين:
الأسلوب الأول: هو تركيز التفسير الواقعي للحياة، وإشاعة فهمها في لونها الصحيح كمقدمة تمهيدية إلى حياة أخروية، يكسب الإنسان فيها من السعادة على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه، في سبيل تحصيل رضا الله. فالمقياس الخلقي – أو رضا الله تعالى- يضمن المصلحة الشخصية، في نفس الوقت الذي يحقق فيه أهدافه الاجتماعية الكبرى. فالدين يأخذ بيد الإنسان إلى المشاركة في إقامة المجتمع السعيد والمحافظة على قضايا العدالة فيه، التي تحقق رضا الله تعالى، لأن ذلك يدخل في حساب ربحه الشخصي، ما دام كل عمل ونشاط في هذا الميدان يعوّض عنه بأعظم العوض وأجّله.
فمسألة المجتمع هي مسألة الفرد أيضًا في مفاهيم الدين عن الحياة وتفسيرها. ولا يمكن أن يحصل هذا الأسلوب من التوفيق في ظل فهم مادي للحياة، فإن الفهم المادي للحياة يجعل الإنسان بطبيعته لا ينظر إلا إلى ميدانه الحاضر وحياته المحدودة، على عكس التفسير الواقعي للحياة الذي يقدمه الإسلام، فإنه يوسع من ميدان الإنسان، ويفرض عليـــــــه نظرة أعمق إلى مصالحه ومنافعه، ويجعل من الخسارة العاجلة ربحـًا حقيقيًا في هذه النظرة العميقة، ومن الأرباح العاجلة خسارة حقيقية في نهاية المطاف:
{مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} (فصلت 46).
{مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} (غافر 40).
{يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (الزلزلة 6: 8).
{… ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (التوبة 120- 121).
هذه بعض الصور الرائعة التي يقدمها الدين مثالًا على الأسلوب الأول، الذي يتبعه للتوفيق بين المقياسين وتوحيد الميزانين فيربط بين الدوافع الذاتية من ناحية وسبل الخير في الحياة من ناحية أخرى، ويطور من مصلحة الفرد تطويرًا يجعله يؤمن بأن مصالحه الخاصة والمصالح الحقيقية العامة للإنسانية – التي يحددها الإسلام- مترابطتان[5].
وأما الأسلوب الثاني الذي يتخذه الدين للتوفيق بين الدافع الذاتي والقيم أو المصالح الاجتماعية، فهو التعهد بتربية أخلاقية خاصة، تُعنى بتغذية الإنسان روحيًا، وتنمية العواطف الإنسانية والمشاعر الخلقية فيه، فإن في طبيعة الإنسان – كما ألمحنا سابقًا- طاقات واستعدادات لميول متنوعة، بعضها ميول مادية تتفتح شهواتها بصورة طبيعية كشهوات الطعام والشراب والجنس، وبعضها ميول معنوية تتفتح وتنمو بالتربية والتعاهد، ولأجل ذلك كان من الطبيعي للإنسان – اذا تُرك لنفسه ــــ أن تسيطر عليه الميول المادية لأنها تتفتح بصورة طبيعية، وتظل الميول المعنوية واستعداداتها الكامنة في النفس مستترة. والدين باعتباره يؤمن بقيادة مسددة من الله، فهو يوكل أمر تربية الإنسانية وتنمية الميول المعنوية فيها إلى هذه القيادة وفروعها، فتنشأ بسبب ذلك مجموعة من العواطف والمشاعر النبيلة، ويصبح الإنسان يحب القيم الخلقية والمثل التي يربيه الدين على احترامها ويستبسل في سبيلها، ويزيح عن طريقها ما يقف أمامها من مصالحه ومنافعه. وليس معنى ذلك أن حب الذات يُمحى من الطبيعة الإنسانية، بل إن العمل في سبيل تلك القيم والمثل تنفيذ كامل لإرادة حب الذات. فإن القيم، بسبب التربية الدينية، تصبح محبوبة للإنسان ويكون تحقيق المحبوب بنفسه معبرًا عن لذة شخصية خاصة، فتفرض طبيعة حب الذات بذاتها السعي لأجل القيم الخلقية المحبوبة تحقيقًا للذة خاصة بذلك.
فهذان هما الطريقان اللذان ينتج عنهما ربط المسألة الخلقية بالمسألة الفردية، ويتلخص أحدهما في إعطاء التفسير الواقعي لحياة أبدية لا لأجل أن يزهد الإنسان في هذه الحياة، ولا لأجل أن يخنع للظلم ويقر على غير العدل، بل لأجل ضبط الإنسان بالمقياس الخلقي الصحيح، الذي يمده ذلك التفسير بالضمان الكافي.
ويتلخص الآخر في التربية الخُلقية التي ينشأ عنها في نفس الإنسان مختلف المشاعر والعواطف التي تضمن إجراء المقياس الخلقي بوحي من الذات.
فالفهم المعنوي للحياة والتربية الخُلقية للنفس في رسالة الإسلام.. هما السببان المجتمعان على معالجة السبب الأعمق للمأساة الإنسانية. ولنعبر دائمًا عن فهم الحياة على أنها تمهيد لحياة أبدية بالفهم المعنوي للحياة. ولنعبر أيضا عن المشاعر والأحاسيس التي تغذيها التربية الخلقية بالإحساس الخلقي بالحياة.
فالفهم المعنوي للحياة والإحساس الخلقي بها، هما الركيزتان اللتان يقوم على أساسهما المقياس الخلقي الجديد الذي يضعه الإسلام للإنسانية وهو، رضا الله تعالى. ورضا الله – هذا الذي يقيمه الإسلام مقياسًا عامًا في الحياة – هو الذي يقود السفينة البشرية إلى ساحل الحق والخير والعدالة.
فالميزة الأساسية للنظام الإسلامي تتمثل فيما يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها، والخط العريض في هذا النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع معًا، وتأمين الحياة الفردية والاجتماعية بشكل متوازن.
وكل نظام اجتماعي لا ينبثق عن ذلك الفهم والإحساس فهو إما نظام يجري مع الفرد في نزعته الذاتية، فتتعرض الحياة الاجتماعية لأقسى المضاعفات وأشد الأخطار، وإما نظام يحبس في الفرد نزعته ويشل فيه طبيعته لوقاية المجتمع ومصالحه. وكل فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها لا ينبثق عنهما نظام كامل للحياة يحسب فيه لكل جزء من المجتمع حسابه، وتعطى لكل فرد حريته التي هذبها ذلك الفهم والإحساس، والتي تقوم الدولة بتحديدها في ظروف الشذوذ عنهما، أقول إن كل عقيدة لا تلد للإنسانية هذا النظام فهي لا تخرج عن كونها تلطيفًا للجو وتخفيفًا من الويلات وليست علاجًا محددا وقضاءً حاسمًا على أمراض المجتمع ومساوئه. وإنما يشاد البناء الاجتماعي المتماسك على فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها ينبثق عنهما، يملأ الحياة بروح هذا الاحساس وجوهر ذلك الفهم.
وهذا هو الاسلام. فهو عقيدة معنوية وخُلقية، ينبثق عنها نظام كامل للإنسانية، يرسم لها شوطها الواضح المحدد، ويضع لها هدفًا أعلى في ذلك الشوط، ويعرفها على مكاسبها منه.
وأما أن يقضي على الفهم المعنوي للحياة، ويجرد الإنسان مـــــن إحساسه الخلقي بها، وتعتبر المفاهيم الخلقية أوهامًا خالصة، والعامل الاقتصادي هو الخلاق لكل القيم والمعنويات وترجى بعد ذلك سعادة للإنسانية، واستقرار اجتماعي لها، فهذا هو الرجاء الذي لا يتحقق إلا إذا تبدل البشر إلى أجهزة ميكانيكية يقوم على تنظيمها عدد من المهندسين الفنيين.
وليست إقامة الإنسان على قاعدة ذلك الفهم المعنوي للحيـــــاة والإحساس الخلقي بها عملًا شاقًا وعسيرًا، فإن الأديان في تاريخ البشرية قد قامت بأداء رسالتها الكبيرة في هذا المضمار، وليس لجميع ما يحفل به العالم اليوم من مفاهيم معنوية، وأحاسيس خلقية، ومشاعر وعواطف نبيلة، تعليل أوضح وأكثر منطقية من تعليل الجهود الجبارة التي قامت بها الأديان لتهذيب الإنسانية والدافع الطبيعي في الإنسان، وما ينبغي له من حياة وعمل.
وقد حمل الإسلام المشعل المتفجر بالنور، بعد أن بلغ البشر درجة خاصة من الوعي، فبشَّر بالقاعدة المعنوية والخلقية على أوسع نطاق وأبعد مدى، ورفع على أساسها راية إنسانية.
وأخيرًا، وفي نهاية مطافنا نخرج بنتيجة هي أن المشكلة الأساسية التي تتولد عنها كل الشرور الاجتماعية وتنبعث منها مختلف ألوان الآثام لم تعالج المعالجة الصحيحة التي تحسم الداء وتستأصله من جسم المجتمع البشري في غير المذهب الاجتماعي للإسلام.
فلا بد أن نقف عند المبدأ الاسلامي في فلسفته عن الحياة والكون، وفي فلسفته عن الاجتماع والاقتصاد، وفي تشريعاته ومناهجه لنحصل على المفاهيم الكاملة للوعي الإسلامي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* منقول بتصرف من:
محمد باقر الصدر (1979). فلسفتنا: دراسة موضوعية في معترك الصراع الفكري القائم بين مختلف التيارات الفلسفية وخاصة الفلسفة الإسلامية والمادية الديالكتيكية (الماركسية). بيروت: دار التعارف للمطبوعات. ص ص. 11- 53.
** هو مرجع ديني ومفكر وفيلسوف شيعي عراقي من أصول لبنانية.
[1] فإن التجربة اكتسبت أهمية كبرى في الميدان العلمي، ووفقت توفيقا لم يكن في الحسبان إلى الكشف عن حقائق كثيرة، وازاحة الستار عن أسرار مدهشة، أتاحت للإنسانية أن تستثمر تلك الأسرار والحقائق في حياتها العملية. وهذا التوفيق الذي حصلت عليه التجربة. أشاد لها قدسية في العقلية العامة، وجعل الناس ينصرفون عن الأفكار العقلية، وعن كل الحقائق التي لا تظهر في ميدان الحس والتجربة، حتى صار الحس التجريبي في عقيدة كثير من التجريبيين الأساس الوحيد لجميع المعارف والعلوم. وسوف نوضح في هذا الكتاب أن التجربة بنفسها تعتمد على الفكر العقلي، وأن الأساس الأول للعلوم والمعارف هو العقل، الذي يدرك حقائق لا يقع عليها الحس كما يدرك الحقائق المحسوسة.
[2] فإن جملة من العقائد العامة كانت في درجة عالية من الوضوح والبداهة في النظر العام، مع أنها لم تكن قائمة على أساس من منطق عقلي أو دليل فلسفي، كالإيمان بأن الأرض مركز العالم. فلما انهارت هذه العقائد في ظل التجارب الصحيحة، تزعزع الإيمان العام، وسيطرت موجة من الشك على كثير من الأذهان، فبعثت السفسطة اليونانية من جديد متأثرة بروح الشك، كما تأثرت في العهد اليوناني بروح الشك الذي تولد من تناقض المذاهب الفلسفية وشدة الجدل بها.
[3] فإن الكنيسة لعبت دورًا هامًا في استغلال الدين استغلالا شنيعا، وجعل اسمه أداة مآربها وأغراضها وخنق الأنفاس العلمية والاجتماعية، وأقامت محاكم التفتيش، وأعطت لها الصلاحيات الواسعة للتصرف في المقدرات، حتى تولد عن ذلك كله التبرم بالدين والسخط عليه، لأن الجريمة ارتكبت باسمه، مع أنه في واقعه المصفى وجوهره الصحيح لا يقل عن أولئك الساخطين والمتبرمين ضيقا بتلك الجريمة، واستفظاعا لدوافعها ونتائجها.
[4] شرحنا هذه النظريات مع دراسة علمية مفصلة في كتاب (اقتصادنا).
[5] انظر اقتصادنا ص ۳۰۸
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies