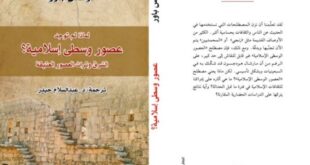ما أشبه اليوم بالبارحة فيما يحيط بالعالم الإسلامي من أحداثٍ جسام تكاد تطيح بالقلوب والألباب في آنٍ واحد….إلا أن الفارق الوحيد بين الزمانين يتمثل في وجود القائد الملهم بالأمس وانعدامه اليوم. إنه القائد الناصر صلاح الدين الأيوبي الذي ألهم الشرق والغرب سواء؛ ولاسيما الغرب. ذلك ما أورده الكاتب والمؤرخ البريطاني “جون مان John Man” في مستهل كتابه تحت عنوان “صلاح الدين: الحياة، الأسطورة، والإمبراطورية الإسلامية Saladin: The Life, The Legend and the Islamic Empire”، الصادر في لندن بدار نشر Bantam Press، في عام 2015.
الكتاب المؤلف من 381 صفحة، والمُكون من 17 فصلاً، يمثل شهادة مؤرخ بريطاني معروف بمؤلفاته التاريخية عن العالم الإسلامي والشرق الأقصى. تخصص في الكتابة عن السير الحياتية للقادة، مثل القائد جانكيز خان. كما برع في الكتابة عن تاريخ الإمبراطوريات، مثل الإمبراطورية المغولية. تُرجمت مؤلفاته إلى أكثر من عشرين لغة؛ وكانت مؤلفاته عن السير الحياتية بالذات من أكثر الكتب مبيعاً.
ويعتبر كتابه عن صلاح الدين الأيوبي – الذي نحن بصدده حالياً – من تلك الكتب التي ركزت على السيرة الذاتية للقائد صلاح الدين. وهو الكتاب الذي تدرجت فصوله على النحو التالي: عالم في صراع، فتى من دمشق، في داخل مصر، بناء قاعدة قوة، العودة إلى سوريا ونهاية مميتة، الدخول على الوغد، هزيمة ونصر: الموجة تتحول، سحق رينالد، من البناء إلى العرض، قرون حطين، استعادة المدينة المقدسة، الحملة الصليبية الثالثة، العاصفة الجامعة، عكا، نهاية الحملة الصليبية الثالثة، الموت والحياة الباقية، تاريخ مختصر للقيادة، الميراث: صورة متوهجة وواقع متهجم.
وعلى الرغم من براعة الكتاب – فكرةً ومضموناً وأسلوباً – وبالرغم من ثرائه من ناحية المعلومات والمراجع والمصادر المُزودة بالخرائط والصور الفوتوغرافية، إلا أنه يؤخذ عليه أمران: الأول في كونه مُستغرقاً في تفاصيل الحروب العسكرية لدرجة تبعث على الملل في بعض الأحيان؛ والثاني في الخطأ المعلوماتي التاريخي بشأن مدينة القدس الذي سيتم توضيحه لاحقاً.
وبعد هذه النبذة السريعة عن الكتاب ومؤلفه، سنقوم حالياً بالدخول في ثنايا الكتاب عبر عرض مضمونه واستنباط خطوطه العريضة… بعد قراءة متأنيةٍ، وتأمل في الأحداث والأفكار والأشخاص.
مقدمة تمهيدية عن مضمون الكتاب:
ظهر صلاح الدين في قلب مشهد سياسي مزرٍ ومعقد، لا يقل تعقيداً عما تشهده الساحة الإسلامية اليوم في القرن الواحد والعشرين. فرجوعاً إلى القرن الثاني العشر الميلادي، كانت أبرز ملامح المشهد السياسي الإسلامي متمثلة في الآتي: انقسام سني شيعي واضح؛ ظهور الأساسانيين (المندرجين من الشيعة) وإلحاقهم أبشع أنواع الظلم والتنكيل بالسُنة؛ هجوم الصليبيين على العالم الإسلامي واقتحامهم للقدس دون مقاومة تُذكر؛ ضعف الخلافة العباسية في بغداد وانزواء أو أفول أيام العصر الذهبي الذي كان متجلياً في القرن الحادي عشر الميلادي، حينما كانت بغداد أكبر مدن العالم، وحينما كانت ُبخارى “قبة الإسلام في الشرق”، بكتابها وعلمائها وشعرائها ومكاتبها.
ولم يكن الانقسام ملازماً للعالم الإسلامي فقط، بل كان ملازماً أيضاً للعالم المسيحي الأوروبي؛ وهو الأمر الذي جعل رجال الدين المسيحي – كما يؤكد “مان” – يعجلون بشحذ وشحن الحروب والحملات الصليبية كسبيل لحل إشكالية الانقسام في وسط المسيحيين الأوروبييين. فكانت دعوتهم لتلك الحروب هي أقرب ما يكون لشحذ همم المسيحيين وشحن غضبهم تجاه المسلمين (الذين كانوا يسمونهم بالبرابرة) بدلاً من شحنها تجاه بعضهم البعض.
كانت أكثر الشخصيات تأثيراً على صلاح الدين – كما يشير “مان” – نور الدين زنكي وأسد الدين شيريكوه (عم صلاح الدين). كل منهما كان له دور جوهري في إظهار صلاح الدين سياسياً وعسكرياً، وإدخاله في قلب المشهد السياسي والعسكري، ونقله من فتى في دمشق إلى والٍ على مصر.
لم يكن طريق صلاح الدين مفروشاً بالورود، بل كان طريقاً وعراً صعباً، تملؤه التحديات التي لم تكن متمثلة فقط في الشيعة والأساسانيين والصليبيين، بل متمثلة أيضاً في الخليفة العباسي ذاته، وفي فئات داخلية مناوئة لشخص صلاح الدين، وفي الولاءات المتعددة التي كانت مفروضةً عليه في وقتٍ واحد، كما ورد في ثنايا الكتاب.
ولعل من أكبر التحديات التي واجها القائد صلاح الدين كان القائد الصليبي “راينالد Reynald” الذي أفرد له “مان” فصلاً كاملاً، يصف من خلاله كيف شكلت تلك الشخصية استفزازاً حقيقياً لصلاح الدين الذي أقسم على قتله بنفسه إن وقع بين بيديه…وهو ما قام به فعلياً في معركة حطين التي “كسر فيها أنوف الصليبيين”، على حد قول “مان”.
استعادة القدس بالسلام – بعد الانتصار في معركة حطين – كانت إحدى المحطات المهمة التي توقف عندها “مان” في ثنايا كتابه. هنا تحدث الكاتب عن كرم أخلاق القائد صلاح الدين في مقابل فظاظة ووحشية نظيره الصليبي ريتشارد قلب الأسد الذي أقام مذبحةً أو قل مجزرةً للأسرى المسلمين في عكا عام 1191 ميلادياً. وكما تم استعادة القدس بالسلام تم إنهاء الحملة الصليبية الثالثة بالسلام أيضاً، بعدما استُنزف الطرفان.
وفي الفصلين الأخيرين، أسهب “مان” في سرد صفات القائد الناصر؛ فتحدث عن عدله وتوازن شخصيته واحترامه لكلمته؛ وتكلم عن عفته المالية، وعن جهاده ومثابرته لتنفيذ وتطبيق الرؤية الإسلامية؛ وأخيراً عن صدقه مع جيشه في مشاركته الهموم والصعاب التي يواجهها في محاربة الصليبيين. إنها تلك الصفات التي جعلت الشعراء والأدباء الأوروبيين في حالة انبهار دائم ومستمر بشخصية القائد الناصر، كما أكد “مان” في نهاية كتابه.
هذا هو مُجمل أو مُلخص ما أورده المؤرخ البريطاني “جون مان” في كتابه . وهو ما سنتحدث عنه تفصيلاً – على لسان “مان” – فيما تبقى من التقرير ؛ وذلك إظهاراً لحقائق وانطباعات وردت من قبل مؤرخ وكاتب غربي معاصر، يحاول إنصاف نموذج قيادي تاريخي إسلامي تعرض مؤخراً لحملات سب وقذف وتشنيع على أيدي مثقفين مسلمين.
إطلالة على المشهد السياسي قبيل ظهور صلاح الدين:
بينما كانت أوروبا تعيش تأخراً واضحاً في القرون الوسطى (ما بين القرن الخامس والقرن الخامس عشر الميلادي)، كان العالم الإسلامي يعيش عصراً ذهبياً متألقاً. تقدم علمي ملموس؛ تعايش بين جميع الأديان؛ ثراء واضح في جميع الأرجاء؛ تألق بارز للمدن الإسلامية كمدن عالمية، مثل بغداد وبُخارى. كان الإسلام والثقافة عاملين أساسيين لتوحيد وتجميع شتات العالم الإسلامي مترامي الأطراف؛ وفي قلبيهما القرآن والسُنة، كما يؤكد “مان”. إلا أن الانقسام السُني الشيعي كان مرضاً عُضالاً وناخراً في جسد هذا العالم الذي انقسم بين الشيعة في مصر التي خضعت تحت ولاية الحكم الفاطمي منذ نهاية القرن العاشر الميلادي، وبين السُنة في العراق تحت ولاية الخليفة العباسي. ثم ازداد الأمر مرارةً إبان هجوم الصليبيين على العالم الإسلامي في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي (1096)، وبداية اقتطاع الإمبراطورية العباسية على أيدي الصليبيين، كما يؤكد “مان”.
لقد أفقدت الهجمات الصليبية العالم الإسلامي ازدهاره ووحدته وصلابته وثراءه، لدرجة أن السُنة والشيعة أنفسهم كانوا يتباكون على ذلك العصر الذهبي الذي ولى ومضى؛ بل ويتغنون بما تحقق تحت راية الإسلام فيما سبق، حالمين باليوم الذي يعود فيه ذلك المجد القديم الذي كان.
بدأ قدوم الصليبيين إلى العالم الإسلامي في عام 1096 ميلادياً، أي قبل ميلاد صلاح الدين بأربعين عاماً. وكانت مجزرة القدس في عام 1099 ميلادياً، حيث تم قتل الجميع: مسلمين، مسيحيين شرقيين، يهود. كانت هناك جبال من الجثث. لقد دخل الفرنجة القدس دون مقاومة تُذكر؛ فالقيادة الإسلامية القادرة على توحيد صفوف المسلمين كانت غائبة؛ والقادة المسلمون بدلاً من جهادهم سوياً ضد الصليبيين، كانوا يتعاركون فيما بينهم؛ وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان العامة الأمل في بزوغ قائد يقذف بالفرنجة في عرض البحر، على حد قول “مان”.
ومما أزاد الطين بلة ظهور الأساسانيين في القرن الثاني عشر الميلادي؛ وهم الذين لم يقلوا خطورةً عن الصليبيين. فالأساسانيون – المندرجون من الشيعة – كانوا يشكلون تحدياً قاسياً للقائد صلاح الدين باعتباره قائداً سُنياً ساعياً لجمع شمل المسلمين تحت الراية السُنية لدحر الصليبيين.
وكما طال الانقسام العالم الإسلامي، فقد طال أيضاً العالم المسيحي الأوروبي. فها هي الحضارة المسيحية الأوروبية منقسمة على ذاتها فيما بين المسيحية الأرثوذكسية والمسيحية الرومانية؛ وها هو البابا يتناطح مع الملك؛ وها هم البارونات يتناطحون فيما بينهم. وتمثل الحل لتلك الانقسامات – من وجهة نظر البابا Urban – في شن الحملات الصليبية على بلاد المسلمين الذين كانوا يُسمون بالبرابرة والكفار من قبل الفرنجة. فبدلاً من توجيه الضغائن فيما بين المسيحيين الأوروبيين كان الحل هو تحويلها إلى حروب موجهة ضد المسلمين. وبذلك قام Urban بإيجاد قضية – تبدو وكأنها نبيلة ومقدسة – ليلتف حولها أهل الفرنجة تحت راية الصليب، ويتحدون جميعهم بإسم الصليب لدحر المسلمين “الكفار” “البرابرة”.
دور زنكي وشيريكوه في حياة صلاح الدين:
في ظل جميع تلك الأجواء، وُلد صلاح الدين في عام 1136 ميلادياً. ترعرع وشب في دمشق؛ مما جعله على مقربةٍ من حاكم حلب حينذاك؛ إنه صلاح الدين زنكي الذي كان معروفاً بانتصاراته على الصليبيين في حلب؛ الأمر الذي بعث وجدد الأمل في وسط المسلمين بإمكانية تحرير القدس على يد زنكي. إلا أن انتصاراته سرعان ما توقفت بعد مقتله على يد أحد عبيده.
استكمل نور الدين زنكي مسيرة والده في دحر الصليبيين واستعادة القدس ثانيةً تحت أيدي المسلمين عبر بناء دولة سُنية مواجهة للفرنجة. نور الدين زنكي – الذي كان ممثلاً للقوة الناعمة على حد قول “مان” – انتقل إلى حلب، جنباً إلى جنب مع أسد الدين شيريكوه عم صلاح الدين الأيوبي.
في ظل تلك الأجواء – كما يشير “مان” – كان صلاح الدين الصبي الفتي يعيش في دمشق التي كان يُطلق عليها “جنة الله في أرضه”؛ فخصوبة أرضها ووفرة مياهها وطيبة أهلها جعلها تظفر بهذا اللقب. إلا أنها كانت “جنة” تحت التهديد، بسبب انعدام الثقة بين سكانها العرب وبين حكامها الأتراك، وبسبب أيضاً وقوعها تحت مخاوف اقتحام الصليبيين؛ والتي اقتحموها بالفعل…وكان صلاح الدين ذو الأحد عشر عاماً شاهداً عليها وعلى اختراقها من قبل الفرنجة؛ كما كان شاهداً على مقتل أخيه الأكبر شاهٍ شاه في ظل تلك الأحداث؛ وهو الأمر الذي أثر في نفسه كثيراً.
كان ذلك استفزازاً لنور الدين زنكي الذي تقدم بجيشه– تحت إمرة شيريكوه – متصدياً جيش الصليبيين الذي أذاقهم في النهاية هزيمةً منكرةً في دمشق؛ الأمر الذي أفضى إلى توحيد حلب ودمشق تحت ولاية القائد الشاب زنكي الذي فتح الباب للفتى صلاح الدين الأيوبي ذي الستة عشر عاماً وقتها لكي يخطو أولى خطواته نحو عالم السياسة والحروب، كما أفاد “مان”، وكما سنرى فيما بعد.
بعد هذه المعركة – التي تولى على أثرها نور الدين زنكي حكم حلب ودمشق معاً – صارت المنطقة في القرن الثاني عشر الميلادي مُقسمة كالتالي: مملكة نور الدين زنكي من ناحية؛ السلاجقة الأتراك من ناحية أخرى؛ البيزنطيون في القسطنطينية من ناحية ثالثة؛ دول الصليبيين من ناحية رابعة؛ الحكم الفاطمي الشيعي في مصر من ناحية خامسة؛ والحكم العباسي السُني في بغداد من ناحية سادسة.
كان عداء الفاطميين (والطائفة الإسماعيلية بالذات) للحكم السُني في بغداد ظاهراً، كما أوضح “مان”. كانت شوكة الفاطميين قد بدأت تنكسر، مما ألجأ الوزير الفاطمي شاوار إلى الاستغاثة بنور الدين زنكي لإنقاذ مصر من السقوط في براثن الصليبيين. وقد أسرع زنكي بالفعل لنجدته، مرسلاً جيشاً تحت قيادة شريكوه، عم صلاح الدين. إلا أن شاوار رد بالخيانة حينما قام بالتحالف مع الفرنجة ضد شريكوه الذي سارع بدوره بإدخال إبن أخيه (صلاح الدين) في الحرب ضد التحالف الفاطمي – الفرنجي لإنقاذ مصر من الصليبيين. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها صلاح الدين محارباً في مصر، تحت إمرة عمه شريكوه.
هُزم جيش شريكوه بدايةً في الأسكندرية إلا أنه انتصر بعد ذلك، مانعاً الفرنجة من دخول مصر، ومنفذاً حكم الإعدام على شاوار بسبب خيانته. ولكن بعد تحقيق ذلك النصر، طمع شريكوه في الحكم؛ معلناً رغبته في الانفصال عن الخليفة العباسي. إلا أن المرض لم يمهله؛ لتوافيه المنية ويصير الطريق ممهداً لتولي إبن أخيه (صلاح الدين) الوزارة في مصر عام 1169 ميلادياً، رُغماً عن قلة خبرته الإدارية.
وصل صلاح الدين إلى تولي وزارة مصر، واضعاً والده مثلاً أعلى له في الكرم والتفاني، وليس عمه صاحب المطامع العسكرية، المجرد من القدرات الحقيقية. تولى صلاح الدين – الذي لُقب بالملك الناصر عند بلوغه سن الواحد والثلاثين – الوزارة في مصر واضعاً ثلاثة أهداف كبرى نصب عينيه: الجهاد ضد الفرنجة؛ الحكم العادل؛ اتباع الخليفة العباسي، كما أكد “مان”.
وهكذا نرى، مما أورده “مان” في كتابه، كيف ساقت الأقدار – المتمثلة في وجود شخصين وهما نور الدين زنكي وأسد الدين شريكوه – إلى دخول صلاح الدين في عالم السياسة والحرب، بالغاً حكم مصر، ومن بعدها موحداً الصف السُني، ثم مجاهداً الصليبيين، وأخيراً منتصراً عليهم… كما سنرى لاحقاً.
صلاح الدين مواجهاً التحديات:
كانت جل مشاريعه العسكرية والمدنية تصب في النهاية في مقصدٍ واحد، ألا وهو: توحيد مصر وسوريا تحت ولاية الحكم السُني، وإقامة جيش قوي موحد مخلص له. إلا أن هذا المقصد كانت تحيط به وتلتف حوله عقبات كُثر؛ كما يبين “مان” في كتابه.
أولى تلك العقبات أو التحديات تمثلت في وجود فئات محلية مناوئة ومناهضة لشخص صلاح الدين. فالمسيحيون والأرمن والشيعة والأساسنيون…جميعهم كانوا يشكلون تحديات كبرى ومعوقة على طريق بناء جيش مسلم سُني قوي يحارب الصليبيين. وهو الأمر الذي ألجأ الملك الناصر نحو تعيين أقاربه كمعاونين له ليضمن ولاءهم، مثلما فعل مع أخيه توران شاه وأبيه أيوب. بل ألجأه ذلك إلى بناء جيش قوي مستند على ذوي القربى.
أما بالنسبة للشيعة في مصر، فقد واجههم صلاح الدين أولاً ببناء وترسيخ مؤسسات سُنية في مصر؛ تعليمية وقضائية وبيروقراطية. ثم قام بتقليص نفوذ الخليفة الفاطمي الشيعي (العديد) تدريجياً، حتى أمر في صبيحة أول يوم من عام 567 الهجري – وفي أثناء وقت الدعاء للخليفة بصلاة الجمعة – باستبدال خليفة القاهرة الفاطمي بخليفة بغداد السُني؛ الأمر الذي كتب النهاية لآخر أسرة في الحكم الفاطمي الذي حكم مصر طيلة قرنين من الزمان.
كانت وفاة نور الدين زنكي – الذي كان رأس حربة لنشر المذهب السُني – وفراغ السلطة في سوريا بسبب حداثة سن إبنه (أحد عشر عاماً) سبباً لجعل صلاح الدين حاكماً لمعظم المنطقة. فقد نصبه الخليفة العباسي حاكماً لمصر وسوريا والمغرب والنوبة وفلسطين. إلا أن صلاح الدين كان يُطوق إلى ما هو أكثر من ذلك: توحيد المسلمين من أسبانيا إلى القوقاز تحت الراية السُنية للوقوف جميعاً ضد الصليبيين. ولكن الخليفة العباسي في بغداد كان يشكل عائقاً ومانعاً لبلوغ هذا الحُلم.
أما أكبر التحديات فكانت متمثلة في شخص القائد الصليبي الفرنجي “رينالد Reynald” الذي وصفه “مان” باعتباره أسوأ القادة الصليبيين الذين كرهوا المسلمين، ونكلوا بهم؛ لدرجة أن صلاح الدين قد أقسم بالله على قتله بيديه.
كان كسر “رينالد” للهدنة التي كانت قد دُشنت بين صلاح الدين و”بالدوين Baldwin” (حاكم القدس الصليبي) آذاناً بتحويل حرب صلاح الدين ضد الصليبيين إلى أمرٍ شخصي، كما أفاد “مان” الذي أفرد فصلاً بأكمله عن “التعامل مع الشرير العدو اللدود رينالد”. وقد كان سبب الهدنة في عام 1180 ميلادياً متمثلاً باختصار في ضعف الطرفين وعدم استعدادهما للحرب نتيجةً لعدة عوامل، منها: موت الأباطرة والملوك الفرنجة بسبب الأمراض؛ فوضى في الزيجات والعلاقات بين الأمراء والأميرات الصليبيين؛ انخفاض في منسوب مياه نهر النيل بمصر وتوقف الفيضانات.
كسر “رينالد” الهدنة في عام 1187 ميلادياً، ساعياً نحو اقتحام الحجاز (مهد الإسلام) عبر قلعته “كراك” التي بناها مجدداً على مقربة من ميناء إيلات على البحر الأحمر. كان مقصده اقتحام مكة والمدينة عبر هجومه على قوافل الحجاج القادمة من مصر إلى الحجاز. كانت نيته الوقحة متمثلة في ضرب سمعة الملك الناصر في وسط المسلمين على اعتباره عاجزاً عن تأمين الحجاج والمقدسات الإسلامية؛ وكذلك في تعطيله عن المضي قدماً في مشاريعه العسكرية.
استفزت وقاحة رينالد صلاح الدين الذي أنهى تلك الوقاحة في معركة حطين عام 1187ميلادياً أو معركة المياه التي استخدم فيها المسلمون المياه سلاحاً لهزيمة الصليبيين هزيمةً منكرة؛ حيث كان المسلمون قريبين من آبار المياه في حطين بينما كان المسيحيون بعيدين عنها، الأمر الذي جعلهم يستنزفون جهودهم للوصول إلى تلك الآبار لسد عطشهم بدلاً من استنزافها في مقاتلة المسلمين. ووقع “رينالد” في يد صلاح الدين الذي قتل ذلك الديكتاتور المتجاوز لكل الحدود. وبالرغم من أن القاعدة تقول أن الملوك لا يقتلون الملوك، فقد اعتُبر “رينالد” استثناءً كما أشار “مان”.
خلفت حطين أربعين ألف قتيل (رواية صلاح الدين). وبغض النظر عن صحة الأرقام، فيكفي القول أن الناصر نجح في تدمير جيش الفرنجة والمرور بالصليب، متجهاً إلى أسفل، في وسط شوارع دمشق، توضيحاً وإظهاراً لمعناه الذي فُقد؛ فلم يعد ذلك الصليب يمثل السيد المسيح عليه السلام لا من قريب أو من بعيد. لقد كسر صلاح الدين أنوف القادة والملوك المسيحيين الذين زعموا أنهم لن يُقهروا، مخلفاً وراءه عدداً مهولاً من الأسرى المسيحيين؛ كما أورد “مان”.
ويعلل “مان” انتصار صلاح الدين على الفرنجة في حطين، وفيما بعد أيضاً كما سنرى، بالرؤية الإستيراتيجية التي امتلكها صلاح الدين والتي لم يمتلكها الصليبيون الذين لم يكونوا ذوي رؤية مسيحية واضحة ولا ذوي قيادة موحدة رشيدة. فهم في النهاية يُعتبرون أغراب على المنطقة؛ لا يمتلكون إلا القلاع والأبراج والحوائط ليحتموا وراءها. فكل ما كان في مقدورهم فعله لم يخرج عن نطاق التكتيكات النابعة من الظروف المحيطة.
استعادة القدس بالسلام:
بعد معركة حطين كان الصليبيون في الموقف الأضعف؛ فقد نقص عدد المقاتلين من بين صفوفهم؛ كما نقصت أموالهم بعد ما فدوا أنفسهم في نهاية المعركة. وفوق ذلك، أعطى المسيحيون الشرقيون المقدسيون ظهورهم لهم بسبب المعاملة السيئة التي كانوا يتلقونها منهم. إلا أن كل ذلك الضعف لم يخلف إلا كرهاً مضاعفاً من قبل الصليبيين تجاه المسلمين، لدرجة أنهم باتوا على استعداد لقتل أبنائهم وزوجاتهم – بل وحرق القدس ذاتها – حتى لا يتركوا للمسلمين شيئاً. أما صلاح الدين، فكان هو أيضاً على أتم استعداد لاستعادة القدس بالسيف كما سُلبت واغتُصبت بالسيف منذ 91 عاماً.
إلا أن الخسارة الفادحة التي مُني بها الصليبيون في حطين أجبرتهم في النهاية على التسليم وطلب السلام. وقد وافق الناصر واستعاد القدس بالسلام؛ وهو الأمر الذي جعل “مان” يُسهب في سرد مكارم أخلاق ذلك القائد المسلم في لحظة استعادته القدس سلمياً؛ قائلاً: “صلاح الدين صدرت منه مواقف لا تُعد حول رحمته وكرمه مع أشخاصٍ طيلة حياته، إلا أنه لا يوجد شيء قد شكَل سمعته مثلما حدث في أثناء استعادته للقدس” (253-254). فعفوه عن أرامل المقاتلين الصليبيين الذين قُتلوا في حطين، وكرمه معهن ومع أولادهن، يُسجل له في التاريخ بكل تأكيد. وهنا قام “مان” بمقارنةٍ سريعة، حيث قارن رحمة القائد الناصر في معركة استعادة القدس من ناحية بوحشية وشراسة الصليبيين مع المسلمين – والمذابح التي أحدثوها بحقهم في حملتهم الأولى عام 1098 ميلادياً – من ناحيةٍ أخرى.
وقد واصل الصليبيون وحشيتهم بعد خسارتهم القدس؛ وذلك في إطار شن حملتهم الصليبية الثالثة. فبوصول المدد الأوروبي إليهم في البلدان المجاورة للقدس، تجلت الفظاظة والشراسة بأبشع صورها في شخص القائد الصليبي ريتشارد قلب الأسد الذي قام بقتل 2600 أسير مسلم بمدينة عكا أمام أعين صلاح الدين. وصف “مان” تلك الفعلة الدنيئة قائلاً: “هذا التصرف السييء وضح الفارق بين الشخصيتيين وبين الثقافتين. لقد كان بإمكان ريتشارد إطلاق سراحهم أو تحويلهم إلى عبيد…ما هذا الفارق بين نُبل صلاح الدين المسلم الذي كان يُظهر [ذلك النُبل] عامةً تجاه أعدائه.. وبين قسوة ريتشارد كمسيحي تجاه أعدائه؟”.
حققت مذبحة الأسرى المسلمين بعكا – في معركة Asruf في 22 أغسطس 1191ميلادياً -لريتشارد ما حققته حطين لصلاح الدين. وهو الأمر الذي مكنه فيما بعد من الوصول إلى يافا والاستفادة من مينائها لتوفير رغد الحياة من الطعام والنساء لجيشه، استعداداً لاستعادة القدس ثانيةً من أيدي المسلمين. وتمثلت الخطورة في إمكان سيطرة ريتشارد قلب الأسد على عسقلان، ومن ثم قطعه على صلاح الدين وجيشه الإمدادات القادمة من مصر؛ فلم يعد أمام صلاح الدين حل سوى تدمير عسقلان لإنقاذ جيش المسلمين.
كانت يافا آخر محطات الحملة الصليبية الثالثة، حيث لا نصر ولا هزيمة وإنما تعب وإرهاق نتيجةً لحرارة الجو الساخنة، ولاسيما في ظل تمسك الصليبيين بملابسهم الثقيلة خوفاً من سهام المسلمين. استُنزف ريتشارد الذي سقط تعباً من الحُمى، وانشغالاً بأخيه جون الذي كان على مشارف اعتلاء العرش في انجلترا. وأسفر ذلك كله عن قيام القائد الناصر بعرض شروط السلام الملزمة للطرفين، والتي كان أهمها: إبقاء عسقلان دون سلاح وبعيداً عن أيدي الفرنجة؛ إتاحة الحق لجميع الديانات بالتواجد في القدس.
انتهت الحملة الصليبية الثالثة بالسلم أيضاً، وأبقى صلاح الدين على القدس، ولم يُقذف بمسيحي القدس في البحر. “لقد كان صلاح الدين بطلاً قومياً وقديساً؛ لقد كان نسخةً من القرون الوسطى لنلسون مانديلا”؛ “لقد بسط أجنحة العدل على الجميع” (“مان”، 311- 312).
وبما أن الشيء بالشيء يُذكر، فهناك نبذة أخيرة نود إدراجها في هذا الصدد، لنؤكد به فكرةً كنا أوردناها سابقاً؛ وهي التحدي الذي كان يمثله الخليفة العباسي في بغداد للقائد الناصر؛ إذ رفض الأول إرسال المدد للثاني في أثناء المحطة الأخيرة بالحملة الصليبية الثالثة بمدينة يافا. نعم…لقد كان الخليفة العباسي متخوفاً من بسط صلاح الدين لنفوذه وهيمنته؛ وامتنع عن تلبية ندائه واستغاثته به.
سر صلاح الدين الذي أسر الغرب قبل الشرق:
كتب عنه ابنه “الأفضل” قائلاً، موجهاً كلامه إلى الخليفة العباسي، “لقد كان هو من سحق الأمراء الكفار واضعاً المحبس حول رقابهم؛ لقد كان هو من أذل عابدي الصليب كاسراً ظهورهم؛ لقد كان هو من وحد المؤمنين، وحافظ عليهم، ونظم شئونهم. هو الذي حفظ حدودنا، وأدار شئوننا بأيدٍ أمينة، وأذل كل عدوٍ خارج قصرك” (316 – 317). وعلق “مان” على ذلك الكلام قائلاً: “إنه بطل وموحد الإسلام…القائد الذي سحق الصليبيين واستعاد القدس؛ أحبه تابعوه وأعداؤه سواء؛ كان محبوباً حينذاك كما هو محبوب الآن” (319).
ولكن ما هو سر صلاح الدين؟ يجيب “مان” عن ذلك السؤال مؤكداً أن ذلك السر كان كامناً في شخصية صلاح الدين التي مزجت بين القوتين الصلبة والناعمة؛ والتي جعلته متفرداً. صحيح أنه استخدم العنف والحيلة مع أعدائه في كثير من الأحيان، إلا أنه قاوم شرور القيادة الدنيئة بقدر ما يستطيع، مما جعله مُقدَراً في وسط الجميع. كان بإمكانه أن يصير قائداً متوحشاً – مثلما افترض ماكيافيللي – إلا أنه رفض أن يكون ذلك الوحش، مُصراً على مزج القوة بالإقناع، واستخدام القوة الناعمة في السيطرة….كما فعل مع سكان وأهل دمشق والموصل وبعلبك وحمص وحما بعد وفاة نور الدين زنكي.
إنها تلك الشخصية المتوازنة التي وازنت بين الإحساس بالأمن والإحساس بعدم الأمن: الأمن بدينه وإسلامه وأسرته، وعدم الأمن بسبب النزاع السني الشيعي من جهة والنزاع الإسلامي المسيحي من جهة أخرى. تلك الشخصية المتوازنة – كما يُكمل “مان” – أفرزت قائداً صاحب رؤية واسعة وهدف نبيل يعلو كل قائد؛ ألا وهو توحيد المسلمين وإجلاء الصليبيين عن أراضيهم وثرواتهم. صحيح أن تلك القضية النبيلة كانت مُثارة من قبل ميلاده بأربعين عاماً – كما أشرنا سالفاً – وصحيح أنه لم يخترع تلك القضية، إلا أنه كان الوحيد الذي سعى سعياً حثيثاً لتطبيقها على أرض الواقع، مُضحياً بالغالي والنفيس من أجل تحقيقها….وقد تحققت إلى حدٍ كبير قبل وفاته. بل كان يحلم بما هو أكبر من ذلك؛ كان يحلم بنشر الإسلام في ربوع أوروبا لكن وافته المنية وحالت دون ذلك.
لم يكن القائد الناصر دنيئاً أو بوجهين– كما نصح ماكيافيللي في كتابه “الأمير” – ولكنه كان محترماً لكلمته حتى مع عدوه؛ وكان عفيفاً عن المال…فهو لم يترك إلا 47 درهماً وقطعة ذهب واحدة. وكان صادقاً مع جيشه، لا يكذب عليه ولا يستر عنه الحقائق؛ بل كان يشاركه همه وألمه، معترفاً أمامه بالتحديات التي تواجهه، مازجاً كل ذلك بالقضية الكبرى: وهي نُصرة الإسلام ودحر الغاصب المحتل.
ذلك هو “السر” الذي أبهر أوروبا المسيحية، بينما لم يُبهر الشرق المسلم بنفس القدر، كما أكد “مان”. نعم؛ لقد تم نسيان صلاح الدين لمدة 500 عام (خمسة قرون). ويعلل “مان” ذلك موضحاً بأن قطاعاً كبيراً من المسلمين – وهم الشيعة الذين يمثلون حوالي 15% من مجموع المسلمين – كرهوا مسلكه ناظرين إليه باعتباره ديكتاتوراً فارضاً للمذهب السُني على حساب المذهب الشيعي، وليس موحداً للمسلمين كما يراه أهل السُنة. لا يعترف الشيعة وكذلك الأساسانيون – المندرجون من تحت عباءتهم وذوو المنهج الدموي الواضح تجاه السُنة – بإنجازات صلاح الدين تحت الراية السُنية؛ ولم ولن يسامحوه أبداً على ذلك.
سبب آخر يوضحه “مان” – وراء عدم تقدير الشرق المسلم لصلاح الدين طيلة خمسة قرون بعد وفاته – تمثل في كون انتصاره على الصليبيين ناقصاً…لم يكتمل بعد. صحيح أنه استعاد القدس، ولكن الفرنجة بقوا، مما مكنهم بعد ذلك من استعادة عكا ومدن كثيرة من الساحل السوري، الأمر الذي أفضى إلى استعادتهم القدس مرةً أخرى بعد خمسة عشر عاماً. وظل الصليبيون قابعين في العالم الإسلامي قرابة قرنٍ من بعد وفاة القائد الناصر؛ ولم يُطردوا تماماً إلا في عام 1291 ميلادياً على أيدي المماليك.
وهنا يجب التنويه عن وقوع المؤرخ البريطاني في خطأ تاريخي واضح، حينما قال أن القدس قد تم احتلالها مرة أخرى بعد وفاة صلاح الدين، فالحقيقة تقول باختصار أن القدس لم تُسلب ثانيةً من قبل الفرنجة بعد قيام صلاح الدين بتحريرها. صحيح أن الصليبيين بقوا في بعض مدن ساحل الشام حتى أجلاهم المماليك نهائياً في نهاية القرن الثالث عشر؛ إلا أن القدس لم يُعاد احتلالها.
وعودة إلى نقطة عدم تقدير الشرق للقائد صلاح الدين، والتي أثارها “مان” في نهاية كتابه، فقد أكد أنه قد تم نسيان صلاح الدين في وسط عالم المسلمين – طيلة خمسة قرون – حتى جاءت الأقدار بمن يحيي سيرته مرةً أخرى؛ إنه السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي أعاد للقائد الناصر حقه وهيبته في أواخر القرن التاسع عشر، في عام 1876 ميلادياً. ونتيجةً للتحالف القائم حينذاك بين الدولة العثمانية وألمانيا ضد روسيا، كانت زيارة قيصر ألمانيا “فيلهيلم الثاني” لقبر القائد الناصر في دمشق، واصفاً إياه “بالسلطان العظيم الذي لم يخف؛ والفارس النبيل الذي كان يُعلم تابعيه كيف تكون الفروسية”.
لم يكن القيصر الألماني هو الأوروبي المسيحي الوحيد الذي انبهر بالقائد الناصر؛ إنما انبهر به عامة المسيحيين، كما يشير “مان”. لقد انبهروا بكرمه وبعفته عن المال. فكانوا يتساءلون ويندهشون…كيف بقائد عظيم يموت هكذا ولا يترك ملكاً عظيماً من بعده؟؟ إنه أمر غير مألوف بالنسبة للعقلية الأوروبية. وصلت درجة انبهارهم به إلى أن بعضهم بات مقتنعاً بأنه مسيحي أو له أصول مسيحية؛ لكونه مطبقاً أخلاق السيد المسيح عليه السلام، مما جعله في حماية الله ونصرته. نعم….لقد أيقن المسيحيون بعد مرور قرن من وفاته أن الله كان ناصراً لصلاح الدين ولم يكن ناصراً لهم بسبب بعدهم عن تعاليم السيد المسيح عليه السلام.
وكما أبهر صلاح الدين عقول وقلوب الملوك والشعوب في الغرب المسيحي؛ فقد أبهر أيضاً عقول وقلوب الأدباء والشعراء الأوروبيين الذين أسهبوا في ذكر شهامته ومروءته وفروسيته وكرمه. لقد أسرتهم أخلاقه أكثر مما أسرتهم قدراته العسكرية. فكتب عنه “دانته Dante” الإيطالي، و”فولتير Voltaire” الفرنسي، و”ليسينج Lessing” الألماني. بل إن “فولتير” جعله رمزاً للتنوير في كتاباته، على اعتبار أن القائد الناصر كان يغدق بالصدقات على جميع الفقراء بغض النظر عن دياناتهم.
وفي العصر الحديث، بل في الألفية الثانية التي نحياها الآن، كان هناك فيلم “مملكة السماء” (2005) الذي أظهر بشاعة الصليبيين وتحيزاتهم، مشيراً إلى التدخل الأمريكي السافر بالعراق وأفغانستان. ثم كانت المسرحية الإنجليزية “مقاتلون ربانيون” (2014) التي يحكي فيها الماضي – متمثلاً في ريتشارد قلب الأسد وصلاح الدين الأيوبي – للحاضر المتمثل في جورج دبليو. بوش وطوني بلير.
أما على المستوى العربي، فقد اتخذه كل من جمال عبد الناصر وحافظ الأسد مثالاً يُحتذى به. ومن العجيب، كما يشير “مان”، أن يراه ناصر مثالاً للقائد العروبي بينما لم يكن صلاح الدين عربياً؛ وأن يراه الأسد مثلاً أعلى له بالرغم من كون الأسد علوياً منتسباً للشيعة التي ظل صلاح الدين يحاربها عقوداً طويلة.
وتعليقاً على وضع العالم الإسلامي الحالي، اختتم “مان” كتابه بهذه العبارات المؤلمة الموجعة قائلاً: “…ويستمر الأمر والإسلام يذرف الدمع على حدوده، فاتحاً أبوابه للتحالفات الأجنبية هنا وللتطرف هناك…وقد قُطعت أحلامه وآماله عبر حرب أهلية…وقنابل وأعمالٍ بربرية بشعة تابعة لما يُسمى بالدولة الإسلامية التي تدمر مُثل الإسلام بإسم الإسلام؛ حتى القلعة في تكريت – التي وُلد فيها أعظم قائد إسلامي – قاموا بتدميرها. لا توجد أية علامة عن ميلاد (صلاح الدين جديد) ؛ ولا أي رؤية عما يمكن تحقيقه، أو حتى كيف. إن حُلم صلاح الدين يمثل الماضي أو المستقبل البعيد”.
واخيرا يمكننا القول إن مأساة العالم الإسلامي في يومنا هذا لا تتمثل فقط في وجود جماعات سُنية متطرفة (مثل تنظيم الدولة) – كما يشير المؤرخ البريطاني – وإنما تتمثل أيضاً في وجود تطرف شيعي مماثل لا يقل ضراوة عن نظيره السُني؛ وتتمثل أيضاً في وجود تطرف غربي عنصري تمثله الدول الغربية الكبرى، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. ذلك التطرف الغربي الذي يسعى سعياً حثيثاً نحو دفن هذه المنطقة تحت الأنقاض، وإعدامها حيةً، بحيث لا يتبقى منها إلا ما يحفظ المصالح الإستيراتيجية للقوى الغربية الكبرى.
عرض:
د. شيرين حامد فهمي
دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies