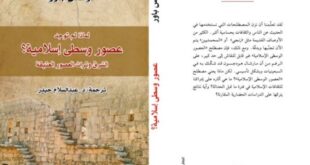العنوان: الحداثة اللامتناهية الشبكية: آفاق بعد ما بعد الحداثة؛ أزمنة النص – ميديا.
المؤلف: هاني جازم الصلوي[1]
الطبعة: الثالثة.
مكان النشر: القاهرة.
الناشر: مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر.
تاريخ النشر: 2016.
الوصف المادي: 342 ص.، 24 سم.
الترقيم الدولي: 8-012-774-977-978.
يتكون الكتاب من إهداء وخاتمتين وضعهما المؤلف في مقدمة الكتاب، ثم تسعة فصول، وبعض الملحقات، وأخيرًا جاءت المقدمة في نهاية الكتاب. وقد جاءت عناوين الفصول كالتالي:
- المتن
- الرقمية بين إشكاليتي الورقية وهدم الأطر الفلسفية والنقدية
- الحداثة اللامتناهية الشبكية.. نافذة على فوضى الكائنات
- ما لا يعنيه اللاتناهي الشبكي: صراحة الفضيحة، وهم العمق
- الحداثة وما بعدها: تفاوض غير مجدٍ
- اللاتناهي الشبكي: انهيار المثقف وبروز مجتمع ما بعد الإعلام وما بعد الاستهلاك
- الفن اللامتناهي الشبكي
- ما قبل بعد ما بعد الحداثة، الحداثة، بعد ما بعد الحداثة
- جدليات اللامجتمع: اللامجتمع الافتراضي – المعتمد – المتون اللامتوازية
مقدمة:
يناقش كتاب “الحداثة اللامتناهية الشبكية” نهاية مرحلة “ما بعد الحداثة” وصعود مرحلة جديدة وهي “بعد ما بعد الحداثة”، ويرى المؤلف أن بعد ما بعد الحداثة ما هي إلا الحياة الرقمية التي أصبحنا نعيشها من خلال شبكة الإنترنت بعد أن أصبحت متاحة للجميع. وهكذا يحاول المؤلف تقديم رؤيته لـ”بعد ما بعد الحداثة” تحت مُسمى “الحداثة اللامتناهية الشبكية” ليرصد انتقال الحركة الإنسانية إلى الفضاء الرقمي؛ فاللامتناهي الشبكي يشير إلى شبكة الإنترنت اللامحدودة واللانهائية التي شكلت مجتمعا افتراضيا فاعلا يمارس أفراده حياتهم بشكل طبيعي فعلي على الإنترنت. وبالتالي يناقش المؤلف كيف أصبح شكل الإنسان والمجتمع في ظل الحداثة اللامتناهية الشبكية، وما هو تأثير الفكر الرقمي الشبكي على كلٍ من التعليم والسياسة والإعلام واللغة.
وقد نوه المؤلف أنه يمكن قراءة الكتاب من أي فصل أو مبحث يريده القارئ دون أن يؤثر هذا على فهمه أو تسلسل الكتاب، ولذلك لم تلتزم هذه المراجعة بترتيب الفصول الوارد في الكتاب، بل ناقشت الأفكار المهمة الواردة في نقاط محددة.
بعد ما بعد الحداثة؟
في الفترة الأخيرة، بدأ منظرو “ما بعد الحداثة” مثل إيهاب حسن وليندا هتشيون يتحدثون عن انتهاء مرحلة “ما بعد الحداثة”، لكنهم لم يقدموا نظرية أو اتجاهًا جديدًا يحل محل تلك المرحلة المنتهية. بينما قدّم باحثون آخرون بعض النظريات في السياسة والفلسفة والإعلام ونسبوها إلى مرحلة “بعد ما بعد الحداثة” على حسب تسميتهم، وهذه النظريات منها ما عاد إلى بعض الاتجاهات القديمة، ومنها ما ركّز على البُعد الرقمي مثل حداثة آلان كيربي الرقمية التي أكدت انتهاء ما بعد الحداثة وبداية الحداثة الرقمية. على صعيدٍ آخر، هناك بعض الاتجاهات الأحدث والتي لم تصرح بانتمائها لـ”بعد ما بعد الحداثة” لأنها ابتعدت في تنظيراتها عن التفكير الزمني، ولكنها تدور حول التكنولوجيا والحيوات الأحدث التي أنتجتها الرقمية، وربما انتمت هذه الاتجاهات إلى مرحلة بعد ما بعد الحداثة. أما على المستوى العربي، فقد حاول بعض الباحثين العودة الى التراث من أجل صياغة نظرية نقدية مثل محاولة عبد العزيز حمودة في كتابه “المرايا المحدبة” ثم كتابه “الخروج من التيه”، ويرى المؤلف أن هذه المحاولات لا تنتمي إلا إلى مرحلة الحداثة. أما محاولات محمد سناجلة وسعيد يقطين فيرى المؤلف أنها تنتمي لمرحلة ما بعد الحداثة لأنها نظرة حاسوبية صرفة؛ بمعنى أنها تركز على الحاسوب كأداة لا الإنترنت اللامتناهي. وهكذا بقيت الرؤى العربية حبيسة المراحل السابقة في نظر المؤلف.
ويرجع السبب في عدم ظهور نظرية متكاملة حتى الآن تتعلق بالبعد التقني أو حتى المعلوماتي -من وجهة نظر الكاتب- إلى أن الثورة الرقمية (وبعدها المعلوماتية) أربكت العلوم الإنسانية إرباكًا شديدًا؛ فالمجتمع الذي كان علم الاجتماع يدرسه بدأ يندثر ليظهر بدلًا عنه مجتمعًا افتراضيًا معلوماتيًا بمسلماته الاجتماعية المختلفة. وهكذا، تغير كل شيء مع ظهور الإنترنت؛ فظهر فضاء رقمي ومعلوماتي جديد، وهو فضاء اخترعناه كبشر ففُرِض علينا، وبالتالي ظهر “الفرد الإنترنتي” المتصل بالشبكة طوال الوقت، وظهر أيضًا “اللامجتمع المآل” وهو مجتمع افتراضي موازٍ للمجتمع الواقعي الذي يسميه الكاتب “المجتمع المعتمد”.
ولذلك، يحاول المؤلف في هذا الكتاب أن يطرح رؤيته لمرحلة بعد ما بعد الحداثة، ويؤكد أن بعد ما بعد الحداثة تمثّل الحياة الرقمية والشبكية التي أتاحها وجود شبكة الإنترنت بعوالمها اللانهائية، ولذلك يصفها بأنها “الحداثة اللامتناهية الشبكية” مشيرًا إلى عصر المعلومات في بُعده ما بعد الألفيني. هذه الحداثة اللامتناهية الشبكية تتضمن رؤية إلى “آليات جديدة في التفكير والفعل تحركها اللاخطية والتشعبية وانتهاء المفاهيم النصية التقليدية”.[2] مع ذلك، يدرك المؤلف جيدًا أن رؤيته تلك ليست نظرية فضلا عن أن تكون نظرية مكتملة، وإنما هي محاولة لتقريب المفاهيم والتعمق في رؤية المرحلة الجديدة.
بعد ما بعد الحداثة؛ نظرة تاريخية
حتى نستطيع فهم مرحلة “بعد ما بعد الحداثة”، يأخذنا المؤلف في جولة بين الحداثة وما بعدها لنتتبع الجذور التاريخية التي أفضت بنا إلى المرحلة الحالية. فكانت البداية مع الحداثة التي غيرت كل المفاهيم بما فيها مفاهيم التاريخ والفلسفة والإنسان، وأصبح الإنسان فاعلًا ومسئولًا ومسخرًا للعمل والإنتاج، يتعامل مع الطبيعة بميكانيكية شديدة من خلال الآلة الصناعية. وقد قامت الحداثة على الفردية والعقلانية والوضعية والاعتماد على العلم، كما آمنت بفكرة التقدم الخطي بمعنى تطور التاريخ الإنساني من مرحلة لأخرى بشكل تصاعدي.
ثم جاءت “ما بعد الحداثة” كرد فعل معارض للحداثة لتعلن رفضها الصريح لكل ما جاءت به الحداثة. وقد انقسم منظرو ما بعد الحداثة إلى فريقين فيما يخص العلاقة بين الحداثة وما بعدها: فريق يرى أن حركة ما بعد الحداثة تقوم على نفي الحداثة ورفض كل مبادئها، بينما الفريق الآخر يرى أن ما بعد الحداثة تعكس نوعًا خاصًا من التأزم في مسيرة الحداثة. وقسّم ليمرت المفكرين ما بعد الحداثيين إلى ثلاث فئات: الراديكاليون الذين يعتبرون الحداثة شيئا ينتمي للماضي من أمثال ليوتار وبورديار وإيهاب حسن، والاستراتيجيون الذين يعتمدون على اللغة والخطاب في تحليلاتهم ويرفضون فكرة المركزية أو القيم الشمولية من أمثال ميشيل فوكو وجاك دريدا، وأخيرا الحداثيون المتأخرون الذين ينقدون الأنساق الشمولية لكنهم لا يرفضون مفاهيم الحداثة بل يحاولون فقط تجديدها مثل هابرماس. وقد قامت “ما بعد الحداثة” بالقضاء على الصرامة والعقل والخطية، كما حطمت مفهوم الزمن وفكرة المركزية، وبشّرت بالنسبية واللاثبات واللايقين، وهذا -كما يرى المؤلف- ما عجّل في ظهور فضاءات اللامتناهي الشبكي والانتقال إلى “بعد ما بعد الحداثة”.
وقد ظل منظرو ما بعد الحداثة خائفين من التكنولوجيا (المتمثل وقتها في الكمبيوتر) وما تمثله من خطر على الإنسان، ولكنّ بعضهم قدّم اقتراحات أرهصت بالعصر الرقمي اللامتناهي. ففي أواخر القرن الماضي، بدأ بعض المفكرين في الحديث عن انتهاء مرحلة ما بعد الحداثة، ومن أوائل من أشاروا إلى ذلك: إيهاب حسن في مقاله “تجاوز ما بعد الحداثية” وليندا هاتشون. وهناك مَن بدأ الحديث عن التكنولوجيا كحاضن جديد مثل ليوتار وجيل دولوز وجيل ليبوفيتسكي. على الجانب الآخر أشار جان بودريار إلى “المجتمع الفائق” ليبدأ الحديث عن الفكر الفائق، ويرى المؤلف أن مرحلة الفكر الفائق -خلال نهاية الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي- هي القنطرة الحقيقية بين “ما بعد الحداثة” و”بعد ما بعد الحداثة”، كما يدخل ضمن القنطرة تلك النقاشات أو النظريات حول موت ما بعد الحداثة (وليس نهايتها).
وهكذا، كان موت “ما بعد الحداثة” يعني ميلاد “بعد ما بعد الحداثة” التي يراها المؤلف غير قابلة للتصنيف ومن الصعب حصرها في نظريات محددة. وبدأ المنظرون يضعون بعض النظريات والرؤى التي تنتمي لمرحلة “بعد ما بعد الحداثة”؛ مثل “عصر ما بعد الألفية”، و”ما بعد العلمانية”، “الحداثة المغايرة”، “الحداثة الزائفة أو الرقمية”، “التلبيدية”، “التعقيدية”، “الحداثة الآلية”، “الأدائية”، “الحداثة المتذبذبة”. لكن المؤلف يرى أن معظم هذه النظريات تنتمي إلى ما بعد الحداثة باستثناء الحداثة الرقمية والفائقة والتعقيدية والحداثة الآلية والتي ينتمي بعضها لبعد ما بعد الحداثة وينتمي بعضها الآخر إلى معطيات العصر الفائق.
كما يوجد تنظيرات عربية “نقلت جملة من مفاهيم بعد ما بعد الحداثة بوعي عميق ومختلف ككتابات نبيل علي مثلًا وأحمد أبو زيد والسيد ياسين أو دراسة علي رحومة (الإنترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية)”.[3]
بالتالي، بدأ الانتقال إلى مرحلة “بعد ما بعد الحداثة” -مع عصر المعلومات/الإنترنت- التي لا يعتبرها المؤلف ردة فعل على “ما بعد الحداثة” وإنما تطور طبيعي ونتيجة حتمية لكل الرؤى السابقة الحداثية وما بعد الحداثية، ومن هنا يقدّم رؤيته لمرحلة بعد ما بعد الحداثة تحت عنوان “الحداثة اللامتناهية الشبكية” ليعبّر عن الانتقال إلى فضاء الإنترنت الواسع واللامتناهي. ويرى المؤلف أنه مع قيام اللامتناهي الشبكي أصبح من الصعب الحديث بصورة زمنية؛ “فبعد الما بعد ليس إلا اللامتناهي المفتوح…هناك حداثات لانهائية وغير محدثة”.[4]
في نهاية هذه الجولة التاريخية، من المهم الإشارة إلى أن الآلة أو التقنية -حسب المؤلف- تشير إلى معانٍ مختلفة في كل مرحلة؛ ففي الحداثة كانت التقنية تشير إلى الآلة التي اخترعها الإنسان والتي تساعده في المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة والطباعة، أما التقنية في ما بعد الحداثة فتشير إلى البعد البرامجي للتكنولوجيا كأجهزة التلفاز والحاسوب، وأخيرا فإن التقنية تتعدى ذلك في ظل بعد ما بعد الحداثة لتدل على تشابك الحاسوب مع العالم الافتراضي والمعلوماتي (الإنترنت)، ولذلك يقترح المؤلف مفهوم الشبكية بدلًا من التقنية للتعبير عن تشابك التكنولوجيا مع الحياة اليومية في عصر بعد ما بعد الحداثة.
بعد ما بعد الحداثة؛ رؤية جديدة
يحاول المؤلف بلورة رؤيته لمرحلة بعد ما بعد الحداثة ويصك مصطلح “الحداثة اللامتناهية الشبكية” ليعرض من خلاله رؤيته لتحولات هذه المرحلة؛ فيحدثنا عن الإنسان الإنترني، وعن شكل المجتمع الافتراضي، وعن الإعلام، وعن الفلسفة والتعليم واللغة والنصوص في ظل الحداثة اللامتناهية الشبكية. لكنه لم يحدد مفهومًا محددًا للاتناهي الشبكي، ويرى أنه لا يمكن الإحاطة بمفهوم كهذا أصلًا لأن الفضاء الشبكي غير متناهي وغير محدود وبالتالي يصعب حصره في مفهوم محدد. ولذلك، في محاولة عرض رؤيته حول اللاتناهي الشبكي، يقوم المؤلف بالمقارنة بين الوضع ما بعد الحداثي وبين الوضع بعد ما بعد الحداثي لتتضح التغيرات التي أحدثها اللاتناهي الشبكي.
(أ) الإنسان والمجتمع في الحداثة اللامتناهية الشبكية
بدأ الإنسان يعيش في حياة “أجد” بعد ارتباطه بالإنترنت، فأصبح من الصعب اليوم النظر للكائن الإنساني بعيدًا عن مساراته التكنولوجية اللانهائية. وهكذا، أصبح لدينا الإنسان اللامتناهي الشبكي -المتصل دائما بشبكة الإنترنت-، والذي لا يحترم التراتبية الاجتماعية، فهو فاعل “داخل دوامة انكسار الأدوار الاجتماعية”، بمعنى أنه يعيش على الشبكة بحرية وتجرد دون أن يعرف سن أو عرق الأشخاص المقابلين له على الشبكة. هذا الإنسان يعيش في نوع من الفوضى وعدم الثبات، يُقدّم الفعل على التأمل، كما أنه يعيش على السطح فلا يتعمق في أي شيء، وهذا كله نتيجة السرعة الفائقة للحياة على الإنترنت. هذا الإنسان إيجابي وفاعل وغير مهزوم، كما أنه يشعر بالحرية والاستقلالية والثقة في النفس لأن الشبكة اللامتناهية سمحت له بالإنجاز والتحكم من أي جهاز إلكتروني.
والعمل بالنسبة للإنسان ليس لتحقيق متطلبات الحياة أو الواجبات الوطنية أو الأسرية، بل إن العمل يكون من أجل تحقيق متعته الخاصة، فهو يعمل ليستمتع وليُمضي الوقت. كما لم يعد يخضع لسلطة مؤسسة أو رقيب توجهه كما تشاء، فالفرد أصبح قائد نفسه -أو أنفسه المتعددة- الموجودة على الشبكة، لكنه مع ذلك -كما يؤكد المؤلف- يشعر بمسئوليته الفردية التي نبعت من استقلاليته. فإذا كان الإنسان في ما بعد الحداثة يائسًا ومهزومًا، نجده في بعد ما بعد الحداثة متفائلًا وواثقًا من قدراته؛ فقد منحت الشبكيةُ الإنسانَ إحساسا بالسيطرة والإنجاز بسبب التدفق اللامحدود للمعلومات والذي فتح أمامه خيارات وبدائل لا نهائية.
ويبدو أن المؤلف متفائل بالوضع الجديد للإنسان في مرحلة بعد ما بعد الحداثة؛ حيث يرى أن الإنسان اللامتناهي الشبكي يتوفر لديه قدر كبير من الاستقلالية والحرية والثقة بالنفس، كما يرى أنه تخلّص من كل السلطات التي كانت تكبل حركته في مرحلة الحداثة أو ما بعد الحداثة، فلم تعد الدولة أو الإعلام قادرين على إحكام سيطرتهم عليه في ظل وجود الإنترنت (الشبكة اللامتناهية) الذي يزوده بقدر لا محدود من المعلومات والأخبار ويفسح له المجال لتبني هويات لا نهائية، فهو يفترض أن الإنسان أصبح قادرا على التوصل للمعلومات والمعارف بنفسه في ظل الشبكة اللامتناهية وبالتالي أصبح مالكا لأمره لا يستطيع أحد التحكم فيه.
لكن ربما تسرّع المؤلف في تفاؤله أو غالى فيه؛ فكيف يستطيع الإنسان التعامل مع هذا القدر اللانهائي من المعلومات/الحرية؟ بمعنى آخر ما الذي يضمن لنا أن الإنسان قادر على التعامل مع هذا المقدار الكبير من الحرية بحكمة وبشكل صحيح؟ وكيف يتعامل مع الكم الكبير من الإشاعات والمعلومات الخاطئة؟ ومن جهةٍ أخرى يمكن أن نرى بوضوح أن الإنسان لم يتحرر بشكل كامل بعد، فمازال هناك العديد من الجهات التي تحاول السيطرة والتحكم بالإنسان من خلال الإنترنت؛ هناك الشركات المتحكمة في بعض المواقع -خاصةً مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الناس بكثافة- والتي تهدف للربح وتوجيه الأفراد/المجتمعات. كما أن فضاء الإنترنت يتم استغلاله من قِبل بعض الدول التي تستخدم المواقع المختلفة للترويج لبعض الإشاعات وتوجيه الرأي العام العالمي. حتى المواقع الإخبارية التي انتقلت إلى فضاء الإنترنت لازالت تستخدم استراتيجيات التلاعب والتعتيم التي كانت تمارسها سابقا من خلال التلفاز. لذلك، ربما يكون من التسرع أن نظن أن الإنسان تحرر من قيوده مع مجئ الإنترنت.
وبالنسبة للمجتمع؛ فمجتمع بعد ما بعد الحداثة يصفه المؤلف بأنه مجتمع ما بعد الإعلام؛ فإذا كنا نحيا في مجتمع الإعلام أو مجتمع الوسائط في زمن ما بعد الحداثة بسبب سيطرة الإعلام وتحكم التلفزيون والوسائط الأخرى على حياة الأفراد وقتها، فإننا نحيا أو نتفاعل في مجتمعات ما بعد الإعلام في مرحلة الحداثة اللامتناهية الشبكية حيث سمحت الشبكية للأفراد بأن يكونوا مستهلكين ومنتجين للإعلام في نفس الوقت، كما منحتهم الحرية في عوالمها اللامتناهية. وهو مجتمع ما بعد الاستهلاك؛ فإذا كان المجتمع استهلاكيا في مرحلة ما بعد الحداثة حيث شاع الاستهلاك كثقافة وقتها، فهو مجتمع ما بعد استهلاكي لأن الاستهلاك اللامتناهي الشبكي “بمجانيته ولاغائيته متطاير في أبعاد لانهائية من الإنتاجية الحرة”،[5] كما يُعتبر الاستهلاك هنا ممارسة وليس ثقافة حيث يكون استهلاك الفرد تلقائيًا وآنيًا ولا يأخذ وقتًا للتفكير والتخطيط.
يرى المؤلف أيضًا أن هذا المجتمع الذي نتج عن اللاتناهي الشبكي هو مجتمع اللامكان “placeless society”؛ حيث يتواجد فيه كل شخص وكل شيء في كل مكان، وهذا اللامكان الذي أصبحنا نحيا فيه على الشبكة هو البُعد الرابع (السائل) كما يشير ويليام نوك.
ويميز المؤلف بين ما يسميه “المجتمع الافتراضي في صيغته اللامتناهية الشبكية (أو مجتمع المآل) وبين المجتمع المعتمد. المجتمع الافتراضي هو المجتمع الذي انتقل بشكل كامل إلى فضاء الإنترنت ليتفاعل فيها، وهو مجتمع الفعل اللامتناهي حيث الأفراد في حركة دائمة لا تتوقف في عوالم الشبكية، وحيث يمكن للأفراد تغيير هوياتهم في كل لحظة. أما المجتمع المعتمد هو الذي يعتمد على مجتمع المآل حيث أنه لم ينتقل بشكل تام إلى فضاء الإنترنت ولم يتحول إلى مجتمع افتراضي بعد، ومازال يتواصل كتابيًا لا رقميًا، وهذه الصيغ الاعتمادية للمجتمع هي التي تنتمي لها نظريات الفكر الفائق لبودريار والفكر التواصلي لهابرماس. ورغم أن المؤلف يرى أن الأصل هو المجتمع اللامتناهي الشبكي الذي انتقل بشكل كامل إلى فضاء الإنترنت وينتقد المجتمع المعتمد بسبب خوفه من فضاء الإنترنت، إلا أنه لم يُشر إلى التبعات المؤلمة والخطيرة لعيش الفرد/المجتمع حيوات شبكية (افتراضية) بعيدة عن الواقع.
(ب) الفلسفة والفيلسوف في الحداثة اللامتناهية الشبكية
وجهّت ما بعد الحداثة ضربة قاصمة للفلسفة من حيث رفضها للسرديات الكبرى؛ فلا يوجد مركز ثابت أو يقين، كما لا يوجد إيمان بعقل أو تقدم. مع ذلك يرى المؤلف أن الفلسفة لم تفقد معناها تماما في مرحلة ما بعد الحداثة لأن منظري ما بعد الحداثة لم ينكروا وجود المعنى بصيغته البسيطة، “بل أشاروا إلى أن اللامعنى هو المعنى، وأن اللايقين هو اليقين، وأن اللاحقيقة هي الحقيقة”[6]، فقد قدّموا تصورا جديدا للحكمة (الفلسفة) يستند إلى النفي والسلب والتغير بدلا من الثبات والإيجاب الذي كان موجودًا في مرحلة الحداثة، لكن تَغَيَر كل هذا مع بعد ما بعد الحداثة خاصةً في صورتها اللامتناهية الشبكية، فقد فقدت الفلسفة معناها التقليدي هنا (حب الحكمة).
وقد انعكس تغير مفهوم الفلسفة على مكانة الفيلسوف أيضا؛ ففي مرحلة الحداثة، كان الفصل بين التفكير والفعل (النظرية والتطبيق) واضحًا، وكان للفيلسوف والمثقف والمفكر مكانة عالية في المجتمع لأنه يفكر نيابةً عن المجتمع بما يمتلكه من قدرات وتجارب. أما مرحلة ما بعد الحداثة، فقد نادى منظروها بسقوط المنهج والنظرية في محاولة لإنهاء هذا الفصل بين التفكير والفعل. لكن المؤلف يرى أن مفكري ما بعد الحداثة حاولوا تفكيك تلك النظرة إلى الفيلسوف والمفكر باعتباره مالك للحقيقة وممثل للمجتمع، إلا أنهم لم يلغوا وجوده كليا، بل قاموا بتغيير دوره وتحجيمه عما قبل؛ فأصبحت وظيفة المثقف هي أن “يكون لسان حال الهامشيين أو المرأة أو شعوب العالم الثالث” كما يقول جاك دريدا. ورغم أن منظري ما بعد الحداثة لم يستطيعوا إزالة السد القائم بين التفكير والفعل، إلا أنهم تمكنوا من توجيه ضربات حادة لهذا السد مما هيأه للزوال مع الحداثة الشبكية. ففي ظل الحداثة اللامتناهية الشبكية، لم يعد لمصطلح “المفكر” أو “المثقف” قيمة، حيث يستطيع كل فرد أن يكون مفكرا ومثقفا دون أن يحتاج إلى من يفكر بالنيابة عنه في المساحات الافتراضية.
(ج) التعليم والإعلام في الحداثة اللامتناهية الشبكية
كان التعليم في ما بعد الحداثة يوظف أدوات التكنولوجيا من تلفزيون وكمبيوتر، و في هذه المرحلة انتهى التلقين والحفظ والاسترجاع مع بروز أفكار ما بعد البنيوية لتظهر بدلًا عنها نظريات التعلم الذاتي والتعلم عن بُعد، لكن ظلت الجدية والصرامة قيمًا مهمة في عملية التعلم.
أما مع ظهور الإنترنت، فيرى المؤلف ضرورة تغيير طرق التعليم وأن ينطلق التعليم من أفكار اللاتناهي الشبكي وفق مدخل تربوي رقمي؛ حيث تصبح الآلة (الكمبيوتر أو الموبايل …) شريكًا فاعلًا في عملية التعلم وليس مجرد أداة. كما يرى المؤلف أن فكرة المدرسة سقطت مع الحداثة اللامتناهية الشبكية، فلا حاجة إلى المدرّس نفسه ولا إلى مؤسسة مقدسة كالمدرسة كما كان سابقا، فالعلوم أصبحت متداخلة، كما أصبح تقدم العلم بطيئا أمام سرعة التكنولوجيا، ولهذا من الضروري أن يكون التعليم افتراضيًا معتمدًا على شبكة الإنترنت؛ فالشبكة العنكبوتية أصبحت مصدرا للمعلومة يتوجه إليها الناس للبحث عن أي معلومة حتى قبل توجههم للمدرسة أو الجامعة.
وإذا كان اللعب وسيلة تعليمية مهمة في المجتمع ما بعد الحداثي، فإن المجتمع الافتراضي الشبكي يصبح “مجتمع ما بعد اللعب” بحيث تتداخل الحدود بين اللعب والتواصل والتعلم؛ فعلى الشبكة يكون لدى الفرد مساحة واسعة للتعلم واللعب والتواصل في نفس الوقت.
أما بالنسبة للإعلام، فكانت مرحلة ما بعد الحداثة توصف -في الدراسات الإعلامية- بأنها عصر الوسائط المتعددة أو عصر الصورة؛ حيث كان الإعلام قائمًا على وجود مرسِل يرسل لمستقبِل عبر وسيلة (مذياع أو تلفزيون أو كمبيوتر …)، ولأن وسائل الإعلام مملوكة من فئات معينة قليلة فإنها تقوم بالتلاعب بالمستقبِل لدرجة أنه لا يصدق أي شيء غير ما شاهد في التلفزيون أو سمعه في الإذاعة. وفي غمرة ما بعد الحداثة قدم ماكلوهان مفهومه القائم على أن الوسيط هو الرسالة. بعد ذلك مع مجيئ الفكر الفائق، أصبح عصر الصورة عصرا زائفا عند جان بودريار وتلاميذه. كما أن التباين الكبير في امتلاك وسائل الإعلام أدى إلى ظهور نظرية الإمبريالية الإعلامية التي ترفض عولمة الإعلام التي -في نظرها- تعكس الهيمنة الأمريكية وذوبان هوية الأقليات نتيجة الضخ الإعلامي الموجَّه.
مع إتاحة الإنترنت للجميع، أصبحت المسافات تتلاشى بين المرسِل والمستقبِل والوسيلة في مرحلة بعد ما بعد الحداثة كما يرى المؤلف؛ فالفرد (المستقبِل) لا يتلقى مسلمات معلّبة من أجهزة الإعلام الموجهة، بل يتفاعل مع أفراد آخرين على شبكة الإنترنت اللانهائية، ويمكن أن يكون هو المرسِل في أي وقت. كما أن الشبكة أتاحت للفرد “قيادة العالم من على الحاسوب” ليصبح الفرد هو قائد نفسه، وهو ما زاد من ثقته بنفسه وشعوره بالاستقلالية. في ظل الشبكة اللانهائية، أصبح الفرد يعيش حيوات مختلفة عن الأنماط الواقعية للحياة، حيوات لا يوجد فيها تكرار أو تقليد، بل يصبح كل يوم على الشبكة مختلفا عن سابقه، كما أنه يكون فاعلا فيها ومنتجا للأفكار والرؤى إن أراد، ويصبح لديه هويات لانهائية. وبهذا أصبحت السرعة هي السمة الأكثر بروزا لمجتمعات اللاتناهي الشبكي، وأصبحت الإشاعة هي الأساس هناك. بالتالي يرى المؤلف أنه لا جدوى من الحديث عن نظرية للإعلام في ظل وجود الإنترنت السريع واللامحدود.
(د) الأدب والفن في في الحداثة اللامتناهية الشبكية
ولأن المؤلف شاعر بالأساس، فإنه يتحدث عن التغيرات التي أصابت الأدب والشعر في مرحلة الحداثة اللامتناهية الشبكية. فيبدأ المؤلف بالحديث عن “الأدب الرقمي”، ويفرّق بين الأدب الرقمي في عصر ما بعد الحداثة والأدب الرقمي في عصر بعد ما بعد الحداثة؛ ففي عصر ما بعد الحداثة كان النص يتم إنتاجه عبر الحاسوب وكان الحاسوب مجرد أداة أو وسيلة للإنتاج، لذلك سُمي هذا العصر بعصر الوسائط والإعلام. أما في عصر بعد ما بعد الحداثة فالنص يعتمد على الحاسوب (أو الموبايل) المتصل بشبكة الإنترنت اللامتناهية، فلا بد أن يظهر على الإنترنت وتعتمد كلياته وجزئياته على اللاتناهي الشبكي، كما أن الحاسوب (أو الموبايل) شريك فاعل في كتابة النص هنا لأنه يقدّم اختيارات للكاتب ويشاركه في الكتابة، فلم يعد الحاسوب أداة بل أصبح فاعلا مشاركا يتيح للكاتب مطلق الحرية في الإضافة والتعديل والحذف، بل ربما يتيح أيضًا للقارئ حرية التعديل والإضافة والحذف. ويصف المؤلف هذا النص الجديد بأنه نص متشظٍ بعيد عن كل التعقيدات والتقسيمات، وهو نص متصالح مع كل أنواع الكتابة.
ويرى المؤلف أن الكتابية أو الورقية (استخدام الورق في عملية الكتابة) تعد إشكالية عند الحديث عن النص اللامتناهي الجديد، لأن الكتابية تنتمي لمرحلة سابقة من المفترض أنها انتهت، فمن المفترض أن تنتمي الكتابية لما بعد الحداثة وربما حتى الفكر الفائق، لذلك كان استعمال الكتابة مقبولا وحتى خلاقا في مرحلة التقنية ما بعد الحداثية، لكن مع اللاتناهي الشبكي من المفترض أن يصبح النص رقميًا تماما، فالنص اللامتناهي من المفترض أنه مُنتَج من أوله إلى آخره عبر الإنترنت. ومع ذلك يعترف المؤلف أن سمة الكتابية مازالت حاضرة في العصر المعلوماتي الشبكي، وهذا يُشكّل مأزقًا بالنسبة للمؤلف، فكثير من المصطلحات مثل “الورق”، و”الكاتب”، و”الأداة” يراها المؤلف من مخلفات المرحلة الماضية التي يجب تجاوزها مع انتقالنا لمرحلة الحداثة اللامتناهية الشبكية.
والنص الرقمي يرفض البنيوية (الحداثية) لأن البنيوية تهتم ببنية النص وتركز على اللغة بشكل محض، أما الفكر الرقمي فلا يهتم ببنية النص ويعتبر النص مكونًا من اللغة والحركة والصوت والصورة، فاللغة جزء بسيط من هذا النص. أما نظريات ما بعد البنيوية (ما بعد الحداثية) فبعض نظرياتها بعيدة تماما عن الفكر الرقمي، والبعض الآخر متداخل مع الفكر الرقمي؛ فمن الأفكار ما بعد الحداثية والتي نجدها متداخلة مع الفكر الرقمي: نظرية “استجابة القارئ” والتي يعدها المؤلف إرهاصًا للنص الرقمي، حيث يكون القارئ العنصر الأهم في العملية وهو مُنتِج النص ومعناه بغض النظر عن مقصد الكاتب الذي أقصَته النظرية نهائيًا، فالنص هو عبارة عن فراغات يملؤها القارئ حسب رؤيته. ومن الأفكار المتداخلة أيضا: فكرة “موت المؤلف” التي نادى بها بارت، وهذه الفكرة تجسدت بالفعل في النص الرقمي إذ “لم يعد هناك مؤلف وقد أصبح نصه عرضة للتطوير والحذف والمحو”.[7] ومن الأفكار أيضًا “التناص” والتي تشير إلى تداخل النصوص وإحالة النص إلى غيره من النصوص، وهذا التناص يظهر أيضًا في النص الرقمي فيما يسميه المؤلف “التناص الرقمي”.
كما يفرّق المؤلف بين 4 أنواع من النص الجديد؛ فهناك “نص التأسيس” وهو نص بصري يلعب على خصائص قصيدة النثر[8]، ونص يسمح بالمحو والحذف والتعديل، وهو نص واضح لا يتعمد استعمال ألفاظ غريبة تصدم القارئ، كما يستفيد من اللهجات العامية ويستخدم ما يناسبه من مفرداتها وسياقاتها، وهو نص متعدد المراجع يحيل لاتجاهات ومتغيرات كثيرة. وهناك “النص الجماعي” وينطبق عليه ما قيل عن النص التأسيسي، إلا أنه يزيد عليه ببروز السمة الجماعية أثناء الكتابة، فهو نص يكتبه أكثر من كاتب بالإضافة للآلة (الحاسب، الموبايل)، ويمكن أن يتاح للجمهور مساحة التعديل والإضافة عليه. وهناك نص ثالث هو “نص الموبايل” وهو نص يميل إلى الاختزال أكثر من سابقيه بسبب قصر مدة الكتابة. وأخيرا، هناك “النص التفاعلي/الرقمي” وهو نص الإحالات أو الهايبرتكست، لكن المؤلف لم يوضح ماهيته وأسباب اختلافه عن سابقيه.
وبالنسبة للفن، يفرق المؤلف أيضا بين فن ما بعد الحداثة وفن بعد ما بعد الحداثة. فن ما بعد الحداثة هو فن تكنولوجي في نظر المؤلف، وقد قام الكثيرون بالتنظير لعلاقة التكنولوجيا بالفنون من زاوية أدب الخيال العلمي مثل ديفيد هارفي الذي اختار فيلمين لهما علاقة بالخيال العلمي عندما أراد دراسة الزمان والمكان في سينما ما بعد الحداثة، كما قدّموا كثيرا من الخصائص الجديدة للسرد التكنولوجي مثل دوجلاس كلنر الذي اعتبر عامل السرعة والطاقة والمفاجأة من الخصائص الأسلوبية للسرد التكنولوجي. ويقوم السرد ما بعد الحداثي على متواليات ضياع المعنى حيث تتقارب خيوط السرد وتتباعد بلا ضابط نقدي صارم، كما يقوم السرد على التمثيل الساخر.
أما فن بعد ما بعد الحداثة فهو فن ما بعد تكنولوجي، وهذا الفن اللامتناهي الشبكي يتميز أيضا بالخصائص الثلاثة التي ذكرها كلنر (السرعة والمفاجأة والطاقة)، ولكن دون محددات نظرية ووفق خصائص آلية لامتناهية مثل اللاخطية والتشعب. هذا الفن يعتمد على الشبكة العنكبوتية؛ حيث يكون الكمبيوتر المتصل بالويب فاعلا رئيسيًا في صناعة الفن وإنتاجه مثلما هو فاعل رئيسي في عملية الكتابة. ويأخذ السرد اللامتناهي الشبكي صيغا غير ثابتة، كما ظهر نمط من الروايات تعتمد الشكل الرقمي بشكل تام مثل روايات الشات.
في النهاية
رغم أن لغة الكتاب جاءت مفككة وكانت الجُمل غير مرتبة ويصعب فهم مراد المؤلف منها، إلا أن الأفكار الرئيسية التي قدّمها الكتاب كانت واضحة. حاول المؤلف أن يناقش “بعد ما بعد الحداثة” على المستوى النظري وعلى المستوى الواقعي. فعلى المستوى النظري، ظهرت العديد من النظريات والرؤى التي يزعم أصحابها أنها تنتمي إلى بعد ما بعد الحداثة، إلا أن المؤلف يرى أنها تنتمي إلى مراحل أسبق، ولا يقبل إلا النظريات التي تتحدث عن فضاء الإنترنت الشبكي اللامتناهي لكي يعتبرها منتمية إلى بعد ما بعد الحداثة. وعلى المستوى الواقعي، حاول المؤلف إلقاء الضوء على جوانب مختلفة للمرحلة الجديدة التي أربكت العلوم الإنسانية وحتى الحياة اليومية، والتي مازال الأفراد والمجتمعات يعانون في محاولة التأقلم مع تغيراتها السريعة والمتتابعة.
لكن ما يعتبره المؤلِف شيئًا إيجابيًا ننظر إليه نحن بعين الريبة والحذر؛ فالانفتاح على كل الآراء الذي أتاحه اللاتناهي الشبكي والسماح للجميع أن يتحدثوا بغض النظر عن خلفياتهم ومعلوماتهم لم يصنع أفرادا أكثر استقلالية وحرية، بل جعلهم أكثر اعتمادية على آراء ورؤى الآخرين ممن ليسوا من أهل الخبرة أو المعرفة. وقبل ذلك، هل هناك انفتاح حقيقي على كل الآراء؟ فالفيس بوك مثلًا يتيح لك نظريًا أن تشارك ما يجول بخاطرك، لكنه عمليًا يفرض قيودًا عند الحديث عن بعض الموضوعات التي تتعارض مع سياسته، كما يقوم بالتعتيم على بعض الأخبار مثلما حصل في أحداث فلسطين الأخيرة. أما تويتر فقد قام بتعليق حساب دونالد ترامب بشكل دائم. أصبحنا إذن أمام سلطة جديدة تتوحش وتتحكم وتوجه الأفراد.
لم يوفر الإنترنت فضاء أكثر حرية، بل سمح للفوضى والعبثية أن تصبحا الأساس الذي يحيا فيه الأفراد، كما أنه من الصعب الجزم أن هؤلاء الأفراد قادرين على التعامل مع هذه الفوضى والسرعة التي أصبحوا يعيشون داخلها. وماذا عن الهويات اللانهائية التي يمكن للفرد أن يتبناها على شبكة الإنترنت؟ ما تأثيرها عليه هو وعلى المجتمع الذي يعيش بداخله؟
عرض
أ. تقى محمد يوسف
باحثة في العلوم السياسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]كاتب وشاعر يمني يقيم في القاهرة، مهتم بتحليل الخطاب والفكر الرقمي، صدرت له 6 مجموعات شعرية.
[2] ص. 128.
[3] ص. 276
[4] ص. 279
[5] ص. 210.
[6] ص.197.
[7] ص. 107.
[8] قصيدة النثر هي قطعة نثر غير موزونة وتكون متحررة من القوالب التقليدية للشعر، لكن المؤلف يرى أنها أصبحت قديمة بعدما ظهر النص الرقمي/الإلكتروني المتحرر أكثر.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies