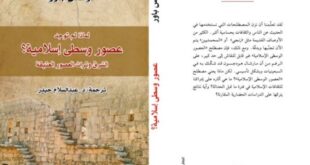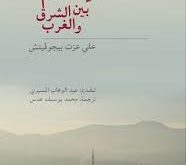العنوان: جيفرسون والقرآن.. الإسلام والآباء المؤسسون.
المؤلف: دينيس أ.سبلبيرغ.
ترجمة: فؤاد عبد المطلب.
الناشر: جداول للنشر والترجمة والتوزيع.
مكان النشر: بيروت.
تاريخ النشر: 2015.
الوصف المادي: 420 ص، 24 سم.
الترقيم الدولي الموحد: 5-289-418-614-978.
يعد هذا الكتاب بمثابة المنقب عن جوانب مجهولة نسبيا في التاريخ الأمريكي الحديث ، فنظرا للأحداث المعاصرة السريعة والجدالات التي لا تنتهى حول مسالة الحرية الدينية ومكانها في الواقع الأمريكي حاضرا وماضيا والأزمات التي يتعرض لها النموذج الأمريكي الليبرالي من تشوهات بفعل الاضطهاد الديني والعرقي الذي يتعرض له الداخل الأمريكي بين الحين والآخر، تأتى الكاتبة والباحثة الأمريكية المتخصصة في التاريخ الإسلامي والناشطة في مجال حماية الحقوق المدنية دينيس أ.سبلبيرغ لتكشف في كتابها الصادر في اكتوبر عام 2013م “جيفرسون والقرآن الإسلام والآباء المؤسسون” عن جانبا غير معروف كثيرا من تاريخ المؤسسين الأوائل للولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرية الدينية الأمريكية، حيث تتناول في كتابها كيف استطاع الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، والذى كان جيفرسون أبرزهم، أن ينظروا إلى أفكار حركة التنوير فيما يخص التسامح الديني وخاصة مع المسلمين الذين يعتبرون من وجهة النظر السائدة لديهم ولدى الغرب عامة أنهم أبعد الناس عن المجتمع الغربي، وفى هذا السياق تتناول سبلبيرغ جيفرسون باعتباره أبرز من اضطلع بهذه الفكرة ولأن مكتبته احتوت على نسخه مترجمة من القرآن مما جعله محل نظر وبحث.
تتبع الكاتبة في كتابها أسلوبا سرديا مما يجعل القارئ في حالة دائمة من التشويق، إلا أن أثناء السرد تمر الكاتبة على الكثير من الشخصيات تعرفهم بتعريف مقتضب في ثنايا حديثها، وهذا مما يؤثر على قدرة القارئ في فهم السياقات وربطها ببعضها، فحبذا لو أسهبت في التعريف في هوامش الكتاب.
يستهل الكتاب بمقدمتين أحدهم للمترجم والأخرى للكاتبة، وينقسم الكتاب إلى سبعة فصول وكلمة ختامية
فصول الكتاب
المقدمة: تخيل المسلم مواطنا عند تأسيس الولايات المتحدة
الفصل الأول: الأصول المسيحية الأوروبية للأفكار الأميركية السلبية ولكن الدقيقة أحيانا حول الإسلام والمسلمين 1529-1797
الفصل الثاني: الأسبقيات المسيحية الأوروبية الإيجابية للتسامح مع المسلمين ووجودهم في أمريكا الاستعمارية (1554-1706)
الفصل الثالث: ما تعلمه جيفرسون- وما لم يتعلمه من القرآن: آراؤه السلبية عن الإسلام، واستعمالاتها السياسية المتباينة مع دعمه للحقوق المدنية الإسلامية 1765- 1786
الفصل الرابع: جيفرسون مقابل جون أدامز: مشكلة القرصنة الأفريقية الشمالية ومفاوضتهما مع سفير مسلم في لندن 1784-1788
الفصل الخامس: هل يمكن لمسلم أن يصبح رئيسا؟ الحقوق الإسلامية وإقرار الدستور 1788
الفصل السادس: جيفرسون بين الحرب ضد قوة إسلامية، ويستضيف أول سفير مسلم ويقرر أين يضع القرآن في مكتبته ويؤكد دعمه للحقوق الإسلامية 1790-1823
الفصل السابع: ما بعد التسامح، جون ليلاند المعمداني المدافع عن حقوق المسلمين 1776-1841
كلمة ختامية
مقدمة:
تبين الكاتبة في مقدمتها السياق التاريخي الذي يدور فيه موضوع الكتاب، وتوضح أن الكتاب هو محاولة لفهم علاقة المؤسسين الأوائل للولايات المتحدة، وعلى رأسهم جيفرسون، بالإسلام والتسامح مع المسلمين، وذلك في ظل العنف بين الطوائف المسيحية في أوروبا وصورة الإسلام المشوهة التي كرستها أوروبا والتي لم تخلو منها العقلية الأمريكية، ويفتح هذا الاهتمام الاستثنائي من بعض الأفراد بحقوق المسلمين كما تشير الكاتبة نقاشا حول الحرية الدينية وحرية بعض الأقليات الأخرى المكروهة ايضا كاليهود والكاثوليك وجميع من هم من غير البروتستانتيين، و كذلك علاقة الحكومة بالدين، مؤكدة على أن اهتمام جيفرسون والآباء المؤسسين بحقوق المسلمين لم يكن نابعا عن أي تقدير منهم للمسلمين ولا لدين الإسلام، بل كان رغبة منهم في إنشاء أمة تتمتع بالتعددية والحرية الدينية، وكان المسلمين مجرد مواطنين متخيلين في ذلك النقاش الدائر حول مستقبل التعددية في الأمة الأمريكية والتي أراد جيفرسون أن تتحقق فيها المساواة، وفى هذا السياق يأتي هذا الكتاب لينظر في وضع المسلمين وقت تأسيس الولايات المتحدة وسؤال المواطنة الكاملة لهم والتي مازالت مهددة.
الفصل الأول
الأصول المسيحية الأوروبية للأفكار الأميركية السلبية ولكن الدقيقة أحيانا حول الإسلام والمسلمين 1529-1797
يهدف هذا الفصل إلى توضيح التحامل المسيحي الأوروبي ضد المسلمين وجذوره وصوره، وكيف استخدم المسيحيون من جميع الطوائف الخطابات المعادية للإسلام كسلاح لتشويه سمعة بعضهم البعض.
تقول سبلبيرغ بأن عداء البروتستانت الأمريكيين للإسلام ورثوه من خلال مصلحي القرن ال16 البروتستانتيين في أوروبا، الذين صوروا المسيح الدجال بأنه تارة البابا الكاثوليك وتارة أخرى بالسلطان العثماني وجيشه الذي يتقدم نحو أوروبا، فعلى سبيل المثال قام المصلح البروتستانتي مارتن لوثر بتصوير المسيح الدجال بأنه عدو مزدوج فهو البابا الكاثوليكي والسلطان العثماني في آن واحد، أما جون كالفن الفرنسي فصوره بأنه النبي محمد ﷺ وأنه توأم البابا الكاثوليكي، وهم بذلك يريدون تشويه سمعة الكنيسة الكاثوليكية بتشبيهها بالإسلام. وفى المقابل فعل الكاثوليك ما فعله البروتستانت باستخدام الإسلام لتشويه سمعة الطائفة البروتستانتية، فمثلا قام أحد رجال الدين الإنغليكان همفرى بريدو بوصف النبي محمد ﷺ بأنه مخادع ومقاتل متطرف حمل القرآن في يد والسيف في اليد الأخرى وبهذا المعتقد بدأ يهاجم البروتستانت بعقد مقارنة بينهم وبين الإسلام.
إذن فقد وصم الإسلام ونبيه وحكامه من جانب الطوائف المسيحية كلها بالاستبداد والتوحش، وتم استخدامه ليوصموا به بعضهم البعض متجاهلين -كما ذكرت الكاتبة- حقيقة القانون الإسلامي الذي يعيش في كنفه اليهود والمسيحيين بسلام في ظل الحكم العثماني.
ثم تنتقل سبلبيرغ لتوضيح كيف تبنى الأمريكيون كمواطنين في أمة جديدة العقيدة البروتستانتية، وتبنوا معها المخاوف من الإسلام والكاثوليكية، ومن ثم كان لهذا الارتباط بين الإسلام المتوحش في نظرهم والكاثوليكية المستبدة أثر كبير في تحاملهم المستقبلي ضد المسلمين والكاثوليك كونهم مواطنين محتملين في الدولة الجديدة.
وفى ذلك الوقت تعرض الأمريكيون لكم كبير من المقالات البريطانية المعارضة للدولة العثمانية ولدول أفريقيا الشمالية الإسلامية والتي تصف دول العالم الإسلامي بالاستبداد والطغيان، وجاء ذلك في مجموعة من الرسائل عرفت برسائل (كاتو)، التي ربطت الاستبداد العثماني بالإسلام، وادعت أن الإسلام كدين يفرض استسلاما أعمى للسلطان، ومن ثم وجد هذا الخداع جمهورا جاهزا بين البروتستانت، وكانت هذه الرسائل مصدر إلهام للثوار الأمريكيين لتشويه سمعة الاستبداد البريطاني عن طريق تشبيهه بالإسلام. وهكذا ظل الإسلام الذي صور بأنه مصدر الاستبداد والطغيان سلاحا يستخدمه البعض ضد البعض.
لقد كان الأوروبيون يستخدمون تعبيري تركي ومسلم بشكل مترادف متجاهلين الهويات المتعددة التي تضمها الأمة الإسلامية، وكان التركي بالنسبة لهم يمثل الهمجية والسلوك القاسي المستبد، وكذلك كانوا يطلقون تعبير “محمدي” على المسلم بما يوحي بأنه متعبد لمحمد بدلا من عبوديته لله وحده، وورث الأمريكيون هذه التصورات الخاطئة، وكانوا يشيرون إلى الدين بأنه المحمدية بدلا من الإسلام، وللقرآن بأنه قرآن محمد، تلميحا بأن النبي كان مؤلف النص المقدس، وهكذا تكوًن الفهم الشعبي للإسلام سواءً في أوروبا أو أمريكا.
وفى إطار الوقوف على جذور الفهم المشوه لدى الأوروبيين والأمريكيين عن الإسلام تذكر سبلبيرغ أول مسرحية عن الإسلام عرضت في أمريكا من تأليف فرانسوا ماري أوريه المعروف باسم فولتير، وعرفت المسرحية باسم “التعصب” أو “النبي محمد” تذكر الكاتبة في هذا السياق كيف صورت هذه المسرحية النبي محمد ﷺ بشكل ساخر جعلته مخادعا دينيا ومتعصبا سياسيا، وكان فولتير يصنع بذلك سياقا إسلاميا متخيلا ليهاجم السياسة الوطنية الكاثوليكية تحت مظلة تشبيهها بالإسلام ليتجنب بهذا النقد غير المباشر غضبة رجال الدين والحكومة الكاثوليكية، وتذكر الكاتبة كيف استخدمت المسرحية في سياقات مختلفة لنقد أنظمة مختلفة، فاستخدمت في بريطانيا ضد فرنسا والكاثوليكية، واستخدمت في بريطانيا أيضا لنقد الثورة الأمريكية، واستخدمها الأمريكيون لنقد الاستبداد البريطاني.
وفى نهاية هذا الفصل تبين سبلبيرغ إجمالا ما ستفصله في الفصل الرابع حول العلاقة بين أمريكا ودول أفريقيا الشمالية، ومن ثم تذكر رواية “الأسير الجزائري” التي كتبها المحامي والمسرحي الأمريكي رويال تايلور (1757-1826) تمهيدا لذلك، حيث تتحدث هذه الرواية -خلافا لرواية فولتير- أسير أمريكي أسر في الجزائر ويقابل رجل دين مسلم، وتدور بينهم مناقشة حول الإسلام حيث يصحح رجل الدين الكثير من التصورات الخاطئة عن الإسلام لدى هذا الأسير بأدلة واضحة، كما يكشف من خلال حديثه التسامح الذي ينطوي عليه الدين الإسلامي، إلا أن الرواية كانت تبدى مجرد تعاطفا ظاهريا مع الإسلام كما تشير الكاتبة، حيث انتهت برفض الأسير المسيحي أن يتحول إلى الإسلام معلنا انه مازال كارها لهذا الدين، إلا أنه أبدى احترامه لرجل مسلم وهذا غريب من وجهة نظره، وتشير الكاتبة أن ما فعله الكاتب من إظهار تفوق الإسلام في مقابل ضعف الحجة المسيحية من خلال النقاش الذي دار في الرواية قوبل بهجوم كبير وغضب أمريكي عام، وفى هذا السياق تبين الكاتبة أن هذا التوجه الإيجابي النسبي نحو الإسلام من خلال رواية تايلور لم يكن الأول من نوعه بل سبقه بعض الأعمال الأخرى، إلا أنها ظلت استثنائية بين جموع الأعمال المعادية للإسلام، ورغم ذلك فإن هذه الافكار المتسامحة نسبيا مع المسلمين والتي يرفض بعضها اضطهادهم من قبل الدولة هي ما سيتبناها جيفرسون والمؤسسون الآخرون في دعواهم لحرية دينية ومساواة سياسية ومواطنة.
الفصل الثاني: الأسبقيات المسيحية الأوروبية الإيجابية للتسامح مع المسلمين ووجودهم في أمريكا الاستعمارية (1554-1706)
تسرد الكاتبة في هذا الفصل بعض الأفكار الأوروبية الاستثنائية التي حملت في طياتها تسامحا دينيا يشمل المسلمين، وتبدأه بقصة طحان إيطالي عرف باسم مينوكيو بدأ يدعو الى أن المسيحية تحبذ التسامح مع الجميع بما في ذلك المسلمين استنادا إلى مساواة الأديان التوحيدية الثلاثة، لتوحدها في مصدرها الإلهي، كانت أفكاره تلك ضلالية بالنسبة لكل من الكاثوليك والبروتستانت، إلا أن أفكاره المهمشة هذه أسست لأفكار القرن الثامن عشر حول المسلمين كمواطنين مستقبليين في الولايات المتحدة، رغم صدور حكما بالإعدام ضده من قبل محكمة التفتيش عام 1601. ولم يكن مينوكيو الوحيد الذي دعا لمثل هذا الأفكار بل كان من بين أهل القرى حينها أفرادا يؤمنون بمثل ما يؤمن به وإن كانوا قلة.
كذلك تذكر سبلبيرغ قصة سيباستيان كاستيليو العالم البروتستانتي الفرنسي الذي كتب أطروحة بعنوان (حول الزنادقة) يرفض من خلالها اضطهاد المسلمين واليهود، ولكنه أكد فيها تفوق المسيحية واعتبر هذا التسامح موقفا تدعمه المسيحية المتفوقة على تلك الأديان الأخرى التي تمثل في نظره درجة أدنى، متمنيا بهذه الطريقة أن يعتنق ذوو الأديان الأخرى المسيحية بطريقة سلمية. واستطردت المؤلفة في سرد العديد من النماذج المشابهة التي قدمت موقفا متسامحا من الإسلام وتنتقد الاضطهاد الديني ضد اليهود والمسلمين مع التأكيد على اعتبار المسيحية أفضل دين، والدعوة الى تحول غير المسيحيين إلى المسيحية ولكن بطرق سلمية. بل كانت هناك دعوة إلى فصل الدين عن الحكومة، وهو ما أزعج جيمس الأول ملك بريطانيا حينها.
وتبين سبلبيرغ أن هذه الدعاوى انتقلت إلى أمريكا، حيث دعا روجر وليمز وهو كاهنا انتقل من انجلترا إلى شمال الولايات المتحدة حاملا معه رفض وصاية الدولة الدينية والدعوة للتسامح مع غير المسيحيين والتعددية الدينية، حيث حاول أن يضع إطارا لرؤيته حول دولة متعددة دينيا، إلا أن سبلبيرغ تشير إلى أنه لا توجد طريقة لمعرفة إذا كان ما دعا إليه وليمز من مساواة سياسية لغير المسيحيين طبقت عمليا أم ظلت حبيسة كتاباته، إلا أن جهوده ستؤثر بشكل كبير لاحقا في جيفرسون وشخصيات محورية أخرى في العصر الثوري الأمريكي. ومما تجدر الإشارة اليه أن جون لوك يعد أحد المتأثرين الكبار بوليمز وهو ما سيتم بيانه لاحقا.
وبعد أن استرسلت سبلبيرغ طويلا حول جون لوك وتعلمه للعربية وقراءته “حي بن يقظان” للفيلسوف المسلم ابن طفيل وتأثره بهذا النص العربي الفلسفي، تنتقل الكاتبة إلى الموضوع الرئيسي الذي استدعت من أجله جون لوك وهو التسامح الديني لديه الذي تأثر فيه بالمؤلف هنري ستوب الذي كان يعتقد أن السلطات الحكومية يجب ألا تتدخل في الدين، وأن دين الفرد مسألة تترك بين المؤمن وبين الله، كما دافع عن الإسلام ونبيه، وقدم الإسلام باعتباره أكثر تسامحا من المسيحية، حيث هاجم الأكاذيب الكبيرة في المسيحية عن الإسلام فيما يخص الفتوحات، وعبًر عن إعجابه بمفهوم وحدانية الله، كما تطرق لموضوع تعدد الزوجات وقدمه بشكل إيجابي، إلا أن كتاباته أيضا لم تخلو من أخطاء فادحة مثل إصراره -على غرار الوصف المسيحي الشائع- بأن النبي كتب القرآن، وذلك على الرغم من مدحه للنبي محمد ﷺ بأنه قائد سياسي فطن وشجاع.
وقد تأثر جون لوك بأفكار هنري ستوب على الرغم من أنه لم يتفق معه في عدة نقاط، أولها أنه لم يرى في الدين الإسلامي أو النبي محمد ﷺ ما يستحق المديح، وتبين سبلبيرغ أن هنري ستوب لم يكن الوحيد الذي تأثر به لوك، لقد كان إدوارد باغش، الذي عرفته بأنه منشقا مسيحيا، ممن تأثر بهم لوك أيضا، لقد كان التسامح الذي دعا إليه جون لوك يمتد ليس إلى اليهود والمسلمين فحسب بل كذلك إلى الأمريكيين الأصليين (الوثنيين) والعبيد الأفارقة في جميع أنحاء المستعمرتين الأمريكيتين، وكان دافعه في ذلك الرغبة لنشر المسيحية البروتستانتية وتحويل هؤلاء بشكل سلمى إليها عن طريق التسامح بدلا من الاضطهاد، وأن على الدولة أن تبتعد عن الإرغام الديني، ثم تنهى سبلبيرغ هذا الفصل بأن أفكار جون لوك تلك سيكون لها أثر كبير في أمريكا في القرن الثامن عشر والتي سيجد فيها جيفرسون سابقته الأقوى.
الفصل الثالث:
ما تعلمه جيفرسون- وما لم يتعلمه من القرآن: آراؤه السلبية عن الإسلام، واستعمالاتها السياسية المتباينة مع دعمه للحقوق المدنية الإسلامية 1765- 1786
تذكر سبلبيرغ أنه في عام 1765 اشترى جيفرسون نسخة من القرآن قام بترجمتها جورج سيل في مجلدين بعنوان “قرآن محمد”، ولعل هذا كان أول تشويه في هذه النسخة التي اقتناها توماس جيفرسون وكان حينها طالب قانون متحمسا. ويدور هذا الفصل -كما تذكر سبلبيرغ- حول أثر مقدمة سيل للقرآن على أفكار جيفرسون عن الإسلام.
تشير سبلبيرغ إلى أنه كان لترجمة سيل للقرآن أثر كبير على تصور جيفرسون للإسلام ابتداءً بوصف سيل للنبي محمد ﷺ بأنه مشرع العرب، حيث أثار هذا الوصف -كما تذكر سبلبيرغ- إعجاب جيفرسون الذي كان محاميا ورجل قانون في ذلك الوقت، ومن ثم كان القرآن بالنسبة له كتاب قانون. وكان هدف سيل تذكير القراء المسيحيين بأن الإسلام دين مزيف، وكانت ترجمته كثيرا ما تخطئ في توصيل المعنى الصحيح، ولكنه في المقابل أصاب في حديثه عن موضوعات عدة، وبالرغم من احتواء ترجمته على العديد من الأخطاء إلا أنها انتشرت في أنحاء اوروبا، وتقول الكاتبة أنها كانت أفضل ترجمة انجليزية في القرن التاسع عشر، وأنه كان أقل حدة تجاه الإسلام من المترجمين الأوروبيين السابقين، فهو يعترف بأن محمدا قدم للعرب أفضل دين لتنتقل الكاتبة بهذا الاعتراف إلى وصفه بالموضوعية والعدل، ويحق لنا هنا أن نتساءل هل يصح عليه هذا الوصف بعد نعته للإسلام بأنه دين مزيف، أم أن لمجرد وجود الأسوأ، وأقصد هنا المترجمين الأوروبيين السابقين كما تقول سبيلبيرغ، يصح هذا الوصف.
تنتقل سبلبيرغ للحديث عن أثر ترجمة سيل على جيفرسون لتذكر ابتداءً أنه لا يوجد دليل على أن جيفرسون تفحص النص بدقة آية بعد آية، وتذكر سبلبيرغ أن جيفرسون شارك معظم معاصريه في الآراء المعادية للإسلام، ولم يكن اهتمامه بالإسلام يعكس اهتمام بالإسلام ذاته بقدر ما هو تعرف على قوانين أمة أخرى باعتباره رجل قانون، كما أنه أراد تضمين المسلمين كأقلية ضمن أقليات اخرى دعا إلى تضمينها في المجتمع انطلاقا من رفضه للاضطهاد ضد الأقليات بسبب دينهم. وبهذا نستطيع القول إن ترجمة سيل لم تؤثر على جيفرسون بشكل واضح، إلا انه وافق سيل في اعتبار النبي محمد هو المشرع. إذن فجيفرسون معادى للإسلام منذ البداية إلا أنه فقط أراد أن يتمتع الأفراد أيا كان دينهم بحقوقهم بغض النظر عن دينهم.
وفى سياق العلاقة بين جيفرسون والإسلام تشير سبلبيرغ إلى أن جيفرسون باعتباره رجل قانون كان دائم البحث في السوابق القانونية من حضارات مختلفة بما في ذلك الفقه الإسلامي، وتذكر أيضا أنه كتب بعض الملاحظات حول الإسلام ولكنه استند فيها إلى تقارير فولتير صاحب مسرحية التعصب التي أساءت كثيرا للإسلام مما أثر سلبا على تصورات جيفرسون عن الإسلام.
تشير سبيلبيرغ بعد ذلك إلى الإصلاحات القانونية التي قام بها جيفرسون في ولاية فرجينيا الأمريكية لإنهاء الاضطهاد الديني وتحقيق المساواة وذلك باعتباره عضوا في مجلس مندوبي فرجينيا وعضوا أيضا في لجنة التسعة عشر عضوا حول الدين، وذلك بعد إعلان الاستقلال في،1776، فحاول إنهاء ترسيخ الأنجليكانية في فرجينيا والتي تحاملت على الأديان الأخرى والطوائف البروتستانتية، فاقترح جيفرسون تشريعين منفصلين في عام 1776 كان الأول مشروع قانون لسحب الاعتراف بالكنسية الإنجليزية وإبطال القوانين التي تتدخل في حرية العبادة، والثاني يعفى المنشقين من المساهمة المالية في دعم الكنيسة الأنجليكانية. وهنا تشير سبلبيرغ أن خطابات جيفرسون في مجلس مندوبي فرجينيا لسحب الاعتراف بالكنيسة الأنجليكانية اعتمدت على مقارنات سلبية بالإسلام استنادا إلى سوابق فولتير بأنه دين يقمع حرية الأفراد، ونستطيع القول بأن هذا الموقف كان على غرار ما ذكرته سبيلبيرغ عن استخدام الطوائف المسيحية للإسلام لتشويه سمعة بعضهم البعض إلا أن الاختلاف يكمن في أن جيفرسون لم يرد كما تقول سبيلبرغ أن يعلى طائفة مسيحية فوق طائفة أخرى ولكنه فقط أراد رفض إجبار الدين الرسمي عن طريق تشبيه الكنيسة الأنجليكانية بالإسلام.
وفى سياق منح المسلمين حقوقا كاملة كمواطنين تقول سبيلبيرغ أن جيفرسون استمد إلهامه حول الحقوق المدنية للمسلمين من عمل جون لوك عام 1689″رسالة تتعلق بالتسامح” الذي قال “بأنه يجب عدم استبعاد الوثني أو المحمدي أو اليهودي من الحقوق المدنية للكومنويلث بسبب دينه” وتذكر سبلبيرغ أحد الفوارق الهامة بين جيفرسون وجون لوك في منظورهم للتسامح، فجون لوك أراد بالتسامح مع المسلمين واليهود التمهيد لتوسيع نطاق التسامح مع المنشقين المسيحيين، ولكنه رفض التسامح مع من يدينون بالولاء لحاكم أجنبي مثل بعض المسلمين في انجلترا الذين يدينون بالولاء للمفتي في اسطنبول، وكذلك رفض التسامح مع من لا يؤمنون بوجود إله أي مع الملاحدة إيمانا منه بأن من يجب التسامح معهم لابد أن تكون آراؤهم متفقة مع القواعد الأخلاقية الضرورية لحفظ المجتمع، أما جيفرسون فأراد ان يمهد بتسامحه مع المسلمين واليهود ليس للمنشقين البروتستانت فحسب بل لجميع الأديان وحتى الملاحدة وأن على الذين يهاجرون ويريدون أن يصبحوا مواطنين أن يؤدوا قسم يدينون فيه بالولاء للكومنولث، ولكن جيفرسون في صياغته لهذا القسم لم يجعل هناك أي اختبار ديني يعد شرطا لمنح الشخص حقوق المواطنة. وتذكر سبيلبريج أيضا في هذا السياق فارق مهم وهو أن جيفرسون في دعوته للتسامح لم يستدعى أبدا مناشدة الوصايا المسيحية بذلك كما فعل لوك الذي لطالما آمن بتفوق المسيحية وكانت هي مرجعه، أما جيفرسون أراد أن يكن مجتمعه مجتمع تعددية دينية بالأساس وليس بروتستانتيا أو حتى مسيحيا.
ولكن اتفق جيفرسون ولوك على أنه لا يجب التسامح مع الذين لا يعلمون واجب التسامح مع جميع الناس في أمور الدين، ومن ثم تخلص سبيلبيرغ أن جيفرسون كان تسامحه أكثر إطلاقا وشمولية من لوك الذي كان تسامحه مشروطا بشروط معينة سبق ذكرها، وتذكر سبيلبيرغ أن مشروع قانون جيفرسون المتعلق بالحرية الدينية لم يقر إلا في عام 1785.
على صعيد آخر تتطرق سبيلبيرغ إلى المسلمين الأمريكيين الأوائل، لتبين أن جيفرسون كان مخطئا عندما ظن أن قانونه المتعلق بالحرية الدينية يشمل الجميع بما فيهم المسلمين، لأنه ظن كذلك بناءً على كون قانونه سيحتفظ بأهمية كبيرة للمواطنين المسلمين الأحرار المستقبليين في القرون التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين غافلا عن حقيقة أن مجتمعه في القرن الثامن عشر كان يوجد به مسلمون بالفعل ولكنهم عبيدا أفريقيين نقلوا إلى أمريكا الشمالية خلافا لرغبتهم والذى رأى أنهم ملكية وليسوا مواطنين لكن تعود سبلبيرغ لتقول أنه ابغض هذه التجارة لحماية الأحرار البيض من الاستعباد اما العبيد السود لم يرى في وجودهم بأسا مماثلا كما علق بول فنكلمان عليه، علما بأنه امتلك 187 عبدا ليتبين لنا عمق التناقض الذي حاوط في كثير من الأحيان مهمته الإصلاحية إن جاز لنا أن نعتبرها إصلاحية حقا والتي قد تعود إلى طبيعة العصر الذي كان صعب الفكاك من موروثاته.
الفصل الرابع
جيفرسون مقابل جون أدامز: مشكلة القرصنة الأفريقية الشمالية ومفاوضتهما مع سفير مسلم في لندن 1784-1788
يدور هذا الفصل حول تطور فكر جيفرسون حول مشكلة القرصنة الأفريقية الشمالية من عام 1784 إلى عام 1788 حيث كانت استراتيجيته منذ البداية غير محكومة باعتبارات دينية بل سياسية واقتصادية وذلك على عكس الرئيس الأمريكي جون أدامز الذي أكد على الدين في تصوراته عن العدو.
أراد جيفرسون في البداية حل المشكلة بالوسائل العسكرية حتى لا يخضع لابتزاز أي من القوى الإسلامية بدفع أي مبالغ مالية، وذلك على عكس رغبة أدامز الذي رأى أن الدفع من أجل السلام هو المسار الأفضل للأمة، ولكن حتى عام 1801 عندما أصبح جيفرسون رئيسا أخفقت الجهود الدبلوماسية في حل الأزمة لأن الولايات المتحدة لم يكن لديها بحرية لحماية سفنها ولا حتى حكومة مركزية مخولة لجمع الضرائب التي يمكن استعمالها لدفع الجزية من أجل السلام أو فدية الأسرى الأمريكيين المحتجزين في شمال أفريقيا، وفى هذا السياق تقول سبلبيرغ أن القرصنة لم تكن ممارسة إسلامية بشكل حصري، وأن الأمريكيين كانوا قد أسروا عشرات الآلاف من المسلمين في مقابل سبعمائة تقريبا (على أعلى إحصاء) قام القراصنة المسلمون بأسرهم في شمال إفريقيا. ولقد بدأت القرصنة في شمال إفريقيا لرد الاحتلال الإسباني عن الأراضي الإسلامية أي أنها أخذت شكلا دفاعيا.
تذكر سبلبيرغ أن أدامز أراد التفاوض ودفع الجزية مقابل السلام مع القراصنة في حين قد عارض جيفرسون هذا واعتبر أن الخيار العسكري هو الخيار الشريف، لكنه دعم أدامز على المستوى الرسمي، ومن ثم وافق على الذهاب إلى لندن للقاء سفير طرابلس المسلم الذي لم يمثل الإسلام بشكل جيد بل صوره دين مشجعا للحرب والجشع والطمع ضاربا بعرض الحائط شروط المعاهدات في الإسلام والهدف من الحرب و آداب الإسلام في معاملة الأسرى كما تبين سبلبيرغ، مما رسخ التشوه التصوري لدى جيفرسون عن الإسلام، ثم تسهب سبلبيرغ في وصف اللقاء بين السفير وأدامز واصفة طريقة التخاطب وصعوبة الحوار نتيجة لمشكلة اللغة لدى الطرفين، ولقد جاء ثمن المعاهدة غاليا أكثر مما توقع أدامز فقد طلب سفير طرابلس مبلغا ماليا كبيرا مقابل السلام الذي قال بأن مدته هي المعيار الذي يحدد الثمن.
وفى هذا الصدد تشير سبيلبيرغ أنه على الرغم من رؤية أدامز لعنصر الدين في الصراع مع قراصنة شمال إفريقيا وفى مفاوضاته مع سفير طرابلس إلى أنه لم يفكر في شراء نسخة من القرآن حتى عام 1806، و في المقابل وعلى الرغم من أن جيفرسون لم يفهم الصراع من منطلق ديني إلا أنه كان مشيرا بحروف اسمه الأولى عند الآيات التي تتحدث عن الحرب، وفى هذا السياق تقول سبلبيرغ أن إشارات السفير الطرابلسي إلى آيات من القرآن لتبرير القرصنة، لربما ألهمت جيفرسون لفهم أيديولوجية معارضيه العسكرية بشكل أفضل فعاد إلى آيات القتال في النص المقدس.
لقد أخفقت المفاوضات مع سفير طرابلس، ومن ثم بدأ ينصب الاهتمام على مناقشة مشروع دستور اتحادي جديد يسهم في وضع نظام ضرائب يمكنه جمع الأموال لدفع فدية الأسرى، ومن هنا بدأ الأمريكيون الاتحاديون يدافعون عن مشروع دستور يقبل التعددية ويلغى الاختبار الديني في التقدم لمنصب اتحادي، في حين أن معارضيهم كانوا يخشون أن هذا الدستور سيفتح الباب لمواطنين مسلمين مستقبليين يحظوا بحقوق سياسية كاملة في مجتمع غالبيته بروتستانت، واستكشاف هذين الاتجاهين هو موضوع الفصل الخامس.
الفصل الخامس
هل يمكن لمسلم أن يصبح رئيسا؟
الحقوق الإسلامية وإقرار الدستور 1788
تشير سبلبيرغ إلى النقاشات حول الدستور الاتحادي الجديد بين الاتحاديين المدافعين عنه والمناوئين له، كان الخوف من الدستور الجديد ينصب بشكل رئيسي من وجود أفرادا من أديان أخرى يشكلون تهديدا خصوصا للبروتستانت الأمريكيين إذا تمكنوا بموجب الدستور من السيطرة الحكومية، فتصبح لديهم سلطة فوق الغالبية البروتستانتية، وهنا تطرح سبلبيرغ السؤال الأهم هل يمكن لمسلم أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية؟.
وهنا تجيب بأنه يمكن ذلك إذا ما أقرت تسع ولايات من الولايات الثلاث عشر المادة السادسة من الدستور التي بمقتضاها يلغى الاختبار الديني ويستبدل بقسم مدني. ثم تمر سبلبيرغ سريعا على أنواع القسم التي كانت موجودة في الولايات الأمريكية المستعمرة قبل 1787 ليتبين اختلافها، فالبعض يستثنى غير البروتستانتيين اليهود والمسلمين والبعض يستثنى الملاحدة. ومن أهم المحاور التي تطرق لها النقاش هو كيفية استخدم الإسلام كسلاح عن طريق استدعاء الاستبداد العثماني، فلقد كانت الإشارات إلى الامبراطورية العثمانية بأنها مصدر استبداد دائم قد أثرت في كل من الاتحاديين والمناوئين لهم، فعلى الرغم من خلافاتهم السياسية فقد اتفقوا على أن الإسلام يتبنى ظلما دينيا وسياسيا، إلا أن المستفيد كان المناوئين للاتحاديين الذين وجدوا في الإسلام سلاحا يمكن استخدامه في معارضة الدستور استغلالا للصورة المشوهة المترسخة عنه عند الغالبية.
ومن هنا وجد الاتحاديون أنفسهم مضطرين إلى الدفاع عن المسلمين في سبيل اقرار الدستور الذي سيحقق من وجهة نظرهم التعددية والمساواة السياسية، بل وتعدى دفاعهم عن المسلمين إلى اليهود والكاثوليك أيضا، ولكن في حقيقة الأمر لم يكن الاتحاديون يتصورون وجود مسلمين أحرار بالفعل سينطبق عليهم ما يدعون إليه فهم يدافعون عنهم على مضض على المستوى النظري الخيالي فقط، وهنا تستدعى سبلبيرغ نموذجين متقابلين، أحدهما يعبر عن المناوئين للاتحاديين وهو “هنري بوت”، وهو أول من اعترض على الدستور خوفا من الهيمنة الكاثوليكية أو تولى مسلمين وظائف رسمية، والآخر والاتحادي المتسامح “جيمس آيرديل” الذي دافع عن الدستور وعن إمكانية تولى المسلمين وظائف رسمية مستشهدا بعبارة لجون لوك وجيفرسون تقول بأن “لا وثنى ولا محمدي ولا يهودي يجب أن يستثنى من الحقوق المدنية للكومنولث” محولا بذلك -كما تقول سبلبيرغ- الخيال الأمريكي حول المسلمين من كونهم متطفلين وقطاع طرق إلى مواطنين أمريكيين لهم وجود حقيقي في المجتمع ولديهم حق تولى وظائف رسمية.
وفي هذا السياق أراد آيرديل تضمين الكاثوليك واليهود والوثنيين في المجتمع الأمريكي، ففي رأيه لم يكن الخطر الحقيقي للجمهورية الجديدة في ارتقاء غير البروتستانتيين، ولكن في نوعية الظلم الذي تأسست الأمة للخلاص منه، ولهذا السبب كان إلغاء الاختبار الديني في الدستور غايته ضمان الحرية الدينية الشاملة بوضع جميع الطوائف على قدم المساواة. وهذا ما دعمه الاتحادي صموئيل جونسون، ولكن التصويت جاء عكس ما أراده آيرديل والاتحاديون ولم يقر الدستور إلا فيما بعد.
إلا أن سبلبيرغ تشير إلى أنه بالرغم من هذا الإخفاق إلا أن نقاشات آيرديل الداعمة للدستور والحقوق الإسلامية المستقبلية قد قرأها أعضاء الكونغرس في جميع أنحاء الإتحاد الجديد، وهكذا شكلت علاقة الدين بالدولة حلقة هامة من النقاشات والسجالات في المجتمع الأمريكي الوليد.
وفى هذا السياق تذكر سبلبيرغ ببراعة -وكأنها تكشف الغطاء عن وضع يتحاشاه هؤلاء الآباء المؤسسون في نقاشاتهم عن التسامح- أن المسلمين المتخيلين في عقول هؤلاء لم يكونوا مجرد قضية نظرية بل كان هناك مسلمين يعيشون بالفعل في أمريكا، وتذكر في هذا السياق اثنان من المسلمين العبيد اللذان عاشا في ذلك الوقت محرومون من الحقوق والحريات في وقت كان يظن فيه أنهم فقط مجرد أشباحا متخيلة.
لتختتم سبلبيرغ الفصل بأن النقاش حول الدستور والاختيارات الدينية يعتبر تقدما فارقا، حيث قدم المسلمين إلى المسرح السياسي الأمريكي لأول مرة، حتى وإن كانوا متخيلين، وحتى وإن كان من يدافعون نظريا عن حقوقهم يفعلون ذلك على مضض، لأنه في نظرها يشير إلى أن الأمريكيين يمكنهم التخلي عن التحامل الأوروبي الموروث ومن ثم إدراك مثلهم الوطنية العليا.
الفصل السادس
جيفرسون بين الحرب ضد قوة إسلامية، ويستضيف أول سفير مسلم ويقرر أين يضع القرآن في مكتبته ويؤكد دعمه للحقوق الإسلامية 1790-1823
تتناول سبلبيرغ في هذا الفصل دور جيفرسون الدبلوماسي مع قوى شمال إفريقيا الإسلامية كرئيس، وذلك في إطار أول تجربة احتكاك بين رئيس أمريكي وقوى إسلامية.
ثم تنتقل سبلبيرغ في هذا الفصل للحديث عن عقد معاهدة بين أدامز وطرابلس عام 1797بعد سنوات من الإخفاق في ذلك كما أشارت في الفصل الرابع، وتشير هنا إلى نقطة هامة تتعلق بالمادة الحادية عشر من المعاهدة والتي تقول -على الرغم من العداء السائد للإسلام في ذلك الوقت- بأن الحكومة الأمريكية لم تكن رسميا مسيحية ولا معادية للإسلام، وهو ما يعد في نظر سبلبيرغ تحرك استراتيجي ميز الولايات المتحدة عن الكثير من السلطات المسيحية في أوروبا التي تورطت فيما وصفته بأنه صراع ديني مع الدول الإسلامية.
وفى سياق التمهيد لدور جيفرسون كرئيس مع قوى افريقيا الشمالية المسلمة تشير سبلبيرغ إلى عملية انتخابه وما جرى فيها من تشهير عن طريق اتهامه بأنه مسلم، وفى ذلك الحين كانت كلمة “مسلم” ترادف كلمة “كافر”، وتعد هذه الحملة أول حملة تشهير في التاريخ الانتخابي الأمريكي، وقد قادها جون أدامز وابنه، وكان أساس استراتيجيتهم هو التأكيد على فكرة أن أمريكا أمة مسيحية وأن خطر وصول رئيس غير مسيحي في رئاسة الدولة وشيك بانتخاب جيفرسون.
وتذكر سبلبيرغ أن فترة رئاسة جيفرسون الأولى بدأت بشن هجوما عسكريا على طرابلس عن طريق محاصرة طرابلس وقصفها، ولكنه لم يحقق نجاحا حاسما في البداية، إلا أنه استمر في الحرب وبدأ في تحقيق نجاحا نسبيا، حيث جرى افتداء عدد كبير من الأسرى الأمريكيين، ثم بدأ جيفرسون الدخول في مفاوضات دبلوماسية لعقد معاهدة سلام مع طرابلس، وفى هذا الصدد تشير سبلبيرغ أن في هذه المرة بدأ عنصر الدين يدخل إلى تفكير جيفرسون على عكس المرة الأولى عندما فاوض أدامز طرابلس، وبدا أن لغته في المعاهدة اتسمت بشكل أكثر تسامحا مؤكدا على أن هجومه لم يكن بدافع العداء لقوى محمدية ولكن للدفاع عن حق الإبحار، ووصفت المعاهدة الدين الإسلامي بأنه دين مميز -وذلك على الرغم من آراء جيفرسون الشخصية السلبية عن الإسلام- مؤكدا على أن الملاحة هي التي قد تسبب صراعا بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية وليس الفوارق الدينية، وفى هذا الإطار -وقبل إقرار المعاهدة مع طرابلس بعام واحد- استقبل جيفرسون في واشنطن مبعوث تونسي للتفاوض بشأن الملاحة ليكون بذلك أول سفير مسلم يتم استقباله في العاصمة الأمريكية، وقد عاد المبعوث إلى بلده برسالة من جيفرسون إلى الحاكم التونسي آنذاك، و تميزت الرسالة بإشارات جيفرسون إلى الأسس الروحية المشتركة بين البلدين فكلاهما يؤمن بإله واحد، وذلك بحثا عن مكاسب دبلوماسية -كما تشير سبلبيرغ- مفسرة ذلك بأن الحرب مع طرابلس استدعت أن تكون العلاقة مع تونس جيدة، ومن ثم كان جيفرسون حريصا على السلام والمصالحة معها.
يعطينا هذا انطباعا أن السياسة العامة لأمريكا على المستوى الرسمي دائما ما تحاول أن تتسق مع الصورة المروجة للولايات المتحدة كونها منار الديمقراطية والسلام العالمي، وأن هذا جزء من السياسة الخارجية الأمريكية والتي تؤكدها الكاتبة بتكرار التأكيد على فكرة المستوى الرسمي والنظري، إلا أن سياساتها العملية عادة ما تناقض، هذا ولعل اهتزاز صورتها العالمية اليوم أكبر دليل على ذلك.
ومما تجدر الإشارة إليه فيما يتعلق بأن جيفرسون كان مؤمنا توحيديا عقلانيا يؤمن بإله واحد ولا يؤمن بالثالوث، ومن ثم وجد ساحة روحية مشتركة ساعدته في التواصل مع حاكم مسلم كحاكم تونس، ولكن هذا لا يمنع ازدرائه العام للإسلام -كما تقول سبلبيرغ- والذي أبداه في كتاباته المهينة للإسلام وللنبي خاصة بعدما اتهم بأنه مسلم.
وتذكر سبلبيرغ في سياق الحديث عن معتقدات جيفرسون، المكان الذي وضع فيه القرآن في مكتبته والذي تعتبره إشارة هامة لفهمه للإسلام، فقد وضع القرآن بعد عدة مجلدات للتوراة العبرية، معلقة على ذلك بأنه ربما يميز الصلة بين الأشكال المتنوعة للتوحيد اليهودي والإسلامي من ناحية وبين الإيمان العقلاني والتوحيدية التي سيعتنقها من ناحية أخرى.
ومن ثم تختتم الفصل بالحديث عن ازدواجية جيفرسون اتجاه الإسلام، بين ازدرائه الشخصي واحترامه على المستوى الرسمي كما رأينا في رسائله لحاكم تونس، إلا أن هذا لم يمنعه من الدفاع عن حقوق الأفراد المسلمين كمواطنين محتملين في بلده في سياق رغبته في فصل الدين عن الدولة وتنحيته عن أن يكون سببا للصراع أو الاضطهاد.
الفصل السابع
ما بعد التسامح جون ليلاند، المعمداني المدافع عن حقوق المسلمين 1776-1841
عنونت سبلبرغ لهذا الفصل ب “ما بعد التسامح” في إطار حديثها عن جون ليلاند المعمداني المدافع عن حقوق المسلمين على غرار جيفرسون، فقد كان مثل جيفرسون لا يفهم كثيرا عن الإسلام بل ولديه تصورات خاطئة عنه، لكنه دافع عن حقوقهم المدنية كما دافع عن حقوق المعمدانيين المضطهدين.
كان ليلاند داعما لجيفرسون في دعوته للحرية الدينية، إلا أنه أبغض التسامح لأنه -كما ذكر جيمس ماديسون وزير الخارجية الأمريكي والداعم أيضا لجيفرسون وأفكاره- قد لا يحقق المساواة الحقيقية لأنه تابعا لدرجة تسامح الحكومة ومن ثم يحكمه المزاج، ولهذا أراد ليلاند مساواة مدنية حقيقية لا تحتكم إلى نسبية المزاج الحكومي، كما دعا إلى فصل الدين عن الدولة حفاظا على الدين من الحكومة، وهذا عكس ما أراده جيفرسون من فصل الدين عن الدولة، حيث أراد جيفرسون بهذا الفصل الحفاظ على الحكومة من الدين، ومن ثم دعا ليلاند إلى ضمان حقوق جميع المؤمنين بما فيهم المسلمين.
وفى هذا السياق تسهب سبلبيرغ في الحديث عن ليلاند في إطار السرد التاريخي الذي تحاول من خلاله الوقوف على تاريخ من برزوا في التاريخ الأمريكي في الدعوة إلى الحرية الدينية وأسسوا لها.
تنتقل سبلبيرغ للحديث عن دعم ليلاند لجيفرسون في الانتخابات الرئاسية، وحشده الأصوات له وإيمانه به كرئيس سيخلصهم من الاستبداد الديني وسيسعى لتخليص المعمدانيين بشكل خاص من الاضطهاد القانوني ضدهم. وقد قام ليلاند بترشيح نفسه ليصبح ممثلا منتخبا في الهيئة التشريعية لولاية ماساتشوستس عام 1811 وقد نجح خلال أشهر قليلة في إقرار قانون الحرية الدينية، كما كانت له محاولات عدة لإقرار حقوق غير المسيحيين والفصل بين الدين والدولة وإلغاء العبودية، على الرغم من أنه في الأصل مبشر مسيحي، وهو ما تحاول الكاتبة إبرازه لتشير إلى نقاء قناعات هذا المعمداني.
كلمة ختامية
في هذه الكلمة الختامية تستكشف سبلبيرغ باختصار المسار العملي لحقوق المسلمين المدنية كما دافع عنها نظريا جيفرسون وآخرون.
فالقرن الثامن عشر ساد فيه الجهل والخوف من الإسلام بين البروتستانت، ومن ثم لم يحصل المسلمون الأمريكيون على حقوق متساوية، ثم بدأت المراسيم تدريجيا تسمح بمنح المواطنة للمسلمين، إلا أن الدين لم يكن التحدي الوحيد أمام المسلمين بل كان العرق أيضا، فلقد واجه المسلمون تعسفا بسبب أصلهم العرقي، ففي البداية لم يكن يسمح بمنح المواطنة إلا للبيض الأحرار، ثم توسع الأمر، ولكن كان هناك معوقات في تحديد من هم البيض، فلقد كان الأمريكيون يرون المسلمين ليسوا سودا تماما وليسوا بيضا تماما وليسوا أمريكيين تماما، واستمر هذا التحامل الشعبي ضد المسلمين في القرن العشرين، إلا أنه بداية من بعد الحرب العالمية الثانية ازداد عدد المهاجرين المسلمين إلى الولايات المتحدة بشكل كبير، وحصل 81 في المائة منهم على المواطنة الأمريكية.
وتختم سبلبيرغ بالحديث عن أحداث 11 سبتمبر وتأثيره السلبى في وضع المسلمين وصورتهم في المجتمع الأمريكي، وما سبق ذلك من محاولات تشويه سمعة المسلمين، وكيفية تصويرهم في الإعلام الأمريكي بشكل سيء، إلا أن أحداث 11 سبتمبر كانت حافزا للدفاع عن حقوقهم المدنية والتي نتج عنها انتخاب أول عضو كونغرس أمريكي مسلم عام 2006 ، إلا أنه لم يلق ترحابا عاما حيث واجه انتقادات كثيرة لكونه مسلما واتهمه البعض بأنه ليس أمريكيا، وحذر البعض من أن وجوده سوف يفتح الباب لمزيد من المسلمين في الولايات المتحدة، وأن في هذا خطر على القيم والمعتقدات التقليدية الأمريكية، كما أنهم وجدوا في الوصم الشائع الذي يربط المسلمين بالتطرف خير سلاح لمواجهة وجوده في الكونغرس. إلا أن البعض علق بعد انتخابه -على الرغم من هذا الرفض المحيط به- أن انتخابه يعد خطوة للأمام في سبيل التعددية.
ثم تنتقل سبليبرغ للحديث عن إمكانية أن يكون رئيس الولايات المتحدة مسلما، وتبدأ الحديث باتهام الرئيس باراك أوباما بأنه مسلم، وكان هذا الاتهام مرتبط ضمنيا لدى الأمريكيين بأنه ما إن اتهم أحد بأنه مسلم فهذا يعنى أنه غير أمريكي.
ولقد كانت حملة التشهير بأوباما قوية قبل انتخابه حتى دفعته إلى تجاهل المسلمين بعض الشيء ليذب عن نفسه هذه التهمة، إلا أنه كان في خطاباته يحاول أن يقر للمسلمين حقوقهم، وهذا ما ظهر في خطابه في مصر عندما قال بأن الإسلام كان دائما جزءا من تاريخ أميركا، وفى هذا الإطار بدأ يتلقى دعما من بعض الإعلاميين والسياسيين الذين أكدوا على انه ليس مسلما، ومع ذلك حاولوا القول بضرورة ألا يكون وصف “مسلم” وصمة.
وتوضح سبلبيرغ أن وجود عضو كونغرس مسلم ورئيس مشكوك في أنه مسلم أثار خوف الكثيرين، وتمثل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للخوف بالنسبة لهم، ومن هنا بدأت حركة المناوئين للشريعة يشعلون ذلك الخوف ويهاجمون ويهددون ويمنعون حتى بناء المساجد، وتختتم سبلبيرغ كتابها بأن وجود المسلمين الآن في الولايات المتحدة بأعداد كبيرة على الرغم مما يواجهوه هو خطوة في سبيل المثل العليا التي أرادها جيفرسون وغيره من المؤسسين والتي وضعوا بذورها منذ سنوات، والتي تشتمل على بناء أمة تتسم بالتعددية، مشيرة إلى أنها مازالت هذه الأمة على طريق الإنجاز ولم تكتمل بعد.
ومما سبق عرضه يتبين أن دفاع جيفرسون وغيره عن حقوق المسلمين لم تتبين له خصوصية واضحة أثناء الكتاب، فهو يأتي من جملة الدفاع عن الحرية الدينية وفصل الدين عن الدولة، ولم يتضح على مدار الكتاب أن اقتناء جيفرسون لنسخة من القرآن كان له أثر حقيقي على ممارساته وأفعاله، بل حتى لم تجزم الكاتبة بأنه قرأه بدقة. فعلى الرغم من الجهد البحثي القوى والسرد التاريخي المهم الذي عرضته الكاتبة إلا أن الإطار الذي يخرج من خلاله الكتاب ليس دقيقا، فالكتاب لا يعكس عنوانه في إبراز علاقة مباشرة بين جيفرسون والقرآن بل حتى عنصر الدين ظل مهمشا في فكر جيفرسون إلى حد كبير. إلا أن سبلبيرغ قامت في هذا الكتاب بجهد بحثي كبير حاولت من خلاله أن ترسم صورة مفصلة قد تبدو للقارئ غير نمطية لكنها أيضا مليئة بالخطوط المتوازية والمتقاطعة التي ترسم صورة للواقع الأمريكي وتاريخه بشكل غير تقليدي.
عرض
أ. يارا عبد الجواد
باحثة في العلوم السياسية
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies