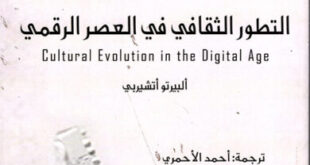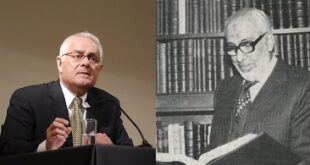العنوان: الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي.
المؤلف: وائل حلاق
ترجمة: عمرو عثمان
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: الدوحة.
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
تاريخ النشر: 2014.
الوصف المادي: 352 ص.، 24 سم.
السلسلة: الترجمان.
الترقيم الدولي الموحد: 9-010-445-614-978.
الفكرة المحورية للكتاب في أن مفهوم “الدولة الإسلامية” مستحيل التحقق وينطوي علي تناقض داخلي، وذلك بحسب أي تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة، ولذلك يعتبر الكاتب أن أي تعريف لدولة إسلامية حديثة “متناقض ذاتيا بصورة جوهرية”.
قسم حلاق كتابه “الدولة المستحيلة” إلى سبعة فصول: يتناول الفصل الأول المعنون “مقدمات” وصف “الحكم الإسلامي النموذجي”، ويرسم حدود مفهوم “النموذج” كما سيجري استخدامه بوصفه مفهوماً مركزياً في أطروحة الكتاب الكلية. ويصف الفصل الثاني الدولة الحديثة، “الدولة الحديثة النموذجية”، ويحدد “خصائص الشكل” التي تمثل الصفات الجوهرية للدولة الحديثة. ويقوم بتفكيك تلك الخصائص، معترفاً في الوقت عينه بالتغيرات المتزامنة والتنوعات المتلاحقة في تكوين تلك الدولة. أمّا الفصل الثالث فأجرى مقارنة بين البنى الدستوريّة للإسلام كما تمت ممارستها لأكثر من ألف عام مع البنى الدستورية الغربية فيناقش مفاهيم الإرادة السيادية وحكم القانون في ما يخصّ مبدأ الفصل بين السلطات؛ هادفًا من وراء هذه المناقشة إلى استعراض الأطر والبنى الدستورية لكلٍّ من الدولة الحديثة والحكم الإسلامي، وتسليط الضوء على الاختلافات الدستورية بين نظامَي الحكم هذين. في الفصل الرابع تعرض للاختلافات النوعية بين المفهوم الأخلاقي للدولة الحديثة والحكم الإسلامي، مع التركيز على البعدين السياسي والقانوني. وانتقل في الفصل الخامس للحديث عن “الذات السياسية والتقنيات الأخلاقية لدى الذات” معتبرًا أن الدولة القومية الحديثة والحكم الإسلامي يميلان إلى إنتاج مجالين مختلفين من تكوين الذاتية. وأنّ الذوات التي ينتجها هذان المجالان النموذجيان تتباين تباينًا كبيرًا، الأمر الذي يولّد نوعين مختلفين من التصورات الأخلاقية والسياسية والمعرفية والنفسية والاجتماعية للعالم. وتلك الاختلافات العميقة بين أفراد الدولة القومية الحديثة ونظرائهم في الحكم الإسلامي إنّما تمثّل التجليات المجهرية المصغّرة للاختلافات الكونية المادية والبنيوية والدستورية، وكذلك الفلسفية والفكرية. أما الفصل السادس فيفترض أنّ الأشكال الحديثة للعولمة ووضع الدولة في هذه الأشكال المتعاظمة القوّة، يكفيان لجعل أيّ صورة من الحكم الإسلامي إمّا أمرًا مستحيل التحقّق، وإمّا غير قابل للاستمرار على المدى البعيد هذا إذا أمكن قيامه أصلًا. وبعبارة أخرى، يصل المؤلف إلى نتيجة مفادها: إذا جرى أخذ كلّ العوامل في الحسبان، فإنّ الحكم الإسلامي لا يستطيع الاستمرار نظرًا للظروف السائدة في العالم الحديث.
ويختم الكاتب بالفصل السابع “النطاق المركزي للأخلاقي”، متفحّصًا مآزق أخلاقية حديثة مع الإشارة إلى أسسها المعرفية والبنيوية بصفتها تؤسّس لأصل الأزمات الأخلاقية التي واجهتها الحداثة في كلّ صورها الشرقية والغربية. ويرى المؤلف أنّ استحالة فكرة الحكم الإسلامي ناتجة بصورة مباشرة من غياب بيئة أخلاقية مواتية تستطيع أن تلبّي أدنى معايير ذلك الحكم وتوقعاته، ويرى أنّ هذه الاستحالة هي تجلٍّ آخر لعدة مشاكل أخرى ليس أقلّها شأنًا الانهيار المطّرد للوحدات الاجتماعية العضوية ونشأة أنماط اقتصادية استبدادية، وانهيار العوامل الطبيعية والبيئية….الخ.
مقدمات:
بدأ وائل حلاق كتابه بمقدمات عن مفهوم الدولة والشريعة وعدد من المفاهيم الأخرى، معتبرًا أن أطروحته ببساطة تتلخص في أن مفهوم “الدولة الإسلامية” مستحيل التحقيق، وينطوي على تناقض داخلي، وذلك بحسب أي تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة. وأضاف أنه حتى بداية القرن التاسع عشر ولمدة اثني عشر قرنا قبل ذلك كان قانون الإسلام الأخلاقي المعروف باسم الشريعة ناجحًا في التفاعل مع القانون المتعارف عليه والأعراف المحلية السائدة التي تنظم شؤون كل من الدولة والمجتمع، لذلك فإن الشريعة كانت قانونًا أخلاقيًا أنشأ مجتمعًا جيد التنظيم، وساعد على استمراره. لكن مع بداية القرن التاسع عشر وعلى يد الاستعمار الأوروبي تفكك النظام الاقتصادي – الاجتماعي والسياسي الذي كانت تنظمه الشريعة هيكليًا، إن الشريعة نفسها أفرغت من مضمونها واقتصرت على تزويد تشريعات قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الحديثة بالمادة الخام.
لذلك فإن مسلمي اليوم بحسب حلاق يواجهون تحدي التوفيق بين حقيقتين: الأولى هي الوجود الحقيقي للدولة وحضورها القوي الذي لا يمكن إنكاره، والثانية هي الحقيقة ( الأخلاقية) المتمثلة في ضرورة استعادة شكل من حكم الشريعة. ويزيد من صعوبة هذا التحدي أن الدولة في الدول الإسلامية لم تقم بالكثير في سبيل إعادة تهيئة أي شكل مقبول من حكم الشريعة الأصلي. وخير دليل علي ذلك المعارك الدستورية للإسلاميين في مصر بعد ثورة 2011، وفشل الثورة الإيرانية كمشروع سياسي وقانوني إسلامي، وخيبات أخري مماثلة. لكن هذه الفرضية تنطوي على سؤالين؛ الأول: إذا كانت حالة الدولة الإسلامية غير متصورة، فكيف حكم بها المسلمون أنفسهم في ضوء الحضارة التي صنعوها والإمبراطوريات التي بنوها؟، والثاني: في ضوء هذه الاستحالة، ما نمط الحكم السياسي الذي يتبعه المسلمون في الحاضر، ويحتمل أن يتبعوه في المستقبل؟. ويذهب حلاق إلى أن أصل الدولة الحديثة أوروبي حصريًا، فلا يمكن لهذه الدولة بحكم طبيعتها أن تكون إسلامية في ضوء الأصل الجغرافي والنظامي والمعرفي للدولة الحديثة. ويعتبر أن الكفاح السياسي والقانوني والثقافي لمسلمي اليوم يرجع إلى قدر من غياب الانسجام بين تطلعاتهم الأخلاقية من جهة، والواقع الأخلاقي للعالم الحديث من جهة أخرى، وهو واقع لابد لهم من العيش فيه وإن كانوا لا يصنعونه بأنفسهم. فالغرب يعيش على نحو ما بحرية أكبر في حاضر يحتل موقعه في سياق سيرورة تاريخية صنعها هو بنفسه.
فتقهقر الأمر الأخلاقي في الدولة الحديثة إلى مرتبة ثانوية، وفصله بصورة عامة عن العلم والاقتصاد والقانون وما إلى ذلك، كان في جوهر المشروع الحديث، وهو ما أدى بنا إلى إهمال الفقر والتفكك الاجتماعي والدمار البغيض للأرض نفسها التي تغذي البشرية. لذلك يجب علينا أن نبحث عن مصادر أخلاقية في تقاليد أخرى، وهو ما دفع مفكرين مثل ألسدير ماكنتاير([1]) وتشارلز تايلور([2]) وتشارلز لارمور([3]) إلى البحث عن إجابات لدى أفلاطون وأرسطو وتوما الأكويني([4]) ومن شاكلهم. لكن حلاق ركز في هذا الكتاب على المصادر الأخلاقية الإسلامية؛ بسبب “أن للمسلمين تراثهم الخاص بهم، وهو تراث ضخم وثري يضرب بجذوره في قرون من الإنجازات الثقافية”. ويقول إن الخلاف بين المرجعيات الأخلاقية للفلاسفة الأوروبيين من جهة والتراث الإسلامي من جهة أخرى قائم على أن الفلاسفة اعتمدوا على مفاهيم نظرية وفلسفية وعلى تصور لمجتمع لم يعش فيه أحد قط، بينما التراث الإسلامي يعتمد على مشروع مركب يضم الظواهر النظرية الفلسفية والاجتماعية والأنثروبولوجية والقانونية والسياسية والاقتصادية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي كمعتقدات وممارسات نموذجية.
وانتقل الكاتب للتعبير عن فكرته من خلال الحديث عما أسماه “النموذج السائد في المجتمع”، حيث ينقل عن كارل شميت([5]) أن “النطاق المركزي” للحداثة الأوروبية هو التقدم التقني، معتبرًا أن “ديانة المعجزات التقنية والإنجازات البشرية والسيطرة علي الطبيعة” بشرت بحل جميع المشكلات. بينما كان النطاق المركزي في عصر الدين التقليدي هو التنشئة الأخلاقية، لذلك فإن المفاهيم كلها يتم التعامل معها في عصر معين من خلال “النطاق المركزي” لهذا العصر. ففي عصر التنوير مثلاً كان النطاق المركزي يتمثل في استبدال الأخلاق العرفية والتقليدية وكل الأديان بأخلاق نقدية وعقلانية. ومن هذا المنطلق يرى حلاق أن الشريعة (أو الأخلاق) هي النطاق المركزي للنموذج الإسلامي، فقد كانت متواجدة بقوة في الاقتصاد والمجتمع والقضاء والتعليم، وإن كانت بشكل أقل في السياسة، إلا أن السياسة كانت تتأثر بالعوامل السابقة. ويرى الكاتب أن المسلمين لا يزالون يجدون في تاريخهم – كما يجد الغرب في عصر التنوير – مصدرًا يستطيعون البناء عليه لمواجهة تحديات المشروع الحديث الذي ثبت فشله، معتبرًا أن المقارنة بين الشريعة والتنوير لا تفي بكل الأغراض، لكن الشريعة بوصفها نطاقًا مركزيًا للأخلاقي، لا تمثل فقط ندًا للتنوير وللنطاق الأخلاقي الناتج عنه، بل تمتلك أيضًا إمكانية أن تكون ينبوعًا أخلاقيًا هاديًا إلى أبعد الحدود. وبناء على ما سبق يؤكد الكاتب أنه من المشروع استدعاء أي نطاق مركزي للأخلاق من الماضي أو الحاضر، يمكنه أن يوفر لنا مصدرًا للإحياء الأخلاقي، فعلى الرغم من أن الماضي بائد ماديًا ومؤسسيًا، فإن مبادئه الأخلاقية ليست كذلك، وهكذا فإن استدعاء نموذج الحكم الإسلامي هو على القدر نفسه من المعقولية والمشروعية مثل استدعاء أرسطو والإكويني وكانط([6]).
في الفصل الثاني والثالث انتقل الكاتب للحديث عن الدولة الحديثة والفصل بين السلطات:
يتحدث حلاق عن طبيعة الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن معظم المفكرين والفلاسفة لديهم نظرات مختلفة لمفهوم الدولة، وهذا التنوع في المنظور (Perspectivism) نتج عنه تنوع في شكل الدولة عند كل منهم. لكن يمكن أن نجمع ما بين بيروقراطي فيبر([7]) وقانوني كلسن([8]) وسياسي شميت واقتصادي ماركس([9]) وهيمني غرامشي([10]) وثقافي فوكو([11]) في سردية متماسكة تمثل تصورنا للدولة .
ويرى أن هناك خمس خواص للشكل تمتلكها الدولة الحديثة ولا يمكنها الوجود أو الاستمرار بدونها وهي:
- أولاً، تكوين الدولة كتجربة تاريخية محددة ومحلية إلى حد بعيد، فهي ترتيب سياسي ثقافي جديد ومحدد، ذا أصل أوروبي على نحو مميز.إذ كانت أوروبا هي المعمل الوحيد الذي صنعت فيه الدولة الحديثة، والتي تأثرت بتراث التنوير والعوامل الاقتصادية التي شهدتها، لذلك يمكننا أن نقول إن الدولة الغربية الحديثة هي نتاج تاريخي في المقام الأول.
- ثانيًا، الدولة كما أنها حادثة تاريخية، فهي كيان مركب من أشياء حقيقية وخيالية وفكرية أسطورية ورمزية، ومفهوم السيادة من أهم خواص شكلها، فالدولة ليست مجموعة من المؤسسات المتمايزة فحسب، لا، بل هي بناء إيديولوجي يتغلغل في نسيج المجتمع الذي تحكمه الدولة، ويشكله.وتقوم فكرة السيادة على أن الأمة صاحبة السيادة، فهي وحدها صاحبة إرادتها ومصيرها، وللسيادة أبعاد داخلية وخارجية، ولا يفقد هذا المفهوم أي من عناصر قوته حتى حين تصل قوى غير ديموقراطية إلى السلطة، فقد أثبت هذا المفهوم نجاحًا إلى درجة أن نظامًا يعلم الجميع أنه لا يمثل شعبه، بل يضطهده، يظل مخولاً للتحدث بصورة شرعية بالنيابة عن مواطنيه مادام يحوز شكل الدولة بعناصرها الخمس، وفي القلب منها السيادة.
- ثالثًا، احتكار الدولة التشريع والعنف المشروع: فالإرادة السيادية تولد القانون الذي يعبر عن الإرادة، وعلاقة الاقتضاء والتبعية الضرورية بين السيادة وصنع القوانين تفسر السبب الذي يتوجب على الدولة أن تدعي ملكية قانونها، فما تتبناه يصبح لها، وفرض القانون يصبح تحققًا لتلك الإرادة.
- رابعًا، جهاز الدولة البيروقراطي: فعبر الجهاز البيروقراطي العقلاني للدولة يعامل الكل على قدم المساواة، لا لجمهور الناس فحسب، بل أعضاء جهاز الدولة أنفسهم، فبالرغم من الثورات والأنظمة المتغيرة طوال قرنين من الزمان ظلت البيروقراطية بمنجاة عن التغيير كسمة رئيسية من سمات شكل الدولة، بل إن البيروقراطية والإدارة لم تصبحا مكونين دائمين في الدولة فحسب، بل تواصلان النمو المطرد في كل من تعقيدهما وشمولهما وتطرحان أسئلة دستورية عميقة في أي دولة حديثة.
- خامسًا، تدخل الدولة الثقافي في المجتمع: فالدولة والثقافة/ المجتمع تنتجان واحدتهما الأخرى بطريقة جدلية، وجدلية الدولة/ الثقافة من الخواص الرئيسية لشكل الدولة، إذ لا يمكن أن توجد دولة ناضجة ومستقرة دون هذه الجدلية، فالتماسك والقوة الداخليين لأي دولة لا يعتمدان على قدرتها على تنظيم المجتمع فحسب، بل يعتمدان على التوغل فيه ثقافيًا. لذلك فالدولة الحديثة لا تقبل وجود كيانات لديها ولاء موازٍ للولاء للدولة، حيث يعمل التوغل الثقافي على تدمير ثم إعادة تشكيل الوحدات الثقافية والاجتماعية السابقة على نشوء الدولة.
هذه الخواص الخمس لا تستطيع دولة الوجود أو الاستمرار من دونها، وأي تغيير فيها يتطلب بالضرورة، لا أن نعيد تقويم افتراضات أطروحتنا – كما يقول المؤلف – وبالتالي أطروحتنا ذاتها فحسب، بل أيضًا مجمل الخطاب حول الدولة منذ القرن الثامن عشر وحتى الوقت الحاضر، فهذه الخصائص مرتبطة بعضها ببعض بنيويًا وعضويًا، وأي تغيير في إحداها يستلزم تغييرًا في الأخرى، وهذه العلاقة الجدلية ليست واضحة تمامًا فقط بل هي أيضًا أساس لاستمرارية وجود الدولة الحديثة وعملها.
ثم يتناول حلاق مؤسسات نموذج الدولة الأوروبية الحديثة التشريعية والتنفيذية والقضائية منطلقًا من أن الإرادة السيادية منتج تاريخي يجسده قانون الدولة التي تعد تجسيدًا لهذا القانون، والقانون يعبر عن قوة جبرية تسانده، وكل ذلك غير منفصل عن الثقافة، لذا فالدولة تنتج جماعتها الخاصة وتمتلكها، وهي في سياستها وقانونها وثقافتها واجتماعها تمثل وحدة مترابطة بقوة، وتعني الوحدة البنيوية الداخلية للدولة الحديثة أن توزيع القوة القانونية لا يتقاطع مع كل خطة حياة فردية فحسب، بل أيضًا مع كل الوحدات التي تكون الدولة، لذا لا بد من تحديد العلاقة بين هذا النظام المعياري والمؤسسات التي تجسده، خاصة تلك المؤسسات التي تتخصص في فض المنازعات وتفعيل مبادئها الخاصة.
ويبدأ حلاق من هذه النقطة في شرح نظام الفصل بين السلطات في الدولة الحديثة باعتباره العمود الفقري، وأساس الحرية والحكم الديموقراطي، فالفرع التشريعي لا يجب أن يتمتع باستقلال كامل تفرضه طبيعته فحسب، بل يجب أيضًا ألا يفوض سلطاته، وخصوصًا إلى السلطة التنفيذية، ولا يمكن للدولة أن تصبح دستورية، وبالتالي ديموقراطية، إلا بتحديد هذا الفصل تحديدًا واضحًا.
لكن التجربة التاريخية حتى اليوم تقرر بأسى أن هذا الفصل لا يبدو ممكنًا، لأن الخطاب البلاغي عن الفصل ونظريته لا يفتقد الدعم المهم من الحقائق القائمة فحسب، بل يحجب أيضًا واقعًا يبدو فيه الفصل مشكلاً بقدر إشكالية الزعم بأنه أساس الحكم الديموقراطي، ويستعرض المؤلف الدراسات والتجارب الدستورية التي تؤكد دعواه تلك، مؤكدًا أن الفصل التام بين السلطات في بنى الدولة الحديثة مستحيل، ويؤكد كذلك أن هذا الأمر يطال أيضًا السلطات القضائية في الدولة الحديثة التي تميل دائمًا للتكيف مع النظام الحاكم أيًا كان نوعه، وتؤكد دائمًا على فكرة السيادة، فترسخ القضاء في نظام الدولة يفسر أيضًا علاقته بالسلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي يستحيل معه الفصل بين السلطتين، ليستنتج من ذلك أن التوزيع الملائم للسلطات لم يتحقق قط في الدولة الحديثة.
نموذج الحكم الإسلامي:
ثم يعقد الكاتب مقارنة بين نموذج الحكم الإسلامي والدولة الحديثة، ويقرر أنه لم يكن ثمة دولة إسلامية قط، فالدولة شيء حديث، لذلك فإن اللجوء إلى استعمالات مثل “الدولة الإسلامية” ككيان وُجد في التاريخ، ليس انخراطا في تفكير ينطوي على مفارقة تاريخية فحسب، بل ينطوي كذلك على سوء فهم للاختلافات البنيوية والنوعية بين الدولة الحديثة وأسلافها، خصوصا ما سماه بـ”الحكم الإسلامي”([12]).
ويضيف أن الحكم الإسلامي “الموازي لما نطلق عليه الدولة” يقوم على أسس أخلاقية وقانونية وسياسية واجتماعية وميتافيزيقية مختلفة جذريا عن الأسس التي تدعم الدولة الحديثة.
فالنموذج الذي يمثله كل منهما مفارق للآخر في منطلقاته ومحدداته الأخلاقية والسياسية والقانونية، بل والميتافيزيقية، ومن ثم في أهدافه النهائية. فإذا كانت “الجماعة أو the community” هي الشكل السياسي، والإطار الأخلاقي والقانوني في الحكم الإسلامي، فإن هذا الإطار في الدولة الحديثة هو “الأمة أو the nation”. إذ إن الشريعة الإلهية هي أساس الجماعة، فإن حدود إطارها السياسي مفتوحة، وقابلة للتمدد. في حين أن إطار الأمة مغلق بحدود جغرافية وسياسية معينة ونهائية. أين يكمن مصدر هذه الاختلافات؟ أولها كما يقول المؤلف أن الدولة الوطنية (the nation-state) هي نهاية في ذاتها، أو “نهاية النهايات”. لا ترى هذه الدولة إلا نفسها. وبالتالي فهي المصدر الوحيد والحصري لسيادتها ولإرادتها السيادية. في المقابل، نجد أن الجماعة ماهي إلا مجرد أداة لنهاية أعظم لا تملك في شأن تقريرها أي سلطة. ما يعني أن الجماعة لا تملك سيادة، ولا إرادة سياسية وقانونية مستقلة. وذلك لأن الله (وليس الجماعة) هو وحده مصدر السيادة. وبما أن الله هو “ملك الملوك”، فهو أيضاً نهاية النهايات. صحيح أن الجماعة تملك سلطة القرار، لكنها سلطة تفسيرية وحسب، محددة بمبادئ أخلاقية تتجاوز الجماعة، مبادئ مستمدة من شريعة إلهية لا تملك الجماعة حيالها إلا سلطة التفسير.
ويقول حلاق أن كل إقليم تطبق فيه الشريعة كقانون نموذجي يعتبر مجالا إسلاميا “دار إسلام”، وكل مكان لا تعمل فيه الشريعة أو تُبعَد فيه إلى مكانة ثانوية يعد دارًا للحرب. وفي الإسلام تحل الأمة محل شعب الدولة القومية الحديثة. وفي حين أن الدولة القومية هي غاية الغايات ولا تعرف إلا ذاتها، فإن الأمة وأعضاءها وسيلة لغاية أعظم، فبالرغم من كون الأمة تملك سلطة القرار، لكن هذه السلطة محكومة بقواعد أخلاقية تمثل تعبيرا عن الإرادة الأخلاقية الإلهية، فالله هو غاية الغايات وهو صاحب السيادة ومالك كل شيء. وإذا كانت الإرادة السيادية في الدولة الحديثة ممثلة في القانون، فكذلك إرادة الله السيادية في نظام الحكم الإسلامي تتمثل في قانونه “الشريعة”.
ويذهب حلاق بعيدا عندما يقول إن الأمة الإسلامية أنتجت خبراءها القانونيين “أئمة الفقه”، من الطبقات الدنيا والوسطى، وتم النظر إليهم باعتبارهم مدافعين عن المجتمع، وتأثروا بالنزعة المساواتية المنتشرة في القرآن مع إعطاء الأولوية للضعفاء والمحرومين. فتوسطوا بين الطبقات غير النخبوية والسلطة، فبرز الفقهاء والقضاة كقادة مدنيين وجدوا أنفسهم بحكم طبيعة مهمتهم مشاركين في الإدارة اليومية للشؤون المدنية، مستشعرين المسؤولية تجاه الأشخاص العاديين، وكثيرا ما بادروا بالتحرك نيابة عن المقهورين. فتقاطع مصير الفقهاء ورؤيتهم إلى العالم مع مصالح مجتمعاتهم، ولم تجعلهم مهنتهم كحماة للدين وخبراء في الشريعة ومثالا يحتذى به للحياة الفاضلة، الممثلين الأكثر أصالة للعامة فحسب، بل جعلتهم أيضا ورثة الرسول، فقد كانوا ركن الشرعية والسلطة الدينية والأخلاقية. وقد تراكم هذا التراث الفقهي مع الزمن وانتقل من جيل إلى آخر من خلال الذاكرة والتدوين. وكان قائما على اهتمام عميق بالمجتمع ومبادئه وأخلاقه العامة، وليس على قانون يأتي من أعلى إلى أسفل.
بعد كل ما سبق يستنتج الكاتب أن القانون في الإسلام هو ظاهرة اجتماعية في الأساس وليست سياسية، بعكس ما عليه الحال في الدولة الحديثة، التي يرى هانز كلسن([13]) أنها هي نفسها نظامها القانوني ولا يمكن الفصل بينهما.
وقد تراكمت الخبرات الفقهية عبر قرون وأصبح الفقهاء والقضاة يتمتعون بمرونة عالية لمواجهة الأحداث المختلفة، وخلقت حالة تنوع كبيرة، وحتى حينما كانت النخبة تستغل الشريعة لخدمة أغراضها، فإنها كانت تفعل ذلك وفق قواعد الشرعية. ولم يكن القضاء الإسلامي – بحسب الكاتب – مكرسا لتطبيق قانون حددته القوى المسيطرة في الدولة أو حدده حاكم متعجرف، بل مكرسا لحماية الشريعة التي تهتم بشكل أساسي بتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية على أسس أخلاقية. ورغم أن الحاكم هو من يعين القاضي ويعزله، إلا أنه لا يملك التدخل في عمله.
ويلفت حلاق النظر إلى ملحوظة مهمة، فبعد القرن التاسع الميلادي لم يعد الحكام هم الخلفاء الذين لديهم دراية بالفقه والشريعة، بل تحولوا إلى سلاطين أصحاب خلفيات سياسية وعسكرية، قدم أكثرهم من وسط آسيا، ورغم هذا لم يكن القضاة في أي محكمة يستطيعون تطبيق أي قانون سوى الشريعة. كما أن القوة الأخلاقية النموذجية للشريعة خففت من احتمالية وجود تواطؤ بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
ويقدم حلاق تفسيرا تاريخيا لمكانة الشريعة في نظام الحكم الإسلامي فيقول إن حكام البلاد الإسلامية عموما كانوا غرباء عن المناطق التي حكموها، وكثيرا ما كانوا غير مسلمين واعتنقوا الإسلام في مرحلة لاحقة وتطلب الأمر جيلا أو جيلين ليتعودوا على القيم والعادات الإسلامية المحلية. ونظرا إلى افتقارهم لآلة البيروقراطية التي تتمتع بها الدولة الحديثة، لم يكن بوسع هؤلاء اختراق المجتمع إداريا، ووجدوا في الشريعة أداة حكم جاهزة، وفي الفقهاء وسطاء مهمين بصفتهم ممثلي الأمة، وهكذا قبلوا بشروط الشريعة وأدوا واجباتهم تجاه الأمة وفقهائها وحصلوا على المنافع المالية التي استطاعوا الحصول عليها في حدود المعقول غالبا. وهذا يشبه حال الحكام في الدول الغربية، فهم ملزمون بالعمل بالقواعد والمعايير العامة التي تتسم بها الديمقراطيات الليبرالية.
يعني كل هذا أن الحاكم التنفيذي كان يقف بمعزل عن السلطة التشريعية، وحتى السلطة القضائية كونه خاضعا لأوامرها من نواح كثيرة. ولم يكن للسلطان سيادة حقيقية، فعلى الرغم من امتلاكه أدوات العنف، فإنه لم يكن يمثل إرادة شعبية أبعد من التي منحها له الفقهاء نيابة عن الشعب. وكانت المقايضة واضحة: يفرض السلطان الضرائب مقابل الشرعية التي يسبغها عليه الفقهاء، وهي شرعية لا تمنع عزله إذا لم ينفذ أوامر الشريعة، بما فيها الحفاظ على الانسجام الاجتماعي.
ومجمل القول إن سيادة الشريعة كانت حكما للقانون أكثر تفوقا من نظيره الحديث، وليس سعي المسلمين اليوم إلى تبني نظام للفصل بين السلطات الخاصة بالدولة الحديثة سوى رهان على صفقة أقل شأنا مما ضمنوه لأنفسهم عبر قرون كثيرة من تاريخهم، وتمثل الصفقة الحديثة سلطة الدولة التي تهدف إلى ديمومتها وسيادتها وخدمة مصالحها هي نفسها، بينما لم تخدم الشريعة الحاكم أو أي شكل من أشكال السلطة السياسية لأنها لم تصمم لهذا الغرض أصلا، بل خدمت الشعب والجماهير والفقراء والمستضعفين دون أن تلحق الضرر بالتاجر ومن على شاكلته، وبهذا المعنى لم تكن غاية في الديمقراطية فحسب، بل كانت إنسانية بطريقة غير معهودة في الدولة الحديثة وقانونها.
وفي الفصل الرابع “القانوني والسياسي والأخلاقي”:
يحاول الكاتب فهم علاقة الأخلاقي والقانوني والسياسي بمفهوم الحداثة للدولة القومية. ويقرر أن نشأة القانوني والسياسي في المشروع الحديث يجعلهما غير متوائمين مع الأشكال المؤسسة لأي نمط إسلامي للحكم، لأنهما يتناقضان مع أدنى درجات النسيج الأخلاقي الذي يجب أن يتوفر في أي حكم إسلامي.
ويؤكد الكاتب ذلك عبر مناقشته لمشكلتين معضلتين عويصتين توضحان بجلاء عبث الجري وراء نموذج الدولة الحديثة من وجهة نظره، وهما:
الأولى: المشكلة المتعلقة بنشأة القانوني، أو مشكلة التمييز بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فالغرب الحديث مهووس باكتساب معرفة السيطرة، وترتبط هذه السمة بنيويًا بفكرة عصر التنوير عن الذات المستقلة، فالإنسان الحديث يمتلك من وجهة نظر فريدريش شيللر([14]) إرادة قًبلية ونضالاً متأصلا من أجل المعرفة، ينشأ من دافع فطري، وبناء قيمي متمركز حول الرغبة في السيطرة على العالم المادي، وبالمقارنة ببنى الفكر الشرقية، فإن الميتافيزيقا الغربية تقوم على وعي بالذات مختلف كليًا، وعلى تفسير للإنسان مختلف تمامًا بصفته صاحب سيادة على الطبيعة بأكملها.
فالإنسان خلق ليتملك الطبيعة ويحكمها حسب فلسفة عصر التنوير، واتجاه الحداثة للسيطرة على الطبيعة أدى إلى تقنين مفهوم الموارد الطبيعية، وهو ما ينتج خطاب الموارد الطبيعية وممارسته، وهما خطاب وممارسة شديدا الاستغلالية والعنف، يتولدان بالضرورة من تجريد الطبيعة من كل قيمة، وحين تكون الطبيعة متوحشة وبليدة فإنه يمكن للمرء أن يتعامل معها من دون أي قيد أخلاقي، وهو ما يحدث بالضبط منذ أوائل القرن التاسع عشر.
ومن العوامل الرئيسية والجوهرية في مشروع الحداثة؛ فصل المادة عن القيم ” فصل الحقائق عن القيم”، وهذا أدى إلى ظهور ما سمي بالعلم الموضوعي والمنفصل في كل المجالات التي رعتها الدولة الحديثة وشكلتها، وليست الدولة الحديثة وإرادتها السيادية، المتمثلة في القانون، جزءًا لا يتجزأ من رؤية العالم هذه فحسب، بل هي أيضًا واحد من معماريها الأساسيين.
وإذا كان توماس هوبز([15]) رينيه وديكارت([16]) هما اللذان كيفا فكرة الانقسام بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون في البداية وبصورة مبسطة، وإذا كان ديفيد هيوم([17]) هو الذي طرحها كإشكالية فلسفية، في حين ترجمها جون أوستن([18]) إلى الوضعية القانونية، فإن فريدريك نيتشه([19]) هو الذي أعلى سقفها الوضعي بإنكاره الحاد صحة الانقسام كليًا عبرالتضحية بالقيمة، أو بما ينبغي أن يكون، فقد جرد فلسفته من كل قيمة وجعل ما ينبغي أن يكون، فارغًا وخادعًا بالكلية، ليقلب نيتشه الأخلاق الأوروبية المسيحية رأسًا على عقب.
هذا التفسير المادي يلغي فكرة المسؤولية الأخلاقية ويحول القانون إلى مجرد آلة خالية من القيم والمبادئ. فهناك رفض لفكرة وجود ارتباط بين القانوني الذي ينبغي أن يكون “القيم” وما هو كائن “الحقيقة”، ولتحقيق المعادلة في هذا النموذج يتم التضحية بالقيمة في مقابل الاعتراف والاستسلام للحقيقة الواقعة وهي حقيقة سيادة الدولة القانونية والسياسية.
وعلى العكس فإن الأخلاق القرآنية المتمحورة حول الأعمال الصالحة متغلغلة في الشريعة حتى النخاع، وظلت عنصرا مركزيا للممارسة الشعبية للمسلمين عبر القرون. وقد طور الفقهاء هذه المعاني إلى قوانين الشريعة، ولم يفصلوا بين القانوني والأخلاقي.
الثانية: مشكلة نشأة السياسي: حيث صاحبت نشأة الدولة القانونية بهيئتها الوضعية نشأة السياسي؛ فالسلطة هي الإله الجديد، وأصبحت السلطة والقواعد الوضعية غير قابلتين للانفصال، مثلما أصبح السياسي والقانوني أشبه بالهوية، أو هوية كاملة داخل الدولة.
ففي العالم كما هو قائم، السلطة وليس الأخلاق، هي الحكم النهائي فيما يتعلق بكل ما هو سياسي، فالسياسي ظاهرة شاملة، متغلغلة، تقتحم كل المجالات، بل تقتحم الوجود نفسه، ومثل ما إن عصورًا أخرى توصف بأنها العصر البرونزي أو العصر التكنولوجي، فالسياسي أيضًا هو اسم لعصر، إنه مجال للفعل يتغلغل في الحياة بأكملها، ويعتبر أي بحث فيه بمنزلة البحث في نظام الأشياء البشرية الحديث، فالسياسي هو التجلي الأكبر لمشروع التفريق بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، وبين الحقيقة والقيمة.
وينشأ السياسي بالتفرقة بين العدو والصديق، وعلى وجه الدقة ينشأ في اللحظة التي يولد فيها هذا التمييز، فعندما يشرع مجتمع ما في النظر إلى وجوده باعتباره وجودًا عنيفًا وحربيًا، أو على أنه في حالة الطبيعة، التي يكون فيها البقاء مهددًا على الدوام، ويعتبر العنف والعداء ركيزتا السياسي وقوته المضمرة، يظل التمييز بين الصديق والعدو هو قوام السياسي دائم الحضور والمتحقق، ولتصبح الدولة ليست موضوع السياسة الوحيد فحسب بل وعاؤها أيضًا، فلا أحد يستطيع العيش خارج المواطنة، حيث لا يمكن لأحد أن يجد مساحة مستقلة خارج الدولة، فالمواطن هو مواطن الدولة، بقدر ما الدولة هي دولة المواطن.
مجمل القول أن الذات الحديثة هي كيان متجنس قومي أو منتم إلى أمة، أي أنها ذات متماهية مع الأمة كطريقة حياة، فالمواطن يؤسس المعنى السياسي لمواطنته من خلال قبوله معنى الدولة والإقليم والأسرة الأكبر – أي الأمة، والتشبع بها كطبيعة ثانية، وإحدى النتائج المترتبة على ذلك أن يرى المواطن ذاته – أي مواطنته – مالكة للقدرة على التضحية بالنفس من أجل الدولة، فالدولة الحديثة لا تتحقق بشكل كامل عندما تحميني من العنف، بل عندما تجندني في قواتها المسلحة، الدولة الحديثة هي الإله الجديد الذي يتحكم في الحياة والموت على أساس إرادة قانونية سيادية ووضعية؛ فالدولة ككيان أخلاقي، لا يمكن دعمها حتى نظريًا، فهذا الأمر يصطدم بحقائق الدولة. فالدولة الحديثة لا يمكن أن تقام على أسس أخلاقية، كما لا يمكن أن تعمل وجوديا ككيان أخلاقي، وأي حجة تقدم في هذا السبيل هي حجة سياسية، أو طريقة لإضفاء الشرعية على الطموح السياسي.
وفي الفصل الخامس “الذات السياسية والتقنيات الأخلاقية لدى الذات“:
يقول الكاتب في هذا الفصل أن أي مجتمع من المجتمعات لابد أن يتواجد به شكل من أشكال الضبط تحكم سلوك الأفراد وتوجهاتهم، وهذه الأشكال متعددة، وتختلف من مجتمع لأخر، ويقول أنه مع ظهور الدولة الحديثة فإن هذه الأشكال اختلفت عن الأشكال التي كانت موجودة إبان الحكم الإسلامي .
ويكمن الاختلاف الأول في إنتاج رعايا الدولة، فالمواطن الجديد يتعرف على نفسه في الدولة الحديثة ويكون مستعدا للموت من أجلها، ولأن الدولة منتج أوروبي فإن المواطن كذلك أيضا، ولأن الدولة الأوروبية شكلت قفزات هائلة في الثروات بعد الاستعمار والثورة الصناعية، فإن هذه الثروات صبت في مصلحة الحاكم على حساب المواطنين، وهو ما أدى إلى إنشاء جهاز شرطة امتد على اتساع البلاد وليس في الحضر فقط. ولأن القوة وحدها لا تكفي فقد تم إنشاء نظام تعليمي يتم من خلاله السيطرة على المواطنين، فأكملت المدرسة دور الشرطة، ثم أنشأت الدولة نظام الرفاه الاجتماعي لتجنب السخط الذي يمكن أن ينتج عن الفقر والمرض. وكان كل هذا يعمل ضمن آلة بيروقراطية هائلة. وأصبح تكوين الذات يتم بإرادة خارجية. كما أن الأسرة في الدولة الحديثة أصبحت مدمجة بالكامل في جهاز الضبط الذي أقامته الدولة، ولم تعد ركنا من أركان المجتمع، وأصبح ينظر إليها ليس باعتبارها وحدة اجتماعية عضوية تسعى الدولة لإسعادها والعمل علي رفاهيتها، بل إلى كونها وحدة تنتج الذات الوطنية. لذلك فالرعايا مدمجون سياسيا ومتأثرون بميتافيزيقا الدولة. فوضع المواطن في قفص حديدي من الخواص التي كرستها الدولة، وهو ما أدى إلى الحرمان الروحي بحسب تعبير ماكس فيبر، أو الفقر العاطفي بحسب تعبير تيودور أدورنو([20]).
وانتقل الكاتب للحديث عن التقنيات الأخلاقية لدى النفس: حيث يقول إنه لا يمكن لنموذج الدولة الحديثة وقدرتها المتأصلة على إنتاج الرعايا أن يجد أي أرضية مشتركة مع نموذج الحكم الإسلامي. مشيرا إلى أن أحد أهم الفروق بين النموذجين هو التجربة التاريخية الناظمة، فالتجربة الأوروبية أفرزت الدولة الحديثة، أما الحكم الإسلامي فهو نتاج العالم الإسلامي بأكمله بما يضمه من ثقافات وخبرات ورؤى متنوعة. ويعتبر عدم وجود ملك أو دولة يتحكمان في التشريع اختلافا أساسيا يميز النموذج الإسلامي، فالتشريع في الإسلام يبرر وجود الحاكم ووجود واقع سياسي معين، لكنه ليس نتاجا للسياسة أو السياسي. كما أن النظام الإسلامي لم يعرف أدوات مراقبة قاسية، ولا تدخلا كبيرا في مجال التعليم. لذلك فالحكم الإسلامي أنتج ذوات قائمة على الشريعة بما تمثله من تعبير عن سيادة الله على الأرض.
ثم تحدث الكاتب عن قضية تعارض الذاتيات، فاعتبر أن الإسلام يفرض على المسلم أن يكون أخلاقيا من باب أن الحب والخوف يتضافران لتحقيق إحساس عميق بالخضوع لقوة أعلى هي الله، بحسب تصور أبو حامد الغزالي الذي جمع ما بين الأخلاق والقانون والعقيدة والتصوف والفلسفة. فبهذا المعنى تتحول تقنيات النفس إلى تقنيات للجسد ويتم الدمج بين “الزهد والحقيقة”. أما في الدولة الحديثة فهي خلاف ذلك، لا تعطي قيمة كبيرة للجانب الأخلاقي وهناك ظواهر حديثة ارتبطت بها كالظواهر المرتبطة بمذهب المتعة والانغماس في الذات. فتقنيات الجسد الجديدة تُعبأ بمطالب العالم المادي، وبتشكيل ما هو جسدي وتقويته وإطالة أمد إقامته المتوقعة والزائلة علي الأرض. والنتيجة، هي الانفصال وتشظي النفس والنرجسية الشاملة.
وفي الفصل السادس “عولمة تضرب حصارها، واقتصاد أخلاقي“:
يقول الكاتب في ظل العالم المعولم الذي نعيشه اليوم فإنه حتي لو توفرت كل خواص الدولة الإسلامية فلن يكون ذلك كافياً لتنجح هذه الدولة. فالعولمة ليست ظاهرة اقتصادية فقط، ولكنها أيضا سياسية وثقافية بشكل واضح. ويضيف أن المعاني والحوادث العالمية تتشابك في الحياة المحلية بسبب تكنولوجيا الاتصال.
ويقول حلاق إنه بينما تتسم الفلسفة الاقتصادية الليبرالية على مستوى كل من الدولة والعولمة بالتجارة الحرة والحركة الحرة لرأس المال والخصخصة والرغبة في تعظيم الربح وتراكم الثروة من أجل ذاتها، يتأسس النموذج الإسلامي على ما يمكن أن ندعوه اقتصادا أخلاقيا، وذلك من خلال تزكية المال والمشاركة في الأعمال الخيرية كالصدقة والوقف والتركيز على المسؤولية الاجتماعية للمال. واذا كان الحكم الإسلامي لا يتوافق مع الدولة الحديثة، فإنه من باب أولى أقل توافقا مع الشكل الحالي للعولمة، فلكي يستطيع الحكم الإسلامي أن يجعل نفسه كيانا معترفا به سياسيا يجب أن يعترف به كمشارك في مجتمع الدول القومية، وبهذا يكون نجاح هذا النوع من الحكم معقدا إلى درجة تقترب من المستحيل، فهو مطالب أن يكون ذاته في عالم ينكره تماما.
ويقول الكاتب إن هناك ثلاثة تحديات يطرحها نظام العولمة الذي تسود فيه الدولة القومية على نظام الحكم الإسلامي وهي: الطبيعة العسكرية للدول الإمبراطورية القوية، والتغولات الثقافية الخارجية، والسوق العالمية الرأسمالية الليبرالية الضخمة. وليست هذه التحديات مستقلة عن بعضها البعض، لأن مراكز القوة العسكرية هي نفسها تقريباً مصادر الهيمنة الثقافية والاقتصادية. وقد يصاحب التحدي الاقتصادي في بعض الأحيان إلزامات وفروض عسكرية وثقافية. وثبت أن الهيمنة الثقافية غالباً ما دعمت العولمة الاقتصادية وأسواقها الحرة.
وعلي الحكم الإسلامي أن يفهم، مصادر هذه الظواهر الثقافية وماديتها وغرائزيتها ونرجسيتها وميلها البنيوي إلي فصل الأخلاق والقيمة من جهة أولي، وعن الحقيقة والعلم والقانون والاقتصاد من جهة أخري.
وفي الفصل السابع “النطاق المركزي للأخلاقي“:
يخلص حلاق في هذا الفصل إلى أن افتراضات الخطابات الاسلامية الحديثة خاطئة عندما تنظر إلى الدولة الحديثة بإعتبارها أداة محايدة للحكم، يمكن استخدامها في تنفيذ وأداء وظائف معينة طبقا لخيارات قادتها و قراراتهم. وأن بمقدور قادتها أن يحولوا آلة الحكم (الدولة) إلى ممثل لإرادة الشعب بدلا من استخدامها للقمع. فالدولة الحديثة ليست محايدة ولا تستطيع أن تكون كذلك فهي تأتي بترسانتها من الميتافيزيقا وأشياء أخرى، لتنتج آثارا متفردة معينة: سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ومعرفية ونفسية. ما يعني أن تلك الدولة تصوغ نظما معرفية تحدد بدورها وتشكل المشهد الذي تبدو عليه الذاتية الفردية والجماعية. وجاءت العولمة فزادت من عمق هذه المشكلة.
وطالب المؤلف النخب المسلمة اليوم برفض التجربة القائمة على الدولة الحديثة في العالم الإسلامي باعتبارها فشلا سياسيا و قانونيا لا يمكن التعلم منه، فالدولة الحديثة في العالم الإسلامي ليست مصدرا للإلهام، مفضلا أن يتم التركيز على الشريعة ذاتها. لذلك يدعو النخب الإسلامية للاختيار ما بين الاستسلام للدولة الحديثة، أو أن تعترف الدولة الحديثة والنظام العالمي بشرعية الحكم الإسلامي، وكلا الأمرين صعب التحقق. أو البحث عن خيار ثالث يمكنه أن يعالج مشاكلهم ومشاكل العالم مع الحداثة و دولتها. ويطالب الكاتب العالم بالإجابة على سؤال يقول: ما هو النطاق المركزي الذي يجب أن يسود عالمنا؟ ويرى أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تقدم إجابة شافية على هذا السؤال من خلال: أن يطرح المسلمون أشكال حكم جديدة مبنية على تراثهم. وأن يعيد المسلمون ونخبهم الفكرية والسياسية صياغة قواعد الشريعة خلال عملية بناء المؤسسات الجديدة وأن يتفاعلوا مع نظرائهم الغربيين في ما يخص ضرورة جعل الأخلاقي النطاق المركزي.
ويختتم المؤلف آخر فصوله بقوله: لا شك أن العيش معا في سلام على الأرض هو عمل شاق وقد يكون يوتوبيا حديثة أخرى، بيد أن إخضاع الحداثة لنقد أخلاقي يعيد هيكلتها، يبقى الحاجة الأساس، لا لقيام حكم إسلامي فحسب، بل لبقائنا المادي والروحي. إذ أن الأزمة ليست حكرا على الحكم الإسلامي والمسلمين.
عرض وتقديم
أ. أحمد محمد علي
باحث ماجستير في العلوم السياسية، جامعة القاهرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – ألسدير ماكنتاير فيلسوف وعالم أخلاق اسكتلندي تعرف عنه إسهاماته في فلسفة الأخلاق والفلسفة السياسية كما له العديد من الأعمال في تاريخ الفلسفة واللاهوت. يعمل حاليًا في مركز للدراسات تابع لجامعة لندن المتربوليتانية، كما يشغل منصب أستاذ فخري في قسم الفلسفة في جامعة نوتردام.
[2] – فيلسوف كندي من. يُعدّ أحد أبرز الفلاسفة المعاصرين في مجال الفلسفة السياسية والفلسفة الأخلاقية. تُرجمت أعماله إلى أكثر من عشرين لغة.
[3] – فيلسوف أمريكي معاصر، وأحد أهم الفلاسفة الأخلاقيين في مرحلة ما بعد الحداثة
[4] – قسيس وقديس كاثوليكي إيطالي من الرهبانية الدومينيكانية، وفيلسوف ولاهوتي مؤثر ضمن تقليد الفلسفة المدرسية. أحد معلمي الكنيسة الثلاثة والثلاثين، ويعرف بالعالم الملائكي والعالم المحيط. عادة ما يُشار إليه باسم توما، والأكويني نسبته إلى محل إقامته في أكوين. كان أحد الشخصيات المؤثرة في مذهب اللاهوت الطبيعي، وهو أبو المدرسة التوماوية في الفلسفة واللاهوت. تأثيره واسع على الفلسفة الغربية، وكثيرٌ من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة إما ثورة ضد أفكاره أو اتفاقٌ معها، خصوصاً في مسائل الأخلاق والقانون الطبيعي ونظرية السياسة.
[5] – أحد أهم المفكرين الألمان وأكثرهم إشكالية في القرن العشرين، يعتبر كارل شميت أحد الممهدين فكرياً لأطروحات المحافظين الجدد اللذين يلعبون حالياً دوراً رئيسياً في صوغ السياسة الخارجية الأمريكية. البعض يعتبره مفكراً رجعياً لأنه ساند النظام النازي بعد وصوله إلى سدة الحكم في عام 1933، تأثر كثيرا بهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي، ولعل الدافع الخفي لفلسفته جاء بمثابة رد فعل عنيف على تلك الهزيمة.
[6] – فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر. عاش كل حياته في مدينة كونيغسبرغ في مملكة بروسيا. كان آخر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبية الحديثة. وأحد أهم الفلاسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية.
[7] – المًا ألمانيًا في الاقتصاد والسياسة، وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولة، وهو من أتى بتعريف البيروقراطية.
[8] – فيلسوف ومحامي أمريكي (1881- 1973)، مؤسس المدرسة المعيارية أو النظرية الخالصة للحق، درس بجامعة فيينا، عمل أستاذا للقانون بجامعة كاليفورنيا. من أشهر مؤلفاته: “النظرية الخالصة للحق” (1934).
[9] – فيلسوف ألماني، واقتصادي، وعالم اجتماع، ومؤرخ، وصحفي واشتراكي ثوري. لعبت أفكاره دورًا هامًا في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات الاشتراكية. واعتبر ماركس أحد أعظم الاقتصاديين في التاريخ.
[10] – فيلسوف ومناضل ماركسي إيطالي، ولد عام 1891. تلقى دروسه في كلية الآداب بتورينو حيث عمل ناقدا مسرحيا عام 1916. انضم إلى الحزب الشيوعي الإيطالي منذ تأسيسه وأصبح عضوا في أمانة الفرع الإيطالي من الأممية الاشتراكية.
[11] – فيلسوف فرنسي، يعتبر من أهم فلاسفة النصف الأخير من القرن العشرين، تأثر بالبنيويين ودرس وحلل تاريخ الجنون في كتابه “تاريخ الجنون”، وعالج مواضيع مثل الإجرام والعقوبات والممارسات الاجتماعية في السجون. ابتكر مصطلح “أركيولوجية المعرفة”.
[12] – للمزيد حول هذا الأمر يمكن الرجوع إلي مقال الأستاذ محمد مرسي في موقع اضاءات بتاريخ 25 أغسطس 2016. والتي بعنوان ” الدولة المستحيلة مرة أخرى: قراءة نقدية جديدة ” علي هذا الرابط : https://www.ida2at.com/the-impossible-state-new-reading-23/
[13] – فيلسوف ومحامي أمريكي (1881- 1973)، مؤسس المدرسة المعيارية أو النظرية الخالصة للحق، درس بجامعة فيينا، عمل أستاذا للقانون بجامعة كاليفورنيا. من أشهر مؤلفاته: “النظرية الخالصة للحق” (1934).
[14] – يوهان كريستوف فريدريش فون شيلر هو شاعر ومسرحي كلاسيكي وفيلسوف ومؤرخ ألماني . يعتبر هو وغوته مؤسسي الحركة الكلاسيكية في الأدب الألماني، ويعتبر من الشخصيات الرئيسية في التاريخ الأدبي الألماني
[15] – عالم رياضيات وفيلسوف إنجليزي. يعد توماس هوبز أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصا في المجال القانوني حيث كان بالإضافة إلى اشتغاله بالفلسفة والأخلاق والتاريخ، فقيها قانونيا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من الأطروحات التي تميز بها هذا القرن على المستوى السياسي والحقوقي
[16] – فيلسوف، وعالم رياضي وفيزيائي فرنسي، يلقب بـ”أبو الفلسفة الحديثة”، وكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، هي انعكاسات لأطروحاته، والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصًا كتاب الذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة.
[17] – فيلسوف و اقتصادى و مؤرخ اسكتلندي و شخصية من الشخصيات المهمة فى الفلسفه الغربيه.
[18] – فيلسوف لغة بريطانياً. ويعرف في الأساس بأنه واضع نظرية أفعال الكلام.
[19] – فيلسوف ألماني، ناقد ثقافي، شاعر وملحن ولغوي وباحث في اللاتينية واليونانية. كان لعمله تأثير عميق على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث. بدأ حياته المهنية في دراسة فقه اللغة الكلاسيكي، قبل أن يتحول إلى الفلسفة.
[20] – فيلسوف وعالم اجتماع وعالم نفس وموسيقي ألماني، اشتهر بنظريَّاته النقدية الاجتماعية
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies