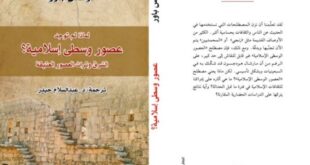Title: Political Order and Political Decay: From The Industrial Revolution to the Globalization of Democracy.
Author: Francis Fukuyama.
Edition: 1 ed.
Place of Publication: London.
Publisher: Profile Books Ltd.
Date of Publication: 2014.
Physical Description: 658 P., 24 cms.
ISBN: 978-1-84668-436-4
فرانسيس فوكوياما: النظام السياسي والسقوط السياسي
كيف قامت الدول في مختلف بقاع العالم؟ كيف تطورت المؤسسات السياسية عبر قرنين من الزمان في ظل ظروف تنموية شديدة التباين والاختلاف؟ كيف انتهي الأمر بعجز الدول وسقوط المؤسسات الديمقراطية الحديثة مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين؟ كيف حدث العجز والسقوط السياسي في أقوى وأعتى القلاع الديمقراطية والليبرالية الحديثة؟
تساؤلات عديدة وشائكة تم مناقشتها وبحثها باستفاضة من قِبَل المُنظر والباحث السياسي “فرانسيس فوكوياما Francis Fukuyama” في كتابه الأخير المُسمى بـ “النظام السياسي والسقوط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية”، أو Political Order And Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy
الكتاب – الصادر في لندن عام 2014 عن دار نشر “بروفايل بوكس ليميتيد Profile Books LTD” – سبقته كتب عدة للمؤلف الذي يعتبر من أهم رواد التنظير السياسي في القرن الواحد والعشرين، والذي تُعتبر كتاباته من أوسع الأدبيات انتشاراً وتأثيراً حول العالم. فمن كتاب”نهاية التاريخ The End of History” إلى كتاب “الرجل الأخير The Last Man” إلى كتاب “مستقبلنا ما بعد الإنساني Our Posthuman Future” إلى كتاب “أصول النظام السياسي The Origins of Political Order”، وأخيراً إلى الكتاب المعني في هذا المقام، سجل المؤلف بتلك الكتب أفضل الكتب مبيعاً في العالم؛ حيث تم ترجمتها ونشرها بلغاتٍ شتى في أنحاء المعمورة.
“فوكوياما” – الباحث والحاصل على زمالة أولى لـ”أوليفييه نوميللينيOlivier Nomellinie” بمؤسسة “فريمان سبوجلي للدراسات الدولية، ستانفورد Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford” – قام بتأليف كتابه الأخير في 658 صفحة؛ مُدرجاً المراجع والملاحظات والإهداءات والفهرس في حوالي 100 صفحة. والمؤلف – الذي تعتبر كتبه الأكثر مبيعاً عالمياً، ومحاضراته الأكثر طلباً دولياً، وظهوره الإعلامي الأوسع انتشاراً – قسم الكتاب المعني إلى أربعة فصول رئيسية، أعطاها العناوين التالية: الدولة؛ المؤسسات الخارجية؛ الديمقراطية؛ السقوط السياسي.
فبعد مقدمةٍ أفرد لها حوالي عشرين صفحة، بدأ “فوكوياما” بالفصل الأول “الدولة” الذي أدرج تحته العناوين الفرعية الآتية: ما هي التنمية السياسية؟؛ أبعاد التنمية؛ البيروقراطية؛ بروسيا تقيم دولة؛ الفساد؛ مكان ميلاد الديمقراطية؛ إيطاليا ومعادلة الثقة المتدنية؛ المحسوبية والإصلاح؛ الولايات المتحدة تخترع الزبائنية؛ نهاية أنظمة المحسوبية والغنائم؛ الطرق السريعة والغابات وبناء الدولة الأمريكية؛ بناء الأمم؛ حكومة رشيدة وحكومة غير رشيدة.
ينتقل بعدها “فوكوياما” إلى الفصل الثاني المُسمى بـ”المؤسسات الخارجية”، مُدرجاً تحته العناوين الفرعية الآتية: نيجيريا؛ جغرافيا؛ فضة ذهب سكر؛ كلاب لم تنبح؛ الدولة النظيفة؛ أعاصير في إفريقيا؛ حكم غير مباشر؛ مؤسسات..محلية أم مستوردة؛ لغة فرانكا؛ الدولة الآسيوية القوية؛ الصراع من أجل القانون في الصين؛ إعادة اختراع الدولة الصينية؛ مناطق ثلاثة.
ثم ينتقل المؤلف إلى الفصل قبل الأخير، وهو فصل “الديمقراطية” الذي ناقش فيه الموضوعات التالية: لماذا انتشرت الديمقراطية؟؛ الطريق الطويل نحو الديمقراطية؛ من 1848 إلى الربيع العربي؛ الطبقة الوسطى ومستقبل الديمقراطية. وأخيراً ينهي المؤلف كتابه بالفصل الأخير الذي أعطاه عنوان “السقوط السياسي”، حيث أدرج تحته العناوين الفرعية التالية: سقوط سياسي؛ دولة المحاكم والأحزاب؛ الكونجرس وإعادة موروث السياسة الأمريكية؛ أمريكا والفيتوقراطية؛ الاستقلال والتبعية؛ النظام السياسي والسقوط السياسي.
عواميد رئيسية في الكتاب:
قبل الدخول في ثنايا الكتاب وتفاصيله المهمة، أود الإشارة سريعاً إلى رؤس أقلامٍ أو عواميد رئيسية، كانت بمثابة إضاءات متكررة، استلهمتها مراراً وتكراراً عبر قراءتي ومعايشتي للكتاب طيلة ثلاثة أشهر كاملة. كان من ضمن تلك “الإضاءات” ما أشار به “فوكوياما” مبيناً: أن هناك ضرورة كونية وأخلاقية للتنمية السياسية المتوازنة مع بقية روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فتحقيق ذلك التوازن – كما يشير المؤلف – يؤدي إلى إيجاد دول أكثر فعالية في تلبية مطالب الناس، بينما يؤدي الإخلال بذلك التوازن إلى صراعات طاحنة بين المؤسسات لا يدفع ثمنها إلا الشعوب؛ مؤكداً ان التحديث الاقتصادي الخالي من التنمية السياسية – مثلما حدث في دول نامية عديدة – قد أضر وما زال يضر بمصالح القاعدة العريضة من المواطنين.
وفي ثنايا ذكره للآثار المترتبة عن التنمية غير المتوازنة، أشار “فوكوياما” إلى الآثار السلبية للثورة الصناعية المندلعة منذ قرنين؛ تلك الآثار التي أحدثت خللاً واضحاً بين مكونات وروافد التنمية المختلفة؛ الأمر الذي أفضى إلى نشوء تنمية ناقصة أو مشوهة، رفعت من العنصر الاقتصادي الصناعي على حساب العنصر الاجتماعي الانساني؛ ونقلت الانسانية من المجتمع القروي الزراعي المتراحم الذي يعرف بعضه بعضاً ((Gemeinschaft إلى مجتمع المدينة الصناعية الذي يعيش فيه الأفراد فرادى غرباء عن بعضهم البعض (Gesellschaft). وقد أشاد المؤلف – في هذا المقام – بمقولات “كارل ماركس” حول التأثير السلبي للثورة الصناعية على العامل الذي حولته من فرد مبدع حر إلى تِرسٍ مُستعبَد في آلة.
فشل تطبيق نموذج الديمقراطية الليبرالية أو الحداثة الغربية في المستعمرات الأوروبية فرضية مهمة أخرى من ضمن الفرضيات التي أثارها الكتاب مُستعرضاً المناطق الثلاث التي احتلتها القوى الأوروبية على مدار القرنين الماضيين؛ وهي: إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا. فأما بالنسبة لإفريقيا،فقد شكلت الظروف الجغرافية والمناخية عائقاً رئيسياً أمام المستوطنين الأوروبيين لفرض نموذجهم المؤسسي الليبرالي الديمقراطي الحداثي. هذا بالإضافة إلى ضعف المؤسسات الذاتية الإفريقية من الأصل، الأمر الذي ساعد على توليد وتفجير العنف في داخل المجتمع الإفريقي؛ ومن ثم أسهم في تعويق مُضاعَف لتنمية النموذج المؤسسي الليبرالي الديمقراطي. وأما بالنسبة لأمريكا اللاتينية، فقد شكل الظلم الطبقي مرضاً عُضالاً أورثته القوى الأوروبية الاحتلالية لتلك المنطقة. ذلك الظلم الذي عوق وما زال يعوق إقامة دعائم نموذج الديمقراطية الليبرالية التي تتمثل – كما يشير “فوكوياما” – في ثلاثة عناصر أساسية: بناء الدولة البيروقراطية الحديثة غير المُشخصنة؛ إقامة سيادة القانون؛ تفعيل المسئولية السياسية. وأخيراً، بالنسبة لمنطقة شرق آسيا، فقد تمثل العائق الرئيسي – أمام فرض النموذج المؤسسي الليبرالي الديمقراطي – في قوة المؤسسات الذاتية التي حالت دون وصول النموذج الغربي الأوروبي.
معوقات ومعطلات التنمية السياسية عمود آخر من ضمن العواميد الرئيسية التي استند عليها “فوكوياما” في كتابه؛ حيث ناقش تلك المعوقات بالتفصيل؛ من المحسوبية إلى الزبائنية إلى الفساد إلى ضعف الدولة إلى انعدام التوازن بين روافد التنمية المختلفة إلى الإثنية إلى الجغرافيا إلى الإرث الاحتلالي إلى التدخلات الغربية الفاشلة لبناء الدولة بعد الحرب الباردة. وكما تحدث المؤلف عن الدولة الضعيفة غير الفعالة كمعوق للتنمية السياسية، ضارباً المثل بالمأسسة الضعيفة في إفريقيا وتدهور الخدمات العامة على أثرها، فقد تحدث أيضاً عن المأسسة القوية المفرطة التي تفضي إلى وقف مصالح الناس، ضارباً المثل بالإدارة الأمريكية.
ومن العواميد أو الموضوعات المهمة الأخرى التي ركز عليها المؤلف في ثنايا كتابه موضوع الطبقة الوسطى الصاعدة وأثرها على التطور المؤسسي؛ حيث ذهب المؤلف إلى فرضية أساسية مفادها أن الطبقة الوسطى – التي ظهرت منذ الثورة الصناعية – لعبت دوراً محورياً وجوهرياً في تطوير المؤسسات السياسية المركزية في أنحاء دول العالم. ويقصد “فوكوياما” هنا بالمؤسسات السياسية المركزية: مؤسسات الدولة والقانون والشفافية. والطبقة الوسطى – كما يراها المؤلف – شكلت العامل الأساسي المساعد على نشر الديمقراطية في مختلف مناطق العالم؛ إلا أن درجة التكيف قد اختلفت من منطقة إلى منطقة. ومع دخولنا في عصر العولمة – بعد انتهاء الحرب الباردة – عاد التركيز على دور الطبقة الوسطى من جديد كي تنشر الديمقراطية كمطلب كوني؛ وهو الأمر الذي نشهده حالياً – كما يؤكد المؤلف – في ظاهرة الجماعات المجتمعية الصاعدة حول العالم وسعيها الحثيث وراء مطلب الكرامة الكونية؛ وهو الأمر الذي انعكس مؤخراً في ثورات الربيع العربي على سبيل المثال. إلا أن الطبقة الوسطى لم تنحاز دوماً تجاه الديمقراطية؛ حيث أظهر التاريخ أن لكل قاعدةٍ استثناء. ففي حالات ليست بقليلة، اختارت الطبقة الوسطى – والكلام لـ”فوكوياما” – الانحياز تجاه النخبة الحاكمة كي تحفظ مصالحها، متجاهلةً الحراك المجتمعي والشعبي نحو التغيير والتطوير المؤسسي. فهناك حالات، التحمت فيها الطبقة الوسطى مع الحكم العسكري، كما حدث في ثورات الربيع العربي الأخيرة. وهناك حالات، التحمت فيها الطبقة ذاتها مع الملوك، كما حدث في فرنسا بعد اندلاع الثورة الفرنسية.
والصين المتصاعدة حالياً في انتظار إجابة التساؤلات الآتية: أي خيار ستختاره الطبقة الوسطى الصينية؟ هل ستختار التحالف مع الطبقة الشيوعية الحاكمة متجاهلةً المطلب المجتمعي نحو التغيير والديمقراطية والتنمية السياسية؟ أم أنها ستتحالف مع المطالب الشعبية نحو التغيير؟ إن الإجابة عن تلك التساؤلات سوف يحدد مسار ومصير الصين على مدار العقود القادمة، كما يوضح المؤلف.
ويختتم “فوكوياما” كتابه بحديثه عن أسباب السقوط السياسي في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الحالية. فينطلق من فرضيةٍ تقول إن السقوط أمر حتمي لكل المجتمعات إلا إذا تكيفت المؤسسات السياسية مع المحيط الخارجي المتغير حولها. أما إذا تعنتت وأصرت تلك المؤسسات على عدم التكيف مع المتغيرات الخارجية، فإن سلوكها المتعنت يصير أول أسباب سقوطها وانهيارها. ثم يتحدث المؤلف عن سقطات الأنظمة الديمقراطية الليبرالية التي ركزت على الإجراءات فأهملت المعاني، والتي ركزت على الصراعات الصفرية فأهملت البرامج، والتي ركزت على الحروب الأيديولوجية فأهملت توفير المطالب الأساسية للشعوب. ويتحدث المؤلف بإسهاب عن الحالة الأمريكية، عارضاً ذلك التناقض القائم بين تلك الدولة التي تعتبر من أبرز النماذج الديمقراطية الليبرالية في العالم وبين الواقع الفعلي لتلك الديمقراطية. فعلى الرغم من المأسسة القوية والمفرطة في المنظومة الأمريكية، إلا أن تلك المأسسة المتمثلة أساساً في “منظومة المراقبة والتوازن checks and balance” لم تؤدي إلا لتعطيل بل وقف مصالح جموع المواطنين الأمريكيين؛ ولاسيما في ظل وجود استقطاب سياسي طاحن وجماعات ضغط قوية.
وبعد استعراض تلك العواميد الرئيسية التي أقام عليها المؤلف كتابه، يجدر بنا الآن تهيئة القاريء إلى استكشاف الفصول الأربعة التي أُدرجت في الكتاب، محاولين استخراج أهم مكنونات وتفاصيل تلك الفصول.
الفصل الأول: الدولة
ينطلق المؤلف من فرضيةٍ تقول إن الدولة الرشيدة هي الدولة التي توازن بين قدرتها على الفعالية في الإنجاز وبين قدرتها على كبح جماح جهازها البيروقراطي المتضخم الذي إن تُرك دون مراقبة صار جهازاً مستبداً طاغياً. فالدولة الرشيدة هي تلك الدولة التي تمتلك فعالية ناجزة وبيروقراطية متمكنة ذات مهارات تقنية عالية؛ تيسر على المواطنين تحقيق مصالحهم، دون التحيز إلى فئة دون فئة. والدولة الفاعلة – كما يؤكد المؤلف – تلعب دوراً رئيسياً في السيطرة على النخب، وفي توفير الخدمات والمنتجات والمرافق العامة، وفي التدخل بقدر محدود في عملية إعادة التوزيع. ومن ثم، فإن تقييم ممارسة الدولة يأتي بناء على مدى ممارستها لتلك الأدوار. فإن لم تقم بها أضحت دولة غير فاعلة وغير حاكمة، بل أضحت دولةً تضر بمصالح الناس لدرجةٍ تجعلهم يتمنون ويحلمون بقدوم الديكتاتور الذي ينجز لهم مصالحهم.
وتعتبر بروسيا Prussia (الدولة الألمانية الأولى في التاريخ التي دشنت في عام 1525وتحولت إلى إمبراطورية ضخمة تحت القيادة البروسية، ثم انتهت بتفككها بعد الحرب العالمية الأولى) من أولى الدول الأوروبية التي رسخت دولةً ذات أسس بيروقراطية فعالة؛ وذلك قبل دخولها في مرحلة التصنيع والتحول الديمقراطي. ويعتبر اختيار توقيت تأسيس الدولة البيروقراطية الحديثة مفصلاً أساسياً ومحدداً رئيسياً لكيفية تطور الدول سياسياً؛ كما يؤكد المؤلف.
لقد طورت بروسيا دولةً قويةً حاكمةً بالقانون منذ القرن السابع عشر الميلادي؛ حيث تحولت من الحكم الديكتاتوري الفردي القائم على الشللية إلى الحكم الأوتوقراطي البيروقراطي الليبرالي الحديث Rechtsstaat القائم على الحكم بالقانون واللاغي لامتيازات النبلاء. لقد صار الأمير يحكم من خلال جهاز بيروقراطي يعبر عن إرادته واستقلاليته، مُحاسباً وضابطاً للسلطة المطلقة. ومن الجدير بالذكر، بقاء تلك التقاليد البيروقراطية الألمانية على مر العصور؛ بل هي باقية حتى يومنا هذا، في ظل الجمهورية الفيدرالية الألمانية الحالية. ومن اللافت للنظر، قيام ألمانيا واليابان بإرساء حكومات قوية بيروقراطية أولاً قبل إرساء الديمقراطية؛ فأضحتا بعد ذلك أكثر ديمقراطية من تلك الدول التي أرست الديمقراطية أولاً قبل إرساء الدولة البيروقراطية القوية الحديثة. والسبب في ذلك, كما يؤكد “فوكوياما”، هو أن الدول البيروقراطية القوية غير المُشخصنة كانت أقوى وأكثر فعالية في مواجهة الفساد.
فالدولة البيروقراطية الحديثة القوية الفعالة غير المُشخصنة تستطيع أن تكافح وتسيطر على الفساد المتمثل في الزبائنية clientelism والمحسوبية patronage وتعطيل تنفيذ القانون. ويشير المؤلف هنا إلى ظاهرتين أساسيتين متعلقتان بالفساد؛ فأما الظاهرة الأولى فهي المتعلقة بالقدرة على إيجاد واستخراج المكاسب مما يشجع الانتهازيين على اختيار السياسة كوسيلة أو كأداة لاكتناز الثروة؛ وأما الظاهرة الثانية فهي المتعلقة بمنظومة الشللية والمحسوبية حيث يتم تبادل المنافع بين فردين مختلفي الوضع والسلطة؛ وحيث يتم توزيع المنافع كرشاوي فردية بدلاً من منحها للفقراء؛ فالمرشح يقدم الخدمة، والناخب يعطي التأييد السياسي في علاقة غير متكافئة بين الراعي الـPatron والعميل الـClient. وقد يرى المؤلف في المحسوبية سلوكاً اجتماعياً طبيعياً بيولوجياً، موجوداً في جميع الأنظمة، ولكن على مستويات صغيرة. بينما تتواجد الزبائنية على مستويات أكبر – وفي الدول الديمقراطية أساساً – حيث يتم تعبئة عدد أكبر من الناخبين. ومن العجيب أن ينظر المؤلف إلى الزبائنية باعتبارها شكلاً قديماً للمساءلة والمحاسبة السياسية، حيث توجد درجة من المساءلة والمحاسبة من قبل الناخب (العميل) تجاه المرشح السياسي (الراعي)؛ وحيث أنها تخلق نوعاً من المشاركة الجماهيرية في يوم الانتخاب.
ويضرب “فوكوياما” باليونان مثلاً للدولة الديمقراطية ولكن الضعيفة غير الفعالة غير الفاعلة. فقد كانت اليونان مهد الديمقراطية في القارة الأوروبية؛ إلا أنها أرست الديمقراطية قبل إرسائها للدولة القوية الحديثة؛ فكانت النتيجة شيوع الزبائنية والمحسوبية والفساد في ظل دولة ضعيفة غير فاعلة. وهو الأمر الذي أفضى إلى فقدان ثقة اليونانيين في دولتهم ومن ثم لجوئهم إلى العلاقات الأسرية والعائلية لقضاء مصالحهم مما أدى إلى مزيد من إضعاف دور الدولة، وتحول المحسوبية والزبائنية إلى عادة ثقافية سواء في الريف أو المدينة. فلم تفلح الديمقراطية والحداثة في اليونان – بعد ذلك – في إزاحة ذلك الموروث الثقافي. ولم تفلح الحداثة الاقتصادية في إفراز تحالف للطبقة الوسطى يقضي على تلك المنظومة الزبائنية، كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا. وظلت اليونان سائرةً على ذلك الدرب حتى يومنا هذا؛ حكومة ضعيفة، وقدرات إدارية ضعيفة، وتنمية سياسية منعدمة على الرغم من التحديث الصناعي بعد الثلث الأول من القرن العشرين.
ومن الجدير بالذكر، أن تكون اليونان – وكذلك إيطاليا التي سارت على نفس الدرب – الدولتين الرئيسيتين التي وقفتا وراء الركود الاقتصادي الذي ضرب الاتحاد الأوروبي في عام 2009. وذلك على عكس ألمانيا والدول الاسكندنافية التي تتمتع بقطاع عام قوي وحديث، مما أهلها ومكنها للتصدي لتلك الأزمة الاقتصادية. إن النموذجين اليوناني والإيطالي القائمين على الزبائنية هما نفس النموذج القائم في الدول النامية الحالية، حيث كان التمدن نتيجة نقل قرى بأكملها إلى المدن cities of peasants وليس نتيجة التقدم الصناعي والتنمية السياسية لمؤسسات الدولة والقانون والديمقراطية. إن الفارق بين شمال أوروبا وجنوبها يكمن في المنظومة الزبائنية؛ فلدينا شمال بروتستانتي منضبط وجنوب كاثوليكي كسول، كما يشير “فوكوياما”.
يمثل الجنوب الإيطالي مثلاً آخر لتفشي ظاهرة الزبائنية في ظل دولة ضعيفة غير فاعلة، كما يؤكد “فوكوياما”. فالفقر المادي لم يكن السبب في تخلف الجنوب، وأنما كان السبب هو عجز الحكم الذي أتي نتيجةَ تاريخٍ طويل من شيوع الزبائنية؛ حيث تمحورت السياسة حول المحسوبية لا على الأفكار والبرامج، الأمر الذي أدى إلى فقدان جنوب إيطاليا لمجتمع مدني قوي، ومن ثم إحباط قدرات المواطنين على تدشين علاقات أفقية من الثقة والترابط، واستحالة وجود أي معارضة، وامتصاص الطبقة الوسطى في داخل الأوليجاركية التقليدية. وقد شكلت تلك الأجواء مناخاً مناسباً جداً لنشوء المافيا التي باتت توفر خدمات الحماية بدلاً من الدولة، ولكنها أنشأت في الوقت ذاته بيئةً من العنف والخوف. واللافت للانتباه، أن التحديث الاقتصادي في الجنوب الإيطالي – مثله مثل اليونان – لم يمنع المافيا والمحسوبية والفساد بل صار الأخير أكثر قوة، ممتداً من الجنوب إلى الشمال الإيطالي. وهنا يؤكد “فوكوياما” فرضيته – التي يكررها دائماً في ثنايا كتابه – القائلة إن الحداثة ليست بالضرورة موازيةً أو مواكبةً للتنمية؛ بل إنها يمكن أن تصير مساعدةً للفساد كما حدث في الجنوب الإيطالي.
كانت بريطانيا – على عكس اليونان وإيطاليا – من الدول الأوروبية التي قاومت محسوبية الملوك والأمراء ساعيةً لإصلاح الخدمة المدنية، كما يؤكد “فوكوياما”. وكان مثقفو بريطانيا، مثل “إدموند بورك Edmund Burke” و”جون ستيوارت ميل John Stuart Mill”، من رواد المفكرين الذين دعوا إلى الإصلاح في القرن الثامن عشر، والذين قرئت أفكارهم من قبل الطبقة الوسطى الإنجليزية ومن قبل النوادي والمجتمعات الإنجليزية الجديدة التي بدأت في الظهور في النصف الأول من القرن التاسع عشر، داعيةً إلى الصناعة والعلم والتكنولوجيا. ولا يُنسى – في وسط كل ذلك – اندلاع الثورة الصناعية التي أحدثت زلزالاً في البناء الاجتماعي البريطاني، تحولت بريطانيا على أثرها من أوليجاركية إلى ديمقراطية؛ حيث قام فاعلي الطبقة الوسطى باستبدال الأوليجاركية القديمة، وبإنفاذ تشريعاتها الإصلاحية على الفور.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد مثلت حالةً فريدةً مقارنةً بالقارة العجوز، كما أشار “فوكوياما”. فالولايات المتحدة – التي نشأت نتيجة ثورةٍ مناهضةٍ لتسلط الملكية البريطانية – لم يكن لديها بنيان الطبقة الإقطاعية الذي كان موجوداً لدى أوروبا. ولم يكن لديها جيران أقوياء يهددونها كما كان الأمر في الحالة الأوروبية. ولم يكن لديها تقسيم طبقي مبني على الفوارق المجتمعية، كما كان الوضع لدى الأوروبيين، وإنما كان تقسيمها الطبقي مبنياً على عنصري التعليم والتملك. وكان المجتمع الأمريكي مجتمعاً تخبوياً بامتياز، حيث كانت معظم قياداته من خريجي جامعتي “هارفارد” و”ييل”. كل تلك العوامل أفضت إلى عدم نزوح الولايات المتحدة الأمريكية نحو دولةٍ قويةٍ حديثةٍ بيروقراطيةٍ تعيد توزيع الثروات. بمعنى آخر، لم تدشن الولايات المتحدة أبداً بيروقراطيةً ضخمةً بالمعايير الأوروبية بسبب البيئة المختلفة التي نشأت فيها.
وقد كانت الولايات المتحدة رائدةً في اتباع الديمقراطية الحديثة وتدشين أحزاب سياسية جماهيرية، الأمر الذي أفضى إلى ظهورمنظومة الزبائنية؛ مما جعل المؤلف يلقب الولايات المتحدة بمخترعة الزبائنية،”The United States Invents Clientelism”. فالتنافس الحزبي الحاد، كالذي شهدته الولايات المتحدة منذ نشأتها، لابد وأن يؤدي إلى شيوع الزبائنية، كما يفترض “فوكوياما”. ولا يُنسى هنا دور “أندرو جاكسونAndrew Jackson”، في القرن التاسع عشر، الذي قام بتحويل النظام النخبوي الأمريكي الذي كان قائماً على المحسوبية إلى نظام جماهيري قائم على الزبائنية حيث يحقق الراعي (المرشح) طلبات العميل (الجماهير). إذ تحولت الولايات المتحدة بعد الثورة “الجاكسونية”(نسبةً إلى “أندرو جاكسون”) إلى دولة الأحزاب والمنظومة الزبائنية، حيث يتم إغداق الخدمات للناخبين الفقراء على مستوى كبير، وهو الأمر الذي جعل من الزبائنية سبيلاً لتمكين الفقراء، ولكن لفترة محدودة. فالحزبان الرئيسيان – الجمهوري والديمقراطي – باتا يعرضان خدمات قصيرة المدى للفقراء والمحتاجين، بدلاً من عرضهما لسياسات وبرامج تغيير على المدى البعيد، مما منع من قيام أحزاب عمالية ومجتمعية كما كان الحال في أوروبا. وفي النهاية، كما يؤكد “فوكوياما”، صرنا أمام مشهد هزيل وضعيف للإدارة الأمريكية التي لم تؤسس بيروقراطيةً حديثةً قويةً كالتي أسستها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا؛ وإنما اكتفت بإجراء انتخابات ديمقراطية لا تتم إلا بشراء الأصوات .
إلا أن كل ذلك قد شهد تغييراً واضحاً على نهايات القرن التاسع عشر، حينما بدأت مرحلة التصنيع تشق طريقها في الأراضي الأمريكية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة نحو إقامة دولة بيروقراطية حديثة، تقاوم المنظومة الزبائنية وتقضي عليها إلى الأبد. فقد قامت الطبقة الوسطى الأمريكية من رجال الأعمال والصناعيين والتجار – التي ظهرت مع بدء مرحلة التصنيع – بمناطحة منظومة الأحزاب الأرستقراطية، سعياً نحو إيجاد حكومة أكثر فعالية تؤمن مصالحهم التي كانت تتمثل أساساً في توفير وسائل النقل ومد الطرق الآمنة. وكان من ضمن تلك الطبقة أيضاً المهنيون المتخصصون الذين باتوا يناطحون الموظفيين الحكوميين القدامى غير المتخصصين. وقد كان لهؤلاء المهنيين، مع المثقفين والمنظمات المدنية المجتمعية الجديدة، دوراً بارزاً في إصلاح الخدمة المدنية، وإخلائها من المحسوبية والشخصانية. ومن اللافت للنظر، انتماء تلك الطبقة الوسطى الإصلاحية إلى فئة البروتستانت المتعلمين الذين نشروا دعوتهم الأخلاقية ضد المحسوبية والزبائنية وليس الكاثوليك واليهود الجاهلين، كما يشير المؤلف.
وقد نجحت الولايات المتحدة بالفعل – بفضل طبقتها الوسطى – في تحديث جهازها الإداري واستبدال النظام الحزبي الزبائني بنظام مؤسس على قواعد بيروقراطية مهنية غير مشخصنة كالتي في أوروبا. إلا أن هذا التحديث قد جرى بصورةٍ بطيئةٍ جداً؛ وحتى بعد إنهاء عملية التحديث الأمريكية، فهي لم تصل إلى مستوى النموذج الأوروبي. فما بين عامي 1880 و1920 سارت الإدارة الأمريكية على خطىً متدرجة لإتمام عملية التحديث السياسي، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تنتهجه وتتبناه على مدار أجيالً عدة. وتعود طول عملية إصلاح القطاع العام في الولايات المتحدة – مقارنةً بأوروبا – إلى الطبيعة المؤسسية الأمريكية، حيث تنقسم السلطة بين الرئيس والكونجرس على عكس بريطانيا التي تكون لديها السلطة مُركزة في يد الحزب الذي يحصد أغلبية البرلمان.
وبالرغم من طول الطريق الإصلاحي على الصعيد المؤسسي السياسي الأمريكي، فإن الأمر انتهى بمأساة مع حلول سبعينيات القرن العشرين؛ حيث صارت اتحادات القطاع العام جزءاً من النخبة التي تستخدم النظام السياسي لحماية مصالحها الخاصة، مما أدى إلى انتفاء الكفاءة كمعيار للتوظيف والترقية؛ وتدني المستوى التعليمي للموظفين الحكوميين الأمريكيين على عكس موظفي الحكومة البريطانية المتخرجين من “كامبريدج” و”أوكسفورد”؛ وهو ما أفضى إلى انهيار الإدارة الأمريكية وسقوطها سياسياً، على حسب توصيف “فوكوياما”. فالجهاز الإداري السليم، على حسب توصيف “ماكس فيبر Max Weber”، هو الجهاز المفصول عن السياسة، وهو ما لم يعد متحققاً في الإدارة الأمريكية منذ سبعينات القرن العشرين، وهو ما أسفر عن حدوث ذلك الانهيار أو السقوط المؤسسي السياسي الأمريكي، كما أدلى المؤلف.
وهنا يصدر المؤلف فرضيته حول الإصلاح القائلة: إن الإصلاح ليس عملية تقنية كما تصوره مؤسسات المعونات الدولية بالنسبة للدول النامية في القرن الواحد والعشرين؛ إنما الإصلاح عملية سياسية طويلة المدى تتعلق بالأفكار التي تشكل كيفية رؤية الأفراد والمواطنين لمصالحهم. فرواج فكرة المحسوبية بين المواطنين، على سبيل المثال، لا تجعلهم يخجلون من تبنيها أو تطبيقها في حياتهم اليومية؛ بينما استهجانها والتقزز منها يجعلهم يقلعون عن ممارستها. ومن ثم، لن يحدث الإصلاح الحقيقي إلا بعد تغير تلك الأفكار في عقول وأذهان الناس لدرجةٍ تجعلهم يشعرون بالخزي لمجرد سماعهم لفكرة المحسوبية أو الفساد بصفةٍ عامة.
ولم يكن للمؤلف أن يختتم فصله عن “الدولة” دون التطرق إلى موضوعٍ رئيسي لا يمكن أبداً فصله عن عملية بناء الدولة؛ ألا وهو بناء الهوية القومية. فلم يقم بناء الدولة – سواءً في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية – إلا بالتوازي مع بناء الهوية القومية، كما يؤكد “فوكوياما”. فبناء الدولة استلزم بناء الهوية القومية. بمعنى آخر، إن الدولة هي المؤسسة التي نادت مواطنيها باعتناق الهوية القومية مطالبةً إياهم بدفع حياتهم ثمناً رخيصاً فداءً لها. إذن، فالهوية القومية كانت – ولا تزال – أداةً لخدمة الدولة والحفاظ على كيانها. ولم تكن الدولة وحدها هي من قامت بهذا الدور، بل انضم إليها أطراف مجتمعية عديدة، من الفلاسفة إلى رجال الدين إلى الفنانين.
والحقيقة إن عملية بناء الهوية القومية لم تكن عمليةً نظيفةً على الإطلاق؛ وإنما تخللها عنف كثير ودم أكثر، كما يشير المؤلف. فالهوية القومية – التي تتمحور حول مباديء إثنية وعرقية ودينية ولغوية – تضم أناساً معينين تحت ظلها وتستقصي آخرين، الأمر الذي جعلها سبباً مباشراً لإثارة الحروب الدامية مع تلك الجماعات التي لا تنضوي تحت لوائها. إن بناء الهوية القومية جاء بعد سحق شعوب كثيرة وهويات عديدة، حيث تم تحريك شعوب بالغصب من مكان إلى مكان، وإعادة ترسيم حدود جديدة. “إن الدراسة التاريخية المتأنية تُعَرض دائماً دراسة القومية للخطر”، (“إرنيست رينان Earnest Renan”، 196). فالهوية القومية الأمريكية، على سبيل المثال، والتي قامت على مباديء المساواة والديمقراطية والحقوق الفردية، لم تكن للترسخ إلا على حساب سكان البلاد الأصليين. إن بناء الهوية القومية في أوروبا وأمريكا كان نتاجاً لحروب دموية وإجرامية في الماضي.
وتمثل القومية – كما يشير المؤلف – شكلاً من أشكال سياسات الهوية التي عبرت عن نفسها أولاً في ظل الثورة الفرنسية، حيث لم تكن مسألة الهوية مثارة في المجتمعات الزراعية. إذ تنامى التيار القومي مع مجيء التحديث والثورة الصناعية وانتشار الطباعة وصعود الرأسمالية التجارية وتصاعد الطبقة الوسطى القارئة التي كان لها معول كبير في دعم المد القومي في القرن التاسع عشر. ملخص القول، “إن القومية ظاهرة حديثة استجابت لاحتياجات المجتمع الصناعي المدني” (“إرنيست جيللنر Earnest Gellner”، 191).
وينهي المؤلف فصله الأول عن “الدولة” بالحديث عن الحكم الرشيد وغير الرشيد، موضحاً أن الحكم الرشيد يستلزم وجود دولة قوية حديثة بيروقراطية غير مشخصنة قبل الدخول في المسار الديمقراطي؛ وأن التحول التسلطي إلى نظام حديث شامل أفضل وأرشد وأعقل من القفز مبكراً في بحار الديمقراطية؛ وأن الطبقة الوسطى لها معول كبير في إنهاء منظومة الفساد كما حدث في الولايات المتحدة وبريطانيا، على الرغم أنها لم تقم بنفس المهمة في اليونان وإيطاليا. ومن سمات الحكم الرشيد أيضاً – كما يدلي المؤلف – أن يصير الولاء الأول للدولة مثلما الوضع في الولايات المتحدة وبريطانيا، وليس للعائلة والقبيلة والإقليم كما هو الحال في اليونان وإيطاليا. وعلى الرغم من إشادته بالحكم الرشيد في كلٍ من الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أنه يعود قائلاً بأنه لم يتم حتى الآن اجتثاث منظومة الشللية Patrimonialism بشكل كامل من هاتين الدولتين. فحتى هذه اللحظة، لم تنته الإدارة الأمريكية عن توزيع الخدمات والهدايا، من قبيل تخفيف الضرائب عن جماعات المصالح على سبيل المثال.
وأخيراً، يلقي المؤلف الضوء على السبل التي اتخذها الغرب لبناء دولته الحديثة؛ فإما كان السبيل هو الحرب والصراع العسكري، كما حدث في ألمانيا؛ وإما كان السبيل هو عملية الإصلاح السياسي المعتمدة على تحالف الجماعات الاجتماعية الراغبة في حكومة فاعلة غير فاسدة، مثلما حدث في النرويج وفنلندا.
الفصل الثاني: المؤسسات الخارجية
يناقش هذا الفصل الظروف التنموية المختلفة التي أثرت على عملية بناء الدولة – وعلى التنمية السياسية بشكل عام – في العالم النامي المتمثل في إفريقيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية. ويركز “فوكوياما” في هذا الفصل على التأثير السلبي للدول الغربية المحتلة على البناء المؤسسي في بلدان العالم النامي عبر القرنين الماضيين، وإسهامها بشكل رئيسي في عرقلة وتعويق التنمية السياسية. إلا أنه لا ينفي أيضاً وجود عوامل داخلية أخرى – مثل الطبيعة الجغرافية والإثنية – كان لها بالغ التأثير على تعويق مسار التنمية السياسية في العالم النامي.
فلنأخذ بلداً مثل نيجيريا الذي على الرغم من عائدات النفط الهائلة التي مُني بها منذ سبعينيات القرن العشرين، إلا أنه دخل القرن الواحد والعشرين بأكثر من ثلثي سكانه تحت خط الفقر. والسبب في ذلك، كما أورد “فوكوياما”، يتلخص أولاً في جود نخبة سياسية فاسدة، قامت بتحويل عائدات النفط إليها، وثانياً في دولةً ضعيفة تقنياً وأخلاقياً وشرعياً، وأخيراً في شعب فقير منقسم على ذاته إثنياً (250 جماعة إثنية)، يتصل أفراده عمودياً مع بعضهم البعض، من خلال شبكات الزبائنية المُسيطر عليها من قبل النُخب السياسية الفاسدة. هنا نجد نموذجاً لبلدٍ عُطلت فيه عجلة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحُجبت فيه موارده الهائلة عن تنمية رأس المال الإنساني، بسبب وجود دولةٍ كان كل همها استخلاص العائدات النفطية وتوزيعها على بقية “الشلة” من النخبة السياسية، وكذلك بسبب وجود شعب حطمه الفقر والإثنية.
وكما كان للإثنية معول في تحديد مسيرة التنمية السياسية وبناء الدول، فقد كان للجغرافيا أيضاً معول – لا يقل أهمية – في تحديد تلك المسيرة، كما يؤكد المؤلف. وكان من أبرز من كتب عن تأثير الجغرافيا على المؤسسات السياسية “بارون دو مونتيسكيو Baron de Montesquieu” (1689- 1715). فبحسب “مونتيسكيو”، قامت معظم الدول الأولى في التاريخ – على سبيل المثال – حول الوديان: الدولة المصرية حول وادي النيل؛ الدولة العراقية حول وادي الفرات؛ الدولة الصينية على وادي النهر الأصفر. مثالٌ آخر تمثل في طبيعة أوروبا الجغرافية – بأنهارها وجبالها وغاباتها – التي كانت مانعاً طبيعياً من سيطرة أي دولة أوروبية على بقية الدول؛ هذا على عكس طبيعة الأراضي المنبسطة في الصين وروسيا والتي مكنت الأباطرة الصينيين والقياصرة الروس من السيطرة. إلا أن الجغرافيا، كما يؤكد “فوكوياما”، لم تكن قدراً أو مصيراً محتوماً لجميع بلدان العالم النامي؛ ففي كل منطقة كان هناك دول استطاعت الهروب من قدر جيرانها بفضل الخيارات الصائبة الرشيدة على أيدي قياداتها. وتمثل سنغافورة وماليزيا مثاليين بارزين في هذا المقام؛ فعلى الرغم من وقوع هذين البلدين في منطقةٍ استوائية تتصف بمناخ بالغ السخونة والحرارة، وبأمراض متفشيةً لا حصر لها، وبمؤسسات احتلالية كانت تمتص معظم خيراتها، إلا أن هذين البلدين استطاعا تحدي الجغرافيا والمناخ وتاريخ الاحتلال المؤلم.
وإذا كانت ماليزيا وسنغافورة تمثلان مثاليين إيجابيين واضحين في تحدي الظروف الطبيعية؛ فقد كانت أمريكا اللاتينية تمثل مثالاً سلبياً على الوجه المناقض؛ إذ كان المناخ والجغرافيا من ضمن المصادر الأساسية لتشكيل “العيب الخَلقي Birth Defect” في القارة اللاتينية، كما يوضح “فوكوياما”. فامتلاك أمريكا اللاتينية لثروات طبيعية مثل الفضة والذهب والسكر أوجد اقتصاد الرق على أيدي القوى الأسبانية المحتلة، الأمر الذي أفضى إلى خلق إرث من التفرقة والفرقة المجتمعية، ظل مستمراً حتى بعد إغلاق آخر منجم للفضة في تلك القارة. وعلى الرغم من نمو المؤسسات الديمقراطية الأمريكية اللاتينية عبر القرنين الماضيين، إلا أن إرث البنيان الطبقي المنقسم بين النخب الثرية البيضاء (المحتلين) والأغلبية الساحقة السوداء (العاملين اللاتينيين) ظل موجوداً إلى يومنا هذا؛ وهو ما كان له معول في صياغة وتشكيل المؤسسات الرسمية الحالية. فعلى الرغم من ظهور ونمو الديمقراطية الرسمية في القارة اللاتينية في القرنين الـ19 والـ20، إلا أن ذلك لم يسفر عنه تمكين المواطنين اللاتينيين العاديين، وانما استمرار هيمنة النخب على الأنظمة السياسية الديمقراطية، ولو بطريقة غير مباشرة.
لقد امتص ذلك الإرث المعيب جهود اللاتينيين في حروب طبقية شعواء، وهو ما عكس الانقسام المجتمعي المرير الذي خلفه الاحتلال الأسباني. لم تخض القارة اللاتينية حروباً بينية لبناء الدولة القوية الحديثة، كما حدث في أوروبا. لم تتمتع القارة اللاتينية بهوية قومية قوية بسبب الانقسامات الإثنية والعرقية؛ ولم تقم أية ثورات اجتماعية ليبرالية بسبب إحباط الولايات المتحدة لتلك الثورات. وقد يذهب “فوكوياما” في هذا الصدد إلى فرضية تقول، إن قلة نسبة العنف في أمريكا اللاتينية، أو قلة نسبة التنافس والصراع العسكري بين دول القارة المختلفة – بالمقارنة مع أوروبا والصين – أعاق تكوين دولة قوية حديثة. فالمنطقة اللاتينية – في ظل القرنين الماضيين – لم تشهد عنفاً سواءً من ناحية الثورات الاجتماعية أو الحروب البينية، مما قلص من الدوافع المفترضة لتحديث الدولة.
وعلى الرغم من ذلك الإرث المعيب الذي ابتُليت به القارة اللاتينية على أثر الاحتلال الأسباني والبرتغالي، فقد استطاعت بعض الدول الاستثنائية – مثل كوستاريكا – الإفلات من ذ لك المصير المحتوم، وذلك بفضل قياداتها الرشيدة وخياراتها السياسية الحكيمة. وهو ما يدلل على أهمية العنصر الإنساني في التأثير على التنمية المؤسساتية بغض النظر عن الثروات والهبات التي تمتلكها البلاد، كما يؤكد “فوكوياما”. فقد استطاعت كوستاريكا، على الرغم من فقر مواردها وجغرافيتها ومناخها، الإفلات من مصير جيرانها في المنطقة بسبب العنصر الإنساني، بينما لم تُفلت منه الأرجنتين، وهي صاحبة الثروات الطبيعية والجغرافية الهائلة، ولكنها في الوقت ذاته صاحبة السياسات غير الرشيدة وغير الحكيمة التي تمثلت باختصار في التحالف بين جنرالات العسكر وطبقة الأوليجاركية الزراعية، وفي تعطيل سيادة القانون، وفي منع اللاعبين السياسيين الجدد من الظهور على الساحة السياسية. ملخص القول، لقد تباينت كوستاريكا عن الأرجنتين في رفضها لوجود عنصر العسكر في المعادلة السياسية، وهو الأمر الذي جعلهما متباينتين تنموياً ومؤسساتياً وسياسياً.
وإذا كان الاحتلال الأوروبي للقارة اللاتينية قد خلف إرثاً من الاستقطاب الطبقي مما أفضى إلى إفشال ومنع التنمية السياسية الطبيعية، ومنها تنمية نموذج الدولة الحديثة البيروقراطية، فإن الاحتلال الأوروبي للقارة الإفريقية جنوب الصحراء لم يخلف أي إرث مؤسسي لأنه ببساطة لم يكن هناك مؤسسات ذاتية من الأصل؛ كما أوضح “فوكوياما”. لقد مُني إلنموذج الإفريقي جنوب الصحراء بدولةً ضعيفةً نتيجةً لعوامل عدة: منها عوامل جغرافية متمثلة في امتداد الغابات الاستوائية التي يصعب معها سيطرة الدولة سيطرةً كاملةً؛ ومنها عوامل جذرية وتاريخية واجتماعية متمثلة في عدم وجود موظفي دولة مهنيين ومحترفين من قبل قدوم قوى الاحتلال؛ ومن ثم عدم وجود مؤسسات سياسية قوية.
وكانت نتيجة ضعف الدولة في تلك المنطقة اندلاع الصراعات وعمليات العنف في أرجاء القارة، وضعف البنيان الاقتصادي، واعتماد الدولة اقتصادياً على الخارج. وكيف لا تعتمد تلك الدول الضعيفة سياسياً واقتصادياً على الخارج، وهي لا تستطيع حتى أن تستخرج الضرائب والعوائد؟ وحينما جاء الاحتلال الغربي أزاد الطين بلة؛ حيث لجأ إلى الحكم غير المباشر بسبب العوائق الكثيرة التي واجهته في القارة السمراء؛ فسخونة المناخ وتفشي الأمراض وصعوبة التواصل مع الإفريقيين بسب اللغة…كلها كانت عوائق أمام المحتل الغربي تمنعه من التواجد هناك بصورة دائمة. إلا أن لجوءه الاضطراري إلى الحكم غير المباشر ساهم في ترسيخ الدولة الإفريقية الضعيفة، حتى بعد حصول القارة على استقلالها في القرن العشرين.
لقد كان حكم الاحتلال الأوروبي غير المباشر حكماً متسلطاً ومتغطرساً؛ إذ تم تمكين الولاة الأفارقة ليصيروا ديكتاتوريين مستبدين مع شعوبهم. فإذا بإفريقيا جنوب الصحراء تخرج من بعد استقلالها مُحملةً بإرث الدولة الضعيفة والمتغطرسة في آنٍ واحد. وأصبح لدينا دولة إفريقية “مستقلةً” متسلحةً بالقوة المتغطرسة الغاشمة الاستبدادية – التي ورثته من الحكم الاحتلالي الأوروبي غير المباشر – بدلاً من دولةٍ إفريقية مستقلة متسلحة بالقوة في دعم البنى التحتية لخدمة مواطنيها، كما أدلى “مايكيل مان Michael Mann”. إن الحكم الاحتلالي الأوروبي غير المباشر لم يرس قواعد الدولة القوية الحديثة القادرة على إقامة نظام إداري مُحكم يستطيع استخلاص ثروات البلاد بطريقةٍ سلمية وعادلة، تدعم وتفيد رأس المال الإنساني. خلاصة القول، إن الدولة الإفرقية الضعيفة بعد الاستقلال هي إرث الدولة الاحتلالية الضعيفة. وإن تاريخ الاحتلال الأوروبي في إفريقيا تضمن وحشيةً سافرةً ومنظمةً ضد السكان الأصليين، الأمر الذي ولد موجات لا نهائية من العنف بعد الاستقلال؛ فيكفينا النظر فقط إلى دول مثل سيراليون والصومال وليبيريا والكونجو لنرى كيف استفحل العنف فيها، ضارباً الدولة الضعيفة في مقتل، مما أدى في النهاية إلى سقوطها بالكامل بعد الاستقلال.
وإذا كان الاحتلال الغربي لإفريقيا وأمريكا اللاتينية قد اكتسب صبغةً وحشيةً على مدار القرنين – التاسع عشر والعشرين – فإنه تحول، بعد نهاية الحرب الباردة وقيادة القطب الأمريكي للنظام الدولي، إلى شكلٍ جديدٍ متصف بالسيطرة والتدخل ولكن في إطار أخلاقي؛ إنه ذلك التدخل بالقوات والعتاد لإقامة السلم الداخلي وحماية حقوق الإنسان المهددة من قبل الصراعات (مثال على ذلك: التدخل في البوسنة والهرسك ورواندا في نهايات تسعينيات القرن العشرين). ثم تطور الشكل من التدخل لإقامة السلم إلى التدخل لإقامة الدولة، على اعتبار أن الدول القوية المستقرة قادرة على حماية شعوبها من الصراعات دون الاعتماد على الخارج (مثال على ذلك: التدخل في أفغانستان 2001، والتدخل في العراق 2005). وفي كلا المثالين، جرت القوات الأمريكية ذيول الخيبة بعد فشلها الذريع في بناء دولة مركزية شرعية وظيفية.
إن فشل القوى الغربية في زرع مؤسساتها الحديثة المستوردة في بلدان العالم النامي يعود إلى تدني مستوى المعرفة لدى الغربيين بالثقافة المحلية التي يريدون زرع مؤسساتهم بالغصب في وسطها. فحينما تكون جهودهم في بناء المؤسسات مفتقدة إلى المعرفة الكافية، فغالباً ما ينتهي الأمر بتدميرهم لتلك المؤسسات بدلاً من بنائها، كما يشير “فوكوياما”. إن الثقافات المحلية ليس من السهل محوها، كما تفترض القوى الغربية؛ ولا سيما في ظل تصاعد الرأي العالمي المناصر لتلك الثقافات في القرن الواحد والعشرين، وازدياد الوعي بها عالمياً، والاعتراف بكماليتها واستقلاليتها؛ فهي لم تعد بحاجة إلى “التمدين” بالقوة كما كان الوضع في وقت الاحتلال المباشر عبر القرنين الماضيين. وإن نجاح قوى الاحتلال البريطانية في زرع مؤسساتها الحديثة في كلٍ من أستراليا وأمريكا وكندا ونيوزيلاندا لم يكن إلا بسبب خلو تلك المناطق من السكان الأصليين أو ندرتهم. فتلك النماذج الاحتلالية البريطانية – التي تعتبر الآن نماذج للديمقراطية الليبرالية – لن يمكن تكرارها في وقتنا الحالي.
إلا أن المؤلف يعود مدافعاً عن النماذج التنموية الغربية، فيقول أن ما أورده سابقاً ليس معناه فشل تلك النماذج في التطبيق عالمياً، إنما لابد من ضرورة تكييف المجتمعات لها في ظل ظروفها وتقاليدها المحلية. فالمؤسسات تُبنى على الوجه الأكمل على يد فاعلين محليين يمثلون مجتمعهم، ويستطيعون تقليد بعض الممارسات الخارجية ولكن في ظل الفرص والحدود التي توفرها لهم تقاليدهم وتاريخهم؛ مثل ما فعلت دول منطقة شرق آسيا. وهي الدول التي لم تكتف فقط بعملية بناء الدولة، وإنما اهتمت في الوقت ذاته بعملية بناء الهوية الواحدة (القومية) التي تعتبر سلاحاً ذا حدين؛ فإما أن تكون سبباً للتجانس والالتحام أو سبباً للنزاع والاعتداء، كما يؤكد المؤلف.
إن بلداناً مثل الصين واليابان وكوريا من أكثر البلدان تجانساً من الناحية الإثنية والمجتمعية؛ إذ تم فرض هوية قومية واحدة مبنية على مباديء الكونفوشية؛ على أيدي دول قوية حديثة. فالصين تُعتبر من أولى الدول الحديثة التي أُسست في التاريخ. وإندونيسيا تعتبر مثالاً آخر، حيث نجحت تنموياً بسبب فرضها لهوية قومية عبر دولة متسلطة، تدعمها جيوش قوية. ومن الجانب الإفريقي، سارت تنزانيا على نفس الخطى. فسوكارنو إندونيسيا ونيريري تنزانيا كان لهما دوراً جوهرياً في جمع الإثنيات والعرقيات في بوتقة واحدة عبر آليات تعليمية تقوم على المزج بين الاختلافات؛ هذا فضلاً عن وجود لغة واحدة في كلتا البلدين؛ اللغة السواحلية في تنزانيا ولغة الـBahasa في إندونيسيا. لقد نجحت إندونيسيا وتنزانيا – بفضل ديكتاتورية ومركزية دولتيهما – في فرض وضمان الهوية القومية الواحدة، بينما أخفقت كل من كينيا ونيجيريا في ذلك، بسبب تناحر الإثنيات في كل منهما، وكذلك بسبب ليبرالية الدولة الكينية وضعف الدولة النيجيرية؛ كما يؤكد “فوكوياما”.
لقد كانت الدولة الآسيوية القوية الحديثة المتسلطة موجودة وكائنة قبل احتكاكها بالغرب؛ الأمر الذي يعكس اختلافاً رئيسياً بين الدولة الآسيوية ونظيرتيها الإفريقية واللاتينية. المشكل الرئيسي في بنيان الدولة الآسيوية تمثل – وما زال يتمثل – في قيام الدولة المعنية قبل بناء القانون. ومن ثم، كانت الأزمة الأساسية في منطقة شرق آسيا متمثلةً في كيفية لجم قوة الدولة لا في إيجادها كما كان الحال في إفريقيا. إن الدولة الآسيوية والدولة الإفريقية تقفان على طرفي النقيض، كما يري “فوكوياما”.
إلا أن تسلط الدولة الآسيوية – من وجهة نظر المؤلف – لم يمنعها من النمو الاقتصادي، بل إنه أحدث نمواً سريعاً، أُطلق عليه فيما بعد “معجزة شرق آسيا”. لقد كانت قوة الدولة وفاعليتها بشرق آسيا – بغض النظر عن تدخلاتها التسلطية وعدم اعترافها بالقانون – سبباً مباشراً لتلك “المعجزة”. وكانت اليابان، دوناً عن كل دول المنطقة، هي الأسرع نمواً وتقدماً في بناء الدولة الحديثة القوية التي لا يحدها القانون؛ وذلك بسبب الإحساس الياباني غير العادي بهويته القومية، وبسبب اهتمام الدولة اليابانية ببناء رأسمال إنساني في الإدارات الحكومية بشكل سريع؛ تماما مثلما فعلت الدولة الألمانية مع جهازها البيروقراطي، كما أشرنا سابقاً.
وإن لجوء اليابان إلى بناء مؤسسات قوية لتحجيم تسلط الدولة، وكذلك لجوئها إلى إيجاد دستور ياباني (دستور “ميجيMeiji”) في القرن التاسع عشر، لم يكن سببه حراكاً مجتمعياً محلياً هادفاً إلى التغيير والدمقرطة كما حدث في أوروبا، وإنما كان سببه بالأساس هو رغبة النخبة اليابانية الحاكمة (الأوليجاركية الميجية) في تقليد الآخر الغربي، وفي أن يعاملها ذلك الآخر بالمثل. إن اليابان لم تعرف المجتمع المدني. فعلى الرغم من وجود ثورات الفلاحين – بسبب إدخال الزراعة في السوق العالية – إلا أنهم لم يصلوا أبداً إلى درجة الانتفاضة الشعبية الواسعة. كذلك لم تكن هناك معارضة يابانية بارزة باستثناء جماعة الساموراي التي تضررت كثيراً بعد إصلاحات “ميجي”. فالجماعات الاجتماعية في اليابان – من الفلاحين إلى التجار إلى المحاربين – لم يكونوا أبداً مهيئين لعمل جماعي منظم كالذي حدث في أوروبا. وكذلك فإن العسكرية اليابانية ممزوجة منذ بداية تاريخها بالهوية القومية؛ ومن ثم، فإن الدولة اليابانية لا تعتمد على قاعدة اجتماعية قوية، ولا ترتبط بحزب سياسي شعبي جماهيري.
حتى دستور “ميجي” – الذي كان من المفترض أن يقلص من سلطة الدولة – ظل مكرساً السلطة في أيدي الإمبراطور؛ ذلك أنه دستور كان أقرب ما يكون لدستور “بيسمارك Bismark” الخاص بالإمبراطورية الألمانية. إلا أن مع هزيمة اليابان أمام الولايات المتحدة في حرب الهاديء في عام 1947 تم فرض الدستور الأمريكي على اليابان والذي بموجبه تم نقل السيادة من الإمبراطور إلى الشعب، والذي بموجبه أيضاً تم إعطاء السيادة اليابانية للولايات المتحدة كي تحميها من الصين وكوريا الشمالية؛ تماماً كما حدث مع ألمانيا حينما أُجبرت على إعطاء سيادتها لحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.
الدولة الصينية القوية المتسلطة – تاريخياً – لم تختلف عن نظيرتها اليابانية. فكلتاهما اتبعتا منهج القوة الديكتاتورية، وكلتاهما أيضاً خاضتا معارك من أجل بناء دولة القانون، إلا أن ناتج تلك المعارك ظل ضعيفاً إذا ما قارناه بما حققته دولة القانون في أوروبا؛ كما يؤكد المؤلف. فقد أرست الصين دولتها المركزية البيروقراطية قبل ظهور نظيرتها الأوروبية بنحو 1800 عام. وهي دولة قامت – منذ اليوم الأول – على إبقاء كل الجماعات المجتمعية والدينية تحت سيطرتها الكاملة؛ مما جعل ظهور الطبقة الوسطى ضرباً من المستحيل. حتى مع مجيء الطبقة التجارية المستقلة، بعد ظهور الاقتصاد التجاري في الصين في القرن السابع عشر الميلادي، فإن مؤسسة الدولة ظلت على تعنتها فيما يخص إجابة طلبات تلك الطبقة من بناء دولة القانون ودولة الديمقراطية والمساءلة السياسية. وتعنت مؤسسة الدولة الصينية لتلك الطلبات ما زال مستمراً حتى هذه اللحظة؛ وهو على عكس ما تم إنجازه باليابان في نهاية أربعينيات القرن العشرين، حيث تم العمل بالدستور الأمريكي الذي نقل السيادة من يد الإمبراطور إلى أيدي الشعب، كما ذكرنا أعلاه.
ومشكلة الصين مع مبدأ سيادة القانون هي مشكلة حضارية بالأساس. فمعاداة الثقافة الصينية لفكرة القانون، على اعتبار أن الإنسان يُقاد من قبل الأخلاق وليس من قبل القانون، يعتبر سبباً. وعدم وجود دين سماوي بالصين، يستقي منه الصينيون القانون، يعتبر سبباً آخر. وذلك يفسر السر وراء رفض الدولة الصينية، منذ الأزل، محاكمة الحاكم بالقانون. فالحاكم في الثقافة الصينية يعتبر القائد الرشيد، صاحب النوايا الطيبة، الذي إن وُجد سيكون حكمه أفضل وأسرع من أي نظام ديمقراطي خاضع لمبدأ سيادة القانون والإجراءات الديمقراطية الرسمية. ولكن – كما حدث في اليابان – تعالت دعوات الإصلاح لإيجاد قانون فقط لمواكبة المعايير الغربية؛ وليتم معاملة الصين مثل الدول السيادية الأخرى؛ ليس أكثر من ذلك.
إلا أن تجربة الصين المريرة مع الرئيس الديكتاتوري “ماوMao” في القرن العشرين، الذي شن هجومه على القانون، دفعت الصينيين إلى أخذ جميع التدابير والمضامين القانونية لمنع صعود ديكتاتور آخر مثل “ماو”. فبعد موت “ماو” في عام 1978، انطلق “دينج إكسياأوبينج Deng Xiaoping” من النخبة الشيوعية، مُصدِراً القوانين اللازمة والدساتير الجديدة لحصر جميع الفرص التي تؤدي إلى ظهور قائد على شاكلة “ماو”. إلا أن دستور “دينج” لم يخلو من “المباديء الأربعة الأساسية” التي تجعل من الحزب الشيوعي الحاكم المسيطر على النظام السياسي. صحيح أن الدستور تضمن قوانين لضبط سلوك صغار الموظفين في الحكومة؛ وصحيح أنه تضمن قوانين اقتصادية جديدة لمواكبة الاقتصاد المتنامي؛ إلا أن الحكومة ظلت هي المالك الوحيد والأوحد مما جعل سن وتشريع حقوق الملكية الخاصة ضرباً من الخيال. وإلى يومنا هذا، تظل الدولة الصينية، المُسيطر عليها من قبل حزب ليني مُنظم، فارضةً لأجندتها المستقلة بنفسها دون مساءلة ديمقراطية أو خضوع لمبدأ سيادة القانون. وإلى يومنا هذا، تظل الآليات الرسمية للمساءلة والشفافية السياسية منعدمة في الصين.
ومن هنا نستطيع القول، كما يبين “فوكوياما”، إن الصين الحالية – على الرغم من تقدمها المهول في العقود الماضية من ناحية النمو الاقتصادي وتقليل نسبة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع الصيني – إلا أنه تظل هناك مخاطر عدة تهدد استدامة النظام السلطوي الصيني، والتي تتلخص في الآتي: إمكانية إفراز قائد لديه كاريزما، على شاكلة “ماو”، مستغلاً الفجوات الهائلة بين الطبقات؛ إمكانية فقدان الحكومة لسيادتها والاستيلاء عليها من قبل جماعات ضغط قوية يفرزها التقدم الاقتصادي المهول؛ إمكانية فقدان النظام الصيني لشرعيته بسبب التناقضات بين تصريحاته وأفعاله (فمن جهة تصرح الحكومة بأنها تتبع نظاماً أخلاقياً غير غربي، ومن جهة أخرى يعتمد الحزب الشيوعي الحاكم في شرعيته على الأيديولوجية الغربية المتمثلة في الماركسية واللينية).
إن مشكلة “الإمبراطور السييء” في النظام الصيني لن تُحل إلا بفرض الضوابط الرسمية على الدولة، كما يوضح المؤلف. هذا يتطلب أولاً تطبيق القانون على المستويات الرفيعة في الحكومة والحزب الشيوعي؛ ويتطلب ثانياً توسيع المشاركة السياسية. إذا رغب النظام السياسي الصيني في الاستمرار على المدى البعيد فعليه أن يأخذ بهذين المطلبين. إن الصين تقف حالياً في مهب رياح التغيير التي تتمثل في تحدي الفاعلين الاجتماعيين الجدد الواقفين في وجه تسلط الدولة، ضاغطين عليها من أجل بناء مؤسسات قوية ضابطة لذلك التسلط. إن هؤلاء الفاعلين الجدد هم الطبقة الوسطى الصاعدة حاليا…التي تضم ملايين الصينيين؛ وهي ظاهرة لم تحدث في الصين من قبل. خلاصة القول، إن مستقبل سيادة القانون والدمقرطة في الصين سيعتمد على مدى قدرة تلك الجماعات المجتمعية الجديدة على إحداث تحول في الميزان الكلاسيكي للقوة بين الدولة والمجتمع.
كانت التجربة التنموية الصينية هي التجربة الأخيرة التي قام “فوكوياما” بعرضها في مصاف التجارب التنموية بمنطقة شرق آسيا. وبهذه التجربة اختتم المؤلف فصله الثاني “المؤسسات الخارجية”، مُنهياً ذلك الفصل بالمرور سريعاً بالمناطق النامية الثلاث بالعالم (أمريكا اللاتينية وإفريقيا وشرق آسيا) مُلخصاً تلك التجارب بتلك المناطق في فرضية تقول: إن الاختلافات النُظمية بين تلك المناطق أحدثت طرقاً مختلفة للتنمية السياسية. وإن مدى قوة الدولة كان عاملاً أساسياً ومؤثراً في تفسير مسارات التنمية السياسية والسلوك الاقتصادي.
الفصل الثالث: الديمقراطية
يبدأ “فوكوياما” فصله الثالث “الديمقراطية” بتوجيه السؤال الآتي: لماذا انتشرت الديمقراطية عبر العالم؟ يرى المؤلف أسباباً عدة أفضت إلى انتشار الديمقراطية؛ منها قوة فكرة الديمقراطية وتجذرها ثقافياً وتاريخياً في دولة أثينا والديانة المسيحية؛ والنمو الاقتصادي والحراك الاجتماعي؛ وسرعة انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة. وقد تناول المؤلف السبب الثاني بالتفصيل حيث قدم فرضيةً تقول: أن هناك علاقة وطيدة بين المستويات العالية من التنمية الاقتصادية وبين الديمقراطية. وهنا أشاد المؤلف بفرضية “آدم سميث” الذي رأى في التنمية الاقتصادية وسيلةً لإيجاد طبقات وسطى جديدة لم تكن متواجدة من قبل في النظام الزراعي؛ تلك الطبقات تُحدث حراكاً اجتماعياً يطالب بمزيد من المشاركة في العملية السياسية، وبإنفاذ سيادة القانون. ومع مرور الوقت – ويستمر المؤلف في صياغة حجته – تصير الديمقراطية هدفاً أساسياً للطبقات الوسطى. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فهذا المطلب لا يمكن أن يتحقق دون تمثيل تلك الطبقات الاجتماعية الفاعلة الجديدة من قبل أحزاب سياسية تنظم حركاتهم سياسياً.
كل ذلك صحيح من الناحية النظرية..ولكن الأمر يختلف كثيراً حينما ننزل إلى أرض الواقع، كما يرى “فوكوياما”. ففكرة أن الطبقة الوسطى (البرجوازية) والديمقراطية عنصران متلازمان ليست دائماً صحيحة؛ فالطبقة الوسطى قد تطالب فقط بالقوانين التي تحمي مصالحها لا التي تُمكِن العامة. فقد كانت “حقوق الإنسانThe Rights of Man” في فرنسا مثالاً لتحجيم سلطة الدولة الفرنسية من خلال تشريع قوانين لحماية الحريات الشخصية…إلا أن تلك القوانين كانت خاصة فقط بالطبقة البرجوازية وليس بجموع المواطنين الفرنسيين. وكذلك بالنسبة للأحزاب؛ فليس شريطةً أن تكون الأحزاب وسيلةً لتنظيم الفاعلين الجدد سياسياً، بل قد ينتهي بها الأمر بتعبئة ناخبين من طبقات مختلفة عبر تحويل أجنداتهم، ومن ثم البعد عن المصالح الرئيسية للطبقة الاجتماعية التي تؤيدها.
لم يكن الطريق الأوروبي نحو الديمقراطية سهلاً أو سريعاً، بل كان طريقاً طويلاً، استمر ما يقرب المئة والخمسين عاماً. فالديمقراطية الليبرالية لم تأت جملةً واحدةً؛ بل إنها لم تتحقق ولم تكتمل كاملةً في غربي أوروبا إلا في النصف الثاني من القرن العشرين، وبعد سقوط الشيوعية في فترة 1989-1991 حيث امتدت بعدها إلى شرقي أوروبا، كما يؤكد المؤلف. وتفرض بريطانيا قاعدةً استثنائية، حيث ترسخت فيها الديمقراطية مبكراً – في العقد الثالث من القرن العشرين – حيث كان المحافظون يغازلون الطبقة العمالية بالقيم التقليدية، مثل الدين والكنيسة والهوية القومية.
كان من أهم ناقدي الديمقراطية “جون ستيوارت ميل John Stuart Mill” الذي قدم فرضيته على النحو الآتي: أولاً، إن الديمقراطية قد تم خطفها من قبل الدعوات القومية بدول أوروبية كثيرة في النصف الأول من القرن العشرين. وثانياً، إن جماعات الضغط هي التي تختار وليس الشعب؛ فنتائج الانتخابات لا تمثل بالضرورة الاختيار الحقيقي للجماهير؛ ذلك أن الفضاء العام يرضخ في النهاية لجماعات الضغط الأكثر تنظيماً. ثالثاً، إن الديمقرطية لم تكن متحققةً قبل القرن العشرين، إذ لم يكن للسود والمهاجرين والسيدات وغير المالكين حق الانتخاب. فكانت النخبة المالكة (الـ20% الذين يسيطرون على 80% من مقدرات البلاد) هي التي تتحكم في العملية التصويتية.
بعد حديثه عن أسباب انتشار الديمقراطية، وعن التحفظات الغربية التي قُدمت حيالها، انتقل “فوكوياما” – ولأول مرة في كتابه – إلى الحديث عن المنطقة العربية، إذ عقد مقارنةً تتلخص في الآتي: مثلما خطف الفكر القومي النبض الديمقراطي في أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، خطف الفكر الديني الحراك المجتمعي الجماهيري في المنطقة العربية. ويستشهد “فوكوياما” هنا بكلام “إرنيست جيللنر Earnest Gellner” عن القومية، حيث قال إن القومية كانت رد فعل طبيعي لضياع الهوية بعد تحديث المجتمعات في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، وتحولها من مجتمع القرية إلى مجتمع المدينة الكبيرة. وبالمثل يدلل “فوكوياما” موضحاً أن تصاعد تيارات الإسلام الحديث بالمنطقة العربية، في القرن العشرين، جاء كرد فعل لعوامل مماثلة – ضياع الهوية – حيث لعب الدين نفس الدور الذي لعبته القومية في أوروبا.
ويستكمل “فوكوياما” حجته متوقعاً ومستشرفاً بطول مشوار الديمقراطية في الشرق مثلما كان في الغرب الأوروبي بعد عام 1848؛ حيث يفترض بوجود أوجه تشابه كثيرة بين المنطقتين. فمن وجهة نظره، فإن العالم العربي يبدو اليوم مثل ما بدت عليه أوروبا في عام 1848؛ فكما كانت أوروبا في ذلك الوقت دون سابقة ديمقراطية، فالعالم العربي اليوم ليس لديه سابقة ديمقراطية. وكما كانت الطبقة الوسطى المحرك الأساسي نحو تأسيس الحراك الاجتماعي والعملية الديمقراطية في أوروبا، فإن الطبقة الوسطى الجديدة الصاعدة حالياً في العالم العربي ستكون هي أيضاً المحرك الأساسي نحو دمقرطة الشرق. وهي طبقة شبابية من خريجي الجامعات؛ متمكنةً من استخدام التكنولوجيا الحديثة ولكنها عاطلة عن العمل في الوقت ذاته.
ويعلل “فوكوياما” عدم استكمال ثورات الربيع العربي لمسارها في القرن الواحد والعشرين بسببين رئيسيين: يتمثل السبب الأول في عدم تنظيم الثوار لأنفسهم بعد اندلاع تلك الثورات الأمر الذي مكن من عودة الحكم العسكري منتهزاً الفرصة لإحداث مزيد من العرقلة للقدرات التنظيمية الثورية؛ بينما يتمثل السبب الثاني في عدم مناصرة الطبقة الوسطى للديمقراطية وتحالفها مع الحكم العسكري.
وهنا يثير المؤلف – مرةً أخرى – مسألة دور الطبقة الوسطى في العملية الديمقراطية؛ موضحاً أنه على الرغم من توجه تلك الطبقة نظرياً نحو التغيير والإصلاح والدمقرطة إلا أن الواقع لم يتطابق مع النظرية في كثيرٍ من الأحيان. فمنذ أيام “أرسطو” والمفكرون يعتقدون بأن الديمقراطية المستقرة لابد لها من الاعتماد على طبقة وسطى كبيرة؛ وذلك لكونها ممثلةً لقيم سياسية مختلفة عن قيم المُترفين والفقراء. فالطبقة الوسطى – ذات المستوى العالي من التعليم والثقافة – تُقدِر الديمقراطية والحقوق الفردية والعمل الدءوب، على عكس الطبقتين الأُخريتين. إلا أن تجربة الديمقراطية بأوروبا في القرن التاسع عشر أظهرت أن الطبقة الوسطى ليست بالضرورة داعمةً للديمقراطية؛ حيث أنها تحالفت في كثير من الأحيان مع الحكام السلطويين لضمان حماية حقوقهم الملكية. بل إن الطبقات العُمالية في أوروبا استطاعت أن تكسب امتيازات عديدة – عبر الاتحادات العمالية – مما حولها إلى طبقة وسطى “أرستقراطية” كبيرة مع نهاية النصف الأول من القرن العشرين. نضف إلى ذلك، فقدان اليسار السياسي عبر العالم تركيزه على الشئون الخاصة بالطبقة العُمالية نتيجةً لانتشار سياسات الهوية في منتصف القرن العشرين. وعلى أثر ذلك، لم تعد أوروبا وأمريكا الشمالية تعانيان من الاستقطاب السياسي بين الأوليجاركية الغنية والطبقة العمالية الكبيرة، كما كان الحال في القرن التاسع عشر.
وهنا يفترض “فوكوياما” وجود ضمانات معينة تجعل الطبقة الوسطى حاضنةً وداعمةً للديمقراطية. أولها اتساع الطبقة الوسطى؛ فكلما كانت تلك الطبقة كبيرة ومتسعة كلما كان الطريق نحو الديمقراطية اكثر ضماناً؛ فقد أظهرت تجارب الدول أن الطبقة الوسطى قد تساند الانقلابات إذا كانت أقلية. ثاني تلك الضمانات هو توفر العدالة؛ فكلما كانت هناك عدالة في النظام السياسي كلما قويت شوكة الطبقة الوسطى وقوي عودها، ومن ثم كانت أقدر على إحداث الحراك الاجتماعي الذي يؤدي إلى الديمقراطية. بمعنى آخر، إذا فشل التطور التكنولوجي الحداثي في إيجاد منافع اقتصادية يتشارك فيها الجميع، فإن المجتمعات الحديثة سيكون لديها معوقات كبيرة في استكمال طريقها نحو الديمقراطية.
ويحذر “فوكوياما” في نهاية الفصل عن “الديمقراطية” من تآكل الطبقة الوسطى في العالم الصناعي الحديث بسبب انعدام العدالة في توزيع المنافع الاقتصادية؛ مبيناً أن مستقبل الديمقراطية بالعالم الصناعي معقود على قدرة الأخير في التعامل مع الطبقة الوسطى المتآكلة. وإن لم تعترف النظم الديمقراطية الحديثة بتلك الإشكالية وتسارع في حلها…فلن تلوم إلا نفسها. فتلك النظم – كما يصفها المؤلف – ازدادت تصلباً وتعنتاً عبر الزمن مما يجعل تكيفها المؤسسي مع المتغيرات أمراً في غاية الصعوبة.
الفصل الرابع: الانهيار السياسي
يختتم “فوكوياما” كتابه بحديثه عن ظاهرة الانهيار السياسي، ليس في الأنظمة المتسلطة بل في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؛ متناولاً بإسهاب انهيار فعالية الجهاز التنفيذي الإداري الأمريكي على مدى العقود الأخيرة؛ معلللاً ذلك الانهيار بعدة أسباب، والتي منها: ترهل وازدياد عدد الموظفين الإداريين بصورة غير طبيعية، وانعدام المهارة كمقياس لتشغيل هؤلاء الموظفين ولا سيما بعد الحربين اللتين خاضتهما الولايات المتحدة في المنطقة العربية في الآونة الأخيرة (أفغانستان 2001، والعراق 2003)، حيث عاد الكثير من المحاربين الأمريكيين القدامى ليشغلوا وظائف بالجهاز الإداري الأمريكي، وهم غير مؤهلين.
ومن الأسباب أيضاً لذلك الانهيار المؤسسي السياسي، تعنت المؤسسات السياسية الأمريكية، وتربصها باللاعبين السياسيين الجدد المنادين بالإصلاح. بل وتمثل ذلك التعنت أيضاً في إصرار تلك المؤسسات على انتهاج الأسلوب العلمي البحت، وتطبيق نظريات العلوم الطبيعية على المشكلات الحياتية، مما أدى إلى انهيار تلك المؤسسات، مثل “المؤسسة الراعية للغابات الأمريكية” التي تحولت من مثال ساطع للبيروقراطية الأمريكية عالية الجودة والفعالية إلى مؤسسة منهارة انهياراً كلياً. ولا يغفل المؤلف تناول أهم الأسباب، وهو ترسخ الثقافة السياسية الأمريكية المناوئة والرافضة لمفهوم الدولة القوية، ومن ثم عدم الثقة في الدولة.
أفضى انهيار وضعف الجهاز التنفيذي الأمريكي إلى اللجوء للمحاكم كمؤسسة بديلة لإدارة الأمور، الأمر الذي حول الولايات المتحدة إلى دولة المحاكم، كما يبين “فوكوياما”. فباتت عملية صناعة السياسة تتم على أيدي قضاة غير منتخبين، أقل فعالية من الجهات التنفيذية، بدلاً من الارتكان إلى الديمقراطية بفروعها التنفيذية القوية. وباتت المشاكل التنفيذية تُحل بحلول قضائية؛ فصار الجميع يقاضي الحكومة عبر القضاء. لقد أدت التقاليد الأمريكية المترسخة – التي لا تثق في سلطة الحكومة التنفيذية – إلى تضخيم أدوار المؤسسات الكابحة للسلطة التنفيذية؛ وهي مؤسسات القضاء والتشريع. وهو الأمر الذي أدى إلى مزيد من إجهاض ثقة المواطنين الأمريكيين في الإدارة الأمريكية. فلم تعد الولايات المتحدة دولة المحاكم فقط بل دولة الأحزاب أيضاً؛ ولا عزاء للإدارة الأمريكية التي انخفضت جودتها وتهاوت قوتها رغم تزايد وظائفها.
فموازاةً لحكم المحاكم، أضحت الأحزاب وجماعات الضغط هي أيضاً الحاكمة من خلال سيطرتها على الكونجرس، مما أوجد أزمةً حقيقيةً في تمثيل المواطنين العاديين الذين لم يعد لهم مكاناً في وسط نخب الظل التي باتت تفرض مطامعها ومصالحها عبر الأحزاب وجماعات الضغط. ويصف “فوكوياما” تلك الظاهرة بالزبائنية الجديدة التي أطلت بوجهها من جديد في النصف الثاني من القرن العشرين؛ حيث تم استبدال زبائنية القرن التاسع عشر التي كان قوامها علاقة المصلحة بين الناخب والمرشح السياسي بزبائنية القرن العشرين التي أصبح قوامها جماعات الضغط والمصالح.
إن انتشار ظاهرة جماعات الضغط في النصف الثاني من القرن العشرين كان له بالغ الضرر على السياسة الأمريكية؛ إذ باتت القرارات الحقيقية يتم أخذها على أيدي جماعات صغيرة من المصالح المنظمة والضيقة جداً التي لا تمثل جموع الشعب الأمريكي. لقد أضحى لدينا جماعات تمثل الأثرياء الأكثر تنظيماً وتعليماً؛ فتتفرض أجندتها ضد جماعات تمثل الفقراء المهمشين الأقل تنظيماً وتعليماً. وهو الأمر الذي جعل الكثير من الأمريكيين يعزفون عن المشاركة السياسية لتأكدهم من أكذوبة الديمقراطية الأمريكية التي تُروج لهم إعلامياً ودستورياً. فحكومة “للناس وبالناس ومن أجل الناس” أضحت وهماً كبيراً بالنسبة لهم. والعجيب أنه على الرغم من التأثير السلبي لجماعات الضغط على الديمقراطية، وعلى جودة السياسات العامة، وعلى النمو الاقتصادي، مما أوجد رفضاً شعبياً واسعاً لها، إلا أن الكثير من الأمريكيين – ومنهم أعضاء المحكمة العليا – لا يرون مشكلةً في جود تلك الجماعات.
إن انعدام الثقة الطويل في الدولة الأمريكية أسفر عن إيجاد شكل غير متوازن من الحكومة التي تجهض أي آفاق للعمل الجماعي الضروري؛ فكانت النتيجة هي نشوء ما أسماه المؤلف بالـvetocracy، أو الفيتوقراطية التي تخول المحاكم وظيفة تنفيذ القرارات الحكومية لعدم توفر جهاز بيروقراطي قوي وموحد للقيام بتلك المهام. إن عدم ثقة الأمريكيين تاريخياً في الحكومة الأمريكية جعلهم يمتنعون عن تفويضها لصناعة القرارات كما يحدث في المجتمعات الديمقراطية. ثم يأتي الكونجرس بقوانينه المعقدة التي تجعل عملية صناعة القرار بطيئة ومكلفة مما يضخم من الشكل الضعيف للحكومة في أعين المواطنين الأمريكيين.
ولا يغفل “فوكوياما” عن ذكر مساويء منظومة “الضبط والتوازنchecks and balance” التي ترسخت بعمق في المؤسسات الأمريكية؛ فكانت سبباً جوهرياً في تعويق تلك المؤسسات عن أداء مهامها المنوطة بها، والتي منها خدمة المواطن الأمريكي العادي. إن تطبيق منظومة “الضبط والتوازن”، مع الاستقطاب السياسي الحاد، خلف نظاماً سياسياً ضعيفاً مفتقداً القدرة على تمثيل مصالح الأغلبية، بينما كان وما زال مانحاً تمثيلاً زائداً لرؤى جماعات الضغط والمصالح التي لا تلبي شيئاً من مطالب القاعدة العريضة للمجتمع الأمريكي. إن تلك المنظومة التي أعطت ثقلاً واضحاً لجماعات المصالح بينما فشلت في إعطائها لمصالح الأغلبية كانت سبباً رئيسياً وراء عرقلة عملية صناعة القرار الأمريكي، ومن ثم عرقلة دولة الرفاه الاجتماعي ومنعها من النمو مثلما نمت نظائرها الأوروبية. إن تلك المنظومة المعرقلة لا يمكن إصلاحها عبر تغييرات سطحية؛ وكذلك فإن الحل الجذري الراديكالي – من قبيل نقل النظام السياسي الأمريكي للنظام البرلماني – لا يمكن قبوله. إن الإصلاح المؤسسي أمر في غاية الصعوبة؛ ولا توجد ضمانة لتحقيقه دون إخلال جسيم بالنظام السياسي، بحسب كلام المؤلف.
إن من سبل رشاد وصلاح الحكومة، كما يشير المؤلف، قدرتها على الوصول إلى التوازن بين الإمكانية والاستقلالية. إلا أن الوصول إلى ذلك التوازن يتحقق غالباً في ظل صراع سياسي. فإيجاد الحكومة لإمكانيات بشرية ومادية وتنظيمية، مع تسلحها بقدر الاستقلالية التي تتناسب مع تلك الإمكانيات، لن يحدث بين يومٍ وليلة. فإذا باتت الحكومة ذات إمكانيات عالية وذات استقلالية من أية جماعات استطاعت الوفاء بوعودها تجاه شعبها الذي سيعطيها ثقته تباعاً. وهي تلك الثقة – العنصر غير المرئي الذي يحتاجه أي نظام سياسي لكي يعمل. إن الحكومة القوية الرشيدة تقاس بقوة بيروقراطيتها وفعاليتها وإمكانياتها…وإن البيروقراطية القوية ليست تلك التي تختبيء وراء الجدران وإنما المترسخة في المجتمع لكي تجيب مطالبه.
إن عملية إصلاح المؤسسات السياسية المركزية (الحكومة/القانون/الشفافية) عملية لها أهمية بالغة، أخذت مكانها في مختلف دول العالم ولكن بمعايير مختلفة؛ بمعنى أنها لم تتحقق بطريقة كونية واحدة. فعلى مستوى العالم، تعرضت تلك المؤسسات للضغط على أثر الحراك الاجتماعي السريع الذي أجج المطالب نحو المشاركة السياسية. فكان أن وضع ذلك الحراك الاجتماعي تلك المؤسسات – التي كانت تابعةً للنظام الزراعي – أمام مفترق طرق: إما تتكيف مع المطالب الجديدة الضاغطة المصاحبة لذلك الحراك؛ إما لا تتكيف فتسقط وتنهار. وهنا يعقد المؤلف وجهاً للتشابه بين عملية التنمية السياسية وعملية التطور البيولوجي، حيث يكون البقاء للأكثر تكيفاً مع البيئة الخارجية. إلا أنه يعود موضحاً بأن عالم الآدميين قد يختلف من حيث القدرة على التعلم من أخطاء الماضي والقدرة على إصلاحها. وقد اختلفت سبل التكيف من دولة إلى دولة، ومن بيئة إلى بيئة. فبينما تحالفت نخبة الطبقة الزراعية القديمة مع البرجوازيين الجدد للإبقاء على وضعها السياسي في بريطانيا، تحالفت الطبقة ذاتها مع النخبة الحاكمة القديمة في أمريكا اللاتينية لإحباط الفاعلين الجدد.
إن الفارق بين المؤسسات يكمن في مدى قدرتها على التكيف وإصلاح ذاتها. إلا أنه في النهاية لا يوجد نظام سياسي واحد قادر على التوافق مع المحيط المتواجد حوله إلى الأبد. فالأنظمة كلها، ديمقراطية وغير ديمقراطية، معرضة للسقوط على مدار الوقت. فلا توجد آلية تاريخية واحدة تجعل التقدم أبدياً، أو تمنعه من السقوط.
إن عملية الإصلاح المؤسسي السياسي لا يُشترط فيها فقط القدرة على التكيف، وإنما أيضاً القدرة على استخدام العنف، بحسب وجهة نظر مؤلف الكتاب. فالعنف كان دائماً عنصراً أساسياً في عملية الإصلاح السياسي أو التنمية السياسية؛ حيث لم يكن النمو الاقتصادي حافزاً كافياً لتطوير مؤسسة القبيلة إلى مؤسسة الدولة ثم أخيراً إلى مؤسسة الدولة الحديثة. فالتاريخ يقول – والكلام لـ”فوكوياما” – أن التطور السياسي لم يحدث إلا بفعل الصراع العسكري واستخدام العنف؛ فالحروب هي التي صنعت الدول، وهي التي أزالت الجمود المؤسسي، وهي التي منعت السقوط السياسي. فاللاعبون السياسيون الذين يصرون على غلق نوافذ التغيير المؤسسي لابد أن يُحاربوا في النهاية. هذا إضافةً إلى عملية رسم الحدود – طبقاً للهويات القومية المصطنعة – التي تطلبت أيضاً ممارسة العنف. إلا أنه ليس بالضرورة أن يظل العنف شرطاً أبدياً للإصلاح في حالاتٍ قد تأتي مستقبلاً؛ إذ على المجتمعات التعلم من الخبرات السابقة بتكييف نماذج أخرى خاصة بها.
وعلى الرغم من عمليات الإصلاح المؤسسي، وعلى الرغم من عمليات التنمية السياسية التي شقت طريقها في الغرب الأوروبي والأمريكي – على مدى قرنين – والتي أفضت في النهاية إلى نشوء تظم ديمقراطية ليبرالية، إلا أن تلك النظم لم تنجح في تحقيق المطالب الأساسية للناس والجماهير العريضة. لقد ركزت تلك الأنظمة على محاصرة قوى الاستبداد، بينما أغفلت التركيز على الحكم الفعال الذي يسد احتياجات جموع المواطنين. لقد طبقت تلك الأنظمة الإجراءات الديمقراطية في قالبها الصارم بينما أغفلت تطبيق معاني وأهداف الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة السياسية. فإن إجراءات الانتخابات لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الشفافية؛ ولنا في ظاهرة جماعات الضغط الشائعة في السياسة الأمريكية مثل حي. ولنا في إخفاق الثورة البرتقالية الأوكرانية لعام 2014، وفي إخفاق الديمقراطية الهندية مثلان آخران. فتلك الأمثلة الثلاثة لم تسد مطالب شعوبها كما فعلت الصين غير الديمقراطية مع شعبها. “إن تقديس الإجراءات وإعلاءها فوق المعنى يمثل مصدراً رئيسياً للسقوط السياسي في الديمقراطيات الليبرالية الحالية” (“فوكوياما”، 543).
إن العوار الذي بدت عليه الديمقراطيات الليبرالية الحالية، بعد مشوارٍ طويل من العراك والصراع، حفز نماذج مستقبلية على الوقوف والتحدي، مُقدمةً ذاتها كبديل للديمقراطية الليبرالية في القرن الواحد والعشرين. ويطرح “فوكوياما” هنا دولاً ثلاث مُعبرةً عن تلك النماذج المستقبلية، وهي: الصين وروسيا وإيران. وتمثل الصين التحدي الأكبر لفكرة عالمية النموذج الديمقراطي الليبرالي. فسكان الصين اليوم يتشكل معظمهم من الطبقة المتعلمة الوسطى على عكس طبقة الفلاحين سابقاً. وتقف الصين حالياً أمام تساؤل مصيري: هل ستتبع الطبقة الوسطى الصينية نفس المسار المُتبع في النموذج الليبرالي الديمقراطي متحديةً تسلط الدولة الصينية أم أنها سترضخ لديكتاتورية الحزب الواحد؟ الإجابة ستكون اختباراً لكونية وعالمية الديمقراطية الليبرالية.
ليست تلك الدول فقط التي تمثل تحدياً للنموذج الديمقراطي الليبرالي الحالي – الذي انتهى أمره بالسقوط – وإنما هناك أيضاً المجتمعات الجديدة التي تزداد بصورةٍ واضحةٍ حول العالم، والتي يتم تعبئتها عبر الحدود والقوميات. ونجد دلائل ذلك في المظاهرات والانتفاضات الجماهيرية التي باتت تندلع بصورة غير متوقعة من تونس إلى كييف إلى اسطنبول إلى سان باولو؛ مطالبةً الحكومات الاعتراف بكرامتهم المتساوية كآدميين. كل هذا ليس له إلا معنى واحد، وهو: أن مطلب الكرامة المتساوية من قبل الحكومات أضحى مطلباً كونياً، وأن المسعى الكوني تجاه التنمية السياسية والإصلاح السياسي أضحى واضحاً للجميع.
نظرة ناقدة للكتاب:
لا يُنكر ثقل الكتاب من الناحية العلمية. فقد طاف المؤلف بتجارب تنموية عديدة، من الغرب الأوروبي إلى الغرب الأمريكي إلى الغرب اللاتيني إلى الشرق الآسيوي إلى الجنوب الإفريقي، مُستخلصاً العبر والدروس من تلك التجارب والخبرات المختلفة في بناء المؤسسات السياسية، مُبيناً الفوارق الجوهرية بين تلك الخبرات، مُسلطاً الضوء على مدى أهمية وضرورة التنمية السياسية في حياة البشر جميعاً. وفي أثناء “رحلته” التنموية يمكننا ملاحظة أمور عدة:
أولاً: أن هوية المؤلف الغربية، وانتماءه للمنظومة الغربية، لم يمنعاه من نقد تلك المنظومة بصدقٍ ونزاهة، واضعاً إياها في مرمى الهجوم. فحديثه عن التاريخ الأوروبي الدموي لتدشين الدول الحديثة، وفرض الهوية القومية؛ وحديثه المُطول عن انهيار وسقوط الأنظمة الغربية الديمقراطية الليبرالية بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين، وإفراده لذلك فصلاً كاملاً من كتابه….كل ذلك يعكس سعي المؤلف وراء تقديم نقدٍ بناء للمنظومة الليبرالية الغربية، بل وتوقعه أن عالم القرن الواحد والعشرين في انتظار البديل المتمثل في المجتمع العالمي الجديد العابر للقارات والجنسيات والأعراق.
ثانياً: تعظيم المؤلف من دور مؤسسة الدولة، معتبراً أن الولاء للدولة من سمات الحكم الرشيد. وهو الأمر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي: هل هو ولاء أم استعباد؟ هل توظيف المواطنين وتعبئتهم – ليصيروا أدوات لبقاء الدولة التي أضحت مرادفاً للنظام السياسي – هل يُعتبر ذلك ولاءً أم استعباداً؟ هل تسخير الشعوب ودفعها دفعاً نحو التضحية من أجل بقاء الدولة أو النظام السياسي – أياً كان هذا النظام – هل يعتبر ذلك التسخير أو تلك السُخرة ولاءً أم استعباداً؟ وهل يكون الولاء الحقيقي للمؤسسة (النظام) أم للقيمة المنزهة عن أي مصلحة؟
ثالثاً: ربط المؤلف عملية بناء الدولة بعملية فرض هوية قومية بالإجبار والعنف والدم. بمعنى آخر، إن عملية بناء الدولة – على حسب قناعة المؤلف – لا تتم إلا بإرغام المواطنين على اعتناق هوية قومية معينة، تجعلهم يقدمون حياتهم رخيصةً فداءً للدولة القومية. وهنا يبرز التساؤل الآتي: كيف كان وضع الدولة الإسلامية؟ هل ارتكزت عند قيامها على فرض هوية قومية أو دينية معينة؟ وهل كان العنف شرطاً لبناء تلك الدولة؟ الشاهد تاريخياً أن الدولة الإسلامية – التي أول من أقامها هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة – لم تكن مرتكزةً على إجبار الناس على اعتناق قومية معينة أو عقيدة معينة؛ وإنما كانت دولةً تضم المسلمين والمسيحيين واليهود سواء، في تجانس وتناغم وتعايش سلمي؛ وفي ظل أول دستور مدني عرفته البشرية؛ ولم يخترق هذا الدستور إلا خيانة اليهود بعد ذلك. ما أريد قوله باختصار، أن الدولة الإسلامية الأولى التي قامت منذ خمسة عشر قرناً – أي قبل نشوء الدولة الأوروبية الحديثة بحوالي إثنى عشر قرناً – قدمت نموذجاً لدولةٍ قامت دون إجبار مواطنيها على اعتناق هويةٍ معينة أو دينٍ معين. وذلك انطلاقاً من قيم إسلامية واضحة تمنع الإكراه على الدين وترفض العنصرية أو التحيز لأي جنس أو عرق أو لون.
رابعاً: تجاهل المؤلف للتجربة الحضارية والتنموية التي قدمها العالم الإسلامي على مدى خمسة عشر قرناً؛ حيث سرد المؤلف تجارب من الغرب والشرق والجنوب، مُسقطاً التجربة الإسلامية من الحُسبان…اللهم إلا تطرقه لثورات الربيع العربي المندلعة في القرن الواحد والعشرين. حتى عند تناوله لتلك الثورات، أظهر المؤلف نظرةً دونيةً تجاه تلك المنطقة، مفترضاً أنها لم تشهد طوال تاريخها أي تنمية سياسية قط، معتبراً أن ثورات الربيع العربي الأخيرة بمثابة الانطلاقة الأولى للتنمية السياسية العربية والإسلامية، مُشبهاً تلك الانطلاقة بانطلاقة أوروبا نحو الديمقراطية في عام 1848. وهو تشبيه لا نستطيع وصفه إلا بالإجحاف والغبن تجاه العالم الإسلامي الذي قدم الكثير – حضارياً وعلمياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً – للعالمين، طيلة قرونٍ طويلة، دون تحيز لدينٍ أو عرق أو جنس. إن تجاهل وإغفال “فوكوياما” لتاريخ ذلك العالم – الذي دشن دولته الإسلامية منذ قرابة خمسة عشر قرناً واضعاً بصمته على المعمورة طيلة تلك القرون – وإن اختزال “فوكوياما” لذلك التاريخ الطويل الثري في ثورات الربيع العربي الأخيرة، يعتبر بحق سقطة علمية مُخزية له كباحث أول معروف دولياً. وهو الأمر الذي يجعلني توجيه سؤالين له؛ أولاً: هل يجوز منطقياً وعقلياً عقد أوجه تشابه بين منطقتين مختلفتين اختلافاً جذرياً، حضارياً وقيمياً وبيئياً ومجتمعياً؟ هل من المنطق عقد تشابه بين منطقتين، أحاطتهما ظروف مختلفة، وأزمنة مختلفة، وقيم ومباديء مختلفة؟ ثانياً: هل انتفاء آليات الديمقراطية الغربية المعروفة في العالم الإسلامي معناه انتفاء وجود آليات أخرى – مثل آليات الشورى وأهل الحل والعقد – كانت تقوم بنفس معاني وأهداف الديمقراطية الغربية، ولكن من منطلقات أخرى، وفي ظل أنساق أخرى؟
وتظل دراسة العالم الإسلامي المنطقة التي لا ينصفها الباحثون الغربيون إلا النذر القليل منهم. وتظل الغالبية العظمى من هؤلاء الباحثين ينظرون إلى تلك المنطقة من علٍ؛ فإما يصنفونها ككمٍ مهمل لا يستحق الدراسة – كما حدث في الكتاب المعني – وإما يتطرقون إليها بتحليل متحيز واضح، يتضمنه العديد من الأفكار المُسبقة غير العلمية وغير المنطقية، والتي لا يدعمها أية حقائق أو قرائن علمية مثبتة. فمصطلح “رجل أوروبا المريض” – الذي كُنيت به دولة الخلافة العثمانية – شاهد على ذلك؛ وهو المصطلح الذي أصر الكثير من الباحثين والمؤرخين الغربيين على استخدامه بالرغم من ضعف بل انعدام الحجج الدالة عليه. وما يؤسف عليه حقاً، أن يقوم بعض الباحثين العرب والمسلمين باستخدام نفس المصطلح في بحوثهم، لينقلوه بالحرف دون فهم أو وعي.
ولكن هذا لا ينفي أن العالم الإسلامي قد تأخر كثيراً عما كان عليه في أزهى عصوره. وبغض النظر عن ماهية أسباب هذا التأخر – والتي يطول شرحها – فإنه لا غبار ولا شك من مواجهة عالمنا الإسلامي لأزمةٍ حقيقةٍ متمثلةٍ في غياب عنصر التنمية لديه، سواء سياسية أو اقتصادية أو مجتمعية أو ثقافية أو نفسية. فالمؤسسات في عالمنا الإسلامي لا يمكن وصفها إلا بالركود والعفن والتصلب والتحجر… مؤسسات آسنة تفتقد إلى الدماء الجديدة التي تُصلح وتُغير وتُطور؛ تلك الدماء الجديدة التي تمنعها أيادي النخب السياسية القديمة العتيقة الرافضة لأي تغيير حقيقي يعود على الشعوب بالنماء الحقيقي ليس النماء الإعلامي المصطنع الُمستورد؛ تلك النخب المتعنتة التي تصر على البقاء حتى ولو كان الثمن هو دفن شعوبها. فهل لتلك الشعوب أن تقوم لتقاوم ثانيةً – في “جولةٍ ربيعيةٍ” أخرى – مطالبةً بحقها في التنمية والإصلاح والعيش بكرامة؟ هل للفاعلين المجتمعيين الجدد أن ينهضوا ثانيةً متعلمين الدرس بل الدروس من ثوراتهم الربيعية الأولى؟؟ هل سيكون القرن الواحد والعشرين هو قرن نهضة العالم الإسلامي من جديد؟
عرض
د. شيرين حامد فهمي
دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies