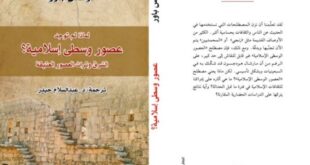العنوان: أزمة العالم الحديث = La Crise du Monde Moderne.
المؤلف: رينيه جينو
المترجم : أسامة شفيع السيد.
الطبعة: ط. 1.
صدرت الطبعة الأولى باللغة الفرنسية 1927.
مكان النشر: القاهرة.
الناشر: مدارات للأبحاث والنشر.
تاريخ النشر: 2019.
الوصف المادي: 240، 21 سم.
الترقيم الدولي الموحد: 7-39-6459-977-978.
ينقسم الكتاب إلى مقدمة بقلم المترجم يعنونها “بين يدي الترجمة”، ثم مقدمة الكتاب وتسعة فصول، وفي النهاية ملحق لقراءة نقدية ليوليوس إيفولا عن كتاب جينو.
الفصل الأول: العصر المظلم
الفصل الثاني: التعارض بين الشرق والغرب
الفصل الثالث: المعرفة والعمل
الفصل الرابع: العلم المقدس والعلم المدنس (الدنيوي)
الفصل الخامس: النزعة الفردية (الفردانية)
الفصل السادس: الفوضى الاجتماعية
الفصل السابع: حضارة مادية
الفصل الثامن: الاجتياح الغربي
الفصل التاسع: عدة نتائج
ملحق : مقال يوليوس إيفولا في نقد كتاب أزمة العالم الحديث
مراجع حواشي الترجمة ومقدمتها
نبذة عن المؤلف:
رينيه جينو أو عبد الواحد يحيى فرنسي ولد عام 1886. اهتم بالدراسات الروحية في الحضارات الشرقية ومن ثم اعتنق الإسلام في عام 1912، ثم تصوف على الطريقة الشاذلية وتسمى عبد الواحد يحيى وعاش في مصر وتوفي فيها عام 1951. له عدة مؤلفات اهتم فيها بنقد الحضارة الغربية الحديثة، وتقديم للحضارات الشرقية بصورة منصفة مبينا فضلها وتميزها وخصوصيتها.
المقدمة:
يشير جينو في المقدمة إلى كتابه السابق “الشرق والغرب” المنشور عام 1924، وأن هذا الكتاب تتمة وإيضاح لما بدأه في كتابه سالف الذكر، وأن الأمور تسارعت وأكدت ما كان قد أشار إليه فيه.
ثم يوضح جينو مقصوده من عنوان الكتاب وما هي الأزمة المتعلقة بالعالم الحديث. ويرى أن مفهوم الأزمة هو الوضع الحرج الذي ينبئ عن وقوع كارثة وشيكة أو تحولا عميقا. وأن الحقبة الحديثة تمثل زمان بحثه.
ثم ينتقل لفكرة “يوم الدين” مقابل فكرة “نهاية العالم”. ويقابل كذلك بين “المظاهر الدينية الزائفة” ومنظور “الحقيقة الخالصة المجردة عن الهوى”. ويؤكد رفضه للتفسير النفسي لفكرة نهاية العالم، ويوضح رأيه في أن مايستشعره بعض الناس من النهاية الوشيكة إنما هي نهاية الحضارة الغربية الحديثة والتي يعتبرونها نهاية العالم ككل، ولكن وفقا لجينو فإننا دنونا من نهاية حقبة أو دور تاريخي بما يتماشى مع العقائد الإلهية في هذا الشأن وهو المعروف بالقوانين أو السنن الدورية. ومن ثم فإن عالما في سبيله إلى الانقضاء، ولذلك فإن العلماء ينبغي عليهم القيام بدور ما وعليهم ألا يستسلموا للسلبية للخروج من هذا “العصر المظلم”.
الفصل الأول : العصر المظلم
يتحدث جينو عن الدورة الإنسانية وفق العقيدة الهندوسية، والتي تتكون من عوالم أربعة متتابعة ومتطورة دون أفضلية ما سبق أو ما تلاها. وليبدأ في دراسة هذه العوالم يرجع لدراسة التاريخ موضحا أن ثمة غموض يكتنف الحقبة التاريخية المنقضية قبل القرن السادس قبل الميلاد، حتى في البلاد الأقدم حضارة مثل مصر والصين التي يصف مؤرخوها هذه الحقبة بالأسطورية.
أما بداية القرن السادس قبل الميلاد فقد شهد وقوع تغيرات هامة لكل شعوب العالم تقريبا، وإعادة تكييف الموروث الإلهي وفقا لظروف كل شعب، ومن ذلك:
– ظهور الطاوية والكونفوشيوسية في الصين، وتطور المازدكية والزرادشتية في فارس وظهور البوذية في الهند.
– زمن التهجير البابلي لليهود.
– مولد الحضارة الكلاسيكية في اليونان وإعادة تكييف المنظومة الربانية وربطها بالفيثاغورية.
– بداية التفكير بالأسلوب الفلسفي، وهو الأسلوب الذي أضر كثيرا بالعالم الغربي ككل وفقا للمؤلف.
تفصيل عن الفلسفة: معناها الأصلي وفقا لفيثاغورس “محبة الحكمة” ومقتضى الأهلية التي تفضي الى المعرفة الحقيقية. ثم تولدت عنها الفلسفة الدنيوية “ذات الطبيعة الإنسانية المحضة التي تصدر عن المنظومة العقلية، والتي حلت محل المعرفة الوهبية التي تسمو على العقل ولا تُعزى لعالم البشر”.
ثم تطورت ليظهر المذهب العقلي، ثم مذهب الشك، والمذهب الأخلاقي الرواقي والأبيقوري، ما يشهد على تدهور الروحانية، وتدهور العقائد القديمة ووجود شوائب وثنية.
ثم استتبت الحضارة والنظام الطبيعي لعدة قرون، عرفت بالعصر الوسيط من 768 حتى مطلع القرن الرابع عشر. ثم ظهر تدهور جديد تزامن مع “تفسخ العالم المسيحي” وانهيار الإقطاع.
يرى جينو أن عصر النهضة كان تدهورا للمعارف الحِكمية واقتصار المعرفة على نظام الدراسة التجريبية لوقائع لا تعلق لها بأي جانب روحاني.
ويتعجب الكاتب من السرعة التي تدهورت بها حضارة القرون الوسطى (القائمة على الروحانيات) وعدم إشارة المؤرخين لها، وجهل رجال القرن السابع عشر بكل ما يتعلق بها. ويرى أن ما ألصق بالعصر الوسيط من وصمة الجهل والبربرية إنما هو فعل متعمد لتشويه التاريخ الحقيقي وهو من فعل المحدثين. حيث روَّج المحدثون لمبدأ (الإنسانية) وهو إعلاء مبدأ قيم إنسانية محضة بعيدا عن أي التفات إلى السماء. ومن ثم كانت الإرهاصات الأولى للعلمانية والبحث عن الإشباع المادي لشهوات الإنسان والانحدار به إلى هوة مهلكة.
ويرى جينو أن العصر المظلم قارب على نهايته، وهي مرحلة الانحلال التي لا مهرب منها إلا بوقوع كارثة، إذ أن الإصلاح لم يعد في الإمكان ولكن الحل هو (الاستبدال) الكامل. وأن الغرب كان هو منشأ هذا الاضطراب الهائل والفوضى التي اجتاحت العالم، وأن النهاية وشيكة لهذا الوضع المروع. ولكن يجب ألا ننساق في التفاؤل أو التشاؤم. هذا ما أخبرت به الكتب السماوية، وهذه النهاية الحتمية إنما هي إيذان ببداية جديدة لعالم جديد.
وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال يطرح نفسه: ما السبب في وجود زمان مثل هذا الذي نحيا فيه؟ ويجيب المؤلف أنه مهما كان هذا الزمان زمان عسر وفتن، فهو جزء من المسيرة العامة لدورة هذا الوجود، وقد أخبرت بقدومه العقائد الربانية. وهو تحول الناس عن مصدر معرفتهم الحكمي (الرباني، أو الروحاني، أو العرفاني) والإغراق في المضمون المادي العلمي البحت بمعناه الضيق، فلا يرون شيئا خلاف المادة، فغدوا عبيدا لها يستزيدون منها بلا أي ضوابط أخلاقية أو قانونية.
الفصل الثاني: التعارض بين الشرق والغرب
من خصائص هذا العالم الحديث التباعد بين الشرق والغرب ؛ ومنشأه إنكار العالم الغربي جميع المبادئ الأساسية التي ترجع إلى ما أسسته العقائد الربانية في النفوس البشرية السوية، وهو ما أسماه جينو (الوفاء للروح الرباني) في مقابل (الحضارة الشاذة المنحرفة).
وهذا الطابع الرباني هو السمة المميزة للحضارات الشرقية مهما تعددت أو تمايزت، فهو القاسم المشترك الذي يربط بين هذه الحضارات:
– في الشرق الأقصى: الحضارة الصينية.
– في الشرق الأوسط: الحضارة الهندية.
– في الشرق الأدنى الحضارة الإسلامية. وهذه الأخيرة الأَولى بنا اعتبارها وسيطا بين الشرق والغرب.
أما الغرب في القرون الوسطى فكان قريب الشبه بهذه الحضارات الشرقية، إلا انه أضحى الآن غريبا حتى عما كان هو عليه. وأن محاولات الغربيين في إحياء ما كان في غابر الأزمنة من حضارات قامت على “روح ربانية” في الغرب، ليس إلا ضربا من الوهم لاستحالة فهم هذه الحضارات في وقتنا الحالي ولدخول كثير من الأساطير والأغلاط عليها.
أما النموذج الوحيد القادر على بعث “الروح الربانية” في الغرب هو النموذج الشرقي للحضارة الذي يمكنهم استلهامه ليقيموا حضارتهم على أسس المسيحية – برغم ما فيها من تحريف حالي – ولكنها على الأقل أقرب ما يكون لهذه الروح، أما محاولتهم استعادة الروح الربانية من خلال الاتصال بالفلسفة التي ميزت العصور الوسطى فلن توصلهم لشيء، لأن الروح الربانية ما زال مركزها الشرق، ولا يخفى أنه ينبغي وجود هذا الطموح لدى الغرب للاتصال بهذه الروح. وهو ما من شأنه إيجاد وفاق فوري مع الشرق.
ينبه جينو إلى فكرة هامة: إن معاداة الحديث لا تعني معاداة الغربي، بل إن معاداة الحديث هي الجهد الوحيد النافع في محاولة استنقاذ الغرب من براثن الاضطراب والفوضى.
والشرق في الحقيقة لا يعادي الغرب، إنما لا يطلب شيئا سوى استقلاله وهدوءه وهذه أمور لا خلاف في مشروعيتها. والغاية التي يرنو إليها جينو والعقلاء من الغرب هو إصلاح الغرب، وإذا تم هذا الإصلاح على الوجه المبتغى، أي ابتعاث الروح الربانية فإن ذلك يُفضي إفضاء طبيعيا إلى التقارب مع الشرق.
الفصل الثالث : المعرفة والعمل
أحد الجوانب الرئيسية للتعارض بين الشرق والغرب، أو بين العقلية الربانية والعقلية الحداثية، هي المقابلة بين المعرفة والعمل؛ فهل التأمل و العمل ضدان حقا؟ أم هما يتكاملان؟ أم العلاقة بينهما تتخذ شكل التبعية؟
الرأي القائل بالتعارض بينهما هو رأي ساذج، بل الأرجح أن ثمة غلبة لأحدهما على الآخر حتى على مستوى الفرد نفسه، كذا على مستوى المجتمعات، والراجح هو وجودهما معا والأوجب العمل على التوفيق بينهما بما يحقق التكامل.
يرى الكاتب أن ملكة النظر (المعرفة) منتشرة لدى الشرقيين عموما، وهي أوضح ما تكون لدى شعب الهند. أما ملكة العمل فلها سلطان على غالبية شعوب الغرب، وبعد فقدهم الروحانيات بدأوا بوضع النظريات والمبادئ التي تعلي من قدر العمل فوق كل شيء مثل (البراجماتية أو الذرائعية). ويرى جينو أن الشرق بمقدوره مد يد العون لإنقاذ الغرب من الاستغراق في المادية.
والتعارض القائم بين الشرق والغرب إنما هو إنكار الأخير لكل قيمة للمعرفة وتفضيله قيمة العمل وجعلها شغله الأوحد، بينما العقائد الشرقية قد أقرت بدور العمل مع إقرارها بسمو دور النظر وأهميته في منظومة الحادثات. وقد اعترفت العقائد الغربية القديمة بأفضلية النظر على العمل كما أن الثابت أعلى رتبة من المتغير.
أما الغرب الحديث فيعوِّل على أنواع المعارف العقلية والاستدلالية أي الناقصة غير المباشرة، ويستخدمها في تحقيق غايات عملية. ومن أظهر خصائص العصر الحديث: الرغبة في الحركة التي لا تنتهي والتغير الذي لا ينتهي، والسرعة الزائدة، إنه التشتت في الكثرة التي لا يلملمها أي مبدأ. الإنجاز الوحيد الذي حققه الإنسان المعاصرهي تلك المكتشفات والمخترعات الميكانيكية التي قد تكون هي نفسها سببا في الكارثة الوشيكة.
ويذكر جينو العديد من الفلسفات القديمة والحديثة ونقاط الاختلاف أو التلاقي بينها، ويضيف المترجم في الهامش الكثير من المعلومات الخاصة بهذه الفلسفات فيزيد من قيمة النص وعمقه لتفسير ما جاء مجملا من مسميات الفلسفات.
الفصل الرابع: العلم المقدس والعلم المدنس (الدنيوي)
يقدم جينو مبدأ “الحدس القلبي”، وهو مبدأ ذائع في الحضارات ذات الطابع الرباني، وفيها تكون العلوم في منزلة الانعكاسات للحقائق المطلقة.
أما في الغرب فالعلوم تتعدد وكذا الاختصاصات؛ ويتم دراسة نفس الموضوع من عدة جوانب من خلال علوم مختلفة فينتج عن ذلك اختلاف وتباين في النتائج. ويعطي مثالا لعلم الفيزياء ومعناه ومادة دراسته قديما وحديثا: فقديما وفق معناه الاشتقاقي الأول هو (علم الطبيعة)، وهو العلم الذي يتعلق بالقوانين الأعم لعلم الصيرورة، أما لدى المحدثين فالفيزياء عَلَم على عِلم مخصوص دون سائر العلوم التي تُعد جميعا من علوم الطبيعة. وهذا التشظي ناشئ عن التخصص وروح التحليل الذي يتسم به العلم الحديث. مما يؤول بالمحدثين في نهاية المطاف إلى رفض هذه العلوم الشاملة والتمسك بصورها التفصيلية لرفضهم ردها إلى مبدأ أعلى.
ويرى المؤلف أن العلم في صورته الحديثة لم يفقد من عمقه فحسب بل فقد من رسوخه أيضا لأن اتصاله بالمبادئ العليا (الميتافيزيقا) يضفي عليه من استقرار هذه المبادئ نفسها، في حين أن انحصاره في علوم التغير ينزع عنه هذا الثبات، وعدم انطلاقه من اليقين المطلق أفضى به إلى أن يكون ضربا من الاحتمالات والفرضيات المجردة التي صنعها خيال الأفراد.
وإذا وافقت نتائجها عطايا (العلوم) الربانية فإن الأخيرة في غنى عن توكيد تصفه به هذه العلوم الفرضية التي قد تتغير نتائجها فيما بعد؛ إذ أنها بالأساس كانت ثمرات يقينية لحقائق ميتافيزيقية مدركة بالحدس القلبي (البصيرة).
ويعدد جينو الأمثلة الدالة على انفصال العلوم الحديثة عن مثيلاتها في العصور القديمة حتى وإن حملت نفس المسميات؛ وذلك لانفصالها عن الجانب الأعلى من هذا العلم أو ذاك وهو قيمته الروحانية الخالصة. ويخلص من ذلك إلى أن العلوم في مآلاتها إلى تدهور وليس تقدم لأنها لاتعدو كونها القشور الخارجية للعلوم القديمة.
ثم يبدأ في ذكر نقاط التمايز بين العلوم اللدنية والعلوم الحديثة؛ فيطلق عدة مسميات على العلوم المعرفية العليا مثل: العلوم المقدسة، العلوم اللدنية، العلوم الوهبية، أو المذهب العرفاني. أما العلوم الحديثة فيطلِق عليها العلوم الدنوية، المعرفة الحسية، علم المحدثين، أو العلم الجاهل.
والطرق المفضية إلى المعرفة الإلهية شديدة الاختلاف في أدنى المراتب ولكنها تتلاقى وتتوحد كلما ارتقينا إلى المراتب العليا، ولعل نفرا من الذين يغلب عليهم النزوع إلى النظر يتوقون إلى الحدس القلبي رأسا. ولكن في الغالب هناك ما يمكن القول إنه ضرورة للتهيؤ للشروع في الاتجاه الصاعد. وإن العلوم ذات مراتب متفاوتة في الأهمية، بحسب الترتيب الهرمي للحقائق المتنوعة التي تتخصص في معالجتها.
الفصل الخامس: النزعة الفردية
يقصد الكاتب بها تلك النزعة التي تفضي إلى إنكار كل ما هو أسمى من الفرد، وقصر الحضارة على العنصر الإنساني المحض، وهي توازي مصطلح المذهب الإنساني في عصر النهضة، وهو ما أسماه الكات في الفصل السابق بالمنظور الدنيوي. وهو العلم المناهض للعلم اللدني، وهو ما تأسست عليه الحضارة الغربية الحديثة القائمة على إنكار كل مبدأ، وأول ما تنكره هو إنكار الحدس القلبي من حيث كونه ملكة فوق فردية في جوهره ورفض مجال الميتافيزيقا (الإلهايات).
أما ما يقصده المحدثون بالميتافيزيقا في العلوم الحديثة فما هي إلا أمور تتعلق بالطبيعة وهي فرضيات خيالية، وأصبح انشغال الفلاسفة المحدثين هي إيراد المشكلات والتصورات العقلية حولها أكثر من الاهتمام بحلها. تلك الرغبة المشوشة في البحث من أجل البحث بمعنى آخر هي الحركة التي لا هدف من ورائها.
ويحرص هؤلاء الفلاسفة أن ترتبط أسماؤهم بحركات وأفكار معينة أو نظريات لا تُنسب إلا إليهم وإن كان ذلك على حساب الحقيقة.
ثم كانت نشأة المذهب العقلي (العقلانية) على يد ديكارت، ولكن سرعان ما أخذ العقل نفسه في التنازل لصالح التطبيقات العملية ؛ فقد أفضت العقلانية إلى المذهب الطبيعي، ثم مذهب النسبية سواء نسبية على يد كانط أو وضعية على يد كونت، ثم مذهب التطور والحدث الحسي.
ثم لم يلبث أن ابتعد الأمر عن كونه حديثا عن الحقيقة ليصبح حديثا عن الواقع، وإلى انحسار الفكر إلى قسمه الأدنى، فغدا إعمال العقل مقصورا على تشكيل المادة من أجل استخدامها في الصناعة، ليسود الإنكار الكلي للفكر والمعرفة، ومن ثم إحلال المنفعة محل الحقيقة وهو ما اضطلعت به البراجماتية أو الذرائعية، وكان ذلك إيذانا بالتدهور الكامل لكل تدرج هرمي طبيعي.
وعلى صعيد المجتمعات فإن الابتعاد نفسه عن العلوم الربانية أفضى إلى تدهور الأخلاق، وهو ما أصبح معروفا بأخلاق العلمانية. وبما أن الدين من العلم الوهبي فإن الروح المناهضة لهذا العلم تناهض الدين وتحرفه، ومن صورها الحركة البروتستانتية التي كان من أهم مبادئها “أنسنة” الدين، ثم تحورت لتصبح أقرب للإنكار الكامل منها إلى المسيحية الحقة. ثم ظهر “مؤرخو الأديان” الذين يحاربون بالنقد الهدام الأديان قاطبة.
ولم يبق من الروح الرباني في الغرب إلا ما بقي في الكاثوليكية، ولكن هل معنى هذا أنها حافظت على العلم الوهبي حفاظا كاملا؟ للأسف لا. ولم يعد للدين في الغرب أي تأثير على ما بقي من مناحي الحياة التي ضُرب بينها وبينه بحجاب غليظ. أصبح هناك جهل كامل بالعقيدة، واقتصر على ممارسات عملية محضة أو عادات روتينية، فغدت العقيدة مجرد مذهب أخلاقي.
ورغم ذلك فهناك سعي دائم (للتبشير) بمفاهيم الحضارة الحديثة على يد من لا علم له بالطابع الحقيقي للعقيدة التي يظن أنه مخوَّل بتمثيلها.
ويرى جينو أن المؤهلين باسم العقيدة يجب عليهم ألا يدخلوا في جولات عقيمة مع أهل العلم الدنيوي، ولكن عليهم أن يشرحوا العقيدة كما هي لمن يستطيعون فهمها وأن يشجبوا الأخطاء أينما وُجدت، مصوبين نحوها شعاعا كاشفا من المعرفة الحقة، فليس من شأنهم خوض صراع يُنال فيه من العقيدة.
ولكن للأسف لم يعد ذلك واقعا، فالناس لم تعد تعترف بأي سلطة شرعية (روحية)، و(أهل الدنيا) يستبيحون النقاش بشأن المقدسات، والاعتراض على طابعها بل على وجودها نفسه.
الفصل السادس : الفوضى الاجتماعية
يتأثر المجال الاجتماعي بالمبادئ ولا يمكن البدء بإصلاحه أولا لأنه تابع لها.
بعيدا عن الطبقات الاجتماعية، يتناول الكاتب الطبقة بمعناها الرباني وهي الملكات الخاصة التي تهيىء كل إنسان للقيام بهذا العمل أو ذاك، ومتى كان تولي الأعمال غير خاضع لأي قاعدة مشروعة فإن النتيجة اللازمة عن ذلك أن يشتغل كل أحد بما شاء وبما لا يحسن في الغالب.
ويتطرق إلى مبدأ المساواة ويرى أنه مبدأ زائف لأنه مبني على إنكار الفروق في طبائع الناس و(طبقاتهم) أو دمجها. وبناء عليه فإن هذه الفرضية العبثية (أن الناس كلهم متشابهون تشابها تاما ومتساوون تماما)، التي فرضها الغربيون المحدثون قد فرضت وحدة شكلية في كل مكان؛ من أمثلتها التعليم الموحد كما لو كان الناس جميعا مؤهلون لفهم الأشياء نفسها.
ثم يعرض جينو فكرة التشرذم في الكثرة ويعدد لها الأمثلة، ومنها التعليم الذي يعد بمثابة مراكمة أفكار أولية غير متجانسة، غلب فيه الكم على الكيف ففقد صفة (التعلم). ويطرح التساؤل الآتي: لماذا يقبل الجميع أفكارا مثل (المساواة) و(التقدم) وغيرهما دون نقاش في الوقت الذي يُدَّعى فيه أن كل شيء خاضع للنقاش. فيراها الكاتب أفكارا زائفة لا تنتمي لمنظومة الأفكار الخالصة؛ حيث يكون للفظ فيها أهمية أكبر من الفكرة التي تفترض أنه يعبر عنها، وهو ما يسميه الكاتب (النزعة اللفظية).
ويتناول المؤلف فكرة الديموقراطية وكيف أنها تنطوي على مغالطات مستترة في المنظومة السياسية. وفي أولها أن الشعب لا يمكنه أن يمنح سلطة لا يملكها إذ أن الأدنى لا يمكنه أن يصدر عنه ما هو أعلى منه. وأن السلطة الحقيقية لا تأتي إلا من أعلى، وهي سلطة تسمو على المنظومة الاجتماعية وهي السلطة الروحية وبها لن يكون هناك اضطراب ولا فوضى، ومنذ أن تم نبذ ورفض المبدأ الميتافيزيقي في كل جوانب الحياة انتكست جميع الهرميات. ولم يبدأ ذلك إلا منذ أن استقلت السلطة الزمنية عن السلطة الروحية، ثم أخضعتها لها بدعوى استخدامها في تحقيق مآرب سياسية.
تعريف الديموقراطية بأنها حكم الشعب بنفسه لنفسه تنطوي أيضا على مغالطات حقيقية، فلا يمكن أن يكون جماعة من الناس حاكمين ومحكومين في الوقت نفسه؛ ولكن المهارة الكبيرة للقادة في العالم الحديث تتجلى في أن يحملوا الشعوب على الاعتقاد بأنه يحكم نفسه والناس يسلمون بذلك راضين.
ومن أجل خلق هذا الوهم ابتُدع (الاقتراع العام) والذي يجعل رأي الأغلبية هو الذي يصنع القانون؛ بيد أن هذا الرأي يمكن توجيهه والتلاعب به بمساعدة الإيحاء وهو المقصود بالمصطلح (صناعة الرأي)، وهو من وجهة نظر الكاتب تعبير صحيح تماما. وفي محاولة من الكاتب التأصيل لفكرة قانون الأغلبية فإنه لا يجد لها إلا بذور قانون المادة والقوة الغليظة، وهو القانون التي تسحق به كتلة ما كل ما يعترضها، وهو ما يخالف تماما النظام الطبيعي لأنه إعلان عن سيادة الكثرة وهو مفهوم وثيق الصلة بالعقلية المعاصرة ومن هنا يأتي الربط بين الديمقراطية والمادية.
ويبين الكاتب أنه ليس هناك إلا سبيل واحد للخروج من الفوضى سواء في المجال الاجتماعي أو غيره وهو إحياء الفكر الروحاني.
الفصل السابع : حضارة مادية
يرى الكاتب أن الشرقيين أصابوا عين الحقيقة حين عابوا على الغرب مادية حضارته، ومن ثم فهو يستأنف توضيح الدلالات المختلفة لكلمة (مادية): هي حالة عقلية ترتبط بكل ما يرجع للمنظومة المادية، ومن ذلك مظاهر التطور العلمي (الدنيوي) الذي لا يتعلق إلا بدراسة العالم المادي. فالمحدثون لا يفهمون من العلوم إلا تلك التي يجري فيها قياس الأشياء وإحصاؤها فهي وحدها التي يمكن تطبيق المنطق الكمي عليها؛ حتى أنهم يريدون تطبيق هذه القياسات في علم النفس مع أنه بطبيعته خارج عن حدودها. أما حديثهم عن الواقع فلا يعنون به سوى الواقع المحسوس، وأنه هو الذي من شأنه أن يرفع مكانة العلم الحديث لأن نتائجه يمكن أن تُرى أو أن تُلمس.
ويرى الكاتب أن (الذرائعية) أو (البراجماتية) هي حصاد الفلسفة الحديثة، وجوهرها هو عدم الانشغال بما ليس فيه فائدة عملية مباشرة؛ لذلك فإن هذه الفلسفات الحديثة لا ترى شيئا (حقيقيا) سوى هذا العالم المادي. ولا تُثبت من المعارف إلا ما تحصل عليه عن طريق الحواس؛ وفي هذه الظروف فإن الصناعة مجرد تطبيق للعلم ولكنها كانت سببا لوجوده والمسوغ للاشتغال به. كما يرى جينو أن الحضارة الحديثة حضارة كمية وهو مرادف لكونها حضارة مادية.
ويتطرق كذلك إلى العلاقات التجارية وأن من شأنها أن تسهم في تقارب الشعوب وتفاهمها، بيد أن ما يحدث هو العكس تماما فقد أسفر هذا التبادل عن صراعات ونزاعات لأنها في جوهر الكثرة والتقسيم. وأما عن اتجاه الشرق للصناعة فقد كان لمواجهة هيمنة الغرب ولم يكونوا هم من سعوا إلى الصراع في هذا الميدان. وكان من النتائج المباشرة للتطور الصناعي في الغرب هو تطوير آلة الحرب وزيادة قوتها التدميرية بقدر هائل.
ورغم إقرار الكاتب بما للتطور من مزايا نسبية، فهو يتساءل هل جاوزت هذه المزايا مثالبه؟ فهناك الكثير مما ضُحي به من أجل الوصول لهذا التطور وأهمها المعارف العليا المنسية، والفكر العرفاني الذي تقوضت أركانه، والروحانية التي ذهبت أدراج الرياح. بهذه الموازنة سترجح كفة المثالب. ولذا فإن العالم الحديث ساع في سبيل هلاك نفسه ما بقي عاجزا عن وقف هذا السلوك. فهذا التقدم المادي لا يتيح إلا مخترعات من شأنها زيادة خطر داهم من شأنه تدمير البشرية أو تقديم مزيد من الرفاهية التي هي في حقيقة الأمر محض أوهام.
وهناك من يرغبون في الفرار من الاضطراب الحديث، ولكنهم في ظل هوس المساواة والنمطية لا يلتفت إليهم. فالغرور والمصالح الاقتصادية هي المحركات الأساسية في الغرب، ومن ثم فإن الغرب الحديث لم يسعه التسامح مع من يؤثرون قليلا من العمل ويرضون من أجل العيش بيسير من الأجر. ولهذا أصبح تقييم من يعمل عملا لا يُرى أثره أنه من عداد الكسالى. وفي الأوساط الدينية فإن الجماعات ذوات الطبيعة التأملية لا يُعقد لها وزن لأنها تهتم بما لا يُرى ولا يُحس مما يجري داخل باطن الإنسان وفكره. فلم يعد هناك مجال إلا للعمل الخارجي حتى وإن كان تافها لا معنى له؛ ومن ذلك الهوس الأنجلوساكسوني بالرياضة وتعهد الإنسان قواه العضلية؛ فالأبطال الرياضيون يثيرون الحماس الشعبي وتتأثر الجماهير بما ينجزونه، وليس من شك في أن عالما تجري فيه الأمور على هذا النحو قد سقط في الهاوية!
ثم يفترض الكاتب تبني وجهة نظر أولئك الذين يؤيدون رفاهية العيش وكل ما يقدمه التطور والتقدم الحضاري المادي، ثم يتساءل هل هم في سعادة حقيقية، أليست حياتهم أكثر اضطرابا وتعقيدا؟ ثم يؤكد جينو على أنه كلما زادت حاجات الإنسان زادت فرص عدم توفر بعض احتياجاته ويفضى ذلك إلى تعاسته. وقد احتدمت الصراعات التي يتزعمها أنصار التطور لتصل إلى رتبة القانون العلمي المسمى (الصراع من أجل البقاء).
ويرى الكاتب أن الحضارة الحديثة مهددة بالانهيار تحت تأثير الشهوات المضطربة جزاء وفاقا لإطلاقها القوى الوحشية للمادة التي هي مقابل كل ما هو روحي؛ فلو قال أحدهم أن الغرب الحديث مسيحي لكان مجانبا للحقيقة، إذ أن الغرب الحديث مناهض للروحانيات وللدين في الأساس، لأنه مناهض للروح الإلهي. وإن بقي ثمة طابع للمسيحية فما هي إلا إسمها وقشور بعيدة كل البعد عن العلوم الإلهية.
الفصل الثامن : الاجتياح الغربي
لقد ولدت الفوضى الحديثة في الغرب ولكن الخطورة الحالية هي بلوغ الفوضى بلاد الشرق. قديما كان تأثير الغرب على الشرق سياسيا واقتصاديا، أما في العالم المعاصر فقد بات التأثير على الروح الشرقي أيضا؛ وذلك على يد بعض الشرقيين الذين طوتهم عباءة التغريب، فأعرضوا عن ميراثهم الإلهي وجنحوا للضلالات العقلية الحديثة، بيد أن الكاتب يرى أن تأثيرهم ما زال محدودا. ومن سلبيات تأثيرهم أفكار القوميات في الشرق، والقومية مناهضة للروح الرباني. ومن العجيب حقا والذي يبلغ حد التناقض هو ظهور هؤلاء الذين يبذلون جهدهم في الناحية الفكرية بمظهر من يقاوم التغريب في المجال السياسي بيد أنهم لا يعولون إلا على الطرق ذاتها المتبعة في الغرب وهي الوسائل التي تتصارع بها الشعوب الغربية فيما بينها.
ويطرح جينو تساؤلات حول مصير الشرق: هل سيكون تأثره بالغرب سطحيا أم سينجرف إلى الهاوية مع الغرب الحديث؟ هو يرى أن الروح الرباني المتغلغل في الشرق بوسعه أن يبدد ظلمات العقلانية الحديثة في الغرب، ولكن قد يسبق هذا الانقشاع حقبة من الظلام الدامس. ويرى أن العالم بصدد بداية النهاية على أثر المادية المأفونة التي تطيح بكل القيم، حتى وإن توارت خلف الشعارات الإنسانية.
ويتطرق الكاتب إلى كتاب “هنري ماسيس Henri Massis” “الدفاع عن الغرب” والذي يرفض فيه تسرب أي أفكار شرقية إلى الغرب وكأنها خطر داهم، وينتقد عدة أفكار مما طرحها ماسيس في كتابه. ويوضح أنه لا أحد في الغرب قد قدم أفكارا شرقية صحيحة، وأن ما قدمه ماسيس كان منبعثا من الخوف الداخلي لديه من الانهيار الوشيك للحضارة الغربية. وأنه، جينو، هو من بوسعه تقديم أفكارا شرقية صحيحة فهو معايش لها فكريا وواقعيا.
ويتساءل: من المسئول عن عدم فهم الغربيين للشرقيين؟ وهم من ظلوا غير مبالين بهم لوقت طويل.
ويوضح مفارقات في تعامل الغرب مع الشرق؛ أحدها تتعلق باختلاف المسميات عند تعارض وجهات النظر: فحب الغربي لوطنه ومقاومته الغزو تسمى “وطنية”، في حين أن الغربيين يزعمون أن الشرقيين المدافعين عن أوطانهم في مواجهة الغزو الأجنبي يمثلون ظاهرة “كراهية الأجانب والتعصب”.
ومن جانب آخر فإن الغرب الذي يدعي الدفاع عن الحق والعدالة والحرية هو ذاته الذي يتدخل في أراضي بعيدة عن حدوده، ويفرض نفوذه وسلطانه على أراضي الشرقيين ويستغل خيراتها.
الفصل التاسع : عدة نتائج
ينبه الكاتب أن سبيله في تبيان رأيه لن يكون هو أسلوب الغربيين بتبني النظريات التحليلية والتركيبية لأن ذلك أبعد ما يكون عن التفسير الحق بشأن ما تضمنته هذه الدراسة.
ورأيه هو أن النخبة الروحية لابد أن يكون لها دور في الحفاظ على ما يجب أن يبقى في العالم الحالي ليستخدم في بناء العالم القادم. (والنخبة مصطلح صوفي يعبر به عن رجال الله أو العارفين بالله.) ولا وجود لهذه النخبة في الغرب ولكن يظل الباقي منها في الشرق، ولابد من وجودها لميراث العلم الإلهي، وإن كانت هذه النخبة في تناقص مطرد وهو ما يسبب زحف العالم الغربي على الحضارات الشرقية.
ولقد بدأ أناس في الغرب يستشعرون ما تفتقر إليه حضارتهم، غير أنه لا يمكنهم استعادة ما فقدوا من العلم الإلهي إلا بصحوة غربية باتجاه العودة مباشرة إلى ما كان لديهم، أو بالاستعانة بالمعرفة الإلهية الباقية لدى الحضارات الشرقية، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق وسطاء وهم الغربيون الذين اتجهوا للنهل من فيض العلم الإلهي لدى الشرقيين، ولا يسعهم إلا أن ينسلخوا بذلك عن غربيتهم ولكنهم يظلون على الأقل حلقات الوصل بين العالمين.
من ناحية اخرى يمكن للكنيسة الكاثوليكية أن تضطلع بمثل هذا الدور في العالم الغربي بعد أن تستلهم العلم الإلهي من العالم الشرقي، حيث إنها منظومة ما زالت قائمة بذاتها بالفعل – وإن كانت فُرغت من جوهرها، ولا تبقى قائمة في هذا الوقت إلا بالقوة- ، ولكن وجودها يعد ضامنا لاستعادة الروح الرباني في معناه الكامل.
وينبه الكاتب أنه لا يمكن تحقيق الوفاق إلا من خلال المنظومة الأعلى ومن المداخل العليا أي المدخل العرفاني أوالروحاني؛ بيد أن التبشير الغربي يعد من المعوقات لاستتباب هذا الأمر.
ويصرح الكاتب أنه لن يتوقف عن توجيه هذه التحذيرات للغرب رغم علمه أن أحدا لن يلقي لها بالا؛ وأن رؤيته هذه إنما تكونت من خلال عمله في المجال الروحي لفترة طويلة كفيلة بأن توفر له الخبرة الضامنة لصحة ما يقول. ويؤكد أنه لن يسلك أي مسلك غربي في منحاه هذا ولن يدخل في مهاترات لفظية أو فلسفية مع المعاصرين.
ومن ثم ينتقد الفلسفة التي يعتبرها مفكرو الغرب الحديث بمكانة المعارف العليا، أما هو فيرى أنها لا تعدو أن تكون ظلالا للمعرفة الحق، وأنها، أي الفلسفة، والعلم الحديث القائم على إنكار الحقائق المعرفية العليا هما الأسباب المؤدية إلى ضلال العقل المادي البشري في عصرنا الحديث.
ولا يضير قلة عدد الباحثين عن الحقيقة والمعرفة الحقة في بيئة تناهض الروحانية جملة وتفصيلا، فليس للعدد شأن كبير لأننا هنا بصدد مجال تحكمه قوانين أخرى سوى تلك التي تحكم المادة، فلا موضع لليأس البتة حتى وإن انقطع الأمل في بلوغ نتيجة واقعية قبل أن تصيب العالم الحديث كارثة، فإن ذلك لن يكون سببا كافيا لترك القيام بعمل تمتد آثاره الحقيقية إلى ما بعد زماننا.
وينهي جينو كتابه بشعار: “الحقيقة تنتصر على كل شيء.”
ملاحظات:
- يجدر الإشارة إلى أهمية الهوامش التي أوردها المترجم؛ فهي على قدر كبير من التخصص والأهمية في فهم الأفكار ومنشأها، ومن ثم فكر المؤلف ككل. كما اتضحت أهميتها في نقل تسلسل نشأة الفلسفات في العصر الحديث ونسبتها إلى أسماء أهم رموزها أو إلى جوهرها الفكري. وغير خاف ما كان لهذه الهوامش من دور في توضيح كثير من المصطلحات الخاصة بالحضارات الهندية والصينية القديمة.
- يتميز الفصل السادس المتعلق بالجانب الاجتماعي ببزوغ رؤية جينو الجديدة عن مفاهيم التقدم والديمقراطية والنزعة الفردية ونقد هذه الأفكار التي طالما تم قبولها واستساغتها دون أدنى شك أو مناقشة. فقدم لها جينو نقدا واعيا ينم عن فهم ومعايشة بدايات هذه الأفكار، كما قدم عنها طرحا جديدا قل إيجاده في غيره من الأعمال الفكرية المعاصرة.
- نلاحظ في الفصل التاسع والأخير حرص جينو على اكتساب أرض خطاب مشتركة مع الغرب عامدا إلى إيصال أفكاره إلى من يهمه الأمر منهم وذلك باستشهاده بآيات الإنجيل ليصل بهم إلى آفاق روحية مألوفة لديهم.
- لا يسعنا في النهاية إلا الوقوف على ما كتب جينو بعين التقدير، حيث أثبت مرور هذا الوقت الطويل على صدور كتابه وما يصادف اليوم من تحقق كثير مما أشار إليه من أزمات كارثية في الغرب تؤثر مباشرة على مسار الأمم والشعوب في الشرق، وما يتعرض له العالم بأسره من كوارث طبيعة واقتصادية وصحية “بما كسبت أيدي الناس” أن سبيلهم الوحيد والآمن الأكيد هو عودتهم لإرثهم الرباني في الشرق والغرب، وأن العلم الإلهي الذي حازه جينو كان له بمثابة الكاشف عن حقائق لم يقل بها غيره من مفكري عصره، فكانت الأحداث شاهدا على صدق حدسه ورهافة استشرافه لأحداث أقرها قابل عهده.
عرض:
أ. أميرة مختار
باحثة ومترجمة مصرية
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies