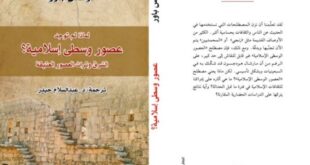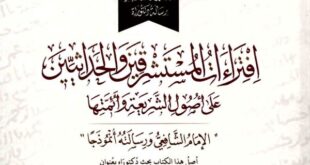العنوان: الاستشراق: المعرفة- السلطة- الإنشاء.
المؤلف: إدوارد سعيد.
المترجم: كمال أبو ديب.
الطبعة: ط. 7.
مكان النشر: بيروت.
الناشر: مؤسسة الأبحاث العربية.
سنة النشر: 2005.
الوصف المادي: 366 صفحة، 24 سم.
حينما تشرع في التعرف على حقيقة الاستشراق – معناه، ماهيته، فلسفته، أفكاره، تاريخه، رواده، سياساته، آثاره – فلن أجد لك أفضل من اللجوء إلى كتاب (Orientalism: Western Conceptions of the Orient)، المؤلَف من قبل أستاذ الأدب المقارن Edward W.Said، الصادر في نيويورك عام 1978. وهو الكتاب الذي نُقل إلى العربية على يد أستاذ الأدب والناقد والشاعر “كمال أبو ديب” تحت عنوان “الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء”، الصادر في بيروت عام 1981. بل هو الكتاب الذي لم تقتصر ترجمته على العربية فقط، إنما امتدت أيضاً إلى الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والتركية والفارسية والماليزية واليابانية.
يتميز كتاب (Orientalism: Western Conceptions of the Orient) – الصادر في نيويورك بدار نشر Pantheon Books – بالعرض الموسوعي الشامل للفكر الاستشراقي الذي عرضه علينا Said أو “سعيد” من وحي تخصصه الأدبي العميق: كيف نشأ هذا الفكر؛ كيف نما؛ كيف أثر على منطقتنا العربية؛ كيف تم استخدامه كأداة سياسية لتمكين الهيمنة الغربية على بلادنا وثرواتنا وحضارتنا وثقافتنا؛ بل كيف أثر على رؤيتنا ورؤية غيرنا لذاتنا كعرب وكمسلمين. والحق يُقال، إن النسخة العربية التي أخرجها “أبو ديب” لا تقل تميزاً عن النسخة الإنجليزية الأصلية. فالتخصص الأدبي للمترجم ساعد كثيراً على هضم واستيعاب نص “سعيد” الأدبي، ونقله إلى القاريء العربي بحرفية واضحة؛ وهو الأمر الذي جعل الترجمة ليست بالميسرة لغير المتخصص الذي سيجد صعوبة واضحة – كما وجدتُها – في فهم ذلك النص الأدبي بخلفياته ومصطلحاته الأدبية المتخصصة.
على امتداد 366 صفحة، تتألف النسخة العربية للكتاب – الصادرة عن “مؤسسة الأبحاث العربية” – من مقدمتين (مقدمة للمترجم ومقدمة للمؤلف)، وكشاف مصطلحي، وثلاثة فصول، وأخيراً فهرس يتضمن إشارات بالعربية والإنجليزية ومؤشراً. يتناول الفصل الأول “مجال الاستشراق” دائرة كبيرة حول أبعاد الموضوع كلها؛ تاريخياً وفلسفياً وسياسياً في آنٍ واحد؛ متطرقاً إلى الموضوعات التالية: 1)”التعرف على الشرق”؛ 2)”الجغرافيا التخيلية وتمثيلاتها: شرقنة الشرق”؛ 3)”مشاريع”، 4)”أزمات”. أما الفصل الثاني، فيتناول “البنى الاستشراقية وإعادة خلق البنى” مبيناً كيف تطور الاستشراق الحديث عبر وصف تتابعي زمني في خطوطه العريضة؛ متطرقاً إلى الموضوعات الآتية: 1)”حدود أعيد رسمها، قضايا أعيد تحديدها والدين المعلمن”؛ 2)”سلفستر دو ساسي وارنست رينان: علم الإنسان العقلاني والمختبر فقه اللغوي”؛ 3)”الإقامة في الشرق والبحث: متطلبات المعجمية والخيال”؛ 4)”الحج والحجاج، بريطانيين وفرنسيين”. وأخيراً، يتناول الفصل الثالث “الاستشراق الآن”، متحدثاً عن مرحلة التوسع الاستعماري الكبير في الشرق منذ 1870 والذي توج بالحرب العالمية الثانية، حيث تم الانتقال من التسلط البريطاني والفرنسي إلى التسلط الأمريكي؛ وهو الفصل الذي تطرق إلى الموضوعات التالية: 1)”الاستشراق الكامن والظاهر”؛ 2)”الأسلوب، المعرفة الخابرة، والرؤيا: دنيوية الاستشراق”؛ 3)”الاستشراق الأنجلو – فرنسي الحديث في ذروة الازدهار الحديث”؛ 4)”المرحلة الأخيرة”.
الاستشراق: ماهيته وآثاره:
ماذا يعني الاستشراق؟ هو أسلوب من الفكر، ومؤسسة للتعامل مع الشرق، وشبكة مصالح، ومشروع ثقافي بريطاني فرنسي، وبعد هام من أبعاد الثقافة السياسية الفكرية الحديثة. كل هذه التعريفات أوردها “سعيد” في مقدمة كتابه، كما نقلها إلينا المترجم “أبو ديب”.
فالاستشراق هو “أسلوب من الفكر قائم على تمييز وجودي (أنطولوجي) ومعرفي (ابستمولوجي) بين الشرق وفي (في معظم الأحيان) الغرب”. وهو “المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق – التعامل معه بإصدار تقريرات حوله، وإجازة الآراء فيه وإقراراها، وبوصفه، وتدريسه، والاستقرار فيه، وحكمه: وبإيجاز، الاستشراق كأسلوب غربي للسيطرة على الشرق، واستبنائه، وامتلاك السيادة عليه”. وهو الذي “يشكل شبكة المصالح الكلية التي يستحضر تأثيرها بصورة لا مفر منها في كل مناسبة يكون فيها ذلك الكيان (العجيب) الشرق موضعاً للنقاش”. وهو ذلك المشروع الثقافي البريطاني الفرنسي، حيث سيطرت فيه القوتان الأوروبيتان على الشرق والاستشراق منذ بداية القرن التاسع عشر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، ليتم بعدها تسليم “الراية” إلى القطب الأمريكي. إن “الاستشراق لا يمثل ببساطة بعداً هاماً من أبعاد الثقافة السياسية الفكرية الحديثة، بل إنه هو هذا البعد”.
إن الاستشراق يقوم على مقدمة أساسية تقول: “إن المستشرق يجعل الشرق يتحدث، ويجعل أسراره واضحة للغرب، ومن أجله، نيابة عن الشرق المسكين”. فالشرقيون عاجزون عن تمثيل أنفسهم، كما كتب “كارل ماركس”.
لقد احتل الاستشراق – كما أورد “سعيد” على لسان “أبو ديب” – مركزاً من السيادة على الحقل المعرفي المتعلق بالشرق لدرجةٍ أوصلت المؤلف إلى القناعة والإيمان بأنه ليس في وسع أي إنسان أن يكتب عن الشرق، أو يفكر فيه، أو يمارس عملاً متعلقاً به، دون أن يأخذ بعين الاعتبار “الحدود المعوقة التي فرضها الاستشراق على الفكر والفعل”. “وبكلمات أخرى، فإن الشرق بسبب الاستشراق لم يكن و(ليس) موضوعاً حراً للفكر أو الفعل”.
وكيف يكون موضوعاً حراً للفكر أو الفعل، وقد استحوذ عليه كُتاب أفراد، صار لهم سلطة ومرجعية تُلزمان كل من يكتب عن أو يفكر في الشرق بالرجوع إليهم والاقتباس منهم. ولعل كتاب “مسالك المصريين المعاصرين وعاداتهم” للمستشرق “إدوارد وليم لين” يمثل نموذجاً صارخاً وموضحاً لتلك السلطة المُلزمة الصارمة، والتي أشار إليها “سعيد” مراراً وتكراراً.
إن الكتاب – كما ورد في المقدمة – يستهدف تسليط الضوء على التساؤلات الآتية: كيف أسهم الاستشراق في إكساب الغرب مزيداً من القوة من خلال وضعه موضع التضاد مع الشرق؟ كيف أثرت السياسة الإمبريالية على كلٍ من: الإنتاج الأدبي، والإنتاج المعرفي، والبحث العلمي، وعملية التنظير، وكتابة التاريخ؟ كيف تأسست وترسخت البنية المتينة الصلبة للسيطرة الثقافية الغربية بكل ما تحمل من أخطار كامنة؟كيف استجاب الاستشراق للثقافة التي أنتجته أكثر مما استجاب لموضوعه المزعوم؟
وللبعد الشخصي للمؤلف باع في إخراج هذا الكتاب إلى النور؛ فـ”سعيد” – كما هو وارد في مقدمة الكتاب – هو مواطن فلسطيني، تلقى دراسته كلها في مستعمرتين بريطانيتين (مصر وفلسطين). وفي الولايات المتحدة – حيث أكمل دراسته الأكاديمية والعلمية – عاش وعاصر الاستشراق بعينه؛ وشهد بنفسه سيطرة ثقافة الاستشراق عليه وعلى حياة جميع الشرقيين من حوله. باختصار، كان “هو” الموضوع الشرقي الذي يتم اختباره ودراسته وفحصه في “المختبر” الأمريكي.
مجال الاستشراق:
يتطرق المؤلف في فصله الأول “مجال الاستشراق” إلى دائرة واسعة تشمل أبعاد الاستشراق المختلفة: 1) كيف تم التعرف على الشرق من قبل المستشرقين الأوروبيين؛ 2) كيف تم تخيل الحدود الجغرافية بين الشرق والغرب في ذهن الغرب؛ 3) كيف تم الزحف الغربي على الشرق؛ 4) كيف تم نشوء وتبلور الأزمة في الاستشراق.
كيف تم التعرف على الشرق:
بدايةً، إن معرفة الشرقيين من قبل الأوروبيين كان يستهدف أساساً تحقيق القوة للطرف الغربي. فتكوين وإنشاء معرفة أوروبية عنصرية عن الشرقيين – معرفة قائمة على التقسيم الحاد المتصلب بين الشرق والغرب – يستهدف في النهاية وضع الشرق في موضع نقصٍ ودونية، موضع يستحل ويبرر هيمنة الغرب عليه. فكل الصفات العنصرية تم إلصاقها بالشرقي، دون إعطاء أي فرصة للجدال أو التشكيك. وصار مُسلماً به أن يصير العرق الشرقي عرقاً محكوماً، لا يعرف ما هو الخير له. وإذا كانت تلك “المعرفة” الأوروبية بالشرق غير مُنظمة قبل القرن الثامن عشر الميلادي، فإنها باتت منظمة ومتنامية منذ ذلك القرن، ليصير الشرق بعدها في وضع المفعول به الذي يتم معاينته وفحصه في قاعة التدريس، كما ورد في الكتاب.
ولنأخذ على سبيل المثال، المعرفة البريطانية لمصر في رؤية اللورد “بلفور” الذي لم ينكر – في أي سياق من ضمن كتاباته – فوقية بريطانيا ودونية مصر، والذي لم يخطر على باله أبداً أن يترك للمصريين فرصة التحدث عن ذاتهم. ولِمَ لا يشعر البريطانيون الإداريون المحتلون بالفوقية، وهم يدركون جيداً أن حكوماتهم في وطنهم الأم تدعمهم وتساعدهم؟ ولم يختلف اللورد “كرومر” عن نظيره “بلفور”؛ فالإثنان كانا على يقين بأنهما قاما بانتشال مصر من “الغفلة الشرقية” إلى “نباهة شأنها الفريدة في الحاضر”.
لقد كتب المحتلون الإنجليز عن فضلهم في تحويل مصر من مثال جامعي للتخلف الشرقي، قبل الاحتلال، إلى تجسيد واضح لانتصار المعرفة والقوة البريطانيتين بعد الاحتلال. لقد رأى المحتلون الإنجليز – كما يؤكد مؤلف الكتاب – إلزامية سيطرة الغربيين على الشرقيين عبر احتلال أراضيهم، وإدارة شئونهم الداخلية بصرامة، ووضع دمائهم وثرواتهم تحت تصرف هذه الدولة الغربية أو تلك. ومن ثم، كانت معارضة “كرومر” المطلقة للقومية المصرية، معتبراً عدم أهلية العروق المحكومة لامتلاك القدرات الذاتية في معرفة ما هو خير لها.
استخدم “بلفور” و”كرومر” مصطلحات كثيرة ومميزة للتعبير عن العلاقة الشرقية الأوروبية التي كانت تقف فيها أوروبا دوماً في موقف السيطرة والقوة. فالشرقي – على حسب وصف اللوردين المعنيين – “لا عقلاني”، “فاسق”، “طفولي”، “مختلف”؛ بينما الأوروبي “عقلاني”، “ناضج”، “سوي”، “متحل بالفضائل”. وكذلك كتب “كرومر” قائلاً: “إن الدقة كريهة بالنسبة للعقل الشرقي”؛ وإن “الشرقي بوجه أو بآخر، وبشكل عام، يتصرف، ويتحدث، ويفكر بطريقة هي النقيض المطلق لطريقة الأوروبي”؛ وإن الشرقي “محاكمته العقلية من طبيعة مهلهلة إلى أقصى درجة” بينما “الأوروبي ذو محاكمة عقلية دقيقة”.
ومن الجدير بالذكر، كما يوضح الكتاب، فإن المعرفة الأوروبية بالشرق كانت معرفةً منظمة متنامية، دعمتها المواجهة الاستعمارية، واستغلتها علوم نامية مثل علم الأصول العرقية وفقه اللغة والتاريخ. هذا ما كان حاصلاً في خلال القرن الثامن عشر؛ أما مع دخول القرن التاسع عشر – ثم القرن العشرين – فقد تغير الوضع؛ إذ سيطرت أوروبا القوية على الشرق الضعيف، الأمر الذي مهد لفرضيةٍ أوروبيةٍ تقول إن الشرق بحاجة إلى “دراسة تصحيحية من قبل الغرب”؛ أي وضع الشرق في قاعة التدريس أو المحكمة الجنائية أو السجن لمراقبته ومعاينته.
صفوة القول، كما يشير الكتاب، إن المعرفة الأوروبية بالشرق كانت تنطلق من رؤية استشراقية سياسية للواقع؛ روجت للتفريق بين المألوف (وهو أوروبا، والغرب، ونحن) وبين الغريب (وهو الشرق، والمشرق، وهم). لقد خُلقت الرؤية أولاً، ثم تم استخدامها سياسياً. إن قوة الغرب وضعف الشرق قائمان في صميم الاستشراق لتقسيم العالم إلى أجزاء كبيرة عامة تتشاحن مع بعضها البعض.
كيف تم تخيل الحدود الجغرافية:
لقد أسس المستشرقون الأوروبيون معرفتهم بالشرق مرتكزين ومعتمدين على قاعدة التقسيم الحاد بين الشرق والغرب، فرسموا في ذهنهم حدوداً جغرافية مُتخيلة احتدامية بين العالمين، مما أفضى إلى تحول الاستشراق نحو شكل من أشكال البارانويا، الأمر الذي أوجد نمطاً من المعرفة، مختلفاً تماماً عن المعرفة التاريخية العادية. لقد تم حبس الشرق المُتخيل من قبل الأوروبي في حقل مغلق و”خاضع إلى نظام من الصرامة الأخلاقية المعرفية”. وكانت “المكتبة الشرقية” مثالاً عن ذلك “الحقل المغلق”؛ تلك “المكتبة” التي تحول بها الاستشراق – في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر – إلى مكتنز علمي بحثي واسع فيما يخص الإسلام والصين والدراسات الهندو أوروبية.
لقد أضحى الاستشراق مكتنزاً علمياً واسعاً؛ فكان هناك الوصف الموسوعي للاستشراق من 1765 إلى 1850، والذي قدمه “ريمون شفاب” في كتابه “النهضة الشرقية”، حيث كان الآسيوي مرادفاً للغريب المدهش، والمجهول السري. وكانت هناك الحوليات التي أُنتجت في القرن التاسع عشر، والتي كان أكثرها اتقاناً هو كتاب “جول مول” عن تاريخ الدراسات الاستشراقية. وقد كان مستشرق القرن التاسع عشر إما باحثاً مختصاً بالإسلام أو الصين أو الدراسات الهندو أوروبية، أو متحمساً موهوباً مثل “غوته” في “الديوان الغربي الشرقي”، أو كلا هذين مثل “فريدريك شليغل”.
إلا أن كل ذلك “المكتنز العلمي الواسع” كتب عن الشرق في نطاقٍ محدود؛ نطاق حدده الغرب في ذهنه؛ فوضع الحدود الجغرافية، مُقراً باختلاف أرض الشرق وعقليته؛ فيصير الشرق (هم) بمقتضى ما يفعله الغرب (نحن)؛ وتصير آسيا تتكلم “عبر الخيال الأوروبي وبفضله”، كما يؤكد المؤلف.
لقد كان الشرق – خاصة الشرق الأدنى – مُتخيلاً في صورةٍ جامدة مغلقة، عصية على الكسر، من قبل الغرب؛ صورةٍ تحول الإسلام رمزاً للرعب، وتضليلاً للمسيحية. فها هي “المكتبة الشرقية” التي أصدرها “بارتلمي ديربيلو” في 1697، مُقسماً فيها التاريخ الإنساني إلى نوعين: يهودي مسيحي مقدس، وإسلامي مدنس. تلك “المكتبة” التي ظلت المرجع الرئيسي السائد في أوروبا حتى أوائل القرن التاسع عشر. تلك “المكتبة” التي قامت بتوثيق الشرق بصورةٍ ظالمةٍ مجحفة في أعين القاريء الغربي. تلك “المكتبة” التي مثلت أداةً أساسية لفرض تقنيات صارمة لمعرفة الشرق؛ فلا يجوز للمستشرق أن يستعين إلا بها، الأمر الذي حوَل “المسرح الاستشراقي” إلى نظام من الصرامة الأخلاقية والمعرفية.
وها هو “دانتي” الذي كتب مسرحية “الملهاة الإلهية”، والذي تخيل فيها النبي محمد باعتباره منتمياً إلى تركيب سلالي متصلب من الشرور، مما يجعله مستحقاً لدخول الجحيم؛ ثم تخيله منتحلاً لشخصية المسيح. وهكذا نرى، كيف امتدت الجغرافيا التخيلية من “جحيم” “دانتي” إلى “المكتبة الشرقية” في سبيل منح الشرعية لوصف الشرق بشكلٍ معين، وإخضاعه لمفردات متصلبة وإنشاءٍ متصلب. وكما يؤكد الكتاب، فقد بات الشرق “حقلاً مغلقاً، ومسرحاً تمثيلياً ملحقاً بأوروبا”.
كيف تم الزحف الغربي:
وقد صاحب تلك الجغرافيا التخيلية، مشاريع أوروبية ضخمة للزحف على الشرق. تلك المشاريع “الزاحفة” التي دشنت تاريخاً طويلاً من السيطرة الغربية على الشرق دون تحدٍ واضح منه إلا من قبل الشرق الإسلامي الذي كان بمثابة الإشكالية الحقيقية أمام الغرب. وكان مشروع
“نابليون بونابرت” في مصر من أهم تلك المشاريع ، حيث تم تحويلها من بلدٍ مبهم، كما ارتأى “نابليون”، إلى دائرة للمعرفة الفرنسية المُجمعة لكل ما يمت بمصر المُحتَلة فرنسياً بصلة؛ على أن يتم بعد ذلك احتواؤها واستئناس إسلامها، وجرها جغرافياً إلى داخل الغرب، كما يؤكد الكتاب.
إن “الغرب بشكل عام هو الذي زحف على الشرق، لا العكس”، كما يؤكد “سعيد” في كتابه. ولقد كان زحف الغرب متواضعاً قبل الزحف الأكبر لـ”نابليون”؛ إذ كانت جميع المشاريع الاستشراقية قبله متواضعة التجهيز. أما “نابليون” بالمقابل، فلم يكن يهدف إلى ما هو أقل من احتلال مصر بأكملها؛ وكانت تجهيزاته السابقة للحملة من الضخامة والإحكام ما جعلها تتفوق على نظيراتها. وكانت تجهيزاته متمثلةً في تسخير معرفة المستشرق الخابرة لأغراض استعمارية بصورة مباشرة.
لقد كانت مصر بالنسبة لـ”نابليون” مشروعاً اكتسب وجوداً حقيقياً في ذهنه من خلال تجارب تنتمي إلى مملكة الأفكار والأساطير المستنبطة من النصوص، لا من الواقع التجريبي. وقد اقتضى إنجاح مشروعه سيطرته “اللطيفة” على قلوب المسلمين بمصر؛ فسعى إلى إطراء دينهم، كما سعى إلى إقناعهم بأن الفرنسيين هم المسلمون الحقيقيون، متسلحاً بفريق من المستشرقين والباحثين ليديروا اتصالاته مع السكان الأصليين، مستغلاً عداء المصريين للمماليك. باختصار، لقد شن “نابليون” حرباً فريدةً على مسلمي مصر؛ فريدة في انتقائيتها ولطفها، كما يشير “سعيد”.
وقد أوجد “نابليون” أدوات عديدة لتعينه على تلك المهمة. فكان إنشاؤه لـ”معهد مصر” الذي كان مسئولاً عن تسجيل حملته الفرنسية على مصر في صورة أرشيفية، وفي صورة دراسات حول كل الموضوعات المختلفة. لقد كان “معهد مصر” اللواء “المتفقه من ألوية الجيش” الذي كان مسئولاً عن صياغة مصر في الفرنسية الحديثة، وتحويل مصر من بلدٍ مبهم يصيغه بعض الرحالة إلى بلدٍ مفتوح، في متناول التحليل المتقصي الأوروبي. وكذلك كان إصداره لكتاب “وصف مصر” الذي سجل كل ما شوهد ودُرس في أثناء الحملة الفرنسية؛ وهو ما تم طبعه في 23 مجلداً ضخماً، فيما بين عامي 1809 و1828.
لقد اقتلع “نابليون” بهذا الكتاب التاريخ المصري أو الشرقي ليلحق مصر بتاريخ أوروبا؛ وأضحى “وصف مصر” النمط الأعلى لجميع الجهود التالية التي بُذلت لتقريب الشرق من أوروبا، ومن ثم لامتصاصه نهائياً، وإلغاء أو على الأقل إخضاع غرابته وتخفيفها. وفي حالة الإسلام بالذات، إخضاع “عدائيته” – كما يراها الغرب – وتخفيفها. لقد كان “وصف مصر” الأداة التي استخدمها “نابليون” للاحتواء الاستشراقي الصرف لمصر، من خلال استخدام القوة والمعرفة الفرنسيتين؛ وكذلك أداة لإظهار كيف كانت مصر “مسرحاً لمجده”.
إن زحف “نابليون” على مصر، بتلك الحملة المعرفية الثقافية الضخمة، يعكس مدى قوة المعرفة الأوروبية المتقنة بالشرق، وسيادتها عليه. تلك المعرفة المُجمعة من خلال الاحتلال الفرنسي، والتي أجلها “نابليون”، فأسماها “إسهاماً في نمو المعرفة الحديثة”، في حين لم يكن السكان الأصليون المصريون قد استشيروا أو عوملوا إلا بوصفهم ذريعة لخلق نص لا يعود بالفائدة عليهم.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك الحملة الفرنسية لم تنتج فقط عملاً فنياً أو نصياً، بل أيضاً أنتجت مشروعاً عملياً متمثلاً في كتاب “أرنست رينان” تحت عنوان “النظام لمقارن والتاريخ العام للغات السامية”، المُنجز عام 1848، والذي كان نواةً أساسية لمشروع قناة السويس على يد “فردينان دوليسيبس”، واحتلال انجلترا لمصر عام 1884. إن فكرة قناة السويس، كما يؤكد المؤلف، هي الخاتمة الطبيعية والمنطقية للفكر الاستشراقي. “لقد دمر دوليسبس وقناته أخيراً نأي الشرق وحميميته المتشرنقة بعيداً عن الغرب، وغرابته المدهشة الصلدة”. لقد أصبح الشرق، بعد حفر قناة السويس، يُتحدَث عنه باعتباره عالم الغرب، أو عالم “واحد” متواشج مترابط. لقد أضحى الشرق مفهوماً إدارياً أو تنفيذياً؛ “لقد أذاب دوليسبس الهوية الجغرافية للشرق بجر الشرق (بالمعنى الحرفي تقريباً) إلى داخل الغرب”.
كيف تم نشوء الأزمة:
إلا أن الشرق الحديث – وهو شرق القرن التاسع عشر والقرن العشرين – لم يصبر طويلاً على ذلك “الاحتواء” و”الاستئناس”…فثار ضد الاحتلالين البريطاني والفرنسي، وناقض النصوص الاستشراقية التي طغت على الرؤية الغربية للشرق طيلة قرون عديدة. باختصار، لقد وقف الشرق الحديث – كما ورد في الكتاب – مقاوماً ومتحدياً لطغيان الموقف النصي الاستشراقي. ومن هنا ظهرت أزمة الاستشراق، وظهرت محدوديتيه وجهله بثقافة الآخر. كذلك تمثلت أزمته في تحوله من الإنشاء البحثي التأملي إلى مؤسسة إمبريالية (نابليون، بلفور، كرومر، دوليسبس) تستهدف إخضاع الشرق كله للتمركزية الأوروبية في مجال العلوم الإنسانية.
لقد تمثلت الخيبة والأزمة لدى المستشرقين حينما ثار الشرق الحديث؛ حينما ظهر شرق جديد سياسي ومسلح؛ شرق مناقض لما صورته نصوص الاستشراق على مدى قرونٍ من الزمان. لقد ثار الشرق الحديث ضد إمبريالة المستشرق الغربي الذي ربط نفسه برجل الدولة الغربي ليحقق أجندته السياسية الاستعمارية. ثار ضد تلك الوحدة المطلقة بين مجال الاستشراق ومجال الإمبراطورية. لقد خرج الشرق الحديث عن سكوته وصمته، وهو ما شكل صدمة للمستشرقين.
وقد تناول “أنور عبد الملك” الحديث عن تلك الأزمة، فيما بين القرنين الثامن عشر والعشرين، كما يوضح الكتاب. فأشار إلى التمركزية الأوروبية في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية فيما يتعلق بالشعوب غير الأوروبية. وهي التمركزية التي رافقها تمركزية الأقليات المالكة في أوروبا – التي كشف عنها النقاب “ماركس” و”انجلز” – كما رافقها التمركزية الإنسانية التي فككها “فرويد”.
ويمضي “عبد الملك” موضحاً أن الأزمة لم تقتصر فقط على حركات التحرير الوطنية في الشرق التي “عصفت بتصورات المستشرقين عن شعوب محكومة سلبية” بل امتدت إلى المختصين والجمهور الغربي الواسع الذي أصبح واعياً بالمسافة الزمنية بين علم الاستشراق وموضوع الدراسة، بل بين التصورات والمناهج وأدوات العمل في العلوم الإنسانية وتلك التي استخدمها المستشرقون.
لقد أظهرت تلك الأزمة قصور الاستشراق، وتجاهله للثقافات الأخرى، وتعريته لها من إنسانيتها، ومعاينته الضحلة للشرق باعتباره شيئاً ثابتاً في الزمان والمكان….من أجل عيون الغربي الذي هو المشاهد وهو الحكم في نهاية الأمر. “ينبغي أن نرى في نهاية الأمر القيم الإنسانية التي بترها الاستشراق بطبيعة مجاله وتجاربه وبناه”.
البنى الاستشراقية وإعادة خلق البنى:
في الفصل الثاني “البنى الاستشراقية وإعادة خلق البنى” قام المؤلف بالتطرق إلى مسألة تطور الاستشراق الحديث. كيف تطورت الرؤى والأدوات الاستشراقية؟ كيف تم علمنة الجوانب الأساسية لنظرية الاستشراق؟ كيف أضحى المستشرق الحديث معتبراً نفسه منقذاً للشرق من مطاوي الإبهام؟ كيف صار المستشرق الحديث ينظر إلى الشرق باعتباره ميتاً مهملاً تمهيداً لما ستفعله جيوش الغرب به؟
باديء ذي بدء، فقد اعتمدت البنى الفكرية والمؤسساتية للاستشراق الحديث، في القرن الثامن عشر الميلادي، كما يشير الكتاب، على أربعة عناصر أو تيارات فكرية. أولها تيار “التوسع”، إذ تم توسيع الشرق إلى مدى بعيد، خارج نطاق العالم الإسلامي، نتيجةً للاستكشافات الأوروبية المستمرة والمتزايدة. تلك الاستكشافات (الهند، الصين، اليابان) التي وضعت أوروبا بثبات في المركز الامتيازي، بصفتها المراقب الرئيسي. ثانيها تيار “التصنيف”، إذ تم النزوع إلى تصنيف الطبيعة والإنسان في أنماط؛ فالأمريكي “أحمر، سريع الغضب، منتصب”؛ والإفريقي “أسود، لا مبال، خامل”؛ والآسيوي “أصفر، سوداوي، متصلب”. ثالثها تيار “المجابهة التاريخية”، حيث تمت المجابهة مع الثقافات غير الأوروبية، مما جعل أوروبا تتفهم العلاقة الموضوعية بينها وبين حدودها الزمانية والثقافية التي لم يكن يمكن الوصول إليها قبل ذلك؛ الأمر الذي ساعد على تليين الذات والهوية الغربية. رابعها وآخرها تيار “التعاطف”، حيث تم النزوع العام والصريح نحو الرومانسية بعد عقلانية عصر التنوير، والتفكير في إنقاذ مستقبل التاريخ الإنساني والمصير الإنساني. وكان مثالاً على ذلك، الدعوة إلى ابتعاث آسيا من أجل تحقيق النضارة والحيوية في أوروبا، وهزيمة المادية والآلية في الثقافة الغربية.
كان المستشرق الحديث يرى نفسه مسئولاً عن إعادة اللغات الشرقية الضائعة، وإعادة عادات وتقاليد الشرق، وتحديثها. باختصار، إعادة دراسة الشرق الكلاسيكي ثم نقله إلى الحداثة. وكان مثالاً على ذلك، إعادة “شامبليون” للغة الهيروغليفية القديمة بعد اكتشافه لها من حجر رشيد.
دور “دو ساسي” و”رينان” في إعادة البناء:
ومن أهم مبادري ورائدي الاستشراق الحديث – كما يوضح المؤلف – هما: “سلفستر دو ساسي” و”ارنست رينان”. فأما “ساسي”، فقد تميز بمسحه الكامل للمباديء الاستشراقية العامة، وتقديمه مختارات ومقتطفات من الأمثلة المُختارة عن الشرق إلى الطالب الذي لا يستطيع أن يلم بكل ذلك الشرق الثري الهائل. وطبعاً، كانت تلك المختارات تابعةً لمنهج فكري استشراقي متحيز ضد الشرق. فلنا أن نتخيل كم التشوه الفكري والمعرفي الذي أوصله “ساسي” لطالبي العلم في الغرب.
يعتبر عمل “ساسي” تعليمياً تنقيحياً تفقيهياً؛ وكان إنجازه الحق هو إنتاج حقل كامل من حقول الدراسة. حقل يمثل جسداً كاملاً منتظماً من النصوص، مع مبدأ منهجي واعٍ وانضباط بحثي واضح. وقد حمل “ساسي” مجهوده البحثي إلى طلبته وجمهوره؛ فأغلق الباب عليهم، وأخذ يشكل عقولهم بعيداً عن العالم الواسع، كما يؤكد “سعيد”. وقد استخدمت مختاراته على نطاق واسع لبضعة أجيال؛ وهي مختارات لم تكن إعباطية بل حوت في مكنونها الرقابة التي مارسها المستشرق على الشرق؛ حيث اعتبر “ساسي” الشرق شيئاً لابد وأن يُرمم.
وأما “رينان”، فقد تميز بإرسائه لمنهج فكري جديد، يتلخص في إدخال الاستشراق من مدخل فقه اللغة، وإحلاله المُختبر اللغوي محل التدخل الإلهي في التاريخ. ومن ثم، تمزيقه لفكرة السلالة الإلهية للغة والانتهاء بعلمنتها. وقد أتبع ذلك، تمييز “رينان” بين اللغات الشرقية “المتعطلة” واللغات الهندو أوروبية الحية، وكذلك تحيزه ضد اللغة السامية الشرقية، وربطه بينها وبين العرق والعقل والمزاج والطبع الشرقي. ومن الجدير بالذكر، أن “ساسي” و”رينان” – وغيرهما من رواد الاستشراق الحديث – قاما بتعزيز المعجمية والمؤسساتية الاستشراقية بهدف تكريس التفاوت بين الشرق والغرب.
كان “رينان” من الجيل الثاني للاستشراق الحديث؛ وكان دوره متمثلاً في منح التماسك والصلابة للإنشاء الرسمي للاستشراق. وقد دخل “رينان” إلى الاستشراق من مدخل فقه اللغة الذي كان يتمتع بمكانة ثقافية عالية؛ حيث قام بالتشبيك بين فقه اللغة والثقافة الحديثة. إن اتجاه “رينان” إلى البحث العلمي من خلال فقه اللغة كان ناتجاً عن الأزمة الإيمانية التي تعرض لها، والتي انتهت بفقدان إيمانه بالمسيحية. وبناءً على ذلك، أسس فكرة المختبر فقه اللغوي، مفترضاً أن اللغات المقدسة لم يكن لها مصدر إلهي؛ وهو ما أسماه “فوكو” اكتشاف اللغة؛ أي أن اللغة باتت حدثاً علمانياً، منحياً أي تصور ديني عن كيفية منح الله اللغة للإنسان في الجنة.
اعتبر “رينان” عدم المساواة بين الشعوب، والسيطرة من قبل الأقلية على الأكثرية، قانوناً طبيعياً من قوانين الطبيعة والمجتمع. كما اعتبر الساميين والسامية مخلوقات من صنع الدراسات فقه اللغوية الاستشراقية. وقد ابتدع “رينان” السامية في المختبر فقه اللغوي، حيث كانت رمزاً له للنقص والدونية. وكان من مرتكزات كتاباته أن اللغات الشرقية غير عضوية، ومتعطلة النمو، وغير حية. ومن ثم، كانت رؤيته للساميين بأنهم ليسوا بمخلوقات حية، بينما كانت رؤيته للهندو – أوروبيين بأنهم مخلوقات حية نسبة لحيوية وعضوية اللغات الهندو – أوروبية، كما يقول المختبر فقه اللغوي. صفوة القول، إن اللغة والثقافة بالنسبة لـ”رينان” هي مخلوق يتم خلقه في المختبر، وعلى يد فقه اللغة. وقد خلق “رينان” وشائج معقدة بين الاستشراق وموضوعه الإنساني المزعوم (المختبر فقه اللغوي)؛ وشائج مبنية على القوة لا على الموضوعية المتجردة بحق، كما أوضح الكتاب.
وهكذا نرى، كيف تم علمنة وإعادة تشكيل البُنى الاستشراقية تحت تأثير فروع الدراسة مثل فقه اللغة. بل كيف تم استبناء لغة شرقية ميتة مهملة، وبالتالي شرق ميت مهمل، تمهيداً وتبريراً لما ستفعله الجيوش والإداريون والبيروقراطيون الغربيون مع الشرق… في مرحلةٍ تالية.
إقامة المستشرقين في الشرق:
إن المستشرقين الذين أقاموا في الشرق – أمثال “دو ساسي” و”رينان” – كانت لهم حياة خاصة؛ حياة كلها امتيازات. ولِم لا وهم يعيشون في وسط المحتلين العسكريين من بني جلدتهم؛ وكذلك في وسط رجال الاقتصاد والثقافة الذين يمثلون أطماع أوطانهم الأم؟ وقد أفضى ذلك إلى إيجاد صبغة كتابية معينة لدى المستشرق المقيم في الشرق؛ صبغة متأثرة بتلك “الحياة” المميزة الفوقية. فانصبت جميع الثمرات البحثية، لتلك الإقامة، في التراث الكتبي للمواقف النصية التي عهدناها لدى “ساسي” و”رينان” اللذان أقاما مكتبةً ضخمةً من الكتابات الاستشراقية، لا يمكن لأحد أن يتجاهلها.
لقد نجح المستشرقان المقيمان بالشرق – كما يذكر الكتاب – في خلق جسد استشراقي من النصوص باستخدام مصطلحات مهنية، طغت على الإنشاء الكتابي المتعلق بالشرق، مما أكسب الشرق هويةً إنشائيةً جعلته غير مساوٍ للغرب، الأمر الذي يضطرنا إلى التأمل في عملية “التعزيز المعجمية والمؤسساتية” التي يتصف بها الاستشراق.
لقد قاما المستشرقان المعنيان – من خلال معايشتهما لحياة الشرقيين – بتدجين المعرفة عن الشرق، ثم تقديمها للعقول الغربية. فنقلا تلك المعرفة عبر تصنيفات ومعاجم وكتب نحو وتعليقات وترجمات، شكلت جميعها صورةً للشرق من أجل الغرب. وكان من ضمن عناصر تدجين تلك المعرفة، تحيزهما الواضح ضد السامية الشرقية التي لم تصل أبداً – في منظورهما – إلى”مشارف السمو التي وصلتها العروق الهندو – جرمانية”؛ وكذلك تحيزهما الصريح ضد العرق السامي الذي وصفاه بكونه بسيط وغير مكتمل؛ ازدهر في عمره الأول لكنه لم يستطع بعدها الوصول إلى درجة البلوغ الحق. فالشرق بالنسبة لهما غير نامٍ في انسانيته، مضاد للديمقراطية، متخلف، بربري. “وهكذا صارت المقارنية في دراسة الشرق والشرقيين مرادفاً لانعدام المساواة الوجودية الواضح بين الغرب والشرق”. “وهكذا فقد كرست مهنة الاستشراق ذاتها هذا التفاوت والمفارقات الضدية الخاصة التي ولدها”. باختصار، لقد اختزل المستشرقان الشرق إلى “شيء من التسطيح الإنساني”.
وعلى الرغم من وجود مستشرقين قد تخصصوا في الأدب الاستشراقي – المبني على الإقامة بالشرق والشهادة الشخصية – فإن عدم التزامهم بـ”العلم الاستشراقي” الصارم لم يخرجهم في نهاية الأمر من بوتقة التحيز الأوروبي ومن منظور القوة الأنوية للوعي الأوروبي. إلا أن البون بين المستشرق الأديب والمستشرق العلمي لا يمكن تجاهله. فالصراع لا يزال قائماً بين النموذجين، كما يفيد المؤلف. فنموذج الاستشراق الأدبي الساعي إلى تأكيد معرفته الأصيلة والمتعاطفة مع الشرق يتصادم مع نموذج الاستشراق العلمي الساعي بإصرار إلى التمسك بسجل محفوظات المعرفة الرسمية الأوروبية بالشرق. ويعد “ريتشارد بيرتين” مثالاً عن النموذج الأول، بينما يعد “برنارد لويس” مثالاً عن النموذج الثاني الذي كان من ضمن فرضياته “العلمية” الصارمة الربط بين الشرق والجنس.
لقد أقام “بيرتين” في الشرق بهدف الملاحظة العلمية؛ لكنه لم يضحي بفرديته في سبيل تحقيق هذا الغرض. إن “بيرتين” يمثل نموذج المستشرق الذي أطلق نفسه من إسار أصوله الأوروبية إلى درجةٍ تكفي لكي يعيش كشرقي؛ وهو الأمر الذي أعطاه قدرةً على الندية مع أي مستشرق جامعي في أوروبا، كما أعطاه وعياً كاملاً بضرورة التصادم مع المعلمين الرسميين الذين أداروا المعرفة الأوروبية عن الشرق بصرامة علمية.
الاستشراق الآن:
في الفصل الثالث والأخير “الاستشراق الآن” يتحدث المؤلف عن مرحلة التوسع الاحتلالي العظيم للشرق فيما بين 1870 ونهاية القرن العشرين، حيث كان الاحتلالان البريطاني والفرنسي مسيطرين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ لينتقل بعدها التسلط الاحتلالي من الأيادي البريطانية والفرنسية إلى الأيادي الأمريكية.
في المرحلة الأخيرة – منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى نهاية القرن العشرين – يشير المؤلف إلى تحولات جوهرية شهدها الاستشراق عبر قرن من الزمان. أول تلك التحولات، تحول الاستشراق من البحثي التأملي إلى الإداري الاقتصادي العسكري. فمع نهاية القرن التاسع عشر، صار هناك مشروع أوروبي ثقافي سياسي مادي صلب تجاه الشرق؛ ولاسيما تجاه إفريقيا بعد أن كان متجهاً نحو آسيا؛ حيث بات هناك تدافع احتلالي بريطاني فرنسي نحو إفريقيا، تضاءلت على أثره المسافات بين الشرق والغرب؛ وتم تباعاً التحول التدريجي من المذهبيات الجامدة للاستشراق الكامن – الناظر إلى الشرق باعتباره منزوع الأهلية والقدرة والإمكانية – إلى مذهبيات حديثة للاستشراق الظاهر الناظر إلى الشرق باعتباره كياناً متحركاً متفاعلاً لا جامداً ميتاً كما كان يُشار إليه دائماً.
إن مطالبة الشرق بالاستقلال السياسي، منذ نهاية القرن التاسع عشر، دفع المستشرقين إلى إعادة النظر في معرفتهم الغربية بالشرق. فلم يعد الشرقي هو ذلك الرجل الكسول الصوفي – على حسب وصف المؤلف – بل صار ذلك الإنسان الدنيوي الذي يتواصل ويتفاعل مع الدنيا والعالم الأرضي. وهو الأمر الذي اضطر الاستشراق إلى تطوير أدواته لكي يتصدى لذلك الإنسان الشرقي “الدنيوي” الجديد؛ ومن هنا كان استخدام الأدوات الإدارية والاقتصادية والعسكرية. ومن هنا أيضاً، كان تحول المستشرق إلى وسيط إمبريالي، كل وظيفته هي تحقيق مصلحة الرجل السياسي الأبيض، تبعاً لنظرية الرجل الأبيض التي تفصل بين البشر على أسس عرقية. صفوة القول، إن تحديد الاستشراق سياسياً راجع إلى كون الاستشراق هو نفسه نتاجاً لقوى ونشاطات سياسية معينة.
وإذا كان الاستشراقي البريطاني يتعامل كإداري استعماري مع الشرق، حيث كان الشرق هو الفضاء الفعلي للهيمنة البريطانية، فإن الاستشراقي الفرنسي تعامل مع الشرق من منظور ثقافي بحت، كان يجذب الشرقيين الجهلة، كما أفاد الكتاب. إلا أن الفرق بين الإثنين كان، في نهاية المطاف، فرقاً في الأسلوب والأداة، ليس أكثر. فكلا القوتين العظميين، في تلك الفترة، عاينتا الشرق بوصفه كياناً جغرافياً ثقافياً سياسياً سكانياً اجتماعياً تاريخياً؛ وبأنهما تمتلكان تخويلاً تقليدياً للتصرف به وتقرير مصيره. فاستحسان السيطرة الغربية على الشرق، وحس التمايز المتحفظ بين الشرق والغرب، والتعميمات حول الشرق… كلها كانت أموراً متفقاً عليها في كلا التراثين الاستشراقيين البريطاني والفرنسي.
وكان ثمة تحول آخر، فيما بين الحربين العالميتين في القرن العشرين، حينما التقى المستشرق الأوروبي مع باحث العلوم الإنسانية الأوروبي على قضية الأزمة الثقافية التي بات يشهدها العالم منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى. وكانت أفضل الأعمال الاستشراقية، في فترة ما بين الحربين، تلك التي تقاطعت مع أفضل ما كُتب في الدراسات الإنسانية لتلك الفترة. لقد التقى المستشرق وباحث العلوم الإنسانية على قضية الأزمة الثقافية التي باتت مهددة من قبل أفكار مثل البربرية والقومية الجامحة والجدب الأخلاقي والاهتمامات التقنية الضيقة.
ثم صاحب ذلك ظاهرة الاستشراق الإسلامي الذي اعتبر الإسلام ممثلاً منحطاً للشرق، ومقاوماً لكل تغيير وتحديث. فقد عكس الاستشراق الإسلامي الكره الغريزي للشرق. وهو ما يصفه المؤلف بالتخلف المنهجي للاستشراق الإسلامي؛ إذا ما قارناه بالفروع الأخرى من الاستشراق، وإذا ما قارناه بالعلوم الإنسانية الأخرى.
وبعد حرب 1948، وقيام دولة إسرائيل، كان هناك ثمة تحول آخر وأخير، حيث أشار إليه المؤلف بـ”المرحلة الأخيرة”. ملخصه هو وقوع الاستشراق في الأيادي الأمريكية بعد تفلته من الأيادي البريطانية والفرنسية. فقد صار العربي، منذ ذلك الحين، يولى اهتماماً عميقاً في الولايات المتحدة على كافة المستويات؛ وصارت صورة العربي نموذجاً لانعدام الكفاءة من ناحية، ومصدراً للإرهاب والتخويف من ناحيةٍ أخرى. وساعد على ذلك ظهور التلفاز، لينتشر ذلك النموذج السلبي في كل أرجاء الأرض. وكانت الولايات المتحدة هي المهد والساحة لاحتضان المستشرقين الأوروبيين، وتوفير مكانة فريدة لهم، تمكنهم من نقل أفكارهم العنصرية تجاه الإسلام في الدوائر والأوساط البحثية والأكاديمية المختلفة؛ وكان “فون جرونباوم” أكثر هؤلاء المستشرقين شهرة.
لقد أسس الاستشراق الأمريكي – بعد انتصار الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية وبروزها كقطب منافس للقطب السوفيتي – المدرسة “الصلبة” التي حولت المستشرق من متقن للغات الشرقية إلى عالم اجتماع مُدرب، يطبق علمه على الشرق. وبالطبع، كانت هناك المؤسسات والمصادر الاستشراقية الأمريكية الداعمة له، والتي كان من أهمها وأبرزها مجلدا “تاريخ كامبريدج للإسلام” الصادران بلندن في عام 1970، واللذان يمثلان – كما يرى المؤلف – فشلاً فكرياً واضحاً، حيث تُركت الأفكار دون تمحيص، وحيث أُهملت المسائل المنهاجية بشكلٍ سافر. فالمجلدان يقدمان الإسلام باعتباره سرداً زمنياً تتابعياً، بلهجة رتيبة بشعة؛ دون أدنى تعرض إلى مفاهيم الصهيونية والاستعمار والإمبريالية؛ بل وصف الثورة العربية في فلسطين (1936) بأنها “قلاقل وتحريض”. الكارثة الحقيقية أن مثل هذا المصدر يشكل، منذ نشره في عام 1970، مصدراً كلياً من مصادر الاستشراق.
ولا يُغفل ما قدمه الاستشراق الأمريكي لخدمة السياسة الإسرائيلية العنصرية تجاه العرب؛ كما لا يُغفل استخفافه بالثورات والمقاومات العربية، والتهوين من شأنها، كما فعل المستشرق الأمريكي المعروف “برنارد لويس” (أبرز مستشرقي القرن العشرين)، حينما ربط بين الثورات العربية وبين الجنس في صورةٍ عنصرية مفتعلة، تفتقد إلى أبسط قواعد المنطقية والعقلانية. ولا يُغفل استخدام الإدارة الأمريكية للضغوط الاقتصادية المباشرة، وكذلك للضغوط الناعمة، لتمرير أفكارها في وسط العرب.
صفوة القول، لقد شهدت أشكال الكتابة الاستشراقية تحولاً جذرياً منذ نهاية الحرب العالمية الأولى؛ كان أهمها تحول الدراسات الشرقية من نشاطات بحثية إلى أدوات للسياسة القومية الغربية بإزاء الأمم العربية حديثة الاستقلال، والتي قد تكون صعبة المراس في عالم ما بعد الاستعمار. فقد كان على المستشرق “أن يكون دليل صانعي السياسة ورجال الأعمال وجيل جديد من الدارسين”. لقد صار المستشرق خبيراً، مؤولاً، وسيطاً، ممثلاً، عارضاً.
وما يُحزن المؤلف حقاً، هو انتقال الاستشراق – على الرغم من ضحالته الفكرية – إلى الشرق، وانتشاره في ربوعه، بل ومشاركة الشرق الحديث في “شرقنة” ذاته، الأمر الذي جعل المؤلف يطلق صرخة استغاثة – في خاتمة كتابه – يستغيث عبرها بالباحثين والدارسين العرب؛ داعياً إياهم إلى اليقظة والمقاومة من خلال دراسة التاريخ والتجارب الإنسانية بحقها، والتحرر من التجريدات المتحيزة وغير الموضوعية التي يطلقها أساتذة الجامعات، والاستفادة من ارتفاع الوعي العام للشعوب.
إطلالة..بعد قراءة الكتاب:
لقد أطلق المؤلف صرخة ضد “الانحلال الإغوائي للمعرفة”، محذراً أشد الحذر من ذلك التحدي المعرفي. وكيف لا يكون تحدياً، وقد احتل العقول والأفئدة العربية إلا القليل منهم الذين يحاولون التحرر من تلك المنظومة الشيطانية؟ إن هذا الكتاب يبرز ويُظهر تلك المنظومة التي طغت على العلم والمعرفة والوعي. إن هذا الكتاب يعكس – بحق – كيف تصير وظيفة العلم مضللة مُزيفة بدلاً من أن تكون هادية مرشدة. بل كيف تقوم مؤسسات وسياسات وقيادات – غربية وعربية – بحراسة ذلك الإضلال المُتعمَد.
ولذلك، فإنه يتحتم على كل باحث عربي يقظ – يحرص على شأن دينه وأمته وحضارته – أن يحارب ويكافح معرفياً وعلمياً ضد ذلك التدليس. يكافح بالتنقيب والتدبر والسؤال والتحقيق؛ ويقاوم بالحجة والدليل والبرهان لكشف ذلك “الانحلال الإغوائي للمعرفة”، كما أسماه “سعيد” وترجمه “أبو ديب”. إن كشف الزيف المعرفي هو الطريق الموصل للحق والحقيقة؛ وطالما أدرك المرء الحقيقة صار أقدر على السعي بوعي ويقظة، ومن ثم أقدر على مقاومة الظلم والاستبداد.
عرض:
د. شيرين حامد فهمي
دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies