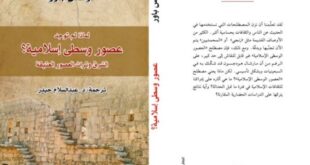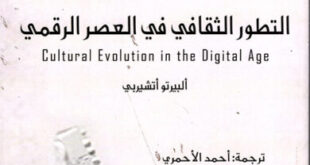المؤلف: زيجمونت باومان.
ترجمة: حجاج أبو جبر.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: بيروت.
تاريخ النشر: 2018.
الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
الوصف المادي: 109 ص. ، 24 سم.
الرقم الدولي الموحد : 4-168-431-614-978.
يتكون كتاب “الثقافة السائلة” على كلمة قصيرة للمترجم ثم ستة فصول، وأخيراً تأتي المراجع.
كلمة المترجم أ. حجاج أبو جبر:
بدأ المترجم كلمته بعرض مختصر جامع لفكر طه حسين في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر”، فيرى المترجم أن طه حسين قد لعب دور “المثقف” بالمعنى الأوروبي، فهو مثقف عصر التنوير الذي يرى بناء “الجماعة المتخيلة” عبر التعليم المدني الموحد. وقد ارتبطت فكرة التثقيف في السياقات الغربية بفكرة القدرة على تغيير كل شيء والاعتقاد بأن نموذج الكمال الأمثل قد تم اكتشافه في أوروبا، وأن على بقية العالم الاحتذاء به، وهذا ما يسمى “المركزية الأوروبية” الذي آمن بها طه حسين. فطه حسين لم يقدم نموذجاً ثقافياً بديلاً، وكان يرى إمكانية بناء “ثقافة صلبة” تقوم على الهوية القومية والمصلحة الوطنية والمنافع العملية تحت إدارة الدولة القومية الحديثة، باعتبارها المسؤول الأول والأخير على تكوين العقلية المصرية من أجل تحقيق الديمقراطية والحفاظ على الاستقلال.
وقد دعت هذه الثقافة الصلبة الى فصل الدين عن الدولة، ووضعت الدولة-الأمة في مركز الوجود، وأكدت مركزية الإنسان في صنع هذا العالم، وآمنت بأن الحضارة هي نتاج المادة والروح والفعل والتفكير والإنتاج، فهي ليست ثقافة مادية خالصة، بل هي دين بديل يؤمن بتضحية الإنسان، لا في سبيل الله، بل “في سبيل تقدم العلم وبسط سلطان العقل على عناصر الطبيعة الجامحة”، وهكذا قامت “الثقافة الصلبة” عند طه حسين على فكرة التقدم الذي يتحقق بمركزية الدولة والإنسان المنتج والتعليم المدني الخالص.
هذا الإيمان الراسخ بمشروع التنوير الثقافي مر بتحولات مهمة خلال العقود الماضية التي شهدت ظهور العولمة والتمركز حول السوق والنزعة الاستهلاكية وانتشار النزعة الفردية وانسحاب الدولة من أدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما مهد الطريق الى انتقال الثقافة من مرحلة الصلابة الى مرحلة السيولة.
الفصل الأول
عن الجولات التاريخية لمفهوم الثقافة
في هذا الفصل تطرق الكاتب الى مفهوم النخبة الثقافية من خلال آراء مجموعة من المفكرين، فالفن الراقي والأعمال الفنية بغرض الاستهلاك الجمالي كانت تُبرز فيما سبق الفروق الطبقية وترسم الحدود بين الطبقات وتعززها، فمن يجدون معاني جميلة في الأشياء الجميلة هم المثقفون، وهم الصفوة الذين يقررون ماهية الجمال، كما يرى “أوسكار وايلد”. إذن كان يُنظر للثقافة باعتبارها مجموعة من الاختيارات يعتبرها مؤلفوها “قوةً محافظةً من الناحية الاجتماعية”.
أما الآن فلم يعد من الممكن تمييز النخبة الثقافية بسهولة عن غيرها في السلم الثقافي وفق السمات التقليدية: كالحضور المنتظم للأوبرا والحفلات الموسيقية، والحماس لكل “فن راقِ”، واحتقار ذوق الإنسان العادي. إلا أن هذا لم يمنع من وجود أناس يراهم المجتمع نخبة ثقافية، ولكن على العكس من النخب الثقافية في الأيام الخوالي هم ليسوا “جهابذة الذوق الرفيع”، بل يمكننا أن نصنفهم باستخدام مصطلح سكًّه “ريتشارد بيترسون” بأنهم “اّكلو كل شيء”. وقد لخص “بيترسون” هذا الأمر بأننا نرى تحولًا في السياسة الجماعية النخبوية من أصحاب الثقافة الرفيعة الذين أصبحوا يستهلكون في شره نطاقاً واسعًا من الأشكال الفنية الشعبية والراقية. وهذا يعني التهام كل شيء، وعدم الحرمان من أي متع.
يرى باومان أن هناك فوائد للجمال وحاجة اليه، وهي ليست حاجة ثقافية بالضرورة، ولكنها أيضاً اجتماعية، ولذلك فإن التمييز بين الجمال والقبح، والرقي من السوقية ستدومان ما بقيت الحاجة والرغبة في تمييز المجتمع الراقي عن العوام والغوغاء. إلا أن الغرض من “الثقافة” وفق مفهومها الأصلي –كما يؤكد باومان- لم يكن غرضاً تمييزياً للحفاظ على الوضع القائم بين طبقات المجتمع ولكن كان الغرض منها أن تكون شعاعاً للتنوير يصل الى خبايا المدينة والريف ليقضي على التخلف والخرافة،عاملًا للتغيير، وعاملاً لتعليم العوام والارتقاء بعاداتهم ولقيادة التطور الاجتماعي. فدخول “الثقافة” قاموس المفردات الحديثة كان بمثابة إعلاناً للنيات ودعوة للفعل وإسماً لرسالة لابد من القيام بها. إن مشروع التنوير استخدم الثقافة كأداة أساسية في بناء أمة ودولة، وفي الوقت نفسه استأمن الطبقة المتعلمة على هذه الأداة.
في السياق ذاته، تحدث “باومان” عن قيام الدولة بتأسيس شبكة واسعة من المؤسسات الإدارية ذات الروتين البيروقراطي وكان المنتج المطلوب منها هو تحويل عامة الناس الى كيان مدني، فتحولت الثقافة من أداة تغيير الى أداة تحافظ على التوازن والاتجاه.
ثم انتقل الكاتب لنقطة أخرى حيث تناول إشكالية ازدياد أعداد الناس في الدولة مما أسفر عنه فائض بشري متزايد، الأمر الذي دفع الأمة للبحث عن أرضِ جديدة فيما وراء حدودها لاستيعاب الفائض البشري الذي لم تعد قادرة على استيعابه داخل حدودها. واتضح أن استعمار الأراضي هو باعث قوي على فكرة التنوير الذي تقوم به الثقافة، وهنا تشكل مفهوم “رسالة الرجل الأبيض”، و”انقاذ البرابرة من حالتهم البربرية”، وسرعان ما اكتست هذه المفاهيم صورة نظرية ثقافية تطورية ارتقت بالعالم المتقدم إلى مرتبة الكمال، وأسندت إليه تحويل بقية سكان العالم إلى هذا “الدين الجديد”. وهكذا تم اختزال مفهوم الثقافة في الدور الذي ستلعبه النخبة المتعلمة في البلاد المستعمَرة للارتقاء بالشعوب عبر العالم.
ثم بدأت الثقافة في فقدان مكانتها وذلك بتحول الحداثة من “مرحلة الصلابة” إلى “مرحلة السيولة”، واستخدم الكاتب مصطلح “الحداثة السائلة – Liquid modernity” للإشارة إلى الشكل الراهن للوضع الحديث الذي يصفه مؤلفون اّخرون بأنه “ما بعد الحداثة – Post modernity”، أو “الحداثة المتأخرة-Late modernity، أو “الحداثة الثانية – Second modernity”، أو “الحداثة العليا -Hyper modernity”.
ويرى الكاتب أن تحول الحداثة من الصلابة إلى السيولة يعود إلى عدم قدرة أي من أشكال الحياة الاجتماعية المتتالية بأن تحتفظ بشكلها زمنًا طويلًا، تمامًا مثل المواد السائلة. “فإذابة كل ما هو صلب” كانت السمة الجوهرية المميزة للشكل الحديث للحياة. ولكن اليوم، على العكس من الأمس، لا يحل محلّ الأشكال المذابة أشكال صلبة أخرى، كما كان الوضع سابقاً، ولكن يحل محلها أشكال أخرى أكثر قابلية للذوبان.
ويعود باومان هنا ليؤكد أن الثقافة بعد أن فقدت وظيفتها بوصفها خادمة للتراتبية الاجتماعية ثم كرسالة حضارية وكأداة لحفظ التوازن في المجتمع، فإنها اليوم تقوم بالتركيز على الحاجات الفردية وحل الصراعات الفردية مع التحديات والمتاعب التي تواجه الحياة الشخصية. فالحداثة السائلة هي حرب ضد كل أدوات حفظ التوازن التي تساعد على الروتين والاحتفاظ بالقدرة على التنبؤ، وبالتالي أصبحت الثقافة السائلة تتألف من العروض المغرية والإغراءات والمفاتن وبإنتاج حاجات ورغبات جديدة والعمل على التغيُّر الدائم، فأصبحت الثقافة اليوم في خدمة السوق الاستهلاكية المتوجهة نحو حركة البيع.
فمجتمع اليوم وفقًا لـ “باومان” هو مُجتمع المستهلكين، وفيه تُظهر الثقافة نفسها باعتبارها مستودعًا للبضائع الاستهلاكية، تتنافس جميعها لجذب انتباه الزبائن المحتملين. وهكذا، فإن الاستراتيجية الأصلح والأسلم هي الاستغناء عن المعايير الصارمة والدقيقة في الاختيار والذوق، وقبول كل الأذواق بحيادية.
ويرى باومان أن إبداعات الفنانين اليوم فقدت مهامها العظيمة والجليلة، وأن هذه الإبداعات تحقق فقط الثروة والشهرة لقلة معدودة، والترفيه والمتعة الشخصية لمتابعي هذه القلة. وإن القوى الدافعة للتحول التدريجي لمفهوم “الثقافة” إلى حالته الحديثة السائلة هي القوى نفسها التي تحبذ تحرير السوق من القيود، لا سيما القيود الاجتماعية والسياسية والأخلاقية.
يصل باومان في نهاية الفصل لخلاصة مفادها بأن ليس لثقافة الحداثة السائلة شعب تهدف الى تنويره والارتقاء به، ولكن لها زبائن تغريهم. فالإغراء، على العكس من التنوير والارتقاء بالنفس، ليس مهمة واحدة ومنفصلة يقوم بها المرء مرة وللأبد، بل هو نشاط مفتوح لا نهاية له. فالاهتمام الرئيس هو منع الإحساس بالرضا، ومنع الإشباع الكامل النهائي الذي لا يترك مجالًا لمزيد من الحاجات والنزوات الجديدة التي لم تتحقق بعدُ.
الفصل الثاني
عن الموضة والهوية السائلة ويوتوبيا العصر
في هذا الفصل يعالج باومان قضية الموضة والعلاقة بينها وبين الثقافة في عصر الحداثة السائلة. ويقول الكاتب على لسان “جورج زيمل” إن الموضة لا تبقى أبدًا على حالها، إنها في صيرورة دائمة”، وأبرز سمة لها هي أن “صيرورتها” لا تفقد شيء من قوتها الدافعة ولا من طاقتها، بل إن هذه القوة الدافعة تزداد مع تأثيرها على متابعيها. ويشير زيمل الى أن الحركة الدائمة لظاهرة الموضة تتأتى من المواجهة بين رغبتين بشريتين متعارضتان هما الرغبة في الإحساس بالانتماء داخل جماعة، ورغبة في التميز عن عامة الناس والإحساس بالفردية والأصالة. إذن هو تقابل بين حلمين: حلم الانتماء وحلم الاستقلال. ويشير زيمل إلى أن “الموضة هي شكل من أشكال الحياة الباحثة عن حلًّ وسط بين نزعة نحو المساواة الاجتماعية ونزعة نحو الانفصال والتميز الفردي”. وهذا الحل الوسط لا يمكن أن يكون “حالة دائمة”، فلا يمكن تثبيته مرة واحدة وللأبد، بل هو حل مؤقت.
ويرى باومان أن في كل حقبة من حقب التاريخ، وفي كل أرض من العمران البشري، وفي كل ثقافة، لعبت الموضة دور إحدى عجلات التقدم، هذا التقدم الذي يُشير إلى عملية متواصلة تحدث من دون اعتبار لرغباتنا وبعدم اكتراث بمشاعرنا، عملية تتطلب قوتها المتواصلة المسيطرة استسلامنا الوديع وفقًا لمبدأ “إذا لم يكن بوسعك أن تهزمهم فانضم إليهم”. وبالتالي فإن التقدم وفقًا للمعتقدات التي غرستها الأسواق الاستهلاكية تدفع الى ضرورة “اللحاق بركب التقدم” أو “الاخذ بأسباب التقدم”. ووفقًا لـباومان يأتي الحديث عن التقدُّم محاولة بائسة لعدم السقوط خارج مسار السباق واجتناب عدم التأهل والإقصاء من السباق، ولا يأتي الحديث عن “التقدُّم” في سياق الارتقاء بمكانتنا، بل في سياق اجتناب الفشل.
وهنا يربط باومان بين الموضة والثقافة، فيوضح أن السوق الاستهلاكية تقوم بجهود كبيرة لتمكين الثقافة من الخضوع لمنطق الموضة، وهي منطق التغيير المتواصل في الهوية، فالنموذج الشخصي في البحث عن الهوية يصبح نموذج الحرباء، ويأتي منطق التغيير والتركيز على نبذ الأشياء مناسباً تماماً لمنطق الاقتصاد الاستهلاكي.
وينهي باومان الفصل بالقول إن هذه هي يوتوبيا الحداثة السائلة، يوتوبيا الحياة المتمركزة حول الموضة المراوغة دوماً، فهي لا تمنح معنى للحياة، إنها تساعد فقط على نفي الأسئلة المتعلقة بمعنى الحياة من العقول، لقد حولت رحلة الحياة الى سلسلة لانهائية من الهموم المتمركزة حول الذات، فلا مجال لتأمل الاتجاه وتدبر معنى الحياة.
الفصل الثالث
الثقافة: من بناء الأمة إلى العولمة
في هذا الفصل تطرق الكاتب للحديث عن سقوط معالم المشهد الثقافي التي كانت سائدة في عصر الحداثة الصلبة، والتي كانت تتميز بمؤسسات ذات قدرة على حفظ الاستقرار والتوازن، ذلك السقوط الذي جاء نتيجة العولمة والحداثة السائلة. وتطرق باومان هنا الى جانب واحد من الجوانب الوخيمة الناجمة عن العولمة، وهو الطابع المُتغير للهجرة العالمية.
ثم تعرض باومان لثلاث موجات يتألف منها تاريخ الهجرة الحديثة:
- الموجة الأولى: تمثلت في هجرة ما يقرب من 60 مليون نسمة من أوروبا، وهي التي كانت المنطقة الوحيدة ذات الانفجار السكاني. وكانت هذه الهجرة تستهدف “الأراضي الفارغة”، أي الأراضي التي كان يُمكن لأوروبا القوية ذات الكثافة السكانية العالية أن تتجاهل سكانها الأصليين، أو تعتبرهم غير موجودين. وأمَّا مَن يتبقى من السكان الأصليين بعد عمليات القتل الجماعي، والأوبئة الجماعية، فيصبحون من منظور الوافدين الجُدد هدف لـ”رسالة الرجل الأبيض”.
- الموجة الثانية: مع سقوط الإمبراطوريات الاستعمارية، قام بعض السكان الأصليين الذين كانوا على قدرِ متفاوت من التعليم والتبحر الثقافي باتباع الاستعماريين العائدين إلى أوطانهم، وتحول الوافدون الجدد الى أقليات حيث تم إخضاعهم للتكيف مع رؤية العالم الوحيدة المتاحة آنذاك فيما سمي “نموذج الإدماج”، الذي جرى استحداثه في المرحلة الباكرة من بناء الدولة الحديثة، كطريقة للتعامل مع الأقليات العرقية.
- الموجة الثالثة: هذه الموجة من الهجرة الحديثة هي الاّن في أوج تدفقها وقوتها المتزايدة رغم كل المحاولات الدؤوبة لصدها، وهي تُمثل بداية عصر الشتات، إنها ستوطنات عرقية ودينية ولغوية لا تعتد بالمسارات التي حددتها الحِقبة الكولونيالية/الإمبريالية، بل سارت بمنطق إعادة التوزيع العولمي لمصادر العيش وفرص البقاء. وينتشر الشتات في أنحاء عدة من العالم من أراضِ كانت سيادية، فلم يعد يعتد بالادعاءات الوطنية أو بأسبقية الحاجات والمطالب والحقوق المحلية، ويتخبط في فِخاخ الجنسية المزدوجة (أو الجنسية المُتعددة)، بل والولاء المزدوج (أو الولاء المتعدد).
هذا وتثير المرحلة الراهنة من الهجرة علامة استفهام حول الرابطة بين الهوية والقومية، بين الجيرة المكانية والهوية الثقافية، أي بين القرب المادي والقرب الثقافي. فهذا الوضع الجديد الذي يعيشه معظم الأوروبيين أكد على أن فن التعايش مع الاختلاف أصبح مشكلة يومية، وجاءت دعوة “حقوق الإنسان” التي يجري الترويج لها هذه الأيام لتحل محل فكر ة الحقوق القومية القطرية هي دعوة للتسامح المتبادل، ولكنه لا يتجاوز ذلك الى وضع أسس التضامن المتبادل. وفي غياب التضامن المتبادل بين هذه الجماعات والإثنيات المختلفة، ينزع أصحاب القوة، إلى إقامة المتاريس بدل الجسور، متبعين النصيحة القديمة “فرِق تسُد”.
في هذا السياق، يوضح باومان أن الانتقال السكاني العالمي اليوم يتسم بأنه نطاق شاسع ومتزايد باستمرار. وتبذل الحكومات قصارى جهدها لنيل رضا الناخبين عن طريق الحد من قدرة المهاجرين على الحصول على حقوقهم في اللجوء. وتضع الحكومات خطًا فاصلاً بين المهاجرين الفقراء غير المرغوب فيهم وهجرة رأس المال والعملة والاستثمار ورجال الأعمال المرحب بهم. ولا شك أن قوى السوق التي تنعم بحرية الحركة تسهم إسهامًا كبيرًا في الحراك المتزايد للمهاجرين الاقتصاديين. والمحصلة النهائية لتلك الضغوط هي ما يسميه “باومان” النمو العالمي للشتات العرقي.
كما ركز “باومان” على حالة بريطانيا، واستند إلى دراسة لـ “جيوف دِنش” خلص فيها إلى أن كثير من الناس في بريطانيا يعتبرون الأقليات العرقية جماعات دخيلة تختلف مصائرها وولاءاتها اختلافًا بديهيًا عن مصائر الشعب البريطاني وولاءاته. كما أن مكانتهم التابعة والدونية في بريطانيا هي أمر مفروغ منه. ويؤكد باومان أن نتائج هذه الدراسة لا تقتصر على بريطانيا وحدها ولا على أقلية عرقية بعينها.
ينتقل باومان بعد ذلك إلى تقديم نقد لتوجهات اليسار الثقافي في قضية التعددية الثقافية. واعتمادًا على الفيلسوف الأمريكي “ريتشارد رورتي” يذهب باومان إلى أن الهدف الذي يحدو بالحكومات إلى الاستثمار في التفرقة بين المواطنين والمهاجرين من الفقراء هو إلهاء الشعوب وإشغالها بالعداوات العرقية والدينية، والنقاشات حول الأعراف الجنسية. فعندما يتقاتل الفقراء مع الفقراء، سيجد الأغنياء أسبابًا منطقية للابتهاج. ويلخص باومان أوجه النقد الموجهة لليسار الثقافي لحذفه من قائمة اهتماماته الاهتمام بالفقر المادي، وهو أصل الظلم. وأسهم بالتالي في تأجيج صراع الفقراء ضد الفقراء لأسباب ثقافية وهوياتية.
إن صلة هذا الوضع بمشكلة الثقافة صلة وثيقة، حيث إن النخبة المثقفة التي تطبعت بطبائع العولمة، تجاهلت هذه الحالة من الصراع والتفكك الثقافي حيث سمت اللامبالاة باسم قبول “التعددية الثقافية”، وهذا أمر طبيعي في ظل تخلف مفهوم “النموذج” الثقافي عن المشهد؛ والمهم أن لهذا مجموعة من النتائج، في مقدمتها: “الممارسة السياسية التي تشكلها هذه النظرية (التعددية الثقافية) وتؤيدها، وهي تعود إلى مبدأ التسامح الليبرالي ودعم حقوق الجماعات في الاستقلال، وحقوقها في القبول العام لهوياتها المختارة أو الموروثة، ويتمثل إنجازها في تحويل اللامساواة الاجتماعية إلى مظهر “التنوع الثقافي”، أي ظاهرة جديرة بالاحترام العالمي والعناية الدقيقة. وعبر هذا الإجراء اللغوي، يتحول القبح الأخلاقي للفقر بلمسة سحرية إلى الجاذبية الجمالية للتنوع الثقافي”.
فالتعددية الثقافية هي الإجابة التي تقدمها في أغلب الأحيان اليوم الطبقات المتعلمة والمؤثرة والمهمة سياسيًا، فهل يمكن بناء أمة بناء على التعددية الثقافية؟، يرى باومان أن الإجابة ستكون بـ (لا) لأنه مبدأ التعددية الثقافية الذي يشار إليه اليوم باعتباره حقًا من حقوق الإنسان يضع أساسًا للتسامح المتبادل، لكنه لا يتجاوز ذلك بتاتًا لوضع أسس التضامن المتبادل.
إن رأس تجليات اللايقين في الثقافة السائلة، هو غياب القيم الكلية الكبرى، وهو ما يتم تقريره عبر نظرية التعددية الثقافية. وقد أشار باومان إلى كتاب بعنوان “نهاية اليوتوبيا” واعتبره بمثابة “تحليل ثاقب لتفاهة الإعلان عن الإيمان بالتعددية الثقافية” حيث تنكشف خيانة نخبةَ المثقفين، ويظهر تخليهم عن المسؤولية تجاه أمور البشر والمشاركة في الاهتمام بها، حيث أمسوا لا رأي لهم فيما يجب أن يكون عليه الوضع الإنساني، ولا شجاعة لهم لتغيير أي شيء؛ والسر فيما يظهر من حصانة هذا الوضع وتفوقه من بين أوضاع الثقافة السابقة، هو أنه يعتبر “أيدولوجيا نهاية الأيدولوجيا”.
الفصل الرابع
الثقافة في عالم الشتات
أوضح باومان أن مفهوم “المثقفين” باعتبارهم فئةً تجمع بينهم رسالة التعبير عن القيم الوطنية وتعليمها والدفاع عنها لم يتشكل حتى فجر القرن العشرين. وقد كانت المهمة التي أُسندت إليهم في عصر التنوير واستمسكوا بها منذ ذلك الحين هي الدور النشط في “إعادة ترسيخ جذور” ما “تعرضت جذوره للاقتلاع” أو “دمج ما تعرض للإقصاء”، وقد تألفت تلك الرسالة من مُهمتين:
- المهمة الأولى: صاغها فلاسفة التنوير في زمن تفكك “النظام القديم” وضموره الذي سُمي فيما بعد باسم “النظام قبل الحديث”، وكانت تلك المهمة تتمثل في “تنوير” العامة أو “تثقيفهم” ليكونوا مواطني الدولة الحديثة، فكان هدف التنوير والثقافة هو خلق “إنسان جديد”، إنسان مجهز بمرجعيات جديدة ومعايير مرنة وبسيطة بدلًا من القواعد المترسخة التي فرضتها من قبل الجماعات التقليدية، وصارت تفقد تدريجيًا قيمتها العملية. وقد رأى رواد التنوير أن قواعد الحياة المترسخة في التقاليد كانت عائقًا لا عونًا في الظروف الجديدة، وأن هذه القواعد تحولت الآن إلى “خرافات” و”أساطير”، وأصبحت العائق الأساسي في طريق التقدم والتحقيق الكامل للقدرة البشرية، فكان من الضروري تحرير الناس من أغلال الخرافات والمعتقدات البالية حتى يمكن فيما بعد، عبر التعليم والإصلاح الاجتماعي، تشكيلهم وفق معايير العقل والظروف الاجتماعية ذات التخطيط العقلاني.
وقد اتسمت فكرة “الثقافة” عند ظهورها بثلاث سمات: (1) التفاؤل، بمعنى الإيمان بأن القدرة على التغيير في الطبيعة البشرية لا تحدّها حدود. (2) العالمية، بمعنى أن مثال الطبيعة البشرية والقدرة على استيفاء مطالبه هو مثال واحد وقدرة واحدة لجميع الأمم والأماكن والأزمنة. (3) المركزية الأوروبية، بمعنى أن المثال قد تم اكتشافه في أوروبا، وحدده هناك المُشرعَّون كما حددته طرق الحياة الفردية والجماعية، فاقترنت الثقافة في جوهرها بنشر الطابع الأوروبي.
- المهمة الثانية: أسندت للطبقات المتعلمة فهي مُهمة وثيقة الصلة بالمهمة الأولى، وهي ابتكار أبنية صلبة جديدةً تحدد إيقاعًا جديدًا للحياة، وتمنح مؤقتًا شكلًا لعديم الشكل، بعدما تحررت من أغلال التقليد. ولقد صدرت المهمة الثانية وفقًا لـ “باومان” مثل المهمة الأولى عن مشروع الثورة الحديثة، عن بناء الدولة والأمة في اّن واحد، عن استبدال كثرة واسعة نسبيًا من الجماعات المحلية ذات اللهجات والتقاليد والتقاويم المتنوعة ليحل محلها كُلٌ جديد متكامل وملتحِم. أي “المجتمع المتخيًّل” الذي تمثله الأمة/الدولة.
إن المهمتين كلتيهما اعتمدتا على توحيد لكل قوى الأمة/الدولة الجديدة، الاقتصادية والسياسية والروحية، لقد اعتمدتا على الجهد المبذول في إعادة التشكيل المادي والروحي للإنسان، باعتباره الهدف الرئيسي والموضوع الأساسي للتحول المتواصل، إضافة لتنفيذ الواجبات الجديدة والإشراف عليها بطرق أكثر دقة وإتقان بحيث تنفذ بطريقة علمية شاملة ومنظمة بدلًا من الطرق القديمة البالية، فتطلب عصر بناء الدولة والأمة تفاعلاً متبادلاً يومياً ومباشراً بين المديرين والمرؤوسين.
أما اليوم فإننا ندخل عصر فك الارتباط، فالنموذج الهادف للسيطرة مع استراتيجيته في الإشراف والمراقبة الدقيقة إنما يجري تفكيكه في كثير من بلدان العالم المعاصر، ليفسح الطريق للإشراف والتحكم الذاتيين، فالصفوف المنتظمة تفسح الطريق للأسراب. فالأسراب على عكس الصفوف المنتظمة لا تحتاج الى من يقودها، فهي تنجح في العثور على طريقها من دون تدخل من جانب القيادات وأوامرها اليومية.
ومفهوم الأسراب هو تعبير عن التعددية الثقافية، فالتعددية الثقافية هي طريقة لتكييف وضع مبدعي الثقافة مع أنماط الواقع الجديد، هي أسلوب التخلص من السيطرة واللجوء الى معنى فك الارتباط حيث تختفي القواعد التنظيمية والنماذج الموحدة لتحل محلها وفرة من الاختيارات.
ورأى “باومان” إن في رؤية العالم الجديدة لدى مبدعي الثقافة يحل المجتمع محل الإله ويتولى وظيفة مدير الشؤون البشرية والمشرف عليها. ففي هذا الزمن جاء الدور على المجتمع ليؤكد أن الإنسان قد تم تجهيزه بأدوات شخصية كافية يواجه بها تحديات الحياة ويصرف الأمور وحده. وهنا يؤكد “باومان” أن المجتمع مثل إله العصور الوسطى “لا يبالي بالخير ولا بالشر”.
ثم تناول “باومان” مفهوم “الحق في الاختلاف” في ظل التعددية الثقافية حيث من المحال الجزم بأن اختياراً ما قد يكون أفضل من غيره وبالتالي يجب الامتناع عن إصدار الأحكام على هذه الاختيارات. فعالم التعددية الثقافية يسمح للثقافات بالتعايش، ولكن لا يعين على الاستفادة من هذا التعايش والاستمتاع به. والتعددية الثقافية لا يمكن تأسيسها إلا من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل جميع الأصوات وتُعقد فيه كل المقارنات والتقابلات، فالاعتراف بالاختلاف الثقافي هو البداية وليس النهاية، وهو نقطة انطلاق لعملية سياسية طويلة، وهذه العملية السياسية يجري التعبير عنها في حوار مُتعدد بين شركاء على قدم المساواة يهدفون إلى الوصول إلى موقف مُشترك على المدى البعيد. وتلك العملية ستكون مضيعة للوقت ووصفة للإحباط إذا افترض القائمون على النقاش افتراضًا مُسبقًا بأفضلية موقف معين على المواقف الأخرى.
ويرى “تشارلز تيلور” أن الاعتراف بالقيم، أو رفض الاعتراف، هو مهمة المثقفين أو أهل العلم، وعندما يتضح لنا أننا نعلم أن ثقافة بعينها هي ثقافة قيَّمة في جوهرها، ومن ثمَ جديرة بالبقاء، عندئذِ لا ينبغي لنا أن نشك أبدًا في أن الاختلاف الذي يميزها ينبغي الحفاظ عليه من أجل الأجيال القادمة. وهنا يضيف “هابرماس” قيمة أخرى لم يذكرها “تيلور” وهي “النظام الدستوري الديمقراطي” كإطار يمكن أن يحدث فيه مثل هذا النقاش.
ويرى باومان أن عالمية حقوق المواطنين واحترامها هما شرطان أوليان لأية “سياسة اعتراف”. كما أن عالمية الإنسانية هي مقياس كل سياسة من سياسات الاعتراف. فأساس الإنسانية العالمية الحقة هو قدرتها على قبول ذلك التعدد وتسخيره قوةً للخير.
وعن رد فعل “الأقليات العرقية” أي المهاجرين، على الضغوط الثقافية المتعارضة التي يخضعون لها في البلد الذي يعيشون فيه، يرى “أمين معلوف” أنه كلما شعر المهاجرون أن تقاليد ثقافتهم الأصلية تلقى احترامًا في البلد الذي هاجروا اليه، وكلما قلَّ شعورهم بأن أهل البلد يتأففون منهم ويكرهونهم ويرعبونهم ويمارسون التمييز ضدهم ويبتعدون عنهم على أساس هويتهم المختلفة؛ زادت في عيونهم جاذبية الخيارات الثقافية للبلد الجديد، وقلَّ استمساكهم بحالة الانعزال.
ويرى “باومان” إن الشعور بالأمان في كلا الجانبين هو شرط ضروري للحوار بين الثقافات، وإذا لم يكن هناك حوار بين الجماعات الثقافية، وانقسموا بين “نحن” و “هم” تحولوا إلى هدف سهل للقوى العولمية، وهي القوى الوحيدة القادرة على الاستفادة من إخفاق البناء المشترك للجماعة الإنسانية.
الفصل الخامس
الثقافة في أوروبا باحثة عن الاتحاد
في بداية الفصل يوضح “باومان” بأن الاتحاد الأوروبي لا يهدم هويات البلدان المتحدة في إطاره، بل إنه أفضل ضمان لأمان الهوية، وأفضل إمكانية لاستمرار بقائها وازدهارها. أما العولمة فقد قوضت سيادة الدول القومية، وهدمت حصون الاستقلال الحدودي التي كانت ملاذًا للهوية وضمانًا لسلامتها، وكادت العولمة أن تهدم السيادة القومية لولا الأساس الراسخ الذي يقوم عليه التضامن في الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد وفقًا لـ “باومان” يتصدى لأثر الضغوط الشديدة التي تصل أوروبا من الفضاء الافتراضي، وبذلك يحمي الاتحاد الأمم من الاّثار التدميرية المُمكنة للعملية الناجمة عن فصل ثالوث (الأمة/الدولة/الأرض).
فبناء الأمم يهدف الى تحقيق مبدأ “بلد واحد، أمة واحدة” أي تسوية الاختلافات العرقية للمواطنين، إن عمليات التنوير أو التهذيب الحضاري كان يقوم على استحضار الجذور المشتركة والروح المشتركة في التعبئة الأيديولوجية من أجل الولاء الوطني، وهذا الوضع اصطدم مع الواقع الذي تمثله فسيفساء الثقافات والعادات واللغات التي اعتُبرت شواهد على الانغلاق والمحلية الشاذة التي يجب أن تحل محلها رؤية وحيدة لتاريخ مشترك وثقافة قومية مشتركة يتبعها الجميع.
فلبناء الأمة وجهان، قومي، وليبرالي، فبينما تتبع القومية الإكراه سبيلاً لمقاومة مَن يرغب في التمسك بعاداته، ولإلغاء كافة مظاهر الاختلاف، وصهر الجميع في بوتقة واحدة؛ نجد الليبرالية في منأى عن كافة مسالك الاستبداد والإكراه، إلا أن هذه الأخيرة قد رأت في الجماعات العرقية والمحلية بذور تمرد لابد من قمعها واستئصالها بسبب نزعتها الطبيعية الى إعاقة التعريف الذاتي للفرد. إذن فإن القومية والليبرالية تتبنيان استراتيجيات مختلفة لكنهما تسعيان الى غايات مشابهة، فإما الاندماج أو الفناء.
كما يسرد “باومان” على لسان “جيفري ويكس” أن “أقوى إحساس بالجماعة يصدر عن تلك الجماعات التي يتهددها وجودها الجمعي وتشكل من ذلك التهديد جماعة تتمتع بهوية تمدهم بإحساس قويًّ بالمقاومة والعزيمة. فعندما يبدو الناس عاجزين عن التحكم في العلاقات الاجتماعية التي يجدون فيها أنفسهم، فإنهم يختزلون العالم في جماعاتهم”.
ويرى “باومان” أن أهم ثمة للحداثة في مرحلتها الأولى “مرحلة الصلابة”، هي تصورها لوضعها المحدد القاطع، فكانت هذه السمة تتوج السعي إلى تحقيق النظام، سواء أكان في صورة “اقتصاد مستقر”، أو إلى “مجتمع عادل”، أو إلى جماعة يحكمها “القانون العقلاني والأخلاقيات العقلانية”. وأمَّا الحداثة السائلة فتطلق العنان للقوى التي تأتي بتغيُّرات تقوم على نموذج سوق الأوراق المالية أو أسواق العملة؛ فهي تسمح بتغييرات ثقافية لا ينظر إليها باعتبارها مستويات محددة ولا قاطعة، ولا يجري تثبيت أي منها حتى تنتهي لعبة العرض والطلب من مسارها “الذي لا يمكن التنبؤ به”. فالحداثة السائلة تعاني من فراغ معياري.
ثم تطرق “زيجمونت”، لفكرتي “العدالة الاجتماعية” و”حقوق الإنسان”، موضًحا أن فكرة حقوق الإنسان استحدثت لصالح الافراد، بمعنى حق كل فرد في أن يكون مُميزًا ومُستقلًا عن غيره، من دون تهديد بالعقاب ولا النفي من المجتمع. ومع ذلك فمن الواضح أن النضال من أجل “حقوق الإنسان” لا يمكن أن يُحققه الفرد إلا مع غيره؛ ذلك لأن الجهد المُشترك وحده هو الذي بوسعه أن يحول الاختلاف إلى حقًّ من الحقوق، فلا بدَّ أن يكن مٌشتركًا بين جماعة أو فئة معتبرة من أفراد يتمتعون بالقدرة على التفاوض. ولا بدَّ لذلك الاختلاف أن يسطع بما يكفي لاجتناب تجاهلها، وحتى يمكن حمله على محمل الجد. ويعني ذلك أن الحق في الاختلاف لا بدَّ أن يصبح ركيزة التنفيذ المُشترك للمطالب. وهكذا فإن النضال من أجل تنفيذ الحقوق الأصلية للفرد يؤدي إلى بناء مكثف للجماعات.
وأخيراً يرى “باومان” أنه إذا كان تعريف “الاعتراف” هو حق المشاركة في التفاعل الاجتماعي على أساس من المساواة، وارتباط ذلك بقضية العدالة الاجتماعية، فإن ذلك لا يعني أن “الجميع لهم حق متساو في التقدير الاجتماعي”، ولا يعني ذلك أن كل القيم متساوية، وأن كل اختلاف جدير بالرعاية لأنه اختلاف، ولكنه دعوة الى حوار يمكن خلاله مناقشة مزايا الاختلافات المطروحة وعيوبها. وهذا الاتجاه يختلف اختلافاً جذرياً عن الاتجاه الأصولي العالمي الذي يرفض كل أشكال الوجود الإنساني الأخرى، بينما تمنح شكلاً واحداً الحق في وجودٍ لا يقبل الجدل. ولكنه يختلف اختلافاً جذرياً أيضاً عن نوع من التسامح الذي يرفض من البداية وباسم “التعددية الثقافية” أية نقاشات حول أساليب الحياة المختلفة.
الفصل السادس
الثقافة بين الدولة والسوق
في الفصل الأخير، تناول “باومان” الحديث عن علاقة الفنون بالسلطة، وركز في هذا المقام على نموذج الدولة الفرنسية التي رأت ضرورة تبني الدولة عمليات التنوير والتثقيف والتي بدأت باهتمام الدولة الفرنسية بالفنون قبل مائتي عام من ظهور مصطلح “الثقافة”، واتخذ هذا الاهتمام صورة جهود الحكومة لنشر التعليم وتهذيب الأخلاق والارتقاء بالأذواق الفنية وإيقاظ الحاجات الروحية التي لم يمتلكها الجمهور من قبل أو لم يكن واعيًا بأنه يمتلكها. وقد بدأت مأسسة رعاية الدولة للأنشطة الثقافية وتقنينها بتأسيس وزارة الشئون الثقافية في عام 1959 في عهد ديجول، وكان الهدف من هذه الوزارة أن تكون الثقافة جزءاً من العظمة المستقبلية لبلاده، وأن تضفي الهيبة والعظمة على فرنسا، وأن تشع الثقافة الفرنسية بنورها على بقية القارة الأوروبية بحيث يصبح نموذجها موضع إعجاب ومحاكاة.
وقد رفض أندريه مالرو أول وزير للثقافة ومن بعده كافة الوزراء حتى جاك لانج (1982) أية مهام ذات طابع تربوي، فهو لم يكن مهتماً بفرض نماذج ولا أذواق “فوقية” مختارة من قبل الحكومات على أفراد مستهدفين بالتثقيف، ولكنه كان مهتماً بدعم التعددية الثقافية وخلق فرص للمبدعين والفنانين، ومساعدة الحركات المستقلة غير المؤسسية والممارسات غير الاحترافية، متمسكاً بالإلغاء التام لمركزية المبادرات الثقافية.
ويشير باومان الى أن التوسط في توصيل الفن للجمهور عادة ما يكون مسئولية الدولة، وأما حديثاً فقد انسحب وكلاء الدولة لصالح جيل جديد من المديرين ووكلاء قوى السوق، وهؤلاء معاييرهم هي معايير الاستهلاك، أي الاستهلاك الفوري والإشباع الفوري والربح الفوري. فالسوق الاستهلاكية تفضل الدورات السريعة لرأس المال، كما تحبذ أقصر فاصل ممكن بن استخدام المنتج والتخلص منه، من أجل تقديم بدائل فورية للمعروض الذي فقد قدرته على تحقيق أرباح كبيرة. هذا التوجه يتناقض بشدة مع طبيعة الإبداع الفني وغاية الفنون جميعها.
في عالمنا الحديث السائل نجد أن الزبائن المحتملين وأعدادهم وأموالهم النقدية هي التي تحدد الخط الفاصل بين الأعمال الثقافية “الناجحة” والأعمال الثقافية المخفقة. ولكن ليس في حقيقة الأمر هناك علاقة وطيدة بين الشهرة التي يحظى بها فنان وقيمة أعماله الفنية.
ويشير “باومان” إلى تصور تطرحه “حنه آرندت”([1]) في التفرقة بين ما هو ثقافي، وما هو وظيفي، فالموضوعات الثقافية تميل إلى سمات الديمومة والامتداد الزمني، أي تجاوز اللحظة الراهنة، أما التعامل الوظيفي أو النفعي مع الموضوعات بمنطق الاستهلاك والإشباع، ومنح الأولوية للوقائع الراهنة هو أسلوب مخالف لطبيعة الموضوعات الثقافية ومعاييرها، والثقافة تتعرض للخطر عندما ننظر إلى كافة الموضوعات الحالية أو الماضية باعتبارها موضوعاتِ وظيفية، كما لو أنها صدرت لإشباع حاجات محددة، ولا يهم قيمة هذه الحاجات ولا وضاعتها.
ومن بين كافة الوظائف التي عُهد بها إلى السوق في عصرنا، يؤكد “زيجمونت باومان” على وظيفتين كان للتخلي عنهما لصالحها أضرارا اجتماعية كارثية، وهما حماية السوق من نفسها عن طريق وضع الحدود، فضلا عن إصلاح الضرر الاجتماعي والثقافي الذي تخلفه.
في الأخير، يٌمكننا القول بأن كتاب “الثقافة السائلة” وصف بشكل دقيق وبعمق أمراضنا المجتمعية، كما عَرض أفكارًا شديدة الجدة والأصالة والأهمية لفهم وضعنا الحالي في عصر السيولة.
عرض:
أ. أحمد محمد علي*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – منظرة سياسية وباحثة يهودية من أصل ألماني
* ماجستير في العلوم السياسية. جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies