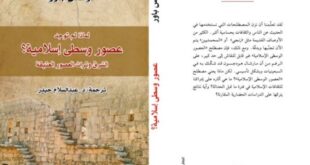المؤلف: جيل ليبوفيتسكي.
العنوان: السعادة المتناقضة= Bonheur Paradoxal: مقالة عن مجتمع الاستهلاك المفرط
ترجمة: الشيماء مجدي.
مراجعة: بشير زندال.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: القاهرة.
تاريخ النشر: 2022.
الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات.
الوصف المادي: 400ص.، 24 سم.
السلسلة: ترجمات؛ 41.
الرقم الدولي الموحد: 978-977-6870-36-9
المقدمة
يعيش الإنسان بدءًا من النصف الثاني من القرن العشرين “حضارة الرغبة”، فقد حلت رأسمالية الاستهلاك مكان اقتصاديات الإنتاج، كما ظهرت هرمية جديدة للأهداف وعلاقات جديدة بالأشياء وبالزمن وبالذات وبالآخر، فقد حلت “الحياة اليوم” محل توقعات المستقبل، واستُبدلت المشاعر القومية بحمى الرفاهية، مدعومًا بدين جديد متمثل في التحسين المستمر لظروف الحياة، فأصبح العيش بشكل أفضل شغفًا جماعيًا وهدفًا أسمى.
لكن بدءًا من العقدين الماضيين، ظهر “زلزال” جديد وضع نهاية لمجتمع الاستهلاك القديم، فقد حدثت ثورة داخل ثورة الاستهلاك نفسها. مرحلة جديدة من مراحل رأسمالية الاستهلاك هي مرحلة “مجتمع الاستهلاك المفرط”. طريقة عملها وتأثيرها على الوجود هو موضوع هذا الكتاب الذي بين أيدينا، المكون من جزئين رئيسيين وإحدى عشر فصلًا.
الجزء الأول
مجتمع الاستهلاك المفرط
أوضح الكاتب أن مصطلح “مجتمع الاستهلاك” ظهر لأول مرة في العشرينات وانتشر في الخمسينات والستينيات وما يزال شائعًا حتى اليوم.
إلا أن بعض التساؤلات والشكوك قد صارت تحوم حول هذا المصطلح مع بداية التسعينات مع ظهور تغييرات مُهمة في طبيعة الاستهلاك كفقدان الشهية للاستهلاك، وعدم الاهتمام بالماركات، والاهتمام المتزايد بالسعر، وتراجع الشراء الاندفاعي. حيث بات التركيز على جودة الحياة، والتعبير عن الذات، وللروحانيات، وللمخاوف المتعلقة بمعنى الحياة؛ ذات أولوية على الرفاهية المادية والمال والأمن الجسدي. وتحولنا من نظام ثقافي مادي بالأساس، لرؤية كونية ذات نزعة “ما بعد مادية”، وهكذا عشنا شيئًا فشيئًا اختفاء قدسية الأشياء.
ثم تطور الأمر في العشرين عامًا الأخيرة حيث دخل العالم حقبة جديدة من تسويق أساليب الحياة، الأمر الذي يمكن أن نطلق عليه “مُستهلك من النوع الثالث” وهو ذلك الشخص الذي يشتري الماركات العالمية، ويبحث عن منتجات قليلة السكر أو عضوية، ويطالب بعلامات الجودة، ويتصفح الشبكات، ويحمّل الأغاني على الهاتف المحمول. إلا أن ظهور اقتصاد وثقافة استهلاك جديدين لا يعني تحولًا تاريخيًا مُطلقًا، فالمجتمع الجديد الذي يرى النور بات يعمل بـ “الاستهلاك المفرط” وليس بـ “اللااستهلاك”.
- العصور الثلاثة لرأسمالية الاستهلاك:
سعى الكاتب من خلال هذا الفصل للوقوف على مراحل تطور الظاهرة الاستهلاكية من خلال التمييز بين ثلاث محطات/لحظات مُهمة:
بدأت المرحلة الأولى من عصر الاستهلاك الجماهيري في حوالي ثمانينات القرن التاسع عشر وانتهت مع الحرب العالمية الثانية. وقد شهدت تأسيس الأسواق الوطنية الكبرى –مكان الأسواق المحلية الصغيرة- كما شهدت ولادة أسواق الجملة التي أصبح تطورها ممكنًا بفضل البنية التحتية الحديثة للنقل والاتصال خاصةً شبكات السكك الحديدية التي مكّنت من ازدهار التجارة على نطاق واسع، كما ساهمت في تصريف كميات ضخمة من المنتجات بشكل منظم. ذلك فضلًا عن تطور اّلات التصنيع بشكل مُستمر والتي أدت إلى زيادة الإنتاجية بتكاليف قليلة، ومهدت الطريق للإنتاج الضخم.
وسمحت السرعة المتزايدة للإنتاج بتخفيض سعر البيع، فاستند اقتصاد الاستهلاك على فلسفةً استهلاكية جديدة تتمثل في بيع أكبر كمية من المنتجات مع هامش ربح صغير بدل من بيع كمية صغيرة بهامش ربح كبير.
وتميزت هذه المرحلة بأن معظم البيوت المتواضعة ظلت تملك موارد قليلة لتتمكن من الحصول على المنتجات المستدامة الحديثة. على سبيل المثال حتى سنة 1954 ظل استخدام الأجهزة المنزلية في فرنسا مرتبطًا بالترف، و7% فقط من البيوت كانت لديها ثلاجة. إذن خلقت هذه المرحلة استهلاكًا جماهيريًا غير مُكتمل، معظمه من الطبقة “البورجوازية”.
كذلك وحتى ثمانينيات القرن التاسع عشر، كانت المنتجات مجهولة، كما كانت تُباع بدون تعبئة مع تواجد قليل للماركات الوطنية. وللسيطرة على تدفقات الإنتاج وجعلها مربحة، قامت المصانع الجديدة بتعبئة منتجاتها والإعلان على المستوى الوطني لماركاتها. ولأول مرة، قامت الشركات بتخصيص ميزانيات ضخمة للإعلان. وبعد أن أصبحت موحدة، ومُعبأة وموزعة على الأسواق الوطنية، حملت المنتجات اسمًا هو “الماركة”، لقد خلقت المرحلة الأولى اقتصادًا مبنيًا على العديد من الماركات المشهورة، بعضها احتفظ بمكانة بارزة إلى يومنا هذا، مثل “كوكا كولا”.
وقد غيَّر ظهور الماركات الكبرى والمنتجات المعبأة بشكل كبير علاقة المستهلك ببائع التجزئة الذي فقد المهام التي كانت مُخصصة له، ولم يعد المستهلك يثق بالبائع، بل بالماركة. ومن خلال كسر العلاقة التجارية القديمة التي يهيمن عليها التاجر، قامت المرحلة الأولى بتحويل المستهلك التقليدي إلى مُستهلك حديث، مستهلك ماركات ينبغي إغواؤه لاسيما بواسطة الإعلان. وهنا ظهر مستهلك الأزمنة الحديثة مع الاختراع الثلاثي: “الماركة” و”التعبئة” و”الإعلان”. وبات المستهلك يحكم على المنتجات انطلاقُا من اسمها ليس انطلاقًا من تركيبتها.
كما اقترن الإنتاج الضخم بظهور المتجر الكبير “المحلات الكبرى” مثل مجموعة “لو برانتون” في فرنسا 1865، ومجموعة “لو بون مارشي” عام 1869. وشكَل المتجر الكبير أول ثورة تجارية حديثة مُفتتحًا بذلك عصر التوزيع الضخم. وسعت المتاجر الكبيرة على تصريف سريع للمخزون واعتماد أسعار منخفضة بهدف تحصيل حجم أعمال كبير مبني على البيع على نطاق واسع. كما زاد أصحاب المشاريع الجديدة من تنوع المنتجات المقترحة للزبائن بشكل كبير. وحوَل المتجر الكبير البضائع التي كانت سابقًا مُخصصة للنخبة إلى مواد استهلاك جماهيرية موجهة للبورجوازية.
كما أحدثت المتاجر الكبيرة ثورة في العلاقة مع الاستهلاك، حيث استعانت بفترينات ملونة ومضيئة، وبات كل شيء مُعد لإبهار البصر لتحويل المحل إلى حفل دائم لإدهاش الزبون وخلق مناخ قهري ملائم للشراء، وهكذا أصبح التسوق و”التسكع أمام الفترينات” طريقة لشغل الوقت، ونمط حياة للطبقات المتوسطة. لقد اخترعت المرحلة الأولى مفهوم الاستهلاك/الإغراء، والاستهلاك/الإلهاء الذي نُعتبر نحن ورثته الأوفياء.
تميزت المرحلة الثانية التي بدأت منذ عام 1950 بنمو اقتصادي استثنائي، وبرفع مستوى إنتاجية العمل، وبمضاعفة القدرة الشرائية للأجور ثلاث أو أربع مرات، كما قدمت المرحلة الثانية نفسها كنموذج خالص لـ “مجتمع الاستهلاك الضخم”. وجعلت المنتجات التي كانت مرتبطة بالنخب الاجتماعية في متناول الجميع، كالسيارة والتلفاز والأجهزة المنزلية. كما تميزت هذه المرحلة بارتفاع القدرة الشرائية فاتسعت لتشمل المزيد من الطبقات الاجتماعية القادرة على أن تتطلع بثقة إلى تحسين ظروفها المعيشية. كما زادت أيضًا في هذه المرحلة أعداد “السوبر ماركت” و”المراكز التجارية الضخمة” وتنوعت المنتجات بشكل كبير. وأصبحت زيادة الناتج الوطني الإجمالي ورفع مستوى المعيشة للجميع بمثابة “واجب متوهج”، والتف المجتمع بأكمله حول مشروع تهيئة حياة مريحة وسهلة مرادفة للسعادة. كما تميزت هذه المرحلة بأكثر من مجرد رفع مستوى المعيشة، حيث جو تحفيز الرغبات، الحماس الإعلاني، صور قضاء العطلات التي تخطف الألباب، وإضفاء الطابع الجنسي على العلامات والأجساد.
وقد أوجدت هذه المرحلة “مجتمع الرغبة”، حيث المرح المثير، الأزياء الخلابة، موسيقى الروك، المجلات المصورة، فتيات أغلفة المجلات، التحرر الجنسي، أخلاقيات المرح، التصاميم الحديثة. وقامت هذه المرحلة بتفتيت الأسس الثقافية القديمة لصالح تفاهات الحياة المادية التجارية. كما خلقت ديناميكية تسويقية قوية بتحويل الاستهلاك التجاري الى نمط حياة والى حلم جماعي قائم على القيم المادية. كما تسببت في قلب الزمن بحيث انتقلت من التوجه المستقبلي إلى “الحياة في الحاضر” وما تمنحه من إرضاءات فورية.
يرى الكاتب أنه يمكن النظر لهذه المرحلة على أنها اللحظة الأولى لمحو تقاليد الحداثة النظامية المتسلطة القديمة، التي تهيمن عليها الإيديولوجيات. وبدأت صفحة جديدة يستهدف فيها الاستهلاك تحقيق منطق التمايز الاجتماعي، بحيث لا يبحث المستهلك عن الاستمتاع بقيمة الاستخدام بقدر ما يبحث عن إبراز المستوى المعيشي الذي يعيش فيه، وأن يُصنًّف ثم يرتقي في التصنيف في التسلسل الهرمي للعلامات التنافسية. ومن هنا يأتي منطقين غير متجانسين يكشفان عن خصوصية المرحلة الثانية هما: الجري وراء التقدير/ الجري وراء الملذات، فجاء الوفاق بين أسطورة مستوى المعيشة والمرح، أو بين الاستهلاك بغرض الظهور والاستهلاك المتعي الفرداني.
ثم بدأت المرحلة الثالثة التي تميزت بتراجع هدف الاستعراض أو إظهار وضع اجتماعي لصالح الوصول للإرضاء العاطفي والجسدي “الاستهلاك ذو الطابع الحميمي”. فحل الاستهلاك من أجل الذات محل الاستهلاك من أجل الآخر. بل بات البحث عن السعادة الخاصة والاستفادة اللامحدودة من إمكانياتنا الجسدية والتمتع بالصحة هي سمة هذه المرحلة. فهذه هي المرحلة التي تتفوق فيها قيمة التسلية على القيمة الفخرية، والمحافظة على الذات على المقارنة المستفزة، والراحة الحسية على عرض العلامات البارزة.
لم يعد الأمر يتعلق إذن بإبراز علامة ثراء أو نجاح خارجي بقدر ما يتعلق بخلق بيئة معيشية ممتعة وجمالية؛ عش دافئ وشخصي، بلا شك أنه نتيجة شراء منتجات غالية الثمن، ولكن يعاد تأويل هذا الأمر بحيث يكون معبرًا عن هوية فردية. ففي السباق نحو الأشياء والترفيه يسعى المستهلك لإعطاء إجابة ملموسة على السؤال الأزلي: من أنا؟. وقد قام عدد كبير من الماركات بالاستفادة من هذا الوضع الاستهلاكي الجديد وذلك باللعب على ورقة الحسي والعاطفي والجذور والنوستاليجا. وهنا ظهر ما سُمي بـ “الاستهلاك العاطفي” حيث تحولت عملية الشراء الى منطق غير مؤسسي وذي طابع حميمي، محوره البحث عن الأحاسيس والرفاهية الشخصية وإيجاد علاقة عاطفية جديدة للأفراد بالمنتجات.
شغف الماركات والاستهلاك الديمقراطي، يؤكد الكاتب على أن هذه الفترة تُسجل نجاحًا هائلًا للماركات التي مرت إعلاناتها من مجرد دعاية تدور حول المنتج وفوائده العملية إلى حملات تنشر قيمًا ورؤية تركز على المذهل وعلى العاطفة وعلى المعنى الخفي للمنتج، فلم تعد الشركات تبيع منتجًا، ولكن رؤية “فكرة” أسلوب حياة مرتبط بالماركة، كما أصبح بناء هوية الماركة من صميم عمل دعاية الشركات.
إن الرغبة في التألق والاختلاف أمور لم تختفِ أبدًا، إلا أن الرغبة في الاعتراف الاجتماعي لم تعد هي ما يدعم الميل للماركات العليا بقدر ما أصبحت تدعمه المتعة النرجسية للإحساس بالبُعد عن المُشترك من خلال الاستفادة من صورة إيجابية للذات من أجل الذات. وبالتالي فإن المتع النخبوية أعيد هيكلتها من طرف المنطق الذاتي للفردانية الجديدة، خالقة مزيدًا من الرضا عن الذات أكثر منه رغبة في جلب إعجاب وتقدير الاَخر.
لكن تلك السياسات الفردانية قادت لطبيعة استهلاك قلق؛ ففي الحقب السابقة كانت المعايير الاجتماعية وثقافة الطبقات تُشكل عالمًا واضحًا ومتينًا من المبادئ والقواعد المنظَّمة بدرجة كبيرة بشكل هرمي ومستوعَبة من طرف الناس، بحيث تفرق بين الذوق الرفيع والسيئ، الأناقة والابتذال، الأنيق والشعبي، ولكنَّ هذا النظام الهرمي تفكك لصالح أنظمة متحررة من الضوابط، ولصالح تصنيفات مشوشة ومختلطة حيث تجعل من الفرد أساسًا لها بعد أن كان أساسها القواعد وأنماط الحياة الجماعية. وبالتالي فإن الوله الشديد للماركات كان صدى لحركة نزع الطابع التقليدي وانتشار مبدأ الفردية وعدم اليقين، فكلما كانت أنماط الحياة أقل خضوعًا لتحكم النظام الاجتماعي ومشاعر الانتماء الطبقي، تفرض قوة السوق ومنطق الماركات نفسها بقوة: فكلما اختلطت معايير “الذوق الرفيع” تقوم الماركة بطمأنة المشتري، وعندما تتضاعف المخاوف الغذائية فإن الناس يفضلون المنتجات التي تحمل شعار “عضوي”…
القلق أيضًا هو أساس الميول الجديدة لدى المراهقين الصغار للماركات، لأن التباهي بالنسبة للشباب لا يعني رغبتهم في التفوق على الآخرين بقدر ماهي رغبة في ألا يظهروا أقل منهم وتجنب الاحتقار والتعرض للرفض الموجع من الآخرين. فالأمر لا يتعلق بالتفوق الاجتماعي بقدر ما يريدون إثبات مشاركتهم الكاملة والمتساوية مع الاّخرين في لعبة الموضة، باعتبار أن الماركة هي تذكرة الدخول إلى نموذج حياة الموضة.
إذن فالمتع المرتبطة باكتساب الأشياء أصبحت في هذه المرحلة الثالثة تتعلق أقل بالتفاخر الاجتماعي من تعلقها بـ “قدرة أكبر” على تنظيم الحياة، وبسيطرة متزايدة على الزمن والمكان والجسم. ومما يؤكد هذا التوجه الجديد زيادة الإنفاق على الصحة بحيث فاقت مجموع الاستهلاكات الأخرى. فقد تحول الإنسان المستهلك إلى “الإنسان الصحي” حيث يتم غزو العقول بشكل متزايد بالمشاكل الصحية وبنصائح الوقاية وبالمعلومات الطبية، ولم نعد نستهلك فقط الأدوية، ولكن أيضًا البرامج، مقالات الصحافة غير المتخصصة، صفحات الويب، الكتب التبسيطية، الموسوعات الطبية … إلخ. وبالتالي تظهر الصحة كقيمة أولى وتظهر كمشكل حاضر في كل الأعمار تقريبًا، وبالتالي تقوم سلع الاستهلاك أكثر فأكثر بإدماج البعد الصحي: مواد غذائية، سياحة، سكن، مواد تجميل، دوامة السلوكيات الوقائية. لقد أصبح موضوع الصحة حجة بيع حاسمة، مما أدى الى إضفاء طابع الدراما على العلاقة بالاستهلاك في صورة قلق متنام على الجسد والصحة.
المتعة والترفيه واقتصاد التجربة: على إثر النقد الماركسي للدِين ووصفه بأنه “أفيون الشعوب”؛ وصف الفلاسفة وعلماء الاجتماع “الشغف الاستهلاكي” كأفيون جديد للشعوب، يهدف لتعويض ملل العمل، وإخفاقات الحراك الاجتماعي، وتعاسة الوحدة، ولا يمارس الاستهلاك نفوذه إلا بقدر ما لديه من القدرة على الإلهاء أو التنويم وتقديم نفسه كمسكن للرغبات الخائبة للإنسان الحديث. ولكن الكاتب ينتقد هذا التحليل ويرى فيه إقصاء للبُعد المتعي للاستهلاك لدى الفرد.
كما يوضح الكاتب أن لا شيء يوضح البُعد المتعي للاستهلاك أكثر من الدور المتنامي للترفيه في مجتمعاتنا، فالنفقات المرتبطة بقطاع الترفيه والثقافة والاتصال والسياحة تشغل مكانة متزايدة في ميزانية الأسر. وبالتالي هذه الهيمنة للترفيه دفعت بعض المحللين للحديث عن رأسمالية جديدة لا ترتكز على الإنتاج المادي، ولكن على التسلية والبضائع الثقافية. وفي هذا السياق شهدت المرحلة الحالية انفجار في عدد المتنزهات الترفيهية، على سبيل المثال في فرنسا، تجذب 250 مدينة ملاهي 70 مليون هاوِ في السنة.
وفي سياق اّخر، أصابت حمى التغيير الدائم مجتمع الاستهلاك، فمن الخصائص الرئيسية لسلع الاستهلاك في مجتمعاتنا هي أنها تتغير وأننا نغيرها إلى ما لا نهاية، بحيث لا يتوقف العرض عن التجدد باستمرار واقتراح منتجات وخدمات جديدة. وفي المرحلة الثالثة.
يمكننا إذن القول أن هذه المرحلة الثالثة تعمل وفقًا لمنطقين متضادين، يتطور الاستهلاك اللعبي المتعي بالتوازي مع استهلاك القلق أو الحذر.
التنظيم ما بعد الفوردي للاقتصاد: هذه المرحلة التاريخية الثالثة لرأسمالية الاستهلاك لا تتميز فقط بطرق جديدة للاستهلاك، ولكن أيضًا بطرق جديدة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وبطرق جديدة للإنتاج والبيع والتواصل والتوزيع. فيتميز مجتمع الاستهلاك المفرط بـ ـ”إعادة اكتشاف الزبون” أو “الزبون الملك”، حيث تحولنا من سوق يتحكم فيه العرض إلى سوق يهيمن عليه الطلب.
وقد ظهرت المرحلة الثالثة في وقت تتجلى فيه علامات التدهور على المبادئ الفوردية التي تنظم إنتاج السلاسل المتكررة. ومن أجل الاستجابة بشكل أفضل للحاجة الفردانية إلى الاختلاف، أعملت الشركات المصنعة أساليب جديدة لتحفيز الطلب مبنية على تجزئة الأسواق، وإحلال منطق تكثير التنوع محل نظام الإنتاج الضخم، فحلت المنتجات حسب الطلب محل المنتجات الموحدة، حيث يمكن للزبائن إضفاء رغبتهم الشخصية باختيار ما يريدونه، ومن ثم تقوم الشركة بتصنيع الحاجة وفقًا لرغبات وأذواق المستهلكين. وانطلاقًا من تلك الفترة، لم تعد الماركات الكبرى تهتم بإغراء كل شرائح المجتمع، ولكن فئات معينة من المستهلكين ومجموعات عمرية محددة، فضلًا عن استهداف سلوكيات مستهلكين متباينة بشكل كبير عن بعضهم البعض. كما ازدهرت استراتيجيات التنويع وكانت علامة على انتصار شعار “الزبون الملك”، وتفوق التسويق على الإنتاج.
السباق نحو الابتكار، أصبح الهدف في المرحلة الثالثة هو تفوق “رقعة الابتكار” على الإنتاج، ففي المراحل السابقة كانت تنافسية الشركات تعتمد على زيادة إنتاجية العمل، وتخفيض التكاليف، واستغلال وفُورات الحجم، بينما في الأسواق الجديدة، لم يعد تحقيق مكاسب الإنتاجية كافيًا، بل لقد أصبح بناء الميزة التنافسية ونمو المبيعات يتحققان بالاستجابة لرغبات المستهلك وبإطلاق منتجات جديدة مبتكرة. ولذلك شهدت هذه المرحلة رصد الشركات ميزانيات لأنشطة البحث والتطوير تجاوزت أحيانًا ميزانيات بعض الدول.
اقتصاد السرعة، بات تسارع تقادم المنتجات حاضرًا في كل القطاعات تقريبًا، وكثير من المنتجات لا تتجاوز مدة حياتها سنتين، ولتحفيز الاستهلاك يعتمد الإنتاج على تجديد الموديلات بسرعة أكبر، وجعلها غير مناسبة للموضة باقتراح نسخ أكثر فاعلية أو مختلفة قليلًا.
في زمن مكاسب التصميم والابتكار أصبح عامل الوقت حاسمًا مما جعل مفهوم “المنافسة الوقتية” يفرض نفسه. وفي سباق تقليل الوقت للوصول إلى السوق أصبحت الشركات تعلن بشكل مبكر عن المنتجات الجديدة حتى قبل أن يرى الإنتاج النور. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء شهرة المنتج والماركة، والتأثير على مبيعات منتجات المنافسين، وإلى خلق الرغبة لدى العملاء، ورفع مستوى المبيعات مُنذ الإطلاق. وفي هذه المرحلة الثالثة، لم يعد المستهلك المفرط يستهلك الأشياء والرموز فقط، بل إنه يستهلك أيضًا ما لم يصبح ماديًا بعد.
صورة وسعر وجودة، هذه المرحلة قد قامت أيضًا بالجمع بين عدم الدوام الأبدي للمنتج ومبدأ الجودة، فقد حددت الشركات المصنِعة كهدف لها مبدأ “خالِ من العيوب” و”الجودة الشاملة”، وبالتالي ظهرت الجودة كعامل حاسم للمنافسة الاقتصادية.
الاستهلاك التقديري الضخم: تميزت مرحلة الاستهلاك الثانية بإعادة تشكيل عالم الاستهلاك بخلق ثقافة تهيمن عليها ميثولوجيا السعادة الخاصة، فكل شيء يباع على وعد بالسعادة الفردية والعيش الأفضل والاستمتاع بالحياة كغايات في حد ذاتها. فهي ثقافة كاملة تعمل على دعوتنا لتذوق ملذات اللحظة والتمتع بالسعادة هنا والآن، والعيش من أجل الذات. وهذا أدى الى بروز استهلاك فرداني متحرر من المنطق العائلي ويسعى الى قيم المرح والترفيه.
وهنا ظهرت المرحلة الثالثة للاستهلاك بتطور الأدوات الإلكترونية الجديدة بما أدى الى تصاعد الطابع الفرداني على إيقاع الحياة بحيث يستطيع كل فرد تنظيم حياته الخاصة بإيقاعه الخاص بشكل مستقل عن الآخرين. وأصبح الأفراد يبنون حيزهم الزمكاني الخاص، فهو زمن الفردانية المفرطة لاستعمال السلع الاستهلاكية. وقد أدى هذا الوضع الجديد الى دفعة هائلة في جميع مجالات الاستهلاك، ويعد تطور العادات الغذائية نموذجًا واضحًا لهذا الوضع الجديد.
وفي المرحلة الثالثة أيضًا، يسعى الفرد الى القيام بمهام متعددة في ذات الوقت، حيث “ربح الوقت” بالنسبة له استراتيجية تهدف إلى الاستمتاع بشكل أفضل بلحظات الحياة، ولذلك تحولت أماكن العبور المرتبطة بالسفر الى ما يشبه المراكز التجارية، وهكذا أصبحت المطارات أماكن للاستهلاك المفرط مع مجموعة محلاتها التجارية، ومع بضائعها المعفاة من الضريبة… وفي الطرق السريعة انتشرت بمحطات البنزين أسواق صغيرة. إذن ففي المرحلة الأولى والثانية، كان المستهلكون ينتقلون إلى المتاجر؛ وفي المرحلة الثالثة، أصبحت التجارة هي التي تأتي إليهم. كذلك ازدهرت حركة الشراء عبر الإنترنت، فيستطيع مستخدم الإنترنت الحصول مباشرة على معلومات عن المنتجات والخدمات، ومقارنتها في أي ساعة من النهار أو الليل قبل أن يتخذ الخيار الذي يناسب احتياجاته. إن ما يميز عصر الاستهلاك الحالي هو نظام معلومات بلا حدود، بدون قيود مكانية، فأصبحنا الآن نعيش في كل مكان وبكافة الطرق وقت استغلال تجاري.
كذلك تطور التنظيم الزمني للاستهلاك، فباتت شركات الخدمات تعمل على مدار الـ 24 ساعة في اليوم لمدة 7 أيام في الأسبوع، المتاجر الليلية تتزايد، أماكن البيع الاّلي تستمر في النمو مما يسمح بالشراء المُستمر، خدمة التوصيل للمنازل والأطباق الجاهزة تتطور بنجاح طوال الوقت. وهكذا ظهر ما يمكن تسميته بـ “الاستهلاك التوربو” على غرار “رأسمالية التوربو” والذي يعني العمل بلا توقف وبشكل مُستمر على مدار العام بشكل كامل. وبذلك تم إخضاع أيام العطل والحياة الليلة لنظام السوق.
تأثير الديفا، لم تعد الخيارات والممارسات الاستهلاكية الخاصة بالفرد مرتبطة بالطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها. فالتفاوتات الاقتصادية تتسع والتطلعات الاستهلاكية تتقارب، والأوضاع الاجتماعية تختلف والنظام المرجعي واحد. وبالتالي بات من الصعوبة الشديدة التنبؤ بخيارات الاستهلاك والتي أصبحت غير متسقة وغير موحدة، وهو ما أطلق عليه الكاتب “تأثير الديفا” في إشارة لفيلم “جون جاك بينيكس”. وانتقلنا بالتالي من نظام آلي مُنضبط إلى نظام احتمالي غير مُحدد، وهو ما يُمثل لُب “المرحلة الثالثة”.
إذا كان تقسيم الاستهلاك في المراحل السابقة كان قائمًا على منطق هرمي قائم على الطبقات فإن هذا الأمر قد تلاشى لصالح نموذج أفقي أو شبكي. حيث اتسمت طرق الاستهلاك في هذه الفترة بالفروقات العمرية، ولم تعد هناك أي فئة عمرية –بما فيها الطفولة المبكرة- لا تشارك بشكل تام في النظام الاستهلاكي.
فبات الأطفال بحكم ما يحصلون عليه من اّبائهم “مصروفات الجيب” يظهرون كمستهلكين وأصحاب قرار في عملية الشراء، وهنا استُبعد النظام الأبوي الاستبدادي، وبات الطفل يُحدد ويختار متطلباته، ويعطي رأيه بمناسبة التسوق، والوالدان يأخذان بعين الاعتبار رغباته، فأصبحنا في عصر “الطفل المستهلك المفرط”.
كذلك فإن جيل كبار السن أصبح يمتلك القوة، فمعدلات الشراء بين كبار السن أعلى من الفئات الأخرى الأصغر سنًا، فقد انتهى الزمن الذي كان فيه المتقاعدون يكتفون بمجالسة أحفادهم، وبات كِبار السن يسافرون في كل العالم، ويزورون المدن والمتاحف، ويمارسون الرياضة. وبات جيل كِبار السن يتوق إلى جودة حياة مرتبطة باستهلاك المنتجات الصحية والسياحية والعناية بالجمال…الخ. وأصبحت فترة كِبار السن فترة حياة تتميز بالمتعة والنشاط الاستهلاكي الفائق. وباتت فئة كبار السن في المرحلة الثالثة تؤخذ بعين الاعتبار كمنجم ذهب جديد.
المصير المذهل للإنسان المستهلك: يصف الكاتب المرحلة الثالثة بأنها اللحظة التي لم يعد يواجه فيها تسويق أنماط الحياة أية مقاومات ثقافية وإيديولوجية بنيوية، وهي المرحلة التي استسلم فيها كل ما تبقى من المعارضة أمام صافرات السلعة. فنشأة المستهلك الحديث لم يتم بشكل عفوي، فقد كان لابد من اقتلاع الأفراد في المرحلة الأولى والثانية من المعايير الخاصة والمحلية، ورفع التأنيب عن الرغبة في الإنفاق، وعدم إعطاء قيمة لأخلاقيات التوفير، وعدم تقدير الإنتاجات المنزلية، وتصفية العادات الاجتماعية التي كانت تقاوم الاستهلاك التجاري. وهنا فقط بُني كوكب الاستهلاك الضخم، حيث تم تدريب وتربية المستهلكين على الاستهلاك اللامحدود. وبدأ العصر الذي أصبحت فيه مرجعية المتعة هي الحقيقة الأولى، والتي لم تعد الثقافات المحلية فيه تُشكل كوابح لرغبتنا في كل ما هو جديد.
الروحانية الاستهلاكية، يرى الكاتب أن حتى الدِين لم يعد يُشكل قوة مضادة لتقدم الاستهلاك العالمي، وما عادت الكنيسة تمجد التضحية والزهد. وتضائل الشعور بالذنب مع تراجع مفهوم السيطرة على الشهوات. أصبحت النصرانية دينًا في خدمة السعادة المنتمية لهذا العالم مؤكدة على معاني التناغم والسلام الداخلي والتحقيق الكامل للشخص، لقد تكيفت المسيحية مع مُثل السعادة والمتعة، فعالم الاستهلاك المفرط لم يكن مقبرة الدين، ولكن وسيلة تكييفه مع الحضارة الحديثة.
تأكيدًا على هذا التوجه، يرى الكاتب أنه قد تم تسليع الأنشطة الدينية تجاوبًا مع حاجة الأفراد لتقوية عالم المعنى الخاص بهم، فتضاعفت المكتبات المتخصصة ومراكز التطوير الشخصي والروحي واستشارات في الطب الروحي ودورات تدريبية لليوجا والزِن وغيره، إذن ففي مجتمع الاستهلاك المفرط حتى الروحانيات تباع وتشترى. ويشير الكاتب هنا الى أن في الحقيقة تنشيط الديني في مرحلة ما بعد الحداثة جاء نتيجة خيبة الأمل تجاه مادية الحياة اليومية، إلا أنه تبقى حقيقة أن الروحانية تحولت الى سوق رائجة ودعامة لتوسيع ما كانت هي نفسها تحاربه. وبالتالي فيمكن القول أن المرحلة الثالثة قد شهدت طمس الهوة بين الإنسان الديني والإنسان المستهلك.
كذلك بات المستهلك المفرط مأخوذًا بالأخلاق، حيث شكلت “الأخلاق” قطاعًا اّخر لذروة الاستهلاك العالمي، فقد سجلت المنتجات التي تحترم المعايير البيئية أو الأخلاقية زيادة مهمة في الحجم وفي التنوع وفي الشهرة. وشهدت المرحلة الثالثة تنامي ظاهرة الماراثونات والمهرجانات وحفلات الروك الخيرية والنجوم الذين يساهمون في العروض الضخمة للإحسان والتي يعود ريعها للأعمال الخيرية، فكلها أعمال للخير غارقة في جو احتفالي وتفاعلي. إذن لم يعد هناك عداء بين المتعة والتجرد، الفردانية والإيثار، المثالية والاحتفالية، الاستهلاكية والكرم، لقد خلط عصرنا الحدود القديمة من أجل إسعاد المستهلك المفرط العاطفي الإعلامي.
الاستهلاك التأملي، أوضح الكاتب إن في زمن المخاطر الغذائية والهوس الصحي يقوم المستهلك بالشراء عن دراية. ففي المرحلة الثالثة لا يكون الشراء بدون معرفة، وبدون مراجعة مستنيرة، وبدون تشاور. فهذه هي نهاية مرحلة التسوق المتسرع البريء، ونحن الآن في الطور التأملي للاستهلاك. فمن خلال الخيارات الواعية، يأخذ المستهلك دور الفاعل الحر الذي يقيِم المنتجات بحذر وفطنة.
وشهدت المرحلة الثالثة أيضًا ظهور تيارات مضادة للعولمة، والتأكيد على ضرورة حماية البيئة، واستدامة ثروات الأرض، والدفاع عن توازن الكوكب، وإنتاج السلع القابلة للتدوير، وإيجاد توافق بين الاقتصاد والبيئة. حتى لا يستمر الاستهلاك العالمي في السير قدمًا كمصير لا يقاوم. ويؤكد الكاتب أن كل هذا لا يشكل تدميرًا للعالم الاستهلاكي، بل هي مطالب لتنظيم وأنسنة العولمة، مع الالتزام بمعايير الاستهلاك المفرط التي ما فتئ يلعنها.
كان التخوف في المرحلة الثالثة أن تبتلع قوى السوق كل الأخلاق الإنسانية من ألفة وثقة اجتماعية وغيرها من قيم ومشاعر تميز إنسانيتنا. وزاد من مشروعية هذا التخوف أن الدراسات قد أثبتت أن استخدام الإنترنت يقلل دائرة العلاقات الاجتماعية، ويزيد من الوحدة. لكن كان للكاتب رأي آخر، فهو يؤكد أن مجتمع الاستهلاك المفرط لم يعزل الناس عن التواصل مع العالم واللقاء بالأصدقاء، بل على العكس، فإن الميل للمباشر، والرغبة في الخروج وفي “رؤية الناس”، والمشاركة في التجمعات الكبيرة الاحتفالية، تظهر كأنها هي ما يمثل التوجهات الأكثر أهمية. ويتوصل الكاتب من خلال الاطلاع على الدراسات الحديثة أن العلاقات الافتراضية لا تهدد العلاقات الشخصية، بل إنها تكملها، فالأفراد الذين يستخدمون خدمات الإنترنت يستمرون في الغالب في إقامة العلاقات خارج الشبكة ويبحثون عن توسيع أفق اللقاءات الفعلية. كذلك يؤكد الكاتب أن قيم مثل حقوق الإنسان، والحريات العامة الفردية، والتسامح، ورفض العنف والقسوة والاستغلال، وأعمال التعاون والتضامن؛ كلها مبادئ لم تندثر بعد.
وفي السياق ذاته، لم يُعلن عالم الاستهلاك نهاية مبدأ عاطفية المشاعر، بل توَجَها كقيمة عليا وملازمة لثقافة الفرد. فالحب كقيمة عليا يُقدم كمثل أعلى، وعلى إنه جوهر الحياة والصورة الأكثر تعبيرًا عن السعادة.
في نهاية هذا الجزء يؤكد الكاتب أن في هذه المرحلة الثالثة يعاني الجميع صعوبات أكبر في تحمل مصاعب الحياة رغم تقدم الظروف المادية، وغدت الحياة أثقل وأكثر فوضوية. ففي الوقت الذي يشع فيه ابتهاج الرفاهية فإن الأغلبية يظهر عليها القلق والكآبة وعدم الرضا عن حياتهم، فحضارة الاستهلاك المفرط تدمر الطمأنينة مع الذات والسلام مع العالم، وعدم الرضا عن النفس يتقدم بالتناسب مع الرضا الذي يقدمه السوق. فكل هذه الإرضاءات المادية والبهجة وطول أمد الحياة لم يحقق لنا سعادة العيش.
الجزء الثاني
متع خاصة .. سعادة مجروحة
يرى الكاتب أن حياة المجتمعات المتطورة تطرح نفسها كتراكم هائل لعلامات المتعة والسعادة. وإذا كانت الرفاهية قد غدت إلهًا، إلا أن “ثورة الحاجات” قد أدت الى إنتاج قراءات متناقضة لحياة المجتمعات الاستهلاكية، وقد قام الكاتب ببلورة هذه التناقضات في خمس نماذج يرى أنها تتحكم في معقولية المتعة والسعادة في مجتمعاتنا. وقد قام الكاتب بعرض موسع لهذه النماذج الخمسة في ارتباطها بالواقع المعاش:
النموذج الأول
في هذا النموذج تقوم المجتمعات الاستهلاكية على نظام تحفيز غير محدود للحاجات والذي يزيد من الخيبة والإحباط وعدم الرضا، ويتميز هذا النموذج بإنتاج البؤس الذاتي في الرغد المادي.
وقد أوضح الكاتب أنه قد بدأت تظهر في مجتمع الاستهلاك مشكلة كبيرة تتعلق بـ “لعنة الوفرة”، فوفرة المنتجات جعلت المستهلك يعيش في حالة نقص دائمة، وهو ما يُمكن أن نطلق عليه “مأساة الاستهلاك الزائد”، حيث لا يرى الفرد فيها الطمأنينة والمتعة الحقيقية. بات الإنسان مسجون في عالم الأشياء، ويعاني من عطش لا يُروى للملذات ولكل ما هو جديد، ويرغب دائمًا في الأكثر، بات المستهلك الجديد “عبد” لوفرة السلع. وباتت مأساة الإنسان تتبلور حول “الرضا غير المشبع على الدوام”. تلك الظاهرة أطلق عليها المفكرون ظاهرة “الاستهلاكوفوبيا”.
في هذه المرحلة يتم استيعاب المعايير والقيم الاستهلاكية من طرف شباب الأحياء الكبرى. لكن على الجانب الآخر، يمنع الفقر شباب الفئات الدنيا من المشاركة بشكل كامل في أنشطة الاستهلاك والترفيه، وينتج عن هذا التناقض دفعة من مشاعر الإقصاء والحرمان بالإضافة إلى سلوكيات من النوع الإجرامي.
النموذج الثاني
هذا النموذج يتميز بالحاجات مفرطة التعدد، والترويج للحظة التي نعيشها وإطلاق العنان لرغبات الاستمتاع من خلال ثقافة تتمركز حول الجسد والهيجان الاحتفالي والبحث عن النشوة بكل أنواعها. وتفرض فكرة ظهور تطلعات وأنماط حياة غير مسبوقة نفسها، بحيث تبشر بمُستقبل يتعارض مع المجتمع التكنوقراطي والسلطوي، ويرفض الانضباط والعائلة والعمل. وعلى هذه الخلفية، يدعو جيل الاحتجاج الرافض للسلطة إلى التحرر الجنسي والتعبير المباشر عن العواطف وتجربة المخدرات وطرق مختلفة للعيش معًا.
النموذج الثالث
على النقيض من ذلك، ترى مدرسة أخرى بروز القيم التطهرية القديمة المعادية للمتع الحسية، والتركيز على النشاط والإنجاز والتنافس والتميز. فوداعًا للملذات السريعة لصالح السلطة والتفوق على الذات. في هذه المرحلة بات كل شخص مُطالب أن يزيد من إمكانياته البدنية والصحية والجنسية والجمالية إلى الحد الأقصى. في العصر الحالي يُطلب باستمرار من المجتمع رفع تحديات المنافسة وبناء الذات والتفوق وزيادة القدرات. يوضح الكاتب أن “مجتمع الأداء” هو المجتمع المنشود في هذا العصر. وهنا ظهرت شخصية رمزية فرضت نفسها كحامل لواء روح العصر: شخصية “سوبرمان”، البطل الخارق صاحب الأداء الاستثنائي، دائمًا في أفضل لياقة، ودائمًا على استعداد لمواجهة تحديات جديدة.
النموذج الرابع
يرى هذا النموذج أن حضارة الرفاهية قد خلقت جوًا من الصراعات وزادت من مشاعر الكراهية والغيرة والتنافس والحسد بين الأفراد. فعصر الوفرة وهم يخفي حربًا سامة تدور بين الفرد والكل. ومما زاد من حدة الصراعات أن مجتمع الاستهلاك المفرط قد تميز بأنه “مجتمعًا شفافًا” فهو عصر “إظهار كل شيء وقول كل شيء، ورؤية كل شيء”. هذا الأمر قد أدى الى ظهور “الحسد” كظاهرة في مجتمعات الاستهلاك المفرط، وقد أكد عليها الباحث قائلًا إن العلوم الاجتماعية والسياسية لم تتطرق لهذا الأمر إلا قليلًا. فالحسد هو الشعور بعدم الرضا الذي نمر به أحيانًا عندما نرى صفات أو سعادة الاّخر، وتمني رؤيته محرومًا من هذه المزايا. كما يوضح الكاتب أنه لم تعد الفروق في الثروات وحدها هي التي تستفز المشاعر الخبيثة، ولكن أيضًا الأشياء التي لا تشترى، كالهيبة والموهبة والشهرة والنجاح والترقية مهنية والجمال والسعادة، هذا هو ما يوحي بالحسد في الأزمنة مفرطة الحداثة. إلا أن الكاتب يرى أن هناك انخفاضًا في الأحقاد والعداء عن المراحل السابقة، وهذا لا يعني اختفاء الحسد، ولكن تقليل قوته، حيث بدأ كل شخص يهتم بحياته الخاصة أكثر من حياة الاّخرين.
النموذج الخامس
تمثل في خصخصة الحياة التي أحدثتها الحضارة الاستهلاكية، بتحطيم السطوة التنظيمية للمؤسسات الكبرى. حيث قامت مجتمعات الاستهلاك بإعطاء دفعة لفردانية قصوى لأنماط الحياة والتطلعات. وقد نتج عن هذا الوضع تخريب المحيط الحيوي إلى درجة تهدد مُستقبل البشرية بأخطار كارثية، فبالاهتمام بالمتع والمصالح الاّنية بدون الاكتراث بالنتائج على المدى البعيد يتزايد خطر تلوث البيئة وتآكل التنوع البيولوجي والاحتباس الحراري. وإن لم نفعل شيئًا، فسنكون قريبًا عاجزين عن تأمين مُستقبل صالح للحياة لأطفالنا.
ويوضح الكاتب أن بعض التغيرات التي طرأت على السلوكيات المعاصرة تُبشر بتجاوز مجتمع الاستهلاك المفرط، حيث بات المستهلكون يُفضلون منتجات أكثر أخلاقية، ويرفضون التماهي مع الماركات، ويشترون أغذية عضوية. إذن يسعى الأفراد لأن يكونوا فاعلين “مسؤولين” أكثر من كونهم “ضحية” سلبية للسوق. وقد ارتبطت السعادة في الفترة الأخيرة بالنموذج “النفسي الروحاني” وشهدت تجدد الاهتمام بالمسارات الروحانية للوصول الى توازن داخلي وتناغم الجسد والروح وتوسيع وتعميق الوعي. وكان الهدف هو تغيير الذات وليس تغيير العالم. وأصبحت السعادة المادية على النقيض تمامًا من السعادة الروحية، فالأولى تركز على الحصول على السلع التجارية، والثانية على تحسين الوعي، الأولى تعطي الأولوية للتملك، والثانية تعطيها للكينونة.
ما بعد الاستهلاك المفرط
يؤكد الكاتب في النهاية، أن القول بأنه لا يوجد حل بديل لمرحلة الاستهلاك المفرط لا يعني بأي حال من الأحوال بأنها تُمثل “نهاية القصة”. قد تكون التأملات السابقة قادرة على إلقاء بعض الضوء على ما يمكن أن يعنيه الخروج من مجتمع الاستهلاك المفرط. إذ بمجرد أن ترى طرق جديدة لتقييم المتع المادية والملذات الفورية النور، ستفرض طريقة أخرى للتفكير نفسها، ويظهر نوع اَخر من الثقافة. فعندما سيتم فك الارتباط بين السعادة وعدد ما يقوم الفرد باستهلاكه والتجديد غير المحدود للأشياء والترفيه، ستتوقف دورة الاستهلاك المفرط. وهذا التغيير الاجتماعي التاريخي لا يتضمن التخلي عن الرفاهية المادية ولا اختفاء التنظيم التجاري لأنماط الحياة؛ إنه يفرض تعددية جديدة للقيم، وتقديرًا جديدًا للحياة التي ينافسها نظام الاستهلاك المتقلب.
ولا يمكننا –وفقًا للكاتب- تحديد الوقت المستغرق لقيام وعي من نوع اّخر وولادة اّفاق جديدة إلا أن هذه اللحظة ستأتي حتمًا. وحتى إن لم يختف الإنسان المستهلك، إلا أنه سوف يفقد خياله الوافر ومركزيته الانتصارية. وسيتمكن حينها علماء الانثروبولوجيا من التأمل بفضول في هذه الحضارة المستنيرة، حيث كان الإنسان العاقل يعبد إلهًا تافهًا ومذهلًا على حد سواء: إنها البضاعة الزائلة.
ولأن الإنسان ليس واحدًا، فإن على فلسفة السعادة أن تضع اعتبارًا لمعايير أو مبادئ حياة متناقضة. وحيث أن الإنسان هو مكون من تناقضات؛ فليس على فلسفة السعادة أن تستبعد “السطحية” ولا “العمق”، ولا التسلية العبثية ولا البناء الصعب للذات. يتغير الإنسان خلال مسيرة حياته، ولا يُنتظر دائمًا الحصول على نفس الرضا من الحياة. وهذا يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك فلسفة سعادة إلا إذا كانت غير موحدة وتعددية.
وفي الأخير يقول الكاتب “لا أحد يملك مفاتيح أبواب الأرض الموعودة: ولا نملك إلا أن نتصرف حسب الظروف ثم نصحح بشكل تدريجي، مع قدر قليل أو كثير من النجاح. إننا نناضل من أجل مجتمع وحياة أفضل، ونبحث بلا كلل عن سبل السعادة”.
عرض:
أ. أحمد محمد علي*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ماجستير في العلوم السياسية. جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies