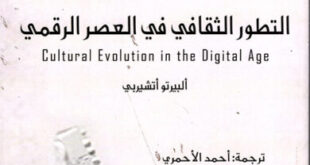العنوان: في سبيل الله والفوهرر: النازيون والإسلام في الحرب العالمية الثانية.
المؤلف: ديفيد معتدل.
المترجم: محمد صلاح علي.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: القاهرة.
الناشر: مدارات للأبحاث والنشر.
تاريخ النشر: 2021.
الوصف المادي: 679ص. ، 24 سم.
الترقيم الدولي الموحد: 0-41-6459-977-978.
كتاب “في سبيل الله والفوهرر: النازيون والإسلام في الحرب العالمية الثانية”، أطروحة الدكتوراه في التاريخ الحديث، نالها الأكاديمي والمؤرخ الألماني، ذو الأصول الإيرانية، David Motadel (ديفيد معتدل) من جامعة Cambridge (كامبريدج) الإنجليزية في عام 2010. الكتاب كان نتيجة عمل متواصل، عكف عليه المؤلف قرب عقدٍ كامل، باحثاً من خلاله في أكثر من 30 أرشيفاً ودار محفوظات، متجولاً في 14 دولة، حاصلاً في النهاية على مادة معلوماتية ضخمة، مكنته من تأليف الكتاب المعني.
صدر هذا الكتاب للمرة الأولى باللغة الإنجليزية في عام 2014، تحت إسم Islam and Nazi Germany’s War، ثم تُرجم إلى العربية، بموجب اتفاق خاص مع المؤلف، لتخرج لنا الطبعة العربية الأولى بالقاهرة في عام 2021، صادرةً عن “مدارات للأبحاث والنشر”، بقلم المترجم والباحث المصري “محمد صلاح علي”. لم يقدم “معتدل” – أستاذ التاريخ الحديث بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية – كتابه للترجمة العربية فقط، بل قدمه أيضاً لثماني لغاتٍ أخرى، نُشرت جميعها في سبع سنواتٍ فقط.
الكتاب المنقول للعربية – والذي نحن بصدد عرضه وتحليله الآن – يحتوي بين دفتيه على 679 صفحة، تضمنتها 220 صفحة من الحواشي، و34 صفحة شاملة لملحق الصور والكشاف، وهو الأمر الذي يدلل على مدى الثراء المعلوماتي الضخم الذي اشتمل عليه هذا العمل.
محور الكتاب
بدايةً، يدرس الكتاب العلاقة بين المانيا النازية والإسلام في اثناء الحرب العالمية الثانية، كاشفاً عن السياسات والأدوات التي استخدمتها السلطات الألمانية في التفاعل مع المسلمين حينذاك. وكما يؤكد الناشر، فإن الكتاب يركز على الدور الخاص الذ ي لعبه الدين في سياسات برلين النازية تجاه العالم الإسلامي، وهو ما لم تتبناه أية دراسة مناطقية أو قطرية أو أية سيرة ذاتية من قبل.
الكتاب إذن هو محاولة لوضع الإسلام على الخريطة السياسية والإستيراتيجية للحرب العالمية الثانية، مقدماً تاريخاً شاملاً لسياسات برلين الدينية في تلك الحرب، واضعاً “المسلمين” في بؤرة البحث، وهو ما أهملته معظم الدراسات المعنية بشكل لافت، بالرغم من كون المسلمين أكثر الجماعات الدينية انتشاراً في المناطق التي دارت عليها الحرب.
الكتاب يسلط الضوء على قضية مركزية، وهي: العلاقة بين الدين والسلطة، وكيفية توظيف الدين في السياسات العالمية والشئون الدولية والصراعات العسكرية، وكيفية استغلال جماعات دينية بعينها استغلالاً جيوسياسياً وعملياً. وإذا ما طبقنا ذلك على موضوع الكتاب، فتصير القضية المطروحة: كيف تم توظيف الإسلام كقوة سياسية هائلة، يمكن أن تؤثر في مسار الحرب، لتصب في المصلحة السياسية والعسكرية والإستيراتيجية لألمانيا النازية.
وتقوم منهجية الدراسة المعنية – كما يشير ناشر الكتاب – على البحث عبر 3 محاور رئيسية: محور الفكر والأيديولوجيا الذي ناقش كيفية تفهم أجهزة الدولة الألمانية المتنوعة للدين عموماً وللإسلام خصوصاً؛ ثم المحور التنفيذي الذي درس الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل السلطات النازية الألمانية لتحقيق أهدافها السياسية والإستيراتيجية، عبر توظيف الإسلام والتودد للمسلمين؛ وأخيراً، محور دراسة التعبئة العسكرية المباشرة لمسلمي الأراضي المحتلة في أثناء الحرب، وتجنيدهم لحساب الجيش الألماني و”وحدات الحماية SS” التي تعتبر أكثر أفرع النظام النازي شراسةً.
القضايا والأفكار المُثارة
لم يقتصر الكتاب على الجانب التاريخي – كما هو وارد في كلمة الناشر – بل سلط الضوء على العديد من القضايا السياسية والفكرية المعاصرة، منها: العلاقة بين الاستشراق الألماني ومشروع توظيف الإسلام لحساب المصالح الألمانية في الحربين العالميتين، إذ بدأ المستشرقون الألمان في الحديث – بل الإسهاب – فيما يتعلق بالنقاط المشتركة بين “الجرمان” والإسلام، بل وصل الأمر إلى حديثهم عن نقاط المماثلة بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين “الفوهرر” Fuehrer.
وكذلك قضية تولي “وحدات الحماية” – أشد أفرع النظام النازي وحشية ودموية – الدعاية للإسلام، حيث وقع العبء الأكبر للمسألة الإسلامية، في البداية، على كاهل القوات المسلحة الألمانية ثم “وحدات الحماية” النازية التي أضحت، على نهاية الحرب، هي المسئولة الوحيدة تقريباً عن توظيف وتعبئة المسلمين.
وكذلك قضية استمرار توظيف الإسلام في الصراعات العالمية في العصر الحديث، وتشابه الحالة الألمانية في الحرب العالمية الثانية مع حالات أخرى تلتها في أثناء الحرب الباردة، حيث الحرب الأفغانية السوفيتية وتوظيف القطب الأمريكي للجهاد الأفغاني ضد القطب السوفيتي، ثم في حقبة ما بعد الحرب الباردة وتفرد القطب الأمريكي بقيادة العالم، وما تبعه من سياسات التوظيف الأمريكي للإسلام “المعتدل” أو “المدني” غير المقاوم.
وأيضاً، هناك قضية توظيف القوة الناعمة من أجل تحقيق أهداف القوة الصلبة. فألمانيا النازية لم تلجأ إلى توظيف الإسلام حباً في الإسلام، أو بناءً على قناعتها بشرعية وأحقية تحرر الشعوب المسلمة من القوى الإمبريالية المحتلة – إبان سقوط الخلافة العثمانية – وإنما بناءً على حاجتها السياسية والعسكرية لكسب الحرب ضد قوى الحلفاء. فاهتمام برلين النازية بالمسلمين ارتبط بتحولين ماديين، لا يمتان بأي صلة بقناعاتٍ أيديولوجية بالدين الإسلامي.
فأما التحول الأول، فكان التحول الجغرافي في عام 1942، حيث أضحت ديار الإسلام ساحات حرب بعد تحول الحرب الأوروبية إلى حرب عالمية، مما أدى إلى تحول الحزام الإسلامي الواصل بين الساحتين الآسيوية والأوروبية إلى ميدان حرب حاسم. وأما التحول الثاني، فكان التحول الإستيراتيجي حيث انقلب وضع الحرب ضد دول المحور، فسعت على أثرها ألمانيا النازية نحو تعبئة العالم الإسلامي، ودعم الانتفاضات الإسلامية المناهضة (القائمة حينذاك) لدول الحلفاء أو دول الخصم. وصار التودد نحو المسلمين سياسة ضرورية، تتبناها الدولة النازية من أجل إثارة الاضطراب خلف خطوط دول الحلفاء، مثل المستعمرات البريطانية في إفريقيا وآسيا، والتخوم الإسلامية غير المستقرة في الاتحاد السوفيتي.
أفضى هذان التحولان إلى شروع الحكم النازي في بناء تحالفات عسكرية براجماتية مع المسلمين، متجاوزاً الفوارق العرقية والأيديولوجية المترسخة في الذهنية النازية. كان الهدف العسكري المادي الصلب متمثلاً في سد النقص الحاد الحاصل في القوات الألمانية، على أثر هزائم “ستالنجراد” و”العلمين” من ناحية، ودخول الولايات المتحدة الحرب من ناحيةٍ أخرى.
إذن، فالدافع الصلب المادي والعسكري كان هو الدافع الأول والأخير الذي كان يتم مناقشته دوماً في الغرف المغلقة. وأكبر دليل على ذلك، تجنب السياسة الألمانية أي وعد باستقلال وطني للشعوب المسلمة القابعة تحت نيران الاحتلال الإنجليزي أو الفرنسي أو الروسي؛ إذ اكتفت السياسة الألمانية بمنح امتيازات دينية زهيدة الثمن، مثل السماح بإقامة الطقوس والشعائر والاحتفالات الإسلامية. وهي الحقيقة المرة التي اكتشفتها الرموز الإسلامية، وكذلك المجندون المسلمون، ولكن للأسف بعد فوات الأوان.
من ضمن القضايا التي كان يثيرها المؤلف باستمرار – بين دفتي كتابه – انتصار مسألة العرق على البراجماتية، رغماً عن كل التدابير السياسية التي اتُخذت لتحقيق العكس. فعلى الرغم من بذل القيادة النازية كل ما في وسعها لاستمالة المسلمين، وكسب قلوبهم وعقولهم، إلا أن تلك الجهود لم تؤتي ثمارها المرجوة. نعم، كان هناك تجنيد لآلاف المسلمين في القوات النازية الألمانية، إلا أن العدد الذي كان مرجواً لم يتحقق أبداً. فعلى سبيل المثال، أخفقت البروباجندا الدينية الألمانية في بلاد المغرب العربي، كما أخفقت في مصر، بل أخفقت عامةً في وسط الجماهير العربية. وكان من ضمن أهم الأسباب وراء تلك الإخفاقات، بروز مسألة العرق في مجال التعامل اليومي بين الجنود الألمان ونظرائهم المسلمين. فماكينة العنصرية العرقية التي كان قد أطلقها “هتلر” – منذ قدومه للحكم – لم تستطع التعامل مع فكرة التعايش مع العرق المسلم “الأدنى” (كما تتصور العقيدة النازية) في جيشٍ واحد. ومن ثم، كان التمييز هو سيد الموقف في كثير من الأحيان، مما أجبر العديد من المجندين المسلمين على الانفلات من الجيش الألماني، إما فراراً من الخدمة العسكرية أو التحاقاً غصباً بجيوش الحلفاء.
صفوة القول، إن بروباجندا الكراهية اليمينية التي كان قد زرعها الحكم النازي – من قبل الحرب العالمية الثانية – فاقت البروباجندا الدينية الألمانية التي أدارتها القوات المسلحة مع وزارة الخارجية لتثوير المسلمين ضد الإنجليز والفرنسيين والسوفييت واليهود.
مسألة نظرة المسئولين والباحثين الألمان تجاه الإسلام قضية أخيرة، كثيراً ما سلط “معتدل” الضوء عليها. فقد اتفق الجميع منهم على أن الإسلام دين قوي ومتماسك، وقوة سياسية بارزة في الشئون العالمية، وأن المسلمين حليف قوي لا حليف ضعيف، وأنهم فرصة لا تهديد. وقد برز الاهتمام السياسي منذ عهد الإمبراطورية الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر؛ كما برز الاهتمام البحثي من قبل معهد Geopolitik بين الحربين العالميتين، منتقلاً بعد ذلك إلى وزارة الخارجية الألمانية، وتحديداً مسئولي قسم الشرق في الإدارة السياسية، ثم إلى القوات المسلحة، وأخيراً إلى “وحدات الحماية”.
هيكل الكتاب وأقسامه
انقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول هو قسم “الأسس” الذي بحث أولاً في تعامل ألمانيا السياسي مع الإسلام منذ سياساتها الاستعمارية قبل عام 1914، ثم بحث ثانياً في الحملة الألمانية لتعبئة المسلمين في الحرب العالمية الأولى، ثم بحث ثالثاً في تجدد اهتمام صناع السياسة في برلين بالإسلام مع وصول الحرب إلى الأراضي الإسلامية في عام 1941.
أما القسم الثاني، وهو قسم “المسلمون في ساحات الحرب”، فكان دارساً لسياسات المانيا تجاه المسلمين في مناطق الحرب، مسلطاً الضوء على أهداف السياسات هناك، من السيطرة على الخطوط الخلفية غير المستقرة وتهدئتها في سياق وضع عسكري ألماني متدهور، إلى التحريض على المقاومة الإسلامية خلف خطوط العدو (دول الحلفاء) الأمامية.
وأخيراً، القسم الثالث – وهو قسم “المسلمون في الجيش” – فتناول خطط وأدوات تعبئة القوات المسلحة الألمانية و”وحدات الحماية” لمئات الآلاف من الجنود المسلمين، منذ عام 1941 فصاعدا، موضحاً كيف تم استقطاب وتنشيط جميع المسلمين الذين يصلون إلى أيدي “قوات الحماية”، من شرق إفريقيا حتى بلغاريا، للوصول في النهاية إلى هدفٍ واحد، وهو حفظ الانضباط العسكري، ورفع الروح المعنوية للجيش الألماني.
القسم الأول: الأسس
غطى القسم الأول فصلين، الفصل الأول “الأصول”، يتبعه الفصل الثاني “اللحظة الإسلامية في برلين”. في فصل “الأصول”، تناول “معتدل” أصول العلاقات الألمانية بالإسلام والمسلمين، والتي ترسخت منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث قامت السياسات الإمباطورية الألمانية حينذاك بتوظيف الإسلام لتعزيز السيطرة الإمبريالية على مستعمراتها في توجو والكاميرون وشرق إفريقيا، حيث كان يقطنها عدد ضخم من المسلمين. وكان من أهم سياساتها ترك البنى الإسلامية على حالها، والتعامل مع الإسلام باعتباره ديناً متحضراً، بل وفاعلاً دولياً. ثم جاءت الحرب العالمية الأولى، لتدشن فصلاً جديداً في علاقة برلين بالإسلام، إذ تم الشروع في تعبئة المسلمين عسكرياً، بالتعاون مع الخلافة العثمانية؛ وهو الأمر الذي شهد إخفاقاً واضحاً، كما سنرى.
ففي عام 1914 – 1915، أنشأ الجيش الألماني معسكرات خاصة بأسرى الحرب المسلمين في Wuensdorf وZosen جنوبي برلين، بهدف استقطابهم عبر منحهم حقوق دينية خاصة، مثل أداء الصلوات اليومية، والاحتفال بأعيادهم الدينية، ودفن موتاهم وفق الشريعة الإسلامية. ثم قامت السفارات والقنصليات الألمانية بنشر بروباجندا “الجامعة الإسلامية” في جميع أنحاء العالم؛ وتضامنت مع القسطنطينية في نشر رسالة الجهاد الملزمة، في داخل المساجد والأسواق؛ إلا أنها لم تلق آذاناً صاغية لدى جماهير المسلمين، بسبب افتقارها إلى المصداقية. لقد أخفقت البروباجندا الألمانية العثمانية، ولم تفلح في ترويج فكرة “الجامعة الإسلامية” في وسط عالم إسلامي غير متجانس، كما أورد المؤلف.
وبعد خسارة المانيا في الحرب العالمية الأولى، انتقلت العلاقة إلى ساحات البحث العلمي والأكاديمي، حيث تم تدشين معهد Geopolotik الذي أسس – ولأول مرة – مصطلح Islampolitik أو أشكال السياسات الموجهة نحو الإسلام، معتبراً إياه فاعلاً عالمياً “من الدرجة الأولى”، وقوة جيوبوليتيكية سياسية. وكان لتلك النقاشات الدائرة في المعهد حينذاك – في حقبة ما بين الحربين العالميتين – أثر فعال على صناع السياسة النازية.
كذلك كانت لدعوة الدبلوماسي الألماني المخضرم المتقاعد Max von Oppenheim، بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وبالضبط في 25/7/1940، أثر آخر على صناع السياسية النازية، إذ ركزت الدعوة على الضرورة الملحة لتجنيد المسلمين بالجيش الألماني، خاصة في ظل تحول مجريات الحرب لصالح دول الحلفاء.
Oppenheim من القلة التي شكلت السياسة الألمانية تجاه الإسلام في أواخر العهد القيصري الألماني. صدرت دعوته المعنية في أثناء الحرب العلمية الثانية، وتحديداً بعد سقوط فرنسا مباشرةً، وبدء المعركة مع بريطانيا. ركزت دعوته – إلى وزارة الخارجية الألمانية – على تحريض الأقاليم الإسلامية (التي تحوزها دول الحلفاء) على التمرد والثورة. باختصار، لقد دعا الدبلوماسي المتقاعد إلى إطلاق إستيراتيجية شاملة لتعبئة العالم الإسلامي ضد الإمبراطورية البريطانية، وإثارة المسلمين في كامل الممر الإسلامي الواصل بين مصر والهند، والتعاون مع رموز دينية مؤثرة مثل “شكيب أرسلان” داعية مفهوم (الجامعة الإسلامية)، و”أمين الحسيني” مفتي القدس.
أما في فصل “اللحظة الإسلامية في برلين”، فقد تناول المؤلف اللحظة الفعلية التي بدأت فيها برلين الاهتمام بالدور الإستيراتيجي للإسلام؛ وكان ذلك في عام 1941، بعدما أخفق الحليف الإيطالي في شمال إفريقيا، مما دعا بل أجبر برلين على سرعة التصرف، وإيجاد حل سريع لوقف تدهور الوضع العسكري لدول المحور هناك. فكان هذا الحل السريع متمثلاً في قيام برلين بالتورط في شمال إفريقيا، ثم تقدمها نحو المنطقة العربية. وكان هذا التورط آذاناً بتوسيع السياسات الألمانية تجاه الإسلام، واستقطاب أكبر عدد من المسلمين – عبر البروباجندا الدينية – لتوظيفهم في الحرب ضد دول الحلفاء. كان هذا التورط آذاناً بالتعرف على الأهمية الإستيراتيجية للمسلمين القابعين تحت نيران دول الحلفاء.
في هذه “اللحظة الإسلامية”، اندفعت الدولة الهتلرية بكامل قوتها وأدواتها – وزارة الخارجية والقوات المسلحة و”وحدات الحماية” – لتنخرط في مخططات واسعة لتوظيف الإسلام. اندفعت اندفاعاً لم يكن مخططاً له، بل تطور في غضون الحرب، معتمداً على ما سبق من التقاليد السياسية الألمانية المترسخة منذ الحقبة الإمبراطورية في أواخر القرن التاسع عشر. إلا أن برلين، هذه المرة، لم توظف الإسلام فقط بغية السيطرة – كما كان الحال في العهد الإمبراطوري – بل وظفته أيضاً بغية التعبئة النشطة، كما أورد المؤلف.
فقد كان “هتلر” ومدير أمن مكتبه “هملر” معجبين أشد الإعجاب بتراث الإسلام البطولي في حروب الجهاد والفتوحات الإسلامية، مما حفزهما على توظيف ذلك بشتى الصور في الحرب الدائرة، بل دفعهما دفعاً نحو تجاوز معضلة الأيديولوجية العنصرية النازية في سبيل البراجماتية والمصالح المادية الإستيراتيجية. لقد تجاوز النظام النازي عقيدته العنصرية التي كانت تعتبر الشعوب غير الأوروبية شعوباً عفنة، منحطة عرقياً. فقام بتعديل تعبير “معاداة السامية” إلى “معاداة اليهود”، معتبراً العرب “أبناء عرقٍ رفيع ذي ماض عريق تليد”؛ كما تجاوز “تشريعات Nuernberg”” (تشريعات حماية الدم والشرف الألماني)، مستثنياً الأتراك والإيرانيين والعرب من القيود العرقية النازية في يونيو عام 1936. هذا فضلاً عن الكتابات النازية – والتي ساهم فيها كُتاب الـGeopolitik بشكلٍ كبير – التي قدمت تأويلات أيديولوجية للتاريخ الإسلامي، والتي أشارت إلى أوجه التقارب بين النازية والإسلام. في النهاية، أسفر ذلك كله عن إعلان الحزب النازي صراحةً، في سبتمبر 1943، قبول أعضاء “مسلمين” بين صفوفه.
ويجدر الإشارة هنا – كما كان “معتدل” يؤكد دوماً – أنه لولا صدورة مذكرة Oppenheim في عام 1940، ثم تطور مجريات الحرب لصالح دول الحلفاء، ما كانت برلين اهتمت بسياسات توظيف الإسلام. وأكبر دليل على ذلك، هو دعم برلين النازية لحليفها الإيطالي في احتلاله لدول المغرب العربي، وكذلك دعمها مُسبقاً لتهجير اليهود نحو فلسطين.
القسم الثاني: المسلمون في ساحات الحرب
في هذا القسم، يبحث “معتدل” في السياسات والأدوات التي استخدمتها المانيا النازية لاستقطاب المسلمين في ساحات الحرب، مركزاً على ثلاث مناطق رئيسية: شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ الجبهة الشرقية المتمثلة أساساً في القرم والقوقاز ثم تتلوها بقية الأقاليم الشرقية التي احتلتها المانيا النازية من الاتحاد السوفيتي؛ وأخيراً البلقان.
ففي فصل “الإسلام والحرب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط” (وهو الفصل الثالث)، تحدث المؤلف عن البروباجندا الدينية الألمانية التي استهدفت الجنود المسلمين بالمستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا، والتي تنوعت بين ما هو مطبوع وبين ما هو إذاعي لتجاوز أولاً عقبة الأمية بين المسلمين، ومخاطبة ثانياً كل بلد إسلامي باللغة التي تثيره ضد كل من الإنجليز والفرنسيين والروس واليهود، والذين أسمتهم البروباجندا بالإمبرياليين. ورُغماً عن العمل الدءوب للمسئولين الألمان في إنجاح تلك البروباجندا، إلا أنها أخفقت – بامتياز – في إثارة الانتفاضات والثورات المرجوة. ولعل أهم أسباب ذلك الإخفاق، كما أوضحنا من قبل، يكمن في عدم قناعة الجنود الألمان بتلك “الإرشادات” الفوقية؛ أولئك الجنود الذين أُشربوا في قلوبهم بروباجندا العنصرية النازية اليمينية لسنواتٍ طويلة، ويكمن ثانياً في عدم مصداقية تلك البروباجندا في وسط الكثير من المسلمين.
وكما يوضح المؤلف في الفصل الثالث، فقد تقدمت المانيا النازية تجاه شمال إفريقيا لمنع كارثة عسكرية، بعد تراجع القوات الإيطالية أمام نظيرتها البريطانية في أواخر عام 1940. فلم يكن لدى القيادات العسكرية الألمانية إلا أن تسرع في نشر “الفيلق الإفريقي” Panzerarmee Afrika بقيادة Rommel، مصحوباً بحملة دينية دعائية ضخمة، أدارتها وزارة الخارجية مع القوات المسلحة. لقد أدركت برلين حينئذٍ الأهمية الإستيراتيجية للمسلمين بطول الطرق الساحلية (على البحر المتوسط) خلف خطوط العدو الأمامية؛ فعزمت وعملت على استهدافهم عبر توجيه بروباجندا مكثفة نحوهم، تقول باختصار أن المانيا صديقة للإسلام، بينما “الحلفاء” هم ألد أعدائه.
استهدفت برلين أسرى المسلمين من الجنود في شمال إفريقيا، والذين وصل عددهم إلى 90 ألف أسير؛ فإذا بها تمنحهم امتيازات دينية خاصة تفسح لهم متسع المجال لأداء شعائرهم الدينية؛ ثم تحضهم في نفس الوقت – عبر المنشورات ومكبرات الصوت والبطاقات البريدية – على الثورة على حكامهم المحتلين من الفرنسيين والإنجليز. وكان جنود المستعمرات الفرنسية بشمال إفريقيا (الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الفرنسي) من بين أوائل المسلمين الذين استهدفتهم البروباجندا الألمانية في الحرب العالمية الثانية.
وقد تفننت القيادات الألمانية في إيجاد الأدوات الدعائية التي تستميل قلوب وعقول المسلمين؛ وهو ما رصده المؤلف بالتفصيل. فمن منشورات “هتلر حامي الإسلام” إلى مكعبات السكر المغلفة بعبارات سياسية تقول “بعون الله، انتصار المانيا محتم”، إلى أنشودة “لا مسيو ولا مستر، الله بالسما وفي الأرض هتلر”، إلى المنشورات الخضراء وشكل الخُميسة، إلى قناة برلين الإذاعية الموجهة باللغة العربية الفصحى لمسلمي المنطقة العربية. وفوق تلك الأدوات، أدوات أخرى كثيرة وعديدة، سردها المؤلف بتأنٍ وصبرٍ، ليُرينا مدى السعي والجهد والوقت الذي بذله الألمان لخطب ود المسلمين، بغرض تجنيدهم.
وكان ما هو مخطط له، تحويل القاهرة إلى مركز جديد للبروباجندا الدينية الألمانية في العالم الإسلامي، واستقطاب علماء الأزهر، إلا أن هزيمة العلمين أمام الجيش البريطاني أحبط المخطط الألماني. فما كان من جيش Rommel إلا أن ينسحب من الصحراء الليبية المصرية إلى تونس، مستأنفاً الأنشطة الدعائية تجاه المسلمين.
لكن لم يكن الأمر بسيطاً أو سهلاً، كما تصورت القيادات الألمانية؛ إذ تولدت عقبات عديدة حالت دون وصول البروباجندا الدينية إلى المسلمين المستهدفين، كما أورد “معتدل“. منها عقبات فنية، تمثلت في قلة عدد أجهزة المذياع التي كانت أداةً رئيسية لبث البروباجندا، ولا سيما لدى الأميين من المسلمين. ومنها عقبات تمثلت في طول فترات انقطاع الكهرباء في المقاهي التي تمتلك أجهزة المذياع، وعدم القدرة على التقاط الموجات بسبب جهود التشويش المكثفة من قبل “الحلفاء” الذين كانوا يحكمون المنطقة. كذلك كانت هناك عقبات فكرية نفسية، تمثلت في عدم اقتناع المستمع المسلم بتلك البروباجندا التي رآها مفتقدةً لكل عوامل الأصالة والمصداقية، ولا سيما فيما يتعلق بالنبرة العدائية واللهجة السوقية، التي استخدمتها البروباجندا، والتي لم تجذب النخب المتمدنة خاصة. وأكبر دليل على ذلك، صمت العلماء والمراجع الدينية، مع استثناءات قليلة، وامتناع المؤسسات والتنظيمات الدينية عن إصدار بيانات رسمية. هذا فضلاً عن الواقع السياسي الذي كان يعمل لصالح دول الحلفاء لا دول المحور، إذ حارب غالبية المسلمين في شمال إفريقيا والمنطقة العربية تحت الراية البريطانية؛ فقاوموا “موسوليني”، ومن ثم حليفه “هتلر”؛ منهم السنوسية (أقوى الجماعات الدينية تأثيراً في المنطقة) الذين دعموا “الحلفاء” بعدما كانوا يحاربونهم في الحرب العالمية الأولى.
وإذا كانت البروباجندا الألمانية قد شهدت إخفاقاً واضحاً في المنطقة العربية بشكلٍ عام، فإنها لم تشهد مثل هذا الإخفاق لدى مسلمي “الجبهة الشرقية” و”البلقان”؛ بل إن المسلمين هناك قد قاموا فعلياً بالترحيب بالغزو الألماني لبلادهم، وإجلاء السوفييت الذين جثموا على أنفاسهم طيلة عشرين عاماً، أذاقوهم فيها شتى أنواع الاضطهاد والتمييز والإقصاء. فكان وضع المسلمين هناك كمن استعان بالرمضاء على النار؛ وقد استغلت برلين ذلك استغلالاً بارعاً، كما أظهر المؤلف في فصله الرابع “الإسلام والحرب على الجبهة الشرقية”.
ففي هذا الفصل، تناول المؤلف بإسهاب كيف استغلت المانيا النازية تعطش المسلمين هناك لأداء طقوسهم الإسلامية، بعد منعهم عنها قرابة عقدين من الزمان، وكيف تحولت المسألة الدينية إلى سمة أساسية للاحتلال الألماني هناك. ففي القوقاز، سجلت المانيا أقوى محاولة لإظهار نفسها نصيرة للإسلام. أما في القرم، فقد سجلت المانيا أطول السياسات عمراً في التوجه نحو الإسلام في الشرق، وأكثرها إحكاماً. ولم لا؟ فإن المنطقتين تحوزان على أهمية قصوى بالنسبة لروسيا والمانيا دوناً عن بقية الأقاليم الشرقية المحتلة.
فالإسلام في القرم والقوقاز مفتاح رئيسي لمعارضة الدولة المركزية الروسية ومقاومتها منذ توسع دوقية موسكو في القرن السادس عشر على حساب المناطق المسلمة في إقليم الفولجا والأورال، ثم الضم القيصري للقرم والقوقاز في القرنين الثامن والتاسع عشر، ثم توسع روسيا في القرن التاسع عشر إلى آسيا الوسطى. ولذا، كان تقدم “هتلر” نحو القوقاز في صيف 1942 مقلقاً للسلطات الروسية على خاصرتها الجنوبية المسلمة التي تعد مهاداً محتملاً للتمرد الإسلامي ضد السياسات الروسية التي هدمت أكثر من 20 ألف مسجد في الأراضي الإسلامية، أو حولتها إلى مكتبات ومطاعم ونوادٍ. أما بالنسبة لألمانيا، فإن القوقاز ذات الطبيعة الجبلية كانت مهمةً لضمان استقرار مؤخرة الجيش الألماني؛ بينما مثلت القرم موقعاً إستيراتيجياً حساساً على البحر الأسود، وخلف خط النار؛ فكانت مهمةً لحفظ استقرار الخطوط الخلفية.
وكان التحكم الألماني في القرم، كما يقول المؤلف، متمثلاً في تأسيس مجالس دينية للمسلمين، للإشراف على خطط بناء المساجد وتجديدها، وتأسيس المدارس الإسلامية الجديدة؛ ولكن تحت رقابة ألمانية صارمة، لمنع أي مسعى لانفصال التتر السُنة، وتأسيسهم دولة إسلامية مستقلة في شبه جزيرة القرم. بل وصل الأمر إلى تأسيس المانيا النازية “دار إفتاء القرم” لممارسة المزيد من التحكم في التتر؛ وهو ما يدلل على سعي الحكم الألماني نحو مأسسة الإسلام بهدف السيطرة عليه. وأكبر دليل على ذلك، هو رفض المانيا محاولات سعي مسلمي القرم والقوقاز نحو الاستقلال.
لقد بلغت درجة “التوظيف” في القرم والقوقاز إلى حد إدماج الرمزية الدينية بالرمزية النازية. لقد وصل “التوظيف” لدرجة أن يُسمر، فوق القرآن الكريم، نسر الـReich (الرايخ) الخشبي مع الصليب المعقوف، ولدرجة أن يقسم مسلمو القوقاز – في وسط احتفالاتهم بعيدي الفطر والأضحى – على عزمهم القتال في صفوف القوات المسلحة الألمانية.
إلا أن وقائع الحرب العنيفة، وتعصب الجنود الألمان ضد شعوب الاتحاد السوفيتي الآسيوية جاءت مناقضةً تماماً لجميع تلك المظاهر العلنية، مما جعل مسلمي القرم والقوقاز يدركون تمام الإدراك أن الألمان ليسوا إلا غزاةً وإمبرياليين مثل غيرهم من الروس والإنجليز والفرنسيين. ومما أضاف الطين بلة، نبذ الألمان التتر – مع نهايات الحرب – بل وقصف قراهم مخافةً من اختراق “البارتيزان” (شيوعيو “تيتو”) لمواطن التتر. وانتهى الأمر بهم، أن صاروا فريسةً بين سندان الروس الذن انتقموا منهم بوحشية (نتيجة التحاقهم بالجيش الألماني) ومطرقة الألمان الذين تركوهم يواجهون ويلات الحرب وحدهم.
وأخيراً، كانت منطقة البلقان محل دراسة “معتدل”، وهي المحطة الثالثة والأخيرة للكشف عن سياسات وأدوات المانيا النازية في توظيف الإسلام؛ وهو ما تجلى في الفصل الخامس “الإسلام والحرب في البلقان”. فكما تورطت المانيا النازية عسكرياً في شمال إفريقيا و”الجبهة الشرقية” – نتيجة تصاعد وتيرة الحرب في أواخر 1942 – تورطت عسكرياً في البلقان. وكما رحب مسلمو القرم والقوقاز بالغزو الألماني، رحب مسلمو البلقان بغزو الألمان لينقذوهم من بطش ثلاثة أعداء: الكروات الأوستاشا، ميليشيات التشيتنيك وهي الصرب الأرثوذكس المسيطرة على مملكة يوغوسلافيا حينذاك، وشيوعيي “تيتو” أو (البارتيزان). وقاد “هتلر” البروباجندا الدينية هناك، كما قادها في المنطقتين الأخريتين، معتمداً تارةً على فكرة دمج الإسلام بكراهية اليهود، العدو المشترك بين النازيين والمسلمين، وتارةً على توظيف جولة المفتي “أمين الحسيني” في 1943 لإسباغ الشرعية على الحرب التي سيقاتل فيها المسلمون إلى جانب الألمان، وتارةً على دعم فكرة “الوحدة الإسلامية” باعتبار أن مسلمي البلقان طرف مهم في الأمة الإسلامية، لا يقلون أهميةً عن مسلمي فلسطين في واجبهم الجهادي لتحريرها من الاحتلال.
وقد أبدى مسلمو البلقان رغبتهم في بناء حكم ذاتي إسلامي للعيش في محمية ألمانية، كما كان الحال في عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية. فها هو “محمد الخانجي”، رئيس (جمعية الهداية)، شارعاً في الدعوة لخطة استقلالية عن الدولة الكرواتية، ملتمساً مساعدة المانيا، مخططاً لدولة إسلامية مستقلة تحت حماية “هتلر”. وها هو “محمد بانجا”، عضو (جمعية الهداية) مطالباً أيضاً بتحقيق الحكم الذاتي لمسلمي البلقان تحت الحماية الألمانية.
لم تكن القيادات الألمانية عازمةً على التفاعل مع مسلمي البلقان لولا حدوث تحولات جذرية في ميدان المعركة في أواخر 1942. كان أولها خروج أجزاء من الدولة الكرواتية (دولة الأوستاشا) عن السيطرة، وبالأخص البوسنة والهرسك (دولة الأوستاشا كانت تحكم الأراضي الإسلامية في البوسنة والهرسك)، مما أدى إلى إدراجهما تحت القيادة العسكرية الألمانية. وكان ثانيها تغير موقف إيطاليا وانسحابها من البلقان، مما أفضى إلى استيلاء المانيا رسمياً على السنجق. فكانت النتيجة أن سيطرت المانيا على كلٍ من البوسنة والهرسك والسنجق.
ورُغماً عن معارضة إيطاليا ونظام الأوستاشا ووزارة الخارجية الألمانية توظيف الإسلام في البلقان – خوفاً من أن يفضي ذلك إلى إقامة دولة مسلمة في المنطقة – إلا أن القيادات العسكرية الألمانية أصرت على موقفها في استقطاب المسلمين هناك. وليس أدل على ذلك من جولة المفتي “أمين الحسيني” في مارس أبريل 1943 الذي أرسلته “وحدات الحماية” إلى دولة الأوستاشا، حيث المناطق التي يقطنها المسلمون، من أجل تعبئة ذكورهم في الجيش الألماني، من خلال استخدام خطاب إسلامي جامع، يشير إلى وحدة المعركة، وهو عين ما رغب فيه المسئولون العسكريون الألمان. هذا فضلاً عن إتاحة الفرصة للمفتي بتأسيس مركز إسلامي في زغرب، ليصير منطلقاً لبث البروباجندا الدينية التي تناشد المسلمين بدعم “المحور”.
ومع تصاعد الانخراط العسكري الألماني في البلقان، بدأت القيادات العسكرية الألمانية في تكثيف البروباجندا الدينية التي اعتمدت بالذات على تناول “البلشفية” – بشكلٍ عام – باعتبارها العدو الملحد والمشترك للإسلام والمانيا، مما يقتضي انضمام المسلمين لفرقة “وحدات الحماية” في سبيل تحرير الوطن والإسلام من الأعداء البلاشفة، كما تصور البروباجندا الألمانية. وفي ذلك، استخدمت القيادات الألمانية المنشورات، مثل منشورات “حي على الفلاح”، والملصقات الدعائية في الشوارع والميادين والقطارات، كما استخدمت الصور والرسومات الدينية كبروباجندا بصرية تصل إلى الأميين.
وكما استغلت المانيا النازية المؤسسات والهياكل الإسلامية في “الجبهة الشرقية”، استغلتها بالمثل في البلقان؛ ولعلها بدرجة أكثر تيسيراً وتأثيراً. فالبلقان تتميز بتماسك مؤسساتها وشبكاتها الإسلامية على عكس القوقاز والقرم، ومن ثم سهُل استغلالها وتوظيفها من قبل “وحدات الحماية”. وكما خاب أمل الهياكل والرموز الإسلامية في برلين النازية في “الجبهة الشرقية”، مع تطور أوضاع الحرب ضد دول المحور تدريجياً، خاب أمل نظيرتها في البلقان، إذ تحول المسلمون في كلتا المنطقتين هدفاً للهجمات الانتقامية من جميع الأطراف، سواءً من “الحلفاء” أو “المحور”. فها هو “بانجا” يرتحل إلى الغابات، مؤسساً “حركة التحرير الإسلامية”، وداعياً للدفاع المسلح عن النفس، بهدف الاستقلال الإسلامي، منادياً المسلمين بالقتال “معتمدين على إيمانهم بالله وعونه بشجاعة وبسالة” في سبيل البقاء.
القسم الثالث: المسلمون في الجيش
ينتقل الكتاب في القسم الثالث إلى الحديث عن وسائل التعبئة للمسلمين في داخل الجيش الألماني، موضحاً إصرار “وحدات الحماية” – بالذات – على المضي قدماً نحو خطط التعبئة رُغماً عن وجود معوقات كثيرة تحول دون ذلك، مما جعلها تصطدم – على نهاية الحرب – بالواقع المرير.
ففي الفصل السادس “تعبئة المسلمين”، وصف المؤلف الحملة الألمانية للتعبئة كأكبر حملة تعبئة للمسلمين، قامت بها قوة غير إسلامية في التاريخ، متجاوزة جهود جيش الدفاع الوطني الألماني في الحرب العالمية الأولى. لقد أفضت تصورات “هتلر” الأيديولوجية الإيجابية عن الإسلام إلى تشكيل وحدات وفيالق إسلامية غير ألمانية، ولكن لأهداف ومصالح مادية عسكرية بحتة. وقد تولت “وحدات الحماية” هذه المسئولية؛ فشرعت في إنشاء فرق إسلامية تابعة لها في البوسنة عام 1943. وكان أولها “فرقة الخنجر” التي استهدفت شحذ بقية العالم الإسلامي لصالح الحرب الألمانية. كان الغرض منها إعلام “العالم المحمدي أجمع” أن الـReich الثالث مستعد لمواجهة العدو المشترك بين الإسلام والاشتراكية القومية، وهو العدو البلشفي. كذلك تم استخدام هذه الفرقة في العمليات العسكرية الألمانية ضد شيوعي “تيتو” في شرق البوسنة.
كما شرعت “وحدات الحماية” في إنشاء فرقة إسلامية تابعة من مسلمي الاتحاد السوفيتي بهدف شحذ بقية العالم الإسلامي، وإشعال لهيب الثورة ضد “الحلفاء”، وشحذ جميع مسلمي الاتحاد السوفيتي ضد موسكو، مستغلةً عشقهم للحرية وتعاليم الإسلام؛ وهو ما فاق أمثالهم من العرب الذين لم تستطع “وحدات الحماية” تجنيدهم، كما أورد المؤلف.
لقد تم تجنيد مئات الآلاف من المتطوعين غير الألمان، من جميع أنحاء اراضي المحتلة في الشرق (الاتحاد السوفيتي) في الفترة ما بين أواخر عام 1941 حتى نهاية الحرب؛ هذا بالإضافة إلى تجنيد الآلاف من أسرى الحرب. فتشكلت في النهاية وحدات حماية قرمية وتركية وقوقازية في الشرق، ووحدات ألبانية وبوسنية في البلقان، كان العنصر الإسلامي هو المهيمن في الكثير منها. ووفقاً لبعض التقديرات، وصل عدد المسلمين المقاتلين في صفوف القوات المسلحة الألمانية إلى 400 ألف مسلم: من تتر الفولجا إلى المسلمين التركستانيين إلى مجندي القوقاز وأذربيجان وجورجيا إلى الآذريين. وقد انتشرت الكتائب الميدانية الإسلامية بطول القارة الأوروبية وعرضها، وعل جبهات الغزو الفرنسية والإيطالية، وفي البلقان.
كان للمسلمين خصوصية واضحة في عملية التعبئة بالقوات المسلحة الألمانية، إذ ارتابت برلين في متطوعي الاتحاد السوفيتي والأرمن، بينما كانت ثقتها غير مشروطة في المسلمين، أو كما قال “هتلر”: “لا آمن أحداً إلا المحمديين”. فالخصائص القتالية، التي عززها الإسلام في المسلم،أجبرت القيادات الألمانية على “استغلالهم إلى أقصى حد”، الأمر الذي انعكس في تشكيل الوحدات والفيالق؛ فصار المسلمون أكبر جماعة دينية بين مجندي القوات المسلحة الألمانية من الشرق. ومن ثم، كان تجنيد المسلمين لا لتعويض الخسائر البشرية في الجيش الألماني، ولا للدعاية فقط، بل أيضاً لما في الدين الإسلامي من اعتبارات كثيرة تحض على القتال والجهاد.
وقد ركزت “وحدات الحماية” – في خطط التعبئة – على توظيف كبار المسلمين، من علماء وزعامات وأئمة، لما يتمتعون به من مصداقية؛ إذ تم استقدامهم من الشرق إلى برلين لمناشدة أسرى الحرب والمدنيين المسلمين الانضمام إلى صفوف الجيش الألماني. وأما عملية التجنيد الفعلية، فقد تم وضعها كليةً بين أيدي الأئمة، كما أورد “معتدل” في الفصل السابع “الإسلام والسياسة في الوحدات”؛ حيث صار الأئمة الميدانيون أجهزة بث للبروباجندا السياسية والدينية لصالح المانيا.
وتابع “معتدل” أدوات التوظيف في الفصل السابع، متناولاً مدارس تأهيل الأئمة التي أقامتها “وحدات الحماية”، بهدف تعليمهم تعليماً إسلامياً منظماً في إطار مؤسسي ألماني، مصبوغاً بأهداف برلين السياسية. هذا بالإضافة إلى إقامة الدورات الدينية على الأراضي الألمانية، توسيعاً لنطاق مشروع برلين الإسلامي في الفترة الأخيرة من الحرب.
أقامت المانيا مدارس الأئمة أو “الملالي”، كما أسماها الألمان، لتأهيل الأئمة إسلامياً بما يتناسب مع مصالح المانيا العسكرية والإستيراتيجية في الحرب؛ منها المركز الإسلامي للتعليم الديني بمدينة Guben في Brandenburg ، ومدرسة الملالي في Dresden، ودورات للملالي في بعض ثكنات الجيش الألماني في Goettingen، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤل مهم، بحسب المؤلف: كيف يقوم الماني غير مسلم بتفقيه المسلمين في دينهم لمجرد قدرته على قراءة القرآن بالعربية أو وعيه بتاريخ المسلمين وتقاليدهم؟
كانت نتيجة توظيف الأئمة الميدانيين العسكريين، كما يشير “معتدل”، تأسيس هرمية دينية لم تكن معروفة في العالم الإسلامي، وإنتاج دين عسكري التنظيم، أضحى فيه هؤلاء الأئمة ركائز للسيطرة على الوحدات الإسلامية، وقمع أية حركات للتمرد.
ورُغماً عن جميع تلك الجهود، لم تحقق خطة التعبئة الألمانية النسب المتوقعة، مما ألجأ “وحدات الحماية” إلى تسجيل بعض المسلمين غصباً في بعض المناطق، وتجنيدهم إجبارياً من المساجد. والسبب في ذلك باختصار، كما يفسر المؤلف، أن دوافع تطوع الجنود المسلمين لم تكن كلها دوافع دينية جهادية بحتة، كما كانت تعتقد القيادات النازية. إنما كانت هناك دوافع دنيوية أخرى، مثل الحصول على راتب شهري وطعامٍ يومي، بدلاً من معاناة الجوع والصقيع والمرض في معسكرات الجيش الأحمر، ومثل التماس الحماية لدى الجيش الألماني من قطاع الطرق و”البارتيزان”.
وتوسع التوظيف ليصل إلى الضباط (مسلمين وألمان) بهدف التعاون مع الأئمة في التلقين العقائدي للجنود المسلمين، كما أوضح المؤلف في فصله الثامن والأخير “الإسلام والبروباجندا العسكرية”. وفي خضام ذلك، قامت القوات المسلحة مع “وحدات الحماية” بالبروباجندا المطبوعة، وإصدار كم ضخم من المنشورات الدعائية، وتوزيعها على الجنود المسلمين. اعتمدت تلك البروباجندا أساساً على إصدار الجرائد العسكرية الدورية بلغات مختلفة، لشتى الشعوب المسلمة، وتم التركيز فيها على مقالاتٍ، كتبها كُتاب مسلمون متعاونون مع “وحدات الحماية”. هذا بالإضافة إلى تضمن تلك الجرائد صوراً فوتوغرافية للمباني الإسلامية المركزية لكل مسلم: من الكعبة إلى المسجد النبوي إلى المسجد الأقصى.
صدر من كل جريدة قُرابة المئة عدد طوال الحرب؛ فمن جريدة (الاتحاد التركي) باللغة التركية إلى جريدة (أذربيجان) للفيلق الآذري إلى جريدة (غزوات) للفيلق القوقازي الشمالي. ركزت المقالات في تلك الجرائد على تثقيف جنود الفيالق عن الإسلام باعتباره الركن الركين للثقافة القومية، وعلى ترويج فكرة “الأمة الإسلامية العالمية”، وعلى نقل سرديات المقاومة الإسلامية التاريخية في العهد القيصري؛ ومنها بطولات الإمام شامل الذي كان قد أسره النظام القيصري؛ هذا فضلاً عن نقل أخبار العالم الإسلامي الأوسع، يصاحبها صور فوتوغرافية تتناول حياة الجنود وقراهم ومساجدهم، وصور الأماكن المقدسة ومراكز الإسلام العالمية. كذلك اعتمدت البروباجندا العسكرية على الكتب الدعائية التي وزعتها القيادات الألمانية على مجنديها المسلمين، أبرزها كتاب “الإسلام واليهودية” الذي يؤطر كراهية اليهود للدين.
في ظل البروباجندا العسكرية، قامت برلين بإعطاء دورات تدريبية للضباط – مسلمين وألمان – تمكنهم من التأثير “الإسلامي” على الجنود المسلمين عبر آليات دعائية عدة، أهمها: تقديم تأويل إسلامي للحرب وجعلها بمنزلة الفريضة الدينية؛ صياغة غايات المسلمين لتنسجم مع نظائرها لدى الجيش النازي؛ إقناع الجنود المسلمين بأنهم ليسوا مرتزقة يحاربون في جيش كافر، وإنما جنود يقاتلون في سبيل قضيتهم.
ورُغماً عن المساعي المبذولة في تلك البروباجند العسكرية الضخمة لخطب ود المجندين المسلمين، تفيد بعض المصادر – كما يوضح المؤلف – بوجود صور شديدة الوضوح للتمييز الديني بالوحدات الإسلامية. فعلى سبيل المثال، كانت العقوبات المهينة تنزل بحق الأئمة، وكانت ألفاظ السباب مثل “خنازير” و”زنوج” و”همج” و”خونة” تطلق على المجندين المسلمين. “لم يكن من السهل تجاوز سنوات من التلقين النازي والبروباجندا العنصرية” (399).
وكما اعتاد “معتدل” أن يختتم كلامه – في معظم الفصول – فإن نهايات الحرب ضربت بجميع تلك الجهود “التوظيفية” عرض الحائط، وآل أمر المجندين المسلمين – بل والأئمة أيضاً – إلى أسوأ حال، حيث تم “بيعهم” من قبل الجميع، سواء دول المحور أو دول الحلفاء، مما دفع العديد منهم إما إلى الفرار من الخدمة العسكرية، أو الانتحار، أو ترحيلهم إجبارياً إلى معسكرات الجيش الأحمر المنتصر على المانيا النازية.
وكما خاب أمل الجنود والأئمة المسلمين في وعود المانيا النازية، بتحريرهم من المحتلين البلاشفة واليهود والإنجليز والفرنسيين، فقد خاب أيضاً أمل “هتلر” ذاته (وبالذات “وحدات الحماية”)، سواءً في الانتصار على دول الحلفاء، أو في القدرة على توظيف وحشد المسلمين في الحرب كما كان مرجواً. فالآمال العريضة التي عقدها “هتلر” على تدين عموم المسلمين، وتشبثهم بحلم الوحدة الإسلامية، وبحلم التحرر من براثن الاحتلال، لم يكن لديها تماس مع واقع العديد من المسلمين؛ وهو ما أوردته التقارير الميدانية، والتي لم تهتم بها “وحدات الحماية”، ولكن اضطرت إلى تصديقها بعد نهاية الحرب، كما أكد المؤلف.
اختتم المؤلف كتابه مؤكداً أنه بالرغم من فشل محاولات المانيا النازية لاستقطاب المسلمين على نطاق واسع – كما كانت تطمح – إلا أن توظيفها يعتبر من أنشط المحاولات عبر التاريخ الحديث. واللافت للنظر، أن فشل تلك المحاولات لم يمنع القوى العظمى – فيما بعد – من الاستمرار في توظيف الإسلام إلى اللحظة التي نعيشها الآن.
ما بعد القراءة
بعد قراءة الكتاب، استثارتني عدة مسائل، واستفزتني عدة تساؤلات، أود طرحها بين يدي القاريء؛ لعل أولها مسألة الولاء والبراء، وحتمية جريان سنن الله على من يتولى ظالماً فاسداً معتدياً حتى ولو كان حُسن النية هو سبب المولاة. فتولي الظالمين الفاسدين العنصريين المعتدين، حتى ولو في معركة عادلة (معركة التخلص من الاحتلال)، يصير آذاناً بخسران القضية برمتها في نهاية الأمر، حتى ولو بدت البدايات مبشرة ومحفزة. فإن تولي المسلمين الجيش الألماني النازي العنصري المتوحش، حتى ولو كانت الغاية هي التحرر من القوات الإمبريالية المحتلة (دول الحلفاء)، هو بمثابة تبرير الغاية بالوسيلة؛ وهو مبدأ الإسلام منه براء؛ فدين الله ومنهجه ينكران هذا المبدأ كليةً.
هذا بالإضافة إلى مسألة الشرك في النية التي تفسد العمل وتحبطه، وتعيد صاحبه خسراناً متحسراً، كما حدث للجنود والضباط والزعماء المسلمين على نهاية الحرب. فكيف تكون الحرب في سبيل الله وفي سبيل “الفوهرر” في آنٍ واحد، ثم يصير النصر حليفاً للمسلمين؟ ملخص الأمر، إن الهزيمة بحق المسلمين كانت لابد وأن تقع، لكونها تتفق مع سنن وقوانين الله في كونه. فالمسلم حيما يتولى أحداً دون الله، ويطلب النصرة من غير الله – سواءً كان هذا النصير الآدمي ظالماً أو غير ظالم – لابد وأن يخسر في النهاية؛ فما بالك إن تولى ظالماً وكان مُصراً على ظلمه.
ولعل استفاقة “محمد بانجا” على نهاية الحرب – حينما تبين له عدم مصداقية الحليف الألماني – يعد مؤشراً ومؤكداً على سلامة وصحة ذلك المنهج منذ البداية. فلا يصح ولا يستقيم – شرعاً وديناً ومنطقاً – مولاة غزاة في سبيل طرد غزاة آخرين. وهو الأمر الذي جعل “بانجا” يعلن فضه لتلك الشراكة مع الحليف النازي، واستقلاله عنه نهائياً، مؤسساً حركة إسلامية مستقلة، ناصراً قضية الإسلام والاستقلال، داعياً مسلمي البلقان التضحية بالغالي والنفيس في سبيل ذلك.
مسألة ثانية، أو لأكون أكثر دقة، تساؤل ثانٍ استفزني، وهو: إذا كانت الشعوب المسلمة (عوام المسلمين) معذورة، في القبول بالالتحاق بالجيش النازي، بسبب فقرها وعدم معرفتها بالعلم الشرعي الذي ينهي عن موالاة الظالمين الفاسدين المعتدين، فهل لدى الأئمة والقامات الإسلامية نفس العذر؟ وهل يمكن تبرئتها أو عذرها على تسببها – بطريقة غير مباشرة – في تلك الجريمة الشنعاء، بحجة أنها كانت مضطرة لذلك التحالف لدفع القوى الاستعمارية والصهيونية بعيداً عن أراضي المسلمين، خاصة بعد انهيار الخلافة العثمانية، وعدم وقوف الدول القطرية الإسلامية من بعدها على مستوى الحدث؟ بالنسبة للمؤلف، فقد صرح بأنه سينأى بنفسه عن تقييم ما فعله المسلمون في تلك الفترة الزمنية، مبرراً ذلك بكون التقييم، في هذه الحالة، مهمة ليست بالسهلة.
إذا كان التقييم صعباً – بسبب عدم القدرة على الإلمام الكافي بفقه الواقع حينذاك، ومن ثم عدم القدرة على الجكم العادل – فمن الواجب، على الأقل، طرح الأسئلة، والتي من أهمها في نظري: إن غفلت العامة (المجندون) عن مسألة استخدام الإسلام كمفعول به، فكيف غفلت عنه الخاصة المسئولة المتعلمة المتفقهة في العلوم الشرعية؟ كيف تجاوزت الرموز الإسلامية تجاهل النظام النازي – “المحب للإسلام” – قضية الحق الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الصهيوني، وحق التتر والقرم والبلقان في الاستقلال كدول مسلمة، وحق شعوب المغرب العربي في التحرر من الاحتلال الإيطالي والفرنسي، ثم استمرت تلك الرموز، رُغماً عن كل ذلك، في التحالف مع النظام النازي والدعاية له؟
وإن انضمام العديد من الأئمة إلى البروباجندا الدينية الألمانية – لدرجة أنهم صاروا بوقاً صريحاً لها – لشيء يثير الانتباه والعجب في آنٍ واحد. فالإمام لديه من العلم الشرعي ما كان يجب أن يمنعه منعاً من الدخول في ذلك المخطط. وهو ما فعله معظم أئمة وعلماء المنطقة العربية، منهم أئمة الأزهر الشريف، حينما امتنعوا عن المشاركة في تلك الدعاية أو المهزلة العسكرية. وهنا يجوز التساؤل: هل كانت طبيعة المعركة في “الجبهة الشرقية” والبلقان أشد بأساً ونكالاً من نظيرتها في شمال إفريقيا والشام، مما اضطر الأئمة البوسنيين والقرميين والقوقازيين والتتر إلى التماس بصيص من الأمل في المحتل الألماني ليخلص المسلمين في تلك المناطق، ولو مؤقتاً، من لهيب وسُعار الاضطهاد الروسي والصربي والكرواتي والشيوعي واليوغوسلافي؟هل كان الاحتلال الروسي واليوغوسلافي للمسلمين في القرم والقوقاز والبوسنة والهرسك والسنجق أشد إيلاماً وإيذاءً من نظيره الفرنسي والإنجليزي في المنطقة العربية، مما أجبر المسلمين هناك على الرضوخ للمحتل الألماني بدلاً من نظيره الروسي واليوغوسلافي، لكي يستعينوا بالرمضاء على النار؟ تساؤلات عديدة، تحتاج إلى تأمل، بل إلى بحثٍ آخر، أو رسالة دكتوراه أخرى، تنقب عن الجانب الآخر في المسألة؛ ألا وهو الجانب الإسلامي: لماذا وافق على الانضمام إلى الحرب، والقتال تحت لواء الدولة الألمانية النازية؟ ما الأسباب والدوافع الحقيقية التي دعته إلى ذلك؟ وماذا كان موقع الدول “الإسلامية” في وسط كل تلك الأحداث؟
وبغض النظر عما ستسفر عنه تلك التساؤلات من إجابات، فإن هذا المشهد – مشهد استخدام المسلمين في الحرب العالمية الثانية – يدلل على واقع مرير، تحول فيه الإسلام إلى مفعول يه، لكونه لم يجد قوة إسلامية كبرى تدافع عنه، لا سيما بعد إسقاط الخلافة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين.
مسألة أخرى، أثارت انتباهي، وهي: منهج القوى غير الإسلامية في إشغال المسلمين بالفرعيات دون الأصول والأولويات. لقد قامت المانيا النازية بإشغال أو إلهاء مسلمي الاتحاد السوفيتي والبلقان بمنحهم امتيازات دينية زهيدة، متمثلة في السماح لهم بإقامة طقوسهم وشعائرهم الدينية التي حُرموا منها عنوةً في وقت الحكم الستاليني. فسُمح لهم بالصلاة الجماعة في الميادين، ورفع الآذان، وإقامة الجنائز الشرعية، والذبح على الطريقة الإسلامية، والاحتفال بعيدي الفطر والأضحى. نعم ألهتهم الدولة النازية بكل الامتيازات لتصرفهم عما هو أولى: وهو قضية الاستقلال والتحرر من كل أصناف الاستعباد والطغيان والاستبداد، لا من الإنجليز والفرنسيين والسوفييت فحسب، بل من الألمان أيضاً، الذين لم يساندوهم أبداً في معاركهم الحقيقية نحو الاستقلال كدول مسلمة.
فعبادة الجهاد في سبيل الله أوجب وأولى وأقرب إلى الله من عبادة إظهار الطقوس والشعائر الإسلامية؛ فالجهاد في الإسلام هو ذروة السَنام؛ وهو أشرف وأعلى منزلةً من سقاية الحجيج في بيت الله الحرام. “أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين” (سورة التوبة، آية 19).
إن سياسة الإلهاء بالفروع عن الأصول لم يقتصر تطبيقها على هذه الحالة فقط، بل امتدت إلى حالات كثيرة أخرى لا حصر لها، ولعل أبرزها فيما يتعلق بتعامل القوى الغربية مع قضية فلسطين. فهي سياسة “تسكينية” بامتياز؛ تعتمد على “تسكين” قضية الاحتلال، وإخماد المقاومة عبر أدوات فرعية لا تمس أبداً أصل القضية. فتارةً ترسل المعونات للشعب الفلسطيني؛ وتارةً أخرى تقوم بتدشين برامج تدريبية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بغرض إيجاد فرص عمل لهم…وكأن حل القضية تمثل كله في سد حاجة الفلسطيني من الأكل والكساء والعمل. إنها سياسة إلهاء واختزال حقيقي للقضايا الكبرى، وهو ما يطرح تساؤلي مرة أخرى: إذا كانت الشعوب المسلمة قد تم خداعها من قبل تلك السياسات، فكيف خُدعت بها النخب والرموز الإسلامية؟ أو بلغة أدق، كيف خُدعت بها العديد من النخب والرموز الإسلامية؟
قضية أخرى طرأت كثيراً على ذهني – طوال تصفحي للكتاب – وهي قضية سعي القوى الغربية نحو توظيف المسلمين، رغماً عن ضعفهم الظاهر والمشهود في اللحاق بالركب الحضاري. ذلك الضعف الناتج عن أسباب كثيرة، لا يسع ذكرها الآن. ويؤكد ذلك، من وجهة نظري، بروز العنصر الإسلامي على مستوى السياسات الدولية والعلمية، والتركيز على منظومتهم العقائدية والفكرية التي تجعل الباحثين والمسئولين الغربيين يعكفون عليها دراسةً وبحثاً وتنقيباً من أجل توظيفها أحسن توظيف. نعم، القوى الغربية تنظر إلى المنظومة الفكرية للإسلام نظرة احترام، رُغماً عن محاربتهم إياها سواءً بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة. فقد استدعى التوظيف النازي معاني الجهاد والعزة والوحدة لدى المسلمين، مختاراً إياهم دوناً عن كل الطوائف الدينية الأخرى، لتميزهم في ذلك الجانب.
وهنا نستطيع أن نضع التوظيف الأمريكي الحالي للإسلام والمسلمين في مقارنةٍ سريعة مع نظيره الألماني، فنجد أنه بينما يستدعي التوظيف الأمريكي الحالي معاني الخنوع والميوعة وفقدان الذات لدى المسلمين، رافعاً شعار الإسلام “المعتدل” بالمفهوم الأمريكي، أي الإسلام الخالي من المقاومة، نجد التوظيف الألماني قد استدعى معاني الإسلام المقاوم البطولي المجاهد. في النهاية، تم استخدام القوة الناعمة من قبل القوتين لتحقيق أهداف القوة الصلبة. فكانت السياسات العسكرية هي العامل المتغير، بينما كانت السياسات الدينية هي العامل التابع. كل من القوتين وظف من الإسلام ما يتناسب مع مصالحه السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبما يتوافق مع الواقع المحيط.
وأخيراً، هل لاقت تلك السياسات التوظيفية قبولاً وقناعةً من قبل الجماهير المسلمة؟ الإجابة التي قدمها الواقع هي “لا”. فلا استطاعت الدولة النازية حشد جماهير المسلمين، بالأعداد المأمولة، لتصطف في الجيش الألماني، ولا استطاعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة حشد جماهير المسلمين للتطبيع مع إسرائيل. السر في كلمةٍ واحدة: ما لا يخرج من القلب لا يصل إلى القلب. والمنافق – حتى لو تظاهر معطم الوقت بما لا يبطنه – فإنه لن يستطيع ولن يفلح في إخفاء باطنه وحقيقته طوال الوقت. بمعنى آخر، إن جميع السياسات والأدوات التوظيفية، التي استخدمتها القوى الغربية تجاه المسلمين، افتقدت عنصر الصدق والمصداقية، فطفحت في نهاية المطاف كذباً وخداعاً ونفاقاً وزوراً، الأمر الذي كشفته الجماهير المسلمة البسيطة، رُغماً عن فقرها وبؤسها وعوزها.
عرض:
د. شيرين حامد فهمي*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies