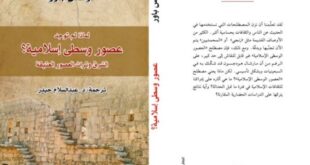العنوان: السعي للعدالة: الطب والفقه والسياسة في مصر الحديثة.
المؤلف: خالد فهمي.
ترجمة: حسام فخر.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: القاهرة.
الناشر: دار الشروق.
تاريخ النشر: 2022.
الوصف المادي: 539 ص. ، 24 سم.
الترقيم الدولي الموحد: 9-3754-09-977-978.
كتاب “السعي للعدالة: الطب والفقه والسياسة في مصر الحديثة” للدكتور “خالد فهمي”، والمُترجم إلى العربية من قبل “حسام فخر”، والصادر عن “دار الشروق” بالقاهرة عام 2022، يقدم مجالاً جديداً لم يُرصد من قبل؛ وهو مجال تعامل المصريين مع قضية التحكم في أجسادهم من قبل السلطة في القرن التاسع عشر الميلادي؛ وهي منطقة بحثية لم تتلمسها أيادي الباحثين والدارسين من قبل.
الكتاب يقدم وصفاً تفصيلياً لمدى تأثر عامة المصريين بإدخال علم الطب الحديث إلى مصر، خلال العقود الوسيطة بالقرن التاسع عشر؛ وهو ما لم ترصده المدارس التأريخية المصرية من قبل. ومن أشهرها المدرسة التي أسسها “شفيق غربال” في القرن العشرين، والتي ركزت فقط على دور النخبة المصرية في تدشين علم الطب الحديث في مصر، بينما لم تعر انتباهاً لدور عامة المصريين في هذه القضية.
يتألف الكتاب، المُترجم إلى العربية، من 539 صفحة، مُقسماً إلى خمسة فصول، يسبقها “شكر وعرفان”، و”نبذة عن المصادر”، و”مقدمة”. أما الفصول، فتبدأ بالفصل الأول “الطب والتنوير والإسلام”، ثم الفصل الثاني “السياسة، القانون المنسي”، ثم الفصل الثالث “الأنف تروي قصة مدينة”، يتلوه الفصل الرابع “الحسبة والسوق والكيمياء الجنائية”، وأخيراً الفصل الخامس “عدالة بدون ألم”. وينتهي الكتاب بـ”الملاحق”، وقائمة المصادر والمراجع التي تم الاستناد إليها في كتابة هذه الدراسة. أما أصل الكتاب، فقد صدر بالإنجليزية تحت عنوان In Quest of Justice: Islamic Law and Forensic Medicine in Modern Egypt، حيث تم نشره بالتنسيق مع دار طباعة جامعة California الأمريكية، في عام 2018.
جديد هذا الكتاب قيامه بسرد تاريخ “الطب الشرعي/العدلي/الجنائي” في مصر القرن التاسع عشر (مصر الحديثة)، وعرضه الارتباط الوثيق الذي تشكل بين الطب والقانون على إثر تبلور الحداثة في مصر، ورصده التطورات والإصلاحات التي شهدها هذان المجالان، وكيف كان تأثيرها على حياة المصريين اليومية، وكيف كان استقبال المصريين لتلك الإصلاحات والتطورات بشكل يومي. وفي ظل هذا السرد والرصد الدقيق، فإن الكتاب لا يكف عن وضع “الحداثة المصرية” – التي كان الطب الشرعي أحد تجلياتها – محل تساؤل وتأمل: هل وصلت “الحداثة المصرية”، التي ولدت خلال العقود الوسيطة للقرن التاسع عشر، إلى كل أرجاء المحروسة؟ أم أنها ركزت على مناطق دون غيرها؟
انطلق الكتاب، المعتمد أساساً على مصادر “دار الوثائق المصرية” وسجلات المؤسسات الطبية، من مجموعة من الفرضيات العامة والمنهجية جاءت كالتالي:
أهم فرضيات الكتاب:
1) الدولة المصرية الحديثة والتحكم غير المسبوق في أجساد المصريين
تفننت الدولة المصرية الحديثة —وفقا لـ”فهمي”— في استخدام تقنيات وأدوات غير مسبوقة بهدف إحكام رقابتها على المجتمع المصري، وذلك تحت مسمى “الحداثة” و “النهضة” و”الإصلاح الطبي” و”الإصلاح القانوني”. وقد اشتملت تلك التقنيات على عمليات التشريح الجنائي، وإجراءات الكشف على الأموات، وإجراءات الدفن ومناظرة الجثث، وإجراءات الحجر الصحي، وإجراءات التطعيم والتجنيد، وإجراءات تعداد السكان، وأخيراً إجراءات التعذيب “القانوني”.
يؤكد “فهمي” على نجاح تلك الأدوات “الحديثة” في إحداث درجة من التحكم لم يحققها الباب العالي ذاته؛ إذ تحول المصريون بموجبها إلى رعايا خاضعين لسيادة الحكومة الخديوية البيروقراطية. على سبيل المثال، أضحى الشخص المطعَّم، الحاصل على التذكرة المختومة، المشمول ضمن تعداد السكان، فرداً “داخل الحكومة”، بينما أضحى الشخص غير المطعَّم، غير المشمول ضمن تعداد السكان، فرداً “خارج الحكومة”. “وهكذا وجد المصريون أجسادهم وقد أصبحت حرفياً موضوعاً لرقابة ومتابعة وتحكم لم يسبق له مثيل، من المهد إلى اللحد، وربما إلى ما بعده.” (ص62).
أفضى هذا الوضع إلى نزع المصري من نسيجه المجتمعي، حيث أدت التقنيات البيروقراطية الجديدة، إلى تفكيك المجتمع، وتحويله إلى أفراد مربوطين بالدولة برباطٍ لا فصم له، ووضعهم في سياق بيروقراطي جديد، صار فيه الفرد مجرد رقم داخل منظومة عددية تمتلك الدولة وحدها شفرتها.
وبالرغم من كفاءة الدولة الخديوية (الحديثة) في حصر رعاياها – في تسجيل تاريخ ومكان وميلاد كل فرد، وتسجيل هويته حين وفاته – إلا أنها لم تكن تتمتع بالشعبية أو المشروعية في أعين رعاياها. وهو ما أكد عليه المؤلف في نهاية كتابه، حينما أقر قائلاً، أن “معظم سمات تلك الدولة الحديثة لم يكن مبعثاً لسعادة المصريين” (ص 439)، الأمر الذي أسهب الكتاب في بيان أسبابه كما سيأتي.
كذلك تعرض الكتاب إلى الصلة الوثيقة بين الطب والقانون، عبر سرده تاريخ إدخال الطب الشرعي في مصر في القرن التاسع عشر، معتمداً على التقارير الجنائية الطبية التي كانت تعدها الضبطيات، ثم تحيلها إلى الأجهزة القانونية المختصة (مجالس السياسة)، حتى يتم الحكم في قضايا جرائم العنف. تلك العملية التي كان يتم فيها إحالة التقارير الطبية الشرعية إلى الضبطية ثم إلى مجالس السياسة –وضعت أجساد المصريين تحت رقابة وتحكم وسيطرة السلطة السياسية.
2)مقاومة المصريين لتحكم الدولة الحديثة
ينظر الكتاب في كيفية تعامل المصريين مع ذلك التحكم السلطوي، وكيف كانت مقاومتهم له. فكما يعرض الكتاب للأساليب المبتكرة التي استخدمت في إحداث التحكم المنشود – والتي ظهرت في أدق تفاصيل الحياة اليومية لعموم المصريين، يظهر الكتاب أيضاً البسالة التي أبداها المصريون لاسترداد أجسادهم، وتحقيق العدالة في معيشتهم، والكرامة في مماتهم. ومن أمثلة ذلك مصادرتهم لممارسات الدولة الخديوية (بما فيها ممارسات الطب الشرعي) واستخدامها من أجل حماية حقوقهم وتحقيق العدالة، وكذلك إصرارهم على تشريح جثث أقاربهم وأهاليهم إذا ساورتهم الشكوك في تقارير الطب الشرعي.
وأهم ما ركز عليه “فهمي” في هذه النقطة، هو التشديد على أن السياق العسكري، لا السياق الديني، كان هو صاحب الأثر الأعظم في تشكيل ردة فعل المصريين المقاومة لتقنيات الطب الحديث. بمعنى آخر، إن مقاومة المصريين لتلك التقنيات إنما كانت بسبب إدراكهم العميق لعسكرة تلك الأدوات على يد الدولة الخديوية، التي لم تكن تبغ من ذلك التحكم سوى تقوية الجيش الذي احتل قمة أولويات الدولة الخديوية؛ وذلك بالنظر إلى السياق العثماني الذي تواجدت فيه، كما سيرد في الفرضية التالية.
3) استدعاء السياق العثماني – وليس الأوروبي فقط – عند تناول إصلاحات مصر الخديوية
يؤكد “فهمي” أنه لا يمكن تناول إصلاحات مصر الخديوية في القرن التاسع عشر دون استدعاء السياق العثماني. ذلك أن مصر الخديوية (1805-1897) كانت جزءا لا يتجزأ من الدولة العثمانية. ومن ثم، فإن علاقات القاهرة المتنامية مع باريس ولندن لا يمكن دراستها إلا في ضوء علاقتها التاريخية بأسطنبول. فعلاقة مصر بأوروبا ليست كافيةً لفهم تطورات وإصلاحات القرن التاسع عشر، بل يجب أيضاً التمعن في السياق العثماني الذي جرت فيه تلك الإصلاحات.
يشدد الكتاب على ضرورة وضع توجهات “محمد علي” (مع التغيرات غير المسبوقة التي عاشها المجتمع المصري خلال فترة حكمه وحكم خلفائه) في إطار إمبراطوري أوسع؛ ذلك الإطار الذي كانت تصارع فيه مصر من أجل شق مسار مستقل لها في داخل الدولة العثمانية. وكان الجيش هو الأداة السياسية لشق ذلك المسار، واستخلاص حكم مصر لـ”محمد علي”. ومن ثم، كانت الإصلاحات مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بالجيش. فكانت المصانع والمدارس التعليمية (أهمها مدرسة القصر العيني) والمطابع (مطبعة بولاق للنشر) خادمةً للجيش المصري.
إذن، فالدولة المصرية (الخديوية) الحديثة التي تطورت عبر خمسين سنة، من بداية ثلاثينيات إلى بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر – كان الجيش يحتل فيها دوماً وأبداً مركز الصدارة، دوناً عن جميع المؤسسات، لأسباب تتعلق برغبة الدولة الخديوية في الانفصال بمصر عن الدولة العثمانية (الباب العالي). وهو الأمر الذي أغفلته المدرسة التأريخية المصرية التي ركزت فقط على السياق الأوروبي؛ ونظرت إلى إصلاحات مصر الحديثة في إطار تاريخي واحد فقط، وهو العلاقة بين مصر الحديثة وأوروبا بأكملها؛ معتبرةً أوروبا المنبع الحقيقي للعلم والمعرفة، وأن حملة “بونابرت” لم تكن إلا تعبيراً عن السعي الأوروبي لإنهاء عزلة مصر، ونشر العلم الحديث فيها.
ومما تجدر الإشارة إليه معارضة “فهمي” لفكرة الطب الكولونيالي في مصر، وإنكاره الواضح لفكرة التفوق الأوروبي. فإذا كان هناك طب كولونيالي في الهند القرن التاسع عشر، حيث سادت عقلية المستعمر البريطاني التي وصفت الهنود “بالمرض وسوء الصحة وانعدام الدراية بالنظافة الشخصية والإيمان بالخزعبلات وانعدام الرؤية العلمية”، فإن هذا “الطب” لم يكن وارداً في مصر الخديوية على الإطلاق، بحسب كلام المؤلف.
ويدلل “فهمي” على صحة حجته بما أشار “كلوت بك” (الطبيب الفرنسي في عهد “محمد علي”) به على الوالي العثماني، حينذاك، بإنشاء مدرسة طبية في مصر – وهي مدرسة “قصر العيني”– لكي يتعلم فيها الطلاب المصريون أحدث ما وصل إليه التعليم الطبي، لا باللغة الفرنسية وإنما بلغتهم الأم؛ وهو ما يتنافى تماماً مع فكرة الطب الكولونيالي. هذا إضافةً إلى كتابات “كلوت بك” عن عملية إدخال الطب الحديث في مصر، حيث أنه لم يصف جسد المصري باعتباره قذراً بطبيعته، بل على العكس، كان يتحدث عن إيمان عوام المصريين بضرورة الأخذ بأساليب الطب الحديث، لقناعتهم بأهمية الصحة العامة؛ وهو ما اعتمد عليه مئات الأطباء المصريين، من خريجي “القصر العيني”، خلال عقود منتصف القرن التاسع عشر.
الفرضيات المنهجية
انطلق الكتاب من فرضية منهجية –لازمت جميع فصوله– وهي أن العلمنة ليست المنظور المناسب لرؤية وتفسير تطورات مصر الخديوية في القرن التاسع عشر. يتمثل المنظور المناسب وفقا للمؤلف في وضع تلك التطورات في سياق الظروف السياسية والاقتصادية والمؤسساتية والبيروقراطية التي أحاطت بتلك التطورات وأفرزتها. ومن ثم، لم يلق الكتاب بالاً إلى رصد آثار تلك التطورات على قضايا مثل الهوية والخصوصية والفكر، وإنما كان تركيزه الأساسي على شرح كيفية وقوع تلك التطورات؛ وهو ما فعله المؤلف عبر البحث المكثف في الأرشيفات، ليدرس كيف ومتى حدثت تلك التطورات الخاصة بالطب والقانون، وكيف تعامل الناس معها عبر حياتهم اليومية. وهو الأمر الذي وضع المؤلف في اشتباك واضح مع كلٍ من “طارق البشري” و “عبد القادر عودة”، و”طلال أسد” و”وائل حلاق” الذين آثروا توظيف “المفاهيم” و”الأفكار” على التفاصيل الإمبريقية.
معارضة “فهمي” للمستشار “البشري”، كانت بسبب نقد الأخير للنظام القانوني المصري الذي رآه مفتقراً إلى الأصالة الثقافية بعدما اجتاحته الإصلاحات الخديوية الحديثة. إذ لم يتطور النظام القانوني في داخل البيئة المصرية الثقافية السياسية الاجتماعية، وإنما فرضته القوى الغربية على أيدي أتباعها المصريين المنبهرين بالغرب. من ناحية أخرى لم يشر “البشري” —وفقا لـ”فهمي”— إلى “مجالس السياسة” بالرغم من أنها كانت تحتل مكان الصدارة في النظام القانوني السائد في مصر، طوال العقود الأربعة التي سبقت إدخال القانون الغربي. كذلك لم يتناول “البشري” التطورات المؤسسية بقدر قيامه بالتحليل الفكري، وأخيراً اعترض “فهمي” على عدم بذل البشري “لأي جهد” في تناول كيفية عمل “مجالس السياسة”، من حيث هي أجهزة قانونية.
وأما معارضة المؤلف لـ”عودة”، فكانت بسبب فرضيته القائلة إن الشريعة غير تاريخية، وإنها ذات طبيعة جامعة شاملة مانعة لكل وقت وزمان؛ ومن ثم غير قابلة للتطور أو التجدد أو التغير. ويرد هنا المؤلف بما يناقض ذلك جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن الشريعة كانت دائماً متطورة، متجددة، متغيرة؛ وأنها منتج تاريخي يتأثر بظروف محددة. ومن ثم، فهي ليست كياناً شاملاً جامعاً مانعاً. ملخص القول، إن المؤلف ينظر إلى إصلاحات القانون المصري في القرن التاسع عشر باعتبارها مرحلة من مراحل التطور التاريخي للشريعة، بدلاً من وصمها بكونها نموذج من نماذج الهجمة الغربية على الهوية الإسلامية.
أما معارضة “فهمي” لـ”أسد”، فكانت بسبب تعويل الأخير على المدخل المفاهيمي في نقده للتطورات والإصلاحات القانونية التي استحدثت نظاماً قانونياً لا ينبع من القيم الأخلاقية التي تحكم علاقات الناس في مجتمع ما، وكذلك نقده للفصل العميق الذي فرضته تلك الإصلاحات بين الأخلاق والقانون. درس “أسد” التغيرات المفاهيمية التي طرأت على الشريعة الإسلامية في ظل مصر الخديوية، مستخلصاً أن تلك التغيرات قد أفضت إلى بتر دور الشريعة. أما “فهمي” فيعول بدرجة أقل على المدخل المفاهيمي الذي يبين أن القانون/الشريعة تغيرت ولكنه لا يشرح الطريقة التي تم بها ذلك. يعول “فهمي” بدرجة أكبر على نمط البحث السياقي، الذي يتتبع التحولات المؤسسية والاجتماعية والسياسية والفكرية، فضلا عن تفاصيل وتفاعلات الحياة اليومية..
وأخيراً، عارض “فهمي” رؤية “حلاق” القائمة على اعتبار الإسلام والحداثة ضدين يستحيل التقاءهما. فالشريعة – من وجهة نظر حلاق– لا يمكن أن تتسق مع الدولة الحديثة التي ترى السيادة للقانون، لا للشريعة. يرى “فهمي” أن رؤية حلاق مبينة على افتراض غير صحيح مفاده أن المجتمع المصري قبل دخول الحداثة إلى مصر كان مجتمعا تصنعه رؤية شرعية/فقهية خالصة. يرى “فهمي” على العكس أن المجتمع المصري – قبل وصول الحداثة – كان مجتمعاً مركبا، تسوده الأخلاقيات الفقهية كما تسوده الأخلاقيات ذات الصلة بالسياسة. بعبارة أخرى يرى مؤلف السعي للعدالة أن السياسة والقانون – إضافةً إلى القضاء والفقه – ضروريان لفهم الشريعة ودراستها، وأنهما ينتميان عضوياً إلى الشريعة، كما ينتمي القضاء والفقه. ومن هنا، نستطيع فهم إصرار المؤلف – مراراً وتكراراً – على طرح التساؤل الآتي: هل فهمنا للشريعة سيتغير إذا ما أدخلنا السياسة كعنصر مكون لها؟
الفصل الأول: الطب والتنوير
يتناول الفصل الأول قضية إدخال الطب الحديث (الفرنسي) إلى مصر الخديوية في القرن التاسع عشر، وارتباطه بحفظ جيش مصر الجديد. كما يناقش هذا الفصل المنظور النخبوي (خطاب السلطة) الذي صور الطب الحديث باعتباره “مركز الحضارة”؛ وهو التصور الذي يرفضه مؤلف الكتاب، مقترحا في المقابل “خطاب المقاومة”؛ أي مقاومة الأهالي المصريين لذلك “المركز”. ويشدد المؤلف على فرضية أساسية في الكتاب؛ وهي أن الحساسية الدينية لم تكن موضوعاً لتلك المقاومة، بمعنى آخر، لم يقاوم عموم المصريين الطب الحديث لأسباب دينية، وإنما لأسباب عسكرية؛ أي لإدراكهم العميق بارتباط الطب المصري الحديث بحالة عسكرة المجتمع؛ وهو الأمر الذي لم يهضموه جملةً وتفصيلا. وبناءً على ذلك، يؤكد المؤلف على أن إشكالية الصراع بين التراث والحداثة (في تلك القضية) إنما هي إشكالية مزعومة، تتجاهل تفاصيل مشروع التحديث، كما تتجاهل العنصر الأساسي في عملية تدشين الطب المصري الحديث، وهو عنصر العسكرة.
ارتباط الطب المصري الحديث بالجيش
كان إقناع الطبيب الفرنسي “كلوت بك” الوالي “محمد علي” بضرورة إدخال علوم الطب الأوروبي إلى مصر، لحفظ جيشها الجديد، إيذاناً بإنشاء الطب الحديث في مصر، ممثلاً في مدرسة ومستشفى قصر العيني. فتدريب أطباء مصريين، بدلاً من الاعتماد على أطباء أوروبيين، كان من شأنه أن يؤدي إلى إصلاحات طبية، ستصير جزءاً من إصلاحات عسكرية أوسع؛ وهو ما يمثل جزءاً من صراع الأسرة الخديوية الحاكمة مع الدولة العثمانية.
لقد كان “محمد علي” بحاجةٍ إلى فيلق طبي عسكري، بعد دروسٍ من الخسائر الفادحة التي فتكت بجيشه. فالأمراض والأوبئة (وأهمها الكوليرا) التي انتشرت في مصر القرن التاسع عشر وأنهت حياة ملايين المصريين لم تكن بالأمر الهين. وانعكس اهتمامه الجارف بالجيش المصري في الطابع العسكري الذي فرضه على جميع المدارس التي أنشئت في عهده، ومنها مدرسة قصر العيني. “إذن، فإن المؤسسة الطبية في القرن التاسع عشر قد ارتبطت بالقوة العسكرية، برابطة لا فصام لها، وتشكلت وفقاً للمنطق والتنظيم والانضباط العسكري” (ص78).
خطاب المقاومة مناقضاً لخطاب السلطة
انتقد المؤلف خطاب السلطة ومنطق “الرجال العظام” في سرد تاريخ مصر الخديوية القرن التاسع عشر. وهو ذلك الخطاب المتمثل في الكتابات المعتمدة، الإنجليزية والفرنسية، التي صورت “كلوت بك” وهو يخوض معركته ضد “تعصب المصريين” و”الدجالين” و”الشعوذة” في سبيل إرساء دعائم الطب الحدبث في مصر. رفض “فهمي” تلك السردية، لما تطرحه من ثنائية “التنوير” (الفرنسي) مقابل “الخرافة” (المصرية)؛ وهو طرح – في نظره – يخفي السبب الحقيقي وراء رفض المصريين التعامل مع الطب الحديث؛ ذلك السبب المتمثل في حالة العسكرة التي كرهها المصريون.
وهنا يطرح المؤلف خطاب “المقاومة” مقابل خطاب “النخبة”، فيتناول عزوف الأهالي عن “مركز الحضارة” (مستشفى قصر العيني)، ليس فقط بسبب التحكم العسكري، وإنما أيضاً بسبب العقم البيروقراطي نتيجة لعدم استقلالية المستشفى إدارياً ومالياً، وتبعيتها لوزارة الجهادية. لقد تحدى المؤلف خطاب النخبة، مقدماً خطاب المقاومة من خلال استعراضه للـ “العرضحالات” المسجلة في “ديوان تفتيش الصحة” و”ضبطية مصر” و”شورى الأطباء”، والتي عكست صورةً مفصلةً عن الأداء اليومي للمستشفى.
وكذلك أبرز المؤلف – عبر “العرضحالات” – مقاومة الأهالي لإجراءات الحجر الصحي، لكونها معرقلةً للقمة عيشهم، ومقاومتهم للتطعيم لكونه مرتبطاً بالتجنيد الذي كان يُفرض فرضاً على الفلاحين، بينما كان يُعفى منه الكثير من القاهريين. بمعنى آخر، لم تكن مقاومتهم لتلك الإجراءات الطبية الحديثة نابعةً من الوازع الديني، أو من “الخزعبلات” التي طالما أشار إليها “كلوت بك” من منظوره النخبوي.
خلاصة الأمر، كما يبين المؤلف، أن سياسات وإجراءات الطب الحديث في مصر الخديوية لم تواجه مقاومة إسلامية. حتى عمليات التشريح، وافق عليها أغلبية فقهاء المسلمين، قاصدين بها درء المفاسد والقيام بالمصالح العامة، لا بقصد إهانة الجسد. فقد آمن المصريون بحرمة الجسد الميت، إلا أن سعيهم نحو العدالة، وإصرارهم على التشريح في مناسبات عديدة، كان أقوى من أية هواجس دينية، كما يشير “فهمي”.
الفصل الثاني: السياسة والقانون المنسي
يتناول الفصل الثاني قضية المزاوجة بين الفقه والسياسة في الدولة المصرية الحديثة في القرن التاسع عشر. فلأول مرة يصير النظام القضائي المصري نظاماً مركباً. ولا يرى المؤلف حرجاً في تلك المزاوجة أو ذلك التركيب؛ بل إنه يرفض – رفضاً كاملاً – سردية علمنة الشريعة التي تقول إن الشريعة قد تمت علمنتها بالسياسة. ويدلل على ذلك مؤكداً بأن “مجالس السياسة” —أحد إفرازات الدولة المصرية الحديثة— لم يحدث أبداً أن تجاوزت الفقه، بل إنها دعمته وعضدته. إلا أن المؤلف لا ينكر أيضاً ضلوع تلك “المجالس” في تغيير مفهوم الفرد، باقتلاعه من نسيجه الاجتماعي، وإخضاعه لسيطرة الدولة الحديثة. كما أنه يعترف بضلوع تلك “المجالس” في انتصار العلمانية، ولكن “من غير قصد“.
رفض سردية المدرسة التاريخية للقانون المصري
يرفض “فهمي” سردية المدرسة التاريخية للقانون المصري، التي تقول إن الدافع وراء الإصلاح القانوني المصري كان هو اللحاق بالغرب، وتبني القوانين الأوروبية (الفرنسية أساساً). فتبعاً لهذه المدرسة، يبدأ تاريخ القانون المصري منذ لحظة إنشاء المحاكم الأهلية. أما ما قبل ذلك، فتعتبره المدرسة فوضى واستبداداً نتيجة سيطرة الوالي الباشا على جميع المسائل القانونية والقضائية. تلك السردية، التي تفترض ضمنياً عدم توافق نظام الدولة الحديثة مع الشريعة، لا يتوافق معها المؤلف، الذي يرفض النظر إلى تاريخ النظام القانوني المصري باعتباره عملية علمنة مستمرة. إنما هو يؤمن بكونه نظاماً قد أُضفي عليه طابع التنظيم البيروقراطي، فأضحت الكلمة المكتوبة (في مجالس السياسة)، للبت في القضايا الشرعية وغيرها، أهم من الكلمة المنطوقة في المحاكم الشرعية. فإن كانت مجالس السياسة تمثل السياسة، فإن المحاكم الشرعية تمثل الفقه؛ ولا وجود للتعارض بينهما. ومن ثم، لا مجال للحديث عن علمنة النظام القانوني المصري في القرن التاسع عشر، تبعاً المؤلف.
مجالس السياسة تختلف عن المحاكم الشرعية
يتحدث المؤلف بالتفصيل عن الفوارق بين مجالس السياسة والمحاكم الشرعية، في النظر إلى القضايا الجنائية. فبينما تعتبر المحاكم الشرعية (المعتمدة على الشريعة والفقه) القصاص على جرائم القتل من “حقوق العباد”، حيث يقتصر الحق في توجيه الاتهام على أولياء الدم، تعتبر مجالس السياسة القصاص من حق الدولة، إذ يتم ترخيص حق رفع الدعوى القانونية لموظفي الدولة ضد المتهم، حمايةً للنظام العام ولحقوق الدولة.
وبينما ترتكز المحاكم الشرعية على الشهود العدول لتحديد هوية المتقاضين، تكتفي مجالس السياسة باستخدام اسم الشخص واسم أبيه ومحل إقامته، لتحديد الهوية القانونية للمتقاضين. وهنا نجد كيف أنشأت السلطة السياسية مفاهيم جديدة للهوية الفردية، وكيف دشنت أدوات بيروقراطية لتحديد الهوية القانونية، مثل شهادة التطعيم أو شهادة التجنيد؛ وذلك كله في سبيل تضمين هؤلاء الأفراد في نظام السياسة الجديد ذي الطابع النصي المكتوب. وكذلك نجد –كما يتابع “فهمي”– كيف تم التنازل عن فكرة الشهود العدول، ومن ثم الكف عن الاهتمام بالتثبت من حسن سمعة المتقاضين أو عدمه، وكيف تم الاستعاضة عن مسألة الشهادة الشفهية، واستبدالها بالمحاضر والتحقيقات المكتوبة.
وبالرغم من تلك التنازلات التي دشنتها مجالس السياسة في النظام القانوني المصري، إلا أن المؤلف يؤكد، مراراً وتكراراً، على أن “السياسة لم تكن قط محاولةً لتجاوز الفقه أو الالتفاف عليه، وإنما كانت وسيلةً هامةً –بل حاسمة الأهمية– لتعزيز الفقه وتنفيذه” (ص204)، وأن “أرشيف مجالس السياسة الذي أعيد اكتشافه حديثاً يوضح أن مصر شهدت واحداً من أكثر الجهود دأباً وابتكاراً في تاريخ التشريع الإسلامي، وهو جهد كان يهدف إلى تطبيق الفقه، وتحقيق الاتساق بينه وبين السياسة” (ص204).
يؤكد المؤلف على فرضيةٍ مفادها أن الشريعة كانت المرجع الأساسي للنظام القانوني المصري خلال معظم سنوات القرن التاسع عشر، وأن تدشين مجالس السياسة، الذي طبق في مصر الخديوية، لم يكن بدعةً أو فرضاً من قبل قوة استعمارية، وإنما له تاريخ طويل ومشهود في التراث الإسلامي. فقد دشن كل من “ابن القيم” و”ابن تيمية” مصطلح “السياسة الشرعية” في صميم الفكر الإسلامي السُني الذي يقضي بأن السياسة ضرورة لحماية مصالح الدولة ورفع شأن الشرع على سواء.
ولا يخفي المؤلف نية الدولة الخديوية –وراء مزجها الفقه بالسياسة– في إرساء سيادتها باسم القانون، وفرض حقها في محاكمة القتلة. كذلك لا يخفي إسهام مجالس السياسة في انتصار العلمانية “من غير قصد”؛ إذ تحولت الشريعة من كونها كلاً إلى اعتبارها جزءاً فرعياً من مجموعة المعايير القانونية التي تسمح بها الدولة. وأكبر دليل على ذلك، ما يتعلق بقوانين الأسرة الحديثة، حيث تم إخضاع الأسرة لمتطلبات الدولة الحديثة، وتم فصل الفرد جسدياً وأخلاقياً وشعورياً عن الجماعة والأمة.
الفصل الثالث: الأنف تروي قصة مدينة
ينفي المؤلف في هذا الفصل تشبيه عموم المصريين في القرن التاسع عشر بعموم الهنود في نفس الفترة الزمنية. فإذا كان الطب الكولونيالي (البريطاني) مسيطراً على الهند، فهو لم يكن له أدنى مكان في أراضي المحروسة. وإذا كان المحتلون البريطانيون يصفون الهنود بكونهم قذرين بطبعهم –حتى يبرروا غزوهم صحياً، وحتى يبرروا إزدواجية المدينة وانفصالهم عنهم فيها– فإن السياسات الحضرية المصرية، حينذاك، لم تنبع أبداً من تلك العقلية الكولونيالية؛ بل إن تلك السياسات قد عكست جهوداً مصرية متضافرة لتعزيز النظافة والصحة العامة في مصر القرن التاسع عشر؛ وهو الأمر الذي أفضى إلى تحول جذري في المحروسة. فقد قاوم المصريون الممارسات غير الصحية، وقاوموا الوضع الصحي المتدني في القرن التاسع عشر. ذلك الوضع الذي كان ناتجاً عن فقرهم، لا عن طبيعتهم القذرة. ويسجل المؤلف هنا ملحوظته العامة، التي ظل مؤكداً عليها في ثنايا الكتاب، وهي أن الشريعة لم تكن أبداً في تعارضٍ مع سياسات التخطيط الحديث للمحروسة. كما يسجل أيضاً نقده الملازم والمستمر للسردية المعتمدة والرؤية التاريخية النخبوية التي كانت تركز فقط على “حاسة البصر”، في رصدها لمباني وشوارع المحروسة الحضارية، متجاهلةً “حاسة الأنف” في رصد مشاهد الفقر والعوز والمرض في الجانب الآخر.
لم يكن بمصر طب كولونيالي
يؤكد المؤلف أن سياسات الصحة العامة، في مصر الخديوية، لم تنبع من عقلية كولونيالية تهدف إلى حماية جيب كولونيالي من “حشود الجماهير المريضة القذرة غير القابلة للإصلاح”، وإنما كانت تتعامل مع المدينة ككل عضوي متكامل. ومن ثم، كانت تركز على ضرورة القضاء على جميع مصادر الأبخرة الضارة التي تعد من أهم أسباب النيل من الصحة العامة، كما تقول نظرية الأوخام والرياح الفاسدة. فقد آمنت السلطات المصرية حينذاك بقدرة القاهريين على التحكم في أجسادهم، والعناية بصحتهم، ولم تتهمهم بالمسئولية عن مرضهم أو فقرهم.
إن نموذج المدينة المزدوجة –الذي طبقه المحتل البريطاني في الهند القرن التاسع عشر– لم ينطبق على القاهرة الخديوية، بحسب رؤية المؤلف. فلم يكن أبداً حافز الخديوي “إسماعيل” أو “علي مبارك” أو اللورد “كرومر” استخدام العمارة لإبراز الاختلافات المتأصلة بين الشرق والغرب. ولم ترغب السياسات المصرية الحضرية في وضع تمييز قاطع بين الشرق والغرب. ولم ينظر الأطباء الفرنسيون أو المصريون إلى مصر باعتبارها بيئة موبوءة بشكل متأصل. “ربما كان جوهر القاهرة قذراً، لكن لم يكن هناك اختلاف جوهري في معتقدات القاهريين وسلوكهم، يميز بينهم وبين الباريسيين أو سكان لندن أو فيينا” (ص292).
الانشغال بسوء حالة الصحة العامة أكثر من التحسينات الجمالية
لم تكن السياسات التخطيطية الحضرية الحديثة تتعارض مع الشريعة، كما يؤكد “فهمي”. فاللوائح العديدة الخاصة بتخطيط المدن، والمراسلات الحكومية المتصلة بها، توضح أن الشريعة لم تحتفظ فقط بمكانتها، بل كانت حاضرةً بقوة في الكثير من الإجراءات الخاصة بتخطيط المدن حضارياً. لقد شددت تلك السياسات الحضرية على أهمية النظافة العامة في القرن التاسع عشر، كما يدلي “فهمي”؛ فتم إنشاء جهاز محلي لتولي تحسين الصرف الصحي، والتخلص من النفايات، ودفن الموتي خارج المدينة، وسد البرك الراكدة، وتنظيم حازم للسلخانات وأعمال الجزارين والمدابغ. كان الهدف الأكبر من وراء ذلك، هو تحسين الصحة العامة للمصريين التي كانت تشهد تدهوراً مستمراً، نتيجةً للأبخرة المنبعثة من مصادر العفونة التي كانت منتشرة حينذاك في القاهرة. فقد كان هم تلك السياسات هو تحسين صحة المصريين، وليس الاعتبارات الجمالية التي كانت تفترضها الرؤية التاريخية التقليدية صاحبة المنظور النخبوي.
يركز المنظور النخبوي —كما يرى “فهمي”— على حاسة البصر والتأمل في المناظر البديعة من شرفات المباني الفخمة، بينما يهمل حاسة الشم والروائح الكريهة التي اتسمت بها القاهرة (البرك/المستنقعات/السلخانات). ذلك المنظور اهتم فقط برصد رغبة الخديوي “إسماعيل” الشديدة في تحويل القاهرة إلى باريس أخرى، بينما تجاهل مآسي عامة المصريين تحت كوبري “قصر النيل”، وغض طرفه عن “الرائحة الزنخة العطنة الكامنة” (ص233).
الفصل الرابع: الحسبة والسوق والكيمياء الجنائية
لم ير المؤلف نظام الحسبة مثالياً، كما رآه بعض الإسلاميين –وأيضاً بعض الغربيين، بل رآه نظاماً يعتريه الكثير من العنف المفرط، الأمر الذي أبعد “المحتسب” تدريجياً عن دوره المنوط به. يقص علينا “فهمي”، في هذا الفصل، كيف تمت إزالة نظام الحسبة تدريجياً –في أثناء القرن التاسع عشر– ليس نتيجةً لتطبيق القانون المدني الوافد من أوروبا، وإنما نتيجة لنشوء منظومة صحية حديثة معقدة، معتمدة على حاسة التذوق دون غيرها من الحواس. بمعنى آخر، حلت الكيمياء الجنائية الحديثة مكان الحسبة في التفتيش على الأسواق، وحدث تحول جذري من الأخلاق إلى الأمزجة، إذ صار معيار التفتيش معتمداً فقط على تذوق المنتجات والتأكد من صلاحيتها الصحية، ليس أكثر من ذلك؛ الأمر الذي أدى إلى وقوف الدولة الحديثة وحدها في موقع المسئولية الكاملة عن النظافة والصحة العامة، كما أدى إلى إيجاد منظومة مهنية تتناقض مع منظومة المحتسب.
وكما في الفصول السابقة، لا يرى المؤلف ضرراً في ذلك التحول الجذري. فهو يبدي قناعته الكاملة بالمهنية والكفاءة العلمية التي توفرها المنظومة الحديثة، وذلك بالمخالفة للرؤية الإسلامية الناقدة لذلك التحول الذي قضى على منظومة المحتسب الحامية للسلم الداخلي، أو أدمجها (على أقل تقدير) في داخل النظام القانوني الحديث، لتصير جزءاً من السلطة القسرية للدولة.
الكيمياء الحديثة بدلاً من الحسبة درءاً للعنف
يرى “فهمي” أن الحسبة لم تتوقف نتيجة “وقوع النخب السياسية والثقافية والحديثة في غواية الغرب”، وإنما بسبب العنف المفرط الذي استخدمه المحتسب، مما أثار حفيظة العديد من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين المعاصرين. فقد شهدت طبيعة وظيفة المحتسب تغيراً جذرياً عبر عمر السلطنة المملوكية الذي دام لقرنين ونصف القرن، حيث احتكرت النخبة العسكرية تلك الوظيفة بدلاً من رجال الدين والمشايخ؛ فأصبح المحتسب جابياً للضرائب، لا حامياً للأخلاق والفضيلة، بل صار ذراعاً للابتزاز السلطاني وفرض سيطرة الدولة على الأهالي. ومن ثم، قامت الدولة الخديوية الحديثة بمواجهة ذلك العنف الغاشم، عبر إدخال الطب الشرعي والكيمياء الجنائية، على حسب المؤلف. إلا أنه لا ينكر في الوقت ذاته عنف الدولة الحديثة الذي أضحى “متوارياً” مقارنةً بالعنف الصريح للمحتسب.
حلول تقارير الصحة محل الأخلاق
قادت عملية إنهاء منظومة المحتسب إلى إنشاء منظومة جديدة مرتكزة فقط على أسس طبية متصلة بالصحة العامة؛ إذ لم يعد الهدف من الرقابة على الأطعمة هو اكتشاف الغش، وإنما أصبح الهدف هو التحقق من طزاجة الطعام وقيمته الغذائية. لقد حدث تحول جذري من الاهتمام بالأخلاق العامة والمكاييل والموازين إلى انشغال عميق بالنظافة والصحة العامة. فلم يعد وارداً، على سبيل المثال،أن يُشار إلى الكتاب والسُنة والاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع المشروبات الكحولية.
وأضحت الدولة وحدها هي التي تقود وتدير تلك المنظومة الجديدة، بدلاً من روابط الأحياء وطوائف الحرف. كانت تلك المنظومة مؤلفة من مسئولين صحيين مسلحين بالعلم، يتم تعيينهم من قبل الدولة، ومن رجال الضبطية المسلحين، الأمر الذي أتاح للدولة استخدام سلطتها، وكذلك عنفها المتواري في نصوص القانون، كما يؤكد “فهمي”.
ولم يكن نشوء تلك المنظومة الجديدة نتيجةً فقط لعسكرة وظيفة المحتسب، وإنما أيضاً نتيجة التوسع الكبير الحادث حينذاك في أسواق القاهرة، في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث اتسعت المسافة بين المنتجين والمستهلكين، مما أوجد مساحات متسعة من الغش، في رأي المؤلف.
وحسب المنظور الإسلامي، تعتبر الحسبة أسلوباً للنقد الأخلاقي، منبت الصلة عن السلطة القسرية للدولة؛ وتعتبر حكماً شرعياً بالوجوب، وفرض عين لا فرض كفاية. ويعتمد الحكم الشرعي للحسبة على المبدأ الإسلامي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)؛ إذ به يُصان السلم الداخلي، ويرفع مستوى المعايير الأخلاقية للمجتمع، وتُرسخ نزاهة الأسواق، والمراقبة لمسائل الشأن العام. ويرى المؤلف في ذلك نظرةً مثاليةً، لم تتحقق في الواقع. ومن ثم يرى أن استبدالها بالمنظومة الحديثة واجب، للأسباب التي ذكرناها سالفاً.
الفصل الخامس: عدالة دون ألم
في هذا الفصل يثني “فهمي” على دور المؤسسين لدولة مصر الحديثة الذين جعلوا مصر أكثر كفاءة وأيسر إدارة، بعد مواجهتهم القوية للأسرة الخديوية الحاكمة. فبحلول خمسينيات القرن التاسع عشر، سعت الدولة المركزية البيروقراطية الحديثة (وتحديداً الضبطية) نحو فرض سيطرتها، منتزعةً القانون تدريجياً من أيدي النخبة الخديوية الحاكمة، الأمر الذي أحدث تغيراً جذرياً في النظام القانوني، تمثل في إلغاء العنف الرسمي الذي طالما اعتمدته الأسرة الخديوية في معاقبة رعاياها، واعتماد الطب الشرعي بدلاً منه. باختصار، إن ظهور الطب الشرعي وفر بديلاً عن التعذيب وإلحاق الألم بالسجناء، إذ كانت هذه الوسيلة الوحيدة لانتزاع الاعترافات منهم لإقامة الأدلة. ومرةً أخرى، يؤكد المؤلف على أن هذا التحديث لم يقده المتنورون، وإنما المؤسسون لدولة مصر الحديثة.
مقاومة العنف الرسمي في مصر الخديوية
كان تنفيذ حكم الإعدام حقاً مكتسباً، يتمتع به الخديوي وحده. وكان شروع أي مسئول آخر في قتل أحد رعايا الخديوي يمثل افتئاتاً على حقه. وقد ارتكزت سياسة “محمد علي” العقابية على التنفيذ العلني للعقوبات؛ إذ كان الضرب عقوبةً مقننة. وكان العنف الدموي سمةً أصيلةً لدى أسرة “محمد علي”، في العقود الأولى من القرن التاسع عشر. وكان إلحاق الألم بالسجناء قانونياً، لم تسع السلطة أبداً إلى إخفائه. وكانت تقبله مجالس السياسة، بينما لم تقبله المحاكم الشرعية لما فيه من إكراه يرفضه الشرع، على حد “فهمي”.
وكان من الطبيعي أن تنشأ مقاومة لكبح ذلك العنف الرسمي العلني الذي ينتهك جسد المجرم. ففي عام 1961، صدرت لائحة تعبر عن القلق العميق من مستويات العنف العلني العام. وقبلها، في بداية الخمسينيات، صدرت قوانين جديدة للحد من أنواع الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، حتى صار الأخير أمراً نادر الحدوث. إلا أن تلك القوانين مثلت أداةً هامةً للهندسة الاجتماعية، وإرساء مسافات بين الطبقات المختلفة، إذ تم استثناء السادة الكرام والعلماء من التعرض لمهانة التعذيب العلني، على حد قول المؤلف.
كان تشريع عقوبة الحبس، كبديل عن الضرب والتعذيب، إجراء آخر يصب في حماية أجساد المصريين من الضرب والألم. ففي بداية الأربعينيات، وفرت السجون المصرية وسيلةً لمعاقبة المدنيين، كبديل آمن عن الضرب. وبناءً على ذلك، تم تحويل مبانٍ قديمة إلى سجون، حيث لم يكن هناك سجون في مصر سوى “ليمان” الأسكندرية. بل تم إصلاح الأوضاع الصحية بالسجون، لتتحول من أماكن للنفي، فاقدة للشروط الصحية للإبقاء على الحياة، إلى أماكن للحبس، يحرم فيها الشخص من حريته دون فقدان صحته.
كذلك كان حلول الطب الشرعي محل الاعتراف أداةً أخرى من أدوات مقاومة العنف الرسمي، إذ وفر وسيلةً موثوق بها في إقامة أدلة الإثبات. وقد عمل نظاما المحاكم الشرعية ومجالس السياسة جنباً إلى جنب –في تناغم وانسجام– في الأخذ بتلك الوسيلة الجديدة، بالرغم من الاختلاف بينهما، كما أشرنا سالفاً. فبينما اعتمدت مجالس السياسة اعتماداً رئيسياً على الخبرة الطبية المكتوبة، لدرجة أن أصبح الاسم الرسمي لتلك الخبرة هو الطب السياسي، أخذت المحاكم الشرعية بالخبرة الطبية، شريطةً أن تكون في صورة شهادة شفهية، إذ أعطى الفقه تلك الشهادة نفس وزن شهود العيان في إقامة أدلة الإثبات. ذلك أن عدم أخذ المحاكم الشرعية بالأدلة الطبية المكتوبة راجع إلى قناعة القاضي بأن عدالة الشهود ونزاهة الخبراء أكثر أهمية من مضمون خبراتهم. ولا ينفي المؤلف، بالرغم من تأييده لإجراءات الطب الشرعي الحديثة، أن استغناء مجالس السياسة عن الشهود العدول قد أدى في أحيانٍ كثيرة إلى عمليات تزوير وتدليس في التقارير الطبية المقدمة.
خلاصة القول، يثني “فهمي” على موقف الموظفين والأطباء والإداريين المصريين، الذين قاموا بنقل مصر نقلةً نوعيةً، من دولةٍ يقودها كرباج الخديوي إلى دولةٍ يقودها العلم (الطب الشرعي)، لتصير دولةً أكثر كفاءة وعدالة. وقد أدركت الدولة الخديوية أهمية تلك النقلة لما فيها من مصلحةٍ لها؛ ذلك أن استخدام الكرباج سيعرضها عاجلاً أو آجلاً إلى تقويض قدرتها على الحكم. ويؤكد المؤلف على فرضيته، الملازمة له طوال كتابته لهذه الدراسة، التي تقول أن المصريين الأصلاء هم الذين قادوا مسيرة التحديث للدولة المصرية، وليس “المتنورون” المتأثرون بالغرب.
تعليق على الكتاب
التعليق الأساسي على الكتاب، يدور حول مدى تماسك حجته الأساسية القائمة على رفض التسليم بآثار عملية العلمنة التي أحدثتها التطورات والتحديثات التي أدخلت في ظل مصر الخديوية. حيث يؤكد الكتاب على النظر فقط إلى كيفية تطبيق إجراءات التحديث دون الالتفات إلى ماهية الأفكار والمفاهيم التي صاحبت وواكبت تلك الإجراءات وهذا ما يبدو أنه نظر غير شامل أو عادل أو وافي. ذلك أن الإجراءات، في عمومها، ليست خاليةً من الأفكار والمفاهيم، حتى وإن لم تفصح عنها. فكل إجراء يستبطن في داخله مجموعة من الأفكار والمفاهيم، ونحن مطالبون بالكشف عنها؛ ونصير مقصرين إذا ما أثنينا على تلك الإجراءات الحديثة دون إعمال العقل، ودون التدبر، فيما يكمن وراءها من أفكار. فالثقافة تتحرك جنباً إلى جنب مع المصالح، لا انفصام بينهما.
ومما يحسن الاستشهاد به هاهنا ما أثاره “إبراهيم أبو ربيع” حول مسألة التحديث، في مقالٍ[1] كتبه في عام 1998، حينما ارتأى التحديث الغربي مُحملاً بالأفكار الغربية والنمط الغربي في إدارة الحياة. فهو لا يأتي مجرداً إلى العالم الإسلامي، كما يظن الكثيرون. وكان “ربيع” يقصد، حينذاك، التكنولوجيا والرأسمالية الأمريكية، منادياً النخب السياسية المسلمة بالتصدي لتلك العولمة أو الأمركة، ناصحاً إياها بعدم إقران التحديث بالتغريب، وإنما الإتيان بالتحديث من داخل المجتمعات الإسلامية، ليتماشى مع أصولها وظروفها وواقعها.
إن “فهمي” يصب جام غضبه على الدولة الخديوية الظالمة المستبدة، متحاشياً تماماً الحديث عن التأثير السلبي الذي أحدثه الغرب تجاه مصر القرن التاسع عشر؛ وهو التأثير الذي لا يقل استبداداً وظلماً عن استبداد وظلم الدولة الخديوية؛ بل إنه يزيد عليه. وأهم روافد ذلك التأثير الغربي السلبي كان رافد “العلمانية الغربية”، الذي مد أظافره في وسط الأنظمة التشريعية والتعليمية، ليقضي على خصوصيتها وأصالتها الحضارية الإسلامية، فشوهها وطمس هويتها وكينونتها. فالمحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية والمدارس التبشيرية الأوروبية، التي دُشنت جميعها في مصر القرن التاسع عشر، كانت (وغيرها الكثير)أدوات من أجل تمكين العلمانية في مصر الخديوية، وهو الأمر الذي انعكس بوضوح على مسألة حفظ الأخلاق والشريعة والقيم في المجتمع المصرى.
عرض:
د. شيرين حامد فهمي*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] Ibrahim Abou Rabii, “Globalization: A Contemporary Islamic Response?”, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol.15, no.3, Fall 1998.
* دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies