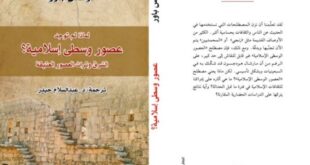العنوان: اللغة هوية.
المؤلف: مختار الغوث*
الطبعة: ط. 2.
مكان النشر: حولي “الكويت”.
تاريخ النشر: 2021.
الناشر: دار صوفيا للنشر والتوزيع.
الوصف المادي: 186 ص. 24 سم.
السلسلة: الحرب الباردة على الكينونة العربية؛ 1
الرقم الدولي الموحد: 5-41-721-9921-977.
يعتبر هذا الكتاب الجزء الأول من سلسلة بعنوان “الحرب الباردة على الكينونة العربية” تتضمن ست كتب: جاء الكتاب الثاني بعنوان: اللغة والإبداع والتعليم. والثالث بعنوان: التجني على الهوية. والرابع بعنوان: كيد الهوية. والخامس بعنوان: الهوية بعد الحادي عشر من سبتمبر. وأخيرًا جاء الكتاب السادس بعنوان مسخ الهوية.
قسَم المؤلف كتابه الأول اللغة هوية لمقدمة وخمسة فصول رئيسية، جاءت تحت العناوين التالية: الهوية- اللغة- اللغة والثقافة- اللغة هوية- الشعوب وتعظيم الهوية.
المقدمة:
ترتبط الفكرة العامة للكتاب باللغة العربية وتحديات العصر، نظرًا لارتباط الأمم بلغاتها، وكونها مفاتيح عقولهم، ومستودع تواريخها وثقافتها، ومرآة لعلومها وأفكارها وهويتها.
أوضح الكاتب أن دافعه للحديث عن هذا الموضوع جاء نتيجة ما رآه من غفلة، أو عدم علم، وعدم عمل، واستخفاف، بل والاحتقار والتجني على اللغة العربية وعظمتها من قبل بعض العرب، بل والاتجاه عنها إلى اللغات الأجنبية لكسب الجاه والرزق الذي لا تُحققه لهم اللغة العربية. والسبب الآخر، هو كيد الأعداء، وجهدهم في التقليل من شأن اللغة العربية، وطمس هوية أتباعها، وإماتة كل معنى في ثقافتهم يوقظ العزة والتأبي. بل والأكثر من ذلك هو اتجاه أعداء اللغة إلى تشويهها، وتبغيضها إلى أهلها، وإلى الناس كافة، بتحميلها كل خطيئة، وإلصاق كل منقصة بها، حتى غدا ذلك مُسلمة من المُسلمات، وكأنهم يريدونها وفقًا للكاتب لغة من اللغات الشرقية القديمة التي لا مكان لها في غير الكنائس، والبحث الأكاديمي الصَرف، ولا يضرُ جهلها، ولا ينفع علمها غير الأكاديميين. كما يوضح الكاتب أن الاستعمار يُنفق الأموال الطائلة، للتقليل من شأن اللغة العربية، وإزاحتها من الحياة، وطمس فكر وثقافة أهلها، حتى يسهل عليه فهم أهلها، ومحو ذاكرتهم وهويتهم، وإفناء خصوصيتهم.
فجاء هذا الكتاب للدفاع عن اللغة العربية من حيث كونها “هوية” وليس لسان فقط، وأيضًا لبيان أن كل نيل منها هو بمثابة نيل من العرب، من حيث هم أمة وحضارة.
أولًا: الهُوية
بدأ المؤلف هذا الفصل بدراسة عن أصل كلمة الهوية لدى النحويين وفي الترجمات إلى اللغات الأخرى، اليونانية والانجليزية والفرنسية، وتعتبر كلمة الهوية المصدر الصناعي من “هو”، اصطنعه بعض فلاسفة المسلمين لربط الخبر بالمخبَر عنه.
ويوضح الكاتب أن لخصائص الشعوب عناصر كثيرة، وأهم عنصريها هما “اللغة” و “الدين”. وقد نجد أن العرب والترك يشتركون في الدين، ولو كان الدين وحده هو “الهُوية” لكان العرب والترك هويتهم واحدة، لكن هذا ليس كذلك، فهم يشتركون في أهم أركان الهوية وهو “الدين” لكن يبقى لكل منهما خصوصيته. هذه الخصوصية يُمكن أن نقول إنها “الثقافة”، والثقافة محمولة في جوف “اللغة”. وبناءً على ذلك يُمكن القول إن “الهوية العربية” هي “الإسلام” و”اللغة”.
ولم يوضح الكاتب في أي عام “صُك” مصطلح الهوية، ولكن يوضح أنه استعمل قديمًا، حيث ورد في رسائل الكندي والفارابي وابن سينا، وربما قد يكون صُك قبل ذلك.
كما أوضح الكاتب أن “الهوية” عند بعض فلاسفة المسلمين تُعني “الوجود”، وتعني عند بعضهم مُطابقةَ الشيء نفسَه، وخصوصيته، ووجوده المُنفرد الذي لا يقع فيه اشتراك مع غيره. والمشهور عند فلاسفة المسلمين ومتلكميهم أن “الهوية” هي حقيقة الشيء الذي يتميز بها عن غيره، ويسميها بعضهم “وحدة الذات”. وفي تراث فلاسفة المسلمين كلمات ترادف “الهوية”، أشهرها: العينية، والهذية، والوحدة، والتشخص، والإنية.
و”هوية الشعب” تُعني ما لا يُشارَك فيه الشعب من صفات معنوية، والصفات المعنوية التي تتمايز بها الشعوب هي “الثقافة”، والثقافة هي: جوانب الحياة الإنسانية التي تكتسب بالتعلم، لا بالوراثة، وهي جماع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز فئة من الناس بعينها، وتشمل الآداب والفنون وطرائق الحياة، كما تشمل حقوق الإنسان، ونظم القيم، والمعتقدات، والمعرفة، والأخلاق، والرموز، والقانون، والنظرة إلى الكون، والحياة، والموت، و الإنسان، ومهامه، وقدراته، وحدوده، وما ينبغي أن يعمل، ومالا ينبغي أن يعمل، والعادات التي يكتسبها، من حيث هو فرد في جماعة. وقد أوجزها “س. إليوت” في أن “الهوية” هي طريقة حياة شعب، يحيا في مكان واحد، واللغة أساسها، لأن الشعب الذي يحيا معًا، ويتكلم بلغة واحدة يفكر ويشعر تفكيرًا وشعورًا يختلفان عن تفكير شعب يستعمل لغة أخرى. واللغة هي لسان الثقافة، ووعاؤها، ورداؤها، والدليل على العقل الذي عليه مدار الإنسانية. لذلك عرف “مارتن هيدجر” الإنسان على أنه “كائن لغوي” في حين عرَّفه الفلاسفة الأولون بأنه “حيوان ناطق”، سواء أكان المراد بالنطق الفكر، أم كان المراد به الكلام، فمفردات اللغة أجساد للمعاني، وأدلة عليها، حتى حين يفكر المرء في صمت، فإن فكره مناجاة لنفس صامتة، فإذا نطق، أخرج فكره أصواتًا.
ثانيًا: اللغة
يوضح الكاتب أن “اللغة” هي ما يجري على الألسنة، من كلام مُصطلح عليه، وليست هي المفردات في المعاجم، أو القواعد في كتب النحو والصرف، فإنما هذه تفسير للكلم، ووصْف لنظام اللغة، أو هي الجانب الشكلي من اللغة. وقد يجهل المرءُ معاجم اللغة وقواعدها وهو عارف باللغة، كما كان العرب قبل تأليف المعاجم وكتب النحو والصرف، وهم أعلم باللغة ممن جمع مفرداتها واستخرج قواعدها.
كما يوضح الكاتب أن للغة معنى وراء الشكل، وما يجري على ألسنة الناس من كلام مصطلح عليه، هو مضمونها، أي ما تحمل من المعاني، والعلوم، والفِكَر، والثقافات. واللغة بهذا المعنى هي التي تُنسب إلى (الإرهاب، الظلام، الأصولية، الجوع، الفقر، الشعر، الشغف، الوفرة، الوضوح، العدل، الصداقة، الحرية، حقوق الإنسان…الخ). وهذه صفات لمضمون الكلام الذي يجري على الألسنة، وليست بصفات لشكل اللغة، أي نحوها وصرفها وألفاظها. وهي بهذا المعنى قد تُطلق ويراد أهلها.
وأوضح الكاتب أن مفردات اللغة يكون لها في كلام الناس من المعاني أكثر مما تُورد المعاجم، فما تورد المعاجم من معاني “الجبل” على سبيل المثال هو “ما علا من الأرض واستطال، وجاوز التل ارتفاعًا”، أما ما توحي به من معانِ فلا حصر لها، ويتعذر على المعاجم إحصاؤه وإيراده، لأنه غير ثابت، ويختلف فيه أهل اللغة الواحدة، باختلاف الزمن، والثقافات الفرعية، والبيئات، والتجارب.. إلخ. ومثال على ذلك، الجبل في قوله تعالى: {وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ألله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ}، وقول الفرزدق:
أحْلامُنَا تَزِنُ الجِبَالَ رَزَانَةً وَتَخَالُنَا جِنًّا، إذا مَا نَجْهَلُ
وقول عروة بن حزام:
تَحَمَّلْتُ مِنْ عفراءَ ما ليس لي بِهِ ولا لِلجبالِ الرَّاسياتِ يَدانِ
والجبل هنا إنما هو الثقل، والرزانة، والثبات، و (Mountain) -الجبل-في الإنجليزية رمز التضخم، يُقال فيها: عندي جبال من الأعمال، وجبال من المصاعب. وهنا الجبل لا يُستعمل رمز للثقل والرزانة، كما في العربية، ولا يهيج لقلب الإنجليزي من المشاعر، ولا لخياله من الصور ما يهيج للعربي. ومن أجل ذلك، شاع أن يقال إن العربية هي العرب، والإنجليزية هي الإنجليز، وإنَّ كلَّ لغة هي أهلُها، لأنها وعاء ثقافتهم ومشاعرهم، وما أنتجت عقولهم.
ثالثًا: اللغة والثقافة
يوضح الكاتب في هذا الفصل أن من يُدرك معاني الألفاظ هم أهل اللغة، دون من يتعلمونها من غيرهم، فهم الذين يتأثرون بها أكثر من تأثر غيرهم. وفيما يتعلق بالثقافات الأخرى فإن أي كلمة بعيدة عن ثقافتهم لا تعني لهم أكثر من معناها في المُعجم، دون أن يكون للكلمة أثر في نفوسهم وعقولهم مثل أهل اللغة نفسها. فألفاظ اللغات الأجنبية عند من يتعلمها من غير أهلها كأيقونات الحاسوب، وأزرار الآلات: تدل على معنى واحد، ودلالتها عليه دلالة اّلية، لا صلة لها بالشعور، وهي عند أهلها ملأي بالأسرار والرموز، شديدة اللصوق بالأفئدة. والاستعمال والثقافة هما اللذان وضعا لها تلك الأسرار والرموز.
ويرى الكاتب، أنه قد يُتعمد استعمال الكلمة العربية في بعض المقامات؛ لأن الكلمة الإنجليزية تقصَّر عن أداء ما تؤدي، كأن يكون المرء غضبان؛ فيكون ما في الكلمة العربية من شحنات هو ما يشفي الصدر، ويذهب الغيظ. واكتسبت الكلمة العربية رمزيتها وما فيها من شحنات من استعمالها في المقامات التي تستعمل فيها، حتى غدت في الشعور العربي عَلَمًا على تلك المعاني، ورمزا لها، دون ما يرادفها من الكلمات، ولا يبلغ ما في النفس غيرُها بخلاف الكلمة الإنجليزية، فليس لها –لحداثة عهدها بالثقافة العربية-رصيد ثقافي نفسي.
من ناحية أخرى رؤي أن المجاز والكناية إذا كثر استعمالها غدت كالحقيقة وزال الفرق بينها وبين الألفاظ ذات الدلالة الصريحة، حتى لا يفرق بينها إلا العارف بتاريخها. وهذا معنى قول اللغويين إن “المجاز متى كثر استعماله كان حقيقة، عرفًا”. وقول ابن جني: “المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة”.
من ناحية أخرى يقول اللغويون أن لكل لغة نظرةً خاصة إلى العالم، ليس حتمًا أن تكون مطابقة لنظرات اللغات الأخرى، وإن المرء يستقبل ما تسمح به لغته، وما عوَّدته إياه، وهيَّأته لاستقباله، وهي تتحكم في نظرته إلى العالم. والشعوب إذ تشير إلى الأشياء في لغاتها تهتم أكثر شيء بإيحائها، وهو إيحاء لا يُطابق اللغات الأخرى.
ويرى الكاتب أن كل قوم يملؤون لغتهم بمعالمهم الثقافية، والثقافة هي التي توجَّه فهم المرء لما يقرأ ويسمع؛ إذ لكل لفظة في لغة من اللغات معنى رمزي، تصنعه ثقافة أهلها. فمن قرأ نصًا بلغة أجنبية حمَل كل لفظ منه ما عهد من دلالة “مرادفه” في لغته. ومن هنا انتقد الكاتب “الترجمة” اذ يرى أن الترجمة لا تحمل في طياتها روح الكلمة، فهي تترجم وفقًا لمعنى الكلمة في المعجم، من أجل ذلك عُدت الترجمة ضربًا من الغش والتشويه، وخيانة الأصل العفيف، والفكر الأصيل، تسوَّغه الحاجة إلى المعرفة. ويغلب على الترجمة أن تكون قليلة البهاء، منزوعة الروح، لتجردها من الرمز، وما يتبعه من إيحاء وتأثير، وليس في وسعها أكثر من التقريب، ولهذا كانت جديرة أن توصف بالعدوان والخيانة، لأنها تعتدي على الكلام، فتنزعه روحه، وتسلبه خصائصه، وتحيله كلامًا باردًا، وتلبسه رداء ثقافة أخرى. ويشير الكاتب هنا الى أن من الصعوبة ترجمة الشِعر، لأن الشعر وفقًا “للجاحظ” لا يُستطاع أن يُترجم، ولا يجوز عليه النقل، ومتى تُرجم تقطَّع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه، وسقط موضع التعجب”؛ لأنه موغل في الثقافة، والتجارب الخاصة.
تجدر الإشارة هنا أن الكاتب ينتقد الترجمة فقط فيما يتعلق بوقع معاني اللفظ في لغة غير لغته، لكنه في أواخر كتابه يرى أن الترجمة مُفيدة بشكل كبير فيما يتعلق بنقل العلوم والمعارف من ثقافة لأخرى.
وفي تبيان أهمية اللغة، يقول الكاتب على لسان “كين هيل” (إنك إذا فقدتَ اللغة، فقدتَ حضارة، وثروة عقلية، وأعمالًا فنية فقدانًا يُشبه إلقاء قنبلة على متحف اللوفر)؛ ذلك لأن شبكة الأنماط الثقافية لحضارة ما مفهرسة في اللغة التي تعبر عنها. وضرب مثالًا على ذلك بما فعله “مصطفى كمال أتاتورك” في تركيا، حيث غيَّر كتابتهم، وأسقط ما في لغتهم من مفردات (إسلامية وعربية) فسلب الترك حضارتهم وثقافتهم ومحا ذاكرتهم، وحال بينهم وبين ما كُتب بلغتهم قرونًا كثيرة، وهو ملايين الكتب والوثائق المطبوعة والمخطوطة؛ فتعذرت عليهم قراءة ما كُتب بها وفهمه، كشواهد قبور الأجداد الذين توفوا قبل قرن.
ويتابع الكاتب حديثه، موضحًا أن الأمة العربية كانت تعتز بلغتها وثقافتها بدرجة كبيرة في الماضي، وكانت العربية القديمة دالة على ثقافة العرب الأوائل مبينة عن تفكيرهم. ولكن اليوم هي لغة مرسومة على محياها هزيمة العرب النفسية، وتقسُّم هواهم بين متناقضات الماضي والحاضر، وعبوديتهم المختارة للغرب وثقافته، وكَسَلهم العقلي، والهوان على النفس، واصطناع ثقافة الغير على علاتها، ومتابعتها عن غير بصيرة. وهي أمور تظهر في كثرة الدخيل من الكلم، والأساليب المحذوة على أساليب الفرنسية والإنجليزية، واستهلاك مجازاتهما، وعباراتهما الجارية مجرى الأمثال، وتحريف الكلم عن معانيه، وما يُسمى “العربيز”، و”الفرانكو أرب”، وما تأتي به الجوالات ومواقع التواصل الاجتماعي، من الولع باللغات الأوروبية خاصة، وابتغاء العلم فيها دون غيرها، وخوف الدوائر العربية من التعريب. فظهرت مؤسسات يكثر في كلام أفرادها الدخيل من الأساليب والمفردات الغربية، وفيهم من أبنائها من يعتز بأنه يجهل العربية مقابل معرفته بالإنجليزية والفرنسية، فهؤلاء يعيشون في “سكرة ثقافية”.
وفي نهاية هذا الفصل عمل الكاتب على تبيان الصلات الوثيقة بين اللغة والثقافة، وأعطى عدد من الأمثلة على هذا الأمر، مثل ترجمة عبارة “أثلج صدري” بـ It warms my heart أو إلى اللغة الفرنسية بـ ca m’a rechauffe le Coeur مع أن العبارتين تعنيان أدفأ قلبي، والدفء والثلج ضدان، غير أن الدفء هو ما يريح الإنجليز والفرنسيين لبرد بلادهم، والبرد هو الذي يريح العرب لحرارة بلادهم. ولذلك فإن معرفة “اللغة” وحدها لا تكفي المترجم، بل يجب أن تزداد إليها معرفة بيئتها، والعلم بثقافتها، لأن المترجَم ثقافة، وأن المجتمع اللغوي نتاج المجتمع الثقافي.
رابعًا: اللغة هوية
يؤكد الكاتب مرةً أخرى في هذا الفصل أن الهوية هي ما تختص به جماعة من الناس من صفات معنوية، سميناها الثقافة، وأن “اللغة” ثقافة، لأنها سجلَ علومها وعقائدها وتجاربها وذكرياتها، فهي مستودع الشعوب، والرباط النفسي بين الأولين والآخرين، وذلك لما تنشئ في المرء من شعور بوحدة الرابطة العقلية والنفسية والعاطفية التي تشد الناس بعضهم إلى بعض، وتختزن جانبًا من اللاوعي الجمعي بين جموع الناس.
كما يؤكد الكاتب أن اللغات المكتسبة لا يُمكن بحال من الأحوال أن تحل محل اللغة الأم، وأن الذي يُخاطب من يوافقه في اللسان يجد من راحة النفس ما لا يجد إذا يتحدث إلى غيره. فاللغة وفقًا للكاتب، هي اَلة التفكير بين الناس، ووسيلة التفاهم ونقل الأفكار والتراث من السلف إلى الخلف. ولهذا كانت تُحدث بين من يشتركون فيها توافقًا في الفكر والشعور، يترتب عليه أن يكون بينهم من التقارب أكثر مما يكون بينهم وبين غيرهم، ولهذا سمَّاها البعض “أسمنت الشعوب”. واللغة تُرجمان ما في الصدور والعقول من أفكار، وأديان، وثقافات.
فاللغة إذن (هوية)، ولما كانت هوية، كانت الشعوب رهنًا بها وجودًا وعدمًا، تبقى ما بقيت، وإن ضعُفت، وقلَّ استعمالها ومستعملوها، فإن ذهبت، ذهبت بذهابها الشعوب وانقرضت، وإن لم تنقرض من حيث هي سلالات، وإنما دخلت في غيرها، فاصطبغت بثقافته، وتكلمت بلغته، كما انقرض الفينيقيون، والسريان، ومن بقي من العرب بإسبانيا وصقلية، بانقراض لغاتهم، وإن لم تنقرض أعيانهم. ويضرب الكاتب هنا المثل برفض إمبراطور اليابان أن يتنازل عن اليابانية، كما أراد الأمريكيون أن يفعل، بعد انتصارهم عليه في الحرب العالمية الثانية؛ لأن الإنجليزية إذا حلًّت محلها صار اليابانيون أمريكيين، وتحللت هويتهم بذهاب لغتهم، طال الزمن أو قصر. وهو أيضًا من أسباب حمْل الاستعمار الشعوبَ على تعلم لغته وترك لغاتها؛ ليمحو ثقافتها، ويطمس هويتها، ويستنبت مكانهما ثقافته وهويته؛ فتنحلَّ فيه، بعد أن تزول دواعي الحرص على التمييز منه. إذن اللغة من أهم الأصول التي تُبنى عليها جنسية الشعب، ورمزًا قوميًا في كل مجتمع.
هذا وضرب الكاتب في هذا الفصل عددًا كبيرً من الأمثلة على المكانة الكبيرة لكل لغة في نفوس أهلها، وكيف عمد الاستعمار على ضرب لغات البلدان التي استعمرها.
ثم تطرق الكاتب للغة العربية، وكيف أنها رابطة قوية بين العرب (مسلمين ونصارى)، على ما بين سياسييهم من تخالف في الأهواء، والمنافع، والتبعية السياسية والاقتصادية. فهم يلتقون عليها، وعلى مراجعها الثقافية، حتى تلك التي يخالفها بعضهم من جهة المعتقد، ويعتزون بها، ويتغنون بجمالها، ويشتركون في خدمتها، ونشر تراثها، ويتجاوز بعض النصارى منهم حبها لغًة وثقافةً إلى حبها تاريخًا وحضارةً، وحبَّ القراّن وحفظه، والاعتزاز به، والمجاهرة بالانتماء إلى حضارة الإسلام والفخر بها، ومدح النبي –صلى الله عليه وسلم- وفي هذا الصدد ضرب الكاتب لعدد من الأمثلة لكتاب عرب مسيحيين يتغنون باللغة العربية والإسلام، منهم على سبيل المثال المفكر العربي السوري “ميشيل عفلق” واللبناني “فكتور سحَّاب”.
واللغة هوية من حيث هي تاريخ لعقول أهلها، وحياتهم، وعلاقاتِهم الحضارية، ومعجم لبيئتهم، وصورة لها في عقولهم ووجدانهم. كما أنها هوية للمكان. فكل ما وقعت عليه عين المرء في أرضه من حيوان أو جماد سماه حتى لا يبقى في المكان شيء إلا وله في اللغة اسم، ومن القلب مكان، وفي الخيال صورة. فإن خرج شيء عن بيئة اللغة جهلته، وتعاصى عليه البيان عنه. على سبيل المثال لا يتوقع المرء كثيرًا من المفردات الدالة على الأشجار في لغة الأسكيمو، ولكنه يتوقع أن يجد في لغة القبائل التي تصيد الحيوان كثيرًا من المفردات الدالة على طرق مُحددة أو دقيقة في الصيد، إذن فتاريخ أهل كل لغة وثقافتهم محمولان في لغتهم، ومعجمها مرآة لحياتهم، وطبائعهم، واهتماماتهم، ومعارفهم، وعاداتهم، ومعتقداتهم، ومُثُلهم العليا في فلسفة أخلاقهم. ولهذا كانت اللغة هوية، لأنها مرآة، ترى فيها الشعوب تاريخها الحضاري، ومبتدأ نشأتها، وما جازت من أطوار، كما ترى فيها صورة بلادها. ويرى الكاتب أنه مَن جهل بيئة اللغة عسُر عليه أن يتصور ما ترمز إليه مفرداتها من معانٍ، لأنه لا يدرك ما بين المحسوس والمعقول من علاقة. من أجل ذلك يكون فقه المرء باللغة على قدر ما يتصور من بيئتها المادية والمعنوية (الثقافة).
ويؤكد الكاتب أن الشعوب كلما تقدمت ازداد اعتدادها بلغتها، وحفاظها عليها، وغدت لغتها عندها هي هويتها التي ترى النَيل منها نَيلًا من وجودها. وانظر –إذا شئت دليلًا على ذلك- إصرار الدول الكبرى على عدم التوحد على لغة واحدة في منظمة من المنظمات الدولية. إذن لو لم تكن اللغة هوية، لما عُنيت بها الشعوب هذه العناية كلها، وما كانت إلا ألفاظًا تتساوى في البيان عن كل شيء، كما تتساوى الأرقام في الدلالة على الأعداد، والرموز في الدلالة على المفاهيم العلمية. غير أن اللغة بعيدة عن ذلك.
ولما كانت اللغة هويةً، كان دأب الاستعمار أن يبعْث ما في مستعمراته من اللغات، ويصنع لها هجاء يكتبها به، إن لم يكن لها هجاء، أو يكتبها بالحرف اللاتيني، ويستخرج قواعدها، ويستعملها في الإدارة، ويحيي ما درس من تراثها، ليعلقهم به، ويشعرهم بالتميز ممن كانوا يتحدون بهم. فإن لم تكن متعددة اللغات باعد بين لهجاتها حتى يصيَّرها لغات، يستحدث بها هويات، يشتَّت بها شمل الشعوب، ليستعين بتشتيتها على إضعافها، ومن ثم السيطرة عليها؛ إذ قد علم أن تعدد اللغات يلزم منه تعدد الهويات، وإذا اختلفت الهويات، تعذَّر الاجتماع على شيء، فيقدَّم لغته على أنها مخرجُ من الخلاف، والحل الذي يلتقي عليه المتنازعون، فإن اصطنعوها، انتقلت إليهم ثقافتهم، وبانتقالها يكون التدمير المنتظم لثقافاتهم، وقتل لغاتهم، وسلخهم من هوياتهم؛ فيسهل عليه ما كان يعسر من استلحاقهم واستتباعهم، ويسوَّغ لهم ذلك بأن لغته لغة الحداثة، والعلم، والمال، والجاه، والمناصب، بعكس اللغات الوطنية، فإنها لغات الجهل والتخلف، ويُلصق بها كل ما ينفًّر منها أهلها ويحقَّرها إليهم.
إذن الشعوب التي تتخلى عن لغتها، تكون بذلك قد حققت للمُستعمر مُبتغاه، إذ تتخلى عن عصبيتها، وتموت فيها روح المقاومة، وتتعطل طاقتها الإبداعية، ويرضى بالاستهلاك؛ فيفتح الأسواق لبضاعتهم، ويغض الطرف عما ينهبون من أرزاقها. فالاستعمار -وفقًا للكاتب- جعل المستعمَرين يحتلُّون أنفسهم؛ إذ احتلتهم ثقافته، فاستبعدتهم، فغدت التبعية له والاتحاد به، والاندماج فيه، ونسيان كل شيء من خصوصيتهم غاية ما يرجون. وهذا من أسباب أن اللغات الأجنبية انتشرت بعد رحيل الاستعمار أضعاف ما انتشرت في أيامه، وأن العرب الذين اتخذوا العربية رمزًا للمقاومة أيام الاستعمار جعلوها عنوان التخلف بعد الاستقلال، وكأن الدماء إنما سالت لتوطين لغة المستعمر وثقافته.
خامسًا: الشعوب وتعظيم الهوية
أوضح الكاتب في هذا الفصل أن الذين تبينوا علاقة اللغة بالهوية، من الشعوب الناضجة، والفلاسفة، والمفكرين، والمصلحين، والساسة الوطنيين؛ ينظرون إلى لغاتهم نظرة تباينُ نظرة الشعوب غير الناضجة إلى لغاتها، فهم يعتزون بها، ويدافعون عنها، ويجتهدون في صونها، والتمكين لها، كما يظهر في تشريعهم، وتراثهم، وأقوالهم. وضرب الكاتب هنا أمثلة من دول مختلفة (بريطانيا، فرنسا، اسبانيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، الصين، اليابان.. وغيرها) توضح كيفية اعتزاز هذه البلدان بلغاتهم. فاللغة إذن هي لسان الفكر، وترجمان الهوية.
ثم تطرق الكاتب لحال العرب، وكيف أن كثير من العرب تأثر بالغرب تأثرًا غير حميد، أضعف الانتماء الحضاري، والاعتداد بالهوية، والولاء للوطن. وهنا يوضح الكاتب أن ذلك يعود لقلة النضج، فقد بهرهم كلًّ ما رأوا، فكانوا يعدًّون السبيل إلى التقدم أن يُماثل العرب الغرب في كل شيء. وضرب الكاتب المثل بالحياة في مصر، فهو يرى أنها أوروبية خالصة في الطبقات الراقية، وتختلف قربًا وبعدًا في الطبقات الأخرى باختلاف قدرة الأفراد والجماعات، وحظوظهم من الثروة. ويعرض هنا الكاتب لبعض أفكار طه حسين وسلامة موسى اللذان كانا يدعوان إلى مماثلة الغرب في كل شيء وأن يركب العرب في سبيل ذلك كل صعب.
ويرى الكاتب أن الفرق بين دول مثل الصين واليابان والدول العربية والأفريقية، أن الأولى أخذت من الغرب العلوم والتقنيات الحديثة، واحتفظت بروحها وأخلاقها وهويتها. بينما ترى بعض النخب العربية أن يكون الروح، والتقنية، والمعرفة غربية، أو لا تكون. ويقول الكاتب الكيني “على المزروعي” إن مصر وإفريقيا بلغتا ما بلغتا بعمل مْضن من التغريب الثقافي بدون تحديث صناعي، وكان التغريب الثقافي تغريبًا شكليًا بعيدًا من روح الحداثة والعلم، ولا يتجاوز القشرة.
كما أوضح الكاتب أن أشد ابتلاء بُليت به الأمة العربية، هو افتخار بعض نخبها باللغات الغربية عن لغتهم الوطنية، بل إن البعض منهم اعتبر العربية سببًا من أسباب التخلف، وسعى لإخراجها من الحياة، وغالى في التغريب، وبالتالي كانت الحرب على العربية وسائرِ أركان الهوية العربية أكبر همهم، وسعى بعضهم لسجنها فيما يكرهون من زوايا الحياة كالعلوم الشرعية.
كان هؤلاء العرب على طرفي نقيض مع اليابان التي بُنِي تعليمها على أصولها وعاداتها الوطنية، لتكون وسيلة توحيد عقل الأمة والحفاظ على هويتها، كما بدا في إصرارها على استعمال اللغة الوطنية في التعليم، والتوسل بالترجمة إلى الانفتاح على العلوم والمعارف الحديثة، وتمييزها من التغريب، فاستوعبت العلوم الغربية بأدواتها، ولم تسقط في التغريب والحداثة المشوهة. وذلك على خِلاف الوطن العربي الذي يُعاني صورًا بائسة من الحداثة الرثة بسبب علاقته بالغرب غير المستبصرة، والترحل بين نظرياته الفكرية، واحتقار التراث، لقلة ما فقهوا منه.
ثم تطرق الكاتب لمكانة اللغة والهوية في الدول العربية من بدايات القرن التاسع عشر، فيوضح على سبيل المثال أن اللغة العربية في القرن التاسع عشر كانت عند الحكومة المصرية كالألمانية عند الألمان، فقد أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني 1893 قانونًا، ينص على أن العربية هي لغة البلاد، ومن الواجب جعلها أساسًا للتعليم في مدارس الحكومة، وتقديمها على أي لغة أخرى، وأوجب أن تشتمل برامج المدارس الأميرية على أكثرِ ما يمكن من المواد باللغة العربية، حتى تتأتى معرفتها معرفة تامة وأكيدة، ولا تعطي نِظارة المعارف العامة طالبًا شهادةً في طور من أطوار التعليم، مهما تكن معرفته بسائر المواد، إلا إذا كانت معرفته بالعربية مستوفية للشروط المنصوص عليها في برامج الحكومة الرسمية.
وهذه النظرة المصرية للتعليم تجلت منُذ عهد محمد علي وفي سائر أبنائه من بعده، إلى أن جاء الاحتلال الإنجليزي، وأجبر مصر على اصطناع الإنجليزية مكان العربية. لكن نظرة عباس حلمي الثاني للعربية تُبين لنا كيف كانت الحكومات القديمة بهذا الوعي، والصرامة في الهوية، بعكس الحكومات الحديثة –التي تدعي العلم والحداثة- لكنهم في حقيقة الأمر أكثر استخفافًا بالهوية، وازورارً عن اللغة العربية.
في السياق ذاته تطرق الكاتب للتجربة السورية في الحفاظ على اللغة العربية، حيث ذكر أن البلد العربي الوحيد الذي كان الأكثر اعتزازًا بلغته، هو الشعب السوري أيام الحكم العربي، فقد رافق قيام الدولة العربية في سورية شعور عارم بالعزة والكرامة، فاندفع السوريون جميعًا، معلمين وصحفيين، وكتابًا، وأدباء، وشعراء، وموظفين، وسياسيين، في معركة التعريب، وحلت العربية محل التركية في المدارس والدواوين، فتم تعريب الدواوين وإصلاح لغة التعليم والصحافة في مدة قصيرة، وكان لمجمع اللغة العربية بدمشق دور كبير في ذلك الأمر.
ويوضح الكاتب أن ما نحتاجه كعرب هو التخلص من التبعية والتحلي بالعزة الحضارية، والهمة، والإرادة، والثقة بالنفس. لقد عارض كثير من العرب حكوماتهم في التعريب، والتقدم والاستقلال، فحملوها على تخليد ما صنع بهم “عدوهم” حملًا. وأبرز مثال على ذلك ما قام به أساتذة الطب المصريين بجامعة القاهرة بمرسوم وزير المعارف “محمد حسين هيكل” عام 1938بتعريب التعليم، فقد ماطلوا في تنفيذه لمدة عشرة أعوام، متأكدين أن الوزير لن يمكث طيلة هذه الفترة في الوزارة، وأن من سيأتي بعده لن يولى اهتمامًا كبيرً بمسألة التعريب في الطب.
كما بين اعتزاز اليهود بلغتهم العبرية، وكيف طالبوا بريطانيا عندما احتلت فلسطين عام 1920 أن يتم نقش اللغة العبرية على النقود. ويوضح الكاتب بأنه لم تكن عبرية إسرائيل هي عبرية التوراة، أو العبرية التي تحمل تراث اليهود القديم في المشرق والمغرب، قبل الإسلام وبعده، وإنما هي لغة مصنوعة من عشرات اللغات واللهجات، يُلزمها المهاجرون إلزامًا، وكان اليهود يأخذون من العربية ما يستعينون به على نقل العلم إليها. وبهذا صنع اليهود لغة، لتكون لهم هوية، ونسبوها إلى التوراة ليكسبوها قدسية، تعلَّقهم بها، وتجمعهم عليها، وأخذوا لها من العربية ما عوضوا به فقرها.
ويوضح الكاتب على نقطة مُهمة وهو ان اصطناع اللغة الوطنية لا يعني الإعراض عن اللغات الأجنبية، فيقول الدكتور “الغوث” أنه لا يعرف من أنصار التعريب من قال بإهمال اللغات الأجنبية، أو زهَّد في تعلمها، وإنما فرَّقوا بين تعلم اللغات والانفتاح بها في البحث العلمي، والتعليم بها، وميزوا بين الاستعمال الذي ينال من الهوية والاستعمال الذي لا ينال منها. ويستشهد الكاتب بمقولة الدكتور “موسى الشامي”، عندما قال “نحن مع الانفتاح على اللغات، ولكن حين ندعو إلى الانفتاح الذي اختارته الدول المتقدمة كلها، ندعو إليه مع الحفاظ على هويتنا وخصوصيتنا اللغوية، والانفتاح يكون حسب مصلحة بلدنا”.
وهنا يُفرق الكاتب بين دُعاة التعريب ودُعاة التغريب، إذ أن دُعاة التغريب إذ يصرون على التعليم بلغة أجنبية، إنما يريدون إخراج العربية من الحياة واستبدال اللغة الأجنبية بها. ويريد دُعاة التعريب أن يُمكَّن للعربية في الحياة، ولا سيما التعليم والإدارة، وتأخذ من اللغات الأخرى ما يتواكب مع جديد العلم.
كما يرى الكاتب أن علاقة العرب بلغتهم أثر لسياستهم اللغوية، وهي سياسة مبنية على تعظيم اللغات الأجنبية، وإيثارها بكثير من مجالات الحياة، والاستهانة بالعربية، وتصغيرها. الأمر الذي دفع أحد المستشرقين للقول بأن “ليس على وجه الأرض لغة لها من الروعة والعظمة ما للعربية، ولا على وجه الأرض أمة، تسعى بوعي أو بغير وعي في تدمير لغتها، كالعرب”.
كما أوضح الكاتب أن العرب قد مُنِيوا بصنفين من الناس، هم سبب ذلك: الساسة الذين لا يعلمون، وحَمَلة الشهادات العليا الذين لا يعون، ومن كان ذا وعي من حملة الشهادات، فهو يدين بالتبعية للغير، ويرى أن ليس للعرب إلا أن يجتهدوا في مماثلته. وهؤلاء هم الذين يعلنون الحرب على العربية سرًا وجهرًا، ويعارضون التعريب، وهم –في الغالب-بطانة الساسة الذين لا يعلمون. فقلة علم الساسة نأت بهم عن اللغة، وفهمها، وفهم ماهيتها، وصلتها بالعقل والثقافة والهوية.
ثم وجه الكاتب اللوم على الرؤساء القوميون، إذ لم تكن للغة العربية مكانة في برنامجهم السياسي. كما أوضح أن من مواطن الضعف في الرئيس المصري “جمال عبد الناصر” أن لم تكن له عقيدة شاملة، ولا كان ذا وعي لغوي، أو صاحب نظرية وعقيدة ثورية، وإنما كان رجل مواقف، فلم يدرك أن بقاء سيطرة لغة المستعمر على قطاعات من حياة البلاد بقاء لهيمنته عليها.
وختامًا أوضح الكاتب أنه من الاستهانة بالعربية أن يتفرد العرب من دون شعوب العالم بتساوي عالمهم وجاهلهم، ورئيسهم ومرؤوسهم، في استعمال العامية في كل حال ومقام، فيخطب بها الرئيس، ويدرَّس بها الأستاذ في أطوار التعليم كلها، ويتكلم بها المفكر، والأديب، والمثقف، والناقد. وبعد أن كانت الفصحى هي لغة الإعلام والمثقفين والعامة؛ تُرك الأمر لكل من هبَّ ودبَّ وباتت العامية هي لغة الجميع، في شيء أشبه بالتهريج منه بأي شيء اَخر.
عرض:
أ. أحمد محمد علي**
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* من مواليد 1969، كاتب موريتاني وأستاذ مناهج بحث أدبي ولغوي بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.
** ماجستير في العلوم السياسية. جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies