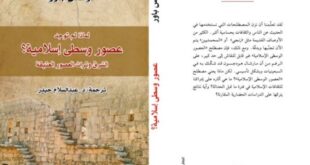العنوان: اللغة والإبداع والتعليم.
المؤلف: مختار الغوث*.
الطبعة: ط. 2.
مكان النشر: حولي “الكويت”.
الناشر: دار صوفيا للنشر والتوزيع.
تاريخ النشر: 2021.
الوصف المادي: 295ص.، 24 سم.
السلسلة: الحرب الباردة على الكينونة العربية؛ 2.
الترقيم الدولي الموحد: 3-39-721-9921-978.
يأتي هذا الكتاب “اللغة والإبداع والتعليم” لمؤلفه مختار الغوث ضمن سلسلة بعنوان “الحرب الباردة على الكينونة العربية”**. وكانت بداية هذا العمل فكرة حول علاقة الهوية باللغة، كان المؤلف ينوي كتابة كتابًا صغيرًا فيه، إلا أنه بعد البحث والتعمق رأى أنه لا يمكن الاكتفاء بكتاب واحد، وأن كتابًا واحدًا سيكون ضخمًا وثقيلاً على القراء، فقرر أن يبث أفكاره وبحثه في موسوعة مكونة من ثمانية أجزاء، أنجز منها حتى الآن ستة أجزاء. وقد استغرق تأليفها قرابة الستة أعوام.
بعد أن أكد الكاتب على العلاقة بين اللغة والهوية في كتابه الأول “اللغة هوية”، يحاول في هذا الكتاب -وهو الجزء الثاني من السلسلة-، أن يشير إلى علاقة كل من الإبداع والتعليم باللغة، كما يتحدث عن حصاد التعليم باللغات الأجنبية في الوطن العربي، وأهمية تعريب العلوم في المدارس والجامعات اليوم.
اللغة والإبداع:
يشير المؤلف إلى العلاقة الوطيدة بين اللغة والإبداع؛ فالإبداع لا يتأتى إلا من خلال استيعاب العلوم، ولكي يتم استيعاب العلوم بشكل تام لا بد من فقه اللغة التي يتم التعلم بها. لذلك، فالتعليم باللغة الأم أسهل لأنه يقيم علاقة بين المتعلم والمفاهيم والأسماء المتداولة في الحياة، ويقصد باللغة الأم اللغة التي تُكتسب بالسليقة مرة واحدة ولا تُتعلم غالبا، وتتمكن من العقل تمكنا لأنها هي التي تسبق إليه، فإذا خطرت الفكرة في الذهن خطرت مقترنة بالألفاظ التي تفصح عن الفكرة أو المعنى المعين، والمعلومات والأفكار لا تكون أساساً للإبداع ما لم تكن جزءا من الشعور والخيال والفكر، يمكن استدعاؤه استدعاءً غير واع؛ فالإبداع إنما هو إلهام يفيض عن الملكات فيضا تلقائيا تعبر عنه أطوع اللغات وألصقها بالعقل؛ التي هي اللغة الأم. هذه العلاقة بين العقل واللغة هو ما يتيح المجال للإبداع. ولذلك قال جوته إن الإنسان لا يحيا الا بلغة واحدة، ولا يبدع الا بها، فإن فكَر بغيرها لم يبدع، لأن الفكر “لا يولد الا مرة واحدة، وبلغة واحدة”.
ويحاول الكاتب تبيين العلاقة بين اللغة والإبداع سواء الإبداع في الأدب من شعر ونثر وغيرها، أو في العلوم المختلفة؛ فيرى أن التعلم باللغة الأم شرط للإبداع، ولا يمكن الإبداع بلغةٍ أخرى إلا في حالات نادرة استثنائية وبصعوبة شديدة.
الإبداع في الأدب: يرى الكاتب أن الإبداع في الشعر والأدب لا يتأتى إلا باستعمال اللغة الأم؛ ذلك أن استعمال اللغة الأم يتيح للمؤلف قدرا من العفوية وحرية التصرف ما لا تتيحه اللغات الأخرى التي تعلمها على كِبَر وإن أجادها إجادةً تامة. ففي البداية يبدأ المؤلف أو الأديب بالتعرف على المثل الفنية للغة ومحاكاتها، ثم يتجاوزها بعد ذلك ليبدع بنفسه مثله وبأساليبه الخاصة، لأنه كلما فقه لغته الأم، كلما تمكن من التصرف فيها على الوجه الأمثل لأداء المعنى كما يجده في نفسه؛ فيقدّم ويؤخر، ويحذف ويذكر ويعرّف وينكر، وهكذا. أما اللغة التي يتعلمها تعلماً، فليس في وسعه أن يتصرف فيها الا تصرفاً منقوصاً، على قدر فقهه بها، وهو تصرف لا يتأتى من مثله إبداع. فالإبداع في هذه الحالة يكون مجرد من “رونق الطبع، ووشي الغريزة” وهما روح الإبداع، فيعاني العمل الأدبي من تكلف واضح. ولذلك، يقول الكاتب الأمريكي البولندي الأصل لويس بيغلي: “البولندية لغتي الأم، ولأسباب لا يد لي فيها أكتب بالإنجليزية؛ فأنا كاتب يتيم، وأشعر بعدم امتلاكي العفوية والحرية حين أكتب بالإنجليزية، وقد تمكنت منها تمكنا تاما وأنا في الرابعة عشر”.
أما الأدباء العرب الذين كتبوا بالإنجليزية كجبران خليل جبران وأمين الريحاني فلم يشتهروا بصفاء لغتهم ولا بفصاحة تعبيرهم بقدر ما اشتهروا بروح الشرق الظاهر من سطورهم، فتمكنهم من اللغة ليس كتمكن أهلها، لذلك يظلون في طور المحاكاة، “والإبداع مشروط بالشعور بالتميز والاختلاف، واستقلال النظرة إلى العالم، ومن نظر بعين غيره لم ير غير ما يرى، ولم يقل غير ما قال، وكان أكبر همه أن يماثله”.[1]
أما ما يُكتب اليوم باللغة العربية فكثير منه مترجم ترجمة حرفية، شكلاً ومضموناً ورموزه مستوردة، وليس لها مكان في قلوب العرب، والغالب على أصحابها العجز عن ابتداع رموز أصيلة، فهناك فقر في معجمات هؤلاء الأدباء واقتصارهم على المفردات الدارجة على أقلام الصحفيين، وقلة الأساليب المبتكرة لعدم إجادتهم اللغة العربية؛ فيقول هاملتون جب “إن الأدب العربي الحديث كله ترجمة “كاملة وأمينة” لما يُكتب في باريس ولندن”. كما يقول دومنيك شوفالييه لأحد صحفيي العرب: “ليس لديكم سوى استغراب”. ويدل هذا التقليد والضعف على شعور بالعجز كما يوهم من لا يعرفون الأدب أن ذلك إنما هو قمة الحداثة والإبداع!
وهناك العديد من الأمثلة على تقليد شعراء العرب لشعراء الفرنجة، من ذلك على سبيل المثال، ما قام به بدر شاكر السياب في قصائده، فيقول في قصيدته “هل كان حبا؟”: ما يكون الحب؟ نوحا وابتساما؟
لكن استعمال “يكون” بين المبتدأ والخبر ليس بعربي، وإنما ترجمة حرفية للكلمة الإنجليزية “What is love”، والصحيح أن يقال “ما الحب؟ أنوحٌ وابتسامٌ”.
وإن كان تقليد السياب جاء في الأساليب والتراكيب، فهناك شعراء استنسخوا قصائد كاملة من شعراء أجانب، مثل إبراهيم المازني الذي نقل بعض قصائده من أدباء أجانب مثل قصيدته “الشاعر المحتضر” التي نقلها من قصيدة “أدوني” لشيلي الإنجليزي[2].
مما تم استنساخه أيضا من شعر الغرب؛ الرموز والأساطير والإبهام، وهي أمور لا تمت لتراث العرب بصلة، بل منقولة من المذاهب الأدبية التي شاعت في أوربا. فتجد الرموز الأسطورية كبرومثيوس وسيزيف وعشتار مُقحمة في معظم الشعر العربي، لكنها لا تُحدث أي أثر في نفس القارئ العربي ومشاعره لأنها ليست جزءا من ثقافته وهويته. كما تجد الشعراء يتكلفون الغموض والإبهام أو يستنسخونه من شعراء الغرب ليوهموا القارئ أن لما يقولون قيمة فنية ليست له! وهذا الضعف الذي أصاب الأدب والشعر العربي يتأتى من ضعف منشئيه في العربية وقلة زادهم منها، وهو ما يحول دون الإبداع ويوقع هؤلاء في فخ المحاكاة والتقليد؛ لأنهم لا تمكنوا من لغتهم بالمقدار الذي يسمح لهم بالبوح عما في نفوسهم بها، ولا هم تمكنوا من اللغة الأجنبية!
أما الذين أبدعوا من أدباء العرب فهم الذين غمسوا أنفسهم في تراثهم، ففقهوه، وأمسكوا بناصية اللغة وتشربوا روحها، كاحمد حسن الزيات وطه حسين وعبد العزيز البشري ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم ممن سبقوهم من أدباء العربية الأوائل كأبي تمام والبحتري والمتنبي وغيرهم كثير.
اللغة والتعلم:
يحاول الكاتب البرهنة على صعوبة تعلم العلوم والآداب باللغات الأجنبية، هذه الصعوبة تحول دون استيعاب الطلاب لهذه العلوم بشكل كامل مما يصعب إضافتهم لتلك العلوم وإبداعهم فيها.
يتحدث الكاتب عن كيفية اكتساب اللغة؛ فاللغة يتم اكتسابها بالتدريج في الشهور الأولى من عمر الإنسان من صوت الأم وكلامها، وهكذا تتشكل لديه الأفكار والتصورات الأولى. يتعامل الإنسان مع الأشياء من حوله ويتعرف على معانيها ووظائفها ثم يتعلم الألفاظ التي تدل عليها. هذه اللغة التي اكتسبها منذ نشأته هي لغته الأم، لكنه حين يتعلم لغة أخرى يبدأ بتعلمها أولا ثم يعيد تنظيم ما تحوي اللغة من معارف وأشياء من خلال قياسها إلى معارف لغته، وهكذا تكون اللغة الثانية منفصلة عن المعارف وتحتاج إلى وساطة اللغة الأم من أجل فهم مفاهيمها. لذلك، فالكلام باللغة الثانية ما هو إلا ترجمة ذهنية عن اللغة الأم؛ لأنها هي التي تبلغ ما في نفسه.
واللغة لها جانبان: جانب صوري وجانب رمزي؛ فالجانب الصوري يتمثل في منطوق الكلام الظاهر سواء كان مقروءا أو مسموعا، أما الجانب الرمزي -وهو روح اللغة- يكون مستمدا من الثقافة ونتاجا لتلاقح معارف وخبرات المرء مع النص بحيث تنتج معاني جديدة تزيد في النص ما لا ينطق به ظاهره. فالتعليم باللغة الأم يوفر للمرء تفاعله مع النصوص والمفاهيم التي يتعلمها حتى تخلص إلى قلبه وعقله ويستطيع ربط ما يتعلمه بثقافته، وبالتالي تنتقل اللغة إلى عالمها الروحي والرمزي، أما التعليم باللغة الأجنبية يحبس اللغة في جانبها الصوري فلا يستطيع المرء سوى فهم الدلالات الظاهرية للمفاهيم التي يتعلمها دون هضمها جيدا أو التفاعل معها.
وقد يؤدي هذا إلى تغريب المرء عن بيئته تغريبا حسيا ومعنويا؛ فالمفاهيم والمعارف التي يتعلمها بلغة أجنبية عنه بعيدة كل البعد عن ثقافته لا يستطيع ربطها بخبرات أو مشاهدات له؛ فـ”الطفل في البلاد المستعمرة تقطع صلته بلغته، وتفرض عليه لغة المستعمر، فيغترب عن بيئته، ويعرض لثقافة عالم آخر يُلزمه أن يرى العالم بعينها، ولا يرى الأشياء إلا كما تظهر في لغة المستعمر”.[3]
وإذا كان التعلم في المدرسة والجامعة بغير لغته الأم، يكون أمام صعوبتين: الأولى فهم اللغة وتراكيبها وفك رموزها، والثانية فهم مصطلحات العلم والمعارف التي يدرسها، فتجتمع عليه مشقتان لا واحدة، ويضطر إلى بذل جهد ووقت كبير في ترجمة المصطلحات إلى لغته حتى يتصورها.
والبحوث والدراسات تؤكد ما يقوله الكاتب من أن استجابة المتعلمين للغتهم لا تكون كاستجابتهم للغة أجنبية، وإن أتقنوها، فتُظهر إحصائية scimago أن العشرين دولة الأولى في الطب في العالم تدرس بلغاتها. وتخلص بعض البحوث التربوية والاجتماعية إلى ضرورة تدريس العلوم باللسان القومي حتى لا تُجمع على المتعلم مشقتين: مشقة فهم اللغة الأجنبية وترجمتها، ومشقة فهم المادة العلمية ذاتها. أما مؤشر التنمية الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيظهر فيه أن البلدان في أعلى سلم التنمية هي التي تستعمل لغتها كفنلندة والنرويج، أما البلدان التي هي أقل تنمية في العالم هي التي تستعمل اللغة الأجنبية في التعليم والعمل كمصر والمغرب.
ثم يسرد الكاتب العديد من الدراسات التي أُجريت على عينات من طلاب عرب في جامعات مختلفة، وتكاد تُجمع هذه الدراسات على أن أكثر الطلاب والأساتذة في الكليات العلمية يؤيدون تعريب العلوم ويرون أن التعريب أفضل من التعليم باللغات الأجنبية وأسهل في استيعاب الطلاب. ويمكن الإشارة هنا إلى نقطتين جوهريتين: الأولى أن نتائج الدراسات التي أوردها لا يمكن تعميمها على كل الطلاب العرب، بل تصدق على المدروسين وحدهم، مع إمكانية الوصول إلى دلالات معينة من تلك النتائج. الثانية أن بعض الطلاب الذين يفضلون التعلم باللغة الأجنبية مفهومة دوافعهم، فهم يعرفون اللغة الأجنبية أفضل من معرفتهم بالعربية بسبب ظروف نشأتهم أو تعلمهم منذ الصغر، فلا يعرفون من العربية إلا ما وافق العامية الدارجة التي يتحدث بها حديثه اليومي.
حصاد التعليم باللغات الأجنبية:
يقوم الكاتب هنا بتقييم عملية التعليم باللغات الأجنبية سواء في المدارس والجامعات لنرى هل كان من الضروري فعلا الانتقال من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية في المدارس والجامعات؟
فيرى الكاتب أن تفضيل المدارس الدولية على المدارس العربية نظرا لقيامها بتعليم الأطفال التفكير والعناية بالفهم وتشجيع البحث والاطلاع ومراعاة قدرات الطلاب وذكاءهم والفروق بينهم، وغيرها من المميزات غير المتوافرة في المدارس العربية التي تُعنى بالأساس بالحفظ والتلقين وتعامل الطلاب جميعا على أنهم متماثلون في القدرات، فهذا كله خارج عن ماهية اللغة وإنما مرده الى السياسة التعليمية، وفلسفتها في التربية، ولا علاقة له بالعربية من حيث هي لغة، ولا بصلاحيتها للتعليم. إذن فيمكن استحداث مدارس عربية على غرار المدارس الأجنبية في كل ما يحمد منها مع استخدام العربية لغة للتدريس.
يستشهد الكاتب بدراسات وتجارب وبحوث تربوية ليخلص إلى أن التعليم باللغة الأجنبية أكبر أسباب إهدار موارد الدولة والإحباط وكثرة انقطاع الطلاب عن الدراسة لعجزهم عن فهم ما يدرسونه بسبب حاجز اللغة.
ويستدل على كلامه بتجربة تونس في التعليم باللغة الفرنسية، حيث تعكس الإحصاءات الحالة المتدهورة للتعليم وانقطاع كثير من الطلاب من المدارس أو الجامعات، ورغم أن الباحثين لا يشيرون إلى العلاقة بين التعليم بالفرنسية والمستوى المتدني للتعليم التونسي، إلا أن الكاتب يرى العلاقة الوطيدة بين تدني مستوى التعليم والتعليم بالفرنسية، ويستدل على كلامه بالإحصاءات التي تُظهر الآثار الحسنة في نتائج الامتحانات بعد تجربة التعريب القصيرة في تونس.
من الواضح أيضا أن خريجي الثانويات في الدول العربية المختلفة لا يجيدون اللغة الأجنبية التي كانوا يدرسونها، وحصيلتهم منها لا تؤهلهم أن يدرسوا بها علما كالطب وغيره، حتى وإن كانوا مفتونين بها أو حريصين على التحدث بها؛ فهذا لا يعني إجادتهم لها. من أجل ذلك، يضطر الأساتذة في الجامعات إلى الشرح بالعربية مع تقديم المصطلحات والألفاظ العلمية، فتظهر لغة هجينة من العربية الفصحى والعامية واللغة الأجنبية، ذلك أن الأستاذ يأخذ في الاعتبار المشقة التي يجدها الطلاب في الدراسة باللغة الأجنبية، لكنه ربما يعبر أيضا عن المشقة التي يجدها الأساتذة في التدريس بلغة أجنبية أيضا، فهم ليسوا أفضل حالا من الطلاب في استيعاب اللغة الأجنبية. وهذا القصور لدى الأساتذة لا يمكنهم من نقل العلم الذي لديهم نقلا يبني الطالب بناء معرفيا أو يعرّفه لغة العلم واصطلاحاته بحيث يتمكن من مواصلة القراءة والاطلاع على التخصص بعد ذلك بنفسه!
من سلبيات التعليم باللغات الأجنبية أيضا أن تعليم العلم والتقنية باللغة الأجنبية يورث المتعلمين شعورا بالنقص قد يستمر طوال حياتهم، حيث ينشأ لديهم شعور بأن الغرب الأجنبي هو وحده المختص بالعلم والتقنية، مما يصيبهم بالإحباط الذي يورث الاستهانة والنفور من ثقافتهم وتراثهم. بل الأدهى من ذلك أن الطلاب العرب الذين يتخصصون في اللغات الأجنبية يشعرون بالتميز والانتماء إلى العالم الغربي فينظرون إلى العرب والعربية نظرة دونية.
لذلك، فـ”إن المعرفة المنقولة أو المستوردة إنما تنشئ الوعي المنقول أو المستورد، ولا يمكن أن تحرر الفكر، أو تطلق قوى الإبداع، وإنما تعمل على تقوية التبعية الثقافية والفكرية والاجتماعية”.[4]
ولا يعني هذا أن الكاتب يغلق الباب أمام تعلم اللغات الأخرى والإفادة منها، بل إنه يدعو إلى الإفادة من اللغات الأخرى جميعها لا الاقتصار على لغة واحدة كما هو الحال في أغلب الدول العربية التي تقتصر على تعليم لغة واحدة والتعليم بها، فالاعتماد على لغة واحدة يحصر المعرفة في مدخل واحد ويغلق المداخل الأخرى التي تقدمها اللغات والثقافات الأخرى.
ويرى الكاتب أن الاستفادة من اللغات الأخرى يكون مع التمسك باللغة الوطنية (العربية) وتعريب العلوم، وترجمة كل ما يمكن أن يكون مفيدا من نتاج الشعوب الأخرى في أي مجال من المجالات وفي أي بلد من البلدان، حتى يتسنى لنا الإفادة من الثقافات والأمم الأخرى مع التمسك باللغة التي هي أساس الهوية. وهو هنا يشير إلى الاستفادة من تجربة اليابان التي وطنت العلوم وجعلتها بلغتها، ومن أجل أن يظل الباحثون والطلاب على اطلاع بكل ما هو جديد في أي علم من العلوم بأي لغة أخرى، فهناك مراكز مختصة بترجمة أي مرجع أو كتاب مفيد في أي تخصص من التخصصات إلى اليابانية في خلال أسبوعين تقريبا من نشره.
تعريب العلوم:
يطرح الكاتب الحل بعد أن رصد المشاق التي تعترض طريق التعلم باللغة الأجنبية، ويكمن الحل في تعريب العلوم؛ ولا يكون التعريب بترجمة الكتب المقررة وإلقاء المحاضرات والدروس بالعربية فقط، بل يعني أيضا توطين العلم والبحث العلمي، وتعريب الدراسات العليا في جميع التخصصات، وإنشاء مراكز لترجمة البحوث والمراجع المهمة الجديدة التي تصدر باللغات الأجنبية. فالتعريب هو الذي يمكّن من وصول العلم إلى عامة الناس، ووصول العلم إلى عامة الناس فكراً وثقافةً هو شرط النهضة والتقدم.
ويرى الكاتب أن التعليم بلغة الأمة يهدف إلى “ترقية الأمة، وجمع كلمتها، وإحياء آمالها، وهذا لا يكون إلا بترقية لسانها، وإحياء آدابه بتأليف الكتب العلمية والأدبية به”.[5] وهذه المهمة طويلة وشاقة وتحتاج إلى صبر طويل ورعاية وتخطيط حتى تصبح العربية لغة عتيدة كغيرها من اللغات التي رعاها أهلها قرونا.
ويشير الكاتب إلى تجربة محمد علي في تعريب العلوم ومدى نجاحها؛ فقد أشار رفاعة الطهطاوي على محمد علي بأن يعدل عن الابتعاث الى الخارج بتوطين العلم بمصر “بصنع طبقة من العلماء ذوي الكفاية، يتولون تعريب العلم، ويكون ذلك بإنشاء مدرسة تعلّم اللغات، وتترجم العلوم، ليتيسر نقل العلم الأوروبي إلى العربية”.[6] فوافقه محمد علي وأنشأ مدرسة الألسن لتعليم اللغات المهمة واستقدم الأساتذة من أوربا، وقد كان المعلم يدخل الفصل ومعه المترجم، فيشرح الدرس ويترجم المترجم للطلاب بالعربية. كما ألزم الطلاب الذين ابتعثوا إلى أوربا لدراسة الطب أن يترجموا الكتب التي درسوها إلى العربية ويرسلوها إلى مصر. لكن هذا الأمر انتهى تماما مع أبناء محمد علي الذين لم يواصلوا التعريب، إلى أن جاء الاستعمار وفرض اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم بسبب “عدم توفر المراجع باللغة العربية” أو غيرها من الحجج. واستمرت هذه الحجج حتى بعد انتهاء الاستعمار سواء في مصر أو غيرها من الدول العربية، ولازالت تتردد إلى اليوم من أن اللغة العربية ليست لغة علم أو أن المراجع لا تتوفر بتلك اللغة. ويمكن الرد على هذه الحجج بأن العربية -وإن كانت قاصرة عن مفاهيم العلم اليوم بسبب تعطيل العربية وعزلها عن العلم لسنوات طويلة- يمكن لها أن تعود قادرة على التعبير عن العلوم متى أُدخلت في العلم والحياة مرة أخرى حتى تجد اصطلاحات تعبر عن تلك المفاهيم العلمية. كما أن قضية الاصطلاحات والتذرع بها لمعرفة تعريب العلوم مبالغ فيها لأن اصطلاحات العلم لا تزيد عن ٣،٣% من مفردات النصوص العلمية أو ٧،٥% عند باحثين آخرين. أما من يقولون بأن المراجع لا تتوفر إلا باللغات الأجنبية لا نجد لديهم حرصا على جلب جديد العلم من مراجع وكتب إلى جامعاتهم، بل قد نجد ما يُدرّس في الجامعات مراجع وكتب قديمة تم تجاوز ما فيها من أفكار أو نظريات أو تم اكتشاف ما هو أحدث! لذلك، يقارن الكاتب بين الدول العربية بعد الاستعمار والتي لم تغير سياسات التعليم التي كانت موجودة أثناء الاستعمار بشكل جوهري وبين فيتنام التي بعد أن تحررت من الاحتلال أصرت على توطين العلوم لديها واستطاعت إحداث نهضة حقيقية عندها.
من هنا، يحاول الكاتب الكشف عن الأسباب الحقيقية لمعارضة التعريب اليوم، فيرى أن سبب عدم تعريب العلوم حتى اليوم -رغم وضوح ضعف التعليم ومخرجاته- ليس تلك الحجج الواهية، بل هو في الحقيقة راجع إلى انعدام الإرادة والجهل باللغة العربية والكسل عن تعلمها والمسارعة في هوى النفس وأيضا الافتتان بحضارة الغرب.
إلى جانب هذه الأسباب، يرى الكاتب أن السبب الرئيسي وراء رفض التعريب وعرقلته هو سبب سياسي بالأساس، لا سبب تربوي أو علمي أو تقني! ويستدل على كلامه بالمغرب العربي -وهي الحالة الأوضح والأكثر تطرفا في هذا السياق نظرا لطبيعة الاستعمار الفرنسي ذي الطابع الثقافي-، فرغم ما ظهر من انقطاع الطلاب عن التعليم ونسب الرسوب العالية التي يكون سبب رئيسي فيها صعوبة اللغة الفرنسية التي يدرس بها الطلاب العلوم، إلا أن صناع القرار لم يتخذوا أي خطوات في اتجاه تعريب العلوم وتوطينها.
كما أن التعليم بلغة أجنبية قد يوقع الأجيال في تصادم حضاري؛ بين أولئك الناجحين الذين تم “غربنتهم” لغةً وفكرا؛ لأن لاعتماد على التعليم بلغة أجنبية يعني الاعتماد على كتب ومراجع مكتوبة بنفس اللغة، ولا يخفى احتواء هذه الكتب بفلسفة وثقافة وهوية وفكر أصحابها، وبين أولئك الذين انقطعوا عن التعليم ولم يطولوا التشبع بالثقافة الأجنبية ولا الهوية الوطنية. وهذا التصادم الحضاري قد يقع بين طلاب المدارس/الجامعات الوطنية وبين طلاب المدارس/الجامعات الأجنبية.
ورغم محاولات التعريب -الجزئية- التي حصلت، إلا أنه ومع أول عقبة تواجه التعريب يتم العدول عنها والعودة إلى اللغة الأجنبية سواء كانت فرنسية أو إنجليزية.
خاتمة:
ينبه الكاتب إلى قضية ملحة في عالمنا العربي اليوم وهي علاقة اللغة بالتعليم والإبداع، وضرورة تعليم العلوم والآداب باللغة العربية لأنه شرط الإبداع والنهضة، وهو هنا يؤكد الترابط بين اللغة والثقافة وأنها أوجه مختلفة لعملة واحدة وهي الهوية، لذلك لابد أن تتوافق اللغة مع الثقافة لأن اللغة هي وعاء الثقافة، وبالتالي فالتعليم بلغة أجنبية يُحدث فجوة بين العرب وبين ثقافتهم وهويتهم بمقدار تعمقهم في تلك اللغة، وربما حتى يؤدي إلى النظر بدونية لثقافتهم. مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن القضية لها أبعاد أخرى، فحتى إن تمكنا من تعريب العلوم والآداب في المدارس والجامعات، فلازالت هناك إشكالات متعلقة بالمؤسسات ربما تعوق استفادة الطلاب من خطوة تعريب العلوم بشكل كامل، فمن جانب تفتقر هذه المؤسسات إلى رؤية شاملة وحتى إلى التخطيط الجيد الذي يسمح لجميع الطلاب الحصول على فرص جيدة في التعلم والمشاركة. ومن جانب آخر، تعتبر المدارس والجامعات مؤسسات حداثية صُممت لأغراض معينة -كتلقين القومية والمواطنة- في أوروبا، ثم ما لبثت أن انتقلت بالاستعمار إلى الدول العربية، وقد جاءت هذه المدارس على حساب نظم التعليم التقليدية في تلك الدول والتي كانت تخرج من صميم الثقافة والهوية العربية الإسلامية.
أما العلوم والآداب نفسها التي تُدرس، فهي تتضمن فكرا وثقافة وفلسفة تظهر أوضح ما تظهر في العلوم الاجتماعية والآداب، لكنها موجودة أيضا في ثنايا العلوم الطبيعية والتطبيقية. لذلك، فمن المهم مع تعريب تلك العلوم أن يتم ذلك بوعي بالفلسفات التي قامت عليها تلك العلوم ولا يكون ذلك إلا عن طريق أشخاص متعمقين في ثقافتهم وتراثهم معتزين بهويتهم قادرين على التمييز والتحليل.
عرض:
أ. تقى محمد يوسف***
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مختار الغوث (مواليد 1963) هو كاتب موريتاني ودكتور في جامعة الملك عبد العزيز، يُدَّرِس مادة مناهج بحث أدبي ولغوي. وإلى جانب هذه السلسلة، فقد ألف العديد من الكتب، منها “في بناء الفكر”، و”العقل أولا”، و”الحقيقة والخيال في الغزل العذري والغزل الصريح”، و”لغة قريش”، وغيرها.
** تتكون السلسلة من ستة أجزاء؛ جاء الأول منها بعنوان “اللغة هوية”، والثاني بعنوان “اللغة والإبداع والتعليم”. والثالث بعنوان “التجني على الهوية”. والرابع بعنوان “كيد الهوية”، والخامس بعنوان “الهوية بعد الحادي عشر من سبتمبر”. والسادس والأخير بعنوان “مسخ الهوية”.
[1] ص. 17.
[2] ص. 26.
[3] ص. 43.
[4] ص. 120.
[5] ص. 83.
[6] ص. 216.
*** باحثة في العلوم السياسية.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies