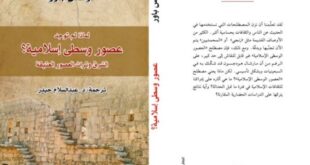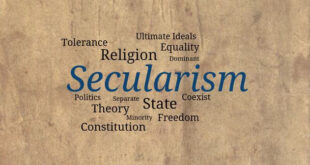العنوان: بين الإسلام والعروبة.
المؤلف: طارق البشري.
الطبعة: ط. 1
مكان النشر: الكويت.
الناشر: دار القلم للنشر والتوزيع.
تاريخ النشر: 1988.
الوصف المادي: 2 ج.
تقديم: حول الكتاب ومنهجيته
يندرج كتاب “بين الإسلام والعروبة” للمستشار طارق البشري (1933: 2021م) بجزئيه ضمن مجموعة مؤلفات البشري التي عُنيت بتحليل قضية “الجامعة السياسية”، والبحث عن إطار عام مشترك لتوحيد تيارات الأمة السياسية، والاجتماعية، والفكرية، والاشتباك مع القضايا الوطنية والقومية المطروحة في مصر والعالم العربي والإسلامي. وهي إسهامات يغلب عليها الحوار مع الآخر، أو على الأقل، الدعوة لفتح آفاق لحوارٍ يركز على الآثار العملية أكثر من مجرد الجدل على المستويات التجريدية النظرية.
شغل المستشار طارق البشري – وهو قاضٍ ومفكر ومؤلف مصري – منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، وبدأ اهتمامه بالشأن العام والكتابة في ستينيات وسبعينات القرن الماضي، فاشتبك مع مساحات الفكر، والتاريخ، والنظم السياسية، وقدم فيها جملة من المفاهيم التحليلية التي ارتبطت باسمه مثل: الوافد والمورث، والتيار الأساسي للأمة، والجامعة الحضارية، وغيرها، كما رأس بعد ثورة يناير لجنة إعداد التعديلات الدستورية التي كلفها المجلس العسكري، ووافق عليها الشعب في استفتاء مارس 2011.
يركز كتاب “بين الإسلام العروبة” – الذي هو في الأساس مجموعة مقالات كُتبت في الثلث الأخير من السبعينيات وبداية الثمانينيات – على قضية الانقسامات التي تعاني منها الحركة الوطنية في العالم العربي والإسلامي بين التيار الوطني (القومي) العلماني وبين الإسلام السياسي، الذي أكد البشري أن العلاقات بينهما شهدت تجاهلًا واضحًا مقارنة بالاهتمام الذي بُذل لدراسة الأقليات غير العربية، والأقليات الدينية، والعلاقات بين القوى الاجتماعية المختلفة.
ومن ثمَّ، أوضح الكتاب أن هدفه هو مناقشة “العلماني؛” ليس في أسسه الفكرية بقدر ما يُناقش نظرته إلى الآخر، والتأكيد على أنه ليس أكثر شرعية وأصالة من “الإسلامي”، إذ أن العلمانية تُعد الدخيلة بمعيار الأرجحية العددية (الانتشار بين النخب والجماهير) والثابت تاريخيًا، والفكرة الإسلامية هي الأصيلة، فضلًا عن البحث في الروابط الجمعية للأمة مثل عامل الدين، المتمثل في الإسلام، وعامل اللغة، والرابط الإقليمي، وإمكاناتها في تحقيق الوحدة، ومواجهة التحديات، مع تقييم رؤية الشوام للعروبة والهنود للإسلام، في إطار النسبية التاريخية (الظرف التاريخي الخاص بهم) و(الوضع التاريخي الراهن).
وينطلق البشري في كتابه من “تحذيرٍ” بشأن الاستثمار في الأسس الطائفية للعلاقة بين التيارين، إذ يتحد العلمانيون في مواجهة التيار الإسلامي، والعكس بالعكس، كما يستغل بعض العلمانيين وضع غير المسلمين لمواجهة الحركات الإسلامية، على الرغم من أن النماذج التاريخية تبرز تسامح المسلمين مع غيرهم، وبالتالي يعتبر تصوير المسألة بهذا الشكل – أي لقاء المسلمين والمسيحيين الشرقين على أرض العلمانية – لقاءً على أرض أجنبية، وأنه من الأحرى أن يكون اللقاء على أرض وطنيةٍ بين الإسلام ومسيحية الشرق (ج1، ص15).
وهنا يدعو البشري إلى إعمال الحرفية الفكرية، أي الاهتمام بالجوانب التطبيقية للأفكار النظرية، وينطلق من مفهوم “الحوار” كمفهوم أساس لحلحلة العلاقة بين التيارين. هذا الحوار الذي يتخذ أسلوب المفاوضات الفكرية، وهدفه التوفيق بين غايتين أو مصلحتين، بمراعاة القوة النسبية لأصحاب المصلحتين، وهو يتطلب استطلاعًا دائمًا لوجهات النظر المتعارضة، ومحاولة إدراك المنطق الداخلي للرأي المخالف، مع تبادل الرؤى بشأن الأبعاد التطبيقية للأفكار؛ ليس على نمط الحرب الفكرية التي تقتضي غلق الحدود الفكرية بين الأطراف المتحاربة، ومنع تسرب أفكار كل طرف إلى الآخر، والامتناع عن تفهم السياق الداخلي لأفكار كل طرف من قِبل الآخر، لينصرف الجهد حينها إلى التفتيش عن وجوه الاختلاف، والتركيز عليها باعتبارها حدود فاصلة، مع عدم الاعتراف بنواحي القوة لدى الطرف المقابل، وإنما بالتنقيب عن نقاط الضعف، والعمل على توسيعها في إطار هدفٍ نهائيٍ هو التصفية والإبادة.
ينتقل حينها الجدل من المفكرين والسياسيين إلى حراس الحدود الفكرية، فينشط رجال الأمن الفكري الذين يعملون على المفاصلة الفكرية والقطيعة بين الأطراف المتصارعة، حذرًا من قيام أي تعاونٌ بين مكونات الفريقين، أو يكون لهم فيه رأى يخالف ما تفرضه الحرب من أحكام. تفرض هذه المفاصلة على كل فريق سحب (الجنسية الفكرية) عن المتعاونين مع الطرف الآخر، ومن هنا تسقط الحلقات الوسيطة التي يمكن أن تقوم بدورها في التقريب بين الأطراف المعنية، ومن ثمَّ تزداد المجانبة والمجافاة (ج1، ص24).
وجاء هذا الصراع – من وجهة نظر البشري – على حساب أجندة القضايا الوطنية وترتيبها، فأضحت قضية حقوق المرأة أولى من الحرب في لبنان، كما صار تصنيف القوى السياسية يجرى لا على أساس الموقف السياسي والاجتماعي من القضايا الوطنية الشعبية المُلحة، بل على أساس الموقف الفكري المجرد من قضية العلاقة بين الإسلام والعلمانية، فتبدت فيه ملامح الموقف الطائفي.
ويذكر البشري أن طرح هذه القضايا يأتي في خضم ظهور المعارضة الإسلامية (فترة المد الإسلامي)، ونجاح الثورة الإيرانية 1979م، والحرب العراقية الإيرانية (1980: 1988م) التي صُوِرَت بأنها حرب بين العروبة والإسلام، وتعمُّق الحرب الطائفية في لبنان (1975: 1990م)، ومعارك فكرية مصطنعة بشأن الحدود الشرعية وحقوق المرأة. وفي هذا السياق تبلور لمؤلف هذا الكتاب سؤال: هل يمكن إيجاد صيغة للتقبل المتبادل بين العروبة والإسلام؟
ويوضح البشري أن العلاقة بين تياري الإسلام والقومية تدور حول موضوعين رئيسين: الجامعة السياسية والشريعة الإسلامية، باعتبارهما ميدان الالتقاء أو الافتراق، وذلك لكونهما يتصلان بالموقف الفكري للتيارين من الرابط السياسي الأعم والجامع، ومبدأ المواطنة، والموقف الفكري للكنيسة القبطية، ويشير إلى أن “العلمانية” هي جوهر الاحتكاك والخلاف بين التيارين، فالقومية قريبة من الإسلام ما ابتعدت عن العلمانية، ولا تجتمع علمانية وإسلام (تطبيق الشريعة)، إلا بطريقة التلفيق وصرف أي منهما على غير حقيقة معناه (ج1، ص49).
ولا يتبع هذا العرض بالضرورة التسلسل الخاص بمحتويات الجزئين، وإنما يتخذ نهجًا موضوعيًا في استعراض الأفكار والقضايا، وترتيبها على نحو يخلصها من التكرار الذي حصل في الجزئين بسبب تداخل مناسبات نشر المقالات وأهدافها، وذلك بالوقوف على الجوانب المفاهيمية والتاريخية لها، والخلافات الفكرية والسياسية بشأنها في السياق المصري والعربي والإسلامي الأعم.
جذور الإسلامية والقومية في العالم العربي: محاولة للفهم
يؤكد البشري أن اتصال الإسلام بالحياة كان وضعًا سائدًا غير متنازع عليه حتى بداية القرن التاسع عشر، وأن تجربة محمد علي (1805: 1840م) في مصر والسلطان محمود الثاني (1808: 1839م) في إستانبول، أخذت عن أوروبا ما يمكن تسميته بالتكنولوجيا، ولكن بقيت الشريعة هي الإطار الحاكم للتفاعلات الاجتماعية والقضاء. كما كان الصراع بين محمد علي والسلطان صراعًا خاصًا ضد مؤسسة الحكم في الآستانة، وليس ضد الجامعة السياسية.
لقد كان بناء الدولة والجيش هما مبدأ ومنطلق الدولة المصرية الحديثة، إذ بدأ مشروع محمد علي التحديثي ببناء الجيش، وبعد 15 عامًا من الاعتماد على عناصر عثمانية مختلطة، كان قراره عام 1820م بجمع أنفار الجيش الجديد من المصريين، فشرَّع التجنيد الإجباري، وسعى لتمصير الدولة، وتمصير الجماعة السياسية، ليُصبح للمؤسسة العسكرية علاقة عضوية بالشعب، وذلك بخلاف العصور المملوكية والعثمانية التي كانت فيها النخب الحاكمة منعزلة عن عامة الجماهير، ولكنها بقيت على مستوى الجند والعسكر دون القيادات في عهد محمد علي، ثُمَّ نما دور المؤسسة العسكرية بعد ذلك في عهد خلفائه.
وإذا كانت دولة محمد علي تتكون من طبقة أتراك ومماليك في القمة، وأوروبيين يلعبون دور الخبراء، ومصريين في قاعدة جهاز الدولة، فإنه لم يكن ثمة جامع سياسي للدولة سوى الإسلام، ولكن هذا الجامع كان يضم عناصر يتوزع ولاؤها السياسي بين محمد علي وبين الباب العالي في تركيا، ولا يكفل له الاستفادة من خبرات الأوروبيين المسيحيين. حل محمد علي هذا الإشكال بمنهج برجماتي، فلم يشجع فكرًا خاصًا، أو جامعة مناهضة للإسلام، وبذلك سبقت عملية التمصير ظهور الفكر القومي، ومن ثمَّ بدأ دخول القبط في الوظائف المتاحة، كما كُلف الأقباط بالتجنيد في عهد سعيد باشا (1854: 1863م)، ودخلوا القضاء والمجالس النيابية في عهد الخديوي إسماعيل (1863: 1879م)، وكل ذلك بغير عراك حقيقي مع العقيدة الإسلامية، وفي ظل الجماعة الإسلامية العثمانية.
ولكن يذكر البشري أن اتفاقية التسوية التي تمت بين الدولة العثمانية والقوى الأوروبية الرئيسة (معاهدة لندن 1840م) فتحت البلاد الإسلامية على النفوذ الأجنبي، خاصةً في عهد الخديوي إسماعيل والسلطان عبد العزيز الأول (1861: 1876م). ولكن حتى خلال هذه الفترة، تعلق ما أُخذ عن الغرب من نظم بالأساليب والتصميمات الإدارية والمؤسسية، وليس بالفكر والمعتقدات السياسية والفلسفية، كما صدرت حركة المقاومة للاستعمار عن فكر إسلامي.
ولكن مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات الاستعمار في مصر (1882م)، أصبح ما يؤخذ من الغرب هو الأفكار والمذاهب الاجتماعية، والسياسية، والفلسفية، ومع ذلك بقيت الحركة/ الجماعة الوطنية ذات طابع إسلامي، إذ لم تظهر حركات التحرر الوطني بصبغتها العلمانية إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وهنا انقسمت الجماعة الوطنية إلى تيارين: إسلامي وعلماني: الأول يرى في الإسلام دين ودنيا، والثاني يكافح الاستعمار على أساس نماذج الغرب وأسسه الشرعية.
ومن ثمَّ، بنت الحركة الوطنية المصرية بأجنحتها المختلفة توجهًا عامًا تجاه الوحدة، ولكنهم لم يشتبكوا مع الأفكار النظرية لمفهوم القومية، وإنما توجهت بحس عملي؛ يسرى هذا على الوفد، والإخوان، ومصر الفتاة خلال الثلاثينيات والأربعينيات، وهي وحدة يلتحم فيها المسلمون والأقباط في حركة مناهضة للاستعمار، فارتبط التوجه العروبي لمصر بمقتضيات الأمن القومي والغزو الخارجي (الحدود الشمالية الشرقية – فلسطين، الحدود الجنوبية – منابع مياه النيل). وقبل المسألة الفلسطينية كانت المسألة السودانية حاضرة مع الاحتلال بسبب سيطرته على السودان في 1899م، فرغم أن ثورة 1919 قامت على أساس من الجامعة المصرية المحدودة فإنها لم تستبعد السودان في إطار وحدة ممتدة. كما أن شعار مصر للمصريين لم يكن خروجًا عن الجامعة الإسلامية إذ كان مواجهةً للاحتلال، وسعيًا للديمقراطية والإصلاح.
كما ظلت الصبغة الإسلامية للحركة الوطنية الإسلامية حتى 1919م، فكانت المصرية – وقتها – وفقًا للبشري تعني وحدة عناصر الأمة، وكانت العروبة بمعنى الوحدة العربية بالصيغة التنظيمية الملائمة في الظروف السياسية والتاريخية القائمة وقتها، أما الوطن فكان يعني الأخوَّة بين المواطنين بمعيار المساواة والشراكة، كما أخذ الاستقلال معنى الجلاء الأجنبي العسكري، وكف النفوذ الخارجي عن مقدرات الوطن السياسية والاقتصادية. ولكن مع أفول الدولة العثمانية ثمَّ انهيارها في 1924م، بدت “المصرية” جامعًا سياسيًا وحيدًا مستقلًا.
ويشير البشري إلى أن الدعوة الإسلامية في صورتها المعاصرة ظهرت نهاية العشرينيات، وهي الفترة التي نشأ فيها التيار العروبي، أو بالأحرى ظهر من رحم الحركة الإسلامية. كما توجه كلاهما نحو توحيد مصر، وكلاهما كان يتجه إلى فلسطين، إذ أثار الخطر الصهيوني معًا النزعة القومية (استعمار قطر عربي) والنزعة الإسلامية (حركة يهودية تعتدي على المقدسات). كما يؤكد أن القومية جاءت على يد المسيحيين في سوريا ولبنان، وتحديدًا من البيئات البروتستانتية (بيئة وافدة من الغرب)، وكان ربط القومية بالعلمانية من الأمور التي نالت رضا السلطات الاستعمارية.
ولذلك يوضح البشري أن العراك بين العروبة والإسلام لم يظهر في العالم الإسلامي قبل منتصف القرن العشرين إلا في بلاد الشام، إذ كان بعض العروبيين يطالبون بالخروج من فكرة الجامعة الإسلامية (سمة رئيسة في الفكري العروبي في الشام)، كما كان لبعضهم اتصال بالإنجليز والفرنسيين، بلغ حد مناصرتهم، ولكنها أضحت دعوات انخلاع عن الإسلامية بعد وصول انقلاب الاتحاد والترقي عام 1908م واتباعه سياسات التتريك. ولكن بعد اتفاقية سايكس بيكو 1916م، وفي العشرينيات، أضحت الحركة القومية العربية تقوم على ثلاثة أركان:
1- الارتباط بالحركة الوطنية في مكافحة الاستعمار.
2- قيامها على أساس توحيد الأقطار المجزأة في العالم العربي.
3- مواجهة التقسيم الطائفي في لبنان، وسوريا، (ضد فرنسا)، وفلسطين (ضد إنجلترا).
وقد حملت هذه الفترة عدة عوامل حفزت الفكر القومي منها: نظرة تركيا إلى العرق التركي على أنه متفوق قوميًا، كما أن الدولة العثمانية ذاتها في القرن التاسع عشر كانت حجر عثرة في مواجهة حركات التحرر الوطني، بسبب الامتيازات الأجنبية، فأصدر السلطان العثماني مثلًا قرار عصيان أحمد عرابي، وقبله خلع الخديوي إسماعيل بنصيحة الإنجليز والفرنسيين، وتشجيع المستعمرين قيام قومية عربية على أساس الجنسية، لمواجهة العثمانيين الأتراك، وإثارة الفتن بين العرقيات الأخرى العرب، والأتراك، والأكراد، والبربر.
أما في الجنوب العربي (بلاد السودان والجزيرة العربية) فلا يكاد يظهر خلال هذه الفترة للدعوة العربية أثر فيه، إذ كانت الإسلامية هي الغالبة بفضل جهود محمد المهدي (1843: 1885م) وعلي المرغيني (1873: 1968م) في السودان، أما الجزيرة العربية فظلت في إطار الدعوة السلفية لابن عبد الوهاب، فيما عدا حركة الشريف حسين عام 1916.
أما فكرة الجامعة الإسلامية فارتبطت بالدعوة إلى التحرر من الاستعمار، ففي الهند قامت حركة التحرر على طلب الدعم من الدولة العثمانية والعالم الإسلامي للمساعدة في التخلص من الإنجليز، وذلك حتى بداية القرن العشرين. وكذلك كانت الدعوة في المغرب العربي (الجزائر ضد الفرنسين والإسبان)، وأمراء بخاري في وسط آسيا (ضد الغزو الروسي)، وآل سعيد في زنجبار، إذ كان هناك تطلع نامٍ لتوثيق الروابط مع المركز الإسلامي لدى أطراف العالم الإسلامي والأقليات المسلمة، تحديدًا في فترات الغزو والتهديد به. وعلى ذلك، يشير البشري إلى أن فكرة الجامعة الإسلامية ظهرت كدعوة توحيدية مع غيرها، إلا في الهند التي ظهرت فيها كحركة انسلاخية، بسبب القيادة العلمانية للانفصال عن الهند بقيادة محمد علي جناح (حزب الرابطة الإسلامية)، إذ بعد الانفصال عارضوا تطبيق الشريعة.
ويخلص البشري من ذلك إلى أن الحديث عن أساس الروابط بين التيارين لا يأتي من فراغ، وذلك رغم اختلاف الفروق النظرية بين الجامعتين: الإسلامية التي أساسها ديني اعتقادي، ومناطها الإنسان والجماعة، والعربية التي أساسها لغوي ومناطها إقليمي، وإمكانية البناء على الآثار الوظيفية لكل دعوة من قِبل الآخر، مع الحذر من الطبعة الشامية للجامع العربي والطبعة الهندية للجامع الإسلامي، التي قرأت القومية على أنها صنو العصبية، والجاهلية كما جاء في أفكار أبو الأعلى المودودي[1] (ج1، ص38-41). وفي هذا الوقت كانت السمة الأساسية لسياسات الغرب هي التفتيت بإرهاق عوامل التوحد، واستخدام أسلوب الفتنمة (أي نقل المعارك من ساحات القتال إلى ساحات الفكر)، وإثارة التناقض، واصطناع المعارك بين المكونات الوطنية.
مسلك العروبيين في مقابل الإسلاميين
يناقش المستشار البشري تحت هذا العنوان المسلك الفكري أو السياسي للحركات الإسلامية في مواجهة القومية والعكس. فمثلًا تصر بعض التيارات الإسلامية في مصر على تبني آراء أبي الأعلى المودودي بشأن القومية، وذلك رغم تفريق الكتاب بين القومية العربية والوحدة العربية.
في المقابل يذهب بعض العروبيين إلى تخليص التاريخ من أي فكرة إسلامية، مع التأكيد على إضافة العصر الجاهلي إليه، لتبدو العروبة أصيلة طرأ عليها الإسلام، مع محاولة تهميش الجانب التشريعي والفقهي للحضارة الإسلامية، وإبدال العربي بالإسلامي، فجعلوا الإسلام كله مجرد إفراز عروبي، كما قاموا بعملية “إخضاع الإسلام للعروبة” و”صياغة التاريخ صياغة عروبية”، وبهذه الطريقة تقوم العروبة على أساس عرقي مضاد دائمًا لما جاورها من قوميات مثل الفرس والأتراك.
كما لجأ العروبيون إلى “تشخيص” الفكرة الإسلامية في الدولة العثمانية ليسهل ضربها، فنسبوا لها كل نقيصة، كما رُبط انهيار الدولة (العثمانية) بتحرير العرب. وبهذا أضيفت كل سوءات الحكم العثماني إلى فكرة الجامعة الإسلامية، وذلك على الرغم مما للدولة العثمانية من مساعي لمراعاة الاختلافات، واستيعاب القوميات، ومعاملة غير المسلمين (وتحديدًا في نهاية القرن التاسع عشر). كما أن التاريخ يشير أن انهيار الدولة العثمانية هو الذي فتت العرب ولم يحررهم، ويؤكد البشري أن تعرض العروبيين للدولة العثمانية جرى بعيدًا عمَّا تقتضيه النظرة العلمية الموضوعية.
على الجهة المقابلة تُشخصن الحركة الإسلامية القومية في جمال عبد الناصر ونظامه، تأكيدًا على علاقة الخصومة والصراع مع هذا التيار، فقد أدى الربط بين الأمن والسياسة في نظام ناصر الذي كان يرى أن الحركة الإسلامية (ممثلة في الإخوان المسلمين) تهديدٌ لأمن نظامه، إلى استبعاد الفكرة الإسلامية في مقابل العلمانية.
ويذكر البشري أن مصر اتصلت بشدة باللون الشامي من العلمانية والعروبة بعد 1948، وهو ما تعزز مع نظام عبد الناصر. ومع ذلك يشدد المستشار أن انتكاسة ثورة يوليو 1952 بعد هزيمة يونيو 1967، لا يخل بالإيجابيات التي قامت عليها: التحرر من الاستعمار وعدم الانحياز. ويخلص من ذلك، أن توظيف التيارين لفكرة “التشخيص” قد أضر بالقضايا الأساسية للأمة متمثلًا في قضايا الهوية، والجماعة السياسية، والمستقبل (ج1، ص55-56).
الازدواجية الثقافية: في تاريخ العلاقة بين الحاكم والمحكوم في العالم الإسلامي
يشير المستشار البشري إلى أن الخلاف بين النخب والجماهير في الحضارة والفكر الإسلامي كان مستوعبًا داخلها، إذ لم يكن هناك بينها فارق في المورد الثقافي والفكري والحضاري. ولكن مع العصور المملوكية والعثمانية انفصمت النخبة الحاكمة عن صفوة المفكرين، والجماهير، وذلك باعتبار أن المماليك كانت نخبة عسكرية مُغلقة على نفسها تتولى الحكم، ثمَّ حمل العثمانيون سمات شبيهة في الحكم بالاعتماد على فئات مُحددة لأداء مهام معينة مثل الاعتماد على المسلمين الأتراك في الولايات الأوروبية العثمانية (الروملي) لتولي المهام الإدارية، والإنكشارية في الدفاع عن أراضي الدولة وحمل السلاح، فكان انغلاقهم أساسه انخلاعهم عن بيئاتهم المحلية وحداثة عهدهم بقيم المجتمعات التي امتد فيها حكمها (ج1، ص60-61).
أسفر هذا الانفصال عن ظهور ازدواجية ثقافية بين الحاكم والمحكوم في النظم والتقاليد والأعراف، وهو ما سهل التأثر بالفكر الغربي الوافد في القرن التاسع عشر. كما كانت هذه النخبة الحاكمة تفتقر إلى القدرة على الانتقاء، والهضم، والطرد في التعامل مع الفكر الوافد وقيادة الجماهير إزاءه، كما كانت مقاومة النظم التحديثية الغربية مدفوعة بالمصالح المادية لبعض هذه الفئات مثل الإنكشارية، فاستغلوا رجال الدين في مقاومة تحديث الجيش دون التركيز على الصراع الفكري والحضاري. كما حلت هذه النخب معضلة التحديث بإضافة المؤسسات الحديثة (الوافدة) إلى جنب المؤسسات التقليدية (الموروثة).
ويُذكر البشري هنا أن مصر عندما خاضت تجربة تحديث في عهد محمد علي تشابهت في هذا الجانب مع مجمل الأقطار التابعة للدولة العثمانية، إذ استولى المماليك والعثمانيون على المناصب الإدارية العليا والقيادة في الجيش دون المصريين – وكذلك في التعليم – وهو ما كرس لنفس الانفصال بين النخبة والجماهير، ولم يبدأ العنصر المصري في البروز سوى في الربع الأخير من القرن التاسع عشر مع الثورة العرابية.
وتأكد هذا الازدواج مع زيادة النفوذ والامتيازات الأجنبية في جميع أرجاء الدولة العثمانية، إذ انعطف النظام القضائي في مصر برمته من الشريعة الإسلامية إلى القوانين الغربية، إذ صدر قانون العقوبات المستمد من القوانين الفرنسية والإنجليزية عام 1840م، كما أُنشأت المحاكم القنصلية، فالمختلطة عام 1875م. رافق ذلك تغلغل مظاهر التحديث السياسي والإداري (الوزارات والمصالح والمكاتب)، والاقتصادي (الشركات على النمط الحديث)، والاجتماعي (متمثلًا في الأحياء الغربية وأنماط اللبس)، وبالتالي تكشفت معالم “الشوق للغرب والاقتداء به إلى حد التقديس خاصة من قِبل خريجي المعاهد الحديثة” (ج1، ص69).
وفي المقابل كانت الهيئات الدينية المكونة من رجال الشريعة والقضاء تقوم بوظيفة دعم السلطة باسم الإسلام، وتجميع التمرد الشعبي في مواجهتها إن لزم الأمر – أيضًا – بفضل أدوارهم المجتمعية المتمثلة في التعليم وحل الخلافات. ولمَّا انقسم العلم إلى علوم للدين وعلوم الدين، انتقص ذلك من المكانة الاجتماعية لهذه الهيئات، كما نافستها المؤسسات الحديثة في الوظيفة التعليمية الدينية التقليدية لها بعد أن افتُتحت المدارس/ المعاهد الحديثة حتى في مجالات الدين، واللغة، والفقه مثل دار العلوم (1875م) ومدرسة القضاء الشرعي (1907م).
ويؤكد البشري أنه طيلة ثلاثة أرباع قرن (1878: 1953) لم يتول النظارات والوزارات المصرية أزهريٌ أو ذو تعليم ديني غير أربعة من أصل 298 وزيرًا، وكانت كلها وزارة الأوقاف (أربعة من أصل 48 وزيرًا من المدنيين): اثنين منهم هما (على عبد الرازق، ومصطفى عبد الرازق) المعروفين بقربهم من المؤسسات الحديثة، وتلقوا تعليمهم في الخارج، وكانا من ركائز الدعوة للتحديث، فتوليا الوزارة مدة ست سنوات ونصف من أصل السنوات السبعة ونصف التي قضاها الوزراء الأربعة.
ورغم ذلك ظل التعليم الإسلامي ينمو، وظل أثره مستمرًا، وانخراطه في المجتمع باقيًا، فالانفصام الحادث في المجتمع لم يخفت لصالح المؤسسات التعليمية الحديثة، ولكن استمر كلا الطرفين المتعارضين في التواجد جنبًا إلى جنب.
وبذلك تشكلت نخبة من المتعلمين في الخارج (الغرب)، والمداس الحديثة المحلية (المؤسسة على النمط الغربي) تولت الإدارة وشؤون الحكم، في حين بقيت النخبة الدينية ولم تذب كليةً، وظل تأثيرها ممتدًا في الأرياف، والمدن الصغيرة، وسكان أحياء الحرفيين وصغار التجار.
ويشير البشري إلى أن خطورة النخبة الحداثية الجديدة بالمقارنة مع النخبة التي كانت حاكمة في عهد المماليك والعثمانيين، هو أنها نخبة تعربت وتواصلت مباشرة مع الجماهير، فساهمت في إنتاج نخب جديدة على حساب الهيئات الدينية التي كانت همزة الوصل بين الحكام والمحكومين، فكان لهذا الفصام أبعد الأثر في المفاهيم الفكرية: مفهوم الوطن، والقومية، والتجديد، والتحديث، والتقدم، وغيرهم.
القومية والعلمانية: بحث في أصل العلاقة بينهما في العالم الإسلامي
جُلبت العلمانية بحسبانها الشرط الأساسي للمجتمع الحديث، وأنها سبب قيام المجتمع المدني الصناعي ونتيجته، ولأن اتصال الدين بالسياسة سمة المجتمع المتخلف، رُبط التصنيع (التحديث) بإقصاء الدين، و(رُبط) حدوث النهضة المساوية لأوروبا بالعلمنة، ومن ثمَّ، دُعي إلى إسلام بروتستانتي، كما اعتُبرت العلمانية الصبغة الوحيدة التي تكفل المساواة بين ذوي الأديان المختلفة.
وهنا يؤكد البشري أن التصاق التصنيف القومي بالعلمانية في التاريخ الأوروبي لا يجعله بالضرورة كذلك عند نقله إلى أي سياق تاريخي وحضاري مختلف، وليس من المقنع افتراض تلازم بين جامع سياسي يقوم على اللغة والتاريخ (القومية) وبين نمط حكم يفضل نظام الأرض عن أحكام السماء (العلمانية). كما يؤخذ على النظرة التي ترادف بين العلمانية والقومية عدة أمور:
1- ثمة فارق بين الإسلام والمسيحية من شأنه أن يغاير وظيفة العلمنة في كليهما، فالعقيدة المسيحية في صفائها الأول تبتعد عن السياسة وتترك ما لقيصر لقيصر، بينما الإسلام في صفائه الأول كان يتصل بشؤون الدنيا وينظم علاقاتها. إذن فالعلمانية عودة إلى جوهر المسيحية في إيمان المسيحي، في حين أنها تبتعد عن جوهر الإسلام في يقين المسلم.
2- التاريخ الأوروبي المسيحي عرف نوعًا من السلطان الدنيوي للكنيسة ورجال الدين (وهو تمدد شاذ في العقيدة المسيحية للكنيسة)، بينما لم يعرف الإسلام ما يماثل سلطة البابوية في العصور الوسطى.
3- إن تجديد لوثر كينج للمسيحية كان يقوم على احتياجات التقدم الاجتماعي، لا مقاومة غزو أجنبي يُهدد المسيحية، وثقافة وحضارة المسيحي، بينما تجديد الإسلام يتطلب إدراكًا للسياق المغاير الذي يهدف إلى مقاومة الغزو الأجنبي في شتى المجالات.
ويشير البشري إلى قول البعض بأن فصل الدين عن الدولة كما أجراه أتاتورك ليس غريبًا عن الإسلام، لأن الشريعة الإسلامية لم تتعرض لمقومات الدولة وكيفية اختيار الحاكم، كما أن القسم الغالب من الفقه الإسلامي هو محض اجتهادات من الفقهاء وليس نصوصًا دينية ملزمة، وبهذا تكون العلمانية أصيلة في الإسلام وليست طارئة عليه. ويرد البشري على هذا الرأي بالقول إن أمر الفكر الإسلامي لا يتعلق بكثرة الأحكام الدينية المنظمة لشؤون الدنيا أو قلتها، ولا بمدى ما أوردته من تفاصيل، ولكنه يتعلق بالمصدر وبما يستمد الإنسان منه من نظم (ج1، ص91).
ويؤكد البشري على مكانة الإسلام في نفوس الجماهير انطلاقًا من عدة أمور منها:
1- شهادات مفكرين عروبيين أو قوميين من أمثال أنور عبد الملك، وحازم نسيبة، وهشام شرابي، وحسن حنفي، وكلهم أكدوا على مكانة الإسلام في نفوس الجماهير، واتخاذهم للإسلام حصنًا لمواجهة العدوان والغزو الغربي، وقربه من العروبة بمعناها التوحيدي، وأن الأفكار الأخرى كالعلمانية والماركسية لم تصل إلى الجمهور بقدر ما ظلت حبيسة بعض النخب المثقفة.
2- انطلاق ثورة 1919 من الجوامع والمساجد، وهو ما اعتُبر بمثابة رمز على صلة الثورة بالإسلام. وكذلك اتصلت الحركة الوطنية في الجزائر مع حركة ابن باديس وجمعية العلماء بالإسلام، مؤكدةً إسلامية الشعب الجزائري. كما أصدر عبد الرحمن الثعالبي ورفاقه جريدة “التونسي” التي شقت الطريق لتيار عربي إسلامي في مواجهة الاحتلال الفرنسي في تونس.
3- أظهر استطلاع رأي أجراه مركز دراسات الوحدة العربية عام 1980 موافقة الجماهير على أن الدين الإسلامي من أهم عناصر الوحدة بين الشعوب العربية، وهو ما أثبت أن الإسلامية تشيع بين الفلاحين، والعمال، والطلبة، وأصحاب التعليم الأدنى، في حين كان الصحفيون، ورجال القانون، وأصحاب التعليم العالي أكثر تحمسًا للعلمانية، وهم أكثر اتصالًا بالنخبة الحاكمة والمثقفين.
وهنا يشدد البشري أن حرص الدساتير على إثبات إسلامية الدولة هو حرص ينجم عن مطلب شعبي قوي أساسه أن الدساتير جرت في بيان الهوية السياسية والاجتماعية على إثبات ما يحتاج إلى تأكيد من هذه الجوانب، فهي تثبت أن الدولة مستقلة عندما يكون ذلك الاستقلال مزعزعًا، ثم تسقطه عندما يثبت الاستقلال في الواقع. ويلاحظ المتابع أن النص على إسلامية الدولة ورد عندما طغت العلمانية والفكر الوافد، فكان النص عليه في مواجهة الهجمة الحضارية وليس في مواجهة المسيحيين.
مبدأ المواطنة وتطبيق الشريعة
يوضح البشري أن مبدأ المواطنة يتعلق بسؤالين: لمَن مِن القاطنين على أرض الدولة حقوق المواطن وواجباته الكاملة؟ وهل يقتضي ترجيح جامعة سياسية أن تنحسر حقوق طائفة من طوائف الشعب، وإلى أي مدى؟
وهو يرد الخلاف بشأن فكرة المواطنة إلى قصور نظري في الفكر الإسلامي السائد بالنسبة إلى تحقيق المساواة التامة بين المسلمين وغيرهم، يقابله قصور نظري في الفكر القومي بالنسبة للأقليات غير العربية في الوطن العربي، ولكن يؤكد أن الاجتهادات من الجانبين مستمرة للتقارب والتقريب.
ويورد البشري هنا ملاحظة بشأن تعامل التيار الإسلامي مع الاجتهادات المتصلة بمعاملة غير المسلمين في إطار الجامعة الإسلامية، فيشير إلى أنه رغم الإمكانات الفقهية الإسلامية والفكر الاجتماعي الإسلامي بصدد التعامل مع هذه القضايا، فإن التيارات الإسلامية تخشى أن يكون فتح الاجتهاد في هذه القضايا ذريعة لاقتلاع أصول الشريعة، بسبب ما تعرضت له على مدار قرنين من الهجمات المتتالية، فضلًا عن تأكيده أنه في مرحلة ترسيخ المبادئ والأصول، وليس في مرحلة معالجة الفروع، أو التعامل مع إشكالات الواقع القائم قبل تحقيق أو فرض واقع اجتماعي جديد مؤسس على هذه الجامعة (المشروع الإسلامي)، وعده استدراجًا له، فقضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج لعلاج وليس الجزية كما يشير سيد قطب.
ولكن يرى البشري أن مبدأ المواطنة ليس من الفروع، وتجاهله يؤدي لزيادة الخلاف بشأنه، ويؤكد نقلًا عن محمد فتحي عثمان: “إن المسائل المتعلقة بتولي غير المسلمين المناصب العليا الوزارية وفي الجيش، وحقوق إنشاء معابد مستحدثة، والمساواة التامة في الحقوق والواجبات من المسائل التي تحتاج أن تُجلى تمامًا للمسلمين ولغيرهم، ولا يكفي بشأنها النيات الغامضة” (ج2، ص41).
كما ينقل البشري عن الغزالي رأيه بأن الإسلام يعترف بالأديان السابقة عليه جمعيًا، وبخاصة يهودية موسى ومسيحية عيسى، وأن التعصب ليس من طبيعته، وأن الآيات المتعلقة باتخاذ المؤمنين للنصارى أولياء وردت جميعها في المعتدين على المسلمين، ولتطهير المجتمع من المنافقين. كما أوضح أن التاريخ الإسلامي شهد تمتع غير المسلمين بحقوق واسعة وتوليهم مناصب عليا في الأمصار المختلفة، مؤكدًا أن ما حدث خلاف ذلك لم يكن مرده إلى الإسلام.
كما يوضح البشري أن القرضاوي حدد واجبات غير المسلمين في ثلاثة:
- أداء الجزية، والخراج، والضريبة.
- الالتزام بأحكام القانون الإسلامي، وذلك بمراعاة القوانين، وعدم الترويج لعقائد أو أديان تخالف عقيدة الدولة ودينها.
- احترام شعائر غير المسلمين ومشاعرهم.
فأما الجزية فهي بدلٌ ماليٌ عن تأدية الخدمة العسكرية، باعتبار أن الإسلام لم يلزمهم بها تلطفًا (بوصفها واجبًا دينيًا على المسلمين)، ولا تجب إلا على القادر على حمل السلاح، ولا تفرض على راهب، وتسقط حال عدم قدرة الدولة على الحماية، كما تسقط باشتراكهم في الدفاع عن دار الإسلام. وأما الضريبة التجارية فأول من فرضها عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) باجتهاد مصلحي، وطالما أن هناك ضرائب حديثة فرضت على المسلمين وغيرهم فلا حاجه لتخصيص مبالغ الأخرى يدفعها المسيحيون.
وهنا، يحيل البشري إلى إشارة الدكتور عبد الحميد متولي بشأن أن منطق الحرب تغير بين زمن الفتوحات الإسلامية والعصر الحالي، فبينما كان الأول دفاعًا عن العقيدة، أصبح في زمننا دفاعًا عن أرض الوطن والمواطنين، ومن ثمَّ يلقى عبئها على المسلمين وغيرهم، وبالتالي تغير حكم الجزية وفقًا لمبادئ رفع الحرج، والضرورة، ومراعاة الاعتدال والتدرج، والتفرقة بين ما يعد تشريعًا دائمًا وتشريعًا وقتيًا من السنة.
ويؤكد البشري أهمية وجديَّة هذه الآراء وجدارتها في حل كثير من الإشكالات بصدد وضع غير المسلمين، ولكن يشير إلى أنه بقي التوجس من تولي بعضهم وظائف الولاية العامة، وهو ما يناقشه في كتابه من ثلاث جهات: الجهة الأولى: تخوف التيار الإسلامي من أن تؤول مقاليد الأمور إلى الأقلية الدينية، ويقابله تخوف آخر من أن يكون استبعاد غير المسلمين أساسه تصور نظري يتعلق بصلاحية من يتولى الحكم مما يمس بمبدأ المواطنة، ويؤكد البشري أن الأغلبية العددية كفيلة بإزالة حذر الإسلاميين.
أما الجهة الثانية: فيضيف البشري أن الفتوح الإسلامية لبلدان لم تكن الغلبة فيها للمسلمين أدت إلى ضرورة تولي المسلمين وظائف القيادة منعًا لتفلت زمام الأمور، إلا أنه في العصر الحالي ذهب هذا الظرف بحيث أصبحت هناك أغلبية عددية واضحة، وبالتالي لا يُخشى على إسلام المسلمين بتولي غيرهم، كما يوضح أن ضعف الوضع الدولي للمسلمين يُخشى فيه من عدم استقرار أوضاع المسلمين بسبب عدم المساواة على أساس المواطنة، فتنحل الرابطة الوطنية ويسهل استغلال القوى الخارجية لهذا الوضع (ج2، ص٦٠ – ٦١).
الجهة الثالثة: التأكيد أن التيار الإسلامي لا يوَاجَه بأقلية غير مسلمة تنازعه السيادة، بل بأقلية كانت لها وظيفة كفاحية شاركت في محطات مفصلية في تاريخ كل قطر إسلامي وعربي.
وهنا يشير البشري إلى أن موضع الخلاف في هذه النقطة يكاد ينحسر في: الإمامة، وقيادة الجيش، والقضاء. كما يؤكد أن منطلق الاجتهاد في تطبيق أصول الشريعة في العصر الحالي لا يرتبط ببيان مطابقتها لنظامٍ قائمٍ فعلًا، بقدر ما يتعلق ببيان مدى موافقة نظام منشود لهذه الأصول، أي إمكان بناء نظام دستوري موافق للشريعة ويحقق المساواة على أساس المواطنة (ج2، ص٦٥).
ويوضح البشري أن أغلب التصورات الشائعة لدى التيارات الإسلامية بشأن نظام الحكم الإسلامي مبنية على كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، ويؤكد أن الشروط والتقسيمات التي وضعها لولاة الأمر (بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ) كانت مبنية على واجبات ووظائف هؤلاء الوزراء التي هي غير موجودة ولا متحققة في واقعنا، ويشير مثلًا إلى أن السلطات الواسعة التي كانت ممنوحة لوزير التفويض من رسم سياسات وإدارة الأقاليم غير موجودة لدى أي وزير في الوضع الراهن أو حتى مجلس الوزراء بكامله، ولكن السلطات الآن موكلة وموزعة على هيئات لا أفراد أو على الأقل هذا هو المرتجى، كما أن القوانين تصدر بعد المرور على عدة هيئات، حتى أن توصيف الماوردي لوزير التنفيذ الذي قد تشمل مهامه إعطاء الرأي والمشورة – ولا يشترط فيه الإسلام – يفسح المجال لأن يكون رئيس الوزراء أو غيره غير مسلم في الوقت الراهن.
ويؤكد البشري أنه حتى وظيفة القضاء والقضاة اختلفت عما تصوره الماوردي، إذ توزعت اليوم على تقسيمات تتعلق بالولاية، ونوعيات الدعاوى، والاختصاص الإقليمي. كما أخد النظام الحديث بنظام القضاة المتعددين في نظر قضية واحدة (ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة) وليس بالفرد، فضلًا عن تعدد درجات التقاضي. كما أصبح القاضي مقيدًا بكم هائل من الاجراءات والقوانين التفصيلية، فلم يعد القاضي محلًا للاجتهاد، والتفسير، والتعامل مع النصوص، وهي وظيفة ذات صفة تشريعية تدخل ضمن اختصاصات المجالس النيابية وحدها الآن (ج2، ص٧٤).
يخلص البشري من ذلك إلى أنه طالما اقتربنا من مبدأ توزيع السلطات وحلول الهيئات محل الأفراد في اتخاد القرار “القرار الجماعي”، فقد أصبحت المسألة تتعلق ببناء الدولة ونظام الحكم الديمقراطي، ولكن إذا كان تنظيم الدولة يبنى على أساس من دمج السلطات والسلطة الفردية يظل ما جاء به الماوردي صالحًا على حاله فيما شرط من شروط لتقلد بعض الوظائف العليا.
الموقف الفكري للكنيسة من الإسلام وتطبيق الشريعة
يؤكد البشري أن الإسلام هو من أنشأ الأمة العربية وخلد ذكراها، كما ينقل عن الدكتور يوسف خليل (أستاذ قبطي مصري) أن القرآن حفظ اللغة العربية من الانحلال إلى لهجات متعددة، وبهذا لا يخص الإسلام المسلمين فقط، بل هو تراث المسيحيين العرب أيضًا، مؤكدًا دور الإسلام كعامل وقوة تماسك وتوحيد في المنطقة أكثر من أي عوامل أخرى، والوحدة العربية في نظره خطوة في طريق وحدة أعم، ومن ثمَّ يقبل مفكرو الاسلام مثل القرضاوي وعبد الفاضل الغوالي القومية إذا كانت تلتزم أحكام وشرائع النظام الإسلامي.
ويشير البشري إلى أن مجمل المواقف الفكرية والدينية للكنيسة القبطية في مصر منذ الستينيات وحتى 1973م كانت مناهضة للاستعمار والصهيونية، وضد العقلية الأنجلو-سكسونية في دعم إسرائيل، المتأثرة بالحروب الصليبية، وضد استغلال كنائسها لدعمها، حيث أكدت بياناتها وتفاعلاتها في هذه المرحلة على رفضها ذلك، ورفضها زعم إسرائيل أنهم شعب الله المُختار، أو أنهم يهود العهد القديم، أو اليهود المذكور تجميعهم في أرض الميعاد، مشيرين أن ذلك قد تحقق من خمسة قرون وانتهى، كما أكدت تعليقاتهم على اشتراك العرب في رفض وجود إسرائيل، وهو ما يجعل الكنيسة رافدًا من روافد الجماعة السياسية (الجامعة الوطنية).
ولكن يوضح البشري أنه منذ منتصف السبعينيات أخذ يتبلور تياران داخل الكنيسة: الأول تشده فكرة القومية المصرية والانتماء الفرعوني، ويرى في الارتباط بالغرب مصلحة لمصر، وأكثر ما يخشاه هو سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة. وخطورة هذا التيار الذي يريد أن يحول انتماء مصر وهويتها الحضارية إلى “البحر المتوسط” والغرب، تكمن في صياغة هذا الموقف صياغة قبطية بجعل الاتصال بالغرب نابعًا عن فكرة الدفاع عن “الحضارة المسيحية”، وأن قبول إسرائيل ينبع من مبدأ تعدد الأديان، ومن ثمَّ تكاملت في مواقف هذا التيار عناصر الموقف الطائفي، أي سيطرة المنطق الطائفي الذي يتحول إلى انتماء سياسي يتحكم في المواقف السياسية، والفلسفات، وحتى التعامل مع التاريخ (ج2، ص94).
ويؤكد البشري أن حتى هذه الروح والتمسك بالقومية المصرية الضيقة لا يحقق لهذا التيار مصالحه الطائفية، لأن تعداد المسيحيين في مصر – الذي يقارب ال 10% من السكان – لا يصل به إلى أهدافه المنشودة في القضاء على التمايز بين المسلمين والمسيحيين، ولا يبقى أمامهم في هذا السبيل سوى الاستقواء بالخارج وحركة المسيحية العالمية لضمان حقوقهم.
أما الاتجاه الثاني فيرى أن اضطهاد الأقباط كان مرتبطًا باضطهاد المصريين عمومًا. ويذكر الأستاذ ميلاد حنا أن المسيحيين منتشرون إلى جانب المسلمين في كل موقع من النخب، والطبقات المتوسطة، والتعليم، والمناصب بما يفوق تعدادهم، وهو ما يعطي في تقديره لهم وزنًا نسبيًا اجتماعيًا وسياسيًا يفوق وزنهم العددي، وأن مشاكلهم تعتبر من أخف مشاكل المنطقة، وبالتالي يتخذ هذا التيار موقفًا مناهضًا للسياسات العالمية الرامية إلى التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، ويرى في إسرائيل نوعًا من الاستعمار الاستيطاني، ولكن هذا التيار ابتعد عن دور الإسلام والفكر الديني عمومًا (حتى القبطي) في مواجهة الهجمات الاستعمارية، أي تبنى الأفكار العلمانية، وبالتالي فهو يلتقي مع التيار الأول في حذره من التيار الإسلامي. كما يشير حنا إلى أن الأقباط تنفسوا الصعداء عندما اصطدم عبد الناصر بالإخوان، في حين أنه لاحظ أن تمثيل الأقباط في المستويات العليا في الساحة السياسية كان ضعيفًا في عهده.
ويرى البشري أن ذلك تيار مغترب وافد ينمو على يد المتأثرين بالغرب من المسلمين والمسيحيين، وهو لا يوفر حقيقةً أمانًا لهم، إذ إن ضرب التيار الإسلامي أو الإسلام ليس مصدر الأمن للأقلية الدينية غير المسلمة، وإنما مصدر الأمن يتعلق بنظام الحكم، أي بالديمقراطية وبإقرار مبادئ المشاركة والمساواة (ج2، ص104).
ويشير البشري إلى أن الإسلام حفظ القبطية أربعة عشر قرنًا، وأن الكنيسة الغربية لا يمكن لها أن تحفظ للكنيسة الشرقية استقلاليتها ومكانتها، وإلا كانت احتفظت لنفسها بذلك، ويذكِّر بما كان من سماحة في اللقاء الأول بين المسيحية والإسلام على أرض مصر مع فتح عمرو بن العاص لها، وهو ما أعقب قهرًا كان يمارسه مسيحيو بيزنطة ضد مسيحي مصر.
كما يؤكد أن خوف المسيحيين من طغيان الأكثرية العددية مصدرها موقف سياسي أساسه الدين، وهو معتقد أكثر منه واقع حقيقي يحتاج إلى سياسات من قِبل الأغلبية، صدره تيار المسيحية العالمية والمتأثرين به في الكنائس الشرقية، والتي يستخدمها التيار الأول في الدول العربية لتشيع الفرقة بين أبناء هذه البلاد، والهدف منها وضع المسلمين والمسيحيين في مواجهة بعضهم، وليس معًا في مواجهة الاستعمار والصهيونية والقمع الدولي، كما يشير إلى أنه ليس من حق مواطن أن يطلب أكثر من المساواة، ولا يملك مواطن أن يعطي أو يضمن لغيره أكثر منها (ج1، ص130).
أما رفض الشريعة لأنها مستمدة من أحكام دين غير دينهم فقد يكون لها وجه لو أن للكنيسة نظام قانون للمعاملات يوازي نظام الشريعة أو يتضمن ما يخالفه، أو إذا كان يأتي ترجيحًا لنظام قانوني أكثر اتصالًا بالبيئة وسياقها التاريخي، ولكنه يجري ترجيحًا لنظام قانوني لاتيني وافد، ولا وجه لترجيح نظام وافد على موروث لمجرد أن الأقلية الدينية تأبى ذلك على الأغلبية الدينية.
واستشهد البشري بكلمات من الأب متى المسكين بشأن أن المسيح لم يهتم بوضع تشريعات مدنية، وأن محاولات جمع الكنيسة بين السلطان الزمني والديني جاءت على حساب تأدية المسيحية رسالتها، وبقدر ما كانت تستمد قوتها من الملوك بقدر ما كانت تفقد من قوتها الروحية. كما أشار ألبرت لحام إلى أنه ليس في الإنجيل تعليم سياسي أو معالجة مباشرة للقضايا السياسية.”، ويؤكد البشري أن الكنيسة القبطية لم تكن في تاريخها كنيسة حكم قط (ج2، ص111-112).
ويشير البشري إلى أن الكتاب القبطي (التراث الكنسي المصري) للصفي أبي الفضائل ابن عسال في القرن الثالث عشر الميلادي – الوحيد الذي عُني بالجرائم والمعاملات – لم يرفض مبدأ العقاب بالإيذاء البدني الذي يصل إلى الضرب أو قطع الأنف أو اليد، وبالتالي، فإن رفض المسيحيين للحدود لا يجد له ما يسوغه من هذه الناحية.
خاتمة: خطورة التوجه نحو الغربي وآفاق الحوار الإسلامي – العربي
يشير البشري إلى أن أخطر سلبيات التوجه إلى الغرب بغير تحفظ تتمثل في ضعف الشعور بالانتماء الحضاري وعموم شعور التبعية والتقليد، ما يضعف في النهاية الباعث على الإصلاح في مقابل استيراد نماذج جاهزة من الخارج. كما أصبح المتعلم غير مدرك للوظيفة الاجتماعية لعلمه، وهي أن ينقله إلى قومه، وأكثر تحفزًا للهجرة والسكن في المهجر، كما أضحى أكبر همه الحصول على مصدر دخل يؤمن له فرص التمتع بنماذج الاستهلاك الغربية، وأنبل طموحه أن تعترف مؤسسات الغرب العلمية بتميزه، وهو بذلك يشبه المحارب الذي افتقد الباعث المعنوي للقتال، فافتقد معنى الجهاد والكفاح وصار مرتزقًا، وكذلك الحال بالنسبة لأي مهني أو عامل إن افتقد معنى كون عمله رسالة يؤديها في نطاق انتماء ما، فصار مرتزقًا أيًا كانت ملكاته وكفاياته.
وهنا تصير أهم أهداف التعليم لا بناء الوطن، أو تقويم الجماعة، ودفع المضار عنها، بل إعداد الفرد بمجموعة من الملكات تمكنه من العمل في أي مكان، أي تمكنه من الهجرة وخدمة الآخرين، فصارت المؤسسات التعليمية بذلك أشبه بمزارع تربية الخيول، التي تربى للتصدير وفقًا لحاجات السوق العالمي، وصار معنى العزة الوطنية لا أن نبني على هذا التراب مجتمعًا وحضارة، ولكن أن يزيد الطلب على كفاءاتنا بالخارج، كما صار الشاطئ الآخر -شاطئ الغربة – هو الأمل والحلم، وما في شاطئنا قديم مهجور منبوذ يسعى للتقليد، وإذا كان التقليد هو الغاية فلما لا يذهب الإنسان إلى الأصل ويترك الخرائب المُقلِدة؟ (ج2، ص122)
ومع ذلك يؤكد البشري أن رأب الصدع بين التيارين: الإسلامي بقيمه الموروثة والقومي بقيمه الوافدة يحتاج إلى (جراحة فكرية)، ليلتئم التياران، ولن يتأتى ذلك إلا بنفي العلمانية من القومية، والأخذ بالشريعة الإسلامية، مع التأكيد على أنها ليست مجرد حدود، بل أحكام، وفقه ومعاملات وبالمساهمة في الجدل وتحريك حركة التجديد في الفكر الإسلامي.
وفي المجمل، يستشعر القارئ لهذين الجزئين صلاحية ما كُتب فيهما رغم مرور ما يقرب من أربعة عقود على طرح هذه الأفكار، إذ لا تزال التصورات بشأن الإسلامية والقومية “المغلوطة” أحيانًا، والمبالغة أحيانًا أخرى حاضرة في العلاقة بين التيارين. وربما تعمقت خطورة أبعاد كالنقل عن الغرب وتقليده أو اقتباس مساوئ نظم الحكم من القوى الصاعدة الأخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية، كما استجدت أوضاع إقليمية ودولية سياقية، جعلت من تحقيق الجامعة السياسية أكثر صعوبة وتعقيدًا.
غير أن أهم ما يؤكده السياق الحالي هو الحاجة إلى الحوار بين هذين التيارين، والوصول إلى صيغة تفاهم بشأن القضايا المختلفة انطلاقًا من تأكيد البشري المهم أن المطلوب تحقيقه هو بناء نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس توزيع السلطات والقرار الجماعي، لا نظام حكم الفرد الواحد، ومن قدرة كل تيار على تقديم إسهام وطني في مواجهة المشاكل المُحدقة بكل قطر إسلامي وبالأمة بكاملها.
عرض:
أ. أحمد عبدالرحمن خليفة*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تقوم القومية في فكر المودودي على ستة مبادئ، هي: وحدة النسل، وحدة المولد والمنشأ، وحدة اللغة، وحدة الجنس، وحدة المصالح الاقتصادية، وحدة نظم الحكم، ولا يمكن توفيقها مع أي أفكار أخرى ولا قوميات أخرى معها.
* ماجستير العلوم السياسية. جامعة الإسكندرية، مصر.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies