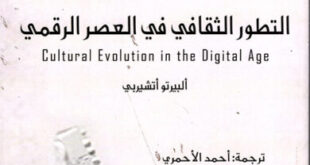بين محمود شاكر ووائل حلاق
أ. تقى محمد يوسف*
يتخذ محمود شاكر موقفا صارما من الاستشراق والمستشرقين، ويتضح هذا الموقف كأوضح ما يكون في كتابه “رسالة في الطريق إلى ثقافتنا” الذي استفاض فيه في نقد الاستشراق والمستشرقين، مبينا تاريخ الاستشراق، ولافتا النظر للعقبات التي تكتنف قدرة المستشرق على دراسة تراثنا أو ثقافتنا لأنه ببساطة لا يفقه لغتنا ولا ينتمي لثقافتنا. السؤال الذي نتناوله في هذه الورقة يتعلق بما لو كان هذا المستشرق —الذي يدرس الشرق من خلال المناهج الغربية— عالما باللغة العربية، نشأ بين أهلها صغيرا وتربى على تلك الثقافة؟ وماذا لو كان بالإضافة لما سبق يتخذ موقفا نقديا من أعمال المستشرقين التقليديين، بل وينتقد الاستشراق نفسه من حيث مقولاته ومناهجه؟ كيف سنصنف هذا المستشرق وفق شاكر، وكيف سنتعامل مع أعماله؟
شاكر والاستشراق والمستشرقون:
وُلد محمود شاكر عام 1909م ونشأ في بيت علم ودين؛ “فأبوه محمد شاكر كان من أبرز علماء مصر وقتها، وشقيقه الأكبر هو أحمد محمد شاكر الذي ولي منصب وكيل الأزهر ثم أصبح قاضيًا كما اشتغل بتحقيق كتب السنة ونشرها”. وفي شبابه، التحق بالجامعة المصرية طالبا في كلية الآداب، وهناك خاض معاناة فكرية أدت به لإعادة التفكير في كل ما اُعتبر من المسلمات في زمانه. فقد بدأت معاناته عندما كان يستمع إلى أستاذه طه حسين وهو يلقي محاضراته في الشعر الجاهلي، ووجد أن كل ما قاله أستاذه في تلك المحاضرات لم يكن سوى سطوًا على مقالة المستشرق مرجليوث. من أجل ذلك، قرر شاكر أن يترك الجامعة، بل يترك بلده مصر حتى يصل للحقيقة فيما يتعلق بقضية الشعر الجاهلي.
من هنا، بدأ شاكر “وحيدا منفردا رحلة طويلة جدا، وبعيدة جدا، وشاقة جدا، ومثيرة جدا”، في تلك الرحلة، رفض شاكر المناهج الأدبية السائدة في عصره لأنها مناهج مستوردة من الغرب ولأنها مناهج منقطعة الصلة بتراثنا العربي والإسلامي. ومن أجل بيان حقيقة ارتباط هذه المناهج بالمقولات الاستشراقية، قام شاكر بعرض تاريخ الاستشراق والمستشرقين ليعرّفنا بأصول تلك المناهج ونشأتها وكيف تسربت إلينا.
يصنف شاكر المستشرقين في فئات ثلاثة: الأولى: فئة المتعصبين الذين تعلموا اللغة العربية في الكنائس لخدمة التبشير، وهؤلاء هم الأصل في رأيه. والثانية: فئة المستشرقين الذين يخدمون الاستعمار وسياساته في العالم العربي. والثالثة: “فئة العلماء الذين يُظن أنهم تجرّدوا من الغرضين جميعًا”؛ ويظهر شاكر تشككا في إمكانية تجرد هذه الفئة عن أعراض خفية لا يعلنون عنها![1] لذلك، فهو يرى أن التعامل الأمثل مع هذه الفئة الثالثة أن يقف القارئ عند آرائهم وينظر إليها نظرة الناقد الذي لا يقبل إلا ما يمكن قبوله من معاني اللغة الموافقة للطبيعة الفطرية؛ ذلك أن أصحاب هذه الفئة ليسوا أصحاب سليقة في فهم اللغة العربية ونصوصها وإدراك معانيها، بل هم أعاجم دخلاء عليها. ويحذر شاكر من إمكانية أن “يستخرجوا قولًا ضعيفًا فاسدًا ليس بشيء في تاريخ الإسلام والعربية، ثم يكتبون وقد اتخذوا هذا القول أصلًا ثم يجرون عليه سائر الأقوال ويؤولونها إليه، ثم يحشدون لذلك شبهًا كثيرة مما يقع في تاريخ مهمل لم يمحص كالتاريخ الإسلامي، وكذلك يلبسون على من لا يعلم تلبيسًا محكما لأنه حشْد وجمع، وتغرير بالجمع والاستقصاء الذي يزعمون”.
بالإضافة إلى تمييزه بين الفئات الثلاثة، يحدد شاكر ثلاثة مداخل تتسرب منها نفس الداخل إلى المنهج -الذي يدرس به التراث الإسلامي- فتؤثر فيه، وهذه المداخل هي: اللغة، والثقافة، والأهواء. فلا يستطيع أي باحث أن يتجرد من لغته التي نشأ وترعرع فيها، ولا من ثقافته التي ينتمي إليها ويؤمن بها، ولا من أهوائه وأفكاره مهما ادعى عكس ذلك. لذلك، بقدر تمكن الباحث من اللغة العربية والثقافة الإسلامية بقدر ما يكون أقدر على الإحاطة بما يدرسه.
ويقوم محمود شاكر “بتحديد مدى تحقيق المستشرق للشروط الثلاثة (اللغة، الثقافة، الأهواء) ليعرف إذا كان هذا المستشرق مؤهلًا لنزول ميدان “ما قبل المنهج”. أما اللغة؛ فالمستشرق رجل أعجمي ناشئ في لسان قومه ثم هو يتعلم اللغة العربية على كِبَر، فمهما بلغ من الإحاطة باللغة فإنه لن يستطيع أن يتجاوز طبقة العوام من العرب الذين لا يُعتد بقولهم في ميدان المنهج وما قبل المنهج. وأما الثقافة؛ فالمستشرق قد تشرّب ثقافته هو، وانتمى إليها مذ كان صغيرا، لذلك فإن شرط الثقافة العربية ممتنع على المستشرق، وبعيد عنه كل البعد، فالثقافة العربية غريبة عليه، كما أنه لا يؤمن بها ولا ينتمي إليها، فمن الصعب أن يتذوقها أو يحيط بأسرارها. وأما الأهواء فواضحةٌ كل الوضوح، لأن المستشرق لم يحمله على النظر إلى ثقافةٍ أخرى غير ثقافته سوى مشاعر الغضب والبغضاء تجاه المسلمين، ومشاعر الشوق إلى حيازة كنوز هؤلاء المسلمين، ولذلك دفعه هواه إلى رسم صورةٍ بعيدة كل البعد عن الحقيقة.”[2] لذلك، لا يعترف شاكر بدراسات المستشرقين وكتاباتهم ولا يعتبرها بأي حال “علمية” بسبب عدم تحقيقهم للشروط الثلاثة التي حددها.
ويشير البعض إلى أن شاكر يضع التعاطف كشرط لفهم التراث الإسلامي، فلا يستطيع الدارس لهذا التراث أن يفهمه بدون تعاطف، وهو ما عبر عنه شاكر بالإيمان والانتماء للثقافة، كما قال: “فالعاصم يأتي من قبل الثقافة التي تذوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به، لا من حيث هي معارف متنوعة تدرك بالعقل وحسب، بل من حيث هي معارف يؤمن بصحتها من طريق العقل والقلب، ومن حيث هي معارف مطلوبة للعمل بها، والالتزام بما يوجبه ذاك الإيمان، ثم من حيث هي بعد ذلك انتماء إلى هذه الثقافة انتماءً ينبغي أن يدرك معه تمام إدراك أنه لو فرط فيه، لأداه تفريطه إلى الضياع والهلاك، ضياعه هو وضياع ما ينتمي إليه!” لذلك لا يمكن للغربي أن يدرس التراث بإنصاف لأنه يحمل معتقدات مختلفة تجعله غير قادر على الانتماء أو التعاطف مع الإسلام.
وإذا كان الأمر مبناه على التعاطف والانتماء، فإننا اليوم لدينا شريحة من المنتمين للحقل الاستشراقي ممن يتعاطفون مع الإسلام والمسلمين، ويظهر ذلك في كتاباتهم المتعاطفة مع الإسلام أو الناقدة للمناهج والرؤى الاستشراقية. وهنا يمكن الإشارة للمفكرين من ذوي الأصول العربية أمثال جورج مقدسي ذو الأصول اللبنانية ووائل حلاق وإدوارد سعيد وجوزيف مسعد ذوي الأصول الفلسطينية.
وهنا يأتي السؤال: إذا كان هؤلاء المسيحيون أقرب للشرق والعرب منهم للغرب، لماذا يكونون جزءًا من الحقل الاستشراقي حتى وإن كانوا ينتقدونه؟
وائل حلاق وزعزعة الاستشراق
يأتي وائل حلاق على رأس المستشرقين ذوي الأصول العربية الذين لهم إسهام كبير في محاولة تفكيك الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين في الأكاديميا الغربية. من جهة، يعتبر حلاق مستشرقًا من حيث إنه باحث متمكن من المعارف المتعلقة بالشرق ينتمي للأكاديميا الغربية وينشر كتبه تحت مظلتها، كما يعمل مدرسا في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة. من جهة أخرى، فإن حلاق على علم بأصول اللغة العربية والثقافة الإسلامية حيث وُلد في فلسطين عام 1955م ونشأ في أسرة متوسطة حتى أنهى دراسته الجامعية.
لكنه هاجر إلى الولايات المتحدة ليواصل دراساته العليا، وهناك بدأت معاناته الفكرية. فبعدما أشار عليه أستاذته الجامعيين بقراءة كتابات جوزيف شاخت على اعتبار أنه أهم عالِم كتب في موضوع الشريعة الإسلامية (في نظرهم)، لم يجد حلاق ضالته في هذه الكتابات، بل ولّدت لديه تساؤلات أكبر فتحت عينيه على إشكاليات المنهج الذي يستخدمه المستشرقون أثناء بحثهم في الشريعة والتاريخ الإسلامي. وقد كانت هذه الإشكاليات هي التي دفعته إلى اختيار موضوع أطروحة الدكتوراه الذي كان عبارة عن نقد إجمالي من جانبه للمواد التي أمضى وقتا طويلا في فهمها وقراءتها، وقد حاول في أطروحته نقد مقولة “جمود الشريعة” بسبب ما يدعيه البعض من “انسداد باب الاجتهاد” والتي تعتبر من المعتقدات المتغلغلة في الكتابات الغربية. من هنا، بدأت فكرة تتبلور في ذهنه مفادها أن مجمل الخطاب الغربي المتعلق بالشريعة متخبط، وينطوي على تناقضات ومغالطات خطيرة، وأنه لذلك يحتاج إلى استبدال كامل. وهكذا، أصبح مشروع حلاق هو تبديل الدرس الاستشراقي للشريعة وتحدي هذا الخطاب الأكاديمي السائد حول الشريعة.[3]
ورغم أن محمود شاكر ووائل حلاق ينتميان إلى أزمنة وأمكنة مختلفة، حيث يفصل بينهما 50 عاما أو أكثر، إلا أننا نجد منطلقاتهما متقاربة خاصةً فيما يتعلق بقضية الاستشراق، ومن هنا يمكن طرح سؤالين مهمين؛ الأول: إلى أي مدى يمكن اعتبار نقد وائل حلاق للاستشراق مكملا لنقد محمود شاكر؟ الثاني: هل يمكن لوائل حلاق – إذا تعاملنا معه كمستشرق وفق التعريف الاصطلاحي- أن يحقق الشروط الثلاثة التي تحدث عنها محمود شاكر؟ وعلام يدل ذلك؟ من أجل الإجابة على هذين السؤالين، نتعمق في عدد من الأفكار التي طرحها كل منهما، خاصةً تلك الأفكار الخاصة بشروط ما قبل المنهج التي وضعها شاكر (اللغة، والثقافة).
(1) مخالفة السائد
كان لكلٍ من محمود شاكر ووائل حلاق من الشجاعة ما جعلهما يرفضان المناهج السائدة، وطرح مناهج أو رؤى بديلة. فبينما رفض شاكر المناهج الأدبية السائدة في عصره؛ لأنها مناهج مستوردة من الغرب ولأنها منقطعة الصلة بتراثنا العربي والإسلامي، أبدى حلاق رفضه لمنهج الاستشراق الذي لا يُنتج معرفة صحيحة بـ “الشرق”.
وفي محاولته طرح مناهج بديلة، يقدّم شاكر رؤيته للمنهج -أو ما أسماه هو ما قبل المنهج، والذي يتكون من شطرين: شطر يتناول المادة وشطر يعالج التطبيق. أما شطر المادة فـ”يتطلب من الباحث أو الدارس جمع المادة من مظانها، ثم تصنيف مجموع ما وصل إليه، ثم تحليل أجزاء هذا المجموع تحليلًا دقيقًا، كل هذا حتى يستطيع الدارس أن يميز بين ما هو زيف وبين ما هو صحيح بشكل جلي واضح. وأما شطر التطبيق فيستلزم ترتيب المادة بعد استبعاد الزيف فيها وتمحيص الصحيح، وفي هذا الترتيب يجب أن يحرص الدارس على أن يضع كل حقيقةٍ في موضعها”.[4]
أما حلاق وإن لم يطرح منهجا بديلا، إلا أنه يؤكد أن الإشكاليات التي تنتج عن مناهج المستشرقين ليست من قبيل الاستثناءات التي يمكن تجاوزها أو إغفالها، بل هي من صميم تلك المناهج والرؤية التي تنطوي عليها وتنطلق منها. ففي كتابه “نشأة الفقه الإسلامي” يقول حلاق: “هذا الكتاب يهدف إلى زعزعة الخطاب الاستشراقي … ولكي تتحقق هذه الزعزعة لا يجب فقط أن يكون للخطاب المزعزِع الذي نؤسسه مستمعون وقارئون، بل يجب أن يشارك هذا الخطاب في بعض الافتراضات والمعطيات الأساسية للخطاب الاستشراقي المزعزَع”.[5]
وفي كتبه اللاحقة مثل “قصور الاستشراق” و”إصلاح الحداثة” يحاول حلاق إضافة ما أسماه بالنقد الخارجي، والذي لا يعني بالنسبة له التحدث من موقع خارج الحداثة لأننا بالفعل داخلها، لكنه يقصد الاستفادة بالنطاقات الهامشية بهدف إبدال النطاقات المركزية في ظل الحداثة. فهو يستعين بفكرة النطاقات المركزية والنطاقات الهامشية لكارل شميت؛ ليقول إن السياسة والاقتصاد تم وضعهم في النطاق المركزي في ظل الحداثة، بينما تم تنحية الأخلاق إلى النطاق الهامشي، لذلك فهو يحاول استعادة الأخلاق ووضعها في المركز.[6] ومن هنا يضع حلاق ملامح منهج بديل يمكن تطويره وإكمال الفراغات فيه، فهو يؤكد أن الحل لن يكون من داخل هذه المناهج نفسها، بل من خارجها. كما يخبر حلاق أن الشريعة الإسلامية لديها ما تقدمه كمنهج ونظرية، بعبارة أخرى توظيفها كنظرية نقدية، وكمنهج لنقد الحداثة من خلال التأكيد على مركزية الأخلاق.
مما سبق يتبين أن كلا من شاكر وحلاق كان لهما نَفس نقدي، نتج ربما بفعل المعاناة الفكرية التي خاضاها والتي قادتهما لإعادة التفكير في كل ما اُعتبر من المسلمات في زمان كل منهما، ولنقد ما هو موجود، لتجاوزه وطرح رؤى ومناهج وأفكار بديلة. فقد كانت حرب محمود شاكر مستعرة على كلٍ من طه حسين ولويس عوض من أجل حماية التراث العربي والإسلامي، وبالتالي حماية اللغة والثقافة. وقد وجه كما هو معلوم نقدا لاذعا لطه حسين الذي كان يدعي — متأثرا بمرجليوث — أن الشعر الجاهلي لا أساس له، وأنه انتُحل في عصر الإسلام، كما وجه نقده للويس عوض الذي كان يزعم تأثر التراث العربي بالإرث اليوناني وكان يشكك في الشعر العربي وجذوره الثقافية.
أما حلاق فلم يراكم على الأطروحات الاستشراقية لجوزيف شاخت وغيره من المستشرقين القدامى، بل راح ينقد تلك الأطروحات ويقدم رؤية بديلة، مستمدة من الشريعة. ولا يكتفي حلاق بمراجعة الكتابات الاستشراقية، بل إنه يقوم أحيانا بمراجعة أطروحات ناقدي الاستشراق، ففي نقده للاستشراق في كتابه “قصور الاستشراق” قدم مراجعة لإدوارد سعيد، في محاولة لتجاوز أطروحاته والتأسيس لأطروحات جديدة في نقد الاستشراق.
(2) الثقافة والانتماء لها
يولي شاكر الثقافة أهمية بالغة، كما يضعها كشرط من الشروط الثلاثة للباحث الذي يريد دخول ميدان ما قبل المنهج ودراسة التراث الإسلامي، وهذه الثقافة هي “معارف كثيرة لا تحصى، متنوعة أبلغ التنوع لا يكاد يحاط بها، مطلوبة في كل مجتمع إنساني للإيمان بها أولا عن طريق العقل والقلب، ثم للعمل بها حتى تذوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به، ثم للانتماء إليها بعقله وقلبه وخياله انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار”.[7]
أما وائل حلاق فقد ظهر تأثره بتلك الثقافة وتجلياتها في واقع المسلمين والإيمان بها والانتماء لها في كتبه؛ ففي كتابه “الشريعة: النظرية والممارسة والتحولات”، يستقصي حلاق الشريعة الإسلامية التي تعتبر الأساس الذي تقوم عليه الثقافة والمجتمعات الإسلامية، كما يحاول التأكيد على أن الشريعة تجمع بين الأخلاق وبين القانون على عكس القانون الحديث الذي همش دور الأخلاق. وإذا كان المستشرقون ينظرون إلى الشريعة باعتبارها منتجا عتيقا يحتاج إلى التحديث، لأن نظرتهم قائمة على فكرة التقدم، فإن حلاق يعمل على إعادة الاعتبار للأخلاق التي المتضمنة في الشريعة، باعتبارها نقطة قوة لا ضعف. لذلك، فإنه ينتقد الحداثة —أصل الثقافة الغربية، لأنها تنحي الأخلاق وتتعامل معها كنطاق هامشي، في حين تقدم السياسة والاقتصاد كنطاقات مركزية، ويقدّم عليها المنظومة الإسلامية التي تضع الأخلاق في المركز.
وفي كتابه “الدولة المستحيلة” ينتقد حلاق الدولة الحديثة التي تنزل الأخلاق في مرتبة ثانوية، بل وتفصلها عن الاقتصاد والسياسة والقانون، ولهذا يقدم عليها الحكم الإسلامي الذي تكون فيه السلطة محكومة بقواعد أخلاقية تعبر عن الإرادة الأخلاقية الإلهية. إذن، فالثقافة الإسلامية ثقافة تستند إلى أصل أخلاقي يتجلى في كل المناحي السياسية والاقتصادية والفكرية، وهذا الأصل الأخلاقي هو نقطة أخرى يلتقي فيها الرجلان نتحدث عنها في فقرة تالية.
ويتفق شاكر وحلاق في أن الثقافة جزء أصيل من أي مجتمع أو أمة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تعميم ثقافة من الثقافات على كل الشعوب، كما لا يمكن الحديث عن “ثقافة عالمية”. لذلك، يتحدث شاكر عن التفريغ الثقافي الذي حصل لأمته من خلال قطع صلة تلك الأمة بتراثها وبلغتها، حتى أصبحت تنظر للثقافة الغربية نظرة انبهار وتعظيم بسبب ذلك التفريغ. ويتحدث حلاق عن الثقافة الأوروبية المهيمنة وكيف أنها فُرضت على المجتمعات الأخرى بواسطة الكولونيالية التي لم تحترم ثقافات المجتمعات والتي أقامت بذور الحداثة فيها.
(3) مركزية الأخلاق
يولي شاكر أهمية بالغة لما أسماه “الأصل الأخلاقي”، هذا الأصل الأخلاقي يقوم بدورين رئيسيين: الأول: أنه يحفظ النازل ميدان ما قبل المنهج من أن تتنازعه الأهواء تنازعا يفضي إلى جعل قضية المنهج وما قبل المنهج “فوضى مبعثرة لا يتبين فيها حقا من باطل، ولا صوابا من خطأ”. والثاني: أنه يحفظ ثقافة الأمة؛ “فهذا الأصل الأخلاقي هو العامل الحاسم الذي يمكن لثقافة الأمة بمعناها الشامل، أن تبقى متماسكةً مترابطةً تزداد على مر الأيام تماسكًا وترابطًا بقدر ما يكون في هذا “الأصل الأخلاقي” من الوضوح والشمول والتغلغل والسيطرة على نفوس أهلها جميعًا … وكل اختلال يعرض فيضعف سيطرة هذا الأصل الأخلاقي، أو يؤدي إلى غموضه أو غيابه أو تناسيه أو قلة الاحتفال به، فهو إيذان بتفكك الثقافة وانهيار الحضارة”. وهذا الأصل الأخلاقي ليس قواعد عقلية ينفرد بها العقل، لأن “القواعد العقلية المجردة لا تكاد تقوم بهذا العبء كله، بل العقائد وحدها هي صاحبة هذا السلطان على الإنسان، لأنها إما أن تكون مغروزة في فطرته … وإما أن تكون مكتسبة، ولكنها مُنَزَّلة منزلة العقائد المغروزة فيه”.[8]
ويرى شاكر أن هذا الأصل الأخلاقي يكون مستندا على الدين أو العقيدة التي تكون مغروزة في الفطرة أو مكتسبة، ولكنها مُنزّلة منزلة العقائد المغروزة، كما أنه جزء من التراث والثقافة الإسلامية، حيث اعتنى به العرب والمسلمون المتقدمون عناية فائقة، “وهذه العناية بالأصل الأخلاقي هي التي حفظت على الثقافة الإسلامية تماسكها وترابطها مدة أربعة عشر قرنا”.
ويصل حلاق إلى نتائج مقاربة، حيث إنه اعتبر المنظومة الحداثية فيها خلل واضح يتصل بالأخلاق، حيث نحت الحداثة الأخلاق إلى الهامش، كما فصلت بين المعرفة والأخلاق. لذلك، يبحث عن منظومة أخلاقية بديلة في محاولة لإعادة الأخلاق إلى النطاق المركزي بعد أن تم تنحيتها إلى الهامش في ظل الحداثة. ويركز حلاق بحثه على المصادر الأخلاقية الإسلامية لسببين: الأول: “أن للمسلمين تراثهم الخاص بهم، وهو تراث ضخم وثري يضرب بجذوره في قرون من الإنجازات الثقافية”، والثاني: أن هذا الموروث الأخلاقي يعكس تجربة تاريخية معيشة بالفعل، لا أفكارا نظرية وفلسفية حول مجتمع لم يعش فيه أحد قط.[9] وهو هنا يصل إلى نفس النتيجة: أن الأخلاق لابد أن تكون مستندة إلى دين.
ويفصل حلاق في مصادر هذا الموروث الأخلاقي الإسلامي ويحصرها في التالي: القرآن (النص المؤسس)، وأركان الإسلام الخمسة، ومقاصد الشريعة الخمسة، والشريعة ذاتها؛ والشريعة عند حلاق هي مجموعة مبادئ أخلاقية تدعمها مفاهيم قانونية.[10]
(4) معضلة الاستشراق
يمثل الاستشراق معضلة ضخمة بالنسبة لكل من شاكر وحلاق، وقد أفرد كلٌ منهما كتابًا لبحث هذا الموضوع، وإن كانت كتاباتهم الأخرى لا تخلو من الإشارة إلى هذا الموضوع الذي يرتبط عندهم بالاستعمار وغيره، فقد أفرد شاكر كتابه “رسالة في الطريق إلى ثقافتنا” للحديث عن الاستشراق وتاريخه وأصوله وكيف أثر في عالمنا العربي والإسلامي حتى أفسد علينا حياتنا الاجتماعية والثقافية. أما حلاق فقد أفرد كتابه “قصور الاستشراق” للكشف عن الأبعاد البنيوية المتعلقة بأصول العلم والمعرفة، وسلط الضوء على الحداثة التي تُعتبر أصل الداء، فيما يُعتبر الاستشراق عرضاً من أعراضها.
وقد ألمح كلٌ من شاكر وحلاق إلى أنه تم تشكيل وعي الأوروبيين تجاه الشرق بطريقة معينة من خلال الاستشراق، فيرى شاكر أن المستشرقين كتبوا ما كتبوا حتى يرسموا صورة للإسلام وحضارته موجهة بالأساس لأولئك الأوروبيين الذاهبين لديار الإسلام ليعاشروا أهلها، فهذه الصورة هدفها أن تكون “مستقرة في أنفسهم، تحميهم من التفرق والضياع فيه، وتحصنهم أيضًا من الانبهار بالإسلام وحضارته كما انبهر أسلاف لهم غبروا”.[11] أما حلاق فيذهب أبعد من ذلك، إذ يرى أن أولئك الأوروبيين لم يتم إعطائهم صورة عن الإسلام وحضارته فحسب، بل تم تشكيل وصنع هؤلاء الأوروبيين لينظروا للعالم كما المستشرقين، فيقول: “فقبل تشكيل الذات الأوروبية لصنع الشخص الكولونيالي وإرساله إلى المستعمرات، كانت هذه الذات قد خضعت بالفعل لنوع من الكولونيالية بوصفها ذاتا معرفية يمكنها النظر إلى العالم كمستشرق”.[12]
وإن كان حلاق يوجه نقده للاستشراق من أجل تغيير هذه الصورة النمطية وهذا الخطاب السائد عن الشرق الموجود في الأكاديميا الغربية وبالتبعية في الثقافة الغربية بشكل عام، معتبرا أن هذا الخطاب السائد ليس علميا بل هو أيديولوجي، فإن شاكر يوجه نقده للاستشراق من أجل توعية القارئ العربي الذي تأثر بخطاب الاستشراق وظن أنه يحمل بعض أو كل الحق، وهو إن كان يعذر المستشرقين ويتفهم دوافعهم في اختلاق وافتراء صورة معينة عن الشرق تحفظ نفوس الأوربيين من الانبهار بالشرق، فإنه لا يستطيع أن يفهم كيف لأولئك العرب أن يتلقفوا كلام المستشرقين على أنه كلام علمي، ويبثونه في الجامعات وبين الطلاب!
أما عن المنهج الذي انتهجه كل منهما في نقده للاستشراق، فقد انتهج شاكر في نقده للاستشراق منهجًا تاريخيا محاولا الكشف عن جذور الاستشراق وبداياته، وعاد بالزمن حتى القرن الثالث عشر متحدثا عن الرحلات المتوجهة من أوروبا للعالم الإسلامي والتي جاءت على مرحلتين، بدأت الأولى بعد إخفاق الحروب الصليبية وقامت على أفراد قلائل مثل روجر بيكون (1214 – 1294 م) الذي توجه للعرب المسلمين ليتعلم منهم فيعلّم غيره، ومثل توما الإكويني (1225 – 1274 م) الذي أراد إصلاح خلل المسيحية حتى يمنع قومه من الانبهار بالمسلمين. أما الثانية فقد كانت عند بداية اليقظة الأوروبية، وهي التي بُعث فيها الكثيرون إلى ديار الإسلام ليحصّلوا كل ما يستطيعون من علوم ومعارف وكتب، ثم يعودون لإمداد “علماء اليقظة” بكل ما حصلوا عليه من كتب ومعارف، وأيضا إمداد الرهبان والملوك بكل ما علموا من أحوال ديار الإسلام. ومن هنا تشكلت طبقة المستشرقين الذين كانوا يمدون الملوك والرهبان بالمعلومات اللازمة عن العالم الإسلامي من أجل إعادة بعث أوروبا.[13]
على الجانب الآخر كان نقد حلاق للاستشراق نقدا على المستوى الفلسفي؛ حيث يحاول حلاق نقد الاستشراق باعتباره أحد مظاهر الحداثة وأحد أهم إشكالياتها، لذلك في نقده للاستشراق يتجه حلاق لنقد أمرين آخرين: نقد الحداثة وأفكارها باعتبارها المظلة التي أنتجت ظاهرة الاستشراق، وأيضا نقد المعرفة الحداثية حيث يكمن جوهر المشكلة في الرؤية الحداثية للمعرفة والعلم عموما، وبالتالي يعمم نقده على كافة الحقول المعرفية مثل علم التاريخ والاجتماع والسياسة لا حقل الاستشراق فقط. ويستعين حلاق في نقده بأطروحات العديد من الفلاسفة والمنظرين وعلى رأسهم فوكو ورينيه جينو وغيرهم.
(5) شرط اللغة
يقف شاكر عند اللغة كثيرا سواء في حديثه عن شروط النازل لميدان ما قبل المنهج والتي على رأسها اللغة لأنها هي وعاء المعارف، أو في حديثه عن حساسيته الشديدة تجاه المصطلحات التي تأتي محملة بحمولة ثقافية وحضارية معينة.
كما نجد تلك الحساسية أيضًا عند وائل حلاق عندما تحدث في بداية كتابه “الشريعة” عن سجني الحداثة واللغة، وتظهر هذه الحساسية من جهتين: الأولى؛ من جهة الألفاظ المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، والثانية؛ من جهة المصطلحات المحملة. فمن جهة الألفاظ المترجمة، تحدث حلاق عن دور اللغة عموما في إنتاج المعرفة وعن تأثير سجن اللغة الإنجليزية في تصورات الغرب لمفاهيم الإسلام ومصطلحاته، ومثّل لذلك بترجمة مصطلح “الشريعة” إلى اللغة الإنجليزية بمصطلح “Islamic law”، حيث يرى أن الكلمة الإنجليزية لا تعكس المعنى المتضمن في مصطلح الشريعة، فكلمة “law” الإنجليزية تترجم إلى “قانون”؛ وهذا المصطلح غير دقيق لأن الشريعة أوسع مما يفيده مصطلح “قانون،” حيث تشمل الشريعة الشعائر والعبادات الدينية كما تشمل مبادئ العدالة وقواعد الأخلاق وواجبات الحكام والمحكومين وغير ذلك، كما أن ترجمة الشريعة إلى “law” تؤدي إلى التفرقة بين القانون والأخلاق، في حين أن الشريعة في الحقيقة لا تفرق بينهما.[14]
وسجن اللغة عند حلاق قريب من شرط اللغة عند شاكر؛ فالشرط الأول للباحث في التراث الإسلامي عند شاكر هو التمكن من اللغة والإحاطة بأسرارها حتى لا يقع في مزالق “يُخشى معها أن تنقلب وجوه المعاني مشوهة الخلقة بقدر بعدها عن الأسرار الخفية المستكنة في هذه الألفاظ والتراكيب”، وهذا الشرط لا ينطبق على المستشرق الأعجمي الذي ينشأ في لسان أمته ثم يتعلم العربية “عن أعجمي مثله، وبلسان غير عربي، ثم يستمع إلى محاضر في آداب العرب أو أشعارها أو تاريخها … بلسان غير عربي، ويقضي في ذلك سنوات قلائل، ثم يتخرج لنا “مستشرقا” يفتي في اللسان العربي والتاريخ العربي والدين العربي”![15]
أما عن المصطلحات المحملة والتي يقف عندها حلاق فيمكن التمثيل عليها بمصطلح “الإصلاح”، فهو مصطلح يصف التحولات الشرعية التي حدثت في العالم الإسلامي نتيجة الهيمنة الأوروبية وبالتالي ينطوي على افتراض “مفاده أن الشريعة قاصرة ومحتاجة إلى تصحيح وتنقيح تحديثي”، كما يشير المصطلح إلى تحول ما، من عدم التحضر إلى التحضر. ويتقاطع هذا مع النقد الذي وجهه شاكر لمصطلح “الرجعية” والذي أصبح يُستخدم توريةً عن الإسلام، بل وأصبح أي منكر لشيء في الحضارة الغربية من أخلاق أو فكر أو طريقة للحياة يوصف بأنه “رجعي”.[16]
كما وجه شاكر نقدا حادا لمصطلحات يتم الترويج لها والاحتفاء بها في عالمنا العربي من قبيل “التجديد” و”التحرر” و”التحديث” و”التقدم”؛ وقد كان هذا الأخير محور نقد أساسي عند حلاق الذي يرى أن التقدم أصبح كالدين أو العقيدة التي ينشأ الأطفال عليها، وبهذا يتم استبعاد الماضي ومن يحن إليه باعتباره “متأخر” أو “رجعي”.
وائل حلاق في ميزان محمود شاكر
شكك محمود شاكر في نوايا المستشرقين، ووضع شروطا صارمة لمن يريد أن يبحث في التراث الإسلامي والعربي، حتى يحمي التراث من عبث العابثين، وحتى يحافظ على العلم من دخول من ليس من أهله فيه. وقد كانت تلك الصرامة ضرورية في ذلك الوقت الذي كثرت فيه كتابات المستشرقين المتعصبين والعرب المتأثرين بتلك الكتابات، حتى ظهرت أجيال مفرّغة تهتكت علاقاتها بثقافتها العربية والإسلامية اجتماعيا وثقافيا ولغويا، تم تفريغها تفريغا كاملا من ماضيها كله، ثم ملأ هذا الفراغ علوم وآداب وفنون لا علاقة لها بماضيها، وإنما هي علوم وآداب الآخر![17]
أما اليوم، لدينا بعض المستشرقين الذين ينتمون إلى حقل الاستشراق، لكنهم في الحقيقة متمردون عليه ينتقدون الاستشراق والمناهج الاستشراقية، ويتعاطفون مع الثقافة الإسلامية والعربية. فهل هؤلاء يدخلون في تعريف شاكر للمستشرق؟ وهل يستطيعون تحقيق الشروط الثلاثة التي وضعها؟
عند النظر إلى وائل حلاق، نجد أنه على علم باللغة العربية حيث تربى عليها صغيرا أثناء نشأته في فلسطين، وإن كان من الصعب الجزم بمقدار براعته في اللغة العربية، وقدرته على التعمق في التراث الإسلامي الذي يحتاج قدرا كبيرا من الإحاطة بتلك اللغة والحساسية تجاه المفردات التي ربما حُمّلت بمعانٍ أخرى. مع ذلك، فإن حلاق يبدي حساسية تجاه المصطلحات وترجمتها مما يدل على إدراكه لأهمية مكون اللغة في فهم التراث، وأن أي خطأ في الفهم أو الترجمة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، مثلما حدث مع ترجمة المستشرقين للشريعة على أنها “Islamic law”.
أما الثقافة، فإن حلاق يتعاطف مع الثقافة الإسلامية بشكل واضح في كتاباته، بل يرى فيها الحل لمشكلات الحداثة وكوارثها. كما نجد وائل حلاق مثلا يؤكد أكثر من مرة أنه يفضل أن يعيش كمسيحي في ظل الدولة الأموية أو العباسية على أن يعيش في الدولة الحديثة الموجودة اليوم؛ حيث يرى أن وضع الأقليات في ظل الدولة الحديثة ليس وضعا جيدا لأنها تعاني من الاضطهاد، على عكس وضع الأقليات في ظل نظام الحكم الإسلامي.
وهكذا، يصعب أن نضع حلاق ضمن فئة من الفئات الثلاثة للمستشرقين[18] التي أشار إليها شاكر. لذلك، ربما نحتاج إلى إضافة فئة رابعة تتضمن المستشرقين المتعاطفين أو المنصفين الذين يتعاملون مع التراث الإسلامي والثقافة الإسلامية بنوع من الإنصاف، ويكون هدفهم هو تغيير الصورة النمطية للإسلام والمسلمين المترسخة في الغرب.
ومع ذلك، يكمن التعامل الأمثل مع هذه الفئة في الحذر أيضا من خلال مراجعة ما كتبوه للتأكد من صحة فهمهم للتراث وتحليلهم له. وربما يجدر الاهتمام بكتابات هذه الفئة -الرابعة- لسببين: الأول: الجانب النقدي التفصيلي الذي يقدمونه للمناهج الغربية، فهذه الفئة قد تعمقت في الأكاديميا الغربية والفكر الغربي بحيث تستطيع توجيه النقد بشكل تفصيلي يعكس تفاعلهم معه. ونحن في تعاملنا مع التراث نحتاج إلى نقد وبناء، نقد التعامل الغربي مع تراثنا وتفكيك رؤيته له، وإعادة إحياء تراثنا والتفكير في مناهج تعيننا على التعامل الأمثل معه، لذلك يمكننا الاستعانة بالجانب النقدي الموجود في كتاباتهم ومراكمته والبناء عليه. الثاني: عند تفاعل هذه الفئة مع التراث -بشكل متعاطف- ربما لاحظت بعض الأمور التي يعتبرها أصحاب التراث من المسلمات ولا يقفون عندها كثيرا، يمكننا أيضا الاستعانة بهذه الأمور والوقوف عندها حينما نطرح تراثنا وثقافتنا كبديل لحل مشكلاتنا أو مشكلات الغرب.
بعد الحديث عن فئات المستشرقين، يمكن أيضا الوقوف عند الميزان الذي وضعه شاكر والتساؤل حول تلك الشروط الثلاثة وهل هي كافية لتقييم الاستشراق اليوم أم لا، فالاستشراق ظاهرة بالغة التعقيد والتغير، وقد حدثت تحولات في حقل الاستشراق سواء من ناحية المناهج أو من ناحية الموضوعات التي تحظى بالاهتمام، حتى ظهر ما يُعرف بالاستشراق الجديد.[19] إذ يرى البعض أن حقل الاستشراق كان محتكرا من قبل الفيلولوجيين (فقهاء اللغة) والمحترفين في اللغات الشرقية، لكن منذ أواسط القرن العشرين شمل الحقل باحثين من حقول معرفية أخرى كالمتخصصين في العلوم الاجتماعية من علم اقتصاد واجتماع وأنثربولوجيا، وشمل أيضا مختصين في الأدب والفنون ليتوجه الاهتمام بشكل متزايد نحو دراسة المجتمعات والثقافات الإسلامية.[20]
لذلك، يمكن القول إن الدراسات الاستشراقية اليوم اختلفت أو اتسعت آفاقها عن الدراسات التي كان يواجهها محمود شاكر ويوجه لها النقد. وإذا كانت الدراسات الاستشراقية التي تعامل معها شاكر يغلب عليها استهداف التراث وتفسير نصوص القرآن والسنة من خلال الاعتماد على المنهج الفيلولوجي، فإن هذا يوضح تركيز محمود شاكر على شرط اللغة ووضعه قيودا صارمة عليه تجعل من الصعب جدا تحقيقه. أما الدراسات الاستشراقية والتي تعتمد على المنهج الأنثربولوجي في دراسة المجتمعات المسلمة وثقافاتها والتي أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل في الحقل الاستشراقي، فيمكن تقييمها من خلال شرط الثقافة الذي وضعه شاكر والذي وضع له قيودا تتمثل في الإيمان بتلك الثقافة والانتماء لها والعمل بها.
وأخيرا، يمكن القول إن نقد حلاق للاستشراق سلط الضوء على أبعاد جديدة يمكن إضافتها للنقد الذي وجهه محمود شاكر. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقل الاستشراق الغربي في انتقاله من القديم إلى الجديد ربما أصبح منفتحا من ذي قبل لمراجعة المقولات والأفكار القديمة التي كانت منتشرة في ظل الاستشراق القديم —سواء استطاع تجاوزها أو لا-، ومن هنا يصبح نقد حلاق للاستشراق ضروريا ومفيدا في تصحيح الأفكار والمقولات القديمة واستبدالها بأفكار ومقولات أكثر حيادا وأقرب للواقع الإسلامي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحثة في العلوم السياسية.
[1] محمود محمد شاكر، جمهرة مقالات محمود محمد شاكر، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 2008). صـ127
[2] تقى محمد، “رسالة في الطريق إلى ثقافتنا”، مركز خطوة للتوثيق والدراسات. bit.ly/3Z56wsf
[3] وائل حلاق، الشريعة؛ النظرية والممارسة والتحولات، (الصنائع: دار المدار الإسلامي، 2018). ص14
[4] تقى محمد، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، مركز خطوة للتوثيق والدراسات. bit.ly/3Z56wsf
[5] وائل حلاق، نشأة الفقه الإسلامي وتطوره، (الصنائع: دار المدار الإسلامي، 2007). ص10
[6] ترجمة حوار مع وائل حلاق وقصور الاستشراق، مركز نماء للبحوث والدراسات. https://bit.ly/3YPRoia
[7] محمود محمد شاكر، رسالة في الطريق الى ثقافتنا، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 2006). صـ28
[8] المرجع السابق. صـ31-33
[9] وائل حلاق، الدولة المستحيلة؛ الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014). صـ37
[10] محمد بو هلال. “الأخلاق في الحداثة من النطاق الثانوي إلى النطاق المركزي مقاربة وائل حلاق”. مجلة تبين، العدد 6، 22 (2017). https://bit.ly/3Wu8n7Y
[11] شاكر، رسالة في الطريق. صـ57
[12] وائل حلاق، قصور الاستشراق؛ منهج في نقد العلم الحداثي، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر: 2019). صـ175
[13] تقى محمد، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، مركز خطوة للتوثيق والدراسات. bit.ly/3Z56wsf
[14] كيان أحمد يحيى، “سجن اللغة وترجمة المصطلح الإسلامي الشرعي”، مجلة فصل الخطاب، العدد 23 (2018): صـ43.
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/81/7/3/119823
[15] شاكر، رسالة في الطريق. ص66، 67
[16] محمود محمد شاكر، أباطيل وأسمار، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 2005). ص404
[17] شاكر، رسالة في الطريق. صـ149
[18] الأولى: فئة المتعصبين الذين تعلموا اللغة العربية في الكنائس لخدمة التبشير. والثانية: فئة المستشرقين الذين يخدمون الاستعمار وسياساته في العالم العربي. والثالثة: فئة العلماء الذين يُظن أنهم تجرّدوا من الغرضين جميعًا، كما أشرنا سابقا.
[19] كانت بدايات الاستشراق الجديد في أواسط القرن العشرين تقريبا، وهي مرحلة تمتاز بالحياد والموضوعية إلى حد ما مع توجيه النقد للمضامين والمناهج والأدوات الاستشراقية الكلاسيكية. انظر: عبد الله الوهيبي، حول الاستشراق الجديد؛ مقدمات أولية، (الرياض: البيان مركز البحوث والدراسات، 2014). ص86
[20] عبد الله الوهيبي، حول الاستشراق الجديد؛ مقدمات أولية، (الرياض: البيان مركز البحوث والدراسات، 2014).
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies