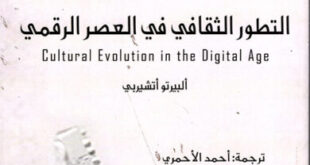العنوان: الأخلاق في عصر الحداثة السائلة.
المؤلف: زيجمونت باومان.
ترجمة: سعد البازعي، بثينة الإبراهيم.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: أبو ظبي.
الناشر: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة- مشروع كلمة.
تاريخ النشر: 2016.
الوصف المادي: 333 ص.، 21 سم.
الرقم الدولي الموحد: 978- 9948-13-526-5
أشار المترجمان في مقدمتهم أن “زيجمونت باومان” (1925) هو من قام باستبدال مفهومي “الحداثة” و”ما بعد الحداثة” بمفهومي “الحداثة الصلبة” و”الحداثة السائلة”. فقد رأى “زيجمونت باومان” بأن صلابة المرحلة التي اتفق المحللون على تسميتها بـ “مرحلة الحداثة” ذابت، فتداخلت الحدود وتراخت السمات وازدادت ضبابية حتى صار من الممكن أن نتحدث عن سيولة سواء أكان ذلك في حدود الدول أو معالم المجتمع أو سمات الهوية الفردية أو خصائص الثقافات. ولم تعد صلابة حداثة التنوير قائمة بل حلت محلها حداثة سائلة هي ما يقصده الآخرون بـ “ما بعد الحداثة” وما يسميه باومان بمرحلة “الحداثة السائلة”.
والكتاب الذي بين أيدينا، والذي يتعرض لمفهوم السيولة أو ما بعد الحداثة على المستوى الأخلاقي يتكون من مُقدمة وستة فصول. سنتطرق بعرض وافي لها في السطور التالية.
المقدمة
يسعى الكاتب من خلال مؤلفه هذا العثور على طرق جديدة من التفكير في أوضاع العالم الذي نعيش فيه، فهو يحاول تطوير أدواتنا الإدراكية حتى نتمكن من الإمساك بعالم يواصل التغير بشكل أسرع مما نستطيع بطرق تفكيرنا الحالية أن نتكيف معه، فيرى الكاتب أن الحاجة إلى إطار جديد يُمكنه استيعاب تجربتنا وتنظيمها بطريقة تسمح بإدراك المنطق الذي يحكم تلك التجربة أصبحت ملحة.
ويوضح الكاتب هنا الفرق بين الخريطة الإدراكية لكل من الجيل الأقدم والجيل الأحدث، تلك الخريطة التي تعكس العبور من مرحلة بناء الدولة في تاريخ الدول الحديثة أو مرحلة الحداثة الصلبة بحدودها السيادية المحصنة إلى مرحلة التعدد الثقافي والتدفق البشري عبر الحدود أو إلى الحداثة السائلة.
ويوضح الكاتب أنه لا توجد دولة لا تواجه تحدي الدمج بين السكان المحليين والوافدين، وأصبح الرهان الأكبر يدور حول الاعتراف بالآخر، حيث أن كل مدينة اليوم هي تجمع لاختلافات إثنية ودينية، مما يستدعي توترات داخلية وخارجية. هذا الأمر يتطلب وضع قواعد للتعاضد الدولي من أجل مواجهة هذا التحدي.
ويؤكد الكاتب أن مركزية المركز قد تفتتت وخرائط العالم التي رسمنا عليها الكيانات السياسية تراجعت أهميتها، وفي محاولة خاطئة للإمساك بشئون هذا العالم هناك إصرار على المحافظة على أدواتنا المفاهيمية القديمة مثل المركز والأطراف، والسلم الهرمي، والأولوية والثانوية.
ويرصد الكاتب هنا طبيعة الاستعمال المتزايد لكلمة “الشبكة” -للتعبير عن الأوضاع الاجتماعية- بدلاً من كلمات مثل الأنظمة والبنى والمجتمعات والجماعات التي كانت سائدة في مرحلة الحداثة الصلبة، فمفهوم الشبكة يعكس إدراك متزايد حول ضبابية الكليات الاجتماعية عند الأطراف، وأنها غير موجودة ولكنها في حالة تشكل. كما يرصد الكاتب أن في مجتمع “الحداثة السائلة”، تميل الحشود إلى أن تحل محل الجماعات- بما لها من قادة، وطبقات، والتقاط الأوامر- فليس للحشد مكان مُحدد، وليس له مركز؛ وتُحرِكه أهداف متغيرة ومتحركة، وتتحقق راحة الاحتشاد في الأمن الذي يوفره العدد، فالاعتقاد بأن اتجاه الفعل قد جرى اختياره بشكل مُناسب، نظراً لأن عددًا كبيرًا من الناس يسيرون بمقتضاه.
ثم ينتقل الكاتب إلى مفهوم الهوية وعملية صناعة الذات والصعوبات التي تواجه الإنسان من أجلها في عالم متغير، فالهوية هي نتاج عمليات مختلفة ومتزامنة من التفاعل الاجتماعي، والتفاعل الاجتماعي ليس عملية أحادية الاتجاه وإنما هو نتاج لتفاعل مستمر بين الحنين إلى الحرية الفردية وصناعة الذات من ناحية، والرغبة في الأمان الذي يمنحه ختم الموافقة الاجتماعية. والتوتر بين الاثنين مستمر. والتنظير حول الهويات في عالم الحداثة السائلة يستخدم كلمات مثل الاقتلاع والاجتثاث والفصل، وهي تشير إلى تحرر الفرد من مجتمع الولادة. إلا أن الجذور التي تجتث من التربة من المحتمل أن تذوي وتموت، ولذلك يفضل الكاتب استخدام مجاز “إلقاء المرساة ورفعها”، فمجاز المرساة يعبر عن تشابك الاستمرار والانقطاع في عدد متزايد من الهويات المعاصرة.
وهنا يتعرض الكاتب إلى مفهوم “تجمعات الانتماء” و”المجتمعات الدامجة”، ويرى أن مفهوم “المجتمع الدامج” مفهوم موروث من العصر الشمولي، وهو يُشير إلى المسعى المنظم لتحصين الحدود التي تفصل “الداخل” عن “الخارج”، في حين أن تجمعات الانتماء هي مرافِقة للفردانية، أي يمكن تشبيهها بسلسلة محطات في مسار الأنا. إلا أن الانتماء –في رأي الكاتب- هو أحد وجهي العملة، والوجه الآخر هو الانفصال والمعارضة الذي يتطور غالبًا إلى استياء وصراع مكشوف. فتحديد العدو عنصر أساسي للتماهي مع “كيان الانتماء”.
أما الاختلاف بين مفهومي “الانتماء” و”المجتمعات الدامجة”، يرى الكاتب أن ليس لدى مرجعيات الانتماء -على نقيض المجتمعات التقليدية الدامجة- أدوات لقياس مدى إخلاص الأعضاء؛ ولا هي معنية بمطالبة الأعضاء بولاء ثابت وإخلاص لا يتزعزع. فالانتماء إلى كيان واحد، في “النمط الحداثي السائل”، قد يُشترك فيه ويُمارس بشكل متزامن مع الانتماء إلى كيانات أخرى في أي صيغة أخرى مُمكنة، من دون أن يستدعي ذلك أي شجب أو خطوات قمعية. نتيجة لذلك فقدت الارتباطات الكثير من شِدتها.
من هنا جاء إعادة تصوير ظاهرة “الهجنة الثقافية” بوصفها فضيلة ومؤشرًا على التميز، بدلًا من أن تكون -كما كان يُنظر إليها في الماضي القريب جدًا- بوصفها رذيلة وعلامة على إما الدونية الثقافية أو هبوط طبقي خليق بالشجب. في الموازين الطارئة للتفوق الثقافي والاحترام الاجتماعي، يغلب أن يحتل المهجنون مراتب عليا حيث تصبح “هجينيته” وسيلة رئيسية للتحرك إلى الأعلى سوسيوثقافيًا. بينما يُنظر إلى التمسك بالقيم وأنماط السلوك الثابتة على أنه مؤشر على الدونية السوسيوثقافية والحرمان.
ويؤكد الكاتب في نهاية المُقدمة على عدد من النقاط منها:
- هناك درجة غير مسبوقة من التحرر من القيود، هذا النوع من التحرر أقرب إلى أن يكون توفيقًا بين “مبدأ اللذة” و”مبدأ الواقع”.
- لا شك أن العولمة أصبحت الاَن حتمية وفي مسار يستحيل عكسه. لقد تم الوصول إلى نقطة اللاعودة. إن علاقاتنا فيما بيننا واعتمادنا على بعضنا البعض صار ظاهرة عالمية. فكل ما يحدث في مكان يؤثر على حياة الناس وفرصهم في العيش في مكان اَخر. لا حدود سيادية، مهما كبرت، أو كثر سكانها، وإمكاناتها، تستطيع بمفردها أن تحمي ظروفها المعيشية، أو أمن سكانها. إذن فاعتماد بعضنا على بعض يحدث على امتداد الكرة الأرضية ولذا فنحن مسؤولون عن بعضنا البعض.
- ضرورة أن يتحلى المثقفون بالأمل، والشجاعة، والإصرار، في دراسة الأوضاع الإنسانية المتغيرة، وأن تحتل هذه المسألة أهمية كبيرة من جانبهم، فيقومون بدراسة كل التهديدات والفرص التي تُواجه إنسانيتنا المُشتركة.
الفصل الأول
أي فرصة للأخلاق في عالم استهلاكي معولم؟
يبدأ باومان هذا الفصل بتحليل التناقض الذي كان سائداً في مرحلة الحداثة الصلبة بين فردانية المرء وسعيه للحرية وحبه لذاته وبين القيود المفروضة عليه من خلال القواعد المعيارية بوصفها ضرورية ومفيدة للتجمع الإنساني.
ولكن بمجيء مجتمع الحداثة السائلة تم تدمير نظام الضبط المعياري، فتحرر السلوك الإنساني من التنميط القسري وتم تصعيد مفهوم اللذة التي لا حدود لها، فحلت الإثارة محل القسر، والإغراء محل فرض الأنماط السلوكية، وإثارة رغبات جديدة محل الضبط المعياري. وبذلك تم تحرير اللذة من ضوابط الماضي وفتحها للاستهلاك الربحي في الأسواق. فأصبح معظم الآلام الإنسانية -في عصر الاستهلاك والحداثة السائلة- صادرة عن فائض أو قلة الإمكانات المادية، بدلاً من التضاد بين المسموح والممنوع أخلاقياً، وأصبح الاكتئاب الفردي وليد رعب العجز المادي بدلاً من أن يكون وليد رعب الذنب نتيجة كسر القواعد القيمية كما كان في الحداثة الصلبة.
ويؤكد باومان أن مفهوم المسئولية الذي كان في الماضي مرتبطاً بالواجب الأخلاقي والاهتمام بالآخر، ارتبط اليوم بتحقيق الذات، فأصبح الاستثمار في الذات هو مشروع الفرد الوحيد. هنا قامت السوق الاستهلاكية بتجريد مفهوم التكاتف الاجتماعي الذي يعززه الوجود المشترك من قيمته. وإذا كان العلماء في الماضي يرون أن المجتمع بدعة اخترعت لجعل الاجتماع الإنساني المسالم ممكناً لكائنات أنانية بالولادة، فإن الحداثة السائلة جعلت من المجتمع حيلة لجعل الحياة الأنانية قابلة للتحقيق لكائنات أخلاقية بالولادة، وذلك بالحد من المسئوليات تجاه الآخرين.
من ناحية أخرى يشير الكاتب إلى أننا أصبحنا نعيش في مجتمع معولم من المستهلكين، ومن المحتم أن يؤثر السلوك الاستهلاكي على كل وجوه حياتنا، فالكل اليوم يعيش تحت ضغط أن نستهلك أكثر، وبذلك صرنا سلعًا في أسواق الاستهلاك.
ويرسم باومان هنا صورة لحياة الإنسان في المجتمع الاستهلاكي حيث يتعرض المرء لقصف متواصل من الإعلانات حتى يقتنعوا بحاجتهم الحتمية لهذه السلع المعلن عنها، ولشراء ما يظنون أنهم يحتاجونه فإنهم يعملون لساعات أطول لكسب مزيد من المال، ولكونهم بعيدين عن أسرهم لتلك الساعات الممتدة فإنهم يعوضون غيابهم هذا بهدايا ثمينة تكلف مزيد من المال، وهو ما أسماه أحد العلماء ب”تمدية الحب”، أي جعل الحب مادياً. ويضيف باومان أن هذا الانفصال العاطفي والغياب الجسدي عن المنزل يجعل أفراد الأسرة الواحدة غير قادرين على تحمل حتى الخلافات التافهة مما يحتمه العيش تحت سقف واحد. لقد أدى الانشغال بالحصول على مزيد من المال لشراء ما يُظن أنه ضروري لتحقيق السعادة إلى عدم وجود وقت للحوار والتفاهم والمشاركة والتعاطف.
إذن فسيادة المجتمع الاستهلاكي قد أدى إلى أمرين: أولهما ذبول التكافل الإنساني في المجتمعات، والثاني اضمحلال قيم التراحم والتشارك في الأسرة. فالعولمة الاستهلاكية أصبحت تحديا أخلاقياً.
كما يوضح باومان أن مع تزايد “سيولة” الأوضاع الاجتماعية، وتزايد ضِعف الروابط الإنسانية، وأجواء الحيرة، وعدم الأمان، والخوف غير الواضح الذي نعيش فيه، فقد ساد شعورًا بـ “الاستياء” تجاه الغرباء؛ وهم الناس غير المألوفين، والذي يصعب التنبؤ بما سيفعلونه، وهم تجسيدات حية لسيولة العالم. وبين الغرباء المُستاء منهم، يحتل الصدارة اليوم “اللاجئون”وأولئك المنفيون من الأجزاء الفقيرة في الأرض. إنهم يطرقون أبواب الغرب، ويهددون أمانهم وهدوئهم –وفقًا للكتاب الغربيين-.
ومهما كان الذي تعنيه “العولمة”، فإنها تُعني أننا جميعًا يعتمد بعضنا على بعض. لم تعد المسافة تعني الكثير الاَن. ما يحدث في مكان قد تكون له نتائج عولمية، ويمكن لأفعال البعض أن تتحرك على مسافات هائلة من المكان والزمان. ومهما كانت محلية مقاصدهم، سُيخطئ الفاعلون أن يلغوا من حساباتهم العوامل العولمية، لأنها قد تُقرر نجاح أو فشل تلك الأفعال. ما نفعله (أو نحجم عن فعله) قد يؤثر على أحوال الحياة (أو الموت) لأناس في أماكن لن نزورها وأجيال لن نعرفها. لقد أنتجت عملية العولمة حتى الاَن شبكة من الاعتماد المشترك التي اخترقت كل بقعة وزاوية من الكرة الأرضية.
الفصل الثاني
القتل الباتر
أو إرث القرن العشرين وكيف نتذكره
في هذا الفصل يركز الكاتب على موضوع الهولوكوست أو الإبادة الجماعية أو القتل الباتر كنماذج صارخة للفشل الأخلاقي لمرحلة الحداثة الصلبة. فإذا كان في مطلع الحقبة الحديثة، كان يُنظر إلى الطبيعة بوصفها مصدرًا رئيسيًا للشرور التي تُحيط بالحياة البشرية، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والمجاعات والأوبئة التي تضرب بدون سابق إنذار، ارتأى البعض أنه يُمكن تجنب ذلك من خلال السعي نحو “عملية التحضر”، فالدولة بوصفها حاملة للقوة السيادية” ستقوم في النهاية بالدفاع عن مواطنيها ضد قوى الطبيعة المخيفة وضد شرورها الكامنة.
لكن في أربعينيات القرن العشرين قام النازيون بحركة قتل جماعي لليهود، فيما سمي “الهولوكوست”(المحرقة) أو”جينوسايد”(إبادة جماعية). وظهر مصطلح جديد يُسمى “القتل الباتر – Categorical Murder” للإعدام الجسدي للرجال والنساء والأطفال، وهذا فقط لمجرد كونهم ينتمون إلى فئة من البشر غير صالحة للنظام المستهدف.
وفي الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية حدثت موجات جديدة من القتل الجماعي الموجه ضد جماعات إثنية، وعرقية، ودينية يمكن وصفها بأنها “هولوكوست” اَخر.
وتتميز الإبادة الجماعية عن الحروب بطبيعتها الفردية، فهي النقيض المباشر للمعركة أي للمواجهة بين قوتين، ففي الإبادة الجماعية تكون الأهداف المتوقعة للعنف محددة من طرف واحد ومحرومة من حق الرد ويتم القضاء عليها لمجرد أنهم صنفوا على أنهم كائنات ينبغي إفناؤها.
ويوضح الكاتب أن هذه النظرة وتلك الرؤية كانت في صميم النظام الجديد، ذلك النظام الذي أعطى لنفسه الحق في تقرير من يستحق أن يحيا ومن لا يستحق. فادعاء الحق بالضم أو الاستثناء من عالم الحقوق القانونية والالتزامات الأخلاقية كان جوهر السيادة للدولة الحديثة.
ووفقًا للكاتب، لقد جعلت الحداثة وإخضاع السلوك الإنساني لسيطرة العقل الأداتي الهولوكوست مُمكنًا، بينما كان الحكم الشمولي “أي السيادة المطلقة والكاملة” هو الذي نقل تلك الإمكانية إلى حيز التنفيذ. كل ذلك حدث في قلب أوروبا، التي نظرت إلى نفسها على أنها تُمثل قمة التقدم التاريخي والضوء الذي يهتدي به بقية البشر الأقل تحضرًا والأقل استعدادًا للتحضر.
ويرى الكاتب أن ثمة أمل قبل خمسين أو ستين عامًا أن تُسبب المعرفة البشعة بالهولوكوست صدمة توقظ البشرية من نُعاسها الأخلاقي وتجعل المزيد من الإبادات الجماعية مُستحيلًا. لكن لم يحدث ذلك، لقد أثبت الهولوكوست قدرته على الإغراء بالمزيد من الإبادات الجماعية للوصول إلى “حلول نهائية”.
يوضح “باومان” هنا أن القراءات المقدسة أو المبتذلة لرسالة الهولوكوست تفقد التجربة قدرتها على إفادة الجماعات الأخرى منها لتجنب من خلال إنكار قيمة الحوار والتشارك في تجارب الجماعة. فالتقديس والابتذال يفقدان التجارب قدرتها التنويرية الكامنة في خصوصيتها.
ويؤكد “باومان” في هذا الفصل أن المشكلات الإنسانية على كوكب معولم يمكن مقاربتها وحلها فقط على يد إنسانية متضامنة. وحيث لا توجد حواجز قانونية أو مؤسسية قادرة على صد الأفعال الإبادية بشكل فعال، فإن دفاعنا الوحيد ضدها –وفقًا للكاتب- سيعتمد على الرفع الأخلاقي من شأن الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وعلى الضمير الحي روحيًا، وعلى الإرادة القوية لفعل الخير. ويرى الكاتب أننا بحاجة “لمحاكمة عادلة، وحكم عادل” يعني حكم القانون؛ حكم يساوي بين الجميع، قانون لا حزبي وغير فاسد. لكن في كوكبنا السريع والفوضوي المتعولم، ليست تلك القوة واضحة إلا من خلال غيابها.
الفصل الثالث
الحرية في حقبة الحداثة السائلة
في هذا الفصل يوضح الكاتب إنه على مدى القرنين أو الثلاثة التي مضت منذ تلك القفزة الكبيرة التي سميت “مجيء العصر الحديث” أو بداية مرحلة التنوير، سار التاريخ باتجاه لم يخطط له أحد، بل لم يتمنَ أحد أن يسير فيه. حيث أن هذه المرحلة بدأت بتصميم إنساني أن يكون التاريخ تحت إدارة وسيطرة بشرية معتمدين في ذلك على العقل الذي نُظر اليه بوصفه أقوى أسلحة الإنسان. فمشروع الحداثة قائم على إحلال الحرية الفردية والجماعية محل الخضوع لتقلبات الطبيعة وأشكال القسر التي يصنعها الإنسان.
فقد كان شعار “الحرية، المساواة، الأخوة” حين أعلن لأول مرة في الثورة الفرنسية تعبيراً دقيقاً عن فلسفة حياة وإعلان نوايا. فهي مبادئ اعتُقِد أنها كل ما يحتاجه البشر للسعي نحو السعادة. ويفرد باومان هنا مساحة لمناقشات فلاسفة التنوير بشأن الحرية وعلاقتها بالسعادة في ضوء الفكرة القائلة إن “الإنسان المثالي هو ذلك الذي يجرؤ أن يفكِّر لنفسه ساحقًا تحت قدميه التعصُّب والتقاليد والمعتقدات الشعبية، باختصار أن يسحق كل ما يستعبد الروح”. وكان الاعتقاد بأنه بمجرد أن يسمع الناس تلك الدعوات إلى الحرية الروحية فإن انهيار العبودية الجسدية سيتبع. أما على الجانب السياسي فإن المواطنة والجمهورية والديمقراطية هم وسيلة الخلاص الذي كان التنوير باعثاً له.
إلا أنه في أقل من قرن وصل التقدم المستمر نحو حرية الفرد في التعبير والاختيار إلى النقطة التي شعر فيها الكثيرون أن فقدان الأمن أصبح ثمناً باهظاً للفردنة والخصوصية في البحث عن السعادة. وبدأ الطلب على الحياة الآمنة يزداد وإن كان ثمنها شيء من النقص في الحرية الشخصية. فانتقلت الصيغة للسعي نحو السعادة من “الحرية، المساواة، الأخوة” إلى “الأمن، المساواة، الشبكة”. أما بالنسبة لمبدأ المساواة فقد تغلب عليه مفهوم التوازي. ففكرة التساوي في الثروة وفي أنماط المعيشة وفي التطلعات المستقبلية توارت وحل محلها في ظل الحداثة السائلة التنوع اللامحدود وحق الإنسان في الاختلاف من دون أن يكون ذلك سبباً في حرمانه من الكرامة والاحترام. فالتوازي يعني السماح فقط بجلوس الجميع إلى الطاولة دون وجود أي قواعد للعبة. أخيراً تأتي الشبكة، فإن كانت الأخوة قد تضمنت وجوداً مسبقاً لبنية لها سلوك ومبادئ ومواقف مشتركة، فإن الشبكة تولد أثناء العمل وتظل حية فقط نتيجة للأفعال الاتصالية المتوالية.
ثم ينتقل باومان إلى مفهوم “فن الحياة” بمعنى جعل حياة الإنسان عملاً فنياً من تأليفه وعلاقة ذلك بالتحولات التي حدثت في الفنون الجميلة بتغير العصور. فيرى أنه لكي يمارس المرء فن الحياة في عالم الحداثة السائلة، يتطلب الأمر أن يكون في حالة تغير دائم، وأن يستمر في عملية إعادة تعريف للذات وأن يتوقف عن أن يكون ما كان عليه بالأمس. ويضيف باومان بأنه -وفي مجتمعنا الاستهلاكي- لن يتم إجبارك على محاكاة أسلوب العيش الذي توصي به عروض السوق، بل سيتم ذلك عبر رغبتك الشخصية، لكن لو حاولت التوقف عن تلك المحاولة أو قاطعت عروض السوق فسوف تعاقب بالطرد والنبذ خارج حلبة السباق لتصير وحيدًا في مواجهة مخاوفك الاقتصادية وشعورك بتدني مكانتك الاجتماعية.
ويختتم باومان الفصل بالتأكيد على فكرة “الكيان الاجتماعي” والذي هو أقصى أشكال التجسد الحديث لفكرة المجتمع، وهو ترتيب مؤسسي لتأمين جماعي يحول دون سقوط المجتمع في البؤس وتحوُل المرء إلى “فائض اجتماعي” محروم من الاحترام.
الفصل الرابع
حياة عجولة
تحديات الحداثة السائلة للتعليم
يتطرق الكاتب في بداية هذا الفصل لإعلان نُشر عام 2005 في مجلة أزياء واسعة الانتشار حول “ستة مظاهر أساسية” للأشهر القادمة “من شأنها أن تبقيك مواكبًا للموضة”؛ ورأى الكاتب في هذا الإعلان أنه صُمم بطريقة مُحددة ليختصر كل المخاوف التي أحدثها المجتمع الاستهلاكي، من حيث أولاً أن مواكبة الموضة التي يتبعها الآخرون المرموقون هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الاحترام والثقة بالنفس واليقين أنك على الطريق الصحيح، وهنا يكتسب المرء الانتماء، أي القبول والاندماج مع الآخرين. ثانياً إن هذا الوعد محدود الصلاحية، أي أن عليك بالإسراع، وسيلزمك التجديد بعد انقضاء الأشهر المعلن عنها. هذا يعني أن هناك اختيار بين ستة نماذج إلا أن الاختيار إلزامي، كما أن القيود المفروضة على خياراتك ليست قابلة للنقاش.
ويرى الكاتب أن المبدأ الأخلاقي للحياة الاستهلاكية هو “وهمية الشعور بالإشباع”. ويتم ذلك من خلال الحط من حاجات الأمس والسخرية منها وتقبيحها بدلاً من خلق حاجات جديدة. ويعتبر هؤلاء الذين يشترون فقط ما يحتاجونه يُعدون “مستهلكين ناقصين”، وبالتالي فهم “منبوذون اجتماعيًا” كما أشار “تالكوت بارسونز”.
ورأى الكاتب أن سر كل نظام اجتماعي ناجح يكمن في تحويل “الشروط الوظيفية” إلى دوافع سلوكية للأفراد. وقد يحدث هذا بوضوح عبر حشد الدعم العام أو من خلال عملية مُفعمة بمؤثرات مُختلفة مثل “التعبئة الروحية”، “التثقيف المدني”، و”التلقين الإيديولوجي”، كما كان عليه الأمر في المرحلة الصلبة من الحداثة في المجتمع الإنتاجي، حيث تم الإعلاء من شأن الإشباع المؤجل على الحساب الإشباع الفوري، وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد من خلال تقديم حاجات الكل على حاجات أفراده وتقديم سعادة الأغلبية على سعادة الأقلية.
وقد ذهب فرويد إلى أن الحضارة تصان عبر القمع، لأن الحضارات تعني القيود، والقيود كلها بغيضة، إن إحلال سلطة المجتمع محل سلطة الفرد تشكل خطوة حاسمة للحضارة. وقد قام علماء الاجتماع بابتكار منهج جديد للتحضر، ليكون وسيلة بديلة لاستمرار نظام السيطرة المسمى بالنظام الاجتماعي مع تحقيق قدر كبير من الحرية للأفراد ويكون أقل إثارة للنزاع نسبياً. هذا النمط الجديد من التحضر صوَر الإلزام بالاختيار على أنه حرية الاختيار، وأحل مهرجانات من الوحدة والانتماء الجماهيري محل الشمولية، مما يكون أكثر إمتاعاً وإبهاجاً. فلم يعد الخضوع للشمولية واجباً معتنقاً بالإكراه وشاقاً ومزعجاً، بل تحولت إلى تسلية جماعية ممتعة.
وهنا يخلص أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية “توماس هيلاند إريكسن” إلى أن “طغيان اللحظة” هي (السمة الأكثر بروزًا للمجتمع المعاصر وبدعته الأكثر ابتكارًا) ويزعم إن عواقب العجلة المُفرطة ساحقة، إذ يخضع كل من الماضي والمستقبل إلى طغيان اللحظة، وحتى “الحاضر” مُهدد لأن اللحظة القادمة تحل بسرعة جدًا بحيث يصعب العيش في الحاضر، وهذا منبع لا ينضب من التوتر. وبالتالي فإنسان ما بعد الحداثة هو إنسان تزامني يعيش في الحاضر فقط، ولا يلقي بالاً لتجارب الماضي، ولا النتائج المستقبلية لها.
بعد ذلك تطرق الكاتب في الفصل ذاته لـ “وفرة المعلومات”، فرأى أن خلال السنوات الثلاثين الماضية تم انتاج معلومات تفوق ما أنتج خلال ال 5000 سنة الماضية، فأصبحت “المهارة الأساسية في مجتمع المعلومات تنطوي على حماية النفس من 99.99% من المعلومات المعروضة والتي لا يرغب بها المرء”. وأصبح هناك شلالاً عشوائياً من المعلومات لا سياق له بحيث أصبحت الجزئيات هي المهيمنة.
ويرى الكاتب أن القيمة الأكثر خصوصية للمجتمع الاستهلاكي هي “الحياة السعيدة”، فربما يكون مُجتمعنا الاستهلاكي هو المجتمع الوحيد في تاريخ البشرية الذي يعد بالسعادة في الحياة الدنيوية أي بسعادة دائمة وغير مؤجلة. ويُنظر إلى الإجابة على سؤال: هل أنت سعيد؟ على أنها الاختبار النهائي لنجاح أو فشل المجتمع الاستهلاكي. وتوصلت الدراسات إلى أن الشعور بالسعادة يتعاظم مع ازدياد الدخل حتى درجة معينة، وفوق هذه الدرجة التي تحقق الحاجات الأساسية أو الطبيعية يتلاشى التلازم بين الثروة والسعادة. هنا يتضح فشل الاستهلاك كنشاط غائي ومصدر للسعادة.
ثم تطرق الكاتب لمعنى الوقت في زمن الحداثة السائلة، وهنا تطرق لمصطلحي “الثقافة اللحظية” و”الثقافة العجولة”. ويرى الكاتب أن الوقت في عصر المجتمع الاستهلاكي ليس دورياً ولا خطياً كما كان في المجتمعات السابقة ولكنه “نقطي” مفتت إلى مجموعة من الأجزاء المنفصلة. ويمكن أن تعاش كل نقطة باعتبارها بداية جديدة، قد تكون بداية مهدرة أو خيالية أو زائفة. ولهذا تميل الحياة اللحظية أن تصبح حياة عجولة لاقتناص الفرص قبل ضياعها.
ويقول الكاتب إذا كانت الحياة ما قبل الحداثة هي تمرين يومي على الخلود النهائي، فإن الحياة في الحداثة السائلة هي تمرين يومي على الفناء الكوني حيث لا شيء في ذلك العالم مُلزم بالدوام. فالرغبات التي تعتبر اليوم مفيدة وضرورية تصبح تاريخًا قبل أن تستقر لفترة كافية لتتحول إلى عادة وحاجة، فلا شيء يبدو غير قابل للاستبدال، فكل شيء يولد موسومًا بالموت الوشيك، ويخرج من خط الإنتاج مصحوبًا بتاريخ صلاحية مطبوع أو مفترض.
ووفقًا للكاتب فإن فرط السيولة أدى إلى هشاشة حضارية، فنحن في حضارة الإسراف والحشو والتبذير وتصريف المخلفات. ويرى الكاتب أن الثقافة في الحداثة السائلة لم تعد تبدو كثقافة تعلم وتراكم، كما كانت في الماضي، ولكنها تبدو اليوم كثقافة انسلاخ وانقطاع ونسيان، “ثقافة نادي القمار” كما أطلق عليها أحد العلماء.
وفي نهاية الفصل ينتقد الكاتب بُعد وانصراف الناس عن السياسة، وفقدان الاهتمام بالعملية السياسية، وفي هذا السياق، أوضح الكاتب أن حريات المواطنين ليست ممتلكات يحوزونها مرة واحدة للأبد، بل إنها تُغرس وتترسخ في التربة الاجتماعية والسياسية، التي تحتاج تخصيبًا وسقاية يوميًا، والتي ستجف وتتفتت ما لم تراقب يومًيا.
الفصل الخامس
بين الرمضاء والنار
أو الفنون بين الإدارة والأسواق
يتناول “باومان” في بداية هذا الفصل مفهوم “الثقافة” قائلًا أن مصطلح الثقافة قد دخل اللغة باعتباره اسماً لنشاط هادف، وبات يعني في استخدامه الشائع، الطريقة التي يختلف بها نوع من السلوك البشري “المُنظم بمعايير” عن نوع اَخر تحت رؤية مُختلفة. وظهر مفهوم “الثقافة” في اللغة بعد مفهوم حديث مهم اَخر بأقل من قرن، وهو مفهوم “الإدارة” الذي يعني تسيير الأمور بطريقة لم يكن لها أن تسير دونها، وإعادة توجيه الأحداث بحسب رغبة المرء وتخطيطه.
ويرى الكاتب أن الثقافة “معارِضة للإدارة”، وأن الصراع بينهما حتمي. لكنه يشير إلى أن الخصوم يحتاجون بعضهم بعضاً، فالفنون تحتاج الإدارة لأن مهمتها لا يمكن أن تنجز من دونها.
وتعد الفنون الوحدات الأولية للثقافة، ووفقًا للبعض فإن “الفن ليس محاولة للهروب من الواقع لكنه محاولة لإحيائه”. لا يعتبر الاستهلاك السريع والذوبان في عملية الاستهلاك الآني غاية المنتجات الثقافية ولا معيار لقيمتها. فقد كان المفهوم الكلاسيكي للثقافة الذي تزامن رواجه مع مرحلة الحداثة الصلبة هو أنه أداة فاعلة في “الحفاظ على النمط”، وتحقيق حلم الإدارة في مقاومة التغيير من خلال إخضاع الفنانين للقوانين والمعايير التي أرسوها، وبالتالي يقصون أجنحة الخيال الفني ويعارضون المبادئ التي تقود إبداع الفنانين.
أما في حقبة الحداثة السائلة، حقبة سلمت نفسها لزوبعة الوجود الاستهلاكي، فقد تم إخضاع الإبداع الثقافي لمعايير السوق الاستهلاكية، حيث أصبحت شهرة الفنان تساوي شهرة “العلامة التجارية”، وأصبح للمبدع تاريخ إنتاج وصلاحية، ما ينذر بولادة ونشوء “ثقافة النبذ أو الهدر” الدائر عبثها المدمر في عصر الحداثة السائلة، على عكس الحقبة السابقة من الحداثة الصلبة التي كانت تحيا بحثًا عن “الخلود”. فالحداثة السائلة لا تضع لنفسها هدفًا ولا ترسم خطًا للنهاية، وبعبارة أدق، إنها تُحدد جودة الاستمرار وفقًا لسرعة الزوال فقط.
ويتعرض الكاتب في آخر هذا الفصل إلى معنى الجمال بين مرحلتي الحداثة الصلبة والحداثة السائلة، فإذا كان الجمال يعتبر أحد التصورات التي وجهت الفنانين إلى ما وراء العالم القائم، وكانت قيمته متضمنة في سلطته الهادية، فإن الجمال في مجتمع الحداثة السائلة قد واجه المصير الذي لاقته كل المُثل الأخرى، فالمهم أن يكون مناسباً للاستهلاك الحالي السريع، ففقد العلاقة بينه وبين الخلود، وتموضع الجمال في الموضة الحالية، وبالتالي فإن الجميل ملزم بالتحول إلى قبيح في اللحظة التي تحل فيها الموضة الجديدة.
الفصل السادس
جعل الكوكب مضيافًا لأوروبا
ينهي باومان كتابه بمحاولة وضع رؤية تنظيرية للعلاقات الإنسانية على هذا الكوكب. إذ تطرق لفكرة “إيمانويل كانط” حول مفهوم “المواطنة العالمية” والتعايش السلمي بين البشر، حيث يصبح الاتحاد بين البشر على طريقة المواطنة هو المحطة التي اختارتها الطبيعة وظروف الكون لنا. وبالتالي سننظر إلى “الضيافة” على أنها المفهوم الأعظم الذي علينا جميعًا بدرجة متساوية أن نتبناه. فإذا كانت الأخلاقيات من نتاج العقل، كما أرادها كانط أن تكون، فإن الضيافة هي -لابد أن تكون أو يجب أن تكون عاجلًا أو اَجلًا- القاعدة الأولى في سلوك الإنسان. كذلك يري “هايدجر” أن الضيافة هي فريضة كونية، ورغم غيابها فهي كانت “دائماً هناك”.
ورغم أن العديد من المؤلفين لم يلقى بالًا حينها لأفكار كانط حول الضيافة، والمواطنة العالمية، لكن تحديات المرحلة الحالية فرضت على كثير من الدراسات أن تقتبس من كتاب كانط.
ثم تطرق الكاتب لهيمنة أوروبا التي سادت العالم على مدى القرون الخمسة الماضية، وكانت هيمنة أوروبا العسكرية والاقتصادية قوية لدرجة جعلها هي المرجعية لأي تقييم. وكان يكفي أن تكون أوروبيًا لكي تحظى بمعاملة مميزة ويتم وضعك في أعلى منزلة في أي مكان خارج أوروبا. غير أن ذلك لم يعد قائمًا الآن، بل يتسم العصر الحالي بالوعي المتزايد بالذات، ولم تعد الشعوب تُظهر تعبدًا لأوروبا، ولكنهم الآن يظهرون إحساسًا متناميًا بقيمتهم الذاتية وطموحهم للحصول على مكانة بارزة في عالم يتجه إلى تعددية في المراكز والثقافات.
كما تؤكد باومان أن حتى وقت قريب كانت أوروبا هي المركز وباقي العالم هامشاً، وكان المرء يعرف أوروبا بناءً على “مهمتها العولمية”. وقد جعلت أوروبا من البلاد الأخرى أسواقًا لتصريف منتجاتها، ومصدراً للعمالة غير المكلفة والمطيعة، وللطاقة والمعادن الرخيصة. لكن الكاتب يرى أن كل ذلك انتهى الآن، فقد انتهت الحلول العالمية للمشاكل الأوروبية المحلية. ومن هنا جاء فقدان أوروبا المفاجئ لثقتها بنفسها، وسعيها للبحث عن “هوية أوروبية جديدة” وفي “إعادة تحديد دور” أوروبا في اللعبة الكوكبية التي تغيرت فيها القواعد والمصالح على نحو جذري وما تزال تتغير بتأثير أوروبي محدود، إن كان لها أي تأثير.
لقد صار من الشائع إلقاء اللوم لفقدان أوروبا لهيمنتها الاقتصادية والعسكرية على النهوض المذهل للولايات المتحدة واحتلالها موقع القوة العظمى الوحيدة عالميًا ومركز الإمبراطورية العالمية، فكل الطرق الاَن تؤدي إلى واشنطن.
ثم يناقش الكاتب مسألة كون الولايات المتحدة الأمريكية هي إمبراطورية العالم، والتطورات السياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي وظهور الإرهاب ومحاربته، ويرى باومان بأن التبعات المأسوية التي يعاني منها العالم تتحمَّلها الولايات المتحدة الأميركية نتيجة سياساتها التي تعتمد القوة العنيفة لا العلاقات الإنسانية، ولذلك يدعو باومان إلى جعل “الكوكب مضيافًا لقيم وأساليب أخرى من الوجود أكثر من تلك التي تمثلها القوة العسكرية الأميركية العظمى وتروِّج لها”.
ويرى الكاتب أن أوروبا الآن تتبع منطقان متكاملان (وربما متناقضان) في التعامل مع الأزمة العالمية، وهما منطق التحصين المحلي، ومنطق المسئولية العالمية التي تتطلب إعادة تشكيل شبكة الاعتماد المتبادل والتفاعل المشترك. . ويقول باومان أن مهمة أوروبا الوحيدة الآن لاستعادة مكانتها من جديد؛ هي مهمة روحية وثقافية لنشر الأخلاق والقيم والمبادئ التي اكتسبتها واختبرتها على مدار تاريخها الحديث عبر العالم.
عرض:
أ. أحمد محمد علي*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ماجستير في العلوم السياسية. جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies