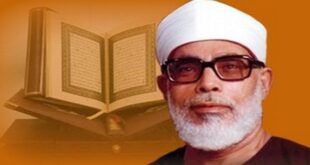مراد هوفمان
رحلة البحث عن معنى الحياة
د. فاطمة حافظ*
مراد هوفمان Murad Hofmann (1931-2020) دبلوماسي ألماني اهتدى للإسلام في مطلع الثمانينات من القرن الماضي -بعد أن أمضى خمسين عاماً من عمره كاثوليكياً- في ختام رحلة بحث مضنية عن المعنى والمغزى من وراء الحياة. تقلد عدة مناصب منها سفيراً لبلاده في الجزائر ثم المغرب، كما عمل خبيراً نووياً في حلف الأطلنطي. ومنذ اعتزاله العمل الدبلوماسي في منتصف التسعينات تجول هوفمان كمحاضر في الندوات التي تعقد حول الإسلام في الشرق أو الغرب. ترجمت بعض أعماله إلى اللغة العربية ومن أهمها يوميات ألماني مسلم، الإسلام كبديل، الإسلام في الألفية الثالثة…. وأخيراً خواء الذات والأدمغة المستعمرة. وهي كتابات حاولت أن تبرهن بكفاءة على تميز الأفكار الإسلامية مقارنة بأفكار الحداثة وما بعد الحداثة. والمتتبع لهذه الكتابات يجدها تركزت حول ثلاثة موضوعات رئيسية وهي:
أ. نقد الحداثة وما بعد الحداثة، والكشف عن زيف ادعاءاتها الرئيسية لاسيما قدرة العلم أن يكون بديلاً للإيمان، وأن باستطاعته تقديم إجابات شافية على الأسئلة الأنطولوجية الكبرى التي يواجهها الإنسان.
ب. التعريف بالإسلام ومحاولة تقديمه للغرب باعتباره ديناً متجدداً، وذلك بالكشف عما هو جوهري وأصيل به كالقيم الإنسانية وما هو عرضي مؤقت وموروث ثقافي ويمثل تجربة تاريخية سابقة.
ج. التجربة الإيمانية كما يعايشها منذ أعلن اعتناقه الإسلام، ورؤاه الذاتية للحياة في ظل الإسلام.
يشكل هوفمان حلقة من سلسلة المفكرين الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام في القرن الماضي وبذلت مساعيها في أن تجد للأفكار الإسلامية موطئ قدم في العالم الغربي وذلك ضمن الأطر والمنطلقات الفكرية الغربية، وخارج الأطر التقليدية الشرقية. وتركزت هذه المساعي حول إبراز الإنسانية الإسلامية ومقارنة موقع الإنسان في كل من الرؤية الغربية والإسلامية. وقد تأثر هوفمان باجتهادات رينيه جينو وجيفري لانج ومحمد أسد، والأخير تركت آراؤه بصمات فكرية واضحة على هوفمان. ومن الواضح أيضاً أنه تأثر كذلك بالمدرسة الفكرية الألمانية التي تبنت نقد الأفكار الغربية وتزعمها اشبنجلر، ومؤلفاته النقدية للحضارة الغربية مع تنوع معارفه يوحيان بذلك.
ويتصف هوفمان بأنه صاحب رؤية معرفية اجتهادية، وحصيلته المعرفية تتسم بثراء وتنوع شديدين؛ فمعجمه الثقافي يتألف من مفردات تنتمي لحضارتين مختلفتين اجتهد في دمجهما معاً داخل منظومة واحدة لم يتم فيها إقصاء وتهميش إحدى الحضارتين لصالح الحضارة الأخرى. ويبدو ذلك في استيعابه التام لأحدث النظريات العلمية الحديثة وفلسفات ما بعد الحداثة، وأيضاً تمكنه من قراءة وفهم التراث الفقهي والفلسفي الإسلامي مما مكنه من تكوين رؤى محددة في مسائل بالغة الدقة من الناحية الفقهية. ولا يدهش المرء حين يجد هوفمان يعرض بالتحليل والنقد لآراء أعلام الفلسفة الغربية هايدجر وماكس فيبر ويتجنشتاين ثم يعقبها بآراء ابن رشد وأبي حامد الغزالي، الذي يكن له هوفمان تقديراً واحتراماً بالغين ويعلن انحيازه لكثير من آرائه الفلسفية، وهذا ما يجعل من كتاباته عملاً فكرياً راقياً ومتميزاً وسياحة فكرية يتمتع فيها القارئ بالتنقل بين ثقافتين مختلفتين.
ويلجأ هوفمان لاستخدام آلية المقارنة بشكل موسع، فهو يعرض للمتقابلات والمتضادات المختلفة كالشيوعية والرأسمالية وغيرها عرضاً عاماً يرتكز بالأساس على ما يذكره مؤيدوها ثم يتناول انتقادات معارضوها، وهو بذلك يقوض هذه النظريات من الداخل بعرضه لتناقضاتها الداخلية وانتقادات مخالفيها ثم يتعرض لها بالنقد. وهذه المنهاجية تجنبه مغبة الانزلاق والتسرع في إصدار أحكام تقييمية مباشرة ويسمح للقارئ بمساحة ليشاركه في نقد وتقييم هذه النظريات.
وينتمي هوفمان إلى ذلك النوع المتفاءل الذي لا يرى في الكوب نصفه الفارغ فقط، لذا يرى أنه على الرغم من سيادة وسيطرة نزعات ونظريات فلسفية إلحادية على العالم في القرن الماضي إلا أنه كانت هناك اتجاهات فلسفية لا أدرية اعترفت باحتمال وجود إله، وأنه من الممكن أن يتعزز هذا الاتجاه في المستقبل. ويذهب تفاؤله إلى مداه بإعلانه أن المستقبل بالنسبة للإسلام سيكون في الغرب مع تهاوي فلسفات ما بعد الحداثة.
وفي مؤلفاته لا يسلك منهاجية الفصل بين العام والخاص؛ فهوفمان الإنسان يطل علينا من وراء كتاباته حين يتحدث عن زواجه ومرضه وطعامه المفضل في مسعى لتأكيد حضور الإنسان وعدم اختفاءه، بل إنه يعترف بأن رؤاه وآراءه وأفكاره لم تتشكل نتيجة اطلاعاته وقراءته فحسب وإنما هي أيضاً محصلة خبرات وتجارب حياتية تركت بصماتها واضحة على آلية تفكيره ومعاييره في الحكم على الأشياء.
اكتشاف الآخر
في عام 1980 حاول هوفمان أن يضع على الورق بطريقة منهجية تتوخى قدراً من التحديد والإيجاز جملة الحقائق الفلسفية التي يعتقد بإمكانية إثباتها دون أن يتطرق إليها أي شك منطقي، وانتهى إلى أن الموقف النموذجي لمعتنق اللاأدرية -التي كان ينتمي إليها- يعوزه الذكاء، وأن ليس بوسع الإنسان الفرار من الاعتراف بوجود خالق ومنظم لهذا الكون ثم الاستسلام والانصياع له، وعندئذ فقط يصبح الإنسان على انسجام مع الحقيقة الكلية، وكم كانت دهشة هوفمان حين عرض هذا المخطوط المؤلف من اثني عشرة صفحة على أحد الناشرين في ألمانيا والذي بادره عقب انتهاءه من قراءته بقوله: “إذا كنت مؤمناً بما ورد فيه فأنت مسلم” وفي هذه اللحظة أيقن هوفمان أنه أصبح مسلماً في تفكيره ووجدانه ولم يتبق له سوى إشهار إسلامه.
تعرف هوفمان على الإسلام للمرة الأولى كمنظومة قيمية ورؤية كلية للوجود في الجزائر، التي يبدو أن قدرها كان التعريف بالإسلام لهؤلاء المتشككين في عالمية النموذج الغربي وصلاحيته للعالم أجمع والباحثين عن رؤى إنسانية بديلة، فمن قبل تعرف جارودي فوق أراضيها على المضمون الإنساني والأخلاقي للمنظومة الإسلامية من خلال مشاركته في مناهضة الوجود الفرنسي بالجزائر، أما هوفمان فقد شاء قدره أن يعمل ممثلاً للقنصلية الألمانية بالجزائر خلال عامي 1961، 1962 وهي الفترة التي شهدت ذروة نضال الشعب الجزائري ضد القوات الفرنسية، وتشكيلات المستوطنين المسلحة التي عرفت باسم “منظمة الجيش السري”، التي ارتكبت أبشع الجرائم ضد المدنيين العزل الأمر الذي جعل الهيومانية الغربية تتهاوى أمام ناظريه. وقد وقف هوفمان شاهد عيان على ذلك حين طلب منه أحد الفرنسيين -باعتباره غربي مثله يشاركه الرؤية العنصرية ضد العرب- أن يدهس أحد العرب بسيارته، ولما امتنع عن ذلك أقدم الفرنسي على قتل العربي بدم بارد ثم سار بتؤدة وعلى مهل في شوارع الجزائر.
وإذا كان هوفمان فقد إيمانه بالهيومانية الغربية في الجزائر فإنه سرعان ما اكتشف هيومانية أكثر إشراقاً مثلها الشعب الجزائري ومجاهديه، وعن ذكريات هذه الأيام المحزنة التي لا تزال تثير الكآبة في نفسه حتى الآن كتب هوفمان “شكلت تلك الوقائع خلفية أول احتكاك لي عن قرب بالإسلام المعاش. لقد لاحظت مدى تحمل الجزائريين لآلامهم، والتزامهم الشديد في رمضان، ويقينهم بأنهم سوف ينتصرون، وسلوكهم الإنساني وسط ما يعانون من آلام. ولقد أدركت إنسانيتهم في أصدق صورها حينما تعرضت زوجتي للإجهاض تحت تأثير الأحداث الجارية آنذاك”[1]. ويستطرد هوفمان بأن زوجته التي كانت تعاني آلام المخاض كادت تفقد حياتها بفضل إرهاب منظمة الجيش السري حين قامت باستبدال الأسماء العربية للحي الذي كان يقطنه بأخرى لاتينية مثيرة لاستفزاز العرب مما أعاق وصول سيارة الإسعاف إليها، فاضطر لاستئجار سيارة يقودها سائق جزائري، ومع تعذر الوصول للمستشفى بسبب الحواجز الفرنسية ساءت حالة الزوجة كثيراً ودون تردد عرض السائق أن يتبرع ببعض من دمه الذي هو من نفس فصيلتها إنقاذاً لحياتها. وهو ما دفعه للبحث جدياً عن منطلقات ومحددات السلوك لدى الجزائريين ولم يجد أفضل من قراءة ترجمات القرآن لتعطيه تفسيراً مقبولاً لها.
وفي اسطنبول التي زارها فيما بعد تأكد هوفمان من وجود صلات بين الإسلام وبين الأسس والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وحسب وصفه لها فهي مدينة دافئة حتى وإن انخفضت درجة حرارتها إلى ما دون الصفر بفضل سكانها الذين يشعون دفئاً إنسانياً بالغاً، مقارنة بما وصفه بالبرودة والقشعريرة التي تنتابه في ألمانيا -وإن كان الطقس صيفاً- جراء برودة العلاقات الإنسانية؛ ففي اسطنبول يلقى المرء الآخر إما بحب وإما بعداء ولكن ليس بأدب جم فقط يعبر عن حيدة باردة ولامبالاة ظاهرة، ولا يكتشف الناس وفاة أحدهم من خلال الرائحة المنبعثة من شقته، فالناس يخالطون بعضهم بعضاً ولا ينعزلون. وأكثر ما استرعى دهشة هوفمان أن تلك الإنسانية تمتد إلى مجالات التجارة والمنافسة، فليس من المستغرب أن يثني أحد التجار على بضاعة جاره المنافس له، وإذا تعثر أحدهم في البازار مد له الجميع يد المساعدة، وهو ما دفعه للتساؤل عن الفارق بين هذا السلوك الإنساني، والمنهج الأمريكي الذي يبيح بلوغ المنافسة حد العنف أو القتل. وكم كانت دهشة هوفمان حين أعاد له سائق سيارة أجرة مبلغاً من المال الذي دفعه والذي كان يشير إليه العداد لاعتقاده أن العداد لا يعمل بصورة سليمة. وهو ما يشير إلى سطوة مجموعة من القيم وتحكمها في السلوكيات الإنسانية وسيطرتها على الرغبات الإنسانية غير المشروعة.
التجربة الإنسانية التي عايشها هوفمان في العالم الإسلامي، والتي مثلت أحد الدروب التي قادته للإسلام، أوقفته على مدى ضمور المنظومة الإنسانية في الغرب، حيث يتم عزل أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم البعض فيودع الأجداد في دور لرعاية المسنين، أما الأحفاد فيتم إيداعهم في دور رعاية الأطفال، وتعتقد الأمهات أن بإمكانهن الاستغناء كلية عن الأب، فكلٌ يحاول أن ينسج خيوطاً حول ذاته التي لا تمس. وقد لخص هوفمان الفارق الجوهري بين موقع العلاقات الإنسانية في الرؤيتين الإسلامية والغربية قائلاً: بينما تعني كلمة تركي جمعاً من الناس يعيش الفرد بينهم، تعني كلمة ألماني فرداً يعيش وحيداً في عزلة من الناس. ويرجع هوفمان هذه الانعزالية والانكفاء على الذات إلى النظام الصارم الذي تمارسه الدولة المركزية في الغرب، والذي يحاول أن يفرض سيطرته على كل شيء تقريباً “كل شيء يسير بالكاد في صمت على نحو نزيه وفعال في المجالات كافة…. فنحن دولة يخضع فيها كل شيء للنظام حتى تصنيف المخلفات. وفي هذا المجتمع المبرمج الخاضع لنظام روتيني يتسم بالرتابة ومن ثم بالملل الشديد لن يجد المرء سوى عنصر واحد لا يخضع لسيطرة وتحكم كاملين، ومن ثم فإنه يمثل مصدر إزعاج، هذا العنصر هو الإنسان الذي لابد من أن يقمع، ومن أن تتوفر إمكانيات للاستغناء عنه، عن طريق ميكنة كل شيء وإخضاع كل شيء للتحكم الآلي عن طريق الكومبيوتر، ولذلك فالويل كل الويل لمن يتورط من الأفراد المزعجين في خلاف مع الإدارة أو الشرطة أو القانون… إن خلاف الأفراد مع النظام يتحول في الغالب إلى شكل من أشكال الصراع التي يحفل بها أدب كافكا؛ فالظروف المخففة للعقوبات ليست بديلاً للقلوب المتحجرة”[2].
واستناداً إلى هذه الرؤية يبدو هوفمان متشككاً من الأنشطة الإنسانية في الغرب، فينظر إليها باعتبارها ثرثرة خالية من المضمون المقصود منها التخفيف عن الضمير الأوروبي المعذب، الذي يرهقه ما ارتكبه في حق الشعوب الأخرى وفي حق الإنسان الأوروبي ذاته.
وعلى وجه الإجمال يرجع هوفمان الفارق الأساسي بين الشرق والغرب إلى الاختلاف بين الكمية والكيفية، فالغرب لا يستطيع تقدير قيمة أي شيء ما لم يعبر عن نفسه في أرقام، فالقيم الروحية والخلقية لا يمكن تسويقها في الغرب لأنها بلا قيمة مادية، وفي هذا الإطار فإن اهتمام الإنسان الأوروبي يدور حول ما يملكه أو ما باستطاعته تملكه، أما الإنسان الشرقي فيهتم بالوجود في حد ذاته، وحسبما يرى فإن من يعيش في الشرق يكتشف جوهراً ومعنى للحياة ويبدو هذا في السلوكيات السائدة كالتعاون والمحبة بين الأفراد، والهدوء والطمأنينة كأسلوب للحياة.
الإنسان بين رؤيتين
من الطبيعي أن تحتل التساؤلات المتعلقة بالظاهرة الإنسانية ومن هو الإنسان وغاية الوجود الإنساني والعلاقة مع المتسامي حيزاً هاماً في فكر هوفمان، صاحب القلق الوجودي الذي ارتحل من الكاثوليكية إلى الإسلام تحت تأثير هذا القلق. وفي تعريفه للإنسان المستمد من الرؤية الكلية التوحيدية يذكر أن الإنسان مخلوق لله تعالى، مثل غيره من المخلوقات، غير أنه يتمايز عنها بأنه ذو وعي ذاتي ووعي بالإله” وأنه صاحب “مسئولية ذاتية مع توجه إلى مآل متسام”. وهذه الأمانة الملقاة على عاتقه والتوجه إلى المتسامي هو ما يجعله في منزلة أقرب إلى الله، وأرقى من عوالم الحيوانات والكائنات الأخرى[3].
وإذا ما دققنا النظر في هذا التعريف وجدنا أن هوفمان قد عرَف الإنسان تعريفاً ثنائياً مركباً ذا بُعدين، مادي وروحي، فهو يقر بأنه جزء من الطبيعة، مثل غيره من المخلوقات، ولكنه لا يتساوى معها، إذ يتطلع “بوعيه الذاتي” وبفطرته نحو ذلك الإله “المتسامي” خالق الطبيعة والمفارق لها وبفعل الخلق فهو يحمل قبساً من ذلك النور الإلهي “الغيبي”.
ويقارن هوفمان في عبارة مكثفة تثير الإعجاب غاية الوجود الإنساني بين الرؤية الإسلامية وما عداها من رؤى إلحادية بأنها (معرفة الله، وتوجيه الحمد إليه، والانقياد لهديه، الرؤية الإسلامية لا ترى أن الإنسان قد “القي” به إلى الوجود بشكل تراجيدي –كما ذهب هايدجر- أو أنه قد ضل طريقه داخل القنوط الوجودي- كما ذهب سارتر- ولا تراه على أنه حيوان ذو ذكاء تتحكم فيه أدنى غرائزه –كما ذهب فرويد- أو شهوة سطوة القتل –كما ذهب نيتشه- إنه بدلاً من ذلك خليفة عن خالقه، تتفجر منه العزة والأمل في الحياة الآخرة. ربما يكون قد ألقى به داخل هذه الحياة لكن لأجل قريب في طريق العودة إلى بيته إلى جوار خالقه)3. ووفقاً لهذه الرؤية الممتلئة بالفاعلية والحيوية فإن الإنسان ليس كائناً عبثياً لا هدف له وليس بإمكانه أن يخضع لأي توجيه أو معايير متجاوزة، كما تزعم الرؤية العدمية الغربية، وإنما هو مخلوق لله يتمتع بقدر كبير من الفاعلية والحركية بوصفه “خليفة لله” ونائباً عنه في الأرض، لذا فعلاقته بالطبيعة لا يمكن وصفها بالعداء أو الاستعلاء فهو ليس مالك الطبيعة وإنما خليفة عليها فحسب. وبما أن الحياة ليست محطة نهائية وأنه سيؤول في خاتمة المطاف إلى خالقه فإن هذا يسمح للإنسان بأن يكف عن النظر للحياة على أنها حلبة للصراع، ويتحلى ببعض الأخلاقيات المتجاوزة ويجفف منابع التوجه نحو اللذة.
ولا يستقيم أي تعريف للإنسان ويستكمل إلا إذا تطرق لموقع الإنسان داخل المنظومة المعرفية، وإذا كانت الرؤية التوحيدية، كما يؤمن بها هوفمان، قد منحت الإنسان فاعلية منضبطة داخل أطر وضوابط محددة بحسبانه خليفة لله، فإن الرؤية الغربية قد تطرفت وبالغت في تقدير فاعلية الإنسان بحيث تضاءلت وتهمشت إلى جوارها فاعلية الإله، الأمر الذي أدى إلى زحزحة الإله –بل والإطاحة به- من على قمة المنظومة المعرفية ليحتل الإنسان محله. وعبر هوفمان عن ذلك بقوله “لقد احتل الإنسان الفرد مكانة الله بحسبان أنه مقياس ومعيار كل شيء. لقد تمادى الإنسان في تقدير ذاته حتى أصبح الوثن الجديد لهذا العصر”[4].
إقصاء الإله وما تبعه من تأليه الإنسان لم يتم دفعة واحدة وإنما على مراحل ظهرت مع بزوغ عصر الاستنارة، وتم التعبير عنها في البداية على هيئة مواقف لا أدرية، تفتقر للذكاء حسب وصف هوفمان، لا تنفي وجود الإله بصورة كاملة وإنما اكتفت بالإعلان عن عدم تيقنها من وجوده. واللاأدرية ليست هي افتقار البرهان والدليل على وجود الله فحسب بل هي موقف براجماتي يُخضع الإيمان لمعايير المكسب والخسارة حسب فرضية باسكال “إذا ما أخذ المرء بمبدأ الإيمان بالله فإذا تبين أن ذلك حق فاز حينئذ بكل شيء، وإذا تبين خلافه فلن يخسر شيئا”… ويرى هوفمان أن حسابات المكسب والخسارة هيأت السبيل أمام تأليه الإنسان “ففي اللحظة التي أصبح فيها الله مجرد إسقاط لرغبات البشر، أصبح المجال مهيأ لتأليه الإنسان في صوره المختلفة، سواء كان ذلك بتأليه الجماعة في الدولة (الماركسية، الاشتراكية، الفاشية) أو تأليه الفرد (الفردية، الليبرالية، الرأسمالية، النزعة النفسية)”[5]. وبناء على ذلك توصل هوفمان أن عاقبة عدم الإيمان لا تعني أن لا يؤمن الإنسان بشيء، إذ ليس بمقدوره فعل ذلك حتى ولو أراد، بل يقيناً سيصبح الإنسان عرضة للإيمان بأي شيء، وهو ما يفتح المجال أمام آلهة دنيئة وشريرة كالمال واللذة والجنس والقوة لتحتل مكان الإله الغيبي. كما سمح بظهور فلسفات وحدة الوجود والحلولية التي فتحت الباب أمام أن يكون الله شخصاً أو لا يكون كذلك.
هكذا تم الانصراف عن الإيمان بالإله الاستشرافي (الغيبي) واتجه التقديس نحو الإله الذي حل في الطبيعة أو الإنسان بصور متعددة. وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى سيادة وذيوع الإلحاد الذي بشر به نيتشه بإعلانه “موت الإله” وزعمه أن افتقار الدليل والبرهان على وجود الإله يعني عدم وجوده. وقد احتج هوفمان بأن الإلحاد هو الذي يفتقر إلى دليل ينفي وجود الله بشكل قاطع وأن “الاعتقاد بوجود الله أو نفي وجوده يظل مسألة تحسمها العقيدة ويقين الفرد”[6].
الفيزياء الميتافيزيقية ومحاولات اختزال الله
التحول البطيء والتدريجي من الإيمان بالإله والغيبيات إلى الإلحاد أرجعه هوفمان بشكل رئيسي إلى صعود العلم منذ القرن الثامن عشر، فهاجم محاولات العلماء في اختزال الذات العلية في صورة علمية، لقد زعم الماديون من علماء الطبيعة قدرة العلم على الإجابة على الأسئلة التي يواجهها الإنسان فنظرية داروين على سبيل المثال تجعل البعض يؤمن بأن كل شيء يحدث نتيجة سلسلة من التطورات التي تحدث مصادفة ويمكن إعادتها بطريقة عكسية Reverse Engineering، واستناداً إلى نظرية النسبية لأينشتاين يعتقد البعض أنه لا يمكن الثقة بأي شيء، ويذهب هاوكنج في كتابه “بداية العالم” أنه لا ضرورة للإيمان بفكرة وجود الإله لتفسير بدء الخليقة “قصة الخلق” إذ تتكفل نظرية الانفجار العظيم بتقديم تفسير مقنع وعقلاني لبداية الخليقة. أما الأسئلة الأنطولوجية الكبرى مثل كنه الحياة وحقيقة الروح وغيرها فستتكفل الكيمياء الحيوية والفيزياء الحديثة بحل هذه الألغاز قريباً. ونظراً لأن الكيمياء والفيزياء لا تأتي إلا في صيغة معادلات مختزلة تعبر عن حقائق كاملة لذلك يتوقع إنسان القرن الحادي والعشرين “أن يتم التوصل إلى صيغة للعالم –معادلة- على أساس ميكروفيزيقي، بمقتضاها يمكن تفسير كل وجود للعالم من خلال حجر بناء أساسي للعالم دون الحاجة إلى اللجوء إلى تفسيرات فلسفية”[7].
ويعلق هوفمان على هذا الإفراط في الثقة بالعلم أو بالأحرى الغرور؛ بأنه بينما كان الإنسان البدائي يحاول بلوغ الحقيقة وكشف أسرار الكون والسيطرة على العالم من خلال السحر والأساطير فإن إنسان ما بعد الحداثة يسعى لذلك عبر بوابة العلوم الطبيعية، والتي لا تقبل سوى بفكرة مادية الحقيقة وموضوعيتها ولا معياريتها، مستبعدة تماماً أن يكون هناك وجه آخر للحقيقة لا يمكن اختباره في مختبرات الكيمياء والفيزياء؛ فشيئاً لم يثبته العلم لا وجود له. ويعرض هوفمان للرؤية التوحيدية الكلية للحقيقة والتي ترى أنها ذات وجهين “غيبي ومادي” وليست أجزاء متناثرة، ومن ثم لا يوجد تناقض بين حقيقة الغيب والحقيقة التي نراها، وينقل عن محمد أسد قوله: لا يجوز الحديث إلا عن الجوانب المُدرَكة وغير المُدرَكة من حقيقة واحدة شاملة، والعلوم الطبيعية ليس بإمكانها أن تساعدنا على اكتشاف الحقيقة بكل جوانبها وحتى يزودنا الله بالهداية الضرورية التي عجز العلم عن الاقتراب منها فقد أرشدنا إياها عبر الوحي الذي أنزله على شخصيات مؤهلة تأهيلاً خاصاً لتلقيه، يطلق عليهم الأنبياء والرسل[8].
لا يكتفي هوفمان بإقرار الاحتياج البشري إلى الوحي الإلهي للاقتراب من الحقيقة، وإنما اجتهد في أن يقوض أسطورة العلم من داخله مستنداً إلى النظريات العلمية وإلى آراء علماء الطبيعة، وقد شغلت هذه القضية الحيز الأكبر من مؤلفه (خواء الذات والأدمغة المستعمرة) والذي حاول من خلاله بث الشكوك في قدرة العلم على احتكار الحقيقة الكلية والنهائية، طارحاً بعض التساؤلات التي تركزت حول إمكانية أن يحل العلم بديلاً للإيمان، وهل بإمكان الحقيقة أن تستحيل إلى معادلات رياضية يحتكر فهمها نفر من العلماء وتستعصي على السواد الأعظم من البشر؟ وما هي حدود العلم؟
وفي مؤلفه سار هوفمان على نفس الدرب الذي سار عليه بيجوفيتش من قبله؛ ففند ادعاءات العلم الكبرى المتعلقة باليقينية والعقلانية والموضوعية، وأثبت زيفها وفراغ مضمونها ومحتواها، وقد شيد حججه على أساس أن العلم قائم على افتراضات أولية تؤسس عليها النظريات العلمية وهذه الفروض لا يمكن إقامة الدليل على صحتها، وقد جمع هوفمان العديد من الشهادات التي تؤيد ذلك ومنها ما ذهب إليه جوديل في قانون النقصان من أن “أي وصف رياضي للعالم سوف يظل ناقصاً لأنه ينطلق بالضرورة من افتراض بديهي واحد على الأقل. وكذلك كارل بوبر الذي ذهب إلى مدى أبعد في التشكيك في صحة النظريات العلمية مفترضاً أنه “لا يمكن لأحد التأكد من صحة نظرية لمجرد أنها تبدو تعمل… يمكننا فقط التأكد من أن هناك نظرية خاطئة عندما نستطيع إثبات زيفها”. وبناء على ذلك استنتج هوفمان أن نتائج هذه النظريات العلمية ليست يقينية بل هي نتائج احتمالية وظنية، وقد تسبب التسليم والإذعان لها في دخولنا عصر “أسطورة النسبية المطلقة” التي لا يمكن معها التيقن من صحة أي فرضية وهو ما يجعلنا بعيدين عن أي ادعاء للحقيقة، وقد لخص هذه الحقيقة المؤلمة حين ذهب إلى أن “الاحتمالية هي أعلى درجات اليقين الممكن الحصول عليه”[9]
وعلى صعيد آخر نظر هوفمان للنظريات العلمية من زاوية تناقض نتائجها وقوانينها مع بعضها البعض ومن ثم لا يمكن الادعاء بأن أحدها تمثل الحقيقة العلمية النهائية في مجالها، وقد ساق النظرية الكمية في الفيزياء كمثال على ذلك حين أتت بمفهوم جديد للطاقة والذرة بعد أن اكتشفت -أنه خلافاً للتعريف السابق للذرة- فإنه بالإمكان تفتيتها إلى جسيمات أصغر بروتونات ونيوترونات محاطة بالإلكترونيات. والآن ومع التطور الحاصل في فيزياء الجسيمات المتناهية الصغر يعتقد أن البروتونات والنيوترونات دونهما مكونات تأتي في مجموعات ثلاثية متناهية الصغر تسمى Quarks. وهذه الجسيمات الدقيقة ليست بمادة ولا بطاقة ولا يمكن التنبؤ بحركتها، وعند هذا الحد نفى العلماء فكرة العلية تماماً في فيزياء الجسيمات المتناهية الصغر. لقد تزايد القلق والتشاؤم من إمكانية تحويل “الحقيقة الكلية” إلى معادلات رياضية عندما وصلت فيزياء الجسيمات إلى أجزاء متناهية في الصغر لا يمكن التحقق منها أو إثبات زيفها تجريبياً “ولم تعد فيزياء الجسيمات المتناهية في الصغر وسيلة علمية يمكن بها استبعاد أن لله يد في الأمر، وبذلك تحولت إلى علم تخميني وما بعد تجريبي”[10]. لقد وصفها هاينزبرج الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بأنها تحولت إلى شكل جديد من الميتافيزيقا أي فيزياء ميتافيزيقية تسعى للوصول إلى “الطبقة العليا من الحقيقة والتي لا يستطيع أحد التحدث عنها إلا على سبيل المجاز”[11].
أبدى هوفمان أيضاً شكوكه في ادعاءات العلماء الطبيعيين ومحاولاتهم إضفاء هالة من الموضوعية المفرطة ونفي الصفة الذاتية عن أبحاثهم، باعتبار أن العلم قائم بالأساس على الملاحظة والتجريب والانفصال بين ذات الباحث والموضوع المبحوث انفصالاً تاماً؛ فذهب إلى أن ذات الباحث لابد وأن تتفاعل مع الموضوع المبحوث بشكل أو بآخر وبدرجات ومستويات متباينة ومن ثم تتأثر بها نتائج التجارب العلمية. وقد استرعى انتباهه أن العالم الذي يراقبه الماركسيون والليبراليون والمسلمون عالم واحد وكذلك أدوات الحس والأدوات العلمية التي يستخدمونها، ومع ذلك فإنهم يصلون بالأسلوب العقلي إلى نتائج متباينة بل ومتعارضة حول حدود الإدراك الحسي وطبيعة الكون وهندسته. وتساءل هوفمان هل بالإمكان أن يقود العلم إلى الإلحاد؟ وافترض أنه لو تكللت مجهودات العلماء بالنجاح في مسعاهم لتفسير كيف وجد الكون والمادة الأولى فربما أمكن التماس العذر في تبنيهم للإلحاد، أما أنهم لم يحصدوا سوى الإخفاق فإن هذا لا يبرر ادعاءهم الإلحاد، وبالتالي لا يمكن القول بأن التقدم العلمي هو الذي قاد إلى الإلحاد وإنما هو القناعات الفكرية المسبقة في عقول هؤلاء، وهو ما ينفي عن العلم صفة الموضوعية. لذلك أيد هوفمان ما ذهب إليه هانز دور من أن “عالم موضوعي حقاً هو أمر بعيد عن منالنا فما نستقبله هو حتما مشوب بذواتنا”[12]وفي النهاية خلص هوفمان إلى أن العلم الطبيعي معرض للزج به في الإيديولوجيات وحينئذ يمكننا أن نقول وداعاً للعلم النزيه.
من ناحية أخرى تتبع هوفمان محاولات العلم أن يحل بديلاً عن الإيمان على هيئة نظريات علمية بذلت لاختصار العالم في معادلة، وكانت آخر صيحة في عالم هذه المحاولات “نظرية الأوتار الفائقة” وهي تفترض أن أصغر جسيمات المادة لا تأتي كنقط في الفضاء وإنما على شكل أوتار متذبذبة ومتناهية في الصغر، والأوتار وفقاً لإدوارد ويتن واضع أسس النظرية ليست مادة ولا طاقة وإنما هي صانعة المادة والطاقة والفضاء والزمن. لقد عد هوفمان النظرية من قبيل محاولات اختزال الله، معتبراً أن فهمنا شديد الاختزال والقاصر للكون يجعلنا قادرين على أن نتقبل فكرة أن بإمكاننا أن نفهمه ونصوغه في معادلة رياضية واحدة، وتساءل مستنكراً ماذا نحن فاعلون بشرح للعالم يقتصر على حقيقة رياضية لا يمكن إثبات صحتها أو زيفها؟؟ وذهب إلى أنه “عندما تكون النماذج الرياضية متماسكة أكثر من الحقيقة التي تمثلها، ألا نكون قد وصلنا إلى نقطة حيث أصبح الاتصال فيها بالحقيقة واهياً”[13].
سوبر ماركت ديانات ما بعد الحداثة
إخفاقات العلوم الطبيعية المتوالية وعجزها عن بلوغ اليقين العلمي، والرغبة في التخلص من عبء العقلانية المفرطة بالارتماء في اللاعقلانية سمح بسيادة تيار من اللاأدرية العلمية والنسبية المطلقة وهو ما يمكن اعتباره إيذاناً بدخول عصر ما بعد الحداثة. وينظر هوفمان إليها باعتبارها رد فعل مأزوم على عالم مرعب لم يعد بالإمكان السيطرة عليه لا من خلال قيم مثل التنوير ولا حتى بقوة السلاح، ويعتقد أن الملمح الأبرز لها هو إعادة طرح الأسئلة الفلسفية القديمة دون انتظار الإجابة عليها، وهو يستشعر القلق العميق نتيجة ذلك وحسب قوله “إذا أصبحت كل مقولة مجرد مادة تأملية؛ فسيصبح عما قريب من الفضائل ألا يكون للمرء رأي ثابت وألا يحدد لنفسه هدفاً، وستصبح كل حماسة دينية وانتماء عقائدي تطرفاً”[14] وفي النهاية ستؤدي تلك النسبية بالإنسان إلى مرحلة اللاموقف أي عدم القدرة على اتخاذ موقف محدد وواضح.
وإذا كانت ما بعد الحداثة تأبى الإقرار بوجود الحقيقة المطلقة اكتفاء بالحقيقة الذاتية بمعنى كون الشيء قائماً في ذاته؛ فإن هوفمان يرى أن التخلي عن فكرة المطلق دعم اتجاهاً نسبياً ذا طبيعة عدمية أصبح بمقتضاه المرء قابلاً لاعتناق أي شيء دون تحديد، وهو يستثني من هذه النسبية العقائدية المسلمين والملحدين، لأن الملحد إذا أقر باحتمال خطأه فسوف يصبح متشككاً أو لا أدريا، وأما المسلم فهو يرى أن الإسلام ليس مجرد رؤية فردانية وتصور شخصي للحقيقة وإنما هو منظومة عقائدية أخلاقية يجب أن تسود عالميا[15]. وبفضل هذه النسبية والسيولة، تسللت العديد من الآلهة العلمانية الغامضة والمثيرة إلى مكان الصدارة بالغرب، وهي على شاكلة علوم إعادة التجسيم والتناسخ وديانات عبادة القمر والبيئة وغيرها مما يزخر به “السوبر ماركت الديني المعاصر”، وهذه الديانات تمثل أحد مظاهر ردة الفعل العنيفة على الخواء الروحي والفكر العقلي، أما المظهر الآخر لها –والكلام مازال لهوفمان– فهي أن المزيد من الناس أصبحوا “شبه متوحدين” وسعداء بالحياة وهم منفردين بأنفسهم ومستغرقين في نوع جديد من العبادة أطلق عليه “عبادة اللذة” أو أولوية اللذة كمذهب للحياة.
وعبادة اللذة شكل فظ من أشكال المادية التي يمكن اقتفاء أثرها في الحياة الغربية المعاصرة وتتجلى في محاولة الإمساك بالحياة واللحظة الراهنة والحصول على أكبر قدر من السعادة، وحسبما يرى هوفمان فإن الأجيال الجديدة في الغرب خلافاً لكل المجتمعات الإنسانية قد تطرفت في تنكرها لكل القيم والمقدسات المتعارف عليها وأخرجت إلى الوجود ما يمكن تسميته “تابو الموت” بمعنى الرفض الكلي لفكرة الموت والتنكر لها. وأرجع هوفمان ذلك إلى أن الحضارة الغربية المعاصرة لا تساعد على تقبل فكرة الموت خلافاً لكل الحضارات السابقة، وهو ما أنجب “جيلا غير مؤهل للموت” وغير معتاد كذلك على مواجهة نوازل الحياة والتي يعجز الكثيرون عن التوائم معها أو مواجهتها إذا لم يمد لهم “مستشارو الأحزان” يد العون.
ويذهب هوفمان إلى أن أوروبا تواجه الآن بجيل جديد لا يرغب بأي حال أن يبدد طريقه نحو السعادة، ولم يعد يروقه أو تستهويه الأشكال المتعارف عليها من السعادة -والتي كانت منذ الأزل جوهراً غير مادي ومتسامي- فقام بابتكار مفاهيم جديدة وأشكال زائفة منها تتوهم أن الإشباع المادي هو الكفيل بتحقيق الجنة الأرضية، والحصول على السلع والكماليات هو نهاية المطاف، وفي هذا السياق تتحول الرفاهية إلى ضرورات، ويجد الإنسان نفسه في حلقة لانهائية من عدم الرضا، حيث استقر أن الكم والإدراك الحسي فقط هما اللذان يستحقان الاعتبار[16].
ومن تجليات عبادة اللذة “الثورة الجنسية” وقد شبهها هوفمان بأنها عُبدت مثل عجل مصنوع من الذهب، في إشارة للتعبير القرآني الشهير، وعدَها الأطول عمراً والأعمق أثراً ضمن الثورات التي مرت بالإنسان الغربي طوال القرنيين الماضيين، حيث “بدا الجنس وكأنه البديل الأول للدين مكتملاً بأنبيائه الذين يبشرون بالحرية الجنسية”[17] وذهب إلى أن الثورة الجنسية التي قامت على افتراض مساعدة النساء وأن يصبح لهن السيادة على رغباتهن الجنسية لم تحقق أياً من وعودها فمازالت النساء مربوطات إلى أطفالهن بعد هروب الأب، وصار الرجل هو الأوفر ربحاً بعد أن صار بإمكانه التنصل من مسئولياته تحت شعار حرية الممارسة الجنسية.
الوجه الآخر لهذه الثورة الجنسية يبدو جليا في تزايد معدلات الإدمان الذي لم يعد مفهومه قاصراً على العقاقير المخدرة كما كان الحال في السابق، وإنما امتد ليطال مجالات حديثة كالتليفزيون والإنترنت، ويصف هوفمان هذه الأنواع من الإدمان بالبنيوية، ويذهب إلى أن غاية مروجي الإدمان إضلال عقول البشر وملء فراغهم الداخلي بالوهم والزيف، ومن ثم إعاقة توجههم نحو الله حيث “يطغى ضجيج الإدمان على صوت الضمير الذي قد يُذكر الإنسان المعاصر بمصيره الحق، وهو معرفة الله والدخول تحت عباءة الخضوع له. تعطي كل أنواع الإدمان معنى زائفاً للحياة، إنهم يحرمون الإنسان من الصمت الوجودي، والتركيز اللذين يحتاج إليهما من أجل إقامة الروابط السامية”[18].
النتيجة التي استخلصها هوفمان من سيادة مبدأ عبادة اللذة هي أن الإنسان الغربي أصبح يكابد أزمة وجودية عميقة “فمشكلة هذا الإنسان هي أن يتعايش مع الحياة، فالمشكلة ليست ما يحدث في أثناء الحياة ولكن المشكلة أن تكون أصلاً على قيد الحياة… ولن تجد إنساناً لا يعاني من أزمة وجوده هذه إلا وعدَه الآخرون إنساناً غير متعايش مع واقعه وغير عاقل”[19].
ويذهب هوفمان إلى أن أزمة القيم والمعنى التي أوجدتها ما بعد الحداثة لا يمكن التغلب عليها من خلال استدعاء القيم الإنسانية والتوصل إلى قناعات مشتركة بين أصحاب الديانات والملحدين واللاأدرين، طالما ظل الإنسان هو معيار ومقياس الأشياء كافة وهو وحده صاحب الحقوق، فالتمسك الأعمى بنموذج للتقدم يستند على الفرد الحر لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانتكاسات. ولا يشكل ما يسمى “علم الأخلاق العالمي” حلاً محتملاً للخروج من تلك الأزمة، فلا يمكن برأيه أن تصبح مجموعة من الأخلاق الوضعية المنفصلة عن أي مصدر متسام ومتجاوز بديلاً للدين في عصر ما بعد الحداثة. وينظر هوفمان إلى هذه الأخلاق البديلة باعتبارها مظهراً من مظاهر الاتجاهات النسبية لما بعد الحداثة، ويتوقع أنها ستفقد كل مصداقيتها إذا أعلنت أنها أخلاق لا تستهدف التمييز ما بين الخير والشر، والحق والباطل.
ويرجع هوفمان فكرة تقديم علم أخلاق عالمي تتواضع عليه البشرية جمعاء بغض النظر عن معتقداتها وانتماءاتها، إلى أن ما بعد الحداثة تؤمن أن التطور التاريخي لابد أن يصحبه تطور مماثل في القيم الإنسانية المصاحبة له، فهي ترفض بشدة فكرة وجود قيم غير مرتبطة بزمان محدد، بمعنى وجود قيم تعلو فوق الزمان وصالحة بشكل أبدي. وهو عين ما ترفضه الرؤية الإسلامية -كما أوضحها هوفمان- التي تؤمن بمطلقية القيم لأنها مستمدة من مصدر متجاوز لا تحده حدود الزمان والمكان، والتاريخ بالنسبة لها ما هو إلا حقب فانية -مثل الحداثة وما بعد الحداثة- أما الخلود فهو للقيم المتجاوزة.
ولا يجد هوفمان أمام الغرب الآن للخروج من أزمة المعنى إلا ثلاثة خيارات: أن يستمر متمسكاً بمشروع الحداثة بمفهوم تنويري عقلاني، أو يعلن استسلامه لنسبية ما بعد الحداثة المطلقة غير القادرة على إنتاج معنى أو مغزى الحياة، وأخيراً إحياء الرابطة مع الدين. وينحاز هوفمان بطبيعة الحال للخيار الأخير ويعتقد أن لا أمل في الشفاء إلا إذا نجح الغرب في التحرر من وهم الحداثة التي تحكمه والتخلص من عملية “التسميم الذاتي العقلاني” التي يمارسها، ليتمكن من إعادة صلته بالمقدس والغيبيات، والأمر يتطلب إعادة الاعتبار للدين كرد فعل عقلاني على حاجة الإنسانية للسلام والهدوء. وفي هذا السياق يعتقد هوفمان بثبات أن الإسلام قادر أن يمد يد العون لأوروبا وأنه يمثل “العلاج والشفاء الذي سينقذ الغرب من نفسه”.
الإسلام كبديل
في معرض تقديمها لكتاب ” الإسلام كبديل ” كتبت العالمة الألمانية آنا ماري شميل: “سيجد القارئ –الغربي– في هذا الكتاب تفسيرات جديدة، وقد يذهله المؤلف أو حتى يصدمه بأفكار مستمدة من الأساس الصحيح للإسلام، سيجد الإسلام الذي كان يٌعتقد أنه بقايا وحطام بالية من العصور الوسطى التي عفا عليها الزمن ديناً حياً أنضر ما تكون الحياة”. فما هي جوهر رؤية هوفمان للإسلام؟ وما الذي يستطيع أن يمنحه للغرب ليساعده على الخروج من أزمته الحالية؟
ينطلق هوفمان من أن الإسلام يمتلك رؤية للكون متكاملة ذات ترابط وعقلانية، وما يميزها عن الرؤى المغايرة هو استنادها إلى الوحي الإلهي وتيقنها من وجود إله لا متناه أبدي، لا يحده زمان ولا مكان، ولكونه فوق التصور البشري المتناهي فإن على الإنسان أن يؤسس إيمانه على التصديق وليس على الدليل. ويذهب هوفمان إلى أن المسلمين توصلوا إلى هذه النتيجة منذ وقت بعيد وقبيل كانط، عبر الفلسفة غير الميتافيزيقية لأبي الحسن الأشعري، الذي رفض بإصرار أن يكون الحكم البشري أو العقل مرجعية الإنسان، مفترضاً ضرورة القبول ببعض الجوانب التي تستعصي على الفهم بدون البحث والتقصي والمقارنة، وهو ما أطلق عليه هوفمان “اللاأدرية العقلانية”.
ويذهب هوفمان إلى أن طريق اللاأدرية العقلانية الإسلامية الوسط تبلور واكتسب شكله النهائي على يد أبو حامد الغزالي، الذي وضع حداً للتخمينات الميتافيزيقية التي طرأت على الفكر الإسلامي، عندما أشار إلى أن كل الأنظمة الفلسفية تستند إلى قواعد ظنية تخمينية غير قابلة للبرهان، ومن ثم لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج قاطعة يقينية يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها. كذلك شكك الغزالي بقوة في قدرة أي علم على توفير البصيرة النافذة إلى أية حقيقة غير محسوسة؛ فالرياضيات تتيح فقط نتائج دورانية متكررة ولا تقدم مزيداً من الوضوح، والمنطق لا يحتوي على قيمة معرفية أو إدراكية لافتقاره إلى قواعد وأسس عامة ملزمة له، وهو ما يجعل هناك حتمية لوجود الوحي كمصدر معرفي يسد الفراغ الناشئ من قصور حواسنا ومعارفنا عن الوصول للحقيقة المطلقة. وينقل هوفمان عن الغزالي قوله “الإلهام هو حالة تكتشف فيها العين الداخلية الأسرار التي يستحيل على العقل الوصول إليها.. أنا مدين في حكمي ليس إلى سلسلة الأدلة والبراهين، ولكن إلى النور الذي قذف به الله في قلبي”.
هكذا وصل الغزالي إلى اليقين بوجود الله وبصدق النبوة والرسالة بواسطة تداعي الأدلة والبراهين التي يستحيل التثبت من صحتها، ومن جانبه يعزز هوفمان ما ذهب إليه الغزالي من ضرورة الرسالة، فالإيمان بالنبوة والرسالة هو أحد مقتضيات الإيمان بالإله اللامتناهي الغيبي-وفي اعتقاده- إن جواز حدوث النبوة هو في الحقيقة افتراض لا يمكن تجاوزه منطقياً ما دام قد حصل اليقين بوجود الله، ويتساءل مستنكراً: لقد وصل العلم إلى حدود لا يمكن تجاوزها بدون مساعدة فروض نظرية لا يمكن التثبت من صحتها “فهل العمل بتصورات مثل الانفجار العظيم أو نظرية الأوتار الفائقة أو فكرة الخلق الذاتي والتنظيم الذاتي للحياة هو أكثر عقلانية من الإيمان بإمكانية وصول الرسالة للجنس البشري ؟” [20] ومع ذلك يظل التساؤل الجوهري –كما يراه- هو كيفية معرفة النبوة الحقة، وهو أيضاً تساؤل لا يحسمه إلا الإيمان الغيبي والتصديق القلبي.
أما عن العلاقة المفترضة بين العلم والدين -كما يراها هوفمان- فهي صادرة عن منظور إسلامي يرى أن الغرب قد أفرط في ممارسة العلم من أجل العلم دون تأطيره أخلاقياً أو ضبطه بقيم النفع والمصلحة لدرجة أصبح يوظف معها من أجل الشر تحت شعار “لا خلاص خارج العلم”. وبالطبع فإن محاولات اعتبار الحواس سبيل اليقين الوحيد، ورد جميع صور الحقيقة واختزالها في المادة تلقى رفضاً إسلامياً قاطعاً إذ “لا يقبل الإسلام تقليص العلم الحديث، ما وراء الطبيعة إلى علم النفس، وعلم النفس إلى علم الأحياء، وعلم الأحياء إلى الكيمياء والكيمياء إلى الطبيعة، وبذلك تنحط كل عناصر الحقيقة إلى أصغر صور ظهور المادة”. تذهب الرؤية الإسلامية إلى أن العلم لا يمكن أن يحل محل الدين، فكلٌ منهما له مجاله الخاص، وفي هذا الخصوص لا يستطيع العلم أن يمنحنا المعنى أو يرسي القيم الخُلقية “فالأخلاق ليست وظيفة جسدية وليس المعنى مستحضراً كيميائياً، والحب غير علمي بالمرة”[21] ولم يؤد تدخل العلم في مجال العقيدة إلا إلى الشك وفقدان اليقين وعبادة المعلومات، وأخيراً أزمة الهوية. وفي نهاية المطاف حسم هوفمان مسألة العلاقة بين الدين والعلم بشكل نهائي حين ذهب إلى أن من يرفض المغامرة الروحية للإيمان لن يتسنى له تعويض ذلك باللجوء إلى العلم.
ولا ينبغي أن يفهم موقف هوفمان على اعتبار أنه إنكار للعلم في حد ذاته ومعاداة مطلقة له، بل يجب أن يفهم في سياق رغبته المخلصة في تحرير العلم من الغرور وسوء التوظيف، وضبطه بالقيم والأخلاقيات المتجاوزة. وانطلاقاً من تلك الرغبة يعرب هوفمان عن تأييده للمحاولات الحثيثة التي يبذلها بعض العلماء المسلمين في إطار ما يسمى بمشروعات “إسلامية المعرفة”، التي يعتقد أنها الأداة الكفيلة بتحرير العقل المسلم من عقال التبعية للفكر الغربي، وتحريضه على الإبداع مجدداً داخل الإطار الحضاري الإسلامي، ولا يتردد هوفمان في إعلان خشيته بأنه إذا تم التخلي عن فكرة أسلمة المعرفة فلن يكون هناك أمل في أن تتمتع الدول الإسلامية بالحرية الحقيقية مطلقاً، لأنه لا معنى للحرية السياسية ما دام العقل المسلم يدور في ركاب الحضارة الغربية. ولا يجب أن يُفهم من ذلك أن هوفمان يدعو لإعادة تنقية العلوم من التأثيرات المنهجية الغربية، فجوهر فكره قائم على شعار “الانتقاء هو السبيل” أي المزاوجة بين الإسلام وإيجابيات الحضارة الغربية وعدم “الرفض المطلق للنموذج الغربي خيره وشره، ضاره ونافعه، ولكن انتقاء ما لا يتعارض مع الإسلام وتطويره وتنميته”[22].
وإذا كان بمقدور الإسلام تقديم منظومة معرفية ترتكز على مبادئ قيمية وأخلاقية فهو أقدر على تقديم منظومة إنسانية أكثر تكاملاً قادرة على انتشال الإنسان الغربي من أزمة وجوده العميقة التي يكابدها منذ انطلق قطار الحداثة، فالإنسان وفق تلك المنظومة كائن أخلاقي، أوكلت إليه مهمة عمران الأرض (الاستخلاف) وفق طرق وقواعد محددة سلفاً (الشريعة) وعليه ألا يتجاوز غاية تلك المهمة أو حدود هذه القواعد التي تستهدف في المقام الأول أن يحيا الإنسان في وئام مع الخالق والطبيعة ومع نفسه. ويوجز هوفمان ببراعة أبرز ما يميز الرؤية الإنسانية الإسلامية عما سواها قائلاً “وسط كل الأديان، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمهد للإنسان طريقاً متكاملاً للعيش يسمح له وللمجتمع أن يعيشا معاً في رخاء وفي توازن فريد. الباقون كلهم إما يسحقون فردية الإنسان أو يحدون من مسئولياته الاجتماعية”[23].
وفي كتابه “الإسلام في الألفية الثالثة” الذي قدم فيه للإسلام ووصفه بأنه قادر على منح الحياة للغرب كتب هوفمان “إنني بجدالي هنا عن كون الإسلام يملك الإجابات الصحيحة عن أسئلة الغرب الكثيرة وأزماته المتعددة إنما أوضح وأثبت أن الإسلام ليس طالب إحسان من الغرب ولكنه مانح رئيسي لكثير من القيم وأساليب الحياة. أما أن يعترف الغرب بهذا أو لا فهذه مسألة أخرى، فجميعنا يعرف بطبيعة الحال الكثير من المرضى والمدمنين الذين يحجبون الحقيقة ويرفضون الذهاب إلى طبيب حتى لا يواجههم بالحقيقة، وهذا هو حال المجتمع الغربي؛ فبالرغم من وجود تحليلات دقيقة ونافذة ذات دقة بالغة مثل تحليلات دانييل بيل ووليم أوفاليس المبهرة، فإن غالبية الناس الذين يعيشون معهم هذه الأزمة، أزمة حضارتهم، لا يعون أبعاد هذه الأزمة. فالاتجاه العام في الغرب يميل إلى إصدار أصوات الانتصار ولا يفيد التشخيص السليم والعلاج السليم مريضاً إلا إذا تناول هذا المريض الدواء في أوقاته، ولكن هذا غير متوقع، فجزء من المشكلة هو أن الغرب قادر على الرؤية والفهم ولكنه غير قادر على الفعل كما هو حال كل الحضارات في حالات انهيارها”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دكتوراة في التاريخ من كلية الآداب، جامعة القاهرة.
[1] ص 32 مراد هوفمان، الطريق إلى مكة (القاهرة، دار الشروق، 1998).
[2] الطريق إلى مكة، ص 112-113.
[3] مراد هوفمان، خواء الذات والأدمغة المستعمرة (القاهرة، دار الشروق، 2002)،ص 104.
[4] مراد هوفمان، الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود (القاهرة، دار الشروق، 2002)، ص22.
[5] الإسلام في الألفية الثالثة، ص 23.
[6] الطريق إلى مكة، ص 37.
[7] الإسلام في الألفية الثالثة، ص 25.
[8] مراد هوفمان، يوميات ألماني مسلم (القاهرة، مؤسسة الأهرام، 1996) ، ص 54.
[9] خواء الذات، ص 34.
[10] نفس المرجع السابق، ص 34.
[11] نفسه، ص 41.
[12] نفسه، ص 38.
[13] نفسه، ص 39.
[14] الإسلام في الألفية الثالثة، ص 180.
[15] خواء الذات، ص 67.
[16] خواء الذات، ص 72.
[17] خواء الذات، ص77.
[18] خواء الذات، ص 83.
[19] الإسلام في الألفية الثالثة، ص 228.
[20] خواء الذات، ص 93.
[21] مراد هوفمان، الإسلام كبديل، الكويت: مؤسسة بافاريا، 1997، ص 50-51.
[22] الإسلام كبديل، ص 52.
[23] خواء الذات، ص105.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies