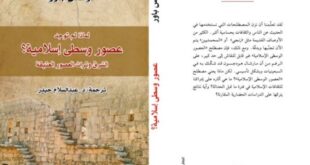العنوان: ثغور المرابطة: مقاربة ائتمانية لصراعات الأمة الحالية.
المؤلف: طه عبد الرحمن.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: بيروت.
الناشر: منتدى المعارف.
تاريخ النشر: 2019.
الوصف المادي: 252ص. ، 24 سم.
الترقيم الدولي الموحد: 6-179-428-614-978.
كتاب “ثغور المرابطة: مقاربة ائتمانية لصراعات الأمة الحالية”، للمؤلف “طه عبد الرحمن” يشد انتباه القاريء العربي المسلم من أول وهلة. فهو لا يمس فقط قضايا مركزية وجوهرية في صميم الوعي العربي الإسلامي، إنما يمس أيضاً شغاف القلب والفؤاد؛ وذلك لتعرضه إلى مسألة “المرابطة” من مدخل مفاهيمي فلسفي أخلاقي روحاني، يدخل في أعماق الفرد القاريء، فيجعله يتخيل ماهية تلك “المرابطة”، وكيفية تطبيقها فعلياً، ليس على مستوى الدول والأمم فسحب، بل أيضاً على مستواه هو شخصياً على امتداد مسار حياته. إن خصوصية هذا الكتاب تكمن –برأيي– في كونه يعطي القاريء فرصةً كي يعيد حساباته مع ذاته ونفسه، ليقوم بدوره “الاستخلافي” في هذه الحياة، حتى يصل إلى نموذج “الإنسان الآية”، كما وصفه المؤلف في ثنايا الكتاب.
كيفية النظر إلى الأشياء بعينٍ “ائتمانية” –أي بعينٍ تنظر إلى كل ما يحيطنا من منظور الأمانة الواجبة علينا شرعاً وأخلاقاً وفطرةً– يمثل في نظري قلب ولُب هذا الكتاب الذي تشرفت بالاستئناس بين دفتيه قرابة شهرين. فهو على الرغم من صغر حجمه نسبياً – 252 صفحة – إلا أن دسامته الفكرية وعمقه الفلسفي تطلبا مني المكوث و”المرابطة” عليه طيلة تلك المدة. ولعل شهادتي تلك عن الكتاب تعتبر دليلاً على إصابة المؤلف لهدفه الإرشادي من وراء هذا العمل، إذ كانت بغيته تتمثل في تبليغ تصوره الأخلاقي المعياري التوجيهي في مواجهة التحديات المعاصرة التي تهدد أمتنا، بحيث يتشرب القاريء ذلك التصور قلباً وعقلاً ووجداناً وفكراً.
هذا الكتاب الصادر في طبعته الأولى عن “منتدى المعارف”، بيروت، عام 2019 (وهي طبعة خاصة وحصرية خارج المملكة المغربية، بناءً على اتفاق خاص مع “مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني)، تناول تحديات الأمة من منظور فلسفي بحت. وهو تناول ضروري وواجب، يتقدم على التحليل السياسي، كما أشار المؤلف في المقدمة، مستهدفاً درء ودفع الهلاك ليس عن الأمة الإسلامية فحسب، بل عن الأمم الإنسانية كلها.
ارتكز التناول الفلسفي على النظرية الائتمانية التي من أبرز خصائصها اعتماد فطرة الإنسان أصلاً وأساساً على الدين. فالإنسان مفطور في أصله على الدين، كما يؤكد المؤلف في المقدمة. ومن ثم، تعد النظرية الائتمانية نظرية دينية أخلاقية، تتأسس على حقائق الإنسان وأصوله، وتجيب عن الأسئلة التي تتعلق بكيفية إدارة السلوك الإنساني في الحياة، و”تدل على ما ينفع ويضر، وعلى ما يُسعد وما يُشقي”. وتلعب إرادة الإنسان دوراً مركزياً في تلك النظرية؛ تلك الإرادة التي يراها المؤلف أقوى من “إكراهات الواقع”.
ويعرض المؤلف التحديات الثلاث التي تواجه الأمة في وقتنا الراهن، على الوجه التالي:
أولاً، تفريط العرب في القدس، وهو التحدي الأول الذي أفرد له المؤلف الفصل الأول من الكتاب تحت عنوان (مرابطة المقدسي: ثغر الصراع الإسلامي الإسرائيلي).
ثانياً، تصارع الحكام المسلمين على النفوذ، وهو التحدي الذي أفرد له المؤلف ثلاثة فصول متتالية؛ الثاني والثالث والرابع، جميعها تحت نفس العنوان، وهو (مرابطة الفقيه والسياسي: ثغر الصراع الإسلامي الإسلامي).
ثالثاً، اقتتال العرب فيما بينهم، وهو التحدي الذي أفرد له المؤلف الفصل الخامس والأخير تحت عنوان (مرابطة المثقف العربي: ثغر الصراع العربي العربي)، مختتماً كتابه بالحديث مُجملاً عن “الائتمان والإيمان”.
التحدي الأول: تفريط العرب في القدس
في هذا الفصل، يتناول المؤلف خصوصية الإنسان المقدسي في مرابطته على ثغر الصراع الإسلامي الإسرائيلي، وفي كيفية دفعه الإيذاء الإسرائيلي الذي يؤذي الإله والأرض المباركة من ناحية، ويؤذي الإرث الإنساني والفطرة الإنسانية من ناحيةٍ أخرى. وينوه هنا المؤلف، أن الأصل الذي اعتمده في استعمال عبارة “إيذاء الإله” هو الآية القرآنية الكريمة: “إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً” (سورة الأحزاب، آية 57).
وتتأتى تلك المُدافعة عبر وسيلتين؛ فأما الوسيلة الأولى، فتتمثل في سعي الإنسان المقدسي نحو رفع أيدي الإسرائيليين عن أي شيء في أرض فلسطين، نصرةً لله أولاً وأخيراً من حيث ائتمنه على هذه الأرض المباركة؛ وهو ما يُسميه المؤلف “الخاصية الائتمانية للمرابطة المقدسية”. وأما الوسيلة الثانية، فتتمثل في سعيه نحو دفع تزييف الفطرة التي دنسها وسلبها المحتل الإسرائيلي، وإعادتها إلى أصلها الإيماني التوحيدي، من خلال استحضار “الحالة الإشهادية الأصيلة” التي أشهد فيها الحق سبحانه وتعالى ذريات بني آدم على ربوبيته ووحدانيته التي هي أصل الفطرة؛ وهو ما يُسميه المؤلف “الخاصية الإشهادية ودفع تزييف الفطرة”.
يعتمد الاقتراب الائتماني –كما يؤكد المؤلف– على مبدأ أساسي يقول إن لكل شيء بعدين: الصورة الظاهرة والروح الأصيلة. فإذا ما طبقنا هذا المبدأ على الإيذاء الإسرائيلي، فسنجد إيذاء الصورة متمثلاً في إيذاء الأرض المباركة والإرث الإنساني الفلسطيني، بينما نجد إيذاء الروح متمثلاً في إيذاء “الإله” الذي هو روح هذه الأرض المباركة، وفي إيذاء “الإنسان الفلسطيني” الذي هو روح الإرث الإنساني.
ويمضي المؤلف موضحاً، أن المحتل الإسرائيلي ينازع -من جهة- “الإله” في صفة “المالك” التي هي صفة عظمى من صفاته، مستأثراً بالأرض المباركة بالقوة، بكل ما ومن عليها، وبما تحتها (الحفريات)، مُسمياً ذلك بـ”إحلال الأرض”. ومن جهةٍ ثانية، يحتل المحتل الإسرائيلي فطرة الإنسان الفلسطيني، فيستأصلها ويفسدها، حتى يصير ذلك الإنسان قابلاً باحتلال أرضه؛ وهو ما يُسميه المؤلف بـ”الحلول الكلي”، والذي يعتبره أخطر بكثير من “إحلال الأرض”، لكون الأول مُضيعاً ومميتاً للفطرة التي هي مستودع القيم وجوهر الروح؛ ومن ثم مميتاً للعقل والبدن؛ وهو ما يعد أشد فتكاً من احتلال الأرض، حتى لو كانت مقدسة.
وبناءً على ذلك، تصير المرابطة المقدسية بمثابة “تطهير مزدوج” للأرض المباركة من تدنيس وإيذاء الإسرائيليين، لإعادة قداستها، من ناحية، وتطهير للفطرة من الزيف لإعادة أصالتها من ناحيةٍ أخرى. إنها مقاومة روحية دائمة، طلباً للقرب الإلهي. إنها مقاومة ممتدة من حراسة الثغر في كل الأفعال الواجبة إلى الوقوف بين يدي الله؛ وهي لا تعني الفلسطيني فقط، بل تعني كل مسلم مؤمن على هذه الأرض، كما يؤكد المؤلف.
وكما ذكرنا سالفاً، يخص المؤلف سبيلين –لا ثالث لهما– من أجل تطبيق وإنفاذ وتفعيل تلك المرابطة المقدسية: استرداد الأرض، واسترداد الفطرة. وهو يسهب ويفصل طويلاً في تناول كلٍ منهما. فيتحدث عن استرداد الأرض المباركة –الأمانة المسلوبة– حفظاً لقداستها، لا حفظاً للأرض دون قداسة، مطالباً بترسيخ ثقافة الائتمان لدى الإنسان الفلسطيني التي من شأنها أن تساعده في بناء عقله ووجدانه. تلك الثقافة المتمثلة في التفكر في آيات الله الخاصة بالكون، والخاصة بتكليف الإنسان على هذه الأرض؛ والمتمثلة أيضاً في التأمل في إرادة الله فيما يحدث من حولنا، ومن ثم الخروج عن الإرادة الإنسانية، درءاً للسقوط في مستنقع “المنازعة البائسة للألوهية” التي سقط فيها المحتل الإسرائيلي من قبل. ويؤكد المؤلف هنا، أن استرداد الأمانة المسلوبة لا يعني أبداً تحصيل أمانة بعينها، وإنما الغرض هو تعميم المبدأ في حد ذاته على الأرض كلها التي بات سكانها يعيشون في “عالم ما بعد الأمانة”، وفي عالم “موت الحياء”، فوجب إخراجهم –من باب الأمانة– من ذلك الواقع المذري.
وأما مسألة استرداد الفطرة، فيوليها المؤلف تناولاً مماثلاً من ناحية الأهمية؛ إذ يطالب المرابط المقدسي بمقاومة كل تجليات الإرادة الإسرائيلية في سلوك الفرد الذي تم تطبيعه، محرراً إياه من تعبيد نفسه لتلك الإرادة، حتى يعود عبداً لله وحده، حامياً لأمانة “حفظ حريته”، وحافظاً لفطرته التي سلبها منه ذلك الكيان الاحتلالي. كذلك يطالب المؤلف المرابط المقدسي بمقاومة تجليات الإرادة الإسرائيلية في سياسات وممارسات الحاكم المُطبع، عبر تنبيهه بمدى خيانته لأمانة العدل التي في ذمته؛ في كونه ظالم لنفسه بتعبيده لتلك الإرادة، كما هو ظالمُ لشعبه بتعبيده لها. وأخيراً، يدعو المؤلف ذلك “المرابط” إلى توعية المجتمع المُكره على التطبيع، المجبور على استئصال فطرته، من خلال إعادة تأسيس قيمه على الصفات الإلهية، ليتحرر من ذلك الاستعباد المادي، المصاحب للتطبيع والمضيع للفطرة؛ ومن خلال إعادة صلته بالذات الإلهية، وإعادة ترسيخ الإسلام لديه على الصبغة المقدسية التي تجعله يُسلم الوجه لله وحده وليس لإسرائيل.
التحدي الثاني: تصارع الحكام المسلمين على النفوذ
يناقش المؤلف هذا التحدي على امتداد الفصول الثلاثة المتتالية من الكتاب، كما ذكرنا سالفاً. فهو تحدٍ يحتل مساحة كبيرة من الكتاب، بل إنه يحتل المساحة الكبرى من الكتاب؛ وهو ما يدلل على مدى اهتمام المؤلف بتلك القضية أو بتلك المصيبة التي أصابت أمتنا الإسلامية في مقتل؛ فالعدو هنا ليس المغتصب الإسرائيلي؛ إنما المسلمون فيما بينهم، طمعاً وحباً في النفوذ السياسي الدنيوي، لا طمعاً وحباً في النعيم الإلهي الأخروي.
يتمثل هذا التحدي – باختصار – في الصراع بين النظامين السعودي والإيراني الحاليين على النفوذ السياسي، واستخدامهما وسائل مذهبية وسياسية وصولاً لذلك النفوذ، بل والتماسهما مشروعية ذلك الصراع السياسي في الصراع التاريخي بين “المتحكمة” و”المتظلمة”، الناتج حينذاك عن النزاع على الخلافة بين “معاوية بن أبي سفيان” و”علي بن أبي طالب”، والذي أسفر عن تبادل وتراشق تهم الخيانة والحيازة فيما بين الطائفتين على مدار القرون الماضية.
1. طبيعة الصراع وتقصير الفقهاء
ينبه المؤلف، في ثنايا حديثه، عن طبيعة ذلك الصراع، باعتبارها سياسية في الأصل، وليست مذهبية أو عقدية بين أهل السُنة وأهل الشيعة كما ترسخ في أذهان وعقول الأمة، أو كما يُراد به أن يُتداول في وسط جماهير الأمة، درءاً لشبهات الطمع السياسي لدى النظامين المعنيين. إذاً، فالجماهير المسلمة لا ترتبط بهذا الصراع من أي جهة، لا تاريخياً ولا وجدانياً.
ثم ينتقل المؤلف إلى تناول أطوار ذلك الصراع بين “المتحكمة” و”المتظلمة”، وكيفية تدرجه من منازعة “معاوية” لـ”علي” حقه في الخلافة منازعة ميدانية، إلى استنزال “معاوية” لـ”الحسن بن علي” عن حقه في الخلافة، متعهداً له بإعادتها عن قريب، إلى قتل “يزيد بن معاوية” لـ”الحُسين بن علي” شر قتلة، استخفافاً بنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي فتح للمسلمين طريقاً مظلماً، يتظالمون فيه فيما بينهم إلى هذا اليوم، ظلم “ليس له سابق ولا لاحق”، كما وصفه المؤلف.
وبعدها يعرج بنا المؤلف إلى عرض الأطوار الأربعة الفاصلة لهذا الصراع السياسي بين الطائفتين المتناحرتين؛ إذ كان هم كل طائفة، وشغلها الشاغل، احتياز الخلافة والنفوذ والتسيد، وهو ما شكل تناقضاً فجاً مع المنطق الائتماني الأخلاقي الذي يقتضي بأن الخلافة أمانة في عنق الخليفة المسئول، لا حيازة له أو تملك.
فمن طور الصراع الأموي الهاشمي الذي اتهم فيه الهاشميون المتظلمة بني أمية المتحكمة بالحيازة المطلقة، إلى طور الصراع العباسي الفاطمي الذي اتهم فيه العباسيون المتحكمة الفاطميين المتظلمة بمنازعة الله في مالكيته، بانتحال بعضهم صفة الألوهية لنفسه، وهو ما يعد أخطر بكثير من حيازة المتحكمة، إلى طور الصراع السلجوقي البويهي الذي اتهم فيه السلاجقة المتحكمة البويهيين المتظلمة بالخيانة، بعد استعانتهم بـ”هولاكو” التتري، وجلبهم إياه إلى بغداد للقضاء على السُنة، إلى طور الصراع العثماني الصفوي الذي اتهم فيه العثمانيون المتحكمة الصفويين المتظلمة بالانحياز، بعد إجبارهم أهل فارس ترك مذهبهم السُني بحد السيف، واعتناق المذهب الشيعي بدلاً منه، وبعد استعانتهم بالقوى الغربية وحملات التبشير للقضاء على الدولة العثمانية.
ويعود المؤلف مكرراً ومؤكداً أن الداء الحقيقي في كلتا الطائفتين السياسيتين كان –ولا يزال– هو الرغبة في “التسيد”؛ تلك الرغبة الجامحة التي أدت بدورها إلى الانحياز والخيانة من قبل الطائفتين، على حدٍ سواء؛ مما هدد الأمة وأضل جماهيرها. فمنذ بدء الصراع السياسي بينهما –بعد أحداث الفتنة الكبرى– ثم انتقاله بين النظامين السعودي والإيراني، ومظاهر “التسيد” هي الحاضرة والثابتة عبر النموذجين؛ وهي التي كان – وما زال– لها دور كبير في اعتلال النظامين. فأما النظام السعودي، فقد أصابته علة “الإختلال في الوجهة”، وأما النظام الإيراني، فقد أصابته علة “الاغترار بالقدرة”.
وبكل أسف، لم تتم محاصرة تلك العلل والأمراض الفاسدة على أيدي العلماء والفقهاء، كما كان ينبغي أن يكون. فأما النظام السعودي الحاكم، فقد تماشى معه “الفقيه غير السياسي”، سائراً في ركبه، مضيفاً ومُسبغاً كل الشرعية على سلطان النظام؛ إذ تمثلت وظيفة ذلك “الفقيه” في التبرير الشرعي لجميع أعمال وممارسات الحكم التسلطية والتوريثية، بل التبرير الشرعي لاتخاذ الحاكم أولياء دون المسلمين بحُجة حفظ وحدة الجماعة واتقاء الفتنة. وأما النظام الإيراني الحاكم، فقد أوجد “الفقيه السياسي” الذي أُعطِيَ تصرفاً مطلقاً في الممارسة السياسية، لدرجة إنزاله منزلة الإمام الذي يملك جميع صلاحيات الرسل والأئمة، والذي تبلغ ولايته غاية الاحتياز والتملك السياسي، مما أغرقه في مستنقع السياسة، ففوت عليه التنبه إلى عيوب التسيد الكائنة في النظام.
إذاً، فـ”الفقيه” في كلا النظامين قصر أشد تقصير في تبصير النظام الحاكم بعيوب ومخاطر التسيد. ومن ثم يصير الحل الائتماني الحافظ للأمانة لهذين النظامين، متمثلاً في الآتي: أن يستوفي “الفقيه غير السياسي” الفقه كله، فلا يأخذ بعضه (المتمثل في المعتقدات والعبادات)، ويترك البعض الآخر المتمثل في المصالح والمعاملات والتدبير السياسي؛ وأن يعتدل “الفقيه السياسي” في تعامله مع السياسة، حتى يستطيع أن يُبصر الحق والأمانة والعدل.
وينتقد المؤلف الفرضية القائلة بأن “المواطنة” هي الحل الجذري لذلك الصراع القائم على داء التسيد. ويعارض المؤلف ذلك الحل، على المستوى المفاهيمي وعلى المستوى التطبيقي الواقعي معاً. فأما على المستوى المفاهيمي، فيرى أنه مفهوم غربي بحت، يتم تنزيله تنزيلاً “آلياً” على المجتمعات المسلمة، مستنداً إلى مؤسسات دولة القانون والنظام العلماني. وأما على المستوى التطبيقي الواقعي، فيرى أنه مفهوم أخلف طائفية من نوعٍ آخر، وهي الطائفية “المواطنية” التي أفرزت تمييزاً وعنصريةً بين الأوطان والقوميات، أكبر مما أوجدته الطائفية الدينية؛ ولعل الحربين العالميتين في القرن العشرين لخير شاهد ودليل على ذلك. هذا إضافةً إلى أن مفهوم “المواطنة” قد ساعد على إختزال الإنسان في وجوده السياسي والاجتماعي فقط، مُخلاً بفطرته التي توجب أن يؤخذ الإنسان في كليته، كما يؤكد المؤلف.
2. تحول “الوحدة الائتمانية” إلى “فُرقة ائتمانية”
بعد عرض المؤلف لطبيعة النزاع بين الطائفتين، تاريخياً وسياسياً، وتصوره لكيفية حل ذلك النزاع، ينتقل بنا إلى مناقشة مفهوم “الوحدة الائتمانية”، وكيف تم تحويلها إلى “فُرقة ائتمانية”، على امتداد الصراع الدائر بين “المتحكمة” و”المتظلمة”.
أما “الوحدة الائتمانية”، فتعني اتحاد الديني بالسياسي؛ أي “وصل تداخل” بينهما، وذلك على عكس التصور المادي العلماني الذي يفصل بينهما “فصل تباين”. فالمسئول في التصور الائتماني يتجرد عن كل ميلٍ احتيازي، بينما يرى الآخرين يختارون ويمتلكون. وقد تعرضت تلك “الوحدة” إلى أول بذور فرقتها -كما يؤكد المؤلف- مع نشوء النزاع على من هو أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تعرضت الأمة لابتلاء قسم وحدتها، وهو “الابتلاء بالعداوة”، كما أسماه المؤلف. فبموجب هذا الابتلاء، يخضع الإنسان –منذ أول وجوده على الأرض– إلى قانون إلهي، متمثلاً في ابتلاء عداوة الشيطان لبني آدم. وما الصراع السعودي الإيراني إلا تجسيداً لذلك الابتلاء وتلك الفُرقة.
وإذا كانت “الوحدة الائتمانية” قد تحققت فعلياً وكُلياً على يد سيد المُرسلين، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بقت روحها مبثوثة في عهدي “أبي بكر الصديق” و”عمر بن الخطاب”، محاولةً لاستعادة الوضع المثالي الذي كان موجوداً في عهد رسول الله، إلا أنها –بكل أسف– تخلخلت تماماً في عهدي “عثمان بن عفان” و”علي بن أبي طالب”.
فأما “أبو بكر” و”عمر”، فقد كان وعيهما شديداً بأهمية إقامة تلك “الوحدة” إقامةً تلازمية، مكان التطبيق المثالي وغير المقدور عليه، في عهد رسول الله. ومن ثم، كان جهادهما لمواجهة “الحيازة” و”التملك” ظاهراً بوضوح وقوة، على امتداد خلافتهما. وأما في عهد “عثمان”، فقد بدأ التراخي في وصل “السياسي” بـ”الديني”، بالغاً ذروته بعد مقتل “الحُسين”. وأما في عهد “علي”، فقد وقع “معاوية” وأصحابه في غلوٍ سياسي، جعلهم يتصورون أنهم مالكون للحقيقة السياسية، بينما وقع “القُراء” (وهم صفوة جيش “علي” المقاتلين من أجل إقامة سلطان القرآن) في غلوٍ ديني، جعلهم يتصورون أنهم مالكون للحقيقة الدينية دون سواهم.
وفي ظل تلك الفتنة، لم يستطع “علي” رفع التراخي، بل هذا التفكك الكلي، الذي أصاب الصلة بين “الديني” و”السياسي”؛ فلم يستطع إعادة الاعتبار لسلطان الديني (القرآن)، بل على العكس، خرج الأمر عن يده وعن اختياره، بعد تفاقم هذا التفكك الذي كان ناتجاً –من ناحية- عن قرار “معاوية” وأصحابه رفع “السياسي” فوق” الديني”، بتذرعهم المطالبة بدم “عثمان” بينما كان مقصدهم انتزاع الخلافة؛ وكان ناتجاً، من ناحيةٍ أخرى، عن قرار “القراء” الاستهانة بقضايا العقل.
هذا التفكك الكلي في العلاقة بين “الديني” و”السياسي” أفضى إلى انفصال أمانة “الديني” عن أمانة “السياسي”، واستبداد كل طائفة بأمانة بعينها. فأما “المتحكمة” –الموالون لـ”معاوية” حينذاك، وهم أهل السُنة حالياً– فقد استبدت بأمانة “السياسي”. وأما “المتظلمة” –المتضررون من التحكيم، الموالون لـ”علي”، وهم أهل الشيعة حالياً– فقد استبدت بأمانة “الديني”.
3. آثار تلك “الفرقة” على النظامين السعودي والإيراني، وآفاق الحل
وبعد بيان كيفية حدوث تلك “الفُرقة” تاريخياً، يعرج بنا المؤلف إلى تناول آثارها المترتبة على النظامين المعنيين. فأما النظام السعودي، فقد تبنى موقف “المتحكمة”، مستخدماً أدوات وسياسات “الإجبار” مكان “الاختيار” في تثبيت حكمه وإرادته، مما أوصله في النهاية –على العكس– إلى سلب إرادته؛ إذ سلبه أعداء الأمة إرادته، فأوقعوه تحت سطوة وصايتهم الخارجية. وأما النظام الإيراني، فقد تبنى موقف “المتظلمة”، مستخدماً أدوات وسياسات “الاحتياز” مكان “الاحتفاظ”. فبدلاً من تعامله مع ما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من منطلق الاستيداع والاحتفاظ، أي النظر إليه باعتباره أمانة ووديعة يجب حفظها، أظهر النظام –على العكس من ذلك– توجهاً احتيازياً شديداً تجاه التركات المادية التي خلفها آل البيت، معتبراً كونه الوريث الوحيد لها، مما أنتج شططاً في إرادة النظام، واغتراراً بقدرته. لقد استبدت الروح الاحتيازية بهذا النظام، كما يؤكد المؤلف، لدرجة اعتقاده بأن رسول الله قد استودع أئمته أحكام الشريعة وأسرارها.
ولا يجد المؤلف حلاً لتلك المعضلة الطائفية إلا الحل الائتماني –والذي تطرقنا إليه سابقاً– والذي يتمثل في إحداث ثورة أخلاقية، تجعل الفقه أخلاقياً لدى النظام السعودي، وتجعل السياسة أخلاقية لدى النظام الإيراني. ويقود هذه الثورة الأخلاقية “فقيهاً تعرفياً” مُصلحاً للنظام السعودي، و”سياسياً تقربياً” مُصلحاً للنظام الإيراني.
فأما “الفقيه التعرفي”، فتتلخص مهمته في إقامة فقهٍ، يتعرف على الله سبحانه وتعالى بقدر ما يمتثل لأمره، مُقرناً الجانب القانوني بالجانب التعرفي، متجاوزاً صور الأحكام الشرعية إلى أرواحها المتمثلة في القيم باعتبارها آثاراً للصفات الإلهية، ومن ثم نقل النظام السعودي من الدين المفصول عن السياسة، فصلاً تاريخياً علمانياً، إلى الدين الموصول بها وصلاً ائتمانياً. ويرابط هنا الفقيه “التعارفي” على هذا الثغر حتى يخلص النظام السعودي من آفة “إختلال الوجهة”، فيُمكنه من تطبيق الحق الذي يدعيه، وهو حماية القبلة.
وأما “السياسي التقربي”، فتتلخص مهمته في نقل النظام الإيراني من السيدية إلى العبدية في مجال التدبير السياسي، فينتقل من تولي شئون التدبير السياسي من كونه سيداً إلى كونه عبداً. ويسعى هنا “السياسي التقربي” نحو تحويل النظام الإيراني من التمسك بسلطان الإنسان إلى التمسك بسلطان الإله، ومن الاعتماد على إرادة الذات في التدبير إلى الاعتماد على إرادة المدبر الأعلى سبحانه وتعالى؛ ومن ثم جعل الإرادة الإنسانية تابعة لإرادة الله. ويظل ذلك “السياسي” مرابطاً على الثغر حتى يخرج النظام الإيراني من آفة الإفراط في السياسة والاغترار بالقدرة التي جعلته متعبداً لذاته.
ويركز هذان المرابطان –كما يشير المؤلف– على مبدأين أساسيين في أثناء أداء مهمتهما، وهما مبدأ “التحرر” ومبدأ “المؤانسة”. فأما مبدأ “التحرر”، فيوظفه “الفقيه التعرفي” من أجل تحرير النظام السعودي من داء سلب الإرادة الذي أذله إلى الآخر (العدو)، وجعله متعبداً له؛ فإذا ما تحرر من ذلك الداء، سُنحت له الفرصة لكي يعرف الله عز وجل، ويتعرف على صفاته، مما يزيل الغشاوة حتماً من على عينيه. ويستخدم “السياسي التقربي” المبدأ ذاته من أجل تحرير النظام الإيراني من داء تعظيم ذاته، واستعلائه على الآخرين، وتعلقه بقدراته وحيازاته، داعياً إياه النظر إلى مقدورية الأشياء لا إلى قدراته الذاتية، مبيناً له أن الأشياء إنما توجد فقط بقدرة الله لا بقدرة الإنسان؛ وأخيراً تحريره من داء إطلاق سلطة “ولاية الفقيه”، موضحاً له أن إطلاق السلطة ليس شرعياً، لكون الإطلاق صفة إلهية في الأساس.
وأما مبدأ “المؤانسة”، فيستخدمه “الفقيه التعرفي” لجعل النظام السعودي نظاماً مؤانساً، أي مُقدِراً لكل فرد في مجتمعه، وخارج مجتمعه، على اعتبار أن البشر جميعهم إخوة في الإنسانية، وعلى اعتبار أنهم مرتبطون أخلاقياً ببعضهم البعض؛ فتصير الحدود الأخلاقية هي الفارقة فقط، وليس الجغرافية أو الطائفية. ومن ثم، يتم إخراج النظام السعودي من داء الإجبار تجاه شعبه، ومن داء المحاربة للمسلم المختلف طائفياً.
أما “السياسي التقربي”، فيستخدم مبدأ “المؤانسة” لجعل النظام الإيراني مؤانساً لجميع المسلمين المختلفين طائفياً، فلا يقهرهم على التشيع، ولا ينظر إليهم باعتبارهم مصدر تهديد، بل يصبر على اختلافهم. فإنه بإخراج النظام الإيراني من شرنقة الذات، تتسع رؤيته ومداركه، ويصير أكثر تفهماً وتقبلاً للمجتمعات المسلمة الأخرى غير المتشيعة.
التحدي الثالث: الفتنة القابيلية في بلاد العرب
بعدما تحدث المؤلف عن تحدي الصراع الطائفي بين “المتحكمة” و”المتظلمة” –والذي درج منه إلى النزاع السياسي بين النظامين السعودي والإيراني– ينتقل إلى تناول التحدي الثالث، مُفرداً له الفصل الخامس والأخير من كتابه، تحت عنوان “مرابطة المثقف العربي: ثغر الصراع العربي العربي”.
في هذا الفصل، يتعرض المؤلف إلى الحديث عن ظاهرة شيوع ثقافة القتل في بلاد العرب، والتي يسميها “الفتنة القابيلية” نسبةً إلى “قابيل”، القاتل الأول على وجه الأرض، الذي سفك دم أخيه “هابيل”. وهنا يصب المؤلف جام غضبه على المثقف العربي الذي أخفق إخفاقاً ذريعاً في التصدي لتلك الفتنة؛ وذلك بسبب تحيزه “للسياسي”، وفصله عن “الأخلاقي”، مما أفضى إلى تزكية العنف والفتنة. يصف المؤلف مثل هذا المثقف بالـ”خائن” الذي خان دوره حيال تلك الفتنة؛ كما وصفه بالـ”منسلخ” الذي انسلخ عن التفكير في آيات الله الكونية والتكليفية، مما حرمه من بوصلة الاهتداء إلى درء ذلك الاقتتال المرير الذي امتد طيلة ثلاثة عقود في بلاد العرب.
ويأسف المؤلف على ذلك الواقع المؤلم الذي ساهم العرب في حدوثه، بشكلٍ جذري، إذ ساهموا في ظهور ما نُسميه بـ”عالم ما بعد الأمانة”؛ وهم كانوا الأولى والأجدر بمنع ذلك، لما يحملونه من معتقدات دينية راسخة، تُحرم عليهم قتل الإنسان “حامل الأمانة”، وهو الأمر الذي يجهله أقوام آخرون.
وتصدياً لذلك التحدي، يؤكد المؤلف على ضرورة وجود “المثقف المرابط” الذي يصلح ما أفسده وما دمره “المثقف المنسلخ”؛ فيعيد للدين والأخلاق دورهما الأصلي والأصيل، جاعلاً القيم الدينية هي أساس القيم الإنسانية التي تحملها الثقافة، واصلاً الديني بالإنساني، وواصلاً السياسي بالأخلاقي، متجاوزاً ثغر السياسي إلى الأفق الأخلاقي، متجاوزاً توصيف الواقع إلى توجيهه بما يحقق الكمال الإنساني، ساعياً نحو إنتاج إنسان ناهض بالعمران، لا بالقتل والذبح؛ وهو عين ما تستهدفه الثقافة.
كذلك يعتمد دور “المثقف المرابط” –كما يؤكد المؤلف– على التصدي لاستئثار الساسة بالتملك والحيازة القصوى، كاشفاً المفاسد الأخلاقية من قمعٍ للحريات، وكبتٍ للكفاءات. يقوم إذاً هذا “المقف المرابط” بتحويل جذري في الرؤية للعالم، من الرؤية الاحتيازية التملكية التي درج عليها “المثقف المنسلخ” وأهل “الفتنة القابيلية” إلى الرؤية الائتمانية التي تقتضي بأن الأصل في الأشياء هو “الأمانة” وليس “المِلك” الذي نتصرف فيه كيفما نشاء؛ وأن الأصل في الإنسان هو حمله للأمانة التي اختارها بذاته، لا تسيده للأشياء.
وحتى يكون هذا “المثقف المرابط” صادقاً فيما يدعو إليه، لابد أن يكون مُجسداً لهذا الإنسان “الآية” الحامل للأمانة، فكراً وسلوكاً؛ ملازماً مراقبة ذاته طوال الوقت، مُقراً بكونه ليس مالكاً للحقيقة، مُستنهضاً “الإنسان الآية” على الدوام، صاحب الخاصية في المؤانسة –وليس القتل– مع بني جنسه ومع غير بني جنسه في شتى بقاع الأرض.
ويقوم هذا “المرابط” على نشر وترسيخ مباديء ثقافة الإحياء؛ فمن مبدأ الخروج من إرادة القتل إلى إرادة الإحياء (اعتماداً على إرادة الإنسان الناتجة عن حريته)، إلى مبدأ اعتبار قتل الأخ لأخيه قتلاً للأخوة جميعاً (لكونه قتل للخاصية الإنسانية في القاتل والمقتول معاً)، إلى مبدأ تقديم الإحسان على العدل (درءاً لمزيد من أسباب الاقتتال)، إلى مبدأ إحياء إرادة التغيير لدى السياسي (بفتح آفاق تصور أخرى لمفهوم السياسة بديلة عن التصور الاحتيازي، وهو التصور الائتماني الذي يوفي بأمانة التدبير السياسي الذي لا حيازة فيه). ومن ثم، كانت معارضة المؤلف المطلقة لمزاحمة الإسلاميين السلطة لكون الدولة، برأيه، كياناً احتيازياً في الأساس.
وقد نال المؤلف نقداً على مختلف الجهات، فيما يخص دعوته إلى تطبيق ثقافة الإحياء. فمن جهة، انصب سهام الناقدين على مبدأ “ثقافة الإحياء” في أساسها، معتبرين إياها غارقة في المثالية. ومن جهة ثانية، انصب نقدهم على ربط المؤلف بين الفلسفة والدين، معتبرين أن الفلسفة ليس لها أدنى علاقة بالدين. وفي ذلك، يرد عليهم المؤلف موضحاً أن ثقافة الإحياء –التي يتهمونها بالمثالية– لهي أقرب صلة بالواقع والوجدان العربي عن ثقافة الانسلاخ التي يمثلونها. ثم إن هذه المثالية مطلوبة لتغيير الواقع، وليس الإقرار به، كما يريد أولئك الناقدون “المنسلخون” الماديون. فالمثالية تجعلنا نعيد صياغة “الثوابت” بما يتناسب مع أشكال التحديات الراهنة المتمثلة في تدفق ذلك النزيف العربي الذي لا ينقطع.
أما بخصوص حُجتهم القائلة بأن الفلسفة منبتة الصلة بالدين، فيرد المؤلف مُفحماً، إن أصل الحكمة موجود أساساً في الدين، إذ أن الدين سابق للفلسفة زمنياً. ومن ثم، يختزن الدين من الحكمة ما يضاهي الحكم الفلسفية، بل ويفوقها؛ ويختزن من الآيات البينة التي تفوق الحقائق الفلسفية المجردة؛ ويختزن من المفاهيم –مثل مفهوم “الائتمان”– ما لا تعرفه الفلسفات المختلفة. فمفهوم الائتمان، المرتبط في الإسلام بمفهوم الحرية، لا يوجد له مثيل في دينٍ آخر، ولا في أي فلسفة بشرية أخرى.
تشعر وأنت تقرأ الكتاب، وكأنك تسمع المؤلف يستشيط غضباً من أولئك “المثقفين” المنسلخين المُقلدين، ذوي العقول الكارهة لأي ائتلاف بين الإيمان والفلسفة. وهو الأمر الذي جعل المؤلف يدق ناقوس خطرٍ منهم؛ إذ تتمثل خطورتهم في تقليدهم الأعمى للفلاسفة الغربيين، وشذوذهم عما هو متعارف عليه من القيم؛ وتصل درجة خبثهم إلى تظاهرهم بكونهم ناقلون فقط للفلسفة الغربية، حتى يكسبوا تعاطف القاريء العربي، بينما الحقيقة أنهم يدسون السُم المُتعمد في وسط ما “ينقلونه”. وتكتظ، بكل أسف، الجامعات العربية بتلك النوعية من الفلاسفة المقلدة الذين يدعون تخصصهم في الفلسفة العربية الإسلامية، بينما هم تابعون كلياً للفكر الغربي. وليتهم ضالعون في اللغات الغربية الضرورية –للاطلاع على أدبيات الفلاسفة الغربيين– وليتهم ملمون بأدوات المنطق ومنهجيات التفكير العقلاني؛ بل إنهم مفتقرون إلى هذا وذاك؛ ومن ثم يصير اعتمادهم الأساسي على الترجمات الركيكة.
من أجل ذلك كله، يدعو المؤلف في نهاية كتابه إلى ضرورة التحرر من أولئك المثقفين، تطبيقاً للإيمان الحقيقي الذي يوجب التحرر من أي عائقٍ يمنع الإنسان العبد من عبادة ربه؛ فما بالك بالتحرر من أولئك المثقفين الذي يعانون أصلاً من “عقدة الدين”. ويصف المؤلف دعوته تلك بمثابة “إبراء الذمة” من “أمانة التنبيه على المنكر الفكري”. وما أجمله من وصف، وما أعمقه من تعبير، يبرز كيف أن المنكر يتعدى الفعل الملموس إلى الفكر غير الملموس؛ وكيف أنه لا يقتصر فقط على القتل أو السرقة أو الزنا أو شرب الخمر، كما يعتقد الكثيرون، إنما يمتد أيضاَ إلى الفكر. ومن ثم، يصير التحذير منه أمانةً في العنق، كما يدعو المؤلف.
ما بعد القراءة
يجب القول، إن الكتاب ممتع على المستوى العقلي والوجداني. فأما على المستوى العقلي، فهو يحفز العقل على التفكير المتعمق في أصول الأشياء والظواهر، بمنهجيةٍ فلسفيةٍ غير معهودة. ظواهر لطالما مرَ عليها المرء دون التدقيق في أصولها وأسبابها. وأما على المستوى الوجداني، فهو كتاب يمس القلب والوجدان وذات الإنسان؛ فيجعله يتعرف على أدق تفاصيل الإخلاص والعبودية لله؛ كيف تكون، وكيف تُحَصَل، وكيف تُمارس؛ ليس فقط على مستوى الدول والأنظمة، بل أيضاً على مستوى الفرد المسلم. وتلك هي عبقرية الكتاب؛ أنه يجعلك تقيس نفسك على ما تقرأه. هل أنت فعلاً إنسان حافظ للأمانة على مستوى سلوكياتك وعلاقاتك الشخصية؟ هل أنت فعلاً إنسان تتعامل مع كل شيء من حولك، يخصك أو لا يخصك، باعتباره أمانة أو وديعة، يجب الحفاظ عليها حتى يحين وقت ردها؟
باختصار، إن الكتاب يعطي الإمكانية لتطبيق وقياس مفهوم “الائتمان” على المستوى الفردي للشخص القاريء. فيسأل نفسه –طيلة قراءته للكتاب– كيف أتخلص من عبادة غير الله؟ كيف أصلح وجهتي التي تختل عبر سنوات عمري، بل عبر ساعات يومي الواحد؟ كيف أتعامل مع الأشياء باعتبارها خارجة عن حيازتي، وعن قدرتي؟ كيف لا أغتر بقدرتي؟ كيف أتواضع وأستكين لتدبير الله وقدرته؟ لقد نجح المؤلف –برأيي– في تحقيق غاية الكتاب، وهي التوجيه والإرشاد والتربية.
فضلاً عن ذلك، لقد قدَم المؤلف من خلال “ثغور المرابطة” حُججاً ومداخل منطقية لدرء فرضية وجوب فصل الدين عن السياسة التي يتشدق بها المنظرون الغربيون، وفي ذيلهم –بكل أسف– مثقفونا المنسلخون. وتنطلق حُججه من مدخل “النظرية الائتمانية” التي تجعل الدين والسياسة يتداخلان فيما بينهما “تداخل تواصل”، على اعتبار أنهما أمانتان شرعيتان لا يجوز فصلهما عن بعضهما البعض؛ وعلى اعتبار أن الفطرة، التي فطر الله عليها الإنسان، توجب عبودية الإنسان لله منذ نشأته في عالم الذر، عبودية لله في كل زمانٍ ومكان، في السياسة وفي خارجها. فمن المنطق، أن يصير “الإنسان الآية” –المفطور على عقيدة التوحيد– عابداً لله في كل أموره وشئون حياته، سواءً كان في حياته الخاصة أو في منصبه السياسي. فالعبودية الخالصة لله تعني طاعته عز وجل طاعةً كاملةً، بكامل التسليم والخضوع والحب؛ ومن ثم عدم انتقاء أشياء دون أشياء. ومن السُخف، افتراض أن يصير الإنسان بوجهين أو قلبين؛ فيراقب الله في حياته الخاصة، ثم لا يُراقبه إذا ما قرر الاشتغال بالسياسة. فإنه لعمري إنعدام للعقل والمنطق، أن يُشطر المرء نصفين، نصف “ديني” ونصف “غير ديني”، فيعيش تلك الازدواجية غير الآدمية وغير المنطقية.
ومن أجل تبرير مواقفهم الشاذة، يدعي هؤلاء العلمانيون –الغربيون منهم والشرقيون– أن عدم الفصل الدين عن السياسة يتيح الفرصة لتوظيف الدين من قبل السياسيين. ونستطيع القول، أن ذلك التوظيف قد شُهِد بالفعل في العديد من الأمثلة التطبيقية؛ ولكن السؤال هنا: من هم هؤلاء السياسيون؟ إنهم السياسيون الاحتيازيون الذين ليس لديهم رؤية أو قناعة بالنظرية الائتمانية؛ الذين يرون في السياسة حيازةً وملكاً وامتلاكاً؛ ومن ثم يستخدمون الدين ويوظفونه لتثبيت ملكهم السياسي؛ وهو ما يناقض مبدأ “الائتمان”. وقد شهدنا ذلك في دول الشرق؛ كما شهدناه في دول الغرب نفسها التي تتشدق وتفتخر بفصلها الدين عن السياسة؛ ولعل في مؤازرة دول الغرب جميعها لإسرائيل باعتبارها دولة الشعب المُختار من الله –وهو افتراء محض– أكبر دليل على توظيف الدين من أجل المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية الغربية.
بمعنى آخر، هؤلاء العلمانيون يُسوقون لخطورة توظيف الدين من قبل السياسة –وهو أمر خطير بالفعل ولا يوافق عليه الإسلام– لا من أجل التحذير والتنبيه، إنما من أجل التبرير الخبيث لحذف الدين كليةً عن المشهد السياسي برمته. فهم –كما يُقال– يدعمون حقاً يُراد به باطل.
ولعلنا ما نشهده حالياً من حرب القوى الغربية كلها على غزة لأكبر دليل على مدى افتقارنا واحتياجنا إلى إعادة ذلك التداخل في حياتنا من جديد. فقد أظهرت هذه الحرب كيف تصير السياسة قبيحةً فاجرةً دون الاهتداء بالأخلاق التي تنبع أصلاً من الدين.
وما يلفت النظر أيضاً في هذا الكتاب، هو تطابق ما تناوله المؤلف (في عام 2019) من عللٍ في النظامين السعودي والإيراني مع واقعنا الحالي في عام 2024. فعلة “إختلال الوجهة” لدى النظام السعودي، نستطيع التمعن فيها بعمق، حينما نشهد –اليوم– درجة التطبيع غير المسبوقة بين النظام السعودي الحالي وبين دولة الاحتلال الصهيوني؛ حتى ولو لم يكن التطبيع قد أُجري عبر اتفاقيات مُبرمة واضحة. فعمليات التوافق والتواصل تجري على قدمٍ وساق بين الدولتين: من الإعداد لمشروع “نيوم”، إلى السماح بدخول الإسرائيليين في مكة والمدينة في وسط مناخٍ شاذٍ من الترحيب والتودد، إلى السماح بتحليق الطيران الإسرائيلي فوق الأراضي السعودية، إلى إقامة “موسم الرياض” في وقتٍ تقوم فيه إسرائيل بإبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023. والحق يُقال، إن اللاموقف للنظام السعودي الحالي تجاه حرب غزة 2023 ليتعدى “اختلال الوجهة” بمراحل وسنواتٍ ضوئية.
وكذلك علة “الاغترار بالقدرة” لدى النظام الإيراني، نستطيع ملاحظتها بوضوح، حينما نشهد استمرار تورط النظام الإيراني في الداخل السوري، دعماً لنظام “بشار” على حساب الشعب السوري، ودفعاً للمد الشيعي في سوريا ضد الوجود السُني، الأمر الذي نال كثيراً من الثورة السورية. فبسبب تحيز النظام الإيراني المفرط تجاه الشيعة، واغتراره بقدرته على فرض قوته العسكرية، كانت النتيجة أنه غلب مصلحته السياسية والطائفية على حساب ثورة شعبية، كانت في طريقها لقلب نظام غاشم، يقتل شعبه بالبراميل المتفجرة.
النظام الإيراني بحاجةٍ إلى تفهم سُنة الاختلاف وحكمتها. وإن “وثيقة المدينة”، التي أرساها رسولنا الكريم، لهي أكبر شاهد على اعتراف الإسلام بهذه السُنة؛ إذ أرست “الوثيقة” مبدأ الوحدة مع المختلفين عرقياً وعقائدياً، ولكن على ثوابت متفق عليها من قبل الجميع.
ولعلني في وسط إعجابي بالكتاب، قد لا أتفق مع بعض الفرضيات التي ذهب إليها المؤلف في ثنايا بحثه؛ منها رؤيته لمبدأ المزاحمة على السلطة، واعتباره معارضاً لمبدأ الائتمان، مفترضاً أن الدولة كيان احتيازي بالأساس، ومن ثم لا يجب التعامل معه. ورأيي المتواضع حيال تلك المسألة، أنه لا ضير في “المزاحمة” على السلطة، ما دامت تجري في نطاق سُنة التداول التي تمثل سُنة من سُنن الله الكونية. فالبقاء -في نهاية الأمر- يكون للأصلح والأتقى والأزكى؛ ولن يتحقق ذلك إلا بالتدافع الذي يعتبر سُنةً أخرى من سُنن الله الكونية. “فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض” (البقرة، آية 251). ومن ثم، يصير التدافع –أو كما يعبر عنها المؤلف بـ”المزاحمة”– مطلوباً وواجباً من الناحية الشرعية لدفع الفساد بالإصلاح، ودفع الباطل بالحق؛ وهو الصراع أو الابتلاء الأزلي السُنني الذي أراده الله عز وجل منذ خلقه للإنسان، والذي سيستمر حتى يوم الدين.
إضافةً إلى ذلك، إنه من الناحية الواقعية التطبيقية، فإن ترك السلطة دون إصلاح، والاكتفاء بالإصلاح من أسفل، لم يُسفر إلا عن إجهاض ما تم إصلاحه على الأرض –طوال سنين وعقود ماضية– بفعل أدوات السلطة المتسلطة. بل إن الأمر قد يتطرق إلى ما هو أخطر من ذلك؛ وهو أن عدم إصلاح الأوضاع من “أعلى” يُفضي حتماً إلى نشر الفقر والجهل اللذين يعتبران وقوداً أساسياً للفتن القابيلية.
ومن ضمن الفرضيات التي استوقفتني أيضاً، ولم أتفق فيها مع المؤلف، فرضيته القائلة بأن العرب قد ساهموا بشكل مباشر في إيجاد “عالم ما بعد الأمانة”. وسؤالي المتواضع هنا: هل ساهم العرب وحدهم في إيجاد ذلك العالم منزوع الأمانة؟ ألم يكن للقوى الغربية أي دور في ذلك؟ ألم تكن القوى الغربية محركاً أساسياً ومحورياً في إذكاء تلك الفتنة القابيلية بين العرب؟ ألم يكن للمخابرات المركزية الأمريكية دور محوري في إيجاد حركات متطرفة مثل “داعش”؟ ألم تساهم الولايات المتحدة الأمريكية في إذكاء الفتنة بين الشيعة والسُنة، بعد احتلالها الغاشم للعراق في أبريل 2003، تحقيقاً لمصالحها في السيطرة والهيمنة؟ ألم يكن بغي القوى الغربية حيال الشعوب العربية –من احتلال عسكري إلى احتلال اقتصادي إلى احتلال ثقافي وحضاري واجتماعي– سبباً قوياً في إفقار تلك الشعوب، وتضييع أحلامها، وسرقة آمالها، مما أدى إلى انفجارها فيما بينها بدلاً من انفجارها في وجه المعتدي الغربي؟
لقد أضحى “الخارجي” مؤثراً بشكلٍ غير مسبوق في “الداخلي”؛ وهو ما تمت ملاحظته بوضوح منذ تقلد الولايات المتحدة الهيمنة على العالم، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في أواخر تسعينيات القرن الفائت. فمنذ ذلك الحين، وظف القطب الأمريكي الأوحد سياساته وأدواته الخارجية، ولاسيما العولمة، للتأثير على مجتمعات الداخل ليتم أمركتها جميعاً، ومصادرة ثقافاتها وحضاراتها المختلفة تحت شعار العولمة؛ خاصةً مجتمعات الداخل الإسلامي التي ناصبها القطب الأمريكي عداءً إستيراتيجياً بعد أفول الاتحاد السوفيتي؛ إذ لا غِنى للإدارة الأمريكية عن إيجاد عدوٍ، تستنفذ حياله قوتها العسكرية، وتُحرك به اقتصادها.
عرض
د. شيرين حامد فهمي*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies