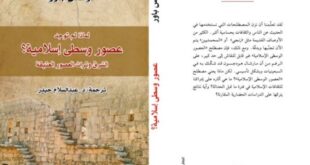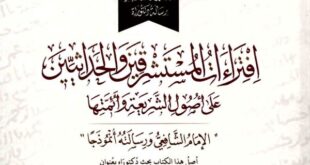العنوان: نقد الثقافة الغربية: في الاستشراق والمركزية الأوروبية.
المؤلف: عبد الإله بلقزيز.
الطبعة: ط. 2.
مكان النشر: بيروت.
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية.
تاريخ النشر: 2018.
الوصف المادي: 288ص. ، 24 سم.
السلسلة: العرب والحداثة؛ 4.
الترقيم الدولي الموحد: 0-822-82-9953-978.
كيف تفاعل النهضويون العرب –مسلموهم ومسيحيوهم– مع الاستشراق؟ كيف تأثروا به إيجاباً وسلباً؟ كيف انعكس الاستشراق على رؤاهم، ومنطلقاتهم الفكرية، ومناهجهم البحثية؟ هل كان الاستشراق شراً محضاً، أم خيراً محضاً، أم مزيجاً بين الإثنين؟
تساؤلات كثيرة تنوه جميعها عن دور الاستشراق كمحطة التقاء جامعة بين الباحثين الغربيين ونظرائهم العرب حول موضوع واحد، وهو الإسلام. لقد دشن الاستشراق علاقةً مُركبةً ومُعقدةً، ذات مستوياتٍ وأشكالٍ عدة، بين الطرفين: بين النهضوي العربي والمستشرق الغربي. فتارةً علاقة انبهار وتماهٍ مع المستشرق؛ وتارةً علاقة نقدٍ للمستشرق ومناظرةٍ معه؛ وتارةً علاقة انبهارٍ ونقدٍ في آنٍ واحد.
ذلك ما استهل به “عبد الإله بلقزيز” كتابه “العرب والحداثة (4): نقد الثقافة الغربية في الاستشراق والمركزية الأوروبية” وهو الكتاب المؤلَف من أربعة أقسام، يندرج تحتها تسعة فصول.
يتحدث القسم الأول عن “النهضويون العرب والاستشراق”، متناولاً الفصل الأول تحت عنوان “من الانبهار إلى الحوار”، والفصل الثاني تحت عنوان “الاستشراق: التماهي والتمايز”.
ثم ينتقل المؤلف إلى القسم الثاني، متحدثاً عن “الاستشراق والمؤسسة”، متناولاً الفصل الثالث تحت عنوان “نقد الخلفيات الكولونيالية للاستشراق: أنور عبد الملك نموذجاً”، والفصل الرابع تحت عنوان “الاستشراق: نقد الخطاب (إدوارد سعيد)”.
يتطرق “بلقزيز” بعدها إلى القسم الثالث تحت عنوان “الاستشراق في عيون نقدية”، متناولاً فيه الفصل الخامس تحت عنوان “الأصول الأوروبية لنظرة الغرب: هشام جعيط ناقدا”، ثم الفصل السادس تحت عنوان “الاستشراق وحدوده المعرفية المنهجية: مطالعة في نقديات محمد أركون”، وأخيراً الفصل السابع تحت عنوان “عبد الله العروي ونقد الاستشراق”.
ويختتم “بلقزيز” كتابه بالقسم الرابع والأخير “في نقد المركزية الأوروبية”، متحدثاً في الفصل الثامن عن “نقد المركزية الأوروبية وثقافويتها: سمير أمين نموذجاً”، مختتماً بالفصل التاسع تحت عنوان “من المركزية الأوروبية إلى المركزية الغربية في نقد مفهوم الغرب وأسطورته: جورج قرم نموذجاً”.
أسهب “بلقزيز” في حديثه عن أشكال وأبعاد العلاقة بين النهضويين العرب والمستشرقين، متناولاً مكامن الانبهار والنقد سواء، مؤكداً انه بالرغم من الكتابات النهضوية العربية الناقدة للمستشرقين، إلا أنها لم تخلو من آثار الاستشراق وتجلياته.
في هذا الصدد، أفرد المؤلف فصلاً كاملاً عن النهضوي العربي المعروف “عبد الرحمن بدوي” الذي اعتبره المؤلف نموذجاً للتماهي والتمايز، المتوازيين، مع الاستشراق، بل اعتبره أفضل نموذج للنقل العربي عن الاستشراق، والتعريف بأعمال المستشرقين لدى القاريء العربي. فهو يعتبر، بحق، أفضل نهضوي عربي نقل عن الاستشراق، سواءً في وسط الجيلين الثالث والرابع أو الجيل المتأخر.
انتقل المؤلف بعدها إلى نموذجين آخرين من النهضويين العرب، يعتبران من الرواد في نقد العلاقة بين المعرفة الاستشراقية والمؤسسة الكولونيالية الكامنة وراءها؛ وهما “أنور عبد الملك” و”إدوارد سعيد” اللذان اعتمدا في أعمالهما على منهجية النقد فقط، دون إفساح أي مساحة للثناء أو الانبهار أو التماهي مع الاستشراق.
كان “أنور عبد الملك” هو صاحب المبادرة في نقد العلاقة بين المعرفة الاستشراقية والمؤسسة الكولونيالية التي تفرز تلك المعرفة، كما يفترض. وكان “عبد الملك” هو مؤسس تلك النظرة الجديدة التي ارتأت الاستشراق في إطار العلاقة بين المعرفة والسلطة. ومن خلال ذلك، صب “عبد الملك” سخطه وغضبه على المركزية الأوروبية التي تقع في قلب الفكر الاستشراقي الكولونيالي.
استأنف “إدوارد سعيد” مشروع “عبد الملك” في نقد العلاقة بين المعرفة والسلطة، متناولاً العلاقة التكاملية بين المستشرق والمحتل، مُستعرضاً عملية “التكييف العلمي” التي يقوم بها المستشرق ليرضي المحتل، ويحقق أهدافه الاستعمارية. لقد اقتفى “سعيد” خُطى أستاذه في نقد المنظومة الكولونيالية الأوروبية، وتسخيرها للمعرفة الاستشراقية الخادمة لمطامعها الاستعمارية في المنطقة العربية، إلا أن “سعيد” وقع في نفس الخطأ المنهجي الذي وقع فيه “عبد الملك”، وهو التمهيد لتكوين صورة نمطية عن الاستشراق في الوعي العربي، مضادة للصورة النمطية عن الإسلام في الوعي الغربي، كما يشير “بلقزيز” في كتابه.
فالإثنان ينتميان إلى جيل النهضويين العرب اليساريين والقوميين الذين ظهروا بعد انقضاء حقبة الاستعمار الأوروبي في المنطقة العربية، الأمر الذي يجعلنا نتفهم وندرك السبب وراء ربطهما المعرفة الاستشراقية بالسلطة الكولونيالية، ومن ثم طعنهما في ذلك الاستشراق الكولونيالي. وهو الأمر الذي يجعلنا نفهم أيضاً السبب وراء انحياز “عبد الملك” للاستشراق الاشتراكي، معتبراً إياه خادماً وداعماً للشعوب العربية بعد انقضاء حقبة الاستعمار الأنجلو – سكسوني الإمبريالي.
وهو ما أعده المؤلف عواراً فكرياً واضحاً في مشروع “عبد الملك” الذي غض طرفه عن الأهداف الاستعمارية للاستشراق الاشتراكي، مما يدل على ازدواجيته في المعايير. وكذلك كان عوار “سعيد” الفكري حينما اختزل الاستشراق في استشراق كولونيالي فرنسي أنجلو أمريكي، مُعرِضاً عن تيارات استشراقية علمية موضوعية أخرى، كانت ألمانيا بيئتها الحاضنة التي لم يكن لديها مشاريع استعمارية في المنطقة العربية، كما كان الحال مع بريطانيا وفرنسا.
ومن نقد الاستشراق، انتقل المؤلف إلى محطةٍ أخرى في جولته النقدية للحداثة، وهي مرحلة نقد الأصول الأوروبية للفكر الأوروبي عن الشرق؛ وذلك عبر استحضاره للنهضوي العربي “هشام جعيط” الذي قدم مناظرةً نقديةً صارمةً للفكر الأوروبي من داخل أوروبا.
كان تركيز “جعيط” على نقد صورة الإسلام المُتخيل في الوعي الشعبي الأوروبي؛ تلك الصورة التي امتزج فيها الجهل مع العداء، والتي هيمنت ليس فقط على القاعدة الشعبية، وإنما أيضاً على النخب المتعلمة الدارسة. وعلى الرغم من التراجع التدريجي لتلك الصورة بعد بزوغ أوروبا النهضة وفقدان المسيحية واللاهوت السيطرة على مجال الاستشراق، إلا أنها لم تنزوي أبداً، بل إنها عاودت الظهور في القرن التاسع عشر، لتطل بوجهها من جديد –وربما بوجهٍ أكثر وحشية عن ذي قبل– حيث اكتسح الفكر الإمبريالي والقومي والعنصري أنحاء أوروبا، محولاً الإسلام إلى موضوع للسيطرة والنظرة الاحتقارية العنصرية.
إلا أن مجال الاستشراق لم يكن كله عنصرياً أو متحيزاً، كما يدلي “جعيط”. فقد كان للاستشراق الموضوعي وجوداً وأثراً، مثله مثل الاستشراق الاستعماري الاحتلالي. وهما –بالمناسبة– نوعان من الاستشراق قد تنازعا، وما زالا يتنازعان، النظر إلى الإسلام. وأهم من مثَل الاستشراق الموضوعي هو الاستشراق الألماني الذي يمتلك خصوصيةً لا يمتلكها الاستشراق الأنجلو سكسوني، والذي تجلى على امتداد القرن الثامن عشر، متمثلاً في تيار الرومانسية والفضول نحو الشرق.
ومن “جعيط” انتقل المؤلف إلى “محمد أركون” صاحب النقد المعرفي والمنهجي لا الأيديولوجي، حيث انصب نقده على المناهج التي يستخدمها المستشرق في دراسته للإسلام. ويتبنى “أركون” في ذلك مشروعاً لإعادة تصويب النظرة إلى الروحي والديني. ومما يلفت الانتباه، أنه رغم نقده لمناهج المستشرقين، إلا أنه يتحسر عليهم إذا ما قارنهم بالاستشراق الأمريكي الراهن، كما أورد “بلقزيز”.
ومن النقد المنهجي المعرفي، ينتقل المؤلف إلى النقد المنهجي التاريخي عبر النهضوي العربي والمؤرخ “عبد الله العروي” الذي صب نقده على منهجية المستشرقين في دراسة تاريخ الإسلام، حيث اتسمت منهجيتهم –كما يقر “العروي”– بالأرشيفية المطلقة والرؤية السلبية البحتة، وهو إن دل على شيء، فإنما يدل على عوار الرؤية التاريخية الغربية للتاريخ العربي والإسلامي، وعدم موضوعيتها في سرد الإيجابيات كما تسرد السلبيات؛ وهو الأمر الذي دفع “العروي” – مستنكراً – إلى طرح التساؤل الآتي: هل أفاد العقل التاريخي الوصفي الغربي مجال الإسلاميات؟
ومن نقد المنهجية التاريخية، انتقل المؤلف في المحطة الأخيرة من كتابه إلى نقد فكرة “المركزية الأوروبية” التي اعتمدها المستشرقون والحداثيون في كتاباتهم وأعمالهم، ليبرزوا بكل عنصرية وتحيز “الفرادة” التي انفرد بها الأوروربيون دوناً عن جميع الشعوب. وقدم “بلقزيز” – لهذه المهمة النقدية – إسمين بارزين من النهضويين العرب، وهما “سمير أمين” و”جورج قرم”.
فأما “سمير أمين، فكان ناقداً للرواية الأوروبية الثقافوية الظاهرة في القرن التاسع عشر، والتي أعادت “المعجزة” الأوروبية إلى عوامل الثقافة والدين كعلل أساسية، متجاهلةً العوامل المادية. وكأن لسان تلك الرواية يقول أن للأوروبيين ثقافةً مميزة، وديناً مميزاً (المسيحية)، كانا السبب الرئيسي وراء نهضتهم، وأن الأمة التي لم يوفقها الحظ لكي تكون إبنةً لتلك الثقافة وذلك الدين، فلن يكون لها نصيب من النهوض والتقدم.
سخر “أمين”، ذو التوجه الماركسي، من تلك الرواية، مشدداً على أولوية العوامل المادية في توليد ظاهرة تاريخية كبرى مثل ظاهرة الحداثة، برؤاها ومؤسساتها. ينتقد “أمين” تلك الرواية التي تبنت أسطورةً، تحولت فيما بعد إلى ثقافة يقينية مترسخة في عقول الأوروبيين…وما زالت مترسخة حتى هذه اللحظة. يصف “أمين” تلك المركزية الأوروبية، ذات النزعة الإثنية، بالشراسة التي ليس لها نظير في التاريخ، والتي ظهرت آثارها ليس فقط على الفكر البرجوازي، بل امتدت إلى الفكر الماركسي ذاته، وإلى مثقفي العالم الثالث. وكان من ضمن نتائج تلك المركزية الشرسة، بزوغ الأصوليات الإسلامية كرد فعل منطقي وطبيعي، كما يؤكد “أمين”.
أما “جورج قرم”، فكان ناقداً للرواية الأوروبية –ذات النزعة المركزية النرجسية– التي تجاهلت واقعاً مهماً، كان يسود أوروبا على امتداد القرن الثامن عشر؛ وهو واقع العبقرية الأوروبية في مجالي الموسيقى والأدب، جيث تجلت القيم التنويرية الإنسانية الأوروبية في أسمى معانيها. وقد يلفت “قرم” الانتباه –آسفاً– إلى انحراف أوروربا، منذ القرن التاسع عشر، عن ذلك الإرث الفكري والإنساني والفني؛ إذ تمثل ذلك الانحراف في سقوط أوروبا بأكملها في مستنقع التيارات القومية والعنصرية والإمبريالية والنازية، الأمر الذي أفضى إلى حتفها عبر حربين عالميتين، في النصف الأول من القرن العشرين. وكانت نتيجة ذلك فقدان أوروبا مكانتها السياسية الرائدة في العالم – على مدى 600 عام – لينتهي بها الحال لكي تصير تابعاً ملحقاً بالغرب أو الولايات المتحدة.
لم تُفقد تلك النقلة أوروبا مركزيتها ونرجسيتها فقط، بل أفقدتها أيضاً أساطيرها التي كانت تتفنن في سرد فرادتها وخصوصيتها وإعجازها ووحدتها. وهكذا تحول الوعي الأوروبي –بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية– من أسطورة أوروبا الموحدة إلى أسطورة الغرب التي تدعي أن الغرب (أمريكا) هو صانع القيم. وهي أسطورة أشد وطأة من الأسطورة الأوروبية، كما يفترض “قرم”. فقد تخلصت أوروبا من أزعومات النرجسية الأوروبية في القرن التاسع عشر، لتسقط فيما هو أشر وأبغض، ألا وهو الأسطورة الأمريكية الجديدة أو النيوليبرالية.
وكما يبين مؤلف الكتاب، يعتمد “قرم” –في نقده– على محاكمة ومساءلة أوروبا من خلال قيمها وثقافتها الإنسانية التنويرية التي تمثلت في الإعجاز الموسيقي والأدبي على امتداد القرن الثامن عشر؛ فهو إذاً ينتقد الحداثة باسم الحداثة، ومن داخل معطياتها الفكرية. كما يعتمد نقده على تفكيك أساطير أوروبا النرجسية، والبحث في أصولها الثقافية المؤسسِة لها. فتلك الأساطير كانت نتاج عمل مستمر من قبل مفكرين أوروبيين كُثُر، كانوا سبباً رئيسياً وراء إثارة النزعات العنصرية والقومية والنازية لدى القادة السياسييين الأوروبيين الذين انتهى بهم الحال إلى تدمير أوروربا في القرن العشرين، وإفقادها مركزيتها.
كما يتضح لنا، عبر القراءة في الكتاب، يضرب المؤلف بقوة في صرح الاستشراق، مستعيناً بمجموعةٍ من النهضويين العرب الذين قاموا بنقد الاستشراق من زوايا متباينة، ومن وجهات نظر مختلفة. اجتهد كل نهضوي عربي، من تلك المجموعة، في تسليط الضوء على عنصر معين: منهم من سلط الضوء على موضوع العلاقة بين المعرفة والسلطة والأيديولوجيا؛ ومنهم من سلط الضوء على الأصول الأوروبية لنظرة الغربي إلى الشرق؛ ومنهم من سلط الضوء على المنهج الكلاسيكي التقليدي المُستخدم من قبل المستشرق الأوروبي؛ ومنهم من سلط الضوء على موضوع المركزية الأوروبية في الفكر الاستشراقي.
ونظراً لاختلاف تخصصاتهم وانتماءاتهم الفكرية، اختلفت مداخل النقد للحداثة. فاليساري الاشتراكي، مثل “أنور عبد الملك”، كان نقده من مدخل الأيديولوجيا، حيث نقد العلاقة بين المعرفة الاستشراقية والمؤسسة الأنجلو ساكسونية الغربية. والمؤرخ، مثل “عبد الله العروي”، كان نقده من مدخل المنهجية التاريخية، حيث نقد منهجية المستشرق في دراسة تاريخ العرب والإسلام. والماركسي، مثل “سمير أمين”، كان نقده من مدخل المادية، حيث نقد فكرة إرجاع حدوث النهضة الأوروبية إلى عوامل الثقافة والدين، مؤكداً على أولوية العوامل المادية في هذا الصدد.
النهضويون العرب والاستشراق: كيف بدأت العلاقة؟
يبدأ المؤلف كتابه بعرض كيفية نشوء العلاقة بين النهضويين العرب والاستشراق. وهي علاقة، كما وصفها المؤلف، شابها الانبهار من الوهلة الأولى؛ انبهار مقرون بهزةٍ عقلية ونفسية، انتابت النهضويين العرب نتيجة تعرضهم لمعارف وأدوات جديدة على أيدي الأوروبيين. لقد كان تحدياً فكرياً –بل كانت مفاجأة– بالنسبة للنهضويين العرب، أن يكتشفوا ويدركوا سعة معرفة الأوروبيين بالإسلام والمسلمين والعرب، أكثر مما يعرفه العرب والمسلمون عن ذاتهم.
تولد ذلك الانبهار الفكري عبر اطلاع مباشر على بحوث ونصوص المستشرقين في دراسة التراث العربي الإسلامي، ثم عبر التلمذة المباشرة للمستشرقين، حيث تأثر كل من التيارين الإسلامي والليبرالي. كلتا الوسيلتين –التلمذة النصية غير المباشرة والتلمذة المؤسسية المباشرة– أفضتا إلى إيجاد علاقة انبهار من قبل النهضوي العربي تجاه المستشرق الأوروبي.
وكان من آثار ذلك الانبهار، أن تحول الاستشراق إلى مثال علمي مرجعي في دراسات التراث الإسلامي عند النهضويين العرب، وأن يتأثر النهضوي العربي برؤى وإشكالات ومناهج المستشرق الأوروبي؛ فيتبناها ويستبطنها كاملةً، ويتماهى معها مثلما حدث بين النهضوي العربي “فرح أنطون” و”إرنيست رينان Ernest Rennan “. لقد صار النهضوي العربي يكتب من داخل الأطر الاستشراقية، مستبدلاً مناهجه الشرقية التقليدية (الاستعراض والتلخيص والشرح) إلى مناهج غربية متنوعة، مثل مناهج النقد التاريخي، والتاريخي المقارن، والتأويلي الحديث.
إلا أن ذلك الانبهار لم يدم طويلاً، فسرعان ما تغير الحال مع الجيل النهضوي الثاني من التيار الإصلاحي الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر؛ وهو الجيل الذي بدأ المناظرة مع المستشرقين؛ حيث تمثلت أبرز مناظراته في مناظرتي “إرنيست رينان – جمال الدين الأفغاني” و “هانوتو – محمد عبده”. وقد توالت حلقات تلك المناظرات حتى بلغت أوجها مع الجيل النهضوي الخامس، في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو جيل الليبرالية العربية في مصر خاصة.
كان أساس تلك المناظرات –والذي ظل قاعدةً راسخةً لكل المواقف النقدية للنهضويين العرب فيما بعد– المدافعة عن الإسلام باعتباره مؤيداً للعلم، لا مناهضاً له، وكذلك المدافعة عن الأمة العربية باعتبارها صالحةً لعلوم ما وراء الطبيعة.
ولم تقتصر المناظرات على النهضويين الإسلاميين فقط، بل امتدت أيضاً إلى نظرائهم الليبراليين، أبرزهم “طه حسين” و”مصطفى عبد الرازق”. فأما “طه حسين”، فتمثل نقده في رفضه نزعة تبجيل التراث الإسلامي من قبل المستشرقين، ونفيه ما يفترضونه عن كون “ابن خلدون” مؤسس علم التاريخ ومؤسس علم الاجتماع؛ إذ لا يجوز –بحسب رأيه– الخلط بين علم التاريخ وعلم الاجتماع كما فعل “ابن خلدون”.
وأما “مصطفى عبد الرازق”، فكان نقده منصباً على ظاهرة التمييز العرقي في البحث الاستشراقي؛ تلك الظاهرة التي كانت من صنع علماء اللغة الأوروبيين في القرن التاسع عشر. كذلك كان نقده لمسلك الباحثين الغربيين في التعامل مع الفلسفة الإسلامية، حيث كان سعيهم دائماً وأبداً نحو استخلاص عناصر غربية من تلك الفلسفة، ليؤكدوا زوراً وبهتاناً عدم أصالة تلك الفلسفة.
إلا أنه على الرغم من جميع تلك المناظرات، وذلك النقد، فقد كان هناك اعتراف واضح من قبل النهضويين العرب –بجميع تياراتهم الفكرية– بسبق المستشرقين؛ بل كان أثر الاستشراق متجلياً في رؤاهم ومنطلقاتهم. وعلى الرغم من تباين المحطتين – الانبهار والنقد – إلا أنهما يجتمعان في النهاية على الاعتراف بالنصوص الاستشراقية، والشهود لها، كما يؤكد المؤلف.
ويفرد المؤلف فصلاً كاملاً عن النهضوي العربي “عبد الرحمن بدوي” كنموذج بارز للتماهي والتمايز، في آنٍ واحد، مع الاستشراق. فهو أحد رموز الجيل النهضوي العربي المتأخر الذي نما وعيه في حقبة ما بين الحربين العالميتين، ودخل ميدان الكتابة في ثلاثينيات القرن العشرين. وهو أفضل نهضوي عربي نقل عن الاستشراق. فكان من أعظم إسهاماته، العلمية والبحثية، تقديم خدمة معرفية كبيرة للقاريء العربي عبر ترجماته العديدة لنصوص الاستشراق، في وقتٍ أضحت فيه الترجمة المتخصصة شحيحة. ومن ضمن إنجازاته أيضا، تأليف “موسوعة الاستشراقيين” التي قدم فيها مئات المستشرقين، بمعلومات تفصيلية عن حياتهم، وعن أعمالهم وكتاباتهم.
كانت ترجمة “بدوي” ترجمةً مصحوبةً برؤيته وتأليفه. فكان ينتقي النصوص التي تفصح عن رؤيته الهادفة نحو تصحيح الصورة النمطية المغلوطة المترسخة في الوعي العربي عن المستشرقين، ومن ثم إعادة الاعتبار إلى الاستشراق، الأمر الذي أوصله إلى درجة عالية من التماهي والتقمص مع النص الاستشراقي، ومحو المسافة بينه وبين المستشرق، حتى صار هو وهم سواء، كما يشير مؤلف الكتاب.
وقد يعود ذلك التماهي إلى اتصاله مباشرةً بالاستشراق عن طريق تلمذته للمستشرقين في جامعات عربية وأوروبية، كذلك تلمذته على أيدي أساتذة كانوا تلامذة لدى المستشرقين، مثل “طه حسين” و”أحمد أمين” و”مصطفى عبد الرازق” الذين حملوا جميعاً نظرة ليبرالية إلى تاريخ الإسلام الثقافي. إلا أن كل ذلك التماهي لم ينف وجود نقد واضح للمستشرقين في كتابات “بدوي”. فمنذ شبابه، وهو ينتقد افتقارهم للنزاهة والأمانة في نقل النصوص.
الاستشراق والمؤسسة: علاقة المعرفة بالسلطة
الإطلالة على الاستشراق من مدخل إشكالية العلاقة بين المعرفة والمؤسسة –أي العلاقة بين المعرفة الاستشراقية والمؤسسة الكولونيالية التي تفرز تلك المعرفة– كانت منهجاً جديداً لنقد الاستشراق؛ منهجاً أسسه وقاده “أنور عبد الملك” المنتمي إلى تيار الحداثة في الفكر العربي. فهو أول من دشن ورشةً لقراءة نقدية لتراث الاستشراق؛ معلناً رفضه القاطع لتسلط وسطو المؤسسة الأنجلو سكسونية الاستعمارية على المعرفة المتعلقة بالشرق.
وأيضاً، هو أول من تحدث عن “أزمة” الاستشراق التقليدي وتهافته بعد انتهاء حقبة السيطرة الغربية، وانتهاء الوصاية العلمية والسطو الأجنبي على التاريخ والماضي والتراث والذاكرة الجماعية للمسلمين. وكذلك طعنه في مناهج الاستشراق التقليدي الذي يتناول فقط ماضي الأمم الشرقية وليس حاضرها، والذي يفصل الدين واللغة عن التطور الاجتماعي، والذي يدرس التاريخ باعتباره بنيةً مغلقةً يجري إسقاطها على الحاضر.
فبعد حلول حقبة التحرر الوطني، والصعود القومي في النصف الثاني من القرن العشرين، كما يؤكد “عبد الملك”، بدأت سيادة الاستشراق التابع للمؤسسة الكولونيالية الإمبريالية في الاضمحلال تدريجياً، نتيجةً لليقظة المعرفية للمُستَعمَر، سواءً كان صينياً أو هندياً أو عربياً أو إسلامياً، ورغبته الملحة نحو إعادة قراءة تاريخه وتراثه القومي؛ وكذلك نتيجةً للثورات المنهجية الجديدة في مجال العلوم الاجتماعية الإنسانية في القرن العشرين.
وفي هذا الصدد، يشير المؤلف إلى الفارق الأيديولوجي فيما بين النهضويين العرب؛ وهو الفارق الذي كان عاملاً أساسياً لتغيير النظرة نحو الاستشراق. فمعظم النهضويين العرب في أثناء فترة الاستعمار كانوا ليبراليين، بينما انتمى أغلب النهضويين العرب في حقبة التحرر الوطني إلى التيار الاشتراكي الحداثي الوطني والقومي واليساري.
وكما انتقد “عبد الملك” الاستشراق التقليدي المرتبط بالمؤسسة الكولونيالية الأنجلو سكسونية في فترة الاستعمار، فقد انتقد أيضاً الاستشراق الجديد الظاهر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ وهو الاستشراق الأمريكي في الفضاء الرأسمالي الذي يتجاهل المصادر والدراسات العربية الحديثة.
ومن قراءته في منهج “عبد الملك” النقدي، يلحظ المؤلف الانحياز الأيديولوجي الواضح لـ”عبد الملك” ضد الإمبريالية الغربية الرأسمالية، وانحيازه في المقابل للمعسكر الاشتراكي؛ وهو ما يفسر تماهيه الكامل مع الاستشراق الاشتراكي الناقد للمركزية الأوروبية، والخادم لشعوب الشرق في كفاحها ضد الإمبريالية، وهو ما رآه المؤلف انحيازاً أيديولوجياً واضحاً مفتقداً للموضوعية.
فاختزال “عبد الملك” ميدان الاستشراق الواسع إلى مجرد أداة من الأدوات الثقافية التي يوظفها المشروع الكولونيالي لخدمته، وتركيزه فقط على العنصر الأيديولوجي دون دراسة الاستشراق من الداخل في مضمونه الفكري والمعرفي والعلمي، وإحجامه عن البحث في العلاقات بين الاستشراق السوفياتي- الأوروبي الشرقي وإستيراتيجيات الدولة السوفيتية….كل ذلك أدى به إلى الوصول لنتائج أيديولوجية أكثر منها نتائج علمية موضوعية. ولو كان “عبد الملك” أمعن النظر فيما أحجم فيه، لوجد أن الاستشراق الاشتراكي مرتبط أيضاً بالمؤسسة السوفياتية والمشروع السوفياتي، كما يفيد المؤلف.
“إدوارد سعيد” مستأنفاً مشروع “عبد الملك”
استأنف “إدوارد سعيد” مشروع “عبد الملك” في نقد العلاقة بين المعرفة والسلطة التي يراها جامعةً بين جميع تيارات المستشرقين؛ إنها علاقة القوة التي تفرض خطاب السيطرة الذي يسخر الاستشراق للمؤسسة الكولونيالية، والذي يمنع مستشرقين كُثر من البحث بنزاهةٍ ومصداقية وحرية. إنها علاقة “التكييف العلمي” من أجل تحقيق مصلحة المحتل. إنها تلك العلاقة التكاملية بين المستشرق والمحتل، حيث يقدم المستشرق المعرفة عن الشرق ليقوم المحتل بالتحكم فيه، كما يؤكد “سعيد”.
ويتضمن خطاب السيطرة –والكلام لـ”سعيد”– النظرة الدونية للشرق باعتباره جزءاً من تاريخ الغرب؛ فيصير تاريخ الشرق في منزلةٍ أدنى مقارنةً بتاريخ الغرب؛ ويصير الشرقيون مجرد إشكاليات –لا أشخاص أو آدميين مثل بقية البشر– تحتاج إلى حلول غربية. تلك هي النظرة الدونية المُستبطنة لدى المستشرق، حتى وإن لم يفصح عنها. وقد يُرجع “سعيد” تلك النظرة إلى العصور الوسطى، حيث تكونت صور نمطية عدائية في المُتخيل الغربي عن الشرق.
لقد صب “سعيد” نقده على الاستشراق الأيديولوجي البريطاني الفرنسي الأمريكي الذي خالف معايير الموضوعية والعلمية والتاريخ والاقتصاد؛ إلا أنه لم ينف رغماً عن ذلك الأدوار التأسيسية لـ”سلفستر دو ساسي” و”إرنيست رينان” و”إدوارد لين” في بناء صرح ميدان الاستشراق. فرُغماً عن عنصريتهم الواضحة ضد السامية، وعن علمهم المتبحر المقرون بالعنصرية، وعن لغتهم الإطلاقية، وعن اعتمادهم المباشر على النصوص لا على العلاقة المباشرة مع الشرق، إلا أن دورهم لم يستطع “سعيد” إنكاره.
كذلك لم ينكر وجود أعمال أدبية متعاطفة مع الشرق، ومعترفة بتميزه؛ حتى وإن كانت شحيحة جداً، إذا ما قارناها مع الكتابات النمطية عن الشرق. وقد تناول “سعيد” في ذلك أثر العوامل النفسية والشخصية في تنمية الهواجس بالشرق، سواءً عند السياسي أو الباحث أو الأديب الأوروبي، مقراً بوجود ولع واضح بالشرق من قبل المستشرق والمحتل سواء.
ونقد “سعيد” للاستشراق الأمريكي له خصوصيته؛ فهو ليس استشراقاً نابعاً من داخل بيئات علمية وفلسفية مألوفة في أوروبا، كما كان الوضع مع الاستشراق البريطاني الفرنسي؛ إنما هو مجرد موقف أداتي، وعلم اجتماع متخصص، يتم تطبيقه على الشرق دون دراية أو معرفة؛ وهو الأمر الذي أفضى إلى تشويه الحقائق وتدهور علم الاستشراق. وما شيطنة الإسلام، منذ مطلع السبعينيات، وإقامة المناظرات المغلوطة ضده، إلا دليلاً صارخاً عن ذلك التدهور.
ويأخذ المؤلف على “سعيد” اختزاله الاستشراق إلى استشراق كولونيالي بريطاني فرنسي أمريكي، دون النظر أو الالتفات إلى تيارات علمية أخرى كانت ألمانيا بيئتها الحاضنة. إن نظرة “سعيد” مهدت –بكل أسف– نحو تكوين صورة نمطية عن الاستشراق في الوعي العربي، مضادة للصورة النمطية عن الإسلام في الوعي الغربي.
نقد الفكر الأوروبي
ركز “هشام جعيط” على نقد الفكر الأوروبي من داخل أوروبا، متناولاً الأصول الأوروبية لنظرة الغرب، مهتماً بتحليل المعرفة الغربية موضوعياً دون مساجلتها، كما فعل “سعيد”. فمن داخل التاريخ العقلاني الأوروبي، ومن داخل قيم التسامح والتنوير التي شهدتها أوروبا في عصر النهضة، انتقد “جعيط” الوجه الظلامي الأوروبي المتمثل في العنصرية والإقصاء.
أرجع “جعيط” المعرفة الغربية المتحيزة ضد الإسلام إلى صورة الإسلام المتخيل، ودور اللاهوتيين الأوروبيين -في العصور الوسطى– في تدشين تلك الصورة المُفتعلة. وهي صورة تترسخ أكثر في الوعي الشعبي الأوروبي الناتج عن التجربة الصليبية، أكثر منه في الوعي المدرسي العقلاني الناتج عن المواجهة الإسلامية المسيحية في أسبانيا. وهي صورة “زاخرة بعنصر التخيل والجنوح إلى التهويل والشيطنة”، والافتقار إلى المادة الواقعية.
وتسيطر تلك الصورة الشعبية، بكل أسف، على المدرسة “العقلانية” التابعة للاهوتيين والمؤلفين الأوروبيين؛ فيصير الوعي الجمعي الأوروبي متأرجحاً في النهاية بين العقلانية التي تعترف بالفتوحات العلمية والفلسفية للإسلام، دون الاعتراف به كدين وأخلاق، وبين العدائية الشعبية الشيطانية للإسلام كله، دون الارتكاز على أية دلائل واقعية، وإنما الارتكاز فقط على تخيلات لا أصل لها. وتصير تلك الرؤية العدائية لازمةً من لوازم النظر إلى الإسلام لدى الأوروبيين منذ القرون الوسطى حتى اللحظة الراهنة. فـ”حين يختلط الجهل بالعداء، تتكون في الوعي أشد الصور المتخيلة سوءاً أو شططاً”.
إلا أن تلك الصورة –كما يقول “جعيط”– شهدت تراجعاً تدريجياً بعد دخول أوروبا في عصر النهضة والحداثة، وتحرر النظرة العلمانية في أوروبا من الضغط المسيحي، والاعتراف التدريجي بالإسلام كجزء من الحياة الإنسانية. وكان القرن الثامن عشر خير ممثل لذلك التراجع، حيث ساد تيار الرومانسية الذي شهد فضولاً علمياً معرفياً أوروبياً بالشرق. لكن سرعان ما عاودت الصورة القديمة الظهور مرة أخرى مع حلول القرن التاسع عشر؛ القرن الإمبريالي بامتياز، حيث سادت تيارات الإمبريالية والرأسمالية والقومية والعنصرية والعلمانية؛ فأضحى الإسلام موضوعاً للسيطرة والاحتقار.
وكان من أهم ما أثار حفيظة ونقد “جعيط” للمستشرقين، خلطهم بين السلطة الأكليركية وسلطة الفقهاء، وزعمهم المغلوط في كون الإسلام كابحاً للعلم والعقل مثلما فعلت المسيحية؛ وكذلك غلقهم للإسلام في شرنقة المواجهة مع الغرب، وقراءة حركته بوصفها مجرد “انعكاس شاحب ومعكوس لتاريخ الغرب”، وأيضاً محاكتهم لتجربة الإسلام انطلاقاً من التجربة المسيحية، ومنح أنفسهم الحق في الحكم عليه، وأخيراً إصرارهم على النيل من أصالة الفكر الإسلامي.
وإذا كان “جعيط” قد انتقد الفكر الأوروبي من داخل أوروبا، فقد نقد “محمد أركون” الفكر الأوروبي نقداً معرفياً ومنهجياً؛ نقداً للخلل في المناهج التي استخدمها المستشرقون في بناء معارفهم عن الشرق والإسلام؛ نقداً للعقل الوضعي العلماني الذي لا يعترف بنوعية المعرفة التي يقدمها الدين؛ نقداً للمناهج الفيولوجية الكلاسيكية في تحقيق النصوص الموروثة منذ القرن التاسع عشر، وإحجام تلك المناهج عن الانفتاح على مكتسبات العلوم الإنسانية المعاصرة.
وقد أسس “أركون” نقده على أربعة مستويات: 1) هامشية المسألة الدينية في السياق العلماني؛ 2) تجاهل الإسلام وتهميشه في الدراسات الغربية مقارنةً بالديانات التوحيدية الأخرى؛ 3) تأثير المتخيل الغربي الموروث عن الإٍسلام في بناء المعارف الحديثة في الأوساط الدراسية؛ 4) تخلف وقصور المناهج المطلقة من قبل الدارسين الغربيين لتراث الإسلام.
انتقد “أركون” ظاهرة تهميش الدين في السياق العلماني؛ وهي الظاهرة التي نشأت وتطورت في القرن التاسع عشر نتاجاً عن الانتصارات العلمية بأوروبا. استهجن “أركون” تحويل العلمانية من فكرة سياسية إلى عقيدة فلسفية وأيديولوجية، بل إلى سلطة قهرية جديدة. فهو على الرغم من موافقته على فصل الديني عن السياسي إلا أنه لا يوافق مطلقاً على تحول ذلك إلى ذريعة للقضاء على الدين في المدرسة والمجتمع، مما يورث أجيالاً جديدة من المواطنين منزوعي الذاكرة التاريخية والثقافية.
أما نقده لظاهرة تهميش الإسلام في الدراسات الغربية، فيراها “أركون” ناتجةً عن سياساتٍ غربية ممنهجة، وكذلك عن تجاهل النخب الفكرية الأوروبية المؤدلجة للإسلام. لقد قامت تلك السياسات والنخب باختزال الإسلام من دين وحضارة وثقافة ومجتمعات إلى “حركة أصولية” و” حجاب ولحية” و”إرهاب”. لقد تم حفر ذلك التهميش، منذ العصور الوسطى، في اللاشعور الجمعي الأوروبي. وظل التجهيل المعرفي والثقافي بالإسلام مستمراً منذ العصور الوسطى حتى اللحظة الراهنة. حتى الهاجس العمومي للتعرف على الإسلام، منذ نهاية القرن العشرين، كان بهدف أمني لا ثقافي أو معرفي.
وكذلك كان نقد “أركون” لتأثير المُتخيل الغربي الموروث عن الإسلام –والذي اشترك فيه مع “جعيط”– وهيمنة ذلك المتخيل على التيار العام الغالب في المجتمعات الغربية. فقد يقر “أركون” بقوة المتخيل الغربي عن الإسلام لدرجةٍ تفوق قوة المعرفة العلمية به، ولدرجةٍ باتت فيه المعرفة الاستشراقية مستبطنةً بعض “يقينيات المُتخيل الغربي عن الإسلام”.
وأخيراً، كان المستوى الرابع لنقده متمثلاً في قصور وتخلف المناهج المطلقة التي يستخدمها الدارسون الغربيون لتراث الإسلام. فهي مناهج غير موضوعية، مطلقة الفرضيات، متسمة بالجمود وعدم الانفتاح على العلوم الحديثة. إلا أنه على الرغم من نقده للقصور المنهجي لدى المستشرقين الأوروبيين، فهو يتحسر عليهم إذا ما قارنهم بما حل في العقود الأخيرة على مجال الدراسات الغربية للإسلام، حيث ظهر على الساحة ما يُسمى بالـ”خبراء” الذين يراهم “أركون” عديمي الخبرة والحُجة العلمية والمعرفية مقارنةً بالمستشرقين القُدامى. فصحيح أنهم يتميزون بالتفوق المنهجي، إلا أن حججهم العلمية تتصف بالضعف. ومن العجيب أنه بالرغم من ضعف حُجتهم العلمية، إلا أنهم قادرون على تركيز قوتهم غير العلمية في التأثير على الجماهير والنخب الغربية.
ومن المفارقة الكبرى، كما يدلي “أركون”، أن يظهر هؤلاء “الخبراء” في لحظةٍ أعاد فيها الإسلام طرح ذاته على جدول أعمال السياسة وعلى الصعيد الفكري؛ وكان من أبرز تلك الأطروحات، الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وكما انتقد “أركون” منهاجية المستشرق في تناول تراث الإسلام، فقد انتقد “عبد الله العروي” المنهجية أيضاً، ولكن هذه المرة من مدخل تاريخي. فباعتباره مؤرخاً، كان تركيز “العروي” على نقد منهجية الاستشراق في دراسة تاريخ الإسلام، ومدى نجاعة تلك المنهجية في ميدان الإسلاميات بشكلٍ عام.
لم يكن “العروي” معنياً بإشكالية الأنا والآخر، وإنما كان معنياً بتعامل المستشرق مع تاريخ العرب والإسلام، حيث وجد في ذلك التعامل تحيزاً واضحاً ضد العرب والمسلمين. فالمستشرق، من وجهة نظره، تعامل مع تاريخ العرب والإسلام وفق رؤية سلبية بحتة، لم تر في ذلك التاريخ إلا السلبيات. هذا بالإضافة إلى المنهجية الأرشيفية الفيولوجية المطلقة التي استخدمها المستشرق ليُزيد مزيداً من الظلم والإجحاف بحق تاريخ العرب والإسلام.
صب “العروي” نقده على الاستشراق الأنجلو سكسوني الذي ورث الاستشراق الألماني- الفرنسي ذا التقاليد الفيولوجية الصارمة التي اختزلت تاريخ العرب والإسلام إلى مجرد أشخاص وأرقام وأحداث، دون ذكر السياق والتطور الاجتماعي والحضاري والثقافي، ودون الوقوف على الأفكار والمباديء والقيم من وراء تلك الأحداث والأشخاص والأرقام.
ومن ضمن المنهجيات التي انتقدها “العروي” منهجية “فون غرونباوم Von Gruenbaum” الأنثروبولوجية الثقافية التي يعتريها نقص فادح في الرؤية التاريخية للظواهر المدروسة. فهي منهجية –مثل بقية منهجيات المستشرقين- فاقدةُ للمعرفة والموضوعية والتنزه عن الأغراض الذاتية. وهو الأمر الذي جعل “العروي” يتلمس العذر للوعي العربي الرافض لنوعية تلك المنهجيات التي يطرحها المستشرق عند دراسته لتاريخ العرب والإسلام. وهو الأمر الذي دفعه أيضاً إلى طرح التساؤل الآتي: هل استفادت الرؤية العربية للتاريخ مما قدمه العقل التاريخي الوضعي الغربي؟ وهو التساؤل الذي ظل يجيبه مراراً وتكراراً في ثنايا كتاباته التي أقرت بالنفي القاطع.
ومن نقد المنهج والمنهجية، انتقل بنا مؤلف الكتاب إلى نقد موضوع أساسي ومحوري في أدبيات الاستشراق والحداثة، وهو موضوع “المركزية الأوروبية” الذي تفرد كل من “سمير أمين” و”جورج قرم” في نقده.
نقد المركزية الأوروبية بين “أمين” و”قرم”
كان نقد “أمين” لتلك النقلة النوعية المعرفية الفكرية التي نقلت المركزية الأوروبية من أيديولوجيا علمانية عنصرية –تفترض ولادة أوروبا الحديثة من قطيعة شاملة مع الميراث المسيحي- إلى أيديولوجيا محافظة رجعية تعيد ظاهرة “فرادة المعجزة الأوروبية” إلى عوامل الثقافة والدين باعتبارها العلل الأولى والأساسية في تلك “المعجزة”.
كان نقد “أمين” لتلك “الرواية الثقافوية الثانية” التي أعادت كتابة تاريخ أوروبا على نحو أسطوري، يبرزها كمثال يُحتذى به، والمعتمدة على عوامل الثقافة الأوروبية والدين المسيحي في التفسير الأهم لصعود أوروبا الحديثة.
لقد ولدت الرواية الثانية، كما ورد في كتابات “أمين”، في القرن التاسع عشر كردة فعل محافظة على الفكر التنويري العلماني، وعلى الرواية العلمانية الأولى. وهي رواية، كما يقول “أمين”، تفتقر إلى النظر للعوامل المادية المؤثرة في توليد ظاهرة تاريخية كبرى مثل الحداثة برؤاها ومؤسساتها؛ وهي تلك العوامل التي يراها “أمين”، كمفكر ماركسي، ذات أولوية وأحقية في التفسير. ومن ثم، كان إنكاره لمغالاة المستشرقين في تعظيم دور الإصلاح الديني باعتباره المولد الرئيسي للنهضة الأوروبية. فالأسباب المادية –المتمثلة في انتصار الجيوش الأوروبية وتراكم القوة مع الثروة– هي التي فرضت الوصفة الأوروبية؛ وهي التي فرضت الغربنة، وليس الأسباب الدينية والثقافية.
يصف “أمين” فكرة المركزية الأوروبية بالشراسة؛ فنزعتها التمركزية الإثنية ليس لها نظير في التاريخ. وكان من ضمن شراستها، قدرة منظريها ومفكريها على بناء الأسطورة التي تحولت عبر الزمن إلى ثقافة عامة يقينية ممتدة إلى العامة والنخبة سواء. بل كان من ضمن شراستها أيضاً، نقل مفكريها نظرية التصنيف الحيواني في علم البيولوجيا إلى مجال الإنسانيات؛ فيُصنف البشر على حسب أعراقهم وألوانهم وأشكالهم.
ومما يثير حفيظة “أمين”، توغل آثار فكرة المركزية الأوروبية وهيمنتها، ليس فقط على الفكر البرجوازي، بل أيضاً على الفكر المناهض للفكر البرجوازي؛ مثل الفكر الماركسي الغربي، والفكر العربي في العالم الثالث. وهي الظاهرة التي أسماها “أمين” المركزية الأوروبية المعكوسة.
وكما حاول “أمين” تفكيك الأسطورة الأوروبية، حاول “قرم” أيضاً تفكيك تلك الأسطورة، ولكن من داخل معطياتها الفكرية، وبإسم الحداثة ذاتها. لقد اجتهد “قرم” في نقد “السرديات المؤسطرة” التي تزعم وجود أوروبا موحدة منذ عصر النهضة، والتي تزعم ارتباط تقدم أوروبا بالعبقرية المسيحية.
ركَز “قرم” – الذي لا ينتمي إلى تيار الأصالة ولا إلى تيار ما بعد الحداثة – على البحث في الأصول الثقافية المؤسِسة لتلك الأساطير، ملقياً كل اللوم على المفكرين الأوروبيين الذين أنتجوا ورسخوا تلك الأصول في الوعي الجمعي الأوروبي، والذين دشنوا نظريات التمييز والعرقية والعنصرية التي تفتقت عنها أساطير التفوق الأوروبي، والتي قادت إلى حتف أوروبا على يد القادة السياسيين الذين تشبعوا –حتى النخاع– بتلك النظريات والأساطير.
ويأسف “قرم” على تجاهل الرواية الأوروبية للعبقرية الأوروبية المتجلية في ميادين الفنون والآداب والموسيقى؛ تلك العبقرية التي كانت تمثل المسار الإنساني الأنواري السائد في أوروبا في القرن الثامن عشر، والتي كانت تمثل ميراثاً ضخماً في الفن والإبداع. ويأسف “قرم” على انحراف أوروبا القرن التاسع عشر والقرن العشرين عن ذلك المسار، وعلى ارتدادها عن ذلك الميراث، وانحطاطها إلى الغرائز والمصالح الأنانية الضيقة، الأمر الذي أوجد أوروبا مناقضةً لأوروبا التنوير. إن “قرم” -من خلال ذلك – يحاسب ويسائل الثقافة الأوروبية؛ يحاسب أوروبا من داخلها.
وقد أفضى انحراف أوروبا عن مسارها التنويري إلى سقوطها كلها –وليس ألمانيا فقط– في براثن النازية والعنصرية والعنف والإمبريالية، ابتداءً من القرن التاسع عشر حتى الربع الأول من القرن العشرين. وقد لفت انتباه “قرم” كيف تحولت الأمة الألمانية من أمة “ميتافيزيقية بامتياز” إلى أمة العنف والحرب. وكانت نتيجة ذلك الانحراف انتهاء سيادة أوروبا –بعد الحرب العالمية الثانية– وبداية وصاية الولايات المتحدة الأمريكية التي أسست أسطورة جديدة؛ وهي أسطورة أمريكا الصانعة للقيم.
وهي أسطورة – برأي “قرم” – لا تقل شراً وبغضاً عن سابقتها، الأسطورة الأوروبية. بل هي أشر وأبغض؛ حيث جاءت تلك الأسطورة الأمريكية الجديدة مُحملة بالأفكار الليبرالية الجديدة التي قامت بتوظيف الدين في البنى والمؤسسات الحديثة، والتي قامت بتقديس نظام التبادل زاعمةً أنه يقدم الخلاص الجماعي والفردي، بينما هو يقدم في الحقيقة المصالح الأمريكية التوغلية التوسعية الاحتلالية.
ويتساءل “قرم” في نهاية بحثه: هل من سبيل إلى تحرير أوروبا من جديد، وإعادتها إلى أوروبا الإنسانية الكونية، لا إلى أوروبا المنغلقة على أساطيرها النرجسية؟ وينتهز “قرم” الفرصة هنا، مُطلقاً دعوته إلى الكونية، وتحرير العالم من أية نزعة مركزية أو نرجسية حضارية، تؤسس لتقسيم الإنسانية إلى منازل ومراتب. إن “قرم” يدعو باختصار –على شفا نقده للحداثة– إلى الخروج من نظام الغريزة والعدوان إلى نظام العقل والتفاعل الخلاق بين جميع الثقافات والقوميات، لتعترف جميعها بالمشترك الإنساني الجامع.
وختاماً…
يمكننا القول، إجماع معظم ناقدي الحداثة على انحطاط ورداءة الاستشراق الأمريكي مقارنةً بالاستشراق الأوروبي، وكذلك على انحطاط العصر الأمريكي الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، مقارنةً بالعصر الأوروبي الذي استمر طيلة ستة قرون.
كما يلفت النظر أيضاً، تطرق معظمهم إلى نقد مناهج المستشرقين في دراسة تراث الإسلام، ووصفها بالتحيز وانعدام النزاهة والموضوعية. وأخيراً، اتفاق معظمهم على دور كلٍ من الأسطورة والخيال الأوروبي المريض والجهل الممزوج بالعداء غير المنطقي في صناعة الرؤية الغربية عن الإسلام، واستمرار تأثيرها – على المجالين الشعبي والأكاديمي على حد سواء – حتى اللحظة الراهنة.
عرض وتقديم
د. شيرين حامد فهمي
دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies