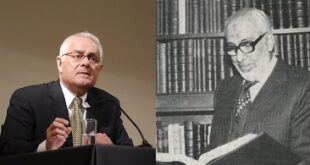الأخلاق والدين*
علي عزت بيجوفيتش
لا يمكن بناء الأخلاق إلا على الدين، ومع ذلك فليس الدين والأخلاق شيئاً واحداً. فالأخلاق كمبدأ، لا يمكن وجودها بغير دين، أما الأخلاق كممارسة أو حالة معينة من السلوك، فإنها لا تعتمد بطريق مباشر على التدين. والحجة التي تربط بينهما معاً هو العالم الآخر.. العالم الأسْمى.. فلأنه عالم آخر هو عالم «ديني»، ولأنه أسمى، فهو عالم «أخلاقي». وفي هذا يتجلى استناد كل من الدين والأخلاق أحدهما إلى الآخر، كما يتجلى استقلال كل منهما عن الآخر. في علاقة التساند هذه يوجد نوع من الثبات الجوّاني، وهو ثبات ليس آليًا رياضيًا أو منطقيًا، وإنما ثبات عملي، قد يتشعب هنا أو هناك، ولكن سرعان ما تستعيد علاقة التساند نفسها عاجلاً أو آجلاً. يؤدي الإلحاد إلى إنكار الأخلاق، ولكن أي بعث أخلاقي حقيقي يبدأ دائمًا بيقظة دينية، فالأخلاق إنما هي دين تحوّل إلى قواعد للسلوك، يعني تحول إلى مواقف إنسانية تجاه الآخرين وفقًا لحقيقة الوجود الإلهي. فإذا كان لزامًا علينا أن نحقق واجباتنا الأخلاقية – بصرف النظر عما نواجه من مصائب أو مخاطر – (وهذا يعتبر سلوكًا أخلاقيًا متميزاً عن السلوك الذي تحفز إليه المصلحة)، فإن هذه الدعوة لا يمكن تبريرها إذا كان هذا العالم هو العالم الوحيد، وإذا كانت حياتنا فيه هي الحياة الوحيدة. وهنا تبرز نقطة الانطلاق لكل من الدين والأخلاق.
لقد ولدت الأخلاق مع المحرّمات ولا تزال كذلك إلى اليوم. والمحرّمات دينية في طبيعتها وفي أصلها. ولا ننسى أن ثماني من الوصايا العشر في «التوراة» محرمات. الأخلاق دائمًا مبدأ تقييد أو تحريم يناقض الغريزة الحيوانية في طبيعة الإنسان.
إن تاريخ الدين حافل بهذه المحرمات التي تبدو كأنها بلا معنى. ولكن من وجهة نظر الأخلاق، لا توجد محرمات بغير معنى. وبطبيعة الحال، يمكن وجود معنىً عقلانيّ للمحرم، ولكن ليست المنفعة هي الهدف الجوهري للمحرم على الإطلاق.
الأخلاق هي على الأرجح الحياة ضد الطبيعة، بشرط أن تكون كلمة «طبيعة» مفهومة بمعناها الصحيح([1]). الأخلاق كالإنسان هي أيضًا لاعقلانية.. لا طبيعية، بل (فوق – طبيعية). فلا يوجد إنسان طبيعي ولا أخلاق طبيعية. فالإنسان في حدود الطبيعة ليس إنساناً، بل هو على أحسن الفروض حيوان ذو عقل. وكذلك الأخلاق – محدودة بالطبيعة – ليست أخلاقًا إنما على الأرجح شكل من أشكال الأنانية.. أنانية حكيمة مستنيرة.
عند «داروين» في الصراع من أجل البقاء لا يفوز الأفضل (بالمعنى الأخلاقي)، الأقوى والأفضل تكيُفًا هو الذي يفوز([2]). ولا يؤدي التقدم البيولوجي -هو الآخر – إلى سمُوّ الإنسان باعتباره أحد مصادر الأخلاق. فإنسان «داروين»، قد يصل إلى أعلى درجات الكمال البيولوجي (السوبرمان) أو الإنسان الأعلى، ولكنه يظل محرومًا من الصفات الإنسانية، ومن ثم محرومًا من السمّو الإنساني. فالسمو الإنساني لا يكون إلا هِبَةً من عند الله.
والتقدم الاجتماعي، كامتداد للتقدم البيولوجي، يحتفظ بعلاقة مماثلة مع الأخلاق. فقد تساءل «ماندفيل» أستاذ علم الأخلاق الإنجليزي: «ما أهمية الأخلاق لتقدم المجتمع والتطور الحضاري؟» وأجاب ببساطة: «لا شيء، بل لعلها تكون ضارة»([3]). عند «ماندفيل» جميع الوسائل التي يقال عنها عادةً أنها وسائل آثمة لها أكبر الأثر في حفز المجتمع على التقدم، حيث “أن كل ما يزيد من احتياجات الإنسان هو أكبر ما يعزز تطوره». ولكي نكون أكثر تحديدًا نقول: «إن ما يُزعم بأنها شرور أخلاقية ومادية في هذا العالم هي القوى الأساسية المحرّكة التي تجعل منا كائنات اجتماعية».
فإذا كان كل تقدم بيولوجي أو تقني يُستمد من نظرية «داروين» في الاختيار الطبيعي حيث يقهر الأقوى الأضعف بل ويحطمه، فلا بد أن تقف الأخلاق ضد النقطة الأساسية في التقدم. ولقد كانت الأخلاق ولا تزال تدعو إلى حماية الأضعف والأقل مقدرةً، وإلى الإشفاق عليه والعناية به. وهكذا، كانت الأخلاق والطبيعة في تصادم منذ البداية. (هذا هو صوت الطبيعة): «تخلّص من الضّمير ومن الشفقة والرحمة. تلك المشاعر التي تطغى على حياة الإنسان الباطنية. اقهر الضعفاء واصعد فوق جُثثهم..»([4]).
الاختلاف عن الأخلاق هنا واضح وتام: حطَّم الضعفاء بدلاً من إحْم الضعفاء.. هاتان الدعوتان المتعارضتان تفصلان البيولوجي عن الروحي، الحيواني عن الإنساني، الطبيعة عن الثقافة، والعلم عن الدين. وكل ما فعله «نيتشه» أنه طبّق بثبات قوانين علم البيولوجيا ونتائجها على المجتمع الإنساني([5]). وكانت النتيجة نبذ الحب والرحمة وتبرير العنف والكراهية. والمسيحية عند «نيتشه»، وبخاصة الأخلاق المسيحية، «هي السمّ الزعاف الذي غُرس في الجسم القوي للجنس البشري..».
يتحدث أفلاطون في “محاورة فيدون” عن الخُلق الأصيل، فيقول: «إن الشجاعة العادية ليست إلا جُبنًا، والاعتدال العادي ليس إلّا شهوة خفية للذّة، هذا النوع من الفضيلة ما هو إلا تجارة.. شبح فضيلة أو فضيلة العبيد. أما الإنسان الأخلاقي على الوجه الصحيح، فيتملّكه شوق واحد: أن ينأى بنفسه عن المادّي وأن يلتصق بما هو روحي. الجسم قبر للروح، والروح في قيدها الأرضي لا يمكن أن تصل إلى غايتها. والمعرفة الحقيقية لا تأتي إلا بعد الموت، وهذا هو السبب في أن رجل الأخلاق لا يهاب الموت. فلكي تحيا وتفكر حياة وفكرًا حقيقيين معناه أن تستعد دائمًا للموت. إنّ الشر هو القوة التي تحكم هذا العالم، وليست الأخلاق إمكانية طبيعية للإنسان ولا يمكن إقامتها على العقل»([6]).
ومن الناحية التاريخية، يعتبر الفكر الأخلاقي من أقدم الأفكار الإنسانية، ولا يسبقه سوى الفكر الديني الذي هو قديم قدم الإنسان نفسه. وقد التحم الفكران معاً خلال التاريخ. ففي تاريخ علم الأخلاق، لم يوجد عملياً مفكر جاد لم يكن له موقف من الدين، إما عن طريق استعارة الضرورة الدينية كمبادئ للأخلاق، أو عن طريق محاولة إثبات العكس. ولذلك، يمكن القول بأن تاريخ علم الأخلاق بأكمله قصة متّصلة لتشابك الفكر الديني والأخلاقي.
ظهر ما يسمى بحركة الأخلاق العَلْمَانية التي تؤكد على استقلالية الأخلاق عن الدين([7]). ومع ذلك، فهذه الحركة نفسها تكشف لنا أن كل فكر أو نشاط أخلاقي لا بد أن ينحو بطبيعته صوب الدين أو يتطابق معه. وعلى أي حال، فإن ما يبدو من تناقض في مسلك هذه الأفكار وتأرجحها بين العلم والدين ظاهرة في غاية الأهمية (تستحق منا الدراسة). ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما حدث في المدارس الفرنسية – حيث حَلّ التوجيه الخلقي محل التوجيه الديني – نجد أن الكتب المدرسية في هذا المجال تتبع الطريقة نفسها التي يتم بها تعليم الدين في الكنائس المسيحية. وهكذا نرى أن هذه النزعة العَلْمانية الحريصة على اتخاذ موقف مستقل عن الدين تتجه في سيرها على طول الخط نحو الدين، وإن كان بطريقة لاشعورية.
لهذا، من الممكن أن نتصور رجل دين لا أخلاق له، وبالعكس. فالدين نوع من المعرفة، والأخلاق هي الحياة التي يحياها الإنسان وفقًا لهذه المعرفة، وهنا يظهر الاختلاف بين المعرفة والممارسة، فالدين إجابة على سؤال: كيف تفكر وكيف تؤمن؟، بينما الأخلاق إجابة على سؤال: كيف تحكم الرغبة، كيف تحيا وكيف تتصرف؟ اقرأ هذه الآية: (..الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..) إنها تتكرر بصيغتها أو معناها في القرآن أكثر من خمسين مرة، كأنما تؤكد لنا ضرورة توحيد أمرين اعتاد الناس على الفصل بينهما. إن هذه الآية تعبر عن الفرق بين الدين «الإيمان» وبين الأخلاق «عملُ الصالحات». كما تأمر في الوقت نفسه بضرورة أن يسير الاثنان معًا. كذلك يكشف لنا القرآن عن علاقة أخرى عكسية بين الأخلاق والدين، فيوجه نظرنا إلى أن الممارسة الأخلاقية قد تكون حافزًا قويًا على التدين: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)، فمعنى الآية هنا لا يقول: (آمن لتصبح خيًّرا) وإنما على العكس يقول: (افعل الخير تصبح مؤمنًا). وفي هذه النقطة نرى إجابة على سؤال كيف يمكن للإنسان أن يقوّي إيمانه؟ والإجابة هي: (إفعل الخير تجد الله أمامك).
الواجب والمصلحة:
إننا لم نتبيّن بعد ملامح النظامين المختلفين اللذين انبثقت منهما كل الحقيقة: الخلْق بما اشتمل عليه من حرية وعفوية ووعي وفردية في ناحية، والتطوّر بما اشتمل عليه من سببية وقصور ذاتي وقصور في الطاقة واتساق في الناحية الأخرى. فالواجب والمصلحة هما حلقتان في هاتين السلسلتين، الواجب هو المصطلح الأساسي في علم الأخلاق، والمصلحة هي المصطلح الأساسي في علم السياسة.
الواجب والمصلحة وإن كانا متعارضين، فإنهما قوتان محركتان للنشاط الإنساني، ولا يمكن الخلط بينهما، فالواجب دائمًا يتجاوز المصلحة، ولا علاقة للمصلحة بالأخلاق. فالأخلاق لا هي وظيفية ولا عقلانية. فمثلاً، إذا غامر إنسان بحياته فاقتحم منزلاً يحترق لينقذ طفل جاره، ثم عاد يحمل جثته بين ذراعيه، فهل نقول إن عمله كان بلا فائدة لأنه لم يكن ناجحًا؟ إنها الأخلاق التي تمنح قيمةً لهذه التضحية عديمة الفائدة، لهذه المحاولة التي لم تنجح، تمامًا كما أن التصميم المعماري هو الذي يمنح الحطام الأثري جماله([8]).
إن مشهد العدالة المهزومة التي تتعلق بها قلوبنا رغم هزيمتها، ليس حقيقة من حقائق هذا العالم. فأي شيء في هذا العالم (الطبيعي، المنطقي، العلمي، الفكري..) يمكن أن يبرر سلوك بطل يسقط لأنه ظلَّ مستمسكًا بالعدالة والفضيلة؟ فإذا كانت الطبيعة لا تبالي بالعدالة، وُجدت أو لم توجد، فإن تضحية البطل تكون بلا معنى. لكننا نستبعد أن تكون التضحية بلا معنى، فلا بد أنها إلهام من عند الله، إنها تنتمي إلى عالم آخر غير عالمنا الدنيوي، عالم يتميز بمعانٍ وقوانين مغايرة لهذا العالم الطبيعي بجميع قوانينه ومصالحه. إننا نستحسن هذا العمل الغامض بكل جوارحنا دون أن نعرف لماذا، ودون أن نسأل عن أي تفسير لذلك. إن عظمة العمل البطولي ليست في نجاحه حيث أنه غالباً ما يكون غير مثمر، ولا في معقوليته لأنه عادة ما يكون غير معقول. ولكنها المحافظة على واحد من أضَّوأ آثار الألوهية في هذا العالم، وفي هذا تكمن القيمة الكونية التي لا تفوقها قيمة أخرى.
إن الأخلاق، كظاهرة واقعية في الحياة الإنسانية، لا يمكن تفسيرها تفسيرًا عقليًا، ولعل في هذا الحجة الأولى والعملية للدين. فالسلوك الأخلاقي، إما أنه لا معنى له، وإما أن له معنى في وجود الله، وليس هناك اختيار ثالث. فإما أن نُسقط الأخلاق باعتبارها كومة من التعصُّبات، أو أن نُدخل في المعادلة قيمةٌ يمكن أن نسميها الخلود، فإذا توافر شرط الحياة الخالدة، وأن هناك عالمًا آخر غير هذا العالم، وأن الله موجود – بذلك يكون سلوك الإنسان الأخلاقي له معنىً وله مبرر.
قلة قليلة من الناس هي التي تعمل وفقًا لقانون الفضيلة، ولكن هذه القلة هي فخر الجنس البشري وفخر كل إنسان. وقليل هي تلك اللحظات التي نرتفع فيها فوق أنفسنا فلا نعبأ بالمصالح والمنافع العاجلة، هذه اللحظات هي الآثار الباقية التي لا تبلى في حياتنا.
ولا يمكن للإنسان أن يكون محايداً بالنسبة للأخلاق، ولذلك فهو، إما أن يكون صادقًا في أخلاقه أو كاذبًا، أو مازجًا بين الصدق والكذب، وهي حالة أكثر شيوعًا بين البشر. فالناس قد يتصرفون بشكل مختلف بعضهم عن بعض، ولكنهم يتحدثون دائمًا بطريقة واحدة عن العدل والحق والصدق والحرية والمساواة: يفعل الحكماء والأبطال هذا بحكم إخلاصهم ومساندتهم للحق، ويفعل السياسيون وقادة الغوغاء الشيء نفسه نفاقًا وبدافع من المصلحة. إن الزيف الأخلاقي الذي يمارسه المنافقون وقادة الغوغاء ليس أقل أهمية من الموضوع الذي نناقشه. فالتظاهر بالأخلاق والحرص على التخفي تحت قناع أخلاقي مما يتمثل في الحملات الإعلامية تحت اسم العدالة والمساواة والإنسانية.. كل هذا يؤكد حقيقة الأخلاق، مثلما تؤكدها المعاناة النبيلة للأبطال والشهداء. إن النفاق وهو زيف أخلاقي يبرهن على قيمة الأخلاق الصحيحة، مثلما تفعل النقود المزيفة ذات القيمة المؤقتة بالنسبة للنقود القانونية ذات القيمة الدائمة. النفاق برهان على أن كل إنسان يتوقع أو يتطلب سلوكاً أخلاقياً من جميع الناس الآخرين.
الأخلاق وما يسمى بالمصلحة المشتركة:
لقد أنكرت العقلانية الأخلاق وتجلّى هذا الإنكار في حذف الازدواجية بين الواجب والمصلحة، وتقليص الأخلاق إلى مجرد المنفعة أو اللذة. ومن ثم قُضي على الوضع الاستقلالي للأخلاق. لقد وجُدت هذه النزعة خلال تاريخ علم الأخلاق كله منذ «أرسطو» حتى «برتراند راسل» Bertrand Russell. ولقد شرح ديتريش فون هولباخ» Dietrich von Holbach – وهو أحد أوائل كُتاب المذهب المادي في الغرب- هذا الاتجاه بطريقة بالغة الوضوح، فبعد أن أكّد على الشعار الشهير (أن المصلحة وحدها هي الحافز للسلوك الإنساني) ذهب ينمّي هذا السيناريو فقال: «إن الإحساسات والانطباعات التي يستقبلها الإنسان من الأشياء بعضها سارّ وبعضها مؤلم، يستحسن الإنسان بعضها ويرغب في بقائه أطول مدة أو في ظهوره مرة أخرى، بينما يستهجن البعض الآخر ويتجنبه بقدر ما يستطيع. بمعنى آخر، إن الإنسان يحب مشاعر وانطباعات معيّنة والأشياء التي تسبّبها، ويكره مشاعر وانطباعات أخرى وكل ما يسبّبها. وبما أن الإنسان يعيش في مجتمع، فهو محاط بكائنات تشبهه وهي حسّاسة مثله. جميع هذه الكائنات تبحث عن اللذة وجميعها يخشى الألم. وقد اصطلحوا على تسمية ما يسبب لهم اللذة (خيرًا) وكل ما يسبب لهم الألم (شرًّا).. إنهم يطلقون على كل ما فيه نفع دائم لهم (فضيلة) وعلى كل ما فيه ضرر لهم (رذيلة)..» ويذهب «هولباخ» إلى أن “الضمير هو الوعي بالتأثير المُحتمَلْ لسلوكنا على الناس الذين يحيطون بنا وعلينا أيضًا، والندم إنما هو الخوف الذي نستشعره لمجرد التفكير بأن سلوكنا قد يجعل الناس يكرهوننا أو يغضبون منا»([9]).
كذلك «بِنتام» – صاحب مذهب المنفعة في علم الأخلاق – واضح ومنطقي في هذا المجال، فهو يقول: «لقد أخضعت الطبيعةُ البشر لحكم سيدين، هما: اللذة والألم. فهُما وحدهما اللذان يحكمان أفعالنا»([10]).
ويذهب الفيلسوف الفرنسي «هلفتيوس» في القرن الثامن عشر إلى أن كل سلوك إنساني موجّه دائمًا إلى ما هو أقل مقاومةً. ولا أحد من الناس يقوم بعمل شيء إلا وهو معتقد أنه بهذا النشاط إما أن يزيد من لذته، أو يقلّل من ألمه. وكما أن الماء لا يصعد الجبل، لا يستطيع الإنسان أن يعمل ضد هذا القانون النابع من طبيعته.
هذه النظرة تجعل من الأخلاق مجرد أنانية مهذبة. مصلحة فرد مفهومة ومقدّرة. إنما يتدخل العقل ليحول هذه الرغبة في اللذة إلى مطلب أخلاقي، ويفسح الذكاء والذاكرة الرؤية أمام الإنسان ليرى الماضي والمستقبل، بالإضافة إلى الحاضر. وهكذا، لا يحفز سلوك الإنسان فقط مصلحته الحاضرة الآنية، وإنما النهاية السعيدة في كلّيتها([11]). وفي ضوء هذه الحِسْبة، يحوّل الإنسان مشاعر الألم، واللذة – وهي حقائق بيولوجية حيوانية داروينية – إلى مفهومي الخير والشر. فالخير والشر ليسا سوى اللذة والألم تضاعفا بالفطنة والتفكير والحساب. وهكذا، تنحصر أخلاقيات المنفعة في حدود الطبيعة، وينحسر بصرها عند أسوار هذا العالم الدنيوي. فهي لا يمكن أن تتقدم وراء حدود المصلحة لكي تصبح أخلاقية بالمعنى الأصيل لهذه الكلمة.
إن الخبرة الإنسانية كلها في مجال الأخلاق تناقض هذه الفكرة المادية، وقد تواضع الناس على أن يستبعدوا اللذة من العمل الأخلاقي. فأي لذة توجد في الزهد والتبتل والتضحية المادية والصيام، وفي كثير من أنواع نكران الذات وكبح النفس، والتضحية في سبيل المبدأ أو من أجل الآخرين..؟. إن الأخلاق النفعية متناقضة مع مفهوم الإنسان المتحضر للأخلاق.
الأخلاق ليست مربحة بالمعنى العام لهذه الكلمة، فهل نستطيع مثلاً أن نقول إن الشعار السائد «النساء والأطفال أولاً» مفيد من الناحية الاجتماعية؟ هل من المفيد أن تكون عادلاً أو أن تقول الصدق؟. إننا نستطيع أن نتصور مواقف عديدة يكون الظلم فيها والكذب هما المفيدان. وبالمثل، فإن التسامح الديني والسياسي والعرقي والوطني ليس مفيدًا بالمعنى المعتاد للكلمة. أمّا أن تدمر الخصوم، فهذا أكثر فائدة من وجهة النظر العقلانية البحتة. ولكن التسامح – إذا توافر – فإن ممارسته لا تكون من قبيل المصلحة، وإنما يكون التسامح بحافز من مبدأ أو بباعث إنساني، أو بسبب ما يطلق عليه «اللاغرضية المستهدفة». إن حماية العجزة والمُقعدين، أو العناية بالمعوّقين والمرضى الذين لا أمل في شفائهم، كل ذلك ليس من قبيل السعي وراء الفائدة. فالأخلاق لا يمكن أن تخضع لمعايير المنفعة. نعم. قد يكون السلوك الأخلاقي أحيانًا مفيدًا، ولكن ليس معنى هذا أن شيئًا قد أصبح أخلاقيًا لأنه أثبت فائدته في فترة ما من فترات الخبرة الإنسانية. على العكس.. فهذه الخبرة نادرة الحدوث([12]). إن الاعتقاد المتفائل بوجود اتساق بين المنفعة من ناحية، وبين الصدق والأمانة من ناحية أخرى، أثبت أنه اعتقاد ساذج بل وضارّ. فله أثر مدمر على نفوس الناس لأنهم يشاهدون عكس ذلك على الدوام. ولكن الإنسان المستقيم بحق هو الإنسان الذي يُقْدم على التضحية، وإذا واجه الإغراء ثبت على إخلاصه للمبادئ لا لمصلحته. ولو كانت الفضيلة مربحةً حقًا، لتسارع إلى اقتحامها الانتهازيون ليكونوا نماذج للفضيلة.
إن خبرات علماء الجريمة مُعلِّمةٌ ومرّةٌ في الوقت نفسه. فطبقًا لتقرير بوليس شيكاغو لسنة 1951 أن أكثر من 90% من جرائم السطو لم يتم التوصل إلى مرتكبيها. وكشف استبيان «كيفوفر» Kefauver أن المجرمين الأمريكيين ينهبون ملايين الدولارات ويتمتعون بغنائمهم عادة بلا وازع من ضمير. وهكذا نرى أن الجريمة مربحة كما استنتج علماء الجريمة، وهي مربحة على الأخص بالنسبة لأولئك الذين يشرفون على تنظيمها ولا يقومون بارتكابها بأنفسهم مثل عصابات المافيا، وغيرها من العصابات الإجرامية. وقد أكد أحد علماء الجريمة الأمريكيين قائلاً: «يبدو أنه كلما زاد الربح من وراء جريمة قتل ما، كلما قلّت الفرصة للقبض على المجرم ومعاقبته». وهنا يبرز السؤال: وماذا عن ربحيّة الجرائم المقنّنة كالفن الإباحي، والكتابات الداعرة، واستعراضات العرايا، وقصص الجرائم وما شابه ذلك؟ لقد وُجد أن فيلماً داعرًا أرخص في إنتاجه عشر مرات من إنتاج فيلم عادي، وأن أرباحه تزيد عشر مرات عن أرباح الفيلم العادي([13]). ولعل أوضح مثال على “الجرائم المقنّنة” تلك التي ترتكب على نطاق واسع: كالحروب العدوانية واحتلال الدول واضطهاد الأقليات.. فهل نستطيع أن نقول إن الأسبان لم يربحوا من القضاء على الهنود الحمر في المكسيك وفي وسط أمريكا وجنوبها. أو أن المستوطنين البيض لم يستفيدوا من الإبادة المنظمة لسكان أمريكا الشمالية من الهنود. أو أن القوى الإمبريالية باستغلال ونهب الدول المحتلّة لم تكتسب منافع مادية؟ نستطيع إذن أن نستخلص أن الجريمة مربحة، ولكن بشرط ألا يكون هناك إله.
يُمكن إقامة أخلاقيات المنفعة على أساس من العقل ولو على المستوى النظري. ولكن من المستحيل أن نقيم على العقل وفي غيبة الألوهية أخلاقيات غيرية لا أنانّية، أو أخلاقيات تقوم على التضحية كما ينبغي أن تكون الأخلاق.
إننا نعرّف الأخلاق الأصيلة بأنها سلوك قد يكون ضد المصلحة الشخصية. ومع ذلك، توجد ظاهرة أخرى تبدو مشابهة رغم أنها في جوهرها مختلفة تمام الاختلاف، ألا وهي ما يُسمى «السلوك الاجتماعي». ففي حياتنا الاجتماعية لا يتصرف الإنسان وفقًا لمصلحته الاجتماعية. إن سلوكه الاجتماعي يستهدف تحقيق احتياجاته الشخصية، وإنما على نطاق اجتماعي أوسع حيث يصبح المجتمع هو التعبير عن جميع الحاجات الشخصية التي يمكن تحقيقها بفاعلية أكبر. هذا الموقف الجديد يخلق «واجبات مختلفة لأعضاء المجتمع تذكرنا (بحكم تطابق اللفظ) بالمطالب الأخلاقية أو «الواجبات». هنا، تبدو الأنشطة التي تستهدف تحقيق المصلحة الشخصية واجبات أو التزامات اجتماعية. هذه الواجبات الاجتماعية قد لا تتكافأ مع المصلحة الشخصية للإنسان (حيث تقتضي تضحيةً أو عطاء أكثر مما يمكن قبوله)، وقد تكون ضد الرغبات والتطلعات الآنية للفرد الذي هو عضو في مجموعة. وهنا يتجلى الوهم بأن الفرد قد تصرف، لا بمقتضى مصلحته، بل في سبيل المبدأ الأسمى. أما الواقع، فهو أن المجتمع شكل معين لتحقيق المصالح الشخصية. فالجو العام لم يتغير إنما الشكل فقط هو الذي تغير للوصول إلى الغرض نفسه. فما يطلق عليه المصلحة المشتركة هو مصلحة شخصية تتساوى في أنانيتها ولا أخلاقيتها. إن العمل الجماعي من صناعة الذكاء وليس فيضاً من القلب أو الروح. وهو يؤدي إلى تحقيق أكبر مصلحة شخصية لأكبر عدد من الناس في المجتمع، وهذا ما يطلقون عليه «المبدأ الأعظم»([14]). ووراء ذلك حسبة مُعدّةٌ إعدادًا جيدًا مع السماح بهامش للخطأ المحتمل، أو سوء الاستخدام من جانب أولئك الذين يحددون العمل الجماعي.
إن ما يوفره الذكاء في حياة الإنسان بطريقة غير كاملاً توفّره الغريزة كاملاً في المملكة الحيوانية. والمثل على ذلك قائم في السلوك الاجتماعي للنمل والنحل والحيوانات البرية الأخرى في قطعانها. وهذه النماذج التي تقدمها لنا الحيوانات في سلوكها الاجتماعي، تبرهن لنا على أننا لا نواجه ظاهرة أخلاقية على الإطلاق، والفرق واضح: فالحافز وراء السلوك الاجتماعي هو المصلحة، بعكس السلوك الأخلاقي الذي لا يقوم على المصلحة. إن السلوك باسم الأنانية شيء، والسلوك باسم الواجب شيء آخر، الأول يستند إلى المصلحة والحاجة والنظام والعقل، أما الثاني فهو ممكن فقط باسم الله.
وتوجد نقطة أخرى تساعد على التمييز في هذا المجال. فالسلوك الأخلاقي يقوم دائمًا على الكمال الروحي، وهو متسق مع الخير المثالي والصدق والعدالة([15]). ومن ناحية أخرى، فإن السلوك الجمعي قائم على التنظيم وقد يكون إجراميًا، ولكنه في أكثر الأحوال لاأخلاقي أو ضد الأخلاق. والمصلحة المشتركة لا يمكن أن تكون مصلحة البشر جميعًا، إنها دائمًا مصلحة مجموعة محددة مغلقة قد تكون مجموعة سياسية أو وطنية، أو طبقة. لقد تحدث تولستوي» عن «تأليه الدولة» أو تأليه «المصلحة العامة»([16]). المصلحة المشتركة لمجموعة من الناس أو لوطن ما قد تستدعي استغلال أو استبعاد، بل حتى إبادة أعضاء مجموعة أخرى، أو شعب آخر. إن التاريخ الحديث للأمم – وعلى الأخص تاريخ الإمبريالية الاستعمارية – حافل بالأمثلة على أن ما يطلق عليه «المصلحة المشتركة» يمكن أن تأخذ شكلاً إجراميًا صريحًا.
النية والعمل:
في عالم الطبيعة توجد الأشياء وجودًا موضوعيًا، فالأرض تدور حول الشمس سواء عرفنا ذلك أو لم نعرف، وسواء رغبنا في ذلك أو لم نرغب، قد نكره هذه الحقيقة ولكننا لا نستطيع تجاهلها أو تغييرها. أما في عالم الأخلاق، فإن هذه الحقائق لا معنى لها، ذلك أن في عالمنا الجواني ليس للأشياء وجود موضوعي، لأننا نحن الذين نساهم مباشرة في وجودها، نحن الذين نشكّل هذا العالم الجوّاني، وهذا هو ميدان الحرية الإنسانية.
في العالم البرَّاني نفعل ما يجب علينا أن نفعله، في هذا العالم يوجد الغني والفقير، الذكي والغبي، المتعلم والجاهل، القوي والضعيف (وجميع هذه الأشياء لا تتوقف على إرادتنا ولا تعبر عن ذواتنا الأصيلة). في مقابل هذا العالم يوجد عالمنا الجُوّاني، وهو عالم قوامه الحريّة والاختيارات المتساوية، وهي حُرية كاملة حيث لا تحدّها حدود مادية أو طبيعية.
وتعبّر الحرية عن نفسها في النية والإرادة. فكل إنسان يتوق إلى أن يحيا في اتساق مع ضميره وفقًا لقوانين أخلاقية معينة. وقد لا يكون هذا سهلا ًعند البعض، إلّا أن كل إنسان يقدّر قيمة الاستقامة. كثير من الناس لا يعرفون سبيلاً لدفع الظلم، ولكن جميع الناس قادرون على كراهية الظلم واستهجانه في أفئدتهم، وفي هذا يكمن معنى الندم. ليست الإنسانية في الكمال أو العصمة من الخطأ. فأن تخطئ وتندم هو أن تكون إنسانًا.
كم من أشياء فعلناها وكنا لا نريد حقيقةً أن نفعلها؟ وكم من أشياء ودَدْنا أَنْ نفعلها ولكن لم نفعلها أبدًا؟ إذن، هناك عالمان: عالم القلب وعالم الطبيعة. فالرغبة قد لا تتحقق ولكنها حقيقة في عالم قلوبنا، حقيقة كاملة. ومن جهة أخرى، يقع الفعل بالصدفة المحضة، فعلٌ لم يكن مقصودًا ولكنه حدث كاملاً في العالم الطبيعي، ولم يحدث مطلقاً في العالم الآخر، عالم الحياة الجوّانية.
هذه العلاقة بين الإرادة والفعل تعكس التناقض المبدئي بين الإنسان والعالم، وتظهر على السواء في الأخلاق والفن والدين. فالنية والرغبة والتقوى تنتمي جُوّانيًا بعضها إلى بعض وعلاقتها واحدة في انعكاساتها المادية: في السلوك، وفي العمل الفني، وفي الشعائر التعبدية. فالأولى تجربة روحية، والثانية أحداث في العالم البرّاني.
وهنا يثور سؤال: هل نحكم على الأعمال بالنوايا التي انطوت عليها، أم بالنتائج التي ترتّبت عليها؟ الموقف الأول هو رسالة كل دين، أما الموقف الثاني، فهو شعار كل أيديولوجية أو ثورة.
وكان لا بد للعلم وللنظرية المادية أن يُدليا بدلويْهما في مسألة أصالة النيّة والقصد في السلوك الإنساني. وانتهيا إلى أن النية ليست مبدأ أوليًّا ولا أصيلاً، بل شيء لا يوجد له تفسير عندهما، شيء هو أقرب إلى أن يكون نتيجة من أن يكون سببًا. ومن ثم، فمصدر الفعل الإنساني –عندهما– ليس النيّة، وإنما يقع في منطقة وراء الوعي هي منطقة الجبرية العامة.
يقرر الدين عكس ذلك حيث يؤكد أن هناك مركزًا جُوّانيًا في كل إنسان يختلف عن بقية العالم، وهو أعمق ما في هذا الكائن الإنساني ألا وهو النفس. والنية خطوة إلى أعماق الذات، وهنالك يتبنّى الإنسان الفعل أو يحققه ويؤكده تأكيدًا جُوّانيًا. قد يقوم به في العالم الخارجي وقد لا يفعل، إنما في العالم الجواني قد تحقّق الفعل وانتهى. بدون الرجوع إلى هذا العالم الجواني يصبح عمل الإنسان عملاً آليًا، مجرد صدفة في العالم البرّاني الزائل. ليس الإنسان بما يفعل بل بما يريد، بما يرغب فيه بشغف.
لقد ذهب «أرنولد جيولنكس» Arnold Geulinex إلى أن وجودنا الحقيقي يشتمل على الإدراك والإرادة فقط، وهو مُركب يجعلنا عاجزين عن القيام بأعمال أبعد من حدود وعينا، وتكاد تكون جميع الأفعال، أبعد من قدرتنا، لأنها جميعًا ملك «للمشيئة الإلهية». ولذلك، فإن الأخلاق ليس في العمل المخلص، وإنما فقط في النيّة المخلصة.
ويعبّر «هيوم» عن فكرة مماثلة حيث يقول: «إن الفعل ليس في ذاته قيمة خلقية، ولكي نعرف القيمة الخلقية لإنسان علينا أن ننظر في داخله، وحيث أننا لا نستطيع ذلك بطريق مباشر فإننا نصرف نظرنا إلى أفعاله، ولكن هذه الأفعال كانت ولا تزال مجرد رموز على الإرادة الجُوّانية، ومن ثم فهي أيضًا رموز للتقييم الأخلاقي»([17]).
العمل الذي انعقدت عليه النية، هو عمل قد تم أداؤه في عالم الأبدية. أما أداؤه البرّاني، فيحمل طابعًا أرضيًا فهو مشروط لا أصالة فيه، إنه صدفة، بل لا معنى له. النية حرة، أما الأداء فيخضع للقيود والقوانين والشروط. النية جميعها ملك لنا، أما الأداء فينطوي على أمور غريبة عنا، عرضيّة في ذاتها.
والإنسان خيّر ما أراد أن يكون خيّرًا، وفي حدود فهمه للخير، حتى ولو اعتُبر هذا الخير شرًا في نظر شخص آخر، والإنسان شرير ما أراد أن يفعل الشر، حتى ولو بدا فيه خير للآخرين أو من وجهة نظر الآخرين. فمدار القضية في عالم الإنسان الجوّاني الخاص، في إطار هذه العلاقة – وهي علاقة جوّانية روحية. يقف الإنسان وحده تمامًا، وهو حر شأنه شأن الآخرين. وهذا هو معنى عبارة سارتر التي تقول بأن كل إنسان مسؤول مسؤولية مطلقة، وأنه «ليس في الجحيم ضحايا أبرياء ولا مذنبين أبرياء»([18]).
التدريب والتنشئة:
لعل أكثر ما نجده في الكتب القديمة مثارًا للإعجاب والدهشة قصص الهداية واليقظة الخلقية، حيث يتحول أعتى الطغاة وأسوأ المذنبين بين يوم وليلة إلى شهداء متواضعين وإلى مدافعين عن العدالة. إنها دائمًا حادثة عفوية؛ فليس هناك عملية إصلاح أو إقناع، إنها حركة في أعماق الروح، مسألة تجربة تتزامن مع وجود طاقة ذات طبيعة جُوّانية خالصة تغيّر بقوتها الخاصة الإنسان تغييرًا كليًا. إنه تحوّل ينبع من ذات الإنسان، ولذلك فلا توجد عملية ما أو صدفة أو شرطية أو أسباب ونتائج، ولا حتى تفسير عقلي، فجوهر هذه الدراما هو الحرية والخلق.
الخير والشر في باطن الإنسان. ولا توجد تدريبات أو قوانين ولا تأثيرات خارجية يمكن بها إصلاح الإنسان، فكل ما تستطيعه هذه الأشياء هو أن تُغيِّر السلوك فحسب. فالفضيلة والرذيلة ليستا منتجات مثل السكر الزَّاج كما يقول «تاين» و«زولا»([19]). إن اليقظة الروحية والهداية تلقائيتان، إنهما نتاج حركة الروح. ومن وجهة نظر الدين، كل تأثير خارجي للقضاء على الشر لا يثمر.
وهذا هو السبب في أن التدريب لا تأثير له على الموقف الأخلاقي للإنسان. تستطيع أن تدّرب جنديًا أن يكون خشنًا، ماهرًا، قويًا، ولكنك لا تستطيع أن تدربه لكي يكون مخلصًا، شريفًا، متحمسًا، شجاعًا. فهذه جميعًا صفات روحية. من المستحيل فرض عقيدة بقرار أو عن طريق الإرهاب أو الضغط أو العنف أو القوة. ويستطيع أي مربٍّ أن يعطيك عددًا من الأمثلة عن أطفال يقاومون التوجيه المُلحّ، وكيف أنهم يُنمّون – نتيجة لذلك – اهتمامًا بسلوك مُضاد تمامًا. ويرجع هذا إلى «الخاصية الإنسانية» للإنسان. فلا يمكن تدريب الإنسان كما يُدرَّب الحيوان. وهذا القصور في التدريب، والتشكّك في أثر التعليم هما البرهان الواضح الصريح أن الإنسان حيوان قد مُنح روحًا، أعني حرية([20]). ولذلك، فإن كل تنشئة حقيقية هي في جوهرها تنشئة ذاتية، وهي مناقضة للتدريب. فهدف التنشئة الصحيحة ليس تغيير الإنسان تغييراً مباشرًا، حيث أن هذا غير ممكن، وإنما هي تحفّز فيه قوى جُوّانية دافعة من الخبرات، وتُحدث قراراً جُوّانيًا لصالح الخير عن طريق المثل الصالح والنصيحة والمشاهدة.. إلى غير ذلك. ولا يمكن تغيير الإنسان بغير هذا الأسلوب. لعل سلوكه قد يتغير، ولكنه سيكون تغييرًا ظاهريًا ومؤقتًا. ذلك، لأن السلوك الذي لا ينبع من أعماق إرادتنا هو تغيير لا يأتي عن طريق التنشئة، وإنما ينتج عن طريق التدريب. فالتنشئة تنطوي على مساهمتنا وجهدنا ومن ثم يأتي أثرها مختلفًا دائمًا ولا يمكن التنبؤ به.
يعتقد دعاة الفردية في هداية الإنسان وفي التجديد الباطني، بينما يعتقد الوضعيون في تغيير السلوك. والفلسفة التي يستندون إليها -من وجهة نظرهم – واضحة: إذا كانت الجريمة نتيجة الاختيار الحر أو الإرادة الشريرة، فإن إعادة التعليم بواسطة وسائل خارجية فرصته في النجاح نادرة. وعلى العكس، إذا كان الجُرم نتيجة ظروف أو عادات سيئة، فإن مرتكب الجريمة يمكن إعادة تعليمه من خلال تغيير الظروف أو تشكيل عادات جديدة. وهذا هو الفرق بين الهداية الجُوّانية والتدريب.
والتنشئة تحدث تأثيرًا لطيفًا على نفس الإنسان لا يمكن قياسه. إن التنشئة فاعلية غير مباشرة تدخل إلى القلب عن طريق الحب والقدوة والتسامح والعقاب، بقصد إحداث نشاط جواني في نفس الإنسان. أما التدريب باعتباره حيوانياً في جوهره، فهو نظام من الإجراءات والأعمال تُتَّخذ لفرض سلوك معين على الكائن البشري، يزعمون أنه السلوك الصحيح. التنشئة تنتمي إلى الإنسان، أما التدريب فإنه مُصمّم من أجل الحيوانات. بواسطة التعليم، يمكن تشكيل المواطنين الذين يطيعون القانون ليس بوازع من الاحترام، بل بدافع من الخوف أو العادة، وقد يكون ضميرهم ميتًا ومشاعرهم ذابلة، ولكنهم لا يخرقون القانون لمجرد أنهم تدربوا على ذلك. ونرى في الأدب شخصيات يزعمون أنها لمواطنين طاهري الذيل وهم في الحقيقة مُفرّغون من الأخلاق، وشخصيات لخاطئين هم في أعماقهم أخيار ونبلاء. ومن ثم يوجد نوعان من العدالة: عدالة الإنسان والعدالة الإلهية، تنظر الأولى إلى الأعمال، وتنظر الثانية إلى جوهر الوجود الإنساني.
إن المساحة الجُوّانية للإنسان شاسعة تكاد تكون لانهائية. فهو قادر على أبشع أنواع الجرائم وعلى أنبل التضحيات. وليست عظمة الإنسان أساسًا في أعماله الخيّرة، وإنما في قدرته على الاختيار. وكل من يقلّل أو يحدّ من هذه القدرة يحطّ بقدْر الإنسان. فالخير لا يوجد خارج إرادة الإنسان، ولا يمكن فرضه بالقوة. (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)([21]) والقانون نفسه ينطبق أيضًا على الأخلاق. إن التدريب، حتى ولو كان يفرض السلوك الصحيح، هو في أساسه لا أخلاقي ولا إنساني.
الأخلاق والعقل:
مفهوم الحرية الإنسانية لا ينفصل عن فكرة الأخلاق. فبالرغم مما خضعت له هذه الفكرة من تحوّرات، ظلت الحرية هي «الثابت» عند كل تحوُّل أو تطور خلال تاريخ علم الأخلاق. فمثل ما للمكان والكمّ من أهمية في علم الطبيعة، كانت أهمية الحرية بالنسبة لعلم الأخلاق([22]). يدرك العقل المكان والكمّ ولكنه لا يفهم الحرية، وهذا هو الخط الفارق بين العقل والأخلاق.
وظيفة العقل أن يكتشف الطبيعة والآلية، وعلم التفاضل والتكامل. بمعنى آخر إن العقل يكتشف نفسه في كل شيء. ولهذا السبب، فإن العقل يدور دائمًا في مكانه. فهو لا يكتشف في الطبيعة إلّا ذاته، أعني الآلية. ومن هنا، يأتي التناقض البيّن في بعض النظريات الأخلاقية التي تُنهي جدلها المنطقي المعقّد بنتائج، مثل أن الغيريَّة تساوي الأنانية، وإنكار اللذة يساوي اللذة وهذا هو التناقض نفسه الذي جعل «فولتير» يستخلص رأيه الغامض الشهير «تضحية الإنسان بنفسه بوازع من مصلحته الذاتية»([23]).
إن التحليل (المنطقي) العقلي للأخلاق يختزلها – ربما لدهشة الملاحظ ۔ إلى طبيعة وأنانيةٍ وتضخيم للذات. يكتشف العقل في الطبيعة مبدأ السببية العامة الكلّية. ويكتشف في الإنسان الطبيعة: الغرائز أو (القوة ذات السيدين: اللذة والألم) التي تؤكد عبودية الإنسان وانعدام حريته. إنها آلية التفكير نفسها التي حوّلت الألوهية إلى «السبب الأول» (المحرك الذي لا يتحرك)، واختزلت الروح إلى نفس، والفن إلى عمل وتكنيك. إن محاولة إقامة الأخلاق على أساس عقلي لا تستطيع أن تتحرك أبعد مما يسمى بالأخلاق الاجتماعية، أو قواعد السلوك اللازمة للمحافظة على جماعة معينة، وهي في واقع الأمر نوع من النظام الاجتماعي.
إن الأخلاق -بسبب ذلك- لا يمكن القول بأنها نتاج العقل. فالعقل يستطيع أن يختبر العلاقات بين الأشياء ويحدّدها، ولكنه لا يستطيع أن يُصدر حُكمًا قيميًّا عندما تكون القضية قضية استحسان أو استهجان أخلاقي. مثلاً من المستحيل التبرير العلمي بأن شيئا ليس خيّرًا بالمعنى الأخلاقي للكلمة، مثلما أنه من المستحيل أن تصل إلى تفرقة علمية دقيقة بين الجميل والقبيح، بين الصح والخطأ، بين الخير والشر. فهذه الصفات ليست موجودة في الطبيعة. فماذا يعني الإنسان -كشخصية متفردة لا تتكرر- بالنسبة للعلم؟ لا بد أن يكون العَالِم شيئًا أكثر من علمه، أن يكون إنسانًا لكي يفهم هذه الحقيقة.
الأخلاق بدون إله:
ليست هناك علاقة «أوتوماتيكية تلقائية بين عقيدتنا وسلوكنا. فسلوكنا ليس بالضرورة من اختيارنا الواعي ولا هو قاصر عليه. إنه على الأرجح نتيجة التنشئة والمواقف التي تشكلت في مرحلة الطفولة أكثر منه نتيجة للمعتقدات الفلسفية والسياسية الواعية التي تأتي في مرحلة متأخرة من مراحل الحياة. فإذا تعلم شخص ما أن يحترم كبار السن، وأن يحافظ على كلمته، وأن يحكم على الناس بصفاتهم، وأن يحب الآخرين ويساعدهم، وأن يقول الصدق، وأن يكره النفاق، وأن يكون إنسانًا بسيطًا أبيًّا، إذا نشأ على كل هذه الأخلاق الحميدة فستكون هي صفاته الشخصية، بصرف النظر عن أفكاره السياسية الأخيرة أو فلسفته التي يعتنقها. هذه الأخلاقيات (إذا نظرنا إليها نظرة تحليلية) مدينة للدين ومنقولة منه. فقد نقل التعليم نظرات وفضائل دينية أصيلة في ما يتصل بالعلاقة بين الإنسان والإنسان، ولكنه لم ينقل معها الدين الذي هو مصدر هذه الأخلاقيات. ومن ثم يظلّ البعض «منقسمين» بين دين لا يتبعونه وأخلاقيات هذا الدين التي يستمرون في اتباعها، برغم أنهم لا يؤمنون بالأساس الذي أقيمت عليه هذه الأخلاق. هذا الموقف يمنح الفرصة لبروز ظاهرتين تعقِدان البحث: الملحدون الأخلاقيون، والمؤمنون الذين لا أخلاق لهم.
يمكن القول أنه يوجد ملحدون على أخلاق، ولكن لا يوجد إلحاد أخلاقي. والسبب هو أن أخلاقيات اللاديني ترجع في مصدرها إلى الدين. دين ظهر في الماضي ثم اختفى في عالم النسيان، ولكنه ترك بصماته قوية على الأشياء المحيطة، تؤثر وتشع من خلال الأسرة والأدب والأفلام والطرز المعمارية.. إلخ. لقد غربت الشمس حقًا ولكن الدفء الذي يشع في جوف الليل مصدره شمس النهار السابق. إن الأخلاق دين مضى، كما أن الفحم في باطن الأرض حصاد قرون ماضية. ولا سبيل لإقامة تعليم تام الإلحاد للأجيال إلا بخلق الشروط النفسية الملائمة، وذلك من خلال التدمير الكامل والقضاء على جميع المواريث الروحية على مدى العصور. لقد عاش الجنس البشري آلاف السنين تحت تأثير الأديان. واستطاع الدين أن يوقر جميع أوجه الحياة الأخلاقية والقانونية والعقائدية وحتى اللغة. ومن ثم، من حقنا أن نتساءل عما إذا كان من الممكن اليوم «إنتاج» جيل ملحد إلحادًا كاملاً؟ لكي تنجح مثل هذه المحاولة، لا بد أن تنشأ في عزلة تامة بعيدًا عن الإنجيل والقرآن وجميع الكتب الدينية الأخرى، ولا ينبغي السماح لمن يتعرضون لهذه التجربة برؤية عمل فني واحد، ولا أن يسمعوا سمفونية أو قطعة واحدة من الموسيقى، ولا أن يشاهدوا مسرحية واحدة من عهد «سوفوكلس» Sophocles حتى عهد «بِكيثْ» Beckett، ولا بد من إخفاء كل ما بناه الإنسان من تحف معمارية شهيرة، وكل ما ألّفه الكُتَّاب من أعمال أدبية عن ناظرهم. بمعنى آخر، لا بد لهم أن ينشأوا وينموا في جهل مطبق بكل ما نسميه ثمار التعبير عن الثقافة الإنسانية. ذلك لأن الميل الفطري للإنسان نحو الدين يمكن أن يستحضر أمامه رؤية لعالم آخر مختلف عن العالم الملحد لمجرد قراءة أو مشاهدة حديث واحد «لهامْلت» عن الموت، أو نظرة إلى لوحات «مايكل أنجلو» أو معرفة المبادئ القانونية في التجريم.. ولكن، ليس هذا هو الحال مع العلم. فلا يوجد خطر على مستقبل الملحدين من معرفة جميع العلوم الرياضية أو العلوم التقنية أو دراسة شيء من علم الاجتماع المبسط أو الاقتصاد السياسي. والثورة الثقافية الصينية في الستينات ليست ببعيدة عنا، ويمكننا الحكم على أهدافها الحقيقية ونتائجها. فمما لا شك فيه، كان أحد أهداف هذه الثورة القضاء على التراث الروحي للصين الذي رأوا فيه تعارضًا تامًا مع الفلسفة الرسمية لـ«ماو تسي تونج» وأيديولوجيته([24]). إن فكرة الثورة الثقافية -في تميّزها عن الثورتين السياسية والاجتماعية – قد تم تحديدها تحديدًا واضحًا، وهي أنه ليس في الإمكان إقامة نظام إلحادي متسق مع نفسه، بينما التقاليد الثقافية الراسخة تشعّ من حوله دينًا هامسًا مُتشرّبًا في بيئته. حتى أن «ماركس» نفسه لم ينجُ من تأثيرات من هذا القبيل. ولكننا لا نعلم على وجه اليقين أي مصادر روحية أو فكرية استلهمها في كتاباته الأولى، إلا أن تأثير دراسته للعلوم الإنسانية والأدب ظاهر في أعماله المبكرة([25]). فنظريته عن الاغتراب Alienation تكاد تكون في جملتها نظرية أخلاقية إنسانية، ولذا فإنها مستغربة تمامًا وغير مُتوقعة من فيلسوف مادي. ويظهر أن «ماركس» نفسه -مع مرور السنين- قد أصبح واعيًا بضلاله في أيام الشباب. فمن الواضح أنه يوجد اختلاف بيِّن بيْن «ماركس المبكر» و«ماركس الناضج»، على حد تعبير النقاد. هذه العملية الداخلية للنضج تتجلى في حقيقتها في اطّراح التراث المثالي (وهو في أساسه ديني أخلاقي) وتقبُّل متزايد للنظريات المادية المتسقة مع نفسها.
إن الجيل الراهن الذي هو لا ديني اسميًّا بل حتى الملحدين من هذا الجيل لم ينشأوا على جهل بالدين وإنما على الأرجح في عداء له. فهم، وإن لم يقبلوا مبادئ المسيح في الحب والإخاء والمساواة باسم الله، إلا أنهم لم يرفضوا هذه المبادئ أصلاً. وإنما بنوع من الوهم الغريب احتفظوا بهذه المبادئ باسم العلم. ولهذا السبب، ليس من حقنا أن نعتبر هذا الجيل وعالَمَه برهانًا على إمكانية الثقافة الإلحادية. فالواقع، أن الجيل الحالي وثقافته قد نشأ متأثراً بالدين ومبادئه الخلقية الأساسية بطريقة صامتة، غير محسوسة، ولكنها ثابتة. ويمكن وصف الموقف بالنسبة لهذا الجيل بأن لديه أيديولوجية جديدة، أما المعايير التعليمية والأخلاقية فقديمة. البناؤون قدامى والتصميم فقط هو المستحْدث
لقد اقترحوا اللجوء إلى ضمير الإنسان بدلاً من الخوف من الله كحافز على استقامة السلوك. وفي إطار هذه المعادلة أقدم أحدهم على طرح الفكرة التالية: إنني أزعم مؤكدًا أن الإلحاد في حد ذاته يعني السموّ بالإنسان وبالأخلاق الإنسانية. فإذا أنا -كإنسان حرّ- سمعت صوتًا داخليًا آمِرًا، دون أن يأمرني أحد، يقول لي لا تسرق أو لا تقتل، إذن أنا شعرت بذلك في باطني ولم استخلصه من أي نوع من أنواع “المطلق” سواء كان اجتماعيًا أو دينيًا، فإن هذا لا يكون حطًّا من قدر الإنسان.. إن هذا يعني أنني تصرفت على أساس من الاستبصار في وعيي وضميري([26]).
بعد كل ما تقدم، لا يسعنا إلا أن نسأل أنفسنا من الذي أخطأ في المفاهيم؟ وهل يعتبر كلٌ من الضمير والوعي بعض أجزاء من هذا العالم الواقعي المادي؟ أليس الإيمان بالإنسان بدلاً من الإيمان بالله هو شكل من أشكال الدين ولكنه أقل درجة؟ إن لجوء الماديين إلى الإنسان بدلاً من الرجوع إلى الله، يبدو غريبًا في ضوء ما أكّده «ماركس» نفسه عندما قال: إن الأمل في الإنسانية المجردة للإنسان وهمٌ لا يقلّ عن الوهم الديني الخالص، وهذا كلام يتسق مع مفهوم المعادلة التي تقول «إذا لم يوجد إله فلا يوجد إنسان أيضًا». إن تأكيد «لينين» على أن الاشتراكية العلمية لا علاقة لها بالأخلاق، كما أن تقرير «البيان الشيوعي» أن العمال يرفضون الأخلاق، حقيقتان معروفتان لا يمكن إنكارهما. لقد زعموا أن ظهور الشيوعية ناتج من حتمية التطور التاريخي وليس بدافع من أسباب أخلاقية أو إنسانية. وتؤكد أعمال «ماركس» التقليدية -تمييزًا لها عن الكتابات المتداولة الاستخدام اليومي– بوضوح أن قانون الاستغلال يملك صلاحية القانون الطبيعي في العلاقات الإنسانية، وأن كل إنسان سوف يستغل غيره من الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، حتى توقفه القوة. هنا لا نرى مكانًا «لصوت الضمير الداخلي»، أو التسامح، أو الإنسانية الطبيعية (المذهب الإنساني الطبيعي) وما شابه ذلك. إنما هو الاستغلال يظل طاغيًا مهيمنًا حتى يتم ضربه والقضاء عليه، كنتيجة لتغييرات في العلاقات الموضوعية. هذا الاستغلال لا يعتمد على إرادة الناس، ولا على أخلاقياتهم، ولا على أي صفة ذاتية مماثلة من (تعلّم أو شخصية أو رأي..) ولا هو يعتمد على صلات الناس الطبيعية من قومية أو عائلية. وعندما قدّم «ماركس» في كتابه «رأس المال» أمثلة على استغلال الأطفال «من قِبل أمهاتهم الجوْعى» إنما كان يقصد بذلك أن يلفت نظرنا إلى الأثر المطلق لقانون الاستغلال على المجتمع الإنساني([27]). لذلك، فإننا نستغرب محاولات بعض الماركسيين اليوم بناء أخلاق مزعومة بالرجوع إلى الإنسان وإلى الإنسانية الخالصة([28]). بينما أكّد «ماركس» على الدوام بأن الرجوع إلى الإنسان أو الإنسانية أو الوعي وما شابه ذلك، إنما ينطوي على مثالية شأنها شأن الدين. ونحن نتفق مع ماركس في هذا الرأي ولكن الماركسيين الحاليين لا يستطيعون أن يتفقوا معه لأسباب عملية. فقد كان بإمكان «ماركس» وهو قابع في مقعده بالمكتبة البريطانية أن يقول بأنه لا وجود للأخلاق، ولكن الذين حاولوا تطبيق أفكار «ماركس» وأن يقيموا مجتمعًا على أساسها، لم يستطيعوا أن يعلنوا هذا الكلام بالسهولة نفسها. فلكي يُنشئوا مجتمعًا ويُحافظوا عليه، كان عليهم أن يطلبوا من الناس مزيدًا من المثالية والتضحية، رُبّما أكثر مما طلب أي نبيّ من قومه باسم الدين. ولهذا السبب، كان عليهم أن يتناسوا بعض المسلّمات المادية الواضحة. ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس هو ما إذا كان الملحد (المادي) من حقّه أن يعظ باسم الأخلاق أو الإنسانية، وإنما السؤال هو هل يمكنه أن يفعل ذلك ويبقى على ما هو عليه، أعني في حدود المذهب المادي لا يبرحه؟
إن الخلاف المعروف في فلسفة «أبيقور» تبيّن لنا أن السلام بين المذهب المادي والأخلاق لا يمكن أن يبقى طويلاً. فهذا الفيلسوف اليوناني القديم (342 – ۲۷۰ق.م.) برغم أنه كان مادي النزعة إلا أنه احتفظ بموقف معين من الأخلاق. فقد علّم تلاميذه أن السعادة توجد في اللذة، ولكنه نصح بالاستمتاع بما سماه «أتاراكسيا Ataraxia ويعني بها هدوء العقل، وهو نفسه رفع قدر المُتع الروحية على المتع الحسية. ولكن تلاميذه أزاحوا هذا التناقض من فلسفة أستاذهم وحصروا أخلاقياته في طلب اللذة وأصبحت «الأبيقورية» اليوم مرادفةً للمتعة الحسية باعتبارها الحياة المثالية. يوجد ارتباط منطقي أو تطابق داخلي بين “مذهب اللذة” وبين فلسفة «أبيقور» المادية. فالكون، طبقًا لهذه الفلسفة وجميع الظواهر المختلفة فيه، نتاج الحركة الآلية لجزئيات مادية في فضاء فارغ. هذا التطابق لا يوجد بين فلسفة «أبيقور» المادية وبين ما دعا إليه من «أتاراكسیا» أو أولوية القيم الروحية. ولذلك يمكن القول، بأن الاتهام الذي وُجّه إلى تلامذة «أبيقور» بأنهم شوّهوا فلسفة معلمهم لا سند لها، لأن ما فعلوه هو جعلها متسقة مع نفسها. فلا بد للمادية أن تنكر الأخلاق في النهاية.
وهكذا نأتي إلى نتيجتين: الأولى أن الأخلاق كمبدأ لا توجد بلا دين، بينما الأخلاق العملية يمكن لها أن توجد في غياب الدين. فهي توجد بحكم القصور الذاتي بالغة الوهن، وذلك لانفصالها عن المصدر الذي منحها قوتها المبدئية. والنتيجة الثانية، أنه لا يمكن بناء نظام أخلاقي على الإلحاد. ومع ذلك، فالإلحاد لا يبطل الأخلاق على الأقل في أدنى أشكالها، وأعني بذلك النظام الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، نجد أن الإلحاد إذا وُضع موضع الممارسة، فإنه عندما يحاول بناء مجتمع يضطر إلى المحافظة على الأشكال القائمة للأخلاق الاجتماعية، إلا أنه لا يملك الوسيلة للحفاظ أو لحماية المبدأ الأخلاقي نفسه، إذا كان موضع اعتراض أو شك. فالإلحاد عاجز تمامًا أمام هجوم دعاة المنفعة أو الأنانية أو اللاأخلاقية المحضة، فماذا يمكن صنعه أمام هذا المنطق الأشلّ؟ إذا كنت سأحيا اليوم فقط ولا بد أن أموت غداً وأذهب في زوايا النسيان، فلم لا أعيش كما يحلو لي بدون قيد أو التزام ما استطعت إلى ذلك سبيلاً؟ إن موجة الإباحية وما يسمى «بالأخلاق الجديدة» للحرية الجنسية توقفت عند حدود الدول الاشتراكية بفعل القوة الجبرية وبواسطة الرقابة أي بطرق مصنوعة، لا يوجد نظام أخلاقي يوافق على هذه الموجة اللاأخلاقية. ورغم بعض الحجج التي سبقت لتدعيمها، فإن هذه الحجج تبقى فقط بسبب انعدام النقد الحر المفتوح. وفي الحقيقة، فإن المعايير الأخلاقية الموروثة فحسب هي التي تبقى في وعي الناس، وقد تُبقي عليها الدولة بدافع من الضرورة المحضة، وفي كلتا الحالتين فإن هذا النظام الأخلاقي الموروث مناقض للأيديولوجية الرسمية ولا يوجد له مكان فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* علي عزت بيجوفيتش (1997). الإسلام بين الشرق والغرب/ ترجمة محمد يوسف عدس. ط. 2. ميونخ: مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات. 1997. ص ص. 177 – 215.
([1]) ذكر بعضهم أن كلمة «طبيعة» تستخدم في 52 معنى مختلفًا. ونحن نعني بها في هذا السياق جميع الحقائق فيما وراء جوهر الإنسان، ومن ثم فهي تعني عالم الإنسان الدنيوي مشتملاً على جسمه وذكائه وكل ما يتصل بهما.
([2]) أنظر: «تشارلز داروين، في كتابه «أصل الأنواع،
Charles Darwin: On the Origin of Spacies by Means Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (London: Oxford University Press, 1925).
Mandeville, Bernard: The Fable of the Bees..(London: Penguin Books, 1970).
Friedrich W. Nietzsche: Thus Spoke Zarathustra
([5]) إذا كانت أفكار نيتشه، امتدادًا فلسفيًا لداروين، فإن هتلر ونازته اشتقاق سياسي من كلا المذهبين.
Plato: Phaedo, trans. R.S. Bluck (London: Routledge and Paul, 1955).
([7]) ظهرت هذه الحركات في فرنسا وإنجلترا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وعرفت بأسماء مختلفة مثل: جمعيات الثقافة الأخلاقية، مؤسسات الإنعاش، الجمعيات الأخلاقية.. إلخ.
- Perret, n.p.d.
Paul Henry, Thirty [Dietrich von Holbach] the System of Nature, or Laws of the Moral and Physical World.. trans (Boston: J.P. Mendum, 1889).
Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Lagislation.. (London: Athlone Publishing, 1970).
([11]) هذه نظرية في الأخلاق تجعل من التماس السعادة أساسًا للسلوك الأخلاقي ومحكًا له.
([12]) كثيرًا ما يتداول الناس المثل الدارج الذي يقول «الأمين والمجنون أخوان». ومع ذلك، فلا بد من تقرير حقيقة أن الحكمة الشعبية لم تروج أبدا للخيانة أو الفساد.
([13]) استبيان أجري في باريس سنة ۱۹۷6.
([14]) مؤلف هذه المعادلة الشهيرة هو «جيرمي بنتام)، وهو قانوني إنجليزي وفيلسوف ومادي وصاحب نظرية المنفعة في علم الأخلاق. أنظر أيضًا: هامش ۳۱ من هذا الفصل.
([15]) إن الفعل الأخلاقي الحق هو الفعل الذي يستهدف الكمال الإنساني. أنظر: «ليبنتز»
Gattfried W. von Leibniz: New Essays Concerning Human Understanding, ed. Karl Gerhardt, vol. 5.. (La Salle, IL: Open Court Publishing Co., 1949).
Leo Tolstoy: The Christian Teaching.. (New York AMS Press, 1968).
David Hume: Treatise on Human Nature (London: J. M. Dent & Sons, 1926).
Jean-Paul Sarter: Huis Clos in Theatre (Paris: Gallimard, 1947).
([19]) أنظر: كُلاً من «إميل زولا»، و«هيبولایت تاين»
Emile Zola: Le Ventre de Paris (Paris: Fasquelk 1953), and Hippolyte Taine: Notes on Paris (New York: H. Holt and Co., 1879).
([20]) يعتقد الماديون في القدرة الشاملة للتدريب، مثال ذلك «كلود هلفتيوس» Claude Helvitius في كتابه الإنسان» De L’Homme، بينما يذهب المسيحيون إلى أن التدريب قاصر تمام القصور.
([21]) أنظر: القرآن، سورة البقرة، الآية (۲56).
([22]) جوهر الروح هي الحرية وجوهر المادة هو الكمّ، أنظر: هيجل
George Hegel: Sämtliche Werke.. (Stuttgart: F. Frommann, 1961).
([23]) أنظر: «فرانسوا ماري أروي دي فولتير»:
Francois Marie Arouet de Voltaire: Oeuvres complètes de Voltaire, vols 17-20: Dictionnaire philosophique (Paris: Garnier freres, 1885).
([24]) لقد حرّمت ثورة الصين الثقافية من بين أشياء أخرى أعمال «تولستوي» و«شكسبير» و«بيتهوفن»، وهو أمر منطقي من وجهة نظر هذه الثورة.
([25]) صرح «ماركس» نفسه أن «أسخيلوس» و«شيكسبير»، و«جوته»، هم الكُتّاب المفضلون عنده. وكان «ماركس» يقرأ «أسخيلوس، كل سنة مرة في لغته اليونانية. وكثيرًا ما كان يتلو أشعار «هوميروس» و«أفيد»، وأما تأثير «جان جاك روسّو» فمعترف به في أعمال «ماركس» الأولى، على سبيل المثال فكرته عن أصل «اللامساواة الاجتماعية وأصل الملكية»، أنظر: «روسّوه»
Jean Jacques Rousseau. On the Origin of Inequality. On Political Economy. The Social Contract, trans. G.D.H. Cole (Chicago: Encyclopaedia Britanica, 1955).
([26]) هذا الكلام منسوب إلى «بروفسوره «فوكو بافیسيفتش» Vuko Pavicevic قاله في مؤتمر «حوار الملحدين ورجال الدين» الذي انعقد في بلجراد خلال مايو ۱۹۷۱م.
.Karl Marx: Capital (Moscow: Progress pub., 1965).
([28]) وليس عند «أنجلز» هو الآخر فكرة أفضل عن الأخلاق، فقد قال: على أساس من الاستبصار في الوعي والضمير نجد أن كل طبقة وحتى كل مهنة لديها أخلاقياتها الخاصة، وهم يخرقونها كلما استطاعوا ويفلتون من العقاب. إن الحب الذي من شأنه أن يوحد كل شيء يكشف عن حقيقته في الحروب والصراعات والنزاعات الأسرية وفي الطلاق وفي أكبر قدر من الاستغلال للناس من جانب أناس آخرين، أنظر: «أنجلز»
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical German Philosophy.. (New York: International Pub., 1941).
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies