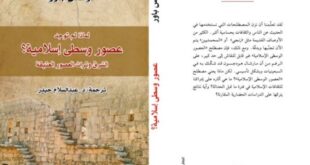العنوان: التطور الثقافي في العصر الرقمي.
المؤلف: ألبيرتو أتشيربي.
المترجم: أحمد الأحمري.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: بيروت.
الناشر: الدار العربية للعلوم.
سنة النشر: 2021.
الوصف المادي: 455ص. ، 24 سم.
الترقيم الدولي الموحد: 6-3339-01-614-978.
لا تزال الأبحاث والدراسات حول العالم الرقمي وأبعاده وتأثيراته المختلفة على الإنسان وشتى جوانب حياته تتوالى في محاولة لملاحقة المستجدات التي لا تتوقف، فهذه الساحة التكنولوجية سريعة التطور والتغير تثير العديد من التساؤلات البحثية بشكل مستمر، ولعل سؤال الثقافة يعد من أكثر الأسئلة إلحاحًا في العصر الرقمي نظرًا لتعلقه بكينونة الإنسان وجوهره، وما يحويه من قيم وعادات وتقاليد ومعاني، أي ما يشكل هويته ككل. وفى هذا السياق يأتي هذا الكتاب ليتناول بالبحث العلاقة بين الثقافة والتقنية في محاولة لفهم آلية تطور وتشكل الثقافة عبر وسائل الاتصال الرقمية وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وفى ظل هذا يؤكد المؤلف على أنه سيخوض هذا الغمار بعين ناقدة مبشرة وليست سلبية.
مقدمة المؤلف
يؤسس المؤلف في مقدمته الخلفية المعرفية للكتاب والقضايا التي سيتناولها ضمن فصوله، فيوضح ابتداءً أن التقنيات الرقمية لا تختلف عن غيرها من التقنيات في سرعة تطورها، ولكن الفارق يكمن في كون تأثيرها على حياتنا اليومية عميق ومستمر، ومن هنا سوف يقوم عبر موضوعات الكتاب بمقارنة الوضع الحالي بأنظمة الاتصال التي كانت تستخدم في الماضي في محاولة لفهم الخصائص التي تجعل من التطور الثقافي في العصر الرقمي حالة خاصة، ومن ضمن هذه الخصائص الوفرة المعلوماتية والقدرة على الوصول الى المعلومات وإيصالها بشكل مباشر وسريع، والوضوح والدقة في معرفة الكثير من الأمور التي كان من الصعب معرفتها سابقًا.
وفى هذا الإطار يستند الكتاب منهجيًا ونظريًا إلى حقل “التطور الثقافي” كحقل معرفي ينتمي لعلم الأنثروبولوجيا باعتبار أنه إطار علمي يهدف إلى تقديم تفسير وفهم للسلوك البشري بالاستناد إلى علوم الإدراك ونظرية التطور والمنهج التجريبي الكمي.
وقبل الخوض في فصول الكتاب يؤكد المؤلف على أن فهم التأثير القائم للبيئة الرقمية لابد له من نظرة بعيدة المدى دون إغفال ما يمكننا فعله في الوقت الحالي للحد من تأثيراتها السلبية والمساهمة في تحسين حياة المجتمعات الإنسانية.
الفصل الأول
شبكة متنامية للانتقال الثقافي
يستدعي المؤلف في بداية الفصل بحث عالم الأنسنة (روبين دونبار) حول الدماغ البشري الذي توصل من خلاله أن الكائنات الحية التي لها أدمغة كأدمغة الإنسان لابد لها أن تعيش في مجموعات يقدر عددها بحوالي 150 فردًا، وقد اشتهر هذا الرقم عالميًا وعرف برقم دونبار. وعلى الرغم من أن الأدلة الواردة غير كافية لإثبات صحة هذا الرقم إلا أن المؤلف يعتمده كرقم تقريبي لقدرة الفرد الإدراكية في التعامل مع الدوائر الاجتماعية المحيطة خارج العالم الرقمي، حيث يري أن الفرد لا يستطيع التواصل مع عدد يفوق رقم دونبار بكثير حيث لا يستطيع الحفاظ على تواصل دائم معهم في ظل القيود الزمنية والإدراكية التي تمنعه من ذلك. بناءً على ذلك ينتقل المؤلف إلى مناقشة أثر الاتصالات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي على حجم الدوائر الاجتماعية المحيطة بالإنسان، نظرًا لما تتيحه من آليات تخفف من القيود الزمنية والإدراكية التي تعيق الفرد من التواصل مع أعداد كبيرة من المعارف والأصدقاء خارج الفضاء الرقمي، فمجرد أن يكتب الفرد منشورًا على فيسبوك أو يغرد على تويتر فإن ذلك يصل إلى قائمة أصدقائه كلها مباشرة دون جهد يذكر، وكذلك يمكنه إرسال التهاني والمعايدات لعدد كبير من عائلته وأصدقاؤه في واتساب أو سناب شات في غضون دقائق، كما أن بعض وسائل التواصل كفيسبوك على سبيل المثال يزيح عن الفرد بعض الحمل الإدراكي الذي يحتاجه للحفاظ على علاقاته بتذكيره ببعض المناسبات المهمة مثل أعياد ميلاد الأصدقاء، إلى غير ذلك من الخصائص التي تسهل عملية التواصل وتتجاوز قيود الزمان والمكان والإدراك. لكن المؤلف يعود ليؤكد أن هذا التجاوز ليس تجاوز مطلق، فمازال هناك تشابه في البنى الاجتماعية بين الفضاء خارج الإنترنت وداخله يجعل هناك قيودًا زمنية وإدراكية تحد من مقدار علاقتنا الاجتماعية ذات الجودة، فالتواصل عبر الشبكات الرقمية مع عدد كبير من الناس لا يكون في الحقيقة تواصلًا حقيقيًا بناءً.
ومن هذه الفكرة يذهب المؤلف لمناقشة نظرية “القرية العالمية” للفيلسوف الكندي (مارشال ماكلوهان) والفرضيات التي تقول بانعدام قيمة الجغرافيا في العصر الرقمي، حيث ينتقد المؤلف هذه الفرضيات ويرى أن الجغرافيا مازالت تؤثر في دوائرنا الاجتماعية حتى عبر الفضاء الرقمي، فتوزيع المعارف في فيسبوك -على سبيل المثال- يرتبط ارتباطًا عكسيًا مع المسافة الجغرافية، فغالبية أصدقاؤنا على فيسبوك يعيشون في نفس مدينتنا، ولذلك فإننا نكثر من استخدام هواتفنا لتعزيز روابطنا على المستوى المحلي خارج فضاء الإنترنت، وليس من أجل البقاء على اتصال مع أولئك الأشخاص البعيدين عنا جغرافيًا.
ونظرًا لأن المناقشات في محيط الفضاء الرقمي لا تسعف الباحثين عن إجابات قاطعة وحاسمة للقضايا، ذلك لاجتماع المتناقضات والثنائيات معًا، يبين المؤلف أننا يمكننا أن ننظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنها هجين من دائرة الأصدقاء وشبكة تبادل المعلومات، فدائرة الأصدقاء هي التي ينطبق عليها ما ذكر آنفًا من أنها لم تنفك كليًا عن القيود الزمنية والمكانية والإدراكية، أما شبكة تبادل المعلومات فهي متحررة كليًا من هذه القيود حيث تهدف إلى زيادة عدد المعارف وتبادل المعلومات العامة وليست الشخصية -كما هو حال على تويتر- والتواصل مع أشخاص لهم نفس الاهتمامات حتى لو لم ولن تلتق بهم نهائيًا في الواقع، أي أنها هي هذا الشق من وسائل التواصل الذي يمكن أن يجسد فكرة “القرية العالمية”.
وهنا يناقش المؤلف بعض الأبعاد الثقافية المتعلقة بشبكة تبادل المعلومات، فيشير أولًا إلى مسألة قيام الإنترنت بتحويل المستخدمين الخاملين إلى صانعي محتوى فاعلين يعتمدون في استمراريتهم على تقييمات المتابعين لهم في ظل عملية من التنظيم الذاتي تدار عبر العالم الرقمي. وهنا لم يتوقف المؤلف عند مسألة التنظيم الذاتي للعالم الرقمي والمتعلق بتقنيات المراقبة التي تقوم بها بعض الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، حيث اكتفى بتسليط الضوء على التطور الثقافي الذي أحدثه العالم الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمستخدمين من أن يصبحوا صناع للمحتوى وليس مستهلكين فقط.
من هذه النقطة ينتقل لمناقشة بُعد آخر يتعلق بدوافع الأفراد في مشاركة المعلومات وصناعة المحتوى -ويقصد هنا المحتوي النافع الإيجابي- ضمن ساحات رقمية، يكون الفرد في بعضها معلوم الهوية –إلا إذا أراد أن يخفي هويته عمدًا- مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر، والبعض الآخر يكون الفرد فيه مجهول الهوية مثل ويكيبيديا. وبعد استبعاد العائد المادي من هذا التحليل، يذكر المؤلف أن السبب وراء انتشار الشبكات التي من خلالها يحدث الانتقال الثقافي هو أننا -معشر البشر- مغرمون بمشاركة المعلومات. كما أن الأفراد يقومون بذلك بشكل رئيسي من أجل الحصول على مردود مباشر سواء من ناحية تبادل المصالح (فمثلًا إذا أعدت تغريدة زميل يبحث عن وظيفة فإنني أكاد أجزم أنه سيعيد إحدى تغريداتي مستقبلًا) أو تحسين السمعة (حيث إن التغريدات المرتبة ومشاركة الأوراق العلمية المثيرة للاهتمام والأخبار يعتبر أسلوبًا فاعلًا ليتعرف الآخرون عليك وتقديرك).
وينتقل المؤلف لمناقشة موقع الويكيبيديا، ويتساءل لماذا نحرر في الويكيبيديا دون ذكر للأسماء؟ وجاء رده “أنها تجعلنا نشعر بالرضا عن أنفسنا”، ولكن لم يشعر الكاتب أن هذا السبب كافي. ويرى أن الأفراد يقومون بذلك لإخبار الآخرين خارج فضاء الإنترنت بما قاموا به بما يعزز من سمعة الفرد، كما أنه يقدم صورة دقيقة لمجالات اختصاصهم. وأخيرًا فإن التكلفة الزهيدة للمشاركة قد تجعل الأفراد يقومون بذلك بشكل عفوي دون انتظار أي مردود.
وينتقل المؤلف إلى مسألة “الحجم المؤثر للمجتمع الثقافي”، التي يرى البعض أنها تعني عدد الأشخاص المشاركين فعليًا في نقل المكون الثقافي، ويقصد بذلك جميع الأفراد المهتمين بموضوع معين “كموضوع الزي التاريخي مثلًا” ويشكلون سلسلة انتقال تتضمن تبادل المعلومات حيال هذا الموضوع. وهناك تعريف آخر يشير الى أن الحجم المؤثر للمجتمع الثقافي يتضمن كل الأفراد الذين يمكن للفرد أن يتواصل معهم في عملية نقل المكون الثقافي والتي يمكن أن يصل عددهم الى الملايين، وذلك بتكلفة زهيدة لا تكاد تذكر وبسرعة كبيرة، حتى أننا نميل الى مشاركة المعلومات بعفوية في هذه الشبكات دون انتظار رد الجميل ولا أي مردود آخر.
الفصل الثاني
المتعلمون الحذرون
يؤكد المؤلف أن “التطور الثقافي” يمد الباحث بمنهج كمي الى جانب إطار نظري قوي في مجال دراسة الثقافة. وعلماء “التطور الثقافي” يميلون الى التفسيرات الكمية والنمذجة وجمع البيانات وإجراء التجارب، والأهم من ذلك كله أنهم يعتقدون أنه ينبغي لدراسة الثقافة أن تكون في الميدان العلمي الصِرف، أي أن تستند على المنهجيات العلمية.
ويتوافق التركيز على الجانب الكمي مع نوع البيانات التي ينتجها العصر الرقمي، حيث أصبح في المقدور الوصول الى فيض المعلومات والبيانات الضخمة لم يكن متاحًا من قبل، وبخاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وهنا يؤكد المؤلف أن “التطور الثقافي” يقدم لنا منظورًا متميزًا لفهم هذه المعلومات، فيبدأ أولًا بوضع الإطار النظري القائم على فرضيات نظرية التطور لتشارلز داروين من أجل توظيفها في الموضوع محل الدراسة، وهنا يشير المؤلف إلى نظرية “التفكير الجمعي” لداروين أيضًا وأهميتها بالنسبة لعلماء التطور الثقافي ودورها في تفسير تحول بعض الأشياء إلى رموز ثقافية.
ويشير المؤلف الى أن الإدراك البشري قد تطور في بيئة اجتماعية وتأقلم على معالجة المعلومات الاجتماعية، إلا أنه يشير الى سهولة التأثير علينا نظرًا لتعرضنا لما يفوق طاقتنا الاستيعابية من معلومات تتدفق بكميات كبيرة جدًا، “إن أهم تحدي نواجهه في حياتنا داخل فضاء الإنترنت هو ألا نسمح بخاصية الوصول السهل جدًا الى معلومات كثيرة جدًا بأن تجعلنا مجرد أوعية خاملة إزاء آراء الناس”.
هنا يتناول المؤلف قضية التعلم الاجتماعي والتقليد ويرى أن التحدي الذي يفرضه العصر الرقمي بشكل كبير على هذه العملية هو زيادة إمكانية وسهولة التضليل والخداع، وفى ظل مسعى المؤلف لبيان نقطة التوازن التي تجمع بين التعلم من الآخرين وبين تجنب التضليل، يميز أولًا بين نوعين من التعلم -مستعينًا بنموذج روجرز نسبة إلى عالم الأنسنة آلان روجرز- التعلم الفردي القائم على الوصول للمعلومة عن طريق الاستكشاف، والتعلم الاجتماعي القائم على استقاء المعلومة التي تم الوصول إليها من قِبل الآخرين.
وفي هذا السياق يشير المؤلف الى مجموعة من استراتيجيات التعلم الاجتماعي يتبعها الأفراد وتختلف من سياق لآخر ومن بيئة لأخرى وتدور في المجمل حول “المحاكاة”، ولكن يختلف شكل المحاكاة وأسبابها، فالبعض يحاكي بمنطق الأغلبية، والبعض الآخر يحاكي أصحاب المكانة، وغيرهم يحاكون الناجحين إلى غير ذلك من أشكال المحاكاة، وتختلف نتائج هذه المحاكاة بالسلب أو الإيجاب بحسب الظروف البيئية.
هنا يغوص المؤلف في بيان الظروف والسياقات التي يجنح فيها الأفراد للتعلم الاجتماعي، ويذكر عدد من التجارب العلمية التي أجريت لقياس حجم التأثير الاجتماعي ومدى تأثر الأفراد برأي الأغلبية ومتى ينصاعوا له، وقد آلت كل التجارب التي استدعاها المؤلف في هذا الفصل إلى بيان قوة تأثير التعلم الاجتماعي وما يتضمنه من استراتيجيات المحاكاة والتقليد، وهكذا وفى نفس الوقت أظهرت مواطن وظروف يُظهر فيها الأفراد قدر عالٍ من استقلالية الرأي. وهنا يؤكد المؤلف على أنه بالرغم من الإقرار بقوة التأثير الاجتماعي المحيط إلا أن مبالغة البعض في الاعتقاد بقوة هذا التأثير بحيث تجعل الفرد ساذجًا دائمًا ولا يملك القدرة على التحقق من موثوقية ما يقدم له ليست دقيقة، بل يرى أنه حتى وإن كان التقليد استراتيجية تعلم عند البشر فهناك مقلدون حذرون أو ما يطلق عليهم متعلمون حذرون، وهم من يتعلمون من الآخرين ويقلدوهم أحيانًا لكن بقدر من الحذر والوعي عملًا بنظرية “الحذر المعرفي” التي تفترض أننا نوظف مجموعة من العمليات الإدراكية المعقدة من أجل التأكد من موثوقية المعلومات المستقاة من الآخرين. وفى غالبية الحالات يكون تعلم الأفراد هجين بين التعلم الفردي والاجتماعي معًا.
الفصل الثالث
المكانة الرفيعة
بناءً على ما سبق طرحه في الفصل الثاني من استراتيجيات (آليات) التعلم الاجتماعي، يأتي هذا الفصل ليسلط الضوء على إحدى هذه الآليات وهي “نزوع الأفراد إلى تقليد ذوي المكانة الرفيعة”، وتعتبر هذه الآلية من أكثر الموضوعات دراسة في مجال التطور الثقافي، وفى هذا السياق يستدعي المؤلف تحدي “كيكي” الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات وشارك فيه عدد من المشاهير، ليطرح سؤال حول كيفية عمل هذه الآليات في الإنترنت وخارجه.
يبدأ المؤلف أولًا بالتأكيد على واقعية هذه النزعة ويستشهد بعدد من التجارب التي تؤكد أن الأفراد والصغار ينزعون لتقليد ذوي المكانة الرفيعة (المكانة الاجتماعية)، ثم ينتقل لبيان مخاطر هذه النزعة وآثارها السلبية. فالتقليد المنحاز للمكانة الاجتماعية قد يؤول لعدد من الحالات السلبية ومنها:
أ-“التطفل الثقافي” بمعنى تقليد الفرد أحد المكونات الثقافية الموجودة في صاحب المكانة الاجتماعية غير تلك التي أكسبته المكانة من الأصل، كأن يقلد الفرد طريقة لباس لاعب كرة قدم وليس مهارته في اللعب.
ب- “الهدف الضائع” وهو أن يقلد الفرد صاحب المكانة في الأمر الذي يتقنه وأكسبه تلك المكانة ولكن الأمر المقلَد لا يقع ضمن اهتمام الفرد من الأساس.
وهنا ينقل المؤلف هاتين المشكلتين إلى عالم وسائل التواصل الرقمي مبينًا أن كلتيهما يشتركان في خاصية الحساسية تجاه الوفرة العالمية التي تقدمها وسائل التواصل، لأنه كلما كبر حجم الشبكة التي يمكن من خلالها أن تنتقل الثقافة كلما زادت صعوبة تقييم المهارات التي لها ارتباط بالمكانة الرفيعة، وكلما بعدت المكانة الرفيعة عن خبراتنا الملموسة كلما سهل تعلم المهارات التي لا علاقة لها بإكساب الفرد المكانة (التطفل الثقافي)، أو التي ليس لها علاقة ببيئتنا المحلية (مشكلة الهدف الضائع)، وهذا بدوره يفسر الاستعانة بالمشاهير والممثلين في الإعلانات التجارية.
وفى هذا السياق يتتبع المؤلف بالبحث مدى قوة تأثير المشاهير من خلال ظاهرة انتشار اقتباساتهم، وذلك بإجراء تجربة يقوم فيها المشاركون باختيار أكثر الاقتباسات إلهامًا من بين نوعين من الاقتباسات في نفس المجال أحدهما منسوب لمؤلف مشهور والآخر غير ذلك، وقد كانت النتائج على غير المتوقع، إذ وجد أن نجاح الاقتباس كان مرتبطًا أساسًا بمحتوى الاقتباس نفسه، إلا أن المؤلف يرى أن العلاقة السببية معكوسة فنسبة الاقتباسات إلى المشاهير يكون نتيجة الانتشار الواسع للاقتباس ذاته وليس العكس.
ويستكمل المؤلف بحثه في مسألة قوة تأثير المشاهير من خلال دراسة ظاهرة ظهور المشاهير في الإعلانات التجارية ليرى ما إذا كان ظهور المشاهير يُكسب المنتج المعلن عنه جاذبية أكبر، وقد توصل المؤلف إلى مجموعة من النتائج تفيد بأن تأثير الشهرة في هذا السياق يفضي إلى نتائج مختلطة، بمعنى أنها ليست دائمًا إيجابية، فعلى الرغم من أن المستهلكين قد يشعرون بجاذبية أقوى نحو الإعلانات التي تحتوي على وجود مشاهير إلا أن هذا الشعور قد يجذب الانتباه الأولي للإعلان لكن هذا لا يعني أن المشاهير قادرون على جعل الإعلان أكثر مصداقية. من ناحية أخرى قد يختلف تأثير المشاهير حسب ارتباط المشهور بالمنتج ذاته، فإذا قام على سبيل المثال رياضي مشهور بالإعلان عن علامة تجارية للملابس الرياضية فهذا يؤثر بشكل إيجابي ويكسب الإعلان مصداقية أكبر. من هنا يخلص المؤلف إلى أن الانحياز للمكانة الاجتماعية له تأثير، ولكن هذا التأثير على درجة من التعقيد، ويضيف بأن تأثير المشاهير يزداد عندما يتلاقى مع اهتمامات المتلقين ولكنه لا يُنشئ اهتمامًا غير موجود.
وبالانتقال إلى ظاهرة “المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي” يرى المؤلف أن وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية سمحت للمؤثرين التقليديين بالحصول على متابعين بأعداد هائلة، كما سمحت بربط الأشخاص المشابهين بعضهم ببعض أو ممن لديهم خبرات أكبر أو موثوقية أعلى في مجال محدد، خاصةً وأن الكثير منهم قادرين على بناء علاقات مباشرة مع متابعيهم. ومن ثم فإن الافتراض القائل بأن البشر يقلدون المشاهير أو ينحازون لذوي المكانة بصورة مطلقة غير صحيح، بل هناك عوامل عديدة ومعقدة تؤخذ في الاعتبار بالإضافة إلى مسألة الحذر المعرفي التي يتم بموجبها التقليد ولكن بوعي واستبصار.
الفصل الرابع
الشهرة
بعد أن تناول المؤلف نزعة الانحياز للمكانة الرفيعة يستكمل في هذا الفصل مناقشة نزعة أخرى، وهي نزعة تقليد الغالبية. ويؤكد الكاتب أن الطريقة التي تؤثر بها الشهرة على خياراتنا لم تختلف عن المرحلة التي سبقت الإنترنت، إلا أن الإنترنت أصبح يزودنا بإشارات صريحة ومباشرة للشهرة يمكن قياسها كمًا. ويتطرق المؤلف لظاهرة الاختيارات العشوائية التي تولد الشعبية بشكل تراكمي بطيء لتبدأ هذه الشعبية في تأييد ذاتها بذاتها، ثم يأتي دور ما يسميه علماء التطور الثقافي “بالامتثال” -بعد أن يدخل المكون الثقافي نطاق الغالبية- وهو ما يتطلب من الأفراد أن يفضلوا الاختيارات ذات الشعبية الواسعة، ومن هنا يظل معدل الشهرة في ازدياد.
ويثير الكاتب هنا تساؤلًا حول ما إذا كنا “نفعل ما يفعله الآخرون” لأن فعلهم هو الشيء الصحيح، أم أننا نفعل ما يفعلونه لأننا نود أن نكون مثلهم، وهذا ما يسمى أكاديميًا بالامتثال “التعريفي” أو “المعياري”. ويهتم علماء التطور الثقافي عمومًا بالنوع الأول.
وقد قام الكاتب بدراسة التأثير العام “للعدادات” التي تحسب عدد مرات الإعجاب والمشاركة والتي تقيس كمًا ظاهرة الشهرة بدقة ووضوح وعلى الملأ، ونظرًا لكوننا حساسين تجاه هذه الإشارات كما يتصور علماء التطور الثقافي، فإن هذا الابتكار سيقوم باستثمار هذه النزعة الطبيعية رغم الشكاوى التي تظهر أحيانًا حول الآثار السلبية المحتملة لهذا الأمر.
ويتوقف المؤلف بعد ذلك لتسليط الضوء بعمق على مفهوم “الامتثال” عند علماء التطور الثقافي وما قاموا به من تجارب عملية لمعرفة إلى أي مدى نحن امتثاليين. ومن خلال ما أورده المؤلف من تجارب عملية توصل إلى نتيجة مشابهة لما آلت إليه التجارب التي ذكرها في فصل المتعلمين الحذرين، وبما ينسجم أيضًا مع ما ذكره بشأن الانحياز للمكانة الرفيعة، وهي أن تقليد الغالبية (الامتثال) إنما يحدث بوجود عوامل كثيرة ومعقدة التأثير، فالأشخاص بحسب التجارب التي أوردها لم يقلدوا الغالبية إلا لتشابه حصل بينهم وبين الأشخاص الذين قلدوهم أو لتشابه المواقف، وبالتالي سيكون من المنطقي أن الجميع سيتصرفون بما ينسجم مع هذا الموقف المعين. بالإضافة إلى ذلك فالمشاركون لم يتبعوا الأغلبية في المهمات السهلة التي استطاعوا حلها من قبل أنفسهم. ومن هنا يؤكد المؤلف أن المخاوف بشأن سلوكنا في تقليد الغالبية قد بولغ فيها، فنحن نتبع الأغلبية في كثير من الأحيان لأسباب وجيهة وإذا اختفت هذه الأسباب فلا نتبع.
ينتقل المؤلف بعد هذا البيان إلى مؤشرات الشهرة في العصر الرقمي في ظل تحليل لآثارها بين العالم الواقعي والعالم الرقمي، فيذكر مسألة علانية مؤشرات الشهرة والتي تظهر في “تقييمات المنتجات” على موقع أمازون أو من خلال معرفة “عدد نقرات الإعجاب والمشاركة” في فيسبوك أو “أعلى القائمة” في تطبيق مثل سبوتيفاي للموسيقى، وما إذا كانت هذه المؤشرات تؤثر في اختياراتنا، ومن خلال بعض التجارب التي أجريت في هذا الصدد تبين أن الأمر لم يختلف كثيرًا عن ما ذكره في تجارب الامتثال، مبينًا أن هذه المؤشرات تؤثر ولكن في ظل وجود عوامل أخرى تتعلق بالجودة الحقيقية للمحتوى وخبراتنا الشخصية تجاهه، فمؤشرات الشهرة هذه تعمل بمثابة إشارة لنا تحفز إعجابنا بالشيء ولكنها لا تضع غشاوة على أعيننا. فبحسب أحد التجارب التي أجريت قام فيها الباحثون بخداع المشاركين من خلال تقديم ترتيب الموسيقى الأكثر تحميلًا معكوسًا لتأتي الأغاني الأقل تحميلًا في المقدمة والعكس صحيح، وقد كانت نتيجة التجربة أن المشاركين بدأ تفضيلهم يقل لأغنية المرتبة الأولى وبدأ معدل تحميل المرتبة الأخيرة في القائمة يتزايد مما يشير إلى أن مؤشرات الشهرة لا تؤثر إذا كانت جودة الأشياء رديئة، ومن ثم فإن مؤشرات الشهرة لا تأتي من فراغ بل لابد أن يكون المنتج أو المحتوى على درجة من الجودة في ذاته، ومن هنا فإن معيار الجودة يصبح هدفًا لشركات مثل أمازون، ومن ثم يكون احتمال وقوع التدليس فيما يعلنوه من تقييمات العملاء لمنتجاتهم ضئيل، وليس الأمر بدافع أخلاقي بقدر ما هو تحقيقًا لمصلحة هذه الشركات في زيادة مبيعاتها التي لا تكون إلا بوجود تقييمات حقيقية تنبئ عن جودة منتجاتها، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تقوم فيها بعض المواقع بتقييمات وهمية كأن تكون هناك مؤسسة أخرى تنافسها فيما تقدمه وبمستوى جودة متقارب.
وفى الختام يشير الكاتب الى أنه حاول في هذا الفصل إثارة الشكوك لدى القارئ حول الفكرة السائدة التي تقول بأن الإنترنت هي الأداة التي من خلالها يزداد الثريُ ثراءً بسبب تواجد قلة من اللاعبين الكبار الذين يربحون على حساب الآخرين مستغلين سلوكنا الجمعي المزعوم. ويؤكد على أن الآثار المترتبة على التأثير الاجتماعي غالبًا ما تُعطى أكبر من حجمها، مشيرًا إلى أن تفضيلنا للأشياء ذات الشعبية الواسعة خاصة في العالم الرقمي لا تعني بالضرورة وجود عنصر الامتثال إذ أنها قد تكون نتيجة لمبدأ الوفرة، فكلما زادت الأمثلة عن شيء ما كلما زادت فرصة رؤيتنا له وبالتالي تزيد احتمالية اهتمامنا به، وهذا من الفروق الجوهرية بين العالم الواقعي والعالم الرقمي الذي تعد الوفرة إحدى خصائصه المميزة. وهذا يقودنا –كما يرى الكاتب- الى أن الشهرة والمكانة الرفيعة إشارتين لهما وزنهما عند اتخاذنا قرارات حيال تقليد شيء من عدمه، لكنهما يتداخلان في التأثير مع عوامل أخرى عديدة كأهمية الأمر نفسه، ومعرفتنا السابقة، وإن كان لدينا أسباب للوثوق بالآخرين إلخ
الفصل الخامس
غرف الصدى
يركز المؤلف في هذا الفصل على ظاهرة “غرف الصدى” التي وصفت من قِبل البعض بأنها أكبر مهدد للديمقراطية، والمتمثلة في كون الأفراد أثناء استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع مجموعات تشبههم في التفكير مما يجعلهم عرضة للمعلومات نفسها على نحو متكرر من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يتعرضون لأي معلومات مخالفة لهم، ومن هنا يحاول المؤلف تقييم هذه الظاهرة من منظور التطور الثقافي والإجابة عن سؤال مدى قوة غرف الصدى وتأثيراتها على التدفق المعلوماتي في الإنترنت، وما إن تم تضخيم أثرها السيئ وأن الحقيقة ليست بهذه المبالغة.
ولفهم ظاهرة “غرف الصدى” يقوم الكاتب بمناقشة استراتيجية “مشابهة الذات”، وهي استراتيجية لها أسبابًا بدهية، فبقدر ما يزداد الشبه بيننا وبين الآخرين من حيث الظروف والتحديات بقدر ما تزيد مساحة محاكاتهم. ويشير المؤلف إلى من يشاركوننا في العرق على وجه الخصوص، لأنهم في هذه الحالة سيشاركوننا أيضًا أنظمة الأعراف والتقاليد، وهذا يجعل تقليدنا لهم يثمر عن تعلم الكثير من المكونات الثقافية النافعة بالنسبة لنا، وهذا لا يتوفر عند تقليدنا ذوي المكانة الرفيعة أو أصحاب الشهرة المختلفين عنا والذي قد يؤدى بنا الأمر في نهاية المطاف إلى تعلم مهارات لا نفع منها، ومن ثم فإن استراتيجية “مشابهة الذات” تعتبر قاعدة عامة بين كل استراتيجيات التعلم الاجتماعي، وهذا بدوره يفسر جزئيًا ميلنا للتعلق بغرف الصدى. أمر آخر يفسر هذا التعلق يرتبط بما يُطلق عليه مصطلح “التحيز لوجهة النظر الشخصية” أو ما أسماه علماء النفس “بالتحيز التوكيدي” أي التحيز إلى ما يوافق آراءنا الحالية.
في هذا السياق ينتقل المؤلف لمناقشة العلاقة بين “غرف الصدى” ومفهوم الاستقطاب، ومدى مساهمتها في زيادة التطرف في الآراء وفي انتشار نظريات المؤامرة، نظرًا لكونها تحيط الفرد بما يتوافق مع آرائه وتصوراته وتغذي هذا التوافق بشكل مستمر بوفرة من المعلومات التي تعزز من هذه الآراء. وهنا يناقش الاستقطاب بين الإنترنت والعالم الواقعي حيث يذكر المؤلف أحد الدراسات التي أجريت لمقارنة الاستقطاب بين العالَمين، ومما توصلت له هذه الدراسة أن الاستقطاب في العالم الواقعي أي المتعلقة بالتفاعلات الإنسانية بين العائلة أو زملاء العمل أو الأحياء السكنية أعلى من الاستقطاب في العالم الرقمي. ومن أسباب هذه النتيجة غير المتوقعة أن الكثيرين ممن يرون أننا نعيش الآن أزمة استقطاب ينظرون فقط للمواقع القائمة في هيكليتها على مبدأ الاستقطاب.
في الجزء الأخير من الفصل يُفصِل الكاتب في الأسباب التي تدعم رؤيته بأن وسائل التواصل الاجتماعي لم توجِد الاستقطاب بل قد تسهم في تخفيف حدته، ويعدد أسباب ذلك والتي تتضمن أن غالبية مستخدمي وسائل التواصل والذين هم من فئة الشباب تستهويهم الأخبار الكثيرة والمتنوعة، هذا بالإضافة إلى أن غالبية مستخدمي وسائل التواصل يحافظون على صداقة مَن تربطهم بهم ارتباطات، ومن ثم فهم يتعرضون لما ينشرونه من محتوى في مجالات أخرى غير مشتركة بينهم وقد تكون في كثير من الأحيان مخالفة لآرائهم في المجمل، ولكنهم يبقون على وجودهم في قائمة الأصدقاء، ثالثًا هناك أسبابًا تتعلق بالمنصة ذاتها، فموقع تويتر على سبيل المثال يعمل بشكل مختلف عن فيسبوك فيجعلك أكثر عرضة لتلقي محتوى لا يشبهك.
في النهاية يؤكد الكاتب على أن أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام ليست في منأى عن النزعات الطبيعية الموجودة في العالم الواقعي ومنها ميلنا الطبيعي لما يعزز آراءنا، ولكنه يؤكد على رفضه لوصف هذه النزعات بأنها إما أن تحدث كلها وإما أن لا يحدث منها شيئًا على الإطلاق، ومن ثم فهو لا ينكر وجود الاستقطاب عبر وسائل التواصل كما هو الحال في العالم الواقعي، ولكنه بحسب الكثير من الدراسات التي يؤكد أن نتائجها لا تمدنا بتقييم قطعي إلا أنها تعطينا إشارات أن حدة الاستقطاب في العالم الواقعي أعلى منها في وسائل التواصل، هذا فضلًا عن التعقيد وسرعة التطور اللذين يتسم بهما العالم الرقمي التي تتضمن الهويات المجهولة وآليات عمل الخوارزميات والتي تجعل من الصعب إعطاء تحليلات وتفسيرات قطعية ونهائية.
وختامًا يذكر الكاتب مساهمات بعض المواقع الإلكترونية لتجاوز مشكلة غرف الصدى مثل موقع “all sides” الذي يقوم بتقديم زوايا مختلفة للقصة الواحدة، وبعض الصحف التي صارت تحوي أقسامًا مثل قسم “افقع بالونك” في صحيفة الغارديان.
الفصل السادس
معلومات مضللة
يناقش المؤلف في هذا الفصل واحدًا من الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالعصر الرقمي، وهو سؤال الحقيقة في مقابل التضليل والأخبار المزيفة. ويشير أولًا إلى أن انتشار المعلومات المضللة بشكل عام ليس وليد العصر الرقمي بل هي مشكلة قديمة حيث تجد الأكاذيب دائمًا طريقها في الانتشار بوتيرة أسرع من الحقائق، ولعل الجديد مع العالم الرقمي هي السرعة والوفرة والتكلفة الزهيدة لنشر المعلومات. ويناقش المؤلف هذه الفكرة ببعديها السلبي والإيجابي، فكما أن هذه الخصائص تساهم في انتشار المعلومات المضللة لأنها تسمح لأي شخص أو جهة بنشر ما يريد إلا أنها على الصعيد الآخر تسمح بسهولة نشر الحقائق، بل حتى على مستوى المجتمعات العلمية باتت وسائل التواصل أحد الوسائل التي تكشف عن الكثير من الأخطاء العلمية التي كانت تحتاج إجراءات معقدة للكشف عنها، حيث أصبحت عملية النقد أسهل وسعة انتشارها أكبر بكثير من ذي قبل.
يعود المؤلف للأسباب التي جعلت للتقنيات الرقمية مساهمة في انتشار المعلومات المضللة، فبجانب ما ذكره مما يتعلق بالسرعة والوفرة والتكلفة الزهيدة يأتي ما يسميه “بوهم الاتفاق”، وهو أن وفرة المعلومات في العالم الرقمي تعطى انطباعًا دائمًا للأفراد أن هناك من يوافقونهم فيما يعتقدون حتى وإن كانوا على خطأ، فبمجرد أن يبحثوا عبر محركات البحث عن أمر ما إذا بمئات النتائج التي تأتي موافقة لما يعتقدونه، وهذا مما يساهم في انتشار التضليل المعلوماتي، ولكن على الرغم من هذه التأثيرات المرتبطة بالعالم الرقمي يؤكد الكاتب على رؤيته المركزية في أننا متعلمون حذرون، وأن هذه العوامل تؤثر علينا بنسبة لكنها لا تعيق بشكل كامل قدرتنا على رؤية الأدلة والوصول للحقائق.
في هذا السياق يرد المؤلف على الرأي القائل بأن انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت يعتمد بشكل كبير على ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من إمكانية النشر مع إخفاء الهوية (خاصية الغموض)، ومن ثم يكون في مقدور أي أحد نشر الأخبار المضللة وبالأخص الشائعات دون إظهار هويته، بأن إمكانية إخفاء الهوية الحقيقية ربما يساعد في نشر المعلومات المضللة خاصة وانه يقلل من التكاليف المترتبة على سمعة الناقل، لكن الأمر ليس حتميًا. وفي هذا السياق يذكر مثال موقع ويكيبيديا وأن إخفاء الكثير من المساهمين فيه لهوياتهم لا يلغي جودة ما يحررونه مقارنة بالأشخاص ذوو الهوية المسجلة في الموقع، بل يذكر أن لإخفاء الهوية جانب إيجابي يتعلق بتوفير مساحة أرحب للآراء الصدامية وبخاصة الفئات المحرومة من حرية التعبير، كما أنه في بعض الأحيان يحفز من التفكير الإبداعي.
ويرى المؤلف أن المحتوى الذي يستثير عاطفة قوية تزيد احتمالية انتشاره بنجاح، ويستعين علماء النفس وعلماء التطور الثقافي بما يسمى أسلوب “الاستنساخ التسلسلي” وهو أسلوب “سلاسل الانتقال” لفهم المحتوى المتوقع انتشاره وبقاؤه ضمن سلاسل الانتقال الثقافي. فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى فإن المعلومات السلبية تكون أكثر جذبًا للاهتمام وقربًا من الذاكرة، وستحقق القصص السلبية نجاحًا ثقافيًا أكبر من القصص الإيجابية.
ينتقل المؤلف للحديث عن دور الخوارزميات كعامل خفي قد يعزز من انتشار المعلومات المضللة في الإنترنت، حيث تقوم الخوارزميات على سبيل المثال في موقع فيسبوك بعرض المنشورات التي حصلت على الكثير من نقرات الإعجاب والكثير من التعليقات والروابط، ومن ثم نجد أن المنشورات التي تستدعي ردات فعل مباشرة تعتلي قائمة ملف الأخبار وهذا عادة ما ينطبق على المنشورات المثيرة للجدل أو القصص الحماسية، وفي مثل هذا النظام يمكن أن تحظى المعلومات المضللة بالأفضلية لاسيما وأن القصص المكذوبة يمكن أن تصاغ بناء على الخصائص التي تجعلها جذابة، في المقابل نجد أنه ليس بوسع الأخبار الصحيحة أن تحقق ذلك والسبب يعود إلى ضرورة تطابقها للواقع.
بناءً على ذلك يطرح الكاتب سؤالًا حول ما إن كان انتشار المعلومات المضللة في الإنترنت يتفوق على انتشارها في الحياة الواقعية؟ ليجيب بطرح مجموعة من الدراسات التي تفيد بأن انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت محدودة النطاق، حيث تشير أحد الدراسات الإحصائية أن المواقع الإلكترونية المزيفة والمضللة عادة ما يتابعها جمهور ضئيل مقارنة بالمواقع الإلكترونية المعتدلة.
في هذا الإطار يناقش المؤلف بشيء من التفصيل الإطار النظري لفهم ظاهرة المعلومات المضللة من منظور علم الأنسنة الإدراكي وعلماء التطور الثقافي، فيتعرض لنظريتين في هذا السياق، الأولي تتعلق بما يسميه علماء التطور الثقافي “التحيز المبني على المحتوى” وهى ترتبط بخصائص جوهرية لمكونات ثقافية معينة تميل للنجاح وقد يعُد ذلك لطبيعة البيئة المستقبلة لهذا المكون الثقافي الذي قد يكون ملائمًا لها فينتقل إليها بشكل ناجح، مثل أن ينتقل اعتماد مجتمع يعيش على الصيد إلى استخدام أدوات أكثر تطورًا، وهذه الأدوات في المقابل لا تنتشر ولا تنجح في مجتمع آخر الصيد فيه ليس حرفة أساسية. أما النظرية الثانية فتتعلق “بالانجذاب النفسي” والمقصود به أن هناك خصائص ثقافية جذابة للنفس الإنسانية بشكل عام، ومن ثم فإن من عوامل نجاح أي مكون ثقافي يعود بشكل كبير إلى عامل الانجذاب النفسي للخصائص المرتبطة به، ومن ثم فإن الكثيرين ممن ينشرون المعلومات المضللة ومَن يصممون الألعاب الإلكترونية الضارة يعتمدون على عناصر الجذب النفسية بشكل كبير.
وفي هذا الصدد يذكر بعض عناصر الجذب النفسي:
أ- المحتوى السلبي: تزيد احتمالية انتشار المحتوى السلبي عن المحتوى الإيجابي بصفة عامة، فالناس عادة ما يميلون إلى تصديق المعلومات التي صيغت بصورة سلبية نظرًا لأنها أكثر جذبًا للانتباه وقربًا من الذاكرة. وتشير الدراسات الى أن هناك تحيزات سلبية مطردة في التغطيات الإخبارية، ولهذا نجد أن المعلومات المضللة في الساحة الرقمية تميل عادة إلى الجانب السلبي.
وهنا يطرح الكاتب سؤالًا حول سبب هذه النزعة الإنسانية في الميل نحو المعلومات السلبية، ويذكر هنا رؤية العلماء التطوريين اللذين يرون أن تفادي التهديدات المحتملة يحظى بمكانة هامة عند الكائنات الحية وعند البشر خاصة، ومن ثم فإنه في حالة وجود معلومات تتعلق بتهديد محتمل -بغض النظر عن مدى صحته- فإن مجرد وجود التهديد يزيد من احتمالية تصديق المعلومات.
سبب آخر يتعلق بتقييم التكاليف النسبية للمعلومات السلبية التي عادة ما تكون أعلى مما لو كانت إيجابية لأنها تتعلق بمخاطر معينة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون المعلومات المضللة تتمحور حول مختلف أنواع التهديدات لأن ذلك أدعى لانتشارها وتصديقها.
ب- الاشمئزاز: يمثل الاشمئزاز عنصر ثاني من عناصر الجذب النفسي، حيث يذكر المؤلف أن الأخبار المثيرة لمشاعر الاشمئزاز عادة ما تنجح في الانتشار ويعتمد مدى نجاحها على مقدار ما تثيره من اشمئزاز في نفوس المتلقين والذي يختلف باختلاف الطبائع والبيئات.
ج- المحتوى الجنسي: في نفس السياق يشير المؤلف إلى المحتوى الجنسي وهل يسهم في نجاح الانتشار أم لا؟ ويبين أن هذا الأمر لم يخضع للاختبار في ميدان التطور الثقافي وإن كانت هناك إشارات تفيد بأن التفاصيل الجنسية ليست مهمة لنجاح المكونات الثقافية فقد ظهر أن المشاهد الجنسية على سبيل المثال لا تزيد من إيرادات الأفلام، ولكن هذا لا يلغي وجود بعض التأثيرات للمحتوى الجنسي مثل سهولة تذكر الإعلانات المتضمنة محتوى جنسيًا أكثر من تلك التي لا تحتوي على ذلك، ولكن هذا لا يعني أنها ستدفع بالمتلقي إلى الشراء دون توفر عوامل أخرى كثيرة. وهنا يذكر المؤلف أن المعلومات المكذوبة تحتوي على موضوعات جنسية بنسبة كبيرة، كما أن المحتوى الذي يتضمن ما يتعلق بالجنس أو ما يثير الاشمئزاز قد صُنف على أنه محتوى ذا طابع تهديدي، ومن هنا يستنتج المؤلف أن الجنس والاشمئزاز قد لا يكونا بحد ذاتيهما مهمين لنجاح المكونات الثقافية لكنهما استخدما كوسائل لإنتاج سرديات ذات طابع تهديدي. وهذا يؤيد الفكرة التي نوقشت سابقًا حول أسباب تفضيل السلبية وأنها مرتبطة من المنظور التطوري بالوظيفة المتكيفة للكشف عن التهديدات.
د- مخالفة البديهة: استكمالًا لعناصر وعوامل نجاح انتشار المعلومات المضللة يشير المؤلف إلى أن وجود بعض المفاهيم المخالفة للبديهة يعد من عناصر الجذب النفسي ومن ثم نجاح الانتشار، فوجود حد أدنى من المفاهيم المخالفة للبديهة تكون من عناصر جذب الانتباه، إلا أنه لو زادت عن حدها لانتفى دورها بوصفها قابلة للتصديق أو صالحة للتفكير، ولو اختفت تمامًا لأصبح الأمر مملًا، ومن هنا وجدوا أن القصص الشعبية الناجحة – باعتبارها أحد المكونات الثقافية- قد احتوت على عنصرين أو ثلاثة تتعارض مع التوقعات البديهية الإنسانية وهذا ما يتوافق مع طبيعة الأخبار المكذوبة في الإنترنت.
ه- المعلومات الاجتماعية: تعتبر الأخبار التي تحتوي على معلومات اجتماعية أكثر نجاحًا في الانتشار، وبالتالي فإن الشائعات والقصص التي تحتوي على دلالات اجتماعية تكون أسهل في الانتشار من تلك التي لا تحتوي على ذلك، وقد انعكس ذلك في تجربة أجريت على عينة من الأخبار المكذوبة على الإنترنت حيث وجدوا أن الكثير منها يدور حول موضوعات مثل الخيانة الزوجية وتشويه السمعة وهكذا.
في نهاية الفصل يؤكد المؤلف على أن ما ذكره من خصائص تفاعلاتنا عبر الوسائل الرقمية بقدر ما تساعد على انتشار المعلومات المضللة فهي أيضًا تساعد على انتشار المعلومات الصحيحة والمفيدة، وبالتالي فهي بحد ذاتها ليست السبب الذي يجعل المعلومات المضللة تزدهر في الإنترنت. كما أن تحقيق بعض المعلومات المضللة نجاحًا على الإنترنت في بعض الحالات نجد فيه مبالغة من حيث الكم، وتحديدًا ما يتعلق بالمعلومات السياسية المضللة. كما أن وجود المعلومات المضللة على الإنترنت كوجودها في أي مكان آخر، فالكثير من المعلومات المضللة موجودة في الفلكلور الشعبي والروايات والأفلام فهي ليست مقصورة على الإنترنت تحديدًا. وهنا يوضح المؤلف رؤيته النابعة من المنظور التطوري حيث يقول: “أن هذا المنظور يختلف جذريًا عن الفكرة الشائعة التي تقول بأن المعلومات المضللة تعتبر ذات جودة منخفضة وتنجح في الانتشار بسبب قصور انتباهنا أمام تعرضنا لوابل من المعلومات التي تعد ولا تحصى، لكن الحالة الفعلية هي على العكس من ذلك فالمعلومات المضللة أو على الأقل بعضها تعتبر معلومات ذات جودة عالية والفرق هنا ليس في جودة المصداقية أو عمق التحليل وإنما ما يتعلق بمدى ملاءمتها لنزعاتنا الإدراكية”
وبالطبع هذه الرؤية تطرح لدينا تساؤلات عديدة ومنها ما يتعلق بمعيار جودة المعلومات فهل جودة المعلومات لا تتعلق بصدقها وإنما بملائمتها لنزعاتنا أليس هذا نوعًا من تأييد الكذب والتضليل لمجرد أنه يتوافق مع نزعاتنا!
وفى الأخير يذكر المؤلف ما يؤيد ذلك بأن نجاح هذه المكونات الثقافية من ضمنها المعلومات المضللة سببه أنها في واقع الأمر جاذبة لنا وليس بسبب بعض الخصائص المتعلقة بانتشار المعلومات رقميًا.
وعلى الرغم أننا قد نوافقه في أن هناك أسباب أخرى في انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت غير خصائصها لكن هذا لا ينفي أن خصائص الإنترنت عامل مهم ورئيسي في انتشارها.
ويوصي المؤلف في النهاية بتحسين الآليات التي تنظم عرض ونشر الأخبار في الإنترنت على أساس من المعرفة بالأسباب التي تجعل بعضها جاذبًا دون البعض.
الفصل السابع
النقل والتشارك
يخوض المؤلف في هذا الفصل بشكل تفصيلي في موضوعي النقل والتشارك وما فيهما من عمليات تُعَد من صلب مفهوم الانتقال الثقافي، إذ ينطلق الفصل من الفكرة القائلة بجدوى اعتبار المحاكاة عملية نشطة يعير من خلالها الأشخاص جل انتباههم لمكونات معينة وينجحون باكتسابها واستذكارها ويقررون مناسبة نقلها من عدمه، ومن ثم يعيدون إنتاجها.
وفى هذا السياق يبدأ المؤلف بمناقشة استخدام المنهج التطوري الدارويني في فهم عملية التطور والانتقال الثقافي، ويناقش بعض الأفكار الرئيسية لعلم “الميمات” “Memetics” وهو مجال علمي يُعنى بدراسة المعلومات والثقافة في ضوء النظرية الداروينية للتطور، حيث يرى أن المكونات الثقافية تنتقل من دماغ لدماغ كما تتناسل الجينات وتنتقل من شخص لأخر.
وهنا يناقش المؤلف بعض أوجه النقد التي وجهت لهذه النظرية والتي تتعلق بافتقاد عملية الانتقال الثقافي للدقة الكافية التي لا تكافئ الدقة في علم البيولوجيا، وأن الانتقال لا يكون استنساخًا بقدر ما يكون تشابهًا يتم الاحتفاظ فيه ببعض العناصر وتُفقد عناصر أخرى، وتعد لعبة “الهمس الصينية” مثالًا على هذه الفكرة. وينتقل المؤلف إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدراسة خصائصها وفعاليتها التي تساهم بشكل كبير في رفع مستوى الدقة في عملية الانتقال الثقافي، ويؤكد أنه تكاد تكون المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي استنساخًا لرسالة نادرًا ما تتطلب دورًا نشطًا من الأشخاص المشتركين.
من هنا يخوض بشكل تفصيلي في عملية الانتقال الثقافي عبر العالم الرقمي ويناقش طبيعته المختلفة التي تتيح الكثير من الوسائل العملية للانتقال الثقافي لا تتوفر في العالم الواقعي، فيتطرق لمسألة وفرة المعلومات وإتاحتها في كل وقت من ثم فلا حاجة للاحتفاظ بنسخ احتياطية فهناك نسخًا افتراضية تؤدي هذا الغرض، وفى هذا السياق يشير المؤلف إلى أن المعلومات لم تعد سلعة تنافسية، كما أن مما يوفره العالم الرقمي قلة أخطاء النسخ في الانتقال الرقمي مقارنة بالنقل المكتوب أو التماثلي، هذا بالإضافة إلى سهولة تحسين نقل المحتوى عبر إضافة محتوى غير مكتوب كالصور والفيديو، فهناك الكثير من المهارات التي تتطلب تسلسلًا لحركات متتالية معقدة كالعزف أو عمل صفة طبخ معقدة وغيرها الكثير تتطلب محتوى بصري، وهذا لم يكن متاحًا إلا مع العصر الرقمي.
وفى هذا السياق يقف المؤلف عند أحد ظواهر الرقمية “ظاهرة الميمة” والتي تشير إلى المحتوى الذي انتشر بنجاح في الإنترنت، وهي عبارة عن مجموعة من المكونات الثقافية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بطريقة أو بأخرى بقالب مشترك والتي من خصائصها أنها قابلة للتغير بصورة كبيرة، فبعض الميمات تنتشر ويتم العمل عليها وإضافة أبعاد مختلفة لها قد يكون بعضه اجتماعي أو حتى سياسي ساخر، ففي معظم الحالات تتعرض الميمة للاقتباس والتعديلات التي يكون بعضها ناجح والآخر غير ذلك، وهنا يشير المؤلف إلى أن نجاح الميمة من حيث الذيوع والانتشار يحدث عندما تنسجم مع التفضيلات النفسية -التي تم تناولها في الفصل السابق- والتي هي نفسها التي تؤدي لانتشار المعلومات المضللة في الإنترنت.
الفصل الثامن
التراكمية
يبدأ المؤلف الفصل بطرح سؤال حول ماهية التطور الثقافي التراكمي؟ مشيرًا إلى أن هناك ثلاث جوانب رئيسية لوصف حالة التطور الثقافي بأنها تراكمية وتتمثل في التراكمية، والتطوير، والترسيخ.
ويعرف المؤلف التراكمية بأنها عبارة عن ازدياد في التنوع والتعقيد مع مرور الزمن حيث تضاعف المكونات الثقافية من حيث الكم، وفي هذا السياق يذكر المؤلف -نظرًا لرؤيته التطورية الداروينية- أمثلة من سلوكيات الشمبانزي والتنوع في أدوات وآليات الطعام التي يستخدمها واختلافها من مكان لآخر كمثال على فهم التراكمية ويسقط ذلك على سلوكيات البشر أيضًا. ويذكر المؤلف أن التنوع التقني هو مثال بارز على التنوع الثقافي.
ثم ينتقل إلى العنصر الثاني “التطوير” الذي يشير إلى زيادة كفاءة المكونات الثقافية وليس فقط زيادتها من حيث الكم.
وأخيرًا يأتي المكون الثالث “الترسيخ” بالابتكارات والتعلم الاجتماعي المتواتر في كل جيل والتي تنتج تطورًا في مجملها، وهذا يعني -حسب علماء النفس- أن كل جيل يؤدي الأشياء بطريقة معينة ويؤديها الجيل التالي بالطريقة نفسها باستثناء شيء من التعديل أو التطوير، ثم يأتي الجيل الذي يليه ليتعلم النسخة المعدلة التي تفرض وجودها، حتى تظهر تغييرات أخرى بها تحسينات وتعديلات تدفع الحركة إلى الأمام مرة أخرى، وهذه الحال تعبر عن التطور الثقافي التراكمي، ولكن مما يشير له المؤلف في هذا السياق أنه من الصعب قياس درجة التراكمية بشكل كمي.
وينتقل المؤلف إلى العالم الرقمي ليناقش “التراكمية الرقمية”، وهنا يسلط الضوء على خصيصتين من الخصائص التي يوفرهما العالم الرقمي وهما “الوفرة” و”النقل المعلوماتي الدقيق” اللتان سمحتا بمزيد من التراكم الثقافي، وبالتالي فإن وسائل التواصل الرقمية فتحت فرصة جديدة للتراكمية، وفى هذا السياق يذكر المؤلف “المجال العلمي” كمثال، حيث تزايد حجم النشر العلمي بشكل هائل، فالتقديرات تشير إلى وجود ارتفاع بحوالي 8% كل عام مما يعني تضاعفًا زمنيًا يصل لما يقارب تسع سنوات، وهذا يعني أن النتاج العلمي العالمي اليوم هو ضعف النتاج العلمي قبل ثماني سنوات.
ومما يشير له المؤلف في هذا الإطار أن هذه الأرقام لا تعني ارتفاعًا في معدل الاكتشافات العلمية، بل هناك بعض الأطروحات التي تقول بأن معدل الاكتشافات في انخفاض، وإنما الفارق يكمن في التغير في الممارسات التي تحيط بالأنشطة العلمية بدءا بعملية المراجعة وصولًا إلى البيانات والترميز المستخدم في التحليل وما يتعلق بالتغذية الراجعة المباشرة التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك انتشار الطبعات الرقمية، وهذا مما يساهم في مزيد من تراكم التطور الثقافي.
يتنقل المؤلف إلى نقطة مهمة في هذا السياق تتعلق بالنتائج المترتبة على ميزة الوفرة ودقة النقل المتوفرتين في وسائل التواصل الرقمي، والتي من ضمنها أن الكثرة الهائلة لإنتاج المعلومات تجعل الكثير منها طي النسيان والهجران في الذاكرة الرقمية، وهذا ما يطلق عليه الكاتب “الثقافة المنسية”، فمثلًا نجد أنه من بين مئات النسخ التي تنتج لأغنية أو فيديو واحد على يوتيوب تنجح نسخ قليلة بينما يظل الكثير لا يحصل إلا على عدد قليل من المشاهدات، وهذه الكثرة في النُسخ عمومًا تجعل هناك تراكمية دون تطوير أو ترسيخ.
في الجزء الأخير من الفصل يتعرض المؤلف لموضوع “الخوارزميات” والانتقادات التي توجه لها ويركز على ثلاث اتجاهات نقدية:
-الاتجاه النقدي الأول يقول إن الخوارزميات تعيد إنتاج تحيزات مبرمجيها الذين صمموها أو تحيزات البيانات التي استخدموها. وهنا يؤكد المؤلف على أن النقطة الجوهرية لا تتعلق بأن الخوارزميات ينبغي أن تكون غير متحيزة لأن هذا مستحيل وغير فاعل ولكن ما يجب أن يحدث هو أن يكون الهدف النهائي من التحيزات هو تقديم المعلومات المفيدة بدلًا من العمل على صيد المستخدمين.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤلف تحدث فقط عن التحيز الخوارزمي الذي يهدف إلى جذب انتباه المستخدمين بشتى الطرق لبقائه أطول وقت ممكن، ولكنه لم يتناول نوع آخر من التحيز الذي يمكن أن نسميه “تحيزًا عنصريًا” وهو الذي تمارسه بعض منصات التواصل الاجتماعي ضد أنواع معينة من المحتوى أو ضد بعض المعتقدات والأفكار والقضايا.
-أما الاتجاه النقدي الثاني فهو يرى أن الخوارزميات غامضة بالنسبة للمستخدمين، وهنا يرى الكاتب أن الغموض ليس مشكلة خاصة وأننا في حياتنا الواقعية نتعامل مع الغموض البشري الذي هو أعقد كثيرًا من غموض الخوارزميات، هذا بالإضافة إلى أن تصور إحكام القبضة الكاملة على عمل الخوارزميات المعقد والذي يشارك فيه عدد كبير جدًا من المبرمجين على اختلاف المستويات هو تصور ساذج.
-أما النقد الثالث والأخير فيتعلق بعملية “التخصيص” التي تقوم بها الخوارزميات وما يتعلق بها من انتقاء معلوماتي وآلية فقاعات التصفية، ويرى الكاتب أن التخصيص في حد ذاته يلعب دورًا هامًا في إحداث نوع من السيطرة على السيل المعلوماتي بتقليص الاختيارات، ولكنه يطرح تساؤلات حول مدى دقة الاختيار بناء على اهتمامات المستخدم ومدى ما يمكن أن يسمح به من إمكانية الوصول لمعلومات جديدة دون أن نعْلق في فقاعات التصفية؟
وبناءً على ذلك لا يقدم المؤلف إجابات نهائية ولكنه يرى أنه يجب علينا فهم عمل الخوارزمية والوقوف على فوائدها وأوجه قصورها وأن التحدي يكمن في إمكانية تصميم خوارزمية تساعد البشر على اتخاذ قراراتهم بشأن الثقافة المنسية وبشأن ما هو جدير بالحفظ في ظل التراكمية الثقافية اللامحدودة.
الخاتمة
في خاتمة الكتاب يلخص المؤلف كل ما تناوله عبر الفصول الثمانية ليختم بتجربته الشخصية في استخدام الهاتف الذكي الذي تظهر قدرته على التحكم فيما يشاهده وفى الوقت الذي يقضيه أو يقضيه أبناؤه على الشاشة في إشارة إلى الفكرة الرئيسية التي يدور حولها الكتاب بشأن مبالغة البعض في نسب كل الظواهر السيئة في عصرنا إلى العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، في حين يؤكد الكاتب أن الكثير من المشكلات التي تعرض لها لم تأتي مع وسائل التواصل بل لها صورًا عديدة في الواقع وأن البشر متعلمون حذرون وأن التعامل مع العالم الرقمي سلاحًا ذو حدين بيد أنه بإمكاننا أن نتعامل معه بذكاء وحكمة تجعلنا نستفيد من مزاياه التي نتعامل معها على أنها أمور مسلم بها.
وفى الختام وبناءً على ما تم عرضه نستطيع القول أن هذا الكتاب وإن كان قد يصنفه القارئ بأنه متفائلًا بشكل زائد بشأن وسائل التواصل الاجتماعي وما يثيره البعض حولها من مشكلات وقضايا إلا أنه قد تناول بعض الجوانب المهمة التي قد تهم الباحثين في هذا المضمار ليقدموا بحثًا منصفًا متوازنًا، فهذا مما يحمد للكاتب، وإن كان منظوره التطوري الدارويني قد جعل هناك الكثير من القصور فيما عرضه من تجارب ودراسات لا تفرق بين الحيوان الذي يتم إجراء التجارب عليه وبين البشر، والذى لا يتسق مع منظورنا ورؤيتنا الإسلامية، هذا فضلًا عن انطلاقه من فرضية تؤكد أن البشر متعلمون حذرون ومن ثم إلقاء اللوم بشكل كبير على الأفراد في التعامل الحكيم الواعي مع وسائل التواصل دون التأكيد على ضرورة العمل بشكل متوازي على تفادي مشكلات تتعلق بتصميم هذه المواقع ذاتها وأهداف الشركات الكبرى القائمة عليها التي في الواقع تعمل على سلب المتلقي في الكثير من الأحيان حريته في الاختيار الواعي.
عرض:
أ. يارا عبد الجواد*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحثة في العلوم السياسية.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies