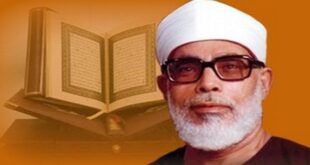عبد الوهاب المسيري
العودة لمصر والذئاب الثلاثة[1]
أ. د. عبد الوهاب المسيري*
حينما عدت إلى مصر من الولايات المتحدة عام 1969 بعد حصولي على الدكتوراه، دارت معركة في داخلي، فقد هاجمتني ثلاثة ذئاب شرسة (هكذا أسميها) ظلت تنهشني بعض الوقت: ذئب الثروة وذئب الشهرة والذئب الهيجلي المعلوماتي.
أما الذئب الأول فهو ذئب الثروة الذي يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أكون ثريًا. فقد أتيت من عائلة تجارية، مصدر الشرعية فيها هو الثروة، ومن هنا إن لم يحققها المرء، انتابته المخاوف واهتزت ثقته بنفسه. ولكن كان من السهل علي أن أتغلب على هذا الذئب، وأن أقرر مشروعي لمستقبلي ربما لا يأتي بالثروة ولكنه سيأتي بالحكمة، وأن أسلوب حياتي بما فيه من آفاق ثقافية واسعة وعلاقات إنسانية دافئة أفضل بكثير من حياة التراكم الرأسمالي بما فيها من أحادية وتنافس.
ومما ساعدني على اتخاذ قراري أنني لاحظت أن أبناء الأسرة حينما كانوا يحضرون إلى منزلنا كانوا يرفضون العودة إلى منازلهم، إذ كانوا يسعدون كثيرًا بأسلوب حياتنا. فقد كنا نأخذهم إلى الحدائق القليلة المتبقية في القاهرة (حديقة الأورمان– حديقة الأندلس– القناطر الخيرية) ونذهب إلى المتاحف المختلفة (متحف السكة الحديد– متحف البريد– متحف العربات الملكية– متحف في أرض المعارض [أرض الأوبرا الآن] أظنه متحف الحضارة المصرية وملحق به قبة سماوية– المتحف الزراعي– المتحف الإسلامي– الأنتكخانة– المتحف القبطي– متحف الفن الحديث). كما كنا نزور آثار القاهرة الكثيرة الإسلامية والفرعونية والقبطية، غير الرحلات الشراعية في النيل. فأسلوب حياتنا كان يشعرهم بالامتلاء، ويشعرني في الوقت ذاته بأن ذئب الثروة لا يمكنه أن يمنحني كل هذه الأشياء. وقد ذكرني هذا بواقعة حدثت لأستاذي في الولايات المتحدة، فقد كتب سيناريو لفيلم (قال لي إنه أساسًا عني) وذهب لهوليود لتسويقه، وقد بدأ في تحقيق بعض النجاح. وفي أحد الأيام كان في منزل أحد كبار المخرجين في حفلة كوكتيل ليقابل أحد وكلاء الفنانين ليعرض عليه فيلمه. وفي أثناء الحديث اكتشف أستاذي أن هذا الوكيل لم يكن قد سمع قط عن أرسطو، ففزع أستاذي، وأنهى زيارته لأنه كما قال «لم يتخيل أنه سيقضي بقية حياته مع بشر من هذا النوع». هذه القصة ترسخت في وجداني وساعدتني على هزيمة ذئب الثروة. وأصبح هدفي هو أن أحقق ذاتي حسب الشروط التي تمليها رؤيتي لذاتي، وأن أحصل من المال على ما يكفي لأن يحقق لي شيئًا من التحرر من تفاصيل حياتي اليومية ولأن أمول حياتي الفكرية وأنجز مشروعي المعرفي. ولذا أردد دائمًا أن المال يشكل عبئًا على البعض، يفنون حياتهم في جمعه، أما بالنسبة لي فالمال حرية.
وقد نجحت إلى حد كبير في توظيف المال بدلًا من أن يوظفني. فلم أضطر قط إلى أن أقوم بعمل يتناقض مع مشروعي الفكري أو يعوقه، ولم أعمل إلا في وظائف أقوم بتوظيفها لخدمته. فكنت أقوم بإلقاء محاضراتي في كلية البنات ولم أزد (إلا محاضرتين اضافيتين أو أربعًا كنت أقبل تدريسها منتدبًا في كلية الآداب حتى أخرج من نطاق كلية البنات). وقد نجحت في أن تكون هذه المحاضرات جزءًا من حواري الفلسفي مع نفسي، أي جزءًا من مشروعي المعرفي. وقد اخترت محل اقامتي عبر الشارع من كلية البنات بحيث لا أضيع أي وقت في الانتقال، ولم أشغل قط أي منصب اداري من أي نوع طيلة حياتي، فلم أعمل رئيسًا للجنة أو لقسم أو وكيلًا أو عميدًا لكلية. وقد عملت مستشارًا ثقافيًا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، ولكن وظيفتي مرة أخرى أصبحت مجرد إطار لتحقيق مشروعي المعرفي (بداية تحديث موسوعة 1975). وحينما عرض علي أن أعمل في هيئة الأمم المتحدة براتب ضخم، آثرت البقاء في وظيفتي والتضحية بالراتب الضخم لأن الوظيفة الجديدة كانت ستستوعب كل وقتي، كما أنها كانت تتعارض كلية مع مشروعي الفكري.
هذا لا يعني أنني لم أعرف شظف العيش. فحينما ذهبنا إلى الولايات المتحدة عام 1963 اضطررنا -كما أسلفت– إلى أن نعيش أنا وزوجتي في فندق رخيص قذر. وفي الشتاء اضطررنا إلى شراء معاطف مستعملة لاتقاء برد نيويورك، فلم يكن معنا ثمن المعاطف الجديدة. وحينما انتقلنا إلى جامعة رتجرز كنا نضطر للسير مسافات طويلة في البرد القارس، بل في الثلج، للوصول إلى الأتوبيس (فلم يكن معنا ثمن السيارة). وقد اضطرت زوجتي إلى أن تعمل لتقدم لنا بعض العون المالي. كما اضطرت إلى أن تعود من المستشفى بعد أن وضعت نور بأربعة أيام في مترو الأنفاق في نيويورك (وكان طريقة للمواصلات متوحشة في الستينيات). كما أنها كانت تحمل ابنتنا في المواصلات العامة وتذهب بها من نيوجرسي إلى نيويورك للتمتع بالخدمة الطبية المجانية بعد الولادة.
ولم أترفع قط عن القيام بأي عمل، ولم أمانع على سبيل المثال في أن أعمل عضوًا في فرقة مكافحة الحريق بمصنع الكابلات في نيو برونزويك. وقد استأجرنا هذا المصنع لا لمكافحة الحريق وإنما ليخبر شركة التأمين بذلك، لتخفيض أقساط التأمين. فالعمل الذي أوكل لنا لم يكن عملًا حقيقيًا ولا يستنفد أي وقت، فقد كان يتلخص في أن نمر على المصنع كل ساعة، ثم نكتب في كراس عبارة «كل شيء على ما يرام». وكانت هذه العملية تستغرق حوالي خمس دقائق. أما بقية وقتنا فكنا نقضيه في القراءة والكتابة يومي السبت والأحد، حينما يكون المصنع مغلقًا، ونربح فيه بضعة دولارات ننفقها في المتاحف والمسارح. وقد رقيت إلى أن أصبحت رئيسًا للفرقة. فاستأجرت كل أصدقائي من طلبة الدكتوراه ليعملوا أعضاء فيها. وكان مدير المصنع يتباهى بأن فرقة مكافحة الحريق في مصنعه تتمتع بأعلى مستوى تعليمي في العالم، وكان محقًا في تباهيه هذا.
ولم يكن الأمر يخلو من مصاعب. فمرة ألقيت محاضرة في ذكرى مالكوم إكس في الجامعة، فنشرتها الصحف المحلية وذكرت اسمي. فاستوقفني مدير المصنع (وكان رجلًا رجعيًا من ولاية تكساس) وسألني: «ألست أنت الشخص الذي كان يثير القلاقل في الجامعة بالأمس؟» ومثل هذه التهمة كفيلة بإقصائي عن منصبي المريح المربح. فأنكرت بطبيعة الحال. فسألني عن إسمي، فهداني الله إلى أن أخبره عن إسمي الرباعي وبمخارج الحروف العربية وبسرعة، فاضطرب الرجل وفقد اتزانه، وقال إنه لابد أن يكون شخصًا آخر.
ومما ساعد على ترويض ذئب الثروة بل تدجينه تمامًا، أن زوجتي، لحسن الحظ، لم تراودها أحلام الثروة ولم تعان من أي نزعات استهلاكية. (من الأمور المضحكة، أنها مصابة بحساسية من نوع فريد، إذ يصفر وجهها وتعطس حينما تمكث مدة طويلة داخل أحد المحلات، وهي حساسية يحسدني عليها كثير من الأزواج المصريين. واقترح علي أحدهم أن أقرضه الفايروس العظيم الذي يتسبب في هذه الحساسية المباركة). اكتشفنا، على سبيل المثال، حينما انتهيت من الموسوعة أننا لم نتناقش قط فيما كنت أدفعه من تكاليف. كما أنني حين قررت الاستقالة من الجامعة لإتمام الموسوعة، وافقت على قراري بعد مناقشة دامت خمس دقائق، برغم ما كان يعنيه ذلك من أن الأسرة ستصبح دون دخل ثابت. وبعد حرب الخليج، حينما أصبح من «حقي» العودة لوظيفتي (باعتبار أنني كنت أعمل في الخليج) ناقشنا الأمر لبضع دقائق أخرى ووجدت أنه لابد من الاستمرار في التفرغ لأنهي الموسوعة (وأسمي هذا ضربًا من الجنون المقدس الذي أصابني وأصاب زوجتي، ولولاه ما انتهيت من الموسوعة). ولم يكن من الصعب أن تقنع زوجتي طفلينا برؤيتها غير الاستهلاكية. ولعل تحييد النقود بهذه الطريقة قد جعلني أتفرغ ذهنيًا للبحث والتأمل، إذ لم أعد مشغولًا بأمور الدنيا المباشرة.
وقد هزمت ذئب الثروة تمامًا إلى درجة أن «حمل» الإحساس بالذنب من الثروة قد أمسك بتلابيبي بعض الوقت. فبرغم حدودي المالية، فإنني بدأت أشعر بالذنب من أجل أصدقائي الذين دخلوا طاحونة المحاضرات الإضافية لتحسين دخلهم. وكان الإحساس بالذنب قويًا إلى درجة أنني لم أتمكن من أن أخط حرفًا واحدًا لمدة عام تقريبًا. ولم يشفني من هذا «الحمل» إلا اكتشافي أن هناك من أقراني من هم أكثر مني ثروة، ومع هذا يتكالبون على المال بشكل مقزز ولا يخطون حرفًا. حينئذ اكتشفت أن التأليف والثروة أمران منفصلان، وأن الثروة قد تكون عنصرًا مهمًا ولكنه لا يؤدي بالضرورة إلى التأليف. وعلى كل ظل حمل العداء للثروة معي بعض الوقت، وكنت أمول كل أعمالي الفكرية تقريبًا، والعائد المالي لمثل هذه الأعمال، كما هو معروف، ضئيل للغاية. وكما قال أحد الناشرين لصديق أفنى عمره في إعداد موسوعة عن الموسيقى، قال له وهو يعرض عليه ألف جنيه لا أكثر ولا أقل: «لكم المجد ولنا الثروة»!
أما الذئب الثاني، فهو ذئب الشهرة الذي يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أصبح من المشاهير. وحينما عدت للمرة الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية لم أواجه ذئب الشهرة، إذ إنني وجدت نفسي أكتب في الأهرام وأتحدث في الإذاعة والتليفزيون ومسئولًا عن وحدة الفكر الصهيوني في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. وأصبحت أحد كتاب الأهرام المنتظمين، وكل ما كنت أكتبه كان يجد طريقه للنشر في إحدى المجلات، وكلما شكلت لجنة ما (مثل لجنة إصلاح تدريس اللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، أو حتى إصلاح العالم)، كنت أجد نفسي عضوًا فيها؛ وإذا عقد مؤتمر لمناقشة الكتب الدراسية في الأرض المحتلة أو لأي موضوع آخر، كنت أدعي له. ولذا كان علي، في كثير من الأحيان، أن أرفض التعيين في بعض هذه اللجان أو الذهاب لبعض هذه المؤتمرات (إن كانت لا تصب في مشروعي المعرفي). ولذا فذئب الشهرة داخلي كان منتشيًا، نائمًا سكران من النشوة.
ولكنه استيقظ وبكل ضراوة عام 1979 حينما عدت للمرة الثانية من الولايات المتحدة الأمريكية. وكان جو التطبيع سائدًا في القاهرة، وبطبيعة الحال لم أسترد مكاني في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام (وكما قال لي مدير المركز آنذاك إن عودتي له تعني القيام بالهارا كيري [أي الانتحار على الطريقة اليابانية]. فكان ردي عليه أن الحياة حسب الشروط المهينة التي قد يضعها الآخرون ليست أمرًا عظيمًا على أي حال، وقد يكون الانتحار هو أحسن اختيار. والانتحار في هذه الحالة ليس انتحارًا وإنما استشهاد في سبيل رسالة). وبطبيعة الحال لم أُدع للحديث في الإذاعة والتليفزيون، وبدأ بعض المذيعين، ممن كنت ضيفًا دائمًا على برامجهم، يخافون حتى من الحديث معي. بل إنني كنت أجد صعوبة بالغة في دخول مبنى الأهرام، وكان علي الاتصال بمساعدتي السابقة للتوسط لي. باختصار شديد، وجدت نفسي نكرة، ومن ثم بدأ جوع ذئب الشهرة ونهمه يتزايدان. وقد أخذ رد فعلي بهذه الصدمة الحضارية شكلًا فريدًا، إذ بدأت في الاهتمام بالعمارة الداخلية لمنزلي، وبدأت في اقتناء الأشياء القديمة، إلى درجة الهوس. ثم دارت المعركة بيني وبين هذا الذئب. فجلست مع نفسي لأكتشف أنني أحب الشهرة نعم، ولكن رغبتي في الشهرة نابعة من رغبتي في حماية نفسي حتى يمكنني الانتهاء من مشروعاتي المعرفية. والمشاهير، كما كنت أظن واهمًا آنذاك، لا يمكن أن يزج بهم في السجن ببساطة. كما أن الشهرة ستكون وسيلة ناجعة لإشاعة وتوصيل ما عندي من أفكار أعتقد أن لها قيمة ما. ولذا إن حاولت أن أشبع ذئب الشهرة داخلي حسب الشروط التي يفرضها العالم الخارجي، فأكون كمن كسب المعركة وفقد الحرب. وويل للمرء الذي يربح كل شيء ويخسر نفسه. حينئذ أخبرت ذئب الشهرة داخلي أنني لا أمانع في الشهرة حسب شروطي، تمامًا كما أنني أحب الثروة بمقدار ما تخدمني. وهكذا صرعت ذئب الشهرة داخلي، وقبلت أن أعيش بعيدًا عن الأضواء، خاصة حين بدأت في كتابة الموسوعة بما كانت تتطلبه من عزلة شبه كاملة أحيانًا.
بقي بعد ذلك أهم الذئاب وأكثرها خطورة وضراوة، وهو الذئب الهيجلي المعلوماتي، وهو ذئب خاص جدًا، جواني لأقصى درجة، يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أكتب كتابًا نظريًا، إطاره النظري واسع وشامل للغاية ولكنه في الوقت نفسه يتعامل مع أكبر قدر ممكن من المعلومات والتفاصيل، إن لم يكن كلها. أي أنني كنت أطمع في كتابة عمل يصل إلى أعلى مستويات التعميم والتجريد والشمول، وفي الوقت نفسه تصل إلى أقصى درجات التخصيص والدقة. وهذه صيغة مستحيلة لأنه إن اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، فما بالك برؤية بانورامية متسعة في غاية الاتساع وتفاصيل دقيقة في غاية الدقة. ويبدو أن هذا الذئب الهيجلي المعلوماتي كان يطاردني منذ طفولتي، فقد كنت أنوي أن أحصر كل ما تبقى من كتب لم أقرأها في مكتبة البلدية بدمنهور (بحسبان أنها تحوي كل المعرفة الإنسانية) حتى يمكنني أن أعرف كل ما خطته يد البشرية! وأذكر في شبابي أنني بدأت في كتابة تاريخ الشعر الإنجليزي منذ البداية حتى النهاية من منظور ماركسي. أقول «بدأت» لأنني لم أنته منه قط، بل لم أجاوز الصفحة الثالثة! وقد أصبت بصدمة عميقة، في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، حين عرفت أن أحد أساتذتي لم يكن قد قرأ الأعمال الكاملة لشكسبير! وحين بدأت كتابة رسالتي للماجستير مع الدكتور محمد مصطفى بدوي عن أثر الشعر الرومانتيكي الإنجليزي وبودلير على جماعة أبوللو وبخاصة إبراهيم ناجي، ظهرت نزعتي الهيجلية المعلوماتية بشراسة، فكنت أريد أن أقرأ كل شيء كمقدمة لكتابة الماجستير. فقرأت المعلقات وكثيرًا من عيون الشعر العربي، وبخاصة شعر المتنبي، وكتبت دراسة عن الانقطاع في الشعر العربي. ثم قرأت كثيرًا من الأعمال النقدية للعقاد والمازني وطه حسين وإبراهيم المصري، وكتبت دراسة مطولة في الموضوع، وقرأت بعض عيون التراث آنذاك. وبدأت في كتابة دراسة في شعر خليل مطران، وأنهيت دراسة عن ترجمة ناجي لديوان أزهار الشر لبودلير وأثرها عليه. كما كتبت الدراسة التي قدمتها لبروفسير إيان جاك عن «الانتقال من الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية». وكان الدكتور بدوي يتركني أكتب ما أريد، ولم ينقذني مؤقتًا من براثن الذئب سوى ذهابي إلى الولايات المتحدة.
وقد صرع هذا الذئب مجموعة من أعز أصدقائي أمام ناظري، مات بعضهم دون أن ينبس ببنت شفة، رغبة منه في أن يحقق هذه الصيغة المستحيلة: عمل نظري شامل مجرد ينتظم كل المعلومات الممكنة. ولعل صديقي الأستاذ علي زيد –رحمه الله– مَثل فريد على ذلك. كان –رحمه الله– يعرف كل شيء تقريبًا، ولا يعرفه كمعلومة، وإنما في إطار نظري شامل كان يزداد اتساعًا على مر الأيام. كما أنه كان يعرف الكثير من اللغات الأوربية (الإنجليزية – الفرنسية – الاسبانية – الإيطالية) وكان تملكه لناصية اللغة العربية شيئًا مذهلًا. كنت كلما أطلب منه كتابة مقالة يجلس ليتحدث عن موضوعها ساعات طوالًا، ويأتي بأطروحات مذهلة. ثم يذهب لكتابة المقال، فيأتي بعشرات الكتب ويبدأ في البحث وتتسع الرؤى إلى ما لا نهاية، فيلتهمه الذئب. وهذه إشكالية لا يواجهها متوسطو الذكاء، فبعضهم يحشد التعميمات التي لا يربطها رابط (أسميها «أفكارًا» في مقابل الفكر)، والبعض الآخر يحشد المعلومات التي لا يربطها رابط أيضًا. وأمثال هؤلاء يخطون بضعة كتب («ويرص كلامًا فوق كلام تحت كلام» على رأي صلاح عبد الصبور) تنشر مع مئات الكتب الأخرى التي تصدر ويقرؤها البعض ثم تموت. وهم يعيشون حياتهم في سعادة بالغة ورضا تام! لكن أن يحاول المرء الجمع بين أعلى مستويات التعميم وأدنى مستويات التخصيص فهذا مستحيل، والمصير هو الفشل النبيل والصمت الدائم.
استمر الذئب الهيجلي المعلوماتي متربصًا بي، وإن كان والحق يقال قد تم ترويضه قليلًا في الولايات المتحدة حيث كان علي أن أكتب أبحاثًا قصيرة لمقررات الدراسة العليا تقدم في نهاية كل فصل دراسي، تعلمت من خلالها أنني لابد أن أكبح جماح ذاتي وإلا لما انتهيت من شيء. كما أن أستاذي المشرف على رسالة الدكتوراه كان لا يسمح لي بالانطلاق في أي اتجاه. فبعد أن كتبت دراسة مطولة عن وردزورث وويتمان وأصولهما التاريخية والدينية والفكرية، أخبرني أن هذه «الخلفية» لا علاقة لها بالرسالة ذاتها، وأنني بوسعي أن أقرأ ما يحلو لي بخصوص «الخلفية»، طالما أن ما أقرأ له علاقة بموضوعي الأساسي (الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ)، ولكن علي ألا أكتب سوى النزر اليسير عن هذه الخلفية، لأنها ليست موضوع اختصاصي. كما أنني لاحظت أنني لو قرأت كل ما كتب عن موضوع تخصصي (من مقالات ورسائل دكتوراه وكتب) لقضيت سحابة أيامي أقرأ وأستوعب وأقرأ دون أن أنتج شيئًا.
ويظهر ترويض الذئب الهيجلي المعلوماتي في النصيحة التي أسديتها لصديقي كافين رايلي. فقد كان يكتب كتابه الغرب والعالم، والذي استغرق معظم حياته الفكرية، وكان لا يكف عن الإضافة والتعديل ولا يجرؤ على نشره. فأخبرته: «كافين، يحين وقت في حياة الانسان، يكون الكتاب الوحيد الذي يستحق القراءة هو الكتاب الذي يؤلفه». وهي عبارة تهدف إلى أن أبين له أن المعرفة لا حدود لها وأن المعلومات بحر يمكن أن يبتلع المرء، ومن هنا يجب أن يتوقف المرء عند نقطة ما. وقد كان، إذ توقف كافين ونشر كتابه، وحقق نجاحًا كبيرًا وذيوعًا منقطع النظير.
وفي هذه الآونة، قرأت قصة قصيرة لكاتب أمريكي (اسمه ألان سيجر Allan Seager) بعنوان «عن هذه المدينة وسلامنكا This Town and Salamanca» وتدور أحداث القصة حول رهط من الشباب ينشئون في نفس المدينة، ولكن أحدهم كان بوهيميًا، لا يتردد في الانتقال من بلده إلى مدن وموانئ بعيدة (سلامنكا هنا هي رمز هذا العالم البعيد الذي يرتاده صاحبنا). وكان صاحبنا يعود من آونة لأخرى ليقص على رفاقه قصص المغامرات المختلفة التي خاضها. أما هم فيبقون في مدينتهم ليعلموا أبناءها وليبنوا بيوتًا وجسورًا. وتدعونا القصة للإعجاب بالبطل البوهيمي، ولكن تعاطفنا الحقيقي يتوجه لهؤلاء الذين بقوا وعلموا وبنوا. وقد تعلمت من هذه القصة أن التحليق البانورامي ليس دائمًا صفة إيجابية، وأنه يمكن أن يقنع المرء بالقليل وينجزه. ولذا حين عدت من الولايات المتحدة كان عندي ثلاث متتاليات: أن أكون ناقدًا أدبيًا وأستاذًا جامعيًا وأبًا وزوجًا متميزًا، فإن أخفقت فلأكن أستاذًا جامعيًا وأبًا وزوجًا متميزًا، فإن أخفقت فلأكن أبًا وزوجًا متميزًا. وغني عن القول أن متتالية حياتي كانت مختلفة عن «خطتي» (فلم أصبح ناقدًا أدبيًا ولم أستمر في التدريس في الجامعة، ولا أدري هل كنت أبًا وزوجًا متميزًا أم لا، ولأترك الحكم لأولادي وزوجتي). ولكن المهم أنني روضت الذئب الهيجلي، والنزعة النيتشوية الفاوستية: أن أجوب كل الآفاق وأن أجرب كل التجارب وأن أجاوز كل الحدود، وبدلًا من ذلك، قبلت الحدود الإنسانية واحتمالات الانتصار والانكسار.
وبرغم ادراكي لمخاطر الذئب الهيجلي، وبرغم نجاحي في ترويضه (ومن هنا نجحت في نشر بعض الكتب التي لا تحتوي على دراسات «شاملة كاملة ضخمة»…. الخ)، فإنه ظل رابضًا داخلي، فكنت كلما انتهيت من احدى دراساتي عن الصهيونية، أعلن أن هذه آخر دراسة، أملًا في أن أبدأ دراستي النظرية الشاملة والتطبيقية في ذات الوقت. ومع هذا ظلت الصهيونية (كموضوع للدراسة) تلاحقني، وكلما انتهيت من كتابة دراسة ما عن الصهيونية كنت أجد نفسي مضطرًا لكتابة الثانية ثم الثالثة وهكذا (كنت أشعر أحيانًا أن من يدفعني إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه هي مشيئته). وقد قررت عام 1984 أن أذبح الذئب الهيجلي المعلوماتي تمامًا، فقبلت الاستمرار في الكتابة في حقل الصهيونية وحسب، أي أنني تخليت عن المشروع النظري التطبيقي الطموح. والطريف أنني حينما فعلت ذلك، تداخلت كل الأطروحات الأيدولوجية والفلسفية (وهي على كل كانت متداخلة منذ البداية) وتبلورت النماذج التحليلية، وبدأت أحاول الإجابة عن التساؤلات التي تطرح نفسها علي من خلال دراساتي في اليهودية واليهود والصهيونية التي تحولت تدريجيًا من الموضوع الأساسي للموسوعة إلى مجرد «دراسة حالة»، أي أنني أتصور أنني كتبت دراسة تتسم بقدر معقول من التجريد والشمول ومن التعين والتخصيص، وأن الحلم الهيجلي (أو بعض جوانبه) قد تحقق دون أن ينهشني الذئب. ولهذا فمعظم كتبي القادمة – بإذن الله – ستكون عن موضوعات نظرية عامة مثل العلمانية الشاملة والحلولية وما بعد الحداثة، وتتعامل في الوقت ذاته مع نصوص وحالات معينة.
ومع هذا، لا شك في أن هناك بقايا «هيجلية» تتبدى في إعجابي الشديد بالفلسفة الألمانية ومقولاتها التحليلية، كما يتبدى في كثير من مقولاتي التحليلية مثل نهاية التاريخ والفردوس الأرضي والثالوث الحلولي واهتمامي بالبعد المعرفي (الكلي والنهائي) للظواهر. واهتمامي بالصهيونية لم يكن قط سياسيًا بل أتناولها من خلال مقولات مثل: إشكالية الإنسان وعلاقته بالطبيعة والتاريخ – الغنوصية – الواحدية المادية – الأسطورة المنفصلة عن التاريخ – الداروينية – العلم المنفصل عن القيمة والغاية…. الخ. ولكن هذه المقولات التحليلية الكبرى ليست مجرد مقولات نظرية ساكنة عامة، وإنما لها تجلياتها المتعينة في تفاصيل التاريخ والواقع الكثيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عبد الوهاب المسيري (2005). رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمار. ط. 1. القاهرة: دار الشروق. ص ص166- 176.
* أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن بكلية البنات جامعة عين شمس.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies