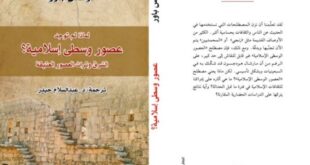يتشرف مركز خُطوة للتوثيق والدراسات بنشر سلسـلة من الدراسات عن الرائدات من النساء المسلمات العالمات في القرون الإسلامية الأولى، والتي تميزت بكونها عصورًا من التقدم العلمي والازدهار الحضاري. تعكس هذه الدراسات الدور القوي للمرأة المسلمة في مختلف المجالات العلمية والعملية، وهو ما شهد انتكاسًا للأسف في العصور التالية. السلسلة للأستاذة الدكتورة أميمة أبو بكر، ونستهلها بدراسة بعنوان : المُحَدِّثَات في التاريخ الإسلامي.
أولًا: المُحَدِّثَات في التاريخ الإسلامي*
أ. د. أميمة أبوبكر **
تقديم:
هل اشتغلت النساء في القرون الإسلامية الأولى بمهنة التدريس في الحقل الدينی؛ أسوة بعلماء وفقهاء العصر؟. هل كن أستاذات يعلمن الطلبة -رجالًا ونساء- ونقلن إليهم علمًا ينتفع به ؟. لم يكن التصدي لتدريس العلوم الدينية، وقراءة الكتب المرجعية الرئيسة في هذا المجال وشرحها، أمرا هينة أو مفروغ منه في هذه العصور المتقدمة، التي اتسمت بصعوبات جمة أمام سُبُل طلب العلم، واكتساب كفاءات للتعليم. ولأننا نتحدث عن عصور ما قبل نشأة الجامعات، كمؤسسات رسمية للتعليم العالي، فقد كان يتطلب ذلك كثرة السفر والارتحال من مكان إلى مكان للاستقاء من مصادر علمية بذاتها، وكذلك الخوض في المجال الاجتماعي العام، وهي أمور تزيد من “مرئية” النساء في أي مجتمع، وتستدعي تقبُلها وتقبُل تغيرات في مفهوم تقسيم أدوار النساء والرجال، بين المجالين الخاص والعام … وهذه كلها تطورات في الفكر الإنساني والمجتمعات البشرية لم تتأت لثقافة العصور الوسطى في مجملها.
مثلًا، يواجه الدارسون لموضوع تعليم المرأة ومشاركتها في الحياة العلمية العامة في تاريخ الغرب الأوروبي، خلال تلك الفترة، صعوبات عديدة للحصول على معلومات أكيدة، عن مستوى معرفة القراءة والكتابة، أو عن إنجازات أخرى في مجالات الثقافة والعلوم، وقد رجحوا أن تعلم القراءة والكتابة اقتصر على نساء الطبقة العليا والبرجوازية اللاتي كن يقرأن الروايات العاطفية ورومانسيات العصر، ولكن غير ماهرات في استخدام القلم، وكن يوظِّفن لذلك كاتبًا أو سكرتيرة خاصة[1]. واستنادًا إلى كتابات بعض التربويين -أمثال المحامي الشهير “فيليب دو نوفار” من فرنسا- استخلص الباحثون أنه في تأكيده على تعلم المرأة الغزل والحياكة فقط؛ لأنه في تعلمها القراءة والكتابة خطر، وأن هذا لمصلحتها قبل كل شيء .. إنما هو يعبر عن الرأي السائد في أوروبا القرن الـ ۱۳، الذي أدان تثقيف المرأة بصفة عامة، وأدی إلى حرمان الغالبية العظمى من النساء من التعليم العالي والتربية الفكرية[2]، سوى النوع المتاح لنساء الطبقة الأرستقراطية من خلال مدارس الراهبات والتعليم بمنازل الكبراء والأمراء، أو تعليم الأبجدية والتلقين الديني (CATECHISMS) لأولاد وبنات الفقراء في مدارس المدن والريف الإبتدائية، أو التعليم الحرفي والمهني لطبقة الحرفيين والأعمال اليدوية[3]. إلا أن الاتجاه السائد في التربية التعليمية للمرأة، كان يميل إلى عزلها عن العلوم المتقدمة، واكتفائها بالمهام المنزلية النسوية، أو تعلم فنون وآداب وإتيكيت “الغزل الرفيع” (COURTLY LOVE) للحصول على زوج مناسب.
وفي المجتمعات الإسلامية المتزامنة، كان العاملان الرئيسان اللذان تسببا في تأخير النساء عن الرجال، في الحصول على فرص مساوية في التعليم -خاصة في المؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية بعد نشأة “المدارس”- هما: أولًا أن العرب وضعوا المرأة في مكانة سامية، وأشفقوا عليها من تعرضها لمخاطر طلب العلم وشظف الحياة والتقشف الذي كان يقاسية الطالب في السفر، وثانيًا الاهتمام الكبير بالناحية الأخلاقية أدى إلى كراهية الاختلاط والرغبة في التقليل منه أو منعه على قدر المستطاع[4]، حتى لو تطور ذلك إلى الجور على الحق الإسلامي الأساسي للنساء في الحصول على العلم من مؤسساته ومنابعه أو العمل به.
وفي ظل هذه الظروف التاريخية الصعبة، فإن ظهور طائفة من النساء العالِمات في المجتمعات الإسلامية المبكرة اللاتي تبوأن موقع الأستاذ المتخصص بمجالس الدرس في المساجد والمنازل لإلقاء الدروس والمحاضرات على الطلبة، هو أمر يستوقفنا، والغرض من هذه المقالة هو عرض للمجال الذي مارست فيه النساء المسلمات هذا النشاط التعليمي المحدد، ورصد طبيعة وخصائص هذه العملية التعليمية في سياقها التاریخی؛ حتى نفهم دلالتها بالنسبة إلى حياة النساء خاصة، وسوف أبني ملاحظاتي بالنسبة إلى الشخصية المُحدِثَة على نصين من أشهر قواميس أعلام القرنين الـ 14 و الـ 15، هما “الدرر الكامنة” لابن حجر العسقلانی (المتوفی 1448) و “الضوء اللامع” لمحمد شمس الدين السخاوي (1928- 1497م)، ويضم كل من الكتابين تراجم مختصرة لأبرز علماء وأعيان وفقهاء العصر.
من هن المُحَدِّثَات:
المُحدِّثَة / المُحدِّثْ هو المتخصص في دراسة علم الحديث الشريف “بطريقة الرواية والدراية، والعلم بأسماء الرجال وطرق الأحاديث والمعرفة بالأسانيد ونحو ذلك”[5]، والتحديث هو تدریس فقه و علوم الحديث. ومن المعروف أنه كان للنساء الصحابيات والتابعيات في الجيل الإسلامي الأول – ومنهن أمهات المؤمنين- دور كبير في حفظ ورواية الأحاديث النبوية، وقد سجلت كتب المراجع الإسلامية عدد “أسانيد” النساء مثل الطبقات الكبرى لابن سعد الذي أورد فيه أكثر من ۷۰۰ امرأة روين عن الرسول أو عن أصحابه وعنهن روی أعلام الدين وأئمة المسلمين، كما ترجم ابن حجر في كتابه “الإصابة في تمييز الصحابة”حياة 1543 راوية حديث[6]. وما يعنينا هو تطور هذا النشاط من مستوى الحفظ والرواية إلى مستوى الدراسة المتقدمة -في الأجيال التي تلت- لكتب الأحاديث وتصنيفاتها وشروحها، وقد انتمت هؤلاء النساء اللاتي تخصصن في مجال الحديث إلى طبقة العلماء المشتغلين في تلك العصور بمختلف العلوم الدينية، وقمن بدور تاریخي مماثل في عملية نقل المعارف وتوثيقها من خلال تحفيظها وتدريسها إلى أجيال أخرى تالية.
رواية الحديث ونشأة التعليم:
بدأ التعليم الإسلامي في أوله شفاهيًا وبصفة غير رسمية، معتمدًا على العلاقة الشخصية المباشرة بين المعلم أو المدرِّس والطالب، وقد كانت باكورة العملية التعليمية تتمثل في نشأتها بحلقات في المساجد أو حتى الطرقات والأماكن العامة بالمدن الكبيرة؛ بأن يلتف السامعون حول المُعلم ويحفظوا محاضراته لترديدها بعد ذلك والأخذ عنها، وعندما يشعر طالب العلم أنه قد نال من عند شيخ ما كل ما لديه من المعارف، يذهب إلى غيره ليستقي منه أشياء أخرى وهكذا. وكان المُعلم يُدَرِّس فقط ما يسمعه مباشرة أو يحفظه من معلم آخر سبقه، ومن هنا كانت أهمية المعرفة التي يتم الحصول عليها من خلال اللقاء الشخصي بالمعلم، وكانت لها قيمتها العالية في تقييم المؤرخين الإسلاميين للعلماء[7]. وهكذا بدأت فكرة التعليم برواية ونقل الأحاديث النبوية والتعليق عليها في القرن الأول الهجرى بالمساجد -كما رأينا- ومنها انتقلت إلى مجالس علمية تعليمية بالمنازل بدءًا من القرن الثاني وما يليه، واستمرت طبيعة هذه العلاقة الحميمة والوثيقة بين الأستاذ والطلبة الذين يحضرون إلى منزله، هي من أحسن ملامح التعليم الإسلامي المبكر، في نظر كثير من الباحثين[8]. وصاحب تطور حلقات المسجد إلى مجالس المنزل تطورًا آخر هو بداية استملاء هذه العلوم والمعارف، أي كتابتها وتداولها للتدريس، وأيضًا التعليق عليها وشرحها وتدوين هذه الشروح وتجميعها في مصنفات خاصة. وعلى الرغم من اتساع دائرة المواد والعلوم، فإن الحديث وروايته ظل له “عناية خاصة من المسلمين …. ولم يكن المدرس يجرؤ على روايته جراءته على تدريس أية مادة أخرى”[9]. أمام نظام المدرسة كمؤسسة تعليمية رسمية، فكانت بدايتها في أواخر القرن العاشر الميلادي بمدينة نيسابور عندما أنشأ الشيعة منشآت لتدريس ونشر المذهب الشيعي أطلقوا عليها في بادىء الأمر “دار العلم”، ثم كانوا أول من استخدموا اسم “مدرسة”، فقد أنشئت المدرسة البيهقية والسعيدية ومدرسة أبي سعيد الأسطرلابی ومدرسة أبي إسحق الأصفراني حتى جاء عصر السلاجقة ووزيرهم المعروف “نظام المُلك الذي طور هذه المنشآت، حتى أنشأ المدرسة النظامية الشهيرة ببغداد (1064م) من أجل مكافحة المذهب الشيعي وتعضيد الفكر السنی، ومنذ ذلك الوقت، تطورت المدارس في بقاع العالم الإسلامي الأخرى، كمؤسسة تعليمية رسمية شاملة يتقاضى فيها المدرسون الرواتب ويتخرج منها الموظفون لتولي مناصب في الإدارة والقضاء، أي أصبحت منشآت عامة تشرف عليها وعلى مناهجها ومدرسيها الدولة، وما فعله نظام الملك في إيران وجنوب بغداد، فعله الأتابكة في الموصل ودمشق، وكذلك صلاح الدين في مصر[10].
إلا أنه على الرغم من انتشار هذه المدارس، فقد استمرت المساجد ومنازل العلماء أمكنة مفضلة للتعليم العالي وللحصول على العلوم الرفيعة؛ لأن الدراسة بالمنازل ظلت نوعًا من الدراسة الحرة غير المقيدة بفکر مذهبي أو سياسي معين، ولا تتدخل فيه الدولة أو تُملي مناهجه، نظرًا “لأن الطالب أو وليه يختار له العلوم التي تناسبه، كذلك كان يختار المدرس .. ذو الشهرة العلمية والخلقية.”[11] ومعنى هذا كما تعلق د. زينب محمد فرید أن اشتغال النساء بالتدريس ودخولهن هذا المجال ذا المنافسة الشديدة، دليل على سعة ثقافتهن وثقتهن بأنفسهن، وعلى المنزلة العلمية والكفاءة المتوفرة لهن[12]. فاتخاذ مجلس الشيوخ لم يكن أمرًا هينًا “بسبب كثرة الأسئلة التي يمطر بها الطلاب المدرّسين .. حتى إذا وُفق المدرس في الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، إلى حد إقناع الذين تحلقوا حوله، فإنه حينئذ يستطيع أن يستمر في عمله، ويواصل التدريس. أما إذا عجز، فعليه أن يعود طالبًا يتلقى العلم في مجالس الشيوخ.”[13] .إذًا فقد خضعت المحدِّثَات المسلمات –أيضًا– لتلك المعايير الصعبة، ولعملية الانتقاء الدقيق في هذا المجال، وقد ساعد على ذلك نشأة معظم هؤلاء النساء في بيئات علمية خاصة، كأن يكون الأب أو الزوج أو أحد الأقارب عالمًا أو فقيهًا معروفًا، فيكون ذلك مُسببًا مباشرًا لبدء سَير النساء في سبيل المعرفة المتقدمة للدراسات الدينية والثقافية العالية، أو عن طريق معلم خاص يُدعى للفتيات الصغيرات. فأنتج هذا التعليم المنزلي الخاص، مجموعة من نساء الصفوة المثقفة في المجتمع المسلم -المحدِّثَات کنماذج للتعليم الإسلامی العالی وتخصصيته؛ فقد كان الحديث أوسع منبع للتشريع في العبادات والمسائل المدنية والجنائية، أي أنهن كن -بالتالي- راويات للتاريخ والقصص والحِكم وقواعد الأخلاق والفلسفة، وعالمات بالتشريع وحكم الدين في كثير من شئونه[14].
ونفهم أن دائرة نشاط “التحديث”، قد اتسعت لتشمل تدریس مبادىء وقواعد فقهية مستمدة من الحديث، ويؤكد أكثر من دارس للموضوع، أن معنى ذلك أن النساء المسلمات قد لَعِبن دور حلقة الوصل الهامة المؤسِّسة للتراث الفقهي والعلمي[15]. كما يتضح لنا أن النساء قد تفوقن في هذا المجال وحظين بسمعة كبيرة، فيما يخص بالذات قِصَر سلسلة “الإسناد” لديهن -وهذه أحد العناصر الهامة في علم الحديث- ومعناها أن تتفرد المُحدِّثَة، وتكون الوحيدة المسئولة عن نقل وقراءة (أي تدریس) مجموعة أحاديث معينة أو أجزاء وكتب عن طريق “السماع” المباشر من شيخة أو شيخ سابق متخصص في تلك المجموعة أو الكتاب المعنِى، وبذلك كانت المُحدِّثَة -في معظم الأحيان- تتميز بالحصول على “مَشْيَخَة” خاصة بها: قائمة بأسماء المشايخ والعلماء الذين دَرَسَتْ تحت توجيههم، ونقلت عنهم مباشرةً العلوم والأحاديث، أى كأنها قائمة بالمصادر المرجعية الرئيسة المسلَّم بها والموثوق فيها في الدوائر العلمية، وتمثل للمُحدِّثة وثيقة لإنجازاتها وتحصيلها الفكري.
طريقة التدريس:
هناك أربع خطوات أو طرق للتعليم أُتُبِّعت داخل مجالس العلم: أولًا، تقرأ المعلمة أو المعلم على الطلبة كتابًا من النص الأصلي أو من الذاكرة، مصحوبًا بتعليقات وشروحٍ من قِبَل المُحَدِّثَة، ويطلق على ذلك “السماع”. ثانيًا، يقرأ الطالب النص على أستاذه أو يسمع ما عرفه وحفظه له ليصحح له، وذلك في حضور بقية طلاب المجلس ذاته، وهو ما يطلق عليه “القراءة”. ثالثًا، قد يسمح المعلم للطالب أن ينقل منه الكتاب أو النسخة الأصلية. رابعًا، يمنح المُحَدِّث “إجازة” للطالب، وهي بمثابة شهادة علمية موثقة، أنه قد درس هذه المواد أو الكتب تحت إرشاده وتعليمه، وهى -أيضًا- رخصة في الوقت ذاته أو إذن بتدريس هذه العلوم عنه، وذلك لضمان صحة ودقة نقل النصوص[16].
ومن الشروط الأساسية الشرعية وصحة هذه “الإجازة” أن يكون مانحها على علم تام بالموضوع، وله سمعة أنه عالم متخصص موثوق به، وتكون “الإجازة” لكتاب واحد بعينه أو عدة كتب تذكر في نص الشهادة، أو لكل أعمال ومسموعات الأستاذ. كما كان يطلق عليها أيضًا “إجازة السماع” فتتكون من اسم “المُسمِع” (وهو مؤلف الكتاب نفسه، أو عالم متخصص فيه -مثل المُحَدِّثَة القائمة بالتدريس أو المُحَدِّث)، ثم اسم “القارىء” أي الطالب الحاصل على “الإجازة”، وتعطى بحضور بقية السامعين وكذلك كاتب السماع أو المُستملي[17]. وما نجد في تراجم المُحَدِّثِين -مثل التي ذكرناها والتي تسجل هذه العملية- من عبارات مثل “قرأ عليها فلان….” معناها أن يقرأ لها فلان من الذاكرة ما عرفه وحفظه، فتصححه له، أو أن يدرس هذه النصوص تحت إشرافها وتلقينها. وجدير بالذكر، أن ابن حجر صاحب “الدرر الكامنة”، قد درس على يد 53 مُحَدِّثة، وحصل السخاوي کاتب “الضوء اللامع” على إجازات علمية من 68 مُحَدِّثَة ضمن اللاتي ذكرهن في التراجم.
والواضح مما سلف، أن الذاكرة كانت أساس العملية التعليمية التي قامت -بادىء ذي بدء على آلية السمع والتكرار والحفظ؛ لتثبيت المعلومات ونقلها صحيحة. وهذه مرحلة أولى، كانت لها حاجتها وأهميتها، ثم تطور منهج التعليم بعد ذلك، وبدأ يظهر الفرق بين “الرواية” المعتمدة على الذاكرة فقط، و”الدراية”، أي فهم وتحليل الحديث واستخدامه كأساس للأحكام والفقه. ويرى جورج المقدسي أن كلمة “دراية” هي أصل علم أصول الفقه، الذي أطلق عليه في بدايته “علم الدراية”. وظهر هذا الفرق، خاصة في تراجم المُحَدِّثِين والمُحَدِّثَات، فيشار إلى شخص بأن علمه بالحديث يقتصر على الرواية فقط، أو الرواية إلى جانب الدراية[18]. إلا أن “جوناثان برکی” في تعرضه لأهمية الذاكرة كوسيلة تعليمية فعالة، في مجال علم الحديث، خاصة عند المُحَدِّثَات افترض أن النساء اعتمدن على هذه الوسيلة -فقط- في التدريس، دون استخدام وسائل أو أساليب أخرى مستخدمة في دراسة الفقه والشريعة، مثل “المناظرة” أو عقد المناقشات الجدلية لتفنيد الآراء والأحكام والفصل في الاختلافات؛ مما وضع قيودًا على ظهور القدرات التحليلية والفكرية للنساء،[19] وذلك استنادًا إلى أن النساء لم يتبوأن مناصب رسمية في أجهزة الدولة التعليمية -مثل المدرسة- فاستنتج أن تدریسهن في المجالس التعليمية بالمنازل أو المساجد لم يتسم بأية محاورات أو مناقشات فكرية تستدعي إعمال العقل و “الدراية” إلى جانب دقة “الرواية ” . وسنرى في الأمثلة التي سنوردها هنا، عدم صحة هذا الفرض، أيضًا عدم جواز استخلاص أن المُحَدِّثَات لم يكن قادرات على المناقشات العلمية داخل حلقات “التحديث”، بل هناك إشارات في التراجم تشير إلى أنهن مارسن ذلك، وقد يكون تم بطريقة أكثر حرية وطبيعة بسبب عدم الارتباط بأغراض أو ضغوط سياسية ومذهبية، التي كما رأينا تحكمت في إنشاء المدارس وتعيين فقهائها وتكوين مناهجها. وأحب أن أذكر هنا، الشيخة شهدة بنت أحمد بن الفرج المعروفة “بفخر النساء” (المتوفية ۱۱۷۸م)، التي كانت تحاضر في جمهور كبير من الطلاب في مسجد بغداد، ويقول عنها ابن خلكان: “كانت شهدة من العلماء وكتبت الخط الجيد وسمع عليها خلق كثير، وكان لها السماع العالي، ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر … واشتهر صيتها وبَعُدَ ذکرها”[20] أي أن بعض المُحَدِّثَات عملن بالمساجد ودرسن لجمهور أكبر ممن كانوا يأتيهن في المنازل، وغير معقول أن يصلن إلى هذه الشهرة ويتوافد “الأصاغر والأكابر” عليهن دون أن يتسمن بتميز فکري وقدرات تحليلية في المواضيع التي يُعلِّمنها.
معالم شخصية المُحَدِّثَة:
وبالنسبة إلى المصادر التاريخية المتاحة لنا، للتعرف على هذا القطاع من النساء المسلمات فأهمها معاجم السيرة وتراجم الأعلام التي كانت لها وظائف عملية وتقنية داخل الإطار القانوني والفكري للمجتمع المسلم {الحضرى} وكان الهدف الأساسي لكاتب السيرة التقليدي هو توفير المعلومات الضرورية للعلماء بغرض الحفاظ على الاستقامة والأمانة المطلوبة في نقل الأحكام القانونية والتراثية. وحتى يتحقق الهدف المنشود، كان على كاتب السيرة أن يقدم بعض المعلومات عن خاصية وجودة إنجاز المترجَم له العلمي ورحلاته أو رحلاتها في سبيل تحصيل العلم إلى جانب معلومات عن حياته أو حياتها الخاصة وسمات شخصيته أو شخصیتها[21]. فعند قراءة هذين المرجعين: “الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ” لابن حجر العسقلاني والجزء الثاني عشر من “الضوء اللامع لأهل القرن التاسع” للسخاوي، وهما عبارة عن تسجيل لتراجم الأعيان والعلماء والفقهاء والمُحَدِّثِين في القرن الـ 14 و الـ 15، سنركز على أوصاف المُحَدِّثَات والعَالِمات التي وردت في معرض الترجمة وهي إن كانت مختصرة وسريعة -في حالة ابن حجر- إلا أن تكرار بعضها يجعلنا نستخلص بعض الملامح الدالة على شخصيات وعمل المُحَدِّثَات وصورتهن كما نقلها ودونها كل من المؤرخِين. مثلًا “يتبع السخاوي في الضوء اللامع المنهج النقدي في تحليل الشخصيات ليتسنى وضعهم في مقامهم الصحيح. وهو في ذلك يخطو خطو (أستاذه) ابن حجر .. ويتضمن مجلده عن النساء كما هي الحال في المجلدات عن الرجال قطاع عرضي پؤرخ فيه للطبقات الاجتماعية الوسطى والعليا في أماكن مثل القاهرة ومكة والمدينة وأقاليم الشام وحتى اليمن”[22]. وبصفة عامة، سنجد أن معظم الخصائص المذكورة تدخل في نطاق آداب مهنة التعليم والمفاهيم الخاصة بمكانة المعلم، والعلاقة بينه وبين طلابه، كما مورست في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت.
أول ما نلحظه في تعليقات ابن حجر والسخاوي المتكررة على المُحَدِّثَات اللاتي يمتدحان علمهن وتدريسهن وصف أن فلانة كانت “ذات فهم وعقل” أو كانت “عاقلة” و “مستوية العقل”، “وكانت تدري الفقه جيدًا” إلى آخره. في الضوء اللامع نقرأ عن العديد: هناك خديجة ابنة الأشرف شعبان بن حسين (توفيت 1422م)، “وكانت توصف بعقل ورياسة “[23]، وخديجة ابنة الوجيه عبد الرحمن بن عبد الله بن فهد المكية (۱۳۸5 – 1455) التي حدَّثَّت كثيرًا من الفضلاء وكانت “…. ذات معرفة وخبرة ودماثة أخلاق” (ص۲۸)، وزينب ابنة النور علی بن الشهاب أحمد بن خلد (ت: 1486م) “كانت عاقلة مدبرة متوددة صابرة قانعة” (ص 43)، ثم زينب ابنة القاضي الكامل أبي الفضل محمد بن عبد العزيز (1393- 1420) التي “كانت رئيسة عاقلة تقرأ القرآن وتُذاكر بأخبار وأشعار حسنة … وكانت ناظرة على أوقاف والدتها” (ص 46). أما سارة ابنة عمر بن عبد العزيز بن على بن جماعة بن صخر (1308- 1451) فقد “حدثت بالكثير وسمع عليها الأئمة وحملت {السخاوى} عنها ما يفوق الوصف وكانت صالحة .. مع فطنة وذوق … ونزل أهل مصر بموتها في الرواية درجة” (ص 52)، وكذلك سارة ابنة الشرف محمد بن على بن يوسف الدمشقية (ت: 1457) التي “كانت من سروات نساء زمانها عقلًا ودينًا وأصالة وعراقة” (ص 53)، وهناك صفية ابنة محمد بن علی بن عمر الكيلاني المكي (ت: 1483) “كانت رئيسة مدبرة متمولة مذكورة بالعقل والجمال” (ص ۷۱)، ثم عائشة ابنة على بن محمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد القاهرية الحنبلية” (1359- 1436) وهي خطاطة بارعة ومُحَدِّثَة معروفة “سمع عليها الأئمة” و “أكثر عنها الطلبة”، “امرأة خيرة صالحة تكتب كتابة حسنة ولها فهم مليح … فهمة مستحضرة للسيرة النبوية تكاد أن تذكر الغزوة بتمامها ذاكرة الأكثر الغيلانيات وغيرها من الأحاديث حافظة لكثير من الأشعار .. سريعة الحفظ بحيث كانت تقول حفظت خمسة أبيات مواليًا بعشرین قرينة من مرة واحدة … وكانت من الذكاء على جانب كبير تطالع كتب الفقه فتفهم”، وقد سافرت إلى فلسطين وحدَّثت هناك -أيضا- فأخذ عنها الكثير من الأعيان، (ص ۷۸). ووصفت كل من فاطمة ابنة البرهان إبراهيم بن على بن أبي البركات بن ظهيرة بمكة (۱466- 1491) وفاطمة ابنة إبراهيم بن عمر بن محمد الزرعي (ت : 1484) بالعقل والبر والتودد (ص 86).
وهكذا فإن المُحَدِّثَة العَالِمة الناجحة لم تُعرف -فقط- بحفظها وروايتها الدقيقة للتراث ولكن عُرِفت -أيضا- بدرایتها و درسها بما تنقله من علوم. ونصادف كثيرة من المُحَدِّثَات لقبن “بالشيخة” -التي يرى “تريتون” أنه استخدم لمُحَدِّثَة أو عالِمة في المذهب الحنبلی خاصةً[24]، كما نجد من کُنیت “بست الوزراء” أو “ست الفقهاء” أو “ست القضاة” إلى آخره. ويرد في الدرر الكامنة ذكر فاطمة بنت عیاش بني أبي الفتح البغدادية (ت: 1314) التي “كانت تدري الفقه جيدًا، وكان ابن تيمية يُثني عليها ويتعجب من حرصها وذكائها، انتفع بها نساء أهل دمشق لصدقها في وعظها وقناعتها، ثم تحولت إلى القاهرة فحصل بها النفع وارتفع قدرها وبعد صيتها، وكانت قد تفقهت عند المقادسة بالشيخ ابن عمر وغيره”[25]. ويبدو أن الكثيرات قد تنقلن في الأقطار الإسلامية بسبب سمعتهن العلمية، مثل زینب بنت أحمد بن عمر بن شکر المقدسية (ت: ۱۳۲۲) التي حدَّثت بدمشق ومصر والقدس (ص ۱۱۸) وست الوزراء بنت عمر بن المنجا الدمشقية (۱۲۲6 – ۱۳۱۹) التي طُلِبت إلى مصر لِتُحدث فيها بسبب شهرتها (ص ۱۲۹)، وكانت أم هانیء ابنة العلامة نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الملك المصرية الشافعية (۱۳6 – 1466) ذات علم غزير ذكره السخاوي بالتفصيل، في الضوء اللامع، وكانت “فصيحة العبارة مجيدة للكتابة ولديها فهم وإجادة لإقامة الشعر بالطبع، حفظت القرآن في صغرها ومختصر أبي شجاع في الفقه والملحة في الإعراب وغيرها، وسمعنا من لفظها وحفظها سورة الصف بفصاحة وحسن تلاوة” (ص 157). وكذلك نضار بنت محمد بن يوسف أم العز بنت الشيخ أبي حيان (۱۳۰۲ – ۱۳۲۹) قال ابن حجر في الدرر: إنها تعلمت الحديث والنحو ونظمت الشعر وكانت تعرب جيدًا وكان أبوها يقول “ليت أخاها حيان مثلها” وكانت كاتبة فصيحة “تفوق كثيرًا من الرجال في العبادة والفقه مع الجمال التام والظرف” (ص 395). وكل هذه دلائل تشير إلى الارتباط الوثيق في مجال التدريس بين علم الحديث والفقه أو أصول الدين.
كما نستخلص من هذه الأوصاف، أن عمل المُحَدِّثَات لم يكن مقتصرًا على تحفيظ الطلبة النصوص، ولكن -أيضًا- تعليمهم فهم العلوم الدينية والتفقه فيها والتعمق في مبادئها. وهذه كلها شروط أساسية في التعليم والتعلم دَوَنها برهان الدين الزرنوجي الذي عاش في أواخر القرن الـ ۱۲م وأوائل القرن ۱۳ وترك أثرًا هامًا -تعليم المُتعلّم طريق التعلُّم (۱۲۰۳م)- وهي وثيقة مشهورة ومن أهم الكتب التي وصلتنا في هذا الشأن أرسى فيها الكاتب مبادئ التعليم والتدريس في الثقافة الإسلامية وآداب التربية الثقافية والعلمية كما طبقها المجتمع المسلم في ذلك الوقت، ومنها نتعرف على صورة المُعلِّم المثالي (رجلًا وامرأة) في نظرهم ومكانته وطبيعة العلاقة بينه وبين طلابه. ونستطيع -بالتالي- أن نستشف تفاصيل عن مقومات شخصية هؤلاء المُحَدِّثَات اللاتي ذاع صيتهن وقَصَدهن جموع الطلبة وجلسوا تحت أيديهن يتلقون العلم. فإذا أكد الزرنوجي عن واجب وضرورة حسن اختيار المتعلم للأستاذ بأن يكون “الأعلم والأورع والألسن”[26]، معنى هذا أن كلها كانت صفات موجودة بالمُحَدِّثَات اللاتي تم اختيارهن من قبل الطلبة والأئمة”. الأعم “هنا تشير إلى الذي امتلك ناصية الفقه” عامةً أي “معرفة دقائق العلم” (ص ۱۳)، “الألسن” معناها الأبلغ في الشرح والتعليق، و “الأورع” الأكثر ورعًا وتقوى تعبيرًا عن أهمية سمو أخلاقيات المعلم. ومن هنا تظهر دلالة اهتمام السخاوي -مثلًا- بوصف المُحَدِّثَات في تراجمه بالتقوى والفضيلة والإحسان والبر والإيمان، مثلًا”.. كانت خيرة مباركة صالحة كثيرة العبادة والصيام والطواف والاعتمار”. (ص 40)، أو ” كانت رئيسة دَيّنة كريمة راغبة في الخير مجابة الدعاء” (ص ۱۱)، أو ” كانت خيرة عفيفة محسنة للفقراء والأرامل …” (ص ۲۸)، أو “كانت كاتبة قرأت القرآن ونظرت في كتب العلم وأكثرت من العبادة والخير …” (ص ۳۹)، ثم خديجة ابنة علي بن عمر بن أبي الحسن الأنصاري (1386- 1468) التي حَدَثَّت بمعلوماتها كثيرًا إلى الفضلاء والشيوخ “وكانت قد قرأت في صغرها اليسير من القرآن ومن العلم وتعلمت الخط مع المداومة على المطالعة والبراعة في استخلاص الخطوط المتنوعة .. {وهی} غاية في الخير والديانة والمحافظة على الصلوات والقيام” (ص ۲۹) وغيرهن .. وهكذا تصبح صفات الصلاح والأخلاق عناصر أساسية من ثقة الطلاب في المعلمين.
وفي تفرقة الزرنوجی بين قيمة الحفظ والفهم إشارة إلى التوقعات المنتظرة من العلم ودوره في الترسيخ والإفهام، وليس فقط التحفيظ: “حفظ حرفين خير من سماع وَقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين” (ص ۳۹)، “وَقْر” هنا بمعنی حِمْل من الكتب. وقد رأينا في الأمثلة السابقة، التأكيد على مقومات العقل والتدبير والفهم في المُحَدِّثَات الناجحات، وهي ترتبط في تراجم السخاوي وابن حجر بذيوع الصيت والشهرة، وتكوين سمعة علمية لمُحَدِّثَة بعينها، خاصة إن “تفردت” بكتب أو أجزاء أو مسموعات معينة ومعناها أن تصبح المصدر الموثوق الوحيد المتواجد لهذه الكتب أو العلوم كما تلقتها من شيوخ سابقين، مثل عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي بن قدامة بن مقدام (1323- 1413) بدمشق التي تفردت عن جل شيوخها بالسماع والإجازة في سائر الآفاق وروت الكثير وأخذ عنها الأئمة سيما الرحالة فأكثروا .. وهي آخر من حَدَّث بالبخاري عاليًا بالسماع” (السخاوي، ص ۸۱)، وكانت هاجر ابنة محمد بن ابراهيم بن علي بن أبي الطاعة “أَسْنَد” أهل مصر وتتكسب من أجر التدريس، (ص ۱۳۱). كوَّنت المُحَدِّثَات إذًا سُمعات مستقلة فريدة في الإسناد والنقل والتعليم، بل إنَّ واحدة مثل ألف ابنة القاضی علم الدين صالح بن عمر البلقيني قامت بتنظيم المجالس العلمية المختلفة في بيتها: “رتبت قراء يقرأون عندها الحديث والتفسير وتردد إليها في ذلك إبراهيم الحموي وعقد الميعاد عندها والفخر الديمي .. والبلبيسي وابن خليل الحسیني وآخرون …” (ص ۸)، إلى جانب إنشاء مدرسة بها قراء كل يوم، والقيام بأمرها وبتفقد الأمراء والأرامل” حتى صارت فريدة في أقربائها وأمثالها” .
وهناك من النساء من ارتبطت سمعتهن كمصادر علمية أو ثقافية بكتابة كتب أو آثار شعرية و مکاتبات ومراسلات، مثل عائشة القاهرية الحنبلية التي ذكرناها من قبل والتي أخرج لها الشيخ الزیني رضوان کتابًا في موضوعات تخصصها، وكذلك أخرج السخاوي نفسه لمريم ابنة أحمد بن القاضي شمس الدين القاهرية (1319- 1402)” معجمًا في مجلد” (ص 124)، ثم نضار بنت الشيخ أبي حيان -المذكورة سالفًا- فقال ابن حجر إنها عالمة بالحديث والنحو و”خرجت لنفسها جزءًا ونظمت شعرًا”. أما حبيبة الله ابنة الصفي عبد الرحمن بن عبد الله (1414- 1489)، فكان “لكثيرين فيها اعتقاد ولها أتباع من أقربائها وغيرهم …” (ص ۱۹)، أى كأنها كانت تمثل مذهبًا تعليميًا محددًا. ومن المؤسف أن تلك الآثار المكتوبة التي ورد ذكرها في تراجم بعض المُحَدِّثَات، لم تصلنا، ولايزال -على حد علمي- غير معروف عنها شيء حتى عناوينها. وجدير بالذكر -أيضًا- هنا أن كثيرًا من المُحَدِّثَات کن خطاطات بارعات لهن خط جميل عُرِفن به، مثل خديجة ابنة أبي الحسن الأنصاري -وذكرناها قبلًا- التي يقول السخاوي إنها تخصصت في استخلاص الخطوط المتنوعة” (ص ۲۹)، منهن من كن على اتصال مع مُحَدِّثِی وعلماء عصرهن من خلال المكاتبات والرسائل التي كانت تضم أشعارًا وتبادلًا للمرويات والمعلومات والآراء وطرح أسئلة في شؤون الدين والحياة والإجابة عنها. يقول السخاوي عن إحدى المُحَدِّثَات اللاتي عرفهن معرفة شخصية، إن مکاتباتها لا تنقطع عنه (ص ۱۳)، وأخرى كانت تراسله تطلب منه النصح والدعاء (ص ۳۳).
أما فاطمة ابنة القاضي كمال الدين محمود القاهرية (ولدت 1451)، فقد كانت مُحَدِّثَة وعالمة متميزة، نشأت بينها وبين السخاوی علاقة زمالة فريدة، وتبادلا العديد من الرسائل وبها قطع شعرية طويلة لها تسأل السخاوي فيها عن أمور في الأحكام والحديث ويرد عليها أو تبعث إليه بآرائها وتعليقاتها على أحداث معينة. وقد توسع السخاوي في ترجمتها حتى أفرد لها حوالي ست صفحات من كتابه (۱۰۷ – ۱۱۲) حيث ضَمَّن أبياتًا كثيرة من شعرها تخاطبه شخصيًا فيها (وإن كان اكتفى في بعض الأحيان بذكر أول بيتين فقط من قصائد لها لا نعرف مکانها). أثنى السخاوي على “براعتها في النظم وحسن فهمها وقوة جنانها حتى كانت فريدة فيما اشتملت عليه ..”. بعثت إليه مرة تواسيه وترثيه في وفاة أخوين له في قصيدة من ۳۱ بیتًا، بها بيتان تمتدح فيهما شرف مهنة “التحديث” والمكانة الخاصة للمُحَدِّث:
نعم هي أهل للجناب الذي له علوم حديث في الوجود بحكمة
ومن خصه الله العظيم بفضله فروى حديثًا صادقًا عن نبوة
ومن الواضح أنها كانت تتمتع بشخصية قوية وثقة في النفس، فكتبت إلى السخاوي مرة تعبر عن رأيها في شأن ما بلغها، فيما يبدو عن بعض الناس في الكلام في حقها أو حقه:
ما ضر بحر الفرات يومًا لو خاض بعض الكلاب فيه
وعندما فقدت هي ابنة لها، وبعث لها السخاوي کتاب رثاء له عنوانه “ارتياح الأكباد”، أرسلت إليه قصيدة أخرى تعلق فيها على كتابه وتشكره عليه، وإن أبدت رأيًا آخر في مسألة الحزن على الرزايا، وقدرة احتمال النفس البشرية نوائب الأقدار، وفي مفهوم الصبر، وتسأله عن رأيه في أبيات شعر قرأتها لشاعر آخر عن الصبر على المكاره فيرد السخاوي عليها بشرح وتعليق ويقدم تقييمه ونقده الشخصي لهذا الشعر من منظور دیني إيمانی، مستخدمًا علمه بتراث الحديث، خاصة في تحليله النص التي بعثت به إليه. ثم تراسله فاطمة بقصيدة أخرى من ۱۹ بیتًا تسأله عن فتوى في أمر يخص أداء العمرة، ومنها:
أسألك يا شيخ شيوخ النهى ومن حوى في فيه در نظيم
فيمن أتاها عائق عاقها عن أمل صارت به في حميم
قيامها إذ ذاك یاسیدي بين مقام زمزم والحطيم
في ليلة أخبرنا أنها يفرق فيها كل أمر حكيم
وهل لها أجر الذي قامها هل يساوي مقعدًا مستقیم
وتمتدحه بأنه كان “حافظًا نقل حدیث قديم”، وأنه يروي “صحيحًا نقله لا سقيم”. مرة أخرى، نلمس في كلامها الاحترام الكبير الذي كان يناله من يشتغل بعلوم الحديث خاصة، والمسئولية العظيمة التي افترض الناس أنها على عاتقه. ويرد عليها السخاوي فعلًا بفتواه، مفصلة ومدعمة بنصوص الأحاديث. كما كان من عادتها أن تنظم ألغازًا شعرية تبعث بها إلى السخاوي، أو إلى شيوخ آخرين ليحلوها، مثل الشهاب أحمد بن صحصاح الفيومي الخانكي الذي كان يجيبها عن هذه الألغاز من خلال الشعر أيضًا. ويذكر السخاوي أنها “طارحت” الشهاب الحرفوش الحاني وعلي بن ناصر وغيرهما، وسوف نوضح معنی ودلالة “المطارحة” بعد قليل.
ومن السمات الهامة -أيضًاً- للمُحَدِّثَة كما نجدها عند ابن حجر والسخاوی: قوة شخصيتها وحضورها وجلالها ووقارها، كما هو واضح من الإشارات المتكررة، إلى أن فلانة مثلا كانت ” رئيسة ” و “مدبِّرة ” و “وجيهة” أو “ذات ریاسة” و “ذات وجاهة”… وخلافه، وتتعدد أسماء اللاتي وُصِفْنَ بهذه المقومات بالذات حتى يتعذر حصرهن جميعًا هنا، ولكن ما يعنينا هو دلالة هذه الصفات التي تشير إلى حُسن تدبير حلقة الدرس أو المجلس واليقظة وفرض الاحترام والإجلال على الطلاب. ويبين جورج المقدسي أن مفهوم “الرياسة” معناه تحقيق العالِم أو العالِمة الامتياز والتفرد في مجال التخصص والوصول إلى منزلة “الرياسة” العلمية، وعادة ما يكون ذلك عن طريق خلو الساحة من أي منافس آخر، أو أن يفوز المُحَدِّث أو المُحَدِّثَة في مناظرة مع علماء آخرين[27]. وقد أكد الزرنوجی -أيضًا- على هذه الصفات النموذجية كدواع لتعظيم أهل العلم: “على المتعلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة وإن سمع المسألة الواحدة أو الكلمة الواحدة ألف مرة”. (ص 25)، ومن توقير المُعَلِم “ألا يمشى المُتَعلم أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدىء بالكلام إلا بإذنه، ولا يُكْثِر الكلام عنده إلا بإذنه، ولا يسأل شيئا عند ملالته، ويراعي الوقت، ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج” (ص ۲۲). وطبيعي إذًا أن تحظى المُحَدِّثَات بهذا النوع من الاحترام والتوقير ويُعَامَلن بالطريقة ذاتها: “ينبغي لطالب العلم ألا يجلس قريبًا من الأستاذ عند السبق {الحفظ} بغير ضرورة بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس، فإنه أقرب إلى التعظيم” (ص 26). أي أن بعد المسافة المكانية هذه كانت للأستاذ أو الأستاذة على حد السواء. فالمُحَدِّثَة نشوان ابنة الجمال عبد الله بن العلاء مثلًا (توفيت: 1475) في القاهرة كانت ذات مكانة عالية ولها عند “غيرها من الرؤساء وجاهة لما اشتملت عليه من الدين والتدبير والعقل وعلو الهمة والكرم والمحاسن الجمة … قاضي الحنابلة العز الكناني لم يكن يقوم لمن يدخل عليه بيته من النساء غيرها، وحمد الطلبة محبتها فيهم وصبرها عليهم…” (السخاوی، ص ۱۳۰).
ويعلق”جوناثان برکی” على ندرة ورود عوامل ” الصُحبة ” و ” الملازمة في تراجم النساء المُحَدِّثَات كأساس للعلاقة التربوية الوثيقة التي كانت سائدة بين الطالب والأستاذ کدلیل على اختلاف طبيعة العملية التعليمية عند المُعَلِّمات النساء وربما ضعف مستواها بسبب ذلك[28]. وإذا كان النسق الأخلاقي والاجتماعى الإسلامي لا يتيح مثل هذه “الملازمة” المستديمة بين النساء والرجال، فإنه -أيضًا- لم يعرقل التبادل التعليمي ولم يؤدِّ إلى غياب عنصر “الرياسة” مقترنًا بالنساء، ومن ثم فإن “علاقة القوة” المفترضة بين الأستاذ والطالب والتي يرى “برکی” أنها كانت تمثل مشكلة في مجال التعليم؛ لأن الميزان سيختل بوضع امرأة -من الناحية الفكرية- في مركز أعلى من الرجل، ظلت علاقة مُعلم وطالب علم في حلقات المنزل والمسجد، ولم يكن هناك حرج في تراجم ابن حجر أو السخاوي من الإشارة إلى “رياسة” المُحَدِّثَة، وإلى الجلوس إليها في موقع أدنى علميًا. ولم ينبه “برکی” إلى ورود عنصر “المُجَاوَرَة” أحيانًا؛ عندما يشير السخاوي أكثر من مرة إلى أنه قد “جاوَر” فلانة عندما حجَّت أو اعتمرت أو نزلت بمكة في رباط أو زاوية.
وترتبط صفات “الوجاهة” و “التدبير” عند ابن حجر والسخاوي بظاهرة إدارة الربط (مساكن خاصة للأرامل والأيتام أو الصوفية) والإحسان بالمال الخاص لبناء المساجد والمدارس والزوايا … إلى آخره. والأمثلة كثيرة سوف أذكر منها بعضهن فقط: عائشة ابنة علي بن عبد الله الرفاعي (السخاوي، ص ۷۷)، التي أنشأت رباطًا بمكة عُرِف بها، ووقفت عليه دارًا مطلة على المسجد، وعقدت حلقات التسبيح والأوراد كل أسبوع، وشيرين أم الناصر فرج بن برقوق (ص۷۰) التي جدَّدت رباط الخوزي بمكة أيضًا وأصلحت ما تهدم منه، وفاطمة ابنة المال يوسف بن سنقر (ص۱۱۳) التي أحسنت إلى الأرامل ونحوهن فاتخذت لها زاوية لإقامتهن، وصارت تلقب بالشيخة، ولها صيت بذلك، ثم فائدة “الملقبة بالشيخة {أيضا} لكونها كانت شيخة رباط الظاهرية بأسفل مكة” (ص 114)، وغيرهن الكثير ممن تطرق نشاطهن إلى نواحي الخدمة الاجتماعية.
وكان على المُحَدِّثَة الجيدة في تعليمها، أن تكون حليمة صبورة على الطلبة حتى يحفظوا، ثم يفهموا ويعوا جيدًا ما نقلته إليهم، مع ما في هذه العملية من دواعي التكرار في الشرح والتسميع والصبر على الأخطاء. من هنا نالت بعض المُحَدِّثَات الجيدات في هذا المضمار خبرة وشهرة، فهذه واحدة “حمد الطلبة محبتها فيهم وصبرها عليهم” (السخاوي، ص ۱۳۰) وأخرى عندها “فطنة وذوق ومحبة في الطلبة وصبر على الإسماع” (ص 25). كما نقرأ عن کثیرات “تزاحم” عليهن الطلبة بسبب سمعتهن الحسنة. ويحدثنا ابن حجر عن زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية (1248- 1339) المُحَدِّثَة الجليلة التي “تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء بالإجازة … روت الكثير وتزاحم عليها الطلبة .. وكانت لطيفة الأخلاق طويلة الروح ربما سمَّعوا عليها أكثر النهار …. كانت قانعة متعففة كريمة النفس طيبة الخلق … ولم تتزوج قط …، ونزل الناس بموتها درجة في شيء كثير من الحديث” (ص ۱۷۷).
يبقى لنا الحديث عن المطارحة والمذاكرة والمناظرة، وهذه ممارسات تعارف الناس عليها في مجال العلم وذكرها الزرنوجي في كتابه كعناصر أساسية لا يستغني عنها طالب العلم أثناء تلقيه الدروس. والمطارحة معناها إلقاء الدارسين المشاكل والمساءَلات على بعضهم في صورة محاورة ومبادلة للرأي من خلال طرح أسئلة وإجاباتها. والمذاكرة عبارة عن مناقشة وتفنيد الموضوعات في إطار الجدل المدعم بالبراهين والحجج العلمية للدفاع عن أو دحض تفسیر معين؛ ثم المناظرة وهى -أيضًا- نوع من المجادلة أو المناقشة التي تتم بين طرفين لتقييم وتفضيل الآراء المختلفة. ويقول الزرنوجي في تعليم المتعلم “فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة تكون لاستخراج الصواب، وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني من المباحثة والإنصاف ولا يحصل ذلك بالشغب والغضب، فإن كانت نيته إلزام الخصم وقهره لا يحل ذلك، وإنما يحل ذلك لإظهار الحق” (ص ۳۷). كما أثنى على أسلوب المطارحة: “مطارحة ساعة خير من تکرار شهر” (ص ۳۸). وقد مرت علينا زینب ابنة الكمال أبي الفضل التي قيل إنها “تُذاكر” بأخبار وأشعار….، وفاطمة ابنة كمال الدين محمود القاهرية التي “طارحت” الشيوخ وناقَشَتهم.
وهكذا اتسم النشاط العلمي للمُحَدِّثَات بكل سمات وأساليب التعليم المتعارف عليها في ذلك الوقت، سواء بالمعاهد التعليمية الرسمية أو في الدوائر الخاصة بالمنازل أو المساجد. وصحيح أن النساء لم يتولين مناصب تعليمية أو قضائية داخل “المدرسة” مثلًا، ونعزو ذلك كما رأينا إلى عوامل القوى السياسية والمذهبية السائدة والمسيطرة على نواحي المجتمع المختلفة، فليس معناه ألا نرى في التعليم الخاص الذي مارسته النساء المسلمات بحرية أكثر داخل المنازل نمطًا آخر مغايرًا للتعليم الرسمي، نمطًا له قيمته وأهميته وبيئته الخاصة. فالمهم هو استكشاف هذا التاريخ المهمش -إلى جانب التأريخ لقضاة وفقهاء “المدارس”- للتعرف عليه وإظهاره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
* البحث منشور في مجلة هاجر ع. 5، 6. (1998).
** أستاذ بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية. جامعة القاهرة، وعضو مؤسس في مؤسسة المرأة والذاكرة.
[1] Eileen Power, Medieval Women (Cambridge University Press, 1975), p. 85 – 87.
[2] Philippe Verdier in Rosemarie Morewedge, ed., The Role of Women in the Middle Ages (Albany: State University Press, 1975), p. 133.
انظري أيضا:
– Rowena Archer in P. J. P. Goldberg, ed., Women is a Worthy: Women in English Society, 1200 – 1500 (United Kingdom: Alan Sutton, 1992), pp. 151 – 52.
[3] Power p. 82.
[4] أحمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية، بيروت: دار الكشاف، 1954، ص 321.
[5] القلقشندي، صبح الأعشى، جـ 5 ص 464، مأخوذ عن عبدالغني عبدالعاطي، التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك (القاهرة: دار المعارف، 1984) ص 320.
[6] زينب محمد فريد، تعليم المرأة العربية في التراث والمجتمعات المعاصرة (القاهرة، ۱۹۸۰) ص ۹.
[7] A. S. Tritton, Materials on Muslim Education in the Middle Ages (London: Luzac, 1957), p. 31.
[8] Bayard Doged. Muslim Education in Medieval Times (Washington: The Middle East Institute, 1962), p. 10.
[9] أحمد شلبي، ص 247.
[10] عبد العاطي، ص ۳۰۰، انظري -أيضًا- سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ۱۹۷۱) وفيه مسح شامل للعمائر الإسلامية في مصر بأنواعها سواء المساجد أو الأضرحة أو الزوايا والخانقاوات أو المدارس والمنشآت التعليمية.
[11] عبد العاطي، ص ۲۰۷.
[12] زينب محمد فريد، ص ۱۱.
[13] أحمد شلبي، ص 245.
[14] زينب فرید،ص 14
[15] Jonathan P. Berkey, “Women and Islamic Education in the Mamluk Period, in “Women in Middle Eastern History“, ed., Nikki Keddie (New Haven: Yale University Press, 1991), p. 151
[16] انظری عرض Trition لهذه الوثائق التعليمية، ص. 4 – 44.
[17] George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), p. 141.
[18] Makdisi, p. 144.
[19] Berkey, p. 145.
[20] ابن خلکان، وفیات الأعيان، جـ 5، ص 56، ورد في زينب محمد فريد، تعليم المرأة العربية، ص۱۰.
[21] انظري مقال د. هدى لطفي، وفيه وصف وعرض مفيد للغاية لمعجم السخاوي الذي نحن بصدده.
Huda Lutfi, “Al-Sakhawi’s Kitab Al- Nisa as a Source for the Social and Economic History of Muslim Women During the 15th century A.D.; “The Muslim World“, LXXI, No. 2 (1981), p. 106.
الترجمة إلى العربية للدكتورة سمية رمضان.
[22]هدی لطفي، ص۱۰۸.
[23] الجزء ۱۲ من الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (القاهرة: مكتبة القدسي، 1934)، ص ۲۷.
[24] Tritton, p.42.
[25] الجزء 3 من الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (بیروت: دار الجيل، ۱۹۷۷)، ص ۱۷.
[26] برهان الدين الزرنوجي، تعليم المُتعلِّم، طريق التَعلُّم، تحقيق عبد اللطيف محمد العبد (القاهرة: دار النهضة العربية، ۱۹۷۷)، ص۱۷.
[27] Makdisi, p. 131.
[28] Berkey, p. 153.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies