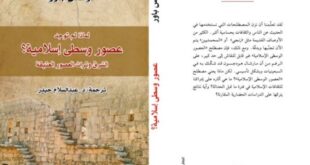العنوان: الله والإنسان في القراّن: علم دلالة الرؤية القراّنية للعالم.
المؤلف: توشيهيكو إيزوتسو.
الترجمة: د.هلال محمد الجهاد.
الطبعة: ط. 1.
مكان النشر: بيروت.
تاريخ النشر: 2007.
الناشر: المنظمة العربية للترجمة.
الوصف المادي: 386 صفحة.
الترقيم الدولي الموحد: 6-0825-0-9953.
الفكرة المحورية لهذا الكتاب
تدور فكرة الكتاب حول دلالات الألفاظ والكلمات في اللّغة العربيّة وكيف جاء الإسلام من خلال القرآن منتقياً ألفاظاً متداولة وليست غريبة في لغة وأفكار النّاس ما قبل الإسلام معطياً إياها دلالات جديدة. وتعكس هذه الدراسة دقّة فهم الكاتب للموضوع المطروح وتمكّنه من اللّغة العربيّة والأدب العربي حتّى استطاع القيام بهذا التحليل للكلمات العربيّة ومعرفة كيف كان مفهومها قبل نزول الوحي وكيف أعطاها القرآن الكريم معنى جديداً وخاصّة فيما يتعلّق بالتّعابير المفتاحيّة..والتي تعني العبارات الأساسيّة في الدّين الإسلامي كيف كانت تُستخدم وكيف صارت بعد نزول القراّن.
الهدف من الكتاب
يذكر مؤلّف الكتاب الأستاذ (توشيهيكو إيزوتسو (Toshihiko Izutsu في مقدّمته أنه أراد من خلال هذا الكتاب المساهمة في فهم أفضل لرسالة القرآن الكريم لدى أهل عصره الأول، ولدى أهل زماننا أيضاً؛ بمعنى أن هذا الكتاب يسعى لتجديد وتحديث فهم القرآن من خلال الكشف عن منظوره الدلالي للعالم.
إن”علم الدلالة”، باعتباره ينكب على دراسة المعنى، فهو يشكل فلسفة من نوع جديد تنبني على تصور جديد للكون وللوجود؛ فكل بنية لغوية أو نصية تحمل تصورا معينا للوجود والكون؛ والقرآن كبنية نصية يحمل تصورا خاصا به عن الوجود والكون والعالم، وهذا ما كرس إيزوتسو كل جهده ليكشفه ويقف عنده.
فإيزوتسو يرى أن علم دلالة القرآن يبحث بشكل رئيس في مسألة عالم الوجود ومكونات ذلك العالم من منظور القرآن، فيمكن لعلم دلالة القرآن أن يتحول إلى نوع من الأنطولوجيا (مبحث الوجود) التي تبحث في الوجود بشكل حي وحركي، بدل التفكير في الوجود بشكل ساكن كما هو الأمر مع بعض الفلاسفة، لكون دلالة القرآن تعكس حركية الوجود وديناميكيته، ولا شك بأن القرآن غني باصطلاحات ومدلولات تعكس الرؤية القرآنية للكون.
توحيد المفاهيم المُستقلة:
يقول الكاتب بأن مُهمته في هذا الكتاب ستتمثل في استخراج ما أسماه بالمفاهيم المفتاحية في النص القراّني، مثل: (الله، إسلام، نبي، إيمان، كافر، …الخ)، ويسعي لتحديد معناها في السياق القرآني، رغم أن هذه المهمة ليست بالسهلة، نظرا لطبيعة التداخل بين هذه المصطلحات مع غيرها في النسيج المكون للنص القرآني، إذ تستمد معناها من تلك العلاقات المترابطة.
كما أوضح الكاتب أن التعابير المفتاحيّة التي تؤدي وظيفة حاسمة في صياغة نظرة القرآن إلى العالم بما فيها اسم “الله” تعالى، ليس منها ماكان جديداً ومبتكراً، بل كانت كلّها تقريباً مستخدمةً قبْل الإسلام. وعندما شرع الوحْيُ الإسلامي باستخدامها كان السّياقُ العامُّ الذي استُخدمت فيه –وليست الكلمات المفردة- هو الذي صدم مشركي مكة بوصفه شيئاً غريباً وغير مألوف وغير مقبول. ويقول إيزوتسو هنا: “الكلماتُ نفسُها كانت متداولةً في القرن السّابع الميلاديّ، إن لم يكن ضمن الحدود الضيّقة لمجتمع مكّة التجاري، فعلى الأقل في واحدة من الدوائر الدينية في جزيرة العرب، إلا أنها كانت تنتمي إلي نظام مفهومي مُختلف. وجاء الإسلام فجمعها معاً وضمها كلها في شبكة مفهومية جديدة كلياً. وغير معروفة من قبل وهي كذلك حتى اليوم”.
وقد أدي هذا التحول في المفاهيم والتبدل الجوهري للقيم الأخلاقية والدينية التي نشأت عنه، إلي إحداث تغير أساسي كامل في تصور العرب للعالم وللوجود الإنساني. ومن وجهة نظر المختص بعلم الدلالة الذي يهتم بتاريخ الأفكار، فإن هذا – وليس أي شيء اّخر – هو ما أعطى الرؤية القراّنية للكون هذا الطابع المميز والواضح.
ثم ضرب أمثلة من القراّن، علي سبيل المثال قال إن اسم “الله” لم يكن مجهولاً بتاتاً لدى العرب الجاهليين، وذلك ما تؤكده حقيقة أن هذا الإسم لا يظهر في الشعر الجاهلي وفي أسماء الأعلام المركبة فحسب، بل في النقوش القديمة أيضاً. وأنَ بعض الناس أو بعض القبائل في الجزيرة العربية علي الأقل كانت تؤمن بإله يُدعى “الله”، حتي إنهم كانوا كما يبدو يذهبون إلي حد الاعتراف بكونه خالق السماء والأرض، كما يظهر ذلك بسهولة من بعض الاّيات القراّنية، وفي أوساط أناس من هذا النوع فإن “الله” قد مُنح المرتبة العليا ليكون “رب البيت”، أي الكعبة في مكة.
إذن كانت كلمة “الله” مستعملة من قبل ومتداولة في الشعر الجاهلي قبل نزول القرآن، ولكن طبيعة توظيف القرآن لهذه الكلمة، ولطبيعة العلاقة التي تشكلت بينها وبين الكثير من المصطلحات داخل النص القرآني، جعلها تأخذ معنى مخالفا لما كانت عليه من قبل من خلال السياق العام الذي وظفت فيه هذه الكلمة كمصطلح مفتاحي أساسي ومركزي داخل القرآن، والحقيقة أنّ كلمة “الله” هي أسمى كلمة صميميّة في المعجم اللغويّ للقرآن، ومهيمنةً على الميدان كلّه، وما هذا سوى المظهر الدّلاليّ لما نعنيه عموماً بالقول إنّ عالَم القرآن مرتكزٌ أساساً على الله، وهذا ما صدم المشركين وأثر فيهم، لكونهم أدركوا معنى غير مألوف لديهم، رغم أنهم معرفتهم القديمة لهذه الكلمة.
والشيء نفسه مع الكثير من الكلمات والمصطلحات الأخرى، مثل: الملائكة، النبي، الجن…؛ فالكلمات هي نفسها ولكن المتغير هو طبيعة العلاقة التي تنحو منحى النظام المفهومي الكلي، الذي يقتضي الوقوف عند شبكة المفاهيم في القرآن؛ بمعنى أن القرآن يحمل هيكلا مفهوميا بمعنى كل موحد، وهو ما يسمى (“الجشتالت” أو “الكل الموحد”)([1]).
المعني “الأساسي” والمعني “العلاقي”:
يميز إيزوتسو بين معنيين للكلمة: الأول أساسي، والثاني علاقي، بوصفهما اثنين من المفاهيم المنهجية والرئيسية لعلم الدلالة، المعنى الأساسي هو الذي تأخذه الكلمة معها، وهو محتواها المفهومي الخاص بها؛ في الوقت الذي يكون المعنى العلاقي شيئا إضافيا يتم إلحاقه بالمعنى الأساسي، وذلك باتخاذ الكلمة معنى خاصا في حقل خاص، في ارتباط بعلاقات متعددة الأشكال بكل الكلمات الأخرى في ذلك النظام، ومن هنا يستمد المعنى العلاقي أهميته المنهجية بخلق حقول دلالية متعددة.
مثال توضيحي، نجد كلمة “يوم” بمعناها الأساسي تعني اليوم أي ليل ونهار، ولكن في المنظومة الدلالية القرآنية، فهي تعني أولا المعنى الأساسي لكلمة يوم، ولكن المعنى العلاقي لها هو المتعلق باليوم الآخر، وهنا وبالضرورة يجب الأخذ بعين الاعتبار الكثير من الكلمات التي ينطبق عليها نفس المعنى العلاقي ككلمة الساعة والبعث…، يعني أن الموضوع يأخذنا إلى حقول دلالية أخرى.
وبهذا فالقرآن عبارة عن حقول دلالية، ويقصد بالحقل الدلالي “مجموعة من الصلات الدلالية ذات طابع نمطي بين كلمات محددة”؛ فـحقول الدلالة التي شكلتها العلاقات المختلفة للكلمات فيما بينها، يمثل كل حقل دلالي منها مجالا مفهوميّا مستقِلا نسبيا ومشابهاً تماماً في الطبيعة للمعجم اللغويّ. والاختلاف بين “المعجم” و”الحقل الدّلالي” اختلافٌ نسبي، ومن الناحية الجوهريّة، لا يمكن أن يكون هناك اختلاف البتّة فيما بينها، لأنّه في جميع الأحوال، ليس “الحقْل الدّلالي” كُلاًّ أقلَّ تنظيماً من “المعجم اللغويّ”؛ لأنه كتلةٌ كاملة من كلماتٍ مرتّبة في نمط دال ممثّلٍ لمنظومة مفهوماتٍ مرتَّبة ومبنيّة وفقاً لمبدأ التنظيم المفهوميّ.
مثال توضيحي أخر، إنَ مفهوم الطريق “صراط” أو “سبيل” يؤدي الدور الأكثر أهمية في تشكيل التصور الديني الممَيز للقراّن، حتي إن القارئ الذي يقرأ القراّن بصورة عابرة، سيلاحظ أنه مُشبع بهذه الفكرة من البداية إلي النهاية. ومن الواضح جداً أن كلمة “صراط” أو مرادفها “سبيل” هي الكلمة المركز التي تحكم حقلاً دلالياً كاملاً مؤلفاً من عائلة كبيرة من الكلمات، يُمثل كل منها بطريقته الخاصة، ومن وجهة نظره، وجهاً جوهرياً من الفكر القراّني، ويُمكن بسهولة تصنيف الكلمات المفتاحية لهذا الحقل إلي ثلاث مجموعات رئيسية:
- الكلمات التي تُمثل المفاهيم المرتبطة بطبيعة كلمة “طريق” نفسها. والقراّن ينظر إليه من زاوية كونه “مُستقيماً” أو “سوياً”..إلي اّخره، أو أنه غير ذلك: “عِوج”، “مُعوج”….الخ.
- المفاهيم التي ترتبط باختيار الإنسان الطريق الصحيح أو انقياده إليه: “هدي”، “اهتداء”، “رشاد”…الخ.
- مفاهيم التيه عن الطريق الصحيح: “ضلال”، “غواية”، “تيه”….الخ.
تناول الكاتب أفكاره في هذا الكتاب من خلال تقسيمه لعدد من الفصول سنتناولها في السطور التالية:
الفصل الأول: الدرس الدلالي للقراّن
يقول الكاتب بأن الشطر المرئي من هذه الدراسة مهتم بشكل حصري بمسألة العلاقة الشخصية بين الخالق العظيم، سبحانه والإنسان في القراّن. وذلك في دراسة دلالية للرؤية القراّنية للعالم.
أراد الكاتب منذ البداية أن يكون لدى القارئ فكرة جلية تماماً عن ارتباط المنهجية القائمة علي علم الدلالة بالدراسات القراّنية، مؤكداً أنه جمع في هذا الكتاب بين النظر المعتمد علي مناهج البحث الدلالي، والتطبيق الذي مادته المعجم اللغوي للقراّن الكريم.
ونظرا إلي تعقيد علم الدلالة وزيادة افتقاره إلي الانسجام والتنظيم، عمد المؤلف منذ البدء إلي إيضاح تصوره الخاص لعلم الدلالة، وهو يقول في هذا الشأن: “إن علم الدلالة كما فهمته هو دراسة تحليلية للتعابير المفتاحية في لغة من اللغات ابتغاء الوصول إلي إدراك مفهومي لرؤية العالم لدى الناس الذين يستخدمون تلك اللغة أداة، ليس فقط للتحدث والتفكر، بل أيضَا لتقديم مفهومات وتفاسير للعالم الذي يحيط بهم”.
وهو يري أن الدراسة الدلالية للقراّن ستعالج الكيفية التي يرى فيها هذا الكتاب الكريم بناء عالم الوجود والمكونات الرئيسة له، وكيف يرتبط بعضُها ببعض. ويبين أن المهم لتحقيق قصده المحدد من الكتاب هو نوع النظام المفهومي الذي يعمل في القراّن، لا المفهومات الفردية المُتباعدة والمنظور إليها في حد ذاتها بعيداً عن البناء العام، أو الأبنية المتكاملة التي اندمجت فيها. ويوضح أن التعابير المفتاحية التي تؤدي وظيفة حاسمة في صياغة نظرة القراّن إلي العالم بما فيها اسمُ “الله” تعالى، ليس منها ما كان جديداً ومُبتكراً، بل كانت كلها تقريباً مُستخدمة قبل الإسلام. وعندما شرع الوحي الإسلامي باستخدامها كان النظام كله، أي السياق العام الذي استُخدمت فيه، هو الذي صدم مُشركي مكة بوصفه شيئاً غريباً وغير مألوف وغير مقبول.
ويميز المؤلف بين المعني الوصفي للألفاظ والمعني السياقي. وتؤلف الكلمات، كما يرى، نظاماً شديد التماسك. والنمط الرئيس لذلك النظام يُحدده عدد معين من الكلمات الشديدة الأهمية. ويساعد التحليل الدلالي للعناصر الوضعية والسياقية للكلمات في رأيه علي أن تبني من جديد، علي مستوى تحليلي، البنية الكلية الثقافية كما عاشت حقا، أو تعيش، في تصور الناس، ويُسمي هذه البنية الكلية “الرؤية الدلالية إلي العالم في ثقافة من الثقافات”.
يقوم عمل المؤلّف في الكتاب على أساس تصوّر واضح لديه يذهب إلى أنّ المعجم اللغوي، أو مجموع مفردات أيّ نص من النصوص أو مَتن من المتون، يتألّف من عدد هائل من طبقات الصلات الترابطية، أو مجالات الترابط المفهومي، التي يتطابق كلّ منها، مع اهتمام بارز لجماعة من الجماعات في مرحلة ما من مراحل التاريخ، ومن هنا يلخّص هذا المعجمُ اللغويّ جانباً من مُثُلها العليا وطموحاتها واهتماماتها. ويقول إنّ المعجم اللغويّ هنا متعدّدة الطّبقات، وتُصاغ هذه الطبقات من خلال مجموعات من التعابير المفتاحيّة التي يسمّيها “حقول الدلاّلة”.
ولتحقيق ذلك انشغل المؤلّفُ بالكيفية التي تُبنى منها “الحقول الدّلالية” المستقلّة، وكيفيّة اكتشاف الحقل الدّلالي وسط كل شديد التعقيد من العناصر المتشابكة. وأدخل في هذا المجال مصطلحاً تقنياً آخر هي “الكلمة الصميميّة”. وعنى بها تعبيراً مفتاحياً هاماً جداً يشير إلى، ويحدّد إطارَ، مجالٍ مفهوميّ مستقلّ ومتميّز نسبياً، أي “حقل دلاليّ” ضمن الكلّ الواسع للمعجم اللغويّ. ويعدّ من الكلمات الصميميّة في المعجم اللغويّ القرآنيّ كلمة “إيمان”، ويوضح أن هذه الكلمة تحكم حقلاً دلالياً خاصاً بها. ويقول إنّنا متى عددنا كلمة ما كلمةً صميميّة بدأنا نرى عدداً من الكلمات الأخَرى المهمّة، الكلمات المفتاحيّة، يتجمّع حولها بوصفها النّواةَ المفهوميّة أو نقطة البؤرة، مشكِّلةً معاً مجالاً مفهومياً دالاً ضمن المعجم اللغويّ الشامل للقرآن.
ويشير المؤلف إلى أنّ الكلمة الصميميّة في حقل دلالي معيّن قد تكون كلمةً مفتاحيّة في حقل آخر، والعكسُ صحيح أيضًا؛ فقد تكون الكلمةُ المفتاحية في حقل دلاليّ ما كلمةً صميمية في حقل آخر، وتتجمّع حولها مجموعةٌ من الكلمات المفتاحيّة. فكلمة “الله” مثلاً تظهر في الحقل الدّلاليّ لـ “الإيمان” كلمةً مفتاحية إلى جانب كلمات أُخَر تتركّز حول الكلمة الصميمية “إيمان”؛ لأنّ مدلولها في هذا السّياق المحدّد هو مَنْ يقع عليه فعْلُ “الإيمان”، فالإيمان في الحقيقة هو إيمانٌ بالله. وهناك اعتبارات أخرى مختلفة تحتّم النظر إلى كلمة “الله” على أنّها كلمة صميمية مهمّة تجمع حولَها مجموعةً من الكلمات المفتاحيّة تشتمل على “الإيمان” نفسه. ويذهب المؤلّفُ إلى أنّ كلمة “الله” هي أسمى كلمة صميميّة في المعجم اللغويّ للقرآن، ومهيمنة على الميدان كلّه. وليس هذا سوى التجلّي الدّلاليّ عندما قال إنّ عالم القرآن مرتكزٌ أساساً على الله.
الفصل الثاني: المصطلحات المفتاحية القراّنية في التاريخ
تحدّث المؤلف في الفصل الثاني عن التعابير المفتاحية القرآنية في التّاريخ، مستخدماً مصطلحي علم الدلالة التّزامنيّ أو الاّني وعلم الدلالة التّعاقبيّ. ويصل المؤلّف هنا إلى استنتاج أنّه في المنظومة القرآنية لايوجد أيّ حقل دلاليّ غير مرتبط بـ “الله” سبحانه وتعالى، وغير محكوم بمفهومه الأساسيّ.. وهذا ماجعل الدّارسين الدّلاليّين يذهبون إلى القول إنّ عالَم القرآن مرتكزٌ أساساً على الله، ولم يكن الأمرُ كذلك في الجاهلية.
ويحدّثنا المؤلّفُ هنا عن أمرٍ غاية في الأهميّة في تاريخ الثقافة الإسلاميّة الذي أعقب نزولَ القرآن، فيقول إنه بلغ من سلطان القرآن أن جعل كلَّ منظومة من منظومات الفكر الإسلاميّ مضطرّةً إلى اللجوء إلى المعجم اللغويّ القرآنيّ للحصول على عناصرها المادية. ويمثل لذلك بمنظومات علم الكلام والفلسفة والتصوف التي أفادت من المادة اللغوية القراّنية في تعابريها المفتاحية والصميمية.
ثم يقول الكاتب ان الشعر الجاهلي شكل معجما لغويا قائما بذاته، وشكل إلى جانبه القرآن حقلا دلاليا، ومع أن الشعر سابق على القرآن، فإن تتبع الحقل الدلالي والمعجمي للشعر الجاهلي سيساعدنا على فهم كيف برزت الأفكار الجديدة، وكيف تحولت الأفكار القديمة في الجزيرة العربية في تلك المرحلة الممتدة من الجاهلية المتأخرة إلى العصر الإسلامي الأول، كما أن هذا العمل سيمكننا من فهم تصور القرآن ورؤيته للكثير من المواضيع بمعزل عن الشعر الجاهلي، وهذا سيحررنا من نظرة جمهور المفسرين الذين فسروا القرآن من خلال دلالة الشعر الجاهلي في أغلب الأحيان.
الفصل الثالث: البنية الأساسية للرؤية القراّنية للعالم
يقدم هذا الفصل مخططا مجردا للبنية الأساسية للرؤية القراّنية للعالم، من خلال دراسة تحليلية ومنظّمة للكلمات الأكثر أهميّة، تلك الكلمات التي تبدو وكأنها تؤدّي وظيفة حاسمة في تمييز الفكرة الغالبة التي تتخلّل جملةَ الفكر القرآنيّ وتنفذ فيه وتغلب عليه .وابتغاء تحقيق هذا الهدف يري المؤلف أنه كان عليه في البدء أن يقرأ القراّن من دون أي تصور قبلي، أي أن لا يحاول أن يقرأ في القراّن الأفكار التي طورها وأحكمها المفكرون المسلمون في الأزمنة التي تلت نزول القراّن، بل عليه أن يحاول فهم بنية تصور العالم في القراّن في صورته الأصلية، أي كما قرأه وفهمه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه المباشرون.
يقول المؤلف في انطباعه الأول عن القراّن أنه نظام عظيم ذو طبقات مُتعددة، يقوم علي عدد من المتضادات المفهومية الأساسية التي يُكوَن كلَ منها حقلاً دلالياً مخصوصاً. والقراّن، كما انتهي إليه فهمه وتأمله، عالم يسوده جو حاد من التوتر والتأزم الروحي، ويقول إننا في القراّن أمام “دراما” روحية حادة تتقدم. ودائمًا لا تحدث “الدراما” إلا حيث يوجد تقابل قوي بين الممثلين أو الأبطال الرئيسيين. ويخلص من ذلك إلي أن الرؤية القراّنية للعالم من الوجهة الدلالية قابلة لأن تمثل صورة منظومة مبنية علي مبدأ التضاد المفهومي.
- الله والإنسان
ثم يتحدث عن التقابل الأول والأهم في هذه المنظومة، بين الله تعالي والإنسان. وهذا التقابل تنشئه أربعة ضروب مًختلفة للعلاقة بين الله والإنسان:
- العلاقة الأونطولوجية (الوجودية): بين الله بوصفه المصدر الجوهري للوجود الإنساني، والإنسان بوصفه مُمثلاً للعالم المخلوق الذي يدين بوجوده عيناً لله. إنها بتعبير علمي ديني، علاقة “الخالق والمخلوق” بين الله والإنسان.
- العلاقة التواصلية: حيث يدخل الله والإنسان في علاقة تبادلية حميمة كل منهما مع الاّخر – يأخذ الله، زمام المبادرة فيها – من خلال تواصل مٌشترك. ويمكن تمييز طريقتين مختلفتين لهذا التواصل:
- النوع اللفظي، وهذا النوع من التواصل قد يتم من الأعلى إلي أدني، وذلك هو “الوحي” بالمعني الضيق، أو من من الأدني إلي الأعلي، وهو الذي يتخذ شكل “الدعاء”.
- النوع غير اللفظي، من التواصل هو إما من الأعلي إلي الأسفل، ويتمثل بالفعل الإلهي (تنزيل الاّيات)، أو من الأسفل إلي الأعلي، ويتخذ شكل “الصلاة” أو الشعائر الدينية عموماً.
- علاقة الربَ – العبد: وتستلزم هذه العلاقة من جهة الله بوصفه “الربَ” كل المفاهيم المتعلقة بجلاله وعظمته وقدرته المطلقة…، بينما تستلزم من جهة الإنسان كـ “عبد” له، مجموعة من المفاهيم التي تتضمن الخضوع والتواضع والطاعة المطلقة وغير ذلك من الخصائص التي ينبغي أن تتوفر عادة في العبد. علي أن لهذا الجزء الإنساني من العلاقة جانباً سلبياً ملازماً له يتألف من مفاهيم تتضمن الغطرسة والتكبر والغرور والصفات المماثلة الأخري المرتبطة بكلمة”جاهلية”.
- العلاقة الأخلاقية، وهذه العلاقة تقوم على ذلك التغاير الأساسي جداً بين الوجهين المختلفين اللذين يمكن تمييزهما في مفهوم “الله”: إله الخير والرحمة والمغفرة والكرم اللامحدود من جهة، وإله العقاب والعدالة الصارمة من جهة أخري. وثمة نظير لذلك من جانب الإنسان يتمثل في التغاير الأساسي بين “الشكر” من جهة، و”التقوى” من جهة أخري. كما أن “الشكر” و”التقوى” يُشكلان معاً مقولة “الإيمان”، وذلك سيؤدي إلي تغاير حاد مع “الكفر” في كل من معنييه: الجحود وعدم الإيمان.
- المجتمع المسلم (الأمَة)
ويرى إيزوتسو أن هذه العلاقات متي رُسخت بين الله، سبحانه، والإنسان ولدت جماعة خاصة من الرجال الذين يعترفون بها ويختارون الجانب الإيجابي أساساً لنظرتهم إلي الحياة والوجود، مما أنشأ في تاريخ الإسلام “الأمة المُسلمة”. وتتمثل الاستجابة الإيجابية في العلاقة الوجودية في اعترافهم بـ “الله” خالقًا لهم وموجداً ومعتنياً بمصيرهم. أما الاستجابة الإيجابية في علاقة الاتصال فتتمثل في استجابة الإنسان استجابة راضية مُخلصة للنداء الإلهي واتباع هدايته وتوجيهه إلي طريق النجاة. وأما في علاقة الرب-العبد فتعني الاستجابة الإيجابية أن يطرد الإنسان عن نفسه بقايا الجاهلية السابقة ويلجأ إلي الله “سيده” كما يليق حقًا بالعبد، وتعني العلاقة الأخيرة أن يعبر عن الشكر لفضل الله عليه وأن يخشى عقابه.
ثم يتحدث المؤلف عن التضاد المفهومي الثاني: الغيب والشهادة. ويوضح أن الرؤية القراّنية تقسم العالم الحاضر الذى يحيا فيه الإنسان إلي نصفين، عالم الغيب وعالم الشهادة، وهذا هو التضاد المفهومي الرئيسي الثاني الذي يُمكن تبينَه فى رؤية القراّن للعالم، وهما الشكلان الأساسيان لعالم الوجود كله.
كما تناول الكاتب مفاهيم أخري موضحاً ما بينها من تضاد، كفهومي الدنيا والاّخرة، ومتناولاً لهذه المفاهيم في الحقبة التي سبقت نزول القراّن “العصر الجاهلي” والسياق التي ذكرت فيه تلك المفاهيم في القراّن الكريم.
مُستخدما عددًا من الرسوم البيانية في كثير من سياقات الكتاب لتوضيح الفرق بين تلك المتضادات.
الفصل الرابع: الله
ويخصّص الكاتب الفصلَ الرّابع للكلمة الصميمية في المعجم اللغويّ القرآنيّ: “الله”، ويبيّن أنّ النظرة إلى العالَم في القرآن مرتكزة على “الله” سبحانه، أساساً. والحال كذلك، أنّه في المنظومة القرآنية يحكم مفهومُ “الله” الكلَّ من علٍ، ويترك تأثيراً عميقًا في البنية الدّلالية للكلمات المفتاحيّة جميعاً. ولأهمية فهم الكيفية التي يُبنى فيها هذا المفهومُ دلالياً، خصّص المؤلّفُ هذا الفصل لتحليل مفصَّل نسبياً لهذا المفهوم، ويتحدّث المؤلّفُ هنا عن تطوّر المعنى “السّياقيّ” لكلمة “الله” بين عرب الجاهلية، ويميّز بين ثلاث حالات مختلفة:
- الأولي هي المفهوم الوثنيّ لكلمة “الله”، وهو مفهوم عربي خالص. وتلك هي الحالة التي نرى بها العرب “الجاهليين” يتحدثون عن “الله” كما يفهمون الكلمة بطريقتهم الخاصة. والنقطة المثيرة للاهتمام بهذا الشأن هو أن الأدب “الجاهلي” لا يُمثل مصدر المعلومات الوحيد الذي نملكه حول هذا الموضوع كما يقول الكاتب، إذ إن أكثر المعلومات المباشرة يًمكننا الحصول عليها من القراّن نفسه، الذي قدم وصفاً حيوياً دقيقاً لما كان عليه الموقف فعلياً.
- الحالة الثانية التي نري فيها يهود ونصارى عصر ما قبل الإسلام يستعملون كلمة “الله” نفسها للإشارة إلي “إلاههم” الخاص بهم. وفى هذه الحالة فإن كلمة “الله” تُعني بالطبع إله الكتاب المقدس، وهو مفهوم توحيدي إلي حدَ نموذجي.
- استخدام العرب الوثنيّين للمفهوم الكِتابيّ لـ “الله” خاصّة عندما يمدحُ شاعر بدويّ مَلِكًا نصرانياً.
- ويضيف إلى الحالات الثلاث السّابقة حالة أخرى خاصّة جداً، هي مفهومُ الله لدى مَن عُرِفوا باسْم “الحُنفاء”. وقد ظلّت هذه الحالةُ مستقلّةً ومتعالية نسبياً عن الأخريات إلى أن ظهر الإسلامُ فأتى بها على نحو مفاجئ إلى ضوء التاريخ.
الفصل الخامس: العلاقة الوجودية بين الله والإنسان
ناقش الكاتب في هذا الفصل محورَينْ مهمّين يدوران في فلَك هذه العلاقة، وهما خلْقُ الله الإنسانَ من عدَم، وقدَرُ الإنسان. ويعقد المؤلّف هنا مقارنة رائعة بين النظرة الجاهليّة إلى العالَم، والنظرة القرآنية. فالنظرة الجاهليّةُ نظرةٌ كئيبة جداً إلى الحياة، إذ تُتصوَّرُ الحياة كلُّها سلسلةً من الفواجع، التي لا يحكمها القانون الطبيعيّ، بل الإرادة الغامضة لكائن مظلم أعمى شبه شخصيّ، لا منجاة من قبضته القويّة.
أمّا عالَمُ القرآن فيقدِّم صورةً مختلفة تمامًا للشرط الإنسانيّ. إذ على حين غِرّة تصحو السّماء، ويتبدّد الظلام، وفي موضع المعنى المأساويّ للحياة يظهر مشهدٌ متلألأ جديد للحياة الخالدة. والاختلافُ بين النظرتين إلى العالَم في هذا الشأن شبيهٌ تمامًا بالاختلاف بين اللّيل والنهار.
وهكذا فإنه في المنظومة الجاهلية القديمة، يكون العمل الخلقي لـ “الله” تعالى هو في الوقت نفسه البداية والنهاية لتدخل الله فى شؤون الإنسان، و”الله” من حيث المبدأ لا يعبأ بمن أتى بهم إلي الوجود، كحال أب غير مبالِ بأولاده، المهمة كلها تُنجز بوساطة كائن اّخر يُسمى “الدهر”.
أما في المنظومة المفهومية الإسلامية فالأمر علي العكس من ذلك، فالخلق يحدد فقط بداية الهيمنة علي المخلوقات. وشؤون الإنسان كلها، حتي أدق تفاصيل الحياة وأكثرها أهمية في الظاهرهي تحت الاطلاع الصارم والمراقبة الدقيقة لحضرة “الله” سبحانه. والأكثر أهمية في هذا الشأن أن “الله” في القراّن هو “الله” ذو العدل الذي لا يظلم أبدًا.
الفصل السادس: العلاقة التواصلية بين الله والإنسان، التواصل غير اللغوي
وجاء الفصْلُ السّادسُ من الكتاب ليعالج العلاقةَ الثانية، الاتّصالية، بين الله سبحانه والإنسان في ضرْب الاتّصال غير اللغويّ. وهنا يفصِّل المؤلّفُ القولَ في نوعين من علاقة الله سبحانه بالإنسان، هما: آياتُ الله، وهدى الله.
ويُفرق المؤلف بين الاثنين تفريقاً دقيقاً. فالاّيات موجودة في كل شئ، والإنسان يستطيع أن يراها، لكن اختيار الاهتداء أو الضلال راجع إلي مشيئة الله، وصحيح أنه يوجد في القراّن قول الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (الكهف – 29)، لكن الصورة النهائية محكومة بمشيئته من له ملك السموات والأرض ومن فيهن { مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }، (الأنعام – 39)،
ويُناقش إيزوتسو المسألة بقدر من التفصيل، فيبين أنه في المفهوم الأول، يستجيب الإنسان لهدى الله إما بالاهتداء وإما بالضلال. أما في المفهوم الثاني، فيستجيب الإنسان لهُدى الله بالاهتداء، ويستجيب للضلال بالضلال، حسب التقدير الإلهي. وختم هذا الفصل بالحديث عن العبادة بوصفها أداة لاتصال العبد بربه، كعبادة “الصلاة” على سبيل المثال، حيث يُمكن النظر إلي الصلاة من زوايا متنوعة، لكنها من زاوية النظر الخاصة بهذه الدراسة هي نوع من التواصل غير اللغوي في الاتجاه الصاعد، أي من الإنسان إلي الله، ذلك أنها تعبير ذو هيئة خاصة عن الإجلال العميق الذي يشعر به الإنسان في حضرة الله. وبدلاً من أن يتلقى الإنسان كلمات الله واّياته بصورة سلبية، فإنه يُحَض ويؤمر بالتعبير الإيجابي عن مشارع التوقير التي يكنَها من خلال مجموعة من الأفعال الجسدية برفقة الذين يقاسمونه الشعور نفسه.
الفصل السابع: العلاقة التواصلية بين الله والإنسان، التواصل اللغوي
حيث تناول المؤلف العلاقة الاتصالية بين الله والإنسان في نوع الاتصال اللغوي. ويدير حديثه هنا حول جملة محاور: كلام الله، والمعني الأصلي لكلمة وحي، والبنية الدلالية للوحي، والوحي في اللغة العربية، والدعاء.
وبدا في هذا الفصل أن الكاتب يتحدث عن اتصال لغوي بين الله تعالي والإنسان في اتجاهين: من حضرة الله إلي الإنسان بوساطة كلام الله والوحي، ومن الإنسان إلي الله بوساطة الدعاء.
الفصل الثامن: “الجاهلية” والإسلام
عالج الكاتب في هذا الفصل الجانب الثالث من علاقة الله والإنسان، وهي علاقةُ الرّبّ – العبد. ويبين أن تصور “الله” ربا لم يكن مجهولاً لدى عرب الجاهلية، وفرق ما بين الجاهلية والإسلام في هذا الشأن حيث أنه في الأزمنة الجاهلية لم يكن “الله” الرب الوحيد المطلق، بل كان إلي جانبه أرباب كثيرون وربات كثيرات. أما الإسلام فقد أقر بـ “الله” لأول مرة الحاكم المطلق، الرب الأوحد للعالم كله. وقد نشأ عن هذا التصور أن فُهم الإسلام بمعنى التسليم التام لهذا الرب العظيم.
الفصل التاسع: العلاقة الأخلاقية بين الله والإنسان
خصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن العلاقة الرّابعة بين الله والإنسان: العلاقة الأخلاقية. وتنهض معالجةُ المؤلّف في هذا الفصل على فكرة تبدو مستقرّة لديه هي أنّ أحد الملامح الجليّة جداً للفِكْر الدّيني الذي نشأ في العالَم السّاميّ، أي اليهوديّة أو النصرانية أو الإسلام، هو أنّ مفهوم “الله” أخلاقيّ أساساً. أي إنّ الله سبحانه لأنّه أخلاقيّ أساساً، يعامل الإنسانَ بطريقة أخلاقية، أي بوصفه اللهَ ذا العَدْل والخير، ويُنتظَر من الإنسان أن يستجيب لهذه المبادرة الإلهية أيضاً بطريقة أخلاقية. والله سبحانه يتجلّى للخلق في نوعين مختلفين من التجلّي: اللهُ ذو الرّحمة، واللهُ ذو الانتقام، أو اللهُ ذو الفضل والله ذو العَدْل. واللهُ سبحانه يعامل الإنسان بطريقة غاية في الرّحمة والفضل واللّطف في صورة الآيات المنزلة. وهذه الحقيقةُ تحدّد الاستجابة الصحيحة الوحيدة المنتظرة من بني البشر، وهي الشّكر. ولا يكون الشّكر إلاّ بعد فهم الآيات. وهكذا لأوّل مرة في تاريخ الفِكَر بين العرب يغدو “الشكرُ” مفهوماً دينياً، وتكون المسافةُ قريبة جدًّا من الشكر إلى الإيمان. وضدُّ الشّكْر هو “الكفرُ”، الذي يعني عدم الاعتراف بالجميل، أو الجحود.
وهكذا يأخذ مفهوم “الكفر” الذي لا علاقة له قبل الإسلام البتة بالدين، مغزي دينياً في المنظومة القراّنية. وإذا كان عرب الجاهلية اعتادوا على أن يعيشوا وفق القاعدة الأخلاقية العليا: “شكر النعمة”، فقد تبنى القراّن هذه البنية كما هي وارتقى بها إلي مستوى ديني. النعمة في هذه الحال هي الفضل الإلهي الذي يستجيب له الإنسان إما علي نحو صحيح بـ “الشكر”، وإما علي نحو خاطئ بـ “الكفر”. ويتطور مفهوم الشكر هنا بسهولة إلى مفهوم “الإيمان”. وعلي نحو مُماثل، يتحول الكُفر، فاقدًا دلالته الأصلية المتمثلة بـ “عدم الاعتراف بالجميل”، إلي مفهوم “عدم الإيمان”، وهكذا يغدو مضادًا مفهومياً مباشراً لـ “الإيمان”، كما يغدو ذلك جلياً في قول المولى سبحانه {كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم} (اّل عمران – 86).
أما من يتخذون موقف الكفر بدلاً من الشكر أو الإيمان، لمن يرفضون الخضوع لله ولمن يغفلون تماماً عن الاستجابة الصحيحة، فيظهر الله تعالي التجلي الاّخر، تجلي العدل الصارم والأخذ الشديد. والنقطة المحورية لهذا كله هي الفكرة الأخروية “يوم الحساب”.
وفي نهاية الفصل يقف المؤلف عند ثنائيين مفهومين واضحين في القراّن هما : الوعد والوعيد، والبشارة والنذارة. وفي مناقشة كل ثنائي يعمد المؤلف إلي المقارنة بين ما كان عليه الأمر في الجاهلية وما اّل إليه في الإسلام.
في الختام، نرى أن هذه الدراسة تثبت أن النص القرآني قائم بذاته وذو رسالة متكاملة ورؤية شاملة للإنسان والكون، رؤية لا يمكن ردها إلى أفكار العرب في الجاهلية أو من التراث اليهودي أو المسيحي، رؤية تجلت واضحة من خلال النقلة الدلالية الواسعة التي أدخلها القرآن على المعجم العربي؛ لتعكس فلسفته عن الكون والوجود.”
فالكتاب عبارة عن نظرة شخص محايد للقرآن يتناول الموضوع من جانب جديد وهو علم الدلالة، من خلال التركيز على الكلمات ودلالتها ومعناها واستخدامها في الجاهلية وفي الإسلام، و العلاقة بين الله والإنسان.
عرض
أ. أحمد محمد على
باحث ماجستير في العلوم السياسية، جامعة القاهرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – كلمة جشتالت ( Gestalt ) كلمة ألمانية معناها شكل ( shape ) أو صورة ( Form ) وتعني الكل المتكامل. إذ يرى أصحاب هذه المدرسة أن الكل أكبر من الأجزاء ذلك لأن الكل هو الذي يحدد معنى عناصره وأجزائه. أي أن الجزء ليس له معنى ألا من خلال الكل.
 مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies
مركز خُطوة للتوثيق والدراسات Khotwa Center for Documentation& Studies